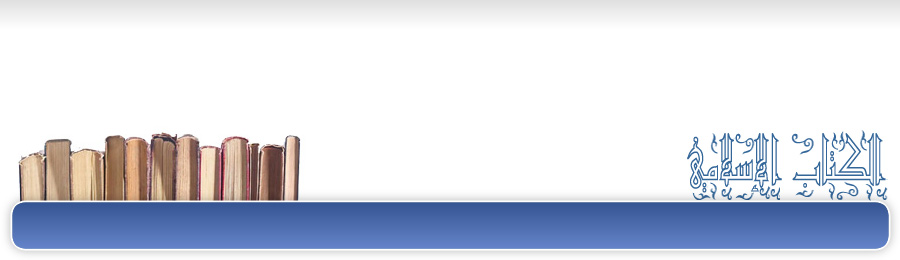كتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبي
المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر
قال الشيخ العلامة أوحد عصره وفريد دهره لسان الشريعة سيد علماء الطريقة أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي رحمه الله تعالى ممليا لحل مقاصد الرعاية للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا به وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابهفصل في حسن الاستماع إلى كل ما أمر العباد بالاستماع إليه
حسن الاستماع أن تصغي إلى ما تستمع إليه من غير أن تشغل قلبك أوشيئا من جوارحك بغير ما تستمع إليه وتقبل عليه إلى ما يعينك على فهم ذلك من الإقبال بعينك من يحدث بذلك أو تنظر في كتاب يشتمل على ذلك وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لمن أحسن الاستماع أن يحصل له الاتعاظ والانتفاع بما استمع له وأصغي إليه فقال تعالى { إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد } أي إن في ذلك اتعاظا لمن كان له عقل أو ألقى سمعه إلى الموعظة وهو حاضر العقل غير غائب عما يستمع إليه
فصل فيما يجب رعايته من حقوق الله تعالى
رعاية الشيء حفظه من الفوات والنقصانوحقوق الله سبحانه وتعالى ضربان أحدهما فعل الواجبات
والثاني ترك المحرمات
ففعل كل واجب تقوى وترك كل محرم تقوى والحامل على التقوى الخوف من عذاب الله تعالى وعقابه فمن أتى بخصلة منها فقد وقى نفسه بها ما رتب
على تركها من شر الدنيا والآخرة مع ما يحصل له من نعيم الجنان ورضا الرحمن
فصل فيما يتقرب به إلى الله تعالى
لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بطاعته وطاعته فعل واجب أو مندوب وترك محرم أو مكروه فمن تقواه تقديم ما قدم الله سبحانه وتعالى من الواجبات على المندوبات وتقديم ما قدمه من اجتناب المحرمات على ترك المكروهات وهذا بخلاف ما يفعله الجاهلون الذين يظنون أنهم إلى الله سبحانه وتعالى متقربون وهم منه متباعدون فيضيع أحدهم الواجبات حفظا للمندوبات ويرتكب المحرمات تصونا عن ترك المكروهات ولا يقع في مثل هذا إلا ذوو الضلالات وأهل الجهالاتفكم منا مقيم لصور الطاعة مع انطواء قلبه على الرياء والحسد والغل والكبر والإعجاب بالعمل والإدلال على الله تعالى بالطاعات { الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا } الكهف
وكم من ناظر إلى ما لا يحل
النظر إليه ومغتاب لمن لا تجوز غيبته ومزدر لمن لا يحل ازدراؤه ظنا أن ذلك
من الجائزات وغفلة عن كونه من المحرمات
والتقوى قسمان أحدهما متعلق بالقلوب وهو ضربان
أحدهما واجب كإخلاص الأعمال والإيمان
والثاني محرم كالرياء وتعظيم الأوثان
والثاني يتعلق بالأعضاء الظاهرة كنظر الأعين وبطش الأيدي ومشي الأرجل ونطق
اللسان
فائدة
إذا صحت التقوى أثمرت الورع والورع ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأسفصل في تعريف الجاهل المغرور غرته
قد تقدم أن التقوى متعلقة بالجنان وبالأركان فنبدأ بتعرف اختلال التقوى في الأركانوطريق ذلك أن يعرض أعمال جوارحه الظاهرة من حين
بلغ إلى وقته ذلك على كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم
فإن وجد نفسه على حفظ حدود الله تعالى بجميع جوارحه فليعدل بعد ذلك إلى
تقوى قلبه فإن وجد قلبه مستقيما من حين بلوغه إلى حين عرضه فهذا ولي من
أولياء الله سبحانه وتعالى وقل أن يوجد ذلك في هذا الزمان
وكيفية
عرض ذلك أن ينظر إلى ما يتعلق بكل عضو من أعضائه من أمر الله تعالى ونهيه
فيعرضهما عضوا عضوا فيعرض اللسان مثلا هل ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى
بقوله كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن تحقق أنه قام بجميع ما أمره
الله تعالى وما أعز ذلك فليرجع إلى ما نهى عنه فإن عرف أن لسانه محفوظ عن
ذلك من حين بلغ إلى حين عرضه وما اعز ذلك فليعدل إلى تقوى العين بفعل
مأموراتها واجتناب منهياتها فإن استقامت على الأمر والنهي في جميع ذلك ولن
يسلم له ذلك فليعدل إلى منهيات سمعه ومأموراته فإن علم أنه قائم بوظائفها
وما أندر ذلك فليعدل إلى بطش يده فليعتبر استقامتها على الأمر والنهي في
بطشها فإن علم أنه قد أدى ما عليه في جميع ذلك وما أغرب ذلك
فليعدل إلى مشي رجله فليعتبره بالأمر والنهي كذلك ثم إلى بطنه
وفرجه كذلك
فإن ظن الاستقامة في ذلك جميعه أو بعضه فلا يغترن بذلك ولينظر إلى قصده
بجميع طاعته هل أراد بكل واحدة منهن وجه الله سبحانه وتعالى أم لا فإن صفى
له ذلك وما أعز صفاءه فلينظر هل أعجب بنفسه فرأى أنه لأجل طاعته خير من
غيره أم لا فإن لم ير نفسه خيرا من غيره في شيء من طاعته فلينظر هل تكبر
على عباد الله بسبب ذلك أم لا فإن صفا له ذلك وما أعز أن يصفو فلينظر هل
أسند استقامته إلى عزمه وحزمه أم نسب ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى فإن صفا
له ذلك مع عزته وندرته فلينظر هل أعجبته نفسه بذلك أم لا صفا له ذلك مع
غرابته فلينظر هل أدل على الله سبحانه وتعالى بهذه الاستقامة أم لا فإن
صفت له هذه الأحوال المتعلقة بالطاعات فلينظر في معاصي أخرى هل تطهر منها
قلبه أم لا كالحسد والشماتة وإرادة العلو في الأرض
فإذا اعتبر ذلك
جميعه وأنصف من نفسه عرف أنه كان هاربا عن الله سبحانه وتعالى وهو يعتقد
أنه هارب إليه ومعرض عن الله سبحانه وتعالى وهو يعتقد أنه مقبل عليه
ومعتمد على خلقه وهو يعتقد أنه معتمد عليه ومفوض إليه
فصل في ابتداء المسير إلى الله عز وجل
أول ما يجب على المكلف أن يعلم أن له ربا أمره ونهاه ليثيبه على طاعته ويعاقبه على معصيته وأنه يلزمه الفرار من عقوبته بطاعته واجتناب معصيته وإليه الإشارة بقوله تعالى { ففروا إلى الله } الذاريات والفرار إليه إنما يكون بطاعته واجتناب معصيته وإنما تعرف طاعته ومعصيته بتعلم شريعتهفعليه أن يتعلم من علم الشرع ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه في ظاهره وباطنه ليجتنبه وما أوجبه عليه في ظاهره وباطنه ليفعله على حسب الحال التي هو ملابسها ومدفوع إليها
فيلزمه تعلم الصلاة والصوم بأركانهما وشرائطهما إذا دخل وقتهما أو دنا دخول وقتهما ولا يلزمه تعلم الزكاة إلا إذا وجبت أو دنا وجوبها وكذلك لا يلزمه تعلم الحج والجهاد إلا إذا كان من أهلهما فإن اتسع وقتهما كان التعلم واجبا مخيرا فإن ضاق وقتهما تضيق تعلمهما
وكذلك سائر ما يتجدد له من سائر الأسباب الموجبة للتقوى في ظاهره وباطنه يلزمه تعلم ذلك بأسبابه وأوقاته وشرائطه وأركانه ومفسداته
فصل في بيان محاسبة النفس على الأعمال السالفة والمستأنفة
أجمع العلماء على وجوب محاسبة النفوس في ما سلف في الأعمال وفيما يستقبل منها فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله سبحانه وتعالىفأما المحاسبة في الماضي فبأن ينظر في التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح والأعضاء فيعتبرها عضوا عضوا وطاعة طاعة فإن سلم جميع ذلك بأركانه وشرائطه وأوقاته وأسبابه فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك فإنه من أكمل نعمة الله تعالى على عباده
والأولى به أن يحاسب نفسه من ليل إلى ليل فما رآه من تقصير في يومه ذلك فليتداركه بالتوبة والاستغفار وكذلك كان يصنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وإن وجد في أعمال يومه ظلامه فليردها من وقته على أهلها إن أمكن ذلك وإلا فليعزم على ردها على حسب إمكانه
وأما المحاسبة في المستأنف فلينظر إذا خطر له إقدام على فعل أو إحجام عنه
فإن كان ذلك الفعل سيئة أحجم عنه وعن العزم عليه وليغيبه عن خاطره ما
استطاع
فإن مالت إليه نفسه واشتدت شهوته فليجاهدها بصرفها عنه وخلاصها منه
فإن غلبته وعزمت عليه فليجاهدها في الإقلاع عن عزيمتها والاستغفار منها
فإن غلبته نفسه العاصية الأمارة بالسوء ففعل ذلك فليبادر إلى التوبة وهي
الندم على ما فاته من طاعة الله تعالى والعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك
في المستقبل والإقلاع عن المعصية إن كان ملابسها في الحال
فإن أخر التوبة أثم بتأخيرها عن كل وقت يتسع لإيقاعها فيه
فإن أبت نفسه عن الإقلاع فليحذرها بما يفوتها من ثواب الله سبحانه وتعالى
وبما تعرضت له من عقاب الله تعالى ويستمر على تخويفها بذلك إلى أن يحصل
الخوف الموجب للتوبة والاستغفار من الحوبة
فائدة في مراقبة النفس للفعل الحسن والقبيح
إنما يفرق المريد بين الفعل الحسن والقبيح بالكتاب والسنة إن كان عارفا بذلك فإن التبس عليه الفعل الحسن بالقبيح فليكف عنه ولا يعزم على إقدام ولا إحجام حتى يسأل عن ذلك من يعرفه من علماء الشريعة لأن التباس المحرم بالمحلل مانع عن الإقدام على ما لا يعرف حلاله من حرامهوأما المحاسبة في مستقبل الأعمال الصالحات فإنها مبنية على معرفة رتب الطاعات وما يجب تقديمه منها أو توسطه أو تأخيره فإن الشيطان إذا يئس من التائب أن يوافقه على المعاصي الظاهرة دس عليه معاصي خفية لا يشعر بها فيأمره بتقديم طاعة أوجب الله تعالى تأخيرها أو توسيطها أو يأمره بتقديم طاعة أوجب الله تعالى تقديمها أو توسيطها كل ذلك ليخسر العبد من حيث لا يعلم
وقد توافق النفس الشيطان على ذلك فرارا من أثقل العبادتين وأشقهما إلى أخفهما وأرفقهما وطريقة في النجاة من ذلك أنه إذا خطرت له حسنة فلا يقدم عليها حتى ينظر أهي مما قدمه الله أو مما أخره أو مما وسطه فإن كانت مما قدمه الله في ذلك الوقت على سائر الطاعات فلا يقدم عليها حتى يخلصها لله عز وجل ولا يرد بها سواه
وإرادة الله تعالى بالأعمال الصالحات أقسام أحدها أن يعمل له طمعا في ثوابه
والثاني أن يعمل له خوفا من عقابه
والثالث أن يعمل له حياء منه أن يخالفه
والرابع أن يعمل له حبا وودادة
والخامس أن يعمل له إجلالا وتعظيما عن المخالفة
والسادس أن يضيف بعض هذه الأعراض إلى بعض
وكل ذلك حسن وإن كان بعضه أفضل من بعض
فصل في رتب مشقة التقوى والمحاسبة
الناس في ذلك ثلاثة أقسامأحدهم شاب نشأ في عبادة الله لا تقع منه إلا الصغائر في أندر الأوقات فرعاية التوبة والتقوى على مثل هذا سهلة قليلة المؤنة لأن التقوى
قد صارت له عادة مألوفة يلتذ بها ويسكن إليها وإذا وقعت منه
الزلة استوحش بسببها وبادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها
الثاني من تاب من ذنوبه وأقلع عن عيوبه بعدما ألف المعاصي والمخالفة فنفسه
تذكره بتلك الشهوات والتلذذ بها ليعود إليها والشيطان يحثه على ذلك ويدعوه
إليه فرعاية التقوى والتوبة على هذا شاقة لأجل ما ألفه من الركون إلى
الشهوات والاستراحة من مشقة الطاعات
الثالث مسلم موحد مرتكب لجميع
ما يهواه من المعاصي والمخالفات قد رين على قلبه بسوء كسبه فرعاية التقوى
على هذا شديدة المشقة لأجل ما يفوته من تلك الساعات ولما يشق عليه من
ملابسة الطاعات
فصل في بيان تيسير التقوى الشاقة وتسهيلها على النفس
خلق الله تعالى الإنسان مجبولا على السعي فيما يلذه من الشهوات وعلى النفور مما يشق عليه من المؤلمات فكان من محنته لعباده أن كلفهم بفعل ما يشق عليهم من الطاعات وبترك ما يشق عليهم تركه من المخالفات فحف جنته بالمكاره وحف ناره بالشهوات
ولما علم ذلك من عباده وعد من أطاعه وخالف شهوته بالمثوبات والكرامات
ليقبلوا على الطاعات والقربات
وتوعد من عصاه ووافق شهوته بالعقوبات والإهانات ليحجموا عن المعاصي
والمخالفات
فالطريق إلى سهولة التقوى تكون تارة بالخوف وتارة بالرجاء فإنه إذا نظر
إلى ما أعده الله لعباده الطائعين من الكرامات مال إليه بطبعه فحثه طبعه
على احتمال مشقة الطاعات بفعل المأمورات وترك المنهيات وإذا نظر إلى ما
توعد الله به عباده العاصين من العقوبات حثه طبعه على أن يتقيها بملابسة
المشقات في إقامة الطاعات
فالخوف والرجاء وسيلتان إلى فعل الواجبات
والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ولكن لا بد من الإكباب على استحضار
ذلك على الدوام واستدامته في أكثر الأوقات حتى يصير الثواب والعقاب نصب
عينيه فيحثاه على فعل الطاعات وترك المخالفات
لكن الفكر الذي يحصل به الإكباب على استحضار الثواب والعقاب شاق على النفس
من ثلاثة أوجه
أحدها أن الفكر في أهوال الآخرة وشدائدها شاق على النفوس ملذع
لقلوب ولا سيما في حق من كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه وتفكر في وقوفه
بين يدي ربه وعرض أعماله القبيحة عليه
الثاني أن الفكر في أحوال الآخرة وشدائدها مانع من الفكر في لذات الدنيا
وشهواتها
الثالث أن الشيطان ونفس الإنسان يستشعران من التائب أنه يمنع نفسه من نيل
شهواتها وإدراك لذاتها في مستقبل الزمان فيحثانه على ترك ما عزم عليه
أما النفس فتحثه على ذلك لتنال لذاتها وشهواتها العاجلة وأما الشيطان
فلأنه عدو للإنسان فلذلك يأمره بكل إثم وعدوان ليحله في دار الهوان وغضب
الديان فالذي يخفف الفكرة على قلبه أن ينظر إلى ما تحصل عليه من لذات
الدنيا وإلى نظره في الآخرة ليعلم أنما يفوته من لذات الدنيا المقرونة
بالنغص لا نسبة له إلى ما يفوته في الآخرة من النعيم والنظر إلى وجه الله
الكريم
والعاقل لا يؤثر الحقير القليل الفاني على الكثير الخطير
الباقي غير مقرون بنغص بلا تعب ولا نصب فإذا واظب على النظر في ذلك آثر
النفيس الباقي على الخسيس الفاني ثم ينظر إلى ما يتحمله في الدنيا من مشاق
الطاعات وينسبه إلى ما يتحمله في الآخرة من مشاق العقوبات الممزوجة بغضب
رب
السماوات فيتحمل المشاق اليسيرة الفانية دفعا للمشاق العظيمة الباقية لأن العاقل يدفع أعلى الضررين بأدناهما ويحاسب نفسه بأن يقول لها ويحك يا نفس كيف تجزعين من تلذيع ذكر أهوال الآخرة لقلبك ولا تجزعين من تلذيع عقوبات الآخرة ومشاقها لجسدك وقلبك وكيف يشق عليك ترك الفكر في لذة الدنيا مع نغصها وخساستها ولا يشق عليك فوات لذات الآخرة مع شرفها ونفاستها أتستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير { ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون } البقرة ولو أنك واظبت على الفكر في أمور الآخرة لأبدلك الله من وحشة العصيان وذلته بأنس الطاعات وعزتها وسرورها وروح رجاء الجزاء عليها في الآخرة ولن يحصل له الإكباب على الفكر الذي يستحضر به أهوال القيامة إلا بجمع همه على الفكر في ذلك ولن يحصل له ذلك إلا بتفريغ قلبه من كل شيء سوى ما يفكر فيه أو يعينه على الفكر فيه وكذلك لا يشغل جوارحه بما يلهيه عن الفكر فيما هو بصدده
وقد ذكرنا نظير ذلك في حسن الاستماع
ولا بد من إدامة الفكر في ذلك إلى أن يحصل في القلب وجل وخوف يحثانه على
الاستعداد لذلك اليوم ومثال ذلك الوقود تحت القدر لا بد من إدمانه إلى
إنضاج ما في القدر فلذلك لا ينضج القلب إلا خوف متوال متواصل يوجب للقلب
قذف الشهوات خوفا من العقوبات كما يقذف القدر بالزبد عند إدمان الوقود
وتكثيره فإذا فعل ذلك أراد الشيطان أن يفسد عليه عمله فأوهمه أنك ما نلت
ذلك إلا بعزمك وحزمك وحسن نظرك لنفسك
فإن قبل منه ذلك وكله الله إلى
نفسه وإن رد ذلك على الشيطان حصل الخوف الناجع بالتفكر وحصل الإقلاع عن
الزلات والإنابة إلى الطاعات بسبب الخوف الناجع وتوفيق رب الأرض والسماوات
ولو لاحت لهؤلاء أو لأحدهم لائحة من لوائح العرفان لاجتمع همه من غير
تكرير الفكر ولا إدمان وما أعز هذا في هذا الزمان
وأنشد فيه
( كانت لقلبي أهواء مفرقة ** فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي )
( تركت للناس دنياهم ودينهم ** شغلا بذكرك يا ديني ودنياي )
( فصار يحسدني من كنت أحسده ** وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي )
وقد مثل إدمان الفكر وجمع الهم لتحصيل الخوف الحامل على التقوى والإنابة
إلى الله تعالى بمثالين
أحدهما الثوب الذي كثرت أوساخه وأدرانه فإنه لا يزول ذلك إلا بتكرير الغسل
وحته وقرصه وكذلك القلب الذي رانت عليه الشهوات ودنسته اللذات المحرمات لا
يزول ما فيه من الشهوات إلا بالإدمان على الفكر الموجب للإقلاع عن الزلات
المثال الثاني المرض المزمن المستحكم لا يزول إلا بتكرير الأدوية
والمعالجات فكذلك القلوب المريضة لا تزول أمراضها إلا بتكرير الفكر فيما
أعد الله تعالى للعصاة من العقوبات
فائدة في فرط الخوف بسبب إدمان الفكر
قد يفرط الخوف بسبب إدمان الفكر فيخشى منه أن يصير قنوطا فلا بد أن يكسر بروح الرجاءوإنما يحصل ذلك بإدمان الفكر في سعة رحمة الله تعالى وغفرانه للحوبات وقبوله للتوبات
فصل في اعتراض النفس والشيطان في أيام تخويف المغرور نفسه
قد يتأخر الخوف الناجع كما يتأخر البرء عن استعمال الدواء النافعفتعرض النفس والشيطان لمن يداوي قلبه بإدمان الفكر والتخويف
فيقولان مثلك
لا ينجع فيه إدمان الفكر ولا ينفعه التخويف وربما حرمك ربك ذلك لكثرة
ذنوبك وفرط عيوبك
فإن أصغى إليهما وقبل منهما يئس من روح الله
ورحمته ورجع إلى أشد مما كان عليه من الفسوق والعصيان { إنه لا ييأس من
روح الله إلا القوم الكافرون } يوسف
وطريقه في ذلك أن يقول التخويف
إنما يليق بمثلي وأمثالي ولولا أن ربي أراد بي خيرا لما نبهني على الذكر
واجتماع الفكر لأخاف من عقوبة ربي فأقبل على طاعته واجتناب معصيته وكم من
ذنب أكبر من ذنبي وقد غفره ربي وكم عيب أقبح من عيبي قد ستره ربي
فحينئذ يستمر على الفكر المثمر للخوف الناجع فإن أفرط خوفه كسر سورته
بالرجاء فحينئذ تعرضه النفس والشيطان فيقولان له إنما وصلت إلى هذه
المنزلة بحزمك وعزمك وحسن نظرك لنفسك
فينسى إنعام الله تعالى عليه وإحسانه إليه ويضيف ذلك إلى نفسه الأمارة
بالسوء فحينئذ لا يأمن أن يخذله ربه لحمده من لا يستحق الحمد
وطريقه في ذلك أن يقول لنفسه كيف تدعين أنك وصلت إلى هذا بحزمك وعزمك وأنت
ما دخلت فيه إلا كارهة أبية مع أنك أنت التي أوقعتني في المعاصي
والمخالفات
فإن دفع الله عنه كيدهما في ذلك اعترضا له بالإعجاب بنفسه
وطريقه في دفع الإعجاب أن يذكر نفسه بأن خير أمة أخرجت للناس أعجبتها
كثرتها يوم حنين فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا
مدبرين
وكذلك داود عليه السلام لما أعجبته نفسه فتن بالمرأة على ما
ذكر الله تعالى في كتابه وكذلك موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما ادعى
أنه أعلم أهل الأرض لما سئل فعتب الله سبحانه وتعالى عليه بكون أنه لم يرد
العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم دله على الخضر
فإذا اعترض هذا
التائب حقوق الله تعالى عليه وحقوق عباده لديه فيما مضى من دهره حقا حقا
بعد أن اعترضها من حين بلوغه إلى حين توبته ثم اعترض حقوق الله تعالى في
قلبه ثم خرج من كل حق كان ضيعه في أيام سهوه وبطالته فلا يغفل التيقظ
والتحرز فيما بقي من أيام عمره فإن طبعه الذي دعاه إلى المخالفة والعصيان
قائم والنفس الأمارة بالسوء لم تمت والشيطان الحريص على إضلال الإنسان
وإغوائه متفقد لأحواله مرتقب لغفلاته لعله يعثر على غفلة يرده فيها إلى
أسوء أعماله وأقبح أحواله
ويقع التفقد في المأمورات والمنهيات
فالمأمورات ثلاث
إحداهن حق الله كأن تركه ثم تاب إلى الله تعالى من تركه فتذكره به النفس
والشيطان في أوقات غفلاته ليعود إلى تركه فلا يطعهما ويستمر على فعله حسب
ما أمر به
والثاني حق لله تعالى تركه وهو لا يشعر بوجوبه عليه فعليه
الآن أن يتذكره ويتفقده ليستدرك قضاءه حسب ما أمر به مثل أن تجب الزكاة في
ماله فلم يشعر بها لفرط غفلته في حين غرته وإن كان ذلك مما لا يدرك جدد
التوبة والاستغفار منه
والثالث حق لم يجب عليه فيما مضى وإنما وجب عليه لما تاب ككسب الحلال
لنفقة العيال وإخلاص الأعمال
والمنهيات ثلاث
إحداهن معصية أقلع عنها وتاب إلى الله منها فلا يعد إليها
الثانية معصية لم يعلم في أيام غفلته أنها معصية فيتفقدها الآن ليتحرز
منها
الثالثة معصية لم توجد في أيام غفلته وإنما حدثت بعد توبته وإنابته كترك
التكسب لعيال حدثوا بعد التوبة والإنابة فإذا واظب التائب على التيقظ لما
ذكرناه فقد تحرز بذلك من كيد النفس وإغواء الشيطان فإن
اعترض له ذلك في بعض الأحيان رجع إلى دفعه بما ذكرناه من الأسباب والله الموفق للصواب
فصل في كيفية رعاية حقوق الله عز وجل مضيقها وموسعها ومعينها ومخيرها ومقدمها ومؤخرها وما أوجب الله تعالى على العباد عند الخطرات وكيفية ابتداء الأعمال من ابتدائها إلى انتهائها
اعلم أن القلوب أول محل التكاليف وأن أعمال الأبدان موقوفة على أعمال القلوب وأن الأعمال إنما يقع ابتداؤها من القلوب ثم يظهر على الجوارحفأول ما يخطر للمكلف فعل من أفعال القلوب فلا تكليف بسبب خطوره على القلب فإذا خطر على القلب وعرفت النفس ما فيه من المصالح أو المفاسد فإنها تميل إليه إن وافقها وتنفر منه إن خالفها ولا يتعلق التكليف أيضا بالميل إليه ولا بالنفور عنه فإنهما أمران طبعيان لا انفكاك عنهما ولا انفصال منهما ولن يكلف الله تعالى نفسا في ضرها ونفعها إلا قدر وسعها
فإذا حصل ميل النفس أو نفورها حضر الشيطان فزين لها الإقدام على فعل ما مالت إليه إن كان من العصيان المسخط للديان أو زين لها النفور مما يرضي الرحمن إن كان مما تنفر منه فهذا ابتداء تكليف القلوب
إذ لا يحق على الإنسان أن لا يعزم إلا على ما يرضي الرحمن ويرغم
الشيطان
فالعزم أول ما تكلف به القلوب فإن كان المعزوم عليه خيرا كان العزم مأمورا
به وإن كان المعزوم عليه شرا كان العزم منهيا عنه والعزم أول واجب أو محرم
بعد حسن الاعتقاد وتصحيح الإيمان
والخطرات ثلاث
خطرة من النفس تخطرها لتنال بها هواها وتدرك بها مناها
وخطرة من الشيطان يخطرها ليهلك الإنسان بما يزينه له من الفسوق والعصيان
وخطرة من الرحمن يخطرها رحمة للإنسان لما ينيله من الثواب والرضوان
والسكنى غدا في جوار الديان
فحق على كل إنسان إذا خطرت له خطرة أن لا يوافقها حتى يعرفها ويميزها
تخطرة النفس والشيطان مما يخطره الرحمن
وإنما يقع التمييز بالتثبت وعرض تلك الخطرات على الكتاب والسنة فما وافق
الكتاب والسنة علم أنه من أخطار الرحمن إما بواسطة الملك أو بغير واسطة
وما خالف الكتاب والسنة علم أنه من أخطار النفس أو أخطار الشيطان وتتميز
خطرة النفس عن خطرة الشيطان بأن يمنعها من العزم على
ما خطر لها فإن ألحت في طلبه فهو من أخطارها وإن نكلت عنه فهو
من أخطار الشيطان
فالعقل مع خطرات الرحمن والنفس مع خطرات الشيطان
وإذا ثبت أن العزم ينقسم إلى محلل ومحرم فالتبس أحدهما بالآخر لم يجز
الإقدام على إحداهما إلا بعد النظر والتبيان كما لو اشتبه إناء طاهر بإناء
نجس أو ثوب طاهر بثوب نجس أو درهم حلال بدرهم حرام
وجب التلبث والتثبت إلى أن تتبين الخطرة فإن عرضها على الكتاب والسنة فلم يظهر له شيء لم يجز له الإقدام على الحلال الملتبس بالحرام كما لو اجتهد بين طاهر ونجس فاجتهد فيهما فلم يظهر له شيء فإنه لا يحل له الإقدام على أحدهما
فصل في أمثلة تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر
وفيه أمثلة الأول أن يقدم بر الوالدة على الوالد ثم يقدم الأقارب على الأقرب فالأقرب فإن استووا قدم أشدهم حاجة على أخفهم حاجة
الثاني يقدم النفقات الواجبات على الحج والعمرة لأنهما واجبان على التراخي
الثالث إذا وعد إنسانا على بر أو عمل خير وحضرت صلاة الجمعة أو ضاق وقت
صلاة مكتوبة فإنه يقدم الجمعة والصلاة المكتوبة على تلك المواعدة لأن
إطلاق المواعدة محمول على ما لا يفوت فريضة أوجبها الشرع
الرابع لا يقدم بر الوالدين المندوب على صلاة الجمعة ولا على فريضة ضاق
وقتها
الخامس تقديم الديون الحالة التي يطالب بها أربابها على الحج وإن طولب
بدين قدم نفقة العيال على الدين في يوم الطلب وقضى الباقي في الدين ثم
يتوكل في أمره وأمر عياله على الله تعالى
السادس لو نهاه والداه عن
دين يطالب به أو عن أداء أمانة يطالب بها أو عن رد واجب يطالب به فليؤد
الدين والأمانة والواجب ولا يطعهما إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
السابع لو نذر صوما معلقا بشرط فوجد شرطه في رمضان أو في يوم يحرم فيه
الصوم لم يجز وفاء النذر في ذلك الوقت
الثامن إذا وجبت عليه عبادة موسعة الوقت كالحج والصلاة وأمره والداه بأمر
لا يفوت عليه الصلاة والحج فليبدأ بطاعتهما لإمكان الجمع بين
طاعتهما وبين ما أوجب الله تعالى عليه وكذلك يقدم كل مأمور مضيق على كل مأمور موسع لإمكان جمعهما
فصل في النهي عن التوسل إلى المأمورات بالمحرمات والشبهات
لا يتوسل إلى أداء واجب من الديون والنفقات والزكوات والكفارات وسائر القربات بشيء من المحرمات ولا بشيء من الشبهات ولذلك أمثلةالأول اكتساب الحرام لنفقة العيال
الثاني تقديم إرضاء الزوجات بإغضاب الوالدات
الثالث إرضاء الوالدات بتضييق حقوق الزوجات
الرابع ضرب الأولاد وإهانتهم لأجل الزوجات
الخامس الأمر بالمعروف مع السب والشتم واللعن والضرب
السادس إرضاء الوالدين بقطع الأرحام
السابع ضرب الزوجة والخادم إذا خاف تقصيرهما فيما يعدانه له من ماء الطهارة أو غيره ظنا منه أن ذلك غضب لله ولو غضب على نفسه لعصيانه لكان ذلك أولى به
فصل في الخروج من فرض إلى فرض قبل إتمامه
إذا شرع المكلف في فرض فسنح له فرض آخر فإن كان الثاني أهم في الشرع أبطل الأول وأتى بالثاني وله مثالانأحدهما أن يشرع في صلاة الفريضة فرأى إنسانا يكره امرأة على الزنا أو صبيا على اللواط وهو قادر على الإنقاذ فيلزمه الإنقاذ وقطع الصلاة الثاني أن يرى إنسانا يقتل إنسانا وهو قادر على تخليصه فيلزمه أن يقطع الصلاة ويخلصه
وكذلك قطع اليد والرجل والجارحة فإن اهتمام الشرع بهذه الأشياء أتم من اهتمامه بالصلاة
وإن كان الفرض الذي هو ملابسه أهم من الفرض الذي سنح له لم يجز له إفساد الفرض الذي هو فيه مثل أن يدعوه أبواه وهو في صلاة فرض إلى أمر ليس في رتبة الصلاة فلا يجوز له قطع الصلاة لأجله ولعل جريجا لما دعته أمه وهو في الصلاة كانت صلاته نافلة إن كان شرعه كشرعنا يكون من القسم الأول
فصل في النهي عن التسبب إلى الورع إلى ارتكاب الحرام
وفيه أمثلة الأول أن يترك نفقة العيال والاكتساب لهم خوفا أن يكون ماله أو كسبه حراماالثاني أن يترك الحج تورعا عن أن يكون المال الذي ينفقه فيه حراما
الثالث أن يخرج من البلد خوفا أن لا يقدر فيه على مال حلال فيضيع الوالدين والعيال
فصل في النهي عن تضييع الفرض لإكمال المفرض
وله أمثلة منها أن يتوسوس في الوضوء إما في نية أو في استيعاب الأعضاء بالغسل فيكرر ذلك إلى أن تفوته الصلاةوكذلك التوسوس في غسل الجنابة
ومنها أن يتوسوس في نية الصلاة أو في شيء من أركانها وشرائطها فيكرر النية
أو القراءة أو يقطع الصلاة لشكه في قطع نيتها
ومنها أن يبادر إلي الصلوات في أوائل الأوقات فيبالغ في ذلك حتى يقدمها
على وقتها وهذا أكثر الوقوع في صلاة الصبح
ومن ذلك أن يؤخر الفرض عن وقته لأجل عذر مستمر كسلس البول وذرب البطن أو
لجراحة نضاخة أو يترك الصلاة إذا عجز عن القيام ليصليها بعد الوقت قائما
وكذلك لو تعذر عليه الركوع والسجود فيؤخرها عن وقتها ليصليها بعد الوقت
ساجدا أو راكعا تامة الركوع تامة السجود
ومن الغلط أن يصرف زكاته أو
ما توكل في صرفه أو ما أوصي إليه به إلى من يرجو مكافأته أو يخاف شره أو
كان له عليه حق خدمة لنفسه أو لأهله أو من يتعلق به فيقي ماله بحق الله عز
وجل أو بحق من وكله أو أوصى إليه
ومن الغلط أن يمتنع من كسب الحلال
للإنفاق على المحتاجين وهو قادر عليه مع كونه لا يشغله عما هو أهم منه
تحرزا عن الاشتغال بكسب المال عن
طاعة الرحمن أو يمسك ماله لعياله ولا يجود منه على محتاج ظنا
منه أنه عامل بقوله صلى الله عليه وسلم ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )
وعلى الجملة فمن قدم واجبا على أوجب منه فقد عصى الله تعالى ومن قدم نفلا
على نفل أفضل منه فقد ضيع حظه من ثواب الله تعالى
ومن الغلط إتيان الظلمة من السلاطين والولاة والقضاة توهما منه أن يدفع
مظلمة عن إنسان أو يجلب نفعا إلى مستحق وهو غالط في ذلك فإن من خالط
الظلمة لا يقدر على أن ينكر عليهم فيترك الإنكار لا لسبب شرعي بل حفظا
لقلوبهم ومخافة أن يفوته ما يرجوه منهم ونفسه تسخر به وتوهمه أنه متسبب
إلى نفع عباد الله تعالى والذب عنهم والذي تعرض له أعظم من ثواب ما تسبب
إليه
وكذلك يصانع أهل البدع لأجل جاههم ويصانع فجرة الأغنياء لأجل
ما يتوقعه منهم من إرفاق الفقراء وكذلك موافقة الإخوان الصالحين في بغض من
أبغضوا وحب من أحبوه وعداوة من عادوه وولاية من والوه بغير
سبب شرعي في ذلك يزعم أنه يحفظ قلوبهم بذلك ويستديم به صحبتهم
ومن الغلط أن يلازم الصوم والجوع أو يلازم عبادة تقطعه عما هو أفضل منها
أو يلحقه من فرط الجوع ضجر وضيق فتسوء أخلاقه فيسب من لا يجوز سبه وربما
ضرب من لا يجوز ضربه وقد يتورع من بعض الاكتساب فيضيع ما أوجب الله تعالى
عليه من نفقات العيال
فصل في الغلط في تقديم بعض النوافل على بعض النوافل كالفرائض
وهن أقسامأحدها أن تكون النافلة أفضل من غيرها من النوافل فتقدم عليهن
الثاني أن تكون مفضولة فتؤخر إلى رتبتها التي شرعت فيها
الثالث أن يكونا متساويين والوقت متسع لهما فيتخير في تقديم أيتهما شاء
الرابع أن يتردد بين التساوي والتفاضل فيبحث عن ذلك إن كان أهلا للبحث أو يسأل عنه أهله
ومن قدم مفضولا على فاضل في هذا الباب فلا إثم عليه ولكن يفوته ما بين الرتبتين من الفضل وإنما يفوت ذلك بتسويل النفس وتزيين الشيطان أما الشيطان فيزين له ذلك ما بين النافلتين من الفضل
وأما النفس فتدعوه إلى ذلك ليكون الأفضل أثقل وأشق مثاله تقديم الزيارة
على العيادة وتقديم بر الأخ المكتفي على الأخ المحتاج وتقديم زيارة
المفضول من الإخوان على الفاضل لأن الشيطان يستشعر من الفاضل أنه يأمر
بالمعروف وينهاه عن المنكر والنفس تكره ذلك لعلمها أنه يأمره بفطامها عن
شهواتها
وكتقديم تشييع جنائز الأغنياء على جنائز الفقراء إذا حضروا
في وقت واحد إما ليد كانت للغني عليه أو لمداراة أو خوف مذمة وهذا عند
تساوي الأغنياء والفقراء في الفضل والدين وسائر الأسباب
ومن ذلك أن يؤثر الصلاة في مكان حسن تميل إليه نفسه على مكان يجتمع فيه
همه وإقباله على صلاته لارتياح نفسه إلى المكان المفضول
ومن ذلك أن يترك الصوم الذي اعتاده توهما أن يقطعه عن كثير من الطاعات وهو
غالط في ذلك
ومن ذلك تقديم ما لا يخاف فوته من الطاعات على ما يخاف فوته من الطاعات
ومن ذلك أن يشرع في شيء من العبادات وأنواع القربات بحيث يراه الناس أو في
خفية ثم يراه الناس فيخشى على نفسه من الرياء فيترك ما شرع فيه لله تعالى
لأمر يتوهمه
ومن ذلك أن يلابس شيئا من أنواع الطاعات مخلصا لله عز وجل ثم يخشى أن ينسب
إلى الرياء فيدع ذلك العمل
ومن ذلك أن يترك سماع ما أمر بالاستماع إليه كخطبة الجمعة وقراءة الإمام
في الصلاة ويشتغل عن ذلك بالتفكر في شيء من أمور الآخرة ولا يشعر بأنه
أساء الأدب بترك الإصغاء إلى ما أمر بالإصغاء إليه
وكذلك إذا قرأ القرآن وتفكر في غير معاني القرآن التي هو ملابسها
ومن ذلك أن يعتاد عملا من أعمال البر وهو قوي عليه فتوهمه نفسه أن تقليله
وتنقيصه أولى به مستدلة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ( خير العمل أدومه
وإن قل ) فتوهمه أنه عامل بالسنة ولا غرض لها إلا الركون إلى الراحة
فصل في أشكال الفضائل إذا عرض فرضان أو ندبان فعرضتهما على الكتاب والسنة أو سألت العلماء عن أيهما أفضل فلم يظهر الفاضل من المفضول
فالطريق إلى معرفة ذلك أن ينظر إلى أخفهما على نفسك فأيهما كان أخف فاتركه فهو المفضول لأن الغالب على الأنفس مشقة الفضائل إلا أن تكون من أكابر أولياء الله تعالى فتقدم ما خف على نفسك لأن الغالب من أولياء الله تعالى استخفاف الأفضل فالأفضل لشدة إقبالهم على الله تعالى والاشتغال به فإن استويا في الثقل والخفة فاعرض نفسك على أيهما تؤثر الموت عليه حالة التلبس به فافعله فإن النفس المؤمنة وإن كانت مقصرة لا تؤثر الموت إلا على أفضل الأعمال وأحسن الأحوال فإن استويا في إيثار الموت عليهما فأنت مخير في البداءة بأيهما شئتفصل في بيان المنازل في رعاية التقوى
والتقوى تتعلق بالقلوب والجوارح فنبدأ بما يتعلق بالقلب إذا خطرت خطرة يكرهها الله تعالى من أعمال القلوب كالكبر والرياء والحسد والعجب فأول المنازل في رعاية التقوى أن يقطع استمرار خطورها عن القلب على الفور
الثانية أن يدعها حتى تتمكن من قلبه وتغلب على لبه وتميل إليها نفسه ويحثه
عليها شيطانه ولا يعزم عليها حتى يحضره خوف من الله تعالى أو حياء أو
إجلال فيقطعها ولا يحقق العزم عليها
الثالثة أن يعزم عليها ثم يقطع العزم عليها قبل ملابستها
الرابعة أن يستمر عزمه عليها فيلابسها فيشرع فيها ثم يوفق للتوبة عنها
فيقطعها خوفا أو حياء أو إجلالا
وأما أعمال البدن فأقسام أيضا
أحدها أن يقطع الخطرة على الفور من خطورها
الثاني أن يدعها حتى تستمكن من قلبه وتستحكم في لبه ويميل طبعه إليها
فتحثه النفس والشيطان عليها ثم يقطعها
الثالث أن يقصدها ويعزم عليها ثم يقطع العزم عليها
الرابع أن يستمر العزم عليها إلى أن يشرع فيها فيقطع الشروع فيها
الخامس أن يرجع عنها قبل إكمالها وإتمامها أو بعد الشروع فيها كمن نظر إلى
محرم أو استمع إلى محرم أو تكلم بمحرم أو أصغى إلى محرم أو بطش بمحرم أو
سعى إلى محرم ثم حضره خوف أو حياء أو إجلال فترك إتمام ما شرع فيه قبل
بلوغ مقصده منه
السادس أن يكمل
الفعل المحرم الذي عزم عليه ثم أدركه الندم على فعله ومخالفة أمر ربه فتاب
وعقد عزمه أن لا يعود إليه وقد يبلغ به بحيث يتوب من جميع الذنوب لفرط
خوفه أو حيائه أو إجلاله
السابع أن يتوب من البعض دون البعض إما
لفرط شهوته له أو لشدة مشقة تركه أو لأنه يعتقد أنه من الصغائر وخير من
هؤلاء كلهم من طهر الله تعالى قلبه من هذه الخطرات إلا في أنذر الأوقات
والمذنبون أقسام
أحدهم من يسعى في التخويف الحامل على التوبة مع شدة مشقة التخويف عليه وهو
مستشعر الأسى والبكاء والحزن على ما فات فهو يخوف نفسه في كثير من الأوقات
بحيث لا ينتهي إلى الخوف الناجع المفيد
الثاني من يكره ذنوبه ويحزنه تقصيره ولا يسعى في التخويف الحامل للتوبة
ولكنه يسوف به من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان
الثالث المصر على الذنوب غير مكترث بها ولا عازم على الإقلاع عنها ولا على
التخويف لها لأنه يحتقرها ولا يراها عظيمة عند الله { وتحسبونه هينا وهو
عند الله عظيم } النور أو لاعتقاده أن توبة مثله لا تقبل أو لاعتقاده أن
التخويف لا ينجع في مثله
وطريق القسمين الأولين أن يذكرا شيئين
أحدهما مباغتة الموت ومعالجته قبل التوبة فيلقيا ربهما وهو عليهما ساخط
غضبان
والثاني التخويف من أن يؤديهما الإصرار على الذنوب إلى الرين والطبع على
القلوب فيقال للذي يسوف بالتوبة ويؤخرها أنت لا تخلو من ثلاثة أحوال
إما أن تموت قبل التوبة فتتعرض لسخط الله تعالى
أو أن يران على قلبك فلا يؤمن عليك سوء الخاتمة
أو أن توفق للتوبة بعد التسويف فيطول وقوفك في موقف الحساب مع مذلة
التوبيخ والتعنيف ولو أنك عجلت التوبة لأمنت من ذلك
فانظر لنفسك قبل أن تروم التوبة فلا تقدر عليها وتسأل الرجعة إلى الدنيا
فلا تجاب إليها
والاستعداد للقاء الله تعالى ضربان
أحدهما واجب وهو التوبة كما ذكرناه
الثاني التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات المندوبات
ويحمله على ذلك قصر الأمل ويحمله على قصر الأمل علمه بأن أجل الموت مطوي
عنه وأنه ما يدري متى يأتيه الطلب ولا متى يكون المنقلب وإنما ينجع ذلك
بإدمان الفكر فيه والإكباب عليه
فصل فيما يجب على العبد إذا وقف على أفضل الأعمال وأولاها
إذا وقف على أفضل الأعمال وتحقق فحق عليه أن لا يقدم عليه حتى يخلصه لرب الأرباب فلا يقصد به سواهوالتائب من الزلات تنقسم أعماله إلى ظاهر وباطن
فأما الباطن الذي في قلبه فلا يمكنه الرياء به فإن الناس لا
ينظرون إليه
ولا يقفون عليه إلا أن يسمعهم بذلك ليعظموه ويفخموه ويوقروه ويشكروه
ويجلبون إليه ما يقدرون عليه من نفع ويدفعون عنه ما يقدرون على دفعه من ضر
فأما عمل الجوارح والأعضاء فمنه ما يمكن إخفاؤه ومنه ما لا يمكن
إخفاءه ولا يتأتى فيه الرياء فيصونه عن الرياء كحزنه بعد سروره وإمساكه عن
الكلام الذي لا يحل بعد خوضه فيه والانقطاع من أهل الفسوق والعصيان إلى
أهل الطاعة والإيمان وكذلك كل عبادة فضلها في إظهارها فإذا عزم عليها
اعترضه النفس والشيطان ليحملاه على الرياء والتصنع بها أما الشيطان فيحمله
على ذاك ليفسد عليه عمله
وأما النفس فتنال غرضها من التعظيم
والتوقير ومن دفع الضرر عنها ومن جلب النفع إليها وكذلك ما يظهر عليه من
زي الصالحين في المآكل والمشارب والملابس والمناكح فيقصد الرياء وقد أعمت
شهوته بصيرته عن إدراك الرياء وما أخفى الرياء عن معظم الناس لأنه قصد خفي
غمرته شهوة عظيمة فأعمت البصيرة وأفسدت السريرة بخلاف معاصي الأعضاء فإنها
ظاهرة محسوسة لا تخفى على أحد
واعلم أن النفس والشيطان يدعوان الإنسان إلى ترك الورع فإن أطاعهما فاتته
منازل أهل الورع وإن عصاهما دعواه إلى ترك الرياء بالورع وإن أطاعهما هلك
وفسد ورعه وإن عصاهما دعواه إلى ترك النوافل وقالا تكفيك الفرائض والورع
فإن أطاعهما فاتته فضيلة النوافل وقد قال الله سبحانه وتعالى ( لا يزال
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) وإن عصاهما حملاه على الرياء بالنوافل
فإن أطاعهما فسدت نوافله وحبط أجره وصار مقتا عند الله تعالى وإن عصاهما
وأخلص أوهماه أنه مراء وقالا له لا خلاص لك من الرياء إلا بترك العمل فإن
أطاعهما وترك النوافل فاته ما يترتب عليها من ثواب الله تعالى ومحبته وإن
عصاهما أخذا في مجادلته ومخاصمته في كونه مرائيا متصنعا ليشوشا عليه قلبه
ويمنعاه من إحضار قلبه في طاعة ربه
أما الشيطان فلأنه عدو للإنسان حاسد له على طاعة الرحمن
وأما النفس فتنال هواها وتدرك مناها بفكرها في لذات دنياها فإنها مجبولة
على حب العاجل والإعراض عن الآجل
وقد حذرنا الرحمن من الشيطان فقال { إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا } أي
لا تلتفتوا عليه ولا تصغوا إليه
وحذرنا من النفس بقوله تعالى { إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي }
يوسف وقليل ما هم
فصل في بيان الإخلاص والرياء
الإخلاص أن يريد الله بطاعته ولا يريد به سواه وهو أقسامأحدها أن يريد الخلاص من العقاب
الثاني أن يريد الفوز بالثواب
الثالث أن يريدهما جميعا
الرابع أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى من غير خطور ثواب أو عقاب
الخامس أن يفعل ذلك حبا لله تعالى من غير ملاحظة ثواب أو عقاب
السادس أن يفعل ذلك إجلالا وتعظيما
وأما الرياء فهو أن يريد الناس بطاعة الله تعالى وعبادته وهما ضربان
أحدهما أن لا يريد بتلك الطاعة إلا الناس
والثاني أن يريد بطاعته الناس ورب الناس وهذا أخف الريائين لأنه أقبل على
الله من وجه وعلى الناس من وجه
وأما الأول فإنه إعراض عن الله بالكلية وإقبال على الناس وكلاهما محبط
للعمل لقول الله عز وجل ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك
فيه معي غيري تركته لشريكه ) وفي رواية ( تركته لشريكي
ولا يتصور شرك الرياء لمن عبد الله تعالى تعظيما وإجلالا لأن تعظيمه يمنعه
من أن يعصيه بشرك الرياء
وكذلك الحياء أيضا يزعه عن ذلك
وكذلك الحب مانع من عصيان المحبوب فيما يتقرب به إليه
فصل في الأسباب الحاملة على الرياء
النفوس مجبولة على طلب ما يلائمها من شهواتها ولذاتها ومن أعظم شهواتها التعزير والتوقير ودفع ما يؤلمها وجلب ما يلذ لهاوالنفوس مستشعرة بأن الناس برهم وفاجرهم يعظمون أهل الدين ويثنون عليهم ويتقربون إليهم ببذل أموالهم وأنفسهم في مباشرة خدمتهم واحترامهم حتى الملوك الذين هم أعظم الناس عند الناس فإذا علمت النفوس ذلك مالت إلى أن تتصنع لهم بطاعة الله تعالى ليوقروها ويعظموها ويثنوا عليها ويتقربوا إلى الله عز وجل بخدمتها بالأنفس والأموال والأولاد ويصغوا إليهم إذا قالوا ويطيعوهم إذا أمروا ويعتذروا عنهم إذا أخطؤوا ويكفوا عنهم أذية من آذاهم وعداوة من عاداهم
فإذن للرياء ثلاثة أسباب
أحدهما التعظيم والإجلال وهو أعظمها وعنه ينشأ السببان الآخران
أحدهما الطمع فيما في أيدي الناس من المنافع والأموال
والثاني دفع الضرر وذلك على قدر همم الناس فيما يلتمسون
فمنهم من لا يؤثر إلا التعظيم والإجلال وإن بذلت له الأموال لم يقبل عليها
ولم يلتفت إليها لعلمه بأنه يعظم بتركها ويؤثر الإعراض عنها وكذلك لا
يستعين بأحد يدفع الضر تصنعا بأنه مستغن عن الناس إما بقوته على دفعه وإما
بتوكله على ربه
ومنهم من يؤثر بريائه جلب النفع وإن قل
ومنهم
من يؤثر بريائه دفع الضرر ولا يخلو هذا من قصد التعظيم والتوقير فما من
رياء إلا فيه طلب تعظيم وتوقير وقد يكون الرياء ناشئا عن هذه الأسباب
الثلاثة
فصل في أمثلة الرياء لدفع الضرر والذم
وله أمثلة أحدها أن يتقدم مع المجاهدين إلى الصف الأول وهو لا يؤثر التقدم معهم لجبنه ولكنه يتقدم خوفا أن يذم بالجبن وقلة الشجاعة فيتقدم معهم دفعا للمذمةالثاني أن يكون قائما في الصف فتجبن نفسه عن الثبوت فيخاف على نفسه فيثبت لئلا ينسب إلى الجبن والفشل والتعرض لسخط الله تعالى
ولو غفل عنه أصحابه أو كان بين قوم لا يعرفونه لانهزم فهذا قد تعرض لسخط الله تعالى وإن كان ظاهر فعله أنه مجاهد في سبيل الله
الثالث أن يكون بين قوم يتصدقون بالقدر الكثير من المال ومن عادته أن لا يتصدق وإن تصدق تصدق بالقليل فيخشى أن يبخل وينسب إلى قلة الرحمة فيوافقهم على التصدق بالكثير دفعا لريبة البخل وقلة الرحمة
وكذلك لو كان من عادته أن لا يتصدق بقليل ولا بكثير فيتصدق من أجلهم بالقليل ليدفع بذلك بعض التبخيل
الرابع أن يحاضر قوما يصلون في الليل أو النهار صلاة لم يعتدها فيخاف أن ينسبوه إلى قلة الرغبة في الخير أو يحضر مع قوم يطيلون الصلاة ويحسنونها فيصنع مثل صنعهم أو دون ذلك على خلاف عاداته دفعا للذم
أو بعضه ومما يشبه الرياء لمشاركته إياه في العلة وليس برياء أن
ينزل به
نازلة يجهل حكم الله فيها فيخشى أن ينسب إلى الجهل بذلك الحكم فيترك
السؤال عنه خوفا من النسبة إلى الجهل بمثله
وكذلك أن يسأل الفقيه أو الشيخ من المشايخ عن حكم من أحكام الله فيجيبنا
عن ذلك بما لا يعلمانه خوفا أن ينسبا إلى الجهل بمثل ذلك
وكذلك يخشى أن ينسب إلى قلة المعرفة فيدعي أنه كتب من الأحاديث ما لم
يكتبه وسمع منها ما لم يسمعه دفعا للذم
فصل في الرياء لجلب النفع والطمع فيما في أيدي الناس
وله أمثلةالأول أن يحاضر من يرجو بره وصلته وإحسانه فيرائيه بطاعة الله تعالى لينيله مارجا منه من البر الصلة
ولو اطلع منه هذا المرجو على زلته لاغتم لاطلاعه عليها ما لا يغتم لاطلاع غيره خوفا من انقطاع بره وصلته ولو اطلع على عبادته وطاعته لارتاح بذلك وفرح به ما لم يرتح إلى إطلاع غيره ممن لا يرجوه
الثاني أن يكون له من يعامله بالنسيئة والمسامحة والصبر بالثمن الحال فيتصنع له بعبادة الله تعالى وطاعته رغبة في الاستمرار على معاملته ومسامحته وصبره
الثالث الأجير والوكيل يبالغان في النصح وأداء الأمانة طمعا في استمرار
التوكيل والإجارة
فصل فيما يهيج أسباب الرياء خوف الذم من حب الحمد وحب الطمع فيما أيدي الناس
الذي يهيج الرياء ويحث عليه معرفة العبد بأن الناس يعظمون من ظهر صلاحه وديانته ويوقرونه ويؤثرونه ويصدرونه في المجالس ويبدؤونه بالسلام ويقبلون عليه ويصغون إليه ويحسنون الجلوس بين يديه ويستشيرونه في المهام وإن أذنب تأولوا ذنبه وإن كذب تأولوا كذبه ويبذلون له أموالهم وينكحونه بناتهم ويتقربون إلى الله عز وجل بولايته ويتبركون بدعائه ويبذلون له الندى ويكفون عنه الأذى فإذا شعرت النفس بمثل هذه المنزلة التي لا ينال مثلها إلا بالطاعة تصنعت عندهم بطاعة الله تعالى وعبادته لتنال هذه المنازل أو بعضها ويدفع الناس عنها ما تكره خوفا من الله أن يؤذوا وليا من أوليائه فإن من آذى لله وليا فقد بارز بالمحاربةفصل فيما يضعف دواعي الرياء ويكسر أسبابه
تضعف دواعي الرياء بأسباب منهاتذكير النفس بما يحرمه الله عز وجل من توفيقه أو صلاح قلبه بسبب الرياء
ومنها خوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو معتقد الرياء
ومنها ما يفوته أو ينقص له من ثوابه على الإخلاص
ومنها ما ينقص من ثوابه في الآخرة
ومنها ما يتعرض له من عقاب الله تعالى وسخطه وعذابه الأليم في الآخرة
ومنها أنه لا يأمن أن يعجل الله تعالى بعض العقوبات ولا يمهله فيفضحه ويمقته لمن كان يتحبب إليه بريائه
ومنها تقبيح ما يحببه إلى العباد بما يبغضه إلى رب العباد
ومنها تزيينه لهم بما يشينه عند الله تعالى
ومنها التقرب إليهم بما يبعده عن رحمة الله تعالى ومن بعد عن الله فقد هوى به ريح شؤم المعصية في مكان سحيق وضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا
ومنها التحمد إليهم بما يوجب ذمة عند الله تعالى
ومنها إرضاؤهم بالتعرض لسخط الله تعالى مع حبوط عمله يوم فقره وفاقته
والله لو لم يكن إلا خجلته بين يدي رب العالمين إذا عرض عليه إقباله على
الناس وإعراضه عن الله تعالى لكان ذلك من أعظم العقوبات وأوضعها
ومنها أن رضا الناس عنه غاية لا تدرك ومطلوب لا يملك فقد يرضي بعضهم ما
يسخط الآخرين
ومنها أن ما ينال منهم لو حصل له مع تعرضه لها بالآفات لكان من أخسر
الخاسرين مع أنه يجهل ما يحصل له من المنزلة في قلوب الناس مما يظهره من
أعماله وريائه ولا يأمن أن يطلعهم الله تعالى على ريائه فيمقتوه ويحرموه
ويضروه ولا ينفعوه فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
ولأنه إن راآى لدفع الضرر كان ما يناله من ضرر الآخرة أعظم من الضرر الذي
راآهم به دفعا له وإن راآهم لجلب نفع كان الذي يفوته من نفع الآخرة أعظم
من ذلك النفع وقد يطلعون على ريائه فيفوته النفعان
وإن راآهم
ليمدحوه أو ليعظموه وليوقروه كان ما فاته من مدح الله تعالى في ذلك كله
على ريائه فيفوته ذلك كله مع عظيم ما تعرض له من غضب الله تعالى
ومقته وعذابه وعقابه الذي لا يدفع ولا يطاق ونعوذ بالله من سخطه
وغضبه وعقابه
فإذا واظب من رغب في الإخلاص لله تعالى على ما ذكرناه بإحضاره وإدمانه
الفكر فيه وتضرع إلى الله تعالى في أن يعينه ويثبته على الإخلاص ويوفقه
إليه اضمحل رياؤه وتلاشى شيئا فشيئا فمجته نفسه بما فيه من عظم الضرر
وفوات عظيم النفع ولا يزال يتدرج في الإخلاص إلى أن يصير من المخلصين
برحمة رب العالمين
فصل في بيان ما يرائى به من الطاعات وغيرها
يراءي الناس في دينهم ودنياهم بخمسة أشياء والرياء بالدنيا أخف من الرياء بالأديان فيرائي أهل الدين والدنيا بأبدانهم وأقوالهم
وأعمالهم وبزيهم في أبدانهم ولباسهم
فأما رياء أهل الدين بأبدانهم فيرائي العبد بالنحول واصفرار اللون ليوهم
الناس أنه شديد الاجتهاد والخوف والحزن وبضعف صوته وغور عينيه وذبول شفتيه
إعلاما للناس بذلك أنه صائم
فالنحول دليل على قلة الغذاء وكثرة
الهموم والأحزان والاصفرار دليل على قيام الليل وغلبة الهموم والأحزان
وليس هذا رياء على الحقيقة وإنما هو تسميع بلسان الحال لا بلسان المقال
وأما رياء أهل الدنيا بالأبدان فبسمتها وحسنها وصفاء ألوانها
وأما رياء أهل الدين بالزي واللباس فبشعث الرؤوس وحلق الشوارب واستئصال
الشعر أو فرقه نهارا لكونه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في زيه وكذلك
غلظ الثياب وآثار السجود وتشمير القمص وقصر الأكمام وخصف النعال وحذوها
على زي أهل الدين
ومن هؤلاء من
يؤثر مدح أهل الدنيا والدين فيطلب بريائه ليمدحه الفريقان وينفق عليهم
ليصل إلى أغراضه منهم فيلبس الثياب الخشان لينفق عند أهل الدنيا ويقصر
أكمامها ويشمر ذيولها لينفق على أهل الدين وكذلك يلبس النعال الخصاف محذوة
على نعال أهل الدين
ومنه من يبالغ في جودة الثياب وغيرها من اللباس
ويجعل هيأتها على هيئة لباس أهل الدين ليحمده الفريقان وينفق عندهما
ويتقرب من السلاطين زعما منه أنه إنما يتقرب إليهما لقضاء حوائج المسلمين
ومنهم من يتصنع بالطاعة لينفق على أهل السنة وأهل البدعة
ومن هؤلاء من لو أعطي ما أعطي من الأموال الخطيرة لما خرج عن زيه الذي عرف
به لئلا يقال خرج عن اقتدائه بنبيه عليه الصلاة والسلام وفتر عما كان عليه
من تقشفه وخوفا من الكساد عند من تحبب إليهم ونفق عندهم
ويرائي أهل
الدنيا بالثياب النفيسة والطيالسة الرفيعة والجباب المصبغة وغير ذلك من
زيهم المعروف عندهم فيخرجون عن زي أهل الدين في ذلك كله
وأما الرياء
بالأقوال فيرائي أهل الدين بالنطق بالحكم وإقامة الحجج عند إقامة المناظرة
وبالحفظ للحديث وأقوال المختلفين وذكر الله تعالى بالألسن والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وتضعيف الصوت عند
الجواب وبتحسين الصوت ورفعه عند القراءة أو تحزينه والتأوه عند
القراءة ليدل بذلك على المخافة
وأما رياء أهل الدنيا بالأقوال فيراؤون بالنطق بالطاعة وغير الطاعة
وبالفصاحة وبحسن البيان في المحاورة وحسن الصوت وإنشاد الشعر ومعرفة
الغناء والنحو والعربية واللغة
وكان السلف إذا اجتمعوا يكرهون أن يذكر الرجل أفضل ما عنده
وأما الرياء بالأعمال فيرائي أهل الدين من أعمالهم بطول الصلاة وتحسين
ركوعها وسجوداتها وبالصوم والغزو والحج وطول الصمت وبذل الأموال وإطعام
الطعام والإخبات بالمشي إذا لقوا الناس بإرخاء الجفون وتنكس الرؤوس
والتثبت عند السؤال
ومنهم من يمشي سريعا فإذا اطلع عليه أهل الدين مشى مشية أهل الدين فإذا
جاوزه عاد إلى ما كان عليه
ويرائي أهل الدنيا بصحبة أهل الدين من العلماء والعباد ليقال فلان يمشي
إلى فلان العالم أو العابد ويصحبه ويتردد إليه
إما لينفق عند الملوك أو ليتولى القضاء أو ليستشهد أو يستودع أو يوصى إليه
فيخون الأمانة
فصل في مراتب نفي الرياء للشيطان
في الرياء ثلاثة أحوال إحداهم أن يخطر الرياء بقلب العبدالثانية أن يزينه ويحببه إلى العبد
الثالثة أن يدعوه إليه ويحثه عليه بعد أن حببه إليه
فأسعد الناس من يدفع الخطرة ويصرفها عن قلبه ويليه الذي يدفعه بعد تحسينه وتزيينه ويليه الذي لا يتعاطاه بعد حث الشيطان عليه ودعائه إليه وهذا جار في جميع المعاصي ويندفع دعاء الشيطان إلى الرياء وإلى جميع أنواع العصيان بشيئين
أحدهما كراهية المعصية والرياء
والثاني الامتناع مما كرهه
وإنما تحصل الكراهة بتذكر ما في تلك المعصية أو الرياء من سخط الله تعالى وغضبه وعقابه وبما اشتملت عليه مما ذكرناه من مضار الدارين
فإن الله تعالى جبل الإنسان على محبة ما ينفعه وكراهة ما يضره وخلق النفس ميالة إلى ما ينفعها نافرة عما يضرها
والشيطان عون لها على ذلك
وخلق
العقل ليدفع أعظم الضررين بأدناهما ويقدم أعلى النفعين على
أدناهما والشرع هو المعرف للنفع والضر
والعقل كالبصر لا يرى النفع والضر إلا في نور الشرع كما أن البصر لا يرى
الحسن والقبيح إلا في نور العقل
وإذا زين الشيطان المعصية وحببها إلى النفس امتلأ القلب بحبها فنسي العبد
ما كان عزم عليه من الطاعة والإخلاص فيغفل عما في الفعل من مضرته في دينه
ودنياه وإنما يقطع ذلك باستجلاب التذكر لما في الذنب من المفاسد التي تربى
على ما في الشهوة من المصالح
فإذا علم ما في طاعة الشهوة من الضرر العظيم كرهتها النفس حينئذ لأنها
مجبولة على دفع أعظم الضررين بالتزام أخفهما
ولا شك أن ضرر الذنوب في الدنيا والآخرة أعظم من ضرر فوات شهوة فانية فإذا
اطلعت النفس على ذلك صارت مع العقل فيغلب جند الرحمن جند الشيطان إذ لا
يتصور في العادة أن يتذكر العبد ما في الطاعة والإخلاص من مصالح الدنيا
والآخرة ويستحضره وما في الرياء والمعصية من مفاسد الدنيا والآخرة ثم يقدم
على الرياء والعصيان مع العلم بما فيهما من فوات الصالح وحصول
المفاسد
فائدة في أحوال العبد إذا حضره الرياء في شيء من الطاعات
إذا حضر الشيطان الرياء في شيء من الطاعات كالصلاة مثلا فللعبد أربعة أحوال إحداهن أن لا يلتفت عليه ولا يصغي إليهالثانية أن ينتهره ويسبه فتنقض صلاته لأنه اشتغل بسب الشيطان عن مناجاة الرحمن
الثالثة أن يجادله ويناظره ويبين له أن يخدعه فهذا أيضا قد اشتغل بمخاصمة
الشيطان عن الإقبال على الملك الديان
الرابعة أن لا يلتفت إليه ولكن يزيد في تحسين صلاته بخضوعها وخشوعها
وإتمام سجودها وركوعها إرغاما للشيطان وهذا هو الأفضل لأنه إذا أدمن على
ذلك هرب منه الشيطان لأن غرضه بالوسواس وإحضار الرياء أن يفسد عبادة
الإنسان فإذا صار إحضاره ووسواسه سببا للتكثير من الطاعة هرب ممن يفعل ذلك
لأن سعيه في ذلك سبب لإرغامه بتحسين الطاعة وتكميل العبادة وذلك مرض
للرحمن مرغم للشيطان
فصل في حكم التحرز من الشيطان والحذر منه
اختلف الناس في ذلكفقالت طائفة ينبغي أن يشتغل العبد بالعبادات والطاعات ولا يلتفت إلى الشيطان ولا يشتغل بالتحذر منه بل يجعل بدل التحذر منه طاعة الله عز وجل
وقالت طائفة التحذر من الشيطان وأخذ الحذر منه مناف للتوكل على الله تعالى والاعتماد عليه إذ لا قدرة للشيطان على إضلال ولا إغواء إلا بمشيئة الرحمن وإرادة الديان
وهاتان الفرقتان غالطتان مخالفتان لنصوص القرآن واتفاق أهل الإسلام على وجوب التحرز من الكفار وإعداد ما استطعنا لهم من قوة وكراع وسلاح وقد قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم } وكيف يكون امتثال أمر الله سبحانه شغلا عن الله متوكلا على غيره وقد دخل سيد المتوكلين مكة وعلى رأسه المغفر وظاهر يوم أحد بين درعين
وإذا أمرنا بأخذ الحذر من عدو نراه كما يرانا فما بال الظن بعدو يرانا ولا
نراه ويجري منا مجرى الدم وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه
وسلم بالاستعاذة من الشيطان الرجيم بل أمره بالاستعاذة من جميع الشياطين
بقوله تعالى { وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون }
أي في شيء من أحوالي كلها
والتحرز من الشياطين أولى من التحرز من
الكافرين لأن الشيطان إذا نكبك بشيء من مكره كنت من العاصين الخاسرين
والكفار إذا نكبوك بشيء من مكرهم كان ذلك مكفرا لسيئاتك رافعا لدرجاتك
فالصواب أخذ الحذر منه والتحرز منه كما أمر رب العالمين
واختلف
القائلون بذلك في كيفية التحرز منه وأخذ الحذر فقالت طائفة ينبغي أن يؤخذ
الحذر منه في أغلب الأحوال ترقبا لخطره يخطرها فيدفع تلك الخطرة بما غلب
على القلب من ذكره والتحرز منه
وقالت طائفة يؤخذ الحذر منه عند كل طاعة تعرض مخافة أن يدخل فيها ما
يفسدها
وأخطأت الطائفة الأولى بجعلها ذكر الشيطان أغلب من ذكر الرحمن
وأخطأت الطائفة الثانية بتسويتها بين ذكر الشيطان وذكر الرحمن
والصواب أن يتحرز منه تحرزا يتنبه بمثله عند خطرته على معصيته ومخالفته
ورد خطرته وأن يكثر الاشتغال بالطاعات والقربات والأذكار وتلاوة القرآن
ولا تضره الغفلة عنه في أكثر الأوقات
ألا ترى أن من اهتم بشيء ثم
رقد فإن اهتمامه يوجب انتباهه لأجله مرات فإذا كان الاهتمام موجبا لتنبيه
النائم فإيجابه لتذكير الغافل أولى
فصل في ترك العمل مخافة الرياء
الشيطان يدعو إلى ترك الطاعات فإن غلبه العبد وقصد الطاعة التي هي أولى من غيرها أخطر له الرياء ليفسدها عليه فإن لم يطعه أوهمه أنه مراء وأن ترك الطاعة بالرياء أولى من فعلها مع الرياء فيدع العمل خيفة من الرياء لأن الشيطان أوهمه أن ترك العمل خيفة الرياء إخلاص والشيطان كاذب في إيهامه إذ ليس ترك العمل خوف الرياء إخلاص وإنما الإخلاص إيقاع الطاعة خالصة لله تعالى دون الناس وقد تترك العمل مخافة الرياء فيوهمك الشيطان أنك مراء بترك العمل لينغص عليك العيش فيما تعمله وفيما تتركهمثال ذلك أن يكون في قراءة أو تعليم أو ذكر أو أمر
بمعروف أو نهي عن منكر فيوهمك أنك مراء بذلك فتتركه فيوهمك أنك
مراء
بالصمت وأن يقال إنما صمت خيفة من الرياء فتغيب عن الناس خوفا من الرياء
فيوهمك أنك مراء بالهروب منهم والاعتزال عنهم وأنهم يقولون إنما فر بدينه
خوفا من الرياء فتستحلي النفس أن تقول الناس إنما فر بدينه خوف الرياء ولا
خلاص لك من مثل ذلك إلا بالكراهة والإباء
فإن أشكل عليك أمرك فإن
وجدت نفسك مائلة إليه من غير كراهة ولا إباء فقد صدقك الشيطان فيما أخبرك
به من أنك مراء فإن لم تنفك عن خطرة الرياء ولم يجد من نفسك الكراهة
والإباء فإن كان ذلك العمل نفلا فدعه وإن كان فرضا لزمك أن تجاهد نفسك على
حسب إمكانك في استحضار نفسك الكراهة والإباء
وإن دخلت في الفرض على
الإخلاص فأوهمك أنك مراء فلا تصغ إليه ولا تلتفت عليه لأنك تحققت الإخلاص
وشككت في الرياء واليقين لا يزال بالشك
فصل في بيان أوقات الخطرات بالرياء والتسميع
لا يكون التسميع إلا بعد انقضاء العمل على الإخلاص فيسمع العبدالناس بما فعله لأجل الله تعالى ليحصل على الأغراض التي ذكرناها
في الرياء
من التوقير والتعظيم والإكرام والاحترام والتصدر في المجالس والبداءة
بالسلام وفي الحديث الصحيح ( من سمع سمع الله به )
ولخطرات الرياء ثلاثة أحوال
إحداهن قبل الشروع في العمل
والثانية عند الشروع فيه
والثالثة بعد الشروع في العمل الخالص
فأما ما يقترن بأول العمل فقد ذكرناه
وأما ما يقع قبل العمل فللخطرة فيه أحوال
إحداهن أن يخطر له عمل لا يقدر عليه ويتمنى أن لو قدر عليه ليرائى به
ويحصل على أغراض الرياء فهذا متمن غير أنه لا يريد معصية الله تعالى
الثانية أن يخطر له الرياء إرادة بحمد المخلوقين ولا يريد عند ذلك رياء
ولا إخلاصا
والثالثة أن تخطر له خطرة الرياء لحمد المخلوقين لا غير مع ذكر الإخلاص
والرياء فيتغافل عن الإخلاص ولا يفزع من الرياء
والرابعة أن تخطر الخطرة فيكرهها ويحب العصمة منها ولا يدعها لفرط شهوته
في الرياء كما يتفق مثل ذلك في سائر الذنوب وهذا أقرب من غيره لأجل توجعه
وكراهته
الخامسة أن يخطر له إرادة الله تعالى وإرادة الخلق
والسادسة أن يخطر له الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء ثم يدخل في العمل بنية
الرياء
وأما الخطرة بعد الدخول في العمل فلها حالان
أحدهما أن يخطر له الرياء المحض وله حالتان
أحدهما أن يستمر على عمله مرائيا به من غير زيادة فيه
الثانية أن يزيد في تحسين العمل وتكميل نوافله لأجل الرياء
الثاني من الحالتين الأولين أن تخطر له رياء الشرك فيزيد في العمل رياء أو
يستمر عليه فهذه خطرات المرائي
وأما المسمع فله أحوال
إحداهن أن يحدث به صريحا ليكون على ثقة من حصول أغراض الرياء
الثانية أن يعرض به تعريضا مخافة أن يفطنوا بتسميعه فلا يحصل غرضه ورجاء
أن يفهم بعضهم ذلك فيحصل على غرضه وقد يخطر له ذلك فيحبه ويؤثره ولا يعرض
به ولا يصرح اكتفاء بما ظهر عليه من الدلالات كاصفرار لونه ونحول جسمه
وغور عينيه وذبول شفتيه
فصل في دركات الرياء والتسميع
شر دركات الرياء الرياء بالإسلام والإيمان وذلك رياء المنافقينويليه الرياء بالفرائض كالصلاة والزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما فرضه الله عز وجل على عباده فيأتي به العبد لأجل الرياء تصنعا للناس وكراهة للذم وحبا للحمد
ولو تمكن من ذلك جميعه لما فعل شيئا وقد يسمع بعبادة لم يفعلها وطاعة لم
يأتها فيكون جامعا بين ذنبين أحدهما التسميع
والثاني الكذب
ويليه الرياء بما تأكد في الشرع كصلاة جماعة وقرى الضيف وعيادة المرضى
وتشييع الجنائز يأتي ذلك لأجل الناس كي لا يذم بترك ما سنه الله تعالى
وأكده وإرادة حمدهم ولو أمكنه أن يترك ذلك كله لتركه
وقد يرائي
أحدهم بالورع وإظهار النسك فيطيل الصمت ويترك الاغتياب وينهى عنه ويؤدي
الأمانة ويجتنب الخيانة وإذا ظهرت منه زلة أظهر التوجع والتندم والحزن
والكآبة ويستحل ممن ظلمه والله تعالى يعلم أنه لو تمكن من ترك ذلك كله أو
من ترك بعضه لتركه غير مبال بتركه
ويليه الذي يكمل الفرائض بسننها
كإطالة الركوع والسجود والاعتدال والقعود يفعله إذا رآه الناس ويتركه إذا
لم يروه وكذلك يؤدي الزكاة من أجود أمواله ولولا الناس لاقتصر على القدر
المجزئ
وكذلك يصمت في الصوم عن الغيبة والكذب ويمسك عن النظر إلى ما لا يحل ولولا
الرياء لما فعل شيئا من ذلك
ويليه المبادرة إلى التكبيرة الأولى ورفع اليدين وأخذ شماله بيمينه وتسكين
أعضائه لا يفعل ذلك إلا رياء ولو خلا بصلاته لم يفعل شيئا من ذلك
ويليه المبادرة إلى الصف الأول عن يمين الإمام وإكرام الضيف فوق ما يستحق
ويليه من يرائي بالتطوع والتورع وغير ذلك من طلب العلم والتخشع ومجالسة
الصالحين وإتيان مجالس المذكرين والواعظين ليصل بذلك إلى معصية من معاصي
الله تعالى كإتيان الغلمان والنسوان وأن يولى أمانة أو معصية أو قضاء أو
شهادة فيخون في ذلك كله
ويليه من يصر على المعصية ويخشى أن تشاع عنه
فيظهر من النوافل والتطوعات والخضوع والخشوع والبكاء ما يوجب تكذيب من
يخبر عنه بالمعصية التي هو مصر عليها فقد جعل الله تعالى وقاية لعرضه
ويليه من يأتي بكثير من الطاعات لينال به شيئا من المباحات مثل أن يتصنع
لقوم يرغب في النكاح إليهم فيكون كمهاجر أم قيس
ويليه من يطلع منه على نقيصه فيظهر من الطاعة ما يجبرها ويمحوها من قلوب
الناس كمن يمشي منبسطا في مشيه فإذا اطلع على من يتنقصه مشى بالسكينة
والوقار ونكس رأسه وأسبل يديه وأرخى عينيه وكذلك الضاحك المنبسط في حديثه
يطلع عليه فيخشى أن ينسب إلى قلة الأدب وترك التخلق بآداب الصالحين
والاستكانة لرب العالمين فيترك ذلك ويظهر الندم عليه والاستغفار منه خوفا
من تغير اعتقاد الناس فيه
ويليه
من يرى الناس يتهجدون فيتهجد معهم لئلا ينسب إلى قلة الرغبة في الخير
ويراهم يتصدقون فيتصدق لمثل ذلك وكذلك سائر التطوعات يأتي بها ليحمد ويشكر
ويولى والله تعالى يعلم منه أنه لو خلا عن الناس لم يفعل شيئا من ذلك
ويليه من يعمل العمل لله تعالى ولأجل العباد ولولا العباد لما فعله
ويليه من يعمل العمل لله تعالى إذا خلا فإذا رآه الناس فعل ذلك لأجلهم
ولأجل الثواب
ويليه من يوهم الناس أنه صائم تطوعا وهو مفطر لكنه يخشى أن ينسب إلى قلة
الرغبة في الخير ويكون ممن يظن به الخير فيسقط اعتقاد الظان فيه فيمتنع من
الطعام والشراب مع حاجته إليهما وقلة صبره عنهما
وفي بعض هذه الرتب نظر
فصل فيما يورثه الرياء من الخصال المذمومة
يورث الرياء خصالا مذمومة منها حب الرياسة والمباهاة بالعلم والعمل والتفاخر بالدين والدنيا ومحبة العلو والتكاثر بالمال وغيره من أمور الدنيا وبالعلم والعمل والتحاسد عليهما من غير منافسة بل خوفا منأن ينال من يحاسده من المنزلة والحمد لا يناله هو ورد الحق على
من أمر به
أو ناظر فيه لئلا يقال هو أعلم منه وحب الغلبة في المناظرة وترك تعلم من
يحتاج إلى تعليمه
وحب الرياسة أن يحب التعظيم والإجلال وتسخير
العباد والاحتقار بهم وان لا يرد عليه شيء من أقواله وأن لا يساوى في
العلم بأمثاله وأن يصر على الخطأ كي لا تنكسر رياسته وإن وعظ عنف وإن وعظ
أنف
والمباهاة بالعلم أن يخبر عن نفسه بكثرة الحفظ والمواظبة عليه
وكثرة عدد من لقي من المحدثين والمبادرة بالجواب حين يسأل هو أو غيره يريد
بذلك كله أن يعلو على غيره وأن يعلمه أنه أعلم منه وإن أخبر بحديث ذكر أنه
يعرفه مباهاة
والمباهاة بالعمل أن يحاضر من يعمل عملا من أعمال البر
كالصلاة والجهاد وغيرهما فيأتي بمثل ما يأتي به ويزيد عليه لا يريد بذلك
إلا تعريفه أنه افضل منه ولو خلا بنفسه لما فعل شيئا من ذلك
وأما المباهاة بالدنيا فبأن يزيد على أبناء جنسه بالأبنية والمآكل
والمشارب والملابس والمناكح والأثاث والخدم لا يريد بذلك إلا أن يفوق غيره
وأن يعرفه أنه أفضل منه في ذلك
والمفاخرة كالمباهاة وتزيد عليها بأن
يذكر ما فضله به تعظيما لنفسه وتحقيرا لصاحبه مثل أن يقول كم سمعت أنت وهل
تحسن شيئا وما تقول في مسألة كذا وكذا أو يقول ما يحسن فلان مثل ما أحسن
ولا قام مقامي قط في حرب ولا في غيره وكم تحفظ من الحديث ومن لقيت من
الشيوخ ومن أدركت من العلماء
والمفاخرة بالدنيا كقوله أنت فقير ولا مال لك وكم ربحت وأي شيء ملكت وعبدي
ومولاي أغنى منك
والتكاثر كالمفاخرة ويزيد عليها بالتعديد مثل أن يقول سمعت كذا وكذا من
الحديث وغزوت وحججت كذا وكذا غزوة وحجة وأدركت كذا وكذا من المشايخ وما
أفطرت من كذا وكذا
ومن ينام بالسحر فإن كان المفاخر المكاثر فطنا
يحب أن يحمد بما فاخر به أو كاثر ويخشى أن يذم بالمفاخرة والمكاثرة عرض
بالمفاخرة والمكاثرة ليحصل على غرضيه
وهذه الأخلاق الذميمة يجامع
بعضها بعضا ويزيد بعضها على بعض ولأجل ذلك فرق الكتاب والسنة بينهما ففي
الكتاب { وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد }
) وفي الحديث ( من طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا مرائيا )
ومن الأخلاق الذميمة الحسد ويكون مسببا عن الرياء وغيره كما يكون التفاخر
والتكاثر كذلك فالحسد أن يتمنى زوال ما فضل الله تعالى به غيره عليه مخافة
أن يعتقد الناس فضله عليه وحب الغلبة يكون عن الرياء وغيره فيحب أن يغلب
في المناظرة وأن يخطئ خصمه فيها ليظهر صوابه ليعظم بذلك ويوقر أكثر مما
يعظم خصمه ولو أصاب خصمه أو ساواه في المعارضة لساءه ذلك ولطال همه وغمه
وقد يترك السؤال عما يلزمه تعلمه أو يجيب بما لا يعلمه مخافة أن ينسب إلى
الجهل بذلك وهذا على الحقيقة تسميع بالعلم بلسان الحال
فائدة في علامة الرياء في نفس الإنسان
من أراد أن يعلم من نفسه أنه مراء أو مخلص فعلامة كونه مرائيا أن يحب الحمد على الطاعة ويكره الذم فيفعل الطاعة خوفا من الذموإذا أخلص العمل لله تعالى أو علم علما لا يعلمه الناس لم يقنع بعلم الله منه ذلك وهاج قلبه لمحبة إطلاع الناس عليه
فأحب الناس إليه من يمدحه على ذلك
وإن طالب نفسه بطاعة خفية ثقلت عليه ولم تطاوعه على ذلك ولا تتمنى طاعة لا يعلم بها أحد وينفى الرياء بأن يعمل العبد العمل لا يريد به إلا الله تعالى اقتصارا على علم الله الذي بيده النفع والضر فقد يعمل العمل في السر بجوارحه أو بقلبه كالفكر الذي يهيج البكاء والأحزان فتجزع نفسه من خفاء ذلك عن الناس فتقول له كيف تخفي مثل هذه الفضيلة عن الناس ولو علموا بها لقمت عندهم مقاما عظيما ولا يعلم العبد أن في ذلك ضعة قدره عند ربه حتى يلزم قلبه الإخلاص فيقنع بعلم
الله تعالى فإن اطلع عليه منع قلبه من الارتياح إلى اطلاعهم عليه فإن غلبته على الارتياح رد عليها بالكراهة والإباء وامتنع من الركون إليه ولا يزال حذرا حتى يفرغ من العمل فإذا فرغ من العمل منع نفسه من طلب التسميع به فإن كان العمل ظاهرا كتشييع الجنائز وطلب العلم والتطوع يوم الجمعة في المسجد فليوطن نفسه على أن تقنع بعلم الله تعالى ولا ينظر إلى علم من لا يضر ولا ينفع ولا يلتفت إليه
فصل فيمن يخلص العمل في السر فيطلع عليه فيعجبه ذلك
من أخلص العمل لله سرا فاطلع عليه فأفرحه ذلك وأعجبه فله أحوالإحداهن أن يفرح بذلك لأن الله عز وجل ستر مساوءه وأظهر محاسنه ولا يفرح بسبب اطلاع الناس على ذلك فهذا فرح بإنعام الله عليه وإحسانه إليه يرجى له الأجر على ذلك وقد يرجو أن يستر الله عليه ذنوبه في الآخرة كما سترها في الدنيا فيكون محسنا للظن بربه وقد قال تعالى ( أنا عند ظن عبدي بي )
الثانية أن يسر كون أن الناس اطلعوا عليه فأطاعوا الله فيه بإحسان الظن به
فيكون سروره بكونهم أطاعوا الله تعالى فيه فهذا سرور منه للمسلمين بطاعة
الله سبحانه وتعالى فيه
الثالثة أن يطلعوا عليه فيقتدوا به فيسر
بكونهم اقتدوا به وبأن الله تعالى جعل طاعته سبب الاقتداء به فأحسن به من
سرور وقد أمرنا الله عز وجل أن نفرح بفضله وبرحمته
الرابعة أن يسر
باطلاعهم عليه ليعظموه ويشكروه وأن ينال منهم ما يرجوه أهل الرياء فلا
يحبط عمله بذلك لأنه مضى على الإخلاص ولم يأثم به لأن من طبع الإنسان
الميل إلى ما يوافق طبعه والنفور مما يخالف طبعه وما كلف أحد أن يخرج عن
طبعه ولكنه إذا ظهر حبه لذلك لم يأمن أن يكون خطرت له خطرة رياء فخفيت
عليه لأن الرياء في العبيد أخفى من دبيب النمل فإن اطلع عليه في أثناء
العمل فسر بذلك لأجل المنزلة عند الناس فقد اختلف فيه وتردد الشيخ فيه ثم
اختار الإحباط وهذا بعيد إذا لم يراء ببقية عمله فإن مجرد الحب لاطلاع
الناس ميل طبعي لا معصية فيه فكيف تحبط الطاعة بما لا معصية فيه
ولو مال قلب الإنسان في الصلاة أو الصوم أو الحج إلى شيء من المعاصي لم
تبطل عبادته بذلك فما الفرق بين هذا أو بين الميل إلى الرياء
فإن قال الشيخ لا آمن عليه الرياء لم يستقم ذلك لأنه تيقن صحة العبادة
وإنما انعقدت على الإخلاص وشك فيما يفسدها وقد جاء في حديث وقفه أكثر
رواته على أبي صالح أن رجلا قال يا رسول الله أسر العمل لا أحب أن يطلع
عليه فيطلع عليه فيسرني فقال ( لك أجران أجر السر وأجر العلانية ) فهذا
محمول على من سر بذلك لستر الله عليه لا لاطلاع الناس ونيل المنزلة عندهم
أو على من سره ذلك لأن الناس وقروا من أطاع الله عز وجل فيه ولم يقعوا فيه
أو لأنهم اقتدوا به لما اطلعوا عليه ولا وجه لإحباط العمل ولا لبعضه بمجرد
الرياء إلا أن يقترن بها رياء أو إرادة رياء
فائدة في عدم جواز الدخول في العمل إلا بعد التيقن من الإخلاص
لا يجوز أن يدخل في العمل إلا وهو متيقن بالإخلاص الحقيقي أو الحكمي فإذا شرع في العمل ومضى عليه زمان يمكن أن يخطر فيه الرياء ثم أنساه أجزأته العبادة لأنه تيقن الإخلاص في أولها وشك في الرياء المفسد لها فأشبه من دخل فيها في الصلاة على يقين من الطهارة ثم شك في زوالها فإن تخوف من ذلك كان مأجورا على خوفه من صحة عبادتهفصل في الإخلاص في النية الحكمية والحقيقية
يتعلق بكل عبادة نيتانإحداهما أن ينوي كونها عبادة
والثانية أن ينوي كونها لله عز وجل
فأما نية العبادة فضربان
أحدهما حكمية
والثاني حقيقية
فأما الحقيقية فيشترط اقترانها بأول العبادة
وأما الحكمية فتجزأ في سائر العبادات إذا تحققت في أولها وكذلك تجزأ في
أول العبادة إذا تعذر اقتران النية الحقيقية بأولها كما هي في الصيام إذ
لا تقترن النية الحقيقية بأوله
وأما الإخلاص فإن كان قد تقدم من
المكلف أنه مهما فعله من الطاعات إنما يفعله خالصا لله تعالى فتجزئه هذه
النية الحكمية من أول العمل إلى آخره إن كان اسم ذلك الفعل في الشريعة
عبادة أو طاعة والأولى أن يأتي في أول الفعل بنية الإخلاص حقيقة كما يفعل
ذلك في نية العبادة كالصلاة وتشييع الجنازة
والنية الحكمية في الإخلاص وغيره لا تجزأ إلا إذا لم يطرأ مناقض لها
وإن كان العمل مما الغالب عليه أن يفعل لأجل الناس كالمساعدة على قضاء
الحاجات فهذا لا يجزئ إلا بنية حقيقية إلا في أربعة أشياء نفع العالم
والعابد والمضطر والرحم والظاهر أنه لا يحتاج إلى تجديد النية في ذلك
فائدة في إدخال السرور على المؤمن بالتعليم والإفادة
إدخال السرور على المؤمن بالتعليم والإفادة إن أراد به وجه الله تعالى فهو مثاب عليه وإن أراد به أن يعظمه المتعلم أو يوقره ويحمده أو ينال منه مالا أو غيره من المنافع الدنيوية فلا يقدم على ذلك وليغير إرادته ما استطاع حتى تكون لله وحده إذ { وما عند الله خير وأبقى } وإن التبس عليه الأمر فلا يقدم على ذلك حتى يتحقق أنه لا يريد بإدخال السرورة عليه إلا لوجه الله تعالىفصل في من افتتح طاعة لله تعالى مخلصا لله فيها ثم حدث له فيها نشاط فزاد فيها وكان ذلك بمرأى من الناس فأشكل عليه أمر الزيادة أهو مخلص فيها أم لا
من افتتح طاعة الله تعالى على الإخلاص أو افتتح عملا مما يتعلق بالناس على الإخلاص أيضا وكان ذلك بمرأى من الناس ثم وجد نشاطا لزيادة ذلك العمل فزاد فيه فإن أراد بالزيادة الرياء فهو مراء وإن أراد بها الإخلاص فهو مخلص وإن التبس عليه الأمر فلم يدر أمخلص هو أم مراء فالأولى به أن يجدد النية لإخلاص تلك الزيادة فإن لم يجددها صح عمله لأنه تحقق إخلاصه وشك في الرياءفائدة في أن الرياء والإخلاص إرادتان زائدتان على إرادة العبادة
الرياء والإخلاص إرادتان زائدتان على إرادة العبادة فإرادة العبادة أن يريد إيقاع تلك الطاعة والإخلاص أن يريد بها ثواب الله تعالى دون شيء من الأغراض الدنيوية والرياء أن يريد بعمله التعظيم والمدح وغير ذلك من أغراض الرياءفصل فيما لا يدخل فيه الإخلاص
لا يدخل الإخلاص في مباح لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة كرفع البنيان لا لغرض والد ولا والدة بل لمحض رعونة النفس وكذلك لا إخلاص في محرم ولا مكروه كمن ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه ويزعم أنه ينظر إلى ذلك يتفكر في صنع الصانع فهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة فيه البتةفصل في حكم من سئل عن طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات فقال لا تحضرني نية
ولهذا حالان أحدهما أن يقول لا تحضرني نية لكسلي عن هذا العمل المتطوع به أو لاشتغالي بغيره فهذا صادق في قوله محروم من طاعة ربه ولا حرج عليه في ذلك لجواز ترك التطوعات
والأولى به أن يحث نفسه على تلك الطاعة واستحضار نيتها فإن التقرب إلى
الله تعالى بالنوافل سبب لمحبة الله تعالى العبد وأحسن به وأعظم به من سبب
الثانية أن لا يعوقه عن تلك الطاعة عائق ويقول لا تحضرني النية التي
هي الإخلاص فهذا غالط باعتذاره لأنه لم يؤمر بترك العمل لعزوب الإخلاص
وإنما أمر بأن يستجلب الإخلاص على حسب إمكانه ولو ترك العمل لعزوب نية
الإخلاص لحمله الشيطان على ترك الواجبات لعزوب نية الإخلاص ولا يضره في
ذلك ما يوسوسه الشيطان من ترك الطاعة ولا اشتغال النفس بتلك الطاعة ولا
محبتها لحمد الناس على الطاعة ولا محبتها لتعظيمهم إياه وتوقيرهم لأن الله
عز وجل جبل النفوس على محبة ما وافقها طاعة كانت أو غير طاعة وعلى كراهة
ما خالفها من الطاعات وغيرها وما أمر الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه أن
يخرج عن طبعه إذ لا قدرة للعبد على ذلك وكذلك لا يقدر على دفع وسواس
الشيطان وإنما أمر بمخالفة طبعه بما فيه رضا الرحمن وإرغام الشيطان
وأهل السماوات والأرض ثلاثة أقسام
أحدها الملائكة وقد ركبت فيها العقول دون الكراهة والملال
ولذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يثابون
على أعمالهم لأنهم لم يجاهدوا أنفسهم ولم يخالفوا أهواءهم
القسم الثاني البهائم والطير والوحش وقد ركبت فيها الشهوات التي تقوم
بمصالحها والنفرة مما يؤذيها ويخالف طبعها ولم يركب فيها عقول تعرف بها
الأمر والنهي فلم يؤاخذها بشيء لعدم العقل ولا ثواب لها في الآخرة إذ لا
طاعة لها ولا عقاب عليها فيما تتلفه من النفوس والأموال وغير ذلك من
الأفعال التي يعاقب عليها الثقلان
القسم الثالث الثقلان وقد ركبت
فيهم العقول كالملائكة وجعلت فيهم الشهوات كالوحش والطير والدواب فكلفوا
لأجل عقولهم وأثيبوا لطاعتهم ومخالفتهم أهواءهم وعوقبوا على معاصيهم
ومخالفة أمر ربهم لأن لهم عقولا تردعهم عن موافقة أهوائهم وتزجرهم عن
مخالفة أمر ربهم ولم يكلفوا إلا بما يطيقون ولم يكلفوا بالخروج عن طباعهم
ولا بإخراج الشيطان من صدورهم ولا حرج على الإنسان في وسواس الشيطان فإن
شياطين الجن مثل شياطين الإنس ولو أمرك شيطان إنسي بمعصية الديان ومخالفة
الرحمن لم يكن عليك حرج في أمره إياك بذلك وإنما الحرج في إجابة الشيطان
وموافقة الطباع فيما يكرهه الرحمن ويزجر عنه القرآن
فصل في حكم من ابتدأ طاعته على الرياء ثم أخلصها في أثنائها
والأعمال ضربانأحدهما متعدد حكما وصورة كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة المترتبة فهذا إذا افتتحه على الرياء ثم أخلص صح ما اقترن به الإخلاص وبطل ما اقترن به الرياء لأن ذلك بمثابة عبادات راءى في بعضهن وأخلص في بعضهن
الثاني العبادة المتخذة كالصلاة والصوم والحج إذا افتتحها مرائيا ثم أخلص في أثنائها فقد اختلف العلماء في ذلك
فقال بعضهم لا يعتد له بشيء منها وهذا هو الظاهر
وقال بعضهم لا يعتد له إلا بافتتاحها دون ما عداه
وقال آخرون يعتد له بالجميع لأنه ما أتى بذلك إلا لله عز وجل فإن التكبير والتسبيح والركوع والسجود لا يكون إلا لله عز وجل وهذا يشكل عليه سائر الأعمال التي لا تكون إلا لله عز وجل
ولعل هذا يقول لا يبطل الرياء العمل إلا إذا اقترن به من أوله إلى آخره
وقد بنى أمره على أن النظر إلى خاتمة العبادة وقد وقعت خالصة لله عز وجل
ولعل من يقول بالصحة في الجميع يجعل الرياء محرما اقترن بالصلاة فلا
يبطلها كمن صلى لابسا ثوب حرير أو متختما بخاتم من ذهب أو من صلى في دار
مغصوبة ولكن هذا لا يستقيم لأن الشيخ نص على أن ما اقترن بالرياء غير معتد
به وليس هذا الفصل صافيا من كدر الإشكال
فصل فيمن يحمده الناس على الطاعة ويشكل عليه سكون نفسه إلى حمدهم
وطريقه في تعرف ذلك أن يعرض على نفسه أنهم إن ذموه وعابوه أو تركوا حمده من غير ذم فإن كره ذلك واشتغل له قلبه لم يؤمن عليه الرياء وإن لم يبال بذلك ولم يلتفت عليه فالظاهر أنه مخلص وقد يكون قبل ذلك مرائيا واقفا مع حمدهم ثم يخطر له ترك الوقوف مع الحمد وكذلك قد يكون مخلصا فإذا تركوا حمده شق عليه ذلكومثل هذا أن يكون للعبد أسباب عتيدة لرزقه فتسكن نفسه ولا يدري هل سكونه اعتماد على الله عز وجل أو اعتماد على تلك الأسباب فيعتبر ذلك
بأن يقدر زوال الأسباب فإن بقي سكونه فالظاهر أنه كان متوكلا على الله تعالى ويجوز خلاف ذلك وإن قلقت نفسه فالظاهر أنه كان معتمدا على الأسباب
فصل فيمن يترك النوافل كي لا يأثم الناس بنسبته إلى الرياء
قد يكره المتطوع نسبته إلى الرياء فيترك العمل دفعا لذلك وقد يتركه شفقة على الناس أن يأثموا بنسبته إلى الرياءوطريقه إلى معرفة ذلك أن ينظر إلى ذنوب الناس فإن شقت عليه كمشقة نسبته إلى الرياء أو أعظم فليس يغالط في ذلك وإن لم يشق عليه ذنوبهم كما يشق عليه نسبتهم إياه إلى الرياء فهو مخطئ من وجهين
أحدهما أنه ترك العمل المحقق نفعه خوفا مما ظنه
والثاني أنه أساء الظن بالمسلمين أن يعصوا الله فيه بنسبته إلى الرياء
فصل في إظهار العمل للاقتداء
من أظهر عمله ليقتدي به فله حالانأحدهما أن يكون ممن لا يلتفت إليه ولا يقتدى بأفعاله فلا يظهر
شيئا من أعماله لأنه لا يأمن في إظهارها الرياء وليس على ثقة من
الاقتداء به
الثانية أن يكون ممن يقتدى به فيما يظهر من أعماله فإن كان ذلك العمل من
أعماله العلانية كالجهاد وأمن من الرياء فأظهر من أعماله التقدم إلى العدو
والثبوت في نحره والصبر إذا انهزم الناس على مكافحة العدو فإن أمن الرياء
فله أجران أجر الجهاد وأجر التسبب إلى الاقتداء به لأن ( الدال على الخير
كفاعله ) وكذلك إظهار الصدقة مع الأمن من الرياء إظهارها للاقتداء ممن
يقتدى بمثله أفضل من إخفائها إلا أن يتأذى آخذ الصدقة بأخذها في العلانية
فيكون إخفاؤها أولى لأن المن والأذى قد يحبطان أجر الصدقة ولا يقاوم تسببه
إلى الاقتداء به تعريضه أخاه المسلم للضيم والأذى وإن أشكل عليه الأمر في
ذلك فليعرض الإخفاء والإظهار على نفسه فإن جزعت نفسه من الإخفاء وشق عليها
فلا يظهره ذلك إذ لا يأمن على نفسه الرياء وإن جزعها إنما كان لفوات غرضها
من الرياء لا لفوات الاقتداء
فصل في الإخبار بالطاعة
من عمل طاعة ثم أخبر بها الناس فله ثلاثة أحوالإحداهن أن يظهر ذلك ليعظم ويوقر ويحصل أغراض المرائين فهذا مسمع و ( من سمع سمع الله به )
الثاني أن يفعل ذلك ليقتدي به ويكون سببا يحث المخبرين على الطاعات والعبادات فله حالان
أحدهما أن يكون مما لا يقتدى به ولا يلتفت إليه فلا يتحدث بشيء من ذلك
احترازا من التسميع والتصنع للناس وقد يسخر منه إذا أظهر عمله ونسب إلى
الرياء فيكون مخاطرا بالتسميع متسببا إلى وقوع الناس فيه
الثانية أن يكون ممن يقتدي به وله حالان
أحدهما أن يكون ممن يعتقد فيه عامة الناس كالخلفاء الراشدين والعلماء
المتقين فإن وثق من أمنه من الرياء إذا تحدث بذلك فليتحدث به وقد فعل ذلك
جماعة من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم وقد تسبب
بإظهار ذلك إلى نصح المسلمين وحثهم على طاعة رب العالمين
الثانية أن يكون ممن يعتقد فيه بعض الناس دون بعض فلا يتحدث به من لا
يعتقد فيه ويذكره عند من يعتقد فيه إذا أمن الرياء
وإن اجتمع الفريقان ففيه تفصيل
الحالة الثالثة أن يخشى من التحدث بالعمل للرياء والتسميع فلا يتحدث بذلك
احتياطا وتحرزا عن التصنع والتسميع
فصل في تفضيل عمل السر على عمل العلانية
اختلف العلماء في ذلكفقالت فرقة عمل السر أفضل من عمل العلانية للقدوة وغير القدوة وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير القدوة
والفرق بينهما أنه في إظهار عمل السر لا يأمن الرياء فيمكنه أن يحفظ عمله عن الرياء بإسراره وإخفائه وحفظ إخلاص العمل أولى من المخاطرة به
وأما عمل العلانية فلا يقدر على التحرز فيه من الرياء
وقالت طائفة عمل السر أفضل من عمل العلانية لغير القدوة وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل السر لأن من تسبب إلى خير أو سن سنة حسنة أجر على ذلك أجرين أو أجورا كثيرة على عدد المقتدين به
وجاء في حديث ( إن عمل العلانية يضاعف على عمل السر إذا استن بعامله
بسبعين ضعفا )
وعمل السر ما شرع إسراره من أول أمره كالنوافل والأذكار
وعمل العلانية ما شرعت العلانية في أول أمره أو ما لا يتأتى عمله إلا في
العلانية كعيادة المرضى وتشييع الجنائز وحضور الأعياد
فالإسرار بأعمال السر أولى إلا رجاء الاقتداء لمن يأمن الرياء وعمل
العلانية مع مجاهدة النفس من خطرات الرياء أولى من تركه مخافة الرياء
وقد ترك جماعة من السلف الأعمال لما اطلع عليهم مع كونهم أعلنوا ما هو
أفضل ومنها وما تركوا ذلك إلا عند ضعف الحال في بعض الأوقات خوفا من خطرة
التصنع والرياء
فصل في ترك العمل خوفا من الرياء
لخطرة الرياء ثلاثة أحوالإحداهن أن يخطر قبل الشروع في العمل لا ينوي بعمله إلا الرياء فعليه أن يترك العمل إلى أن يستحضر الإخلاص
الثانية أن يخطر رياء الشرك فيترك ولا يقدم على العمل حتى يمحض الإخلاص
الثالثة أن يخطر في أثناء العمل الخالص فليدفعها ويستمر في العمل فإن دامت الخطرة ولم يجب نفسه إلى الرياء صح عمله استصحابا لنيته الأولى
فصل فيما يندب إلى تركه من الأعمال الخالصة
الأعمال قسمانأحدهما عام كالصلاة والصوم والغزو والجهاد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه وما أشبهها من الأعمال العامة لا يترك شيء منها بل يفعلها الخاص والعام
والثاني خاص كالخلافة والإمرة والقضاء والانتصاب للحق بالدعاء إلى الله تعالى فهذا القسم يؤمر العامة بتركه خوفا من العجز عن القيام بحقه ولا يتولى ذلك إلا الأقوياء الواثقون بأنفسهم وقد جاء تشديد عظيم في النهي عن الولايات
وقد أجمع المسلمون على أن الولاة أفضل من غيرهم
وتفصيل ذلك أن الولايات تشتمل على غرض شرعي وغرض طبعي فنهي عنها من يغلبه طبعه وهواه وأمر بها من يكون قاهرا لطبعه غالبا لهواه
فلا يتولاها من لا يملك هواه ولا يرد نفسه إلا أن يتعين لها فيجب عليه أن يتولى وأن يجاهد نفسه في دفع هواها ما استطاع
وأما الأعمال العامة فلا يترك شيء منها
وأما الاكتساب بالأسباب المباحة ليتصدق مما يكسبه ويصرفه في القربات فقد
اختلف فيه هل تركه أفضل أم فعله
فقالت طائفة تركه أفضل
وقال آخرون بل فعله مع السلامة أولى كما في الصلاة والصيام
فائدة في أن العمل بطاعة الله إرادة محبة الناس رياء
من الرياء أن يعمل العبد بطاعة الله تعالى إرادة محبة الناس ومن أخلص عمله لله عز وجل وأحب أن يحبه الناس من غير أن يعمل لأجلهم فلا بأسفائدة فيمن اطلع الناس على ذنبه وتقصيره فاشتد غمه
من اطلع الناس على ذنبه وتقصيره فاشتد غمه لذلك فلا بأس عليه لأن ذلك من فعل الطبع والغريزة التي لا يكلف بترك آثارها وله أحوالإحداهن أن يكون اغتمامه باطلاع الناس على تقصيره أشد من اغتمامه باطلاع الله عز وجل عليه فهذا خاسر في دينه
الثانية أن يكون اغتمامه باطلاع الله تعالى عليه أشد من اغتمامه باطلاعهم عليه فهذا أفضل في الدين
الثالثة أن يخشى سقوط المنزلة عند الناس فيعتذر بالكذب أو يتصنع بالأعمال
الصالحة ليمحو ذلك من قلوبهم فلا يجوز ذلك
الرابعة أن يجزع أن يشغله غمه عن القيام بوظائف الطاعات فهذا أفضل لعزة
دينه عليه
الخامسة أن لا يبتنى على اغتمامه شيء مما ذكرناه فلا بأس عليه إذ لا يتعلق
التكليف بمجرد الاغتمام
فائدة في أنه لا يفعل في الخلوة إلا ما يسهل فعله في العلانية
ينبغي للمريد أن لا يفعل في الخلوة إلا ما يسهل عليه فعله في العلانية ولذلك قال عمر رضي الله عنه عليكم بعمل العلانيةويستثنى من ذلك ما يستحي منه كالجماع وقضاء الحاجة وليس كتم الإنسان ذنوبه وإخفاؤها وإخفاء عيوبه من أبواب الرياء إلا أن يظهر من أعماله وأقواله ما يدل على أنه عفيف عن تلك الذنوب منزه عنها فيكون حينئذ كاذبا ومسمعا بلسان الحال
وقد اتفق العلماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة إلا أن تمس إليها حاجة كالإقرار بما يوجب الحدود أو الكفارة كما في حديث
ماعز والأعرابي الذي واقع في رمضان وكذلك الإقرار للعباد بحقوقهم ومعصية الله تعالى فيهم فيلزمه تعريف المستحق لذلك ليبرئه ألا يقيم عليه العقوبة الشرعية
فصل في التباس سبب الرياء بالحياء
اعلم أن الله عز وجل جبل الآدمي على أوصاف جالبة للنفع وعلى أوصاف دافعة للضر فخلق صفة الجوع لأنها جاذبة لنفع تنفيذ الغذاء وخلق صفة الظمأ لأنها جالبة لنفع تنفيذه للغذاء وخلق شهوة الجماع لأنها في الغالب سبب للنسل وخلق الغضب لدفع الضيم وخلق الحياء لجلب النفع ودفع الضر جميعافيحمل الحياء العبد على فعل ما يستحي من تركه
وترك ما يستحي من فعله فقد جمع من الخير ما تفرق في غيره ولذلك
قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ( الحياء من الإيمان ) شبهه بالإيمان لاستوائهما
في الحث على كل حسن والزجر عن كل قبيح وقد يفعل الإنسان البر حياء وقد
يفعله رياء
مثال ما يفعله حياء أن يسأل شيئا من أنواع البر فيدفعه حياء من السائل أن
يمنعه فله أربعة أحوال
إحداهن أن يدفعه رياء فهذا مذموم لأنه قدم الحياء من الخلق على الحياء من
الله سبحانه وتعالى
الثاني أن يفعله إخلاصا وحياء فهذا ممدوح مأجور لأنه استعمل الحياء في
موضع ينبغي أن يستعمل الحياء فيه
الثالث أن يتردد بين كونه مرائيا أو كونه مستحيا فلا يقضى بإثمه
ولا بكونه مخلصا لأنه لا نتحقق إخلاصه فيكون مأجورا ولا نتحقق
رياءه فيكون مأزورا
الرابع أنه يعلم أنه فعله حياء من غير إخلاص ولا رياء فهذا محمود لا مأجور
ولا مأزور ومثل هذا عزيز الوجود أن يفعل العبد فعلا لا لغرض
ومثال
ترك البر حياء أن يرى شيخا ذا شيبة ووقار وهيبة قد ألم بذنب يجب الإنكار
عليه فيترك الإنكار عليه حياء من شيبته ووقاره فهذا عاص لله تعالى من
وجهين بترك النكير على من يجب عليه الإنكار وبتقديم استحيائه من الشيخ
الكبير على استحيائه من الملك القدير ولو لاحظ عظمة الله تعالى لم يستح
إلا منه ولكن الغفلة عن ملاحظة العظمة أوجبت له ذلك
فصل في أسباب كراهة العبد لذم الناس
كراهة الذم أمر طبيعي لا يتعلق به تكليف وقد يكره لأسباب
أحدها أن يكره ذمهم مخافة أن يكون ذمهم دليلا على ذم الله تعالى له إذ هم
شهداء الله سبحانه وتعالى في الأرض
الثاني أن يكره ذمهم لكونه شاغلا لقلبه عن طاعة ربه
الثالث أن يكره ذمهم مخافة أن يعصي الله تعالى فيهم بقلبه أو بجوارحه
الرابع أن يكره ذمهم مخافة أن يعصوا الله تعالى فيه بذمهم إياه فهذا كله
لا بأس به ولا حرج عليه فيه
الخامس أن يكره ذلك مخافة أن يزول عنه مدح الناس واعتقادهم فيه الورع فإن
لم يراء بشيء من الأعمال فهذا نقص في دينه بالنسبة إلى ما تقدم وإن راءى
بشيء من الطاعات أو اعتذر كاذبا فقد عصى الله عز وجل
الذي ينبغي
للمؤمن أن لا يلاحظ حمد الناس إياه على طاعة ربه ولا ذمهم على معصية ربه
وأن يخلي قلبه من ذلك كله وأن يجعل من يعرفه كمن لا يعرفه فيتفرغ عن حمد
معارفه وكراهة ذمهم كما يتفرغ من ذلك في حق من لا يعرفه ولو اطلع على
حمدهم فسره ذلك لأنهم أطاعوا الله تعالى فيه فلا بأس بذلك
وكذلك لو سره أن الله تعالى ستر مساوئه وأظهر محاسنه فذلك سرور بإنعام
الله تعالى عليه وإحسانه إليه
فصل في بيان ما يسوى فيه بين الحامد والذام وما يفترقان فيه
على العبد أن يسوي بين حامده وذامه في كونهما لا يقدران بحمدهما ولا ذمهما على نفعه ولا ضره لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته فيصير الذم والمدح في حقه مستويين في كونهما لا يجلبان خيرا أو لا يدفعان ضرا وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه حتى يكون حامده وذامه في الحق سواء بخلاف ذم الله تعالى ومدحه فإنه هو الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع فمدحه زين وذمه شين مع ما يترتب على مدحه من العطاء والرفع وعلى ذمه من الخفض والمنعوأما ما يفترق فيه مدح العباد وذمهم فنفور النفس من الذم وسكونها إلى المدح
وللعبد في تأثيره بالذم والمدح أحوال
أحدها أن يتأثر لنفسه كما قدمناه
الثاني أن يتأثر لأجل ربه كما ذكرناه
الثالث أن يلتبس عليه أمره في ذلك
فطريقه في ذلك أن ينظر إلى مدح الناس لغيره وذمهم فإن تأثر به كما
يتأثر به في حق نفسه بتين بذلك أن محبته وكراهته لأجل ربه سبحانه وإن لم يتأثر به عرف بذلك أن كراهته ومحبته لأجل نفسه لأنه لو كره ذلك أو أحبه لأجل الله عز وجل لكانت محبته وكراهته في حق غيره كمحبته وكراهته في حق نفسه وإن تأثر بذلك في حق غيره أقل مما يتأثر به في حق نفسه دل ذلك على أنه قد شرك في المحبة والكراهة بين نفسه وربه
فائدة في التوسل بالرياء إلى طاعة الرحمن
لا يجوز لأحد أن يرائي العالم بعمله ليزداد علما بذلك ولا أن يرائي والديه بشيء من عمله ليرضيا عنه لأن الرياء معصية لله تعالى وليس لأحد أن يتوسل بمعاصي الله تعالى إلى طاعتهقال الشيخ وفي هذا نظر لأن هذا توسل بطاعة الله إلى طاعة الله تعالى بخلاف المرائي فإنه توسل بطاعة الله تعالى إلى هوى نفسه
فصل فيمن راءى من يطيع الله تعالى بطاعة لم يعتدها هو فوافقه على تلك الطاعة
من راءى المتهجدين فتهجد والقارئين فقرأ أو المتصدقين فتصدق أو الصائمين فصام أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فوافقهم ولم يكن شيء من ذلك من عادته فله ثلاثة أحوالأحدها أن يفعل ذلك خالصا لله عز وجل واقتداء بمن رآه يفعل ذلك فهذا مطيع لله تعالى حثه ما رآه على طاعة ربه
الثاني أن يخشى الذم بترك الطاعة فيفعلها رياء لدفع الذم وجلب الحمد أو لأحدهما فهذا مراء شقي فإن كان ذلك العمل واجبا جاهد نفسه في دفع الرياء وجلب الإخلاص وإن كان ندبا لم يجز له فعله حتى يتحقق إخلاصه
الثالث أن يلتبس عليه أمره في ذلك فلا يدري أمخلص هو أم مراء فطريقه معرفة ذلك أن يقدر نفسه مستترا عنهم بحيث لا يرونه فإن طابت نفسه بالإقتداء بهم مع الاستتار عنهم فهو مخلص وإن لم تطب بذلك فهو مراء فلا يقدم على ذلك العمل حتى يخلصه لله تعالى
وكذلك من راءى
الباكين من خشية الله تعالى فاستحضر أسباب البكاء فبكى فإن بكى رياء فهو
مراء وإن بكى خالصا من خشية الله تعالى فهو مخلص وإن أشكل أمره عليه قدر
نفسه غائبا عنهم فإن بكى مع الغيبة فهو مخلص وإلا فلا
فصل في التصنع بالصياح والتنهد والزفير والشهيق والتحزن
من سمع وعظا أو قرآنا أو رأى أسبابا يهيج مثلها الخوف والحزن وما في معناهما فتنهد لذلك أو تنفس أو صاح أو أظهر الحزن والتندم والزفير والشهيق أو ما في معنى ذلك فله حالانأحدهما أن لا يكون في قلبه شيء من الحزن والخوف والندم ولكنه يظهر ذلك تصنعا للناس إما ليحمدوه على ذلك أو لئلا يذموه وينسبوه إلى القسوة وترك الخوف أو يتصنع بذلك ليشككهم فيما بلغهم عنه من الذنوب أو يوهمهم أنه قد تاب من ذنوبه وأقلع عن عيوبه
الثاني أن يكون إذا سمع القرآن أو الوعظ أو تفكر فيما يوجب الحزن أو الخوف فخاف خوفا يسيرا او حزن حزنا خفيفا فأظهر ما ذكرناه ليوهم الناس أن حزنه وخوفه شديد فهذا والذي تقدمه مسمعان بلسان
الحال لا بلسان المقال وهذا أخف حالا من الذي قبله
وإن خطر له التصنع بذلك فلم يتصنع فقد خلص وسلم وإن تصنع فقد سمع بلسان
الحال وعليه إثمان إثم الكذب وإثم التصنع بخلاف التسميع بالأعمال الخالصة
فإنه صادق في الإخبار عنها آثم في التسميع بها والمتشبع بما لم يعط كلابس
ثوبي زور
وإن هجم عليه سبب من أسباب الخوف أو الحزن فهاجت نفسه ليصنع بذلك
فإن قبل ذلك وتصنع به فهو مسمع بلسان الحال وإن لم يقبله فلا بأس به ولكنه
نقص
وكذلك حكم من ظهر منه الشهيق والتنفس والتنهد لخوف أوجب ذلك فخطر له خطرة
التصنع بالزيادة فإن لم يقبلها فلا بأس عليه وإن قبلها فهو متصنع
وحكم المتصنع في البكاء كما ذكرناه في التصنع في الشهيق والتنفس والتنهد
فصل في التصنع في السقوط والإغماء
من سقط عند الأسباب المحزنة أو المخوفة فله أحوالإحداهن أن يسقط لغلبة حزنه أو خوفه بحيث لا يستطيع أن يتمالك فلا بأس عليه فإن إفراط الخوف والحزن قد يوجبان ذلك
الثاني أن يتعاطى ذلك تصنعا بإظهار الشدة الخوف والحزن فهذا كاذب مسمع بلسان الحال وقد يتوهم هذا الكاذب أن الناس قد فطنوا لتصنعه فيتغاشى ويوهمهم أن عقله قد ذهب وأن سقوطه إنما كان لذهاب عقله وقد يسقط ويغشى عليه لفرط خوفه وحزنه أو لفرط غرامه وحبه ثم يفيق عن قريب فيطيل ذلك فيوهم أنه لم يكن متصنعا في سقوطه أو يوهم أن خوفه شديد لا يفيق من غشيته عن قريب فيطيل الغشية تصنعا وإيهاما لشدة الخوف وقد يسقط لفرط ضعفه لا لخوف ربه ويفيق عن قرب فيزيد ذلك لإيهام خوفه فيطيل التغاشي أو يعجز عن
التغاشي فيوهم الضعف في قوله وبدنه وجميع جوارحه
وقد يحضر ذلك عاشق لبعض الأشخاص أو من مات له حبيب عن قرب فيبكي ويصيح
ويسقط ويغمى عليه من فرط عشقه وحزنه على ميته ويظهر أن ذلك من حبه لربه أو
من حزنه على تقصيره في حق ربه
فصل فيما ينفى به التخشع والتصنع بما ذكر في الفصل قبله
إذا أبدى من الخشوع ما ليس في قلبه أو خشع ظاهره كما خشع باطنه ثم زاد في ذلك تصنعا أو أظهر السقوط أو الصياح والتنهد تصنعا بالحب أو الخوف وليس بمحب ولا خائف أو أظهر ذلك عن خوف من غير تصنع ثم أحدث التصنع أو أظهر السقوط أو الغشي عن الخوف وليس بخائف أو أظهر ذلك عن خوف حقيقي ثم تصنع أو زاد رياء أو بكى مغلوبا أو تباكى تصنعا أو غير هذا مما في معناه فطريقه في نفي ذلك كله أن يفكر في نظر الله عز وجل إليه واطلاعه عليه وأنه يظهر الخوف من الله تعالى وهو آمن أو يظهر الحزن على ما فاته من الله تعالى وهو خلي من الحزن وأنه يتحبب إلى الناس بما يتبغض به إلى الله تعالى وأنه لا يأمن أن يطلع اللهالعباد على تصنعه فيمقتوه فيجتمع مقت الناس إلى مقت الله تعالى فيخسر الدنيا والآخرة فإذا أدمن على ذلك بالفكر والملاحظة والاستحضار ذهب تصنعه لمن لا يملك له ضرا ولا نفعا وأخلص عمله لمن له الأمر كله
فائدة في زيادة خشوع العبد إذا نظر الناس إليه
إذا نظر الناس إلى الخاشع فزاد خشوعه فإن تصنع به فمراء وإن زاد فيه من غير تصنع فله أحوالإحداها أن يزيده لله عز وجل وحده فهذا مخلص
الثانية أن يزيد في خشوعه لئلا يطمع الناس فيه فيمنعوه من خشوعه
الثالثة أن يفعل ذلك ليقتدى به ففيه فضيلة الخشوع والسبب إلى الاقتداء
الرابعة أن يزيد في خشوعه إرغاما للشيطان الذي حمله على التصنع بالخشوع فهذا مخلص مجاهد الشيطان
فصل في إيثار الأصحاب الأغنياء على الفقراء
من صحب غنيا وفقيرا أو كانت مخالطته للغني أكثر من مخالطته للفقير وزيارته للغني أكثر من زيارته للفقير فله أحوالإحداها أن تكون مخالطته للغني أسلم له في دينه أو أزيد في علمه وعمله أو لأنه أجهل من الفقير فيزيد تعليمه وإرشاده فمخالطته للغني على هذا الوجه أولى من مخالطة الفقير
الثانية أن يكون الأمر بالعكس فتكون مخالطة الفقير أولى من مخالطة الغني
الثالثة أن يستوي حال الفقير وحال الغني فيتخير بينهما إلا أن يترجح أحدهما بقرابة أو مجاورة أو رحم
الرابعة أن يلتبس عليه الأمر فيعرض على نفسه أن الفقير لو كان غنيا والغني فقيرا أكان يؤثر الغني أم لا فإن كان بحيث أن يؤثر الغني على الفقير فليعلم أنه إنما آثره عليه لغناه وإن كان بحيث لا يؤثره عليه فهو مخير ما لم يسنح سبب يقتضي إيثار أحدهما على الآخر
فصل فيما يعين على ترك المعاصي رياء كان أو غيره
ولذلك أمثلةأحدهما ما يعين على ترك الرياء وهو أن لا يحاضر قوما يرائيهم إلا لضرورة كأداء فريضة أو معيشة كافيه لنفسه وعياله ويتحرز من ذلك جهده وطاقته
الثاني أن يكون ممن لا يقدر على حفظ بصره من المحارم فلا يخرج إلى الأسواق ولا يجلس على الطريق ولا ينظر في طاق يتعرض فيه لرؤية المحارم إلا أن يخرج لأداء فريضة أو كفاية معيشة
الثالث أن لا يخالط أقواما لا يكاد يسلم معهم دينه مثل أن يوافقهم على الغيبة أو على تصديق كاذبهم أو تكذيب صادقهم أو على الإزراء بالمسلمين واحتقارهم فلا يخالط هؤلاء إلا لضرورة مع التحرز من موافقتهم على أغراضهم
فإن خالطهم لغير ضرورة دعت ل ذلك فقد غرر بدينه
وتعرض لإسخاط ربه
فإن جالسهم على مذاكرة علم أو نحوها من الطاعات المندوبات فانجر بهم الحال
إلى شيء من المعاصي فليعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن جرت نفسه في
مخالطتهم فتكرر ذلك منهم مرارا فليجتنب مخالطتهم لما تجر إليه من المعصية
إذ لا تقوم المذاكرات والتطوعات بالمعصية وليس هؤلاء بإخوان ولا أصدقاء
ولا أصحاب لأن الأخ والصديق والصاحب من يسلم معه دينك أو تزداد بمجالسته
خيرا
وأما من يعرضك لسخط الله تعالى ومعصيته فإنه باسم العدو أولى
منه باسم الصديق فعليك أن لا تستهين بما يجري بينكم من الكلم فرب كلمة
يكتب الله بها لقائلها سخطه إلى يوم القيامة { وتحسبونه هينا وهو عند الله
عظيم }
ومن هؤلاء من لا يرضى منك إلا بالتصنع ويلتمس منك أن تعادي من عاداه أو
توالي من والاه وتصدقه في كذبه وتعينه على ظلمه
والجليس السوء كصاحب الكير إما أن يحرق ثيابك شرره وإما أن تجد منه ريحا
منتنة وقد قال الله تعالى لموسى يا موسى كن يقظان مرتادا لنفسك إخوانا فكل
خدن لا يؤاتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدوك وهو يقسى عليك قلبك
ولا يؤتى الناس في الأغلب إلا ممن يشاكلهم فيجتمعون تارة على الخير
فيحسدهم الشيطان عليه فيزين لهم الانتقال منه إلى الحديث المباح من
الفكاهة وغيرها فإن أجابوه إلى ذلك طمع فيهم وحملهم على الخروج إلى اغتياب
من يبغضونه وإلى احتقار من لا يجوز احتقاره فإن أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى
ما هو أشد منه من السعاية فيمن يكرهونه وفي أذيته وحط منزلته عند الناس
والشيطان صياد حاذق يصطاد كل إنسان بشكله ونظيره كما يفعل الصيادون في
اصطياد كل طير بشكله
فالويل كل الويل لمن آثر طاعة الشيطان على طاعة الرحمن فقدم إرضاء الإخوان
على إرضاء الديان
فائدة في المجالسة
يسهل عليك مقاطعة من ذكرت وترك مجالسته بأن تعرض على نفسك ما في مجالسته من التعرض لغضب الله تعالى وسخطه وتطيل التفكر في ذلك فتكره لقاءه بسببه وما مثلك في ذلك إلا كمثل من يلقى إخوانهفكلما لقي واحدا منهم أخذ شعرة من لحيته أو سلكا من ثوبه فإنه
يكره لقاءهم
فإنه لو واظب على لقائهم على تلك الحال لأصبح بادي العورة منتوف اللحية
وهذا مما يأنف منه كل عاقل
ومهما دعتك نفسك إلى مجالستهم ومخالطتهم لما ألفته من مصاحبتهم فاعرض ذلك
على نفسك فإنها تنفر منهم وتكره لقاءهم
فإن بليت بمخالطة من لا تقدر على مفارقته كالأهل ومن تشتغل معهم بالعلم أو
بالشركة في الصنائع والتجارات أو بمن يستأجرك أو تستأجره فالطريق في
فطامهم أن تظهر لهم شدة كراهتك لمشاركتهم في معاصيهم وغفلتهم فإن أبوا
عليك فالطريق في ذلك أن تعظهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فتكون
مأجورا أجرين أحدهما على كفك عن مشاركتهم في عصيانهم والآخر في أمرهم
بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإن أجابوك إلى ذلك كان لك أجر ثالث على
إجابتهم فإن من دعى إلى هدى كان له أجره ومثل أجور من دعاهم إليه فإن شق
عليك ذلك في
ابتداء الأمر فواظبت عليه ابتغاء مرضات الله تعالى فإن الله تعالى يهونه عليك وييسره لك بحيث يصير ألفا وعادة لك والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا
فصل في بيان أن النفس شر أعداء الإنسان
الشيطان عدو فاتن للإنسان وكذلك الدنيا ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله تعالى { فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور }وكذلك كل شيطان إنسي يدعوك إلى معصية الله تعالى
وشر أعدائك نفسك التي بين جنبيك لأن الدنيا والشيطان يدعوانك بغرورهما وكذلك شيطان الإنس
ولا ضرر عليك في دعاء هؤلاء إلى معصية الله تعالى وإنما تضررك في الدنيا والآخرة بإجابة هؤلاء إلى ما يدعونك إليه فهم متسببون وهي مباشرة
والعهدة العظمى على المباشر دون المتسبب ما لم يكن قاهرا مجبرا ولذلك يقول الشيطان يوم القيامة { وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني } لأني متسبب ولوموا أنفسكم لأنكم مباشرون وإذا أردت أن تعرف نفسك فانظر في كثرة مخالفتها ومعصيتها
كيف عرضتك بكل ذنب من ذنوبها لسخط الله تعالى وعقابه ثم انظر في
حسناتها
وفي مقاصدها بأعمالها قل ما ينفعك عمل من أعمالها من رياء أو كبر أو عجب
فإذا كشفت عن ذلك حق الكشف وفتشت عنه حق التفتيش عرفت أنها هي المباشرة
لأسباب إهلاكك بمعاصيها وصور طاعتها التي لا تنفك عن رياء أو كبر أو إعجاب
ومما يبين لك كذبها وغدرها أنها تعدك بكثير من الطاعات قبل حدوث
أسباب تلك الطاعات فإذا أحدثت أسبابها أخلفت وعدها وظهر تعزيرها وأبدلت ما
وعدته من الطاعات بمعصية أو معاص عظام وما مثلها في غدرها وغرورها إلا
كمثل رجل وعدك أنه يساعدك عند الضرورة وينصرك عند الغلبة فإذا حدثت
الضرورة والغلبة خذلك وأسلمك للهلكة
ولكذبها وإخلاف وعدها أمثلة
منها أن تعدك بالحلم عند جهل الجاهلين أو أذية المؤذين فإذا جهل عليك جاهل
أو آذاك مؤذ أخلفت وعدها فلم تحلم عنه وارتكبت من سبه وإضراره والسعي في
أذيته ما لا يحل مثله
ومنها أن
تعدك بالإخلاص في جميع الأفعال وأن لا تفعلها إلا لله وحده فإذا سنحت
العبادة ووجدت من ترائيه غدرت بك ونقضت عزمها وراءت بأعمالها وتصنعت
بأحوالها وأقوالها
ومنها أن تعدك بالورع عند حصول أسبابه فإذا حصلت أسبابه لم تتورع وارتكبت
أعظم الشبهات غدرا منها وقلة حياء من ربها
ومن ذلك أن تعدك بالزهد في الأشياء قبل تملكها والقدرة عليها فإذا ملكتها
وقدرت عليها تكالبت عليها واشتدت رغبتك فيها
وكذلك أيضا تعدك بالرضا بالقضاء قبل نزوله فإذا نزل القضاء كرهت ما زعمت
أنها ترضى به وتسخطت بالقضاء ولم تصبر على البلاء ولمثل هذا جاء في الحديث
( وأسألك الرضاء بعد القضاء )
ومن ذلك أن تعدك بالتوكل مع قيام
الأسباب عند انقطاع الأسباب فإذا انقطعت الأسباب رجعت إلى المخلوقين
فخافتهم ورجتهم وكانت قبل ذلك تتوهم أنها متوكلة على الله تعالى وإنما
كانت متوكلة على الأسباب فتظن أنها من الراضين بالقضاء وليست براضية بل
عازمة عليه
وكذلك تظن الإخلاص قبل العمل وليست بمخلصة وإنما هي عازمة على الإخلاص
وكذلك جميع ما ذكرناه من الأحوال قبل حضور أسبابه فإنها عازمة عليه متصفة
به فالتبس عليها العزم بالمعزوم عليه جهلا منها بأوصافها ومتعلقات أوصافها
ولو أنك خوفتها بأنواع التخويف وحثثتها على الطاعة بأنواع الحث
فأجابت إلى الطاعة لصارت إلى المعاصي الخفية كالرياء والكبر والإعجاب وغير
ذلك مما يسنح للعباد دون أهل الغي والفساد وليس غرضها بما تدعوك إليه من
المعاصي الجلية والخفية أن تهلكك وأن تعرضك لعذاب الله تعالى وإنما غرضها
أن تنال شهوتها ولذتها أينما كانت وحيث ما عجلت سفها منها وغفلا وجهلا
بعواقب الأمور بخلاف الشيطان فإنه يأمرك بطاعة هواك ليهلكك ويرديك لا
لتلتذ بنيل هواك وبلوغ مناك
ولو قدر أن يهلكك بما لا لذة فيه لفعل
لفرط عداوته إياك وكيف لا تتحرز من عدو لم ترد خيرا قط إلا نازعتك إلى
خلافه إن لم يكن موافقا لهواها ولا عرض لك شر قط يوافق هواها إلا كانت هي
الداعية إليه والحاثة عليه ولا ضيعت خيرا قط إلا بهواها ولا ركبت مكروها
قط إلا بمحبتها
ومناها فكيف لا تحذر ممن هذا شأنها وقد شهد عليها خالقها بأنها
أمارة بالسوء كما شهد على الشيطان أنه يأمر بالسوء والفحشاء
إن تيقظت لمعادك شغلتك عن ذلك بالفكر في شهواتها وأمر دنياها فإن قهرتها
بعقلك نازعتك أشد المنازعة حتى لا يخلو شيء من صلواتك من فكرها في هواها
وأمر دنياها ولو عاملك بعض أعدائك بما تعاملك به على الدوام لأبغضته ومقته
وقاطعته وهجرته ولكن هذا عدو لا تقدر على مقاطعته ولا على مهاجرته إذ لا
يمكنك مفارقتها ولا يجوز لك قتلها فهي العدو الملازم الذي لا يفارق
وجهادها أعظم من جهاد الكفار لأنك إذا قتلت عدوك الكافر أجرك الله على ذلك
وإن قتلك أعطاك الله تعالى منازل الشهداء ولو قتلتك نفسك أو قتلتها لخسرت
الدنيا والآخرة فشرها قائم وغرورها دائم
فينبغي لك أن تقابل شرها وغرورها بقمع أوصافها وردع أخلاقها حتى تسوقها
إلى الله عز وجل وهي كارهة
فعليك بأخذ حذرك منها متوكلا على ربك لا على حذرك وهي مع هذه الأوصاف
الخسيسة والأخلاق الذميمة إذا وفقك الله تعالى لشيء من الطاعة وابتغاء
مرضاته على خلاف غرضها نسبت ذلك إلى نفسها ونسيت
منة خالقها وإن نبهك الله سبحانه على خير نسبت ذلك إلى نفسها
وأدلت به على ربها مع أنه لم ينبهك للخير سواه
فإياك إياك أن تنسب الخير إلى من لم تعرفه إلا بالشر وانسب ذلك إلى ربك
الذي وفقك لذلك ونبهك عليه { وما بكم من نعمة فمن الله } واعتمد في ذلك
كله على لطف الله تعالى وحسن توفيقه فما التوفيق إلا من عند الله وما
التحقيق إلا من رفده
فائدة في أخذ الحذر من العجب
واعلم أنك إذا استقمت وقمعت نفسك استعظمت أفعالك فأعجبت بذلك فألقتك في مهالك العجب الذي أهلك كثيرا من العالمين
والعابدين والزاهدين
لأن من أعجب بعمله لم ير لنفسه ذنبا فيتوب منه ولم ير لنفسه تقصيرا فيقلع
عنه وقد جاءت الشريعة بذم الإعجاب لأدائه إلى ما ذكرته
فالعجب معم لأكثر الذنوب والعيوب موجب لاستعظام الطاعات والإدلال بها على
رب السماوات مفض إلى العزة والكبر والتعظيم على العباد حتى يصير المعجب
كأن له منة على الله تعالى لاستعظامه أعماله وكذلك يمن على عباد الله بما
يسديه إليهم من معروفه وإحسانه في زعمه فما أجدره بأن يحبط الله عمله
بإعجابه ويكله ربه على نفسه
واعلم أن سبب العجب استعظام واستكثار لما فيك من خير وعلم وعمل بزعمك
فأما العلم فمعرفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة
ويقع الإعجاب أيضا بالرأي الصواب وهو القياس الصحيح
ويقع أيضا بالرأي الخطأ وهو القياس الفاسد والاستدلال الباطل وهو خطأ من
وجوه
أحدها زيغه عن الحق
الثاني فرحه بالباطل
الثالث إعجابه بما لا يجوز إعجابه به والعجب فرحة في النفس بإضافة العمل
إليها وحمدها عليه مع نسيان أن الله تعالى هو المنعم به والمتفضل بالتوفيق
لها
ومن فرح بذلك بكونه منة من الله تعالى واستعظمه لما يرجو عليه
من ثواب الله عز وجل ولم يضف ذلك إلى نفسه ولم يحمدها عليه فليس بمعجب
وكذلك إذا علمت أن كل نعمة من الله ثم استعظمت شيئا من أعمالك ناسيا غافلا
عن كونه من الله تعالى ومن نفسك غير حامد لنفسك عليه فلست بمعجب ولو
استحضرت كونها من الله تعالى كان ذلك أفضل
فالفرح بنسبة النعم إلى
الله تعالى مأمور به في كتاب الله في قوله تعالى { قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا } وإنما الشر والإعجاب في نسبة تلك النعم إلى النفس ونسيان
كونها من الله تعالى وما أجدر من فعل ذلك أن يكله الله عز وجل إلى نفسه
كما فعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يوم حنين إذ أعجبتهم
كثرتهم فنسبوا
النصر إلى الكثرة ونسوا نسبته إلى الله تعالى { علوا كبيرا }
فخذلوا فهزموا مع أنهم خير خلق الله
وقد يؤدي العجب إلى الإدلال على الله تعالى
والإدلال أن يرى العبد أن له عند الله سبحانه وتعالى قدرا عظيما قد استحقه
واستحق الثواب عليه مع الأمن من عقاب الله تعالى وليس رجاء المغفرة مع
الخوف إدلالا
واللإدلال علامات
منها أن يناجي ربه بإدلاله بعمله
ومنها أن يستنكر أن ينزل به بلاء
ومنها أن يستنكر أن ينصر عليه غيره أو ترد دعوته مع كونه عامل بالعمل الذي
استعظمه حتى حمله العجب والإدلال فما أجهل المدل على الله تعالى بعمله كيف
يدل على ربه بإنعامه عليه وإحسانه إليه والشكر على النعم من جملة النعم
والله تعالى يقول { ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا
} وقد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ( ما منكم من أحد
ينجيه عمله ) قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ( ولا أنا إلا أن يتغمدني
الله منه برحمة وفضل )
فائدة في أن الإعجاب لا يقع إلا بصفة كمال
لا يقع العجب إلا بصفة كمال أو ما يعتقد انه صفة كمالفمن أخطأ في اعتقاده أو في مسألة من مسائل الفروع فإنما أتاه الإعجاب من جهة أنه ظن أنه على الصواب فأعجب بصوابه إذ لا يصح الإعجاب إلا بما يعلم أو يظن أنه من باب الخيور وما فرح هؤلاء بخطئهم إلا باعتقادهم أنهم أصابوا
وقد ذم الله تبارك وتعالى فرحهم في كتابه في قوله تعالى { فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون }
فصل فيما ينفي الإعجاب بالعلم والعمل والرأي الصواب
وينفى ذلك باستحضار أن الذي وفقك للعمل إنما هو الله عز وجل وأن النفس لا صنع لها في ذلك وأنك إنما فعلته على كراهة منها وأن من الخطأ أن تنسب الخير إلى من لم تعرفه إلا بالشر وأن تقطعه عن من له الأمر كله وأن النعم كلها منهفإذا لاحظت ذلك وداومت عليه ارتفع عنك العجب
فإن غفلت عن ذلك فعادت إلى الإعجاب ونسيت منة الله رب الأرباب فعاودها
بالدواء الذي ذكرته كلما عادت
فصل فيما ينفي الإعجاب بالرأي الخطأ
ليس الخطأ نعمة حتى يقع الإعجاب بها وإنما هي بلية من الله عز وجل يتوهم المخطئ أنها نعمة من الله تعالى فيعجب بهاوطريقه في نفي الإعجاب به أن يعلم أنه من جملة بني آدم وأن بني آدم قد أخطؤوا وضلوا في كثير من الفروع والأصول وأعجبوا بخطئهم ظنا منهم أنه صواب وهو بشر مثلهم يجوز عليه ما جاز عليهم ومآخذ الحق والصواب
موجودة في السنة والكتاب فمن ذلك ما هو محكم ظاهر لا يقع فيه خطأ
ومنه ما
هو متشابه قابل للخطأ والصواب فيجب عليه أن يتوقف فيه وأن لا يجزم فيه
برأي حتى يقف على دليل شرعي يعتمد على مثله
فإن لم يقف على دليل
يرشده إلى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك
المتشابه فليسأل العلماء عن ذلك فإن وقفوه على ما يجوز الاعتماد عليه أصغى
إليه واعتمد عليه وإن لم يقفوه على ذلك آمن بالمتشابه ولم يتأوله حتى يقف
على دليل شرعي موجب للتأويل وعلى العامة الإيمان بالمتشابه ورد معناه إلى
العلماء
وقد يقع الإعجاب بما يستقبل من الأعمال بناء على عزمه وحزمه
وما جربه من نفسه ناسيا لمنة ربه ومضيفا له إلى نفسه الأمارة
بالسوء
فصل فيما يقع به الإعجاب من الأسباب الدنيوية غير الأسباب الدينية
ويقع الإعجاب بأسباب أخر غير العلم والدينفمن ذلك إعجاب المرء بحسن صوته ناسيا لإنعام الله تعالى عليه بذلك
وقد يحمله حسن الصوت على الفجور والافتخار به على غيره وينفي ذلك
بنظره في
بدء خلقه وأنه خلق من نطفة قدره وفيما ينقلب إليه من الأقذار وبما يصير
إليه في آخر أمره من سيلان صديده وتبديل صورته ونتنه وتغير ريحه وفي
تضييعه ما وجب عليه من شكر ربه وفيما يتعرض له بترك الشكر من سخط الله عز
وجل ودخول النار المغيرة لشكله وحسن صورته
ومن ذلك الإعجاب بالقوة
باستعظامها والاعتماد عليها ونسيان شكرها مع ترك الاتكال على خالقها كما
قالت عاد من أشد منا قوة وكما أدل سليمان عليه السلام بقوته فقال لأطوفن
الليلة على سبعين امرأة
ولم يقل إن شاء الله
وينفي العجب بذلك
بأن يعلم أنها نعمة من الله تعالى ابتلاه بها هل يستعملها في طاعته أم في
معصيته وإن الله عز وجل قادر على أن يسلبها منه فيصبح من اضعف خلق الله
ومن ذلك العجب بالعقل والذهن والفطنة باستعظام ذلك واستحسانه ونسيان نعم
الله تعالى به والاتكال عليه أن يدرك به من أمور دينه ودنياه ما لا يصل
إليه غيره ناسيا لإنعام الله تعالى به عليه للتوكل على الله
عز وجل في ذلك كله وقد يحمله ذلك على الجدال بالباطل ورد الحق
على أهله واستصغار علم العلماء بالإضافة إلى علمه
وقد يستصغر ما علموه من البر والخير مع تضييعه العمل بذلك اجتراء منه
بفهمه وفطنته وينفي العجب بذلك بأن يعلم بان الله عز وجل هو المنعم عليه
بذلك نعمة من الله ابتلاه بها لتكون حجة عليه آكد منها على غيره وأنه لا
يأمن أن يسلبه الله تعالى ذلك كما فعل بغيره وكيف ينفعه عقله وجودة ذهنه
إذا كان غيره أطوع لله تعالى منه فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا
أفئدتهم من شيء
ومن ذلك العجب بالحسب وهو أن يتعظم بانتسابه إلى من
عظم الله قدره في الدين والعلم والرسالة والنبوة ناسيا لإنعام الله تعالى
به عليه ومحتقرا لعباد الله ومعتقدا أن له الحق عليهم
وقد يعتقد أحدهم أن ينجو بغير عمل وقد يفتخر على الناس بذلك مع عصيانه
وفجوره
وينفي العجب بذلك بأن يعده من إنعام الله تعالى عليه وإحسانه إليه وأن
الأحساب لا تجلب شيئا من الثواب ولا تدفع شيئا من
العقاب وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأن رسول الله صلى الله
عليه وسلم
قال لابنته فاطمة وعمته صفية رضي الله عنهما ( لا أغني عنكما من الله شيئا
) وأن الأحساب ليست من أسباب الثواب
وليعلم أن أسلافه الذين يفتخر
بهم إنما شرفوا بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته وقد كان أبو طالب وأبو
لهب من اقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغن ذلك عنهما من
الله شيئا ولا يغتر بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة
لبني عبد المطلب فإن الله عز وجل لا يشفع في أحد من ذوي الأحساب ولا من
غيرهم إلا لمن ارتضى منهم فهو وغيره مما لا حسب له في ذلك سواء
وقد
يبلغ الحمق بأحدهم بأن يعجب بالانتماء إلى جماعة من أكابر مشركي العرب
وينفي الإعجاب بذلك بأن يعلم أن الذين افتخر بهم عند الله عز وجل وعند
عباده المؤمنين شر من الكلاب مع التخليد في العذاب ولو تصاغرت به نفسه إلى
الانتماء إلى هؤلاء لكان أولى به
وأحمق من هؤلاء من يعجب بالانتماء
إلى الملوك المشركين من غير العرب استعظاما لقدره ونسيانا إلى ما صاروا
إليه من السخط والعذاب وينفي الإعجاب بذلك بأن يعلم أن
ما كانوا فيه من السعة والسطوة وبال عليهم من الله عز وجل فإذا
لاحظ ذلك وعلم هوانهم عند الله انتفى إعجابه بذلك
ومنهم من يعجب بكثرة العدد والأولاد والمماليك والموالي والعشائر والأصحاب
متكلا عليهم ناسيا للتوكل على رب الأرباب وقد يحمله ذلك على أن يسطو بمن
خالفه ويبطش بمن آسفة اعتمادا على كثرة عدده ومدده
وينفي العجب بذلك
بأن يعلم أن النصر من عند الله وان الكثرة لا تغني شيئا كما لم تغن كثرة
الصحابة عنهم يوم حنين شيئا مع أنهم خير عصابة على وجه الأرض وبأن يعلم أن
ولده وعشيرته وخوله وإن كثروا لن يغنوا عنه شيئا إذا حضر الموت وأفرد في
قبره ويوم يبعث منفردا وكل منهم مشغول عنه بنفسه { يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه } وبأن يعلم أن
كثرة ما ذكرناه من النعم الموجبة للشكر وأن من شكرها أن لا يعتمد عليها
ولا يستند إليها
ومنهم من يعجب بكثرة الأموال فيفتخر بها على
الفقراء ويحتقرهم بسبب فقرهم وخصاصتهم وينفي عجبه بذلك بأن يعلم أن
الأموال فتنة ومحنة ابتلي بها العباد { إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى }
وأن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة وأن الله عز وجل قد عافى الفقراء من التعرض لهذه الفتنة وخلصهم من هذه المحنة وأن غنى قارون كان سببا لإهلاكه
فصل في الكبر
الكبر أن يتعظم على غيره أنفة منه واحتقارا لهوله أسباب من جملتها العجب وهو أكبرها وكذلك يطلق الكبر على العجب لأنه سبب عنه ولا يتكبر إلا من جهل قدره وعظمة ربه
وقد تهدد الله تعالى المتكبرين في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لأن العظمة و الكبرياء لا يليقان إلا برب الأرباب
وقد تسمى أخلاق الكبر كبرا أيضا لكونها مسببة عنه
والكبر أقسام أحدها الكبر عن بعض طاعة الله تعالى
الثاني الكبر عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثالث الكبر على العباد أن يرى أنه خير منهم فينظر إليهم بعين الازدراء
والأنفة والحقرية وأن لا يقبل منهم الحق لعلمه أنه حق فمن أمره بخير تكبر
عن قبوله منه مع علمه أنه صواب كما تكبرت اليهود عن متابعة رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكما تكبر إبليس على آدم
مع علمه بأن الله تعالى فضله عليه
وقد يحمل التكبر على المخلوق على
التكبر على الخالق كما فعل إبليس إذ حمله التكبر على آدم على التكبر عن
السجود فمن رأى أنه خير من أخيه حقرية له وازدراء به أو رد الحق وهو يعرفه
فقد تكبر على العباد
ومن تعظم وأنف عن الذل والخضوع لطاعة الله تعالى فقد تكبر على الله تعالى
فأصل الكبر التعظيم وحقيقته الأنفة والازدراء ورد الحق مع العلم به
فصل في الكبر المسبب عن العجب بالعلم
من أعجب بعلمه تكبر على من هو دونه في العلم وعلى العامة وينتهر من يعلمه وإن وعظ عنف وإن وعظ أنف وإن أمر بالحق لم يقبله وإن ناظر ازدرأ بمناظريه وينقبض عن الناس ليبدؤوا بالسلام ويسخرهم في أغراضه ويغضب على من لم يقم بحوائجهفمن المتكبرين من يجمع بين هذه الخلال القبيحة لفرط غفلته عن الله عز وجل
ومنهم من يعامل الناس ببعض ذلك
والعلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتغيره الأشجار إلى طباعها فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة وكذلك العلم إذا حصله المتكبرون ازدادوا كبرا إلى كبرهم وإذا ناله المتواضعون ازدادوا تواضعا إلى تواضعهم
فصل في الكبر المسبب عن العجب بالعمل
من تكبر إعجابا بعمله احتقر من لا يعمل مثل عمله فإن كان أجهل منه قال مضيع جاهل وإن كان أعلم منه قال الحجة عليه أعظم منها علي فينظر إلى الناس بعين الاحتقار والازدراء منقبضا عنهم ليبدؤه بالسلام ولا يبدؤهم ويزوروه ولا يزورهم ويعودوه ولا يعودهم ويخدموه ولا يخدمهم وإن بدأ أحدا منهم بالسلام أو زاره أو عاده رأى أنه قد تفضل عليه وأحسن إليه وأن مثلهم لا يستحق ذلك منه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لهم ويخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه آمنا من عذاب الله تعالى وهم يتواضعون له ويوقرونه ويقومون بحقوقه الواجبة والمندوبة تقربا إلى الله عز وجل وهو يعاملهم بما ذكرناه من الأوصاف معصية لله فيهم فهم عند الله تعالى خير منهفصل في الكبر المسبب عن الرياء
من تكبر على الرياء حمله ذلك على أن يرد الحق على من أمره به أو ناظره فيه وإن كان أفضل منه وأعلم كي لا يقال غلب فلان فلاناأو خطاه أو قهره فيخرجه ذلك إلى الأنفة من قبول الحق والاعتراف به وقد يوجب الحقد تكبرا موجبا لرد الحق مع العلم به كما ذكرناه من الكبر المسبب عن العجب
فائدة في أن الإعجاب والكبر في الغالب لا يكون إلا بنعم دينية أو دنيوية
لا يكون الإعجاب والكبر في الغالب إلا بنعم دينية أو دنيوية ونعم الدين أعظم من نعم الدنيا وقل أن يخلو عارف أو عابد أو عالم عن نوع من الكبر ولكن قد يخلو القوي عن آثار الكبر فإن تكبر بقلبه لم يحمله ذلك على رد الحق ولا على شيء مما ذكرناه من أفعال الجوارح المذمومةوقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه ترك إمامة قومه لأن نفسه حدثته أنه أفضلهم
واستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمام قوم في أن يدعو بدعوات بعد الصلوات فمنعه من ذلك خوفا عليه من الكبر وقال أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا
فصل في التكبر بالأسباب الدنيوية
وهي ضروبأحدها التكبر بالأحساب الموجبة احتقار الناس واجتنابهم والافتخار عليهم مثل أن يقول أنا فلان بن فلان فمن أبوك ومثلك يقاوم مثلي أو يخاطبه وقد يقع ذلك لبعض الصالحين في بعض الأحايين في أوقات الغفلات ولكن لا يخرجهم ذلك إلى جميع ما ذكرناه
الثاني التكبر بالقوي وحسن الصور ويخرج إلى الافتخار بذلك على من هو دونه وإلى حقريته واجتنابه
الثالث التكبر بالأموال والأولاد وكثرة العشائر والأنصار يخرج إلى الافتخار والاحتقار لمن ليس كذلك
فصل فيما ينفى به الكبر
ينفى الكبر بأن يعلم الإنسان أن الله عز وجل خلق أباه من التراب ثم من حمأ مسنون أي طين منتن ثم جعل نسله من نطفة قدره في مكان قذر فأوجده بعد العدم وأسمعه بعد الصمم وأنطقه بعد البكم وخلق له العقل الذي يعرف به أوصافه ثم أخرجه من بطن أمه ضعيفا عاجزا جاهلا ثم رباه إلى أن أدركه أجله وهو فيما بين ذلك ملابس الأقذار كالبول والغائط والمخاط والبزاق لا ينفك عن ذلك ولا يتخلص منه يريد أن يذكر فينسى وأن يعلم فيجهل وأن يصح فيسقم وأن يقدر فيعجز وأن يستغني فيفتقر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا خفضا ولا رفعا وهو مع ذلك كثير الكبر على العباد والجرأة على رب الأرباب لا يشكر إحسانه إليه ولا يذكر إنعامه عليه ولا يستحي من وقوفه غدا بين يديه عريان حافيا حاسرا فيسأله عن أعماله كلها دقها وجلها فيا خجلته بين يديه من عرض أعماله القبيحة عليه بل لو ذكر انفراده في القبر عن الأموال والأولاد والحشم والأحفاد وقد صار جيفة قذرة منتنة لكان ذلك مانعا له من الكبر الذي لا يليق إلا بمن لا يزول ولا يحول وليس كمثله شيء وهو السميع البصير
فسبحان من العظمة إزاره والكبرياء رداؤه فمن نازعه من ذلك كان جديرا
بالعذاب وسوء المآب
وعلى المرء إذا خاف الإعجاب أن يتفقد نفسه فإن خطرت له خطرة للكبر فطريقه
في ذلك أن يردعها عن ذلك بما ذكرناه فإن أبت نفسه زجرها بوعيد الله
وتهديده
وإن تكبر في مناظرة أو في سؤال من دونه فليردعها عن ذلك حتى
تقبل الحق ممن هو دونها وتعترف لمن يناظرها بالحق والصواب وكذلك يردعها عن
الامتناع من الكسب الدنيء إذا كان حلالا وعن الأنفة من حمل سلعتها وكذلك
يزجرها عن إجابة الداعي وإن كان عبدا أو فقيرا وكذلك عيادة الضعفاء
والفقراء وإن كان أرفع منهم في حسبه ونسبه وكذلك لا يأنف من الانتساب إلى
أصله وإن كان دنيا وكذلك لا يأنف من لبس الخشن من الثياب وأكل الخشن من
الطعام ومن جميع ما يأنف منه الجبارون والمتكبرون
وإذا شك في نفسه هل تواضعت أم لا فليمتحنها بهذه الأسباب فإن أنفت منها
واستكبرت عنها فهو باق على كبره متوهم أنه صار من أهل التواضع وقد جرب عبد
الله بن سلام رضي الله عنه نفسه في ذلك بأن حمل حزمة حطب مع كثرة غلمانه
وأتباعه تجربة لنفسه
وقد يحمله الكبر على أن يتصنع بما ليس عنده من
العلم والعمل والحسب الشريف ونزاهة النفس وسلامة العرض وكذلك يحمله على
ترك الاختلاف إلى العلماء إظهارا منه أنه مثلهم أو أفضل منهم وأن يأنف أن
يتقدم عليه غيره في الصلاة كل ذلك تكبرا أو خوفا من سقوط منزلته عند الناس
وربما أوهمته نفسه أنه يترك السؤال وغيره حياء من الناس وهو متكبر
غير مستح يخيل إليه أن كبره استحياء إليه ليروج عليه الكبر ويدفع ذلك كله
بما ذكر أول الفصل
فصل في ترك الكبر على الفساق والتباس الكبر بالبغض لله سبحانه والغضب لله سبحانه وتعالى
الناس بالنسبة إليك أقسامأحدها من لا تعرفه ولا تعرف أنك فضلت عليه
الثاني من تعرفه بذنوب أقل من ذنوبك فلا يمكنك أن تتكبر على هذا ولا على القسم الأول
الثالث من عرفت أن ذنوبه أكثر من ذنوبك وعيوبه أكبر من عيوبك مع أنك من عيوبك على يقين ومن عيوبه على ظن
فإن كنت تخاف على نفسك من العقوبة أكثر مما تخاف عليه فلست بمتكبر عليه وإن خفت عليه أكثر مما تخاف على نفسك فأنت متكبر عليه فإن سبب الخوف العصيان
فلو كان خوفك لأجل معصيته مع قلتها لكان خوفك على نفسك مع كثرة معاصيك أكثر وإن كانت معاصيه أكثر من معاصيك فالطريق في ترك الكبر عليه بأن تعرف نعمة الله عليك بعصمته إياك من مثل عمله وأن تغضب عليه وتجانبه غضب الله تعالى مع خوفك على نفسك بحيث لا ترى أنك ناج وهو هالك إذ لا تدري بما يختم له وبما يختم لك
وأنك أمرت بالخوف على نفسك دون الخوف عليه إلا من طريق الإشفاق مع ملازمتك الخوف من سوء الخاتمة ومما اقترن بأعمالك الصالحة من المفسدات كالرياء والعجب وغيرهما
فكم من عاص ختم الله أعماله بأحسن الأعمال وكم
من مطيع ختم الله أعماله بسيء الأعمال { لا يسخر قوم من قوم عسى
أن يكونوا خيرا منهم }
وكذلك أهل البدع المضلون للناس يجب عليك أن تبغضهم في الله وأن لا تنكر
عليهم بحيث تظن أنك عند الله خير منهم فإن الأعمال بالخواتيم ولا تدري
بماذا يختم لك من الأعمال وبماذا يختم لهم
وكذلك الكفار تبغضهم في
الله وتعاديهم فيه ولا تتكبر عليهم بناء على أن عاقبتك عند الله خير من
عاقبتهم إذ لا تدري نفس ماذا تكسب غدا
ولا يدري أحد بما ذا تختم أعماله فقد ارتد جماعة من الصحابة وماتوا على
الردة
وكم من كافر احتقره المؤمنون وكان عند الله خيرا منهم
ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه عن إسلام جماعة من
الصحابة رضي الله عنهم ولعلهم كانوا ينظرون إليه قبل إسلامه بعين الإزراء
ولا يدرون أنه عند الله تعالى أفضل منهم
وليس من الكبر أن يعرف الإنسان ما فضله الله تعالى به على غيره وإنما
الكبر أن يحتقره وينكر عليه أنه عند الله في الآخرة خير منه مع جهله بما
يؤول إليه أمرهما
فصل في الحسد والتنافس
التنافس عبارة عن طلب الأنفس وهو مأمور به في الدين لقوله تعالى { وفي ذلك فليتنافس المتنافسون } والحسد تمن وهو من أعمال القلوب وله آثار من الأقوال والأعمالوالتمني ضربان أحدهما أن يتمنى مثل ما لغيره من الفضل والخير في الدين أو الدنيا ويعبر عنه بالغبطة
والثاني أن يتمنى زوال ما لغيره من فضل في دين أو دنيا فهذا منهي عنه لقوله تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض } وأمر بالغبطة في قوله تعالى { واسألوا الله من فضله } والحسد المذموم ضربان شرهما أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود وإن لم تصل إليه
والثاني أن يتمنى زوالها عن المحسود إليه
وقد أجمع العلماء على تحريم هذين الضربين وورد بذلك الكتاب والسنة في غير
ما موضع
وشر الحسد الحسد على معاصي الله عز وجل وهو أن يتمنى أن يتمكن من المعاصي
التي يفعلها غيره
وليس من الحسد أن لا ينال غيره خيرا من خيور الدنيا والآخرة لأن الحسد
مخصوص بما حصل من النعم
وينشأ التحاسد في الدين عن فرط المحبة لطاعة الله تعالى وفي الدنيا عن فرط
المحبة للدنيا وقد يكون مسببا عن الكبر وعن العجب وعن الرياسة وحب المنزلة
والرياء وقد يكون مسببا عن العداوة والبغضاء وهو أشدها فإنه قد يحث على
السعي في إهلاك النفوس والأموال
ولا يتصور الحسد لمحبوب لأن المحب يتمنى زيادة النعم للمحبوب ولا يتمنى
زوال النعم عنه
وقد يقع التحاسد على تفضيل دنيوي كإيثار الأب أحد ابنيه والزوج لإحدى
زوجتيه
وقد يقع التحاسد بين أرباب الصنائع والمتعلقين بالأمراء والملوك
وقد يقع التحاسد بسبب الإعجاب بالفضائل في الأنساب وكذلك التماثل في
الأنساب كالأخوة وبني الأعمام بحسد بعضهم بعضا وكذلك يحسد العباد العباد
والعلماء العلماء
والغالب أن الحسد لا يقع إلا بين المشتركين في
فضيلة من الفضائل أو في شيء من الأسباب الدنيوية فلا يحسد الفقيه النحوي
ولا التاجر الجمال ولا الصانع البقال
ومن أسباب الحسد التجاوز ولذلك أمر عمر رضي الله تعالى عنه الأقارب أن
يتزاوروا ولا يتجاوروا
وقال كعب رضي الله عنه ما من حكيم في قوم إلا حسدوه وكثروا عليه
وشر أنواع الحسد تمني زوال النعم عن عباد الله عز وجل وإن لم تصل إلى
الحاسد
ويزال هذا النوع بأن تعلم أنك لم تحب لأخيك المسلم ما أحببت لنفسك وأنك
شاركت الشيطان في عداوة أخيك المسلم وسخطت لما أعطى الله عباده من غير أن
يحصل لك بذلك نفع أو غرض صحيح
وما الحاسدون إلا كما قال الله تعالى { وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
}
ومثل الحاسد مع المحسود كمثل رجل رمى إنسانا بحجر ليقتله أو يفقأ عينه
فرجع الحجر عليه فقتله أو فقأ عينه بل حال الحسد أشد لأنه يتعرض بحسده
لغضب الله تعالى وسخطه عليه
فائدة في مدافعة خطرة الحسد
لم يكلف الله تعالى العباد أن يخرجوا عن مقتضى طباعهم في الحسد ولا في شيء من الشهوات وإنما عليك إذا خطرت لك خطرة الحسد ودعاك الشيطان إليه أن تكره ذلك أشد الكراهة لما يؤدي إليه من السعي في مضارة المحسود وكذلك كراهة جميع الشهوات تكرهها إذا نازعتك نفسك وعدوك إليهافائدة أخرى في آثار الحسد
للحسد آثار قبيحة وهي السعي في أذية المحسود بالأقوال والأفعال وإزالة النعمة عنه فمن حسد وترك آثار الحسد فله حالان
أحدهما أن يكره الحسد ولا يريد ضرر المحسود فليس هذا بحاسد
الثاني أن لا يكره الحسد فقد قال بعض الناس لا إثم عليه إذ لا حسد على
الحقيقة إلا السعي في أذية المحسود وهذا لا يصح لأن الحسد من أفعال القلوب
وقد يتجوز به عن آثاره فتسمى حسدا وإنما نهى عن الحسد لكونه إذا تمكن من
القلب حمل على المعاملة بآثاره فيكون تحريمه من باب تحريم
الوسائل
فائدة في إثم الحسد وآثاره
الحسد بالقلب ذنب بين الحاسد وبين الرب تعالى لا تقف صحة التوبة عنه على تحليل المحسود وإبرائه بخلاف آثار الحسد فإنها أذية للمحسود فلا تصح التوبة عنها إلا بالخروج عن عهدتها لأن الضرر ليس بمجرد الحسد وإنما هو بتعاطي آثارهفصل في النهي عن الغرة
الغرة اعتماد القلب على ما لا ينبغي أن يعتمد عليه كاعتماد العالم علىعلمه والحليم على حلمه والزاهد على زهادته والعابد على عبادته
والعارف على
معرفته والعصاة على إمهال الله تعالى إياهم والأغنياء على غناهم وهذا شرك
فإن الاعتماد ليس إلا على رحمة الله عز وجل إذ لا ينجي أحدا عمله إلا أن
يتغمده الله برحمة منه وفضل وقد يلتبس على العامة الرجاء بالغرة فيجترئ
على المعاصي اغترارا بسعة الرحمة وكثرة النعمة وجهلا بالفرق بين الغرور
والرجاء فإن الرجاء إنما يتحقق عند أسباب الفلاح وطرق النجاح
فمن بذر بذرا في أرض طيبة وتعهد بذره تعهد مثله كان راجيا لاستغلاله
ومن بذر بذرا في أرض خبيثة أو في أرض طيبة ولم يتعهده تعهده مثله ثم قال
أنا راج لاستغلاله قيل له بل أنت مغرور لأن الرجاء إنما يتحقق عند القيام
بأسباب المرجو
ومدار الغرور كله على الجهل فما اغتر الكفار بعبادتهم
إلا جهلا منهم بحبوطها وما اغتر المبتدعة ببدعهم إلا جهلا منهم ببطلانها
وما اغتر الأغنياء بغناهم إلا جهلا منهم بأنه فتنة ومحنة وظنا منهم أنه
كرامة ونعمة
وكذلك اغترار العابد
بعبادته والزاهد بزهادته والعارف بمعرفته وربما أقدم هؤلاء على معصية ربهم
ظنا منهم أن الله عز وجل لا يؤاخذهم بقربهم إليه وكرامتهم عليه
والرجاء ضربان أحدهما ما يخرج عن القنوط من رحمة الله تعالى كرجاء العصاة
للتوبة
والثاني رجاء ارتفاع الدرجات وكثرة المثوبات والكرامات وهذا لا يصح إلا من
العاملين المقبلين على إرضاء رب العالمين قال الله تعالى { الذين آمنوا
والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله } وقال في
الرجاء القاطع للقنوط { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله }
فائدة في تخويف النفس من خطرة المعصية
إذا خطرت خطرة بمعصية فليخوف النفس من القصد إليها والعزم عليها فإن قصدتها فليخوف النفس من الإقدام عليها فإن غلبته وأقدمت عليها فليخوفها من الإصرار عليها وليأمرها بالتوبة منها فإن حدثه الشيطان بأن توبته لا تقبل وأن توبته لا تغفر فليرجها سعة رحمة الله تعالى وليذكرها أنه يغفر الذنوب جميعا ولا يباليفإن أصرت على الذنب قنوطا من رحمة الله فليذكرها أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الظالمون
ويعرفها أن القنوط من رحمة
الله سبب الانهماك في المعاصي والمخالفات وكذلك متى ما رأى كثرة غرتها بالله تعالى فليجتهد في تخويفها من غضب الله تعالى وعقابه وأليم عذابه فيكون بذلك واضعا للخوف في مواضعه وللرجاء في مظانه
فصل في الغرة بأنواع دينه
وهي أنواع أحدها كثرة الروايات والتبحر في علم الحديث يغتر به من قام به معتقدا أنه ينجيه ناسيا الاعتماد على ربه مقصرا في طاعته محتقرا لعباد الله عز وجل عاملا بمعصية الله تعالى لا يرى أن أحدا يكافيه وربما ارتكب بعضهم الكبائر معتقدا ان مثله لا يؤاخذ بذلك وتنفى الغرة بذلك بأن يعلم أن علمه حجة لله عز وجل عليه وأنه إذا لم يعمل بالعلم كان وبالا عليهوقد جاء في الحديث ( إن أول من يدخل النار العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فيقولون أي ربنا بدئ بنا قبل عبدة الأوثان فيقال لهم ليس من علم كمن لم يعلم )
وينبغي أن يواظب على هذه الملاحظة إلى أن تزول غرته ويعتمد على
رحمة ربه ناظرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( لن ينجي أحدكم
عمله ) فإذا
كان العمل الذي هو المقصود لا ينجي فما الظن بالوسيلة التي هي العلم
النوع الثاني في الاغترار بالفقه والتبحر في معرفة الحلال والحرام وسائر
الأحكام والتأهل للقضاء والفتيا فغرة هذا أشد من غرة من تفرد بالرواية لأن
هذا يعتقد أن به قوام الدين لمعرفته بالشرع ويعتقد أنه هو الطبيب وأن
الراوي هو الصيدلاني فيعميه ذلك حتى يخفى عليه أكثر ذنوبه وعيوبه وإن عرف
ذنوبه وعيوبه اعتمد على علمه وقال مثلي لا يؤاخذ بذلك وينفي الغرة بذلك
بأن يعلم أن المعرفة بجلال الله تعالى وكماله وسعة رحمته وشدة نقمته
وبمعرفة أحكام القلوب وأعمالها أفضل من علمه الذي وصل إليه واعتمد عليه
وقد قال الله تعالى { إنما يخشى الله من عباده العلماء }
قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يخشاني من عبادي من علم عزتي وملكوتي
وسلطاني
وكذلك يكثر ذكر المعاد وما أعد الله تعالى فيه من الحساب والمناقشة على
الأعمال والثواب والعقاب
النوع الثالث الاغترار بمعرفة الأحوال والآداب وأخلاق النفوس الذميمة
والحميدة وكيفية السعي في إبطالها وتقلبها وكذلك معرفة التعظيم والإجلال
والترك والإهمال والخوف وأسبابه والرجاء وموجباته والمحبة والمهابة
والتوبة وأركانها وشرائطها والزهد والرغبة ورتب المجهود فيه والمرغوب فيه
والتوكل على الله تعالى والرياء والإخلاص ويبالغ في حسن التعبير عن ذلك
كله ويظن بجهله أنه متصف بهذه الأوصاف توهما منه أن حسن العبارة عنها تدل
على تحقيقها فيعتقد أنه راج وهو مغرور ويعتقد أنه خائف وهو متوهم ويعتقد
أنه متوكل على الله تعالى وهو متوكل على الأسباب ويعتقد أنه مقبل على الله
وهو معرض عنه ويعتقد أنه محب مع خلوه من آثار الحب ويعتقد أنه مشمر وهو
متهاون إلى غير ذلك مما يوهمه الشيطان أنه من أهله وليس من أهله
وإنما يعرف هذا غلطه بأن يجرب نفسه فيما يدعيه من الأوصاف فإن ادعت عليه
الخوف جربها عند همه بمعصيته لله تعالى فإن أقدم على ما هم به فليس بخائف
ثم ينظر في قطع الإصرار عن ذنبه والتوبة منه فإن لم تسمح نفسه بالتوبة علم
أنه غير خائف لأن أول رتب الخوف الخوف من الذنوب فكيف يدعي الخوف من ليس
في رتب أدنى الخائفين
وكذلك
توهمه نفسه الزهد في الدنيا ما دام فاقدا لها فإذا سنحت له الدنيا أخلد
إليها وأقبل عليها فيعلم بذلك أن زهده كان من أماني نفسه وكذلك يعتبر
المحبة لله تعالى بآثارها من الأنس والمبادرة إلى الطاعة وتجنب أسباب
السخط والالتذاذ بذكره وحلاوة مناجاته وكثرة اللهج بذكره فإذا لم يكن عنده
ذلك علم أن نفسه قد كذبته
وكذلك يعرف أنه متوكل على الأسباب دون رب
الأرباب بأن يزيل الأسباب فإذا جزعت نفسه لذلك علم أنه كان معتمدا على
الأسباب دون رب الأرباب ومثال ذلك بأن يكون لرزقه أسباب يعتمد عليها كضيعة
أو صنعة أو راتبا أو من يقوم بأمره من ولد ووالد فتسكن نفسه إلى تلك
الأسباب فيتوهم أن سكونه إلى الله عز وجل فإذا أزيلت تلك الأسباب جزعت
نفسه واضطربت وتبين أنها كانت معتمدة على الأسباب دون ربها عز وجل
وكذلك يعتقد أنه من المخلصين في أعماله وأقواله وأحواله فإذا سنحت له
أسباب الرياء لم يملك نفسه حتى يرائي بأقواله وأعماله وأحواله
وكذلك يعتقد البراءة من الكذب والإعجاب والإدلال بالأعمال فإذا وقعت أسباب
ذلك مالت نفسه إليه وغلبته عليه وإنما غلط هذا فيما اعتقده من الأحوال
المذكورة من جهة أن المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر لا يخلو عن أصول هذه
الأحوال فلا ينفك أحد من المؤمنين عن الإخلاص لله تعالى ولو في التوحيد
ولا عن التوكل ولوفي حال الشدائد ولا عن محبة الله تعالى إما لملاحظته
جماله وكماله أو بملاحظته إنعامه وإحسانه وإفضاله
وقد جبلت النفوس على حب من أنعم عليها وأحسن إليها
وكذلك لا تخلو عن الرجاء عند ملاحظة سعة الرحمة ولا عن الخوف عند ملاحظة
شدة النقمة ولا عن التوكل عند ملاحظة توحد الله تعالى بالنفع والضر
فلما كانت أصول الأحوال موجودة فيه توهم أن تلك الأحوال في رتب الكمال
فإذا دعى الناس إلى شيء من ذلك فإن أوهمهم أنه متصف بأعلى رتب هذه الأحوال
فقد تصنع بما ليس فيه بلسان الحال إلا أن يقع في أثناء ذلك قول يدل على
ذلك فيكون متصنعا بلسان المقال و ( المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور )
النوع الرابع الاغترار بما يحفظ من كلام القصاص والوعاظ والمذكرين ولا
يفهم معانيه ولا يعرف صحيحه من فاسده فتارة يحدث به العامة وتارة يخص به
أصحابه وهو مغتبط به يظن أنه سبب نجاته ويقتصر في ذلك في طاعة ربه وينتفي
الاغترار بذلك بأن يعرض أعماله على أقواله فإذا وجد نفسه واصفة للزهد وهو
من الراغبين وللخوف وهو من الآمنين وللإخلاص وهو من المرائين وللعفاف وهو
من الفاسقين وللاجتهاد وهو من المقصرين وللإقبال على الله وهو من المعرضين
علم حينئذ أنه من المغترين
النوع الخامس الاغترار بعلم الكلام
والجدل والرد على أهل الأديان وإبطال مذاهبهم والرد على أهل البدع وإبطال
بدعهم ودحض حججهم يعتقد أحدهم أنه لا يعرف الله تعالى سواه وأنه لا يصح
العمل إلا بأحكام ما عرفه وهم مع ذلك حفاة عصاة يظنون علمهم ينجيهم من سخط
ربهم فمنهم من يضيع الصلوات ويتبع الشهوات ولا يقدرون لأحد قدرا ولا
يقيمون له وزنا وتنتفي غرة هؤلاء بأن يعلموا بان الكتاب والسنة مشتملان
على المحكم والمتشابه وأن النظر بالعقل قد يخطئ ويصيب ولا يغره جزمه
بمذهبه فإن خصمه كذلك جازم بمذهبه مضلل غيره { ويحسبون أنهم على شيء ألا
إنهم هم الكاذبون }
والطريق في
استقامة الاقتداء بما اتفق عليه السلف الصالح في أصول الدين وفروعه
فيتابعه فلا يلزمه سوى ذلك ومما ينجع فيه أن الاعتقاد قد يلتبس بالعلم
فيظن المعتقد الجازم بانه عارف عالم وبمثل هذا ضل أكثر المختلفين ويدل على
ذلك أن الإنسان يقطع بالشيء ويجزم به ثم يظهر له بطلان جزمه لاعتقاد
يعتقده أو علم يعلمه فالجزم أن يتمسك بالسنة التي درج الناس عليها وأن لا
يتعداها إلى غيرها لما في ذلك من المخاطرة بالدين ومخالفة سيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين
النوع
السادس الاغترار بالعبادة والزهادة والتقشف والصيام والقيام ودعوى محبة
الله عز وجل حتى يصعق أحدهم عند ذكره ويتغاشى في السماع إيهاما لغلبة الحب
عليه
ومن هؤلاء من يترك الأهم بما ليس كذلك ككسب الحلال وتضييع
العيال والخروج للحج والعمرة بغير زاد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكل من
هؤلاء معتقد أنه قد أقام التقوى على حدودها وحقوقها وأنه قد صار إلى منازل
المتقين الورعين
وطريقه في نفي ذلك أن يعتبر اكتسابه وأقواله
وأعماله وجميع أحواله فإذا بحث عن كسبه وجده حراما أو شبهة فقد تبين له
مجانبة التقوى في مكسبه وإذا حج بغير زاد زاعما أنه متوكل على ربه تعالى
فليعتبر توكله بما ذكرناه عند ارتفاع الأسباب وليعلم أنه مخالف لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في تزودهم في أسفارهم للحج وغيره
وإن
ظهر أن أقواله وأعماله موافقة في ظاهرها للكتاب والسنة فلينظر في إخلاصها
لله عز وجل وليعرضها في نفسه عملا عملا فإذا اطلع على تصنعه وريائه زالت
غرته بأعمال كان يعتقد صحتها وهي باطلة عند الله تعالى بالرياء
وكذلك
يعتبر جميع أعماله الظاهرة والباطنة فإذا اطلع من ذلك على نفسه زالت غرته
وأقبل على إصلاح أعماله وأقواله
النوع السابع الاغترار بالتورع في
المآكل والمشارب والملابس مع ظن فاعل ذلك أنه قد قام بالتقوى في جميع ما
أمر به وهو مضيع لكثير من التقوى في ظاهره وباطنه ظنا منه أن تقشفه في
المطعم والملبس ينجيه وينفي اغتراره بذلك بان يعلم أن التقوى ليست بمحصورة
فيما تورع فيه وأنها متعلقة بالقلوب والأسماع وسائر الأعضاء وأن الله
سبحانه وتعالى توعد من أضاع تقواه بالعذاب الشديد مع طيب مشربه ومطعمه
وملبسه
النوع الثامن الاغترار بالخلوة والعزلة والانقطاع عن الناس
مع الاعتماد عليها والسرور بما ينسبه الناس إليه من الانقطاع إلى الله عز
وجل وينفي الاغترار بذلك بأن ينظر فيما حرمه الله تعالى عليه في ظاهره
وباطنه من
حين كلف وإلى وقته فلا يكاد
أن يسلم في ذلك كله بل لا يسلم في بعضه فكيف يغتر بانقطاعه وعزلته مع
وقوعه في معصية ربه التي قد تحبط أعماله وتسقط آماله
ثم ينظر بعد
ذلك في جميع ما أوجبه الله تعالى عليه فلا يكاد يسلم من تفريطه في واجب أو
واجبات فإن ظهر تفريطه فيها لم يأمن من أن يكون تفريطه سببا لإحباط عمله
وحسناته وفي التنزيل { لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون }
وقد جاء
في الحديث ( إن من ضيع صلاة العصر حبط عمله ) وإن أتى بها على وجهها لم
يأمن الرياء المحبط لها وإن أخلصها لم يأمن التصنع بها فإن لم يتصنع بها
لم يأمن الإعجاب بها والإدلال بها على ربه والتكبر بها على عباد الله
تعالى فإن سلم له ذلك لم يأمن من إحباطه ببعض ذنوبه وفي إحباط العمل
بالعجب نظر
النوع التاسع الاغترار بالغزو والحج وقيام الليل وصوم
النهار مع تضييع أكثر التقوى الظاهرة والباطنة وترك التفقد لأقواله
وأعماله وأحواله ظنا منه أن مثله لا يحتاج إلى التفقد ونسيانا لتضييع
الواجبات وارتكاب المنهيات وتنتفي الغرة بذلك بما ذكرناه في الفصل قبله
واغترار الذي قبله
بالعزلة والانقطاع أقبح من اغترار هذا لأن ذلك اغترار بمندوب ليس
بمفروض
وليست رتبته في المندوبات كرتبة القيام والصيام والحج والغزو ولا يقع إلا
واجبا لأن الصفوف إذا التقت تعين القتال
النوع العاشر الاغترار
برعاية التقوى الظاهرة والباطنة والاهتمام بتقديمها على غيرها من الطاعات
المسنونات والمندوبات مع اعتقاد أحدهم التوحد في عصره وأنه الناجي دون
غيره وهو لو سلمت تقواه له لم يأمن أن يحبط الله تقواه بما يقع منه في
الاستقبال أو أن يعذبه بما تقدم من ذنوبه قبل تقواه
وينتفي الاغترار
بذلك بأن يعرض تقواه على تقوى سلف هذه الأمة وخوفه على خوفهم ووجله على
وجلهم واستشعار نفسه على استشعار أنفسهم فقد كانوا كما وصفهم ربهم بقوله {
والذين يؤتون ما آتوا } من التقوى والطاعة { وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم
راجعون } أي خائفة من رجوعهم إلى جزاء ربهم ولقد انتهى بهم الوجل والخوف
إلى أن تمنى أحدهم أن يكون شجرة تعضد وتمنى بعضهم أن يكون كبشا سمنه أهله
فذبحوه وأكلوه وقد كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أخوفهم
لله تعالى مع أن هذا المغتر بتقواه لا يأمن أن يكون ضيع من التقوى ما يحبط
تقواه
النوع الحادي عشر الاغترار
بالعزم على التقوى وبالعزم على الأفعال الرضية والأحوال السنية كالبصر
والتوكل والرضا والإخلاص وغير ذلك من الأحوال العلية وبالعزم على ترك
الأخلاق الدنية كالغضب والحسد والرياء
ويظن كل من هؤلاء أنه من أهل
ما عزم عليه بمجرد عزمه فإذا سنحت له الأسباب المقتضية للمعزوم جاشت عليه
نفسه فخرج عما عزم عليه إلا القليل منه فإنه يأتي به فيزداد غروره
لاعتقاده أنه من أهل ما عزم عليه
مثال ذلك أن يعزم على الصبر على ما يصيبه فإذا حضر ما يصبر عليه كذبته
نفسه وجزعت
وكذلك يعزم على الإخلاص فإذا وجد من يرائيه جاشت نفسه إلى الرياء وحملته
عليه
وكذلك يعزم على الرضا بالقضاء فإذا نزل القضاء كان من أسخط الناس به
وتنتفي الغرة بذلك بأن يتامل التفرقة بين العزم وبين المعزوم عليه فيعلم
أن العزم على الإخلاص ليس بإخلاص وعلى التوكل ليس بتوكل وعلى الحلم ليس
بحلم وعلى الصبر ليس بصبر وعلى الرضا ليس برضا وأنه مغرور بعمل لم يصدر
منه بخلاف من تقدم ذكره من المغرورين فإنهم صدرت منهم أعمال وأحوال اغتروا
بها واعتمدوا عليها
النوع الثاني عشر الاغترار بستر الله تعالى على
الذنوب والعيوب وبإمهاله عن المؤاخذة مع تضييع كثير من حقوق الله تعالى
ظنا منه أن الله
تعالى إنما أمهله
وستر عليه لكرامته عليه وحظوته لديه وأنه إنما حببه إلى إخوانه وإلى غيرهم
من الأجانب لمنزلته عنده وتنتفي الغرة بذلك بأن يعلم بان ثناءهم حجة لله
تعالى عليه وأنه يلزمه أن يشكر الله تعالى على إظهار محاسنه وستر ذنوبه
وعيوبه وأنه لا يأمن أن يختم له بذنوبه التي سترت عليه فيكون عند الله
سبحانه من الهالكين
وأن من أشد الجهل اغترار الإنسان بما يقوله
الناس بالظن الكاذب وترك الوجل مما يتحققه من ذنوبه وعيوبه وينبغي لمن مدح
بما ليس فيه أن يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون
واغفر لي ما لا يعلمون
فصل في سيرة المريد في نومه ويقظته
ينبغي للمريد إذا أراد النوم أن يجدد التوبة من معاصي الله تعالى وأن يعزم فيما بقي من عمره على طاعة الله عز وجل واجتناب معصيته وأن يحذر من أن يفاجئه الموت في نومته وأن يقول اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
فإذا استيقظ حمد الله تعالى على إمهاله إياه وذكر المعاد وليستعد له فإن
اليقظة من النوم مشبهة للحياة بعد الموت
وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيقول ( الحمد لله الذي أحيانا بعدما
أماتنا وإليه النشور ) ثم يتذكر ما عاهد الله تعالى عليه عند نومه استحياء
منه وإجلالا له عن أن ينقض عهده عن قريب فإذا أراد أن يلبس ثوبه فلينو
بلبسه امتثال أمر ربه في ستر عورته ثم ليستاك ناويا للاقتداء بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم
شاص فاه بالسواك ثم يقضي حاجته ليدخل الصلاة وهو غير مدافع للأخبثين ناويا
لذلك ويبسمل قبل دخوله الخلاء ويقول ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث )
فإذا خرج فليقل ( الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي
ما ينفعني
) ثم يتوضأ الوضوء المشروع بسننه وآدابه راجيا تكفير خطيئاته بما يغسله من
أعضائه ثم يقصد إلى المسجد ماشيا بالسكينة والوقار وبالزيارة للمسجد
وإظهار الشعار ثم يأتي بصلاة الفجر بشرائطها وأركانها وخشوعها وخضوعها إن
استطاع ثم ينظر ما هو الأهم به في دينه ودنياه فليخرج إليه فإن اختار
الخروج إلى منزله فليدخل إليه مشفقا من عذاب الله تعالى ومعلما لأهله ما
يحتاجون إليه في أمر دينهم وحاثا لهم عليه امتثالا لقوله تعالى { قوا
أنفسكم وأهليكم نارا } وليدخل في مدحه بقوله { إنا كنا قبل في أهلنا
مشفقين }
وإذا سلك طريقا إلى منزله أو من منزله إلى سوقه فلينو أنه
إذا رأى منكرا أنكره أو صادف أمرا بمعروف أمر به أو صادف من يشرع السلام
عليه سلم
عليه فإن وقع ذلك أثيب على نيته وفعله وإن لم يقع ذلك أثيب على
نيته
وكذلك ينوي نصرة المظلوم وإماطة الأذى عن الطريق وليسلم في طريقه على من
مر به غير مستوعب لجميعهم وإن لقيك أحد من أصحابك أو معارفك فسألته عن
حاله وحال أهله كان ذلك حسنا وآكد من يبدأ بالسلام من إذا تركت التسليم
عليه ساءه ذلك وحقد عليك ولتكن في ذلك مخلصا لله عز وجل فإذا سلمت على أحد
من إخوانك أو سلم عليك فاحترز كل التحرز من التصنع والرياء بأقوالك
وأفعالك أو شيء من أعمالك وإياك والتصنع بلسان الحال فإنه كالتصنع بلسان
المقال
وإن خرجت لاكتساب ما تنفقه على نفسك أو عيالك أو على إخوانك
أو في حق لزمك أو ندبت إليه فاقصد بذلك كله امتثال أمر الله تعالى وطلب
مرضاته وتوكل في ذلك على ربك لا على حسن صناعتك ولا على كسبك في تجارتك
قاصدا لترك اكتساب الشبهات فإن اجتنابها أبرأ لدينك وعرضك
وأكثر من ذكر الله تعالى في سوقك وحانوتك فإن ذكر الله تعالى في الغافلين
كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم
وتجنب الخوض مع أرباب الأسواق فيما يخوضون فيه ولا تشتغل بدنياك عن طاعة
مولاك وتستعمل مثل هذا في جميع العقود والمعاملات والقضاء والاقتضاء
وإن غدوت طالبا للعلم فاقصد بطلبه وتعلمه أن تستقيم في نفسك وتأمر
بالاستقامة بمقتضاه وان تعلمه الناس ابتغاء وجه الله تعالى وكذلك يكون
قصدك في جميع أقوالك وأعمالك كعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإطعام الجيعان
وكسوة العريان وقرى الضيفان وإغاثة اللهفان فإن الله تعالى لا يقبل من
الأعمال إلا ما أريد به وجهه
فائدة في حسد الشيطان من استقام على رعاية حقوق الله تعالى
فمن استقام على رعاية حقوق الله تعالى في ظاهره وباطنه كما ذكرناه حسده الشيطان على ذلك فأراد أن يخرجه عن حيز الرعاية إلى حيز المعصية بأنزين له طاعة من الطاعات تستلزم كثيرا من المعاصي والمخالفات
فيقول له انظر
إلى عباد الله قد فسدت قلوبهم واعرضوا عن ربهم وأقبلوا على دنياهم وتركوا
أمر مولاهم فاخرج إلى عباد الله وانصحهم في دين الله بدلالتهم عليه
وإرشادهم إليه فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس
فتحثه نفسه على ذلك لعلمها بما يحصل لها من الرئاسة والتعظيم والإجلال
والخدمة ونفوذ الكلمة واعتقاد الولاية فيخرج إلى الناس ليدعوهم إلى ذلك
فيعظموه ويوقروه ويبذلوا له أنفسهم وأموالهم ويبجلونه غاية التبجيل
ويعظمونه أقصى التعظيم وتستشعر النفس بلذة لم تستشعرها قط فترائي في بعض
المواطن لئلا تزول تلك المنزلة
وإذا رد عليه شيء من كلامه غضب كيف
يرد على مثله وربما قابل الراد بالشتم والسب مع كونه محقا في رده وربما
اغتابه ونال منه ونسبه إلى الجهل وسوء الأدب وربما وقعت منه زلة أو ركوب
أمر مباح لا يليق بأمثاله فيخشى من نقص منزلته عند أصحابه فيأتي من الرياء
والتصنع والتسميع ما يمحو به ذلك من قلوب أصحابه فيصير معرضا عن الله
تعالى بعد أن كان مقبلا عليه وظاعنا عنه بعد أن كان سائرا إليه ومتباعدا
منه بعد أن كان متقربا إليه ولو لم يخرج إلى الناس ليسلم من هذا كله وإنما
يخرج إلى الناس من رسخت قدمه في التقوى ووثق بالسلامة من هذه المفاسد في
غالب الأمر وإنما يحصل
له ذلك بعد تجربة نفسه في الوعظ والتذكير والدعاء إلى الله تعالى مع غلبة السلامة عليه في ذلك