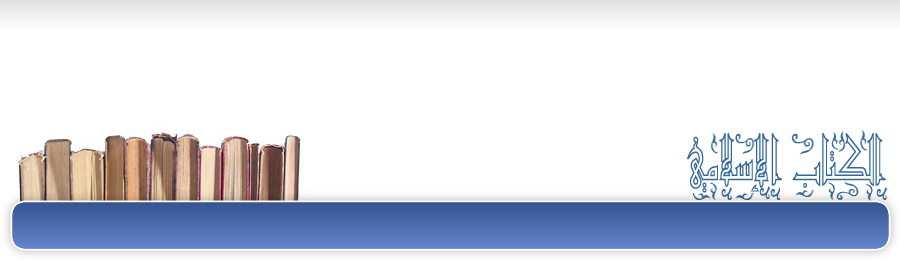كتاب : الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع
المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي
xفصل في الكفالة
وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان وإن ضمن معرفته أخذ به."وتصح الكفالة بـ" بدن " كل" إنسان عنده "عين مضمونة" كعارية ليردها أو بدلها.
"و" تصح أيضا " ببدن من عليه دين" ولو جهله الكفيل لأن كلا منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان.
و " لا" تصح ببدن من عليه " حد" لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف لحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا كفالة في حد" . ولا ببدن من عليه " قصاص" لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا.
"ويعتبر رضى الكفيل" لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه " لا" رضى " مكفول به" أو له كالضمان " فإن مات" المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه "أو تلفت العين بفعل الله تعالى" قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل "أو سلم" المكفول "نفسه برئ الكفيل" لأن الأصيل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا.
9-
باب الحوالة
مشتقة من التحول1 لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وتنعقد بـ: أحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه."و لا تصح" الحوالة "إلا على دين مستقر" إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال مكاتبة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مبيع مدة خيار ونحوها وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة و الحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. "لا يعتبر استقرار المحال فيه" فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمه و حوالته تقوم مقام تسليمه.
ـــــــ
1 التحول: هو الانتقال من مكان لآخر أو من وجهة إلى أخرى والاشتقاق هنا مستند إلى الدين نفسه لأنه هو المحول من ذمة إلى أخرى.
"ويشترط" أيضا للحوالة "اتفاق الدينين" أي تماثلهما " جنسا" كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح " ووصفا" كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلفا لم يصح " ووقتا" أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها "ولا يؤثر الفاضل" في بطلان الحوالة فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه.
"وإذا صحت" الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه " وبرئ المحيل" بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرهما وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضا جاز " ويعتبر" لصحة الحوالة "رضاه" أي رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه.
ويعتبر أيضا علم المال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها و لا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه بوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على إتباعه لحديث أبي هريرة يرفعه: "مطل الغني ظلم1 وإذا اتبع أحدكم على ملىء2 فليتبع" متفق عليه وفي لفظ: "من أحيل بحقه على مليء فليحتل" و الملىء القادر بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء وقوله أن لا يكون مماطلا وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي.
"وإن كان" المحال عليه "مفلسا ولم يكن" المحتال " رضي" الحوالة عليه "رجع به" أي بدينه على المحيل لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع لمعيب فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه.
"ومن أحيل بثمن" مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع
ـــــــ
1 أي مماطلة القادر على سداده فلا يسدد الدين رغم استطاعته بل يؤجل ذلك من وقت إلى آخر هي ظلم للدائن لأنه يمنعه حقه وهو قادر على أدائه.
2 أي قادر على السداد.
باطلا فلا حوالة "أو أحيل به" أي بالثمن " عليه" بأن أحال البائع على المشترى مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا.
"وإذا فسخ البيع" بتقايل أو خيار عيب أو نحوه "لم تبطل" الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض "ولهما أن يحيلا" أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. وإذا اختلفا فقال: أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإذا طالب الدائن المدين فقال: أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة.
10-
باب الصلح
هو لغة: قطع المنازعة وشرعا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.والصلح في الأموال قسمان: على إقرار وهو المشار إليه بقوله: "إذا أقر له بدين أو عين فأسقط" عنه من الدين بعضه "أو وهبه" من العين " البعض وترك الباقي" أي لم يبرئ منه ولم يهبه " صح" لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق. ومحله أيضا "إن لم يكن شرطاه" بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض واسم يكن ضمير الشأن وفي بعض النسخ: إن لم يكن شرطا أي بشرط ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل لأنه أكل لمال الغير بالباطل
"و" محله أيضا أن لا يكون ممن " لا يصح تبرعه" كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.
وإن وضع رب دين "بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط" لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ
الصلح فلا يصح كما تقدم. " و إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا" لم يصح في غير الكتابة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز " أو بالعكس" بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم " أو أقر له ببيت" ادعاه " فصالحه على سكناه" ولو مدة معينة كسنة أو على أن " يبني له فوقه غرفة" أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح لأنه صالح عن ملكه على ملكه أو منفعته وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد "أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية" أي بأنه مملوكه لم يصح أو صالح " امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح" الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. " وإن بذلاهما" أي دفع العبد المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليهما الزوجية عوضا " له" أي للمدعي "صلحا عن دعواه صح" لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
"وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل" أي فأقر بالدين " صح الإقرار" لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره و "لا" يصح " الصلح" لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخذ شيئا رده وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه فإن كان بنقد عن نقد فصرف وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا وإن صالح عما في الذمة بشئ في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول.
فصل
القسم الثاني: صلح على إنكار وقد ذكره بقوله: " ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله" أي يجهل ما ادعي به عليه " ثم صالح" عنه "بمال" حال أو مؤجل " صح" الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. ومن ادعي
عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قرض فأنكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره "وهو" أي صلح الإنكار "للمدعي بيع لأنه" يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده " يرد معيبه" أي معيب ما أخذه من العوض "وبفسخ الصلح" كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا " ويؤخذ منه" العوض إن كان شقصا1 " بشفعة" لأنه بيع. وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر " و" الصلح " للآخر" المنكر إبراء لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه " ولا شفعة" فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه "لم يص" الصلح " في حقه باطنا" لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق " وما أخذه حرام" عليه لأنه أكل للمال بالباطل و إن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير.
"ولا يصح" الصلح " بعوض عن حد سرقة وقذف" أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه "ولا" عن حق " شفعة" أو خيار لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة " و" لا عن " ترك شهادة" بحق أو باطل. " وتسقط الشفعة" إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض " و" كذا حكم " الحد" و الخيار وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة له للحاجة ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا و بقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يجني عليه بنيانا موصوفا ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة "وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره" الخاص به أو المشترك " أو" حصل غصن شجرته في " قراره" أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى "فإن أبى" مالك الغصن إزالته " لواه" مالك الهواء " إن أمكن وإلا" يمكن " فله قطعه" لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ولا يفتقر إلى حاكم ولا يجبر المالك على إزالته لأنه ليس من فعله وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز وان اتفقا على أن لثمرة بينهما ونحوه صح جائزا وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره.
ـــــــ
1 شقصا: حصة أو جزءا.
"ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق" لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. و "لا" يجوز "إخراج روشن" على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط " و" لا إخراج " ساباط" وهو المستوفي للطريق كله على جدارين " و" لا إخراج "دكة" بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم و لا إخراج " ميزاب" ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. " ولا يفعل ذلك" أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا " في ملك جار ودرب مشترك" غير نافذ "بلا إذن المستحق" أي الجار أو أهل الدرب لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة و حرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه.
"و ليس له وضع خشبة على حائط جاره" أو حائط مشترك "إلا عند الضرورة" فيجوز "إذا لم يمكن التسقيف إلا به" ولا ضرر لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره" ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه. " وكذلك" حائط " المسجد وغيره" كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما " أو خيف ضرره" بسقوطه " فطلب أحدهما أن يعمره الأخر معه أجبر عليه" إن امتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه وإن بناه شريك شركة بنية الرجوع رجع. " و كذا النهر والدولاب والقناة" المشتركة إذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة فإن فعل فالماء على الشركة وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة1 الأسفل فإن استويا اشتركا.
ـــــــ
1 أي تمنع إشرافه على عورات الأسفل.
باب الحجر
مدخل
11- باب الحجروهو في اللغة: التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. وشرعا: منع إنسان من تصرفه في ماله. وهو ضربان: حجر لحق الغير كعلى مفلس ولحق نفسه كعلى نحو صغير.
"ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه" وملازمته لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1 فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده وإلا حلف وخلي سبيله. " ومن له "مال قدر دينه لم يحجر عليه" لعدم الحاجة إلى الحجر عليه " وأمر" أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه لحديث: "مطل الغني ظلم" ولا يترخص من سافر قبله ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل ملئ. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال "حبس بطلب ربه" ذلك لحديث: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام: قال وكيع: عرضه: شكواه وعقوبته: حبسه فإن أبى عزره مرة بعد أخرى "فان أصر" على عدم قضاء الدين " ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه" لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير.
"و لا يطلب" مدين " بـ" دين " مؤجل" لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله " ومن ماله لا يفي بما عليه" من الدين " حالا وجب" على الحاكم " الحجر عليه بسؤال غرمائه" كلهم " أو بعضهم" لحديث كعب بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الحلال بإسناده.
"ويستحب إظهاره" أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة " ولا ينفذ تصرفه" أي المحجور عليه لفلس " في ماله" الموجود والحادث بإرثه أو غيره " بعد الحجر" بغير وصية أو تدبير "ولا إقراره عليه" أي على ماله لأنه محجور عليه و أما تصرفه في ماله في الحجر عليه فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. "ومن باعه أو أقرضه شيئاً" قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به" متفق عليه من حديث أبي هريرة وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه " رجع فيه" إذا وجده بعينة "إن جهل حجره" لأنه معذور بجهل حاله " وإلا" يجهل الحجر عليه " فلا" رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.
"وإن تصرف" المفلس " في ذمته" بشراء أو ضمان أو نحوهما " أو أقر" المفلس " بدين أو" أقر بـ " جناية توجب قودا أو مالا صح" تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "280".
للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته "ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه" وما أقر به "بعد فك الحجر عنه" لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفى فقد زال المعارض "ويبيع الحاكم ماله" أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر " ويقسم ثمنه" فورا بقدر ديون غرمائه الحالة1 لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم.
"ولا يحل" دين "مؤجل بفلس" مدين لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه " ولا" يحل مؤجل أيضا " بموت" مدين " إن وثق ورثته برهن" يحرز " أو كفيل مليء" بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. " وإن ظهر غريم" للمفلس " بعد القسمة" لماله لم تنقض، و " رجع على الغرماء بقسطه" لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغنى عنهما " ولا يفك حجره إلا حاكم" لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه.
ـــــــ
1 الحالة: المستحقة الأداء فوراً.
فصل في المحجور عليه لحظه
"و يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم" إذا المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها "رجع بعينه" إن بقي لأنه ماله وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه "ويلزمهم أرش الجناية" إن جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. " و" يلزمهم أيضا " ضمان مال من لم يدفعه إليهم" لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره."وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة" حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه " أو نبت حول قبله شعر خشن" حكم ببلوغه
لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" متفق عليه " أو أنزل" حكم ببلوغه لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} 1 " أو عقل مجنون ورشد" أي من بلغ وعقل " أو رشد سفيه زال حجرهم" لزوال علته قال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} 2 بلا قضاء حاكم لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه.
"وتزيد الجارية" على الذكر " في البلوغ بالحيض" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الترمذي وحسنه. " وان حملت" الجارية " حكم ببلوغها" عند الحمل لأنه دليل إنزالها لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر لأنه اليقين.
"ولا ينفك الحجر" عنهم " قبل شروطه" السابقة بحال ولو صار شيخا " والرشد: الصلاح في المال" لقول ابن عباس في قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً} 3 أي: صلاحا في أموالهم فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه ويؤنس رشده " بأن يتصرف مرارا فلا يغبن" غبنا فاحشا غالبا " ولا يبذل ماله في حرام" كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة كغناء ونفط لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. " ولا يدفع إليه" أي الصغير " حتى يختبر" ليعلم رشده " قبل بلوغه بما يليق" به لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى...} 4 الآية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون " حال الحجر: الأب" الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته " ثم وصيه" لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع " ثم الحاكم" لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد " ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ" لقوله تعالى: { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 5 والسفيه والمجنون في معناه.
"ويتجر" ولي المحجور عليه " له مجانا" أي إذا إتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه " وله دفع ماله لمن
ـــــــ
1 سورة النور من الآية "59".
2 سورة النساء من الآية "6"
3 سورة النساء من الآية "6"
4 سورة الأنعام من الآية "152".
5 سورة الإسراء من الآية "34".
يتجر فيه " مضاربة بجزء" معلوم " من الربح" للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة وشراء الأضحية لموسر وتركه في المكتب بأجرة ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة.
"ويأكل الولي الفقير من مال موليه" لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 1 " الأقل من كفايته أو أجرته" أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه " مجانا" فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب.
"ويقبل قول الولي" بيمينه " والحاكم" بغير يمين " بعد فك الحجر في النفقة" وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفا ولو قال: أنفقت عليك منذ سنتين فقال: منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته قاله في المبدع. " و" يقبل قول الولي أيضا " في وجود الضرورة والغبطة" إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. " و" يقبل قول الولي أيضا في " التلف" وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. " و" يقبل قوله أيضا في " دفع المال" إليه بعد رشده لأنه أمين وإن كان بجعل2 لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه.
"وما استدان العبد لزم سيده" أداؤه " إن أذن له" في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته " وإلا" يكن استدان بإذن سيده " فـ" ما استدانه " في رقبته" يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعنته3 وإن كانت العين باقية ردت لربها" كاستيداعه" أي أخذه وديعة فيتلفها " وأرش جنايته وقيمة متلفه" فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول إعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا وتشك في رضاه.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "6".
2 جعل: أجر معلوم أو حصة محددة من الربح.
3 أعنته: شق عليه ذلك.
باب الوكالة
الوكالة بفتح الواو وكسرها: التفويض تقول: وكلت أمري إلى الله أي: فوضته إليه واصطلاحا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة."تصح" الوكالة " بكل قول يدل على الإذن" كـ: افعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. " ويصح القبول على الفور والتراخي" بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول: قبلت " بكل قول أو فعل" دال عليه أي دال على القبول لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم قاله في المبدع ويعتبر تعيين الوكيل. " ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل" فيه " والتوكل فيه" أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيره وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته و نحوها لأجنبي.
"ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود" لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه "والفسوخ" كالخلع والإقالة " والعتق والطلاق" لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى " والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه" كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. " لا الظهار" لأنه قول منكر وزور " واللعان والأيمان" والنذر والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية فلا تدخلها النيابة " و" تصح الوكالة أيضا " في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات" كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وكذا حج وعمرة على ما سبق. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه لكن ركعتا الطواف تتبع الحج " و" تصح في " الحدود في إثباتها واستيفائها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته " وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه" إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله " إلا أن يجعل إليه" بأن يأذن له في التوكيل أو يقول له: اصنع ما شيءت ويصح توكيل عبد بإذن سيده.
"والوكالة عقد جائز" لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها. " وتبطل بفسخ أحدهما وموته" وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفيا انتفت صحتها وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت. " و" تبطل أيضا بـ " عزل الوكيل" ولو قبل علمه لأنه رفع عقد1 لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة "و" تبطل أيضا " بحجر السفيه" لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها.
"ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه" لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة. " و" لا من " ولده" ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه.
"ولا يبيع" الوكيل " بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد" لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير " وإن باع بدون ثمن المثل" إن لم يقدر له ثمن أو باع بـ دون ما قدره له الموكل صح " أو اشترى له بكثر من ثمن المثل" وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره "وضمن النقص" في مسألة البيع "و" ضمن " الزيادة" في مسألة الشراء لأنه مفرط والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا2.
"وإن باع" الوكيل " بأزيد" مما قدره له الموكل صح. " أو قال" الموكل: " بع بكذا مؤجلا فباع" الوكيل " به حالا" صح " أو" قال الموكل: " اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما" أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا " صح" لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها " وإلا فلا" أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو بعه بعشرة
ـــــــ
1 هو رقع عقد من صاخب الصلاحية بإمضائه ووقفه وفسخه.
2 فإن باعه بأقل من ذلك لم يجز لأن ما فوضه به هو الحد الأدنى المقبول لديه أي مادام الضرر لم يحصل بفعله جائز أما إذا في فعله ضرر لم يوكل به ففعله غير جائز.
حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال أو قال: اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى و التنقيح في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن.
فصل
"و إن اشترى" الوكيل " ما يعلم عيبه لزمه" أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة " إن لم يرض" به " موكله" فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح " فإن جهل" عيبه " رده" لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضى غيره فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل.
"ووكيل البيع يسلمه" أي يسلم المبيع لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه " ولا يقبض" الوكيل في البيع " الثمن" بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن " بغير قرينة" فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى: لا يقبضه إلا بإذن فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه.
"ويسلم وكيل المشتري الثمن" لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن " ضمنه" لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. " وإن وكله في بيع فاسد" لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه و لو باع الوكيل إذا بيعا " صحيحا" لم يصح لأنه لم يوكل فيه " أو وكله في كل قليل وكثير" لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر "أو" وكله في " شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين" نوعا وثمنا " لم يصح" لأنه يكثر فيه الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما
شاء منه صح. قاله في المبدع: وظاهر كلامهم في: بع من مالي ما شيءت له بيع ماله كله.
"والوكيل في الخصومة لا يقبض" لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض " والعكس بالعكس" فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا1. " و" إن قال الموكل: " اقبض حقي من زيد" ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه " و لا يقبض من ورثته" لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف " إلا أن يقول" الموكل للوكيل: اقبض حقي " الذي قبله" أو عليه فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا وإن قال: اقبضه اليوم لم يملكه غدا " ولا يضمن وكيل" في " الإيداع إذا" أودع " ولم يشهد" وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف و أما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان.
فصل
"والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط" لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن
"ويقبل قوله" أي الوكيل " في نفيه" أي نفي التفريط ونحوه و في " الهلاك مع يمينه" لأن الأصل براءة ذمته لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه2 ثم يقبل قوله فيه. وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع وإن كان بجعل فقول موكل و إذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ويقبل قول الوكيل فيما وكله فيه.
"ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو" بلا بينة " لم يلزمه" أي عمرا "دفعه إن صدقه" لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه " ولا" يلزمه " اليمين إن كذبه" لأنه لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه " فإن دفعه" عمرو " فأنكر زيد الوكالة
ـــــــ
1 و الموكل يقبض الإيجارات مثلا له حق التأجير والخصومة والمقاضاة وإخلاء وكل ما من شأنه تأمين الإيجار للمالك وبالتالي فإن كل في موكل في أمر لابد من أمور عديدة لحصوله فهو موكل بهذه الأمور حكما وعرفا.
2 أي إن ادعى سببا لابد أن يعم العلم به كلف بإظهار بينته.
حلف" لاحتمال صدق الوكيل فيها " وضمنه عمرو" فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. " وإن كان المدفوع" لمدعي الوكالة بغير بينة " وديعة أخذها" حيث وجدها لأنها عين حقه " فإن تلفت ضمن أيهما شاء" لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم.
13-
باب الشركة
الشركة بوزن سرقة ونعمة ونمرة. " وهي" نوعان: شركة أملاك وهي: "اجتماع في استحقاق" كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر أو شركة عقود وهي اجتماع في "تصرف" من مبيع ونحوه "وهي" أي شركة العقود وهي - المقصودة هنا - "أنواع" خمسهفأحدها: "شركة عنان"1 سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير وهي "أن يشترك اثنان" أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف "بماليهما المعلوم" كل منهما الحاضرين "ولو" كان مال كل "متفاوتا" بأن لم يتساو المالان قدرا أو جنسا أو صفة "ليعملا فيه ببدنيهما" أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاعوإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما "فينفذ تصرف كل منهما فيهما" أي في المالين" بحكم الملك في نصيبه و" بحكم "الوكالة في نصيب شريكه" ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف.
ويشترط لشركة العنان والمضاربة "أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين" لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين ولو "مغشوشين يسيرا" كحبة فضة في دينار ذكره في المغني و الشرح لأنه لا يمكن التحرز منه فإن كان الغش كثيرا لم تصح لعدم انضباطه.
"و" يشترط أيضا "أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما" كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما
ـــــــ
1 لأن الشريكين يملكان حق التصرف أي كأنهما يمسكان معا بعنان فرس واحد.
بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة فإن قالا: والربح بيننا فهو بينهما نصفين " فان لم يذكرا الربح" لم تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به " أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا" لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب "أو" شرطا ربح "دراهم معلومة" لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها "أو" شرطا "ربح أحد الثويين" أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه "لم تصح" لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة "وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة" فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم "والوضيعة" أي الخسران "على قدر المال" بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.
"ولا يشترط خلط المالين" لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط "ولا" يشترط أيضا "كونهما من جنس واحد" فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله ثم اقتسما الفضل وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه و إحرازه وقبض النقد ونحوه فإن استأجر له فالأجرة عليه.
فصل في المضاربة
النوع " الثانية: المضاربة" من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} 1 وتسمى قراضا ومعاملة وهي دفع مال معلوم "لمتجر" أي لمن يتجر "به ببعض ربحه" أي بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم فلو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال ث الوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله و إن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وإلا لم تصح المضاربة "فإن قال" رب المال للعامل: اتجر به "والربح بيننا فنصفان "لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية "وإن قال:"ـــــــ
1 سورة المزمل الآية "20".
اتجر به "ولي" ثلاثة أرباعه أو ثلثه أو قال: اتجر به " ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح" لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر لأن الربح مستحق لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ1.
"وإن اختلفا لمن" الجزء "المشروط ف" هو "لعامل" قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه وكذا "مساقاة ومزارعة" إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله وتصح مؤقتة ومعلقة.
"ولا يضارب" العامل "بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض" لأنها تنعقد على الحظ والنماء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو إذن جاز "فإن فعل" بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه "رد حصته" من ربح الثانية" في الشركة" الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط "ولا يقسم" الربح "مع بقاء العقد" أي المضاربة "إلا باتفاقهما" لأن الحق لا يخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال.
"وإن تلف رأس المال أو" تلف "بعضه" قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض وإن تلف "بعد التصرف" جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح "أو خسر" في إحدى سلعتين أو سفرتين "جبر" ذلك "من الربح" أي وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة "قبل قسمته" ناضا "أو تنضيضه" مع محاسبته فإذا احتسبا وعلما ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل.
وتبطل بموت أحدهما فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين والقول قول رب المال في عدم رده إليه.
ـــــــ
1 أي يجب أن يكون على حق كل واحد منهما واضحا محددا قبل العمل وحدود تصرف المضارب بالمال أيضا وذلك لقطع الخلاف.
فصل في أنواع الشركات
"الثالث: شركة الوجوه" سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما الجاه والوجه واحد. وهي أن يشتركا على "أن يشتريا في ذمتيهما" من غير أن يكون لهما مال "بجاهيهما" فما ربحاه " فـ" هو "بينهما" على ما شرطاه سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا صح"وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن" لأن مبناها على الوكالة والكفالة "والملك بينهما على ما شرطاه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" " والوضيعة على قدر ملكيهما" كشركة العنان لأنها في معناها "والربح على ما شرطاه" كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان.
"الرابع: شركة الأبدان" وهي "أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما" أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما فما رزق الله تعالى فهو بينهما "فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله" ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن.
"وتصح" شركة الأبدان "في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات" كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشئ وجاء سعد بأسيرين قال أحمد: شرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. "وإن مرض أحدهما فالكسب" الذي عمله أحدهما "بينهما" احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر "وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه" لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها كآلة صنعة لمن يعمل عليها وما رزقه الله تعالى بينهما على ما شرطاه.
"الخامس: شركة المفاوضة" وهي "أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة" بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح.
ـــــــ
أي يقيم مقامه شخصا آخر ينوب عنه ويقوم بالعمل الذي كان يقوم به.
"والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال" لما سبق في العنان "فان أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين" كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية "أو" ما يلزم أحدهما من ضمان "غصب أو نحوه فسدت" لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد.
باب المساقاة
مدخل
14- باب المساقاةمن السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير "مغروس" 1 إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمرة.
"تصح" المساقاة "على شجر له ثمر يؤكل" من نخل وغيره لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع ولا تصح على ما لا ثمر له كالجور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ.
"و" تصح المساقاة أيضا "على" شجر ذي "ثمرة موجودة" لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت بالمعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى "و" تصح أيضا " على شجر يغرسه" 2 في أرض رب الشجر "ويعمل عليه حتى يثمر" احتج الإمام بحديث خيبر ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقاة على شجر مغروس "بجزء من الثمرة" مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر.
"وهو" أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة "عقد جائز" من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء "فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة" أي أجرة مثله لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض "وان فسخها هو" أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة "فلا شىء له" لأنه رضي بإسقاط حقه وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب.
ـــــــ
1 فيغرسه الآخر ويسقيه.
2 وهذا ما يسمى المغارسة فيقدم أحدهما الأرض الآخر الغراس والعمل والناتج من ثمر بعد ذلك بينهما أو قد يقدم صاحب الأرض الغراس على أن يقوم الآخر بالغرس والرعاية.
"ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار" بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم " وتلقيح وتشميس لإصلاح موضعه و" إصلاح "طرق الماء وحصاد ونحوه" كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم "وعلى رب المال ما يصلحه" أي ما يحفظ الأصل "كسد حائط وإجراء الأنهار" وحفر البئر " والدولاب ونحوه" كآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك.
فصل في المزارعة
"وتصح المزارعة" لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه "بجزء" مشاع "معلوم النسبة" كالثلث أو الربع ونحوه "مما يخرج من الأرض لربها" أي لرب الأرض "أو للعامل والباقي للأخر" أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وان شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر."ولا يشترط" في المزارعة والمغارسة "كون البذر والغراس من رب الأرض" فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني و الشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين "وعليه عمل الناس" لأن الأصل المعمول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة وأختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح
وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر الى معدل المغل فيجب القسط المسمى1.
ـــــــ
1 أي القسط المتفق عليه.
باب الإجارة
مدخل
15- باب الإجارةمشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم وتنعقد بلفظ الإجارة و الكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين.
و "تصح" الإجارة "بثلاثة شروط:"
أحدها : "معرفة المنفعة" لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع. وتحصل المعرفة إما بالعرف "كسكنى دار" لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعا وله إسكان ضيف وزائر و كـ "خدمة آدمي" فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر و يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كـ ت"عليم علم" وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجل هو عبدالله بن أرقط وقيل: ابن أريقط كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا والخريت: الماهر بالهداية. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.
الشرط الثاني : " معرفة الأجرة" بما تحصل به معرفة الثمن لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. " وتصح" الإجارة "في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما" روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير وأما الظئر فلقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل المشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة العوض. " وإن دخل حماما أو سفينة" بلا عقد " أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا" ليعملاه "بلا عقد صح بأجرة العادة" لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة.
الشرط الثالث : " الإباحة" في نفع "العين" المقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "233".
مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعود بظله "فلا تصح" الإجارة "على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لمبيع الخمر" لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده1 ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني و الشرح ولا نحو تفاحة لشم " وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه" المعلوم "عليه" لإباحة ذلك " ولا تؤجر المرأة نفسها" 2 بعد عقد النكاح عليها "بغير إذن زوجها" لتفويت حق الزوج.
ـــــــ
1 لأنه مما يسرع إليه الفساد فإذا فسد كان ذلك بابا للخلاف بينهما وأصل الأحكام إزالة الخلاف بين الناس ومسبباته.
2 أي للقيام بعمل معين في أرض أو خدمة منزل أو ما شابه ذلك.
فصل في شروط الإجابة
"ويشترط في العين المؤجرة" خمسة شروطأحدها : " معرفتها برؤية أو صفة" إن انضبطت بالوصف ولهذا قال: " في غير الدار ونحوها" مما لا يصح فيه السلم فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان و مطرح الرماد ومصرف الماء وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه."و" الشرط الثاني : "أن يعقد على نفعها" المستوفي "دون أجزائها" لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها "فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله" ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد "ولا حيوان ليأخذ لبنه" أو صوفه أو شعره أو وبره "إلا في الظئر" فيجوز وتقدم ، " ونقع البئر" أي ماؤها المستنقع فيها "وماء الأرض يدخلان" تبعا كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه.
"و" الشرط الثالث : " القدرة على التسليم" كالبيع "فلا تصح إجارة" العبد "الآبق و" الجمل " الشارد" والطير في الهواء و لا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه1 و لا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها.
ـــــــ
1 لأن فيه غررا فقد يحصل وقد لا يحصل ففيه وجوه من وجوه القمار والمغامرة.
"و" الشرط الرابع : اشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين.
"و" الشرط الخامس: " أن تكون المنفعة" مملوكة " للمؤجر أو مأذونا له فيها" فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. "وتجوز إجارة العين" المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر "لمن يقوم مقامه" في الانتفاع أو دونه لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر منه ضررا لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له.
"وتصح إجارة الوقف" لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر "فإن مات المؤجر فانتقل" الوقف "إلى من بعده لم تنفسخ" لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق "وللثاني حصته من الأجرة" من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في المبدع وإن لم تقبض فمن مستأجر وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينها.
"وإن أجر الدار ونحوه" كالأرض "مدة" معلومة "ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح" ولو ظن عدم العاقد فيها ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه "وإن استأجرها" أي العين "لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث" أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة "أو" استأجر "من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك" العمل " وضبطه بما لا يختلف" لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع.
"ولا تصح" الإجارة "على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية" أي مسلما
كالحج والأذان وتعليم القرآن لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ويجوز رزق أخذ على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط ويكره للحر أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم.
"و" يجب " على المؤجر كل ما يتمكن به" المستأجر " من النفع كزمام الجمل" وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة "والشد عليه" أي على الحل "وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير" لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر و على المؤجر أيضا عمارتها فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته "فأما تفريغ البالوعة والكنيف" وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام " فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة" من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به أما بالفراسخ أو الزمان وإن استأجر اثنان جمل يتعاقبان عليه صح وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح قاله في المبدع.
فصل
"وهي" أي الإجارة "عقد لازم" من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه "فان أجره شيئا ومنعه" أي منع المؤجر المستأجر الشئ المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة "فلا شيء له" من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا "وإن بدأ الآخر" أي المستأجر فتحول " قبل انقضائها" أي انقضاء مدة الإجارة "فعليه" جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع.
"وتنفسخ" الإجارة "بتلف العين المؤجرة" كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط "و" تنفسخ الإجارة أيضا "بموت المرتضع" لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. و تنفسخ الإجارة أيضا بموت "الراكب إن لم يخلف بدلا" أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع والذي في الإقناع
و المنتهى وغيرهما: أنها لا تبطل بموت راكب. و تنفسخ أيضا "بانقلاع ضرس" اكترى لقلعه "أو برئه" لتعذر استيفاء المعقود عليه فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر "ونحوه" أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ.
و لا تنفسخ "بموت المتعاقدين أو أحدهما" مع سلامة المعقود عليه للزومها "ولا" تنفسخ بعذر لأحدهما مثل "ضياع نفقة المستأجر" للحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه.
"وإن اكترى دارا فانهدمت أو" اكترى "أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي" من المدة "لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف" وإن أجره أرضا بلا ماء صح وكذا إن أطلق مع علمه بحالها1 وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ومن استؤجر لعمل شي فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيتخير فيه المستأجر بين الصبر والفسخ "وإن وجد" المستأجر "العين معيبة أو حدث بها" عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر "فله الفسخ" إن لم يزل بلا ضرر يلحقه "وعليه أجرة ما مضى" لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي
ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.
"ولا يضمن أجير خاص" وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد يسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ولا يستنيب "ما جنت يده خطأ" لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن
"ولا" يضمن أيضا "حجام وطبيب وبيطار" وختان "لم تجن أيديهم إن عرفه حذقهم" 2 أي معرفتهم صنعتهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذا وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن
ـــــــ
1 فإن لم يعلمه بحالها وكان حالها غير معلوم لم يجز.
2 أي كانت مهاراتهم وخبرتهم في هذا الأمر معلومة معروفة.
لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ "ولا" يضمن أيضا "راع لم يتعد" لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن.
"ويضمن" الأجير "المشترك" وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال فكل منهم ضامن "ما تلف بفعله" كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله روي عن عمر وعلي و شريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا "ولا يضمن" المشترك "ما تلف من حرزه أو بغير فعله" لأن العين في يده أمانة كالمودع "ولا أجرة له" فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن.
"وتجب الأجرة بالعقد" كثمن وصداق وتكون حالة "إن لم تؤجل" بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل "وتستحق" أي يملك الطلب بها "بتسليم العمل الذي في الذمة" ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها.
16-
باب السبق
هو بتحريك الباء: العوض الذي يسابق عليه وبسكونها: المسابقة أي المجاراة بين حيوان و غيره."ويصح" أي يجوز السباق "على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق" جمع مزراق وهو: الرمح القصير وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم
سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود و صارع ركانة فصرعه رواه أبو داود و سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
"ولا تصح" أي لا تجوز المسابقة "بعوض إلا في إبل وخيل وسهام" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الخمسة عن أبي هريرة ولم يذكر ابن ماجه: أو نصل وإسناده حسن قاله في المبدع.
"ولابد" لصحة المسابقة "من تعيين المركوبين" لا الراكبين لأن المقصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه و لا بد من اتحادهما في النوع فلا تصح بين عربي وهجين. و لابد في المناضلة من تعين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية و يعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. و لابد أيضا من تحديد "المسافة" بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي "بقدر معتاد" فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع لم تصح لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره.
"وهي" أي المسابقة "جعالة لكل واحد منهما فسخها" لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه.
"وتصح المناضلة" أي المسابقة بالرمي من النصل وهو: السهم التام على "من معينين" سواء كانا اثنين أو جماعتين لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم "يحسنون الرمي" لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض والسنة أن يكون لهم غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الأخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
ـــــــ
1 وذلك بأن يكون العوض من شخص ثالث يؤدي للسباق منهما أو من أحدهما على ألا يؤدي الآخر شيئا إن خسر السباق جاز فإن كان عليه أن يؤدي شيئا لم يجز لأنه صار في حكام القمار وصورته فإن كانوا ثلاثة والجائزة من أحدهم جاز على ألا يكون العوض من الخاسر للرابح شرطا للسباق.
17-
باب العارية
بتخفيف الياء وتشديدها: من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض"وهي إباحة نفع عين" يحل الانتفاع بها "تبقى بعد استيفائه" ليردها على مالكها وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها ويشترط أهلية مستعير للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له وهي مستحبة لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} 1.
"وتباح إعارة كل ذي نفع مباح" كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها "إلا البضع" لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف "و" إلا "عبدا مسلما لكافر" لأنه لا يجوز له استخدامه "و" الا "صيدا ونحوه" كمخيط "لمحرم" لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 22. "و" إلا "أمة شابة لغير امرأة أو محرم" لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير في رجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع مادامت في لجة البحر وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه.
"و لا أجرة لمن أعار حائطا" ثم رجع "حتى يسقط" لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين "ولا يرد" الخشب "إن سقط" الحائط لهدم أو غيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره "إلا بإذنه" أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح.
"وتضمن العارية" المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم: "وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط. وحيث ضمنها المستعير فـ "بقيمتها يوم تلفت" إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف "ولو شرط نفي ضمانها" لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه غير مضمون
"وعليه" أي على المستعير "مؤنة ردها" أي رد العارية لما تقدم من حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد لا المؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل
ـــــــ
1 سورة المائدة من الآية "2".
2 سورة المائدة من الآية "2".
يرفع يده إذا انقضت المدة ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه. "ولا يعيرها" ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام "فإن" أعارها و "تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها" إن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا لأن التلف حصل في يده و استقر "على معيرها أجرتها" للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليه أيضا و للمالك أن "يضمن أيهما شاء" من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده
"وإن أركب" دابته "منقطعا" طلبا "للثواب لم يضمن" لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال فإن أذن له فيه فكعارية وإن كان بإجرة فإجارة فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن.
"وإذا قال" المالك: "أجرتك" و "قال" من هي بيده: "بل أعرتني أو بالعكس" بأن قال: أعرتك قال: بل أجرتني فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلفا "عقب العقد" أي قبل مضي مدة لها أجرة "قبل قول مدعي الإعارة" مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة و حينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية و إن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول "قول المالك" مع يمينه لأن الأصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ "بأجرة المثل" لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت. "وإن قال" الذي في يده العين: "أعرتني أو قال: أجرتني قال المالك: "بل غصبتني" فقول مالك كما لو اختلفا في ردها " أو قال" المالك: "أعرتك" و " قال" من هي بيده: "بل أجرتني والبهيمة تالفة" فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الغارم في القيمة "أو اختلفا في رد فقول المالك" لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد وإن قال: أودعتني فقال: غصبتني أو قال: أودعتك قال: بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع1.
ـــــــ
1 أي على المستعير أو المستأجر تأدية الأجرة مقابل انتفاعه.
18-
باب الغصب
مصدر غصب يغصب - بكسر الصاد - "وهو" لغة: أخذ الشئ ظلما واصطلاحا: "الاستيلاء" عرفا: "على حق غيره" مالا كان أو اختصاصا "قهرا بغير حق"،فخرج بقيد القهر: المسروق والمنتهب والمختلس وبغير حق: استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس وهو محرم لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} 1. من عقار بفتح العين: الضيعة والنخل والأرض قاله أبو السعادات ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كانا فيها قماشه ذكره في المبدع. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بدبغ وقال الحارثي: يرده حيث قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد المية هدر سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه.
ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا و لا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها" رواه أبو داود وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد و نحوه. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق" و لزمه أرش نقصها أي نقض الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعها وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرشا فحصل بذلك
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "188".
الجارح أو العبد أو الفرس "صيد فلمالكه" أي مالك الجارح ونحوه لأنه بسبب ملكه فكان له وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به ولا أجرة لذلك وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آلة فهو كالحبل يربط به "وإن ضرب المصنوع" المغصوب "ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة" بابا "ونحوه أو صار الحب زرعا و" صارت "البيضة فرخا و" صار "النوى غرسا" رده "وأرش نقصه" إن نقص "ولا شيء للغاصب" نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها ويلزمه أي الغاصب "ضمان نقصه" أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته وإن جني عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما.
"و إن خصى الرقيق رده مع قيمته" لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه "وما نقص بسعر لم" يضمن لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. "ولا" يضمن نقصا حصل "بمرض" إذا "عاد" إلى حاله "ببرئه" من المرض لزوال موجب الضمان وكذا لو انقلع سنه ثم عاد فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك.
"وإن عاد" النقص "بتعليم صنعة" كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة فهزل فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة "ضمن النقص" لأن الزيادة الثانية غير الأولى " وإن تعلم" صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده " فزادت قيمته ثم نسي" الصنعة "أو هزل فنقصت" قيمته "ضمن الزيادة" لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل و "كما لو عادت من غير جنس الأول" بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي مائة ثم هزل فصار يساوي تسعين فتعلم صنعة فصار يساوي مائة ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى و إن كانت الزيادة الثانية "من جنسها" أي من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة "لا يضمن" لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ "إلا أكثرهما" يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده وان جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته.
فصل
"وإن خلط" المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه و "بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما" لزمه مثله منه لأنه مثلي فيجب مثل مكيله وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب "أو صبغ" الغاصب "الثوب أو لت سويقا" مغصوبا "بدهن" من زيت أو نحوه "أو عكسه" بأن غصب دهنا ولت به سويقا "ولم تنقص القيمة" أي قيمة المغصوب "ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه" لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين "وإن نقصت القيمة" في المغصوب "ضمنها" الغاصب لتعديه "وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ" إذا طلبه صاحبه وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله "ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض" أي لخروج الأرض مستحقة للغير رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على "بائعها بالغرامة" له لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له "وإن أطعمه" الغاصب "لعالم بغصبه فالضمان عليه" لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الأكل "وعكسه بعكسه" فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل "وإن أطعمه" الغاصب "لمالكه أو رهنه" لمالكه "أو أودعه" لمالكه "أو آجره إياه لم يبرأ" الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته.
"ويبرأ" الغاصب "بإعارته" المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه "وما تلف" أو أتلف من مغصوب "أو تغيب" ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد "من منصوب مثلي" وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه غرم مثله إذا لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها والمثل أقرب إليه من القيمة وينبغي أن يستثني منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع "وإلا" يمكن رد مثل المثلي لإعوازه "فقيمته يوم تعذر" لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذا.
"ويضمن غير المثلي" إذا تلف أو أتلف "بقيمته يوم تلفه" في بلده من نقده أو غالبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه" ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. "وإن تخمر عصير" مغصوب "ف" على الغاصب "المثل" لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه "فإن انقلب خلا دفعه" لمالكه لأنه عين ملكه و دفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده استوفى المنافع أو تركها تذهب.
فصل
"وتصرفات الغاصب الحكمية" أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوها والبيع والإجارة والنكاح ونحوهما "باطلة" لعدم إذن المالك وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه "والقول في قيمة التالف" قول الغاصب لأنه غارم أو قدره أي قدر المغصوب "أو صفته" بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب: لم يكن كاتبا فـ " قوله" أي قول الغاصب لما تقدم و القول في رده أو تعييبه بأن قال الغاصب: كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها وأنكره مالكه فـ "قول ربه" لأن الأصل عدم الرد والعيب وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب: كان معيبا وقت غصبه وقال المالك: تعيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غارم "وإن جهل" الغاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرى من عهدته ويلزمه تسلمه "أو تصدق به عنه مضمونا" أي بنية ضمانه إن جاء ربه فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا.
"ومن أتلف" لغيره مالا" محترما" بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه "أو فتح قفصا" عن طائر فطار ضمنه أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه "أو حل وكاء" زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته ريح فاندفق ضمنه أو حل رباطا عن فرس "أو" حل "قيدا" عن مقيد "فذهب ما فيه أو أتلف" ما فيه "شيئا ونحوه" أي نحو ما ذكره "ضمنه" لأنه تلف بسبب فعله "وإن ربط دابة بطريق ضيق فتعثر به إنسان" أو أتلفت شيئا "ضمن" لتعديه بالربط ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط "ك" ما يضمن مقتني "الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج" منزله لأنه متعد باقتنائه فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول وان أتلف العقور
شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان لأن هذا لا يختص بالعقور وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق
وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محبس وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله.
"وما أتلفت البهيمة من الزرع" والشجر وغيرهما "ليلا" ضمنه صاحبها "وعكسه النهار" لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم "إلا أن ترسل" نهارا "بقرب ما تتلفه عادة" فيضمن مرسلها لتفريطه وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. "وإن كانت" البهيمة "بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها" كيدها وفمها لا ما جنت "بمؤخرها" كرجلها لما روى سعيد مرفوعا: "الرجل جبار" وفي رواية أبي هريرة: "رجل العجماء جبار" ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما1 "وبقي جنايتها هدر" إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار" أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها" كقتل الصائل عليه" من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل فإذا قتله لم يضمنه لأن قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس "و" كـ " كسر مزمار" أو غيره من آلات اللهو "وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة" لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء.
ـــــــ
1 أي على الماسك بزمامها لأنه بيد تركها تسير وتفعل ما تريد إن أرض زمامها وبيده ردعها إن شد زمامها.
19-
باب الشفعة
1بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا.
ـــــــ
1 الشفعة: حق الأفضلية للجار إن أراد بيعها فعليه أن يعرضها عليه أولا بالسعر المعروض فإن وافق واشتراها فيها وإن رفض فرفضه تنازل عن حقه بالشفعة وله أن يبيعه لطرف ثالث إن شاء والعادة أن يراعي الجار عند بيعه فلا يتغالى في طلبه لثمن الأرض ليمنعه حقه فإن اختلفا
"وهي استحقاق" الشريك "انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي" كالبيع والصلح والهبة بمعناه فيأخذ الشفيع نصيب البائع "بثمنه الذي استقر عليه العقد" لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. "فإن انتقل" نصيب الشريك "بغير عوض" كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية "أو كان عوضه" غير مالي بأن جعل "صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة" لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه.
"ويحرم التحيل لإسقاطها" قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل فى إبطالها ولا إبطال حق مسلم واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل".
"وتثبت" الشفعة "لشريك في أرض تجب قسمتها" فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة" رواه أبو عبيد في الغريب والمنقبة: طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد "ويتبعها" أي الأرض "الغراس والبناء" فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها لا إن بيعا منفردين "لا الثمرة والزرع" إذا بيعا مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار "فلا شفعة لجار" لحديث جابر السابق.
"وهي" أي الشفعة "على الفور وقت علمه فان لم يطلبها إذن" أي وقت علم الشفيع بالبيع " بلا عذر بطلت" لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة لمن واثبها" وفي رواية: "الشفعة كحل العقال" رواه ابن ماجة فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر.
"وإن قال" الشفيع "للمشتري: بعني" ما اشتريت "أو" صالحني سقطت لفوات الفور "أو كذب العدل" المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر فإن كذب
ـــــــ
= في ذلك كان للقاضي أن يقدر قيمة الأرض بما يعادل قيمة مثلها إلا إن وجد ثالث يؤدي الثمن المطلوب والشفعة في كل مال مشترك ما لم يقسم فإن وقعت الحدود فلا شفعة ولا شفعة لكافر على مسلم.
فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه "أو طلب" الشفيع "أخذ البعض" أي بعض الحصة المبيعة "سقطت" شفعته لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. "والشفعة لـ" شريكين "اثنين بقدر حقيهما" لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس فباع رب الثلث فالمسألة من ستة والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد " فإن عفا أحدهما" أي أحد الشفيعين "أخذ الأخر الكل أو ترك" الكل لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه.
"وإن اشترى اثنان حق واحد" فللشفيع أخذ حق أحدهما لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين "أو عكسه" بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما لأن تعدد البائع كتعدد المشتري "أو اشترى واحد شقصين" بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض.
"وإن باع شقصا وسيفا" في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره "أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن" لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة "ولا شفعة بشركة وقف" لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به ولأن مستحقه غير تام الملك ولا شفعة أيضا بـ " غير ملك" للرقبة "سابق" بأن كان شريكا في المنفعة كالموصي له بها أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر ولا شفعة "لكافر على مسلم" لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
فصل
"وإن تصرف مشتريه" أي مشتري شقص تثبت فيه الشفعة "بوقفه أو هبته أو رهنه" أو صدقة به "لا بوصية سقطت الشفعة" لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه لأنه ملكه بغير عوض ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية و إن تصرف المشتري فيه "ببيع فله" أي الشفيع "أخذه بأحد البيعين" لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما ولأنه شفيع في العقدين
فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له وان أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذا.
"وللمشتري الغلة" الحاصلة قبل الأخذ و له أيضا "النماء المنفصل" لأنه من ملكه والخراج بالضمان و له أيضا "الزرع والثمرة الظاهرة" أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد و الجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه
وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب "فإن بنى" المشتري "أو غرس" في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى "فللشفيع تملكه بقيمته" دفعا للضرر فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.
"و" للشفيع "قلعه ويغرم نقصه" أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فإن أبى فلا شفعة ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته "بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت" الشفعة لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول "و" إن مات "بعده" أي بعد الطلب ثبتت "لوارثه" لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده "ويأخذ" الشفيع الشقص "بكل الثمن" الذي استقر عليه العقد لحديث جابر: "فهو أحق به بالثمن" رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم "فإن عجز عن" الثمن أو " بعضه سقطت شفعته" لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشترى قبوله وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره لأن الشفعة قهري والبيع عن رضى ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام.
"و" الثمن "المؤجل يأخذ" الشفيع "المليء به" لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته "وضده" أي ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا " بكفيل ملئ" دفعا للضرر وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. "ويقبل في الخلف" في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما "قول المشتري" مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف
الغاصب ونحوه "فإن قال" المشتري: "اشتريته بألف أخذ الشفيع به" أي بالألف "ولو أثبت البائع" أن البيع "بأكثر" من الألف مؤاخذة للمشترى بإقراره فإن قال: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره
ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص فقال: ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد "وإن أقر البائع بالبيع" في الشقص المشفوع "وأنكر المشتري" شراءه "وجبت" الشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإن أسقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري "وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع" في غير الصورة الأخيرة فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب ثم يرجع المشتري على البائع فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد ومصر والشام لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه.
20-
باب الوديعة
من ودع الشيء: إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل فيه كذلك. ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها ويكره لغيره إلا برضى ربها."و إذا تلفت" الوديعة "من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن" لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه" رواه ابن ماجة وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا.
"ويلزمه" أي المودع "حفظها في حرز مثلها" عرفا كما يحفظ ماله لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن "فإن عينه" أي الحرز "صاحبها فأحرزها بدونه ضمن" سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله و إن أحرزها " بمثله أو أحرز" منه "فلا" ضمان عليه لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. "وإن قطع العلف عن الدابة" المودعة "بغير قول صاحبها ضمن" لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا وإن نهاه المالك عن علفها
وسقيها لم يضمن إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها لكن يأثم بترك علفها إذا لحرمة الحيوان.
"وإن عين جيبه" بان قال له: احفظها في جيبك "فتركها في كمه أو يده ضمن" لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده " وعكسه بعكسه" فإذا قال له: اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز وإن قال: اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس أو قال: اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز.
"وإن دفعها إلى من يحفظ ماله" عادة كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ "مال ربها لم يضمن" لجريان العادة به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع "وعكسه الأجنبي والحاكم" بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر "ولا يطالبان" أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط "إن جهلا" جزم به في الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين وقال القاضي: له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فعلى الأول وجزم بمعناه في المنتهى.
"وإن حدث خوف أو" حدث للمودع "سفر ردها على ربها" أو وكيله فيها لأن في ذلك تخليصا له من دركها فإن دفعها للحاكم إذن ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر "فإن غاب" ربها "حملها" المودع "معه" في السفر سواء كان لضرورة أو لا "إن كان أحرز" ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي "وإلا" يكن السفر أحفظ لها أو كان نهي عنه دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غررا لأنه عرضة للنهب وغيره والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له فإن تعذر حاكم "أودعها أهل ثقة" لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها ولأنه موضع حاجة وكذا حكم من حضره الموت.
"ومن" تعدى في الوديعة بأن "أودع دابة فركبها لغير نفعها" أي علفها وسقيها "أو" أودع "ثوبا فلبسه" لغير خوف من عث أو نحوه أو أودع "دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها" إلى حرزها "أو رفع الختم" عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز "أو خلطها" بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره "فضاع الكل ضمن" الوديعة لتعديه وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع ومن أودعه صبي وديعة لم
يبرأ إلا بردها لوليه ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته1.
فصل
"ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها" أو من يحفظ ماله "أو غيره بإذنه" بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. و يقبل قوله أيضا "في تلفها وعدم التفريط" بيمينه لأنه أمين لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله "فإن قال: لم تودعني ثم ثبتت" الوديعة "ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة" لأنه مكذب للبينة وان شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف في ما إذا أجاب بـ "قوله: مالك عندي شيء ونحوه" كما لو أجاب بقوله: لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة2 لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. "وإن" مات المودع و "ادعى وارثه الرد منه" أي من وارث المودع لربها "أو من مورثه" وهو المودع "لم يقبل إلا ببينة" لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع "وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم" بلا ضرر "أخذه" أي أخذ نصيبه فيسلم إليه لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن "وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر" إذا غصبت العين منهم "مطالبة غاصب العين" لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن قاله أبو الخطاب.
ـــــــ
1 أي في حدود قيمة رقبته ولصاحبه أن يؤدي عنه ما يعادل ذلك لا أكثر أو تقديمه بنفسه ليباع وتؤدي قيمته رقبته.
2 وجاهد الوديعة إن قامت عليه البنية عليه حد السرقة لحديث المخزومية التي قطعت يدها لجحدها الوديعة وجاحد الوديعة حاله حال فهو أخذ الشيء من حرز لأن الأمانة حرز والمؤتمن مسؤول وعن حفظها.
21-
باب إحياء الموات
بفتح الميم والواو "وهي" مشتقة من الموت وهو عدم الحياة واصطلاحا: "الأرضالمنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" بخلاف الطرق و الأقنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها لحديث جابر يرفعه: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" رواه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة مثله رواه مالك وأبو داود وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم "من مسلم وكافر" ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم لكن على الذمي خراج ما أحيى من موات عنوة "بإذن الإمام" في الإحياء "وعدمه" لعموم الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن "في دار الإسلام وغيرها" فجميع البلاد سواء في ذلك "والعنوة" كأرض مصر والشام والعراق "كغيرها" مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج.
"ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته" لعموم ما تقدم وانتفاء المانع فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونحوه لم يملك وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء وليس للإمام إقطاعه وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع "ومن أحاط مواتا" بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه سواء أرادها للبناء أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط حائطا على أرض فهي له" رواه أحمد وأبو داود عن جابر "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" فقد أحياه "أو أجراه" أي الماء إليه أي إلى الموات "من عين ونحوها أو حبسه" أي الماء "عنه" أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع فقد أحياه لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع.
"ويملك" المحيي "حريم البئر العادية" بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يردها عادا بعينها "خمسين ذراعا" من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه "وحريم البدية" المحدثة "نصفها" خمسة وعشرون ذراعا لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا
وحريم شجرة: قدر مد أغصانها وحريم دار من موات حوالها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب
و لاحريم لدار محفوفة بملك ويتصرف كل منهم بحسب العادة ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به ووارثه من بعده وليس له
بيعه "وللإمام إقطاع موات لمن يحييه" لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق "ولا يملكه" بالإقطاع بل هو أحق من غيره فإذا أحياه ملكه.
وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة "وله إقطاع الجلوس" للبيع والشراء "في الطرق الواسعة" ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة "ويكون" المقطع له أ"حق بجلوسها" ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ويسمى هذا إقطاع إرفاق "ومن غير إقطاع" للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق " لمن سبق بالجلوس ما في قماشه فيها وإن طال" جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره: فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك
"وان سبق اثنان" فأكثر إليها وضاقت اقترعا لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما " ولمن في أعلى الماء المباح" كماء مطر " السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه" فيفعل كذلك وهلم جرا فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: "استق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" متفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء.
وللإمام دون غيره حمى مرعى" أي أن يمنع الناس من مرعى "لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة "ما لم يضرهم" بالتضييق عليهم لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه
و لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه مادام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا
ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة.
22-
باب الجعالة
بتثليث الجيم قاله ابن مالك قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. "وهي" اصطلاحا: "أن يجعل" جائز التصرف شيئا متمولا "معلوما لمن يعمل له عملا معلوما" كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا أو عملا "مجهولا مدة معلومة" كشهر كذا أو مدة مجهولة فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة ودليلها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} 1.و حديث اللديغ والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه "كرد عبد ولقطة" فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه "و" كـ " خياطة وبناء حائط" وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال " فمن فعل بعد علمه بقوله" أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا " استحقه" لأن العقد استقر بتمام العمل. "والجماعة" إذا عملوه "يقتسمونه" بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي بستحق به العوض فاشتركوا فيه و إن بلغه الجعل "في أثنائه" أي أثناء العمل "يأخذ قسط تمامه" لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه فلم يستحق به عوضا وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك "و" الجعالة عقد جائز "لكل" منهما "فسخها" كالمضاربة.
فـ متى كان الفسخ "من العامل" قبل تمام العمل فإنه "لا يستحق شيئا" لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه و إن كان الفسخ "من الجاعل بعد الشروع" في العمل فـ "للعامل أجرة مثل عمله" لأنه عمله بعوض لم يسلم له وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز "ومع الاختلاف في أصله" أي أصل الجعل "أو قدره يقبل قول الجاعل" لأنه منكر والأصل براءة ذمته.
"ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل" ولا إذن "لم يستحق عوضا" لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا وإلا "دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق" من المصر أو خارجه روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة
ـــــــ
1 سورة يوسف من الآية "72".
وعمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. "ويرجع" راد الآبق "بنفقته أيضا" لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع ولو هرب في الطريق وإن مات السيد رجع في تركته وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوالع الإبل وإن باعه ففاسد.
23-
باب اللقطة
اللقطة: بضم اللام وفتح القاف - ويقال: لقاطة - بضم اللام ولقطة - بفتح اللام والقاف1."وهي مال أو مختص ضل عن ربه" قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. "و" يعتبر فيما يجب تعريفه أن "تتبعه همة أوساط الناس" بأن يهتموا في طلبه "فأما الرغيف والسوط" - وهو الذي يضرب به - وفي شرح المهذب: هو فوق القضيب ودون العصا "ونحوهما" كشسع النعل "فيملك" بالالتقاط "بلا تعريف" ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله "وما امتنع من سبع صغير" كذئب ويرد الماء "كثور وجمل ونحوهما" كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها: الضوال والهوامى والهوامل "حرم أخذه" لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: "ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" متفق عليه
وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال أي: مخطئ فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير
"وله التقاط غير ذلك" أي: غير ما تقدم من الضوال ونحوها "من حيوان" كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء "وغيره" كأثمان ومتاع "إن أمن نفسه على ذلك" وقوي على تعريفها لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي
ـــــــ
1 اللقطة هي كل مال أو متاع متروكا أو مرميا في أرض لا يحفظ مثله في مثلها في غير حرز وهي غير قادرة على حرز نفسها ولا يكون حيوانا لأن الحيوان يسمى ضالا.
لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه مختصرا والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر. "وإلا" يأمن نفسه عليها "فهو كغاصب" فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف يمكن تجفيفه.
"ويعرف الجميع" وجوبا لحديث زيد السابق نهارا "في مجامع الناس" كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذا كل يوم أسبوعا ثم عرفا وأجرة المنادي على الملتقط.
"ويملكه بعده" أي بعد التعريف "حكما" أي من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف "لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها" أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها "فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه" بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقة لحديث زيد وفيه: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" رواه مسلم ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط.
"والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما" لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها فإن لم تعرف فهي لهما وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. "ومن ترك حيوانا" لا عبدا أو متاعا "بفلاة لانقطاعه أو "عجز ربه عنه ملكه آخذه" بخلاف عبد ومتاع وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل "ومن أخذ نعله" ونحوه من متاعه "ووجد موضعه غيره فلقطة" ويأخذ حقه منه بعد تعريفه
وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له.
24-
باب اللقيط
بمعنى ملقوط "وهو" اصطلاحا: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ" أي طرح في شارع أو غيره "أو ضل" و "أخذه فرض كفاية" لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} 1. ويسن الإشهاد عليه وهو حر في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض."وما وجد معه" من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه "أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره" مشدودا بثيابه "أو" مطروحا "قريبا منه فـ" هو له عملا بالظاهر ولأن له يدا صحيحة كالبالغ "وينفق عليه منه" ملتقطه بالمعروف لولاية عليه "وإلا" يكن معه شيء "فمن بيت المال" لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه ولا يجب على الملتقط فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين فإن تركوه أثموا "وهو مسلم" إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار
"وحضانته لواجده الأمين" لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالح "وينفق علي"ه مما وجد معه من نقد أو غيره "بغير إذن حاكم" لأنه وليه وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده "وميراثه وديته" كدية حر "لبيت المال" إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" . "ووليه في" القتل "العمد" العدوان " الإمام يتخير بين القصاص والدية" لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه و نحوه.
"وإن أقر رجل أو امرأة" ولو "ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق" به لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه "ولو بعد موت اللقيط" فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب "ولا يتبع" اللقيط " الكافر" المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة وكذا لا يتبع رقيقا في رقه.
ـــــــ
1 سورة المائدة من الآية "2".
"وإن اعترف" اللقيط " بالرق مع سبق مناف" للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه " أو قال" اللقيط بعد بلوغه: " إنه كافر لم يقبل منه" لأنه محكوم بإسلامه و يستتاب فإن تاب وإلا قتل. " وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة" مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه " وإلا" يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة " فمن ألحقته القافة به" لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبره وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما.
كتاب الوقف
مدخل
9- كتاب الوقفيقال: وقف الشئ وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها.
"وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" على بر أو قربة والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف.
"ويصح" الوقف "بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه" أو أذن فيه وأقام أو جعل أرضه "مقبرة وأذن" للناس "في الدفن فيها" أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفي دلالة على الوقف.
"وصريحه" أي صريح القول: "وقفت وحبست وسبلت" فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد "وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت" لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي "فتشرط النية مع الكناية أو اقتران" الكناية بـ " أحد الألفاظ الخمسة" الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف "أو" اقترانها بـ " حكم الوقف" كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث.
"ويشترط فيه" أربعة شروطالأول - "المنفعة" أي أن تكون العين ينتفع بها "دائما من عين" فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة ي"نتفع به مع بقاء عينه" كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ويصح وقف المصحف والماء والمشاع.
"و" الشرط الثاني - "أن يكون على بر" إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه
التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود "كالمساجد والقناطر والمساكن" والسقايات وكتب العلم "والأقارب من مسلم وذمي" لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين "غير حربي" ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب "و" غير "كنيسة" وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء و غير "نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة" وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي" . ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة "وكذا الوصية" فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه
"و" كذا "الوقف على نفسه" قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرج الله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها كان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة.
والشرط الثالث – ما أشار إليه بقوله: "ويشترط في غير" الوقف على " المسجد ونحوه" كالرباط والقنطرة "أن يكون على معين يملك" ملكا ثابتا لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على عبد ومكاتب و لا على "ملك" وجني وميت و " حيوان وحمل" أصالة ولا على من سيولد ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا.
الشرط الرابع - أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في الشرح "لا قبوله" أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين "ولا إخراجه عن يده" لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلا يعتبر فيه ذلك كالعتق وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر أقاربه أولى الناس ببره فإن لم يكونوا فعلى المساكين.
فصل
"ويجب العمل بشرط الواقف" لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة "في جمع" بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه "وتقديم" بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين1 أو المريض ونحوه "وضد ذلك" فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده فضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان "واعتبار وصف أو عدمه" بأن يقول: على أولادي الفقهاء فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم والترتيب بأن يقول: على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم "ونظر" بأن يقول: الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها "وغير ذلك" كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي " فإن أطلق" في الموقوف عليه "ولم يشترط" وصفا "استوى الغني والذكر وضدهما" أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص والنظر فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر "للموقوف عليه" المعين لأن ملكه وغلته له فإن كان واحدا استقل به مطلقا وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه.
"و إن وقف على ولده" أو أولاده "أو ولد غيره ثم على المسكين فهو لولده" الموجود حين "الوقف الذكور والإناث" والخناثى لأن اللفظ يشملهم "بالسوية" لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشئ ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان لأنه لا يسمي ولده "ثم" بعد أولاده لـ " ولد بنيه" وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا " دون" ولد "بناته" فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 2 " كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه" أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة والعطف بـ ثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده والعطف بالواو
ـــــــ
1 الأدين: الأكثر تدينا وصلاحا.
2 سورة النساء من الآية "11".
للتشريك " ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم" لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى: {أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ} "إلا أن يكونوا قبيلة" كبني هاشم وتميم وقضاعة "فيدخل فيه النساء" لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسائه "يشمل الذكر والأنثى من أولاده و" أولاد " أبيه و" أولاد "جده و" أولاد " جد أبيه" فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد لأن الرحم يشملهم والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل.
"وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو" تقتضي "حرمانهن عمل بها" أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ.
"و إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم" كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة "وجب تعميمهم والتساوي" بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم
"وإلا" يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن "وجاز التفضيل" لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه "والاقتصار على أحدهم" لأن مقصود الواقف بر بذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم وإن عين إماما أو نحوه تعين والوصية في ذلك كالوقف.
فصل
"والوقف عقد لازم" بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم العتق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث" قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فـ "لا يجوز نسخه" بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد "ولا يباع" ولا ينقل به "إلا أن تعطل منافعه" بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد - لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب - أن انقل المسجد
الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال بالمسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع.
ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد "ويصرف ثمنه في مثله" لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو "ولو أنه" أي الوقف "مسجد" ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته "وآلته" أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته "وما فضل عن حاجته" من حصره وزيته ونفقته ونحوها "جاز صرفه إلى مسجد آخر" لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له "والصدقة به على فقراء المسلمين" لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة1 وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع وإن وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته.
ـــــــ
1 خلقان الكعبة: الستائر القديمة التي لم تعد تصلح لها.
باب الهبة والعطية
مدخل
1- باب الهبة والعطية2الهبة: من هبوب الريح أي مروره يقال: وهب له شيئا وهبا - بإسكان الهاء - وفتحها - وهبة والاتهاب: قبول الهبة والاستيهاب: سؤال الهبة والعطية هنا: الهبة في مرض الموت "وهي التبرع" من جائز التصرف "بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره" - مفعول تمليك - بما يعد هبة عرفا فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وبالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال نحو الكلب وبالمعلوم المجهول وبالموجود المعدوم - فلا تصح الهبة فيها - وبالحياة الوصية. "وإن شرط" العاقد "فيها عوضا معلوما
ـــــــ
2 والهبة نوعان الهبة بمقابل وهي الهبة بغير مقابل وعي على ثلاث أحوال.
أ- هبة الدين وهو إبراء الدائن لذمة المدين من الدين الذي لا يقدر على سداده سواه أو بحجز عن ذلك لسبب ما.
ب- العطية وهو ما يعطيه المريض مرض الموت لغير ذوي الميراث من أقاربه الفقراء.
ج- الصدقة وهي هبة في سبيل الله يطلب بها ثواب رب العالمين في الآخره.
فـ" هي "بيع" لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه.
"ولا يصح" أن يهب "مجهولا" كالحمل في البطن واللبن في الضرع "إلا ما تعذر علمه" كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد1.
"وتنعقد" الهبة "بالإيجاب" والقبول بأن يقول: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول: قبلت أو رضيت ونحوه أو بـ "المعاطات الدالة عليها" أي على الهبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا.
"وتلزم بالقبض بإذن واهب" لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف "إلا ما كان في يد متهب" وديعة أو غصبا ونحوهما لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء.
"ووارث الواهب" إذا مات قبل القبض "يقوم مقامه" في الإذن والرجوع لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار وتبطل بموت المتهب ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده.
ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه ب"لفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها" كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو " برئت ذمته ولو" رده و "لم يقبل" لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ولو كان المبرأ منه مجهولا لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل " وتجوز هبة كل عين تباع" وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما "و" هبة "كلب يقتنى" ونجاسة يباح نفعها كالوصية ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو: جعلتها لك
ـــــــ
1 الشارد: أي الجمل الشارد.
عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت1 فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده وإن قال: سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع2. ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه.
ـــــــ
1 وهذه تسمى العمرى.
2 وهذه تسمى المنيحة.
فصل في الرجوع في الهبة
"يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم" 3 للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد "فإن فضل لبعضهم" بان أعطاه فوق إرثه أو حصته "سوى" وجوبا "برجوع" حيث أمكن "أو زيادة" المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه مختصرا وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه "فإن مات" الواهب "قبله" أي قبل الرجوع أو الزيادة "ثبتت" للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين."ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة" لحديث ابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" متفق عليه "إلا الأب" فله الرجوع قصد التسوية أو لا مسلما كان أو كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك "وله" أي لأب حر " أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه" لحديث عائشة مرفوعا: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا أو لا
ـــــــ
3 فلا يصح أن يختص بعض أولاده بعطية أ, هبة دون الآخرين لقوله صلى الله عليه وسلم "أكل ولدك نحلته مثل هذا" الحديث وفيه النهي عن ذلك.
وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف فإن تصرف والده في "ماله" قبل تملكه وقبضه "ولو فيما وهبه له" أي لولده وأقبضه إياه "ببيع" أو هبة "أو عتيق أو إبراء" غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز "أو أراد أخذه" أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده "قبل رجوعه" في هبته بالقول كرجعت فيها أو أراد أخذ مال ولده قبل "تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح" تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده أي بعد لقبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.
"وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه" كقيمة متلف وأرش جناية لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال: "أنت ومالك لأبيك" "إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها" لضرورة حفظ النفس وله لطلب بعين مال له بيد أبيه فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته والصدقة: وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية: وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم ووعاء هدية كهي1 مع عرف.
ـــــــ
1 كهي: أي كالهدية.
فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها
"من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع" أي وجع رأس يسير "فتصرفه لازم ك" تصرف "الصحيح ولو" صار مخوفا و "مات منه اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح"."وإن كان" المرض الذي اتصل به الموت "مخوفا كبرسام" 2 وهو
ـــــــ
2 مرض عصبي يسبب اختلالا في الدماغ.
بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه "وذات الجنب" قرحة بباطن الجنب1 "ووجع قلب" ورئة لا تسكن حركتها "ودوام قيام" وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه2 " و" دوام "رعاف" لأنه يصفي الدم فتذهب القوة3 "وأول فالج" وهو داء معروف يرخي بعض البدن وآخر سل بكسر السين والحمى المطبقة "و" حمى "الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف" فعطاياه كوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" رواه ابن ماجة.
"ومن وقع الطاعون ببلده" أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل ومن أخذها الطلق حتى تنجو "لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا بما فوق الثلث" ولو لأجنبي "إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه" كوصية لما تقدم لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض "وإن عوفي" من ذلك "فكصحيح" في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع "ومن امتد مرضه بجذام أو سل" في ابتدائه "أو فالج" في انتهائه "ولم يقطعه فراش ف" عطاياه "من كل ماله" لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف "ويعتبر الثلث عند موته" لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة ونماء لعطية من القبول إلى الموت تبع لها ومعاوضة المريض بثمن لمثل من رأس المال والمحاباة كعطية.
"و" تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء.
أحدها: أنه "يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية" لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة "ويبدأ بالأول فالأول في العطية" لوقوعها لازمة.
و الثاني: أنه "لا يملك الرجوع فيها" أي في العطية بعد قبضها كلها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطي في الحياة ولو كثرت وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها.
و الثالث: أن العطية "يعتبر القبول لها عند وجودها" لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده.
ـــــــ
1 هي داء السل أو تشمع الكبد.
2 هو الهواء الأصفر المعروف بداء الكوليرا.
3 هو الهيموفيليا: أي نقص عوامل التجلط في الدم.
"و" الرابع: أن العطية "يثبت الملك" فيها "إذن" أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوفقنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره "والوصية بخلاف ذلك" فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه واذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث وإن قال: أنت حر آخر حياتي عتق وورث.
كتاب الوصايا
مدخل
10- كتاب الوصاياجمع وصية مأخوذة من وصيت الشئ: إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. و اصطلاحا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.
و "يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير" عرفا "أن يوصي بالخمس" روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} 1.
"ولا تجوز" الوصية "بأكثر من الثلث لأجنبي" لمن له وارث "ولا لوارث بشئ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله ؟ قال: "لا" قال: بالشطر ؟ قال: لا قال: "الثلث والثلث كثير" متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوارث في القدر لا في العين والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث ف إنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ: أجزت أو أمضيت أو أنفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة.
"وتكره وصية فقير" عرفا "وارثه محتاج" لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب.
"وتجوز" الوصية "بالكل لمن لا وارث له" روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد
ـــــــ
1 سورة الأنفال من الآية "41".
على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع "وان لم يف الثلث بالوصايا" أولم تجز الورثة " فالنقص" على الجميع "بالقسط" فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول. "وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث" كأخ حجب بابن تجدد "صحت" الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له "والعكس بالعكس" فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. "ويعتبر" لملك الموصى له المعين الموصى به "القبول" بالقول أو ما قام مقامه كالهبة "بعد الموت" لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح "وإن طال الزمن" بين القبول والموت و لا يصح القبول "قبله" أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت "ويثبت الملك به" أي بالقبول "عقب الموت" قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها " ومن قبلها" أي الوصية "ثم ردها" ولو قبل القبض "لم يصح الرد" لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها.
"ويجوز الرجوع في الوصية" لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته فإذا قال: رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. "وإن قال" الموصي: "إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم زيد في حياته" أي حياة الموصي "فله" أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد "و" إن قدم زيد "بعدها" أي بعد حياة الموصي فالوصية "لعمرو" لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه.
ويخرج وصي فوارث فحاكم "الواجب كله من دين وحج وغيره" كزكاة ونذر وكفارة "من كل ماله بعد موته وان لم يوص به" لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1 ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي "فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به" أي بالواجب "فإن بقي منه" أي الثلث "شيء أخذه
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "11".
صاحب التبرع" لتعيين الموصي "وإلا" يفضل شيء "سقط" التبرع لأنه لم يوص له بشئ إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال.
1-
باب الموصى له
"تصح" الوصية "لمن يصح تملكه" من مسلم وكافر1 لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً} 2 قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده "ولعبده بمشاع كثلث" لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله "ويعتق منه بقدره" أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيه العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته "ويأخذ الفاضل" من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث "و" إن وصى "بمائة أو" بـ " معين" كدار وثوب "لا تصح" هذه الوصية "له" أي لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره."وتصح" الوصية "بحمل" تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث. و تصح أيضا " لحمل تحقق وجوده قبلها" أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة.
"وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ" الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ وإن قال: حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه.
"ولا تصح" الوصية "لملك" وجني "وبهيمة وميت" كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم " فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي" لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده "وإن جهل" موته "ف" للحي "النصف" من الموصى به
ـــــــ
1 ولا يرث القاتل من المقتول ولا تصح الوصية له وإن كان قد أوصى له قبل قتله إياه أو بجرح أدى إلى وفاته وسواء كان عمدا أو خطأ بطلت الوصية له.
2 سورة الأحزاب من الآية "6".
لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. و لا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها. وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته فله التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصي له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج1 غير وارثين لم يوص دم فهم أحق به.
ـــــــ
1 محاويج: محتاجين.
2-
باب الموصى به
1"تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء" وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى.
"و" تصح "بالمعدوم ك" وصية بـ " ما يحمل حيوانه" وأمته وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع
"فإن" حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية "وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية" لأنها لم تصادف محلا وتصح بـ بما فيه نفع مباح من "كلب صيد ونحوه" كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد "و" للموصى "له ثلثهما" أي ثلث الكلب والزيت المتنجس "ولو كثر المال إن لم تجز الورثة" لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية.
"وتصح بمجهول كعبد وشاة" لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى "ويعطى" الموصى له "ما يقع عليه الاسم" لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم "العرفي" في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم وقال الأصحاب: تغلب الحقيقة لأنها الأصل "وإذا وصى بثلثه" أو نحوه "فاستحدث مالا ولو دية" بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته "دخل" ذلك "في الوصية" لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. "ومن أوصى له بمعين فتلف" قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول "بطلت" الوصية لزوال حق الموصى له "وإن تلف المال كله غيره" أي غير المعين الموصى به "فهو للموصى له" لأن حقوق الورثة لم تتعلق
ـــــــ
1 ولا وصية لإنسان فيما لا يملك وفيما يشك بإمكان قبضه ولا بمجهول ولا يعرف حده أو نوعه.
به لتعيينه للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة" وإلا فبقدر الورثة والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله.
3-
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء. "وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة" فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية وكذا لو أسقط لفظ مثل "فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه" أو بنصيبه "وله ابنان فله" أي للموصى له الثلث لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه "وإن كانوا ثلاثة ف" للموصى "له الربع" لما سبق "وإن كان معهم بنت فله التسعان" لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان "وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين" ذلك الوارث "كان له مثل ما لأقلهم نصيبا" لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه "فمع ابن وبنت" له "ربع" مثل نصيب البنت "ومع زوجة وابن" له "تسع" مثل نصيب الزوجة وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه له أربعة أمثاله وهكذا. "و" إن أوصى" بسهم من ماله فله سدس" بمنزلة سدس مفروض وهو قول علي وابن مسعود لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السدس. و إن أوصى "بشئ أو جزء أو حظ" أو نصيب أو قسط "أعطاه الوارث ما شاء" مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان علي إطلاقه.4-
باب الموصى إليه
لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم "تصح وصية المسلم إلى كل" مسلم "مكلف عدل رشيد ولو" امرأة أو مستورا أو عاجزا ويضم إليه أمين أو "عبدا" لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر "ويقبل" عبد غير الموصي "بإذن سيده" لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه وإذا " أوصى إلى زيد و" أوصى بعده "إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا" كما لو أوصى إليهماكتاب الفرائض
مدخل
مدخل
11- كتاب الفرائضجمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما" رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له.
"وهي" أي الفرائض "العلم بقسمة المواريث" جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت ويقال له أيضا: التراث ويسمى العارف بهذا العلم: فارضا وفريضا وفرضيا وفرائضيا وقد منعه بعضهم ورده غيرهم.
"أسباب الإرث" وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده ثلاثةأحدها : "رحم" أي قرابة قربت أو بعدت قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 1.
"و" الثاني : "نكاح" وهو عقد الزوجية الصحيح قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} 2.
"و" الثالث : "ولاء" عتق لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم لغير أم وابنه والزوج وذو الولاء ومن
ـــــــ
1 الأنفال من الآية "75" وسورة الأحزاب من الآية "6".
2 سورة النساء من الآية "12".
الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.
"والورثة" ثلاثة: " ذو فرض وعصبة و" ذو "رحم" ويأتي بيانهم وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج وجميع النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة وممكن الجمع من الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين.
"فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات" الواحدة فأكثر "وبنات الابن" كذلك والأخوات من كل جهة كذلك "والإخوة من الأم" كذلك ذكورا كانوا أو إناثا "فللزوج النصف" مع عدم الولد وولد الابن "ومع وجود ولد" وارث "أو ولد ابن" وارث "وإن نزل" ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا "الربع" لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} 1 "وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما" فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وثمن معه لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 1.
"ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن" أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 2 " ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد" الذكر والأنثى "و" عدم "ولد الابن" كذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2 فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب "و" يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"
فصل
"والجد لأب وإن علا" بمحض الذكور "مع ولد أبوبن أو" ولد "أب" ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا " كأخ منهم" في قاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "12".
2 سورة النساء من الآية "11".
وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان والأخ سهمان والأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي
"فإن نقصت" أي الجد "المقاسمة عن ثلث المال" إذا لم يكن معهم صاحب فرض "أعطيه" أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين "ومع ذي فرض" كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر " الأحظ من المقاسمة" كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم أو ثلث مابقي كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان "أو سدس الكل" كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة " فان لم يبق" بعد ذوي الفروض "سوى السدس" كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة "أعطيه" أي أعطي الجد السدس الباقي "وسقط الإخوة" مطلقا لاستغرق الفروض التركة إلا الأخت "في الأكدرية" وهي: زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة سميت أكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة "ولا يعول" في مسائل الجد غيرها " ولا يفرض للأخت معه" أي مع الجد ابتداء "إلا بها" أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر "إذا انفردوا" عن ولد الأبوين "معه" أي مع الجد "كولد الأبوين" فيما سبق "فإن اجتمعوا" أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب "ف" إذا "قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب" كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب "و" تأخذ "أنثاهم" إذا كانت واحدة "تمام فرضها" وهو النصف "وما بقي لولد الأب" فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء
فصل أحوال الأم
"وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن" ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} 1 "أو اثنين" فأكثر "من إخوة أو أخوات" أو منهما لمفهوم قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 1. "و" لها "الثلث مع عدمهم" أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1. "و" ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما ا"لسدس مع زوج وأبوين" فتصح من ستة "و" إما "الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما" أي مثلا النصيبين في المسألتين وتسميان بالغراوين والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط.ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "11".
فصل في ميراث الجدة
في ميراث الجدة "ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب" فقط "وإن علون أمومة السدس" لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني فإن انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث و "تحاذين" أي تساوين في القرب أو البعد من الميت "ف" السدس "لها وحدها" مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى. "وترث أم الأب و" أم " الجد معهما" أي مع الأب والجد "كـ" ما يرثان "مع العم" روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنه "وترث الجدة" المدلية "بقرابتين" مع الجدة ذات القرابة لواحدة "ثلثي السدس" وللأخرى ثلثه "فلو تزوج بنت خاله" فأتت بولد "فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته" فأتت بولد "فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه" فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث.فصل في ميراث البنات وبنات الإبن والأخوات
"والنصف فرض بنت" إذا كانت "وحدها" بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1 "ثم هو" أي النصف "لبنت ابن وحدها" إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها أو يعصبها "ثم" عند عدمهما "لأخت لأبوين" عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها "أو" أخت "لأب وحدها" عند عدم الشقيقة وانفرادها "والثلثان لثنتين" من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب "فأكثر" لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 1 وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين وقال تعالى في الأختين: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 2 " إذا لم يعصبن بذكر" بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين "والسدس لبنت ابن فأكثر" وإن نزل أبوها تكملة الثلثين "مع بنت" واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله: إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري "ولأخت فأكثر لأب مع أخت" واحدة "لأبوين" السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب "مع عدم معصب فيهما" أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين "فإن استكمل الثلثين بنات" بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن أو استكمل الثلثين "هما" أي بنت وبنت ابن "سقط من دونهن" كبنات ابن ابن "ان لم يعصبهن ذكر بإزائهن" أي بدرجتهن "أو أنزل منهن" من بني الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه "وكذا الأخوات من الأب" يسقطن "مع أخوات لأبوين" اثنتين فأكثر "إن لم يعصبهن أخوهن" المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه "والأخت فاكثر" شقيقة كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر "ترث ما فضل عن فرض البنت" أو بنت الابن "فأزيد" أي فأكثر فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت "وللذكر" الواحد "أو الأنثى" الواحدة أو الخنثى "من ولد الأم السدس ولاثنين" منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين "فأزيد الثلث بينهم بالسوية" لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُواـــــــ
1 سورة النساء من الآية "11".
2 سورة النساء من الآية "176"
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 1 أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "12".
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع واصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول: حجب حرمان وهو المراد هنا. "يسقط الأجداد بالأب" لإدلائهم به "و" يسقط " الأبعد" من الأجداد "بالأقرب" كذلك "و" تسقط "الجدات" من قبل "الأم" والأب بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادةو يسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه "و" يسقط " ولد الأبوين" ذكرا كان أو أنثى "بابن وابن ابن" وإن نزل "وأب" حكاه ابن المنذر إجماعا " و" يسقط " ولد الأب بهم" أي بالابن وابنه وإن نزل والأب "وبالأخ لأبوين" وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن و يسقط "ولد الأم بالولد" ذكرا كان أو أنثى "وبولد الابن" كذلك "وبالأب وأبيه" وإن علا "ويسقط به" أي بأبي الأب وإن علا" كل ابن أخ و" كل "عم" وابنه لقربه ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا.
1-
باب العصبات
من العصب وهو الشد سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض "وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة" كالأب والابن والعم ونحوهم واحترز بقوله: بجهة واحدة عن ذي الفرض فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين "ومع ذي فرض يأخذ ما بقي" بعد ذوي الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة "فأقربهم ابن فابنة وإن نزل" لأنه جزء الميت "ثم الأب" لأن سائر العصبات يدلون به "ثم الجد" أبوه "وإن علا" لأنه أب وله إيلاء "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم " ثم هما" أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب "ثم بنوهما" أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا "أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك" فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب "ثم أعمام أبيه لأبوين ثم" أعمام أبيه "لأب ثم بنوهم كذلك" يقدم ابن الشقيق على ابن الأب "ثم أعمام جدهم ثم بنوهم2-
باب أصول المسائل والعول والرد
أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها " والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس" هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد."و الأصول سبعة" أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول "فنصفان" من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب وتسميا باليتيمتين "أو نصف وما بقي" كزوج وعم "من اثنين" مخرج النصف " وثلثان" وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم "أو ثلث وما بقي" كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها "من ثلاثة" لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما "وربع" وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع " أو ثمن وما بقي" كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن أو ربع مع النصف كزوج وبنت "من أربعة" لدخول مخرج النصف في مخرج الربع "و" ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم "من ثمانية" لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن "فهذه أربعة" أصول "لا تعول" لأن العول: ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة "والنصف مع الثلثين" كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة "أو" النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين "أو" النصف مع "السدس" كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس "أو هو" أي السدس "وما بقي" كأم وابن "من ستة" مخرج السدس.
"وتعول" الستة "إلى عشرة شفعا ووترا" فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها "والربع مع الثلثين" كزوج وبنتين وعم من اثني عثر لتباين المخرجين "أو" الربع مع "الثلث" كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن "من اثني عشر" للتوافق "وتعول" الاثنا عشر "إلى سبعة عشر وترا" فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ "والثمن مع السدس" كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين "أو" الثمن مع "ثلثين" كزوجة وبنتين وأخ شقيق "من أربعة وعشرين" للتباين "وتعول" مرة واحدة "إلى سبعة وعشرين" ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى المنبرية.
"وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة" معهم "رد" الفاضل "على كل" ذي "فرض بقدره" أي بقدر فرضه لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 1 "غير الزوجين" فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم.
ـــــــ
1 سورة الأنفال من الآية "75" وسورة الأحزاب من الآية "6".
باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
مدخل
التصحيح3- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر "إذا انكسر سهم فريق" أي صنف من الورثة "عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم" كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهن في أصل المسألة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة "أو" تضرب "وفقه" أي وفق عددهم "إن وافقه" أي عدد سهامهم "بجزء كثلث ونحوه" كربع ونصف "وثمن في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه" المسألة كزوج وست أخوات لغير أم أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من واحد وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان "ويصير للواحد" من الفريق المنكسر عليه "ما كان لجماعته" عند كالمثال الأول أو يصير لواحدهم "وفقه" أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح كجدتين وثلاثة إخوة لأم ستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.
ـــــــ
1 سورة الأنفال من الآية "75" وسورة الأحزاب من الآية "6".
فصل المناسخات
والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال والإزالة والتغيير أو النقل وفي الاصطلاح: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته."إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه" أي ورثة ورثة الثاني "كالأول" أي كما يرثون الأول "كإخوة" أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا "فاقسمها" أي التركة "على من بقي" من الورثة ولا تلتفت للأول "وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح" المسألة "الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته" وهي عدد بنيه "وصحح المنكسر كما سبق" كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم مات الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينها ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثني عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح للأول اثنا عشر لابنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة. "وإن لم يرثوا الثاني كالأول" بأن اختلف ميراثهم منهما "صححت" المسألة "الأولى" للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني "وقسمت أسهم الثاني" من الأول "على" مسألة "ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها" كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسالة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة: ثلاثة من أخيه وسهم منها "وإن لم تنقسم" سهام الثاني على مسألته "ضربت كل الثانية" إن باينتها سهام الثاني "أو" ضربت "وفقها للسهام" إن وافقتها "في الأولى" فما بلغ فهو الجامعة "ومن له شيء منها" أي من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق "ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت" الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة "أو وفقه" عند الموافقة ومن يرث منهما تجمع ماله منه فما اجتمع "فهو له" مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في الأول وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللأخ من
الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها ستة. ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون وللأخ في الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين "وتعمل في" الميت "الثالث فأكثر عملك في" الميت "الثاني مع الأول" فتصحح الجامعة للأوليين وتعرف سهام الثاني منها وتقسمها على مسألته فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثالثة أو وفقها ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر.
فصل في قسمة التركات
والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم "إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء" كنصف وعشر "فله" أي فلذلك الوارث من التركة "كنسبته" فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسألة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلثا خمسها فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة وان قسمت على القراريط هي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر.4-
باب ذوي الأرحام
وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة "ويورثون بالتنزيل" أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة "الذكر والأنثى" منهم "سواء" لأنهم لا يرثون إلا بالرحم المجردة فاستوى5-
باب ميراث الحمل
بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال: امرأة حامل وحاملة: إذا كانت حبلى "و" ميراث "الخنثى المشكل" الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته "من خلف ورثة فيهم حمل" يرثه "فطلبوا القسمة وقف للحمل" إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة "الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين" لأن وضعهما كثير معتاد وما زا د عليهما نادر فلم يوقف له شيء ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك "فإذا ولد أخذ حقه" من الموقوف "وما بقي فهو لمستحقه" وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده."ومن لا يحجبه" الحمل "يأخذ إرثه" كاملا "كالجدة" فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه "ومن ينقصه" الحمل "شيئا" يعطى "اليقين" كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي "ومن يسقط به" أي بالحمل "لم يعط شيئا" للشك في إرثه "ويرث" المولود ويورث "إن استهل صارخا" لحديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود "أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد" منه "دليل" على "حياته" كحركة طويلة وسعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة "غير حركة" قصيرة "واختلاج" لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة "وإن ظهر بعضه فاستهل" أي صوت "ثم مات وخرج لم يرث" ولم يورث كما لو لم يستهل "وإن جهل المستهل من التوأمين" إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل
وكانا ذكرا وأنثى "واختلف إرثهما" بالذكورة والأنوثة "يعين بقرعة" كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه.
"والخنثى" من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو "المشكل" فإن رجي كشفه لصغره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة "يرث نصف ميراث ذكر" إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ وعم خنثى "ونصف ميراث أنثى" إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما متفاضلا أعطى نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينتان فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصبح من اثني عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة وان صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه.
6-
باب ميراث المفقود
وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت "من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة" أو سياحة "انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد" لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وإن فقد ابن تسعين: اجتهد الحاكم "وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة" كدرب الحجاز "انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف" أي فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية "ثم يقسم ماله فيهما" أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين وغلبة الهلاك بعد الأربع سنين فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به"فإن مات مورثه قي مدة التربص" السابقة أخذ كل الإرث إذا أي حين الموت "اليقين" وهو ما لا يمكن أن ينقص
عنه مع حياة المفقود أو موته "ووقف ما بقي" حتى يتبين أمر المفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين "فإن قدم" المفقود "أخذ نصيبه" الذي وقف له "وإن لم يأت" أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه "فحكمه" أي حكم ما وقف له "حكم ماله" الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره "ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه" على حسب ما ينفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم.
7-
باب ميراث الغرقى
جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم "إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار" معا فلا توارث بينهما "و" إن "جهل السابق بالموت" أو علم ثم نسي "ولم يختلفوا فيه" بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر "ورث كل واحد" من الغرقى ونحوهم من الأخر من تلاد ماله أي من قديمه وهو بكسر التاء "دون ما ورثه منه" أي من الآخر "دفعا للدور" هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال يصير مال كل واحد لمولى الآخر وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا.8-
باب ميراث أهل الملل
جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين فـ " لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء" لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" رواه الدارقطني وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث "ولا" يرث "الكافر المسلم إلا بالولاء" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" متفق عليه وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق "و" اختلاف الدارين ليس بمانع فـ " يتوارث الحربي والذمي والمستأمن" إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص "وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها9-
باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان
"من أبان زوجته في صحته" لم يتوارثا "أو" أبانها "في مرضه غير المخوف ومات به" لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق "أو" أبانها في مرضه "المخوف ولم يمت به لم يتوارثا" لانقطاع النكاح وعدم التهمة بل يتوارثان في "طلاق رجعي لم تقض عدته" سواء كان في المرض أو الصحة لأن الرجعية زوجة "وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها" بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا "أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو" علق إبانتها "على فعل له" كدخوله الدار "ففعله في مرضه" المخوف "ونحوه" كما لو وطىء عاقل حماته بمرض موته المخوف لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها "وترثه" هي "في العدة وبعدها" لقضاء عثمان رضي الله عنه "ما لم تتزوج أو ترتد" فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها مادامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه.10-
باب الإقرار بمشارك في الميراث
"إذا أقر كل الورثة" المكلفين ولو أنه أي الوارث المقر "واحد" منفرد بالإرث "بوارث للميت" من ابن أو نحوه "وصدق" المقر به "أو كان" المقر به "صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه" بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت وأن لا ينازع المقر في10-
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق "من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا" كحفر بئر تعديا ونصب سكين بلا حق "لم يرثه إن لزمه" أي القاتل قود أودية أو كفارة على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمد. " والمكلف وغيره" أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا " سواء" لعموم ما سبق "وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا" أي غير ردة "أو ببغي" أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي "أو" بـ "صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه" بما يوجب القتل "أو قتل العادل الباغي وعكسه" كقتل الباغي العادل ورثه لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع من الميراث."ولا يرث الرقيق" ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي "ولا يورث" لأنه لا مال له "ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية" لقول علي وابن مسعود: وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم.
"ومن أعتق عبدا" أو أمة أو اعتق بعضه فسرى إلى الباقي وأعتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاء أو أعتقه في زكاة أو كفارة "فله عليه الولاء" لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده وإن سفلوا من زوجة عتيقه أو سريته وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله ويرث ذو الولاء مولاه
"وإن اختلف دينهما" لما تقدم فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق. " ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن" أي باشرن عتقة أو عتق عليهن بنحو كتابة "أو أعتقه من أعتقن" أي عتيق عتيقهن وأولادهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن" والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء وتسمى: مسألة القضاة يروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطئوا فيها.
كتاب العتق
مدخل
12- كتاب العتقوهو لغة: الخلوص وشرعا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
وهو من أفضل القرب لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار . وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به وعكسه بعكسه فيكره عتق من لا كسب له1 وكذا من يخاف منه زنا أو فساد وإن علم ذلك منه أو ظن حرم و صريحه نحو: أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك
وكناياته نحو: خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك ومن أعتق جزءا من رقيق سرى إلى باقيه ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته ومات ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد " ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير" 2 سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره3.
ـــــــ
1 لأنه بعتقه له وهو غير قادر على اكتساب معيشته إنما يجعله عالة على الناس فهو إن كان ذكرا إما أن يستجدي أكف الناس أو يسرق وإن كان امرأة لم تجد إلا الزنا تنال به رزقها في الحالين في عتق العاجز عن الكسب أو من لا مهنة له إنما يسبب الضرر له وللمجتمع.
2 وهو أنه يعبه حريته على أن عليه أن يخدمه مدة حياته ويتحرر بوفائه.
3 أي إن جاوزت قيمته الثلث عتق منه ما يساوي الثلث وسعى بالباقي غير مشقوق عليه.
1-
باب الكتابة
وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع لأنها تجمع نجوما. وشرعا: " بيع" سيد "عبدهنفسه بمال" معلوم يصح السلم فيه " مؤجل في ذمته" بأجلين فأكثر وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} 1 وتكره الكتابة مع عدمه أي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس. ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز تصرف وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد وإن لم يقل: فإذا أديت فأنت حر ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة و لأنه قن ما بقي عليه درهم ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء فإن أدى المكاتب له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له أي للمشتري وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابه أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا فإذا كل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو بيع عرض ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} 2 قال: ربع الكتابة وروي مرفوعا عن علي.
ـــــــ
1 سورة النور من الآية "33".
2 سورة النور من الآية "33".
2-
باب أحكام أمهات الأولاد
أصل أم أمهة ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل "إذا أولد حر أمته" ولو مدبرة أو مكاتبة "أو" أولد "أمة له ولغيره" ولو كان له جزء يسير منها "أو أمة لولده" كلها أو بعضها لم يكن الابن وطئها قد "خلق ولده حرا" بأن حملت به في ملكه "حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان" ولو خفيا لا بإلقاء "مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله" ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه: "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه" رواه أحمد وابن ماجه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه "وأحكام أم الولد" كـ " أحكام الأمة" القن "من وطء وخدمة وإجارة ونحوه" كإعارة وإيداع لأنها مملوكة له مادام حيا " لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له" أي لنقل الملك فالأول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه "و" الثاني كـ "رهن و" كذا "نحوها" أي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعأمهات الأولاد وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهي حرة" رواه الدارقطني. وتصح كتابتها فإن أدت في حياته عتقت وما بقي بيدها لها وإن مات وعليها شيء عتقت وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها أومن قيمتها كالخطأ وان أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها1.
ـــــــ
1 لأنه مسئول عن نفقتها لكونها أمه ولو كانت على غير العادة
كتاب النكاح
مدخل
مدخل
13- كتاب النكاحهو لغة: الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان: أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.
وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
"وهو سنة" لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة1 فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 2 رواه الجماعة ويباح لمن لا شهوة له كالعنين3 والكبير " وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة" لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له.
"ويجب" النكاح "على من يخاف زنا بتركه" ولو ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير.
ـــــــ
1 الباءة: القدرة على نفقات الزواج والمهر واستطاعة الوطء.
2 وجاء: بكسر ومد رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوأين وقد شبه الصيام هنا بالوجاء لأنه يقطع الرغبة إلى الجماع لما له من تأثير في إضعاف الشهوة إلى الجماع فالمعنى بالتالي أن الصيام جنة ودرع يحمي صاحبه من الانحراف إلى الزنا إذا ازدادت به الرغبة إلى النكاح ولا يقدر على تكاليف الزواج.
3 العنين: المصاب يضعف انتصاب عضوه أو اكتمال هذا الانتصاب فهو بالتالي غير قادر على الجماع وربما في فترات متباعدة جدا.
"ويسن نكاح واحدة" لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} 1 دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" 2 متفق عليه أجنبية3 لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم بكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: "فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" متفق عليه "ولود" أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد "بلا أم" لأنه ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره.
"و" يباح "له" أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته " نظر ما يظهر غالبا" كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود "مرارا" أي يكرر النظر "بلا خلوة" إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها. ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم ولعبد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليه ومن تعامله وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ولا يحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة.
"ويحرم التصريح بخطبة المعتدة" كقوله: أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} وسواء كانت المعتدة " من وفاة والمبانة" حال الحياة " دون التعريض" فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "129".
2 تربت يداك: لفظة تقال في معرض الدعاء بالخير أو بالشر استنكارا لفعل أو قول وهي تعني امتلأت يداك بالتراب ولأن التراب فيه الزرع والخير فهو دعاء بالخير وفي الحالة الثانية تعني انقلب كل ما تلمسه إلى تراب والمقصود هنا تزوج ذات الدين وقد عد الزواج بها ظفرا وقوله تربت يداك بعدها تعني أغناك الله بها عن مال الأولى وحسب الثانية وجمال الثالثة لأن المال يذهب والمغني هو رب العالمين والحسب هو العمل الصالح والجمال يزول أثره مع الأيام كما يذبل مع تقدم العمر أما ذات الدين فلا تنقضي معاملتها الحسنة لزوجها وإحسانها في بيتها وحفظها لنفسها في غيبته ومحافظتها على ماله أبدا بل آثار أفعالها يراها كل يوم أوضح من الآخر.
3 أي من غير أقاربه الأقربين كابنة العم وابنة الخال لأن الزواج بين الأقارب يحمل مخاطر عديدة للنسل الجديد.
ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعية فإن له رجعتها في عدتها ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه إذا كانت بائنا و ما يرغب عنك ونحوهما كقوله: لا تفوتيني بنفسك وقولها: إن قضي شيء كان فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" رواه البخاري والنسائي وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب.
"ويسن العقد يوم الجمعة مساء" لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله " بخطبة ابن مسعود" وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".
فصل في أركان النكاح
وأركانه أي أركان النكاح ثلاثةأحدها - " الزوجان الخاليان من الموانع" كالمعتدة1."و" الثاني - "الإيجاب" وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.
"و" الثالث - "القبول" وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
"ولا يصح" النكاح "ممن لا يحسن" اللغة "العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت" لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. "" لا يصح قبول إلا بلفظ: " قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت" أو رضيت.
ـــــــ
1 والمتزوج بأربعة كلهن على ذمته.
ويصح النكاح من هازل وتلجئة "ومن جهلهما" أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية "لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان" لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة "فإن تقدم القبول" على الإيجاب لم يصح لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا "وإن تأخر" أي تراخى القبول "عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه" عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام.
فصل
"وله شروط "أربعة"أحدها: تعيين الزوجين" لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا لو قال: زوجتها ابنك وله بنون "فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها" باسمها "أو وصفها بما تتميز به" كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز "أو قال: زوجتك بنتي وله" بنت "واحدة لا أكثر صح" النكاح لعدم الإلباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
فصل
الشرط " الثاني: رضاهما" فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع "إلا البالغ المعتوه" فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح "و" إلا "المجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة لا الثيب" إذا تم لها تسع سنين "فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم" كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم "كالسيد مع إمائه" فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن "و" كالسيد مع "عبده الصغير" فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير "ولا يزوج باقي الأولياء" كالجد والأخ والعم "صغيرة دون تسع" بحال بكرا كانت أو ثيبا "ولا" يزوج غير الأب ووصيه في النكاح "صغيرا" إلا الحاكم لحاجة ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا "ولا بنت تسع" سنين كذلك "إلا بإذنهما" لحديث أبي هريرة مرفوعا: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد
ومعناه في حكم المرأة "وهو" الإذن "صمات البكر" ولو ضحكت أو بكت "ونطق الثيب" بوطء في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها قال: "أن تسكت" متفق عليه. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة.
فصل
الشرط " الثالث: الولي" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين.
"وشروطه" أي شروط الولي"التكليف" لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره.
"والذكورية" لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى.
"والحرية" لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى.
"والرشد في العقد" بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحسبه.
"واتفاق الدين" فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.
"والعدالة" ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك.
"فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها" لما تقدم.
"ويقدم أبو المرأة" الحرة "في إنكاحها" لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة "ثم وصيه فيه" أي في النكاح لقيامه مقامه "ثم جدها لأب وإن علا" الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب "ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا" الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال: "ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك" فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رواه النسائي "ثم أخوها لأبوين" ثم لأب كالميراث "ثم بنوهما كذلك" وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب "ثم عمها
لأبوبن ثم لأب لما تقدم ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث1 "ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث" فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة "ثم المولى المنعم" بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها "ثم أقرب عصبته نسبا" على ترتيب الميراث ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم "ثم السلطان" وهو الإمام أو نائبه قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا لخال ونحوه من ذوي الأرحام.
"فإن عضل" الولي "الأقرب" بأن منعها كفئا رضيته رغب بما صح مهرا ويفسق به2 إن تكرر أو لم يكن الأقرب "أهلا" لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا "أو غاب" الأقرب "غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة" فوق مسافة القصر أو جهل مكانه زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم. " وإن زوج الأبعد أو" زوج "أجنبي" ولو حاكما "من غير عذر" للأقرب "لم يصح" النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكلى فلان وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله: تزوجتها.
فصل
الشرط "الرابع: الشهادة" لحديث جابر مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا. " فلا يصح" النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو
ـــــــ
1 وليس للعم ومن دونه أن يزوج موليته بغير كفء إن لم ترضاه وكان للمولى الأقرب الذي يليه في درجة القرابة أو يساويه أن يفسخ العقد ويستحق من يزوج موليته بغير كفء العقوبة الشرعية وليس لعم ومن دونه أن يجبر موليته البالغة الراشدة أن تتزوج ممن لا ترغب به ولو كان من الأكفاء ففي غيره أولى وإن لم يكن لها مولى آخر يفسخ العقد كان لها أن تطلب ذلك من السلطان وفي أيامنا إلى القاضي أو رأس جهاز القضاء الشرعي في بلدها.
2 يفسق به: أي يعتبر عمله فسقا ويعتبر فاسقا لتكرار إعضاله لتزويجها.
ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح "ذكرين مكلفين سميعين ناطقين" ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطله تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده "وليست الكفاءة وهي" لغة: المساواة وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي "ومنصب وهو النسب والحرية" وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها "شرطا في صحته" أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط للزوم " فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي" أو حرة بعبد "فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء" حتى من حدث "الفسخ" فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل.
باب المحرمات في النكاح
مدخل
1- باب المحرمات في النكاحوهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله: " تحرم أبدا الأم وكل جدة" من قبل الأم أو الأب "وإن علت" لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 1 " والبنت وبنت الابن وبنتاهما" أي بنت البنت وبنت بنت الابن "من حلال وحرام وإن سفلت" وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} 1 "وكل أخت" شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} 1 "وبنتها" أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها "وبنت ابنتها" وإن نزلت لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} 1 "وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه" أي ابن الأخ "وبنتها" أي بنت بنت ابن أخيه "وإن سفلت" لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} 1 "وكل عمة وخالة وإن علتا" من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} 1.
"والملاعنة على الملاعن" ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين.
"ويحرم بالرضاع" ولو محرما "ما يحرم بالنسب" من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه "إلا أم أخته" وأم أخيه من رضاع "و" إلا "أخت ابنه" من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "23".
"ويحرم" بالمصاهرة: بـ " العقد" وإن لم يحصل دخول ولا خلوة "زوجة أبيه" ولو من رضاع "وزوجة كل جد" وإن علا لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 1 و تحرم أيضا بالعقد "زوجة ابنه وإن نزل" ولو من رضاع لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} 2 " دون بناتهن" أي بنات حلائل آبائه وأبنائه "و" دون "أمهاتهن" فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 3 "وتحرم" أيضا "أم زوجته وجداتها" ولو من رضاع "بالعق"د لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} 4 و تحرم أيضا الربائب وهن "بنتها" أي بنت الزوجة "وبنات أولادها" الذكور والإناث وإن نزلن من نسب أو رضاع "بالدخول" لقوله تعالي: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} 5 "فإن بانت الزوجة" قبل الدخول ولو بعد لخلوة "أو ماتت بعد الخلوة" أبحن أي الربائب لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} 5. ومن وطىء امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "22".
2 سورة النساء من الآية "23".
3 سورة النساء من الآية "24".
4 سورة النساء من الآية "23".
5 سورة النساء من الآية "23".
فصل في الضرب الثاني من المحرمات
"وتحرم الى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما" أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته "وعمتاهما وخالتاهما" وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} 6 وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد."فإن طلقت" المرأة "وفرغت العدة أبحن" أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع.
ـــــــ
6 سورة النساء من الآية "23".
ومن وطىء أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة "فإن تزوجهما" أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح "أو" تزوجهما في "عقدين معا بطلا" لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا "فإن تأخر أحدهما" أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به "أو وقع" العقد الثاني "في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل" الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين.
"وتحرم المعتدة" من الغير لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} 1 "و" كذا " المستبرأة من غيره" لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب و تحرم الزانية على زان وغيره "حتى تتوب وتنقضي عدتها" لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} 2 وتوبتها أن تراود فتمتنع
"و" تحرم "مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره" بنكاح صحيح لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} 3 "و" تحرم "المحرمة حتى تحل" من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يخطب" رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة.
"ولا ينكح كافر مسلمة" لقوله تعالى: { وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} 4 ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 4 إلا حرة كتابية أبواها كتابيان لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 5 "ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوية لحاجة المتعة أو الخدمة" لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها "ويعجز عن طول" أي مهر "حرة وثمن أمة" لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} 6 الآية واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "235".
2 سورة النور من الآية "3".
3 سورة البقرة من الآية "230".
4 سورة البقرة من الآية "221".
5 سورة المائدة من الآية "5".
6 سورة النساء من الآية "25".
أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى "ولا ينكح عبد سيدته" قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه. "ولا" ينكح "سيد أمته" لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه.
"وللحر نكاح أمة أبيه" لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك "دون" نكاح "أمة ابنه" فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم "وليس للحرة نكاح عبد ولدها" لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها "وإن اشترى أحد الزوجين" الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره أو ملك "ولده الحر أو" ملك "مكاتبه" أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده "الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما" ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق "ومن حرم وطؤها بعقد" كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا "حرم" وطؤها "بملك يمين" لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى "إلا أمة كتابية" فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 1 "ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل" وبطل فيمن تحرم فلو زوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح "ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره" لعدم تحقق مبيح النكاح.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "3".
باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح
مدخل
2- باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاحوالمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان: صحيح وإليه أشار بقوله: " إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو" أن " لا يخرجها من دارها أو بلدها" أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن لا ترضع ولدها الصغير " أو شرطت نقدا معينا" تأخذ منه مهرها أو شرطت "زيادة في مهرها صح" الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤه به "فإن خالفه فلها الفسخ" على التراخي1 لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا: مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.
ـــــــ
1 أي أن مرور الزمن لا يسقط الشرط إلا إن سقطت أسبابه وموجباته.
القسم الثاني: فاسد1 وهو أنواعأحدها - نكاح الشغار وقد ذكره بقوله: " وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا" أي زوج كل منهما الآخر وليته "ولا مهر" بينهما "بطل النكاحان" لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار متفق عليه والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه.
وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى "فإن سمي لهما" أي لكل واحدة منهما "مهر" مستقل غير قليل بلا حيلة "صح" النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمى لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.
الثاني - نكاح المحلل واليه الإشارة بقوله: " وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه" أي التحليل "بلا شرط" يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح2 لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار" قالوا: بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له" رواه ابن ماجة
"أو قال" ولي: "زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها" أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح كقوله: زوجتكها إن كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شيءت فقال: شيءت وقبلت ونحوه فإنه صحيح أو قال ولي: زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بأن قال: زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم.
فصل
"وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة" لها "أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر" منها "أو شرط فيه" أي في النكاح " خيارا أو" شرط " إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما" أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه "بطل الشرط" لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل
ـــــــ
1 أي إن وقع الدخول فالشرط باطل و النكاح ثابت ولها مهر مثلها وإن لم يقع الدخول فالنكاح باطل.
2 ولا يحل لها بمثل هذا النكاح أن تعود إلى زوجها.
انعقاده "وصح النكاح" لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه
"وإن شرطها مسلمة" أو قال وليها: زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه "أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو" شرط " نفي عيب لا يفسخ به النكاح" بأن شرطها سميعة أو بصيرة "فبانت بخلافه فله الفسخ" لما تقدم وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده حر - أيضا - يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. "وإن عتقت" أمة "تحت حر فلا خيار لها" لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم "بل" يثبت لها الخيار إن عتقت كلها "تحت عبد" كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود رواه البخاري 1 وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها.
فصل في العيوب في النكاح
وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: "ومن وجدت زوجها مجبوبا" قطع ذكره كله "أو" بعضه "وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو" ثبتت "ببينة على إقراره أجل سنة" هلالية "منذ تحاكمه" روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت فصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة "فإن وطئ فيها" أي في السنة "وإلا فلها الفسخ" ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط " وإن اعترفت أنه" وطئها في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا" لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته."و" القسم الثاني يختص بالمرأة وهو "الرتق" بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة "والقرن" لحم زائد ينبت في الرحم فيسده "والعفل" ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر "والفتق" انخراق ما بين سبيلها أو
ما بين مخرج بول ومني "واستطلاق بول ونحوه" أي غائط منها أو منه "وقروح سيالة في فرج" و استحاضة.
"و" من القسم الثالث وهو المشترك "باسور وناصور" وهما داآن بالمقعدة.
"و" من القسم الأول "خصاء" أي قطع الخصيتين "وسل" لهما1 "ووجاء" 2 لهما لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه.
"و" من المشترك "كون أحدهما خنثى واضحا" أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم "وجنون ولو ساعة وبرص وجذام" وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم "يثبت بكل واحد منهما الفسخ" لما فيه من النفرة ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة "أو كان بالآخر عيب مثله" أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه.
ومن رضي بالعيب بأن قال: رضيت به "أو وجدت منه دلالته" من وطء أو تمكين منه "مع علمه" بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به.
"ولا يتم" أي لا يصح "فسخ أحدهما إلا بحاكم" فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه "فإن كان" الفسخ "قبل الدخول فلا مهر" لها سواء كان الفسخ منه أو منها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها: وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها "و" إن كان الفسخ "بعده" أي بعد الدخول أو الخلوة فـ "لها" المهر المسمى في العقدة لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط "ويرجع به على الغار إن وجد" لأنه غره وهو قول عمر والغار: من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار.
"والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب" يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم "فإن رضيت" العاقلة "الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع" لأن الحق في الوطء لها دون غيرها "بل" يمنعها وليها العاقد من تزوج "مجنون ومجذوم وأبرص" لأن في ذلك
ـــــــ
1 وسل الخصيتين يكون بسبب شق في الصفن يخرجان منه ويبقى الصفن فارغا والصفن هو الكيس الحاوي للخصيتين.
2 الوجاء هو الرض وقد سبق شرحه في أول هذا الكتاب.
عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد "ومتى" تزوجت معيبا لم تعلمه ثم " علمت العيب" بعد عقد لم تجبر على فسخ أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم "حدث به" العيب بعده "لم يجبرها وليها على الفسخ" إذا رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه.
3-
باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
"حكمه كنكاح المسلمين" في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا " ويقرون على فاسده" أي فاسد النكاح " إذا اعتقدوا صحته في شرعهم" بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم "ولم يرتفعوا إلينا" لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم "فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا" بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} 1 "وإن أتونا بعده" أي بعد العقد فيما بينهم "أو أسلم الزوجان" على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك "و" إذا تقرر ذلك فإن كانت " المرأة تباح إذا" أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود "أقرا" على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته "وإن كانت" الزوجة "ممن لا يجوز ابتداء نكاحها" حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره "فرق بينهما" لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته "وإن وطئ حربى حربية فأسلما" أو ترافعا إلينا "وقد اعتقداه نكاحا أقرا" عليه لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم وإلا يعتقداه نكاحا "فسخ" أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره "ومتى كان المهر صحيحا أخذته" لأنه الواجب "وإن كان فاسدا" كخمر أو خنزير "وقبضته استقر" فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك " وإن لم تقبضه" ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل "و" إن "لم يسم" لها مهر "فرض لها مهر" المثل لخلو النكاح عن التسمية.ـــــــ
1 سورة المائدة من الآية "42".
فصل
"وإن أسلم الزوجان معا" بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين "أو" أسلم "زوج كتابية" كتابيا كان أو غير كتابي "فعلى نكاحهما" لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية "فإن أسلمت هي" أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن لمسلمة لا تحل لكافر "أو" أسلم "أحد الزوجين غير الكتابيين" كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} 1 وقوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} 1 "فإن سبقته" بالإسلام "فلا مهر" لمجئ الفرقة من قبلها "وإن سبقها" بالإسلام "فلها نصفه" أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا: سبق أحدنا ولا نعلم عينه.
"وإن أسلم أحدهما" أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر "بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة" لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما "فإن أسلم الآخر فيها" أي في العدة "دام النكاح" بينهما لما سبق "وإلا" يسلم الآخر حتى انقضت "بان فسخه" أي فسخ النكاح " منذ أسلم الأول" من الزوج أو الزوجة ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم.
"وإن كفرا" أي ارتدا أو ارتد " أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة" كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد. "و" إن ارتدا أو أحدهما "قبله" أي قبل الدخول "بطل" النكاح لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزبر وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة.
ـــــــ
1 سورة الممتحنة من الآية "10".
4-
باب الصداق
يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. "يسن تخفيفه" لحديث عائشة مرفوعا: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده. "و" تسن "تسميته في العقد" لقطع النزاع وليست شرطا لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} 1.ويسن أن يكون "من أربعمائة درهم" من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى "خمسمائة" درهم وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس و لا يتقدر الصداق "بل كل ما صح" أن يكون "ثمنا أو أجرة صح" أن يكون "مهرا وإن قل" لقوله صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتما من حديد" متفق عليه "وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح" الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} 2 وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: "لا تكون لأحد بعدك مهرا" بل يصح أن يصدقها تعليم معين من "فقه وأدب" كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها "وشعر مباح معلوم" ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال "وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح" لحديث: "لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" "ولها مهر مثلها" لفساد التسمية " ومتى بطل المسمى" لكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه "وجب مهر المثل" بالعقد لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط.
فصل
"وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل" لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح "و" إن تزوجها "على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن" لي زوجة "بألف يصح" النكاح "بالمسمى" لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها "وإذا أجل الصداق
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "236".
2 سورة النساء من الآية "24".
أو بعضه" كنصفه أو ثلثه "صح" التأجيل "فإن عين أجلا" أنيط به "وإلا" يعينا أجلا بل أطلقا "فمحله الفرقة" البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة.
"وإن أصدقها مالا مغصوبا" يعلمانه كذلك "أو" أصدقها "خنزيرا ونحوه" كخمر صح النكاح كما لو لم يسم لها مهرا و " وجب" لها "مهر المثل" لما تقدم وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا "وإن وجدت" المهر "المباح معيبا" كعبد به نحو عرج "خيرت بين" إمساكه "مع أرشه و" بين رده وأخذ "قيمته" إن كان متقوما وإلا فمثله وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير.
"وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها" أو على أن الكل للأب "صحت التسمية" لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع الزوجة الألف وأبيها الألف رجع عليها "بالألف" دون أبيها وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه "ولا شيء على الأب لهما" أي للمطلق والمطلقة لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها "ولو شرط ذلك" أي الصداق أو بعضه "لغير الأب" كالجد والأخ "فكل المسمى لها" أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل.
"ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح" ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر " وإن زوجها به" أي بدون مهر مثلها "ولي غيره" أي غير الأب "بإذنها صح" مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب "ف" لها "مهر المثل" على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها وإن "زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح" لازما لأن المرأة لم ترض بدونه وقد تكون مصلحة الابن في بدل الزيادة ويكون الصداق "في ذمة الزوج" إن لم يعين في العقد "وإن كان" الزوج "معسرا لم يضمنه الأب" لأن الأب نائب عنه في التزويج والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وتعلق صداق ونفقه وكسوة ومسكن بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.
فصل
"وتملك المرأة" جميع " صداقها بالعق" كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ولها أي للمرأة "نماء" المهر "المعين" من كسب وثمر وولد ونحوها ولو حصل "قبل القبض" لأنه نماء ملكها "وضده بضده" أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفا فيه قبل في قبضه كمبيع "وإن تلف" المهر المعين قبل قبضه "فمن ضمانها" فيفوت عليها "إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه" لأنه بمنزلة الغاصب إذا "ولها التصرف فيه" أي في المهر المعين لأنه ملكها إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك "وعليها زكاته" أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين.
"وإن طلق" من أقبضها الصداق "قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه" أي نصف صداق حكما أي قهرا كالميراث لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} 1 " دون نمائه" أي نماء المهر "المنفصل" قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لها2 " وفي" النماء "المتصل" كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة "له نصف قيمته" أي قيمة العبد "بدون نمائه" المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه فإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته و أقبضته أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى "وإن اختلف الزوجان" أو ولياهما "أو ورثتهما" أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته "في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به" من دخول أو خلوة أو نحوهما "فقوله" أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته و إن اختلفا في قبضه ف القول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها.
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "237".
2 إذ صار يملك نصفه فله بالتالي نصف النماء الحاصل بعد الطلاق.
فصل
"يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة" بلا مهر " أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر" فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} 1. "و" يصح أيضا " تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما" أي أحد الزوجين "أو" يشاء " أجنبي فـ" يصح العقد و لها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه "ويفرضه" أي مهر المثل "الحاكم بقدره" بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة وإن تراضيا ولو على قليل صح لأن الحق لا يعدوهما ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه.
"ومن مات منهما" أي من الزوجين " قبل الإبانة" 2 و الخلوة "والفرض" فلها المثل و "ورثه الأخر" لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح "ولها مهر" مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها "فإن طلقها" أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد "قبل الدخول" والخلوة "فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره" لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} 3 فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها "ويستقر مهر المثل" للمفوضة ونحوها "بالدخول" والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك و يتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها.
"وإن طلقها" أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها "بعده" أي بعد الدخول "فلا متعة" لها بل لها المهر كما تقدم "وإذا افترقا" في النكاح "الفاسد" المختلف فيه "قبل الدخول والخلوة فلا مهر" ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه و إن افترقا "بعد أحدهما" أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم "يجب المسمى" لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: "ولها الذي أعطاها بما أصاب منها"
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "236".
2 أي قبل إيضاح قيمة المهر كم هو أو قبل أن يتضح إن حصلت خلوة أولا.
3 سورة القرة من الآية "236".
"ويجب مهر المثل لمن وطئت" في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة أو وطئت "بشبهة أو زنا كرها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهي المهر ولا "يجب معه" أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم.
"وللمرأة" قبل دخول "منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال" مفوضة كانت أو غيرها لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه "فإن كان" الصداق "مؤجلا" ولم يحل "أو حال قبل التسليم" لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره "أو سلمت نفسها تبرعا" أي قبل الطلب بالحال "فليس لها" بعد ذلك "منعها" أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقر الصداق ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه " فإن أعسر" الزوج "بالمهر الحال فلها الفسخ" إن كانت حرة مكلفة "ولو بعد الدخول" لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة "ولا يفسخه" أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حكم كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب.
5-
باب وليمة العرس
أصل الوليمة: تمام الشئ واجتماعه ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة "تسن" الوليمة بعقد "بشاة فأقل" من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت "أولم ولو بشاة" وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة."وتجب في أول مرة" أي في اليوم الأول "إجابة مسلم يحرم هجره" بخلاف نحو رافضي متجاهر بمعصية إن دعاه "إليها" أي إلى الوليمة "إن عينه" الداعي "ولم يكن ثم" أي في محل الوليمة "منكر" لحديث أبي هريرة يرفعه: "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله" رواه مسلم. فإن دعاه
الجفلى" - بفتح الفاء - كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة أو دعاه "في اليوم الثالث" كرهت إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء رسمعة" رواه أبو داود وغيره. وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر "أو دعاه ذمي" أو من في ماله حرام "كرهت الإجابة" لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره "ومن صومه واجب" كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا و " دعا" استحبابا "وانصرف" لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وأن كان مفطرا فليطعم" رواه أبو داود "و" الصائم "المتنفل" إذا دعي أجاب و "يفطر إن جبر" قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال: إني صائم: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت" "ولا يجب" على من حضر "الأكل" ولو مفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك" قال في شرح المقنع: حديث صحيح.
ويستحب الأكل لما تقدم "وإباحته" أي إباحة الأكل "متوقفة على صريح إذن أو قرينة" ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لحديث ابن عمر: "من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا" والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه. وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة "منكرا" كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان "يقدر على تغييره حضر وغيره" لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر "وإلا" يقدر على تغييره "أبى" الحضور لحديث عمر مرفوعا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" رواه الترمذي "وإن حضر" من غير علم بالمنكر "ثم علم به أزاله" لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك " فإن دام" المنكر "لعجزه" أي المدعو "عنه انصرف" لئلا يكون قاصدا لرؤيته وسماعه "وإن علم" المدعو " به" أي بالمنكر ولم يره "ولم يسمعه خير" بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ.
"وكره النثار والتقاطه" لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف "ومن أخذه" أي أخذ شيئا كل من النثار "أو وقع في حجره" منه شيء "ف" هو له قصد تملكه أو لا لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه " ويسن إعلان النكاح" لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح" وفي لفظ: "أظهروا النكاح" رواه ابن ماجة "و" يسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج "فيه" أي في النكاح "للنساء" وكذا ختان
وقدوم غائب وولادة وإملاك لقوله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه النسائي. وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود قال في المستوعب و الترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور.
تتمة - في جمل من آداب الأكل والشربتسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع وتخليل ماعلق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وإذا شرب ناوله الأيمن ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها وفعله ما يستقذره من غيره ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا1 وأن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأكله كثيرا حيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره.
ـــــــ
1 قران الطعام والتمر: أن يأكل الطعام التمر معا في لقمة واحدة.
باب عشرة النساء
مدخل
6- باب عشرة النساءالعشرة - بكسر العين -: الاجتماع يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر. وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
"ويلزم" كلا من "الزوجين العشرة" أي معاشرة الآخر "بالمعروف" فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولايتبعه أذى ومنة لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1 وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 2. وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} 3 قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا
"ويحرم مطل كل واحد" من الزوجين "بما يلزمه" للزوج "الأخر والتكره لبذله" أي بذل الواجب لما تقدم.
"وإذا تم العقد لزم تسليم" الزوجة "الحرة التي يوطأ مثلها" وهي بنت تسع ولو كانت
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "19".
2 سورة البقرة من الآية "228".
3 سورة النساء من الآية "19".
نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض "في بيت الزوج" متعلق يتسليم "إن طلبه" أي طلب الزوج تسليمها "ولم تشترط" في العقد "دارها أو بلدها" فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال: لا أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة " وإذا استمهل أحدهما" أي طلب المهلة ليصلح أمره "أمهل العادة وجوبا" طلبا لليسر والسهولة "لا لعمل جهاز" - بفتح الجيم وكسرها - فلا تجب المهلة له لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك "ويجب تسليم الأمة" مع الإطلاق "ليلا" فقط لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا.
"ويياشرها" أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة "ما لم يضر بها" ، "ويشغلها عن فرض" باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب وله أي للزوج "السفر بالحرة" مع الأمن لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم "ما لم تشترط ضده" أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط وإلا فلها الفسخ كما تقدم والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا.
"ويحرم وطؤها في الحيض" لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ...} 1 الآية وكذا بعده قبل الغسل "و" في "الدبر" لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" رواه ابن ماجة
ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة "وله إجبارها" أي للزوج إجبار زوجته "على غسل حيض" ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة و غسل "نجاسة" واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن "وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره" كظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث لأنه يمنع كمال الاستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه "ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة" في رواية والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها.
فصل
ويلزمه أي الزوج "أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع" ليال إذا طلبت أكثر لأن
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "222".
أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف "و" له "أن ينفرد إن أراد" الانفراد "في الباقي" إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا.
"ويلزمه الوطء إن قدر" عليه "كل ثلث سنة مرة" بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها "وإن سافر فوق نصفها" أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه "وطلبت قدومه وقدر لزمه" القدوم "فإن أبى أحدهما" أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته "فرق بينهما الحاكم" بطلبها وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه.
"وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد" لحديث ابن عباس مرفوعا: "لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا" متفق عليه
"ويكره" الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجة وتكره "كثرة الكلام" حالته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة " " و" يكره "النزع قبل فراغها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها" .
"و" يكره "الوطء بمرأى أحد" أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيعا "و" يكره "التحدث به" أي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه أبو داود وغيره وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. "ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد1 بغير رضاهما" لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغبرة واجتماعهما يثير الخصومة.
"وله منعها" أي منع زوجته "من الخروج من منزله" ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة "ويستحب إذنه" أي إذن الزوج لها في الخروج " إن تمرض محرمه" كأخيها وعمها أو مات لتعوده "وتشهد جنازته" لما
ـــــــ
1 أي في غرفة واحدة.
في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها "وله منعها من إجارة نفسها" لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت "و" له منعها "من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته" أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذا لما فيه إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.
فصل في القسم
"و" يجب "عليه" أي على الزوج "أن يساوى يين زوجاته في القسم" لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1 وتمييز إحداهما ميل2 ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث "وعماده" أي القسم "الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس" فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها."ويقسم" وجوبا "لحائض و نفساء ومريضة ومعيبة" بنحو جذام "ومجونة مأمونة" وغيرها كمن آلى و ظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن.
"وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو" أبت "المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة" لأنها عاصية كالناشز وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فإن لبث أو جامع لزمه القضاء3.
"ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه" أي إذن الزوج جاز "أو" وهبته "له فجعله لـ" زوجة "أخرى جاز" لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا فإن رجعت الواهبة "قسم لها مستقبلا" لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "19".
2 أي هو تفضيل لها غير جائز.
3 أي أن يقسم بغيرها مثلها أو ينقص يوما من أيامها خلال الشهر.
ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه.
"ولا قسم" واجب على سيد "لإمائه وأمهات أولاده" لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 1 "بل يطأ" السيد "من شاء" منهن "متى شاء" وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن.
"وإن تزوج بكرا" ومعه غيرها "أقام عندها سبعا" ولو أمة "ثم دار" على نسائه "و" إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة: لو شيءت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان. "وإن أحبت" الثيب أن يقيم عندها "سبعا فعل وقضى مثلهن" أي مثل السبع "للبواقي" من ضراتها لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: "إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي" رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية "3".
فصل في النشوز
وهو معصيتها إياه فيم يجب عليها مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة وعظها أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها ما شاء وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح أي شديد لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" ولا يزيد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" متفق عليه ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة وله تأديبها على ترك الفرائض وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهماويلزمهما لحق فان تعذرا وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه.
7-
باب الخلع
وهو فراق الزوجة بعوض1 بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} 2."من صح تبرعه" وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه "من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه" ومن لا فلا لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع "فإذا كرهت" الزوجة "خلق زوجها أو خلقه" أبيح الخلع والخلق - بفتح الخاء -: صورته الظاهرة - وبضمها -: صورته الباطنة "أو" كرهت "نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع" لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} 3
وتسن إجابتها إذا لا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة "كره ووقع" لحديث ثوبان مرفوعا: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه الخمسة غير النسائي "فإن عضلها ظلما للافتداء" أي لتفتدي منه "ولم يكن" ذلك" لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت" أي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله تعالى: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} 4 فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق "أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة" ولو بإذن ولي "أو" خالعت "الأمة بغير إذن سيدها لم يصح" الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه "ووقع الطلاق رجعيا إن" لم يكن تمام عدده و كان الخلع المذكور "بلفظ الطلاق أو نيته" لأنه لم يستحق به عوضا فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه ويصح الخلع ممن يصح طلاقه.
ـــــــ
1 أي بتعويض تؤديه المرأة إلى الرجل.
2 سورة البقرة من الآية "187".
3 سورة البقرة من الآية "229".
4 سورة النساء من الآية "19".
فصل
"والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته" أي كناية الطلاق "وقصده" به الطلاق "طلاق بائن" لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها "وإن وقع" الخلع "بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء" بأن قال: خلعت أو فسخت أو فاديت "ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق" روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}1 ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} 2 فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا
"ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها" الزوج "به" روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بعضها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية.
"ولا يصح شرط الرجعة فيه" أي في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما " وإن خالعها بغير عوض" لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه أو خالعها "بمحرم" يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب "لم يصح" الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض.
"ويقع الطلاق" المسؤول على ذلك " رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته" لخلوه عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتها فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة "صح الخلع به" لعموم قوله تعالى: { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} 3.
"ويكره" خلعها "بأكثر مما أعطاها" لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: "ولا تزداد" ويصح الخلع إذا لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. "وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح" ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل "ويصح" الخلع "بالمجهول كالوصية" ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط يدخله المسامحة "فإن خالعته على حمل شجرتها أو" حمل "أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد" مطلق ونحوه "صح" الخلع وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها "وله مع عدم
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "229".
2 سورة البقرة من الآية "230".
3 سورة البقرة من الآية "229".
الحمل" فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها "و" مع عدم "متاع" فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع "و" مع عدم "العبد" لو خالعها على ما في بيتها من عبد " أقل مسماه" أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم "و" له "مع عدم الدراهم" فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم "ثلاثة" دراهم لأنها أقل الجمع.
فصل
"وإذا قال" الزوج لزوجته أو غيرها: "متى" أعطيتني ألفا "أو إذا" أعطيتني ألفا "أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بائنا بعطيته" الألف "وإن تراخى" الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد "وإن قالت: اخلعني على ألف أو" اخلعني "بألف أو" اخلعني "ولك ألف" ففعل أي خلعها - ولو لم يذكر الألف - "بانت واستحقها" من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب و إن قالت: "طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها" لأنه أوقع ما استدعته وزيادة "وعكسه بعكسه" فلو قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت وحصلت ما يحصل به الثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره.
"وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها" لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة والدارقطني "ولا" للأب "خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها" لأنه لاحظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي ويحرم خلع الحيلة ولا يصح "ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق" فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق "وإن علق طلاقها بصفة" كدخول " الدار ثم أبانها فوجدت الصفة" حال بينونتها "ثم نكحها" أي عقد عليها بعد وجود الصفة "فوجدت" الصفة "بعده" أي