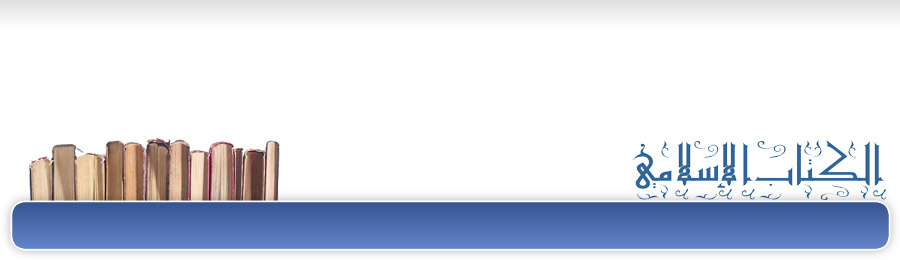كتاب : دلائل الإعجاز
المؤلف : أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني
ضروريٌّ وعلمٌ مكتَسبٌ وعلم جليٌّ وعلم خفيٌّ وضربُ شديدٌ وضربٌ خفيفٌ وسيرُ سريع سيرٌ بطيء وما شاكل ذلك . انقسَم الجنسُ منها أقساماً وصار أنواعاً وكان مَثَلُها مثلَ الشيء المجموع المؤلَّفِ تُفرِّقه فِرقاً وتشعِّبُهُ شُعَباً . وهذا مذهبٌ معروف عندهم وأصلٌ متعارفٌ في كلِّ جيل وأمة
ثم إن هاهُنا أصلاً هو كالمتفرِّع على هذا الأصل أو كالنظيرِ له . وهو أن مِنْ شأنِ المصدر أن يفرَّقَ بالصِّلات كما يفرِّقُ بالصفات . ومعنى هذا الكلامِ أنك تقول : " الضربُ " فتراه جنساً واحداً فإذا قلتَ : الضربُ بالسيف صار تعديتُك له إلى السيف نوعاً مَخصوصاً . ألا تراك تقولُ : الضربُ بالسيف غيرُ الضرب بالعصا تريدُ أنهما نوعانِ مختلفانِ وأنِّ اجتماعَهما في اسم الضربِ لا يوجِبُ اتفاقَهما لأن الصِّلةَ قد فَصَلَتْ بينُهما وفرِّقَتهما . ومن المثال البيِّن في ذلك قولُ المتنبي - الكامل - :
( وتوهًّمُوا اللّعِبَ الوَغى والطَّعْنُ في ... الْهَيْجاءِ غَيْرُ الطَّعْنِ في المَيْدَانِ )
لولا أَنَّ اختلافَ صِلة المصدرِ تَقتضي اختلافَه في نفسهِ وأن يَحْدُثَ في انقسامٍ وتنوعٍ لما كان لهذا الكلام معنًى ولكان في الاستحالة كقولك : والطَّعنُ غيرُ الطعن . فقد بان إذاً أنه إنَّما كانَ كلُّ واحد من الطَّعنين جنساً برأسِه غيرَ الآخر بأّنْ كان هذا في الهيجاءِ وذاك في الميدانِ . وهكذا الحكمُ في كلِّ شيء تَعَدّى إليه المصدرُ وتعلَّق به . فاختلافُ مفعولَيْ المصدر يقتضي اختلافَه . وأن يكونَ المتعدي إلى هذا المفعولِ غيرَ المتعدّي إلى ذاك . وعلى ذلك تقولُ : ليس إعطاؤك الكثيرَ كإعطائك القليلَ . وهكذا إذا عدَّيَته إلى الحال كقولك : ليس إِعطاؤكَ مُعسِراً كإعطائك موسِراً . وليسَ بذْلُك وأنت مُقِلٌّ كَبذْلك وأنت مُكْثِرٌ . وإذ قد عَرَفْتَ هذا من حُكْم المصدِر فاعتبِرْ به حكمَ الاسم المشتقِّ منه
وإذا اعتبرتَ ذلك علمتَ أنَّ قولك : هو الوفيُّ حين لا يَفي أحدٌ وهو الواهبُ المئةَ المصطفاةَ . وقوله - الخفيف - :
( وَهُوَ الضَّارِبُ الكتيبةَ والطَّعْنة ... تغلو والضَّربُ أَغْلى وَأَغْلَى )
واشباهُ ذلك كلُّها أخبارٌ فيها معنى الجنسية وأنها في نوعِها الخاصِّ بمنزلِة الجنسِ المُطلَقِ إذا جعلتَه خَبراً فقلتَ : أنتَ الشجاعُ وكما أنك لا تقصِدُ بقولك : أنت الشجاعُ إلى شجاعةٍ بعينها قَدْ كانت وعُرِفَتْ من إنسان . وأردتَ أن تعرِفَ ممن كانت بل تريدُ أن تَقْصُرَ جنسَ الشجاعة عليه ولا تجعلَ لأحدٍ غيرهِ فيه حظّاً . كذلك لا تقصِدُ بقولك : " أنت الوفٌّي حين لا يَفي أحدٌ " إلى وفاءٍ واحدٍ كيفَ وأنتَ تقول : " حينَ لا يفي أحدٌ " . وهكذا محالٌ أنَ يَقْصِدَ من قولِه : " هُوَ الواهبُ المئةَ المصطفاةَ " إلى هِبَةٍ واحدةٍ لأنه يَقْتضي أنْ يقصِدَ إلى مِئةٍ منَ الإبلَ قد وهَبها مرةً ثم لم يَعُدْ لمثلها . ومعلومٌ أنه خلافُ الغرضِ . لأن المعنى أنه الذي من شأنِه أن يَهَبَ المئةَ أبداً والذي يبلغُ عطاؤه هذا المبلغَ كما تقول : هو الذي يُعطي مادِحَه الألفَ والألفين وكقوله - الرجز - :
( وحاتمُ الطائيُّ وهّابُ المِئي ... )
وذلك أوضحُ من أن يَخْفَى . وأصلٌ آخرُ وهو أن مِنْ حَقِّنا أن نَعْلَمَ أنَّ مذهبَ الجنسية في الاسم وهو خبرٌ غيرُ مذهبها وهو مبتدأ . تفسيرُ هذا أَنَّا وإنْ قلنا : إنَّ اللامَ في قولك : أنت الشجاعُ للجنس كما هُوَ له في قوِلهم : الشجاعُ موقَى والجبانُ مُلقًّى فإنَّ الفرقَ بينهما عظيمٌ . وذلك أنَّ المعنى في قولك : الشجاعُ موقًّى أنك تُثْبتُ الوقايةَ لكلِّ ذاتٍ من صفتها الشجاعةُ فهو في معنى قولِك : الشجعانُ كلهم موقًّوْن . ولستُ أقولُ : إن الشجاعَ كالشجعان على الإطلاق وإن كان ذلك ظَنُّ كثيرٍ من الناس ولكنّي أريدُ أنك تجعلَ الوقايةَ تستغرِقُ الجنسَ وتَشْمَلهُ وتَشيعُ فيه . وأما في قولك : أنت الشجاعُ فلا معنى فيه للاستغراقِ إذْ لستَ تريدُ أن تقولَ : أنت الشجعانُ كلُّهم حتى كأنك تذهبُ به مَذْهبَ قولِهم : أنت الخلقُ كلُّهم وأنت العالمُ . كما قال - السريع
( لَيسَ على الله بمستنكَر ... أن يَجْمَعَ العالَم في واحدِ )
ولكنَّ لحديث الجنسيةِ هاهُنا مأخذاً آخرَ غيرَ ذلك وهو أنك تَعمدُ بها إلى المصدِر المشتَقِّ منه الصفةُ وتوجِّهُها إليه لا إلى نفسِ الصِّفة . ثم لك في تَوجيهها إليه مسلَكٌ دقيقٌ وذلك أنَّه ليس القَصْدُ أن تأتَي إلى شجاعاتٍ كثيرةٍ فتجمَعَها له وتُوجدَها فيه ولا أن تقولَ : إنَّ الشجاعاتِ التي يُتوَهَّم وجودُها في الموصوفينَ بالشجاعة هي موجودةٌ فيه لا فيهم . هذا كلُّه مُحالٌ بل المعنى على أنك تقولُ : كنا قد عَقَلنا الشجاعَة وعرَفنا حقيقتَهَا وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسانُ في إقدامِه وبَطْشهِ حتى يعلَمَ أنه شجاع على الكمال واسْتَقْرينا الناسَ فلم نجدْ في واحدٍ منهم حقيقةً ما عرفناهُ . حتى إذا صِرْنا إلى المخاطبِ وجدناهُ قِد استكملَ هذه الصفةَ واستجمعَ شرائطَها وأخلصَ جوهَرها ورسَخ فيه سِنْخُها . ويُبَيِّنُ لك أن الأمرَ كذلك اتفاقُ الجميع على تفسيِرهم له بمعنى الكامِل ولو كان المعنى على أنه استَغْرَقَ الشجاعات التي يُتوهَّم كونُها في الموصوفينَ بالشجاعة لما قالوا : إنَّه بمعنى الكامل في الشجاعِة لأن الكمالَ هو أن تكونَ الصفةُ على ما يَنْبغي أن تكونَ عليه وأن لا يخالَطها ما يقدحُ فيها . وليس الكمالُ أن تجتمعَ آحادُ الجنسِ وينَضَّم بعضُها إلى بعضٍ فالغرضُ إذاً بقولنا : أنتَ الشجاعُ هو الغرضُ بقولهم : هذه هيَ الشجاعةُ على الحقيقة وما عداها جُبْنٌ . وهكذا يكون العلمُ وما عداه تَخَيُّلٌ . وهذا هو الشِعّرُ وما سواهُ فليس بشيءٍ وذلك أظهرُ من أن يَخْفى
وضربٌ آخرُ منَ الاستدلال في إبطالِ أن يكونَ : أنتَ الشجاعُ : بمعنى أنك كأنَّك جميعُ الشجعانِ على حَدِّ : أنت الخَلْقُ كلُّهم . وهو أنّك في قولك : أنتَ الخلقُ وأنتَ الناسُ كلُّهم وقد جُمِعَ العالمُ مِنْكَ في واحدٍ تدَّعي له جميعَ المعاني الشَّريفةِ المتفرقِة في الناس من غيرِ أن تُبْطلَ تلك المعاني وتَنفيَها عن الناس بل على أن تدَّعيَ له أمثالَها . ألا تَرى أنك إذا قلتَ في الرجلِ : إنه معدودٌ بألفِ رجلٍ فلستَ تعني أنه معدودٌ بألفِ رجل لا معنى فيهم ولا فضيلةَ لهم بوجه . بل تريدُ أنَّه يُعْطِيكَ من معاني الشجاعةِ أو العلم أو كذا أو كذا مجموعاً ما لا تجدُ مقدارَهُ مُفرَّقاً إلاًّ في ألفِ رجلٍ . وأمَّا في نحوِ : أنت الشجاعُ فإنك تدَّعي له أنه قد انفردَ بحقيقةِ الشجاعةِ وأنه قد أُوتَي فيها مزيَّةً وخاصيَّة لم يُؤتَها أحدٌ
حتى صار الذي كان يَعُدُّه الناسُ شجاعةً غيرَ شجاعةٍ وحتى كأنّ كلَّ إقدامٍ إحجامٌ وكلَّ قوةٍ عُرفَتْ في الحرب ضَعْفٌ وعلى ذلك قالوا : جادَ حتى بَخَّل كلَّ جوادٍ وحتّى مَنع أن يستحقَّ اسمَ الجوادِ أحدٌ : كما قال - الوافر - :
( وأنَّكَ لا تَجُودُ عَلَى جَوادٍ ... هِباتُكَ أَنْ يُلقَّبَ بالجَوادِ )
وكما يقالُ : جادَ حتى كَأَنْ لم يُعْرَفْ لأحدٍ جُودٌ وحتى كَأَنْ قد كَذَبَ الواصفون الغيثَ بالجود . كما قال - البسيط - :
( أَعْطَيتَ حتّى تَرَكْتَ الرِّيحَ حاسِرةً ... وجُدْتَ حتّى كأنَّ الغَيْثَ لم يَجُدِ )
هذا فصل في " الذي " خصوصا
ًأعلمْ أنَّ لك في " الذي " علماً كثيراً وأسراراً جمَّةً وخفايا إذا بحثْتَ عنها وتصورتَها اطَّلَعْتَ على فوائدَ تُؤْنسُ النفسَ وتُثلِجُ الصَّدرَ بما يُفْضِي بكَ إليه منَ اليقين ويؤدِّيه إليكَ من حُسْنِ التَّبيين . والوجُه في ذلك أنْ تتأملَ عباراتٍ لهم فيه : لِمَ وُضِعَ ولأيِّ غَرَضٍ اجتُلِبَ وأشياءَ وصفوه بها
فمن ذلك قولهم : إن " الذي " اجتُلِبَ ليكونَ وصلةً إلى وصفِ المعارفِ بالجُمل كما اجتُلِبَ " ذو " ليتوصَّلَ به إلى الوصِف بأسماءِ الأجناس يعنون بذلك أنك تقولُ : مررتُ بزيدٍ الذي أبوه منطلِقٌ وبالرجلِ الذي كان عندَنا أمسِ . فتجدُكَ قد توصَّلتَ بالذي إلى أن يبيِّنَ أبنْتَ زيداً مِنْ غيرهِ بالجملة التي هي قولُك : " أبوه منطلِقٌ " . ولولا " الذي " لم تصِلْ إلى ذلك كما أنك تقولُ : مررتُ برجلٍ ذي مَالٍ : فُيتوصَّلُ بذي إلى أن يبيَّن الرجلُ من غيرهِ بالمال . ولولا " ذو " لم يتأتَّ لكَ ذلكَ إذ لا تستطيعُ أن تقولَ : برجلٍ مالٍ . فهذه جملةٌ مفهومةٌ إلاّ أن تحتَهَا خبايا تحتاجُ إلى الكشفِ عنها
فمن ذلك أن تَعْلَمَ مِنْ أينَ امتنعَ أن توصَفَ المعرفةُ بالجملة ولِمَ لَمْ يكن حالُها في ذلك حالَ النكرةِ التي تَصِفُها بها في قولكَ : مررتُ برجلٍ أبوه منطلِقٌ ورأيتُ إنساناً تُقادُ الجنائبُ بينَ يديِه . وقالوا : إنَّ السببَ في امتناعِ ذلك أن الجملَ نكراتٌ كلُّها بدلالة أنها تُسْتَفَادُ وإنما يستفادُ المجهولُ دونَ المعلوم . قالوا : فلمَّا كانت كذلك كانتْ وَفقاً للنكرة . فجازَ وصفُها بها ولم يَجُزْ أن توصَفَ بها المعرفةُ إذ لم تكُنْ وَفقاً لها
والقول المبينُ في ذلك أن يقالَ : إنَّه إنَّما اجتلِبَ حتى إذا كان قد عُرِفَ رجلٌ بِقصةٍ وأمرٍ جَرى له فتخصَّص بتلك القِصة وبذلك الأمِر عندَ السَّامعِ . ثم أُرِيدَ القصدُ إليه ذُكِرَ " الذي " . تفسيرُ هذا أنك لا تَصِلُ " الذي " إلاَّ بجملةٍ من الكلام قد سَبَقَ مِنَ السامعِ علمٌ بها وأمرٌ قد عَرفه له نحوُ أَنْ ترى عندَه رجلاً يُنِشدُه شعراً فتقولُ له مِنْ غدٍ : ما فَعَلَ الرجلُ الذي كانَ عندكَ بالأمس ينشدُك الشِّعرَ هذا حُكْمُ الجملةِ بَعْدَ " الذي " إذا أنتَ وصفتَ به شيئاً . فكانَ معنى قولهم : إنه اجتُلِبَ لِيتُوصَّلَ به إلى وصفِ المعارفِ بالجملة أنه جيءَ به ليفْصِلَ بين أن يُرادَ ذِكْرُ الشيءِ بجملةٍ قد عَرفها السامعُ له وبينَ أنْ لا يكونَ الأمرُ كذلك . فإنْ قلتَ : قد يُؤتى بَعْد " الذي " بالجملة غيرِ المعلومة للسامع وذلك حيثُ يكون " الذي " خبراً كقولك : هذا الذي كان عندَك بالأمسِ وهذا الذي قَدِمَ رسولاً من الحَضْرة . أنتَ في هذا وشِبْهه تُعلِمُ المخاطَبَ أمراً لم يسبِقْ له بِه علْمٌ وتفيدُه في المشارِ إليه شيئاً لم يكنْ عندَه . ولو لم يَكُنْ كذلكَ لم يكنِ " الذي " خبراً إذ كان لا يكونُ الشيءُ خبراً حتى يُفَادَ به . فالقولُ في ذلك : إنَّ الجملة في هذا النحوِ وإن كان المخاطبُ لا يعلمُها لعَيْنِ مِنْ أشرتَ إليه فإنه لا بدَّ من أن يكونَ قد عَلِمَها على الجملة وحُدِّثَ بها . فإنك على كلِّ حالٍ لا تقولُ : هذا الذي قَدِم رسولاً : لمن لم يعلم أنَّ رسولاً قدَم ولم يبلغْه ذلك في جملةٍ ولا تفصيل . وكذا لا تقولُ : هذا الذي كان عندك أمسِ لمن قد نسيَ أنه كان عندَه إنسانٌ وذهَب عن وَهْمهِ وإنما تقولُه لمن ذاك على ذِكرٍ منه . إلاَّ أنه رأى رجلاً يُقبلُ من بعيدٍ فلا يعلمُ أنه ذاك ويظنُّه إنساناً غيرَه
وعلى الجملة فكلُّ عاقلٍ يعلمُ بَوْنَ ما بينَ الخبرِ بالجملة مع " الذي " وبينها معَ غير " الذي " . فليس مِنْ أحدٍ به طِرْقٌ إلاَّ وهو لا يشكُّ أنْ ليس المعنى في قولِكَ : هذا الذي قَدِمَ رسولاً من الحضرة كالمعنى إذا قُلتَ : هذا قَدِمَ رسولاً مِنَ الحَضْرة ولا : هذا الذي يَسْكُن في محلًّة كذا كقولك : هذا يسكنُ مَحَلّةَ كذا . وليس ذاك إلا أنك في قولك : " هذا قَدِم رسولاً من الحضرة " مُبتدىءٌ خبراً بأمرٍ لم يبلغِ السامعَ ولم يُبلَّغْه ولم يَعْلَمَه أصلاً . وفي قولكَ : " هذا الذي قَدِمَ رسولاً " مُعْلِمٌ في أمرٍ قد بَلَغه أنًّ هذا صاحبُه فلم يَخْلُ إذاً منَ الذي
بدأنا به في أمرِ الجملة مع " الذي " من أنه ينبغي أن تكونَ جملةً قد سَبَق منَ السامعِ عِلمٌ بها . فاعرِفْه فإنَّه من المسائلِ التي مَنْ جَهِلها جَهِلَ كثيراً من المعاني ودخلَ عليه الغلطُ في كثيرٍ منَ الأمور . واللهُ الموفقُ للصَّواب
فروق في الحال لها فضلُ تعلُّقٍ بالبلاغة
اعلم أن أوَّلَ فَرْقٍ في الحال أّنَّها تجيءُ مفرداً وجملةً . والقصدُ هاهنا إلى الجملة . وأوَّلُ ما ينبغي أنْ يُضْبَطَ من أمِرها أَنَّها تجيءُ تارة معَ الواو وأُخرَى بغيرِ الواو فمثالُ مجيئها معَ الواو قولُك : أتاني وعليهِ ثوبُ ديباجٍ ورأيتُه وعلى كَتِفِه سيفٌ ولقيتُ الأميرَ والجندُ حَواليْهِ وجاءني زيدٌ وهو متقلِّدٌ سيفَه . ومثالُ مجيئها بغيرِ واو : جاءني زيدٌ يسعى غلامُه بين يديه وأتاني عمرٌو يقودُ فَرَسه
وفي تمييزِ ما يقتضي الواوَ مما لا يَقْتضيه صعوبةٌ . والقولُ في ذلك أنَّ الجملةَ إذا كانت من مبتدأ وخبرٍ فالغالبُ عليها أنْ تجيءَ مع الواو كقولكَ : جاءني زيدٌ وعمرٌو أمامَه وأتاني وسيفُه على كَتِفه . فإنْ كان المبتدأ من الجملةِ ضميرَ ذي الحال لم يصلُحْ بغيرِ الواو البتَّةَ وذلك كقولكَ : جاءني زيدُ وهو راكبٌ ورأيتُ زيداً وهو جالسٌ ودخلتُ عليه وهو يُمْلي الحديثَ وانتهيتُ إلى الأميرِ وهو يُعَبِّىءُ الجيشَ . فلو تركتَ الواوَ في شيءٍ من ذلك لم يصلُح . فلو قلتَ : جاءني زيدٌ هو راكبٌ ودخلتُ عليه هو يمُلي الحديثَ لم يكنْ كلاماً . فإنْ كان الخبرُ في الجملة من المبتدأ والخبر ظرفاً ثم كان قد قُدِّم على المبتدأ كقولنا : عليه سيفٌ وفي يده سوط كَثُر فيها أن تجيءَ بغَيرِ واوٍ . فمما جاء منه كذلك قولُ بشَّار - الطويل -
( إذَا أنْكرَتَنْي بَلْدَةٌ أوْ نَكِرْتُها ... خَرَجْتُ مَعَ البازي عَلَيَّ سوَادُ )
يَعْني : عليَّ بقيةٌ من الليل
وقولُ أُمية - البسيط - :
( فاشْرَبْ هنيئاً عَلَيْكَ التّاجُ مُرْتَفِقاً ... في رَأْسِ غُمْدَانَ داراً منكَ مِحْلالاً )
وقولَ الآخرِ - الطويل - :
( لقد صَبَرتْ لِلذُّل أعوادُ مِنْبرٍ ... تَقُومُ عَلَيها في يَدَيْك قَضيبُ )
كلُّ ذلك في مَوْضعِ الحالِ وليس فيه واوٌ كما ترى ولا هُوَ محتمِلٌ لها إذا نظرتَ . وقد يجيءُ تركُ الواو فيما ليس الخبرُ فيه كذلكَ ولكنه لا يكثُرُ . فمن ذلك قولهمُ : " كلَّمتُه فوهُ إلى فيَّ " و " رجَع عَودُه على بَدْئهِ في قولِ من رفعَ ومنه بيتُ " الإصلاح " - الكامل - :
( نَصفَ النهارُ الماءُ غامِرُه ... ورفيقُه بالغَيْبِ لا يدري )
ومن ذلك ما أنشدَه الشيخُ أبو عليّ في " الإغفالِ " - الطويل - :
( ولَوْلا جِنَانُ اللَّيلِ ما آبَ عامرٌ ... إلى جَعْفرٍ سِربالُهُ لم يُمزَّقِ )
وَمِمّا ظاهِرُهُ أنَّه منه قولُه - البسيط - :
( إذا أتَيتَ أبا مَرْوانَ تَسْأّلُهُ ... وجدتَهُ حاضِرَاهُ : الجُودُ والكَرَمُ )
فقولُه : " حاضراه الجودُ " : جملة من المبتدأ والخبر كما تَرى وليس فيها وَاوٌ والموضعُ موضعُ حال ألا تراكَ تقولُ : أتيتُهُ فوجدتُه جالساً فيكونُ جالساً حالاً ذاك لأنَّ " وجدتُ " في مثلِ هذا منَ الكلام لا تكونُ المتعديةَ إلى مفعولينِ ولكنْ المتعديةُ إلى مفعولٍ واحدٍ كقولكَ : وجدتُ الضاَّلةَ . إلا أنه ينبغي أن تعلمَ أنَّ لتقديمهِ الخبرَ الذي هو " حاضراه " تأثيراً في معنى الغِنى عن الواوِ وأنه لو قالَ : وجدتُه الجودُ والكرمُ حاضراهُ لم يحسُنْ حُسنه الآنَ . وكان السببُ في حسنِه معَ التقديم أنه يقرُبُ في المعنى مِنْ قولكَ : وجدتُه حاضُره الجودُ والكرمُ أو حاضراً عندَه الجودُ والكرمُ
وإن كانِت الجملةُ من فِعْلٍ وفاعلٍ والفعلُ مضارعٌ مُثْبتٌ غيرُ منفي لم يكَد يجيءُ بالواوِ بل ترى الكلامَ على مَجيئها عاريةً منَ الواو كقولك : جاءني زيدٌ يسعى غلامُه بينَ يديِه . وكقوله - البسيط - :
( وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْل يَسْفَعُني ... يومٌ قُدَيْديمَةَ الجوزاءِ مسمومٌ )
وقولِهِ - الخفيف - :
( وَلَقد أغْتدي يدافِعٌ رُكْني ... أحْوَذِيٌّ ذُو مَيْعَةٍ إضْريجُ )
وكذلك قولُك : جاءني زيدٌ يسرعُ . لا فَصْلَ بينَ أن يكونَ الفعلُ لذي الحالِ وبينَ أن يكونَ لمن هو مِنْ سببِه فإنَّ ذلك كلَّه يستمرُّ على الغَنى عن الواوِ . وعليه التَّنزيلُ والكلامُ ومثالهُ في التنزيل قولُه عَزَّ وجَلّ ( ولا تَمْنُنْ تَسْتَكثِرْ ) وقولُه تعالى : ( وسَيُجَنَّبُها الأَّتْقَى . الذي يؤْتي مَاَلَهُ يَتَزَكَّى ) وكقوله عَزّ اسمُه ( وَيَذَرُهُم في طُغْيَانِهم يَعْمَهُونَ ) . فأما قولُ ابن هَمّامٍ السَّلُولي - من المتقارب - :
( فَلَمَّا خَشِيْتُ أَظافيرهُ ... نَجَوْتُ وأّرْهُنُهم مَالِكا )
في روايةِ مَن رَوى " وأرهُنُهم " وما شَبَّهوه به مِنْ قولهم : قُمْتُ وأَصُكُّ وَجههَ . فليستَ الواو فيها للحال وليس المعنى : نجوتُ راهناً مالكاً وقمتُ صاكًّا وجهَهُ ولكن أرهنُ وأَصُكُّ حكايةُ حالٍ مثلُ قوله - الكامل - :
( وَلَقد أمُرُّ على اللَّئيمِ يَسُبُّني ... فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ : لا يَعْنِيني )
فكما أن " أمرُّ " هاهُنا في معنى " مررت " كذلك يكون أَرْهَنُ وأَصُكُّ هناك في معنى " رَهَنْتُ وصَكَكَتُ " . ويبينُ ذلك أنك تَرى الفاءَ تجيءُ مكانَ الواوِ في مثلِ هذا وذلك كنحوِ ما في الخبر في حديثِ عبدِ الله بن عَتيك حينَ دَخَلَ على أبي رافعٍ اليهوديِّ حصْنَه قال : " فانتهيتُ إليه فإذا هو في بَيْتٍ مظلمٍ لا أدري أينَ هوَ منَ البيتَ . فقلتُ : أبا رافعٍ . فقالَ : مَنْ هذا فأهويتُ نحوَ الصَّوْتِ فأضرِبُه بالسَّيف وأنا دَهِشٌ " . فكما أنَّ " أضرِبُه " مضارعٌ قد عَطَفه بالفاء على ماضٍ لأنه في المعنى ماضٍ كذلك يكون " أرهُنُهم " معطوفاً على الماضي قبلَه . وكما لا يُشَكُّ في أن المعنى في الخبر : " فأهويتُ فضربتُ " كذلك يكون المعنى في البيت " نجوتُ ورهنتُ " . إلا أنَّ الغرضَ في أخراجهِ على لفظِ الحالِ أن يَحكيَ الحالَ في أحدِ الخبرين ويدعَ الآخَرَ على ظاهرهِ كما كان في : " ولقد أمرُّ على اللئيمِ يسبُّني فمضَيْتُ "
إلاَّ أنّ الماضي في هذا البيت مؤخَّرٌ معطوف وفي بيتِ ابن هَمَّام وما ذكرناه معه مقدَّمٌ معطوفٌ عليه فاعرِفْه
فإن دخلَ حرفُ نفيٍ على المضارع تغيرَّ الحكمُ فجاءَ بالواوِ وبتَرْكِها كثيراً وذلك مثلُ قولِهم : كنتُ ولا أُخشَّى بالذئبِ . وقولِ مسكين الدَّارمِي - من الرمل - :
( أكْسَبَتْهُ الوَرَقُ البيضُ أباً ... وَلَقد كانَ ولا يُدعَى لأَبْ )
وقولِ مالِك بن رُفَيعٍ وكان جَنَى جنايةً فطلَبه مُصْعَبُ بنُ الزُّبَيْر - الوافر - :
( أَتَاني مُصْعَبٌ وبَنُوا أبيهِ ... فأَيْنَ أَحِيدُ عَنْهمْ لا أَحِيدُ )
( أَقَادُوا مِنْ دَمي وتَوَعَّدُوني ... وكُنْتُ وما يُنْهْنِهُني الوَعيدُ )
" كان " في هذا كلِّه تامةٌ والجملةُ الداخلُ عليها الواوُ في موضِعِ الحال ألا ترى أنَّ المعنى " وُجِدْتُ غيرَ خاشٍ للذئبِ . ولقد وُجِدَ غيرَ مدعوِّ لأَبٍ . وَوُجِدتُ غيرَ مُنهنهٍ بالوعيد وغيرَ مبالٍ به " ولا معنًى لجعلها ناقصةً وجَعْلٍ الواوِ مزيدةً . وليس مَجيءُ الفعل المضارعِ حالاً على هذا الوجه بعزيزٍ في الكلام . ألا تراكَ تقولُ : جعلتُ أمشي وما أدري أينَ أضَعُ رجلي وجَعَل يقولُ ولا يدري وقال أبو الأَسود :
" ويُصيبُ وما يدري " وهو شائعٌ كثيرٌ
فأمَّا مجيءُ المضارعِ مَنفياً حالاً من غيرِ الواوِ فيكثرُ ويَحْسُن . فمن ذلك قولُهُ - الطويل - :
( مَضَوْا لا يُريدونَ الرَّوَاحَ وغَالَهُمْ ... منَ الدَّهرِ أسْبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرِ )
وقال أرطاةُ بنُ سُهَيَّةَ وهو لطيفٌ جداً - البسيط - :
( إنْ تلْقَني لا تَرى غَيْري بناظرةٍ ... تَنْسَ السلاحَ وتَعرِفْ جبهةَ الأَسَدِ )
فقولُه : " لا ترى " : في موضعٍ حال . ومثلُه في اللُّطفِ والحُسْنِ قولُ أعشى هَمْدان وصَحِبَ عتّابَ بنَ وَرقاءَ إلى أصبهانَ فلم يَحْمَدْه فقال - الوافر - :
( أَتَينا أَصْبَهَانَ فَهزّلَتْنا ... وكنَّا قبلَ ذلك في نَعيمِ )
( وكانَ سَفاهةً مِنِّي وجَهلاً ... مَسيري لا أسيرُ إلى حَميمِ )
قولُه : لا أسيرُ إلى حَميمٍ . حالٌ من ضميرِ المتكَلم الذي هو الياءُ في " مَسِيري " وَهُوَ فاعلٌ في المعنى . فكأنه قال : وكان سَفاهةً مني وجهلاً أنْ سِرتُ غيرَ سائرٍ إلى حَميمٍ وأنْ ذهبتُ غيرَ متوجِّهٍ إلى قريبٍ . وقال خالدُ بنُ يزيدَ بِن معاويةَ - الكامل - :
( لَو أنَّ قَوْماً لارْتِفاعِ قَبيلةٍ ... دَخَلُوا السَّماءَ دخَلْتُها لا أُحْجَبُ )
وهو كثيرٌ إلا أنّه لا يَهْتدي إلى وضْعِه بالموضع المرضِي إلا مَنْ كان صحيحَ الطَّبع
ومما يجيءُ بالواوِ وغيرِ الواوِ الماضي وهو لا يقعُ حالاً إلاّ مع " قد " مُظهَرة أو مُقدَّرة . أمّا مجيئُها بالواوِ فالكثيرُ الشائعُ كقولِكَ : " أتاني وَقَدْ جَهَدَه السَّيُر " . وأّمَّا بغيرِ الواو فكقولِه - البسيط - :
( مَتَى أَرَى الصُّبْحَ قَدْ لاَحَتْ مَخايِلُهُ ... واللَّيْلَ قَدْ مُزِّقتْ عَنْهُ السَّرابِيلُ )
وقولِ الآخر - الوافر - :
( فآبُوا بالرّماحِ مُكَسَّراتٍ ... وأُبْنا بالسُّيوفِ قَدِ انْحِنْينا )
وقال آخرُ وهو لطيفٌ جداً - الكامل - :
( يَمْشُونَ قد كَسَرُوا الجُفُونَ إلى الوَغى ... مُتَبَسِّمينَ وفِيهُمُ اسْتِبْشارُ )
وممِّا يجيءُ بالواو في الأكثرِ الأَشْيَعِ ثم يَأتي في مواضعَ بغيرِ الواو فَيَلْطُف مكانهُ ويدلُّ على البلاغة الجملةُ قد دخلَها " ليس " تقول : أتاني وليس عليه ثوبٌ ورأيتُه وليس معه غيرُه . فهذا هوَ المعروفُ المستعمَلُ . ثم قد جاءَ بغيرِ الواو فكانَ من الحُسْن على ما تَرى وهو قولُ الأعرابي - الرجز - :
( لَنا فتًى وحبَّذا الأَفْتَاءُ ... تعرفُهُ الأَرْسانُ والدِّلاءُ )
( إذا جَرىَ في كفِّهِ الرِّشاءُ ... خَلَّى القَليبَ ليسَ فيهِ الماءُ )
وممّا يَنبغي أن يُراعى في هذا الباب أنَّكَ ترى الجملةَ قد جاءتْ حالاً بغيرِ واوٍن ويَحْسُن ذلك . ثم تنظُر فترى ذلك إنما حَسُنَ من أجلِ حَرْفٍ دخلَ عليها مثالُهُ قولُ الفرزدق - الطويل - :
( فَقُلْتَ : عَسى أّنْ تُبْصِريني كأنَّما ... بَنِيَّ حَواليَّ الأُسودُ الحَوارِدُ )
قولُه : " كأنما بنيَّ " إلى آخرهِ في موضعِ الحال من غَيْرِ شُبْهة . ولو أنك تَرَكْتَ " كأن " فقلتَ : عسى أن تبصريني بنَّي حواليَّ كالأَسود . رأيَته لا يحسُن حُسْنَه الأولَ ورأيتَ الكلامَ يقتضي الواو كقولكَ : عسى أن تُبصريني وبَنَّي حوالَّي كالأّسود الحواردِ
وشبيهٌ بهذا أنك ترى الجُملة قد جاءتْ حالاً بِعقبِ مُفْردٍ فَلَطُفَ مكانُها . ولو أنك أردتَ أن تجعلَها حالاً من غيرِ أن يَتقدَّمَها ذلك المفردُ لم يحسُنْ . مثالُ ذلك قولُ ابنِ الرومي - السريع - :
( واللّهُ يُبقيكَ لنا سَالِماً ... بُرْداكَ تَبْجيلٌ وتَعْظيمُ )
فقولُه : بُرْداك تبجيلٌ في مَوْضِع حالٍ ثانية . ولو أنَّك أسقطتَ " سالماً " من البيت فقلتَ " واللّهُ يُبقيكَ برداكَ تبجيلٌ . لم يكن شيئاً
وإذْ قد رأيتَ الجملَ الواقعةَ حالاً قد اختلفَ بها الحالُ هذا الاختلافَ الظاهرَ فلا بُدْ من أن يكونَ ذلك إنَّما كان من أجلِ عِلَلٍ تُوجِبُه وأسبابٍ تَقْتضيِه . فمحالٌ أن يكونَ هاهُنا جملةٌ لا تَصِحُّ إلاَّ مع الواوِ وأخرى لا تَصْلُحُ فيها الواوُ وثالثةٌ تَصْلُحُ أن تجيءَ فيها بالواو وأن تَدَعَها فلا تجيءُ بها . ثم لا يكونُ لذلك سببٌ وعلَّةٌ . وفي الوقوفِ على العِلَّة في ذلك إشكالٌ وغموضٌ . ذاك لأنَّ الطريقَ إليه غيرُ مسلوكٍ والجهةَ التي منها تُعْرَف غيرُ معروفة . وأنا أكتبُ لك أصلاً في الخبرِ إذا عرفتَه انفتحَ لك وجُه العِلة في ذلك
واعلمْ أن الخبرَ ينقسم إلى خَبَرٍ هو جزءٌ منَ الجملة لا تتمُّ الفائدةُ دونه وخبرٍ ليس بجزءٍ مِنَ الجملةِ ولكنَّه زيادةٌ في خَبَر آخرَ سابقٍ له . فالأولُ خبرُ المبتدا كمُنْطَلِقٍ في قَوْلِكَ : زيدٌ منطلقٌ . والفعلُ كقولك : خرجَ زيدٌ . وكلُّ واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة وهو الأصلُ في الفائدة . والثاني هو الحالُ كقولك : جاءني زيدٌ راكباً . وذاك لأن الحالَ خبرٌ في الحقيقة من حَيْثُ إنك تُثْبتُ بها المعنى لذي الحالِ كما تُثبِته بالخبرِ للمبتدأ وبالفعلِ للفاعل . ألا تراكَ قد أثبتَّ الركوبَ في قولك : جاءني زيدٌ راكباً لزيدٍ إلا أن الفَرْقَ أنك
جئتَ به لتزيدَ معنًى في إخباركَ عَنْه بالمجيء وهو أنْ تَجعَله بهذه الهيئةِ في مجيئهِ . ولم تجرِّد إثباتَك للركوب ولم تباشِرْه به ابتداءً بل بدأتَ فأثبتَّ المجيءَ ثم وصلت به الركوبَ . فالتبسَ به الإثباتُ على سبيلِ التَّبَع لغيِره وبشرطِ أنْ يكونَ في صِلَتِهِ . وأمّا في الخبِر المطلق نحو " زيدٌ منطلقٌ وخرج عمرٌو " فإنَّك أثبتَّ المعنى إثباتاً جرَّدتَه له وجعلتَه يبُاشِرهُ من غيرِ واسطةٍ ومن غير أن تتسبَّبَ بغيره إليه
وإذْ قَدْ عَرَفْتَ هذا فاعلمْ أنَّ كلًّ جملةٍ وقعتْ حالاً ثم امتنعتْ منَ الواو فذاك لأَجْلِ أنَّك عمَدتَ إلى الفعل الواقعِ في صدرِها فضممتَه إلى الفعلِ الأَول في إِثباتٍ واحدٍ . وكلُّ جملة جاءَتْ حالاً ثم اقتضِت الواو فذاكَ لأنكَ مستأنِفٌ بها خبراً وغيرُ قاصدٍ إلى أن تضمَّها إلى الفعلِ الأوًّل في الإثبات
تفسيرُ هذا أَنك إذا قلتَ : جاءني زيدٌ يسرعُ . كانَ بمنزلة قولِكَ : جاءني زيدٌ مسرعاً . في أنك تثبتُ مَجيئاً فيه إسراعٌ وتصلُ أحدَ المعنيين بالآخَرِ وتجعلُ الكلامَ خبراً واحداً وتريدُ أن تقولَ : جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة . وهكذا قولُه :
( وقد عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُني ... يَوْمٌ قُدَيدِيمَةَ الجَوزاءِ مَسْمُومُ )
كأنه قال : وقَدْ عَلَوتُ قُتودَ الرحل بارزاً للشمس ضاحياً . وكذلك قولُه :
( مَتَى أَرَى الصُّبْحَ قَدْ لاَحَتْ مَخايِلُه ... )
لأنه في معنى : متى أرى الصبحَ بادياً لائحاً بَيِّناً متجلِّياً وعلى هذا القياس أبداً . وإذا قلتَ : جاءني وغلامُه يسعى بَيْنَ يديه ورأيتُ زيداً وسيفُه على كتفه . كان المعنى على أنك بدأتَ فأثبتَّ المجيءَ والرؤيةَ ثم استأنفتَ خبراً وابتدأتَ إثباتاً ثانياً لسعيِ الغلام بينَ يديه ولكونِ السيفِ على كتِفِهِ . ولمَّا كان المعنى على استئنافِ الإثبات احتيجَ إلى ما يربِطُ الجملةَ الثانية بالأُولى فجيءَ بالواو كما جيءَ بها في قولك : زيدٌ منطلقٌ وعمرٌو ذاهبٌ والعلمُ حسنٌ والجهلُ قبيحٌ . وتسميتُنا لها " واو الحال " لا يُخرجُها عن أنْ تكونَ مُجتلبةً لضمِّ جملةٍ إلى جملة . ونظيرُها في هذا الفاءُ في جوابِ الشرطِ نحوُ : إن تأتِني فأنتَ مُكْرَم
فإنها وإنْ لم تكن عاطفةً فإن ذلك لا يُخرجُها مِنْ أن تكونَ بمنزلة العاطفة في أنها جاءتْ لتربِطَ جملةً ليس مِنْ شأنِها أن ترتبِطَ بنفسِها فاعرفْ ذلك ونزِّلِ الجملةَ في نحوِ : جاءني زيدٌ يسرعُ وقد عَلَوْتُ قُتودَ الرَحْل يسفعني يوم منزلةَ الجزاءِ الذي يستغني عنِ الفاء لأنَّ من شأنِه أن يرتبطَ بالشَّرط مِنْ غيرِ رابطٍ وهو قولُك : إن تُعطني أّشْكُرْك . ونزِّلِ الجملةَ في : جاءني زيد وهو راكبٌ منزلة الجزاءِ الذي ليس من شأنِه أن يرتبطَ بنفسهِ ويحتاجُ إلى الفاء كالجملة في نحوِ : إنْ تأتني فأنت مُكْرَمٌ قياساً سَويَّاً وموازنةً صحيحة
فَإنْ قلتَ : لقد عَلِمْنا أنَّ علَّةَ دخولِ الواو على الجملة أن تَسْتأْنِفَ الإثباتَ ولا تصلَ المعنى الثاني بالأول في إثباتٍ واحدٍ ولا تُنزِّلَ الجملةَ منزلةَ المفرد . ولكنْ بقِيَ أنْ تَعَلَم لِمَ كان بعضُ الجمل بأن يكون تقديُرها تقديرَ المفرد في أَنْ لا يُسْتَأْنَفَ بها الإثباتُ أَوْلى مِنْ بعض وما الذي مَنَع في قولكَ : جاءني زيدٌ وهو يسرعُ أو وهو مسرعٌ أن يَدْخُلَ الإسراعُ في صلة المجيءِ ويُضامَّه في الإثبات كما كان ذلك حِينَ قلتُ : جاءني زَيْدٌ يسرعُ
فالجوابُ أنّ السببَ في ذلك أنَّ المعنى في قولك : جاءني زيدٌ وهو يسرعُ على استئنافِ إثباتٍ للسرعة ولم يكنْ ذلك في : جاءني زيدٌ يُسْرعُ . وذلك أنك إذا أعدْتَ ذكرَ زيدٍ فجئتَ بضميرِه المنفصلِ المرفوع كانَ بمنزِلِة أَنْ تُعيدَ اسمَه صريحاً فتقولُ : جاءني زيدٌ وزيدٌ يسرعُ . في أّنَّك لا تجدُ سبيلاً إلى أّنْ تُدْخِلَ " يسرعُ " في صلةِ المجيءِ وتضمَّه إليه في الإثبات . وذلك أنَّ إعادتَكَ ذكرَ زيدٍ لا تَكونُ حتى تقصدَ استئنافَ الخبرِ عنه بأنه يسرعُ وحتى تبتدىءَ إثباتاً للسُّرعَة لأنك إنْ لم تَفْعلْ ذلك تركتَ المبتدأ الذي هو ضميرُ زيدٍ أو اسمُهُ الظاهرُ بِمَضِيْعة وجعلتَه لَغواً في البَيْن وجرى مَجرى أن تقول : جاءني زيدٌ وعمرٌو يسرع أمامه . ثم تزعمُ أنك لم تستأنفْ كلاماً ولم تبتدىءْ للسُّرعة إِثباتاً وأنَّ حالَ " يُسرع " هاهُنا حالُه إذا قلتَ : جاءني زيدٌ يسرعُ . فجعلتَ السرعةَ له ولم تذكرْ عَمراً وذلك محالٌ
فإن قلتَ : إنَّما استحالَ في قولك : جاءني زيدٌ وعمرٌو يسرُع أمامه أَن تَرُدَّ " يسرعُ " إلى زيدٍ وتُنْزِلَهُ منزلَةَ قولكَ : جاءني زيدٌ يسرعُ من حيثُ كان في " يسرعُ " ضميرٌ لعمرٍو
وتَضَمُّنُهُ ضميرَ عمرٍو يمنعُ أن يكونَ لزيدٍ وأن يُقدَّرِ حالاً له . وليس كذلك : جاءني زيدٌ وهو يسرعُ لأن السرعةَ هناك لزيدٍ لا محالةَ فكيفَ ساغَ أَنْ تقيسَ إحدى المسألتين على الأُخرى قيل : ليس المانُع أن يكون يسرعُ في قولك : جاءني زيدٌ وعمرٌو يسرع أمامه حالاً من زيدٍ أنَّه فعلٌ لعمرٍو . فإنك لو أخَّرتَ عَمراً فرفعتَه بيسرع وأوليتَ " يسرعُ " زيداً فقلتَ : جاءني زيدٌ يسرعُ عمرٌو أمامَه . وجدتَه قد صَلُح حالاً لزيدٍ مع أنه فِعْلٌ لعمرٍ وإنما المانُع ما عرَّفْتُك من أنكَ تدعُ عمراً بِمَضْيعةٍ وتجيءُ به مبتدأ ثم لا تُعطيه خبراً . ومما يَدُلُّ على فسادِ ذلك أنه يؤدي إلى أن يكونَ " يسرعُ " قد اجتمعَ في موضعِه النَّصبُ والرفُع وذلك أنَّ جعلَه حالاً من زيدٍ يقتضي أن يكونَ في مَوْضِع نصبِ وجعلَه خبراً عن عمرٍو المرفوعِ بالابتداءِ يَقتضي أَنْ يكونَ في موضعِ رفعٍ . وذلك بِّينُ التًّدافعِ . ولا يَجِبُ هذا التًّدافُع إذا أخَّرتَ عمراً فقلتَ : جاءني زيدٌ يسرعُ عمرُو أمامَه . لأنك ترفعُه بيسرعُ على أنه فاعلٌ له . وإذا ارتفعَ به لم يوجبْ في موضِعه إعراباً فيبقى مُفْرَغاً لأن يقدَّرَ فيه النصبُ على أَنه حالٌ من زيد وجَرَى مَجْرى أن تقولَ : جاءني زيدٌ مسرعاً عمرٌو أمامه . فإن قلتَ : فقد ينبغي على هذا الأصلِ أن لا تجيءَ جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ حالاً إلاّ معِ الواو وقد ذكرتَ قَبْلُ أنَّ ذلك قد جاءَ في مواضعَ من كلامهم فالجوابُ أنَّ القياسَ والأصلَ أن لا تجيءَ جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ حالاً إلاّ مع الواو . وأما الذي جاءَ من ذلك فسبيلُهُ سبيلُ الشيءِ يَخْرُج عن أصله وقياسِه والظاهِر فيه بضربٍ منَ التَّأويل ونوعٍ منَ التشبيه . فقولُهم : " كلمته فُوهُ إلى فيَّ " إنما حَسُن بغيرِ واو من أجلِ أنَّ المعنى كلمتُه مُشافِهاً له . وكذلك قولُهم : " رجعَ عَودُه على بَدْئه " إنما جاءَ الرفعُ فيه والابتداءُ من غيرِ واو لأن المعنى : رجعَ ذاهباً في طريقه الذي جاءَ فيه . وأما قولُه : " وجدتُه حاضراه : الجودُ والكرمُ " فلأَنَّ تقديمَ الخبر الذي هو " حاضراه " يَجْعَلُه كأنه قال : وجدتُه حاضراً عنده الجودُ والكرم . وليس الحَمْلُ على المعنى وتنزيلِ الشيءِ منزلةَ غيرهِ بعزيزٍ في كلامِهم وقَدْ قالوا : زيدٌ اضرِبْهُ . فأجازوا أن يكونَ مثالُ الأمر في موضعِ الخبرِ لأن المعنى على النَّصب نحوُ : اضرِبْ زيداً . ووَضَعُوا الجملةَ من المبتدأ والخبر موضعَ الفعل والفاعل في نحوِ قولِهِ تعالى : ( أدَعَوْتُمُوهمُ أَمْ أنْتُمْ صامِتون ) لأن الأَصلَ في المعادلة أن تكونَ الثانيةُ كالأولى نحو ( أدعوتموهم أم صَمَتُّم )
ويدلُّ على أنْ ليس مجيءُ الجملةِ من المبتدأ والخبر حالاً بغيرِ الواو أصلاً قِلَّتُه وأنه لا يجيءُ إلاّ في الشيءِ بَعْدَ الشيء . هذا ويجوزُ أنْ يكونَ ما جاءَ من ذلك إنما جاءَ على إرادةِ الواو كما جاءَ الماضي على إرادة " قد "
واعلمْ أنَّ الوجهَ فيما كان مثلَ قولِ بشار
( خَرَجْتُ مَعَ البازي عَلَيَّ سَوادُ ... )
أن يُؤْخَذَ فيه بمذهَبِ أبي الحسن الأخفشِ فيُرْفَعَ " سواد " بالظرفِ دونَ الابتداء ويَجْري الظرف هاهُنا مَجراه إذا جَرتِ الجملةُ صفةً على النكرة نحوُ : مررتُ برجلٍ معه صقرٌ صائداً به غداً . وذلك أنَّ صاحبَ الكتاب يُوافِقُ أبا الحسنِ في هذا الموضع فيرفَعُ " صقرٌ " بما في " مَعَه " مِنَ الفعلِ . فلذلكَ يجوزُ أن يُجْريَ الحالَ مُجْرى الصفةِ فَيرفَعُ الظاهرَ بالظرف إذا هو جاءَ حالاً فيكونُ ارتفاعُ " سواد " بما في " عَليَّ " من معنى الفعل لا بالابتداء . ثم ينبغي أن يُقَدَّر هاهُنا خصوصاً أنّ الظرفَ في تقديرِ اسم فاعلٍ لا فعل أعني أنْ يكونَ المعنى " خرجتُ كائناً عليَّ سوادٌ أو باقياً عليَّ سوادٌ " ولا يُقدَّرُ " يكون سوادٌ عليَّ ويبقى عليَّ سواد اللهمَّ إلاَّ أن تقدِّرَ فيه فعلاً ماضياً مع " قد " كقولك : خرجتُ مع البازي قد بقيَ عليًّ سوادٌ والأوُل أظهرُ
وإذا تأملتَ الكلامَ وجدتَ الظرفَ وقد وقع مواقعَ لا يستقيمُ فيها إلاّ أنْ يقدَّر تقديرَ اسم فاعلٍ . ولذلك قال أبو بكرِ بنُ السرَّاج في قولِنا : زيدٌ في الدار إنك مخيَّرٌ بين أنْ تقدِّرَ فيه فعلاً فتقولَ : استقرَّ في الدارِ وبينَ أن تقدِّرَ إسمَ فاعلٍ فتقولَ : مستقرٌ في الدار . وإذا عاد الأمرُ إلى هذا كان الحالُ في تركِ الواو ظاهرةً وكان " سوادٌ " في قوله : خرجتُ مع البازي عليَّ سوادٌ بمنزلة " قضاء الله " في قولِه - الطويل - :
( سأغْسِلُ عَنّي العارَ بالسَّيْفِ جالِباً ... عَلَيَّ قَضاءُ اللّهِ ما كانَ جَالباً )
في كونِه اسماً ظاهراً قد ارتفعَ باسمِ فاعلٍ قد اعتمد على ذي حالٍ فعَمِل عملَ الفِعْل . ويدلُّكَ على أن التقديرَ فيه ما ذكرتُ وأنّه من أجْلِ ذلك حَسُنَ أنك تقولَ : جاءني زيدٌ والسيفُ على كَتِفه وخرجَ والتاجُ عليه . فتجدُه لا يَحْسُنُ إلاّ بالواوِ وتعلمُ أنك لو قلتَ : جاءني زيدٌ السيفُ على كَتِفه وخَرَجَ التاجُ عليه . كان كلاماً نافراً لا يكادُ يقعُ في الاستعمال وذلك لأنه بمنزلةِ قولكَ : جاءني وهو متقلِّدٌ سيفَه وخرجَ وهو لابسٌ التاجَ . في أنَّ المعنى على أنك استأنفتَ كلاماً وابتدأتَ إثباتاً وأنك لم تُرِدْ . جاءني كذلكَ . ولكن جاءني وهُوَ كذلكَ فاعرِفْه
بسم الله الرحمن الرحيم
القول في الفصل والوصل
اعلمْ أنَّ العلمَ بما ينبغي أن يُصْنَعَ في الجملِ من عطفِ بعضها على بعضٍ أو تركِ العطفِ فيها والمجيءَ بها منثورةً تُسْتَأْنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى من أسرارِ البلاغة ومما لا يتأتَّى لتمامِ الصَّوابِ فيه إلاَّ الأعرابُ الخُلَّص والإَّ قَوْمٌ طُبِعُوا على البلاغة وأوتوا فنَّاً مِنَ المعرفة في ذوقِ الكلامِ هم بها أفرادٌ . وقد بلغَ من قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوهُ حَدّاً للبلاغة فقد جاء عَنْ بعضهم أنه سُئِل عنها فقال : مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الوصلِ ذاك لغموضِه ودقِة مَسْلكِه وأّنَّه لا يَكْمُلُ لإِحرازِ الفضيلة فيه أحدٌ إلاَّ كَمَلَ لسائِر معاني البلاغةواعلم أنَّ سبيلَنا أن ننظَر إلى فائدةِ العطف في المُفْرد ثم نَعودَ إلى الجملة فننظرَ فيها ونتعرفَ حالَها . ومعلومٌ أن فائدَةَ العطف في المُفردِ أن يُشْرِكَ الثاني في إِعراب الأوّل . وأنه إذا أَشْرَكَه في إِعرابه فقد أَشْرَكَه في حُكْمِ ذلك الإِعرابِ نحوُ أنَّ المعطوفَ على المرفوع بأنه فاعلٌ مثلُه والمعطوفَ على المنصوبِ بأنَّه مفعولٌ به أو فيه أوْ لُه شريكٌ له في ذلك . وإذا كان هذا أصلَه في المفرد فإِنَّ الجملَ المعطوفَ بعضُها على بعضٍ على ضربين : أحدُهما أن يكونَ للمعطوفِ عليها موضعٌ من الإِعراب وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكونَ واقعةً موقعَ المفرد . وإذا كانت الجملةُ الأولى واقعةً موقعَ المُفْرَدِ كان عطفُ الثانية عليها جارياً مَجْرى
عطفِ المفردِ وكانت وجهُ الحاجة إلى الواو ظاهراً والإِشراكُ بها في الحُكْمِ موجوداً . فإذا قلتَ : مررتُ برجلٍ خُلُقهُ حَسَنٌ وخَلْقه قبيحٌ . كنتَ قد أشركتَ الجملَة الثانيةَ في حُكمِ الأُولى وذلك الحكمُ كونُها في موضع جرٍّ بأَنَّها صفةٌ للنكرة . ونظائرُ ذلك تَكْثُر والأمرُ فيها يَسْهُلُ
والذي يشكلُ أمُره هو الضربُ الثاني وذلك أن تَعطِفَ على الجملةِ العاريةِ الموضعِ من الإِعرابِ جملةً أخرى كقولَك : زيدٌ قائمٌ وعمرٌو قاعدٌ والعِلْمُ حسنٌ والجهلُ قبيحٌ . لا سبيلَ لنا إلى أن ندَّعيَ أن الواوَ أشركتِ الثانيةَ في إِعرابٍ قد وجَبَ للأُولى بوجهٍ منَ الوجوه . وإذا كان كذلك فينبغي أنْ تعلمَ المطلوبَ مِنْ هذا العطفِ والمغْزى منه . ولمَ لَمْ يَسْتَوِ الحالُ بينَ أن تعطِفَ وبَيْنَ أن تَدَعَ العطفَ فتقولَ : زيدٌ قائمٌ عمروٌ قاعدٌ بعد أن لا يكونَ هنا أمرٌ معقولٌ يؤتَى بالعاطفِ ليُشْرِكَ بين الأولى والثانيةِ فيه
واعلمْ أنه إنما يَعْرِضُ الإِشكالُ في الوِاو دونَ غيرِها مِنْ حروفِ العطفِ وذاك لأَن تلكَ تفيدُ مع الإِشراكِ معانَي مثلَ أنَّ الفاءَ توجِبُ الترتيبَ مِنْ غَير تراخٍ وثُمَّ توجِبُه مَع تراخٍ و " أوْ " تردِّدُ الفعلَ بينَ شيئين وتجعلُهُ لأّحِدهما لا بِعَيْنِه فإِذا عطفتَ بواحدٍ منها الجملةَ على الجملةَ ظهرتِ الفائدةُ . فإذا قلتَ : أعطاني فشكرتُ ظهرَ بالفاءِ أنَّ الشكرَ كان مُعْقَباً على العطاءِ ومسبَّباً عنه . وإذا قلتَ : خرجتُ ثم خرجَ زيدٌ . أفادتْ ثم أن خروجَه كان بَعْدَ خروجِكَ وأن مُهْلَةً وقعتْ بينهما . وإذا قلتَ : يعطيكَ أو يكسوكَ . دلَّتْ أو على أنه يفعلُ واحداً منهما لا بِعَيْنِه . وليس للواو معنًى سوى الإشراكِ في الحكمِ الذي يَقْتَضيهِ الإعرابُ الذي أتبعتَ فيه الثانيَ الأولَ . فإذا قلتَ جاءني زيدٌ وعمروٌ . لم تُفِدْ بالواو شيئاً أكثرَ من إشراكِ عمرٍو في المجيء الذي أثبتَّه لزيدٍ والجمْعِ بينُه وبينَه ولا يُتَصوَّرُ إشراكٌ بينَ شيئين حتَّى يكونَ هناك معنًى يقعُ ذلك الإِشراكُ فيه . وإذا كانَ ذلك كذلكَ ولم يكن مَعَنا في قولنا : زيدٌ قائمٌ وعمرٌو قاعدٌ معنًى تزعمُ أن الواو أشركتْ بَينَ هاتين الجُملَتين فيه ثَبَتَ إشكالُ المسألة
ثم إن الذي يوجِبُه النظرُ والتأملُ أّنْ يقالَ في ذلك : إنّا وإن كنَّا إذا قلنا : زيدٌ قائم وعمرٌو قاعدٌ . فإنا لا نرى هاهُنا حكماً نزعمُ أنَّ الواو جاءتْ للجمعِ بين الجملتين فيه فإنا نرى أمراً آخرَ نحصُلُ معه على معنى الجمعِ وذلك أَنّا لا نقولُ : زيدٌ قائمٌ وعمرٌو قاعدٌ
حتى يكونَ عمرٌو بسبب من زيدٍ وحتى يكونا كالنَّظيرينِ والشريكَيْنِ وبحيث إذا عرفَ السامُع حالَ الأّوَّل عناه أن يعرفَ حالَ الثّاني . يدلُّكَ على ذلكَ أنَّكَ إنْ جئتَ فعطفتَ على الأَوَّل شيئاً ليس منه بسببٍ ولا هُوَ مما يُذْكَرُ بذكرِه ويتَّصِلُ حديثُه بحديِثه لم يستقْم . فلو قلتَ : خرجتُ اليومَ من داري . ثم قلتَ : وأحسنُ الذي يقولُ بيتَ كذا . قلتَ ما يُضْحَكُ منه . ومن هاهُنا عابوا أبا تمامٍ في قوله - الكامل -
( لا والذي هُوَ عالِمٌ أنَّ النَّوَى ... صَبِرٌ وأنَّ أبا الحُسَيْنِ كريمُ )
وذلك لأنه لا مناسبةَ بينَ كَرَمِ أبي الحسين ومرارِة النَّوى ولا تعلُّقَ لأَحِدهما بالآخرِ وليس يقتضي الحديثُ بهذا الحديثُ بذاك
واعلمْ أنه كما يجبُ أن يكونَ المحدَّثُ عنه في إحدى الجملتين بسببٍ من المحدَّثِ عنه في الأخرى كذلكَ ينبغي أنْ يكونَ الخبرُ عن الثاني مما يَجْرِي مَجْرى الشبيهِ والنظيرِ أو النَّقيضِ للخبر عن الأولِ . فلو قلتَ : زيدٌ طويلُ القامة وعمرٌو شاعرٌ . كان خُلْقاً لأنه لا مُشاكلَةَ ولا تعلُّق بينَ طولِ القامةِ وبين الشعرِ وإنما الواجبُ أن يقالَ : زيدٌ كاتبٌ وعمرٌو شاعرٌ وزيدٌ طويلُ القامة وعمرٌو قصيرٌ . وجملةُ الأمِر أنها لا تجيءُ حتى يكونَ المَعْنى في هذِهِ الجملة لَفْقاً للمعنى في الأخرى ومُضَامَّاً له مثل أن زيداً وعمراً إذا كانا أخوَيْن أو نظيرين أو مُشتبكَيِ الأحوالِ على الجملة كانتِ الحالُ التي يكونُ عليها أحدُهما من قيامٍ أو قعودٍ أو ما شاكَلَ ذَلكَ مضمومةً في النَّفسِ إلى الحالِ التي عليها الآخَرُ من غَير شَكٍ . وكذا السبيلُ أبداً والمعاني في ذلك كالأَشخاصِ . فإنما قلتَ مثلاً : العلمُ حسنُ والجهلُ قبيحٌ . لأنَّ كونَ العلم حَسَناً مضمومٌ في العقولِ إلى كونِ الجهلِ قبيحاً
واعلمْ أنَّه إذا كان المخَبرُ عنه في الجملتين واحداً كقولنا : هو يقولُ ويفعلُ ويَضُرُّ ويَنْفَعَ ويُسيءُ ويُحْسِنُ ويأمُرُ ويَنْهى ويَحُلُّ ويْعقِد ويأخُذُ ويُعْطي ويَبيعُ ويَشْتَري ويأكُلُ ويشرَبُ واشباه ذلك ازدادَ معنى الجمعِ في الواو قوةً وظهوراً وكان الأمْرُ حينئذٍ صريحاً . وذلكَ أنَّك إذا قلتَ : هو يَضُرُّ وينفعُ . كنتَ قد أفدتَ بالواو أنكَ أوجبتَ له الفعلينِ جميعاً وجعلَته يفعلُهما معاً . ولو قلتَ : يَضرُّ ينفعُ من غير واو لم يجبْ ذلك بل قد يجوزُ أن يكونَ قولُكَ ينفعُ رجوعاً عن قولك يضرٌّ وإبطالاً له . وإذا وقعَ الفعلانِ في مثلِ هذا
في الصِّلة ازدادَ الاشتباكُ والاقترانُ حتى لا يتصوَّرُ تقديرُ إفرادٍ في أحدِهما عن الآخِر وذلك في مثلِ قولَك : العَجَبُ من أني أحسنتُ وأسأتَ ويكفيكَ ما قُلتُ وسمعتَ وأيحسُنُ أن تنهَى عن شيءٍ وتأتَي مثلَه وذلك أنه لا يشبهُ على عاقلٍ أنَّ المعنى على جعلِ الفِعْلَين في حكمِ فعلٍ واحد . ومِنَ البيِّن في ذلك قولُه :
( لا تَطْمَعُوا أَنْ تُهِينُونَا ونُكْرِمَكُمْ ... وأن نَكُفَّ الأّذَى عَنْكُمْ وتُؤْذُونا )
المعنى : لا تطمعوا أن تَروا إكرامَنا وقد وُجِد مع إهانَتِكم وجامَعَها في الحصولِ . وممَّا له مأخذٌ لطيفٌ في هذا البابِ قولُ أبي تمام - الطويل - :
( لَهانَ عَلَيْنا أنْ نقولَ وتَفْعلا ... ونَذْكُرَ بَعْضَ الفَضْلِ مِنكَ وتُفضِلا )
وأعلمْ أنه كما كان في الأسماءِ ما يَصِلهُ معناهُ بالاسم قبلَه فيستغني بصلةِ معناهُ له عن واصلٍ يصلُه ورابطٍ يربِطُه وذلك كالصِّفِة التي لا تحتاجُ في اتِّصالِها بالموصوفِ إلى شيءٍ يصلُها به وكالتأكيدِ الذي يَفتقِرُ كذلك إلى ما يِصلُه بالمؤكَّد - كذلك يكونُ في الجملِ ما تتصلُ من ذاتِ نفسها بالتي قَبلها وتَستغني بربطِ معناها لها عن حَرْفِ عطفٍ يربُطها وهي كلُّ جملةٍ كانت مؤكِّدةً للتي قبلها ومبينِّةً لها . وكانت إذا حُصِّلتْ لم تكن شيئاً سِواها كما لا تكونُ الصفةُ غيرَ الموصوفِ والتأكيدُ غيرَ المؤكد . فإذا قلتَ : جاءني زيدٌ الظريفُ وجاءني القومُ كلٌّهم لم يكنِ الظريفُ وكلُّهم غيرَ زيدٍ وغيرَ القومِ
ومثالُ ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى ( آلم ذلِكَ الكِتابُ لا رَيْبَ فيه ) . قولُه ( لا رَيْبَ فيهِ ) بيانٌ وتوكيدٌ وتحقيقٌ لقولِه : ( ذلك الكتابُ ) وزيادةُ تَثْبيتٍ له وبمنزلِة أنْ تقولَ : هو ذلك الكتابُ هو ذلك الكتابُ فتعيدُه مرةً ثانيةً لتُثْبِتَه . وليس تَثْبيتُ الخبرِ غيرَ الخبرِ ولا شَيءَ يتميّزُ به عنه فيحتاجُ إلى ضامٍّ يَضُمُّه إليه وعاطفٍ يعطِفُه عليه . ومثلُ ذلك قولُه تعالى : ( إنَّ الذينَ كَفَروا سَواءٌ عَلَيْهِم أأنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . خَتَم اللَّهُ
على قلوبِهم وعلى سَمْعِهمْ وعلى أبْصارِهم غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عظيمٌ ) قولُه تعالى : ( لا يُؤْمِنُونَ ) تأكيدٌ لقولِه : ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُم ) وقولُه : ( خَتَمَ الله عَلَى قُلوبِهمْ وعَلى سَمْعِهِمْ ) تأكيدٌ ثانِ أبلغُ من الأول لأنَّ مَن كان حالُه إذا أَنْذِرَ مثلَ حالِه إذا لم يُنذَرْ كانَ في غايِة الجَهْل وكان مطبوعاً على قَلْبِه لا محالةَ . وكذلكَ قولُهُ عَزَّ وجَلَّ ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللّهِ باليَومْ الآخِرِ وما هُمْ بِمُؤمنْيِنَ يُخادِعُونَ اللّهَ ) إنما قال ( يخادِعُون ) ولم يَقُل : ويخادعون لأن هذه المخادعةَ ليست شيئاً غيرَ قولِهم : آمنا من غيرِ أن يكونوا مؤمنين . فهو إذاً كلامٌ أَكَّدَ به كلامٌ آخرُ هو في معناه وليس شيئاً سواه وهكذا قولُه عزَّ وجلَّ ( وإذا لَقُوا الَّذيِنَ آمَنُوا قالُوا آمنَّا وإذا خَلَوْا إلى شَياطينِهم قالُوا إنّا مَعَكُمْ إنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهزِئونَ ) وذلك لأنَّ معنى قولهم : إنّا معكُم أّنا لم نؤمنْ بالنبيِّ ولم نتركِ اليهوديةَ وقولُهم : ( إنما نحنُ مُستهزئون ) خبرٌ بهذا المعنى بعينه لأنَّه لا فَرْقَ بَيْن أن يقولوا : إنَّا لم نَقُل ما قُلْناه من أنَّا آمنا إلا استهزاءً . وبَيْنَ أن يقولوا : إنّا لم نَخْرُجْ من دينكِم وإنَّا معكم . بل هما في حُكْم الشيءِ الواحد . فصار كأنهم قالوا : إنَّا معكم لم نفارْقكم . فكما لا يكون إنا لم نفارقْكم شيئاً غيرَ أنَّا معكم كذلك لا يكون إنما نحنُ مستهزئونَ غيرَه فاعرِفْه
ومن الواضحِ البَيِّنِ في هذا المعنى قولُه تعالى : ( وإذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكبْراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كأنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْراً ) لم يأتِ معطوفاً نحوَ وكأنَّ في أذنيه وقراً لأنَّ المقصودَ من التشبيه بِمَنْ في أذنيه وقْرٌ هُوَ بعينه المقصودُ مِنَ التشبيه بِمَنْ لم يسمع إلاَّ أنَّ الثاني أبلغُ وأكَدُ في الذي أُرِيدَ . وذلك أنَّ المعنى في التشبيهين جميعاً أنْ يَنْفِيَ أن يكونَ لتلاوةِ ما تُلِيَ عليه من الآياتِ فائدَةٌ معه ويكونَ لها تأثيرٌ فيه وأنْ يجعلَ حالَه إذا تُلِيتْ عليه كحالِه إذا لم تُتْلَ . ولا شبهةَ في أن التشبيه بِمَنْ في أذنيه وقرٌ ابلغُ وآكَدُ في جعلِه كذلكَ مِنْ حيثُ كان مَنْ لا يصحُّ منه السَّمْعُ - وإن ارادَ ذلكَ أبعدَ مِنْ أنْ يكونَ لتلاوةِ ما يُتْلَى عليه
فائدةٌ مِنَ الذي يصحُّ منه السَّمْعُ إلاّ أنه لا يسمعُ إما اتفاقاً وإما قصداً إلى أنْ لا يسمعَ فاعرفْه وأحسِنْ تدبُّره
ومنَ اللطيف في ذلك قولُه تعالى : ( ما هذا بَشرَاً إنْ هَذا إلاّ مَلَكٌ كرِيمٌ ) وذلك أن قولَه : ( إنْ هذا إلاّ ملكٌ كريمٌ ) مشابِكٌ لقولِهِ : ( ما هذا بشراً ) ومُداخلٌ في ضِمْنه من ثلاثة أوجهٍ : وجهان هو فيهما شبيهٌ بالتأكيدِ ووجهٌ هو فيه شبيهٌ بالصفةِ . فأحدُ وجهَيْ كونِه شبيهاً بالتأكيدِ هو أنه إذا كان مَلكاً لم يكن بشراً وإذا كان كذلك كان إثباتُ كونِهِ ملكاً تحقيقاً لا محالَة وتأكيداً لنفي أنْ يكونَ بشراً . والوجهُ الثاني أن الجاريَ في العرِف والعادةِ أنه إذا قيلَ : ما هذا بشراً وما هذا بآدميٍّ والحال حالُ تعظيمٍ وتعجُّبٍ مما يُشَاهَدُ في الإِنسانُ مِنْ حُسْنِ خلْقٍ أو خُلُق أن يكونَ الغرضُ والمرادُ من الكلامِ أن يقال إنه ملَكَ وأنْ يُكْنَى به عن ذلك حتى إنَّه يكون مفهومَ اللفظ . وإذا كان مفهوماً مِنَ اللفظ قَبْلَ أن يُذْكَر كان ذكرهُ إذا ذُكِرَ تأكيداً لا محالَة لأنَّ حَدَّ التأكيدِ أنْ تحقِّقَ باللفظِ مَعْنًى قَد فُهِمَ مِنَ لَفْظٍ آخرَ قَدْ سَبَقَ منَكَ . أفلا ترى أنه إنما كان كلُّهم في قولَك : جاءني القوم كلُّهم تأكيداً من حَيْثُ كانَ الذي فُهِمَ منه وَهُوَ الشُّمولُ قد فُهم بديئاً من ظاهِرِ لفظِ القومِ . ولو أنَّه لم يكن فُهِم الشمولُ من لفظِ القومِ ولا كانَ هو مِنْ موجبه لم يكن كلٌّ تأكيداً ولكان الشمولُ مُستفاداً من كلِّ ابتداء
وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيهٌ بالصِّفة فهو أنّه إذا نُفَيَ أن يكونَ بَشراً فقد أثبتَّ له جنسَ سِواه إذْ منَ المُحالِ أن يخرُجَ من جنسِ البشرِ ثم لا يدخُلُ في جنسٍ آخرَ وإذا كانَ الأمُر كذلكَ كان إثباتُه مَلَكاً تبييناً وتعييناً لذلك الجنسِ الذي أريدَ إدخالُه فيه وإغناءً عن أن تحتاجَ إلى أن تسألَ فتقولَ : فإنْ لم يكنْ بشراً فما هُوَ وما جنسُه كما أنًّك إذا قلتَ : مررتُ بزيدٍ الظريفِ كان الظريفُ تَبييناً وتعييناً للذي اردتَ مِنْ بينَ مَنْ له هذا الاسمُ وكنتَ قد أغنيتَ المخاطَبَ عن الحاجةِ إلى أن يقول : أيَّ الزَّيدينِ أردتَ
ومما جاءَ فيه الإِثباتُ بإنْ وإلاّ على هذا الحدِّ قولُه عزَّ وجلَّ ( ومَا عَلَّمناهُ الشِّعْرَ وما يَنْبَغي لَهُ إنْ هُوَ إلاّ ذِكْرٌ وقُرآنٌ مُبِينٌ ) وقولُه ( وما يَنْطقُ عَنِ الهَوى إنْ هُوَ إلاّ وَحْيٌ
يُوحَى ) . فلا ترى أنَ الإِثباتَ في الآيتين جميعاً تأكيدٌ وتثبيتٌ لنَفي ما نُفِيَ . فإِثباتُ ما عُلِّمَه النبيُّ وأُوحَي إليه ذِكراً وقرآناً تأكيدٌ وتثبيتٌ لنَفي أن يكونَ قد عُلِّم الشعرَ . وكذلك إثباتُ ما يتلوهُ عليهم وحياً مِنَ الله تعالى تأكيدٌ وتقريرٌ لنفيِ أن يكون نُطِق به عَنْ هوًى
وأعلمْ أنَّه ما من عِلْمٍ من علومِ البلاغةِ أنتَ تقولُ إنَه فيه خَفيٌّ غامضٌ ودقيقُ صَعْبٌ إلاّ وعِلْمُ هذا البابِ أغمضُ وأخفى وأدقُّ وأصعبُ . وقد قِنَعَ الناسُ فيه بأنْ يقولوا إذا رأوا جملةً قد تُرِكَ فيها العطفُ : إنَّ الكلامَ قد استؤنفَ وقُطِعَ عما قبله لا تطلبُ أنفسُهم منه زيادةً على ذلك . ولقد غَفِلوا غَفْلةً شديدة
وممَا هو أصلٌ في هذا الباب أنَّك ترى الجملةَ وحالُها معَ التي قبلها حالُ ما يُعْطَفُ ويُقْرَنُ إلى ما قبلَه ثم تراها قَدْ وجبَ فيها تركُ العطفِ لأمرٍ عرضَ فيها صارت به أجنبيةً ممّا قبلها مثال ذلك قولهُ تعالى : ( اللهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِم وَيَمُدُّهمْ فِي طُغيانِهِمْ يعمهون ) الظاهر كما لا يخفى يقتضي أن يعطف على ما قبله من قوله : ( إنّما نحن مُسْتَهزِئون ) وذلك أنه ليس باجنبيّ مِنْه بل هو نظيرُ ما جاءَ معطوفاً من قولهِ تعالى : ( يُخادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) وقولهِ ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ ) . وما أشبهَ ذلك مما يُرَدُّ فيه العَجُزُ على الصَّدر . ثم إنك تجدهُ قد جاءَ غيرَ مطوفٍ وذلك لأمرٍ أوجبَ أنْ لا يُعطَفَ وهو أنَّ قوله : ( إنَّما نحن مُسْتَهزِئون ) حكايةٌ عنهم أنَّهم قالوا وليس بخبرٍ من الله تعالى . وقولُه تعالى : ( اللهُ يستهزىءُ بهم ) خبرٌ منَ الله تعالى أنه يجازيهم على كُفْرِهم واستهزائِهم . وإذا كان كذلك كانَ العطفُ مُمتنعاً لاستحالةِ أن يكونَ الذي هو خَبَرٌ منَ الله تعالى معطوفاً على ما هو حكايةٌ عنهم . ولا يُجَابُ ذلك أنْ يخرجَ من كونِه خبراً مِنَ الله تعالى إلى كونِه حكايةً عنهم وإلى أنْ يكونوا قد شَهِدوا على أنفسهِم بأنَّهم مؤاخَذُون وأنَّ الله تعالى يُعاقِبهم عليه
وليس كذلك الحالُ في قولهِ تعالى : ( يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعهُمْ ) . ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ ) . لأن الأوَّلَ من الكلامَيْنِ فيهما كالثاني في أنه خَبَرٌ مِنَ الله تعالى ولَيْسَ بحكايةٍ . وهذا هُوَ العِّلةُ في قولِه تعالى : ( وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قالُوا إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون . ألا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ ولكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) . إنما جاء ( إنَّهم هُمُ المُفْسِدُون ) مُستأنفاً مُفتتحاً بأَلا لأنَّه خبرٌ من الله تعالى بأنهم كذلك والذي قبله من قوله ( إنما نحن مصلحون ) حكاية عنهم فلو عطف لَلَزِم عليه مثلُ الذي قدَّمتُ ذكرَه منَ الدخولِ في الحكايةِ ولصارَ خبراً مِنَ اليهودِ ووصفاً مِنْهم لأنفسِهم بأنَّهم مُفْسِدون . ولصار كأنه قِيلَ : قالوا إنما نحنُ مُصْلِحون وقالوا إنَّهم هم المفسِدون . وذلك ما لا يُشَكُّ في فسادِه . وكذلك قولهُ تعالى : ( وإِذا قيلَ لهم آمِنوا كما آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمِنُ كِما آمَنَ السُّفهاءُ أَلا إنَّهُمْ هُمُ السُّفهاءُ ولكنْ لا يَعْلَمون ) . ولَو عُطِفَ ( إنهُم هُم السفهاءُ ) على ما قَبْلَه لكان يَكونُ قد أُدْخِلَ في الحكايةِ ولصار حديثاً مِنهم عن أنفسهم بأنهم هُمُ السفهاءُ من بَعْدِ أن زَعموا أنهم إنَما تُركوا أن يؤمِنوا لئلا يكونوا مِنَ السفهاءِ . على أنَّ في هذا أمراً آخرَ وهو أن قولَه : " أنؤمنُ " استفهامٌ ولا يُعْطَفُ الخبرُ على الاستفهام
فإِن قلت : هَلْ كان يجوزُ أن يُعْطَف قولُه تعالى : ( اللهُ يستهزئُ بِهم ) على " قالوا " من قولِه : ( قالوا إنَّا معكُم ) لا على ما بَعْدَه وكذلك كان يَفْعَلُ في ( إنَّهم هُم المفسدون ) و ( إنَهم همُ السفهاء ) . وكان يكونُ نظيرَ قولِه تعالى : ( وقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ولَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لقضي الأمر ) وذلك أن قوله ( ولو أنزلنا ملكا ) معطوف من غير شك على " قالوا " دون ما بَعْده قيل إنَّ حكمَ المعطوفِ على " قالوا " فيما نحنُ فيه مخالفٌ لحكمه في الآية التي ذكرت وذلك أنَّ " قالوا " ها هُنا جوابُ شرطٍ . فلو عُطِف قولُه : ( اللهُ يستهزىءُ بهم ) عليه لَلزِمَ إدخالُه في حُكْمِه مِنْ كونِه جواباً وذلكَ لا يَصِحُّ . وذاك أنه متى عُطِف على جوابِ الشرطِ شيءٌ بالواو كان ذلك على ضربينِ :
أحدُهما : أن يكونا شيئين يتصوَّرُ وجودُ كلِّ واحدٍ منهما دُونَ الآخر ومثالُه قولكَ : إن تأتِني أُكْرِمْكَ أعْطِكَ وأكْسُكَ
والثاني : أن يكونَ المعطوفُ شيئاً لا يكونُ حتى يكونَ المعطوفُ عليه . ويكونَ الشرطُ لذلك سبباً فيه بوساطةِ كونِهِ سبباً لأَوَّل ومثالُه قولُك : إذا رجَع الأَميرُ إلى الدار استأذنتهُ وخرجتُ فالخروجُ لا يكونُ حتى يكون الاستئذانُ وقد صارَ الرجوعُ سَبباً في الخروج من أجلِ كونِه سبباً في الاستئذان . فيكونُ المعنى في مثلِ هذا على كلامين نحوُ : إذا رجَع الأميرُ استأذنتُ وإذا استأذنت خرجتُ
وإِذْ قد عرفْتُ ذلك فإِنه لو عُطِفَ قولُه تعالى : ( اللهُ يستهزئُ بِهِم ) على " قالوا " كما زعمتَ كان الذي يتصوَّرُ فيه أن يكونَ من هذا الضربِ الثاني وأن يكونَ المعنى ( وإذا خَلَوا إلى شياطِينهم قالُوا إنَّا معكم إنما نحن مستهزئون ) . فإِذا قالوا ذلك استهزأَ اللهُ بهم ومدَّهم في طُغْيانِهم يَعْمَهون . وهذا وإن كان يُرَى أنه يَسْتَقيمُ فليس هو بمستقيمٍ وذلك أنَّ الجزاءَ إنَّما هو على نَفْس الاستهزاءِ وفِعْلِهم له وإرادتهم إيَّاه في قولهم إنّا آمنا لا على أنَّهم حَدَّثُوا عَنْ أنفسِهم بأنَّهم مستهزئون والعَطْفُ على " قالوا " يَقْتضي أَنْ يكونَ الجزاءُ على حديثهم عَنْ أنفسِهم بالاستهزاء لا عليه نفسِه . ويبيِّنُ ما ذكرناه مِنْ أنَّ الجزاءَ يَنْبغي أن يكونَ على قَصْدِهم الاستهزاءَ وفِعلهم له لا على حديثهم عن أنفسِهم بإِنّا مستهزئون أنَّهم لو كانوا قالوا لكُبرائهم : ( إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئونَ ) : وهُم يريدونَ بذلكَ دَفْعَهم عَن أنفسِهم بهذا الكلامِ وأن يَسْلَموا من شَرِّهم وأنْ يوهموهُم أَنَّهم مِنْهم وإنْ لم يكونوا كذلك لكان لا يكونُ عليهم مؤاخذةٌ فيما قالوه من حَيْثُ كانت المؤاخذةُ تكونُ على اعتقادِ الاستهزاءِ والخديعةِ في إظهار الإِيمانِ لا في القولِ : إنَّا استهزأنا من غيرِ أن يقترنَ بذلك القولِ اعتقادٌ ونيَّةٌ
هَذا وهاهُنا أمرٌ سِوَى ما مضَىَ يوجِبُ الاستئنافَ وتركَ العطفِ وهو أنَّ الحكايةَ عنهم بأنهم قالوا : كيتَ وكيتَ تحرِّكُ السامعين لأن يعلموا مصيرَ أمرِهم وما يُصْنَعُ بهم وأَتَنْزِلُ بِهِمُ النِّقْمةُ عاجلاً أم لا تنزلُ ويُمْهلَونَ وتُوقِعُ في أنفسِهم التَّمنٍِّي لأنْ يتبيَّنَ لهم ذلك . وإِذا كان كذلك كانَ هذا الكلامُ الذي هو قولُه : ( اللهُ يستهزىءُ بهم ) في معنى ما صَدَر جواباً عن هذا المقدَّرِ وقوعُه في أَنْفُسِ السامعينَ . وإذا كان مصدرُه كذلك كان حَقُّه أن يؤتَى به مبتدأ غيرَ معطوف ليكونَ في صورتِهِ إذا قيل : فإِنْ سألتم قِيلَ لكم : ( الله يَسْتَهزِىءُ بهم ويَمُدُّهمُ فِي طُغيانِهم يَعْمَهُون )
وإذا استقريتَ وجدتَ هذا الذي ذكرتُ لك من تنزيلِهم الكلامَ إِذا جاء بعقبِ ما يَقتضي
سؤالاً منزلتَه إِذا صرَّحَ بذلك السؤالِ كثيراً . فمن لطيفِ ذلك قولهُ من - الكامل - :
( زَعَمَ العَواذِلُ أَنَّنِي في غَمْرَةٍ ... صَدَقُوا ولكِنْ غَمْرَتِي لا تَنْجَلِي ! )
لمَّا حَكَى عن العواذِلِ أنَّهم قالوا : " هُوَ في غَمْرَةٍ " . وكان ذلك مما يحرِّك السامعَ لأنَّ يسألهَ فيقولَ : فما قولُكَ في ذلكَ وما جوابُك عَنْه أَخْرَجَ الكلامَ مُخْرَجَهُ إِذا كان ذلكَ قَدْ قِيل له وصارَ كأنَّه قال : أقول صَدَقُوا أنَّا كما قالوا ولكنْ لا مَطْمَعَ لهم في فلاحِي . ولو قالَ : زعمَ العواذلُ أنني في غَمْرةٍ وصَدَقُوا لكانَ يكونُ لم يَصِحُّ في نَفْسِهِ أَنَّه مسؤولٌ وأن كلامَه كلامُ مجيبٍ :
ومثْلُه قولُ الآخَرِ في الحماسة - الكامل - :
( زَعَمَ العَواذِل أنَّ ناقَةَ جُنْدَبٍ ... بجَنوبِ خَبْتٍ عُرّيَتْ وأُجِمَّتِ )
( كَذَبَ العَواذِلُ لو رأَيْنَ مُنَاخَنا ... بالقَادِسيَّةِ قُلْنَ : لَجَّ وذلَّتِ )
وقد زادَ هذا أمرَ القطعِ والاستئنافِ وتقديرَ الجواب تأكيداً بأنْ وضَعَ الظاهِرَ موضعَ المُضْمر فقال : كذَب العواذلُ ولم يَقُلْ : " كَذَبْنَ " . وذلك أنَّه لمَا أعادَ ذِكْرَ العواذلِ ظاهراً كان ذلك أَبْيَنَ وأقوىَ لكونِه كلاماً مستأَنفاً مِنْ حَيْثُ وَضَعَه وضْعاً لا يحتاجُ فيه إلى ما قَبْلَه وأتى فيه مأتَى ما لَيْس قبلَه كلامٌ . وممَّا هُوَ على ذلك قولُ الآخر - الوافر - :
( زَعَمْتُمْ أنَّ إخوتَكُم قُرَيْشٌ ... لَهُمْ إلفٌ ولَيْسَ لَكُمْ إِلافُ )
وذلك أن قولَه : لهم إلفٌ تكذيبٌ لدعواهُم أَنَّهم من قريشٍ . فهو إذاً بمنزلةِ أن يقولَ : كذبتُم لهم إلفٌ وليس لكم ذلكَ . ولو قال : زعمتُم أنَّ إخوتَكم قريشٌ ولهم إلفٌ وليس لكم إلافٌ لصارَ بمنزلةِ أن يقولَ : زعمتُم إن إخوتَكم قريشٌ وكذبتُم في أنه كانَ يَخْرجُ عن أن يكونَ موضوعاً على أ نّه جوابُ سائلٍ يقولُ له : فماذا تقولُ في زَعْمِهم ذلك وفي دعواهم فاعرِفْه
واعلمْ أنه لو أظهرَ " كذَبتْمُ " لكان يجوزُ له أن يَعْطِفَ هذا الكلامِ الذي هو قولُه : " لهم إلفٌ " عليه بالفاء فيقول : " كَذَبْتُم فلهم إلفٌ وليس لكم ذلك " . أما الآنَ فلا مَسَاغَ لدخولِ الفاءِ البتَّةَ لأنَّه يصيرُ حينئذٍ معطوفاً بالفاء على قولِه : زَعَمْتُم أنَّ إخوتَكم قريشٌ وذلك يَخْرجُ إلى المُحالِ مِنْ حيثُ يصير كأَنه يستشهدُ بقوله : لهم إلفٌ . على أنَّ هذا الزعمَ كان منهم كما أنَّك إذا قلتَ : كذَبْتمُ فلهم إلفٌ كنتَ قد استشهدتَ بذلكَ على أنهمْ كذبوا فاعرِفْ ذلك . ومن اللطيفِ في الاستئناف على معنى جعلِ الكلامِ جواباً في التقديرِ قولُ اليزيديِّ - السريع - :
( مَلَّكْتُهُ حَبْلي ولكنَّهُ ... أَلْقَاهُ من زُهْدٍ عَلى غارِبي )
( وقالَ : إِنّي في الهَوى كاذِبٌ ... انْتَقَمَ اللهُ مِنَ الكاذبِ )
استأنفَ قولَه : انتقمَ اللهُ من الكاذبِ لأَنه جعلَ نفسَه كأنه يجيبُ سائلاً قالَ له : فما تقولُ فيما اتَّهمكَ به مِن أنَّك كاذبٌ فقال : أقولُ : انتقمَ اللهُ منَ الكاذبِ . ومن النادرِ أيضاً في ذلك قولُ الآخَرِ - الخفيف - :
( قالَ لي : كيْفَ أَنْتَ قُلْتُ : عَليلٌ ... سَهَرٌ دائمٌ وحُزْنٌ طَوِيْلُ )
لِما كانَ في العادةِ إذا قيلَ للرجلِ : كيفَ أنتَ فقالَ : عليلٌ أن يسألَ ثانياً فيقالَ : ما بكَ وما علَّتُك قَدَّر كأنه قد قيلَ له ذلكَ فأَتَى بقولِه : سهرٌ دائمٌ جواباً عَنْ هذا السؤالِ المفهوم مِن فحوى الحالِ فاعرفهْ
ومن الحَسَن البيِّنِ في ذلكَ قولُ المتنبي - الوافر - :
( وما عَفَت الرِّياحُ لَهُ مَحَلاًّ ... عَفاهُ مَنْ حَدا بِهِمُ وَساقا )
لمَّا نَفَى أن يكونَ الذي يُرى به منَ الدُّروسِ والعَفاءِ منَ الرياحِ . وأن تكونَ التي فعلتْ ذلك وكان في العادةِ إذا نُفِيَ الفعلُ الموجودُ الحاصلُ عن واحدٍ فقيلَ : لم يفعلْه فلانٌ أن يقالَ : فمَنْ فعلَه قدَّر كأنَّ قائلاً قال : قد زعمتَ أنَّ الرياحَ لم تَعْفُ له مَحلاً فما عفاه إذاً فقالَ مجيباً له : عفاهُ مَنْ حَدا بِهم وساقا
ومثلُه قولُ الوليدِ بنِ يزيدَ من الهزج :
( عَرفْتُ المَنْزلَ الخالي ... عَفا مِنَ بَعْدِ أحَوْالِ )
( عَفاهُ كُلُّ حَنَّانٍ ... عَسُوفِ الوَبْلِ هَطّالِ )
لما قالَ : " عفا من بعدِ أحوالِ " قَدَّرَ كأنّه قيلَ له : فما عفاهُ فقالَ : عفاه كلُّ حنَّان
واعلمْ أن السؤالَ إِذا كانَ ظاهراً مذكوراً في مثلِ هذا كان الأكثرُ أنْ لا يُذكرَ الفعلُ في الجوابِ ويُقْتَصرَ على الاسمِ وحدهَ . فأمّا مع الإِضمار فلا يجوزُ إلاَّ أن يُذْكرَ الفعلُ . تفسيرُ هذا أنه يجوز لك إِذا قيلَ : إنْ كانتِ الرياحُ لم تَعْفُه فما عفاهُ أن تقولَ : " مَنْ حَدا بهم وسَاقا " ولا تقولَ : عفاهُ مَن حدا . كما تقولُ في جوابِ من يقولُ : مَنْ فعلَ هذا زيدٌ . ولا يجبُ أن تقولَ : فعلَه زيدٌ . وأمّا إذا لم يكنِ السُّؤالُ مذكوراً كالذي عليه البيتُ فإِنَّه لا يجوزُ أن يُتْرَكَ ذكرُ الفعلِ . فلو قلتَ مثلاً : وما عفتِ الرياحُ له محلاًّ مَنْ حدا بهم وسَاقا تزعُم أنك أردتَ " عفاهُ مَنْ حدا بهم " ثم تركتَ ذكرَ الفعلِ أَحَلْتَ لأنه إنَّما يجوزُ تركُه حيثُ يكونُ السؤالُ مذكوراً لأَن ذكرَه فيه يدلُّ على إرادتِه في الجوابِ فإِذا لم يُؤْتَ بالسُّؤالِ لم يكن إلى العلم بهِ سبيلٌ فاعرفْ ذلك
واعلم أنَّ الذي تراهُ في التنزيلِ من لفظِ " قال " مَفصولاً غيرَ معطوف هذا هو التقديرُ
فيه واللهُ أعلم . أعني مثلَ قولِه تعالى : ( هل أتاكَ حديثُ ضَيفِ إبراهيمَ المُكْرَمين . إذ دَخَلوا عليهِ فقالوا سَلاماً قال سَلامٌ قومٌ مُنْكَرون . فراغَ إلى أهلِه فجاءَ بعجْلٍ سمينٍ . فقرَّبَه إليهِم قال ألا تأكُلونَ . فَأوجَسَ منهم خِيفةً قالوا لا تَخَفْ ) جاء على ما يقعُ في أنفسِ المخلوقين منَ السُّؤال . فلما كان في العُرفِ والعادةِ فيما بينَ المخلوقينَ إذا قيل لهم : دخلَ قومٌ على فلانٍ فقالوا كذا أَن يقولوا : فما قَال هو ويقولُ المجيبُ : قال كذا أخرجَ الكلامَ ذلك المُخْرجَ لأنَ الناسَ خُوطبوا بما يتعارفونه وسُلِكَ باللفظِ معهم المَسْلكُ الذي يَسْلُكُونه . وكذلك قولُه : ( قال ألا تأكلون ) وذلك أن قولَه : ( فجاءَ بعجلٍ سمينٍ فقربه إليهم ) يقتضي أن يُتْبعَ هذا الفعلُ بقولٍ فكأنه قِيل واللهُ أعلمُ : فما قال حينَ وَضَعَ الطعامَ بين أيديهم فأتى قولُه : ( قال ألا تأكلون ) جواباً عن ذلك . وكذا ( قالوا لا تخف ) لأنَّ قولَه : ( فأوجسَ منهم خِيفةً ) يقتضي أن يكونَ من الملائكةِ كلامٌ في تأنيسِه وتَسكينه مما خامَره . فكأنه قيلَ : فما قالوا حينَ رأوه وقد تغيَّرَ ودخلتْه الخيفةُ فقيل : قالوا لا تَخفْ وذلك واللهُ أعلم المعنى في جميع ما يجيءُ منه على كثرتِه كالذي يجيءُ في قِصَّةِ فرعونَ عليه اللعنةُ وفي رَدِّ موسى عليه السلامُ كقولِه : ( قالَ فرعونُ وما ربُّ العالمين . قال ربُّ السماواتِ والأرضِ وما بَيْنَهما إنْ كنتُم مُوقِنينَ . قال لَمَنْ حولَه ألا تَسْتَمعون . قال ربُّكم وربُّ آبائكُم الأوَّلين . قالَ إنَّ رسولَكُم الذي أرسْلَ إليكُم لَمَجنونٌ . قال ربُّ المشرقِ والمغربِ وما بَيْنَهما إنْ كنتُم تعقِلون . قال لَئنَ اتَّخذْتَ إلهاً غيري لأجعلنَّك مِنَ المسجونين . قال أوَ لَوْ جِئْتُكَ بشيءٍ مُبينٍ . قال فَأْتِ بِهِ إنَّ كُنْتَ منَ الصَادِقِيْن ) جاء ذلك كلُّه واللهُ أعلمُ على تقديرِ السؤال والجوابِ كالذي جرتْ به العادةُ فيما بينَ المخلوقين فلما كان السامعُ إِذا سَمِع الخبرَ عن فرعونَ بأنه قال : وما ربُّ العالمين وقعَ في نفسه أن يقول : فما قال موسى له أتى قوله : ( قال ربُّ السماوات والأرض ) مأتى الجوابِ مبتدأ مفصولاً غيرَ معطوف . وهكذا التقديرُ والتفسيرُ أبداً في كل ما جاءَ فيه لفظُ " قال " هذا المجيء . وقد يكونُ الأمرُ في بعضِ ذلك اشدَّ وضوحاً
فممّا هَوَ في غاية الوضوح قولُهُ تعالى : ( قَالَ فَما خَطْبُكُمْ أيُّها المُرْسَلُونَ . قَالُوا إنّا
أُرْسِلْنا إلى قَوْمٍ مُجْرِمينَ ) وذلك أنَّه لا يَخْفَى على عاقلٍ أنه جاء على معنى الجوابِ وعلى أن ينزَّلَ السامعون كأنهم قالوا : فما قالَ له الملائكةُ فقيل : ( قالُوا إنّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمٍ مُجْرِمينَ ) . وكذلك قولُه عزَّ وجلَّ في سورة يس : ( واضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ إذْ جَاءهَا المُرْسَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثَالثٍ فَقالُوا إِنّا إليكُمْ مُرْسَلُونَ . قالُوا ما أَنْتُمْ إلاّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وما أَنْزَلَ الرّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلاّ تَكْذِبُونَ . قَالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . ومَا عَلَيْنَا إلاّ البَلاغُ المُبينُ . قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمُ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيمٌ . قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئنْ ذُكِّرْتُم بلْ أَنْتُم قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ . وَجاءَ مِنْ أَقْصى المَدينةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يا قَوْمِ اتِّبِعُوا المُرْسَلينَ . اتَّبِعُوْا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وهُمْ مُهْتَدُونَ ) التقديرُ الذي قدَّرْناهُ من معنى السؤالِ والجوابِ بيِّنٌ في ذلكَ كلِّه ونسألُ الله التوفيقَ للصَّواب والعِصمَةَ منَ الزَّلل
باب الفصل والوصل
فصل في الأصول العامة لوصل الجمل وفصلها
وإِذْ قد عرفتَ هذه الأصولَ والقوانين في شأنِ فصلِ الجُملِ ووصلها فاعلمْ أنّا قد حَصَلنا من ذلك على أنَّ الجملَ على ثلاثةِ أضربِجملةٌ حالُها مع التي قبلَها حالُ الصفةِ معَ الموصوفِ والتأكيدِ مع المؤكَّدِ . فلا يكونُ فيها العطفُ البتَّةَ لشَبهِ العطف فيها لو عُطِفَتْ بعطفِ الشيءِ على نفسه
وجملةٌ حالها مع التي قبلها حالُ الاسمِ يكونُ غيرَ الذي قبلَه إلا أنه يشارِكُه في حكمٍ ويدخلُ معه في معنى مثلِ أن يكونِ كِلا الاسمينِ فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه فيكون حقُّها العطف
وحملةٌ ليست في شيء مِنَ الحالين بل سبيلُها مع التي قبلها سبيلُ الاسم مع الاسم لا يكونُ منه في شيءٍ فلا يكونُ إياهُ ولا مشاركاً له في معنًى بل هو شيءٌ إن ذُكر لم يُذْكَر إلا بأمرٍ ينفردُ به . ويكونُ ذِكْرُ الذي قَبْلَه وتَركُ الذِّكْر سواءٌ في حالِه لعدم التعلقِ بينه وبينَه رأسا . وحقُّ هذا تركُ العطفِ البتَّةَ فتركُ العطفِ يكونُ إمَّا للاتصالِ إلى الغاية أوِ الانفصال إلى الغايةِ والعطفُ لما هو واسِطَةٌ بينَ الأمرين وكانَ له حالٌ بينَ حالين فاعرِفه
فصل في مسائل دقيقة في عطف الجمل
هَذا فَنٌّ من القولِ خاصٌّ دقيقٌ . اعلمْ أن ممّا يقِلُّ نظرُ الناسِ فيه من أمر العطفِ أنه قد يؤتَى بالجملةِ فلا تُعْطَفُ على ما يليها ولكنْ تُعْطَفُ على جملةٍ بينها وبينَ هذه التي تعطفُ جملةٌ أو جملتانِ . مثالُ ذلك قولُ المتنبي - الوافر - : ( تَولَّوْا بَغْتَةً فَكأنَّ بَيْناً ... تَهيِّبني فَفَاجَأَني اغْتِيالا )
( فَكانَ مَسِيرُ عِيْسِهمُ ذَمِيلاً ... وسَيْرُ الدَّمْعِ إِثْرَهُمُ انْهِمالا )
قولُه : فكان مسيرُ عيسِهم معطوفٌ على " تولَّوا بَغتةً " دونَ ما يليهِ من قولِه : " ففاجأني " لأنّا إنْ عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيثُ إنه يدخلُ في معنى كأنَّ وذلك يؤدِّي إلى أن لا يكونَ مسيرُ عيسِهم حقيقةً ويكونَ متوهِّماً كما كان تهيُّبُ البَين كذلك وهذا أصلٌ كبيرٌ . والسببُ في ذلك أن الجملةَ المتوسِّطةَ بين هذه المعطوفةِ أخيراً ويبن المعطوفِ عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى كالذي ترى أن قولَه : " فكأنّ بيناً تهيِّبني " مرتبطٌ بقوله : " تَولَّوا بَغتة " . وذلك أنَّ الثانية مسبَّبٌ والأُولى سَبَبٌ ألا تَرى أن المعنى " تولَّوا بغتةً فتوهَّمتُ أنَّ بيناً تهيَّني " ولا شكَّ أن هذا التوهُّمَ كان بسببِ أنْ كان التوليِّ بغتةً وإِذا كان كذلك كانتْ مع الأولى كالشيءِ الواحدِ وكان منزلتُها منها منزلَةَ المفعول والظرفِ وسائرِ ما يجيءُ بعدَ تمام الجملةِ من مَعْمولاتِ الفعل مما لا يمكنُ إفرادُه عل الجملةِ وأن يُعتدَّ كلاماً على حِدَتِه
وهاهُنا شيءٌ آخرُ دقيقٌ . وهو أنَّك إذا نظرْتَ إلى قوله : فكانَ مسيرُ عيسِهم ذميلاً وجدتَه لم يُعْطَفْ هو وحدَه على ما عُطِفَ عليه ولكنْ تجدُ العطفُ قد تناوَل جملةَ البيت مربوطاً آخرُه بأوله ألا ترى أنَّ الغرضَ من هذا الكلام أن يجعلَ تولِّيهم بغتةً وعلى الوجه الذي تُوُهِّم من أجلِه أنَّ البينَ تهيِّبه مُسْتدعياً بكاءه وموجباً أن ينهَمِلَ دمعُه . فلم يَعْنِه أن يذكُرَ ذَمَلانَ العيسِ إلاَّ ليذكَر هَملانَ الدمع وأن يوفِّقَ بينهما وكذلكَ الحكمُ في الأوَّل فنحنُ وإن قلنا إن العطفَ على " تَولوا بغتةً " فإِنا لا نَعْني أن العطفَ عليه وحَده مقطوعاً عمَّا بعدَه بل العطفُ عليه مَضموماً إليه ما بعدَه إلى أخرهِ . وإنَّما أردْنا بقولنا : " إنَّ العطفَ عليه " أنْ نُعلمَك أنه الأصلُ والقاعدةُ وأن نصْرِفَك عن أن تطرحَه وتجعلَ العطْفَ على ما يَلي هذا
الذي تعْطِفُه فتزعُمَ أنَّ قولَه : فكانَ مَسِيرُ عيسِهم معطوفٌ على " فاجأني " فتقعَ في الخطأَ كالذي أريناك . فأمرُ العطفِ إِذاً موضوعٌ على أنَّك تعطِفُ تارةً جملةً على جملةٍ وتعَمد أخرى إلى جُملتين أو جُمَلٍ فَتعْطِفُ بعضاً على بعضٍ ثم تعطِفُ مجموعَ هذي على مجموعِ تلك
ويَنْبغي أن يُجْعَلَ ما يُصْنَعُ في الشرطِ والجزاءِ من هذا المعنى أصلاً يُعتَبرُ به . وذلك أنك تَرى متى شئتَ جملتين قد عطفتْ إحداهُما على الأخرى ثم جَعلنا بمجموعِهِما شرطاً ومثالُ ذلك قولُه تعالى : ( ومَنْ يكْسِبْ خَطيئةً أو إثماً ثُمَّ يَرْمِ به بريئاً فقدِ احتَملَ بُهتاناً وإثْماً مُبيناً ) الشرطُ كما لا يخفَى في مجموعِ الجملتين لا في كلِّ واحدةٍ منهما على الانفراد ولا في واحدةٍ دونَ الأخرى لأَنَّا إنْ قلنا إنه في كلِّ واحدةٍ منهما عل الانفرادِ جعلناهُما شرطينِ وإذا جعلناهُما شرطينِ اقْتضَتا جزاءَينِ وليس معنا إلاّ جزاءٌ واحدُ . وإنْ قلنا إنه في واحدةٍ منهما دونَ الأخرى لَزِمَ منه إشراكُ ما ليس بشَرْطٍ في الجزم بالشرط وذلك ما لا يخفى فسادُه . ثم إنَّا نعلمُ من طريق المعنى أنَّ الجزاءَ الذي هو احتمالُ البُهتان والإِثمِ المبينِ أمرٌ يتعلَّق إيجابُه لمجموعِ ما حصلَ منَ الجملتين . فليس هو الاكتسابِ الخطيئة على الانفرادِ ولا لرِميِ البريءِ بالخَطيئةِ أو الإِثم على الإِطلاق بل لرميِ الإِنسانِ البريءِ بخطيئةٍ أو إثمٍ كانَ مَن الرامي . وكذلك الحكُم أبداً فقولُه تعالى : ( ومَنْ يخرُجْ من بيتِه مُهاجِراً إلى اللهِ ورسولهِ ثم يُدركْه المَوْتُ فقد وَقَعَ أجرُه على الله ) لم يعلَّقِ الحكمُ فيه بالهجرةِ على الانفراد بل بها مَقْروناً إليها أن يدركَه الموتُ عليها
واعلمْ أنَّ سبيلَ الجُملتين في هذا وجَعلهما بمجموعهما بمنزلةِ الجملةِ الواحدة سيبلُ الجزءينِ تُعْقَدُ منهما الجملةُ ثم يُجْعَلُ المجموعُ خبراً أو صفةً أو حالاً كقول : زيدٌ قامَ غلامهُ وزيدٌ أبوه كريمٌ ومررتُ برجلٍ أبوه كريمٌ وجاءني زيدٌ يَعدو به فرسُهُ . فكما يكونُ الخبرُ والصفةُ والحالُ لا محالَة في مجموعِ الجزءين لا في أحدِهما كذلك يكونُ الشّرطُ في مجموعِ الجملتين لا في إحداهُما . وإِذا علمتَ ذلك في الشرطِ فاحتذهِ في العطفِ فإِنكَ تجدُه مثلَه سواءً
ومما لا يكونُ العطفُ فيه إلاّ على هذا الحدِّ قولُه تعالى : ( وَما كُنْتَ بِجانِبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسى الأَمْرَ وما كُنْتُ مِنَ الشّاهدِينَ . ولكنَّا أَنْشَأَنَا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَليْهِمْ العُمُرُ وما كُنْتَ ثاوياً في أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلو عَلَيهِم آياتِنا ولكنّا كُنّا مُرْسِلين ) . لو جَريْتَ على الظاهر فجعلتَ كلَّ جملةٍ معطوفةً على ما يليها مَنَعَ منه المعنى وذلك أنه يلزمُ منه أن يكونَ قولُه : ( وَما كُنْتَ ثاوياً في أَهْلِ مَدْيَنَ ) معطوفاً على قولِه ( فَتَطاولَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ ) وذلك يقتضي دخولَه في معنى " لكن " ويصيرُ كأنه قيل : ولكنَّك ما كنتَ ثاوياً وذلك ما لا يخفى فسادُه . وإِذا كانَ ذلك بانَ منه أنه ينبغي أن يكونَ عُطِفَ مجموعُ ( وما كُنْتَ ثاوِياً في أهلِ مَدْيَنَ ) إلى ( مُرْسِلين ) على مجموعِ قولهِ ( وَمَا كُنْتَ بِجِانَبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسى الأَمْرَ ) إلى قوله ( العُمُرُ )
فإِن قلت : فهلاّ قدَّرتَ أن يكونَ ( وما كنتَ ثاوياً في أهل مدْيَن ) معطوفاً على ( وما كنتَ من الشاهدين ) دونَ أن تزعمَ أنه معطوفٌ عليه مضموما إليه ما بعدَه إلى قولهِ " العمرُ " قيل : لأنَّا إن قدَّرنا ذلك وَجَبَ أن يُنْوَى به التَّقديمُ على قوله : ( ولكنَّا أنشأَنَا قروناً ) وأن يكونَ الترتيبُ : وما كنتَ بجانبِ الغربيِّ إذْ قضَينا إلى موسى الأمرَ وما كنتَ من الشاهدين وما كنتَ ثاوياً في أهل مَدْيَنَ تتلو عليهم آياتِنا ولكنا أنشأنا قروناً فتطاولَ عليهم العمرُ ولكنّا كنا مُرسِلين وفي ذلك إزالةُ ( لكن ) عن موضِعِها الذي ينبغي أن تكونَ فيه . ذاك لأنَّ سبيلَ ( لكن ) سبيلُ ( إلاّ ) فكما لا يجوز أن تقولَ : جاءني القومُ وخرجَ أصحابُك إلا زيداً وإلا عَمراً بجعلِ " إلاّ زيداً " استثناءً من جاءني القوم و " إلاّ عمراً " من خرج أصحابُك . كذلك لا يجوز أن تصنعَ مثلَ ذلك بلكن فتقول : ما جاءني زيدٌ وما خرجَ عمرُو ولكنَّ بكراً حاضرٌ ولكنَّ أخاكَ خارجٌ : فإِذا لم يَجُزْ ذلك وكان تقديرُك الذي زعمتَ يؤدي إليه وجبَ أن تحكم بامتناعه فاعرفْهُ
وهذا وإنما تجوزُ نيَّةُ التأخيرِ في شيء معناه يَقتضِي لهُ ذلكَ التأخيرَ مثل أن كونَ الاسمِ مفعولاً لا يَقتضي له أنْ يكونَ بعدَ الفاعلِ فإِذا قُدِّمَ على الفاعل نُويَ به التأخيرُ . ومعنى ( لكن ) في الآية يقتضي أنْ تكونَ في مَوضِعها الذي هيَ فيه فكيفَ يجوزُ أن يُنْوَى بها التأخيرُ عَنْه إلى موضِعٍ آخرَ
هذه فصول شتى في أمر اللفظ والنظم فيها فضل شحذ للبصيرة وزيادة كشف عما
فيها من السريرةفصل " البلاغة ليس مرجعها إلى العلم باللغة بل العلم بمواضع المزايا
والخصائص "وغَلَطُ الناسِ في هذا البابِ كثيرٌ فمن ذلك أنَّكَ تجدُ كثيراً ممن يتكلمُ في شأن البلاغة إذا ذُكِرَ أنَّ للعربِ الفضلَ والمزيَّةَ في حُسْنِ النظمِ والتأليفِ وأن لها في ذلك شأواً لا يبلغُه الدُّخلاءُ في كلامِهم والمولَّدون جعلَ يعلِّلُ ذلك بأنْ يقولَ : لا غروَ فإنَّ اللغَةَ لها بالطَّبعِ ولنا بالتكلُّفِ ولن يبلغَ الدَّخيلُ في اللغاتِ والألسنةِ مبلغَ مَنْ نشأ عليها وبدأ مِنْ أولِ خَلْقِهِ بها . وأشباهُ هذا مما يُوْهِمُ أنَّ المزيَّةَ أتَتْها من جانبِ العلمِ باللغة وهو خطأٌ عظيمٌ منكَرٌ يُفْضي بقائله إلى رَفْعِ الإِعجازِ من حيثُ لا يعلَمُ وذَلكَ أنه لا يَثْبُتُ إعجازٌ حتى تثْبُتَ مَزايا تفوقُ علومَ البشرِ وتقصُرُ قوى نظرتِهم عنها ومعلوماتٌ ليس في مُنَنَ أفكارِهم وخواطرِهم أن تُفْضِيَ بهم إليها وأن تُطلعَهم عليها . وذلك محالٌ فيما كان علماً باللغة لأنَّه يؤدِّي إلى أن يُحدِثَ في دلائلِ اللغةِ ما لم يتواضَعْ عليه أهلُ اللغةوذلك ما لا يخْفَى امتناعُه على عاقِلِ
واعلمْ أنّا لم يوجِبِ المزيَّةَ من أجلِ العلم بأنفُسِ الفروقِ والوجوه فنستندَ إلى اللغة ولكنا أَوجبناها للعلم بمواضِعها وما ينبغي أن يُصْنَعَ فيها . فليس الفضْلُ للعلمِ بأنَّ الواوَ للجَمع والفاءَ للتَّعقيبِ بغيرِ تراخٍ " وثم " له بشرطِ التَراخي . و " إنْ " لكذا و " إذا " لكذا
ولكنْ لأن يتأتَّى لك إِذا نظمتَ شعراً والّفتَ رسالةً أن تُحسِنَ التخيُّرَ وأن تعرف لكلٍّ من ذلك موضعَه
وأمرٌ آخرُ إذا تأمَّله الإِنسان أَنِفَ من حكايةِ هذا القولِ فضلاً عن اعتقادِه وهو أنَّ المزيَّةَ لو كانت تجبُ من أجلِ اللغةِ والعلمِ بأوضاعِها وما أرادَه الواضعُ فيها لكانَ ينبغي أن لا تَجبَ إلا بمثلِ الفرقِ بين الفاء وثُمَّ وإنْ وإِذا وما أشبهَ ذلك مما يعبَّر عنه وَضْعٌ لغوي . فكانت لا تجبُ بالفَصلِ وتركَ العطفِ بالحذفِ والتكرارِ والتقديم والتأخير وسائرِ ما هو هيئةٌ يُحدِثُها لك التأليفُ ويقتضيها الغَرضُ الذي تَؤمُّ والمعنى الذي تقصِدُ وكانَ ينبغي أن لا تجبَ المزيَّةُ بما يبتدئه الشاعر والخطيبُ في كلامِهِ منِ استعارةِ اللفظ لشيءِ لم يُسْتَعَرْ له وأنْ لا تكونَ الفضيلةُ إلا في استعارةٍ قد تُعورفتْ في كلامِ العربِ وكفى بذلك جهلاً
ولم يكن هذا الاشتباهُ وهذا الغلطُ إلاَّ لأنه ليس في جُملة الخفايا والمشكلاتِ أغربُ مذهباً في الغموض ولا أعجب شأناً من هذه التي نحنُ بصَددها ولا أكثرُ تَفَلُّتاً منَ الفهمِ وانْسلالاً منها . وأنّ الذي قاله العلماءُ والبُلغاءُ في صفتِها والإِخبارِ عنها رموزٌ لا يفهمُها إلاَّ مَنْ هُوَ في مثلِ حالِهم مِنْ لُطفِ الطبعِ ومَنْ هو مهَيَّأ لفهمِ تلك الإِشاراتِ . حتى كأنَّ تلكَ الطباعَ اللطيفةَ وتلك القَرائح والأذهانَ قد تَواضعتْ فيما بينها على ما سبيلُه سيبلُ التَّرجمة يتواطأُ عليها قومٌ فلا تَعْدُوْهم ولا يعرِفُها منْ ليسَ مِنْهم
وليتَ شِعْري مِنْ أينَ لمن لَمْ يتعبْ في هذا الشأن ولم يمارسْه ولم يوفِّرْ عنايتَه عليه أن ينظرَ إلى قولِ الجاحظِ وهو يذكر إعجازَ القرآن : " ولو أن رجلاً قرأ على رجلٍ منْ خُطبائِهم وبلغائِهم سورةً قصيرةً أو طويلةً لتبيَّنَ له في نظامِها ومَخْرجها منْ لفظِها وطابَعِها أنه عاجزٌ عن مثلِها ولو تَحدَّى بها أَبْلَغَ العربِ لأظهرَ عجزَه عنها " وقولهِ وهو يذكرُ رواةَ
الأخبار : " ورأيتُ عامَّتَهم فقد طالتْ مُشاهَدتي لَهُم - وهم لا يَقفونَ إلاّ على الألفاظِ المتخيَّرةِ والمعاني المنتخَبَةِ والمخارجِ السهلةِ والديباجةِ الكريمةِ وعلى الطبعِ المتمكِّن وعلى السَبْكِ الجيدِ وعلى كلِّ كلامٍ له ماءٌ ورونقٌ " وقولهِ في بيتِ الحطيئة - الطويل - :
( متى تأتِه تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِه ... تجدْ خيرَ نارٍ عندَها خَيْرُ موقِدِ )
" وما كانَ ينبغي أن يُمدَحَ بهذا البيتِ إلاّ من هُوَ خيرُ أهلِ الأرض . على أنّي لم أُعْجَبْ بمعناه أكثرَ من عُجْبي بلفظِه وطبعِه ونَحتِه وسَبْكِهِ " فيفهَمُ منه شيئاً أو يقفُ للطابَعِ والنِّظام والنَحْتِ والسَّبْك والمَخارجِ السَّهلِة على معنًى أو يَحْلَى منه بشيءٍ . وكَيْفَ بأنْ يعرفَه ولربَّما خَفِيَ على كثيرٍ من أهلِهِ
واعلمْ أن الداءَ الدَّويَّ والذي أعيا أمرُه في هذا الباب غلط مَنْ قَدَّم الشعرَ بمعناه وأقلَّ الاحتفالَ باللفظِ وجعلَ لا يعطيه مِنَ المزيةِ إنْ هو أعطى إلا ما فَضَلَ عن المعنى : يقولُ ما في اللفظِ لولا المعنى وهلِ الكلامُ إلاّ بمعناه فأنتَ تراهُ لا يقدِّم شعراً حتى يكونَ قد أودِعَ حكمَةً أو أدباً واشتملَ على تشبيهٍ غريبٍ ومعنًى نادرٍ . فإِنْ مالَ إلى اللفظِ شيئاً ورأى أنْ ينحَلَه بعضَ الفضيلة لم يعرفْ غيرَ الاستعارةِ ثم لا ينظرُ في حالِ تلك الاستعارةِ : أحسُنَتْ بمجرَّدِ كونِها استعارةً أم منْ أجلِ فَرْقٍ ووجهٍ أم للأمرين لا يَحْفِلُ بهذا وشبههِ قد قَنِعَ بظواهرِ الأمور وبالجملِ وبأنْ يكونَ كمن يجلُبُ المتاعَ للبيعِ إنما همُّه أن يروِّجَ عنه . يرى أنَّه إِذا تكلمَ في الأخذ والسرقةِ وأحْسنَ أن يقولَ : أخذَهُ من فلانٍ وألمَّ فيه بقولِ
كذا فقدِ استكمل الفضلَ وبلغَ أقصى ما يُراد
واعلمْ أنَّا وإنْ كنّا إذا اتبعنَا العُرفَ والعادةَ وما يهجِسُ في الضَّميرِوما عليه العامةُ أرَانا ذلك أن الصَّوابَ معهم وأن التَّعويلَ ينبغي أن يكونَ على المعنى وأنه الذي لا يسوغُ القولُ بخلافِه فإِنَّ الأمرَ بالضدِّ إذا جئنا إلى الحقائقِ وإلى ما عليه المحصِّلون لأنا لم نرى متقدِّماً في علمِ البلاغةِ مبرِّزاً في شأوِها إلاّ وهو يُنكِر هذا الرأيَ ويَعيبُه ويُزْري على القائل به ويغضُّ منه . فمن ذلك ما رُويَ عن البحتَريِّ : رُوِيَ أنَّ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ طاهرٍ سأله عن مسلمٍ وأبي نواس أيُّهما أشعرُ فقال : أبو نواس . فقالَ : إنَّ أبا العباسِ ثَعْلباً لا يوافقُك على هذا . فقال : ليس هذا من شأنِ ثعلبٍ وذويهِ مِنَ المُتعاطينَ لعلْمِ الشعرِ دونَ عملِه إنما يَعلمُ ذلك مَنْ دُفِعَ في سَلْكِ طريقِ الشعرِ إلى مَضايقهِ وانتهى إلى ضَروراتِهِ . وعن بعضِهم أنه قال : رآني البحتري ومعي دفترُ شعرٍ فقال : ما هذا فقُلْتُ : شعرُ الشَّنفرى . فقال : وإلى أينَ تَمضي فقلتُ : إلى أبي العباس أقرؤه عليه . فقال : قد رأيتُ أبا عبّاسِكُم هذا منذُ أيام عندَ ابنِ ثَوَابةَ فما رأيتهُ ناقداً للشعرِ ولا مُميزاً للألفاظِ ورأيتُه يستجيدُ شيئاً وينشده وما هو بأفضل الشرعِ . فقلتُ له : أمّا نقدُه وتمييزهُ فهذه صناعةٌ أُخرى ولكنَّه أعرَفُ الناس بإِعرابهِ وغريبهِ . فما كان يُنْشِدُ قالَ : قولَ الحارثِ بنِ وَعْلَة - الكامل - :
( قَوْمي هُمُ قَتَلُوا أُميمَ أَخي ... فإِذا رَمَيتُ يُصيبُني سَهْمي )
( فَلَئِنْ عَفَوْتُ لأعْفُوَنْ جَلَلاً ... وَلَئِنْ سَطَوْتُ لأُوهِنَنْ عَظْمي )
فقلت : واللهِ ما أنشَدَ إلاّ أحسَنَ شعرٍ في أحسنِ معنًى ولفظٍ . فقال : أين الشعرُ الذي فيه عروقُ الذهبِ فقلتُ : مثلُ ماذا فقالَ : مثلُ قولِ أبي ذُؤابٍ - الكامل - :
( إن يَقْتُلوكَ فقَدْ ثَلَلْتَ عُروشَهُمْ ... بِعْتَيْبَةَ بنِ الحارثِ بنِ شهابِ )
( بأشدِّهِمْ كَلَباً عَلَى أَعْدائِهِ ... وأعزِّهِمْ فَقْداً على الأَصْحابِ )
وفي مثلِ هذا قالَ الشاعرُ - الطويل - : ( زَوامِلُ للأشعارِ لا عِلْمَ عِنْدَهم ... بِجَيِّدِها إلاَّ كعِلْمِ الأباعِرِ )
( لَعَمْرُكَ ما يَدْرِي البعيرُ إذا غَدا ... بأوساِقهِ أو رَاحَ ما في الغَرائرِ )
وقال الآخرُ - الخفيف - :
( يا أبا جَعْفَرٍ تَحَكَّمُ في الشِّعرِ ... ومَا فيكَ آلةُ الحُكَّامِ )
( إنَّ نَقْدَ الدِّينارِ إلاّ على الصَّيْرفِ ... صَعْبٌ فكيفَ نَقْدُ الكَلامِ )
( قَدْ رأينَاكَ لَسْتَ تفْرُقُ في الأَشْعارِ ... بَيْنَ الأَرْواحِ والأجْسامِ )
واعلمْ أنهم لم يَعيبوا تقديمَ الكلام بمعناه من حيثُ جَهِلوا أنّ المعنى إذا كان أدباً وحكمةً وكان غريباً نادراً فَهو أشرفُ مما ليس كذلكَ بل عابوه من حيثُ كان مِنْ حكمِ من قضى في جنسٍ من الأجناسِ بفضلٍ أو نقصٍ أن لا يعتبرَ في قَضيَّتِهِ تلك إلاّ الأوصافَ التي تخصُّ ذلك الجنسَ وترجعُ إلى حقيقتِه . وأن لا ينظَر فيها إلى جنسٍ آخرَ وإنْ كان من الأوَّل بسبيلٍ أو متصلاً به اتِّصالَ ما لا يَنْفَكُّ منه . ومعلومٌ أنَّ سبيلَ الكلامِ سبيلُ التصويرِ والصياغةِ وأنَّ سبيلَ المعنى الذي يعبَّر عنه سبيلُ الشيءِ الذي يقعُ التصويرُ والصَّوغُ فيه كالفضةِ والذهبِ يصاغُ منهما خاتَمٌ أو سِوارٌ . فكما أنَّ مُحالاً إذا أنتَ أردتَ النظرَ في صَوغِ الخاتمِ وفي جودةِ العملِ ورداءتِهِ أن ينظرَ إلى الفضةِ الحاملةِ تلك الصورةِ أو الذهبِ الذي وقعَ فيه العملُ وتلك الصنعةُ - كذلك محالٌ إِذا أردتَ أن تعرفَ مكانَ الفضلِ والمزيةِ في الكلامِ أن تَنْظُرَ في مجرَّدِ معناهُ . وكما أنَّا لو فَضَّلْنا خاتماً على خاتَمٍ بأنْ تكونَ فضةُ هذا أجودَ أو فصُّه أنفسَ لم يكنْ ذلك تفضيلاً له من حيثُ هو خاتمٌ . كذلك ينبغي إذا فضَّلنا بيتاً على بيتٍ من أجلِ معناه أن لا يكون ذلك تَفضيلاً له مِنْ حيثُ هو شعرٌ وكلامٌ وهذا قاطعٌ فاعرفُه
واعلمْ أنك لستَ تنظرُ في كتابٍ صُنِّفَ في شأنِ البلاغةِ وكلامٍ جاءَ عن القدماءِ إلاّ وجدتَه يدلُّ على فسادِ هذا المذهبِ . ورأيتَهُم يتشدَّدون في إنكارِه وعيبِه والعيبِ به . وإِذا نظرتَ في كتب الجاحظِ وجدتَه يبلغُ في ذلك كلَّ مَبلغٍ ويتشدَّدُ غايةَ التشدُّد . وقد انتهى في ذلك إلى أنْ جعلَ العلمَ بالمعنى مشتركاً وسوَّى فيه بينَ الخاصةِ والعامةِ فقالَ :
" ورأيتُ ناساً يبهرِجون أشعارَ المولَّدين ويَسْتَسْقِطونَ مَنْ رَوَاها . ولم أرَ ذلك قطُّ إلاّ في روايةِ غيرِ بصيرٍ بجوهرِ ما يروي . ولو كان له بصرٌ لعرفَ موضعَ الجيِّدِ ممن كانَ وفي أيَّ زمانٍ كان . وأنا سمعتُ أبا عمرِو الشيبانيَّ وقدْ بلغَ مِنِ استجادته لهذين البيتين ونحنُ في المسجد الجامعِ يومَ الجمعةِ أن كلَّف رجلاً حتَّى أحضَره قِرطاساً ودواةً حتّى كتبهما " . قال الجاحظُ : وأنا أزعمُ أنَّ صاحبَ هذين البيتين لا يقولُ شعراً أبداً ولولا أنْ أُدخِلَ في الحكومةِ بعضُ الغَيبِ لزعمتُ أن ابنَه لا يقولُ الشعر أيضاً . وهما قولُه - السريع - :
( لا تَحْسَبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البِلَى ... وإنَّما المَوْتُ سؤالُ الرِّجالْ )
( كِلاَهُما مَوْتُ ولكِنَّ ذَا ... أشَدُّ مِنْ ذاكَ عَلى كُلِّ حَالْ )
ثم قال : وذهبَ الشيخُ إلى استحسانِ المعاني والمعاني مطروحةٌ في الطريقِ يعرفُها العجميُّ والعربيُ والقرويُّ والبدويُّ . وإنما الشأنُ في إقامةِ الوزنِ وتخيُّرِ اللفظِ وسهولةِ المَخْرجِ وصحةِ الطَبْعِ وكثرةِ الماء وجَودةِ السَّبكِ . وإنما الشعرُ صياغةٌ
وضربٌ من التصوير . فقد تراه كيفَ اسقطَ أمرَ المعاني وأبى أنْ يجبَ لها فضلٌ . فقالَ : وهي مطروحةٌ في الطريقِ . ثمَّ قال : وأنا أزعمُ أنَّ صاحبَ هذين البيتين لا يقولُ شعراً أبداً فأعلمك أنَّ فضلَ الشعرِ بلفظهِ لا بمعناه وأنه إذا عدمَ الحُسنَ في لفظِه ونظمهِ لم يستحقَّ هذا الاسمَ بالحقيقة . وأعادَ طرفاً منْ هذا الحديثِ في " البيان " فقال : " ولقد رأيتُ أبا عمرو الشيباني يكتبُ أشعاراً منْ أفواهِ جلسائهِ ليُدخلَها في بابِ التحفُّظِ والتذكُّر . وربَّما خُيِّلَ إليَّ أنَّ أبناءَ أولئكَ الشعراءِ لا يستطيعونَ أبداً أن يقولوا شعراً جيّدا لمكان أعراقِهِم مِنْ أولئك الآباءِ . ثم قال : " ولولا أنْ أكونَ عيّاباً ثُم للعلماء خاصةً لصوَّرتُ لكَ بعضَ ما سمعتُ من أبي عبيدَة ومَنْ هو أبعدُ في وهمكِ من أبي عبيدة "
واعلمْ أنَّهم لم يبلغوا في إِنكارِ هذا المذهب ما بلغوه إِلاّ لأنَّ الخطأ فيه عظيمٌ وأنه يُفْضِي بصاحبه إِلى أنْ ينكرِ الإِعجازَ ويُبطلَ التَحدِّي من حيث لا يشعرُ . وذلك أنه إنْ كان العملُ على ما يذهبون إليه من أن لا يجب فضلٌ ومزيّةٌ إلاّ من جانِبِ المعنى وحتى يكونَ قد قالَ حكمةً أو أدباً واستخرجَ معنًى غريباً أو تشبيهاً نادراً فقد وَجِب اطِّراحِ جميعِ ما قاله الناسُ في الفصاحةِ والبلاغةِ وفي شأن النظمِ والتأليفِ . وبَطَلَ أن يجبَ بالنظم فضلٌ وأنْ تدخلَه المزيةُ وأن تتفاوتَ فيه المنازلُ . وإِذا بطَلَ ذلك فقد بطَل أنْ يكونَ في الكلامِ مُعجزٌ وصارَ الأمرُ إلى ما يقولُه اليهودُ ومن قالَ بمثلِ مقالهِم في هذا البابِ ودخلَ في مثلِ تلك الجهالاتِ . ونعوذُ بالله من العَمى بعدَ الإِبصارِ
فصل باب اللفظ والنظم
لا يكونُ لإِحدى العبارتين مزيةٌ على الأُخرى حتى يكونَ لها في المعنى تأثيرٌ لا يكونُ لصاحبتها . فإِنْ قلتَ : فإِذا أفادتْ هذه ما لا تفيدُ تلك فليستا عبارتين عَنْ معنى واحدٍ بل هما عبارتان عن معنيين اثنين قيل لك : إِن قولَنا : " المعنى " في مثل هذا يرادُ به الغرضُ . والذي أرادَ المتكلمُ أن يثبتَه أو ينفيَه نحوُ : إنْ تقصِد تشبيهَ الرجلِ بالأسد فتقول : زيدٌ كالأسد ثم تريدُ هذا المعنى بعينهِ فتقولُ : كأن زيداً الأسد . فتفيدُ تشبيهه أيضاً بالأسدِ إِلاّ أنك تزيدُ في معنى تشبيههِ به زيادةً لم تكن في الأولِ وهي أن تجعلَه من فرطِ شجاعتِه وقوةِ قلبِه وأنه لا يروعُه شيءٌ بحيث لا يتميَّز عن الأسدِ ولا يقصُرُ عنه حتى يُتوهَّم أن أسدٌ في صورة أدميٍّ . وإِذا كان هذا كذلك فانظرْ هل كانت هذه الزيادةُ وهذا الفرقُ إِلاّ بما تُوُخِّيَ في نظمِ اللفظِ وترتيبه حيثُ قدَّم الكافَ إِلى صدرِ الكلامِ وركَّبت مع " أَنَّ " . وإِذا لم يكن إِلى الشكِّ سبيلٌ أن ذلك كانَ بالنظم فاجعلْه العبرةَ في الكلام كلِّه ورُضْ نفسَك على تفهُّمِ ذلكَ وتتَّبعه واجعلْ فيها أنك تزاولُ منه أمراً عظيماً لا يُقادَر قَدْرُه وتدخلُ في بحر عميقٍ لا يُدْرَك قعرُهفصل هو فَنٌّ آخره يرجع إلى هذا الكلامُ
قد عُلِم أن المُعارضَ للكلام مُعارضٌ له من الجهةِ التي منها يُوْصَفُ بأنه فصيحٌ وبليغٌ ومتخيَّرُ اللفظِ جيدُ السبكِ ونحوُ ذلك من الأوصافِ التي نَسَبوها إلى اللفظِ
وإذا كان هذا هكذا فبِنَا أن ننظرَ فيما إِذا أُتِيَ به كان مُعارضاً ما هوَ أهو أن يجيءَ بلفظٍ فيضعَه مكانَ لفظٍ آخرَ نحوُ أنْ يقولَ بدلَ أسدٍ : ليثٌ وبدلَ بَعُدَ : نأى ومكانَ قَرُب : دَنا . أم ذلك م لا يَذْهَبُ غِليه عاقلٌ ولا يقولُه مَنْ به طِرْقٌ كيف ولو كان ذلك معارضَةً لكان الناسُ لا يفصِلون يبنَ الترجمةِ والمُعارضَةِ . ولكان كلُّ مَن فسَّرَ كلاماً مُعارِضاً له . وإِذا بطلَ أن يكونَ جهةً للمُعارضةِ وأن يكونَ الواضعُ نفسُهُ في هذِه المنزلةِ مُعارِضاً له . وإِذا بطلَ أن يكونَ جهةً للمُعارضةِ وأن يكونَ الواضعُ نفسُهُ في هذهِ المنزلةِ معارِضاً على وجهٍ منَ الوجوه علمتَ أن الفصاحةَ والبلاغةَ وسائرَ ما يَجري في طريقِهما أوصافٌ راجعةٌ إلى المعاني وإلى ما يُدَلُّ عليه بالألفاظِ دونَ الألفاظِ أنفسِها لأنه إذا لم يكنْ في القسمةِ إِلا المعاني والألفاظُ وكانَ لا يُعقَل تعارضٌ في الألفاظِ المجرَّدة إِلا ما ذكرتُ لم يبقَ إلاّ أن تكونَ المعارضةُ معارضةً من جهة ترجعُ إِلى معاني الكلام المعقولةِ دون ألفاظِه المسموعَةِ . وإِذا عادتِ المعارضةُ إِلى جهةِ المعنى وكانَ الكلامُ يعارَضُ من حيثُ هو فصيحٌ وبليغٌ ومتخيَّرُ اللفظِ حَصَلَ من ذلكَ أنَّ الفصاحةَ والبلاغةَ وتخيُرَ اللفظِ عبارةٌ عن خصائصَ ووجوهٍ تكونُ معاني الكلامِ عليها وعن زياداتٍ تحدُثُ في أصولِ المعاني كالذي أريتُك فيما بينَ : " زيدٌ كالأسد " و " كأنَّ زيداً الأسدُ " . وبأنْ لا نصيبَ للألفاظِ من حيثُ هي ألفاظٌ فيها بوجهٍ من الوجوه
واعلمْ أنك لا تَشْفي الغُلَّة ولا تنتهي إِلى ثلجِ اليقينِ حتى تتجاوزَ حدَّ العلمِ بالشيء مُجملاً إِلى العلم به مفصَّلاً وحتَّى لا يُقْنِعَك إِلاّ النظرُ في زواياهُ والتَّغلغلُ في مكامنه وحتى تكون كمن تتبَّعَ الماءَ حتّى عرفَ منْبَعَه وانتهى في البحثِ عن جوهرِ العُود الذي يصنع فيه إِلى أن يعرفَ منبتَه ومَجرى عُروقِ الشجرِ الذي هو منه . وإِنّا لنراهُم يقيسونَ الكلامَ في معنى المعارضة على الأعمالِ الصناعية كَنَسْج الديباج وصَوْغ الشَّنْفِ والسِّوار وأنواعِ ما يصاغُ وكلِّ ما هو صنعةٌ وعملُ يدٍ بعد أن يبلغَ مبلغاً يقعُ التفاضُلُ فيه ثم يعظمُ حتى يزيدَ فيه الصانعُ على الصانعِ زيادةً يكونُ له بها صِيتٌ ويدخلُ في حدِّ ما يعجُز عنه الأكثرون
وهذا القياسُ وإِن كان قياساً ظاهِراً معلوماً وكالشيءِ المركوزِ في الطباعِ حتّى ترى العامةَ فيه كالخاصَّةِ . فإِنَّ فيه أمراً يجبُ العلمُ به وهو أنه يتصوَّرُ أنْ يبدأ هذا فيعملُ ديباجاً ويُبدعُ في نقشه وتصويره فيجيءُ آخرُ ويعملُ ديباجاً آخرَ مثلَه في نقشِه وهيئته وجُملة صفتِه حتى لا يفصِلَ الرائي بينهما ولا يقعَ لمن لم يعرفِ القصَّةَ ولم يخُبرِ الحالَ إلا أنهما صنعة رجلٍ واحدٍ وخارجان من تحت يدٍ واحدةٍ . وهكذا الحكمُ في سائرِ المصنوعات كالسِّوار يصوغْه هذا ويجيءُ ذاكَ فيعملُ سِواراً مثلَه ويؤدي صنعتَه كما هي حتى لا يغادِرَ منها شيئاً البتةَ . وليس يتصوَّرُ مثلُ ذلك في الكلامِ لأنه لا سبيلَ إِلى أن تجيء إلى معنى بيتٍ مِنَ الشعرِ أو فصلٍ منَ النثر فتؤدِّيَه بعينهِ وعلى خاصِّيَّتِهِ وصِفَته بعبارةٍ أخرى حتى يكونَ المفهومُ من هذهِ هو المفهومَ من تلكَ لا يخالفُه في صفةٍ ولا وجهٍ ولا أمرٍ من الأمور . ولا يغرَّنك قولُ الناسِ : قد أتى بالمعنى بعينهِ وأخذَ معنى كلامِه فأدّاه على وجهه فإِنه تسامحٌ منهم . والمرادُ أنه أدَّى الغرضَ فأما أن يؤديَ المعنى بعينه على الوجهِ الذي يَكُونُ عليه في كلامِ الأوَّلِ حتى لا تعقلَ ها هُنا إِلاّ ما عَقَلتَه هناك وحتى يكونَ حالُهما في نفسِك حالَ الصورتين المُشْتبهتين في عينك كالسِّوارين والشِّنْفين ففي غاية الإِحالةِ وظنٌّ يُفضي بصاحبهِ إِلى جَهَالةٍ عظيمةٍ وهي أنْ تكونَ الألفاظ مختلفةَ المعاني إِذا فُرِّقتْ ومُتَّفقتها إِذا جُمِعَتْ وألِّفَ منها كلامٌ . وذلك أنْ ليس كلامنا فيما يُفْهَمُ من لفظتين مفردتين نحوُ " قعدَ وجلس " . ولكنْ فيما فهِمَ من مجموعِ كلامٍ ومجموعِ كلامٍ آخرَ نحوُ أنْ تنظر في قولِهِ تعالى : ( ولكُمْ في القِصاصِ حياةٌ ) وقولِ الناسِ : قَتْلُ البعضِ إِحياءٌ للجميع فإِنَّه وإِنْ كان قد جَرَتْ عادةُ الناسِ بأنْ يقولوا في مثلِ هذا إنهما عبارتانِ معبَّرُهما واحدٌ فليس هذا القولُ قولاً مِنْهم يمكنُ الأخذُ بظاهرِهِ أو يقعُ لعاقلٍ شَكٌّ أنْ لَيسَ المفهومُ من أحدِ الكلامَيْن المفهومَ من الآخر
فصل الكلامُ على ضربين
ضربٌ أنتَ تصلُ منه إِلى الغرضِ بدلالةِ اللفظِ وحدَه وذلك إِذا قصدتَ أن تُخبِرَ عن زيدٍ مثلاً بالخروجِ على الحقيقة فقلتَ : خرجَ زيدٌ وبالانطلاقِ عن عمرٍو فقلتَ : عمرٌو منطلِقٌ وعلى هذا القياس
وضربٌ آخرُ أنتَ لا تصلُ منه إِلى الغرضِ بدلالة اللفظِ وحده ولكنْ يدلُّك اللفظُ على معناه الذي يقتضيه موضوعُهُ في اللغُّة ثُمَّ تجِدُ لذلك المعنى دَلالةً ثانيةٌ تصلُ بها إلى الغرضِ . ومدارُ هذا الأمرِ على الكنايةِ والاستعارة والتمثيلِ . وقد مَضَتِ الأمثلُه فيها مشروحةً مُستقصاةً أوَ لا ترى أنك إذا قلتَ : هو كثيرُ رمادِ القِدْر أو قلتَ : طويلُ النجادِ أو قلتَ في المرأةِ : نَؤُومُ الضُّحا فإِنَّك في جميعِ ذلك لا تفيدُ غرضَكَ الذي تعني من مجرَّدِ اللفظِ ولكنْ يدلُّ اللفظُ على معناه الذي يوجبهُ ظاهرهُ ثم يَعْقلُ السامعُ من ذلك المعنى على سَبيلِ الاستدلالِ معنًى ثانياً هو غرضُك كمعرفتكَ من كثيرِ رمادِ القدرِ أنه مِضيافٌ ومن طويلِ النّجادِ انه طويلُ القامة ومن نؤومِ الضُّحا في المرأةِ أنه مترفةٌ مخدومةٌ لها مَنْ يكفيها أمرَها . وكذا إِذا قال : رأيتُ أسدا - ودلَّك الحالُ على أنه لم يُردِ السَّبعَ - علمتَ أنه أراد التشبيهَ إِلاّ أنه بالغَ فجعلَ الذي رآه بحيثُ لا يتميَّز من الأسد في شجاعته . وكذلك تعلمُ في قولهِ : بلغني أنك تقدِّم رجلاً وتؤخر أخرى أنه أراد التردُّدَ في أمرِ البيعة واختلافِ العزمِ في الفعلِ وتركِه على ما مضى الشرحُ فيه
وإذ قد عرفتَ هذه الجملةَ فها هنا عبارةٌ مختصرةٌ وهي أن تقولَ المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهومَ من ظاهرِ اللفظِ والذي تصِلُ إليه بغيرِ واسِطَة وبمعنى
المعنى أن تعقِلَ من اللفظِ معنًى ثم يُفْضي بكَ ذلكَ المعنى إِلى معنًى آخرَ كالذي فسَّرتُ لك
وإِذْ قد عرفتَ ذلك فإِذا رأيتَهم يجعلونَ الألفاظَ زينةً للمعاني وحِليةً عليها أو يجعلونَ المعاني كالجواري والألفاظَ كالمعارضِ لها وكالوشْيِ المحبَّر واللباس الفاخرِ والكُسوةِ الرائقة إِلى أشباهِ ذلك مما يفخِّمون به أمرَ اللفظِ ويجعلونَ المعنى يُنبل به ويشرُفُ
فاعلمْ أنّهم يضعون كلاماً قد يفخِّمونَ به أمرَ اللفظِ ويجعلونَ المعنى أعطاكَ المتكلمُ أغراضَه فيه من طريقِ معنى المعنى فكنَّى وعرَّضَ ومثَّل واستعارَ ثم أحسنَ في ذلك كلِّه وأصابَ ووضعَ كلَّ شيء مه في موضعِه وأصابَ به شاكلتَه وعمدَ فيما كنَّى به وشبَّه ومثَّل لما حَسُنَ مأخذُه ودقَّ مسلكُه ولَطُفَتْ إِشارتُه . وأن المعرضَ وما في معناه ليس هُوَ اللفظَ المَنْطوقَ به ولكنْ معنى اللفظِ الذي دّللتَ به على المعنى الثاني كمعنى قولِه - الوافر - :
( . . . . . . . . . . . . . . . . فإِنّي ... جَبانُ الكَلْبِ مَهْزولُ الفصيلِ )
الذي هو دليلٌ على أنَّه مضيافٌ فالمعاني الأُوَلُ المفهومةُ من أنفُسِ الألفاظِ هي المعارضُ والوشْيُ والحَلْيُ وأشباهُ ذلكَ . والمعاني الثَّواني التي يُومأ إِليها بتلكَ المعاني هي التي تُكْسى تلك المعارِضَ وتزيَّن بذلك الوَشي والحَلْيَ . وذلك إِذا جَعَلُوا المعنى يتصوَّر من أجلِ اللفظِ بصورةٍ ويبدو في هيئةٍ ويتشكّل بشكلٍ يرجع المعنى في ذلكَ كلِّه
إِلى الدَّلالاتِ المعنوية ولا يَصْلُحُ شيءٌ منه حيثُ الكلامُ على ظاهرهِ وحيثُ لا يكونُ كنايةٌ وتمثيل به ولا استعارةٌ ولا استعانةٌ في الجملةِ بمعنًى على معنًى وتكونُ الدلالةُ على الغرضِ من مجرَّدِ اللفظِ فلو أنَّ قائلاً قال : رأيتُ الأسَدَ وقال آخرُ : لقيتُ الليثَ لم يَجُزْ أنْ يقالَ في الثاني : إِنه صوَّرَ المعنى في غيرِ صورتِه الأولى ولا أنْ يقالَ : أبرزَه في معرضٍ سِوى مَعرضِه ولا شيئاً من هذا الجنسِ . وجملةُ الأمر أنَّ صُوَرَ المعاني لا تتغيَّر بنقلها من لفظٍ إلى لفظٍ حتى يكونَ هناك اتساعٌ ومجازٌ وحتّى لا يُرادَ منَ الألفاظِ ظواهرُ ما وُضعتْ له في اللغة ولكنْ يشارُ بمعانيها إِلى معانٍ أخَر
واعلمْ أنّ هذا كذلكَ ما دامَ النظمُ واحداً فأما إِذا تغيَّر النظمُ فلا بدَّ حينئذٍ من أنْ يتغيَر المعنى على ما مضى منَ البيانِ في مسائلِ التقديمِ والتأخيرِ وعلى ما رأيتَ في المسألةِ التي مضتِ الآن أعني قولَك : إِنَّ زيداً كالأسدِ وكأن زيداً الأسدُ ذاكَ لأَنَّه لم يتغيَّرْ من اللفظِ شيءٌ وإِنَّما تغيَّرَ النظمُ فقط . وأما فتحُك " أنّ " عندَ تقديم الكاف وكانتْ مكسورةً فلا اعتدادَ بها لأنَّ معنى الكسرِ باقٍ بحالهِ
واعلمْ أنَّ السَبب في أنْ أحالوا في أشباهِ هذِه المحاسنِ التي ذكرتُها لكَ على اللفظِ أنها ليستْ بأنفُسِ المعاني بل هي زياداتٌ فيها وخصائصُ . ألا ترى أنْ ليستِ المزيةُ التي تَجدُها لقولِكَ : كأنَّ زيداً الأَسدُ عَلَى قولِكَ : زيدٌ كالأَسدِ بشيءٍ خارجٍ عن التشبيه الذي هو أصلُ المعنى وإِنما هو زيادةٌ فيه وفي حكمِ الخصوصيَّةِ في الشَّكْلِ نحو أن يصاغَ خاتَمٌ على وجهٍ وآخرُ على وجهٍ آخرَ تجمعهما صورةُ الخاتَمِ ويفترقان بخاصَّةٍ وشيءٍ يُعْلَم إِلاّ أنه لا يُعلم منفرداً . ولمّا كانَ الأمرُ كذلك لَم يُمكِنْهم أن يُطْلقوا اسمَ المعاني على هذه الخصائص إِذا كان لا يفترقُ الحالُ حينئذٍ بينَ أصلِ المَعنى وبين ما هو زيادةٌ في المعنى وكيفيَّةٌ له وخصوصيةٌ فيه . فلما امتنعَ ذلك توصَّلوا إِلى الدَّلالة عليها بأنْ وصفوا اللفظَ في ذلك بأوصافٍ يُعْلَم أنها لا تكوُن أوصافاً له من حيثُ هو لفظٌ كنحو وصفِهم له بأنَّه لفظٌ شريفٌ وأنه قد زانَ المعنى وأن له ديباجةً وأنَّ عليه طُلاوة وأن المعنى منه في مثلِ الوَشْي وأنه عليه كالحَلي إِلى أشباهِ ذلك مما يُعْلَمُ ضرورةً أنه لا يُعنَى بمثله الصوتُ
والحرفُ ثم إِنه لمَّا جرتْ به العادةُ واستمرَّ عليه العُرفُ وصارَ الناسُ يقولونَ : اللفظُ واللفظُ لَزَّ ذلكَ بأنفُسِ أقوامٍ باباً منَ الفسادِ وخامَرهم منه شيءٌ لستُ أُحْسِنُ وصفَه
فصل في دلالة المعنى على المعنى
ومِن الصفاتِ التي تجدُهم يُجْرُونَها على اللفظ ثم لا تعترضُك شُبهةٌ ولا يكونُ منك توقّفٌ في أنها ليستْ له ولكنْ لمعناه قولُهم : لا يكونُ الكلامُ يستحقُّ اسمَ البلاغة حتى يُسابقَ معناه لفظَه ولفظُه معناه . ولا يكونَ لفظُه أسبقَ إِلى سمعك من معناه إِلى قلبكَ وقولُهم : يدخلُ في الأُذنِ بلا إِذْنٍ فهذا مما لا يَشُكُّ العاقلُ في أنه يرجعُ إِلى دلالةِ المعنى على المعنى وأنه لا يتصوَّرُ أن يرادَ به دلالةُ اللفظِ على معناه الذي وُضِعَ له في اللغةِ ذاك لأَنهُ لا يخلو السامعُ من أنْ يكونَ عالماً باللغةِ وبمعاني الألفاظِ التي يسمَعُها أو يكونَ جاهلاً بذلك فإِن كانَ عالماً لم يُتَصوَّر أن يتفاوتَ حالُ الألفاظُ معه فيكونَ معنى لفظٍ أسرعَ إِلى قلبِه من معنى لفظٍ آخرَ وإِنْ كان جاهلاً كان ذلك في وصفهِ أبعدَوجملةُ الأمرِ أنَّه إِنما يُتصوَّر أن يكونَ لمعنًى أسرعَ فهماً منه لمعنًى آخرَ إِذا كانَ ذلك مما يُدْرك بالفِكْرِ وإِذا كان مما يتجدَّد له العلم به عند سَمْعِه للكلامِ . وذلك مُحالٌ في دلالاتِ الألفاظِ اللغويةِ لأن طريقَ معرفتِها التَّوقيفُ والتقدّمُ بالتعريفِ
وإذا كان ذلك كذلك عُلِم عِلْمَ الضرورةِ أنَّ مَصْرِفَ ذلك إِلى دلالات المعاني على المعاني وأنهم أرادوا أنَّ من شرطِ البلاغةِ أن يكونَ المعنى الأَوّلُ الذي تَجْعله دليلاً على المعنى الثاني ووسيطاً بينك وبينه متمكناً في دلالتِه مستقلاً بوساطتِهِ يَسْفُرُ بينَكَ وبينَه أحسنَ سِفارة ويشيرُ لك إِليه أبْيَنَ إِشارةٍ حتى يُخَيَّلَ إِليكَ أنك فهمتَه من حاقِّ اللفظِ وذلك لقلةِ الكُلفة فِيه عليكَ وسُرعةِ وصولِه إِليكَ فكانَ من الكنايةِ مثلَ قولِه - المنسرح - :
( لا أمْتِعُ العُوذَ بالفِصالِ ولا ... أَبْتَاعُ إِلاَّ قَريبَةَ الأَجَلِ )
ومن الاستعارةِ مثلَ قولِه - الطويل - :
( وصَدْرٍ أَراحَ الليلُ عازِبَ هَمِّهِ ... تَضاعَفَ فيه الحُزْنُ من كلِّ جانبِ )
ومن التمثيلِ مثلَ قولِه - المديد - :
( لا أَذُودُ الطَّيْرَ عن شَجَرٍ ... قد بَلَوْتُ المُرَّ مِنْ ثَمَرِهْ )
وإِنْ أردتَ أن تعرفَ ما حالُه بالضدِّ من هذا فكانَ منقوصَ القوِّةِ في تأديةِ ما أريدَ منه لأَنَّهُ يعترِضُه ما يَمْنَعُه أن يَقْضِيَ حقَّ السِّفارةِ فيما بَيْنَك وبينَ مَعْناك ويوضِّحَ تمامَ الإِيضاحِ عن مَغْزاكَ فانظرْ إِلى قولِ العباسِ بنِ الأحنفِ من - الطويل - :
( سأطلبُ بُعْدَ الدَّارِ عنكم لتقْرُبوا ... وتَسكُبَ عَيْنايَ الدُّمُوعَ لَتَجْمُدا )
بدأ فدلَّ بسكبِ الدموعِ على ما يوجبُه الفراقُ منَ الحزنِ والكمدِ فأحسنَ وأصابَ لأنَّ من شأن البكاءِ أبداً أن يكونَ أمارةً للحزنِ وأن يُجعَلَ دَلالةً عليه وكنايةً عنه كقولِهم :
أبكاني وأضحكني على معنى " ساءني وسرَّني " وكما قالَ - السريع - :
( أبْكانيَ الدَّهْرْ ويا رُبَّما ... أَضْحَكَني الدَّهْرُ بِما يُرْضِي )
ثم ساقَ هذا القياسَ إِلى نقيضِهِ فالتمسَ أن يدلَّ على ما يوجبُه دوامُ التَّلاقي من السرورِ بقولِه " لتجمُدا " . وظنَّ أن الجمودَ يبلغُ له في إِفادةِ المسرَّةِ والسَّلامة من الحزنِ ما بلغ سكْبُ الدمعِ في الدَّلالةِ على الكآبةِ والوقوعِ في الحزنِ . ونظر إِلى أن الجمودَ خُلُوُّ العينِ من البكاءِ وانتفاءُ الدموعِ عنها . وأنه إِذا قال : " لتجمدا " فكأنَّه قال : أحزنُ اليومَ لئلا أحزنَ غداً وتبكي عيناي جهدَهما لئلا تبكيا أبداً . وغَلِطَ فيما ظنَ وذاك أنَّ الجمودَ هو أن لا تبكيَ العينُ مع أنَّ الحالَ حالُ بكاءٍ . ومع أن العينَ يرادُ منها أن تبكيَ ويُشتكى مِنْ أن لا تبكي ولذلكَ لا ترى أحداً يذكرُ عينَه بالجمودِ إِلاّ وهُوَ يشكوها ويذمُّها وينسبُها إِلى البُخْلِ ويعدُّ امتناعَها نم البكاءِ تركاً لمعونةِ صاحِبها على ما بهِ منَ الهَمِّ ألا تَرى إِلى قولِه - الطويل - : ( ألا إِنَّ عَيْناً لم تَجُدْ يومَ واسطٍ ... عَلَيْكَ بِجاري دَمْعِها لَجَمودُ )
فأتى بالجمودِ تأكيداً لنفي الجُودِ ومحالٌ أن يجعلَها لا تجودُ بالبكاءِ . وليس هناك التماسُ بكاءٍ لأنَّ الجودَ والبخلَ يقتضيان مطلوباً يُبْذلُ أو يُمنعُ . ولو كان الجمودُ يصلحُ لأنْ يرادَ به السلامةُ منَ البكاء ويَصِحُّ أن يُدَلَّ به على أن الحالَ حالُ مسرَّةٍ وحبورٍ لجازَ أن يُدْعى به للرجلِ فيقالَ : لا زالتْ عينُكَ جامدةً كما يقالُ : لا أبكى اللهُ عينَك . وذاك مما
لا يُشكُّ في بطلانِه . وعلى ذلك قولُ أهل اللغةِ : عَيْنٌ جَمُود لا ماءَ فيها وسنةٌ جَمادٌ لا مطرَ فيها وناقةٌ جماد لا لبنَ فيها . وكما لا تُجْعَل السنةُ والناقةُ جماداً إِلاّ على معنى أن السَّنةَ بخيلةٌ بالقَطْرِ والناقةَ لا تسْخُو بالدَّرِ . كذلك حُكْمُ العينِ لا تُجْعَلُ جَمُوداً إِلا وهناكَ ما يَقْتضي إِرادةَ البكاءِ منها وما يجعلُها إِذا بكَتْ مُحسِنَةً موصوفَةً بأن قَدْ جادتْ وسخَتْ . وإِذا لم تبكِ مُسيئةً موصوفةً بأن قد ضَنَّتْ وَبَخِلَتْ
فإِنْ قيل : إِنه أرادَ أن يقولَ : إِني اليومَ أتجرَّعُ غُصَصَ الفراقِ وأحمِلُ نفسي على مُرِّه وأحتملُ ما يُؤَدّيني إِليه من حُزْنٍ يفيضُ الدموعَ من عيني ويسكبُها لكي أتسبَّبَ بذلك إلى وصْلٍ يدومُ ومسرَّةٍ تتصلُ حتى لا أعرفَ بعدَ ذلك الحزْنَ أصلاً ولا تعرفَ عيني البكاءَ وتصيرَ في أن لا تُرى باكيةً أبداً كالجَمود التي لا يكونُ لها دمعٌ فإِنَّ ذلكَ لا يستقيمُ ويستتبُّ لأنه يوقعُه في التَّناقُضِ ويجعلهُ كأنه قال : أحتملُ البكاءَ لهذا الفراقِ عاجلاً لأصيرَ في الآجلِ بدوامِ الوصلِ واتصالِ السُّرورِ في صورةِ من يريدُ مِن عينِه أن تبكيَ ثم لا تبكي لأَنها خُلِقَتْ جامدةً لا ماءَ فيها . وذلك من التَّهافِت والاضطرابِ بحيثُ لا تنجَعُ الحيلةُ فيه
وجملةُ الأمرِ أنَّا لا نعلمُ أحداً جعلَ جمودَ العين دليلَ سرورٍ وأمارةَ غِبْطةٍ وكنايةٍ عن أنَّ الحالَ حالُ فرحٍ . فهذا مثالٌ فيما هو بالضِّدِّ مما شرطوا من أنْ لا يكونَ لفظُه أسبقَ إلى سَمعك من معناهُ إِلى قلبكِ لأنَك ترى اللفظَ يصِلُ إِلى سمعِكَ وتحتاجُ إِلى أن تَخُبَّ وتُوضِعَ في طلبِ المعنى . ويجري لك هذا الشرحُ والتفسيرُ في النظمِ كما جرَى في اللفظِ لأنه إِذا كان النظمُ سويّاً والتأليفُ مستقيماً كان وصولُ المعنى إِلى قلبِك تِلْوَ وصولِ اللفظِ إِلى سمْعِك . وإِذا كان على خلافِ ما ينبغي وصَلَ اللفظُ إلى السمعِ وبقيتَ في المعنى تطلبُه وتتعَبُ فيه . وإِذا أفرط الأمرُ في ذلكَ صارَ إِلى التعقيدِ الذي قالوا : إِنه يستهلِكُ المعنى
واعلمْ أنْ لم تَضِقِ العبارةُ ولم يقصِّرِ اللفظُ ولم ينغلقِ الكلامُ في هذا الباب إِلاّ لأنه
قد تَناهى في الغموضِ والخفاءِ إلى أقصى الغايات وأنكَ لا ترى أغربَ مذهباً وأعجَب طريقاً وأحرى بأن تضطربَ فيه الآراء منه . وما قولُكَ في شيءٍ قد بلَغ من أمْرِه أن يُدَّعَى على كبار العلماءِ بأنهم لم يعلموه ولم يفطِنوا له فقد ترى أنَّ البحتريَّ قال حينَ سئِل عن مسلمٍ وأبي نواس : أيُّهما أشعرُ فقال : أبو نواس : فقيل : فإِنَّ أبا العباس ثَعلباً لا يوافقُك على هذا . فقال : ليس هذا من شأنِ ثعلبٍ وذَويهِ من المُتعَاطِينَ لعلمِ الشعر دونَ عملهِ إنما يعلُم ذلك من دُفِعَ في مسْلكِ طريقِ الشعر إِلى مضايقهِ وانتهى إلى ضروراته
ثم لم يَنْفَكَّ العالِمون به والذين هم من أهلِه من دخول الشُّبهة فيه عليهم ومن اعتراض السَّهْوِ والغلطِ لهم . رُوي عن الأَصمعيِّ أنه قال : كنتُ أسيرُ مع أبي عمرِو بنِ العلاء وخلفٍ الأَحمر . وكانا يأتيان بشاراً فيسلِّمان عليه بغايةِ الإِعْظام ثم يقولانِ يا أبا مُعاذٍ ما أحدثْتَ فيخبُرهما وينشِدُهما ويسألانه ويكتبانِ عنه متواضِعَيْنِ له حتى يأتي وقتُ الزَّوالِ . ثم ينصرفان . وأتياه يوماً فقالا : ما هذه القصيدةُ التي أحدثْتَها في سَلْمِ بنِ قُتَيْبَةَ قال : هي التي بلغتكُم . قالوا : بلغَنَا أنَّك أكثرتَ فيها مِنَ الغريبِ . قال : نعَمْ بلغني أنَّ سَلْم بنَ قتيبةَ يتباصَرُ بالغريب فأحببت أن أورِدَ عليه ما لا يَعْرِفُ . قالوا : فأنشِدْناها يا أبا معاذ . فأنشدَهما من الخفيف :
( بكِّرا صاحِبيَّ قبلَ الهَجيرِ ... إِنّ ذاكَ النجاحَ في التَّبكيرِ )
حتى فرغَ منها فاقل له خلفٌ : لو قلتَ يا أبا مُعاذٍ مكانَ " إِنَّ ذاك النجاحَ في التبكيرِ " :
( بَكِّرا فالنَّجاحُ في التَّبْكيرِ ... )
كان أحسَنَ . فقال بشارٌ : إِنما بنيتهُا أعرابيةً وحشيّةً فقلتُ : " إِنَّ ذاك النجاح في التبكير " كما يَقولُ الأَعراب البدويون . ولو قلت : " بكرا فالنجاح " كانَ هذا من كلامِ
المولَّدين ولا يشبه ذاكَ الكلامَ ولا يدخلُ في معنى القصيدةِ . قالَ : فقامَ خلفٌ فقبَّل بشَّاراً بَيْنَ عينيه . فهل كان هذا القولُ من خَلَفٍ والنقدُ على بشارٍ إِلاّ لِلُطفِ المعنى في ذلك وخفائه
واعْلَمْ أنَّ من شأنِ " إِنَّ " : إِذا جاءتْ على هذا الوجهِ أَن تُغْنيَ غَناءَ الفاءِ العاطفةِ مثلاً وأَن تُفِيدَ من ربطِ الجملةِ بما قبلَها أمراً عجيباً . فأَنتَ ترى الكلاَم بها مُستأنفاً غيرَ مستأنفٍ مقطوعاً موصولاً معاً . أفلا ترى أنك لو أسقطتَ " إِنَّ " من قولِهِ : إِنَّ ذاك النجاحَ في التبكيرِ لم تَرَ الكَلاَم يلتئِمُ ولرأيتَ الجملةَ الثانيةَ لا تَتَّصلُ بالأولى ولا تكونُ منها بسبيلٍ حتى تجيءَ بالفاءِ فتقولَ : بكِّرا صاحِبَيَّ قبلَ الهجيرِ فذاكَ النجاحُ في التبكيرِ ومثُلُه قولُ بعضِ العربِ - الرجز - :
( فغَنِّها وَهْيَ لكَ الفِداءُ ... إِنَّ غِناءَ الإِبلِ الحُداءُ )
فانظرُ إِلى قولِه : إِنَّ غناءَ الإِبلِ الحُداءُ وإِلى ملاءمَتِهِ الكلامَ قبلَه وحُسْنِ تشبُّثهِ به وإِلى حُسْنِ تعطُّفِ الكلامِ الأَوَّلِ عليه . ثم انظُر إِذا تركتَ " إِنَّ " فقلتَ : فغنّها وهيَ لك الفداءُ غناءُ الإِبلِ الحُداءُ كيفَ تكونُ الصورةُ وكيفَ يَنْبو أحدُ الكلامينِ عنِ الآخَرِ وكيف يُشْئِم هذا ويُعْرِقُ ذاك حتى لا تجدَ حيلةً في ائتلافِهما حتى تجتلبَ لهما الفاءَ فتقول : فغنِّها وهيَ لك الفداءُ فغناءُ الإِبلِ الحُداءُ ثم تَعَلَّمْ أنْ ليستِ الألفةُ بينهما من جنسِ ما كانَ وأنْ قد ذهبتَ الأَنَسَةُ التي كنتَ تجدُ والحسنُ الذي كنتَ ترى . ورُويَ عن عَنبسة أنه قال : قَدِمَ ذو الرُّمَّةِ الكوفَةَ فوقف ينشِدُ الناسَ الكُناسةِ قصيدتَه الحائية التي منها - الطويل - :
( هِيَ البُرْءُ والأسْقامُ والهَمُّ والمُنى ... ومَوْتُ الهَوى في القَلْبِ مِنّي المبرِّحُ )
( وكانَ الهَوى بالنَّأي يُمْحَى فَيَمَّحي ... وحبُّكِ عِنْدي يَسْتَجِدُّ ويَرْبَحُ )
( إِذا غَيَّرَ النَّأيُ المحبّينَ لمْ يَكَدْ ... رَسِيْسُ الهَوى من حُبِّ ميَّةَ يَبْرَحُ )
قال : فلما انتهى إِلى هذا البيتِ ناداه ابنُ شُبرُمَةَ : يا غَيْلانُ : أراه قد برحَ ! قالَ فشنقَ ناقَتَه وجعلَ يتأخرُ بها ويتفكَّر ثم قال :
( إِذا غَيَّرَ النّأيُ المُحِبِّينَ لم أَجِدْ ... رَسِيسَ الهوى من حُبِّ ميّةَ يَبْرحُ )
قال : فلما انصرفتُ حدثتُ أبي قال : أخطأَ ابنُ شُبْرُمة حين أنكر على ذي الرُّمة وأخطأ ذو ذو الرُّمة حين غيَّر شعرَه لقولِ ابن شبرمة إِنما هذا كقولِ الله تعالى : ( ظُلُمَاتٌ بَعْضُها فوقَ بَعْضٍ إِذَا أَخرجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها ) . وإِنما هُوَ لم يَرَها ولم يَكَدْ
واعلمْ أنَّ سبب الشُّبهةِ في ذلكَ أَنَّه قد جَرَى في العُرفِ أن يقالَ : ما كادَ يفعلُ ولم يكدْ يفعلُ : في فعلٍ قد فُعِلَ على معنى أنَّهُ لم يفعلْ إِلاّ بَعْدَ الجهْدِ وبعد أن كان بعيداً في الظّنّ أنْ يفعلَه كقولِه تعالى : ( فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ) . فلما كانَ مجيءُ النفيِ في
" كادَ " على هذا السبيلِ تَوهَّم ابنُ شُبْرمةَ أنَّه إِذا قال : لم يكدْ رسيسُ الهوى من حُبِّ ميَّةَ يبرحُ فقد زعمَ أن الهوى قد بَرِحَ ووقعَ لذي الرُّمة مثلُ هذا الظنِّ . وليس الأَمْرُ كالذي ظنّاه فإِنَّ الذي يقتضيهِ اللفظُ إِذا قيلَ : لم يكد يفعلُ وما كادَ يفعلُ أنْ يكونَ المرادُ أنَّ الفعلَ لم يكن من أصلِه ولا قاربَ أن يكونَ ولا ظنَّ أنَّه يكون . وكيفَ بالشّكِّ في ذلك وقد عَلمنا أنّ " كاد " موضوعٌ لأن يَدُلَّ على شدَّةِ قربِ الفعلِ من الوقوعِ وعلى أنه قد شارفَ الوجودَ . وإِذا كان كذلك كان مُحالاً أن يوجِبَ نفيُهُ وجُودَ الفعلِ لأنه يؤدي إِلى أن يوجِبَ نفيُ مقاربةِ الفعلِ الوجودَ وأن يكونَ قولُك : ما قاربَ أن يفعلَ : مقتضياً على البتِّ أنه قد فعلَ
وإِذ قد ثَبَتَ ذلك فمن سبيلِك أن تنظرُ فمتى لم يكنِ المعنى على أنه قد كانَ هناك صورةٌ تقتضي أنْ لا يكونَ الفعلُ وحالٌ يَبْعُدُ معَها أن يكونَ ثُمَّ تَغَيَّر الأمرُ كالذي تراهُ في قولِهِ تعالى : ( فذَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ ) فليس إِلا أن تُلْزِمَ الظاهرَ وتجعلَ المعنى على أنك تزعُمُ أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون فالمعنى إذاً في بيت ذي الرمة على أنَّ الهوى من رسوخِه في القلبِ وثبوته فيه وغلبتِه على طباعِه بحيثُ لا يُتوهَّم عليه البَراحُ وأن ذلك لا يقارِبُ منه أن يكونَ فضلاً عن أنْ يكونَ كما تقولُ : إِذا سَلا المحبونَ وفَتَروا في محبَّتِهم لم يَقَعْ لي وَهْمٌ ولم يَجْرِ مني على بالٍ أنه يجوزُ عليَّ ما يُشبهُ السَّلوةَ ما يُعَدُّ فترةً فضلاً عن أنْ يوجدَ ذلك مني وأصيرَ إِليه . وينبغي أنْ تعلمَ أنَّهُمْ إِنما قالوا في التفسيرِ : لم يَرَها ولم يَكَدْ فبدؤوا فنفَوا الرؤيةَ ثم عطَفُوا " لم يكَدْ " عليه ليُعْلِمُوك أنْ ليس سبيلُ " لم يكد " هاهُنا سبيلَ " ما كادوا " في قولهِ تعالى : ( فذَبحُوها وما كادوا يَفْعلون ) في أنه نَفْيُ معقِّبٍ على إِثباتٍ وأنْ ليس المعنى على أنَّ رؤيةً كانت من بَعْدِ أن كادتْ لا تكون ولكنَّ المعنى على أنَّ رؤيتَها لا تقارِبُ أنْ تكونَ فضلاً عن أن تكونَ . ولو كان " لم يكد " يوجبُ وجودَ الفعلِ لكان هذا الكلامُ منهم مُحالاً جارياً مَجْرى أن تقولَ : لم يَرَها ورآها . فاعرِفْه
وهاهُنا نكتةٌ وهي أنَّ " لم يكد " في الآيةِ والبيتِ واقعٌ في جوابِ " إِذا " والماضي إِذا وقعَ في جوابِ الشرطِ على هذا السبيلِ كان مُستقبلاً في المعنى فإِذا قلتَ : إِذا خرجتَ لم أخرج كنتَ قد نفيتَ خروجاً فيما يُسْتَقْبَلُ . وإِذا كان الأَمر كذلكَ استحالَ أن يكونَ المعنى
في البيتِ أو الآية على أن الفعلَ قد كانَ لأنه يؤدِّي إِلى أن يجيءَ بلم أفعلْ ماضياً صريحاً في جوابِ الشرطِ فتقول : إِذا خرجتَ لم أخرجْ أمسِ وذلك مُحال . ومما يتضحُ فيه هذا المعنى قولُ الشاعر - المتقارب - :
( دِيارٌ لَجَهْمَةَ بالمُنْحَنى ... سَقاهُنَّ مُرْتَجِزٌ باكِرُ )
( وراحَ عَلَيْهنّ ذو هَيْدَبٍ ... ضَعيفُ القُوى ماؤُهُ زاخِرُ )
( إذا رامَ نَهْضاً بها لَمْ يَكَدْ ... كَذي السَّاقِ أخْطأَها الجابِرُ )
وأعودِ إِلى الغرضِ فإِذا بلغَ من دقةِ هذه المعاني أن يشتَبِه الأَمْرُ فيها على مِثْلِ خَلَفٍ الأحمرِ وابنِ شُبرمة وحتى يشتبهَ على ذي الرُّمة في صوابٍ قاله فيرى أنه غيرُ صوابٍ فما ظنُّك بغيرِهم وما تعجّبُك من أنْ يكثرَ التخليطُ فيه ومِنَ العَجَبِ في هذا المعنى قولُ أبي النَجْم - الرجز - :
( قد أَصْبَحَتْ أمُّ الخِيارِ تَدَّعِي ... عليَّ ذَنْباً كَلُّه لَمْ أَصْنَعِ )
قد حَمَلَه الجميعُ على أنَّه أَدخَلَ نفسَهُ مِنْ رفع " كلّ " في شيءٍ إِنما يجوزُ عندَ الضَّرورةِ من غيرِ أن كانتْ به ضرورةٌ . قالوا : لأَنَّه ليس في نَصْبِ " كلّ " ما يكسرُ له وزناً أو يَمنَعُهُ مِنْ معنًى أَرادهُ . وإِذا تأملتَ وجدتَه لم يرتكبْهُ ولم يحملْ نفسَه عليه إِلاّ لحاجةٍ له إِلى ذلكَ وإِلاّ لأنَّه رأى النَّصْبَ يمنعُه ما يريدُ . وذاك أنه أرادَ أنها تدَّعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة لا قليلاً ولا كثيراً ولا بَعضاً ولا كُلاًّ . والنصبُ يمنعُ من هذا المعنى ويقتضي أن يكونَ قد أتى منَ الذنبِ الذي ادَّعتْه بعضَه . وذلك أَنَّا إِذا تأملنا وجدنا إِعمالَ الفعل في
" كلّ " والفعلُ منفيٌ لا يصلحُ أن يكونَ إِلاّ حيثُ يرادُ أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن . تقولُ : لم ألقَ كلَّ القومِ ولم آخذْ كلَّ الدراهم فيكونُ المعنى أنك لقيتَ بعضاً من القومِ ولم تلقَ الجميعَ . وأخذتَ بعضاً من الدراهمِ وتركتَ الباقي . ولا يكونُ أن تريدَ أنك لم تلقَ واحداً من القومِ ولم تأخذْ شيئاً من الدراهم . وتعرَّفْ ذلك بأن تنظرَ إِلى " كلّ " في الإِثبات وتتعرفَ فائدتَه فيه . وإِذا نظرتَ وجدتَه قد اجتُلِبَ لأن يُفيدَ الشُّمولَ في الفعلِ الذي تُسِندُه إِلى الجملةِ أو توقِعُه بها . تفسيرُ ذلك أنك إِنما قلتَ : جاءني القومُ كلُّهم لأَنك لو قلتَ : جاءني القومُ وسكتَّ لكان يجوزُ أن يتوهَّمَ السامِعُ أنه قد تخلّفَ عنكَ بعضُهم إِلاّ أنك لم تعتدَّ بهم أو أنكَ جعلتَ الفعلَ إِذا وقعَ من بعضِ القومِ فكأنَّما وقعَ منَ الجميع لكونِهم في حُكْم الشخصِ الواحدِ كما يقالُ للقبيلة : فعلتُم وصنعتُمْ يرادُ فعلٌ قد كانَ من بعضِهم أو واحدٍ منهم . وهكذا الحكمُ أبداً . فإذا قلتَ : رأيتُ القومَ كلَّهم ومررتُ بالقومِ كلِّهم كنتَ قد جئتَ بكلٍّ لئلا يُتوهَّم أنه قد بَقِي عليكَ مَنْ لم تَره ولم تَمرَّ به . ينبغي أن يُعْلَم أنَّا لا نعني بقولنا : يفيدُ الشُّمولَ أن سبيلَه في ذلك سبيلُ الشيءِ يوجِبُ المعنى مِن أصلِه وأنه لولا مكانُ " كلّ " لما عُقِل الشُّمولُ ولم يكن فيما سبقَ منَ اللفظِ دليلٌ عليه . كيفَ ولو كانَ كذلكَ لم يكنْ يسمَّى تأكيداً . فالمعنى أنه يمنعُ أن يكونَ اللفظُ المقتضي الشمولَ مُستَعملاً على خلافِ ظاهرِه ومتجوَّزاً فيه
وإِذ قد عرفتَ ذلك فها هنا أصلٌ وهو أَنَّه من حُكمِ النفي إِذا دخلَ على كلامٍ ثمَّ كان في ذلكَ الكلامِ تقييدٌ على وَجْهٍ من الوجوهِ أن يتوجَّه إِلى ذلكَ التقييد وأن يقعَ له خصوصاً . تفسيرُ ذلك أنَّك إِذا قلتَ : أتاني القومُ مجتمعين . فقالَ قائلٌ : لم يأتِك القومُ مجتمعين . كانَ نفيهُ ذلك متوجِّهاً إِلى الاجتماعِ الذي هو تقييدٌ في الإِتيان دونَ الإِتيان نفسِه حتى إِنه إِنْ أرادَ أنْ ينفيَ الإِتيانَ من أصلهِ كان من سبيلِهِ أن يقولَ : إِنهم لم يأتوكَ أصلاً فما معنى قولِكَ " مجتمعين " هذا مما لا يَشُكُّ فيه عاقلٌ . وإِذا كانَ هذا حكمَ النفي إِذا دخلَ على كلامٍ فيه تقييدٌ فإِنَّ التأكيدَ ضربٌ منَ التقييد فَمتى نفيتَ كلاماً فيه تأكيدٌ فإِنَّ نفيكَ ذلكَ يتوجَّه إلى التأكيدِ خصوصاً ويقعُ له
فإِذا قلتَ : لم أرَ القومَ كلَّهم أَوْ لَمْ يأتِني القومُ كلُّهم أو لم يأتِني كلُّ القومِ أو لم أرَ كلَّ القومِ كنتَ عمدتَ بنفيكَ إِلى معنى " كلّ " خاصةً وكانَ حكمُه حكمَ " مجتمعين " في قولِكَ : لم يأتِني القومُ مجتمعين . وإِذا كان النفيُ يقعُ لكلٍّ خصوصاً فواجبٌ إِذا قلتَ :
لم يأتني القومُ كلُّهم أو لم يأتِني كلُّ القومِ أَنْ يكونَ قد أتاك بعضُهم . كما يجب إِذا قلتَ : لم يأتني القومُ مجتمعين أن يكونوا قَدْ أتَوك أشتاتاً . وكما يستحيلُ أن تقولَ : لم يأتني القومُ مجتمعين وأنتَ تريدُ أنهم لم يأتوكَ أصلاً لا مجتمعين ولا منفردين . كذلك محالٌ أن تقولَ : لم يأتِني القومُ كلُّهم وأنتَ تريدُ أنَّهم لم يأتوك أصلاً فاعرِفْه
واعلم أَنَّك إِذا نظرتَ وجدتَ الإِثباتَ كالنَفْي فيما ذكرتُ لك وَوجدتَ النفيَ قد احْتذاهُ فيه وتبعَه وذلك أنك إِذا قلتَ : جاءني القومُ كلُّهم كان " كُلّ " فائدةَ خبرِك . هذا والذي يتوجَّه إِليه إِثباتُك بدلالةِ أنَّ المعنى على أن الشكَّ لم يقعْ في نفسِ المجيءِ أنه كانَ من القومِ على الجملة وإِنَّما وقعَ في شمولِه " الكلَّ " وذلك الذي عناك أمرُه في كلامِكَ
وجملة الأَمْرِ أَنَّه ما من كلامٍ كانَ فيه أمرٌ زائدٌ على مجرَّد إِثباتِ المعنى للشيء إِلاَّ كان الغرضَ الخاصَّ من الكلام والذي يُقصَدُ إِليه ويُزجَى القولُ فيه . فإِذا قلتَ : جاءني زيدٌ راكباً وما جاءني زيدٌ راكباً كنتَ قد وضعتَ كلامَك لأنْ تُثبتَ مجيئه راكباً أو تنفيَ ذلك لا لأن تثبتَ المجيءَ وتنفيَهُ مطلقاً . هذا ما لا سبيل إِلى الشكِّ فيه
واعلمْ أنه يلزمُ مَنْ شكَّ في هذا فتوهَّم أنه يجوزُ أن تقولَ : لم أرَ القومَ كلَّهم على معنى أنك لم ترَ واحداً منهم أن يَجْريَ النَهْيُ هذا المَجرى فتقولَ : لا تضربِ القوم كلَّهم على معنى لا تضربْ واحداً منهم وأن تقولَ : لا تضربِ الرجلين كليهما : على معنى لا تضربْ واحداً منهما . فإِذا قال ذلك لَزِمه أن يُحيلَ قولَ الناس : لا تضربْهما معاً ولكن اضربْ أحدَهما . ولا تأخذْهما جميعاً ولكنْ واحداً منهما وكفى بذلك فساداً
وإِذْ قد بانَ لَكَ من حالِ النَّصْبِ أنه يقتضي أن يكونَ المعنى على أنه قد صنعَ منَ الذنبِ بعضاً وتركَ بعضا فاعلمْ أنَّ الرفعَ على خلافِ ذلك وأنه يقتضي نفيَ أن يكونَ قد صنعَ منه شيئاً وأتى منه قليلاً أو كثيراً . وأنك إِذا قلتَ : كلُّهم لا يأتيك وكلُّ ذلك لا يكونُ وكلُّ هذا لا يحسُنُ كنتَ نفيتَ أن يأتيهُ واحدٌ منهم وأبيتَ أن يكونَ أو يَحْسُنَ شيءٌ مما أشرتَ إِليه . ومما يَشْهَدُ لكَ بذلكَ منَ الشعر قولُه من - الطويل
( فكيفَ وكُلٌّ لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ ... ولا لامْرِئٍ عَمّا قَضَى اللهُ مَزْحَلُ )
المعنى عَلَى نَفْيِ أن يَعْدُوَ أحدٌ منَ الناسِ حِمَامَه بلا شُبْهةٍ . ولو قلتَ : فكيفَ وليس يعدو كلٌّ حمامَه فأخَّرتَ " كلاًّ " لأفسدتَ المعنى وصرتَ كأنك تقولُ : إِنَّ منَ الناس مَنْ يَسْلمُ من الحِمام ويبقى خالداً لا يموتُ . ومثلُه قولُ دعبل من - الطويل - :
( فواللهِ ما أَدْري بأيِّ سِهامِها ... رَمَتْني وكُلٌّ عِنْدَنا ليسَ بالمُكْدي )
( أبِالجيدِ أَمْ مَجْرى الوِشاح وإِنَّنِي ... لأُتْهِمُ عَيْنَيها مع الفَاحِمِ الجَعْدِ )
المعنى عَلَى نفيِ أن يكونَ في سِهامِها مُكْدٍ على وجهٍ منَ الوجوهِ . ومن البَيِّن في ذلك ما جاءَ في حديث ذي اليدين قال للنبي : أَقَصُرَتِ الصلاةُ أم نَسِيتَ يا رسولَ الله فقال : " كلُّ ذلك لم يكُنْ " . فقال ذو اليدين : بَعْضُ ذلكَ قَدْ كان . المعنى : لا محالَة على نفيِ الأَمرين جميعاً وعلى أنه عليه السلام أرادَ أنه لم يكنْ واحدٌ منهما لا القَصرُ ولا النسيانُ . ولو قِيلَ : لَمْ يَكُنْ كلُّ ذلك لكانَ المعنى أنه قد كانَ بعضُه
واعلمْ أنَّه لما كانَ المعنى مع إِعمال الفعلِ المنفيِّ في " كلّ " نحوُ : لم يأتِني القومُ كلُّهم ولم أرَ القومَ كلَّهم . على أنَّ الفعلَ قد كانَ من البعضِ ووقعَ على البعضِ قلتَ : لم يأتِني القومُ كلُّهم ولكنْ أتاني بعضُهم . ولم أر القومَ كلَّهم ولكنْ رأيتُ بعضَهم فأثبتَّ بعد ما نَفيْتَ . ولا يكونُ ذلك معَ رفعِ " كلّ " بالابتداءِ . فلو قلتَ : كلُّهم لم يأتِني ولكنْ أتاني بعضُهم . وكلُّ ذلك لم يكنْ ولكنْ كان بعضُ ذلك لم يَجُزْ لأنَّه يؤدي إلى التناقُضِ
وهو أنْ تقولَ : لم يأتِني واحدٌ منهم ولكن أتاني بعضُهم
واعلَمْ أنَّهُ ليس التأثيرُ لِما ذكرْنا من إِعمالِ الفعلِ وتركِ إِعمالِه على الحقيقةِ . وإِنَّما التأثيرُ لأَمرٍ آخرَ وهو دخولُ كلّ في حيِّز النَّفْي وأن لا يدخُلَ فيه . وإِنما علَّقنا الحكمَ في البيتِ وسائرِ ما مضى بإِعمالِ الفعلِ وتركَ إِعمالِه من حيثُ كان إِعمالُه فيه يقتضي دخولَه في حيِّزِ النفي وتركُ ِعمالِه يوجبُ خروجَه منه من حيثُ كان الحرفُ النافي في البيتِ حرفاً لا ينفصِلُ عن الفعلِ وهو " لم " لا أنّ كَوْنَهُ معمولاً للفعل وغيرَ معمولٍ يقتضي ما رأيتَ من الفرق . أفلا تَرى أنك لو جئتَ بحرفِ نفيٍ يتصوَّرُ انفصالُه عن الفعلِ لرأيتَ المعنى في " كلّ " مع تركِ إِعمالِ الفعلِ مثلَه مع إِعمالِه ومثالُ ذلكَ قولُه - البسيط - :
( ما كُلُّ ما يتمنى المرءُ يدركُه ... )
وقولُ الآخر - البسيط - :
( ما كلُّ رأيِ الفتى يَدْعو إِلى رَشَدِ ... )
" كلٌ " كما ترى غيرُ مُعْمَلٍ فيه الفعلُ ومرفوعٌ إِما بالابتداءِ وإِما بأنه اسمُ " ما " . ثم إِنّ المعنى مع ذلك على ما يكونُ عليه إِذا أعملتَ فيه الفعلَ فقتل : ما يدركُ المرءُ كلَّ ما يتمناه وما يدعو كلُّ رأيِ الفتى إِلى رشَدٍ وذلك أن التأثيرَ لوقوعِه في حيِّز النفي وذلك حاصلٌ في الحالين . ولو قدَّمتَ " كلاًّ " في هذا فقلت : كلُّ ما يتمنى المرءُ لا يدركه وكلُّ رأي الفتى لا يدعو إِلى رَشَدٍ لتغَّير المعنى ولصارَ بمنزلةِ أَنْ يقالَ : إِنَّ المرءَ لا يدركُ شيئاً مما يتمناه ولا يكونُ في رأيِ الفتى ما يدعو إِلى رَشَدٍ بوجهٍ من الوجوه
واعلمْ أنَّكَ إِذا أدخلتَ كلاًّ في حيِّزِ النفي وذلك بأن تقدِّم النفيَ عليه لفظاً أو تقديراً فالمعنى على نَفْي الشمولِ دونَ نفيِ الفعلِ والوصفِ نفسِه . وإِذا أخرجتَ كلاًّ في حيِّز
النفي ولم تُدْخِلْه فيه لا لفظاً ولا تقديراً كان المعنى على أنَّك تَتَّبعتَ الجملةَ فنفيتَ الفعلَ والوصفَ عنها واحداً واحداً . والعلةُ في أنْ كانَ ذلك كذلكَ أنَّك إِذا بدأتَ بكلٍّ كنتَ قد بَنَيْتَ النفيَ عليه وسلَّطتَ الكُليَّةَ على النَفْي وأعملتَها فيه . وإِعمالُ معنى الكلّية في النفي يقتضي أن لا يَشُذَّ شيءٌ عن النفي فاعرِفْه
واعلمْ أنَّ من شأنِ الوجوهِ والفروقِ أنْ لا يزالَ يَحْدُثُ بسببِها وعلى حَسَبِ الأغراضِ والمعاني التي تَقَعُ فيها دقائقُ وخفايا لا إِلى حَدٍّ ونهايةٍ وأنَّها خفايا تكتمُ أنفسَها جَهْدَها حتى لا يُنتَبَه لأكثرِها ولا يُعْلَمَ أنها هي . وحتّى لا تَزالَ ترى العالِمَ يعرضُ له السَّهْوُ فيه وحتى إِنّه ليقصِدُ إِلى الصَّوابِ فيقعُ أثناء كلامِه ما يُوهِم الخطأَ وكلُّ ذلك لِشدَّةِ الخفاءِ وفَرْطِ الغموضِ
فصل في وجوب تنكير بعض المفردات
واعلمْ أنه إِذا كان بَيّناً في الشيء أنه لا يَحْتَمِلُ إِلاّ الوجهُ الذي هو عليه حتّى لا يُشكِلَ وحتى لا يُحْتَاجَ في العلم بأنَّ ذلك حقّه وأنه الصَّوابُ إِلى فِكْرٍ ورَوِيَّةٍ فلا مَزِيَّةَ . وإِنما تكونُ المزيةُ ويجبُ الفضلُ إِذا احتَمَل في ظاهِر الحالِ غيرَ الوجه الذي جاءَ عليه وجهاً آخرَ ثمَّ رأيتَ النفسَ تَنبو عن ذلكَ الوجهِ الآخرِ ورأيتَ للذي جاء عليه حُسْناً وقبولاً يَعْدَمهُما إِذا أنت تركتَه إِلى الثانيومثالُ ذلكَ قولُه تعالى : ( وجَعَلوا للهِ شُركاءَ الجِنَّ ) ليس بخافَ أن لتقديمِ الشركاءِ حُسْناً وروعةً ومأخذاً من القلوبِ أنتَ لا تجدُ شيئاً منه إِنْ أنتًَ أخَّرتَ فقلتَ : وجَعَلوا الجنَّ شركاءَ لله وأنك ترى حالكَ حالَ مَن نُقِلَ عن الصورةِ المبهجة والمنظرِ الرائقِ والحُسْنِ الباهرِ إِلى الشيءِ الغُفْلِ الذي لا تَحْلَى منه بكثير طائلِ ولا تصيرُ النفسُ به إِلى حاصلٍ . والسببُ في أن كانَ ذلك كذلكَ هو أنّ للتقديم فائدةً شريفةً . ومعنى جليلاً لا سبيلَ إِليه مع التأخيرِ . بيانه أنّا وإِنْ كنّا نرى جملةَ المعنى ومحصولَه أنَّهم جعلوا الجنَّ شركاءَ وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى يحصُل مع التأخيرِ حصولَه مع التقديمِ فإِنَّ تقديمَ الشركاءِ يفيدُ هذا المعنى ويفيدُ معه معنى آخر وهو أنه ما كانَ ينبغي أن يكونَ لله شريكٌ لا مِنَ الجنِ ولا غيرِ الجن . وإِذا أخِّرَ فقيل : جَعَلوا الجنَّ شركاءَ لله لم يُفِدْ ذلكَ ولم يكنْ فيه شيء أكثرُ من الإِخبارِ عنهم بأنهم عبدُوا الجنَّ مع الله تعالى . فأما إِنكارُ أنْ يُعْبَد مَعَ الله غيرُه وأنْ يكونَ له شريكٌ مِنَ الجنِّ وغيرِ الجنِّ فلا يكونُ في اللفظِ مع تأخيرِ الشركاءِ دليلٌ عليه . وذلك أن التقديرَ يكونُ مع التقديمِ أنَّ " شركاءَ " مفعولٌ أولُ لجعلَ و " لله " في موضعِ المفعولِ الثاني ويكونُ " الجنّ " على كلامٍ ثانٍ على تقديرِ أنه كأنّه قيل فمن جعلوا شركاءَ
الله تعالى فقيل : الجنَّ وإِذا كان التقديرُ في " شركاءَ " أنّه مفعولٌ أوّلُ و " لله " في موضعِ المفعولِ الثاني وقَعَ الإِنكارُ على كونِ شركاءِ الله تعالى على الإطلاق من غيرِ اختصاصِ شيءٍ دونَ شيءٍ وحصَلَ من ذلك أن اتخاذ الشَّريكِ من غَيْرِ الجنِّ قد دَخَلَ في الإِنكارِ دخولَ اتِّخاذِه من الجنِّ لأَنَّ الصفَة إِذا ذُكرتْ مجرَّدَةً غيرَ مُجراةٍ على شيءٍ كانَ الذي تَعَلَّقَ بها من النَّفْي عامَّاً في كلِّ ما يجوزُ أن تكونَ له تلك الصفةُ
فإِذا قلتَ : ما في الدار كريمٌ كنتَ نفيتَ الكينونَةَ في الدارِ عنْ كلِّ من يكون الكرمُ صفةً له . وحكمُ الإِنكارِ أبداً حكمُ النفي . وإِذا أخِّرَ فقيلَ : وجعلوا الجنَّ شركاءَ لله كان " الجنَّ " مفعولاً أولَ و " الشركاء " مفعولاً ثانياً . وإِذا كان كذلك كان " الشركاء " مخصوصاً غيرَ مطلقٍ من حيثُ كانَ مُحالاً أن يجريَ خبراً على الجنِّ ثم يكونَ عاماً فيهم وفي غيرهم وإِذا كان كذلكَ احتملَ أن يكونَ القصدُ بالإِنكار إِلى الجنِّ خصوصاً أن يكونوا شركاءَ دونَ غيرهم جَلَّ الله وتعالى عن أن يكونَ له شريكٌ وشبيهٌ بحالٍ
فانظُرِ الآنَ إِلى شَرَفِ ما حصلَ من المعنى بأن قدِّم الشركاءُ واعتبرْه فإِنه يُنبِّهك لكثيرٍ منَ الأمورِ ويدلُّكَ على عِظَمِ شأنِ النظمِ وتَعْلمُ به كيف يكونُ الإِيجازُ بهِ وما صورَتُه وكيف يُزادُ في المعنى من غيرِ أن يُزادَ في اللفظِ إِذ قدْ ترى أنْ ليس إِلاّ تقديمٌ وتأخيرٌ وأنه قد حَصلَ لك بذلك من زيادةِ المعنى ما إِنْ حاولتَ مع تَرْكِه لم يحصُلْ لك واحتجْتَ إِلى أن تستأْنِفَ له كلاماً نحوَ أن تقولَ : وجعلوا الجنَّ شركاءَ لله وما ينبغي أن يكونَ لله شريكٌ لا مِنَ الجنِّ ولا مِنْ غيرِهم . ثم لا يكونُ له إِذا عُقِلَ من كلامين من الشَّرفِ والفخامةِ ومنْ كرمِ الموقعِ في النفسِ ما تجِدُهُ له الآنَ وقد عُقِلَ من هذا الكلامِ الواحدِ
ومما يَنْظُر إِلى مثلِ ذلكَ قولُه تعالى : ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ) . إِذا أنتَ راجعتَ نفسَكَ وأذكيْتَ حِسَّك وجدتَ لهذا التنكيرِ وأنْ قِيلَ " على حياة " ولم يَقُلْ على الحياةِ حُسناً وروعةً ولطفَ موقعٍ لا يُقَادَرُ قَدْرُه . وتجدُك تَعْدَم ذلك مع التعريفِ وتخرجُ عن الأريحيَّة والأُنْسِ إِلى خلافِهما . والسَّبَبُ في ذلك أنَّ المعنى على الازديادِ منَ
الحياةِ لا الحياةِ من أصلِها وذلك لا يحرص عليه إِلاّ الحيُّ . فأمَّا العادمُ للحياة فلا يَصِحُ منه الحرصُ على الحياةِ ولا على غيرها . وإِذا كانَ كذلكَ صارَ كأنه قيلَ : ولتجدنَّهم أحرصَ الناسِ ولو عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إِلى حياتِهم في ماضي الوقت وراهِنِه حياةً في الذي يُسْتَقْبَلُ . فكما أنَّك لا تقولُ هاهنا أن يزدادوا إِلى حياتِهم الحياةَ بالتعريفِ وإِنما تقولُ حياةً إِذْ كانَ التعريفُ يصلحُ حيثُ تُرادُ الحياةُ على الإطلاق كقولنا : كلُّ أحدٍ يحبُّ الحياةَ ويكرهُ الموتَ . كذلك الحكمُ في الآية
والذي ينبغي أَنْ يُراعى أنَّ المعنى الذي يوصفُ الإِنسانُ بالحرصِ عليهِ إِذا كانَ موجوداً حالَ وصفِك له بالحرصِ عليه لم يُتَصوَّرْ أن تجعَلَه حريصاً عليه من أصلِه . كيف ولا يحْرَصُ على الراهن ولا الماضي وإِنما يكونُ الحِرصُ على ما لم يُوجَدْ بعدُ
وشيبهٌ بتنكير " الحياةِ " في هذه الآية تنكيرُها في قولِه عزَّ ولجَّ : ( وَلَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ ) . وذلكَ أنَ السببَ في حُسنِ التنكيرِ وأنْ لم يحسُنِ التعريف أنْ ليسَ المعنى على الحياةِ نفسِها ولكنْ على أنه لمَّا كانَ الإِنسانُ إِذا عَلِم أنه إِذا قَتَلَ قُتِلَ ارتدعَ بذلك عن القَتْلِ فَسَلِمَ صاحبُه صارتْ حياةُ هذا المَهْمومِ بقتلِه في مُستأْنَفِ الوقتِ مستفادَةً بالقِصَاصِ وصارَ كأنَّه قد حَيِيَ في باقي عمرِه به أي بالقِصاص
وإِذا كان المعنى على حياةٍ في بعضِ أوقاته وجَبَ التنكيرُ وامتنعَ التعريفُ من حيثُ كان التعريفُ يقتضي أن تكونَ الحياةُ قد كانَتْ بالقصاصِ من أصلِها وأن يكونَ القصاصُ قد كان سبباً في كونِها في كافَّة الأوقاتِ وذلك خلافُ المعنى وغيرُ ما هو المقصودُ ويُبيِّنُ ذلك أنك تقولُ : لك في هذا غنًى فتنكِّرُ إِذا أردتَ أن تجعَل ذَلك من بعضِ ما يُستغَنى به . فإِنْ قلتَ : لك في الغنى كان الظاهرُ أنك جعلتَ غِناهُ به
وأمرٌ آخرُ وهو أنه لا يكونُ ارتداعٌ حتى يكونَ همٌّ وإِرادةٌ . ليس بواجبٍ أن لا يكونَ إِنسانٌ في الدنيا إِلاّ وله عدوٌّ يَهُمُّ بقتله ثم يردَعُه خوفُ القِصاصِ . وإِذا لم يَجِبْ ذلك فمَن لم يَهُمَّ إِنسانٌ بقتلِه فكُفيَ ذلك الهمَّ لخوفِ القصاصِ ليس هو ممَّن حَيِيَ بالقصاص . وإِذا دخلَ الخصوصُ فقد وجبَ أن يقالَ " حياةٌ " ولا يقالَ " الحياةُ " كما وجبَ أن يقالَ " شفاءٌ "
ولا يقالُ " الشفاءُ " في قولِه تعالى : ( يَخْرُجُ من بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهُ فِيْهِ شِفاءٌ للنَّاسِ ) حيثُ لم يكن شفاءً للجميع
واعلمْ أنه لا يتصوَّر أن يكونَ الذي هَمَّ بالقتلِ فلم يقتلْ خوفَ القصاصِ داخلاً في الجملة وأن يكونَ القصاصُ أفادَه حياةً كما أفادَ المقصودَ قتلُه . وذلك أنَّ هذه الحياةَ إِنَّما هي لمن كان يُقتلُ لولا القصاصُ وذلك محالٌ في صِفَةِ القاصِدِ للقتلِ . فإِنما يصحُّ في وصفِه ما هو كالضِّدِّ لهذا وهو أن يقالَ إِنه كان لا يُخافُ عليه القتلُ لولا القصاصُ وإِذا كانَ هذا كذلكَ كان وجهاً ثالثاً من وجوبِ لتَّنكير
فصل في الذوق والمعرفة
واعلمْ أنه لا يصادِفُ القولُ في هذا البابِ موقعاً من السامِعِ ولا يَجدُ لديه قَبولاً حتى يكونَ من أهل الذوقِ والمعرفةِ وحتى يكونَ ممن تحدِّثُه نفسُه بأنَّ لما يُومىءُ إِليه من الحسنِ واللطفِ أصلاً وحتى يختلفَ الحالُ عليه عندَ تأمُّلِ الكلام فيجدَ الأريحيةَ تارةً ويَعرى منها أخرى . وحتى إِذا عجَّبتَه عجِبَ وإِذ نَبَّهتَه لموضع المزية انتبه . فأمّا من كانتِ الحالانِ والوجهان عنده أبداً على سواءٍ وكان لا يَفْقَه من أمرِ النظمِ إِلا الصحَّةَ المُطلقةَ وإِلا إِعراباً ظاهراً فما أقلَّ ما يُجدي الكلامُ معه . فليكنْ مَنْ هذه صفتُه عندَك بمنزلةِ مَن عدم الإِحساسَ بوزنِ الشعرِ والذوقَ الذي يقيمه به والطَّبعَ الذي يميِّزُ صحيحُه من مكسورِه ومزاحفَه من سالمِه وما خرجَ من البحرِ ممّا لم يخرجْ منهُ في أنك لا تتصدَّى له ولا تتكلَّفُ تعريفَه لعلمك أنه قد عدمَ الأداةَ التي معها يَعرفُ والحاسَّةَ التي بها يَجدُ . فليكن قَدْحُك في زَنْدٍ وارٍ والحكُّ في عُودٍ أنت تطمعُ منه في نار
واعلمْ أن هؤلاء وإنْ كانوا هم الآفَةَ العظمى في هذا البابِ فإِن منَ الآفَةِ أيضاً مَن زعمَ أنه لا سبيلَ إِلى معرفةِ العِلَّةِ في قليلِ ما تُعْرَفُ المزيةُ فيه وكثيرِه وأنْ ليس إِلا أن تعلمَ أنَّ هذا التقديمَ وهذا التنكيرَ أو هذا العطْفَ أو هذا الفصْلَ حسَنٌ . وأن له موقعاً من النفسِ وحظّاً من القَبولِ . فأمّا أن تَعْلَمَ لِمَ كان كذلك وما السَّببُ فممَّا لا سبيلَ إِليه ولا مطمعَ في الاطِّلاعِ عليه فهو بتوانِيه والكسلِ فيه في حكمِ مَن قالَ ذلك
واعلمْ أنه ليسَ إِذا لم يُمكنْ معرفةُ الكلِّ وجبَ تركُ النظرِ في الكل . وأن تعرفَ العلةَ والسَّبَب فيما يمكنك معرفةُ ذلك فيه وإِنْ قلَّ فتجعلَه شاهداً فيما لم تعرفْ أَحرى من أن تسُدَّ بابَ المعرفة على نفسِك وتأخذها عن الفهم والتفهُّم وتعوِّدَها الكسلَ والهُوينى . قال الجاحظُ : " وكلامٌ كثيرٌ قد جَرى على ألسنةِ الناس وله مَضَرّةٌ شديدةٌ وثَمرةٌ مُرَّةٌ . فمِنْ أضرِّ ذلك قولُهم : لم يدَعِ الأولُ للآخرِ شيئاً . قال : فلو أن علماءَ كلِّ عصرٍ مُذْ جرتْ هذه الكلمةُ في أَسماعِهِم تَركوا الاستنباطَ لِمَا لم يَنتهِ إِليهم عمَّن قبلَهُم لرأيتَ العلمَ مُختلاًّ "
واعلمْ أن العلمَ إِنما هو معدِنٌ فكما أنه لا يمنعُك أنْ ترى ألفَ وِقْرٍ قد أخرجتْ من معدنِ تبْرٍ أن تطلبَ فيه وأن تأخذَ ما تجد ولو كَقَدْرِ تُومةٍ كذلكَ ينبغي أن يكون رأيُك في طلبِ العلمِ ومنَ الله تعالى نسألُ التوفيقَ
فصل هذا فَنٌّ من المجازِ لم نذكره فيما تقدم
اعلَمْ أنَّ طريق المجازِ والاتِّساعِ في الذي ذكرناه قبلُ أنك ذكرتَ الكلمةَ وأنت لا تريدُ معناها ولكن تريدُ معنى ما هو رِدفٌ له أو شبيهٌ . فتجوّزتَ بذلك في ذاتِ الكلمة وفي اللفظِ نفسه . وإِذ قد عرفتَ ذلك فاعلمْ أنَّ في الكلامِ مجازاً على غيرِ هذا السبيلِ وهو أن يكونَ التجوُّزُ في حُكمٍ يجري على الكلمة فقط وتكونَ الكلمةُ متروكةً على ظاهرِها ويكونَ معناها مقصوداً في نفسهِ ومُراداً من غيرِ توريةٍ ولا تعريض . والمثالُ فيه قولُهم : " نهارُك صائمٌ وليلكُ قائمٌ ونام ليلي وتجلَّى همي " . وقولُهُ تعالى : ( فما رَبِحَتْ تِجارَتُهُم ) وقولُ الفرزدق - الطويل - :
( سَقَتْهَا خُرُوقٌ في المَسامِع لَمْ تَكُنْ ... عِلاطاً ولا مَخْبوطَةً في المَلاغِمِ )
أنت ترى مجازاً في هذا كلِّه ولكن لا في ذَواتِ الكلم وأنفُسِ الألفاظ ولكن في أحكامٍ أُجريتْ عليها أفلا ترى أنك لم تتجوَّزْ في قولك : " نهارُك صائمٌ وليلُكَ قائمٌ " في نفسِ صائمٍ وقائمٍ ولكنْ في أنْ أجريتهما خبرينِ على النَّهارِ والليلِ . وكذلك ليس المجازُ
في الآية في لفظه " ربحتْ " نفسِها ولكن في إِسنادها إِلى التجارة . وهكذا الحكمُ في قولهِ : " سقتها خروق " ليس التجوّزُ في نفس " سقتها " ولكنْ في أن أسنَدَه إِلى الخروقِ . أفلا ترى أنك لا تَرى شيئاً منها إِلاّ وقد أُرِيدَ به معناه الذي وُضِعَ له على وجههِ وحقيقتهِ فلم يُرِدْ بصائمٍ غيرَ الصوم ولا بقائمٍ غيرَ القيام ولا ب " ربحت " غيرَ الربح ولا ب " سقت " غيرَ السَقي كما أريدَ ب " سالَتْ " في قوله - الطويل - :
( وسالتْ بأعناقِ المطيِّ الأباطحُ ... )
غَيرَ السَّيل
واعلمْ أن الذي ذكرتُ لك في المجاز هناك مِنْ أَنَّ مِنْ شأنِهِ أن يَفْخُمَ عليه المعنى وتحدُثَ فيه النَّباهةُ قائم لك مثلُه هاهُنا . فليس يَشتَبه على عاقلٍ أنْ ليس حالُ المعنى وموقعهُ في قولهِ - الرجز - :
( فَنَامَ لَيْلي وتجَلَّى هَمِّي ... )
كحالهِ وموقعهِ إذا أنتَ تركتَ المجازَ وقلتَ : فنمتُ في ليلي وتجلَّى همي كما لم يكنِ الحالُ في قولك : رأيتُ رجلاً كالأسد . ومَنْ ذا الذي يَخفى عليه مكانُ العلوِّ وموضعُ المزية وصورةُ الفُرقان بينَ قولهِ تعالى : ( فما ربحتْ تجارتُهم ) وبينَ أن يقالَ : " فما رَبحوا في تجارتِهم "
وإنْ أردتَ أَنْ تزدادَ للأمرِ تَبيُّناً فانظرْ إلى بيتِ الفرزدق - الكامل - :
( يَحْمي إذا اخْتَرَطَ السُّيوفُ نِساءَنا ... ضَرْبٌ تَطيرُ لَه السَّواعدُ أرْعَلُ )
وإلى رَونِقه ومائِه وإلى ما عليه مِنَ الطَّلاوة . ثم ارجعْ إلى الذي هو الحقيقةُ وقُل : " نحمي إذا اخْتَرطَ السيوفُ نساءَنا بضربٍ تطيرُ له السواعدُ أرعلُ " ثم اسْبِرْ حالَك هل تَرى مما كنتَ تراه شيئاً
وهذا الضَّرْبُ منَ المجاز على حِدَته كنز من كنوزِ البلاغة ومادَّةُ الشاعر المُفْلِقِ والكاتبِ البليغِ في الإِبداع والإِحسان والاتِّساعِ في طُرُق البيانِ . وأن تجيءَ بالكلام مَطبوعاً مصنوعاً وأن يضعَه بعيدَ المَرامِ قريباً منَ الأَفهامِ . ولا يغرَّنَّك من أمرِه أنك ترى الرجلَ يقولُ : " أتى بيَ الشَّوقُ إلى لقائك وسارَ بيَ الحنينُ إلى رؤيتك وأقْدَمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان " وأشباهُ ذلك مما تجدُه لسَعَتهِ وشهرتهِ يَجري مَجرى الحقيقةِ التي لا يُشكلُ أمرُها فليس هو كذلك أبداً بل يَدِقُّ ويلطفُ حتى يمتنعَ مثلهُ إلا على الشاعرِ المُفْلق والكاتبِ البليغِ وحتى يأتيَك بالبِدعةِ لم تَعرفْها والنادرةِ تأنَقُ بها
وجملةُ الأمر أنَّ سبيلَه سبيلُ الضَّرب الأول الذي هو مجازٌ في نفسِ اللفظ وذاتِ الكلمة . فكما أنَّ مِن الاستعارة والتَّمثيل عاميَّاً مثلَ : رأيتَ أسداً ووردتُ بحراً وشاهدتُ بدراً وسَلَّ من رأيه سيفاً ماضياً . وخاصّياً لا يكمُلُ له كلُّ أحدٍ مثلَ قوله :
( وسالَتْ بأعْناقِ المَطِيِّ الأَباطِحُ ... )
كذلك الأمرُ في هذا المجازِ الحكميِّ
واعلمْ أنه ليس بواجبٍ في هذا أن يكونَ للفعل فاعلٌ في التقدير إذا أنتَ نقلتَ الفعلَ إليه عدتَ به إلى الحقيقةِ مثلَ أن تقولُ في ( ربحت تجارتُهم ) : رَبحوا في تجارتِهم وفي " يحمي نساءَنا ضربٌ " : نَحمي نساءنا بضرب فإِنَّ ذلك لا يتأتَّى في كلِّ شيءٍ . ألا ترى أنه لا يمكنُك أن تثبتَ للفعل في قولك : أقدَمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان : فاعلاً سوى الحقِّ وكذلك لا تستطيعُ في قولهِ - مجزوء الوافر - :
( وصَيَّرني هَواكِ وَبي ... لِحَيْني يضْرَبُ المَثَلُ )
وقوله - مجزوء الوافر - :
( يزيدُكَ وجْهُهُ حُسْناً ... إِذا ما زِدْتَهُ نَظَرا )
أنْ تزعُمَ أنَّ لصيَّرني فاعلاً قد نُقِل عنه الفعلُ فجعلَ للهوى كما فُعِلَ ذلك في " ربحت تجارتهم " و " يحمي نساءنا ضربٌ " ولا تستطيعُ كذلك أن تقدرَ ل " يزيد " في قوله : يزيدك وجهُه فاعلاً غيرَ الوجه . فالاعتبارُ إذاً بأن يكونَ المعنى الذي يرجعُ إليه الفعلُ موجوداً في الكلام على حقيقته . معنى ذلك أن القُدومَ في قولك : أقدمني بلدَك حقٌّ على إنسان موجودٌ على الحقيقة وكذلك الصَّيْرورة في قولِه : وصَيَّرني هواك والزيادةُ في قوله : " يزيدُك وجهُه " موجودتان على الحقيقة . وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقةِ لم يكن المجازُ فيه نفسِه . وإِذا لم يكنِ المجازُ في نفسِ اللفظِ كان لا محالةَ في الحُكمِ . فاعرفْ هذه الجملةَ وأحسِنْ ضبطَها حتى تكونَ على بصيرةِ من الأمر
ومنَ اللطيف في ذلك قولُ حاجزِ بنِ عوفٍ - الوافر - :
( أَبي عَبَرَ الفَوارِسَ يَوْمِ داجٍ ... وعَمِّي مالِكٌ وَضَعَ السِّهاما )
( فَلوْ صاحَبْتِنا لَرَضِيتِ عَنَّا ... إِذا لَمْ تَغْبُقِ المِئةُ الغُلاما )
يريد إذا كان العامُ عامَ جَدْبٍ وجفَّتْ ضروعُ الإِبل وانقطعَ الدَّرُّ حتى إنْ جُلِبَ منها مئةٌ لم يَحصُلْ من لبنها ما يكونُ غَبُوق غلامٍ واحد . فالفعلُ الذي هو غَبق مُسْتَعْمَلٌ في نفسه على حقيقته غيرَ مُخْرَجٍ عن معناهُ وأصلهِ إلى معنى شيءٍ آخر . فيكونُ قد دخلَه مجازٌ في نفسِه . وإنما المجازُ في أن أُسندَ إلى الإِبلِ وجُعِلَ فعلاً لها . وإسنادُ الفعل إلى الشيءِ حكمٌ في الفعلِ وليس هو نفسَ معنى الفعل فاعرفْه
واعلمْ أنّ من سبب اللطفِ في ذلك أنَّه ليس كلُّ شيء يصلُح لأن يُتعاطى فيه هذا المجازُ الحكميُّ بسهولةٍ بل تجدُك في كثيرٍ من الأمر وأنت تحتاجُ إلى أن تهيِّىءَ الشيءَ
وتصلِحَه لذلك بشيءٍ تتوخّاه في النظم . وإن أردتَ مثالاً في ذلك فانظْر إلى قوله - الطويل - :
( تناسَ طِلابَ العامِريَّة إذْ نأتْ ... بأسْجَحَ مِرْقالِ الضُّحَى قَلقِ الضَّفْرِ )
( إذا ما أَحَسَّتْهُ الأفاعي تَميَّزتْ ... شَواةُ الأفاعي في مُثَلَّمةِ سُمَرِ )
( تَجُوبُ له الظَّلْماءَ عينٌ كأنَّها ... زُجَاجَةُ شَرْبٍ غيرُ مَلأى ولا صِفْرِ )
يَصِفُ جَملاً ويريد أنه يهتدي بنورِ عينه في الظلماء ويمكنُه بها أن يخرقَها ويمضي فيها . ولولاها لكانتِ الظلماءُ كالسدِّ والحاجزِ الذي لا يجدُ شيئاً يفرِّجُه به ويَجعلُ لنفسه فيه سبيلاً . فأنت الآن تعلمُ أنه لولا أنه قال : " تجوبُ له " فعلَّق " له " ب " تجوب " لما صلُحَتِ العينُ لأن يُسْنَدَ " تجوب " إليها ولكان لا تَتَبَيَّن جهةُ التجوُّز في جعلِ " تجوب " فعَلاً للعين كما ينبغي . وكذلك تعلمُ أنه لو قال مثلاً : تَجوبُ له الظلماءَ عينُه لم يكنْ له هذا الموقعُ ولا ضرَبَ عليه معناه وانقطع السِّلْكُ من حيثُ كان يعيبُه حينئذٍ أن يصِفَ العينَ بما وصفها به الآن
فتأمَّلْ هذا واعتبرْه . فهذه التهيئة وهذا الاستعدادُ في هذا المجاز الحُكْمي نظيرُ أنك تراك في الاستعارةِ التي هي مجازٌ في نفسِ الكلمة وأنت تحتاجُ في الأمر الأكثر إلى أن تمهِّدَ لها وتقدِّمَ أو تؤخرَ ما يُعْلَمُ به أنك مستعيرٌ ومشبِّهٌ ويفتح طريقَ المجاز إلى الكلمة . ألا تَرى إلى قولهِ - الطويل - :
( وصاعِقَةٍ مِن نَصْلِهِ تَنْكَفِي بها ... عَلى أَرْؤُسِ الأَقْرانِ خَمْسُ سَحائبِ )
عَنى بخمسِ السحائبِ أناملَه ولكنه لم يأتِ بهذه الاستعارة دفعةً ولم يَرْمِها إليك بَغْتةً بل ذكر ما يُنبىءُ عنها ويُستدَلُّ به عليها فذكر أن هناك صاعقةً وقال : " مِنْ نصلِه " فبيَّن أنَّ تلك الصاعقةَ من نصلِ سيفِه ثم قال : " على أرؤسِ الأقرانِ " ثم قال : " خمسُ "
فذكر الخمسَ التي هي عددُ أناملِ اليدِ فبانَ من مجموعِ هذه الأمورِ غرضُه
وأنشدوا لبعضِ العرب - الرجز - :
( فإِنْ تعافُوا العدلَ والإيمانا ... فَإِنَّ في أيْمانِنا نِيرانا )
يريدُ أنَّ في أيماننا سيوفاً نضرِبكُم بها . ولولا قولُه أوَّلا : " فإِنْ تعافوا العدلَ والإِيمانَ " وأَنَّ في ذلك دلالةً على أن جوابَه أنهم يُحارَبُون ويُقْسَرُون على الطاعةِ بالسيفِ ثم قولُه : فإِنَّ في أيماننا لمَا عُقِل مرادُه ولما جَازَ أنْ يستعيرَ النيرانَ للسيوفِ لأنه كان لا يُعْقَل الذي يريد لأنا وإن كنَّا نقول : " في أيديهم سيوفٌ تلمع كأَنها شُعَلُ نارٍ " كما قال - الكامل - :
( ناهَضْتُهُمْ والبارِقاتُ كأَنَّها ... شُعَلٌ على أَيديهِمُ تَتَلهَّبُ )
فإِنَّ هذا التشبيهَ لا يبلغُ ما يُعْرَفُ مَعَ الإِطلاق كمعرفتنا إذا قال : " رأيتُ أسداً " أنه يريدُ الشجاعةَ . وإذا قال : " لقيتُ شمساً وبدراً " أنه يريدُ الحُسنَ ولا يقوى تلك القوَّة فاعرفْه
ومما طريق المجازِ فيه الحكمُ قولُ الخنساء - البسيط - :
( تَرْتَعُ ما رتَعَتْ حَتّى إذا ادَّكَرتْ ... فإِنّما هيَ إِقْبَالٌ وإدبارُ )
وذاك أنها لم تُرِدْ بالإِقبال والإِدبارِ غيرَ معناهُما فتكونَ قد تجوَّزتْ في نفسِ الكلمة . وإنما تجوَّزَتْ في أنْ جعلتها لكثرةِ ما تقُبِلُ وتُدبرُ ولغلبة ذاك عليها واتصالِه بها وأنه لم يكنْ لها حالٌ غيرُهما كأنها قد تجسَّمتْ منَ الإِقبالَ والإِدبارِ . وإنَّما كان يكونُ المجازُ في نفسِ الكلمة لو أنها كانت قد استعارتِ الإِقبالَ والإِدبار لمعنى غيرِ معناهُما الذي وُضعا له في اللغة . ومعلومٌ أنْ ليس الاستعارةُ مما أرادتْه في شيء
واعلمْ أنْ ليس بالوجهِ أنْ يُعَدَّ هذا على الإِطلاق مَعَدَّ ما حُذِفَ منه المضافُ وأقيمَ المضافُ إليه مقامه مثلَ قولهِ عزَّ وجلَّ : ( وأسألِ القريةَ ) ومثلَ قولِ النابغة الجعدي - المتقارب - :
( وكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أصْبَحَتْ ... خِلالَتُهُ كأَبي مَرْحَبِ )
وقولِ الأعرابي - الوافر - :
( حَسبتَ بُغامَ راحلتي عَناقاً ... وما هيَ وَيْبَ غَيْرِك بالعَناقِ )
وإنْ كنا نراهُم يذكرونه حيثُ يَذكرون حذفَ المضافِ ويقولون : إنه في تقدير " فإِنما هي ذاتُ إقبالٍ وإدبارٍ " ذاكَ لأن المضافَ المحذوف من نحوِ الآية والبيتين في سبيل ما يُحذَفُ من اللفظِ ويُرادُ في المعنى كمثل أن يحذَفَ خبرُ المبتدأ أو المبتدأ إذا دَلَّ الدليلُ عليه إلى سائرِ ما إذا حُذِفَ كان في حكمِ المنطوق به وليس الأمرُ كذلك في بيتِ الخنساء لأنَّا إِذا جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إِذا نحنُ قلنا : " فإِنما هي ذاتُ إقبالٍ وإدبارٍ " أفسدنا الشعرَ على أنفسِنا وخرجْنا إلى شيءٍ مغسولٍ وإلى كلامٍ عاميٍّ مرذولٍ . وكان سبيلُنا سبيلَ مَنْ يزعمُ مثلاً في بيتِ المتنبي - الوافر - :
( بَدَتْ قَمَراً ومالَتْ خُوطَ بانٍ ... وَفاحَتْ عَنْبَراً وَرَنَتْ غَزالا )
أنه في تقديرِ محذوفٍ وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلتَ : بدتْ مثلَ قمرٍ ومالتْ مثلَ خوطِ بانٍ وفاحتْ مثلَ عنبرٍ ورنتْ مثلَ غزال في أنَّا نخرجُ إلى الغَثاثة وإلى شيءٍ يَعْزِلُ البلاغةَ عن سلطانها ويخفِضُ من شأنها ويصدُّ بأوجُهِنا عن محاسنِها ويَسُدُّ بابَ المعرفة بها وبلطائفها علينا . فالوجهُ أن يكون تقديرُ المضافِ في هذا على معنى أنه لو كان الكلامُ قد جىءَ به على ظاهرهِ ولم يُقْصدْ إلى الذي ذكرنا من المبالغة والاتِّساع وأن تُجْعَلَ الناقةُ كأَنها قد صارتْ بجملتها إقبالاً وإدباراً حتى كأَنها قد تَجَسَّمتْ منهما لكان حقُّه حينئذٍ أن يُجاءَ فيه بلفظِ الذَّاتِ فيقالَ : إنما هي ذاتُ إقبالٍ وإدبارٍ . فأما أن يكونَ الشعرُ الآن موضوعاً على إرادةِ ذلك وعلى تنزيلهِ منزلةَ المنطوقِ به حتى يكونَ الحالُ فيه كالحال في :
( حَسِبْتُ بُغامَ راحِلَتي عَناقاً ... )
حين كان المعنى والقصدُ أن يقولَ : حَسِبْتَ بُغامَ رَاحلتي بغامَ عناقٍ . مما لا مساغَ له عندَ من كان صحيحَ الذوق صحيح المعرفة نَسّابةً للمعاني
فصل في تهوُّرِ بعض المفسرين
هذه مسألةٌ قد كنتُ عملتُها قديما وقد كتبتُها هاهُنا لأن لها اتصالاً بهذا الذي صارَ بنا القولُ إليه . قولهُ تعالى : ( إنَّ في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌ ) أي لمن كان أعْمَلَ قلبَه فيما خُلِقَ القلبُ له منَ التدبُّرِ والتفكُّر والنظر فيما ينبغي أن ينظرَ فيه . فهذا على أن يُجْعَلَ الذي لا يَعِي ولا يسمعُ ولا ينظرُ ولا يتفكَّرُ كأنه قد عَدِم القلبَ من حيثُ عَدِمَ الانتفاعَ به وفاتَه الذي هو فائدةُ القلبِ والمطلوب منه . كما جُعِل الذي لا ينتفعُ ببصرهِ وسمعهِ ولا يفكر فيما يؤدِّيان إليه ولا يحصُلُ من رؤية ما يُرى وسَماع ما يُسمعُ على فائدةٍ بمنزلة من لا سَمْعَ له ولا بَصَرَ
فأما تفسيرُ من يفسِّره على أنه بمعنى " من كان له عقلٌ " فإِنه إنما يصحُّ على أن يكونَ قد أرادَ الدَّلالةَ على الغرض على الجملة . فأمَّا أن يُؤْخَذَ به على هذا الظاهر حتى كأنَّ القلبَ اسمٌ للعقل كما يتوهَّمه أهلُ الحشوِ ومَنْ لا يعرفُ مخارجَ الكلامِ فمُحالٌ باطلٌ لأنه يؤدي إلى إبطالِ الغرض من الآية وإلى تحريفِ الكلام عن صورتِه وإزالةِ المعنى عن جهته . وذاك أنَّ المرادَ به الحثُّ على النظر والتقريعُ على تركِه وذمُّ من يُخِلُّ به ويَغْفلُ عنه . ولا يحصُلُ ذلك إلا بالطريقِ الذي قدمتهُ وإلاّ بأن يكونَ قد جعل من لا يفقَه بقلبهِ ولا ينظرُ ولا يتفكَّرُ كأنه ليس بذي قلبٍ كما يُجْعَلُ كأنه جمادٌ وكأنه مَيّت لا يشعر ولا يحسُّ . وليس سبيلُ من فسَّر القلبَ هاهنا على العقل إلاّ سبيلَ من فسَّر عليه العينَ والسمع في قول الناس : " هذا بَيِّنٌ لمن كانت له عَيْنٌ ولمن كان له سمعٌ " . وفسَّر العَمى والصَّمَم والموتَ في صفةِ من يوصفُ بالجهالة على مجرَّد الجهلِ وأَجْرى جميعَ ذلك عل الظاهر فاعرفْه
ومن عادةِ قومٍ ممَّن يتعاطى التفسيرَ بغير علمٍ أن يتوهَّموا أبداً في الألفاظ الموضوعةِ على المجاز والتمثيلِ أنها على ظواهرِها فيفسدوا المعنى بذلك ويُبطلوا الغرضَ ويمنعوا أنفسَهم والسَّامعَ منهم العلمَ بموضعِ البلاغة وبمكان الشرق . وناهيك بهم إِذا هم أخذوا في ذكرِ الوجوه وجعَلوا يُكثرون في غيرِ طائل هناك ترى ما شئتَ من بابِ جهلٍ قد فتحوه وزَنْدِ ضلالةٍ قد قَدَحوا به . ونسألُ الله تعالى العصمةَ والتوفيقَ
فصل في الكناية والتعريض
هذا فنٌ من القول دقيقُ المسلم لطيفُ المأخذ وهو أنَّا نراهم كما يصنعون في نفسِ الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكنايةِ والتعريضِ . كذلك يذهبون في إِثباتِ الصفة هذا المذهبَ . وإذا فعلوا ذلك بدَتْ هناك محاسنُ تملأ الطرف وَدقائقُ تُعجزُ الوصفَ . ورأيتَ هناك شعراً شاعراً وسحراً ساحراً وبلاغةً لا يكمل لها إلاّ الشاعرُ المُفلِقُ والخطيب المِصْقَعُ . وكما أنَّ الصفةَ إذا لم تأتك مُصرَّحاً بذكرها مكشوفاً عن وجهها ولكنْ مدلولاً بغيرها كان ذلك أفخمَ لشأنها وألطفَ لمكانِها . كذلك إثباتُك الصفةَ للشيءِ تثبِتُها له إِذا لم تُلقِه إلى السامع صريحاً وجئتَ إليه من جانبِ التعريضِ والكنايةِ والرمزِ والإِشارة كان له من الفضلَ والمزية ومن الحُسْنِ والرونَقِ ما لا يقلُّ قليلُه لا يُجْهلُ موضعُ الفضيلة فيهوتفسيرُ هذه الجملةِ وشرحُها أنهم يرومون وصفَ الرجل ومدحَه وإثباتَ معنًى من المعاني الشريفة له فَيدَعون التَّصريحَ بذلك ويُكَنّون عن جعلِها فيه بجعلِها في شيءٍ يشتَمِلُ عليه ويتلبَّسُ به . ويتوصَّلون في الجملة إلى ما أرادوا من الإِثبات لا من الجهةِ الظاهرةِ المعروفةَ بل من طريقٍ يَخفَى ومسلَكٍ يَدِقُّ . ومثالُه قولُ زيادٍ الأعجمِ - الكامل - :
( إنَّ السَّماحَةَ والمُروءةُ والنَّدَى ... في قُبَّةٍ ضُرِبَتْ على ابْنِ الحَشْرَجِ )
وبعده :
( ملكٌ أغَرُّ مُتَوَّجٌ ذُو نائِلٍ ... للمُعْتَفِيْنَ يَمِيْنهُ لَم تَشْنَجِ )
( يا خَيْرَ من صَعِدَ المنابِرَ بالتُّقى ... بعدَ النَّبِيِّ المُصْطفى المُتَحَرِّجِ )
( لمَّا أَتَيْتُكَ رَاجِياً لِنَوالِكُمْ ... أَلفَيْتُ بَابَ نوالِكُمْ لَمْ يُرْتَجِ )
أرادَ - كما لا يخفى - أن يُثبتَ هذه المعاني والأوصافَ خلالاً للمدوح وضرائبَ فيه . فترك أنْ يصرِّحَ فيقولَ : " إِنَّ السماحَة والمروءة والندى مجموعةٌ في ابنِ الحَشْرج أو مقصورةٌ عليه أو مختصةٌ به " وما شاكلَ ذلك مما هو صريحٌ في إِثبات الأوصافِ للمذكورين بها . وعَدَل إِلى ما تَرى مَن الكناية والتَّلويح فجعل كونَها في القبَّة المضروبةِ عليه عبارةً عن كونها فيه وإِشارةً إِليه . فخرج كلامُه بذلك إِلى ما خرجَ إِليه منَ الجزالة وظهر فيه ما أنت ترى منَ الفخامة . ولو أنه أسقطَ هذه الواسطةَ من البَيْت لما كان إِلاَّ كلاماً غُفْلاً وحديثاً ساذَجاً . فهذه الصنعةُ في طريق الإِثبات هي نظيرُ الصنعةِ في المعاني إِذا جاءتْ كناياتٍ عن معانٍ أُخَر نحوُ قولهِ - الوافر - :
( وما يَكُ فِيَّ مِنْ عَيْبٍ فإِنّي ... جَبَانُ الكَلْبِ مَهْزُولُ الفَصِيلِ )
فكما أنه إِنَّما كان من فاخرِ الشعر ومما يقعُ في الاختيار لأجلِ أن أرادَ أن يذكرَ نفسَه بالقرى والضيافةِ فكنَّ عن ذلك بجبنِ الكلبِ وهُزالِ الفصيلِ وتركَ أن يصرِّحَ فيقول : قد عُرِفَ أنَّ جنابي مألوفٌ وكلبي مؤدَّب لا يَهِرُّ في وجوهِ من يَغشاني من الأضيافِ وأني أنحرُ المَتَالي من إِبلي وأدعُ فصالَها هزلى
كذلك إِنما راقك بيتُ زياد لأنه كنَّى عن إِثباته السماحةَ والمروءة والندى كائنةً في الممدوحِ بجعلها كائنةً في القبَّة المضروبةِ عليه . هذا - وكما أنَّ من شأنِ الكنايةِ الواقعةِ في نَفْسِ الصفة أن تجيءَ على صورة مختلفة كذلك من شأنها إذا وقعت في طريق إثبات الصفة أن تجيء على هذا الحدِّ ثم يكونَ في ذلك ما يتناسَبُ كما كان ذلك في الكنايةِ عن الصفةِ نفسِها . تفسيرُ هذا أنك تنظرُ إِلى قولِ يزيدَ بنِ الحَكَم يمدحُ بن يزيدَ بنَ المهلَّبِ وهو في حَبْسِ الحَجّاجِ - المنسرح - :
( أَصْبَحَ في قَيْدِكَ السَّمَاحَةُ ... والمجدُ وفَضْلُ الصَّلاحِ والحَسَبُ )
فتراه نظيراً لبيتِ زياد وتَعْلَمُ أنَّ مكانَ القيدِ هاهنا هو مكانُ القبَّة هناك . كما أنك تنظرُ إلى قوله : " جبان الكلب " فتعلمُ أنه نظيرٌ لقولهِ - الطويل - :
( زجرتُ كلابي أَنْ يهِرَّ عَقُورُها ... )
من حيثُ لم يكن ذلك الجبنُ إلاّ لأنْ دامَ منه الزَّجرُ . واستمرَّ حتى أخرجَ الكلبَ
بذلك عما هو عادتُه منَ الهرير والنَّبحِ في وجهِ مِنْ يدنو من دارٍ هو مُرصَدٌ لأن يَعُسَّ دونها . وتنظُرُ إلى قولهِ : " مهزولُ الفصيل " فتعلمُ أنه نظيرُ قولِ ابن هَرْمَةَ
( لا أمْتِع العُوذَ بالفصال ... )
وتنظُر إلى قول نُصَيْبٍ - المتقارب - :
( لِعَبْدِ العَزيزِ على قَوْمِهِ ... وغَيْرِهِمُ مِنَنٌ ظاهِرَه )
( فَبابُكَ أسْهَلُ أَبْوابِهمْ ... ودَارُكَ مَأْهُولَةٌ عامِرَهْ )
( وكلبُكَ آنَسُ بالزّائِرينَ ... منَ الأُمِّ بالابْنَةِ الزَّائِرَهْ )
فتعلمُ أنه من قولِ الآخَرِ - الطويل - :
( يَكادُ إذا ما أبْصَرَ الضَّيْفَ مُقْبلاً ... يُكَلِّمهُ مِنْ حُبِّهِ وهْوَ أَعْجَم )
وأنَّ بينهُما قرابةً شديدةً ونسَباً لاصِقاً وأنَّ صورتَهما في فَرْطِ التناسُب صورةُ بيتَي " زيادٍ " و " يزيدَ "
ومما هو إثباتٌ للصفةِ على طريقِ الكنايةِ والتَّعريض قولُهم : المجدُ بَيْنَ ثوبيهِ والكرمُ في بُرديه وذلك أن قائلَ هذا يتوصَّل إلى إثباتِ المجدِ والكرمِ للممدوحِ بأن يجعلَهما في ثوبِه الذي يلبَسُه كما توصَّل زيادٌ إلى إثباتِ السَّماحة والمروءة والنَّدى لابنِ الحَشْرجِ بأن جعلَها في القبة التي هو جالسٌ فيها . ومن ذلك قولُه - البسيط - :
( وحيْثُما يكُ أمرٌ صالحٌ فَكُنِ ... )
وما جاءَ في معناهُ من قولهِ - المتقارب - :
( يَصيرُ أَبانٌ قَرينَ السَّماحِ ... والمَكْرُماتِ مَعاً حَيْثُ صارا )
وقول أبي نواس - الطويل - :
( فَما جازَهُ جُودٌ ولا حَلَّ دُونَهُ ... ولكِنْ يَصيرُ الجُودُ حَيْثُ يَصيرُ )
كلُّ ذلك توصُّلٌ إلى إثباتِ الصِّفة في الممدوح بإِثباتها في المكانِ الذي يكونُ فيه وإلى لزومِها له بلزومها الموضعَ الذي يحلُّه . وهكذا إنِ اعتبرتَ قولَ الشَّنْفَرَى يصف امرأةً بالعفة - الطويل - :
( يَبيتُ بِمَنْجاةٍ مِنَ اللَّوْمِ بَيْتُها ... إِذا ما بُيوتٌ بالمَلامَةِ حُلَّتِ )
وجدتَه يدخلُ في معنى بيتِ زيادٍ وذلك أنه توصَّلَ إلى نفي اللوم عنها وإبعادِها عنه : بأن نفاه عن بيتها وباعدَ بينه وبينه . وكان مذهبهُ في ذلك مذهبَ زيادٍ في التوصُّلِ إلى جعلِ السَّماحةِ والمروءة والنَّدى في ابنِ الحشرج بأن جعلَها في القبَّة المَضْروبة عليه . وإنَّما الفرقُ أنَّ هذا ينفي وذاك يثبتُ . وذلك فرقٌ لا في مَوْضعِ الجمعِ فهو لا يمنع أن يكونا من نصابٍ واحدٍ
ومما هو في حُكم المناسِبِ لبيت زيادٍ وأمثالِه التي ذكرتُ وإنْ كانَ قد أُخرجَ في صورةٍ أغربَ وأبدعَ قولُ حسانَ رضي الله عنه - الطويل - :
( بَنَى المَجْدُ بَيْتاً فاسْتَقَرَّتْ عِمَادُهُ ... عَلَيْنا فَأَعْيا النَّاسَ أن يَتَحَوَّلا )
وقَولُ البحتري - الكامل -
( أوَ ما رأيتَ المَجْدَ أَلْقى رحلَهُ ... في آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يتحوَّلِ )
( ذاك لأنَّ مدارَ الأَمر على أَنه جَعَل المجدَ والممدوحَ في مكانٍ وجعلَه يكونُ حيثُ يكون
واعلمْ أنه ليس كلُّ ما جاء كنايةً في إثباتِ الصفة يصلُحُ أنْ يُحْكَمَ عليه بالتناسُب . معنى هذا أنَّ جَعْلَهم الجودَ والكرمَ والمجدَ يَمْرضُ بِمَرضِ الممدوحِ كما قال البحتري - الطويل - :
( ظَلِلْنا نعودُ الجودَ من وَعكِكَ الذي ... وجدتَ وقُلنا : اعتلَّ عضوٌ منَ المجدِ )
وإنْ كان يكونُ القصدُ منه إثباتَ الجودِ والمجدِ للممدوحِ فإِنَّه لا يصحُّ أنْ يقالَ إنه نظيرٌ لبيتِ زيادٍ كما قلنا ذاك في بيتِ أبي نواس :
( ولكن يصيرُ الجودُ حَيْثُ يصيرُ ... )
وغيرهُ مما ذكرنا أنه نظيرٌ له كما أنه لا يجوزُ أن يُجْعلَ قولهُ :
( وكلبُك أرأفُ بالزائرين ... )
مثلاً نظيراً لقوله : مهزولُ الفصيلوإنْ كان الغرضُ منهما جميعاً الوصفَ بالقِرى والضيافة وكانا جميعاً كنايتين عن معنًى واحدٍ لأنَّ تعاقبَ الكناياتِ على المعنى الواحدِ لا يوجبُ تناسُبَها لأنه في عَروضٍ أن تتفقَ الأشعارُ الكثيرةٌ في كونها مدحاً بالشجاعة مثلاً أو الجُودِ أو ما أشبه ذلك . وقد يجتمعُ في البيت الواحد كنايتان المغزى منهما شيءٌ واحِدٌ
ثم لا تكونُ إحداهما في حُكْم النظيرِ للأُخرى . مثالُ ذلك أنه لا يكونُ قولهُ : جبانُ الكلب نظيراً لقوله : مهزولُ الفصيل بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصلٌ بنفسه وجنسٌ على حدة . وكذلك قول ابن هَرْمة - المنسرح - :
( لا أُمْتِع العُوذَ بالفِصال ولا ... أَبْتاعُ إلاّ قَريبَةَ الأَجَلِ )
ليس إحدى كنايتيهِ في حُكم النظيرِ للأخرى وإن كانَ المُكنى بهما عنه واحداً فاعرفْه
وليس لِشُعَبِ هذا الأصْلِ وفروعِه وأمثلَتِه وصُوَرِهِ وطُرِقه ومسالِكه حدٌّ ونهايةٌ . ومن لطيفِ ذلك ونَادِره قولُ أبي تمام - الوافر - :
أَبَيِّنَ فمَا يَزُرْنَ سِوى كَريمٍ ... وحَسْبُكَ أنْ يَزُرْنَ أبا سَعِيدِ )
ومثلُه وإن لم يبلغْ مبلَغَه قولُ الآخَرِ - الوافر - :
( مَتى تخلُو تميمٌ من كَريمٍ ... ومَسْلَمَةُ بنُ عَمرٍو مِنْ تَميمِ )
وكذلك قولُ بعض العرب - المتقارب - :
( إذا اللهُ لم يَسْقِ إلاَّ الكِرامَ ... فَسقَّى وُجُوهَ بني حَنْبَلِ )
( وسَقى ديارَهُمُ باكِراً ... مِنَ الغَيْثِ في الزَّمنِ المُمْحِلِ )
وفنٌّ منه غريبٌ قولُ بعضهم في البرامكة - الطويل - :
( سَألْتُ النَّدَى والجُودَ : ما لي أراكُما ... تَبدَّلتُما ذُلاَّ بِعِزٍّ مؤيَّدِ )
( وما بالُ رُكْنِ المَجْدِ أَمْسَى مُهدَّماً ... فَقالا : أصِبْنا بِابْنِ يَحْيُى محمّدِ )
( فقُلْتُ : فَهلاّ مُتُّما عِنْدَ موتِهِ ... فقَدْ كُنتما عَبْدَيْهِ في كُلِّ مَشْهدِ )
( فقالا : أَقَمْنا كي نُعَزَّى بفَقْدِه ... مَسافَةَ يَوْمٍ ثَمَّ نَتْلوهُ في غَدِ )
فصل في التوكيد وعلاماته
واعلمْ أنَّ ممَّا أغمضَ الطريقَ إِلى معرفَةِ ما نحنُ بصَددِه أن هاهنا فروقاً خفيَةً تَجْهلها العامَّةُ وكثيرٌ من الخاصة ليس أنهم يجهلونَها في موضعٍ ويعرفونَها في آخَرَ بل لا يدرون أنها هي ولا يعلمونَها في جملةٍ ولا تفصيلٍ . رُوي عن ابن الأَنباري أنه قال : رَكِبَ الكِنْدي المتفلسِفُ إلى أبي العباس وقال له : إني لأَجِدُ في كلامِ العرب حَشْواً : فقال له أبو العباس : في أيِّ موضعِ وجدتَ ذلك فقال : أَجِدُ العربَ يقولون : عبدُ الله قائمٌ . ثم يقولون : إنَّ عبد الله قائمٌ ثم يقولونَ : إن عبد اللهَ لقائمٌ فالألفاظ متكرِّرةٌ والمعنى واحدٌ . فقال أبو العباس : بل المعاني مختلِفةٌ لاختلافِ الألفاظِ فقولُهم : عبدُ الله قائمٌ إخبارٌ عن قيامه وقولُهم : إنَّ عبد الله قائمٌ جواٌب عن سؤالِ سائلٍ . وقولُهم : إنَّ عبدَ الله لقائمٌ جوابٌ عن إنكارِ منكِرٍ قيامَه فقد تكرَّرتِ الألفاظُ لتكرُّرِ المعاني . قال : فما أَحَارَ المتفلسفُ جواباً . وإِذا كان الكنديُّ يذهبُ هذا عليه حتى يركَبَ فيه ركوبَ مُستفهِمٍ أو معترِضٍ فما ظنُّك بالعامةِ ومَن هو في عِدادِ العامَّة ممن لا يخطُر شِبْهُ هذا بباله واعْلَمْ أن هاهُنا دقائقَ لو أنَّ الكنديَّ استقرأ وتصفَّحَ وتتبَّعَ مواقِعَ " إِنَّ : ثم أَلْطَفَ النظرَ وأكثر التدبُّرَ لَعَلِمَ عِلْمَ ضرورةٍ أنْ ليس سواءً دخولُها وأن لا تَدْخلَ . فأوَّلُ ذلك وأعجبُه ما قدَّمتُ لك ذكرَه في بيتِ بشارٍ :
( بَكِّرا صاحِبَيّ قبلَ الهَجيرِ ... إنَّ ذاكَ النَّجاحَ في التَّبْكير )
وما أنشدتُه معه من قولِ بعض العرب :
( فَغَنِّها وَهْيَ لكَ الفِداءُ ... إنّ غِناءَ الإِبلِ الحُداءُ )
وذلك أنه هَلْ شيءٌ أبْينُ في الفائِدة وأدلُّ على أنْ ليس سواءً دخولُها وأنْ لا تدخل من أنك ترى الجملةَ إذا هيَ دخلتْ ترتبطُ بما قبلها وتأتلفُ معه وتَتَّحدُ به . حتى كأنَّ الكلامين قد أُفرغا إفراغاً واحداً وكأنَّ أحدَهما قد سُبِك في الآخَرِ
هذه هي الصورةُ حتى إذا جئتَ إلى " إنَّ " فأسقطتَها رأيتَ الثاني منهما قد نَبا عن الأوَّل وتجافى معناه عن معناه ورأيتَه لا يتصلُ بهولا يكونُ منه بسبيل حتى تجيءَ بالفاء فتقول : بكِّرا صاحبَيّ قبل الهجير فذاكَ النجاحُ في التَّبكير وغنِّها وهي لك الفداءُ فغناءُ الإِبلِ الحُداءُ . ثم لا ترى الفاءَ تعيدُ الجملتين إلى ما كانتا عليه مِنَ الألفة ولا تردُّ عليك الذي كنت تجد ب " إنَّ " من المعنى
وهذا الضربُ كثيرٌ في التَّنزيلِ جدَّاً من ذلك قولُه تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظيمٌ ) وقولُه عزَّ اسمُه : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وأْمُرْ بالمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ المُنْكَرِ واصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) وقولُه سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) ومن أَبْينَ ذلك قولُه تعالى : ( ولا تُخَاطِبْنِي في الَّذينَ ظَلَمُوا إنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ ) وقد يتكَّررُ في الآيةِ الواحدةِ كقوله عزَ اسمُه : ( وما أُبَرِّىءَ نَفْسي إنَّ النفسَ لأَمَّارةٌ بالسُّوء إلاَّ ما رَحِمَ رَبّي إنَّ ربَّي غَفورٌ رَحيمٌ ) وهي على الجملةِ من الكَثْرةِ بحيثُ لا يدركُها الإِحصاءُ
ومن خصائِصِها أنك ترى لضميرِ الأمرِ والشأنِ معها منَ الحُسْنِ واللطفِ ما لا تراه إذا هي لم تدخلْ عليه بل تراه لا يصلحُ حيثُ صَلَحَ إلاّ بها وذلك في مثْلِ قولهِ تعالى : ( إنَّه مَنْ يَتَّقِ ويَصْبرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنينَ ) وقولِه : ( أنّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فأنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ ) وقولِه : ( أنَّه منْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ ) وقولِه : ( إنَّه لا يُفْلِحُ الكافِرُونَ ) . ومن ذلك قولُه : ( فإِنَّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ ) . وأجاز أبو الحَسنِ فيها وجهاً آخر وهو أن يكونَ الضميرُ في " إنها " للأَبصارِ أضْمِرتْ قبلَ الذكرِ على شريطةِ التفسير . والحاجةُ في هذا الوجهِ أيضاً إلى " إنَّ " قائمةٌ كما كانت في الوجهِ الأولِ فإِنه لا يُقالُ : هيَ لا تَعْمى الأبصار كما لا يُقالُ : هوَ من يَتَّقِ ويَصْبِرْ فإِنَّ الله لا يُضِيعُ . فإِن قلتَ : أو ليسَ قد جاء ضميرُ الأمر مبتدأً به مُعَرًّى منَ العوامِلِ في قولِهِ تعالى : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) قيل : وإنْ جاء هاهُنا فإِنه لا يكادُ يوجدُ مع الجملة منَ الشرط والجزاء بل تراهُ لا يجيءُ إلاّ ب " إنّ " . على أنهم قد أجازوا في ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) أن لا يكونَ الضميرُ للأمر
ومن لطيفِ ما جاء في هذا الباب ونادرِه ما تجدُه في آخِرِ هذه الأبياتِ التي أنشدَها الجاحظُ لبعضِ الحجازيين - الطويل - :
( إِذا طَمِعٌ يَوْماً عَراني قَرَيْتُه ... كتائِبَ يَأْسٍ كَرَّها وطِرادَها )
( أَكُدُّ ثِمادي والمياهُ كَثيرَةٌ ... أُعالِجُ مِنها حَفْرَها واكْتِدادَها )
( وأَرْضَى بها مِنْ بحرِ آخرَ إنّهُ ... هُوَ الرِّيُّ أن تَرْضَى النُّفوسُ ثِمادَها )
المقصودُ قولُه : إنه هو الريُّ وذلك أَن الهاءَ في " إنه " تحتَملُ أمرين : أحدُهُما أن تكون ضميرَ الأمْرِ ويكونَ قولُه " هو " ضمير " أن ترضى " وقد أَضْمِرَ قبل الذِّكْر على شريطةِ التفسير الأصل أن الأمر أن ترضى النفوس ثمادها الري ثم أضمر قبل الذكر كما أضمِرَتِ الأبصارُ في ( فإِنها لا تَعمى الأَبصارُ ) على مذهب أبي الحسنِ ثم أتى بالمضْمَرِ مصرَّحاً به في آخر الكلام فَعُلِمَ بذلك أن الضميرَ السابقَ له وأنه المرادُ به . والثاني أن تكون الهاء في " إنه " ضميرَ أن ترضى قبلَ الذكر ويكونَ " هو " فَصْلاً ويكونَ أصلُ الكلام : إنَّ أنْ ترضى النفوسُ ثِمادَها هو الرِّيُّ ثم أُضمِرَ على شريطةِ التفسير . وأيُّ الأمرين كان فإِنه لا بُدَّ فيه من " إنَّ " ولا سبيلَ إلى إسقاطِها لأنك إنْ أسقطتَها أفضَى ذلك بك إلى شيءٍ شنيعٍ وهو أن تقولَ : وأرضَى بها من بَحْر آخرَ وهو الريُّ أن ترضَى النفوسُ ثمادَها
هذا وفي " إنّ " هذه شيءٌ آخرُ يوجبُ الحاجةَ إليها وهو أنَّها تتولَّى من رَبْط الجملةِ بما قبلها نحواً مما ذكرتُ لك في بيتِ بشارٍ . ألا ترى أنك لو أسقطتَ " إن " والضميرين معاً واقتصرتَ على ذكرِ ما يَبقى من الكلامِ لم تَقُلْه إلا بالفاء كقولك : وأرضَى بها من بَحْرِ آخرَ فالريُّ أن ترضَى النفوسُ ثِمادَها . فلو أنّ الفيلسوفُ قد كان تتبَّعَ هذه المواضعَ لَما ظَنَّ الذي ظنَّ
هذا وإِذا كان خلفٌ الأحْمرُ وهو القُدوةُ ومَنْ يؤخذُ عنه ومَنْ هو بحيثُ يقولُ
الشِّعرُ فينحَلُه الفحولَ والجاهليين فيخفَى ذلك له . ويجوزُ أن يَشْتَبِهَ ما نحن فيه عليه حتى يَقعَ له أن يَنْتِقدَ على بشارٍ . فلا غروَ أن تدخُلَ الشُّبْهةُ في ذلك عَلَى الكندي
ومما تصنَعُه " إنَّ في الكلام أنَّك تَراها تُهيِّىءُ النكرةَ وتصلِحُها لأن يكون لها حكمُ المبتدأ أعني أن تكونَ مُحدَّثاً عنها بحديثٍ من بعدِها . ومثالُ ذلك قوله - مخلع البسيط - :
( إنَّ شِواءً ونَشْوَةً ... وخبَبَ البازلِ الأُمونِ )
قد تَرى حسنَها وصحَّة المعنى معها ثم إنّك إن جئتَ بها من غيرِ " إنَّ " فقلتَ :
( شِواءٌ ونشوةٌ وخببُ البازلِ الأمون ... )
لم يكن كلاماً . فإِنْ كانتِ النكرةُ موصوفةً وكانتْ لذلك تصلُحُ أن يُبتدأ بها فإنك تَراها مع " إنَّ " أحسنَ وترى المعنى حينئذٍ أَولى بالصِّحَّة وأمْكَنَ . أفلا ترى إلى قوله - الخفيف - :
( إنَّ دَهْراً يَلُفُّ شَمْلي بسُعْدى ... لَزَمانٌ يَهُمُّ بالإِحْسانِ )
ليس بخفيٍّ - وإن كانَ يستقيمُ أن تقولَ : دهرٌ يلفُّ شملي بِسُعْدَى دهرٌ صالحٌ : - أنْ ليس الحالان علىسواءٍ . وكذلك ليس يَخْفى أنك لو عَمدتَ إلى قوله - مشطور المديد - :
( إِنَّ أَمْراً فادِحاً ... عَن جَوابي شَغَلَكْ )
فأسقطتَ منه " إنّ لعَدمْتَ منه الحُسْنَ والطّلاوةَ والتمكُّنَ الذي أنت واجَدهُ الآن ووجدتَ ضعفاً وفتُوراً
ومن تأثيرِ " إنَّ " في الجملة أنها تُغْني إذا كانتْ فيها عن الخبرِ في بعضِ الكلام . ووضعَ صاحبُ الكتاب في ذلك باباً فقال : " هذا باب ما يحسنُ عليه السكوتُ في الأحرفِ الخمسةِ " لإِضمارك ما يكونُ مستقرّاً لها وموضعاً لو أضمرتهُ وليس هذا المضْمَرُ بنفسِ المُظهَرِ . وذلك " إنَّ مالاً وإن ولداً وإنَّ عدداً " أي : إن لهم مالاً . فالذي أضمرتَ هو " لهم " . ويقولُ الرجلُ للرجل : هل لكم أحدٌ إنَّ الناس أَلْبٌ عليكمْ فَيَقول : إنَّ زيداً وإنَّ عمراً أي لنا وقال - المنسرح - :
( إنَّ مَحَلاًّ وإنَّ مُرْتحلا ... وإِنَّ في السَّفْرِ إنْ مَضَوْا مَهَلا )
وتَقول : إنَّ غَيرَها إبلاّ وشاءَ كأنه قال : إن لنا أو عندنا غَيرها . قال : وانتصبَ الإِبلُ والشاءُ كانتصابِ الفارسِ إذا قلتَ : ما في الناسِ مثلُه فارساً . وقال : ومثلُ ذلك قوله من الرجز :
( يا لَيْتَ أيَّام الصِّبا رَوَاجِعا ... )
قال : فهذا كقولِهم : ألا ماءً بارداً : كأنه قال : ألا ماءً لنا بارداً : وكأنه قال : يا ليتَ أيامَ الصِّبا أقبلتْ رواجعَ
فقد أراك في هذا كلِّه أن الخَبرَ محذوفٌ . وقد ترى حُسْنَ الكلامِ وصحته مع حذفِه وتركِ النطق به . ثم إنَك إن عمدتَ إلى " إنَّ " فأسقطْتَها وجدتَ الذي كان حَسُنَ من حذفِ
الخبر لا يحسُنُ أو لا يسوغُ فلو قلتَ : مالٌ وعددٌ ومحٌل ومرتَحلٌ وغيرُها إبلاً وشاءً لم يكن شيئاً . وذلك أنَّ " إنَّ " كانت السببَ في أنْ حَسُنَ حذفُ الذي حُذِفَ من الخبرِ وأنها حاضِنَتُهُ والمترجِمُ عنه والمتكفِّلُ بشأنه
واعلمْ أنَّ الذي قلنا في " إنّ " من أنَّها تدخلُ على الجُملة من شأنها إذا هي أسقِطَتْ منها أن يُحْتَاجَ فيها إلى الفاءِ لا يطَّردُ في كلِّ شيءٍ وكلِّ موضِع بل يكونُ في موضِعٍ دونَ موضعٍ وفي حالٍ دونَ حالٍ . فإِنك قد تراها قد دخلتْ على الجملةِ ليستْ هي مما يَقْتضي الفاءَ . وذلك فيما لا يُحْصَى كقولهِ تعالى : ( إنَّ المُتَّقينَ في مَقامٍ أَمِينٍ . في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) وذاكَ أنَّ قبله ( إنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ) . ومعلومٌ أنك لو قُلتَ : إنّ هذا ما كنتُم به تَمْترون فالمُتَّقونَ في جناتٍ وعيونٍ لم يكن كلاما . وكذلك قولُه : ( إِنَّ الذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولئك عَنْها مُبْعَدُون ) لأنك لو قلت : ( لَهُمْ فيها زَفيرٌ وهُمْ فيها لا يَسْمعُون ) . فالذين سَبَقتْ لهم منَّا الحسنى لم تجدْ لإِدخالِك الفاء فيه وجهاً . وكذا قولُه : ( إِنَّ الذينَ آمَنُوا والذينَ هَادُوا والصّابِئينَ والنَّصارى والمَجُوسَ والذينَ أَشْرَكُوا إنّ الله يَفْصِلُ بينهُم يومَ القِيامةِ ) ( الذين آمنوا ) اسم إنَّ وما بعدَه معطوفٌ عليه وقولُه : ( إنَّ اللهَ يفصلُ بينهُم يومَ القيامةِ ) جملةٌ في موضعِ الخبرِ . ودخولُ الفاء فيها مُحالٌ لأنَّ الخَبر لا يُعْطَفُ على المبتدأ
ومثلُه سواءٌ ( إِنَّ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ إنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلاً ) فإِذًا إنما يكونُ الذي ذكرنا في الجملة من حديثِ اقتضاءِ الفاءِ إذا كان مصدرُها مصدَرَ الكلام يُصَحَّحُ به ما قبلَه ويُحْتَجُّ له ويُبَيَّنُ وجهُ الفائدة فيه . ألا ترى أنَّ الغرضَ من قوله : إنَّ ذاكَ النجاحَ في التكبيرِ جلُّه أن يبيِّن المعنى في قوله لصاحبيه " بكِّرَا " وأن يحتجَّ لنفسه في الأَمرِ بالتبكير ويبينَ وجهَ الفائدةِ فيه وكذلكَ الحكمُ في الآي التي تَلوْناها فقولُه : ( إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظيمٌ ) بيانٌ لمعنى في قوله تعالى : ( يا أَيُّها النَّاسُ اتَّقُوْا
رَبَّكُمْ ) ولِمَ أُمِرُوا بأَنْ يَتَّقُوا وكذلك قولُه : ( إنّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ ) . بيانٌ للمعنى في أمرِ النبي بالصلاة أي بالدُّعاء لهم . ولهذا سبيلُ كلِّ ما أنتَ ترى فيه الجملةَ يُحتاجُ فيها إلى الفاء . فاعرفْ ذلك
فأما الذي ذُكِرَ عن أبي العباس مِن جَعْلِهِ لها جوابَ سائلٍ إذا كانتْ وحدَها . وجوابَ مُنكِرٍ إذا كان معها اللامُ . فالذي يدلُّ على أنَّ لها أصلاً في الجوابِ أنَّا رأيناهم قد ألزَموها الجملةَ من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً للقَسمِ نحو : واللهِ إنَّ زيداً منطلقٌ . وامتنعوا من أن يقولوا : واللهِ زيدٌ منطِلقٌ . ثم إنّا إذا اسْتَقرينا الكَلامَ وجدنا الأَمْرَ بيِّنًا في الكثير من مواقِعها أنه يقصدُ بها إلى الجوابِ كقولهِ تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً . إِنَّا مَكَّنّا لَهُ في الأَرْضِ ) وكقولِه عزَّ وجلَّ في أَوَّلِ السورة : ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبأَهُمْ بالحَقِّ إنّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهم ) وكقوله تعالى : ( فإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إنّي بَرِىءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ) وقولِه تعالى : ( قُلْ إنّي نُهيْتُ أنْ أَعْبُدَ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله ) وقولِهِ : ( وَقلْ إنّي أَنا النَّذيرُ المُبِينُ ) وأشباهِ ذلك مما يُعلمُ به أنه كلامٌ أُمِرَ النبيُّ بأن يجيبُ به الكفارَ في بعضِ ما جادلوا وناظَروا فيه . وعلى ذلكَ قولُه تعالى : ( فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ) وذاك أنَّه يعلَمُ أنَّ المعنى : فأْتياهُ فإِذا قالَ لَكُما ما شأْنُكما وما جاءَ بكما وما تقولان فقولا : إنَّا رسولُ ربِّ العالمينَ . وكذا قولُه : ( وقَالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ) هذا سبيلُه
ومَنِ البِّينِ في ذلك قولُه تعالى في قِصَّةِ السَّحَرةِ : ( قَالُوا إنّا إلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ) . وذاك لأنه عَيَانٌ أنه جوابُ فرعونَ عن قولِهِ : ( آمنتُم له قبلَ أنْ آذَنَ لكم ) فهذا هو وَجْهُ القولِ في نُصْرةِ هذه الحكاية
ثم إنَّ الأَصْلَ الذي ينبغي أن يكونَ عليه البناءُ هو الذي دُوِّنَ في الكتبِ من أنها للتأكيدِ . وإذا كانَ قد ثَبتَ ذلك فإِذا كان الخبرُ بأمرٍ ليس للمخاطب ظنٌّ في خِلافهِ البتَّةَ ولا يكونُ قد عَقَد في نفسِهِ أن الذي تزعمُ أنَّه كائنٌ غيرُ كائنٍ وأنَّ الذي تزعمُ أنه لم يكنْ كائِنٌ فأنتَ لا تحتاجُ هناك إلى " إنّ " وإنما تحتاجُ إليها إذا كاَن له ظنٌّ في الخلافِ وعَقْدُ قلبٍ على نفيِ ما تُثْبِتُ أو إثباتِ ما تَنْفي . ولذلك تراها تزدادُ حسناً إذا كان الخبرُ بأمرٍ يَبْعُدُ مثلُه في الظنِّ وبشيءٍ قد جرتْ عادةُ الناس بخلافهِ كقول أبي نُوَاس - السريع - :
( إِنَّ غِنى نَفْسِكَ في اليَاسِ ... )
فقد ترى حسنَ موقعها وكيف قبولُ النفسِ لها وليسَ ذلك إلاّ لأنَّ الغالبَ على الناس أنهم لا يَحمِلون أنفسَهم على اليأس ولا يَدَعونَ الرجاءَ والطَّمعَ ولا يعترفُ كلُّ أحد ولا يَسلِّم أنَّ الغنى في اليأس . فلما كان كذلك كان الموضعُ موضعَ إلى التأكيدِ فلذلك كان من حُسنِها ما ترى . ومثلُه سواءٌ قولُ محمدِ بنِ وُهَيبٍ - الطويل - :
( أجَارتَنا إنَّ التَّعَفُّفَ باليَاسِ ... وصَبْراً على اسْتِدْرارِ دُنْيا بإِبساسِ )
( حَرِيَّانِ أنْ لا يَقْذِفا بمَدلَّةٍ ... كَريماً وأنْ لا يُحوِجاهُ إلى النّاسِ )
( أجارَتَنا إنَّ القِدَاحَ كَواذِبٌ ... وأكْثَرُ أَسْبابِ النّجاحِ معَ الياسِ )
هو كما لا يَخْفَى كلامٌ مع مَن لا يرى أن الأمْرَ كما قال بل ينكِرُه ويعتقدُ خلافَه . ومعلومٌ أنه لم يقلْه إلاَّ والمرأةُ تحدُوه وتبعَثُه على التعرُّضِ للناس وعلى الطلب
ومن لطيفِ مواقِعها أنْ يُدَّعى على المخاطَبِ ظنٌّ لم يظنَّه ولكنْ يرادُ التهكُّمُ به وأنْ يُقالَ : إنّ حالَك والذي صنعتَ يقتضي أن تكونَ قد ظَنَنْتَ ذلكَ . ومثالُ ذلكَ قولُ الأوَّل - السريع - :
( جاءَ شقيقٌ عارضاً رُمْحَهُ ... إنَّ بَني عمِّك فيهِمْ رماحْ )
يقولُ : إنَّ مجيئَه هكذا مُدلاًّ بنفسِه وبشجاعتِه قد وَضَع رمحَه عرضاً دليلٌ على إعجابٍ شديدٍ وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقومُ له أحدٌ حتى كأنْ ليس مع أحدٍ منَّا رمحٌ يدفعهُ به وكأنا كلَّنا عُزْلٌ . وإِذا كان كذِلكَ وَجَبَ - إذا قيلَ أنَّها جواب سائل - أن يشترط فيه أن يكونَ للسائلِ ظنٌّ في المسؤول عنه على خلافِ ما أنتَ تجيبُه به فأمَّا أن يُجْعَلَ مجرَّدُ الجوابِ أصلاً فيه فلا لأنه يؤدِّي أنْ لا يستقيمَ لنا إذا قال الرجلُ : كيفَ زيد أن تقولَ : صالحٌ . وإِذا قال : أينَ هو أن تقول : في الدار . وأن لا يصحَّ حتّى تقولَ : إنه صالح وإنه في الدار . وذلك ما لا يقولُه أحدٌ . وأما جعلُها إذا جُمعَ بينها وبين اللام نحو : إنَّ عبدَ الله لقائم للكلامِ مع المُنكرِ فجَيّدٌ لأنَّه إذا كان الكلامُ مع المنكرِ كانت الحَاجَةُ إلى التأكيدِ أشدَّ وذلك أنك أحوَجُ ما تكونُ إلى الزيادة في تثبيت خَبركِ إذا كانَ هناك من يَدفعُه وينكرُ صحَّتَه . إلاّ أنه ينبغي أن يُعْلَمَ أنه كما يكون للإِنكار قد كانَ من السامع فإِنه يكون للإِنكارِ أو يُرى أن يكونُ من السامعين . وجملةُ الأمر أنك لا تقولُ : إنَّه لكذلك حتى تريدَ أن تضعَ كلامَك وضعَ من يَزع فيه عن الإِنكار
واعلمْ أنها قد تدخلُ للدَّلالة على أن الظنَّ قد كان منك أيُّها المتكلمُ في الذي كان إنه لا يكونُ . وذلك قولُك للشيء : هو مرأًى من المخاطَبِ ومسمعٍ إنه كان من الأمرِ ما ترى وكان مني إلى فلانٍ إحسانٌ ومعروفٌ ثم إنه جعلَ جزائي ما رأيتَ . فتجعلُك كأنك تَرُدُّ على نفسِك ظنَّك الذي ظننتَ وتبيِّنُ الخطأ الذي توهَّمت . وعلى ذلك واللهُ أعلمُ قولُه تعالى حكايةً عن أمِّ مريم رضي الله عنها : ( قَالَتْ رَبِّ إنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثى واللهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعَت ) وكذلك قولُه عزَّ وجلَّ حكايةً عن نوحٍ عليه السلام : ( قالَ ربِّ إنَّ قومي كَذَّبونِ ) . وليس الذي يعرِضُ بسببِ هذا الحَرْفِ من الدقائق وَالأمور الخفيَّة يُدْرَك بالهُوَينا ونحن نقتَصرُ الآن على ما ذكرنا ونأخذُ في القولِ عليها إذا اتصلتْ بها ما
فصل في مسائل إنما
قال الشيخُ أبو علي في الشيرازياتِ : يقولُ ناسٌ من النَّحْويين في نحوِ قولهِ تعالى : ( قُلْ إنما حَرَّمَ ربِّي الفواحشَ ما ظهَرَ منها وما بَطَنَ ) : إنَّ المعنى : ما حَرَّمَ ربي إلا الفواحشَ . قال وأصبتُ ما يدلُّ على صحَّةِ قولِهم في هذا وهو قوُل الفرزدق - الطويل - :( أَنَا الذّائدُ الحامي الذِّمَارَ وإنَّما ... يُدافِعُ عَنْ أحْسابِهِمْ أَنا أَوْ مِثْلي )
فليس يَخْلُو هذا الكلامُ من أن يكونَ موجَباً أو مَنفياً . فلو كان المرادُ به الإِيجابُ لم يستقمْ . ألا ترى أنك لا تقولُ : يدافعُ أنا ولا يقاتلُ أنا وإنَّما تقول : أدافعُ وأقاتلُ . ألاَّ أنَّ المعنى لما كانَ : ما يدافعُ إلا أنا فَصَلْتَ الضميرَ كما تفصِلهُ مَع النفي إذا ألحقْتَ معه إلاّ حملاً على المعنى . وقال أبو إسحاقَ الزجَّاجُ في قولِه تعالى : ( إنَّمَا حرَّمَ عليكُم المَيْتَةَ
والدَّمَ ) النصبُ في الميتة هو القراءة ويجوزُ : إنما حُرِّم عليكم . قال أبو إسحاقَ والذي أختارُه أن تكونَ ما هي التي تمنعُ إنَّ مَن العمل ويكونَ المعنى : ما حُرِّم عليكم إلا الميتةُ لأن إنما تأتي إثباتاً لما يُذْكَرُ بعدَها ونفياً لما سواهُ وقولِ الشاعر :
( وإنّما يُدافِعُ عَنْ أَحسابِهمْ أَنا أَوْ مِثْلي ... )
المعنى : ما يدافِعُ عن أحسابِهم إلاّ أنا أو مثلي . انتهى أبي كلامُ أبي علي
اعلمْ أنَّهم وإنْ كانوا قَدْ قَالوا : هذا الذي كَتْبتُه لك فإنَّهم لم يَعْنُوا بذلك أن المعنى في هذا هُوَ المعنى في ذلكَ بعينِه وأنَّ سبيلَهُما سبيلُ اللفظين يُوضعان لمعنًى واحدٍ . وفرقٌ بينَ أنْ يكونَ في الشيءِ معنَى الشيءِ وبينَ أن يكونَ الشيءُ للشيءِ على الإطلاق . يُبيِّنُ لك أنَّهما لا يكونان سواءً أنه ليس كلُّ كلامٍ يصلحُ فيه ما وإلا يصلحُ فيه إنما . ألا تَرى أنها لا تصلحُ في مثلِ قولِه تعالى : ( ومَا مِنْ إِلهٍ إلاَّ اللّهُ ) ولا في نحوِ قولِنا : ما أحدٌ إلاَّ وهو يقولُ ذاك . إذ لو قلتَ : إنَّما مِنْ إلهٍ اللّهُ وإنَّما أحَدٌُ وهو يقولُ ذاك قلتَ ما لا يكونُ له معنًى . فإِنْ قلتَ : إنَّ سببَ ذلك أن أحداً لا يقعُ إلاَّ في النفيِ وما يَجْري مَجْرى النفي من النَهْي والاستفهام وأنَّ مِن المَزيدةَ في ما مِنْ إلهٍ إلاّ اللهُ كذلكَ لا تكونُ إلاّ في النفي . قيلَ : ففي هذا كفايةٌ بأنه اعترافٌ بأنْ ليسا سواءً لأنهما لو كانا سواءً لكانَ ينبغي أن يكونَ في إِنما منَ النفي مثلُ ما يكونُ في ما وإلاّ . وكما وجدتَ إنما لا تصلحُ فيما ذكرنا تجدُ ما وإلاّ لا تصلحُ في ضربٍ من الكلام قد صلُحَت فيه إنما وذلكَ في مثلِ قولكَ : إنَّما هو دِرهمٌ لا ينارٌ . لو قلتَ : ما هو إلاَّ دِرهمٌ لا دينار لم يكن شيئاً . وإذ قد بانَ بهذه الجملةِ
أنَّهم حينَ جعلوا إنّما في معنى ما وإلا لم يَعْنوا أنَّ المعنى فيهما واحدٌ على الإطلاق وأن يسِقطوا الفرقَ فإني أبيِّنُ لك أمَرها وما هو أصلٌ في كلِّ واحدٍ منهما بعونِ الله وتوفيِقه
اعلمْ أنَّ موضوعَ إنما على أن تجيءَ لخبرٍ لا يجهلهُ المخاطَب ولا يدفَعُ صحَّتَه أو لما ينزَّل هذه المنزلة . تفسيرُ ذلك أنك تقولُ للرجل : إنّما هو أخوكَ وإنما هُوَ صاحُبك القديمُ لا تقولُه لمن يجهلُ ذلك ويدفُع صحتَه ولكن لمن يعلَمُه ويُقرُّ به . إلاَّ أنَّك تريدُ أن تنبهَهُ للذي يجبُ عليه من حقِّ الأخِ وحرمِة الصاحِب . ومثُله قولُ الآخَرِ - الخفيف - :
( إنَّما أَنْتَ والِدٌ والأَبُ ... القاطِعُ أَحْنَى مِنْ واصِلِ الأوْلادِ )
لم يُردْ أن يُعْلم كافوراً أنه والدٌ ولا ذاك مما يحتاجُ كافورٌ فيه إلى الإِعلام ولكنه أراد أن يذَكِّرَه بالأمِر المعلوم لينبنيَ عليه استدعاءُ ما يوجُبه كونُه بمنزلة الوالدِ . ومثلُ ذلك قولُهم : إنّما يعجلُ مَنْ يَخْشَى الفَوْتَ . وذلك أنَّ منَ المعلومِ الثابتِ في النفوسِ أن مَنْ لم يخشَ الفوتَ لم يَعْجَلْ . ومثالُه منَ التنزيلِ قولُه تعالى : ( إنَّما يستجيبُ الذينَ يَسْمَعونَ ) وقولُه تعالى ( إنما تُنذِرُ مَنِ اتَّبعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بالغيبِ ) وقولُه تعالى : ( إنَّما أنتَ مُنذِرُ مَنْ يخشاها ) . كلُّ ذلكَ تذكيرٌ بأمْرٍ ثابتٍ معلوم . وذلك أنَّ كلَّ عاقلٍ يَعْلَمُ أنه لا تكونُ استجابةٌ إلاّ ممَّن يسمعُ ويَعقِلُ ما يقالُ له ويُدْعى إليه . وأنَّ مَنْ لم يسمعْ ولم يَعْقِلْ لم يستَجِبْ . وكذلك معلومٌ أَنَّ الإِنذارَ إنما يكونُ إنذاراً ويكونُ له تأثيرٌ إذا كان معَ مَنْ يؤمنُ بالله ويخشاه ويُصَدِّقُ بالبعثِ والساعِة . فأما الكافُر الجاهلُ فالإنذارُ معه واحدٌ . فهذا مثالُ ما الخبِر فيه خبرٌ بأمرٍ يعلَمُهُ المخاطَبُ ولا ينكِرهُ بحالٍ
وأمَّا مثالُ ما ينزَّلُ هذه المنزلةَ فكقولِه - الخفيف - :
( إنما مُصْعَبٌ شِهابٌ مِنَ الله ... تَجلَّتْ عن وَجْهِهِ الظَّلْماءُ )
ادَّعى في كونِ الممدوحِ بهذه الصفةِ أنه أَمْرٌ ظاهرٌ معلومٌ للجميع على عادةِ الشعراءِ إذا مَدَحوا أن يدَّعوا في الأوصاف التي يذكرونَ بها الممدوحِينَ أنها ثابتةٌ لهم وأنَّهم قد شُهروا بها وأنهم لم يَصِفوا إلاّ بالمعلومِ الظاهرِ الذي لا يدفعُه أحدٌ كما قال :
( وتَعْذُلُني أَفْناءُ سَعْدٍ عَلَيْهِمُ ... وَمَا قُلْت إلاّ بالذَّي عَلِمَتْ سَعْدُ )
وكما قال البحتري :
( لا أدَّعي لأبي العَلاءِ فَضيلَةً ... حَتَّى يُسَلِّمَها إلَيْهِ عِداهُ )
ومثلُه قولُهم : إنما هو أسدٌ وإنما هو نارٌ وإنما هو سيفٌ صارمٌ . إذا أدخلوا إنما جَعلوا في حكمِ الظاهرِ المعلومِ الذي لا يُنْكَر ولا يدْفَعُ ولا يَخْفَى
وأما الخبرُ بالنَّفي والإِثباتِ نحو ما هذا إلاَّ كذا وإنْ هو إلاّ كذا فيكونُ للأمرِ يُنْكِرهُ المخاطَب ويشكّ فيه . فإذا قلتَ : ما هو إلاّ مصيبٌ أو : ما هو إلاّ مُخطىءٌ قلتَه لمن يدفَعُ أن يكونَ الأمْرُ على ما قلتَه . وإذا رأيتَ شخصاً مِنْ بعيد فقلتَ : ما هو إلاّ زيدٌ لم تقله إلاّ وصاحبُك يتوهّم أنه ليس بزيدٍ وأنه إنسانٌ آخرُ ويجدُّ في الإِنكارِ أن يكونَ زيداً . وإذا كان الأمْرُ ظاهراً كالذي مَضى لم تقلْه كذلك فلا تقولُ للرجل ترقِّقه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه منْ صِلَةِ الرَّحِمِ ومنْ حُسْنِ التَّحابِّ : ما هُوَ إلاّ أخوك . وكذلك لا يصلُحُ في : إنما أنتَ والدٌ ما أنتَ إلاَّ والدٌ . فأما نحوُ : إنما مُصْعَب شهابٌ فيصلُح فيه أن تقولَ : ما مُصْعَبٌ إلاّ شهابٌ . لأنَّه ليس من المعلومِ على الصِّحة وإنما ادَّعى الشاعرُ فيه أنه كذلك . وإذا كانَ هذا هكذا جازَ أن تقولَه بالنفي والإثباتِ . إلاّ أنك تخرِجُ المدحَ حينئذٍ عن أن يكونَ على حدِّ المبالغةِ من حيثُ لا تكونُ قد ادَّعيتَ فيه أنه معلومٌ وأنه بحيثُ لا ينكِرهُ منكِرٌ ولا يخالِفُ فيه مخالِفٌ
قولهُ تعالى : ( إنْ أنتُمْ إلاّ بَشَرٌ مِثلُنا تُريدونَ أن تَصَدُّونا عمّا كانَ يعبدُ آباؤنا ) . إنما جَاء - واللهُ أعلمُ - بإِنْ وإِلاّ دونَ إنَّما فلم يَقُلْ : إنما أنتم بشرٌ مثلُنا لأنهم جعلوا الرسلَ كأنهم بادِّعائهم النبوَّةَ قد أَخرجوا أنفسَهم عن أن يكونوا بشراً مثلَهم وادَّعَوا أمراً لا يجوزُ أنْ يكونَ لِمنْ هو بشرٌ
ولما كان الأمرُ كذلك أخرجَ اللفظَ مُخْرجَه حيث يُرادُ إثباتُ أمرٍ يدفعُه المخاطَبُ ويدَّعي خلافَه . ثم جاء الجوابُ منَ الرسُل الذي هو قولُه تعالى : ( قالتْ لهُم رسُلُهم إنْ نحنُ إلا بشَرٌ مثلُكُم ) كذلك بإِنْ وإلاّ دون إنَّما لأنَّ من حُكْم مَن ادَّعى عليه خصمُه الخلافَ في أَمْرٍ هو لا يخالِفُ فيه أن يعيدَ كلامَ الخصمِ على وجههِ ويجيءَ به على هيئتِه ويحكيهِ كما هو . فإِذا قلتَ للرجلِ : أنتَ من شأنِك كيتَ وكيتَ . قال : نَعَمْ أنا مِنْ شأني كَيْتَ وكيتَ ولكن لا ضَيْرَ عَلَيَّ ولا يلزمُني من أجْل ذلك ما ظَننْتَ أنه يلزمُ . فالرسلُ صلواتُ الله عليهم كأنهم قالوا : إنَّ ما قلتُم من أنّا بشرٌ مثلُكم كما قلتم : لسنا ننكِرُ ذلك ولا نجهلهُ ولكن ذلك لا يمنعُنَا من أن يكونَ اللهُ تعالى قَدْ منَّ علينا وأكرمَنا بالرسالة . وأما قولُه تعالى : ( قُلْ إنَّما أنا بَشَرٌ مثلُكُم ) . فجاء بإنما لأنَّه ابتداءُ كلام قد أمِرَ النبيُّ بأنْ يُبلِّغَه إياهم ويقولَه معَهُم وليس هو جواباً لكلامٍ سابقٍ قد قِيلَ فيه : إن أنتَ إلاَّ بشرٌ مثلُنا . فيجبُ أن يؤتَى به على وفقِ ذلك الكلامِ ويُراعَى فيه حَذوُه كما كانَ ذلك في الآيةِ الأولى
وجملةُ الأمْرِ أنك متى رأيتَ شيئاً هُوَ منَ المعلومِ الذي لا يُشَكُّ فيه قد جاء بالنَّفي فذلك لتقديرِ معنًى صار به في حُكْم المشكوكِ فيه . فَمِنْ ذلك قولُه تعالى : ( وما أنتَ بمُسْمِعٍ مَنْ في القُبورِ إنْ أنتَ إلاَّ نذيرٌ ) إنما جاء والله أعلم بالنفي والإِثبات لأنه لما قال تعالى : ( وما أنتَ بمُسمعٍ مَنْ في القبور ) . وكان المعنى في ذلك أن يقالَ للنبيِّ : إنك
لن تستطيعَ أن تحوِّلَ قلوبَهُم عمَّا هي عليه من الإِباء ولا تملِكُ أن تُوقعَ الإِيمانَ في نفوسِهم مع إصرارِهم على كُفْرهم واستمرارِهم على جَهْلِهم وصدِّهم بأسْماعِهم عما تقولُه لهم وتتلوه عليهم . كان اللائقُ بهذا أن يُجعَلَ حالُ النبيِّ حالَ مَن قد ظَنَّ أنه يَمْلكُ ذلكَ ومَنْ لا يَعْلَمُ يقينا أنه ليس في وُسْعِه شيءٌ أكثرُ من أن ينذِرَ ويحذِّر . فأخرجَ اللفظ مُخْرَجَه إذا كان الخطابُ مع مَنْ يَشُكُّ فقلَ : ( إنْ أنتَ إلا نذيرٌ ) ويبينُ ذلك أنك تقول للرجل يطيلُ مناظرةَ الجاهل ومُقاولَته : إنك لا تستطيعُ أن تُسمعَ الميِّتَ وأن تُفهمَ الجمادَ وأن تُحوِّل الأعمى بصيرا وليس بيدك إلا أن تُبَيِّنَ وتحتجَّ ولستَ تملكُ أكثرَ من ذلك لا تقولُ هاهُنا : فإنَّما الذي بيدك أن تُبَيِّنَ وتحتجَّ . ذلك لأنك لم تَقُلْ له : إنك لا تستطيع أن تُسمِعَ الميِّتَ حتى جعلتَه بمثابَةِ مَن يظنُّ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيانِ شيئاً . وهذا واضحٌ فاعرفْه . ومثلُ هذا في أنَّ الذي تقدَّم منَ الكلام اقتضى أن يكونَ اللفظُ كالذي تراهُ من كونِه بإن وإلا قولُه تعالى : ( قُلْ لا أملِكُ لنفسي نَفْعاً ولا ضَراًّ إلا ما شاءَ اللهُ ولو كنتُ أعلمُ الغيبَ لاستكثَرْتُ منَ الخيرِ وما مَسَّنيَ السُّوءُ إنْ أنا إلاَّ نذيرٌ وبشيرٌ لقومٍ يؤمنون )
فصل هذا بيان آخرُ في " إنما "
اعلمْ أنها تفيدُ في الكلام بعدَها إيجابَ الفعل لشيءٍ ونفيَه عن غيرِه . فإذا قلتَ : إنما جاءني زيدٌ عُقِلَ منه أنك أردتَ أن تنفيَ أن يكونَ الجائي غيرَه . فمعنى الكلامِ معها شبيهٌ بالمعنى في قولِك : جاءني زيدٌ لا عمرٌو إلا أنَّ لَهَا مَزيّةً وهي أنك تعقِلُ معها إيجابَ الفعل لشيءٍ ونفيَه عن غيرِه دفعةً واحدة وفي حالٍ واحدةٍ . وليس كذلك الأمرُ في : جاءني زيدٌ لا عمرٌو . فإنَّك تعقِلُهما في حالين . ومزيّةً ثانيةً وهي أنها تجعلُ الأمرَ ظاهراً في أن الجائي زيدٌ ولا يكونُ هذا الظهورُ إذا جعلتَ الكلامَ بلا فقلتَ : جاءني زيدٌ لا عمرُو
ثم اعلمْ أن قولَنا في " لا " العاطفة : إنها تَنفي عن الثاني ما وجبَ للأوَّل ليس المرادُ به أنها تنفي عن الثاني أنْ يكون قد شارك الأولَ في الفعل بل إنها تنفي أن يكونَ الفعلُ الذي قلتَ إنه كانَ من الأول قد كان مِنَ الثاني دونَ الأول . ألاَ ترى أنْ ليس المعنى
في قولك : جاءني زيدٌ لا عمروٌ أنه لم يكن مِنْ عمرٍو مجيءٌ إليك مثلَ ما كانَ من زيدٍ حتى كأنه عكسُ قولِكَ : جاءني زيدٌ وعمرٌو . بل المعنى أن الجائي هو زيدٌ لا عمرٌو فهو كلامٌ تقوله مع مَنْ يغلَطُ في الفعل قد كانَ مِنْ هذا فيتوهَّم أنه كان من ذلك . والنكتةُ أنه لا شُبهةَ في أنْ ليس ها هنا جائيان وأنه ليس إلا جاءٍ واحدٌ وإنما الشُّبهةُ في أنَّ ذلك الجائي زيدٌ أم عمرٌو . فأنتَ تحقِّق على المخاطَب بقولِك : جاءني زيدٌ لا عمرٌو أنه زيدٌ وليس بعمرٍو . ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول : جاءني زيدٌ لا عمرٌو حتى يكونَ قد بلغَ المخاطَبَ أنه كان مجيءٌ إليك من جاءٍ . إلاّ أنه ظنَّ أنه كان من عمرٍو فأعلمتُه أنه لم يكن من عمرٍو ولكنْ من زيد
وإذْ قد عرفتَ هذه المعاني في الكلام ب " لا " العاطفةِ فاعلمْ أنها بجملتها قائمةٌ لك في الكلام بإنما فإذا قلتَ : إنما جاءَني زيدٌ . لم يكن غرضُك أنْ تنفيَ أن يكونَ قد جاء مع زيدٍ غيرُه ولكن أن تنفيَ أن يكونَ المجيءُ الذي قلتَ إنه كانَ منه كان من عمرٍو . وكذلك تكونُ الشبهةُ مرتفعةً في أن ليس هاهنا جائيان وأن ليسَ إلاّ جاءٍ واحدٌ . وإنما تكونُ الشبهةُ في أنَّ ذلك الجائي زيدٌ أم عمرٌو . فإذا قلتَ : إنما جاءني زيدٌ . حتى يكونَ قد بَلَغ المخاطَبَ أن قدْ جاءَك جاءٍ ولكنه ظنَّ أنه عمرُو مثلاً فأعلمتَهُ أنه زيد . فإنْ قلتَ : فإنه قد يصحُّ أن تقولَ : إنَما جاءَني مِنْ بين القومِ زيدٌ وحدَه وإنما أتاني من جملتِهم عمرٌو فقط . فإنّ ذلك شيءٌ كالتَكلُّفِ والكلامُ هُوَ الأوَّل . ثم الاعتبارُ به إذا أُطلِقَ فلم يقيَّد ب " وحدَه " وما في معناه . ومعلومٌ أنك إذا قلتَ : إنما جاءَني زيدٌ ولم تَزِد على ذلك أنه لا يَسْبِقُ إلى القلبِ من المعنى إلاّ ما قَدَّمنا شرحَه من أنك أردتَ النصَّ على زَيْدٍ أنه الجائي وأن تُبْطِلَ ظنَّ المخاطَب أن المجيءَ لم يَكُنْ منه ولكن كان من عمرٍو حَسْبَ ما يكونُ إذا قلتَ : جاءني زيدٌ لا عمرٌو فاعرفْه
وإذ قَدْ عرفتَ هذه الجملةَ فإنا نذكُر جملةً منَ القولِ في ما وإلاّ وما يكونُ من حكمِهما
اعلم أنك إذا قلتَ : ما جاءني إلاّ زيدٌ احتَمَلَ أمرين أحدُهما : أن تريدَ اختصاصَ زيدٍ بالمجيءِ وأن تنفيَه عمَّنْ عَداه . وأن يكون كلاماً تقولهُ لا لأنَّ بالمخاطَبِ حاجةً إلى أن تعْلَمَ أنَّ زيداً قد جاءَك ولكِنْ لأنَّ به حاجةً إلى أن يَعْلَمَ أنه لم يجئْ إليكَ غيرُه . والثاني : أن تريدَ الذي ذكرناهُ في " إنما " ويكونُ كلاماً تقولُه ليُعْلَمَ أن الجائي زيدٌ لا غيرُه . فمن ذلك قولُكَ للرجلِ يدَّعي أنك قلتَ قولاً ثم قلتَ خلافَه : ما قُلتَ اليومَ إلاّ ما قلتَه أمسِ بعينِه
ويقولُ : لم تَرَ زيداً وإنما رأيتَ فلاناً . فتقولُ : بل لم أرَ إلاّ زيداً . وعلى ذلك قولُه تعالى : ( ما قلتُ لهم إلاّ ما أمرْتَني به أنِ اعبُدُوا اللهَ رَبِّي وربَّكُم ) لأنه ليس المعنى أني لم أَزِدْ على ما أمرتَني به شيئاً ولكنَّ المعنى أني لم أدعْ ما أمرتَني به أن أقولَه لهم وقلتُ خلافَه . ومثالُ ما جاء في الشعرِ من ذلك قولُه - السريع - :
( قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وجَارَاتُها ... ما قَطَّرَ الفَارِسَ إلاّ أَنا )
المعنى : أنا الذي قطَّر الفارسَ وليسَ المعنى على أنَّه يريدُ أن يَزْعُم أنَّه انفردَ بأنْ قطَّره وأنَّه لم يَشْرَكْه فيه غيرُه
وهاهُنا كلامٌ ينبغي أن تَعْلَمَه إلاّ أني أكتبُ لكَ مِنْ قبلهِ مسألةً لأن فيها عوناً عليه . قولهُ تعالى : ( إنما يخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ) في تقديم اسمِ الله عزَّ وجلَّ معنًى خلافُ ما يكونُ لو أُخِّر . وإنما يبيِّنُ لكَ ذلكَ إذا اعتبرتَ الحكمَ في " ما " و " إلا " وحصَّلْتَ الفرقَ بينَ أن تقولَ : ما ضربَ زيدا إلاّ عمرٌو وبينَ قولِك : ما ضربَ عمرٌو إلاّ زيداً . والفرقُ بينهما أنك إذا قلتَ : ما ضربَ زيداً إلاّ عمرٌو فقدَّمْتَ المنصوبَ كان الغرضُ بيانَ الضَّاربِ مَنْ هو والإخبارَ بأنَّه عمرو خاصة دون غيره وإذا قلت ما ضرب عمرو إلا زيداً فقدمت المرفوع كان الغرض بيان المضروب من هو والإخبار بأنه زيدٌ خاصَّةً دونَ غيره
وإذ قد عرفتَ ذلكَ فاعتبرْ بهِ الآيةَ . وإذا اعتبرتَها به علمتَ أنَّ تقديمَ اسمِ الله تعالى إنما كانَ لأجْلِ أن الغَرَضَ أن يُبَيَّنَ الخاشُونَ مَنْ هُمْ ويخبرَ بأنهم العلماءُ خاصَّةً دونَ غيرهم . ولو أخِّر ذكرُ اسمِ الله وقدَّم العلماءُ فقيلَ : إنَّما يخشى العلماءُ اللهَ لصارَ المعنى على ضِدِّ ما هو عليه الآن ولصارَ الغرضُ بيانَ المخشِيٍِّ مَنْ هو والإِخبارَ بأنّه اللهُ تعالى دونَ غيره . ولم يَجِبْ حينئذٍ أن تكونَ الخشيةُ مِنَ الله تعالى مقصورةً على العلماءِ وأن
يكونوا مخصوصينَ بها كما هو الغرضُ في الآية . بل كان يكونُ المعنى أنّ غيرَ العلماء يخشون اللهَ تعالى أيضاً إلاّ أنهم مع خشيتِهم اللهَ تعالى يخشَوْن معه غيرَه والعلماءُ لا يخشون غيرَ الله تعالى . وهذا المعنى وإن كانَ قد جاءَ في التنزيلِ في غيرِ هذه الآية كقولهِ تعالى : ( ولا يخْشَوْنَ أحداً إلاّ الله ) فليس هو الغرضَ في الآية ولا اللَّفظُ بمحتَمِلٍ له البتةَ . ومَنْ أجازَ حَملها عليه كان قد أبطلَ فائدةَ التقديمِ وسوَّى بينَ قولِهِ تعالى : ( إنّما يخشَى اللهَ مِنْ عبادِه العلماء ) وبين أن يقالَ : إنما يخشى العلماءُ اللهَ . وإذا سوَّى بينهُما لَزِمَه أن يُسَوِّيَ بينَ قولِنا : ما ضَرَبَ زيداً إلاّ عمرٌو وبَيْنَ : ما ضربَ عمرٌو إلاَّ زيداً . وذلك ما لا شُبْهَةَ في امتناعِه
فهذه هيَ المسألةُ . وإذ قد عرفتَها فالأمرُ فيها بيِّنٌ أنّ الكلامَ بما وإلاّ قد يكونُ في معنى الكلامِ بإنما . ألا ترى إلى وضوحِ الصورةِ في قولك : ما ضربَ زيدا إلا عمرٌو وما ضربَ عمرٌو إلاّ زيداً أنه في الأولِ لبيانِ مَن الضارب . وفي الثاني لبيانِ مَنِ المضروبُ وإنْ كان تكلفاً أن تَحمله على نفي الشرِكة فتريدَ بما ضربَ زيداً إلاّ عمرو أنه لم يضرِبْه اثنان وبما ضربَ عمرٌو إلا زيداً أنه لم يضرِب اثنين
ثم اعلمْ أن السببَ في أنْ لم يكن تقديم المفعولِ في هذا كتأخيرِه ولم يكنْ ما ضربَ زيداً إلا عمرٌو وما ضربَ عمرٌو إلا زيداً سواءٌ في المعنى أن الاختصاصَ يقعُ في واحدٍ من الفاعلِ والمفعولِ ولا يقع فيهما جميعاً . ثم إنَّه يقع في الذي يكونُ بعد " إلاّ " منهما دونَ الذي قبلَها لاستحالة أن يحدُثَ معنى الحرفِ في الكلمة قبلَ أن يجيءَ الحرفُ . وإذا كان الأمرُ كذلكَ وجبَ أن يفترِقَ الحالُ بينَ أن تقدِّم المفعولَ على " إلا " فتقولَ : ما ضربَ زيداً إلاّ عمرٌو وبين أن تقدم الفاعلَ فتقول : ما ضربَ عمرٌو إلاّ زيداً . لأنَّا إنْ زعمْنا أنَّ الحالَ لا يفترقُ جعلنا المتقدِّمَ كالمتأخِّر في جوازِ حدوثِه فيه . وذلك يقتضي المُحالَ الذي هو أن يَحْدثَ معنى " إلا " في الاسمِ من قبلِ أن تجيءَ بها فاعرِفْه
وإذ قد عرفتَ أنَّ الاختصاصَ مع " إلا " يقعُ في الذي تؤخِّرُه من الفاعل والمفعول فكذلك يقعُ مع " إنما " في المؤخَّرِ منهما دونَ المقدَّم . فإذا قلتَ : إنما ضربَ زيداً عمرٌو كان الاختصاصُ في الضاربِ . وإذا قلتَ : إنما ضربَ عمرٌو زيداً كان الاختصاصُ في
المضروبِ . وكما لا يجوزُ أن يَستويَ الحالُ بينَ التقديم والتأخيرِ معَ " إلا " كذلكَ لا يجوزُ مع " إنما " . وإذا استبنْتَ هذه الجملةَ عرفتَ منها أن الذي صنعَه الفرزدقُ في قولِه :
( . . . . . . . . . . . . . . . . وإنَّما ... يُدافِعُ عَنْ أَحْسابِهِمْ أَنا أَوْ مِثْلي )
شيءٌ لو لم يصنعْهُ لم يصحَّ له المعنى . ذاك لأنَّ غرضَه أن يخصَّ المدافِعَ لا المدافعَ عنه . وأنه لا يزعمُ أنَّ المدافعة منه تكون عن أحسابِهم لا عن أحسابِ غيرهم كما يكونُ إذا قال : وما أدافِعُ إلا عن أحسابِهم . وليس ذلك معناه إنَّما معناه أن يزعم أنَّ المدافِعَ هو لا غيرُه فاعرفْ ذلك فإن الغلطَ كما أظنُّ يدخلُ على كثيرٍ ممن تسمعُهُم يقولونَ : إنه فَصَلَ الضميرَ للحملِ على المعنى . فيرى أنه لوْ لم يفصِلْه لكان يكونُ معناه مثلَه الآن . هذا ولا يجوزُ أن يُنْسَب فيه إلى الضرورةِ فيجعلَ مثلاً نظيرَ قولِ الآخَرِ - الهزج - :
( كأنَّا يَوْمَ قُرَّى إنْما ... نقْتُلُ إيّانا ! )
لأنَّه ليس به ضرورةٌ إِلى ذلك من حيث إنَّ أدافِعُ ويدافِعُ واحدٌ في الوزن فاعرِفْ هذا أيضاً
وجملةُ الأمْر أنَّ الواجبَ أن يكونَ اللفظُ على وجهٍ يجعلُ الاختصاصَ فيه للفرزدق وذلك لا يكونُ إِلاّ بأن يقدِّمَ الأحسابَ على ضميرِه وهو لو قال : وإِنما أدافِعُ عن أحسابهم استكنّ ضميرُه في الفعل فلم يُتصوَّر تقديمُ الأحسابِ عليه ولم يقعِ " الأحساب " إِلاَّ مؤخَّراً عن ضميرِ الفرزدق . وإِذا تأخرتِ انصرفَ الاختصاصُ إِليها لا محالة
فإِنْ قلتَ : إِنَّه كان يمكنه أن يقولَ : " وإِنما أدافِعُ عن أحسابهم أنا " فيقدِّمَ الأحسابَ على " أنا " . قيل إِنه إِذا قال : أدافِعُ كان الفاعلُ الضميرَ المستكنَّ في الفعلِ وكان " أنا " الظاهرُ تأكيداً له أعني للمستكنِّ . والحكمُ يتعلَّقُ بالمؤكَّد دون التأكيد لأنّ التأكيدَ
كالتكريرِ فهو يجيءُ من بَعْد نفوذِ الحكمِ ولا يكونُ تقديم الجارِ مع المجرورِ الذي هو قولُه عن أحسابهم على الضمير الذي هو تأكيدٌ تقديماً له على الفاعلِ لأنَّ تقديمَ المفعولِ على الفاعل إِنما يكونُ إِذا ذكرتَ المفعولَ قبل أن تذكرَ الفاعل . ولا يكونُ لكَ إِذا قلتَ : " وإِنَّما أدافِعُ عن أحسابِهم " سبيلٌ إِلى أن تذكرَ المفعولَ قبل أن تذكرَ الفاعلَ لأنَّ ذكَر الفاعلِ هاهنا هو ذكرُ الفعلِ من حيثُ إِن الفاعلَ مستكِنٌ في الفِعْلِ فكيف يتصَوَّرُ تقديمُ شيءٍ عليه فاعرِفْه
واعلمْ أنك إِنْ عمدتَ إِلى الفاعلِ والمفعولِ فأخَّرتَهما جميعاً إلى ما بَعْدَ إلاّ فإنَّ الاختصاصَ يقعُ حينئذٍ في الذي يلي " إِلاّ " منهما . فإِذا قلتَ : ما ضربَ إِلا عمرٌو زيداً كان الاختصاصُ في الفاعلِ وكان المعنى أنك قلتَ : إِنَّ الضاربَ عمرٌو لا غيرُه . وإِن قلتَ : ما ضربَ إِلا زيداً عمرٌو كان الاختصاصُ في المفعول وكان المعنى أنك قلتَ : إِنَّ المضروبَ زيدٌ لا مَنْ سِواه . وحُكْمُ المفعولَيْنِ حكمُ الفاعلِ والمفعولِ فيما ذكرتُ لك . تقولُ : لم يَكْسُ إِلاّ زيداً جبةً . فيكون المعنى أنه خصَّ الجبةَ من أصنافِ الكُسوةِ . وكذلك الحكمُ حيثُ يكونُ بدلَ أحدَ المفعولي جارٌّ ومجرورٌ كقولِ السيِّد الحِمْيري - السريع - :
( لَوْ خُيِّرَ المِنْبَرُ فُرْسَانَهُ ... ما اخْتَارَ إِلاّ مِنْكُم فَارِسا )
الاختصاصُ في " منكُم " دونَ " فارساً " . ولو قلتَ : ما اختارَ إِلاّ فارساً منكم صار الاختصاصُ في " فارساً "
واعلمْ أنّ الأمرَ في المبتدأ والخبر إِن كانا بَعْدَ " إِنّما " على العبرةِ التي ذكرتُ لك في الفاعلِ والمفعولِ إِذا أنتَ قدَّمتَ أحَدَهما على الآخَرِ . معنى ذلك أنك إِن تركتَ الخبرَ في موضِعِه فلم تقدِّمه على المبتدأ كان الاختصاصُ فيه . وإِن قدَّمته على المبتدأ صار
الاختصاصُ الذي كان فيه في المبتدأ . تفسيرُ هذا أنَّك تقولُ : إِنما هذا لك . فيكونُ الاختصاصُ في " لك " بدلالةِ أنك تقولُ : إِنَّما هذا لكَ لا لغيرك . وتقولُ إِنما لك هذا . فيكونُ الاختصاصُ في " لك " بدلالةِ أنكَ تقولُ : إنما هذا لك لا لغيرك وتقول : إنما لك هذا فيكون الاختصاص في " هذا " بدلالة أنك تقول : إِنما لكَ هذا لا ذاكَ : والاختصاصُ يكونُ أبداً في الذي إِذا جئتَ بلا العاطفة كان العطفُ عليه . وإِنْ أردتَ أن يزدادَ ذلك عندَكَ وضوحاً فانظرْ إِلى قولِه تعالى : ( فإِنَّما عليكَ البلاغُ وعلينا الحسابُ ) وقوله عزّ وعلا : ( إِنّما السَّبيلُ عَلَى الّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ ) . فإِنّك ترى الأمرَ ظاهراً أنَّ الاختصاصَ في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاغُ والحسابُ دون الخبر الذي هو عليكَ وعلينا وأنه في الآيةِ الثانيةِ في الخبرِ الذي هو " على الذين " دونَ المبتدأ الذي هو " السبيل "
واعلمْ أنه إِذا كان الكلامُ بما وإِلاّ كان الذي ذكرتُه من أن الاختصاصَ يكون في الخبر إِنْ لم تقدِّمْه وفي المبتدأ إنْ قدَّمتَ الخبر أوضحَ وأبينَ تقولُ : ما زيدٌ إلاَّ قائمٌ فيكون المعنى أنك اختصصتَ القيامَ من بين الأوصافِ التي يتوهَّم كونُ زيد عليها بجعله صفةً له . وتقول : ما قائم إِلا زيد فيكون المعنى أنك اختصَصْتَ زيداً بكون موصوفاً بالقيام . فقد قَصْرتَ في الأول الصفةَ على الموصوفِ وفي الثاني الموصوف على الصفة
واعلم أنَّ قولَنا في الخبرِ إذا أخِّرَ نحو " ما زيدٌ إِلاّ قائم " أنك اختَصَصْتَ القيامَ من بين الأوصافِ التي يُتوهَّم كونُ زيدٍ عليها ونَفَيْتَ ما عدا القيامَ عنه . فإِنما نعني أنك نفَيْتَ عنه الأوصافَ التي تُنافي القيامَ نحو أن يكون جالساً أو مضطجعاً أو مُتَكئاً أو ما شاكلَ ذلك . ولم نُردْ أنك نفيتَ ما ليس منَ القيامِ بسبيلٍ إِذْ لسنان ننفي عنه بقولِنا : ما هوَ إِلاّ قائم أن يكونَ أسودَ أو أبيضَ أو طويلاً أو قصيراً أو عالماً أو جاهلاً . كما إنَّا إِذا قلنا : ما قائمٌ إِلا زيد لم نُرِدْ أنه ليس في الدنيا قائمٌ سِواهُ وإِنَّما نعني ما قائمٌ حيث نحن وبحضرتنا وما أشبهَ ذلك
واعلم أنَّ الأمرَ بَيّنٌ في قولِنا : ما زيدٌ إِلاَّ قائم أنْ ليس المعنى على نفيِ الشركةِ ولكنْ على نفي أن لا يكونَ المذكورُ ويكونَ بدلَه شيءٌ آخر . ألا ترى أنْ ليس المَعنى أنه ليس له معَ القيامِ صفةٌ أخرى بلِ المعنى أنْ ليس له بدلَ القيام صفةٌ ليستْ بالقيام وأنْ ليس القيامُ منفياً عنه وكائناً مكانَه فيه القعودُ أو الاضطجاعُ أو نحوُهما . فإِنْ قلتَ : فصُورَةُ المعنى إِذاً صُورَتُهُ إِذا وضعتَ الكلامَ بإِنما فقلتَ إِنما هو قائمٌ . ونحنُ نرى أنَّه يجوزُ في هذا أن تَعْطِفَ بلا فتقول : إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ ولا نرى ذلك جائزاً مع ما وإلاَّ إذ ليس من كلام الناس أن يقولوا : ما زيدٌ إِلاّ قائمٌ لا قاعدٌ فإِنَّ ذلك إِنما لم يَجُزْ من حيثُ إِنك إِذا قلتَ : ما زيدٌ إلاَّ قائمٌ فقد نفيتَ عنه كلَّ صفةٍ تُنافي القيامَ . وصرت كأنك قلت : ليس هو بقاعدٍ ولا مضطجعٍ ولا متكىءٍ . وهكذا حتى لا تدعَ صفةً يخرجُ بها من القيامِ
فإِذا قلتَ من بعد ذلك : لا قاعد كنتَ قد نفيتَ بلا العاطفةِ شيئاً قد بدأتَ فنفيتَه وهي موضوعةٌ لأنْ تنفيَ بها ما بدأتَ فأوجبتَه لا لأن تفيدَ بها النفيَ في شيءٍ قد نفيتَه . ومن ثَمَّ لم يَجُزْ أن تقولَ : ما جاءني أحدٌ لا زيدٌ على أنْ تعمدَ إِلى بعضِ ما دخلَ في النفيِ بعمومِ أحدٍ فتنفيَه على الخُصوصِ بل كان الواجبُ إِذا أردتَ ذلك أن تقولَ : ما جاءني أحدٌ ولا زيدٌ فتجىءَ بالواو من قَبْل " لا " حتى تخرجَ بذلك عن أن تكونَ عاطفةً فاعرفْ ذلك
وإِذْ قد عرفتَ فسادَ أن تقولَ : ما زيدٌ إلا قائمٌ لا قاعدٌ فإِنَّك تعرفُ بذلك امتناعَ أن تقولَ : ما جاءني إِلا زيدٌ لا عمرٌو وما ضربتُ إِلا زيداً لا عمراً وما شاكلَ ذلك . وذلك أنكَ إِذا قلتَ : ما جاءني إِلاّ زيدٌ فقد نَفَيْتَ أنْ يكونَ قد جاءك أحدٌ غيرُه . فإِذا قلتَ : لا عمرٌو كنتَ قد طلبتَ أن تنفيَ بلا العاطفةِ شيئاً قد تقدمتَ فنفيتَه وذلك - كما عَرَّفْتُك - خروجٌ بها عن المعنى الذي وُضِعَتْ له إِلى خلافِه . فإِنْ قيلَ : فإِنَّك إِذا قلتَ : إِنما جاءني زيد فقد نفيتَ فيه أيضاً أن يكونَ المجىءُ قد كانَ من غيرهِ فكانَ ينبغي أن لا يجوزَ فيه أيضاً أن تعطِفَ بلا فتقول : إِنَّما جاءني زيدٌ لا عمرٌو قيل : إِن الذي قلتَه من أنك إِذا قلتَ : إِنما جاءني زيد فقد نفيتَ فيه أيضاً المجىء عن غيرهِ غيرُ مسلَّمٍ لك على حقيقتِه وذلك أنه ليس معك إِلاّ قولُك : جاءني زيد وهو كلامٌ كما تراهُ مثْبَتٌ ليس فيه نفيٌ البتَّةَ كما كانَ في قولِك : ما جاءني إِلاّ زيدٌ . وإِنما فيه أَنَّك وضعتَ يدَك على زيدٍ فجعلتَه الجائي . وذلك
وإِن أوجَبَ انتفاءَ المجيء عن غيرِه فليس يوجِبُه من أجلِ أنْ كان ذلك إِعمالَ نفيٍ في شيءٍ . وإِنما أوجَبَه من حييثُ كان المجيءُ الذي أخبرتَ به مَجيئاً مخصوصاً إِذا كانَ لزيدٍ لم يكنْ لغيره . والذي أَبيناهُ أن تنفيَ بلا العاطفةِ عن شيءٍ وقد نفيتَه عنه لفظاً
ونظيرُ هذا أنّا نعقلُ من قولنا : زيدٌ هو الجائي . أن هذا المجيءَ لم يكن من غيرِه ثم لا يمنعُ ذلك من أن تجيءَ فيه بلا العاطفةِ فتقولَ : زيدٌ هو الجائي لا عمرٌو . لأنَّا لم نعقلْ ما عَقَلْناه من انتفاءِ المجيءِ عن غيرِه بنفيٍ أوقَعناه على شيءٍ ولكنْ بأنَّه لمّا كانَ المجيءُ المقصودُ مجيئاً واحداً كان النصُّ على " زيدٍ " بأنه فاعلُه وإِثباتُه له نفياً له عَنْ غيرِه ولكنْ من طريقِ المعقولِ لا من طريقِ أن كانَ في الكلامِ نفيٌ كما كان ثَمَّ فاعرْفه . فإِنْ قيل : فإِنَّك إِذا قلتَ : ما جاءني إِلاّ زيدٌ . ولم يكن غرضُك أن تنفيَ أن يكونَ قد جاءَ معه واحدٌ آخرُ كان المجيءُ أيضاً مجيئاً واحداً . قيلَ : إِنه وإِنْ كانَ واحداً فإِنَّك إِنما تُثْبِتُ أنَّ زيداً الفاعلُ له بأنْ نفيتَ المجيءَ عن كلِّ مَنْ سوى زيدٍ كما تصنعُ إِذا أردتَ أن تنفيَ أن يكون قد جاءَ معه جاءٍ آخرُ . وإِذا كان كذلك كانَ ما قلناهُ من أنَّك إِنْ جئتَ بلا العاطفةِ فقلتَ : ما جاءني إلاّ زيدٌ لا عمرُو كنتَ قد نفيتَ الفعلَ عن شيءٍ قد نفيتَه عنه مرةً صحيحاً ثابتاً كما قلنا فاعرفْه
واعلمْ أنَّ حكمَ " غير " في جميعِ ما ذكرنا حكمُ " إِلا " فإِذا قلعت : ما جاءني غيرُ زيدٍ احتملَ أن تريدَ نَفْيَ أن يكونَ قد جاءَ معه إِنسانٌ آخرُ وأن تريدَ نفيَ أن لا يكونَ قد جاءَ وجاءَ مكانه واحدٌ آخرُ . ولا يَصِحُّ أن تقولَ : ما جاءني غيرُ زيدٍ لا عمرٌو . كما لم يَجُزْ : ما جاءني إِلاّ زيدٌ لا عمرٌو
فصل في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه ب " ما " و " إلا "
اعلمْ أنَّ الذي ذكرناه من أنك تقولُ : ما ضَرَبَ إِلاّ عمرٌو زيداً . فَتُوقِعُ الفاعلَ والمفعولَ جميعاً بعد إِلاّ ليس بأكثَرِ الكلام وإِنَّما الأكثرُ أن تقدِّم المفعولَ على " إِلاَّ " نحوُ : ما ضربَ زيداً إلاّ عمرٌو . حتى إِنّهم ذهبوا فيه أعني في قولكَ : ما ضربَ إِلا عمرٌو زيداً
إِلى أنَّه على كلامين وأنَّ زيداً منصوبٌ بفعلٍ مضمَرٍ حتى كأن المتكلِّمَ بذلك أَبْهَمَ في أوَّلِ أمرِه فقال : ما ضَرَبَ إِلا عمرٌو . ثم قيلَ له : مَنْ ضَرَبَ فقال : ضَربَ زيداً
وهاهنا - إِذا تأملتَ - معنًى لطيفٌ يوجِبُ ذلكَ وهو أَنَّكَ إِذا قلتَ : " ما ضرب زيداً إِلا عمرٌو " كان غرضُك أن تَختَصَّ عَمْراً بضربِ زَيْدٍ لا بالضربِ على الإِطلاق . وإذا كانَ كذلِكَ وجبَ أن تُعَدِّيَ الفِعْلَ إِلى المفعولِ من قَبْلِ أن تذكُرَ عمراً الذي هو الفاعلُ لأنَّ السَّامعَ لا يعقِلُ عنكَ انك اختصَصْتَه بالفعلِ معدًّى حتّى تكونَ قد بدأتَ فعدّيتَه . أعني : لا يفهمُ عنكَ أنك أَردْتَ أن تختصَّ عمراً بضربِ زيدٍ حتى تذكرَه له مُعَدًّى إِلى زيدٍ . فأما إِذا ذكرتَه غيرْ معدًى فقلت : ما ضربَ إِلاَّ عمرٌو . فإِنَّ الذي يقع في نفسِه أنك أردتَ أن تزعُمَ أنه لم يَكُنْ من أحدٍ غيرِ عمروٍ ضَرْبٌ وأنه ليس هاهنا مضروبٌ إِلاّ وضاربُه عمرٌو فاعرِفْه أصلاً في شأنِ التقديم والتأخير
فصل في " إنما " و " ظَنَّ "
إن قيلَ : مضيتَ في كلامِك كلِّه على أنَّ " إِنما " للخبرِ لا يجهلهُ المخاطَبُ ولا يكونُ ذكرُك له لأنْ تفيدَه إِياه . وإِنَّا لنراها في كثيرٍ من الكلامِ . والقصدُ بالخبر بعدَها أن تُعْلِمَ السامع أمراً قد غَلِط فيه بالحقيقة واحتاجَ إِلى معرفتِه كمثلِ ما ذكرتَ في أوّلِ الفَصْل الثاني مِنْ قولك : إِنّما جاءني زيدٌ لا عَمرٌو . وتراها كذلك تدورُ في الكُتب للكشفِ عن معانٍ غيرِ معلومةٍ ودلالةِ المتعلمِ منها على ما لا يعلمُ
قيل : أمَّا ما يجيءُ في الكلامِ من نحوِ : إِنما جاءَ زيدٌ لا عمرٌو فإِنه وإِنْ كانَ يكونُ إِعلاماً لأمْرٍ لا يَعلَمُه السَّامعُ فإِنه لا بدَّ مع ذلك من أن يُدَّعى هناك فضلُ انكشافٍ وظهورٍ في أنَّ الأمْرَ كالذي ذُكِرَ . وقد قسمتُ في أولِ ما افتتحتُ القولَ فيها فقلتُ إِنّها تَجيءُ للخبر لا يجهلُه السامعُ ولا ينكِرُ صحتَه أو لِمَا تنزَّلَ هذه المنزلةَ . وأمّا ما ذكرتَ من أنها تجيءُ في الكتبِ لدلالة المتعلِّم على ما لم يعلمْه فإنَّك إِذا تأملتَ مواقِعَها وجدتَها في الأمر الأكثر قَدْ جاءتْ لأَمْرٍ قد وَقَع العلمُ بموجِبِهِ وشيءٍ يدلُّ عليه . مثالُ ذلك أنَّ صاحبَ الكتابِ قال في بابِ كان : " إِذا قلتَ : كان زيدٌ قد ابتدأتَ بما هو معروفٌ عندَه مثلهُ عندك وإِنما ينتظِرُ الخبرَ . فإِذا قلتَ : حليماً فقد أعلمتَه مثلَ ما علمتَ . وإِذا قلتَ : كان حليماً فإِنما ينتظِرُ أن تعرِّفَه صاحبَ الصفة " . وذاك أنه إِذا كان معلوماً أنه لا يكونُ مبتدأ من غيرِ خَبَرٍ ولا خبرٌ من غير مبتدأ كانَ معلوماً أنك إِذا قلتَ : كان زيدٌ . فالمُخاطبُ ينتظرُ الخبرَ . وإِذا قلتَ : كان حَليماً أنه ينتظر الاسمَ فلم يقعْ إِذاً بعدَ " إِنما " إِلا شيءٌ كانَ معلوماً للسَّامِعِ من قبلِ أن ينتهيَ إِليه
وممّا الأمْرُ فيه بَيِّنٌ قولهُ في باب ظننتَ : وإِنما تحكي بعد " قلتُ " ما كان كلاماً لا
قولاً . وذلك أنه معلومٌ أنك لا تحكي بعد " قلتُ " إِذا كنتَ تنحو نحوَ المعنى إِلا ما كَانَ جملةً مُفيدةً . فلا تقول : قال فلانٌ : زيد وتسكت اللّهم إِلاّ أنْ تريدَ أنه نَطَق بالاسمِ على هذهِ الهيئة كأنك تريد أنه ذكرَه مرفوعاً . ومثلُ ذلك قولُهم : إِنّما يحذَفُ الشيءُ إِذا كانَ في الكلامِ دَليلٌ عليه . إِلى أشباه ذلك مما لا يُحْصَى . فإِنْ رأيتَها قد دَخَلَتْ على كلامٍ هو ابتداءُ إِعلامٍ بشيءٍ لم يعلَمْه السامعُ فلأنَّ الدليلَ عليه حاضرٌ منعه والشيءَ بحيث يقع العلمُ به عن كَثَبٍ . واعلمْ أنه ليس يكادُ ينتهي ما يعرِضُ بسببِ هذا الحرفِ من الدقائق
ومما يَجِبُ أن يُعلَمَ أنه إِذا كانَ الفعلُ بعدها فعلاً لا يَصِحُّ إِلاّ من المذكورِ ولا يكونُ من غيرِه كالتذكُّرِ الذي يُعْلَمُ أنه لا يكونُ إِلاّ مِنْ أولي الألبابِ لم يحسُنِ العطفُ بلا فيه كما يحسنُ فيما لا يختصُّ بالمذكورِ ويَصحُّ من غيرِه . تفسيرُ هذا أنه لا يحسنُ أن تقولَ : إِنما يتذكرُ أولو الألبابِ لا الجُهَّالُ . كما يحسنُ أن تقولَ : إِنما يجيء ُ زيدٌ لا عمرٌو . ثم إِنَّ النفيَ فيما يجيءُ فيه النَفْيُ يتقدَّم تارةً ويتأخَّرُ أخرى . فمثالُ التأخير ما تراه في قولِكَ : إِنما يجيء زَيْدٌ لا عمرٌو . وكقولِه تعالى : ( إِنَّما أَنت مذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ )
وكقولِ لبيد - الرمل - :
( إِنَّما يَجْزي الفَتى لَيْسَ الجَمَلْ ... )
ومثالُ التقديم قولُكَ : ما جاءني زيدٌ وإِنما جاءني عمرٌو . وهذا ممّا أنتَ تعلَمُ به مكانَ الفائدةِ فيها وذلك أنكَ تَعْلَمُ ضَرورةً أنَّك لو لم تُدْخِلْها وقلتَ : ما جاءني زيدٌ وجاءني عمرٌو لكانَ الكلامُ مع من ظنَّ أنهما جاءاكَ جميعاً وأنَّ المعنى الآن مع دخولِها أنَّ الكلاَم معَ من غَلِط في عينِ الجائي فظنَّ أنه كان زيداً لا عمراً
وأمرٌ آخرُ وهو ليس ببعيدٍ أن يظنَّ الظانُّ أنَّه ليس في انضمام " ما " إِلى " إِنّ " فائدةٌ أكثرُ
من أنها تُبطِلُ عملَها حتى ترى النَّحويين لا يزيدون في أكثرِ كلامِهم على أنها كافَّة . ومكانُها هاهنا يُزيلُ هذا الظنَّ ويبطلهُ . وذلك أنك ترى أنك لو قلت : ما جاءني زيدٌ وإِنَّ عمراً جاءني لم يُعقَلْ منه أنك أردتَ أن الجائي عمرٌو لا زيدٌ بل يكونُ دخولُ إِنّ كالشيءِ الذي لا يحتاجُ إِليه ووجدتَ المعنى يَنْبو عنه
ثم اعلمْ أنك إِذا استقريتَ وجدتَها أقوى ما تكونُ وأعلَقَ ما ترى بالقلب إِذا كان لا يُرادُ بالكلامِ بعدَها نفسُ معناه ولكنَّ التّعريضَ بأمرٍ هو مقتضَاه نحوُ أنَّا نعلمُ أنْ ليس الغرضُ من قولِه تعالى : ( إِنّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألبْابِ ) أن يعلمَ السَّامِعُون ظاهرَ معناه ولكن أن يُذمَّ الكفارُ وأنْ يُقالَ : إِنهم من فرطِ العِنادِ . ومن غَلبَةِ الهوى عليهم في حكمِ مَنْ ليس بذي عقلٍ . وإِنكم إِنْ طَمعْتُم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتُمْ كمن طَمِع في ذلك من غيرِ أولي الألباب . وكذلك قولُه : ( إِنَّما أنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها ) وقوله عزَّ اسمُه : ( إِنَّما تُنْذِرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغَيْب ) . المعنى على أَنَّ مَن لم تكنْ له هذه الخَشيةُ فهو كأنه ليس له أذُنٌ تسمعُ وقلبٌ يَعْقِلُ . فالإِنذارُ معه كلاًّ إِنذارٌ . ومثالُ ذلك من الشعرِ قولُه - مجزوء الرمل - :
( أَنا لَمْ أُرْزقْ محبَّتَها ... إِنَّما للعبْدِ ما رُزِقا )
الغرضُ أن يُفهِمَك من طريقِ التَّعريضِ أنه قد صار يَنْصَحُ نفسَه ويعلم أنه يَنْبغي له أن يقطعَ الطَّمعَ من وصلِها ويَيْأسَ من أن يكونَ منها إِسعافٌ . ومن ذلك قوله - البسيط - :
( وإِنَّما يعذرُ العُشَّاقُ مَنْ عَشِقَا ... )
يقولُ : إِنَّه ليس يَنْبغي للعاشقِ أن يلومَ من يَلومُهُ في عشقِه وأنه ينبغي أَن لا يُنكَرَ ذلك منه فإِنه لا يَعْلَمُ كُنْهُ البلوَى في العِشْقِ . ولو كان ابْتُلي به لعَرفَ ما هو فيه فَعَذَره . وقولُه - الكامل - :
( ما أَنتَ بالسَّبَبِ الضَّعيفِ وإِنّما ... نُجْحُ الأُمورِ بقوَّةِ الأسبابِ )
( فاليومَ حاجَتُنا إِليكَ وإِنّما ... يُدْعَى الطَّبيبُ لِساعةِ الأَوْصابِ )
يقولُ في البيتِ الأول : إِنه ينبغي أن أنْجحَ في أمري حِينَ جعلتُك السببَ إِليه . ويقولُ في الثاني : إِنَّا قد وضعْنا الشيءَ في موضِعِه وطلبنا الأمرَ من جهَتهِ حينَ استعنّا بك فيما عرضَ من الحاجة وعوَّلنا على فضلِكَ . كما أنَّ مَنْ عوَّل على الطبيبِ فيما يعرِضُ له من السُقْم كان قد أصابَ بالتَّعويلِ موضِعَه وطلب الشيءَ من مَعْدِنه
ثم إِن العجَبَ في أنَّ هذا التعريضَ الذي ذكرتُ لك لا يحصُلُ من دُونِ " إِنما " فلو قلتَ : يتذكَّرُ أولو الألباب لم يدلَّ على ما دلَّ عليه في الآية وإِنْ كان الكلامُ لم يتغيَّرْ في نفسِه وليس إِلاَّ أنه ليس فيه " إِنما " . والسَبَبُ في ذلك أن هذا التَّعريضَ إِنما وقعَ بأن كان من شأنِ إِنَّما أن تضمَّنَ الكلامُ معنى النفي من بَعْدِ الإِثباتِ والتصريحِ بامتناعِ التذكُّرِ ممن لا يَعْقِل . وإِذا أُسقِطَتْ من الكلامِ فقيل : يتذكَّر أولو الألباب كان مجرَّدَ وصفٍ لأولي الألباب بأنهم يَتذكَّرُون . ولم يكنْ فيه معنى نفيٍ للتذكرِ عمَّن ليس منهم . ومحالٌ أن يقعَ تعرضٌ لشيءٍ ليس له في الكلام ذكرٌ ولا فيه دليلٌ عليه . فالتعريضُ بمثلُ هذا أعني بأن يقولَ : يتذكرُ أولو الألباب بِإسقاطِ " إِنما " يقعُ إِذًا إِنْ وقع بمدحِ إِنسانٍ بالتيقُّظ وبأنه فعلُ ما فعلَ وتنبهٌ لِما تنبَّهَ له لعقله ولحسنِ تمييزِه كما يقال : كذلك يفعلُ العاقلُ وهكذا يفعل الكريمُ . وهذا موضعٌ فيه دقةٌ وغموضٌ وهو مما لا يكادُ يقعُ في نفسِ أحدٍ أنه ينبغي أن يُتعرَّفَ سبُبُه ويُبحثَ عن حقيقة الأمرِ فيه
وممّا يجبُ لك أن تجعلَه على ذكرٍ منك من معاني " إِنما " ما عرَّفتُك أولاً من أنها قد
تدخلُ في الشيء على أن يُخيِّلَ فيه المتكلِّمُ أنه معلومٌ ويدَّعي أنه من الصحَّةِ بحيثُ لا يدفعُه دافعٌ كقوله :
( إنَّما مُصْعَبٌ شِهابٌ مِنَ الله ... )
ومنَ اللطيفِ في ذلك قولُ قَتبَ بن حِصْنٍ - الطويل - :
( أَلا أيُّها النَّاهِي فَزارةَ بَعْدَما ... أجَدَّتْ لِغَزْوٍ إِنّما أنْتَ حالِمُ )
ومن ذلك قولُه ( تعالى ) حكاية عن اليَهُود : ( وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأَرْضِ قالُوا إِنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ) دخلتْ " إِنّما " لتدلَّ على أنَّهم حين ادَّعَوا لأنفسهم أنهم مُصْلِحُون أظهروا أنهم يدَّعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً . وكذلك أكَّد الأمرَ في تكذيبِهم والرَّدَّ عليهم فجمَعَ بين " أَلاَ " الذي هو للتَّنبيه وبين " إِن " الذي هو للتأكيد فقال : ( أَلا إِنَّهم هُم المُفْسِدون ولكنْ لا يَشْعُرون )
فصل في " المحاكاة " و " النظم "
أعلمْ أنَّه لا يَصِحّ تقديرُ الحكايةِ في النَّظمِ والترتيبِ بل لن تعدوَ الحكايةُ الألفاظَ وأجراسَ الحروفِ وذلك أنَّ الحاكي هو منْ يأتي بمثلِ ما أَتَى به المَحْكِيُّ عنه ولا بدَّ أن تكونَ حكايتُه فعلاً لَهُ وأن يكونَ بها عامِلاً عَملاً مثلَ عمل المحكيِّ عنه نحو أن يصوغَ إنسانٌ خاتَماً فيبدعَ فيه صنعةً ويأتي في صِنَاعتِه بخاصَّةٍ تُستغرَبُ فيعمَدَ واحدٌ آخرُ فيعملَ خاتماً على تلك الصُّورةِ والهيئةِ ويجيءَ بمثلِ صنعَتِه فيه ويُؤدِّيها كما هي فيقالُ عند ذلك : إنه قد حَكَى عَملَ فلانٍ وصَنْعةَ فلانٍ . والنَّظْمُ والتَّرتيبُ في الكلام كما بَيَّنا عملٌ يعملهُ مؤلِّف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظِها . وهو بما يَصْنعُ في سبيلِ مَنْ يأخذُ الأصباغَ المختلفة فيتوخَّى فيها ترتيباً يحدثُ عنه ضربٌ من النقشِ والوشْيِ . وإذا كانَ الأمْرُ كذلك فإِنَّا إنْ تعدَّينا بالحكايةِ الألفاظَ إلى النظمِ والترتيبِ أدَّى ذلك إلى المُحالِ وهو أنْ يكونَ المنشدُ شعرَ امرىءِ القيس قد عَمِل في المعاني وترتيبها واستخراج النتائجِ والفوائدِ مثلَ عملِ امرىء القيس وأن يكونَ حالُه إذا أنشدَ قوله - الطويل -
( فَقُلْتُ لَهُ لَمّا تَمطَّى بِصُلْبِهِ ... وأَرْدَفَ أَعْجازاً ونَاءَ بكَلْكَلِ )
حالَ الصّائغِ يَنْظُر إلى صورةٍ قد عَمِلَها صائغٌ مِنْ ذَهبٍ له أو فضّةٍ فيجيءُ بمثلها في ذهبهِ وفضتِه . وذلك يخرجُ بمرتكبٍ إنِ ارتكبَه إلى أن يكونَ الرّاوي مستحقاً لأن يوصَفَ بأنه استعارَ وشبَّه وأن يُجْعَلَ كالشّاعرِ في كل ما يكونُ به ناظماً فيقالَ إنه جَعلَ هذا فاعلاً وذاك مفعولاً وهذا مبتدأ وذاك خبراً . وجعلَ هذا حالاً وذاكَ صفةً . وأن يقالَ نَفى كذا واثبتَ كذا وأبْدَلَ كذا من كذا وأضافَ كذا إلى كذا وعلى هذا السَّبيلِ كما يقالُ ذاك في الشّاعرِ . وإِذا قيلَ ذاك لَزِم منه أنْ يُقالَ فيه : صَدَق وكَذَب كما يقالَ في المَحكِيِّ عنه وكفَى بهذا بُعداً وإحالةً . ويَجمع هذا كلَّه أنه يلزمَ منه أن يُقال إنه قال شعراً كما يقال فيمنْ حَكَى صَنعةَ الصّائغِ في خاتَمٍ قد عَمِلَه : إنه قد صاغَ خاتماً
وجُملةُ الحديثِ أنَّا نعلَمُ ضرورةَ أنّه لا يتأتَّى لنا أن نَنظِمَ كلاماً من غير رَوِيَّةٍ وفكْرٍ فإِنْ كانَ راوي الشّعرِ ومُنشدُهُ يحكي نظمَ الشّاعرِ على حقيقته فينبغي أنْ لا يتأتَّى له روايةُ شعرِه إلاّ برويَّة وإلاّ بأن ينظرَ في جميعِ ما نَظَر فيه الشاعرُ من أَمْرِ النظمِ وهذا ما لا يبقى معه موضعُ عذرٍ للشَّاكِّ
هذا وسببُ دخولِ الشُّبهَةِ على من دَخَلَتْ عليه نه لمَّا رأى المعاني لا تتجلَّى للسامعِ إِلاَّ مِنَ الألفاظ وكان لا يوقَفُ على الأمورِ التي بِتَوخّيها يكون النظمُ إلا بأن ينظرَ إلى الألفاظِ مرتَّبةً على الأَنحاء التي يوجبها ترتيبُ المعاني في النفسِ . وجرتِ العادةُ بأن تكونَ المعاملةُ مع الألفاظ فيقالَ : قد نظم ألفاظاً فأحسنَ نظمَها وألَّف كلماً فأجادَ تأليفها
جعل الألفاظَ الأصْلَ في النظمِ وجعلَه يَتوخَّى فيها أنفسَها وتركَ أن يفكِّرَ في الذي بيّناه من أن النظمَ هو توخِّي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخِّيَها في متونِ الألفاظِ محالٌ . فلما جعلَ هذا في نفسِه ونَشب هذا الاعتقادُ به خرجَ له من ذلك أن الحاكي إذا أدَّى ألفاظَ الشعر على النَّسق الذي سَمِعها عليه كان قد حَكى نظمَ الشاعر كما حكى لفظه . وهذه شُبهةٌ قد ملكت قلوبَ الناس وعشَّشتْ في صُدورِهم وتشَرَّبتها نفوسُهم حتى إنكَ لترى كثيراً منهم وهو من حلولِها عندهم محلِّ العلم الضروري بحيثُ إنْ أومأتْ له إلى شيءٍ مما ذكرناه اشمأزَّ لك وسَكَّ سمعَه دونَك وأظهرَ التعجبَ منك وتلك جريرةُ تركُ النظر وأخذِ الشيءِ من غيرِ معدنِه . ومنَ الله التوفيق
فصل في ضرورة ترتيب الكلام ونسبته إلى صاحبه
اعلمْ أنّا إذا أضفنا الشعرَ أو غيرَ الشعر من ضروب الكلامِ إلى قائِلِه لم تكن إضافتُنا له من حيثُ هو كَلِمٌ وأوضاعُ لغةٍ ولكنْ من حيثُ تُوخِّيَ فيها النظمُ الذي بيّنا أنه عبارةٌ عن تَوخّي معاني النحو في معاني الكلم وذاك أنَ من شأن الإِضافة الاختصاصِ فهي تتناولُ الشيءَ من الجهة التي تختصُّ منها بالمضاف إليه . فإذا قلتَ : غلامُ زيدٍ تناولت الإضافةَ للغلام من الجهة التي يختصُّ منها بزيدٍ وهو كونُه مملوكاً . وإذا كان الأمرُ كذلِك فينبغي لنا أن ننظرَ في الجهة التي يختصُّ منها الشعر بقائله . وإِذا نَظَرْنا وجدناه يختصُّ به من جهةِ توخِّيهِ في معاني الكَلِم التي ألَّفه منها ما توخّاه من معاني النحو . ورأينا أنفسَ الكَلِم بمعزلٍ عن الاختصاصِ ورأينا حالَها معها حالَ الإبريسَم مع الذي يُنْسَج منه الدِّيباجُ وحالُ الفضة والذهبِ مع من يصوغ منهما الحُلِيَّ فما لا يشتبهُ الأمْرُ في أنَّ الديباجَ لا يختصُّ بناسِجِه من حيثُ الإِبْرِيسَمُ والحُليُّ بصائغها من حيثُ الفضةُ والذهبُ ولكن من جهة العملِ والصنعة كذلك ينبغي أن لا يشتَبِه أنَّ الشعرَ لا يختصُّ بقائله من جهةِ أنفُسِ الكَلِم وأوضاعِ اللغة . ويزداد تبيناً لذلك بأن يُنظر في القائل إذا أضفتَه إلى الشعر فقلتَ : امرؤ القَيْس قائلُ هذا الشعر . من أينَ جعلتَه قائلاً له أمن حيثُ نَطَق بالكلم وسُمِعَتْ ألفاظُها مِنْ فِيهِ أم من حيثُ صنَعَ في معانيها ما صنعَ وتوخَّى فيها ما توخَّى فإِن زعمتَ أنك جعلتَه قائلاً له من حيثُ إنه نطقَ بالكلم وسُمِعَتْ ألفاظُها من فيهِ على النَّسقِ المخصوص فاجعلْ راويَ الشعر قائلاً له فإِنه ينطِقُ بها ويخرجها من فيهِ على الهيئة والصورةِ التي نطقَ بها الشاعر وذلك ما لا سبيلَ لك إليه . فإِن قلتَ : إنَّ الراوي وإنْ كانَ نطقَ بألفاظِ الشعرِ على الهيئة والصورة التي نطقَ بها الشاعرُ فإِنَّه لم يبتدئىءْ فيها النَّسقَ والترتيبَ وإنما ذلك شيءٌ ابتدأه الشاعرُ . لذلك جعلتَه القائلَ له دونَ الراوي . قيل لك : خبِّرنا عنك أَترى أنه يتصوَّر أن يجبُ لألفاظِ الكلم التي تراها في قولِه - الطويل -
( قفا نبكِ مِنْ ذِكرى حَبيبٍ ومنزلِ ... )
هذا الترتيبُ من غيرِ أن يُتوخَّى في معانيها ما تعلمُ أن أمراً القيس توخَّاه من كونِ " نبكِ " جواباً للأَمْرِ وكونِ " من " معدِّيةً له إلى " ذكرى " وكون " ذكرى " مضافةً إلى " حبيب " وكون " منزل " معطوفاً على " حبيب " أم ذلك محال فإِن شككتَ في استحالته لم تُكلَّمْ وإن قلتَ : نعم هو محالٌ . قيل لك : فإِذا كان مُحالاً أن يجبَ في الألفاظ ترتيبٌ من غير أن يتوخَّى في معانيها معانيَ النحو كان قولُك : " إن الشاعرَ ابتدأ فيها ترتيباً " قولاً بما لا يتحصَّل
وجملةُ الأمْرِ أنَّه لا يكونُ ترتيبٌ في شيءٍ حتَّى يكونَ هناكَ قصدٌ إلى صورةٍ وصنعةٍ إنْ لم يُقَدَّمْ فيه ما قُدِّمَ ولم يُؤخَّر ما أخِّرَ وبُدِىءَ بالذي ثُنِّيَ به أو ثنِّي بالذي ثُلِّث به لم تحْصلْ لكَ تلكَ الصورةُ وتلك الصنعة . وإذا كان كذلكَ فينبغي أن ينظرَ إلى الذي يقصِدُ واضعُ الكلامِ أن يحصلَ له من الصورةِ والصنعةِ : أفي الألفاظ يحصُلُ له ذلك أم في معاني الأَلفاظِ وليس في الإِمكانِ أنْ يَشُكَّ عاقلٌ إِذا نَظَر أنْ ليس ذلك في الألفاظِ وإنَّما الذي يتصوَّرُ أن يكونَ مقصوداً في الألفاظِ هو الوزنُ وليس هو من كلامِنا في شيءٍ لأَنَّا نحنُ فيما لا يكونُ الكلامُ إلاّ به وليس للوزن مدخلٌ في ذلك
فصل في ضرورة ربط اللفظ بالمعنى
واعلم أني على طولِ ما عدْتُ وأبدأتُ وقلتُ وشرحتُ في هذا الذي قامَ في أوهام الناس من حديثِ اللفظِ لربما ظننتَ أني لم أصنعْ شيئاً وذاكَ أنك ترى الناس كأنه قد قُضِيَ عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدَدِه على التقليد البحْتِ وعلى التوهُّم والتخيُّل . وإطلاقُ اللفظ من غيرِ معرفةٍ بالمعنى قد صارَ ذاك الدأبَ والدِّيدنَ واستحكم الداءُ منه الاستحكامَ الشديدَ . وهذا الذي بيناه وأوضحناه كأنك ترى أبدا حجاباً بينهم وبينَ أن يعرفوه وكأنَّك تُسمِعُهم مِنْهُ شيئاً تلفِظُه أسماعُهم وتُنكرِه نفوسُهم . وحتى كأَنه كلما كانَ الأمْرُ أبينَ وكانوا عنِ العلم به أبعدَ وفي توهُّم خلافهِ اَقْعَد وذاك لأَنَّ الاعتقادَ الأوّلَ قد نَشِب في قلوبهم وتأشَّب فيها ودخَلَ بعروقهِ في نواحيها وصارَ كالنّبات السُّوء الذي كلما قلعتَه عادَ فنبتَ . والذي له صاروا كذلك أنهم حينَ رأَوهم يُفردون اللفظَ عن المعنى ويجعلونَ له حُسناً على حدةً ورأَوهم قد قسَّموا الشعرَ فقالوا : إنَّ منه ما حَسُنَ لفظُه ومعناه ومنه ما حَسُنَ لفظهُ دونَ معناهُ ومنه ما حَسُنَ معناه دونَ لفظهِ ورأوهم يصفون اللفظَ بأوصافٍ لا يصفونَ بها المعنى ظنوا أنَّ للفظ من حيثُ هو لفظٌ حسناً ومزيةً ونُبلاً وشرفاً وأن الأوصافَ التي نَحلوه إياها هي أوصافُه على الصحَّة . وذهبوا عما قدَّمنا شرَحه من أنَّ لهم في ذلك رأيا وتدبيراً وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرضُ وبين الصورةِ التي يخرجُ فيها فنسبوا ما كانَ منَ الحُسْنِ والمزيَّة في صورةِ المعنى إلى اللفظِ ووصفوه في ذلك بأوصافٍ هي تُخبِرُ عن أنفسها أنها ليسَتْ له كقولهم إنه حَلْيُ المعنى وإنه كالوَشْي عليه وإنه قد كَسَب المعنى دَلاَّ وشِكْلاً وإنه رشيقٌ أنيقٌ وإنه متمكِّن وإنه على قَدْرِ المعنى لا فاضلَ ولا مقصِّر إلى أشباه ذلك مما لا يشَكُّ أنه لا يكونُ وصفاً له من حيثُ هو لفظٌ وصَدَى صوتٍ . إلاّ أنهم كأَنهم رأوا بَْسْلاً حراماً أن يكون لهم في ذلك فكرٌ ورُويَّة وأن يميِّزوا فيه قَبيلاً من دبير
وممَّا الصفةُ فيه للمعنى وإنْ جرى في ظاهرِ المعاملةِ على اللفظِ إلاّ أنه يبعُد عند الناسِ كلَّ البعد أن يكونَ الأمرُ فيه كذلك وأن لا يكونَ من صفةِ اللفظ بالصحَّةِ والحقيقةِ وصفُنا اللفظَ بأنه مَجازٌ . وذاك أن العادةَ قد جرتْ بأن يقالَ في الفرق بين الحقيقة والمجاز : إنَّ الحقيقةَ أن يُقَرَّ اللفظُ على أصْلِهِ في اللغةِ والمجازَ أن يُزالَ عن موضِعه ويستعملَ في غيرِ ما وضِعَ له فيقالَ : أسدٌ ويرادَ شجاعٌ . وبحرٌ ويرادَ جوادٌ . وهو وإنْ كانَ شيئاً قد استَحكَم في النفوسِ حتَّى إنك ترى الخاصةَ فيه كالعامة فإِن الأمْرَ بعدُ فيه على خلافهِ . وذاك أنَّا إذا حقَّقْنا لم نجدْ لفظَ أسدٍ قد استعملَ على القطع والبتِّ في غيرِ ما وضع له . ذاك لأنه لم يُجعلْ في معنى شجاعٍ على الإِطلاقِ ولكن جُعل الرجل بشجاعته أسداً فالتجوُّزُ في أن ادَّعيتَ للرجل أنه في معنى الأسدِ وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدةِ بطشه وفي أنَّ الخوفَ لا يخامرُه والذُّعْرَ لا يعرضُ له . وهذا - إن أنت حصَلتَ - تجَّوز منك في معنى اللفظ وإنما يكونُ اللفظُ مُزالاً بالحقيقة عن موضعه ومنقولاً عما وضع له أنْ لو كنتَ تجدُ عاقلاً يقول : هو أسد وهو لا يضمرُ في نفسه تشبيهاً له بالأسدِ ولا يريد إلاّ ما يريدهُ إذا قال هو شجاعٌ وذلك ما لا يُشَكُّ في بطلانه
وليس العَجَبُ إلاّ أنّهم لا يذكرون شيئاً من المجازِ إلاّ قالوا : إنَّه أبلغُ من الحقيقة فليتَ شعري إنْ كان لفظ " أسد " قد نُقِل عما وُضع له في اللغة وأزيلَ عنه وجُعل يُرادُ به الشجاع هكذا غُفلاً ساذجاً . فمن أين يجبُ أنْ يكون قولنا : أسدٌ أبلغَ من قولنا شجاع
وهكذا الحكْمُ في الاستعارة هي وإن كانت في ظاهرِ المعاملة من صفةِ اللفظ
وكنا نقول : هذه لفظةٌ مستعارة قد استعير له اسمُ الأسد إنَّ مآلَ الأمر إلى أن القصدَ بها إلى المعنى . يدلّك على ذلك أنّا نقول : جعله أسداً وجعله بدراً وجعله بحراً . فلو لم يكن القصدُ بها إلى المعنى لم يكن لهذا الكلام وجهٌ لأن " جعل " لا تصلح إلاّ حيث يُرادُ إثباتُ صفةٍ للشيء . كقولنا : جعلته أميراً وجعلته واحدَ دهره تريد : أثبتُّ له ذلك . وحكمُ " جعل " إذا تعدَّى إلى مفعولين حكُم " صيَّرَ " فكما لا تقول : صيَّرته أميراً إلاّ على معنى أنك أثبتَّ له صفةَ الإِمارة كذلك لا يصحُّ أن تقولَ : جعلته أسداً إلاّ على معنى أنك جعلتَه في معنى الأسد . ولا يقال : جعلته زيداً . بمعنى سمَّيْته زيداً ولا يقال للرجل : اجعل ابنَك زيدا بمعنى سمِّه زيداً وولد لفلانٍ ابن فجعلَه زيداً . وإنما يدخل الغلطُ في ذلك على من لا يحصِّل
فأما قوله تعالى : ( وَجَعَلوا المَلائِكَةَ الذينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ) فإِنَّما جاء على الحقيقة التي وصفتُها وذاك أن المعنى على أنهم أثبتوا للملائكةِ صفةَ الإِناث واعتقدوا وجودَها فيهم . وعن هذا الاعتقادِ صدرَ عنهم ما صدرَ من الاسم أعني إطلاقَ اسم البنات . وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظَ الإِناث أو لفظَ البنات اسماً من غير اعتقادِ معنًى وإثباتِ صفة . هذا مُحال لا يقوله عاقل : أَما تسمعُ قولَ الله تعالى : ( أَشَهِدوا خَلْقَهُمْ ستُكتَبُ شهادتُهم ويُسْأَلونَ ) فإِن كانوا لم يزيدوا على أن أجْرَوا الاسمَ على الملائكة ولم يعتقدوا إثباتَ صفة ومعنى بإجرائه عليهم فأيُّ معنًى لأن يقال : اَشَهدوا خلقهم هذا وَلو كانوا لم يقصِدوا إثباتَ صِفَةٍ ولم يزيدوا على أن وضعوه اسماً لما استحقّوا إلاّ اليسيرَ من الذمِّ ولما كان هذا القولُ منهم كفراً والأمرُ في ذلك أظهرُ من أن يخفى
وجملةُ الأمر أنه إنْ قيل : إنه ليس في الدنيا علمٌ قد عرضَ للناس فيه من فحشِ الغلط ومن قبيح التورُّط منَ الذهاب معَ الظنونِ الفاسدة ما عَرَضَ لهم في هذا الشأن ظننتَ أَنْ لا يُخْشَى على من يقوله الكذبُ . وهل عَجَبٌ أعجبُ من قومٍ عقلاءَ يتلون قولَ الله تعالى :
( قُلْ لَئِن اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً ) ويؤمنون به ويدينون بأن القرآن معجزٌ ثم يصدُّون بأوجههم عن برهان الإِعجازِ ودليلهِ ويسلكون غيرَ سبيله . ولقد جَنَوا - لو دَرَوْا ذاك - عظيماً
فصل في تحليل بعض الشواهد على اللفظ والمعنى
واعلمْ أنه وإن كانت الصورةُ في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أن لا معنى للنظم غيرُ توخِّي معاني النحو فيما بينَ الكلم قد بلغتْ في الوضوح والظهور والانكشافِ إلى أقصى الغاية وإلى أن تكون الزيادةُ عليه كالتكلُّف لِمَا لا يُحتاجُ إليه فإِنَّ النفس تنازعُ إلى تَتّبعِ كلِّ ضربٍ منَ الشُّبهة يرى أنه يعرضُ للمُسلِم نفسَه عند اعتراض الشكِّ . وإنّا لنرى أنَّ في الناس مَن إِذا رأى أنُه يَجري في القياس وضربِ المثَل أن تشبِّه الكلمَ في ضمِّ بعضها إلى بعضٍ بضمِّ غزلِ الإِبريسم بعضِهِ إلى بعضٍ ورأى أن الذي ينسجُ الديباجَ ويعملُ النقشَ والوشْيَ لا يصنعُ بالإِبريسم الذي ينسِجُ منه شيئاً غيرَ أنْ يضمَّ بَعضَه إلى بعض ويتخيّرَ للأَصباغِ المختلفة المواقعَ التي يعلمُ أنه إِذا أوقعَها فيها حدثَ له في نسجهِ ما يريدُ منَ النقش والصورة جرى في ظنِّه أنَّ حالَ الكلمِ في ضمِّ بعضها إلى بعض وفي تخيُّرِ المواقع لها حالُ خيوط الإِبريسم سواءٌ ورأيت كلامَه كلامَ مَن لا يعلم أنه لا يكونُ الضمُّ فيها ضمّاً ولا الموقعُ موقعاً حتى يكونَ قد تَوخَّى فيها معانيَ النحو وأنك إنْ عمدتَ إلى ألفاظٍ فجعلتَ تُتْبع بعضَها بعضاً من غيرِ أن تتوخَّى فيها معانيَ النحو لم تكن صنعَت شيئاً تُدعى به مؤلفاً وتشبَّه معه بمن عَمِلَ نسجاً أو صَنَعَ على الجملة صَنيعاً ولم يتصوَّر أن تكون قد تخيرتَ لها المواقعوفسادُ هذا وشبيههُ منا الظَنِّ وإن كان معلوماً ظاهراً فإِنَّ هاهُنا استدلالاً لطيفاً تكثرُ بسببه الفائدةُ وهو أنه يتصوَّرَ أن يعمدَ عامدٌ إلى نظمِ كلام بعينهِ فيزيلَه عنِ الصورة التي أرادَها الناظمُ له ويفسِدُها عليه من غير أَن يحوِّلَ منه لفظاً عن موضعهِ أَو يبدِلَه بغيره أو يغيرَ شيئاً من ظاهر أمرهِ على حال . مثالُ ذلك أنك إنْ قدَّرتَ في بيتِ أبي تمام - الطويل - :
( لُعابُ الأَفاعي القاتِلاتِ لُعابهُ ... وأَرْيُ الجَنَى اشْتَارتْه أيْدٍ عَواسِلُ ... )
أنَّ " لعابَ الأفاعي " مبتدأ و " لعابُه " خبرٌ كما يوهمُه الظاهر أفسدتَ عليه كلامَه وأبطلتَ الصورةَ التي أرادها فيه وذلك أن الغَرضَ أن يشبِّه مدارَ قلمهِ بلعاب الأفاعي على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات وكذلك الغَرض أن يشبه مدادَه بأَرْي الجنَي على معنى أنه إِذا كَتبَ في العطايا والصِّلات أوصلَ به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها وأَدْخَلَ السرورَ واللذةَ عليها . وهذا المعنى إنما يكونُ إِذا كان " لعابُه " مبتدأ ولعاب الأفاعي خبراً . فأما تقديرُك أن يكونَ " لعاب الأفاعي مبتدأ و " لعابه " خبراً فيبطلُ ذلك ويمنع منه البتَّةَ ويَخْرجُ بالكلام إلى ما لا يجوزُ أن يكونُ مُرادًا في مثل غرضِ أبي تمام وهو أنْ يكون أرادَ أنْ يشبِّه لعابَ الأفاعي بالمدادِ ويشبه كذلك الأرْيَ به . فلو كان حالُ الكلم في ضمِّ بعضِها إلى بعض كحالِ غزْلِ الإِبريسَم لكان ينبغي أن لا تتغيَّرَ الصورةُ الحاصِلةُ من نظم كَلِمٍ حتى تُزال عن مواضِعها . كما لا تتغيرُ الصورةُ الحادثةُ عن ضمِّ غزلِ الإِبريسم بعضِه إلى بعض حتى تُزالَ الخيوطُ عن مواضِعها
واعلمْ أنه لا يجوزُ أن يكونَ سبيلُ قولِه :
( لُعابُ الأفاعي القاتِلاتِ لُعابُه ... )
سبيلَ قولهم : " عتابُك السيفُ " . وذلك أن المعنى في بيت أبي تمام على أنّك تشبِّهُ شيئاً بشيءٍ لجامعٍ بينهما في وصفٍ . وليس المعنى في " عتابُك السيف " على أنك تشبِّه عتابَه بالسيفِ ولكن على أن تزعُمَ أنه يجعلُ السيفَ بدلاً من العتاب . أفلا ترى أنه يصحُّ أن تقول : مدادُ قلمهِ قاتلٌ كسمِّ الأفاعي ولا يصحُّ أن تقولَ : عتابك كالسيفِ اللهم إلاّ أن تخرجَ إلى بابٍ آخرَ وشيءٍ ليس هو غرضَهم بهذا الكلام فتريدَ أنه قد عاتَب عتاباً خَشناً مظلماً . ثم إنك إنْ قلتَ : السيفُ عتابُك خرجتَ به إلى معنًى ثالث وهو أن تزعمَ أن عتابَه قد بلغَ في إيلامهِ وشدَّةِ تأثيرِه مبلغاً صارَ له السيفُ كأنه ليس بسيف
واعلمْ أنَّهُ إنْ نظرَ ناظرٌ في شأنِ المعاني والألفاظِ إلى حالِ السامع فإِذا رأى المعاني تقعُ في نفسِه من بعدِ وقوعِ الألفاظِ في سَمْعِه ظنَّ لذلك أن المعاني تِبْعٌ للألفاظِ في
ترتيبها . فإِنّ هذا الذي بينّاهُ يريهِ فسادَ هذا الظن . وذلك أنه لو كانتِ المعاني تكونُ تِبعاً للألفاظ في ترتيبها لكان مُحالاً أنْ تتغيَّرَ المعاني والألفاظُ بحالها لم تَزُل عن ترتيبها فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغيّر من غيرِ أن تتغيَّرَ الألفاظُ وتزولَ عن أماكِنها علمنا أن الألفاظَ هي التابعةُ والمعاني هي المَتْبوعةَ
واعلمْ أنّه ليس من كلام يعمدُ واضعُهُ فيه إلى معرفتين فيجعلُهما مبتدأ وخبراً ثم يقدِّم الذي هو الخبرُ إِلاّ أشكلَ الأمرُ عليك فيه فَلَم تعلم أنَّ المقدَّم خبرٌ حتى ترجعَ إلى المعنى وتُحسِنَ التدبُّر . أنشدَ الشيخُ أبو علي في " التَّذكرة " - الخفيف - :
( نَمْ وإنْ لم أنمْ كرايَ كراكا ... )
ثم قال : ينبغي أن يكونَ " كراي " خبراً مقدَّماً ويكونَ الأصلُ " كراكَ كرايَ " أي نَم وإن لم أنم فنومُك نومي . كما تقول : قُم وإن جلستَ فقيامُك قيامي . هذا هو عُرْفُ الاستعمال في نحوِه . ثم قال : وإِذا كان كذلك فقد قدَم الخبرَ وهو معرفةٌ وهو يَنوي به التأخير من حيث كان خبراً . قال : فهو كبيتِ الحماسةِ - الطويل - :
( بَنونا بَنو أَبْنائِنا وبَناتُنا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجالِ الأَباعِدِ )
فقدَّم خبرَ المبتدأ وهو معرفة . وإنما دلَّ على أنه ينوي التأخيرَ المعنى ولولا ذلك لكانتِ المعرفةُ إذا قدِّمتْ هي المبتدأ لتقدُّمها فَافْهَمْ ذلك . هذا كلّه لفظُه
واعلمْ أنَّ الفائدةَ تعظُم في هذا الضَّرب من الكلام إذا أنت أحسنتَ النظرَ فيما ذكرتُ لك من أنك تستطيعُ أن تنقلَ الكلامَ في معناه عن صورةٍ إلى صورةٍ من غير أن تُغيِّر من لفظِه شيئاً أو تحوّلَ كلمةً عن مكانها إلى مكانٍ آخرَ وهو الذي وَسِعَ مجالَ التأويل والتفسير حتى صاروا يتأوَّلون في الكلام الواحد تأويلين أو أكثر ويفسِّرون البيتَ الواحدَ عدّةَ تفاسير وهو على ذاك الطريقُ المُزِلَّةُ الذي ورَّط كثيراً من الناس في الهَلَكة . وهو مما يعلمُ به العاقلُ شدَّةَ الحاجة إلى هذا العلم وينكشفُ معه عَوارُ الجاهلِ به ويُفْتضَحُ عنده المُظْهِرُ الغنى عنه . ذاك لأنه قد يُدْفَع إلى الشيءِ لا يصحُّ إلا بتقديرِ غيرِ ما يُريه الظاهر . ثم لا يكونُ له سبيلٌ إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلاً بهذا العلم فيتسكَّع عند ذلك في العَمَى ويقع في الضَّلال . مثالُ ذلك أنَّ من نظَرَ إلى قوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنَى ) . ثم لم يعلمْ أنْ ليس المعنى في " ادعوا " الدعاءَ ولكنِ الذِّكرَ بالاسم كقولك : هو يُدْعى زيداً ويدعى الأميرَ . وأنَّ في الكلام محذوفاً وأنَّ التقديرَ : قُل أدعوه اللهَ أو ادعوه الرحمنَ أياًّ ما تدعوا فله الأسماءُ الحسنى كان بعُرض أن يقعَ في الشِّرْكِ من حيثُ إنه إنْ جرى في خاطره أنَّ الكلامَ على ظاهره خرجَ ذلك به - ولعياذُ بالله تعالى - إلى إثباتِ مدعوين تعالى عن أن يكونَ له شريك . وذلك من حيثُ كان محالاً أن تعمدَ إلى اسمين كلاهما اسمُ شيءٍ واحدٍ فتعطِفَ أحدَهما على الآخر فتقول مثلاً : ادعُ لي زيداً الأمير - والأميرُ هو زيد . وكذلك محالٌ أن تقولَ : " أياًّ تدعو " وليس هناك إلاّ مدعوٌّ واحدٌ لأن من شأن " أي " أن تكون أبداً واحداً من اثنين أو جماعةٍ ومن لم يكن له بدٌّ من الإِضافة إما لفظاً وإما تقديراً
وهناك بابٌ واسع منَ المُشكِل فيه قراءةُ مَن قرأ ( وقالَتِ اليَهُودُ عُزَيرُ ابْنُ اللهِ ) بغيرِ تنوين وذلك أنَّهم قد حَملوها على وجهينِ :
أَحدُهما أن يكونَ القارىءُ له أرادَ التنوينَ ثم حَذَفه لالتقاءِ الساكَنْين ولم يحركه كقراءة من قرأ : ( قُلْ هوَ اللهُ أحدُ اللهُ الصَّمدُ ) بتركِ التَنوين من " أحد " : وكما حُكي عن عُمارةَ بنِ عَقيلٍ أنه قرأ ( ولا الليلُ سابقُ النَّهارَ ) بالنصب فقيلَ له : ما تريدُ فقال : أريدُ " سابقٌ النهار " . قيل : فهلاّ قلتَه . فقال : فلو قلتُه لكان أوزَنَ . وكما جاءَ في الشعر من قوله - المتقارب - :
( فألفيتُهُ غَيْرَ مُسْتعتِبٍ ... ولا ذاكِرَ اللهَ إلاّ قليلاً )
إلى نظائرِ ذلك . فيكونُ المعنى في هذه القراءة مثلَه في القراءة الأخرى سَواء
والوَجهُ الثاني : أن يكون الابنُ صفةً ويكونَ التنوينُ قد سقط على حدِّ سقوطه في قولنا : جاءني زيدُ بنُ عمرٍو ويكونَ في الكلام محذوف . ثم اختلفوا في المحذوف فمنهم من جعله مبتدأ فقدّر " وقالتِ اليهودُ هو عُزيرُ ابنُ الله " ومنهم من جَعَله خبراً فقدَّر وقالت اليهودُ : " عزيرُ ابنُ الله معبودنا " وفي هذا أمرٌ عظيم . وذلك أنك إِذا حكَيْتَ عن قائل كلاماً أنتَ تريدُ أن تكذِّبه فيه فإِن التكذيبَ ينصرفُ إلى ما كان فيه خبراً دون ما كان صفة . تفسيرُ هذا أنك إِذا حكَيْتَ عن إنسانٍ أنَّه قال : زيدُ بنُ عمرٍو سيّدٌ ثم كذَّبته فيه ولم تكن قد أنكرتَ بذلك أن يكون زيدَ بنَ عمرٍو ولكن أنْ يكونَ سيداً . وكذلك إذا قال : زيدٌ الفقيهُ قد قَدِم فقلتَ له : كذبتَ أو غلطتَ لم تكن قد أنكرتَ أن يكون زيدٌ فقيهاً ولكن أن يكون قد قدم
هذا ما لا شُبهة فيه وذلك أنك إذا كذَّبت قائلاً في كلامٍ أو صدّقتَه فإِنما ينصرفُ التكذيبُ منك والتصديقُ إلى إثباته ونفيهِ . والإِثباتُ والنفيُ يتناولان الخبرَ دونَ الصفة يدلُّك على ذلك أنك تجدُ الصفةَ ثابتةً في حالِ النفي كثبوتِها في حال الإِثبات . فإِذا قلتَ : ما جاءني زيدٌ الظريفُ كان الظَّرفُ ثابتاً لزيدٍ كثبوته إذا قلت : جاءني زيدٌ الظريف . وذلك أنْ ليس ثبوتُ الصفة للذي هي صفةٌ له بالمتكلم وبإِثباته لها فتنتفي بنفيهِ . وإنما ثبوتُها بنفسها
وبتقرُّر الوجود فيها عندَ المخاطب مثلَه عند المتكلم لأنه إذا وقعتِ الحاجةُ في العلم إلى الصفةِ كان الاحتياجُ إليها من أجل خِيفَةِ اللَّبس على المخاطَب . تفسيرُ ذلك أنك إذا قلتَ جاءني زيدٌ الظريفُ فإِنك إنما تحتاجُ إلى أن تصفَه بالظريفِ إذا كان فيمن يجيءُ إليك واحدٌ آخرُ يسمى زيداً . فأنت تَخْشى إنْ قلتَ : جاءني زيدٌ ولم تقل " الظريف " أنْ يلتبسَ على المخاطب فلا يدري : أهذا عنيتَ أم ذاك وإذا كان الغرضُ من ذكرِ الصفة إزالةَ اللبس والتبيين كان مُحالاً أن تكونَ غيرَ معلومةٍ عند المخاطب وغيرَ ثابتة . لأنه يؤدي إلى أنْ تروم تبيينَ الشيءِ للمخاطب بوصفٍ هو لا يعلمُه في ذلك الشيء وذلك ما لا غايةَ وراءه في الفساد . وإذا كان الأمرُ كذلك كان جعل الابنِ صفةً في الآية مُؤديًا إلى الأمرِ العظيم وهو إخراجُه عن موضعِ النفي والإِنكار إلى موضع الثبوتِ والاستقرارِ . جلَّ الله تعالى عن شَبَه المخلوقين وعن جميعِ ما يقول الظالمون علوّاً كبيراً
فإِن قيلَ : إن هذه قراءةٌ معروفةٌ والقولَ بجواز الوصفية في الابن كذلك معروفٌ ومدوَّن في الكتبِ وذلك يقتضي أن يكونوا قد عرفوا في الآيةِ تأويلاً يدخُلُ به الابنُ في الإِنكار مع تقديرِ الوصفية فيه قيل : إن القراءةَ كما ذكرتَ معروفةٌ والقولَ بجواز أن يكونَ الابنُ صفةً مُثبتٌ مسطورٌ في الكتبِ كما قلتَ . ولكنَّ الأصلَ الذي قدَّمناه من أنَّ الإِنكارَ إِذا لَحِق الخبرَ دونَ الصفة ليس بالشيءِ الذي يعترضُ فيه شكٌّ أو تتسلطُ عليه شُبهة . فليس يتَّجه أن يكونَ الابنُ صفة ثم يلحقُه الإِنكارُ مع ذلك إلاّ على تأويلٍ غامضٍ وهو أن يقالَ : إنَّ الغرضَ الدَّلالةُ على أنَّ اليهودَ قد كان بلغَ من جهلِهم ورسوخِهم في هذا الشِّرْك أنهم كانوا يذكرون عُزيراً هذا الذكرَ . كما تقولُ في قومٍ تريدُ أن تصفَهُم بأنهم قد اسْتَهلكوا في أمْرِ صاحِبهم وغَلَوا في تعظيمه : إني أراهُم قد اعتقدوا أمراً عظيماً فهم يقولون أبداً زيدٌ الأميرُ تريدُ أنه كذلك يكون ذكرُهم إذا ذكروه إلاّ أنه إنما يستقيمُ هذا التأويلُ فيه إذا أنتَ لم تقدِّر له خبراً معيناً ولكن تريدُ أنهم كانوا لا يُخبِرُون عنه بخبرٍ إلاّ كان ذكرُهم له هكذا
وممّا هو من هذا الذي نحنُ فيه قولُه تعالى : ( ولا تَقُولوا ثلاثةٌ انْتَهَوْا خَيْراً لكُم )
وذلك أنَّهم قد ذهبوا في رَفْعِ ثلاثةٍ إلى أنها خبرُ مبتدأ محذوف وقالوا : إنَّ التقديرَ " ولا تقولوا آلهَتُنا ثلاثةٌ " وليس ذلك بمستقيم . وذلك أنّا إذا قلنا : " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة " كان ذلك - والعياذ بالله - شبه الإِثبات أن هاهُنا آلهةً من حيثُ إنك إذا نفيتَ فإنما تَنفي المعنى المستفادَ من الخبر عن المبتدأ ولا تنفي معنى المبتدأ . فإِذا قلتَ : ما زيدٌ منطلقاً كنتَ نفيتَ الانطلاقَ الذي هو معنى الخبر عن زيدٍ ولم تنفِ معنى زيد ولم توجبْ عدمَه . وإِذا كان ذلك كذلك فإِذا قلنا : " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة " كنا قد نفينا أن تكونَ عدَّةُ الآلهةِ ثلاثةً ولم ننفِ أن تكون آلهة - جلَّ الله تعالى عن الشَّريك والنَّظير - كما أنك إِذا قلتَ : ليس أمراؤنا ثلاثةً كنت قد نفيتَ أن تكونَ عدَّةُ الأمراء ثلاثة ولم تنفِ أن يكون لكم أمراء هذا ما لا شبهة فيه وإذا إن أدى هذا التقدير إلى الفساد وجب أن يعدل عنه إلى غيره والوجه - والله أعلمُ - أن تكونَ " ثلاثة " صفةَ مبتدأ لا خبرَ مبتدأ ويكون التقديرُ : " ولا تقولوا لنا آلهةٌ ثلاثة أو في الوجود آلهة ثلاثة ثم حذف الخبر الذي هو " لنا " أو في الوجود كما حذف من ( لا إله إلا الله ) و ( ما مِن إلهٍ إلاّ الله ) فبقي : ولا تقولوا : آلهةٌ ثلاثةٌ ثم حذف المصوفُ الذي هو آلهة فبقي " ولا تقولوا ثلاثة " . وليس في حذفِ ما قدَّرنا حذفه ما يتوقَّف في صحته . أما حذفُ الخبر الذي قلنا إنه " لنا " أو " في الوجود " فمطَّردٌ في كلِّ ما معناهُ التوحيدُ ونفيُ أن يكون مع الله - تعالى عن ذلك - إلهٌ
وأما حذفُ المصوف بالعدد فكذلك شائعٌ . وذلك أنه كما يسوغُ أن تقولَ : عندي ثلاثة وأنت تريدُ ثلاثَة أثوابٍ . ثم تحذفُ لعلمك أن السامعَ يعلم ما تريدُ . كذلك يسوغُ أن تقول : عندي ثلاثةٌ وأنت تريدُ ( أثواب ثلاثة ) لأنه لا فصلَ بين أن تجعلَ المقصودَ بالعدد مميَّزاً وبين أن تجعلَه موصوفاً بالعدد في أنه يحسنُ حذفُه إذا عُلِم المراد . ويُبَيِّنُ ذلك أنك ترى المقصودَ بالعدد قد تُرك ذكرُه ثم لا تستطيعُ أن تقدره إلاَّ موصوفاً وذلك في قولك : عندي اثنانِ وعندي واحدٌ يكون المحذوف هاهنا موصوفاً لا محالةَ نحو : عندي رجلانِ اثنان وعندي دِرْهَمٌ واحدٌ . ولا يكون مميزاً البتةَ من حيثُ كانوا قد رفضوا إضافةَ الواحدِ والاثنين إل الجنسِ فتركوا أن يقولوا : واحدٌ رجالٌ واثنان رجالٌ على حَدِّ " ثلاثة رجال " . ولذلك كان قولُ الشاعر - الرجز - :
( ظَرْف عَجُوزٍ فيه ثِنْتا حَنْظَلِ ... )
شاذاً . هذا ولا يمتنِعُ أن تجعلَ المحذوف من الآية في موضعِ التمييز دونَ موضعِ الموصوفِ فتجعلَ التقدير : " ولا تقولوا ثلاثة آلهة " ثم يكونَ الحكمُ في الخَبرِ على ما مضى ويكونَ المعنى - واللهُ أعلمُ - " ولا تقولوا لنا أو في الوجود ثلاثة آلهة "
فإِن قلتَ : فلمَ صار لا يلزمُ على هذا التقديرِ ما لَزِمَ على قولِ من قدَّر : " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة " فذاك لأنَّا إذا جعلنا التقديرَ : ولا تقولوا لنا أو في الوجود آلهةٌ ثلاثة أو ثلاثة آلهة كنّا قد نفينا الوجودَ عن الآلهة كما نفيناه في ( لا إلهَ إلاّ الله ) و ( وما مِنْ إلهٍ إلاّ اللهُ ) . وإِذا زعموا أنَّ التقدير " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة " كانوا قد نَفَوا أنْ تكون عدَّةُ الآلهةِ ثلاثةً ولم ينفوا وجودَ الآلهة . فإِنْ قيلَ : فإِن يَلْزَم على تقديرك الفسادُ من وجهٍ آخَرَ وذاك أنَّه يجوزُ إذا قلتَ : " ليس لنا أمراء ثلاثة " أنْ يكونَ المعنى ليس لنا أمراء ثلاثة ولكن لنا أَميرانِ اثنان . وإذا كان كذلك كان تقديرُك وتقديرُهم جميعاً خطأ . قيل : إنَّ هاهنا أمراً قد أغفلتَه وهو أنَّ قولهم آلهتنا : يوجِبُ ثبوتَ آلهةٍ جلَّ اللهُ تعالى عمّا يقولُ الظالمون علوَّاً كبيراً
وقولنا : ليس لنا آلهةٌ لا يوجبُ ثبوتَ اثنينِ البتةَ . فإِن قلت : إن كانَ لا يوجبَه فإنه لا ينفيه . فقيلَ : ينفيه ما بعدَهُ من قوله تعالى : ( إنّما اللهُ إلهٌ وَاحِدٌ ) . فإِن قيل : فإِنَّه كما ينفي الإِلهين كذلك ينفي الآلهة . وإِذا كان كذلك وجبَ أن يكون تقديرُهم صحيحاً كتقديرك . قيل : هو كما قلتَ : ينفي الآلهةَ . ولكنَّهم إذا زعموا أن التقديرَ " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة " وكان ذلك - والعياذُ بالله - من الشِّرْك يقتضي إثباتَ آلهة كانوا قد دفعوا هذا النفيَ وخالفوه وأخرجوه إلى المُناقضة . فإِذا كان كذلك كان مُحالاً أنْ يكونَ للصحَّة سبيلٌ إلى ما قالوه وليس كذلك الحالُ فيما قدَّرناه لأنَّا لم نقدرْ شيئاً يقتضي إثباتَ إلهين - تعالى الله - حتى يكونَ حالنا حالَ من يدفعُ ما يوجِبُه هذا الكلامُ من نفيهما . يبيِّن لك ذلك أنه يصحُّ لنا