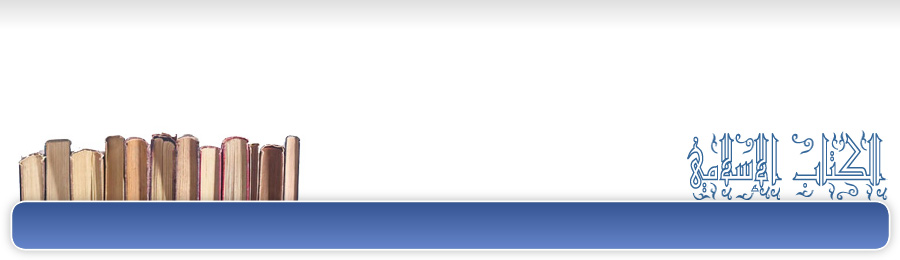كتاب : المعتمد في أصول الفقه
المؤلف : محمد بن علي بن الطيب البصري
فيه وإنما أثبت الربا فيه بالرد إلى غيره وإن ألزمنا أن نقيس الربا في البر لا على شيء فقد ألزم ما لا يعقل لأن المعقول من القياس أن يكون قياسا على شيء ويقال لهم إذا جاز قياس شيء على شيء جاز ما لا يتصور من قياس شيء لا على شيء وعلى أن المخالف لم يقصد إلزامنا ما لا يعقل وإنما قصد إلزامنا ما يعقل مما تحظره الحكمة لأنه قال لا يجوز أن يتعبد بالظن في المصالح وهذا إن امتنع فانما يمتنع من جهة الحكمة لا لأنه لا يعقل
ومنها قولهم الشرعيات مصالح فلو جوزنا إثباتها بالأمارات مع أنها قد تخطىء جاز أن يخبر بأن زيدا في الدار إذا دلت الأمارات على كونه فيها وإن كانت الأمارات قد تخطىء وتصيب والجواب حكى قاضي القضاة عن الشيخ ابي عبد الله رحمهما الله التسوية بين الأمرين قال لأنه كما نجوز أن بنصب الله تعالى أمارة على شبه الفرع بالأصل فاذا غلب على ظننا شبهه به تعبدنا بالعلم بوجوب إلحاقه به في حكمه وبالعمل به فكذلك نجوز أن ينصب على كون زيد في الدار أمارة فاذا ظنناه في الدار جاز أن يتعبدنا بأن ننتقل عن ظن كونه فيها إلى العلم لكونه فيها ويتعبدنا بالخبر عن كونه فيها فلم يفرق بينهما
ولقائل أن يقول إنه لم يسو بينهما لأن الأمارة الدالة على كون زيد في الدار نظيرها الأمارة الدالة على شبه الفرع بالأصل فيما هو علة الحكم ونحن لا ننتقل عن الظن لشبه الفرع بالأصل إلى القطع على ذلك فكيف قال إنه يجوز أن يتعبدنا أن ننتقل عن الظن لكون زيد في الدار إلى العلم بأنه فيها كما فعلنا في القياس وهو لم يفعل مثل ذلك في القياس وأيضا فان جاز مع كون الأمارة قد تخطىء وتصيب أن يستمر الحال في إصابتها في دلالتها على كون زيد في الدار جاز مع أن الاختيار قد يخطىء ويصيب أن تستمر إصابته للحق وإن جاز أن يتفق إصابة الأمارة في شيء من الأشياء فتتعبد بها في ذلك الشيء بالقطع على حكمها جاز مثله في الاختيار إذا اتفق إصابته الحق في موضع واحد وفي ذلك موافقة مويس بن عمران
وحكي عن الشيخ أبي هاشم أنه منع من التعبد بالأخبار عن كون زيد في الدار ويمكن نصرة ذلك فنقول إن أراد السائل إلزامنا جواز الخبر عن ظننا كون زيد في الدار فذلك جائز وهو خبر صدق وإن أراد إلزامنا الإخبار عن كون زيد في الدار على الإطلاق لا بحسب الظن فذلك غير لازم لأن من شرط حسن الخبر أن يكون صدقا والخبر عن أن زيدا في الدار لا يكون حسنا إلا وهو صدق وليس معنى كونه مصدقا أن نفعله ونحن ظانون أن زيدا في الدار بل معنى كونه صدقا أن يكون متناولا لكون زيد في الدار ويكون زيد فيها وقد يظن المخبر أنه فيها ولا يكون فيها فمتى أخبر والحال هذه عن كونه فيها على سبيل القطع كان مقدما على خبر لا يأمن كونه كذبا وذلك قبيح وأما العبادات الشرعية فهي مصالح وقد يكون الفعل يصلح إذا فعلناه ونحن على صفة ما ومتى لم يكن مصلحة فلا يمتنع أن يكون فعلنا الفعل ونحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة وإذا لم ننظر حتى نظن شبهه به أو بغيره فاتتنا المصلحة فاذا تعبدنا الله عز و جل بذلك علمنا بتعبده أن المصلحة هو أن نفعل بحسب ظننا
وهكذا الجواب إذا قيل لنا جوزوا أن تدل أمارة على أن العموم مستغرق وتخبرون بذلك على سبيل القطع لأن معنى كونه مستغرقا هو أن العرب وضعته للاستغراق وكذلك الخبر عن أن الله عز و جل لا يرى لأجل أمارة وليس يختلف ذلك بحسب ظننا كما يجوز أن تختلف المصالح بحسب ظننا
فان قيل أتجوزون أن يدلكم أمارة على أن العرب وضعت ألفاظ العموم للاستغراق فيلزمكم أن تستدلوا به على الأحكام قيل لا يمتنع ذلك ولا أعرف فيه نصا عن شيوخنا لأنه إن جاز أن نستدل بقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا ظننا أنه قاله جاز أن نستدل إذا ظننا أن العرب وضعته للاستغراق
فان قيل أفتجوزون أن يجب عليكم عبادة الله إذا ظننتم وجوده بأمارة وأن تقتصروا على الظن في ذلك قيل لا يجوز ذلك لأنه إنما تجب معرفته
لأنها لطف ونحن مع المعرفة والعلم به ابعد من القبيح ومتى أمعن الإنسان في النظر وصل إلى العلم به فلزم الإنسان ذلك لأنه يلزمه كل ما معه يكون أبعد من القبيح ومن المضار ويمكنه ذلك بالإمعان في النظر
فان قيل أيجوز أن لا يمكنه ذلك بأن لا تنصب له دلالة عليه وتنصب له أمارة قيل هذا محال لأن جسم الإنسان دلالة على الله تعالى فكيف يجوز والحال هذه أن لا يكون الإنسان دلالة على ربه
ومنها قولهم إن المصالح لا يتوصل إليها بالاستدلال ولكن بالنصوص فكيف يتعبد فيها بالقياس الجواب أنهم إن أرادوا أن المصالح لا يتوصل إليها بالاستدلال أصلا فذلك باطل بالاستدلال بالنصوص وإن أرادوا الاستدلال بالأمارات قيل أتريدون الأمارات التي لا تستند إلى اصول منصوصة فان قالوا نعم فكذلك نقول وإن قالوا نريد الأمارات المستندة إلى اصول منصوصة فهو نفس المسألة فقد استدلوا على صحة قولهم بقولهم
ومنها قولهم إن الأمارة والظن قد يخطئان ولا يجوز أن يتعبد الحكيم في المصالح بما يجوز أن يخطىء المصالح الجواب أنا لا نقول إنا نظن المصلحة فيلزم ما ذكرتم وإنما نقول إن عملنا بحسب الظن هو المصلحة وذلك معلوم بدليل قاطع وهو دليل التعبد بالقياس على أن ما ذكروه منتقض بما تعبدنا فيه بالظن في الشرع والعقل كالشهادات والتصرف في المنافع والمضار لأنا قد نتصرف ونحن نظن المنفعة فيؤدي ذلك إلى المضرة ويحسن ذلك وإن أمكن أن يدلنا الله عز و جل على ما فيه منافعنا بدليل قاطع أو يعلمنا الله عز و جل ذلك ضرورة وقد أجاب قاضي القضاة رحمه الله عن الشبهة بأن المصالح إنما يتوصل إليها بالنصوص لا غير لكن بعضها يتوصل إليه بنص ظاهر وبعضها يتوصل إليه بنص خفي يفتقر إلى الاستدلال حتى يعلم أن الحكم مراد به وما علم بالقياس من هذا القبيل ولقائل أن يقول إنه لا معنى لقولكم إن النص دل على حكم الفرع وأنكم احتجتم إلى استدلال لتعلموا أنه مراد بالنص إلا
أن النص دل على حكم الأصل ثم استخرجتم علة الحكم وقستم بها بعض الفروع وهذا الذي أنكرناه
ومنها قولهم القياس فعلنا ولا يجوز التوصل إلى المصالح بفعلنا الجواب أن القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم ولا بد في ذلك من أمارة يستدل بها على علة الأصل ومن دليل يدلنا على وجوب إلحاق حكم الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الحكم ولا بد من نظر في هذه الدلالة وفي الامارة فان أرادوا بقولهم إن القياس فعلنا إثباتنا حكم الأصل في الفرع فذلك هو اعتقادنا وليس هو الذي توصلنا به إلى المصالح بل إنما توصلنا إلى هذا الاعتقاد بغيره وإن أرادوا الدليل الدال على وجوب إلحاق الفرع بالأصل أو الأمارة الدالة على صحة العلة فذلك ليس بفعلنا وإن أرادوا النظر في الدليل والأمارة فلعمري إنه فعلنا وليس يمتنع أن نتوصل به إلى المصالح إذا وقع في دليل كما أن النصوص تؤدي إلى المصالح بشرط وقوع النظر فيها وبالجملة فكل ظن وكل علم مكتسب فانما يتوصل إليه بالنظر وهو فعلنا
ومنها قولهم جلى الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالنصوص فلم يجز إثبات خفيها إلا بالنص أيضا لأن ما علم جليه بطريق فخفيه لا يعلم إلا بذلك في الطريق كالمدركات لا يعلم جليها وخفيها إلا بالإدراك الجواب يقال لهم ولم إذا كانت المدركات كذلك كانت غيرها مثلها أليس ما عدا الشرعيات يعلم جليه بالإدراك والضرورة ويعلم خفيه بالاستدلال دون الإدراك وجلى الشرعيات تعلم بالنصوص الظاهرة وخفيها تعلم بنص خفي وكثير من الزعفران الواقع في الماء يعلم بالإدراك وخفيه يعلم بخبر من شاهد وقوعه فيه فان قالوا أليس قد استند ذلك إلى المشاهدة قيل فكذلك أحكام الفروع تستند إلى الأحكام الثابتة بالنصوص وأجاب قاضي القضاة عن الشبهة بما ذكرناه من وقوع الزعفران في الماء وبأن جميع الشرعيات تعلم
بالنص لكن بعضها تعلم بظاهر النص وبعضها تعلم استدلالا بالنص وما علم بالقياس هو من القسم الثاني ولهم أن يقولوا إن النص لا يتناول إلا حكم الأصل وليس فيه ذكر لحكم الفرع ولو كانت الفروع معلومة بالنصوص لأنه لا بد منها لكانت العقليات المكتسبة معلومة بالإدراك لأنه لا بد منه في العلم بها
ومنها قولهم لو كانت للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية في الاستحالة انفكاكها من أحكامها في كل حال ألا ترى أن الحركة يستحيل وجودها وليس الجسم متحركا وفي ذلك ثبوت الأحكام الشرعية قبل الشرع الجواب أنهم جمعوا بين العلل العقلية والشرعية من غير جامع وأيضا فان عنوا بالحركة تحرك الجسم فذلك إنما وجب كون الجسم معه متحركا لأن كون الجسم إذا تحرك هو معنى كونه متحركا فالقول بأن فيه حركة وليس هو متحرك مناقضة وإن عنوا بالحركة معنى يوجب كون الجسم متحركا كما يقوله أصحابنا فذلك ذات موجبة كون الجسم متحركا ولا يجوز وقوف ايجابها على شرط لأنها لو وجدت من دون إيجاب لنا انفصل وجودها من عدمها وأما العلل الشرعية فانها إما أن تكون وجه المصلحة وإما أن تكون أمارة يصحبها وجه المصلحة فان كانت وجه المصلحة فمعلوم أن وجه المصلحة يجوز أن يقتضي المصلحة بشرط يختص بعض الأزمان دون بعض ألا ترى أن مصلحة الصبي في وقت الرفق ومصلحته في وقت العنف ولهذا اختلف شرائع الأنبياء وصح نسخ العبادات فلم يمتنع أن يكون الشرط في كون العلل الشرعية موجبة للمصلحة لا يحصل قبل الشريعة فلا تثبت المصلحة قبل الشريعة وإن كانت العلل الشرعية امارات تصحب وجه المصلحة وكان وجه المصلحة قد يقف على شرط يرجع إلى أحوال المكلف ويختص ببعض الأزمان كانت الأمارة التي تصحب وجه المصلحة تختص كونها أمارة أيضا ببعض الأزمان دون بعض فان قيل بماذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة الشرعية قيل بتعليق النبي عليه السلام الحكم عليها إما نصا وإما تنبيها كما نعلم تعلق
الحكم بالاسم بتعليق النبي عليه السلام الحكم عليه وذلك غير حاصل قبل الشريعة فلم يثبت قبل الشرع
ومنها قولهم العقل كالنص في أنه يدل على حكم الحادثة فكما لا يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس المخالف لنص معين فكذلك لا يجوز أن يتعبدنا بقياس يخالف حكم العقل وكل حادثة فلها حكم في العقل فاذن لا يجوز أن يتعبد فيها بالقياس الجواب أن هذا منتقض بخبر الواحد لأنه لا يجوز استعماله في خلاف نص القرآن ويجوز أن ينتقل به عن حكم العقل على أن ما ذكروه لا يمنع من التعبد بقياس مطابق لما في العقل على أن النص المعين لو تركناه بالقياس كنا قد ألغينا كلام الحكيم لأنه اقتضى الحكم مطلقا والعقل فانما اقتضى الحكم ما لم ينقلنا عن دليل شرعي فمن أين لهم أن القياس ليس بدليل شرعي وهل نوزعوا إلا في ذلك
ومنها قولهم إن الحكيم لا يقتصر بالمكلف على أدون البيانين مع قدرته على أعلاهما والقياس أدون بيانا من النص الجواب أن في هذا الكلام تسليم أن القياس بيان فلا يمتنع أن تكون فيه مصلحة زائدة وإن كان أدون بيانا من غيره ولو وجب التعبد بأعلى الباينات لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة أو الاقتصار بنا على النصوص الجلية المتواترة دون الآحاد لأنها أعلى بيانا من الخفية
ومنها قولهم نظر القائس لا بد من أن يقع في منظور فيه وليس إلا النص أو الحكم وليس يجوز أن يقع في النص لأن النص لا يتناول الفرع ولا يجوز وقوعه في الحكم لأن الحكم هو فعل المكلف فكان ينبغي لو لم يوجد فعل من المكلف أن لا يصح منه الذي يحصل من القائس هو نظر في الأمارات الدالة على العلل وقد تكون الأمارة كيفية في الحكم نحو ان يحصل الحكم بحسب حصول صفة وينتفي عند انتفائها في الأصل أو يكون لصفة من الصفات تأثير في الاصول فالنظر في ذلك يقتضي كون تلك الصفة علة والنظر في حصولها في
الفرع يؤدي إلى إلحاقه بالأصل وليس الحكم هو فعلنا بل كون الفعل واجبا وقبيحا وذلك متصور متوهم يمكن النظر في حصوله بحسب صفة من الصفات وجد الفعل أو لم يوجد
ومنها قولهم لو جاز أن يكون القياس صحيحا لكان حجة مع النص الجواب أن ذلك دعوى ومع ذلك فإن أرادوا أنه يكون حجة مع النص على حكم الأصل فكذلك نقول وإن أرادوا مع النص على خلاف حكمه في الفرع فقد بينا القول في ذلك في الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول على انه لا يمتنع أن يكون حجة إذا انفرد وإذا عارضه النص كان النص أولى منه كما أن خبر الواحد حجة إذا انفرد وإذا اجتمع مع الخبر المتواتر ومع نص القرآن كانا أولى وإن أرادوا النص على مثل حكمه في الفرع فانا نجوز ذلك لأنه إن كان النص خبر واحد فهو أمارة وكذلك القياس المطابق له وإن كان النص خبرا متواترا فالقياس حجة في الفرع بمعنى أنه لو فقدنا النص المتواتر لوجب الحكم لمكان القياس
ومنها أنه لو جاز التعبد بالقياس لجاز أن يتعبد به النبي عليه السلام ومن حضره ولصح به النسخ الجواب أن كل ذلك مجوز في العقل
ومنها لو جاز التعبد بتحريم شيء لظننا شبهة بأصل محرم جاز أن نتعبد بتحريمه إذا ظننا شبهة بالأصل من غير أمارة أو اعتقدنا شبهة تنحيتا وإذا اشتهينا تحريمه وإذا اخترنا ذلك أو شككنا في كونه مشبها له لأنه إذا جاز أن تكون مصلحتنا أن نفعل بحسب شهوتنا وشكنا واختبارنا الجواب أن العمل بالقياس مبني على ما تقرر في العقل من حسن التصرف في الدنيا بحسب ظن النفع وانفاع الضرر إذا كان الظن صادرا عن امارة كما تقرر حسن ذلك في العقل فقد تقرر فيه قبح تحمل المشاق لأجل الشهوات والهوى والاختيار ولأجل ظن لا أمارة له وتقرر في العقل أن الإقدام على الفعل مع الشك في مضرته لا يحسن إلا بعد البحث ومتى أقدم الإنسان من غير بحث ذمه
العقلاء وليس كذلك إذا ظن اندفاع مضرة لأجل أمارة صحيحة وأما إذا شك في حصوله وجه القبح في الشيء كشكه في كون الخبر كذبا فانه يقبح منه فقد عمل في هذا الموضع على الشك وإذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فمالك عمل على الشك فأوجب الطهارة وغيره من الفقهاء عمل على الأصل ولكل وجه في التعبد فقد جاز العمل على الشك على بعض الوجوه
ومنها قولهم لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على علته أمارة ولا يجوز أن تكون عليها أمارة فاذا لا يجوز التعبد به وإنما لم تكن على علته أمارة لأن الأمارة إما أن تدل عليها العادات أو النصوص وكلامنا في قياس ليست علته ولا أمارتها منصوص عليها فلم يجز أن يكون النص طريقا إلى أمارة القياس المستنبطة علته ولما لم تكن الأحكام الشرعية ثابتة بالعادات لم تكن عللها وأماراتها ثابتة بالعادات يقال لهم ولم لا يجوز أن يكون الطريق إلى ذلك تنبيه الشرع وعاداته لأن الشرع يدل تصريحه وقد يدل تنبيهه فاذا علمنا أن الحكم يثبت في الأصل عند وصف وينتفي عند انتفائه غلب على ظننا أنه لأجله ثبت وكذلك إذا كان الوصف مؤثرا في جنس ذلك نحو البلوغ المؤثر في رفع الحجر في المال كان اولى بأن يرفع الحجر في النكاح ولا شبهة في حصول الظن عند هذه الأمارات
باب في أنه كان يجوز من جهة العقل أن يتعبد الله الأنبياء بالقياس
والاجتهاداعلم أن اجتهاد النبي عليه السلام إن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد الله عز و جل فذلك جائز لا شبهة فيه وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية فالأمارات الشرعية ضربان أخبار آحاد وذلك لا يتأتى في النبي عليه السلام والآخر الأمارات المستنبطة التي يجمع بها بين الفروع والاصول وهذا هو الذي يشتبه الحال فيه هل كان يجوز تعبد النبي عليه السلام فالصحيح جوازه لأنه كما يجوز في العقل أن تكون مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة
وبالنص أخرى جاز مثله في النبي صلى الله عليه و سلم وليس يحيل العقل ذلك في النبي صلى الله عليه و سلم ويصححه فينا كما لا يصححه في زيد ويمنع منه في عمرو ولهذا جاز أن يجب علينا وعليه العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها
فان قيل إن اجتهاد النبي صلى الله عليه و سلم يختص بوجه قبح لأنه ينفر عنه من وجهين أحدهما أنه إذا علم أنه يثبت الأحكام باجتهاده نفر عنه والثاني أنه إذا ثبت الحكم باجتهاده كان للعالم أن يخالفه ووجب إذا أفتى العامي أن يخبره وذلك أبلغ ما ينفر عنه الجواب انه لا تنفير في إثباته الحكم باجتهاده لأن المجتهد ليس يجتهد من قبل نفسه لكنه يعتقد أن الله عز و جل حكم بذلك الحكم وأنه استدل بتنبيه الله عز و جل إياه فأي تنفير في الاستدلال على مراد الله عز و جل وأما مخالفة العالم والعامي له فلا يجوز كما لا يجوز مخالفتهما الإجماع
إن قيل لو وجب على غيره الأخذ بقوله والقطع عليه لوجب ذلك لكونه نبيا وذلك يقتضي أن يقطع هو على قول نفسه لعلمه أنه نبي وقطعه على قول نفسه يخرجه عن ان يكون من جملة الاجتهاد المفضي إلى الظن قيل قد أجاب قاضي القضاة رحمه الله بأن كونه نبيا يكون دلالة لغيره على القطع ولا يكون دلالة لنفسه قال ولا يتنافى ذلك وهذا لا يصح لأن الدليل لا يجوز ان يدل مكلفا دون مكلف مع اشتراكهما في العلم بشرائطه وليس يعلم غير النبي عليه السلام من شرائط الاستدلال على أن النبي عليه السلام مصيب قطعا ما لا يعلم النبي فكيف يكون كونه نبيا دلالة قاطعة لغيره ولا يكون دلالة له ونحن نقول في ذلك إنه إذا كان الله عز و جل إنما كلف المجتهد الحكم بأشبه الأمارتين ومكنه من الوصول إلى ذلك بأن ينظر النظر الصحيح فالنبي عليه السلام يعلم من نفسه الوصول إلى ذلك لعلمه بأنه قد نظر النظر الصحيح كما يعلم ذلك من غيره من المجتهدين وغير النبي يعلم ذلك من حال النبي عليه السلام لعلمه بأنه معصوم من الخطأ في الأحكام كما أنه معصوم فيما يؤديه إذ خلاف
ذلك ينفر عنه ولا يجوز ان يرجع عن ذلك الحكم لأن الرجوع عنه خطأ فأما إذا قيل كل مجتهد مصيب فانه إذا كان غيره من المجتهدين يقطع على أنه مصيب فالنبي بالقطع على ذلك من نفسه أولى ولا يجوز لغيره أن يخالفه فيما أداه إليه اجتهاده لأنه ينفر عنه وإن كان رجوعه إلى قول آخر ينفر عنه لم نجوزه وإن لم ينفر جوزناه
فان قيل لو جوزنا أن يجتهد لوجب القطع على ان العلة التي استخرجها هي علة الحكم لوجوب حكمنا بها ولا يقطع هو عليها لأنه مجتهد ومحال أن نقطع نحن على ذلك دونه مع كوننا متبعين له ومع انا إنما قطعنا على ذلك لكونه نبيا وهو يعلم مع كونه نبيا ما علمناه الجواب أنه لا يقطع هو ولا نحن على علة حكم الأصل ونحن وهو نقطع على علة حكم الفرع على ما سنذكره عند الكلام في أن الحق في واحد وأجاب قاضي القضاة عن ذلك رحمه الله في الشرح بجوابين أحدهما أنا نحن نقطع على العلة التي استخرجها لأنه يجب علينا اتباعه ولا يقطع هو على ذلك لأنه مجتهد وهذا لا يصح لما ذكرناه والآخر أنه بعد تكامل اجتهاده يعلم أنها علة الحكم كما أنا نظن صدق المخبر إذا أخبر وحده فاذا تواتر المخبرون حصل لنا العلم بصدقه
فان قيل أفتجوزون أن يتعبد النبي عليه السلام باجتهاده في تأويل آية قيل يجوز ذلك بل ذلك أولى مما تقدم لأن الاستدلال على ذلك استدلال بدلالة لا بأمارة باب في هل كان يجوز ان يتعبد الله عز و جل من عاصر النبي صلى الله عليه و سلم ممن حضره أو غاب عنه بالاجتهاد والقياس أم لا
اما من غاب عنه عليه السلام فحكى قاضي القضاة رحمه الله في الشرح
أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد أجازوا ذلك والأقلون منعوا منه وحكي أن أبا علي رحمه الله قال في كتاب الاجتهاد لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه و سلم في عصره أن يجتهد أم لا قال لأن خبر معاذ من اخبار الآحاد والصحيح أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء النبي صلى الله عليه و سلم إذ لا يمكنهم سوى ذلك ولأنه لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلى الله عليه و سلم وذكر قاضي القضاة رحمه الله أن خبر معاذ وإن كان من اخبار الآحاد فقد تلقته الأمة بالقبول فهم بين محتج به ومتأول له فصح التعلق به في أن للمجتهد أن يجتهد مع غيبته عن النبي صلى الله عليه و سلم فأما إذا أمكن المجتهد مراسلة النبي صلى الله عليه و سلم فالقول فيه كالقول في الحاضر إذا أمكنه سؤاله وقد أجاز اجتهاده قوم من القائسين إلا أن يمنع من اجتهاده مانع ومنع منه آخرون منهم الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأجاز قوم لمن بحضرته أن يجتهد إذا أذن له النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك وأجاز قاضي القضاة رحمه الله من جهة العقل ورود التعبد بالقياس لمن حضر النبي صلى الله عليه و سلم ولمن غاب عنه قال لأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة أن يعمل باجتهاده إذا لم يسأل النبي صلى الله عليه و سلم ولا يمتنع إذا سأله أن يكون مصلحته أن ينص له على الحكم ولا يمتنع أن تكون مصلحته أن يكله إلى اجتهاده والأولى أن يقال إنه لا يجوز لمن حضر النبي صلى الله عليه و سلم أن يجتهد من جهة العقل قبل سؤال النبي صلى الله عليه و سلم كما لا يجوز للسالك في برية مخوفة أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من بخبر الطريق أسد من خبرته وكما لا يجوز أن يجتهد من غير أن يطلب للنصوص ويفقدها ويجوز إن سأل النبي صلى الله عليه و سلم أن يكله إلى اجتهاده بأن يعلم الله تعالى أن مصلحته أن يعمل على اجتهاده
باب في أنه لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات ويجوز التعبد في
جميعها بالنصوصأما جواز ذلك بالنصوص لأنه ممكن أن ينص الله عز و جل على صفات المسائل في الجملة فيدخل تفصيلها فيها ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة نحو أن ينص الله تعالى على الربا في كل موزون فيدخل في ذلك أنواع الموزونات أما التعبد في جميعها بالقياس فلا يصح لأنه إما أن تقاس جميع الشرعيات أو لا تقاس فان لم تقس انتقض كونها مقيسة وإن قيست فاما أن يقاس على غيرها وإما ان يقاس بعضها على بعض بأن يقاس الفرع على الأصل ويقاس الأصل على فرعه وفي ذلك تبين الشيء بنفسه وإن قيست على غيرها فذلك الغير إما شرعي وإما عقلي وقياسها على أصول غيرها شرعيه لا يمكن لأنا قد فرضنا الكلام في أن يكون جميع الشرعيات مقيسة ولم يبق منها شيء يقاس عليه وإن قيست على أصول عقلية باعتبار وجوه قبحها وحسنها أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إلى عادات لم يصح لأنا لم نجد في العقل أصلا لوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها وشروطها واوقاتها ولا نعلم أيضا وجه وجوب ذلك في الصلاة من جهة العقل فيقع القياس بها على غيرها وأما الأمارات المستخرجة بالعادات فليست دالة على وجوب شيء ولا على حظره وإنما تدل على حدوث حادث كأمارة المطر أو تدل على مقدار شيء كأمارة قيمة المتلف وليس وجوب الصلاة وأعداد ركعاتها من هذين ولا تجد من جهة العادات أمارات على وجوب الصلاة وشروطها ولو دلت أمارات العادات على ذلك لما كان وجوب الصلاة شرعيا بل كان معروفا بالعادة فصح أن التعبد بالقياس في جميع الشرعيات لا يجوز
باب في أنا متعبدون بالقياس
اعلم أن من الناس من قال قد تعبدنا الله تعالى في الحوادث الشرعية بالقياس ومنهم من قال لم يتعبد به واختلف هؤلاء فمنهم من قال قد وردت الشريعة بالمنع منه ومنهم من قال إنما لم يثبته في الشريعة لأنه ليس فيها ما يدل على التعبد به واختلف من أثبت التعبد به فقال قوم العقل يدل على ذلك والسمع وقال آخرون السمع فقط يدل عليه والذي يبين أن العقل بدل على التعبد به أن مرادنا بقولنا إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا ظننا بأمارة شرعية علة حكم الأصل ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوتها في شيء آخر فان العقل يوجب قياس ذلك الشيء على ذلك الأصل بتلك العلة أما جواز قيام امارة شرعية على علة حكم الأصل فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب الخمر يحصل عند شدتها وينتفي عند انتفاء شدتها كان ذلك أمارة تقتضي الظن لكون شدتها علة تحريمها ومعلوم أن الشدة معلوم ثبوتها في النبيذ وإنما قلنا إن العقل يوجب قياس النبيذ على الخمر لأن العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه أمارة المضرة وأمارة التحريم هي أمارة المضرة ألا ترى أن العقل يقتضي قبح الجلوس تحت حائط مائل لعلمنا بثبوت امارة المضرة فان قيل كيف يجوز القطع على قبح ما وجدت فيه امارة التحريم والمضرة مع ان الأمارة قد تخطىء وقد تصيب قيل كما يجوز مثله في امارة المضار الحاصلة في القيام تحت حائط مائلفان قالوا العقل إذا انفرد يقتضي إباحة شرب النبيذ فلم يجز الانصراف عنه لأمارة قيل لهم مثله في الجلوس تحت الحائط لأن العقل يقتضي إباحة الجلوس في الأصل فيجب أن لا ننتقل عن هذه الإباحة لأمارة يجوز أن تخطيء وتصيب
فان قالوا إنما حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه امارة المضرة قيل
وإنما حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط أن لا يكون فيه أمارة التحريم والمضرة ولا فرق بينهما
ويدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنه لأنهم قالوا في مسائل اختلف فيها بالقياس من غير نكير ظهر من بعضهم وما قالوه من غير نكير فهو حق فمن ذلك قول الرجل لزوجته أنت علي حرام قال أبو بكر وعمر عليهما السلام هو يمين وقال علي وزيد عليهما السلام هو طلاق ثالث وقال ابن مسعود عليه السلام هو طلقة واحدة وقال ابن عباس عليه السلام هو ظهار وقال بعضهم هو إيلاء واختلافهم في ذلك ظاهر وإنما قلنا إنهم قالوا ذلك قياسا لأنهم إما أن يكونوا قالوا ذلك عن طريق أو لا عن طريق ولو كانوا قالوا ذلك لا عن طريق لكانوا قد اتفقوا على الخطأ لأن من أعظم الخطأ أن يقال في دين الله عز و جل لا عن طريق فان قالوا ذلك عن طريق فأما أن يكون نصا جليا أو غير جلي أو قياسا أو استنابطا ولو كان في ذلك نص لاحتج به بعضهم ليقيم عذر نفسه وليرد غيره عن خطئه هذه عادة من قال قولا خالفه فيه من يقصد مباحثته وطلب الحق منه ولأنهم كانوا يعظمون مخالفة نصوص النبي صلى الله عليه و سلم جليها وخفيها فلو كان عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك نص مخالف لبعض هذه الأقاويل لكانت كراهتهم لمخالفته تدعو إلى إظهاره سيما إن كان جليا وأيضا محال من جهة العادات في عدد كثير يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعي أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحاجة إليه مما يتعلق به حكم شرعي ووقع في الاختلاف ويفارق ذلك ترك نقل ما أجمعوا لأجله لأن الإجماع حجة وقد أغنى عن الخبر وليس كذلك إذا وقع الاختلاف ولو أظهروا النص لاحتجوا به ولكان خوضهم فيه يمنع من أن ينكتم ولا ينقل ولو نقل لعرفه الفقهاء مع فحصهم عن السنن ولسنا نجد في الشريعة نصا في ذلك فان قول الله عز و جل يآيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إنما هو منع من
التحريم وليس فيه ما حكمه
فان قالوا ولو كانوا قاسوا هذه المسألة على غيرها لصرحوا بالعلة قيل لا يجب ذلك بل يكفي التنبيه على العلة وقد نبه كل منهم على القياس والعلة لأن من قال إنه طلاق ثلاث جعل مطلق التحريم يقتضي غاية التحريم ثم ألزمه هذا الحكم قياسا على طلاق الثلاث من حيث كان كل واحد منها يفيد غاية التحريم ومن جعله طلقة واحدة اعتبر أقل ما يثبت معه التحريم وقاسه على الطلقة الواحدة بعلة ان كل واحد منها يتناول أقل التحريم ومن جعله إيلاء اعتبر أن الزوج قد منع نفسه بهذا القول عن وطئها ومن جعله ظهارا أجراه مجرى الظهار من قبل أنه يفيد التحريم بلفظ ليس بلفظ طلاق ولا إيلاء
وإذا كان هذا الذي ذكرناه ممكنا ولم يمكن ذكر نص ولا أنهم قالوا بغير طريق وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه من التشبيه
وأيضا فان الناس قد يقتصرون على الفتوى في كلامهم ويعلم السامع الوجه الدال على الفتوى من نفس الفتوى ألا ترى أن الناس قد يشيرون في الحرب بآراء ويجرون الشيء مجرى غيره ولا يصرحون بذكر الشبه فيعلم وجه التشبيه بيان ذلك أن رئيس الجيش لو امر مرة بضرب رقاب من يتحسس عليه لعدوه قصدا منه إلى زجر من يتحسس عليه ثم أحسن مرة إلى من يتحسس عليه استمالة منه لهم ليدلوه على عورة عدوه ثم ظهر مرة ثالثة على آخرين ينقلون اخباره على عدوه فقال بعضهم اقتلهم كالذين قتلهم وقال آخرون أحسن إليهم كالذين أحسنت إليهم لعلم أن هؤلاء لحظوا استمالتهم ليدلوه على عورة عدوه واولئك قصدوا زجر غيرهم عن التحسس عليه فكذلك ما ذكرنا عن السلف رضي الله عنهم
فان قيل هلا وجب أن يصرحوا ولا يقتصروا فيها على التنبيه كما وجب
أن ينقلوا النص قيل قد ثبت أن العادة والديانة قد أوجبتها نقل النص وأن العادة في التعليل والتشبيه أن يصرح بها تارة وينبه عليها أخرى
فان قيل هلا صرحوا بذلك ليقيموا عذرهم ويمكنوا غيرهم من الاحتجاج به قيل قد بلغوا هذه الغرض بالتنبيه ولهذا قد ينبه الفقهاء من كلامهم على تلخيص العلة والقياس وإنما قلنا إنه لم يكن منهم نكير لأنه لو كان منهم نكير لظهر ولا منع مع ظهوره أن ينكتم وإنما قلنا إنهم إذا لم ينكروه لم يكن باطلا لأنه لو كان باطلا لكان إنكاره واجبا وكانوا قد اتفقوا على ترك الواجب وليس لأحد أن يقول إنما لم ينكروه لأنه كان صغيرا لأنه ليس في معاصي غير الأنبياء ما يقطع على أنه صغير ولأن الصغير يجب إنكاره كالكبير
ومما اختلفوا فيه وشبهوه بغيره مسألة الجد وقول ابن عباس أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب ابا ولم يذهب إلى تسمية الجد ابا لأن ابن عباس لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة أن الجد لا يسمى أبا حقيقة ألا ترى أنه ينفي عنه الاسم فيقال ليس هو بأبي الميت ولكنه جده وإنما أراد أنه بمنزلة الأب كما أن ابن الابن بمنزلة الابن لما كان يدلي إلى الميت من جهة الأولاد بواسطة وأنه لا فرق في الولادة والقرب بها بين العلو السفل هذا يدل عليه كلامه لأنه إذا لم يرد أنه أب في الحقيقة فلا بد مما ذكرناه وعن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما شبهاه بغصني شجرة وبجدولي نهر ليعرفا قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث
قان قيل ومن أين صحة هذا التشبيه عنهم قيل من نقل فتاويهم نقل هذا التشبيه فاذا كان أحدهما معلوما كان الآخر مثله ويبين ذلك أن المتقدمين من المخالفين كانوا بين متناول لهذه التشبيهات وبين محط لها فلم يكن فيهم من يجحدها وإنما تجاسر على جحدها بعض أهل هذا العصر ولو علموا أن الإقراربفتاويهم يضرهم لجحدوها على أنهم لو لو يشبهوا بما ذكرناه لكانوا
قد قالوا غير ذلك من الاحتجاج إما نص أو غيره مجملا أو مفصلا ولا يجوز مع اهتمام النقلة بأحوالهم على كثرتهم أن يتركوا نقل ما كان بينهم ويطبقوا على نقل ما لم يجز له ذكر فيهم وليس لأحد أن يقول إن تشبيههم الجد والأخ بغصني شجرة وبجدولي نهر تشبيه عقلي يعرفون به قربهما من الميت ثم يورثونهما أو أحدهما لما تقرر في الشرع من أن المشتركين في القرب يرثان وأن أقربهما أحق بالميراث وذلك أنه قد يرث الأبعد مع الأقرب فان ابن الابن إلى أربع منازل هو أولى بالمال من بنت البنت وابن ابن العم أول من بنت العم وهو أبعد منهما وأيضا فانهم لم يورثوهما على سواء بل بعضهم قاسم بالجد ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث وشبهه في ذلك بالام لما كان له أولاد ولم ينقصه من الثلث مع ما له من الأولاد والتعصيب وبعضهم قاسم به ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس فلم ينقصه من السدس تشبيها بالجدة أم الأم من حيث اشتركا في الأولاد بواسطة
إن قيل إنما اعتبر بالسدس لأن رجلا روى أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل للجد السدس فقال له عمر مع من قال الرجل لا ادري والجواب أن قوله لا أدري دليل على أنه جعل له السدس في حال دون حال وأنه نسي الرجل تلك الحالة فلا يمكن أن يقال له السدس في كل حال فلهذا لم ينقصوه منه وعلى أنه لو كان ذلك عاما في جميع الحالات لتعلقوا به وتعلق به بعضهم وكانوا لا يعطونه إلا السدس إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعطاه السدس في كل حال وليس لأحدأن يقول إنهم قالوا في هذه المسائل بالصلح لأن مسألة الحرام لا يجوز فيها الصلح ولأن كل منهم أفتى المستفتى وحكم بما يقوله ولم يرده إلى الصلح وليس لأحد ان يقول إنهم قالوا فيها بأقل ما قيل لأنه لم يتقدم اختلافهم أقوال فقالوا هم بأقلها ولا اتفقوا على قول فيقال إنه أقل ما قيل بل قالوا بأقاويل متباينة بعضها اقل من بعض ومما قاله السلف اعتبارا أن عمر رضي الله عنه لم يعط الإخوة للأب والأم شيئا في المسألة الحمارية فقالوا هب أن ابانا كان حمارا فورثهم وهذا اعتبار لأنهم قالوا إذا
أعطيت الإخوة للأم ونحن قد شاركناهم في ولادة الأم وزدنا عليهم بالأب فان لم ينفعنا ذلك لم يجز أن يضرنا وليس يجوز أن يكون أعطاهم لدخولهم تحت الظاهر وهو قوله فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث لأن الخطاب انصرف إلى الاخوة للأم فقط ألا ترى إلى قوله تعالى فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
دليل آخر ظاهر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالرأي وذلك لا يمكن دفعه كقول أبي بكر رضي الله عنه أقول فيها برأيي وقول عمر اقضي برأيي فيه وقال هذا ما رأى عمر وقال علي عليه السلام في أم الولد كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت ببيعهن وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق أقول فيها برأيي وقولنا رأي عبارة عن اعتقاد أو ظن فان توصل إليهما باعتبار واستنباط إما بدلالة عقلية أو امارة فلا شبهة في وقوع اسم الرأي عليهما فانه يقال فلان رأيه العدل وفلان من رأيه القدر وإن توصل إليهما بنص جلي أو خفي فوقوع اسم الرأي عليهما مشتبه والأقرب أنه يجوز أن يقع عليهما لأنه لا يمتنع أحد من أن يقول إن تحريم الميتة يراه المسلمون وهو رأيهم ويمتنع أن يقول هو من رأيهم لأنه يوهم أنهم حرموها برأيهم فأما قول القائل قلت هذا برأيي فلا يعقل منه أنه قاله بنص لا جلي ولا خفي وإنما يفهم منه أنه قاله استنباطا واستخراجا بما يراه من الأمارات والأدلة التي ليست بنص جلي ولا خفي ولهذا لا يقال إن المسلمين حرموا الميتة برأيهم ولا يقال إن ابا حنيفة اثبت الربا في الستة الأجناس برأيه ويقال إنه أثبت الربا فيما عداها برأيه ولا يقال في الجيش إذا اطاعوا الإمام في رأي إنهم فاعلون ذلك بأرائهم ولذلك لا توصف آراؤهم بالسداد إذا كان رأي الإمام سديدا واتبعوه فيه من غير فحص ويقال
للإنسان أقلت هذا برأيك أم بكتاب الله فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر
ومخالفونا يذمون القول بالرأي ويذمون أصحاب الرأي وهم القائلون بآرائهم وليس يجوز أن يذموا القائلين بالنصوص فاذا ثبت ذلك ولم تكن على الأحكام الشرعية أدلة عقلية علمنا أن قول من قال من السلف أقول فيها برأيي إنما اراد به الأمارات المظنونة وأما قول عمر رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى ابي موسى قس الأمور فهو صريح في القياس
إن قيل قد روي عنهم ذم الرأي كقول أبي بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني أو سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي وقول عمر رضي الله عنه أجرأكم على الجد أجرأكم على النار وقوله أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي وقول علي عليه السلام من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه وقوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره وقول ابن مسعود يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الامور بآرائهم الجواب إنه إذا كان الذين ذموا الرأي هم الذين قالوا به وجب صرف ذمهم إلى الرأي مع وجود النص أو مع ترك الطلب للنص كما يجب مثله لو حكي الرأي وذمه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن قول أبي بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي إنما عنى به تفسير القرآن ولعمري إنه إنما ينبغي أن يفسر على عرف اللغة وبما سمع من النبي صلى الله عليه و سلم وقول عمر أجرأكم على الجد أجرأكم على النار إنما هو ذم الجرأة وترك التثبت وليس بذم للرأي وقوله أعيتهم الأحالديث أن يحفظوها إنما هو ذم لمن عدل إلى الرأي ولم يطلب الأحاديث ولم يحفظ ما وجد منها وقول علي عليه السلام من اراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه معناه الرأي الذي لا يستند إلى الكتاب والسنة والقول بما سنح من غير استقصاء النظر في الأمارات الصحيحة وقول ابن مسعود يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس علماء جهالا
يقيسون الامور بآرائهم فانما ذم بذلك الرأي قبل طلب السنن والنظر فيها وقول علي عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره معناه لو كان الدين جمعه بالرأي فكانه أراد أن يبين ان ليس جميع ما أتت به السنن على ما يقتضيه راي الإنسان وبين ذلك بمسح الخف
دليل آخر روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فان لم تجد قال أجتهد رأيي وعنه أنه قال لمعاذ وأبي موسى وقد أنفذهما إلى اليمن بم تقضيان قالا إن لم نجد الحكم في السنة قسنا الأمر بالأمر فما كان اقرب إلى الحق عملنا به وقال صلى الله عليه و سلم لابن مسعود رضي الله عنه اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهد رايك وقوله صلى الله عليه و سلم لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم أرايت لو تمضمضت بماء ثم مججته وقال للخثعمية وقد سألته الحج عن ابيها أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وخبر معاذ وإن قيل إنه مرسل رواه جماعة من أهل حمص مذكورون عن معاذ وقد تلقى بالقبول لأن الناس فيه فريقان احدهما يحتج به والآخر يتأوله ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه و سلم صوبه في قوله أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنة فعلمنا أن قوله أجتهد رأيي لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنة
فان قيل إنما عنى معاذ أن يجتهد رأيه في الاستدلال بخفي النصوص من الكتاب والسنة قيل قول النبي صلى الله عليه و سلم فان لم تجد مطلق في نفي وجدان نص جلي وخفي في الكتاب والسنة على أن من استدل بالنصوص الخفية لا يقال إنه قد اجتهد رأيه فان قيل إنما أراد أجتهد رأيي في طلب الحكم في الكتاب والسنة قيل الطالب لا يقال إنه اجتهد رأيه وإنما يقال اجتهد في الطلب وأيضا فان معاذ لما قال أحكم بكتاب الله وقال له ص
فان لم تجد انصرف إلى نفي الوجدان الذي يجوز معه الانتقال من الكتاب وكذلك قوله في السنة فان لم تجد يريد نفي الوجدان المسوغ للانتقال من السنة وذلك لا يكون إلا وقد استوفى الطلب فان قيل أفتقطعون على ثبوت خبر معاذ قيل لا وما استدل به على صحته من احتجاج بعض الأمة به وتاول بعضها له لا يدل على أن متفق على صحته لأنه لا يمتنع أن تكون الأمة إنما لم ترده لأنها لم تعلم بطلانه ولما أمكن المخالف تأويله ولم يعلم بطلان تاويله لم يرده كأخبار الفقه إن قيل أفصحيح الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت من أخبار الآحاد قيل يصح ذلك لأن استعمال القياس من الأعمال فجاز ان يقبل فيه أخبار الآحاد ويقطع على وجوبه علينا لأجل الدليل الدال على وجوب قبول أخبار الآحاد كما يقطع بذلك على وجوب ما تضمنته اخبار الآحاد من فروع الشريعة ولا فرق بين أن نظن أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالنية في الطهارة وبين أن نظن أنه أمر باستعمال ما يفضي إلى وجوب النية في انه يجب ألا ترى أنه لا فرق بين أن يخبرنا مخبر بوجود سبع في الطريق في لزوم تجنبه إذا ظننا صدقه وبين أن يأمرنا من ظاهره السداد والنصح سؤال رجل عن الطريق ويقول لنا إنه خبير بالطريق في أنه يلزمنا سؤاله إذا خفنا الطريق وإذا أخبرنا بشيء وظننا صدقه عملنا بحسبه
وأما وجه الاستدلال يقول النبي صلى الله عليه و سلم لعمر أرأيت لو تمضمضت بماء فهو أنه شبه قبلة الصائم من غير إيلاج بمضمضة من غير ازدراد واجرى حكم أحدهما على الآخر وهو نفي إفساد الصوم وهذا قياس وقوله أرأيت لو تمضمضت يدل على أنه كان تمهد أمر القياس وأنه قد دل عليه الدليل وكذلك قوله عليه السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين وتشبيهه حجها عنه بذلك يدل على تمهد القياس في الشريعة
دليل آخر قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار والاعتبار هو
اعتبار الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه قال ابن عباس رضي الله عنه في الأسنان اعتبر حكمها بالأصابع في ان ديتها متساوية وقال اعتبر هذا بهذا وقولهم إن في هذا عبرة معناه أن فيه ما يقتضي حمل غيره عليه نحو أن يعاجل من ظلم بالهلاك فيقال في هذا عبرة أي فيه ما يقتضي حمل غيره عليه وليس الاعتبار هو الانزجار والاتعاظ لأن الاتعاظ والانزجار غاية الاعتبار فعلمنا تباينهما
إن قيل لو كان الاعتبار ما ذكرتم لوصف قائس الفروع على الاصول بأنه معتبر وإن أقدم على المعاصي ولم يعمل لآخرته قيل لا يوصف بهذا لأن إطلاق ذلك يفيد أنه معتبر بجميع ما ينبغي أن يعتبر به لأنه يخرج مخرج المدح لكنه يقال إنه يعتبر الفروع بالاصول
إن قيل لو كان المراد بالآية ما ذكرتم لحسن التصريح به ومعلوم أنه لا يحسن أن نقول يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الارز على البر قيل إنما لم يحسن ذلك لأنه اقتصار على ما لا تعلق له بالكلام وعدول عما يتعلق به ويفارق ذلك أن يأتي بكلام يشتمل على ما يتعلق بالكلام المتقدم وعلى ما لا يتعلق به ألا ترى أن النبي عليه السلام لو سئل عمن بلع حصاة في شهر رمضان لم يحسن أن يقول من جامع في رمضان فعليه الكفارة إذا لم يكن في ذلك تنبيه على حكم من بلغ حصاة ويحسن أن يقول من أفطر فعليه الكفارة ولو كان ذلك دخل فيه لزوم الكفارة لمن بلع حصاة
ولمعترض أن يقول إن قوله سبحانه فاعتبروا ليس بعموم فلم يفد جميع ضروب الاعتبار في كل شيء كما أن قول القائل اقتلوا لا يفيد جميع ضروب القتل ولا قتل كل إنسان واعترضت الدلالة أيضا بأن للمخالف أن يقول إنا اعتبرنا بالاصول التي وردت فيها النصوص فكما لا
أثبت في الاصول التي لا ينفرع على غيرها الحكم إلا بالنص أو البقاء على حكم العقل كذا لا اثبت في غيرها حكما إلا بالنص أو بالبقاء على حكم العقل دليل آخر وهو قوله تعالى يآيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فظاهر الرد يفيد القياس ولأنه لو أراد بالرد إلى الله الاستدلال بظاهر كتاب الله تعالى لكان الكلام متكررا لأن ذلك مستفاد من قول الله تعالى وأطيعوا الله إذا ذلك أمر بامتثال خطاب الله سبحانه كله والجواب أن الرد إلى الله يفيد الرجوع إلى ظاهر كتاب الله جليه وخفيه لأنه يقال لمن يستدل به ويعمل بما فيه إنه يرد امره إلى الله والغرض بالآية أمر بطاعة الله سبحانه فيما نعلم أنه امرنا به وأمرنا بما لا نعلم أنه أمرنا به مما اختلفنا فيه أن نرده إلى كتاب الله عز و جل وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم بأن نفحص عنه فيهما حتى إذا علمنا أنه مما أمرنا الله تعالى به دخل ذلك فما قد أوجبه علينا في اول الآية من طاعته وطاعة رسوله فلا تكرار في ذلك ويحتمل أن يكون الله تعالى عنى بالخطاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه و سلم لأن خطاب المواجهة هذا ظاهره فقال لهم أطيعوا الله فيما امركم به وأطيعوا الرسول فان تنازعتم في شيء لم يظهر فيه من الله ورسوله أمر فردوه إلى الله والرسول بأن تسألوا عنه الرسول
فان قيل هذا قصر للخطاب على المعاصرين للنبي عليه السلام دون غيرهم وذل تخصيص بغير دلالة قيل ظاهر المواجهة يقتضي الحاضرين وأيضا فانا إن تركنا الظاهر من هذا الوجه فنحن متمسكون به من حيث جعلناه عاما في أهل الاجتهاد وغيرهم وأنتم تخصون بالرد أهل الاجتهاد فكل منا تأول الظاهر وأنتم المستدلون
دليل آخر قوله تعالى لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والاستنباط هو القياس وكذلك الرد
ولقائل أن يقول إن الرد إلى اولي الأمر يكون بالاستفتاء والاستشارة والاستنباط هو إخراج الشيء من كونه باطنا إلى أن يظهر وقد يكون ذلك بالقياس وقد يكون بغيره لأنه يقال لمن استدل على الشيء بخفي النصوص قد استنبط هذا الحكم من هذه النصوص على أن هذا وارد في الأمن والخوف قال الله تعالى وإذا جآءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول الآية
دليل قول الله عز و جل إن أنتم إلا بشر مثلنا ولم ينكر عليهم هذا التشبه ولقائل أن يقول إن الكلام خرج مخرج النكير عليهم لأنهم أوجبوا إذا كانوا بشرا مثلهم أن لا يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم وقد ردوا عليهم بما حكاه الله عز و جل من قوله إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وعلى ان هذا تشبيه في غير حكم شرعي فهو بخلاف ما نحن فيه
وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لمن ذكر أنه ولد له ابن أسود ألك إبل فقال نعم فقال أفيهما جمل أورق قال نعم قال وأني ذلك قال الرجل لعل عرقا نزع قال النبي صلى الله عليه و سلم ولعل عرقا نزع وذلك أن هذا تنبيه على أمارة عقلية في حكم عقلي
دليل عقلت الأمة من قول الله سبحانه فلا تقل لهما أف المنع من ضربهما ولم تعقل ذلك إلا قياسا ولقائل أن يقول إن الأمة عقلت ذلك لفظا كما أن قول القائل ما لفلان عندي حبة يفيد في عرف اللغة أنه ما له عنده قليل ولا كثير لا حبة ولا أقل منها وله أن يقول إن المنع من ضربهما علم قياسا على المنع من التأفيف بعلة أنه أذى وكون الأذى علة في ذلك معلوم غير مظنون
دليل أجمعت الأمة على قياس الزناة على ماعز في الرجم ولقائل أن يقول بل عقلت الأمة أن حكم الزناة حكم ماعز من قصد النبي صلى الله عليه و سلم ضرورة أو أنها عقلت ذلك من قوله صلى الله عليه و سلم حكمي في الواحد حكمي في الجماعة على أن كون الزنا بشرط الإحصان علة في الرجم معلوم غير مظنون
دليل قد تعبدنا الله عز و جل بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرها وأن نصلي إلى الجهة التي ظننا أن القبلة فيها وهذا تعبد بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها الجواب ان من المخالفين من لا يجوز الاجتهاد في القبلة ويوجب على من اشتبهت عليه القبلة الصلاة إلى جميع الجهات فلا يسلم هذاالموضع ومنهم من يوجب الاجتهاد في القبلة وله أن يقول إن الأمارات الدالة على القبلة أمارات عقلية لا سمعية ولست امنع من كوننا متعبدين بما ذكرتم في القبلة ولكني أمنع من كوننا متعبدين في الحوادث الشرعية بالاستدلال بالأمارات المظنونة الشرعية وبالعمل بحسبها وليس يلزم إذا تعبدنا بالأمارات في موضع أن نكون متعبدين بها في موضع آخر إلا لجامع يجمع بين الموضعين فان قالوا إذا جاز التعبد بالأمارات المظنونة في موضع جاز التعبد بها في موضع آخر إذا ما سوغ احدهما سوغ الآخر وإن منع من احدهما مانع فهو مانع من الآخر قيل هذا يدل على جواز التعبد بالأمارات في الحوادث الشرعية وليس ذلك مسألتنا فان قالوا إنا تعبدنا بذلك في القبلة لأنه لما لم نعاينها لم يبق إلا التعبد فيها بالأمارات وكذلك مع فقد النص على الحوادث لا يبقى إلا التعبد بالأمارات قيل لم زعمتم ذلك وما أنكرتم أنه يبقى من التعبد في الموضعين وجوه أخر منها ان نتعبد فيها بحكم العقل فيبقى في الحوادث الشرعية على مقتضى العقل ولا يلزم عند اشتباه القبلة الصلاة إلى جهة من الجهات ويمكن أن نتعبد بالصلاة إلى جميع الجهات أو إلى أي جهة اخترنا فان قالوا إنما تعبدنا بالاجتهاد في القبلة والعمل بحسبه لفقد العلم بها فيجب إذا فقدنا العلم بحكم الحادثة أن نكون متعبدين بالاستدلال عليه بالأمارات والعمل بحسبها قيل لهم إن مخالفكم
لا يسلم أنا قد فقدنا طريقا إلى العلم بحكم الحادثة لأنه يجعل الطريق إلى ذلك العقل فان قالوا إنما تعبدنا بالأمارات في القبلة لفقد معاينتها فيجب مثله في حكم الحادثة عند فقد النص لأن فقد النص يجري فقد معاينة القبلة قيل لهم أتجعلون فقد معاينة القبلة عند فقد معاينة القبلة علة مظنونة أو معلومة فان قالوا هي مظنونة قيل لهم وهل نوزعتم إلا في صحة القياس بعلة مظنونة وإن قالوا هي معلومة قيل لهم دلوا على ذلك ولا سبيل إليه لأنه لا يمتنع أن يكون إنما يجب العمل في الأمارات في القبلة لمصلحة لا يعلمها إلا الله ألا ترى أنه كان لا يمتنع أن يتعبدنا بالأمارات في القبلة إذا لم نعاينها ويتعبدنا بالبقاء على حكم موجب العقل في الفروع التي لا نص فيها فان قالوا إنما تعبدنا بالأمارات في القبلة لأن ذلك من قبيل دفع المضار وهذا موجود في الفروع الشرعية قيل هذا رجوع إلى دليلنا الأول ويجب الرجوع فيه إلى أصل عقلي لأن ما ذكرتموه علة عقلية
دليل آخر كل حادثة فلا بد فيها من حكم ولا بد من أن يكون إليه طريق وكثير من الحوادث لا نص فيها ولا إجماع وليس بعدهما إلا القياس فلو لم يكن القياس حجة خلت كثير من الحوادث من أن يكون إلى حكمه طريق فان قيل جميع الحوادث عليها نصوص تشملها إما ظاهرة وإما خفية وليس يبعد ذلك وإن كثرت الحوادث إذا كانت النصوص عامة لأن قول النبي صلى الله عليه و سلم فما سقت السماء العشر شامل لكل ما سقته السماء وإن كثر عدده قيل لو كان جميع الحوادث يشملها النصوص لما افتقر أهل الظاهر في كثير منها إلى استصحاب الحال وهذه الدلالة معترضة لأنه إن أراد المستدل أنه لا بد في كل حادثة من حكم أي من قضية إما نفيا وغما إثباتا فصحيح لكن لا يلزم أن يكون طريق ذلك الشرع بل قد يجوز أن يكون طريقه الشرع ويجوز أن يكون طريقه العقل فيلزمنا التمسك بحكمه إذا لم ينقلنا عنه نص وإن اراد بالحكم حكما شرعيا فانه يجوز خلو كثير من الحوادث منه
وقد استدل بهذه الدلالة من وجه آخر وهو أن السلف رجعوا في أحكام الحوادث إلى الشرع فعلمنا أن طريقها الشرع دون العقل فاذا لم يكن فيها نص ولا إجماع فطريقها إذا القياس ولقائل أن يقول إن أردتم بهذا الكلام المسائل التي دارت بين الصحابة وبينتم أنهم لم يستدلوا فيها بالعقل ولا بالكتاب والسنة وأنه ليس بعد ذلك إلا أنهم استدلوا عليها بالقياس فهذا استدلال بإجماع السلف وقد تقدم وإن أردتم أن السلف لما طلبوا حكم بعض المسائل من الشرع وجب أن نطلب حكم جميع الحوادث من الشرع فقط قيل لكم ولم يجب ذلك أو لستم وغيركم من مخالفيكم تستدلون في كثير من المسائل بالبقاء على حكم العقل فان قلتم لو لم يكن القياس صحيحا لعدلوا في الحوادث الحادثة فيما بينهم التي لا نص فيها إلى حكم العقل فلما لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم عدلوا إلى القياس قيل لكم هذا رجوع إلى استدلالكم الأول وهو قولكم إنما حكموا في المسائل بأحكام لا وجه لما حكموا به إلا القياس
واحتج المخالف بأشياء
منها قوله تعالى يآيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وبقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبقوله ولا تقف ما ليس لك به علم وبقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قالوا والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله لأنه حكم بغير قولهما وقول على الله بما لا نعلم ووصف الشيء بأنه حلال وحرام ولا نأمن كونه كذبا وبقوله وان احكم بينهم بما
أنزل الله وبقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وبقوله فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وبقوله تبيانا لكل شيء وبقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء وبقوله أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الجواب يقال لهم لم زعمتم أن الحكم بالقياس هذا سبيله وما أنكرتم أنا لا نكون بالحكم به متعبدين بين يدي الله ورسوله إذ كنا حاكمين بما أمرنا الله أن نحكم به ولم نقف ما ليس لنا به علم ولم نقل على الله ما لا نعلم ولا واصفين بالكذب لأن الدلالة القاطعة على صحة القياس قد أمنتنا من كل ذلك وأوجبت أن الحكم به حكم بما انزل عز و جل ورد إلى الله والرسول وأنه مما بينه الله عز و جل في كتابه لأنه دل على صحة القياس ومعلوم أن المراد بقوله تبيانا لكل شيء إما على جملة أو على تفصيل لأنه ليس فيه بيان لكل شيء على التفصيل ألا ترى أن كثيرا منه مبين بسنته عليه السلام
ومنها ما احتج به النظام من أن الله عز و جل قد دل بوضع الشريعة على أنه منعنا من القياس لأنه فرق بين المتفقين وجمع بين المفرقين فأباح النظر الى شعر الأمة الحسناء وحظر النظر إلى شعر الحرة وإن كانت شوهاء وأوجب الغسل من المني دون البول وأوجب على الطاهر من الحيض قضاء الصيام دون الصلاة وأجاب قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك بأشياء منها أن القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم واختلافهما فيه إذا اشتركا أو افترقا في علته لا في الصورة ولم يبين النظام أن شعر الحرة والأمة قد اشتركا في علة التحريم أو الإباحة حتى يكون ورود الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع من القياس
وللنظام أن يقول غرضي بما ذكرته الإبانة عن أن الشريعة قد شهدت بابطال أماراتكم لأن الشريعة لو حظرت النظر إلى شعر الحرة ولم تذكر الأمة لقلتم إنما حظرت ذلك خوف الفتنة وذلك قائم في شعر الأمة الحسناء فيحرم النظر إليه ولكان ذلك من اقوى ما تذكرونه من أماراتكم في القياس فاذا شهدت الشريعة بابطاله فقد صح قولي إن وضعها يمنع من القياس ومنها أن ذلك لو منع من القياس الشرعي لمنع من القياس العقلي لأن الأحكام العقلية قد تختلف فيها الأشياء المتفقة وتشترك فيها الأشياء المتباينة وللنظام أن يقول الاحكام العقلية لا تشترك فيها الأشياء المتباينة في علل تلك الأحكام ولا تفترق فيها الأشياء المتفقة في عللها وأنا قد أريتكم أشياء متفقة في أمثال عللكم وأماراتكم وهي متباينة في أحكام تلك الامارات فكان في ذلك بطلان قولكم ولم توجدوني مثله في العقليات ومنها أن قال أكثر ما يقتضيه وضع الشريعة أن تختلف أحكام الأشياء فيكون القياس عليها يثبت أحكاما متضادة في الفروع وليس ذلك يمتنع عندنا إذا كان المكلف مخيرا فيها وللنظام أن يقول ما التزمتموه خارج عما رمته لأن الذي رمته هو ورود الشريعة بما يخالف مفايستكم في التسوية والتفرقة ليصح أن وضعها يمنع من القياس وليس غرضي أن أبين أن القياس يقتضي أحكاما متضادة في الفرع فتجيبوني بالتزام ذلك ونحن نجيب النظام فنقول إنه أرانا مثل أمارتنا فقد نفت الشريعة أحكامها وذلك إنما نمنع من كونها أدلة ولا نمنع من كونها أمارة لأنه ليس من شرط الأمارة أن تدل هي وأمثالها على حكمها على كل حال بل قد تتخرم دلالتها ولا تخرج من كونها أمارة ألا ترى أن الغيم الرطب أمارة في الشتاء على المطر وليس ينقض كونه أمارة على ذلك وجودنا غيما أرطب من ذلك في صميم الشتاء ولا يكون المطر وامثال ذلك كثير وكذلك لا تخرج أمارتنا من كونها أمارات بوجه لوجودنا أمثالها وأحكامها متخلفة عنها فان قال قد وجدت الأكثر من أمثال أماراتكم لا يتعلق بها في الشريعة حكم فخرجت بذلك عن أن تكون أمارات إذ الأكثر من الأمارات يتعلق بها
الأحكام قيل له بين ذلك ولا سبيل له إلى بيانه ومما احتج به المخالف قولهم لو كان الله عز و جل ورسوله قد تعبدنا بالقياس لكان القائسون مطيعين للنبي صلى الله عليه و سلم وفي ذلك كونه عالما بهم وبما يؤديهم اجتهادهم إليه وأجاب قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك بأنه لا يمتنع أن يكون الله عز و جل قد أعلم نبيه صلى الله عليه و سلم بالقائسين مفصلا وأراد القياس منهم وكانوا مطيعين له ولا يمتنع أن يكون قد أراد في الجملة من المجتهدين أن يجتهدوا الاجتهاد الصحيح ويفعلوا بحسبه وكل من فعل ذلك يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه و سلم فان قيل فمتى أراد الله عز و جل حكم الفروع من المكلف قيل ذكر قاضي القضاة في الشرح أن من يقول إن الحق في واحد وعليه دليل يقول إن الله عز و جل أراد حكم الفرع بنصب الدلالة على ذلك ومن يقول كل مجتهد مصيب منهم من يقول أراد أحكام الفروع عند نصب الأمارات ومنهم من يقول أرادها عند نصب الدلالة على العمل بالقياس وقد اختاره قاضي القضاة في العمد وقال ومنهم من يقول أرادذلك عند النص الدال على حكم الأصل وقد اختاره في الشرح وفي كتاب النهاية ومنهم من يقول أراد بعض الأحكام بالنصوص ويقف على الباقي ولا يدري بماذا أريد وابطل في الشرح أن تكون الأحكام مرادة بدليل القياس لأن دليل القياس مجمل وأوجب أن تكون مرادة بالنص الدال على حكم الأصل قال لأن عند القياس نقول لا يخلو مراده بتحريم الربا إما أن يكون نفس العين أو بعض صفاتها ثم نتوصل بالأمارات إلى إثبات المعنى ولقائل أن يقول لا أقسم هذه القسمة لأني قد علمت أنه ما أريد بتحريم التفاضل في الأشياء الستة إلا ما اقتضاه اللفظ دون غيره وإنما أعرف حكم الفرع لاختصاصه بما ظننت أنه علة الحكم مع قيام الدلالة على العمل بالقياس والأولى أن يقال إن الله عز و جل إنما أراد الحكم عند نصب الدلالة على صحة القياس مع نصب الأمارة الدالة على علة الحكم ووجودها في الفرع لأنه لا بد من مجموع ذلك في العلم لحكم الفرع وليس بعض ذلك مرتبا على بعض بل لمجموعة تشافه
الحكم ومعنى ذلك انه فعل كل واحد من ذلك لأجل الحكم
ومنها قولهم إن التعبد بالقياس وإن جاز فان مقايستكم لم يرد التعبد بها لأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي الحكم وذلك يقتضي ثبوتهما فيه وذلك محال فعلمنا أن الله سبحانه لم يتعبدنا بذلك الجواب يقال لهم إن كل فرع يشبه أصلين متضادي الحكم ثم لو كان الأمر كذلك لم يؤد إلى محال لأن من لا يجيز الحكم في الفرع بالتخيير يقول إن الله سبحانه قد جعل لنا طريقا إلى قوة شبهه باحد الأصلين فينبغي أن يراجع المجتهد النظر حتى يظفر بذلك ومن يجوز الحكم بالتخيير يقول يجوز ان يعتدل الشبهان عند المجتهد فيكون مخيرا بين إلحاقه بأي الأصلين شاء فلا ينافي في ذلك والقول في ذلك كالقول في أخبار الآحاد المتعارضة
ومنها قولهم إن القياس وإن جاز التعبد به موقوف على ثبوت الحاجة إليه وتناول النصوص الخاصة والعامة للحوادث كلها يرفع الحاجة إليه فاذا لسنا متعبدين به الجواب أن قولهم إن النصوص متناولة لجميع الحوادث دعوى ولو كانت النصوص متناولة لجميع الحوادث لتناولت الحوادث التي اختلف الصحابة فيها وكانوا يحتجون بها ولما لم يحتجوا بها علمنا أنه لم يكن فيها نصوص ولو تناولت النصوص جميع الحوادث لما افتقر نفاة القياس إلى الاستدلال بالبقاء على حكم العقل في كثير من الحوادث
ومنها أن يزيدوا في هذه الدلالة فيقولوا تناول خاص النصوص وعامها أو دليل العقل لكل حادثة تغني عن القياس فيها فلم نكن متعبدين به إذ التعبد به موقوف على الحاجة ولسنا محتاجين إليه مع هذه الامور الجواب أن تناول النصوص للحادثة لا يمنع من قياسها على غيرها إذا كان حكم القياس هو حكم النص لأنه إن تناولها خبر واحد كان عليها أمارتان خبر واحد وقياس وإن تناولها خبر متواتر قسناها على غيرها لأنه لو لم يكن الخبر المتواتر لدل القياس على حكمها وإن تناول الحادثة عموم جاز إثبات حكم العموم فيها
بقياسها على غيرها وجاز إخراجها من العموم بقياسها أيضا على غيرها فتناول النصوص للحادثة لا يقتضي كوننا غير متعبدين فيها بالقياس وأما تناول العقل للحادثة فانه إنما يقتضي إثبات حكمه فيها ويغني عما سواه ما لم ينقل عنه دليل شرعي فعليهم أن يبينوا أن القياس ليس بدليل شرعي حتى يمتنع أن ينقلنا عن حكم العقل هذا إذا كان القياس غير مطابق لحكم العقل فان كان مطابقا له فما المانع من ان يدل هو على الحادثة مع العقل كما يدل العقل على الحادثة مع خبر واحد
ومنها قولهم لو نص الله عز و جل على علة حكم الحادثة ما جاز أن نقيس عليها غيرها بتلك العلة فأحرى أن لا يجوز أن نقيس على ما لم ينص على علته وإذا لم يجز لنا القياس ثبت أن الله عز و جل ما تعبدنا به واستدلوا على أن القياس على ما نص على علته لا يجوز بأن الإنسان لو قال لوكيله أعتق زيدا عبدي لأنه اسود ما جاز أن يعتق كل عبد له أسود الجواب يقال لهم أتمنعون القياس على ما نص على علة حكمه وإن تعبدنا بالقياس أو إن لم نتعبد بالقياس فان قالوا بالأول كانوا قد منعوا من فعل ما تعبد الله عز و جل به لأن الله عز و جل إذا تعبدنا بالقياس فأولى المقاييس ما نص على علته وإن قالوا بالثاني قيل لهم من الناس من يقول لا يجوز القياس على ما نص على علته إلا بعد أن نتعبد بالقياس ولا يكفي النص على علة الحكم في إباحة القياس ويحوج إلى ذلك من النص على العلة ومع فقد النص عليها ويسوى بين الموضعين ومن الناس من يقول يكفي النص على العلة في جواز القياس بها لما سنذكره في باب ياتي ولا بد من تعبد بالقياس إذا لم ينص على العلة وإن اختلفوا فمنهم من يقول إن التعبد بذلك يثبت عقلا وشرعا ومنهم من يقول يثبت شرعا فقط فما بني عليه المستدل دليله من أن القياس على ما نص على علته لا يجوز لا يسلمه هؤلاء وما احتج به من العتق سيجيء الكلام فيه في باب مفرد أن شاء الله تعالى
باب في النص على علة الحكم هل هو تعبد بالقياس بها أو لا بد من تعبد زائد
على النص على العلةاختلف الناس في ذلك فقال الجعفران وبعض أهل الظاهر ليس النص على العلة تعبدا بالقياس بها وقال أبو اسحاق النظام وهو ظاهر مذهب الفقهاء وقول بعض أهل الظاهر إن النص عليها يكفي في التعبد بالقياس بها والشيخ أبو هاشم أبو عبد الله رحمه الله إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدا بالقياس بها وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا بالقياس بها
واحتج المانعون من القياس بها من غير هذا التفصيل فقالوا إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة وإما أن تكون أمارة فان كانت وجه المصلحة وجب أن يوقع المكلف الفعل لأجلها وليس يجب إذا فعل الإنسان فعلا لغرض من الأغراض ووجه من الوجوه ان يفعل ما ساواه في ذلك الغرض لأن من اكل رمانة لأنها حامضة لا يجب أن يأكل كل رمانة حامضة ومن تصدق على فقير بدرهم لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على كل فقير فلو أوجب الله علينا أكل السكر لأنه حلو وكانت حلاوته داعية إلى اكله لم يجب أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله فلم يجب علينا أكله وأكل كل حلو وإن كانت العلة أمارة فمعنى ذلك هو أن وجه المصلحة يقارنها ولا ينفك منها فاذا ثبت بها ذكرنا أن وجه المصلحة لا تتبعها المصلحة في كل موضع فكذلك ما لا ينفك من وجه المصلحة فعلى هذا الوجه ذكر قاضي القضاة رحمه الله هذا الدليل والجواب إن السكر لو وجب أكله لأنه حلو وقلنا إن حلاوته وجه المصلحة والوجوب لم يلزم أن يأكل المكلف السكر لأنه حلو فيوقع الفعل لهذا الوجه بل يكفي أن يأكله لأنه واجب وليس من شرط كون
حلاوة السكر وجه المصلحة أن يكون داعية إلى اكل السكر بل من شرط كونها وجه المصلحة أن يكون أكل السكر يدعو لأجلها إلى فعل واجب آخر أو يصرف عن قبيح وهذا القدر كاف في كون الحلاوة وجه المصلحة ولو لزم المكلف أكل السكر لنه حلو لم يسقط عنه وجوب أكل كل حلو من حيث أمكنه أن يأكل السكر من حيث أنه حلو ولا يأكل ما ساواه في الحلاوة على ما ذكره المستدل في الرمانة لأن وجوب الواجب لا يقف على كونه لا بد من وقوعه من المكلف بل من شرط وجوبه إمكان وقوعه وإمكان تركه
ويمكن أصحاب هذه المقالة أن يحتجوا بهذه الدلالة على وجه آخر فيقولوا إن علل الشرعيات هي وجوه المصالح والمصلحة إما أن تكون داعية إلى فعل واجب ومسهلة له أو صارفة عن قبيح أو داعية إلى تركه ومسهلة له وما دعا إلى فعل وسهلة لا يجب أن يكون هو ولا مثله داعيا إلى جنس ذلك الفعل ولا مسهلا له وما يصرف عن الفعل يجب أن يصرف هو ومثله عن جنس ذلك الفعل ألا ترى أن من أكل رمانة لأنها حامضة فان حموضتها قد دعته إلى أكلها وسهلت عليه ولا يجب أن يأكل غيرها من الرمان ومن لم يأكل رمانة لأنها حامضة فان حموضتها قد صرفته عن أكلها وسهلت عليه الإخلال بأكلها ويلزم أن لا يأكل كل رمانه حامضة فاذا ثبت ذلك فلو نص الله عز و جل على أن علة وجوب أكل السكر كونه حلوا يجوزنا أن تكون حلاوته لطفا وداعيا إلى الإخلال بالكذب فيلزم أن تكون حلاوة العسل إذا أكله الإنسان داعيا له إلى الإخلال بالكذب وجوزنا أن تكون حلاوته داعية إلى فعل واجب كرد الوديعة ومسهلا له كما ان حموضة الرمانة داعية إلى أكلها ولا يلزم أن تدعو حلاوة العسل إلى رد الودائع كما لم يلزم أن تدعو حموضة رمانة أخرى أو حموضة الخل إلى أكله وإذا جوزنا كلا الأمرين لم يجز لنا إيجاب أكل العسل لتجويزنا أن تكون حلاوة السكر وجه مصلحة في فعل واجب فلا يجب أن تكون حلاوة العسل بمثله بل يلزمنا أن نقطع على أن حلاوة السكر
ليس بوجه مصلحة في الترك لأنها لو كانت كذلك لأخبرنا الله عز و جل بذلك أو لتعبدنا بالقياس والجواب إن من يفعل الفعل لداع ومسهل فانه يفعل ما ساواه في ذلك الداعي إلا أن يقابل ذلك الداعي صارف أو يؤدي إلى ما لا نهاية له وآكل الرمانة إنما لم يأكل رمانة أخرى لأن شهوته للحموضة قد زالت أو تناقصت فلم يحصل داعية إلى أكل رمانة أخرى أو لم يحصل على حد ما حصل إلى الأولى وإذا نص الله سبحانه على أن علة أكل السكر كونه حلوا فظاهر أن حلاوته هي وجه المصلحة من غير شرط فلم يجز حصول الحلاوة إلا وهي داعية إلى ما دعت إليه حلاوة السكر
واحتجوا بأن الإنسان لو قال أعتقت عبدي زيدا لأنه اسود لم يعتقد السامعون أنه قد أعتق كل عبيده السود ولو قال لوكيله أعتق عبدي زيدا لأنه أسود لم يجز للوكيل عتق كل عبيده السود الجواب إن الإنسان إذا قال أعتقت عبدي زيدا لأنه أسود فان كل عاقل يناقضه إذا لم يعتق غيره من عبيده السود إلا أن يكون قد عرف من قصده أنه اعتقده لأنه أسود مع شرط آخر لا يوجد في غيره وإذا قال لوكيله أعتق زيدا عبدي لأنه أسود قال له العقلاء فعندك الآخر أسود فلم خصصت هذا بالعتق وإنما لم يجز للوكيل الإقدام على عتق عبد له لأن الشرع منع من ذلك إلا بصريح القول ولأن المؤكل لما جازت عليه البدوات والمناقضات لم يجز من جهة العقل الإقدام على إتلاف ماله إلا بصريح القول ألا ترى أن المؤكل لو أمر وكيله بالقياس لم يكن للوكيل عتق كل عبيده السود ولهذا ثبت القياس فيما عدا الإتلاف لأن الإنسان لو قال لعبده لا تدخل دار فلان لأنه عدوي فدخل دار غيره من أعدائه لامه العقلاء ولو قال أوجبت أو أبحت لك دخول دار فلان لأنه صديقي كان له دخول دار غيره من أصدقائه ولو لامه لائم على ذلك لعنفه العقلاء
وذكر قاضي القضاة أن الشيخ عبد الله رحمهما الله احتج لمذهبه بأن من فعل
فعلا لغرض من الأغراض فانه لا يجب أن يفعل ما ساواه في ذلك الغرض ومن ترك فعلا لغرض فانه لا يجب أن يفعل ما ساواه في ذلك الغرض ومن ترك فعلا لغرض فانه يترك ما ساواه في ذلك الغرض فاذا حرم الله تعالى الخمر لشدتها فان الشدة تكون وجه المصلحة ولا يكون كذلك إلا ولها يترك الفعل وإذا كانت وجها في الترك وجب أن يشيع في تحريم كل شدة فاذا وجب أكل السكر لأنه حلو لم يجب أن يشيع في كل حلو والجواب يقال إن أردت أن الشدة وجه لها بترك شرب الخمر فقد بينا بطلان ذلك إن أردت أنها لاختصاص الخمر بها يقتضي ترك شربها انصرافا عن قبيح آخر فمن أين ذلك وما ينكر أنه يجوز ذلك ويجوز أن يكون تارك شربها يفعل واجبا ولو شربها أخل به وما ينكر لو أوجب الله تعالى علينا أكل السكر لأنه حلو أن يكون أكله يصرف عن قبيح ولا يدعو إلى واجب فلا ينبغي أن يفرق بين الموضعين بل ينبغي أن يجوز في كل واحد منهما أن يكون داعيا إلى الترك وداعيا إلى الفعل على أن قوله إن وجه المصلحة لها يفعل الفعل إن أراد به لها يفعل الملطوف فيه على معنى أن المكلف يفعل الملطوف فيه لأجل اللطف فهو صحيح وإن أراد أن وجه المصلحة هو غرضه ومقصوده بفعل الملطوف فيه كما يقول خرجت من الدار لاسلم على زيد فباطل لأن اللطف متقدم فلا يجوز أن يكون هو غرض المكلف ألا ترى أن الإنسان إذا استغنى أو رزقه الله ولدا فدعاه ذلك إلى الصلاة لا يكون غرضه وقصده بالصلاة الاستغناء والولد
وأما أبو إسحاق النظام فله أن يحتج فيقول لو قال الله عز و جل اوجبت أكل السكر في كل يوم لأنه حلو لكان ذلك تعليلا لوجوبه في كل يوم ولكانت الحلاوة فقط وجه المصلحة في وجوبه في كل يوم لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا ولا يجوز حصول وجه الوجوب أو الحسن أو القبح فلا يؤثر ألا ترى أنه لا يجوز حصول الفعل ظلما ولا يكون قبيحا وأيضا فان قدرا من الرفق لا يجوز أن يصلح الصبي وهو على صفة مخصوصة
ولا يصلحه مثله متى كان الصبي على تلك الصفة وإذا ثبت ذلك كانت الحلاوة مؤثرة في المصلحة في كل موضع فوجب أكل العسل
وقد احتج لهذه المقالة أيضا بأنه لو لم يجز القياس بالعلة المنصوصة لم تكن للنص عليها فائدة ولقائل أن يقول إن الفائدة فيها أن يعلم كونها علة لأن العلم نفسه فائدة
وقال أيضا لو لم يتعبد بالقياس لعلم كل عاقل تحريم ضرب الوالدين من قول الله تعالى فلا تقل لهما أف لما نبه الله تعالى على العلة فاذا نص عليها فالقياس بها أولى فالجواب إن كثيرا من الناس يقول إن المنع من ضربهما معلوم باللفظ لا من جهة القياس ومن لم يقل إن ذلك معلوم باللفظ يقول لو لم يتعبد الله عز و جل بالقياس لم أعرف ذلك بالقياس على التأفيف لكن أعرفه بالعقل من حيث أن ضربهما كفر نعمة وإنما يثبت أن المنع من التأفيف دال على تحريم الضرب إذا ثبت أن العلم بالعلة يكفي في التعبد بالقياس فأما مع الشك في ذلك فلا يمكن المنع من ضربهما بالقياس على التأفيف فأمأ إذا نص الله عز و جل على العلة وتعبد بالقياس فلا شبهة في جواز القياس بها لأنا قد بينا أن النص على العلة هو تعبد بالقياس فانضمام تعبد زائد يزيد التعبد تأكيدا ولأنه لو لم يجز القياس بها لم يجز القياس بالمستنبطة فكان لا يجوز القياس أصلا وفي ذلك ورود التعبد بما لا يجوز فعله
شبهة
إن قيل إذا أوجب الله تعالى أكل السكر لأنه حلو فيجب إذا شاركه العسل في الحلاوة أن يكون قد قام مقامه في وجه المصلحة وفي ذلك كونهما واجبين على البدل والجواب إن الفعل إذا وجب التعيين لوجه ثم شاركه
فيه فعل آخر وجب أن يشاركه في الوجوب على التعيين لأن هذا هو حكم الأصل
شبهة
إن قالوا لو قال الرجل لوكيله أعتق عبدي زيدا لأنه أسود وينبغي أن يقيس لم يجز له أن يعتق جميع عبيده السود والجواب عن ذلك ما تقدم من أن الشرع والاحتياط من جهة العقل يمنع من الإتلاف على المؤكل إلا بصريح اللفظ لما يجوز عليه من المناقضات والبدوات
باب في أنا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص لنا على القياس عليه
بعينه ولا أجمعت الامة على تعليله ووجوب القياس عليهحكي عن بشر المريسي المنع من القياس على الأصل إلا بعد أن تجمع الامة على تعليله وعن قوم أنه يجب أن ينص لنا على وجوب القياس عليه والدليل على أنه لا اعتبار بذلك أن الصحابة قد قاست على أصول لم يتقدمها إجماع على قياس تلك المسائل عليها وقد قاس كل منهم على غير الأصل الذي قاس عليه غيره ولا نص لهم على القياس على أصل من تلك الأصول لأنه لو نص لهم على ذلك لاحتج به بعضهم على بعض في وجوب القياس على ذلك الأصل ولأنه إن كان الأصل قد نص على علته فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليه وأنه لا يحتاج إلى زيادة تعبد وبينا مثل ذلك في العلل المستنبطة وقلنا إن العقل يقتضي القياس بها على الأصل كالأمارات العقلية باب في النبي صلى الله عليه و سلم هل كان متعبدا بالاجتهاد أم لا
قال أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله إنه لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شيء من الشرعيات وحكي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان متعبدا بذلك
وجوز الشافعي في رسالته أن يكون في الأحكام الشرعية ما قاله صلى الله عليه و سلم اجتهادا وجوز قاضي القضاة رحمه الله ذلك ولم يقطع عليه واستدل بأن العقل يجوز أن يتعبده الله بالاجتهاد وليس في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد به وذلك يصح إذا أفسدنا أدلة القاطعين على أنه تعبد بذلك والقاطعين على أنه لم يتعبد به
فمما احتج به القائلون بأنه تعبد بالاجتهاد قولهم إن في الاجتهاد مزيد ثواب فلا يجوز أن يحرمه النبي صلى الله عليه و سلم والجواب إنه ليس يثبت أن ثواب المجتهد في الأمارات أكثر من ثواب المستدل بالأدلة لأن المشقة موجودة فيهما ولا يعلم التفاضل بينهما فيما يقتضي مزيد الثواب على أن الواجب أن يكون ثواب النبي صلى الله عليه و سلم أكثر وليس في كل فعل فعلناه يجب أن يفعل النبي صلى الله عليه و سلم مثله ليستحق مثل ثوابنا على أن هذا يقتضي أن يكون متعبدا بالاجتهاد في جميع ما تعبدنا بالاجتهاد فيه
ومنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قال في مكة لا يختلي خلاها قال العباس إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه و سلم إلا الإذخر ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحال ولكنه تنبه من استثناء العباس على موضع الاجتهاد والجواب إنه لا يمتنع ان يكون أراد استثناء الإذخر فسبقه العباس إليه فلا يجب القطع على ما قالوه
ومنها أن العمل على القياس معلوم بالعقل والنبي صلى الله عليه و سلم وغيره في ذلك سواء والجواب إن العقل يوجب عندنا إذا لم يكن في الحادثة نص وإذا لم يدل الشرع على أن القياس مفسدة فما يؤمننا أن يكون استعمال القياس للنبي صلى الله عليه و سلم مفسدة وأن مصلحته أن يعمل على النص فدله الله عز و جل على ذلك ونص له على الأحكام
واحتج المانعون من كونه متعبدا بالاجتهاد بأشياء
منها قول الله عز و جل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأخبر أن ما ينطق به هو عن وحي ولا يقال لما يصدر عن اجتهاد إنه عن وحي ألا ترى أنه لا يقال إن قول المجتهد منا هو عن وحي وأجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن الآية تنصرف إلى ما ينطق به دون ما يظهر منه فعلا فمن أين أن كل ما فعله كان وحيا وأما قوله وما ينطق عن الهوى فلا يمتنع من كونه مجتهدا لأن الحكم بالاجتهاد ليس هو عن هوى
ومنها قولهم إن الأمة اتفقت على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه و سلم ليس عن اجتهاد والجواب إن أبا يوسف والشافعي يخالفان في ذلك ولا يعلم سبق الإجماع لهما
ومنها أنه لو كان في الأحكام ما صدر عن اجتهاد فيجب أن لا يجعل أصلا وأن يخالف فيه ولا يكفر مخالفه لأن كل ذلك من حق الاجتهاد الجواب إنه ليس ذلك من حق الاجتهاد على الإطلاق ألا ترى أن الأمة إذا أجمعت عن اجتهاد فانه لا يجوز مخالفته ويجب أن يجعل أصلا وربما فسق من خالفه وإن كان من خالف الاجتهاد الذي لم يجمع عليه لا يفسق وإذا جاز أن يفسق إذا قارنه إجماع جاز أن يكفر إذا قارنه قول النبي صلى الله عليه و سلم
ومنها أن النبي صلى الله عليه و سلم نزل منزلا فقيل له إن كان ذلك عن وحي فالسمع والطاعة وإن كان إنما هو الرأي فليس بمنزل مكيدة فقال بل هو الرأي فدل على أنه يجوز مراجعته في الرأي ومعلوم أنه لا يجوز مراجعته في الأحكام فعلم أنها ليست برأي والجواب أن ذلك إنما يدل على مراجعته في الآراء التي ليست من الأحكام كالرأي في الحرب والأحكام الشرعية خارجة عن ذلك
ومنها أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لاظهره الجواب إنه لا يمتنع ان يكون من المصلحة إظهاره
ومنها أنه لو تعبد بالاجتهاد لما توقف على الوحي الجواب إنه ليس معنى أن توقف في كل الأحكام على الوحي فاذا ثبت ذلك فكل ما تعبدنا فيه بالاجتهاد الشرعي فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم تعبد به ويجوز أن يكون قد نصب له دليل يخصه وأما الاجتهاد في أخبار الآحاد فيتأتى فينا دونه باب فيمن عاصر النبي صلى الله عليه و سلم هل كان متعبدا بالقياس والاجتهاد أم لا
أما من عاصر النبي صلى الله عليه و سلم فذكر قاضي القضاة رحمه الله في الشرح أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد قالوا كان متعبدا بذلك والأقلون منعوا وحكى أن أبا علي رحمه الله قال لا أدري هل كان من عاصر النبي صلى الله عليه و سلم متعبدا بأن يجتهد أم لا لأن خبر معاذ من أخبار الآحاد ولم يقطع قاضي القضاة على ورود التعبد بذلك لمن حضر النبي صلى الله عليه و سلم لأن ما يروي في ذلك أخبار آحاد وقطع على أن من غاب عنه ممن عاصره متعبد بذلك لأن خبر معاذ عنده ثابت لتلقي الامة له بالقبول وظاهر أنه لم يكن عادة الحاضرين عند النبي صلى الله عليه و سلم الاجتهاد لأنه لو كان ذلك عادة لهم لظهر لهم ذلك عنهم كما أنه لم يكن عادتهم طلب الحكم من التوراة ويجوز أن يكون الواحد والاثنان قد أذن لهما النبي صلى الله عليه و سلم أن يجتهدا بحضرته لأن خبر عمرو بن العاص يجوز صحته فأما من غاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيجوز أن يكون متعبدا بالاجتهاد أيضا إلا أن الأمر فيه أظهر ممن حضره لأن خبر معاذ أظهر
باب في القياس هل هو مأمور به ودين أم لا
أما كونه مأمورا به بمعنى أن الله عز و جل بعثنا على فعله بالأدلة فصحيح وأما كونه مأمورا به بصيغة افعل فصحيح أيضا عند من يحتج بقول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وما جرى مجراه من ألفاظ الأمر وأما من يحتج بالإجماع أو بالعقل فلا يمكنه علم ذلك لجواز أن يكون ما دل الأمة على صحة القياس هو إخبار من النبي صلى الله عليه و سلم بصحته وثبوت التعبد به
وأما وصفه بانه دين الله عز و جل فلا شبهة فيه إذا عني بذلك أنه ليس ببدعة وإن عني غير ذلك فعند الشيخ ابي الهذيل رحمه الله انه لا يطلق عليه ذلك لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر وأبو علي رحمه الله يصف ما كان منه واجبا بذلك وبأنه إيمان دون ما كان منه ندبا وقاضي القضاة رحمه الله يصف بذلك واجبه وندبه
والقياس الشرعي ضربان واجب وندب والواجب ضربان أحدهما واجب على الأعيان والتضييق والآخر على الكفاية فالذي على الأعيان والتضييق هو قياس من نزلت به حادثة من المجتهدين أو كان قاضيا فيها أو مفتيا ولم يقم غيره مقامه وضاق الوقت والواجب على الكفاية أن يقوم غيره مقامه في الفتوى والندب فهو القياس فيما لم يحدث من المسائل مما يجوز حدوثه فقد ندب الإنسان إلى إبلاء الاجتهاد فيه ليكون الجواب فيه معدا لوقت الحاجة
باب الكلام في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
اعلم أن القياس لما كان هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم كان الكلام فيه إما كلاما في العلة التي هي دليل الحكم أو كلاما في الحكم الذي هو مدلولها والكلام في الحكم يجب أن يتعلق بالحكم وبما يوجد الحكم فيه ولما كان الحكم موجودا في الأصل وفي الفرع أمكن أن ننظر فيه نظرا متعلقا بالأصل أو بالفرع أو بالأصل وبالفرع معا والكلام في العلة إما كلام في وجودها أو في غير وجودها والكلام في وجودها إما أن يتعلق بوجودها في الأصل أو في الفرع لأن العلة يجب أن توجد في الأصل وفي الفرع والكلام في غير وجودها إما أن يكون كلاما في طريق صحتها أو فيما يعترضها ويفسدها ويدخل في كل قسم من ذلك عدة فصول سنذكرها إن شاء الله وقد أجرينا الكلام في القياس في كتاب مفرد في القياس الشرعي وذكرنا جميع فصوله في هذه الأقسام وذكرنا هذه القسمة وشرحناها في شرحنا للعمد
ونحن نجري الكلام في القياس في هذا الكتاب على قسمة اخرى فنقول إن الكلام في القياس يجب أن يتعلق بعلته لأنها علة حكم أصله ودليل حكم فرعه ولما كانت علة القياس هي علة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما وجب أن نتكلم في وجود العلة في الأصل وفي الفرع وفي طريق وجودها فيهما ثم نتكلم في كونها علة حكم الأصل وفي طريق كونها علة فيه ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع وكلامنا في كونها علة حكم الأصل هو كلام في شروطها المختصة بكونها علة حكم الأصل وكلامنا في كونها دلالة حكم الفرع هو كلام شروطها المختصة بكونها دلالة على حكم الفرع وإن كان هذان الكلامان جميعا كلاما يقف عليه فساد العلة ونفي فسادها وأما الكلام في طريق كونها علة حكم الأصل فانه يتبعه القول بأنه لا بد في القياس من علة لأنه لا يجوز أن نقول لا بد من طريق إلى كون العلة علة إلا وقد أوجبنا انه لا بد في القياس من علة
والكلام في طريق العلة يقع في فصول منها أنه لا يجوز إثبات الوصف علة إلا بدلالة ومنها أنه يجب أن تكون الدلالة شرعية ومنها أنه يجوز أن يكون
الدليل على كونها علة نصا وغيره ومنها أنواع أدلة صحة العلة
وأما الكلام في الشروط الراجعة إلى كونها علة حكم الأصل فيقع في مواضع منها الكلام في وجود الحكم في الأصل لأنه يستحيل كون الوصف علة في حكم والحكم غير حاصل ومنها تعليل الحكم بالاسم وبحكم شرعي وبالأوصاف الكثيرة ومنها التعليل بأوصاف فيها وصف لا يؤثر ومنها تعليل الحكم المخصوص من جهة القياس ومنها تعليل الكفارات والحدود والتقديرات ومنها هل يوجد في الاستنباط طريقة غير القياس يجوز الاستدلال بها على موضع الحكم أم لا ومنها تعليل الحكم بعلتين وذلك ضربان أحدهما أن تكون إحدى العلتين دلالة حكم الأصل والآخر لا تكون دلالة حكمه ومنها تعليل الحكم بما لا يتعدى عن الأصل ومنها هل يجوز أن تخالف العلة موضوع حكم أصلها أم لا
وأما الكلام في العلة من حيث هي دلالة على حكم الفرع فضربان احدهما يتعلق بحكم الأصل والآخر لا يتعلق به والمتعلق بحكم الأصل ضربان أحدهما هل تدل العلة على حكم الفرع وإن اختلف موضوع الأصل والفرع والآخر هل تدل على حكمه وإن كان حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وأما ما لا يتعلق بحكم الأصل فأشياء منها هل العلة دالة على اسم الفرع ثم يعلق به حكم شرعي أو يدل ابتداء على حكم شرعي ومنها هل تدل على حكمه وإن لم يثبت ذلك الحكم في ذلك الفرع في الجملة أم لا يحتاج إلى هذا الشرط ومنها هل تدل على حكم الفرع مع معارضة نص خاص أو عام فيخصه أو ينسخه ومنها هل تدل على الحكم وعلى ضده وهذا هو القلب ومنها هل يمكن الخصم أن يقول بموجبها ليعلم أن المستدل ما استدل بها على موضع الخلاف ومنها هل يجوز وجودها لفظا أو معنى في فرع ولا تدل على حكمها أم لا ويتبع ذلك ذكر النقض وما يحترس به من النقض وذكر الاستحسان ومنها القول في دلالتها على حكم الفرع مع معارضة على أخرى
وهو ضربان احدهما معارضة علة الأصل بعلة أخرى وقد دخل ذلك في القول بالعلتين والآخر معارضة قياس بقياس
ولما كانت المعارضة إنما تتم مع التنافي ومع الاشتباه وقد يجب متى حصلت المعارضة أن يقع الترجيح وجب ذكر العلل المتنافية والفصل بينهما وبين العلل التي ليست متنافية وذكر قياس غلبة الأشباه والفصل بينهما وبين العلل التي ليست متنافية وذكر قياس غلبة الأشباه والفصل بينه وبين قياس المعنى وذكر ما يقع به الترجيح وهل يجوز استواء الأمارتين في وجوه الترجيح وما القول فيهما إذا استويا وهل يجوز إذا استويا عند المجتهد أن يكون له اقاويل مختلفة في المسألة الواحدة وهل يجوز أن ينسب إلى المجتهد أقاويل على طريق الترجيح
ونحن نذكر هذه الأبواب على هذا النسق إن شاء الله
باب القول في وجود العلة في الأصل وفي الفرع وفي طريق وجودهما فيهما
اعلم أن القائس قد يعلل الفرع بأوصاف لا يسلم خصمه وجودها في الفرع فيكون له أن ينازعه في ذلك وقد لا يسلم وجودها في بعض الفرع فيمتنع القائس من قياس جميع الفرع بتلك العلة وإن رام القائس أن يقيس ما وجدت فيه العلة دون ما لم توجد فيه العلة جاز ذلك إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معللا دون بعض وقد يعلل القائس الأصل بعلة لا توجد في الأصل عند خصمه ولا توجد في بعضه فله أن يمنعه من رد الفرع إلى جميع ذلك الأصل فان رده إلى الموضع الذي وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك إلا أن يمنع مانع من تعليل بعض الأصل دون بعض وذلك كمنع أصحاب الشافعي من قياس الجص على البر بعلة أنه مكيل لقولهم إن علة تحريم البر هي علة واحدة شائعة في جميع البر والكيل غير شائع في جميع البر لأن الحبة أو الحبتين لا يتأتى فيهما الكيل وأصحابنا ينفصلون عن ذلك بأن المحرم من البر علته واحدة وهي الكيل إلا أن المحرم هو ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه الكيل لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهي عن بيع البر بالبر إلا كيلا بكيل فأجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل والذي يجوز بيعه إذا تساوى في الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل فيجب أن يكون ما يتأتى فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل في الكيل فهذا هو الكلام في وجود العلة في الأصل والفرع
فأما طريق وجودها فيهما فقد يجوز أن تكون أمارة تفضي إلى الظن وقد تكون دلالة تقتضي وجودها فيهما ضرورة ولا فرق بين هذه الأقسام في صحة القياس لأنه إذا جاز أن يعلق الحكم بما يظنه علة الحكم جاز أن يعلق الحكم بما ظن وجوده من علة الحكم ألا ترى أنا يظن مجيء المطر إذا ظننا بخبر من ظاهره الصدق وجود الغيم كما يظن ذلك وإن علمنا وجود الغيم فاذا جاز لنا التسوية بين الأصل والفرع إذا ظننا اشتراكهما في الاوصاف جاز ذلك مع العلم المكتسب لاشتراكهما في الأوصاف وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في الأوصاف أحق
باب في أنه لا بد في القياس من علة وأنه لا بد أن يكون إليهما طريق
اعلم أن القياس الشرعي لا بد فيه من أصل وفرع يثبت فيه حكم الأصل وليس يخلو القائس إما أن يثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل أولا يثبت تبعا له فان لم يثبته تبعا للأصل كان مبتدئا بالحكم غير قائس وإن أثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل ولم يعتبر شبها بين الفرع والأصل لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى من أن لا يتبعه إياه ويتبعه أصلا ويجب أن يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم وتأثير فيه وإلا لم يكن القائس بأن يعتبر ذلك الشبه بأولى من أن لا يعتبره ويعتبر شبها آخر بين الفرع وبين أصل أخر أولا يعتبر شبها أصلا
فان قيل ألستم تقيسون الفرع على أصل لم تدل دلالة على وجوب القياس عليه فهلا جاز أن تقيس لأجل شبه لم تدل دلالة على كونه علة الجواب أنا لا نقيس الفرع على اصل إلا وقد دلت الدلالة على وجوب القياس عليه لأنه إذا دلت الدلالة على علة حكم الأصل وعلمنا وجودها في الفرع فقيام الدلالة العقلية أو السمعية على أنا متعبدون بالقياس يدل على وجوب قياس ذلك الفرع على ذلك الأصل
باب في أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط
إنما قلنا ذلك لأن طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه نحو أن يثبت حكمها معها في الأصل وينتفي بانتفائها ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع لأن حكمها وكيفية ثبوتها بحسب العلة حاصلان بالشرع فقطفان قيل هلا توصلتم إليها بأمارة من جهة العادات كما تتوصلون إلى قيم المتلفات وجهة القبلة بأمارات من جهة العادات قيل إنما ساغ ذلك في القيم لأن العادات قد جرت ببيع الأشياء التي من جنس المتلف وأمكن أن يعرف قيمة المتلف باعتبار ثمن نظيره فأما العلل الشرعية فأحكامها شرعية لم تثبت بالعادات فتعلم علتها بكيفية ثبوتها في العادة وأما القبلة فقد عرف كونها في بعض الجهات وعرف كون الشمس في بعض الجهات وكذلك الرياح فأمكن أن نستدل ببعض ما هو في جهة على شيء آخر هو في جهة وليس كذلك الأحكام الشرعية مع أمارات العادات
إن قيل أليس نستدل بعقولنا على أن الحكم الشرعي إذا حصل عند صفة وارتفع عند ارتفاعها فهو مؤثر فيه قيل إنا لا ندفع أن الاستدلال
بالأمارات والأدلة إنما يتمكن منه بالعقول ولكنا انكرنا أن تكون الأمارة عليها أمارة عقلية وما ذكرتم من الأمارة شرعي
باب في أن الطريق إلى صحة العلل الشرعية يجوز أن يكون نصا وغير نص
اعلم أن العلة الشرعية قد يجوز كونها معلومة فيكون طريقها نصا من الله أو من رسوله أو من الامة متواترا ويجوز أن يكون مظنونا كونها علة وأكثر العلل الشرعية مظنونة فيجب أن يكون طريقها أمارت مظنونة ولا فرق بين أن يكون نصا منقولا بالآحاد أو تنبيه نص هذه سبيله أو استنباطا لأن كل ذلك يؤدي إلى الظن الذي هو المطلوب في العلل ونحن نشرح أدلة النصوص والاستنباط على صحة العلل في باب يلي هذا الباب إن شاء الله تعالىباب أقسام طرق العلل الشرعية
اعلم أنه لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع وكانت الطرق الشرعية إما لفظا وإما استنباطا كانت طرق العلل الشرعية إما لفظا وإما استنباطا والألفاظ الدالة على ذلك إما صريحة وإما منبهة أما الصريحة فمنها أن يكون لفظها لفظ العلة ومنها ما يقوم مقام لفظ العلة فالأول كقول القائل لغيره أوجبت عليك كذا لعلة كذا والثاني قول القائل لغيره أوجبت عليك كذا لأنه كذا أو لأجل كذا أو كيلا يكون كذا قال النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهيتكم لأجل الرأفة وقال الله عز و جل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إن قيل قد يقول الإنسان لغيره صل للتقرب إلى الله عز و جل ولا يفيد ذلك كون التقرب علة في وجوب الفعل قيل لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب وإنما علل فعله للصلاة وهذا يقتضي كون التقرب علة وغرضا باعثا على الفعل
وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب
منها أن يكون في الكلام لفظ غير صحيح في التعليل يعلق الحكم بعلته
ومنها أن يصدر الحكم من النبي صلى الله عليه و سلم عند علمه بصفة المحكوم فيه فيعلم أنها علة الحكم
ومنها أن تكون الصفة مذكورة على حد لو لم تكن علة لم يكن لذكرها فائدة
ومنها أن يقع النهي عن فعل بمنع ما تقدم إيجابه علينا فنعلم أن العلة في كونه محرما كونه مانعا من الواجب وإن لم يصرح بذلك
أما القسم الأول فكتعليق الحكم على علته بلفظ الفاء ولا بد من تأخير لفظ الفاء وهو ضربان أحدهما أن تدخل الفاء على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقول النبي صلى الله عليه و سلم في المحرم الذي وقعت به راحلته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والآخر أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ضربان أحدهما أن تكون الفاء دخلت على كلام الله عز و جل أو كلام رسوله صلى الله عليه و سلم والآخر أن تدخل في رواية الراوي فالأول قول الله عز و جل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل
هو فليملل وليه بالعدل يدل على أن العلة في قيام وليه وبالإملاء هو أنه لا يستطيع أن يمل هو والثاني قول الراوي سها النبي صلى الله عليه و سلم فسجد و زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه و سلم
وأما القسم الثاني وهو أن يصدر القول من النبي صلى الله عليه و سلم عند علمه بصفة المحكوم فيه فنحو أن يسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن حكم شيء ويذكر السائل صفة لذلك الشيء مما يجوز كونها علة مؤثرة في ذلك الحكم فيجيب النبي صلى الله عليه و سلم عند سماع تلك الصفة فيعلم أنه لو لم تكن مؤثرة في ذلك الحكم لم يجب النبي صلى الله عليه و سلم عند سماعها نحو أن يقول قائل يا رسول الله أفطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار إذ لو لم يكن الإفطار مؤثرا في ذلك لما أوجب الحكم عند سماعه له كما لا يجوز أن يوجب عليه الكفارة لو سمع أنه مشى وتحدث
وأما الثالث وهو أن لا يكون لذلك الوصف فائدة لو لم يكن علة فضروب
منها أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم امتنع من الدخول عند قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على آل فلان وعندهم هر فقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين تأثير في طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فائدة
ومنها أن يوصف المحكوم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بذكرها وذكر ما جرى مجراها فنعلم أنها ما ذكرت إلا لأنها مؤثرة في الحكم كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في النبيذ تمرة طيبة وماء طهور
ومنها التقرير على وصف الشيء وهو على ضربين أحدهما أن يقرر النبي صلى الله عليه و سلم على وصف الشيء المسئول عنه كقوله أينقص الرطب إذا جف
فقالوا نعم قال فلا إذن فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن للتقرير عليه فائدة وهذا يدل على العلة أيضا من حيث الجواب بالفاء
ومنها أن يقرر النبي صلى الله عليه و سلم على حكم ما يشبه المسئول عنه وينبه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقول النبي صلى الله عليه و سلم لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت بماء ثم محجته فعلم أنه لم يفسد الصوم بالمضمضة والقبلة لأنه لم يحصل ما يتبعهما من الإنزال والازدراء
ومنها أن يفرق النبي صلى الله عليه و سلم بين شيئين في الحكم بذكر صفة فيعلم أنه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها معنى وهذا ضربان أحدهما أن لا يكون حكم أحدهما مذكورا في الخطاب والآخر أن يكون حكمهما مذكورا فيه أما الأول فقول النبي صلى الله عليه و سلم القاتل لا يرث وذلك أنه قد تقدم ببيان إرث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مؤثرا في نفي الإرث علمنا أنه العلة في نفي الإرث وكقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لأنه قد تقدم أمر القاضي بأن يقضي فاذا منع من ان يقضي وهو غضبان علمنا أن الغضب علة في المنع سيما وقد علمنا أن الغضب بمنع من الوقوف على الحجة ويمنع من الاستيفاء وأما إذا كان حكم الشيئين مذكورا في الخطاب فضروب
منها أن يفرق بينهما بلفظ يجري مجرى الشرط كقول النبي صلى الله عليه و سلم فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد بعد نهيه عن بيع البر متفاضلا فدل على أن اختلاف الجنسين علة في جواز البيع
ومنها أن تقع التفرقة بينهما بالغاية كقوله عز و جل ولا تقربوهن حتى يطهرن فلو اقتصر على ذلك لدل على تعلق الإباحة بالطهر وإلا لم
يكن لذكره فائدة مع جواز كونه علة
ومنها وقوع التفرقة بينهما بالاستثناء كقول الله عز و جل إلا أن يعفون
ومنها أن تكون التفرقة وقعت بلفظ يجري مجرى الاستدراك كقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فدل على أن التعقيد مؤثر في المؤاخذة
ومنها أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من الصفات بعد ذكر الآخر وتكون تلك الصفة مما يجوز أن تؤثر في ذلك الحكم كقول النبي صلى الله عليه و سلم للراجل سهم وللفارس سهمان وهذه الأقسام وإن كانت مؤثرة في الحكم فانه لا يمتنع أن تكون مؤثرة فيه لعلل لأنه يجوز أن يعلل كون الغضب مانعا من الحكم بين الخصمين بأنه يشغل الذهن ويجوز أن تدل الدلالة على أن هذه العلل لها شروط ويجوز أن تدل على أنها غير مشروطة فاذا فقدت الدلالة حكم بأشياء مختلفة غير مشروطة
وأما الرابع وهو النهي عن شيء يمنع من الواجب فهو كقول الله عز و جل فاسعو إلى ذكر الله وذروا البيع وذلك أنه لما أوجب علينا السعي ثم نهانا عن البيع المانع من السعي علمنا أنه إنما نهانا عنه لأنه مانع من الواجب وكقوله تعالى فلا تقل لهما أف وذلك أنه نهى عن ذلك لأنه مناف للإعظام الواجب لهما من حيث كان أذى واستخفافا فدل من طريق الأولى على المنع من ضربهما لأن ما منع منه لعلة فما فيه تلك العلة وزيادة أولى بالمنع وذكر قاضي القضاة رحمه الله أن المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ لا من جهة القياس قال ولا بد من اعتبار عادة أهل اللغة في ذلك
والدليل على أن ذلك معقول من قياس الأولى لا باللفظ هو أنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعا للمنع من ضربهما إما في اللغة او في العرف ومن البين أنه غير موضوع للمنع من الضرب في اللغة ولا يجوز أن يكون موضوعا لذلك في العرف لأن العلم بالمنع من ضربهما موقوف على قياس الأولى بيان ذلك إن الإنسان إذا سمع قول الله عز و جل فلا تقل لهما أف إلى قوله وقل لهما قولا كريما علم أن هذا القول خرج مخرج الإعظام لهما سيما مع ما تقرر في العقول من وجوب تعظيمهما إذا كانا مؤمنين وإذا علم ذلك علم أنه نهى عن التأفيف لأنه ينافي التعظيم فانه ينافيه من حيث كان أذى قصد به الاستخفاف فنعلم أنه نهى عن ذلك لكونه أذى ونعلم أن الحكيم لا ينهى عن الشيء لعلة ويرخص فيما فيه تلك العلة وزيادة بل يكون يحظر ذلك أولى والضرب هذه سبيله فكان أولى بالمنع يبين ذلك أنه لو لم يحصل للإنسان هذه الجملة لم يعلم المنع من ضربهما لأنه لو جوز أن يكون إنما نهى عن التأفيف لأنه أذى قليل لا للإعظام لجوزنا أن نؤمر بضربهما فان الإنسان قد يقول لغيره لا تحبس اللص لكن اقطع يده ولا تقطع يد فلان بل اقتله ولو علم أنه نهى عن التأفيف لأنه أذى وجوز أن يمنع الحكيم من الشيء لعلة ويرخص فيما فيه تلك العلة وزيادة لما علم المنع من ضربهما فعلمنا أن العلم بذلك موقوف على الجملة التي ذكرناها لا غير دون ما يدعى من العرف وأيضا فليس يجوز الحكم بنقل الكلام إلى العرف إلا إذا لم يمكن سواه وقد بينا أنه قد أمكن سواه
إن قيل لو عقل ذلك بالقياس لجاز أن لا يعلم المنع من ضربهما كثير من الناس بأن لا يقيسوا قيل إنما كان يجب ذلك لو كان ما ذكرناه من مقدمات هذا القياس مستانفا تحتاج إلى غامض فحص فأما وكثير منها يعلمه المكلف قبل الخطاب كالقول بأن الحكيم لا يرخص في فعل ما فيه علة المنع وزيادة
وكالقول بمنافاة الأذى والاستخفاف للتعظيم ومنها ما العلم به مقارن للخطاب كالقول بأن هذا الخطاب خرج مخرج التعظيم فاذا كان كذلك كانت هذه المقدمات متكالمة للعاقل عند سماع الخطاب وبها يكمل قياس الأولى
فان قيل لو علم ذلك بالقياس لصح أن لا يعلم العاقل المنع من ضربهما لو منعه الله عز و جل من القياس الشرعي قيل لا يحسن المنع من هذا القياس مع الإيضاح لعلته لأنه لا يحسن أن يقول الحكيم لا تمنعوا مما وجد فيه علة المنع وزيادة ألا ترى لو قال إنما منعت من ضرب الأبوين لكونه أذى ولا تقيسوا على ذلك ما هو اشد منه كان مناقضة للتعليل ولا يكون مناقضة في اللفظ ولو حسن المنع من هذا القياس لكان إذا منع الله من القياس لا يعلم المنع من ضربهما وإن منع من التأفيف
فأما قول القائل ليس لفلان عندي حبة فانه يمنع من أن يكون له عليه أكثر من ذلك لأنه لو كان له عليه أكثر من ذلك لكان له عليه حبة وزيادة فأما ما نقص عن الحبة فليس ينبىء القول عنه لكنه لا يثبت في الذمة على وجه يطالب به الإنسان فان جرت العادة بالمطالبة به لم يفد قوله ليس له عندي حبة نفى ما نقص عنها
وقول القائل فلان لا يملك حبة ينفى كونه مالكا لأكثر منها هو حبة وزيادة وما نقص عنها لا يتعرض له خطابه وليس هو مما يوصف الإنسان بأنه مالكه وقول القائل فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا فانه يدل من جهة العرف على أنه لا يملك شيئا لا من جهة اللغة ولا جهة التعليل أما اللغة فلان قولنا قطمير موضوع لما يغشى النواة وقولنا نقير موضوع للنقرة التي على ظهرها وليس هو موضوعا لقليل المال وكثيره وأما أنه غير مفهوم بالتعليل فلأن الإنسان لا يقصد أن ينفي كون غير مالكا لنقير النواة وللفتيل وإذا لم يقصد نفي ذلك ولا يحظر ذلك على ماله لم يمكن أن يقال إذا لم يكن الإنسان مالكا لهما فبأن لا يملك ما فوقهما أولى ولا يقصد الإنسان أن يصف
غيره بالخيانة بالنقير والقطمير حتى يقال إذا خان فيهما فما فوقهما أولى بذلك فاذا بطل أن يكون ذلك مفهوما باللغة والتعليل علمنا أنه في العرف موضوع لنفي ملك القليل والكثير لا أنه يفيد نفي ملكه لأقل القليل ثم يقال ما زاد على أقل لغيره قد حصل فيه القليل وزيادة
فأما قول القائل لغيره لا تقل لأبيك أف فانه يقصد به المنع من التأفيف على الحقيقة فيمكن أن يقال إذا منعه من ذلك لأنه أذى فبأن يمنعه مما هو أعظم منه أولى
وأما قول القائل فلان مؤتمن على قنطار فانه لا يدل على انه أمين فيما زاد على ذلك لأن الإنسان قد يصرفه نفسه عن الخيانة في قدر من المال ولا يصرفه عن الخيانة فيما هو اكثر منه وأما ما نقص عن قنطار فانه قد دخل في القنطار فالخطاب يتناوله فان علمنا أن قوله فلان مؤتمن على قنطار يقتضي أمانته على كل حال كان ذلك معروفا بالعرف لأنه لا تقتضيه اللغة ولا التعليل
فأما طريق العلة المستنبطة فأشياء
منها أن يكون الوصف مؤثرا في قبيل ذلك الحكم ونوعه في الاصول فيكون أولى بأن يكون علة من وصف لا تؤثر في نوع ذلك الحكم ولا تؤثر فيه بعينه لأن العلة تؤثر في الحكم فما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة وذلك كالبلوغ مؤثر في رفع الحجر عن المال فكان أولى بان يكون علة في رفع الحجر في النكاح من الثيوبة لأن الثيوبة لا تؤثر في جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر
ومنها أن يوجد الحكم في الأصل عند حصوله صفة وينتفي عند انتفائها وذلك يقتضي ان لذلك الوصف من التأثير في ذلك الحكم ما ليس لغيره وهذه طريقة تعتمد في المؤثرات العقلية وقد حكى قاضي القضاة رحمه الله عن الشيخ
أبي عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يعتمدها ويقول يجب أن يقوى بغيرها والأولى كونها معتمدة بنفسها فان قيل إن كان للأصل وصف آخر يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه ما قولكم فيه قيل إنه إذا كان الحكم يوجد مع وجود كل واحد من الوصفين لم يكن الحكم ينتفي عند انتفاء كل واحد منها على كل حال إلا أن كل واحد منهما مؤثر فيه لأنه قد كفى كل واحد من الوصفين في وجود الحكم وأثر عدمه في عدمه على بعض الوجوه وهو إذا لم يخلفه الوصف الآخر
ومنها أن يجمع الأمة أو القائسون منها على تعليل أصل ويختلفوا في علته فيبطل إلا علة واحدة فيعلم صحتها لأنها لو فسدت لخرج الحق عن أيدي الأمة فأما إذا لم يجمعوا على تعليل الأصل بل علله فمنهم من علله بعلة ومنهم من علله بأخرى وفسدت إحداهما فانه لا يجب صحة الأخرى لأنه ليس في إفسادها ذهاب جميع الأمة عن الحق ولا في سلامتها من وجوه الفساد ما يوجب صحتها على أن من أقوى وجوه الفساد أن لا يدل دليل على صحتها وقد ذكر قاضي القضاة في الدرس أن قيام الدلالة على التعبد بالقياس يوجب القياس على كل حال إلا أن يمنع من ذلك مانع ولقائل أن يقول إن أقوى الموانع أن لا يظفر بعلة قد دل الدليل على صحتها ومما ذكر من الطرق أن يكون الحكم مجاورا لأحد الوصفين دون الآخر فيكون ما جاوره الحكم علة دون ما لم يجاوره ولمعترض أن يقول إن كان الحكم المجاور للوصف حاصلا عنده وإن عدم الوصف الآخر ومرتفعا عند ارتفاعه وإن وجد الوصف الآخر فهذا رجوع إلى أن الحكم قد وجد بوجود الوصف وانتفى بانتفائه ولم يوجد بوجود وصف آخر ولا انتفى بانتفائه وإن أريد أن الحكم قد يتجدد عند تجدد أحد الوصفين ولا بد من تقدم وجود الوصف الآخر فانه لا يدل ذلك على أن أحد الوصفين هو العلة وحده لأنه ليس يكفي حصوله وحده كالرجم المتجدد استحقاقه عند تجدد الزنا ليس يكفي فيه الزنا إلا بعد تقدم الإحصان فوجب اعتبارهما وإن كان الإحصان شرطا
لا علة لأنه لا يجوز ان يستحق به العقوبة
ومنها قولهم إن جريان العلة في معلولها دليل على أنها علة ومعنى جريانها في معلولها هو أن الحكم يتبعها في كل موضع وجدت فيه والجواب إن أراد المستدل أن الحكم يتبعها في كل موضع باتفاق منه ومن خصمه لم يسلم له الخصم ذلك لأن العراقي لا يسلم للحجازي أن تحريم التفاضل يحصل في كل مأكول وإن اراد أنه هو الذي يتبعها حكمها في كل موضع وجدت فيه قيل له أفيسوغ لك أن يتبعها الحكم في موضع وجدت فيه فان قال لا قيل له فلم ساغ لك ذلك فان قال لأنها علة الحكم في الأصل قيل فأنت مستدل على أنها علة حكم الأصل بصحة الجريان ونستدل على صحة الجريان بأنها علة الحكم في الأصل وذلك فاسد فان قال إنما ساغ لي ذلك لأنها لا تنتقض قيل معنى كونها غير منتقضة أنك علقت الحكم بها في كل موضع وجدت فيه فكأنك قلت إنما ساغ لي تعليق الحكم بها أينما وجدت لأني علقت الحكم بها أينما وجدت فان قال إنما ساغ لي تعليق الحكم بها أينما وجدت لأنه لم يمنعني من ذلك نص ولا علة أولى منها قيل له ولم إذا لم يمنع من ذلك نص أو علة وجب تعليق الحكم بها وما أنكرت أنه إذا لم يمنع النص من ذلك منع غيره من وجوه الفساد لأن وجوه الفساد كثيرة فان قال ليس يمنع من ذلك وجه من وجوه الفساد قيل له أتعد في وجوه الفساد فقد الدلالة على صحتها فان قال نعم قيل فدل على صحتها واترك جريانها وعدم انتقاضها وإن قال لا أعد ذلك من وجوه الفساد بل يجوز لي أن أعلق الحكم بها إذا سلمت من نص يدفعها وغيره ذلك قيل له لم زعمت أنها إذا سلمت من ذلك صحت فان قال لأنها تفسد بمعارضة النص وغيره من وجوه الفساد فيجب صحتها بسلامتها من ذلك قيل إن قولنا إن ما حصل فيه وجه من وجوه الفساد فهو فاسد إنما يلزمه القول بأن ما ليس بفاسد فليس فيه وجه من وجوه الفساد ولا يلزم منه أن ما لم يحصل فيه وجه فساد فليس بفاسد
كما أن قولنا الإنسان حيوان يلزمه أن ما ليس بحيوان فليس بانسان ولا يلزمه منه أن ما ليس بانسان فليس بحيوان ويبين ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لو قال زيد ليس في الدار لبطل القول بأن زيدا في الدار ولا يجب إذا لم يخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك أن يصح القول بأنه في الدار فان قال ألستم تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدلالة فيجوز مثله في العلة قيل إنما نفي ذلك شيوخنا لعلمهم باضطرار أن ذلك ليس من الدين ولو لم يعلم ذلك باضطرار لنفيناه لدلالة وهي أنه لو وجبت لدلنا الله سبحانه على ذلك فان قالوا قولوا لو لم يكن العلة صحيحة لأعلمنا الله تعالى ذلك قيل يكفي في النفي فقد دلالة الإثبات ولا يكفي في الإثبات فقد دلالة النفي ألا ترى أنا ننفي صلاة سادسة لفقد الدليل على وجوبها ولا نوجبها لفقد الدليل على نفيها وذلك أن الأصل نفي وجوبها فلا ننتقل عنه إلا بدليل والأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة فلا ننتقل عن ذلكم إلا بدليل فان قالوا عجز الخصم عن إفسادها يدل على صحتها قيل الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد وأكثر ما في عجزه أن يكون قد سلمت العلة من وجوه الفساد وقد تقدم الكلام في ذلك
وهذا هو الكلام في طريق العلة ونحن نتكلم الآن في العلة من حيث هي علة حكم الأصل وما يتصل بذلك
باب الكلام في حكم الأصل
اعلم أن الوصف لا يصح كونه علة حكم الأصل إلا والحكم موجود في الأصل فينبغي أن ينظر الإنسان هل الحكم موجود في الأصل ام لا فانه قد يقيس الإنسان على أصل لا يسلم خصمه وجود الحكم فيه وقد يكون الحكم موجودا في بعض الأصل دون بعض ويكون القائس قد رام رد الفرع إلى جميع الأصل فلا يمكنه ذلك فان رام رده إلى الموضع الذي وجد فيه ولم يمنع من ذلك مانع من إجماع أو غيره جاز ذلك
باب في تعليل حكم الأصل بالاسم وبأحكام شرعية وبجميع أوصاف الأصل
أما تعليله بالاسم نحو تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا فلا يصح لأنه لا تأثير لذلك في التحريم ويجوز تعليل التحريم بكونه خمرا ويراد بذلك فائدة قولنا خمر لأن المرجع بذلك إلى صفات علتها الخمر ويجوز تعليل الحكم بحكم شرعي لأنه لا يمتنع أن يكون لبعض الأحكام الشرعية تأثير في حكم آخر نحو قولنا طهارة مزيلة للحدث وأشباه ذلك كثيرة ولا يمتنع أن يكون المؤثر في الحكم مجموع صفات كثيرة كما لا يمتنع أن يكون المؤثر فيه صفات قليلة فاما تعليل الحكم بجميع صفات الأصل حتى يدخل فيه كونه في مكان كذا وأن كونه كذا فلا يصح لأنه لا تأثير لكثير من هذه الأوصاف في الحكم ومن يمنع من العلة القاصرة يقول إن تعليل الشيء بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى لأن جميع صفات الشيء لا توجد في غيرهباب القول في عدم التأثير
اعلم أنه إذا كان في أوصاف العلة وصف لا تأثير له لو عدم عن الأصل لم يعدم الحكم عنه فانه يعلم بذلك أنه لا يجوز أن تكون العلة مجموع تلك الأوصاف بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف لأنه لو أثبت في العلة ما لا يضر عدمه وجب إشبات ما لا نهاية له من الأوصاف فان انتقضت العلة بفرع من الفروع متى أزلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة ولا يجوز ضم الوصف إليها لتسلم العلة من النقض لأن العلة يجب أن تعلم أولا أن حكم الأصل متعلق بها وانها مؤثرة فيه ثم تجري في الفروع فاذا كان وصف منها غير مؤثر في حكمه لم يجز كونه في جملة علته فيجب إسقاطه وإذا سقطوانتقض ما عداه لم يجز كون مجموع الأوصاف علة ولا ما عدا ذلك الوصف ويفارق عدم التأثير عكس العلة لأن عكسها هو أن يوجد حكمها مع عدمها في بعض المواضع وليس ذلك يمتنع لأن العلة إذا كانت أمارة فقد يجوز أن تدل على الحكم الواحد أمارتان أيهما وجدت دلت عليه وإن كانت وجه المصلحة فقد شبت المصلحة لوجه وقد ثبت لوجه آخر كما يقبح الشيء لوجه ويقبح لوجه آخر فأما عدم التأثير فهو أن لا يؤثر وصف من الأوصاف في الحكم ويكون التأثير لغيره فلا يجوز ضم ما لا تأثير إلى ما له تأثير
باب في تعليل الأصل الوارد بخلاف قياس الاصول
اعلم انه إذا تقررت في الاصول أحكام معلومة ويثبت بخبر من الأخبار في شيء من الأشياء حكم مخالف لما يقتضيه قياس ذلك الشيء على تلك الاصول فمعلوم أن القياس على ذلك الشيء يوجب خلاف ما يوجبه القياس على تلك الاصول وقد اجاز أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة القياس على ذلك الشيء المخصوص من جملة القياس ولم يجوز الشيخ أبو الحسن القياس عليه إلا لإحدى خلال ثلاث أحدها أن يكون ما ورد خلاف قياس الاصول قد نص على علته نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه علل طهارة الهر بأنها من الطوافين علينا والطوافات قال لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس على ذلك الشيء وأحدها أن تكون الامة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته وأحدها أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الاصول وإن كان مخالفا للقياس على أصول أخر كالخبر بالتحالف في المتبايعين إذا اختلفا فانه بخلاف قياس الاصول ويقاس عليه الإجارات لأن قياسها موافق لقياس آخر من قياس الاصول وهو أنه تملك على الغير فالقول قوله فيه وذلك أنه إذا كان في الشرع أصل يبيح هذا القياس وأصل يحظره وكان الأصل جواز القياس وجب القياس وقد أجاز الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه القياس على خبر الواحد المخصص للعموم وقال محمد بن شجاع الثلجي رحمه الله إذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول غير مقطوع به لم يجز القياس عليه فاقتضى قوله هذا أنه يجوز أن يكون مذهبه أنه إذا كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه واعلم أن ما ورد بخلاف قياس الاصول إما أن يكون دليلا مقطوعا به أو غير مقطوع به فان كان مقطوعا به فهو أصل في نفسه لأن هذا معنى قولنا أصل في هذا الموضع فالقياس عليه كالقياس على تلك الاصول ويجب أن يقصد المجتهد مقصد الترجيح بين القياسين ويبين ذلك أنه إذا كان عموم الكتاب لا يمنع من قياس يخصصه فبأن يكون القياس على العموم لا يمنع من القياس على أصل آخر يخالف العموم اولى لأن العموم أقوى من القياس عليه وإن كان الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول غير مقطوع به فانه لا تخلو علة حكمه إما تكون منصوصة أو غير منصوصة فان لم تكن منصوصة ولو كانت اقوى من العلة التي يقاس بها الفروع على تلك الاصول فلا شبهة في أن القياس على الاصول أولى لأن القياس على ما طريقه معلوم أولى من القياس على ما طريقه غير معلوم وإن كانت العلة منصوصة فقد ذكر قاضي القضاة رحمه الله في الدرس أنه يستوي القياسان من هذا الوجه لأن القياس على الاصول يختص بأن طريق حكم أصله معلوم وإن كانت طرق علته غير معلومة والقياس على ما ورد بخلاف قياس الاصول علته منصوصة
ولقائل أن يقول إن هذه العلة وإن كانت منصوصة فهي غير معلومة إذ هي منقولة بالآحاد فلم يساو القياس بها على تلك الاصول في القوة والأولى أن يقال إن القياس على الاصول المعلومة له حظ من القوة من حيث كان حكم أصله معلوما ولا يمتنع أن تعارض هذه القوة قوة أخرى وهي طريق العلة بأن يكون طريق علة القياس الآخر أقوى من طريق علة القياس على الاصول أما بأن تكون العلة منصوصة أو مدلولا عليها بتنبيه فالموضع موضع اجتهاد فلا ينبغي إطلاق المنع من ذلك
يبين ذلك أن خبر الواحد إذا خص عموم الكتاب جاز أن يكون القياس على الخبر الخاص أولى من القياس على العموم وإن كان العموم معلوما وخبر الواحد غير معلوم إن قيل إن ما ورد بخلاف قياس الاصول وإن كان معلوما فانه لا يجوز القياس عليه لأنه لا يمتنع أن تدل أمارة على علة حكمه قيل هذا دعوى لا دليل عليها فان قالوا الدليل على ذلك أن القياس على الأصول يمانع القياس على ما ورد بخلاف الاصول قيل هلا كان القياس على ما ورد بخلاف قياس الاصول يمانع القياس على الاصول ويمنع أن تدل على علته أمارة وإذا جاز أن يدل على علة هذا القياس النص جاز أن يدل عليه دلالة غير النص
فان قيل ما ورد بخلاف قياس الاصول وإن كان معلوما فانه لا يجوز أن يساوي أمارة علة القياس على الاصول في القوة فلا يجوز القياس عليه قيل هذا دعوى وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد بخلاق قياس الاصول قد غير الحكم عما كان عليه من قبل لأنه لما كان معلوما صار أصلا في نفسه فلا يمتنع أن يقع التنبيه على علته ويكون التنبيه عليه أقوى وأظهر من التنبيه على علة الاصول ثم يقال لهم أليس قد جاز أن يدل عليها النص وهو أقوى وأظهر من علة الاصول فلا يجوز أن يدل عليها تنبيه النص ويكون أقوى من دلالة علة الاصول
باب في تعليل أصول العبادات والتقديرات وغير ذلك
اعلم أن أبا علي رضي الله عنه لا يجوز تعليل الاصول ولا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس ولا بتعليل الحدود وهو قول أبي الحسن ولهذا منع من قطع المختلس بالقياس ومنع من إثبات صلاة بإيماء الحاجب بالقياس ومنع من تعليل الكفارات وإثبات كفارة بقياس وسوى بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات وبين ما لا تجري مجرى العقوبات وأعمل الاستدلال في موضعها وفي موضع الحد وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه شبيها بذلك لأنه لم يثبت الصوم بدلا من هدى المحصر لأن ذلك إثبات عبادة مبتدأة ومنع الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه من إثبات النصب ابتداء بالقياس أو بخبر الواحد وكذلك لم يثبت الزكاة في الفصلان واستعمل القياس في نصب ما ثبت فيه الزكاة كما يعمل القياس في صفات الصلاة وإن لم يستعمله في نفس الصلاة وقبل خبر الواحد في إثبات نصاب زائد على المائتين على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ومنع من القياس في المقادير ولم يعلل ما رخص فيه للتساهل ولم يقس عليه كاجرة الحمام والاستصناع وقبل أبو يوسف خبر الواحد في إثبات الحدود كما يقبل الشهادة فيه وإن كان مما يدرأ بالشبهة وهذا يقتضي أنه يثبت الحد بالقياس أيضا لأن القياس كخبر الواحد في إفادة الظن فان لم يمتنع إثباته بأحدهما وإن كان يدرأ بالشبهة فكذلك الآخر أما الشافعي رحمه الله وأصحابه فانهم يعللون كل ذلك ويستعملون القياس فيه ما لم يمنع منه مانع إلا أنهم يقولون إن الأصول والحدود لا مجال للقياس فيهما ولو دل الدليل على العلة فيهما لقيس عليهما وقد حد بعضهم واطىء البهيمة قياسا على الزاني وإن كان بعضهم يقول إن ذلك زنا
والخلاف بين الناس هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز أن تدل دلالة على علة أحكامها فيمتنع استعمال القياس فيها في الجملة أو ليس ذلك بل ينبغي أن يستقرىء مسألة مسألة فأصحاب أبي حنيفة يقولون إنا قد علمنا ذلك في جملة من المسائل وهي التي ذكروها وغيرهم لا يحكم بذلك في أكثر هذه المسائل على سبيل الجملة بل يستقرءون مسألة مسألة والأظهر في كثير مما ذكروه أنه لا يظهر علته كالتقديرات واصول العبادات والأولى مع ذلك استقراء مسألة مسألة فما لا يدل على علته دلالة لم يستعمل فيه القياس لجواز أن يكون فيها ما دل دلالة على علة حكمه غير أن ما أخذ علينا التطرق إليه بالأدلة المعلومة فانه لا يجوز استعمال القياس فيه كصلاة سادسة ولإجماع الامة على أنه لا مجال للقياس فيه ولأنه لا تظهر فيه دلالة تدل على علته وما رخص فيه للتساهل فلا علة فيه إلا شذة البلوى به وكل ما هذه حاله قد رخصوه وما لم يرخصوه من ذلك فالإجماع على حظره يمنع من قياسه على ما
رخصوه ويبعد أن تظهر في التقديرات والأعداد علة فاما الكفارات فلا يبعد أن تظهر علتها فيقاس عليها غيرها بتلك العلة وليس لمن منع من ذلك أن يجري به مجرى الحدود من حيث كانت عقوبات لأنه يسوي في المنع من إثباتها قياسا بين ما يجري منها مجرى العقوبات وبين ما لا يجري منها مجرى العقوبات وأيضا فقد أثبتوا على الآكل في شهر رمضان كفارة وهي جارية مجرى العقوبات اعتبارا بالمجامع وسلكوا في ذلك مسلك التعليل ولا يعصمهم من ذلك أن يمتنعوا من تسمية ذلك قياسا وسيجيء القول في ذلك إن شاء الله
باب في الاستدلال على موضع الحكم هل هو قياس أم لا
اعلم أن الشيخ أبا الحسن رحمه الله لم يكن يثبت الكفارات بالقياس وكان يثبتها بالاستدلال على موضع الحكم فيثبت الكفارة على الأكل في شهر رمضان اعتبارا بالمجاميع فيه فيقول قد علمت أن الكفارة لم تجب في الجماع لعينه بل لأنه مفسد لعين صوم شهر رمضان مع ضرب مخصوص من المأثم وهذا موجود في الأكلوذكر قاضي القضاة رحمه الله أنه كان يفصل بين القياس وبين ذلك بأنا نحتاج إلى الاستدلال لنعلم بأن الجماع يختص بمأثم مخصوص ولا يحتاج إلى الاستدلال لنعلم أن البر مكيل فيقال له حاجتك إلى هذا الاستدلال لا يخرجك من أن تكون قد سلكت مسلك التعليل بهذه الأوصاف وأجريت حكمها معها وهذه صورة القياس على أن المقائيس ما يعلم ثبوت علته في أصله بدليل وذلك بأن تكون العلة حكما شرعيا لأن الأحكام الشرعية معلومة بالدليل على أن ما افتقر فيه إلى الاستدلال هو أخفى مما علم ضرورة فان لم تثبت الكفارة بالأجلى فالأولى أن لا تثبت بالأخفى
ويمكن أن نقيس الاستدلال على موضع الحكم بوجه آخر وهو أن يكون الحكم ثابتا في موضع مجمل ثم نستدل لنعلم ذلك الموضع فاذا ثبت بالدليل أن
شيئا من الأشياء من ذلك الموضع ألحق به حكمه لا على سبيل القياس بل على سبيل إدخال التفصيل في الجملة فان قيس الاستدلال على موضع الحكم بهذا قيل له أموضع الكفارة هو الجماع أم بعض أوصافه فان قال هو الجماع قيل هذا لا يحتاج إلى استدلال زائد على الخبر وينبغي أن لا يلحق به إلا ما كان جماعا وإن قال موضعها هو بعض أوصافه وهو إفساد عين صوم الشهر مع مأثم مخصوص قيل ابالنص علمت أن هذا موضع الكفارة أم بدليل وليس يمكنه القول بأنه علم ذلك بالنص لأن النص يتناول الجماع لا هذه الأوصاف وإن قال علمت ذلك لا بالنص ولكن باعتبار أفسدت به تعليق الكفارة بالجماع وبغيره من أوصافه سوى ما ذكرته قيل هذا تعليل منك لأنك علقت هذه الكفارة بهذه الأوصاف وقلت لها ما ثبت الكفارة وتوصلت إلى ذلك بأن أفسدت تعلق الكفارة بما عداها فاذا حكمت على الأكل بالكفارة لأنه مفسد لعين صوم رمضان مع مأثم مخصوص فقد قست وجرى ذلك مجرى أن تفسد تعليق الربا بعين البر وبصفاته سوى الكيل ثم تحرم الارز لأنه مكيل وكل من أثبت الكفارة بالقياس أن يسلك هذا المسلك ونسميه استدلالا على موضع الحكم
باب تعليل حكم الأصل بعلتين
اعلم أن حكم الأصل إذا علل بعلتين فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل بل الدليل عليه نص أو إجماع فان لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل جاز أن تصحا جميعا لأن العلة إن كانت أمارة فجائز أن تدل على الحكم الواحد امارتان وإن كانت موجبة وجه مصلحة فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين يبين ذلك أنه قد يستحق الإنسان القتل لردته ولأنه قتل غيره وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث وبالكلام إذا وجدا معا وأمثال ذلك كثيرة وإن كان إحدى العلتين دليلا على حكم الأصل فإما أن تكون دليل حكمه من غير أن يقاس بها على اصل آخر أو أن تكون دليله بان يقاس بها على أصل آخر مثال ردنا التطاول في الشهادة على السرقة إلى التطاول في الشهادة على الزنا في أن الحاكم لا يحكم بهما بعلة أن كل واحد منهما حق من حقوق الله تعالى وليست هذه العلة هي التي لها لم يحكم الحاكم بالشهادة على الزنا إذا تطاول عهدها لكن العلة في ذلك أن الشهود على الزنا مخيرون بين إقامة الشهادة بحق الله سبحانه وبين الستر على المشهود عليه فاذا أخروا الشهادة علمنا أنهم آثروا فاذا شهدوا من بعد تبينا ان عداوة تجددت لهم والعدوان تتهم الشهود وقد منع النبي صلى الله عليه و سلم من قبول شهادة ذوي الأضغان وظهر لنا أنهم من ذوي الأضغان لا أنا نقيسهم على ذوي الأضغان وهذه العلة لا يمكن ذكرها في الشهادة على السرقة لأنه يجوز أن يكون الشهود إنما أخروا الشهادة لأن المسروق منه أخر المطالبة فقد بان علة حكم الأصل غير العلة التي بها رددنا الفرع إلى الأصل
وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من أجاز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم بها قال لأن العلة التي بها يثبت حكم الأصل هي طريق الحكم في الأصل فجرت مجرى النص الدال على حكم الأصل فكما يجوز أن تدل دلالة على أن لبعض اوصاف الأصل المنصوص على حكمه تأثيرا في ذلك الحكم فتجعل علته ويقاس بها فرع من الفروع عليه جاز أيضا في بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل أن تدل دلالة على أن لبعض أوصافه تأثيرا في ذلك الحكم فتجعل علة فيه ويقاس بها على الفروع ومنهم من لم يصحح العلة التي لا يثبت بها حكم الأصل لأن هذه العلة لا يمكن أن تدل على صحتها وأنها لمكانها ثبت حكم الأصل لأنه لا يمكن أن يستدل على ذلك بفساد ما عداها لأن العلة الأخرى صحيحة ولا يمكن أن نستدل عليها بأن الحكم يوجد بوجودها في الأصل وينتفي بانتفائها عن الأصل وانتفاء ما يقوم مقامها لعلمنا أنها لو وجدت وحدها في الأصل من دون العلة الأخرى لم يثبت الحكم فاذا لم يمكن أن تدل دلالة على صحتها لم تثبت صحتها
وأما القسم الثاني وهو إذا كانت العلة التي هي دليل الحكم في الأصل يقاس بها ذلك الأصل على أصل آخر فلا يخلو إما أن يمكن أن يقاس الفرع الآخر بتلك العلة على الأصل الأول أو لا يمكن فإن لم يمكن فالخلاف فيه
كالخلاف فيما تقدم الآن وإن أمكن ذلك فمثاله أن يرد الذرة إلى الارز بعلة أنه مكيل ويرد الارز إلى البر بهذه العلة وهذا تطويل لا فائدة فيه لأنه يمكن رد الذرة إلى البر بهذه العلة ولأن رد الذرة إلى الارز يوهم أن حكمه منه مستفاد وليس كذلك لأن الذرة كالارز في أن العلم بحكم أحدهما لا يسبق العلم بحكم الآخر فلا يترتب عليه بل حكمها يترتب على البر
باب في تعليل الأصل بعلة لا تتعدا
أما الشيخ أبو عبد الله رحمه الله فانه أفسدها إلا أن يدل عليها نص أو إجماع وحكى عنه قاضي القضاة رحمه الله أنها صححها في بعض مسائله والشيخ أبو الحسن رضي الله عنه أفسدها إلا أن يدل عليها نص والشافعي وأصحابه وقاضي القضاة يصححونهاوالدليل على صحتها هو أن من أفسدها إما أن يفسدها لأنها لم تتعد إلى فرع مختلف فيه أو أنها لم تتعد إلىفرع أصلا اختلف فيه أو لم يختلف فيه فان قال بالأول كان قد جعل صحتها وفسادها موقوفين على أن يختار الناس الخلاف في الفرع أو الاتفاق فيه وهذا شنيع وأيضا فإن كانت العلة هي وجه المصلحة فوجوه المصالح إذا حصلت في الشيء اقتضت كونه مصلحة وقع الاتفاق عليه أو لم يقع وإن كانت أمارة على الحكم وعلى وجه المصلحة فالأدلة والأمارات لا تفسد بالاتفاق على مدلولها وإن قالوا بالثاني فالذي يفسده أيضا هو أن العلة الشرعية إذا دلت عليها الأمارة غلب على ظننا أنها وجه المصلحة وإن لم تتعد لأن وجوه المصالح قد تختص نوعا واحدا وقد تتعداه كما نقوله في وجوه القبح والحسن كلها وأيضا فالعلة لو فسدت إذا لم تتعد لكان فسادها وجه معقول
فان قالوا الوجه في ذلك هو أن العلة المستنبطة إذا لم تتعد لم يكن في استنباطها فائدة لأن حكم الأصل ثابت بالنص لأنها بالنص قد أغني غنها في الأصل وليست موجودة في فرع فيكون طريقا إلى حكمه وإذا لم يكن في
استنباطها فائدة كانت عبثا وليس كذلك العلة المنصوصة لأنها لم تثبت علة بالاستنباط قيل إن المستنبط للعلة طالب لها وهو في حال طلبه لا يعلم ما علة الحكم وهل هي متعدية أم لا فيقال له لا تتكلف هذا البحث والطلب وإنما يعلم أن العلة التي تبحث عنها لا تتعدى بعد استيفاء الطلب وأيضا يكون الطلب لها عبثا لا يفسد العلة لأنه لا يمتنع كونها علة ويكون الطالب لها عابثا حين يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه وأيضا فلو جاز أن يكون الطلب لها عبثا لأنها ليست بطريق إلى الحكم لا في الحكم ولا في الفرع لكان النص عليها عبثا لأنها ليست بطريق إلى حكم في أصل ولا فرع وأيضا وقوع الغنى عن الشيء لا يفسده ألا ترى أنا نستغني بالقرآن في بعض الأحكام عن أخبار الآحاد وعن القياس ولا يوجب ذلك فسادهما
فان قيل خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى الحكم الذي دل عليه القرآن ولا يمكن أن تكون العلة القاصرة طريقا إلى حكم أصلا قيل إنما تكلمنا على قولكم طلبها عبث إذ النص قد أغنى عنها وليس لها وجود في بعض الفروع ولم نتكلم على ما ذكرتموه الآن وهو قولكم العلة القاصرة لا يمكن أن تكون طريقا إلى حكم فلم يكن في طلبها فائدة فان قلتم ذلك أجبناكم بما تقدم دون هذا الوجه
وإن قالوا إذا لم تكن العلة طريقا إلى حكم لم تكن فيها نفسها فائدة وما لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله عز و جل عليه أمارة فكل علة قاصرة فإنا نعلم أن الله عز و جل لم ينصب عليها أمارة قيل وما لا فائدة فيه لا يجوز أن ينص الله عز و جل ولا رسوله عليه فان جعلتم للنص عليها فائدةفقد بطل قولكم إن ما لا يفيد حكما فهو فاسد وأيضا فلا فائدة أكثر من العلم بعلة الحكم فانا إذا علمنا كم الشيء ووقفنا على علنه صرنا عالمين أو ظانين بما لم نكن عالمين به وذلك ما تتشوق النفس إلى معرفته ولا يمتنع أن يكون لنا في ظن ذاك مصلحة وفائدة أخرى وهي أن نمتنع من قياس فرع على أصل علته قاصرة
فان قالوا فهذا يمكن إذا لم تنصب أمارة على أن ذلك الوصف علة قيل
هذا القدر لا يمنع من القياس على ذلك الأصل لأنه يجوز أن يظن أن علته وصف آخر فيقاس به فرع من الفروع وإذا ظننا أن ما لا يتعدى هو العلة لأن أمارة كونه علة أقوى من كل الأمارات رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم نقس على ذلك الوصف شيئا ولهم أن يقولوا وكان يمكن أن لا يقاس على ذلك الأصل بأن لا ينصب الله عز و جل أمارة على شيء من أوصافه وإذا أمكن ذلك لم يكن في نصب أمارة على الوصف الذي لا يتعدى فائدة
واقوى ما يمكن أن يحتجوا به هو أن العلة الشرعية أمارة والأمارة كالدلالة في أنها كاشفة عن شيء ولا يتصور دلالة وامارة لا تكشف عن شيء والعلة القاصرة لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع فلم تكن أمارة وإذا لم تكن أمارة لم تكن علة والجواب إنه إذا دلت أمارة صحيحة على كون الوصف علة قضينا بأنها وجه المصلحة وقلنا بأن العلة أمارة على معنى أنها مظنون كونها علة ويمكن أن نقول إنها أمارة على وجه المصلحة بمعنى أنها مقارنة فيدل على أن وجه المصلحة يوجد حيث توجد العلة ثم يقال لهم إذا نص على العلة التي لا تتعدى أليس تكون العلة أمارة أو دلالة فان قالوا بلى قيل لهم فعلى ما تدل فان قالوا إنها تكون وجه المصلحة أو تكون أمارة على وجه المصلحة ولا تكون أمارة ولا دلالة على حكم قيل لهم مثله في العلة المستنبطة
باب في اختلاف موضوع العلة والحكم
اعلم أن العلة قد تكون حكما ما شرعيا ويكون حكمها شرعيا وإذا كان أحدهما مبنيا على التخفيف والآخر على التغليظ جاز أن يجعل ذلك أمارة تقتضي أن لا يعتبر أحدهما بالآخر ويمكن أن يجاب عن ذلك فيقال لا يمتنع اعتبار أحدهما بالآخر إذا دلت الدلالة على صحة العلة فان قيل إنه لا يجوز أن تدل الدلالة على صحة مثل هذه العلة انتقل الكلام إلى إقامة الدلالة على صحة العلة ونحن من بعد نذكر الكلام في العلة من حيث هي دليل على حكم الفرع إن شاء الله
باب في اختلاف موضوع الفرع والأصل وفي حكم الفرع إذا تقدم حكم الأصل
أما اختلاف موضوع الأصل والفرع فنحو أن يكون الأصل مبنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويكون الفرع مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مخففا ويكون الأصل مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويكون الفرع مبنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مغلظا فاختلاف الفرع والأصل كالأمارة على أنه لا ينبغي رد أحدهما إلى الآخر فان دلت دلالة على صحة العلة الجامعة بينهما أوجبت الدلالة التسوية بين الفرع والأصل في ذلك الحكم وإن اختلفا في التغليظ والتخفيف من وجوه أخروأما الفرع إذا تقدم حكمه على حكم الأصل فمثاله الوضوء إذا قيس على التيمم في اشتراط النية فيه وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم وجب بعد الهجرة وقد منع من ذلك قوم لأن شرط ما تقدم وجوبه لا يجوز كونه مستفادا مما تأخر وجوبه لأن الدليل لا يجوز تأخره عن المدلول عليه والأولى أن يقال إن الفرع إذا تقدم حكمه فانه إن لم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل فانه لا يصح ذلك القياس لأنه لا يجوز أن يكون لنا على الحكم الذي تعبدنا به دليل في الحال وإن دل على حكم الفرع دليل متقدم لم يبطل ذلك القياس لأنه لا يجوز أن يدلنا الله عز و جل على الحكم بأدلة مترادفة ألا ترى أن المعجزات تتواتر بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة
باب في العلة هل هي دليل على رسم الفرع ثم يعلق به حكم شرعي أو تدل
ابتداء على حكم شرعيحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال إنما يثبت بالقياس الأسماء في الفرع ثم تعلق عليها الأحكام وكان يتوصل بالقياس إلى أن الشفعة تركة ثم
يجعلها موروثة وإن وطىء البهيمة زنا ثم يتعلق به الحد وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدة ثم يحرمه بالآية وأكثر الفقهاء متفقون على أن العلل تثبت بها الأحكام
فان كان أبو العباس بن سريج منع من إثبات الأحكام في الفرع بالعلل فذلك باطل لأن أكثر المسائل إنما تعلل فيها أحكامها دون أسمائها والأمارات إنما تدل على أن بعض صفات الأصل له تأثير في الحكم لا في الاسم ألا ترى أنا نعلل تحريم البر بكونه مكيلا لا بكونه مسمى بأنه بر والأمارة إنما تدل على أن للكيل أو الطعم تأثيرا في تحريم بعضه ببعض متفاضلا لا في كونه مسمى بأنه بر ثم إنا نرد الارز إليه لنثبت فيه حكمه ابتداء لا تبعا للاسم لأنا لا نروم بقياسه عليه أن نسميه برا وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى الأسماء في بعض المواضع ولم يمنع من أن يتوصل بها إلى الأحكام أيضا فان أراد بالعلل العلل الشرعية وبالأسماء الأسماء اللغوية فذلك باطل لأن اللغة أسبق من الشرع ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بها فلا يجوز إثبات أسمائها بأمور طارئة ولأن أمارات جميع العلل الشرعية تتعلق بالأحكام ولا تتعلق بالأسماء اللغوية وإن أراد أن الأسماء قد تثبت في اللغة بقياس غير شرعي نحو أن نعلم أنهم سموا الجسم الأبيض الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض فيه لعلمنا أنه إذا انتفى عنه البياض لم يسموه بذلك فاذا وجد فيه سموه بذلك ثم نقيس عليه ما غاب عنهم من الأجسام البيض فقد تقدم القول في ذلك وليس هو ببعيد وإن أراد أن من الأسماء الشرعية ما تثبت بالعلل فغير بعيد ايضا لأنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة من الصفات متى انتفت عنها لم تسم في الشريعة صلاة فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يسمى صلاة
وأما قول بعض الشافعية أن النبيذ يسمى خمرا فليس هو مذهب الشافعي
وقد قال في كثير من كتبه إن الخمر هو عصير العنب الني المشتد وأما قياسه النبيذ على الخمر بعلةالشدة وإيجابهم بذلك أن يسمى خمرا فباطل لأن الخمر لم تسم خمرا للشدة فقط وإن كان لو لم توجد الشدة لم تسم خمرا كما أن الخل لم يسم خلا للحموضة وإن كان لولاها لم يسم خلا لكنه إنما سمى خمرا لأنه عصير العنب الني المشتد ولو كان قولنا خمر يشتمل التمري والعنبي لشمول اسم الخمر لخمر العراق وخمر فارس لكان قول القائل لغيره أمعك نبيذ أم خمر كقوله أمعك خمر أو خمر العراق فلما افترقا في الجنس علمنا أن اسم الخمر لا يتناول النبيذ وقول النبي صلى الله عليه و سلم الخمر من هاتين محمول على أنه إنما سمى ما يكون من النخلة خمرا مجازا لما ذكرناه الآن
فان قيل هلا قلتم إنه يقع عليه اسم الخمر يعرف الشرع قيل ليس هذا قولا لأحد ولو اقتضاه عرف الشرع لسبق إلى إفهام أهل الشرع من قولنا خمر التمري والعنبي معا على سواء كما يسبق إلى إفهامهم من اسم الصلاة هذه الأفعال الشرعية فكان ينبغي أن يقبح أن يقول القائل أمعك نبيذ أم خمر
باب في أن العلة هل يتوصل بها إلى إثبات الحكم في الفرع وإن لم ينص عليه
في الجملة أم لاذهب الشيخ أبو هاشم رحمه الله إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم في شيء بالقياس إلا وقد ورد النص باثباته فيه على الجملة فيكون القياس دالا على تفصيل الحكم قال فلو لم يكن إرث الأخ ثابتا في الجملة لم يجز إثبات إرثه مع الجد بالقياس وأجاز غيره من القائسين إثبات الحكم بالقياس وإن لم يتقدم إثباته في الجملة والدليل على ذلك هو أن الدلالة العقلية على جواز استعمال القياس لا تخص التفصيل من الجملة بل تجوز استعمال القياس فيها ولأن الأمة قاست مسألة الحرام ولم يتقدمه فيها حكم شرعي على الجملة راموا
تفصيله بل كانوا لمقايستهم يثبتون أصل الحكم وقول الله عز و جل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ليس يدل على إثبات الحكم في الجملة في مسألة الحرام لأن ذلك إنما يدل على المنع من التحريم ولا يدل على حكم التحريم إذا وجد وقد قاس مثبتو القياس الارز على البر ولا يتقدمه تحريم ببيعه متفاضلا على الجملة
باب في تخصيص النصوص بالقياس ونسخها به
أما نسخ النصوص بالقياس فسنبينه في تضاعيف هذا الفصل وأما إذا كان القياس رافعا للنصوص من غير نسخ فقد تقدم ذلك في الأخبار وإنما ذكرنا هذا الفصل هناك ولم نذكره في أبواب القياس لأنا نقدم النص على القياس وذلك لا يقف على كون القياس حجة في الجملة وأما إذا كانت النصوص عامة فانما ذكرنا القول في معارضة القياس لها في ابواب القياس لأنا نخصص العموم بالقياس وذلك لا يتم إلا والقياس حجة في الجملةوقد اختلف الناس في تخصيص العموم بالقياس فقال الشيخ أبو علي رحمه الله وبعض الفقهاء لا يخص به أصلا وهو قول أبي هاشم أولا وقال الشافعي وأبو الحسن وكثير من الفقهاء أنه يخص به العموم على كل حال وهو قول أبي هاشم أخيرا ومن الناس من خص العموم بالقياس في حال دون حال واختلف هؤلاء في تلك الحال فمن أصحاب الشافعي من خص العموم بالقياس الجلي ولم يخصه بالخفي ومن الناس من خصه بالقياس إذا دخله التخصيص ولم يخصه به إذا لم يدخله التخصيص
والدليل على تخصيص العموم بالقياس هو أن الصحابة رضي الله عنها اختلفت في الجد فبعضهم جعله أولى من الأخ والاخت بجميع المال وذهب في
ذلك إلى قياس وخص به قول الله عز و جل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وبعضهم قاسم بين الجد والأخ واستدل بالقياس على أنه يقاسم ولم يجعل للاخ إرث جميع مال اخته ولم يجعل لاخته مع الجد النصف بل خص الآية وهذا يبطل قول من لم يخص العموم إلا بقياس معنى لأن القياس في مسألة الجد هو قياس غلبة الأشباه
فان قالوا خصو الآية بكون الجد وارثا بمقدار ما يرثه وإثبات إرثه في الجملة معلوم بقياس جلي قيل إنهم لم يذكروا في ذلك قياسا مفردا بل لم يستعملوا في إثبات إرثه إلا ما استعملوه في مقدار إرثه لأنهم استعملوا القياس في هل يرث الكل أو البعض ثم تبع ذلك ثبوت إرثه وهذه الدلالة تفسد قول من شرط في تخصيص العموم بالقياس أن يكون العموم قد خص من وجه آخر لأنا قد بينا في تخصيص العموم بأخبار الآحاد أن العموم المخصوص هو كالعموم الذي لم يخص وإذا لم يكن بينهما فرق كان إجماع السلف رضي الله عنهم على أحدهما كاجماعهم على الآخر كما إن إجماعهم على القياس في مسألة الجد دليل على صحة القياس في مسألة تجري مجراها
إن قيل اليس التخصيص في معنى النسخ لأن كل واحد منهما هو إخراج بعض ما تضمنه الطاب ثم لم يدل عندكم إجماع الصحابة على تخصيص العموم بالقياس وبأخبار الآحاد على جواز نسخه بهما ولا دل إجماعهم على المنع من نسخ العموم بهما على المنع من تخصيصه بهما فهلا قلتم إن إجماعهم على تخصيص عموم الكتاب بالقياس إذا دخله التخصيص لا يدل على جواز تخصيصه إذا لم يدخله التخصيص وإن كان أحدهما في معنى الآخر قيل إن الحكمين إذا كان معناهما واحدا فان الدلالة على جواز أحدهما هي دلالة على جواز الآخر إلا أن يمنع من ذلك مانع ألا ترى أن الصحابة لو أجمعت على قبول خبر
الواحد في وجوب النية في الوضوء لدل ذلك على قبوله في النية في التيمم فاذا ثبت ذلك فاجماعهم على تخصيص العموم بالقياس هو دليل على جواز نسخه بالقياس لولا مانع من ذلك وهو الإجماع وإجماعهم على المنع من نسخه بالقياس هو دليل على المنع من تخصيصه بالقياس لولا مانع منع من ذلك وهو إجماعهم على تخصيصه به
دليل آخر وجوب العمل بالقياس مقطوع به لأن دليله مقطوع به وهو إجماع الصحابة كما أن العمل بالعموم مقطوع به فهما متساويان في هذه الجهة ومنها يقع التخصيص فيجب إذذ كان أحدهما أخص من الآخر أن يخص به الأعم كما يخص العموم بدليل خاص مقطوع به يبين ذلك أنا نعدل عن مقتضى العقل في تحليل الأنبذة وغير ذلك إلى القياس مع أن مقتضى العقل مقطوع به فيجب مثله في العموم
فان قيل إنما نعدل إلى القياس عن مجوزات العقول لا عن واجباتها وإباحة النبيذ من مجوزات العقول قيل ما معنى وصفكم لإباحة النبيذ أنه من مجوزات العقول فان قالوا معنى ذلك أن العقل وإن أباحه فانه يجوز أن يختص بوجه مفسدة في المستقبل فيرد الشرع بتحريمه قيل لهم وكل ما يعدل إليه بالقياس عن مقتضى العقول هذه سبيله وهو موضع استدلالنا عليكم فان قالوا إنما جوزنا استعمال القياس في مقتضى العقل لأن العقل اقتضى حكمه بشرط أن لا ينقلنا عنه دليل سمعي والقياس دليل سمعي فاذا نقلنا عن مقتضى العقل وجب الانتقال عنه قيل والعموم أيضا إنما يقتضي الاستغراق ما لم يمنعنا دليل سمعي والقياس في الجملة دليل سمعي عندنا وعندكم واعلم أنا قد بينا في تخصيص العموم بأخبار الآحاد انه لا يصح الاحتجاج باجماع الصحابة على قبول أخبار الآحاد في الجملة على قبولها في التخصيص وأنه إنما ينبغي أن يحتج بقبولهم لها في التخصيص لأن إحدى المسألتين مفارقة للاخرى وما ذكرناه هناك يتوجه ها هنا فلا معنى لإعادته
دليل قد خصت الصحابة العموم بالقياس لأنها خصت آية الجلد واخرجت منها العبد لأنهم لم يجلدوه مائة وإنما خصوه بالقياس ولقائل أن يقول ما يؤمنكم أن يكونوا خصوه من الآية بدليل غير القياس واستغنى بالإجماع عن نقله
دليل قد خصت الصحابة قول الله عز و جل أحل الله البيع بقياس الارز على البر ولقائل أن يقول لا سبيل لكم إلى بيان ذلك لأن كثيرا من الفقهاء لا يسلمون أن الصحابة اعتقدت تحريم التفاضل فيما عدا الستة فضلا عن أن يكونوا محرمين له قياسا
دليل قد عدلت الصحابة عن ظاهر القرآن لقياس فيجب مثله في التخصيص لأن التخصيص عدول عن الظاهر ولقائل أن يقول إن من يخالف في تخصيص عموم الكتاب بالقياس لا يسلم أن الصحابة أجمعت على ترك الظاهر بالقياس
واحتج المخالف باشياء
منها أن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة ولا يجوز الاعتراض بالمظنون على المعلوم والجواب عن ذلك قد تقدم في باب تخصيص العموم بأخبار الآحاد وربما تعلق بهذه الشبهة من لا يجيز تخصيص العموم بالقياس إذا لم يدخله التخصيص ويجيز تخصيصه إذا دخله التخصيص فاذا نوقض بتخصيصه بالقياس إذا دخله التخصيص يقول إن دخول التخصيص يدل على أن صاحب الشريعة قال مع العموم احملوه على عمومه ما لم يمنعكم مانع ويدل على أن صاحب الشريعة قد أشعرنا بأنه معرض للتخصيص فيقال له لم زعمت أن تخصيصه يقتضي حمله على عمومه ما لم يمنع منه مانع فان قال لأن العموم من حقه أن يجري على عمومه إلا لدليل قيل فهذا حكم العموم
سواء علمنا دخول التخصيص عليه أو لم نعلم ذلك وليس يقف ذلك على دخول التخصيص ويقال له ودلالة الأمارة على تخصيص العموم تدل على أن صاحب الشريعة قال في العموم إحملوه على عمومه إلا أن يمنع من ذلك مانع ويقال لهم لم زعمتم أن دخول التخصيص في العموم إشعار بتخصيص زائد وربما قالوا لو خص العموم الذي لم يدخله التخصيص لاقترن به ما يخصه لأن البيان لا يتأخر قيل كذلك يقول من لم يجوز تاخير البيان لأنه يذهب إلى أن ما دل على علة القياس لم يكن متأخرا عن العموم ثم يقال له يلزمك ما ألزمتنا في العموم إذا دخله التخصيص وقالوا أيضا إن ما دخله التخصيص يدل على أن صاحب الشريعة قد قال فيه إنه ليس المراد به جميعه فيكون مجملا فجاز إعمال القياس فيه والجواب أن العموم إذا خص تخصيصا معينا فانه يبقى الباقي ومعلوم دخوله تحت العموم ولا يكون مجملا وإنما يكون مجملا إذا خص تخصيصا غير معين
ومنها قولهم إن القياس إنما يصح بالضرورة الداعية إليه ومع وجود العموم فلا ضرورة تدعو إليه الجواب يقال لهم اتريدون أن الضرورة الداعية إلى القياس زائلة إذا دخل الحكم تحت لفظ العموم أو اذا كان الحكم مرادا بالعموم فان قالوا بالأول كان موضع الخلاف وإن قالوا بالثاني لم يمكنهم أن يبينوا أن الحكم مراد بالعموم إلا إذا اثبتوا أن القياس ليس بحجة مع العموم فيصير دليلهم مبنيا على نفس المسألة فان قالوا تناول لفظ العموم للمسألة يدل على أنها مرادة به وذلك نعني عن القياس قيل إنما تعلمون أن تناول لفظ العموم لها يدل على انها مرادة به إذا علمتم أنه ليس من شرط دلالة العموم على ذلك أن لا يعارضه قياس وإنما تعلمون ذلك إذا علمتم أن القياس المخصص للعموم ليس بدلالة وهذا موضع الخلاف
ومنها قولهم إن القياس فرع على النص فلو خص القياس العموم لكان قد اعترض بالفرع على الأصل الجواب إن قياس الارز على البر إنما يخص
قول الله عز و جل وأحل الله البيع وليس هذه الآية أصلا لهذا القياس لأن أصل القياس هو إما ما يقع الرد إليه كالبر أو تحريمه أو ما يدل على تحريمه أو ما يدل على صحة القياس كاجماع الصحابة وغيره فاما قول الله عز و جل وأحل الله البيع فليس هو الذي رددنا إليه الارز ولا هو الدال على صحة القياس فلم يعترض بالفرع على أصله
ومنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ بماذا تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة نبيه قال فان لم تجد قال أجتهد رأيي فجعل اجتهاده مشروطا بان لا يجد الحكم في الكتاب والسنة وما يتناوله عموم الكتاب والسنة فهو موجود إما في الكتاب وإما في السنة وقد صوبه النبي صلى الله عليه و سلم الجواب أن المراد بذلك إن لم يجد في نص الكتاب والسنة الذي يعلم بدليلنا يدل على ذلك أنه قال أحكم بكتاب الله عز و جل قال فان لم تجد قال أحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعلوم أن ذلك لا يمنع من تخصيص الكتاب بالسنة المعلومة وليس يجوز الجواب عن هذا الخبر بان يقال إن حكم القياس غير موجود وإن تناوله العموم وأن ذلك قد دخل تحت قوله أجتهد رأيي لأنه إنما يعلم معاذ أن ذلك الحكم غير موجود في الكتاب وان تناوله عمومه بعد أن يجتهد فيعلم أن القياس قد دل على أن ذلك الحكم لم يرد بالعموم وعند ذلك يسقط عنه الاجتهاد ومعلوم أنه قد جعل اجتهاد رأيه مشروطا بنفي وجدانه الحكم وهذا التأويل يقتضي أن نفي وجدانه الحكم في الكتاب مشروط بتقدم اجتهاد رأيه
ومنها أن النسخ كاتخصيص في ان كل واحد منهما يدل على أن المخاطب بالخطاب لم يرد به بعض ما تناوله فاذا لم يجز النسخ بالقياس فكذلك التخصيص والجواب أن شيخنا أبا عبد الله يقول إن الأمة أجمعت على أن القرآن لا ينسخ بقياس كما أجمعت الصحابة على أنه يخص به ولولا ذلك لجوزت نسخ القرآن به فالشبهة زائلة عنه فان قيل كيف يجوز أن نجمع على
المنع ما اجمعت الصحابة على جوازه قيل إن الصحابة لم تنص على جواز نسخ القرآن بالقياس وإنما أجمعت على تخصيصه بالقياس الذي هو في معناه وليس يمتنع أن يرد التعبد بأحدهما دون الآخر لوجه المصلحة يفترقان فيه لا يعلمه إلا الله عز و جل ألا ترى أنه كان يجوز ورود النص بالفرق بين التخصيص والنسخ بالقياس وأجاب الشيخ أبو هاشم رحمه الله بأنه إنما لم يجز النسخ به لأنه لا يجوز أن ينزل الله عز و جل نصا ويجعل العمل به موقوفا على اجتهادنا وإنما الجائز صرفه من وجه إلى وجه بالاجتهاد ولقائل أن يقول إن كون العمل بالنص موقوفا على اجتهادنا معناه أنا نجوز أن لا يعمل به أصلا إذا أدى الاجتهاد إلى ذلك وليس هذا سبيل النسخ من المنسوخ قد عمل به في حال متقدمة فان كان إخراج بعض الأشخاص من كونهم مرادين بالخطاب هو صرف للخطاب من جهة إلى جهة وليس هو إيقاف الخطاب على اجتهادنا فكذلك إخراج حكم الخطاب في بعض الأزمان دون بعض هو صرف الخطاب من جهة إلى جهة وأجاب أصحاب الشافعي عن الشبهة بأن النسخ إنما لم يصح بالقياس لأن كونه ناسخا للنص بخلافه والقياس لا يصح إذا دفعه النص فوقوع النسخ به وقوع بدليل فاسد وهذا لا يصح لأن القياس إذا نسخ الكتاب لم يكن الكتاب بخلافه لأنه ليس يبطل حكمه وإنما يقصر حكمه على بعض الأزمان كما أن القياس إذا خصه لم يكن النص بخلافه لأنه لم يرفعه بالقياس وإنما قصره على بعض الأشخاص
ومنها قولهم من شرط القياس أن لا يرده النص لأن الامة أجمعت على هذا الشرط وإذا كان العموم بخلاف القياس فقد رده النص الجواب يقال لهم إن أردتم برد النص أن يكون القياس دافعا له أصلا فكذلك نقول وليس ذلك موجودا في مسألتنا وإن أردتم أن يكون القياس ينافي بعض ما اقتضاه العموم فليس فساد ما هذه سبيله يجمع بل هو موضع الخلاف
باب في قلب العلة والقول بموجبها
أما قلب العلة فهو أن يعلق الخصم عليها ضد ما علقه المعلل من الحكم فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر فيبطل تعلقها بهما وذلك على أضرب أحدهما أن يكون الحكمان مفصلين والآخر أن يكونا مجملين والآخر أن يكون أحدهما مجملا والآخر مفصلا أما المفصلان فضربانأحدهما أن يتناقضا بأنفسهما حتى يقول المعلل فوجب أن يجوز ويقول الاخر فوجب أن لا يجوز والآخر لا يتناقضان بأنفسهما بل بواسطة مثاله أن يعلل المعلل استحقاق من قتل بغير السيف للقصاص بأنه قتل لا على وجه القصاص فأشبه ما إذا قتل القاتل بالسيف فيقول الخصم فوجب أن لا يقتص منه بغير السيف كما إذا قتل القاتل بالسيف أما القسم الأول فلا وجود له لأن الحكمين إذا تناقضا كذب احدهما واستحال اجتماعهما في الأصل ومن حق من قلب القياس أن يصدق هو والمعلل فيما يحكمان به في الأصل واما الثاني فله وجود وهو دليل على فساد العلة لأنه ليس بان تدل العلة على أحد الحكمين ولا تدل على الآخر لأن الإجماع واقع على أحد الحكمين إذا ثبت انتفى الآخر بأولى من العكس واما إذا كانا مجملين فنحو أن يقول أحدهما فوجب أن يكون من شرط هذه العبادة معنى ما ويقول الآخر فوجب أن لا يكون من شرطها معنى من المعاني وهذا كالقسم الأول في التناقض لأن الحكمين وإن كانا مجملين فهما مفصلان في إثبات الشرط ونفيه وأما إذا كان أحدهما مجملا والآخر مفصلا فضربان
أحدهما أن يكون المجمل هو حكم التسوية نحو أن يقول القائل فوجب أن يستوي كذا مع كذا وتكون الامة مجمعة على أن أحدهما على الحظر فيجب مثله في الآخر والآخر ليس هو قياس التسوية ومثاله تعليل الاعتكاف
بأنه لبث في مكان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى من المعاني كالوقوف بعرفة ويقول الخصم فلم يكن من شرطه الصوم كالوقوف وهذا هو الذي قلبه يفسد العلة لأنه ليس بأن يدل العلة على أحدهما فينتفي الآخر لمكان الإجماع بأولى من العكس وهذا أولى مما ذكرناه في كتاب أفردناه في القياس الشرعي فان اعترض قلب العلة نقض أو غيره من وجوه الفساد بطل القلب وصح قياس المعلل لأنه قد صار حكمه أولى بأن يعلق على العلة
فأما القول بموجب العلة فهو أن يمكن الخصم أن يقول بالحكم الذي علقه القائس فيعلم أن العلة ما دلت على موضع الخلاف مثاله تعليل الاعتكاف بأنه لبث في مكان مخصوص فكان من شرطه معنى ما كالوقوف بعرفة فيقول الخصم أنا أقول من شرط الاعتكاف اقتران معنى ما وهو النية
باب في تخصيص العلة
اعلم أن العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها ومعناها في فرع من دون حكمهافالأول هو الكسر وذلك بأن ترفع وصفا من أوصاف العلة ظنا منك أنه لا تأثير له وأن الذي يجوز أن يؤثر في الحكم هو ما عداه ثم ينقض ما عداه مثاله أن يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤها كصلاة الأمن فيظن المعترض انه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وأن الذي يظن أنه مؤثر في الوجوب هو وجوب القضاء ثم ينقض ذلك بصوم الحائض في شهر رمضان يجب قضاؤه وليس بواجب وينبغي للمعلل إذا أراد أن يجيب عن ذلك أن يبين أن لكون العبادة صلاة تأثيرا في الحكم المعلل وأن الصلاة تخالف الصيام في هذا الباب
وأما القسم الثاني فهو النقض وقد اختلف الناس هل يجوز تخصيص العلة المستنبطة ولا يمنع ذلك من كونها أمارة على الحكم ولا يجوز تخصيصها ويكون تخصيصها مانعا من كونها أمارة فأكثر أصحاب أبي حنيفة يجيزون تخصيصها وهو محكي عن مالك وأصحاب الشافعي يمنعون وربما مر في كلام الشافعي جوازه وذكر قاضي القضاة في الشرح أن الشافعي يجيز ذلك وإنما يعدل عن حكم علة إلى حكم علة أخرى والمعلوم من مذهبه أنه يشترط نفي العلة الثابتة في العلة الاولى حتى لا ينتقض غير أنه لا يصرح باشتراط ذلك لأنه معلوم من مذهبه الاشتراط
أما العلة الشرعية المنصوصة فقد اتفق على جواز تخصيصها من أجاز تخصيص الشرعية المستنبطة واختلف مانعو تخصيص المستنبطة في جواز تخصيص المنصوصة الشرعية فأجازه بعضهم وهو ظاهر مذهب الشافعي ومنع منه آخرون وأقوى ما يحتج به المانعون من تخيص العلة المستنبطة هو أن يقال معنى قولنا إنه لا يجوز تخصيص العلة هو أن تخصيصها يمنع من كونها أمارة وطريقا إلى الوقوف على الحكم في شيء من الفروع سواء ظن بها أنه وجه المصلحة أو لم يظن بها ذلك فاذا بينا ان تخصيصها يمنع من كونها طريقا إلى الحكم فقد تم ما اردناه وبيان ذلك أنا إذا علمنا أن علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا هي كونه موزونا ثم علمنا إباحة بيع الرصاص متفاضلا مع أنه موزون لم يخل إما أن نعلم ذلك بعلة أخرى تقتضي إباحته هي أقوى من علة تحريم الذهب وإما أن نعلم ذلك بنص فإن دل على إباحته علة يقاس بها الرصاص على أصل مباح نحو كونه أبيض أو غير ذلك من أوصافه فانا حينئذ إنما نعلم تحريم بيع الحديد متفاضلا لأنه موزون غير أبيض لأنا لو شككنا في كونه أبيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما لا نعلم ذلك لو شككنا في كونه موزونا فبان أنا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شيء بكونه موزونا فقط وبطل أن يكون هذا فقط علة وثبت أن العلة كونه موزونا مع أنه غير أبيض
فان قال أنا أشترطه غير أني لا أسميه جزءا من العلة وإن كان التحريم لا يحصل من دونه قيل قد ناقضت في هذا الكلام لأنك قد اشترطته في التحريم ولم تفصل بينه وبين غيره من الأوصاف ثم نقضت ذلك بقولك لا أسميه جزءا من العلة مع أنك قد وافقت في المعنى وخالفت في الاسم وإن دل على إباحة بيع الرصاص نص وكنا قد علمنا إباحته فالقول في ذلك قد تقدم من أن نشترط نفي علة الإباحة في علة الحظر وإن لم نعلم علة إباحته فمعلوم أن علة ذلك مقصورة على الرصاص لا يتخطأه لأنها لو تخطئه لوجب في الحكمة أن ينصب الله عليها دلالة ليعلم ثبوت حكمها فيما عدا الرصاص وإذا كان كذلك لم نعلم قبح بيع الحديد متفاضلا ولا غيره إلا إذا علمناه موزونا ليس برصاص لأنه لو شككنا في كونه رصاصا لم نعلم قبح بيعه متفاضلا وكذا القول في الاستدلال بالعموم لأنا إنما نعلم حسن قتل زيد المشرك بقول الله عز و جل اقتلوا المشركين وإن ذلك تناوله اللفظ مع أنه لا دليل يخصصه وهذا لا يمكن تخصيصه والذي يبين ما قلناه من اشتراط نفي المخصص أن الإنسان لو استدل على طريقه في برية بأميال منصوبة ثم رأى ميلا لا يدل على طريقه وعلم أنه لا يدل على طريقه لأنه أسود فانه لا يستدل فيما بعد على طريقه بوجود ميل دون أن يعلم أنه غير أسود لأنه لو شك في سواده لم يستدل به على طريقه فقد صح ما اردناه والعلة المنصوصة في ذلك كالمستنبطة
وقد احتج في المسألة بأشياء أخر
منها أنه لا طريق إلى صحة العلة الشرعية المستنبطة إلا جريانها في معلولاتها فاذا لم تجر فيها لم يكن إلى صحتها طريق ولو كانت صحيحة لوجب في الحكمة نصب طريق إليها وهذا باطل لما بيناه من أن جريان العلة في معلولها ليس بطريق إلى صحتها فضلا أن يقال إنه ليس إليها طريق سواه
فلم يجب بطلان العلة إذا لم تجر في معلولها
ومنها قولهم إن العلة الشرعية قد دل الدليل على تعلق الحكم بها فلم يجز تخصيصها كالعلة العقلية ولقائل أن يقول ولم زعمتم أن العقلية إنما لم يجز تخصيصها لأن الدلالة دلت على تعلق الحكم بها وما أنكرتم أن الذي له لم يجز تخصيصها هو كونها موجبة والعلة الشرعية أمارة فالأمارات قد يتبعها حكمها وقد لا يتبعها فان قالوا ألستم تجوزون كون بعض العلل الشرعية وجه المصلحة ووجوه المصالح موجبات ايضا فلم يجز إذا تخصيصها قيل إن ثبت ذلك في بعض العلل الشرعية فأنا نظن كونها وجه مصلحة فهي من هذه الجهة أمارة أيضا والأمارات المظنونة لا يجب أن لا تخطيء أبدا فان قالوا العلة المانعة من تخصيص العقلية هو وجوب تبع حكمها لها اينما حصلت ما لم يمنع من ذلك مانع فلذلك لم يجز ان يمنع مانع من حكمها وكان وجوب تبع الحكم لها من غير مانع هو الذي لأجله لم يجز أن يمنع مانع من حكمها قيل لم زعمتم أن العلة ما ذكرتم ولم إذا وجب تبع الحكم لها ما لم يمنع مانع لم يجز أن يمنع مانع من تعليق الحكم بها في بعض المواضع ثم يبطل ذلك عليهم بالعلة المنصوصة على قول من أجاز تخصيصها ويبطل بالعموم لأنه يجب شموله ما لم يمنع منه مانع ولا يستحيل أن يمنع مانع من شموله
ومنها قولهم إن العلة الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل فكما لم يجز تخصيص هذه العلة لم يجز تخصيص تلك ولقائل أن يقول إن عنيتم أنها مع الشرع كالعقلية مع العقل من حيث دل الدليل على تعلق الحكم بها فهو الدليل المتقدم وإن عنيتم أنها مع الشرع كالعقلية مع العقل في المنع من تخصيصها فقد جمعتم بينهما بغير علة
ومنها أن الأمارة الدالة على العلة هي طريقها والطريق إلى الاعتقادات والظنون لا يختلف في الشخص الواحد بل إذا كان طريقا إلى الظن شيء أو اعتقاده ووجد في شيء آخر كان طريقا إلى اعتقاده أو ظنه فيجب أن يكون
الأمارة طريقا إلى ظن الوصف علة في كل موضع وجدت فيه ولقائل أن يقول الأمارة ليست دالة على أن العلة في الفروع فيلزم الإنسان أن يعتقد كونها علة في كل تلك الفروع وإنما هي دالة على أنها علة الأصل وإنما يعلم أنه لا يجوز تخصيصها بنظر آخر وهو موضع الخلاف ومنها أن العلة طريق إلى إثبات الحكم في الفرع لأنا إذا علمنا أن الوصف علة الأصل ودل الدليل على التعبد بالقياس فان الوصف يكون طريقا إلى إثبات الحكم في الفرع فاذا اختص هذا الطريق بفرعين لم يجز كونه طريقا إلى العلم بحكم أحدهما ولا يكون طريقا إلى العلم بحكم الآخر لأن طريق العلم بالشيء أو الظن له لا يجوز حصوله في اشياء فيكون طريقا إلى العلم أو الظن بأحدهما ولا يكون طريقا إلى ذلك في الآخر سيما وما ذكرناه طريق إلى العلم بحكم الفرع وليس بطريق إلى الظن وإنما الطريق إلى الظن ما ذكرناه من الأمارة لأنه طريق إلى كون الوصف علة للحكم وإنما قلنا إن الحكم في الطرق لا يختلف لأن هذه سبيل الأدلة والإدراك في كونهما طريقين إلى العلم فان قيل إنما وجب ذلك فيما ذكرتم لأنه طرف موجب قيل الإدراك ليس بموجب للعلم فقد استمرت هذه القضية فيه فان قيل العلة في استمرار الأدلة والإدراك فيما ذكرتم أنه ليس للأمارات فيها مدخل وليس كذلك الحكم بالعلة الشرعية قيل إن ما ذكرناه لا يختلف بحسب الأمارات لأن من ظن أن زيدا في الدار بخبر رجل بعيد من الكذب فانه لا يجوز أن يخبره عن كون عمرو في الدار فلا يظنه صادقا فاذا وجب ذلك في الأمارات المفردة فالذي يقترن بها أدلة قاطعة أولى بذلك ولقائل أن يقول ليس العلة في العلة والإدراك أنهما طريقان بل لأن الأدلة إما أن كون موجبة كدلالة كون الحي حيا على كونه مدركا وإما أن تكون لولا المدلول ما كانت الدلالة على كل حال كدلالة صحة الفعل على كون فاعله قادرا وليس كذلك الأمارة لأنها غير موجبة وليست لولا المدلول ما كانت الأمارة على كل حال وأما كون المدرك مدركا فعند اصحابنا يجب عنده العلم بالمدرك فهو كالموجب والصحيح أن كون المدرك مدركا يوجب
كونه عالما بالمدرك وله أن يقول إذا جاز أن تختلف الأدلة والأمارات في الشخصين فهلا جاز اختلافهما في الشخص الواحد فانكم لا تجيزون أن يستدل الاثنان بالدلالة استدلالا صحيحا فيعلم أحدهما مدلولها دون الاخر ولا أن يستدل الواحد بالدلالة على مدلول في موضعين فيعلم ثبوته في أحدهما دون الآخر وتجيزون أن ينظر الاثنان في الأمارة نظرا واحدا فيظن أحدهما حكمها دون الآخر فيعلم حكمها في أحد الشيئين دون الآخر ويفارق الأدلة في ذلك كما فارقها في الناظرين ويقول ايضا على استدلالهم بالخبر إن من أخبره زيد بأن عمرا في الدار فانه لو قيل له لم ظننت أن عمرا في الدار لقال إن زيدا أخبر بذلك وهو بعيد من الكذب ومع ذلك قد يخبره بأن خالدا في الدار فلا يظن ذلك إذا أخبره من هو أبعد من الكذب منه أنه في ذلك الوقت في السوق أو ظن كونه في السوق بأمارة أخرى ولا يخرج إخبار زيد على كونه أمارة على أن عمرا في الدار لأن الأمارة لا تخرج عن كونها أمارة إذا أخطأت في موضع آخر فكذلك لا تخرج العلة من كونها أمارة وإن تخلف عنها حكمها
ومنها لو جاز وجود العلة في فرع ولا يتبعها فيها حكمها لم يكن بعض الفروع بذلك أولى من بعض فكان يجب أن نحتاج في تعلق الحكم عليها في كل فرع إلى دلالة لأن كونها علة ليس يقتضي تعليق الحكم بها في كل موضع إن قيل أليس يجوز تخصيص العموم ولم يخرجه ذلك من كونه دلالة قيل إن التخصيص ليس يدخل العموم من الوجه الذي كان منه دلالة لأنه إنما يدل لأجل صيغته بشرط انتفاء القرائن وصدره عن حكيم وليس يجوز اجتماع ذلك كله ولا يدل فلم توجودنا دلالة حصلت في موضع ولم تدل ولم ينقض ذلك كونها دلالة وليس كذلك العلة عندكم لأنكم جعلتموها أمارة وخصصتموها مع ذلك ولقائل أن يقول قولكم ليس بعض الفروع بأن لا يوجد فيه حكمها اولى من بعض باطل لأن بعضها أولى من بعض لأن
الفرع المختص بما يمنع من حكم العلة أولى بأن لا يوجد فيه حكم العلة من فرع لم يوجد فيه ما يمنع من حكم العلة وذلك أن العلة أمارة والأمارة يتبعها حكمها على الأكثر ولذلك كانت طريقا إلى الظن والأصل فيها أن يتبعها حكمها إلا لمانع فان وجدت في موضع وكان حكمها لا يتبعها والحكمة تقتضي أن يدل الله عز و جل على ذلك فاذا لم يدلنا عليه فلا مانع من تعليق الحكم بها
ومنها قولهم وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن المعلل ما استوفى شروط العلة والعلة إذا لم تستوف شروطها كانت باطلة الجواب يقال لهم ولم زعمتم أن تخلف حكمها عنها يدل على أن المعلل ما استوفى شروط العلة ولا بد من أن يقولوا لو استوفى شروطها لم يتخلف عنها حكمها فيقال لهم هذا موضع الخلاف ويبطل ذلك بالعلة المنصوصة إذا لم يقرر بها التعبد بالقياس ويبطل على بعضهم بتخصيص العلة المنصوصة مع ورود التعبد بالقياس
ومنها قولهم إن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو من آكد ما يفسد به العلة والجواب يقال لهم ما معنى قولكم مناقضة فان قالوا المناقضة هي الإقرار بوجود العلة من دون حكمها من غير دليل منع من حكمها قيل هذا لا يدل على فساد العلة وإنما يدل على أن المعلل قد أخطأ حين لم يتبعها حكمها فان قالوا المناقضة هي الإقرار بوجود العلة من دون حكمها وإن دل الدليل على انتفاء حكمها قيل لهم مخالفكم لا يسلم أن ذلك مناقضة ويقول إن سميتم أن ذلك مناقضة فلم زعمتم أنه يفسد العلة فان قالوا إنما قلنا إن ذلك مناقضة تفسد العلة لأن العقلاء يعدونه مناقضة مفسدة حتى العوام منهم لأن قائلا لو قال سامحت فلانا لأنه بصري ثم لم يسامح غيره من البصريين لقال له العوام والخواص زعمت أنك سامحت فلانا لأنه بصري فهذا بصري قيل إن هذا الإنسان لو اعتذر بأنه لم يسامح فلانا وإن
كان بصريا لأنه عدوه لم يمكن أن يدعى على جميع الناس أنهم يذمونه ويلزمونه اشتراط نفي العداوة في علته الأولى وإن ادعوا ذلك على جميع العقلاء فمخالفوهم من العقلاء ولا يلزمون المعلل ذلك فان قالوا لو لم تفسد العلة بتخصيصها لم تفسد بمعارضة نص لها قيل لهم إن أردتم أن النص عارضها في بعض فروعها فهذا هو التخصيص الذي لا تفسد العلة به عند خصومكم وإن اردتم أن النص يمنع من حكمها في جميع فروعها فمن أجاز العلة القاصرة لا يمنع من كونها علة في الأصل فقط ومن لم يجز ذلك يفسد العلة من حيث كانت قاصرة خارجة عن كونها أمارة في كل المواضع وليس كذلك إذا تخلف عنها حكمها في بعض فروعها لمانع لأن ذلك لا يمنع من كونها أمارة على أن هذه الشبهة تبطل بالنص على العلة إذا لم يرد معه التعبد بالقياس على قول من لم يجز القياس بها لأن حكمها ينتفي عنها في الفروع كلها وليس ذلك مناقضة ولا يجري مجرى معارضة النص بعلة ويبطل العلة المنصوصة مع ورود التعبد بالقياس
ومنها قولهم إن العلة مع كل فرع تجري مجرى النص على فرع واحد فكما لم يجز تخصيص النص على فرع واحد فكذلك العلة الجواب إن النص المتناول لعين واحدة لا يمكن تخصيصه لأنه غير متناول الأشياء فيخرج بعضها وليس كذلك العلة الشائعة في فروع كثيرة لأنها تتناول أشياء فهي كالعموم فجاز أن تدل دلالة على إخراج بعض تلك الأشياء من حكمها ويبطل ذلك بالعلة المنصوصة على قول من أجاز تخصيصها
واحتج من أجاز تخصيص العلة بأشياء
منها أن العلة الشرعية أمارة فجاز وجودها في موضع ولا حكم كما جاز وجودها قبل الشرع وليس معها ذلك الحكم ولقائل أن يقول ولم إذا جاز قبل كونها أمارة أن يوجد من دون حكمها جاز تخصيصها بعد كونها أمارة وما تنكرون أن تكون لما صارت أمارة صارت طريقا إلى الحكم وليس
كذلك قبل كونها أمارة ألا ترى أنها قبل الشريعة لم يتعلق بها حكم ولا يجوز أن يتعلق بها حكم أصلا بعد كونها أمارة على أن ذلك يبطل على قول الشيخ أبي عبد الله رحمه الله بالعلة في الترك لأنه قد أجاز وجودها قبل الشريعة من دون حكمها ولم يجز تخصيصها بعد كونها أمارة
ومنها أن العلة الشرعية أمارة على الحكم بجعل جاعل فجاز أن نجعلها أمارة في مكان دون مكان كما أن خبر الواحد لما كان أمارة جاز أن يجعل أمارة مع عدم نص القرآن ولا يجعل أمارة مع أن نص القرآن بخلافه الجواب إن العلة لا تكون أمارة على الحكم بجعل جاعل لأننا إن جعلناها وجه المصلحة فوجوه المصالح لا تكون كذلك بجعل جاعل وكذلك جميع وجوه القبح والحسن ألا ترى أن كون الفعل ردا للوديعة لا يكون وجها في حسنه بجعل جاعل وإن جعلناها أمارة توجد مع وجه المصلحة فكونها كذلك ليس بجعل جاعل بل هي كذلك شاء الجاعل ذلك أو لم يشأه فإن وجدت الأمارة مع وجه المصلحة في موضع دون موضع وعرفنا ذلك فلا بد من أن نشترط انتفاء الموضع الذي يوجد العلة فيه من دون وجه المصلحة حتى يصح أن تكون طريقا ولهذا نقول إن خبر الواحد أمارة وطريق إلى حكم بشرط أن لا يعارض كتابا ولا خبرا متواترا أو إجماعا
ومنها قولهم إنه إذا كان المانع عند خصومنا من تخصيص العلة المستنبطة أن ذلك يمنع من جريانها في معلولها وهو طريق صحتها لأنه ليس طريق صحتها فالعلة المنصوص عليها إذا لا يمتنع تخصيصها لأن ذلك لا ينقض طريق صحتها لأنه ليس طريق صحتها هو الجريان في معلولها وإذا صح تخصيص العلة المنصوصة علمنا أن ذلك إنما لم يمنع منها لكونها علة شرعية وأمارة فجاز مثله في المستنبطة لأن ما يجوز ويستحيل على الشيء لا يختلف بحسب اختلاف طريقه الجواب إن من منع من تخصيص العلة المنصوصة له أن يقول إنما أمنع من تخصيص المستنبطة بغير الجريان بل بما ذكرته من كون
ذلك طريقا إلى الحكم إلى غير ذلك من الوجوه لا أستدل بالجريان أصلا واستدل به على المنع من تخصيص العلة المستنبطة فقط وأما المنصوصة فاذا كان طريق صحتها غير الجريان جاز أن يمنع من تخصيصها بوجه آخر ومن يجيز تخصيص العلة المنصوصة له أن يفرق بينها وبين المستنبطة بما قد بني عليه المستدل دليله وهو أن طريق صحة المستنبطة الجريان والتحصيص يبطل ذلك وليس طريق صحة المنصوصة الجريان فيبطله التخصيص وقولهم إن ما يستحيل ويجوز على الشيء لا يختلف بحسب اختلاف طريقه فباطل لأنه إذا كان ما يستحيل على الشيء إنما يستحيل عليه لما يرجع إلى طرقة جاز أن تختلف استحالته إذا اختلفت الطرق واستحالة تخصيص العلة إنما كان لأجل بطلان طريقها فالعلة التي طريقها نص لا يفسدها نص تخصيصها فلا يستحيل التخصيص عليها
ومنها وهو وجه قوي يمكن أن يحتجوا به فيقولوا إن العلة الشرعية أمارة فوجودها في بعض المواضع من دون حكمها لا يخرجها من كونها امارة لأن الأمارة ليس يجب وجود حكمها معها على كل حال وإنما الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها لها وليس يبطل هذا الغالب بتخلف حكمها عنها في بعض المواضع فبطل قول من قال إن تخصيصها يخرجها من كونها أمارة وعلة يبين ذلك ان وقوف مركوب القاضي على باب الأمير أمارة لكونه في دار الأمير ولا يخرجه عن كونه أمارة على ذلك أن لا نشاهد القاضي في بعض الحالات في دار الأمير أو نرى مركوبه علي باب الأمير مع غلام غيره فنظن أنه قد استعاره غيره ألا ترى أنا إذا رأينا مركوبه على باب الأمير مرة أخرى ظننا كون القاضي في دار الأمير إذا كان الأغلب أنه هو الذي يركب ذلك المركوب وكذلك وجود الغيم الرطب في الشتاء من دون مطر لا يخرج الغيم من كونه أمارة على نزول المطر الجواب إنا لا نمنع أن توجد الأمارة في بعض المواضع لعله من العلل شرطنا في كونها أمارة انتفاء تلك العلة أو انتفاء الموضع الذي لم يوجد فيه حكمها ولا يكون طريقا إلى الحكم
إلا إذا علمنا انتفاء ما شرطنا انتفاؤه يبين ذلك أنه إذا لم يكن القاضي في دار الأمير وإن كان مركوبه ببابه إذا كان مع غلام غيره فانا لا يمكننا أن نظن كون القاضي في دار الأمير إذا شاهدنا مركوبه على بابه إلا بأن نعلم أو نظن أنه ليس غلام غيره معه ألا ترى أنا لو ظننا غلام غيره معه لم نظن كون القاضي في الدار ولو رأينا مركوبه على باب الأمير ونظرنا في الدار ولم نشاهده فيها فانا نظن فيما بعد أنه في الدار إذا شاهدنا مركوبه على الباب وعلمنا أننا لم نشاهد داخل الدار فلم نشاهده فيها والله أعلم
باب مناقضة العلة وما يحترس به من النقض
اعلم أن نقض العلة هو أن توجد في موضع من دون حكمها وحكمها ضربان مجمل ومفصل والمجمل ضربان إثبات ونفي فالإثبات المجمل لا ينقض بنفي مفصل والنفي المجمل ينقض باثبات مفصل مثال الأول أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمي فيقول لأنهما حران مكلفان محقونا الدم فثبت بينهما قصاص كالمسلمين فينقض به إذا قتله خطأ وذلك ان نفي القصاص بينهما في الخطأ لا يمنع من صدق القول بأن بينهما قصاصا وإذا صدق القول بذلك علم أن ثبوت القصاص بينهما لم يرتفع فلم ينتف حكم العلة ومثال الثاني أن يقول المعلل لأنهما مكلفان فلم يثبت بينهما قصاص فاذا نوقض بالمسلمين ثبت بينهما قصاص في قتل العمد انتقضت العلة لأن ثبوت القصاص بين الشخصين في موضع من المواضع لا يصدق معه القول بانه لا قصاص بينهما على الإطلاقوأما الحكم المفصل فإما أن يكون إثباتا وإما نفيا فالإثبات ينقض بالنفي المجمل مثاله أن يقول المعلل فوجب أن يثبت بينهما جميعا قصاص في قتل العمد وذلك ينتقض بالحر والعبد إذا قتل العبد لأنه لا يثبت بينهما قصاص لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض
المواضع واما النفي المفصل فانه لا ينقض باثبات مجمل لأن قول المعلل فلم يثبت بينهما قصاص في قتل الخطأ لا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين لأن ثبوت القصاص ينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع
وقد يحترس من النقض بوجوه منها الاحتراس بالأصل ومنها الاحتراس بشرط يذكر في حكم العلة ومنها الاحتراس بحذف الحكم والاقتصار على الشبه بالأصل
مثال الاحتراس بالأصل أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم فقتل احدهما بالآخر قياسا على المسلمين فاذا نوقض بقتل الخطأ قال أنا رددت الفرع إلى المسلم وانا أقول في الفرع مثل ما قلته في الأصل وأنا اوجب القصاص في الأصل في العمد دون الخطأ وهذا الاحتراس غير صحيح لأن الحكم هو ما يلفظ به المعلل دون ما أضمره وهو إنما صرح باشتباه الشخصين في القتل لا غير ولم يشترط فيه شرطا آخر وليس رد الفرع إلى الأصل بموجب استوائهما في كل حكم على كل وجه لأنه لم يصرح بذلك
وأما الاحتراس بشرط مذكور في الحكم فمثاله أن يقول المعلل لأنهما حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت بينهما قصاص إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا ولقائل أن يقول إن الاحتراس في الحكم هو إقرار بانتقاض العلة وذلك أن المعلل قد حكم بأن العلة هي كونهما حرين مكلفين محقوني الدم فقط وأنه لا يدخل في العلة غير ذلك فاذا قال إن هذا يوجب القصاص في قتل العمد دون الخطأ مع وجود هذه الأوصاف فقد أقر بأن العلة توجد في موضعين ويتبعهما حكمها في أحدهما دون الآخر فان قيل لا يمنع أن تكون الحرية والعقل وحقن الدم إنما تؤثر في إيجاب القصاص في قتل العمد دون الخطأ قيل إن كان ذلك يؤثر في احد الموضعين دون الآخر لمعنى اختص به أحدهما فينبغي أن يذكر ذلك المعنى في جملة العلة لأن له تأثيرا في إيجاب القصاص وإن كانت الأوصاف تؤثر في الحكم في أحد الموضعين دون الآخر
لا لأمر افترق فيه الموضعان فقد أقررتم أن العلة تقتضي الحكم في موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيهما على سواء ولنا أن نجيب عن هذا الكلام ونقول إن الشرط المذكور في الحكم هو متأخر في اللفظ متقدم في المعنى لأن معنى القياس لأنهما حران مكلفان محقونا الدم قتل أحدهما صاحبه عمدا فثبت بينهما القصاص وذلك أن قتل العمد له تأثير في القصاص وهذا يقتضي أنه وإن كان ذكر في الحكم فهو مذكور على أنه من جملة العلة
وأما الإحتراس بحذف الحكم فهو أن يذكر المعلل العلة ولا يذكر الحكم لكنه يقول عقيب العلة فأشبه الفرع كيت وكيت وقد يفعل ذلك إذا لم يمكن التصريح بالحكم وقد قيل إن هذا لا يصح لأن قولنا فأشبه كيت وكيت هو حكم بأن الفرع يشبه كيت وكيت وإذا كان ذلك حكما احتاج الفرع إلى أصل يرد إليه
باب القول في الاستحسان
اعلم أن المحكي عن أصحاب ابي حنيفة القول بالاستحسان وقد ظن كثير ممن رد عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها وهذا اولى ممن ظنه مخالفوهم لأنه الأليق بأهل العلم ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل فقالوا استحسنا هذا الأثر ولوجه كذا فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريقوالذي يمنع من الحكم بغير طريق أن الحكم بغير طريقة إما أن يكون حكما بالشهوة أو بأول خاطر أو بظن الأمارة له وذلك يتأتى من الصبي والعامي كما يتأتى من العالم فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء أجمعين وكان ينبغي ان
لا يلام من حكم بذلك ولأن هذه الأشياء قد تتناول الحق كما تتناول الباطل ولأن الظن لا عن أمارة لا يتميز من ظن السوداوي
والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى ويقع في العبارة أما في المعنى فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض ويجوز العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الاخرى وذلك راجع إلى تخصيص العلة وقد تقدم القول في ذلك ومن الكلام في المعنى الكلام في حد الاستحسان وأما الكلام في العبارة فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجه صحيح
وأما حد الاستحسان فقد اختلف فيه فحده بعضهم بانه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه وهذا باطل لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص كما لا يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه وتركهم القياس في ذلك للخبر وحده بعضهم بأنه تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه وهذا باطل لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس وحده بعضهم بأنه ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى ويقرن هذا من وجه أبي الحسن رحمه الله وهو قوله الاستحسان هو ان يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا
وينبغي أن يقال الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطارىء على الأول ولا يلزم على ذلك قولهم تركنا الاستحسان باقياس لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطارىء بل هو الأصل ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع مما تركوه
واما الوجه في تسميتهم ذلك استحسانا فهو أن الاستحسان وإن كان وقع على الشهوة والاستحلاء فقد يقع على العلم بحسن الشيء فيقال فلان يستحسن القول بالتوحيد والعدل وقد يقع على الاعتقاد والظن بحسن الشيء فاذا ظن المجتهد الأمارة واقتضاء ذلك أن يعتقد حسن مدلولها جاز أن يقول قد استحسنت هذا الحكم فصح فائدة هذه التسمية وجاز الاصطلاح منهم على التسمية
باب في تعارض العلل والقول في تنافيها
اعلم أن وصفنا العلل بانها متناقضة متنافية قد يفهم منه أنها متضادة لا يصح اجتماعها وهذا غير موجود في هذا الموضع لأن الأكل والكيل والاقتيات لا تتضاد وقد يفهم منه أنها لا تجتمع كونها عللا وذلك ضربان أحدهما لا تجتمع كونها عللا لتنافي أحكامها والآخر لا تجتمع كونها عللا لا لتنافي أحكامها والمتنافي أحكامها لا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون أصلها واحدا لأنه لو كان أصلها واحدا على وجه واحد لكان قد اجتمع في الأصل حكمان متنافيان وذلك محالفان قيل هلا تنافت العلل وإن كان اصلها واحدا وخكمه واحدا إذا تنافت الأحكام في الفروع بان توجد إحدى العلتين في فرع ولا توجد الأخرى فيه فيلزم أن يوجد فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتين وإن ينتفي لانتفاء العلة الأخرى قيل إذا وجدت إحدى العلتين في الفرع دون الاخرى وجب وجود حكمها فيه ولا يلزم انتفاؤها لانتفاء العلة الاخرى لأن انتفاء العلة لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى
فاذا ثبت أن أصل العلتين المتنافيتي الحكم اثنان فصاعدا فمثاله وجوب النية في التيمم ونفي وجوبها في إزالة النجاسة ورد الوضوء إلى إزالة النجاسة
بعلة انها طهارة بالماء ويرد إلى التيمم بعلة أنها طهارة عن حدث وإن امتنع كونها عللا لوجوه سوى تنافي الحكمين فبان لا يكون في الامة من علل ذلك الأصل بعلتين بل كل منهم علله بعلة واحدة كتعليلهم تحريم التفاضل في البر بكونه مكيلا أو مأكولا أو مقتاتا وليس منهم أحد علله بكل واحد منهما ومتى تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وجب الترجيح وينبغي قبل ذلك أن نتكلم في غلبة الأشباه
باب الكلام في غلبة الأشباه
اعلم أنه ينبغي أن نذكر ما الشبه وبماذا يقع وما الشبه الغالب وما قياس المعنى وما قياس غلبة الأشباه وقسمة قياس غلبة الأشباهوالشبه هو ما له يحصل الاشتباه والاشتباه هو اشتراك الشيئين في صفة من الصفات ووجه من الوجوه وهذه الصفة وهذا الوجه هو الشبه
وأما ما يقع به الأشباه فابن علية يعتبر الصورة كردة الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في إسقاط وجوبها لأن كل واحدة منها جلسة والشافعي يعتبر الشبه بالأحكام كردة العبد المقتول إلى المملوكات في اعتبار قيمته بالغة ما بلغت من حيث أشبه المملوكات في احكام كثيرة والصحيح أن الشبه يكون بكل ما كان له تأثير في الحكم سواء كان حكما او لم يكن حكما لأن كون البر مكيلا أو مأكولا ليس بحكم
وأما غلبة الشبه فهو أن يكون الشبه أقوى من شبه آخر فهو أولى بأن يتعلق الحكم به لقوة امارته وقوة الأمارات امر ظاهر لا إشكال فيه
وأما قياس المعنى فهو أن يكون شبه فرعه بأصله لا يعارضه شبه آخر فان عارضه كان خفيا جدا كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزنا
وأما قياس غلبة الأشباه فهو أن يعارض الشبه الحاصل فيه شبه آخر يساويه في القوة ويخفي فضل قوة أحدهما على الآخر ولا يخلو هذان الشبهان إما أن يرجعا إلى أصل واحد أو إلى أصلين فان رجعا إلى أصلين جاز أن يكون الفرع واحدا ويشبه بأحد الشبهين أحد الأصلين ويشبه بالشبه الآخر الأصل الآخر كالعبد المقتول يشبه الحر في تحديد بدله من حيث كان مكلفا ويشبه المملوكات في نفي تحديد بدله من حيث كان مملوكا
وأما أن يرجع إلى اصل واحد فقد يكون الفرع اثنين وقد يكون واحدا فان كانا اثنين فانه يكون كل واحد منهما يشبه الأصل بأحد الشبهين دون الآخر كالارز والجص أحدهما يشبه البر من حيث كان مكيلا والآخر يشبهه من حيث كان مأكولا وأما إذا كان الفرع واحدا فكالارز المشبه للبر من حيث كان مأكولا ومن حيث كان مكيلا ومن حيث كان مقتاتا فيقع النظر في أي هذه الوجوه هي علة الحكم فما لم تدل عليه أمارة قضي بفساده وما تساوى في دلالة الأمارات عليه عدل فيه إلى الترجيح
ونحن نذكر الآن الوجوه التي يقع بها ترجيح العلل إن شاء الله تعالى
باب فيما يرجح به علة على علة
اعلم أنه ينبغي أن نذكر أولا ما الترجيح وما الفائدة فيه ثم نقسم الترجيح للعللأما الترجيح فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر ولذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق
واما الفائدة في الترجيح فهي أن يقوي الظن الصادر عن إحدى الأمارتين
عند تعارضهما ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة لأنها لا تتعارض لأن تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتها وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها ولأن الأدلة لا تقتضي الظن فلا يمكن القول بأن أحد الظنين يقوى ولأن الترجيح يقتضي التمسك بما ثبت فيه الترجيح واطراح ما لم يثبت فيه والدليل لا يجوز اطراحه
فأما قسمة ترجيح العلل فهي أن العة ينبغي أن ترجح بما يرجع إلى طريقها وبما يرجع إلى الحكم الذي هي طريقه وبما يرجع إلى مكانها وهو الأصل أو الفرع أو هما بمجموعهما
أما الراجع إلى طريقها فمنه ما يرجع إلى طريقها في الأصل ومنه ما يرجع إلى طريقها في الفرع
أما الراجع إلى طريقها في الأصل فضربان أحدهما أن يكون طريق وجودها في الأصل أقوى من طريق وجود علة أخرى في أصلها والآخر أن يكون طريق صحة إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى
وأما الراجع إلى طريقها في الفرع فأن يكون طريق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الاخرى في فرعها
وأما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان أحدهما يتعلق بحكمها في الأصل والآخر يتعلق بحكمها في الفرع أما المتعلق بالأصل فضربان أحدهما أن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين في الأصل أقوى من طريق ثبوت الحكم الآخر في أصله والآخر أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع وطريق ثبوت الآخر في أصله العقل وأما المتعلق بحكمها في الفرع فضروب منها أن يكون أحدهما حظرا والآخر إباحة ومنها أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر كالندب والمباح ومنها أن يكون قد شهدت الاصول بأحد الحكمين كعموم خطاب أو قول صحابي ومنها أن يكون حكم إحدى
العلتين يتبعها في جميع فروعها وحكم العلة الأخرى لا يتبعها في جميع فروعها فيكون أولى على قول من أجاز تخصيص العلة
وأما الترجيح الراجع إلى الأصل وحده فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة من عدة أصول والأخرى منتزعة من أصل واحد
وأما الترجيح الراجع إلى الفرع وحده فبأن يكون فروع إحدى العلتين أكثر من الأخرى
وأما الراجع إلى الأصل والفرع جميعا فبأن يكون الفرع باحد الأصلين أشبه منه بالآخر بأن يكون من جنسه كرد كفارة إلى كفارة ورد المقدار المفسد للصلاة من كشف العورة إلى مقدار ما يفسدها من النجاسة لأن بين هذين تجانسا من بعض الوجوه وفي بعض هذه الوجوه اختلاف وسنذكر عند الأمثلة إن شاء الله
أما التي طريق وجودها في الأصل أقوى فبأن تكون إحداهما يعلم وجودها في الأصل بالحس والصورة نحو كون البر مكيلا أو مطعوما وتكون الأخرى معلوم وجودها فيه باستدلال أو إحداهما معلوم وجودها في الأصل بدليل والأخرى مظنون وجودها فيه بأمارة أو يكون جميعا مظنونين بأمارتين غير أن أمارة وجود إحداهما أقوى وذلك وجه ترجيح لأن الوصف لا يكون علة في الأصل إلا وهو موجود فيه فاذا كان علمنا أو ظننا لوجوده فيه أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الآخرى فيه فقد صار ظننا لكونها علة حكم الأصل أقوى من ظننا لكون الأخرى علة حكم الأصل وأما التي طريق كونها علة حكم الأصل أقوى فبأن يكون علة كونها حكم الأصل صريح نص وطريق الأخرى تنبيه نص أو طريق إحداهما تنبيه نص وطريق الأخرى الاستنباط أو أمارة إحداهما أقوى من أمارة الأخرى وإنما كان ذلك ترجيحا لأن ما قوى طريقه قوى الظن له أو الاعتقاد له وكذلك التي طريق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الأخرى في الفرع لأن ثبوت الحكم في الفرع تبع
لوجود علته فاذا قوي علمنا أو ظننا لوجودها في الفرع قوي علمنا لقوة أصل العلم وإذا كان حكمها في الفرع أولى صار كونها علة أولى
وأما الترجيح بقوة ثبوت الحكم في الأصل فنحو أن يدل على الأصل دليل قاطع ويدل على حكم الأصل الآخر أمارة وإنما كان من قوي حكم أصله أولى لأن الوصف لا يكون علة حكم الأصل إلا وحكمه ثابت فاذا كان حكم أحد الأصلين أقوى ثبوتا كان ما يقعه من العلة ومن حكم الفرع أقوى ثبوتا
وأما الترجيح بكون أحد الحكمين شرعيا والآخر عقليا فصحيح لأن القياس الشرعي دلالة شرعية والأولى في الأدلة الشرعية أن تكون أحكامها شرعية والقياس الذي حكمه شرعي هو أشد مطابقة للأدلة الشرعية
فان قيل كيف يجوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية قيل يجوز ذلك إذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لها لم ينقلنا عنه الشرع
فأما إذا كان أحد الحكمين نفيا والآخر إثباتا وكانا شرعيين فقد ذطر قاضي القضاة رحمه الله أنه لا يكون أحدهما أولى من الآخر وقد ذكرنا في ترجيح الأخبار أنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون أحدهما عقليا والآخر سمعيا
وأما الترجيح بكون احد الحكمين في الفرع حظرا والآخر إباحة فانه إن كان الحظ شرعيا كان أولى فكانت علته لأن الحكم الشرعي أولى ولأن الأخذ بالحظر أحوط وإن كان الحظر عقليا فكونه حظرا جهة ترجيح وكون الإباحة شرعية جهة لترجيح الإباحة فالواجب الرجوع إلى ترجيح آخر ولا بد في الحظر والإباحة من أن يكون أحدهما عقليا والآخر شرعيا على ما بيناه في الأخبار وأما إذا كان حكم إحدى العلتين العتق وحكم الأخرى الرق فالمثبتة للعتق أولى لأن تعلق الحرية بالقول ثابت بالشرع لا بالعقل
فهو من هذه الجهة حكم شرعي ولأن العتق في الشريعة فوقه من حيث لا يلحقه الفسخ فكانت علته أولى فأما إذا كان حكم أحدهما في الفرع إسقاط الحد وحكم الأخرى إثباته فالشيخ أبو عبد الله رحمه الله يرجح المسقط للحد لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحد ولأن العلة تقتضي حظره والحظر أولى وقال قاضي القضاة رحمه الله لا ترجيح بذلك بل يرجح المثبتة للحد لأنه حكم شرعي ويقول إنما أخذ علينا إسقاط الحد من الأعيان ولم يؤخذ علينا إسقاطه عن جملة الشريعة
فأما الترجيح بكون احد حكمي العلة أزيد من حكم الأخرى فمثل أن يكون حكم أحدهما الإباحة وحكم الآخر الندب فالتي حكمها الندب أولى لأن الندب يتضمن شيئا من معنى الإباجة الذي هو الحسن ويزيد عليه فكان أولى إذا كانت الزيادة شرعية
وأما الترجيح بشهادة الأصول فقد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول مثل تحريم المثلة في الجملة فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة أولى لأن الشريعة في الجملة تشهد بها وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب والسنة والإجماع وهذه إن كانت صريحة فهي الأصل في الدلالة لا يجوز وقوع الترجيح بها وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها لوضوح دلالة القياس على دلالتها ويقع الترجيح بقول الصحابي لأنه أعرف بمقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وكذلك إذا عضدت العلة علة كما ترجح أخبار الآحاد بعضها ببعض وكما يرجح الخبر على خبر آخر بكثرة الرواة ولما تقدم كانت العلة التي لا تخصص العموم أولى من التي تخصه لأن لفظ العموم قد شهد لها
وذكر قاضي القضاة في الشرح أن هذا مخالف لما ذكرناه من شهادة الأصول لأن كلا المعللين قد اتفقا على مطابقة ذلك الأصل لإحدى العلتين ولم يقع الاتفاق منهما على ذلك في هذا الموضع لأن أحد المعللين يقول ما
أراد الله عز و جل بالعموم ما تناولته العلة المخصصة ولقائل أن يقول إنهما سواء لأن أحد المعللين وإن لم يقل ذلك فان العموم يشهد لمطابقة إحدى العلتين فكانت أولى وإذا اقترن بالقياس خبر واحد محتمل فقد قال إنه يرجح به مع أن الخصم يمكنه أن يقول في المحتمل إنه ما أريد به ما يخالف علتي وقوله في المحتمل أمكن من قوله في العموم
وأما الترجيح بلزوم الحكم للعلة في الفروع كلها دون الأخرى فبعض من أجاز تخصيص العلة لا يرجح بذلك وبعضهم يرجح به وهو الصحيح لأن لزوم الحكم لها يكسبها شبها بالعقليات ويؤذن بلزومه لها في الأصل
فأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كثيرة والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول فقد اختلف في ذلك فمن الناس من رجح بذلك ومنهم من لم يرجح به وقال قاضي القضاة رحمه الله لا يرجح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة وإن كانت طريقته غير واحدة رجح به أما أنه إذا كانت علل تلك الأصول كثيرة وأماراتها مختلفة فالترجيح يقع بذلك لشهادة العلل وأماراتها بعضها لبعض ويكون الترجيح واقعا حينئذ بشهادة العلل بعضها لبعض وأما إذا كانت العلة واحدة وأماراتها واحدة فانه إن كان الأصل نوعا وإنما أشخاصه كثيرة فانه لا يرجح في ذلك لأن النوع واحد وعلى أنا لا نعلم أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النوع الآخر وإن كانت الاصول أنواعا كثيرة وقع الترجيح بها وإن كانت علتها واحدة لأنه تكون الأصول الكثيرة شاهدة لإحدى العلتين ويكون حكمها أكثر ثبوتا في الأصول من حكم الأخرى وذلك مقو للظن
وأما ترجيح العلة الراجع إلى فروعها فأن تكون فروع إحدى العلتين أكثر من فروع الأخرى وقد رجح بذلك قوم وكذلك العلة المتعدية ولم يرجح به آخرون
والأولون قالوا إنها إذا كثرت فروعها كثرت فائدتها فكانت أولى ولقائل أن يقول إنما يجب أن يكون أولى إذا كثرت فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع إلى اختيار الله تعالى خلق الأنواع التي تختص تلك العلة وليس ذلك بأمر شرعي
واحتج من لم يرجح بذلك بأن قال لو كان أعم العلتين بالأخذ أولى لكان أعم الخطابين أولى بالعمل والجواب إنه إنما لم يكن أعم الخطابين أولى بل كان أخصهما أولى لأن الأخذ بأخصهما ليس فيه إطراح لأعمهما والأخذ بأعمهما فيه إطراح لأخصهما وأما العلتان فانهما إذا انتهتا إلى الترجيح لم يمكن الجمع بينهما وأيهما استعملت اطرحت الأخرى فكان اطراح ما قل حكمه لقلة فروعه أولى
وقالوا أيضا ينبغي أن تصح العلة في الأصل وإذا صحت أجريت في القوة قلت أو كثرت والجواب إنه إنما ترجح العلة على العلة إذا شهد لثبوت كل واحدة منهما أمارة ولا معنى لقولكم ينبغي أن تثبت العلة في الأصل
وقالوا ايضا كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق الله مما يوجد فيه العلة وليس ذلك بأمر شرعي فيقع به الترجيح وليس كذلك كثرة أنواع الاصول لأن الأصل شاهد للعلة فكثرة ما يشهد لها تقويها والفرع لا يشهد للعلة بل حكمه تابع لها
وأما ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والفرع فهو أن تكون إحدى العلتين يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه كرد كفارة إلى كفارة والأخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه كرد كفارة إلى غير كفارة فتكون الأولى أولى وهو مذهب أبي الحسن وأكثر الشافعية لأن الشيء أكثر شبها بجنسه منه بغير جنسه والقياس يتبع الشبه فكثرته تقوي الظن وإن لم تكن تلك الوجوه علة وبالجملة رد الشيء إلى ما هو أشبه به أولى ولذلك كان رد كشف العورة إلى
إزالة النجاسة في أن انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة يفسد الصلاة أولى من الرد إلى غير ذلك
باب في أن المجتهد هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات في المسألة أم لا
أجاز شيخانا أبو علي وأبو هاشم ذلك وقالا يكون المجتهد عند تساوي الأمارتين مخيرا بين حكميهما ومنه شيخنا أبو الحسن من ذلك وقال لا بد من ترجيحوحجة من أجاز ذلك هي أن من منع من ذلك إما أن يمنع منه من جهة العقل بأن يجعل استحالة ذلك كاستحالة لا تعادل الدلالة والشبهة حتى تكونا جميعا صحيحتين أو يمنع من ذلك لدليل سمعي والوجه الأول باطل لأنا لا نجد في العقل ما يحيل تساوي الأمارتين في القوة فكان ذلك من مجوزات العقول ألا ترى أنه لا يمتنع عندنا أن يخبر اثنان باثبات الشيء ونفيه ويستوي عندنا عدالتهما وصدق لهجتهما وتتعارض الأمارات الدالة على جهة القبلة ثم ليس يؤثر سقوط فرض التوجه في بعض المواضع فيما ذكرناه من جواز كون الأمارات متساوية في القوة فالفرق بين الأمارات في ذلك وبين الأدلة أن الأدلة يجب أن يكون مدلولها على ما دلت عليه فلو كان ما يدل على الشيء وما يدل على نفيه متساويين في أنفسهما لكان الدليلان صحيحين وفي ذلك حصول مدلوليهما جميعا النفي النفي والاثبات كالدليل الدال على أن الله سبحانه يستحيل أن يرى والشبهة الموجبة أن يرى وأما الأمارة فليس يجب أن يتبعها مدلولها بل قد توجد الأمارة الأقوى ولا يتبعها مدلولها كالغيم الكثيف الرطب في زمان الشتاء فلا يتبعه المطر ويتبع الأمارة الضعيفة مدلولها كالغيم الخفيف وقد يخبر الرجل المعروف بالصدق فيكذب وقد يخبر الرجل المعروف بالكذب فيصدق في ذلك الخبر وليس في تساوي الأمارتين في
القوة ما يوجب حصول مدلولهما ولو وجب حصول مدلولهما وهو صحة علة التحريم وصحة علة الإباحة لم يلزم منه حصول التحريم والإباحة على شخص واحد بل كان يلزمه التخيير ليس في ذلك ثبوت النقيضين وأما إن منع من تعادل الأمارتين لدليل سمعي وهو أنهما للو تعادلا في القوة لم يكن الحكم باحداهما أولى من الأخرى وفي ذلك إثبات حكميهما إما على الجمع وذلك غير ممكن وإما على التخيير والأمة مجمعة على أن المكلفين غير مخيرين في مسائل الاجتهاد باطل لأن تعادل الأمارتين كلفظ التخيير في الدلالة على التخيير لأنه إذا لم يكن حكم إحداهما أولى من حكم الأخرى ولم يمكن الجمع فليس إلا التخيير وقد يثبت التخيير من غير لفظ لأن من معه مائتان من الإبل فهو مخير بين اداء أربع حقاق أو خمس بنات لبون وليس في ذلك لفظ التخيير وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
إن قيل هذا يقوم مقام لفظ التخيير قيل فكذلك تعادل الأمارتين
وأما قوله إن الأمة مجمعة على أن المكلفين غير مخيرين في مسائل الاجتهاد فان عنوا جميع المسائل الماضية من مسائل الاجتهادوالمستقبلة لم نسلم ذلك وإن ارادوا المسائل الماضية دون المستقبلة لم نسلم أيضا لأن عبيد الله بن الحسن العنبري خير بين غسل الرجلين ومسحهما وهو مذهب الحسن البصري والشافعي يقول بقولين في المسألة الواحدة ويقول بكل واحد منهما وجه قالوا ولو تتبعنا ما ذكروه من الإجماع في المسألة الماضية لم يمنع ذلك من صحة التخيير في الحوادث المستقبلة قال الشيخ أبو الحسن يحتج بأن تعادل الأمارتين يقتضي التخيير بين الحكمين ولا لفظ للتخيير والأمة مجمعة على بطلانه وقد أجيب عنه ما ذكرناه وله أن يحتج بما هو جواب عن دلالة مخصوصة فيقول لو تعادلت الأمارتان لأدى إلى الشك في الحكم وذلك لا يجوز وإنما قلنا إنه يؤدي إلى الشك لأن الرجلين المتساويين في الصدق لو
أخبرنا أحدهما أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة مع أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة وأنه لم ينفك الراوي من مشاهدته له منذ دخلها إلى أن خرج منها وأخبرنا آخر أنه رآه يصلي فيها فانا نشك هل صلى فيها أو لم يصل فيها ولا نظن أحدهما ولا كل واحد منهما أما أنا لا نظن واحدا منهما فقط فلأن الظن هو تغليب أحد المجوزين على الآخر وإنما يغلب أحدهما ويترجح بأمارة ترجحه فاذا كان في أحد المجوزين من الأمارة مثل ما في الآخر لم يترجح أحدهما على الآخر وكيف يترجح أحدهما على الآخر ونحن نجوز من خطأ أحد المخبرين مثل ما نجوز من خطأ المخبر الآخر فأما أنا لا نظن كل واحد منهما فلأن الظن هو تغليب أحد المجوزين على نقيضه فاذا قلنا هذا التجويز أغلب وأظهر من الآخر أفاد زيادته على الآخر وإذا قلنا كل واحد منهما ظن غالب للآخر أفاد أن كل واحد منهما زائد على الآخر وكل واحد منهما ناقص عن الآخر وهذا محال وإذا لم يحصل عند ذلك ظن وكان الحكم موقوفا على الظن لم يجز الحكم وهكذا لقول في الأمارات المستنبطة
وأما أنه لا يجوز أن لا نحكم في المسائل إلا بحكم شرعي بالإجماع لأن الناس على قولين أحدهما أنه يجب أن نحكم فيها بحكم شرعي معين غير التخيير والآخر أنه يجب أن نحكم فيها إما بحكم معين وإما بالتخيير فان قيل هلا قلتم إنه يجوز أن يحكم في المسألة بالأحوط أو بحكم العقل أو بالحكم الشرعي لأنه ناقل قيل هذا رجوع إلى أن الأمارتين لا تتساويان لأنه ليس يخلو حكم أحدهما من أن يكون هو الحكم العقلي وما عداه شرعي ولا يخلو إما أن يكون أحدهما حظرا والآخر مباحا أو وإذا أقررتم أنه يلزم المصير إليها فقد اقررتم بأن الأمارتين لا تتعادلان عند المجتهد إذا استوفى الاجتهاد
فان قيل فهلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان قيل لا يجوز ذلك لأن التخيير هو يفيد لحكم كل واحد من الأمارتين وذلك لا يجوز مع تجويزنا ان يكون كل واحد منهما غير أمارة وانتفاء ظننا يبين ذلك أنه إذا تعادلت
الأمارات الدالة على أن الكيل علة للأمارات الدالة على أن الطعم علته لم يجعل لنا الظن بأن أحدهما علة ولا الظن بأن كل واحد منهما علة ومع انتفاء الظن لكون الوصف علة لا يجوز أن يعلق الحكم به
وأيضا فالتخيير بين النفي والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل محظورا أو مباحا أو واجبا أو غير واجب لأنه إذا خير الإنسان بين الحظر والإباحة وقيل إن شئت فافعله وإن شئت فلا تفعله فقد ابيح الفعل إذ ليس للإباحة معنى سوى ذلك فان قيل الفرق بين ذلك وبين الإباحة معنى سوى ذلك وهو أن الإباحة هي تخيير بين الفعل والكف عنه على الإطلاق وفي هذا الموضع إنما قيل للمكلف افعل إن اعتقدت كون الفعل مباحا ولا تفعل إن اعتقدت حظره قيل أليس الاعتقاد لحظره وإباحته علما فمن قولهم نعم فيقال لهم فما الطريق إلى كون ذلك علما فان قالوا ثبوت الأمارة مع الدلالة الدالة على وجوب الحكم بالأمارة قيل وفي القول الآخر مثل هذه الدلالة وكيف يجوز أن تقولوا إن الطريق إلى العلم بالإباحة ما ذكرتم وأنتم تجوزون له أن لا يعتقد الإباحة ويعتقد الحظر فان قالوا الطريق إلى العلم بالإباحة أو إلى العلم بالحظر أن يختار المكلف اعتقاد أحدهما قيل اختيار الإنسان أن يعتقد شيئا ليس يدل على صحة معتقده فيكون اعتقاده علما إذ ليس له تعلق بالأدلة ولو جاز ذلك لجاز أن تختار الاعتقادات فتصير باختيارنا علوما وكيف يجوز ذلك مع أن الإنسان قد يختار الصحيح كما يختار الفاسد وليس مع الاختيار من الدلالة ما يختص أحد الاعتقادين دون الاخر فان قالوا إنما دلت على حسن الفعل بالشرط أن يختار المكلف اعتقاده قيل الدلالة الدالة على الحسن والقبح لا تعلق لها بالاختيار ففارق ذلك جميع شروط الأدلة وأيضا فحسن الاختيار للاعتقاد تابع لحسن الاعتقاد لأنه إنما يحسن أن نعتقد ما هو صحيح في نفسه فالاختيار تابع لما هو تابع للمعتقد وهم عكسوا القضية فجعلوا الاعتقاد تابعا للاختيار وجعلوا صحة المعتقد تابعا للاعتقاد وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن
العامي إذا أفتاه مفت بالحظر وأفتاه آخر بالإباحة وقلنا إنه يجب عليه الاجتهاد فيها فانه إذا اجتهد فيهما فلا بد من أن يترجح عنده أحدهما على الآخر فان قيل هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا إذا تساويا عند الإنسان قيل لو جعلناه مباحا لكنا قد علمنا على أمارة الإباحة مع مساواة أمارة الحظر لها وليس يجوز ذلك لأنهما إذا تساويا عنده وجب الشك على ما ذكرناه والعمل في هذه المسائل يتبع الظن لا الشك وأما إن لم يلزم المستفتي الاجتهاد فيهما فلا بد من القول بأنه يصير الفعل مباحا وليس هناك اجتهاد في أمارتين فيمتنع مع تساويهما عند المجتهد أن يحكم بحكم أحدهما
باب فيما يصح أن يقوله المجتهد من الأقاويل وما لا يصح وهل يصح أن يقال
له في المسألة قولاناعلم أن الأقاويل المتناقضة لا يصح أن يعتقدها أحد من الناس نحو أن يعتقد أن العفل حرام عليه في وقت مخصوص في مكان مخصوص على وجه مخصوص ويعتقد مع هذا الاعتقاد أن ذلك الفعل حلال له على هذه الشروط فأما اعتقاد وجوب فعلين ضدين على البدل والتخيير فغير ممتنع نحو أن يعتقد أن الخروج من الدار يجب من كلا بابيها على التخيير ونحو الصلاة في أماكن متضادة ويجوز أن يعتقد معتقد الاعتداد بالأطهار والحيض على البدل لأنه لا تنافي في ذلك
وذكر قاضي القضاة في العمد أنه يصح أن يعتقد الإنسان إثبات الحكم ونفيه وكون العبادة واجبة ومستحبة وكون الفعل حسنا وقبيحا كل ذلك على البدل ومنع في الشرح من دخول التخيير بين المستحب والمباح قال لأن لأحدهما مدخلا في التعبد دون الآخر فان قال أريد له أن يفعل المستحب ولا يفعله فهو صحيح كان التخيير أو لم يكن قال وأما التخيير
بين الواجب والمستحب فبعيد لأن ذلك يقدح في كون الواجب واجبا
وأما نحن فقد بينا في الباب المتقدم القول في ذلك فأما ما يعزى إلى الشافعي من القولين فذكر قاضي القضاة أن ذلك يصح من وجوه ثلاثة
أحدها أنه يتكافى عنده أمارتا القولين فيقول بهما على التخيير والآخر أن يكون قد فسد عنده ما عداهما ولا يدري ايهما الحق من غير أن يقويا والآخر أن يكونا قد قويا عنده قوة ما وله فيهما نظر وفسد ما عداهما فيقال له فيها قولان على معنى أنهما قولاه اللذان قواهما على ما عداهما
ولقائل أن يقول أما تكافي الأمارتين في قولين نفي وإثبات والقول بأن المكلف يكون مخيرا فيهما فقد بينا أنه لا يصح نحو ما يقوله فيما سقط من شعر اللحية عن الوجه أن فيه قولين أحدهما يجب غسله في الوضوء والآخر لا يجب وأما تكافي الأمارتين في فعلين غير متنافيين نحو الاعتداد بالأطهار وبالحيض فقد كان يصح التخيير بين ذلك كما يصح التخيير بين الكفارات الثلاث إلا أنه لا يقال لمن اعتقد التخيير في ذلك إن له في المسألة قولين بل قول واحد وهو القول بالتخيير فانه ما من أحد يقول إن للمسلمين في كفارة اليمين ثلاثة أقاويل أحدهما أن يكفر بالعتق والآخر بالكسوة والآخر بالإطعام وإن لهم في الصلاة في البقاع أقاويل كثيرة وفي الخروج من دار مغصوبة ذات بابين قولان وأما الوجهان الآخران فالمرجع بهما إلى أنه شاك في قولنا ومن شك في شيئين وجوز كل واحد منهما بدلا من الآخر لا يكون له قول في المسألة أصلا فضلا أن يقال له فيها قولان فان من شك في أن العالم محدث أو قديم لا يقال له في العالم قولان على أنه قد قال قولا نفيا وإثباتا لا متوسط بينهما فلا يمكن أن يقال قد فسد ما عداهما وتوقف في الصحيح منهما نحو غسل ما سقط عن الوجه من اللحية
فأما ما يحكى عن الشافعي من القولين فينبغي أن يقال إن الشافعي إذا
قال في المسألة قولان فله ثلاثة أحوال أحدها أن لا يكون له في تلك المسألة ولا فيما يجري مجراها غير ذلك القول وظاهر فيما هذه حاله أن لا ينسب إليه في تلك المسألة غير ذلك القول والآخر أن يكون له قول آخر في تلك المسألة أو فيما يجري مجراها والآخر أن يكون له في تلك المسألة أو فيما يجري مجراها قولان أو أكثر فان كان له في تلك المسألة قول آخر ذكره في موضع آخر فلا بد من أن يكون قد اثبتهما في زمان بعد زمان فان علمنا المتأخر منهما كان ذلك القول رجوعا إلى القول الآخر لأنه لا شيء أبلغ في رجوع العالم عن القول من أن يقول بضده وعلى هذا يكون أمر الله عز و جل بضد ما أمر من قبل ناسخا لأمره الأول فان لم يعلم المتأخر منهما فالواجب إسنادهما إليه ويقال لا يعلم المتقدم منهما ولا يجوز أن يقال إنهما قولاه في حالة واحدة لأنا غير عالمين بذلك فأما إن نص على خلاف ذلك القول في مسألة تجري مجرى تلك المسألة فان أمكن أن يفرق بينهما بعض المجتهدين فانه لا ينبغي أن ينقل قوله من إحدى المسألتين إلى الأخرى لجواز أن يكون قد فرق بينهما وإن لم يمكن أن يذهب بعض المجتهدين إلى الفرق بينهما فانه يجري نصه فيها مجرى أن ينص في المسألة الواحدة على قولين مختلفين وأما إن وجد له في موضع آخر قولان في تلك المسألة بعينها فانه لا يجوز أن يحملا على اختلاف حالين ولا يحمل على أنهما حكاية عن غيره لأن الظاهر خلاف ذلك فان أشار إلى أحد القولين فقال وهذا مما أستخير الله فيه أو قواه ضربا من التقوية فانه يدل على أنه قد اختاره على القول الآخر لأنه إنما يختار المجتهد أحد القولين على ألاخر إذا قوي عنده ويجوز أن يكون إنما بانت له قوة أحدهما عند فراغه من إثباتهما في الكتاب وكانا متكافئين عنده لما ابتدأ باثباتهما وإن لم يقو أحد القولين فانه إن كان حين نص على أحد القولين في المسألة لم تكن المسألة مقصودة في كلامه فانه لا يدل ذكره على أنه في تلك الحال ما كان يعتقده سواه لأن ما ليس بمقصود لا يستوفي القول فيه وسواء علمنا تقدم بعضه على ذلك القول أو علمنا تأخره أو لم نعلم تقدمه ولا تأخره
وإن كانت المسألة مقصودة في كلامه فذكره لذلك القول يدل على أنه لم يكن يعتقد في تلك المسألة سواه فان علمنا تأخره أعني القول المنفرد كان ذلك رجوعا عن ما عداه فان كان هو أحد القولين الآخرين فهو رجوع عن القول الآخر وإن كان غيرهما فهو رجوع عنهما إليه وإن علمنا تأخر القولين فقد صار له في المسألة قولان فان كانا سوى القول المنفرد فقد رجع عن القول النفرد وإن كان القول المنفرد هو أحد القولين فقد صار له في المسألة قول آخر مع ذلك القول وإن لم نعلم تأخر أحد النصين عن الآخر وجب حكاية الحال ويقال لا ندري أي النصين تقدم الآخر فان كان نصه على القولين في مسألة يجري مجرى المسألة التي نص فيها على القول المنفرد وأمكن أن يكون بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فينبغي أن يقال له في المسألة قول واحد وفي المسألة الأخرى قولان وإن لم يمكن أن يفرق بينهما مجتهد فالقول فيهما كالقول في المسألة الواحدة وقد دخل في جملة هذه القسمة أن ينص على قولين معا في مسألة واحدة فنقول فيها قولان
باب في الوجه الذي يجوز معه تخريج المذهب
اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده فمتى ظننا اعتقاد الإنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه ومتى لم نظن ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبهوقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة بوجوه منها أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين ومنها أن يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها فيقول الشفعة لكل جار ومنها أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين وينص على حكم احدهما فيعلم أن حكم الاخرى عند ذلك الحكم نحو أن يقول الشفعة لجار الدكان فيعلم أن الشفعة عنده لجار الدار إذ قد علمنا أنه لا يفرق بين الدار
والدكان ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص لعلة أو لم يقل أما إذا لم يقل بتخصيص العلة وقال النية واجبة في التيمم لأنه طهارة عن حدث فقد اعتقد وجوب النية لأجل هذه العلة فاذا علم أن العلة شاملة علم شمول حكمها فأما من يجوز تخصيص العلة فانه يجوز تخصيصها إذا دل على تخصيصهما دلالة كالعموم فكما أن كلام العالم العام يدل على مذهبه فكذلك تعليله
فأما إذا نص العالم في مسألة على حكم وكانت المسألة تشبه مسألة أخرى شبها يجوز أن يذهب على بعض المجتهدين فانه لا يجوز أن يقال قوله في هذه المسألة هو قوله في المسألة الأخرى لأنه قد لا تخطر المسألة بباله ولم ينبه على حكمها لفظا ولا معنى ولا يمتنع لو خطرت بباله لصار فيها إلى الاجتهاد الآخر
فان قيل أليس إذا نص الله تعالى على حكم مسألة ثم نبه على علته ورأى بعض المجتهدين أن علة ذلك الحكم موجودة في فرع فانكم تقولون من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه و سلم الحكم في الفرع بحكم الأصل فهلا قلتم في نص المجتهد مثل ذلك قيل له إنما قلنا إن ذلك دين الله تعالى لأنه قد دلنا على العلة بتنبيه عليها ودلنا على أنه قد تعبدنا باجراء حكمها بتبعها والعالم لم يدلنا على مذهبه في غير ما نص عليه لأنه يجوز أن يكون ممن يفرق بين المسألتين ويخطىء في الفرق بينهما ولا يجوز مثل ذلك على الله سبحانه
الكلام في الحظر والإباحة
باب في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة
اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان قبيح وحسن فالقبيح كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك والحسن ضربان أحدهما يترجح فعله على تركه والآخر لا يترجح فعله على تركه فالأول منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضل ومنه ما لا بد من فعله وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم وأما الذي لا يترجح فعله على تركه فهو المباح وذلك كالانتفاع بالمآكل والمشارب وهذا مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم والشيخ ابي الحسن وذهب بعض شيوخنا البغداديين وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحتهوقد تقدم معنى المباح والمحظور فلا معنى لإعادته غير أنه قد يوصف الفعل بأن الإقدام عليه فقط مباح وإن كان محظورا تركه كوصفنا المرتد بأنه مباح الدم ومعناه أنه لا ضرر على من اراق دمه ولا تبعة وإن كان الإمام ملوما بترك إراقته ودليلنا على أن الانتفاع بالمآكل مباح في العقل هو أن الانتفاع بها منفعة ليس فيه وجه من وجوه القبح وكل ما هذه سبيله فحسنه معلوم والعلة في حسن ما هذه سبيله هي أن المنفعة تدعو إلى الفعل وتسوغه إذ هي غرض من الأغراض فاذا انتفى وجوه عنها تجرد ما يقتضي الحسن أما أن أكل الفاكهة منفعة فلا شبهة فيه ولا شبهة في انتفاء وجوه القبح عنه نحو الكذب والجهل وكفر النعمة أو مضرة على النفس أو على الغير لأنا إنما تكلمنا في أكل ما لا مضرة فيه ولو كان فيه مفسدة لدلنا الله عليها
وليس في العقل دليل عليها ولا في السمع
إن قيل جواز كونه مفسدة يغني في قبحه كما يغني جواز كون الخبر كذبا في قبحه وإذا قبح مع الجواز لم يجب في الحكمة تعريف كونه مفسدة قيل قد أجيب عن السؤال بأشياء
منها أنا كما نعلم قبح خبر لا نأمن كونه كذبا فانا نعلم حسن منفعة لا نعلم فيها وجها من وجوه القبح ألا ترى أنا نعلم حسن التنفس في الهواء أو التصرف فيه وليس يضرنا أن لا نعرف الفرق بين ذلك وبين الخبر الذي يقبح إذا جوزنا كونه كذبا وهذا الجواب لا يصح لأن المستدل رام أن يثبت حسن هذا التصرف بانتفاء وجوه القبح عنه واستدل على انتفاء كونه مفسدة بأنه لو كان مفسدة للزم في الجملة تعريفنا كونه مفسدة وهذا الجواب ينفي وجوه القبح عنه تبعا للعلم بأنه حسن فهو مخالف لموضوع الدلالة وهو انتقال إلى دلالة أخرى وهي قياس سائر المنافع على التنفس في الهواء وسيجيء الكلام على هذا القياس
ومنها أن الكذب يقبح على كل وجه وإن اختص بنفع ودفع ضرر وليس كذلك المنافع والمضار ولقائل أن يقول ولم إذا افترقا من هذه الجهة وجب إذا قبح أحدهما لتجويز كونه كذبا لا يقبح الآخر لتجويز كونه مفسدة وأيضا فان المفسدة لا تحسن على وجه وإن اختصت بنفع أو دفع ضرر كما أن الكذب لا يحسن مع النفع ورفع الضرر فهلا كان تجويز المفسدة كتجويز كون الخبر كذبا في تقبيح الفعل
ومنها أن الأصل في النفع أن يكون حسنا وأن يكون خالصا إذا لم يعلم فيه مضرة ووجه قبح فاذا كان كذلك وجب متى لم يخبرنا الله أن الفعل مفسدة أن نقطع على أنه ليس بمفسدة وليس كذلك الخبر لأنه ليس الأصل فيه كونه صدقا ولقائل أن يقول إن أردتم بهذا الكلام أن النفع الذي لا يعلم
فيه وجه قبح يجب القطع على أنه ليس فيه وجه قبح ففي ذلك تخالفون لأن مخالفكم يقول متى لم نعلم فيه وجه قبح فنحن نجوزه وإن أردتم ان الغالب فيما هذه سبيله أنه ليس فيه وجه قبح قيل لكم لم زعمتم أن الغالب ما ذكرتم ولم إذا كان الغالب ذلك لم يكن تجويز وجه القبح كافيا في القبح
ويمكن الاستدلال بالنفع على وجه آخر فيقال إن النفع يدعو إلى الفعل ويقتضي حسنه إذا خلا من وجوه القبح وخلا من أمارة الضرر والمفسدة والانتفاع بالمآكل هذه سبيله في العقل فكان حسنا والدلالة على أن المعتبر هو بأمارة الضرر والمفسدة هي أن العقلاء يلومون من امتنع عن الفعل لتجويز الضرر بلا أمارة ويعذرونه إذا كانت فيه أمارة ألا تراهم يلومون من قام من تحت حائط لا ميل فيه لجواز سقوطه لفساد في اساسه وفي باطنه ولا يلومونه إذا كان مائلا ولا يلومون من امتنع من أكل طعام شهي لأمارة دلت على أنه مسموم ويلومونه من جهة العقل إذا امتنع منه لتجويز كونه مسموما وليس يلومونه على ذلك لأنه خالف الشرع في امتناعه من ذلك بل ربما لا يخطر الشرع ببالهم في ذلك الوقت ولأن لومهم على ذلك ليس كلومهم من امتنع من أكل لحم الحيوان ولأن البراهمة يلومونه على ذلك ولا يعرفون الشرع وأما أن الانتفاع بالمأكل هذه سبيله فلانه ظاهر خلوه من كونه كذبا وجهلا وكفر نعمة وكونه تصرفا في ملك الغير إنما يقبح الفعل إذا استضر به الغير علىما سنشرحه وأما كونه مفسدة ومضرة فاستبعاد العقلاء له كاستبعادهم أن يكون الطعام مسموما وأن الحائط الذي لا ميل فيه يسقط وأما الأخبار إذا لم يؤمن كذبها فقد علمنا قبحها وإن لم نشهد أمارة بكذبها كما نعلم حسن نفع لا أمارة فيه بكونه مفسدة ومضرة ولا يضرنا أن لا نعرف العلة في ذلك وأيضا فالنفع وجه يحسن وليس كون الخبر خبرا وجه حسن ولا الأظهر أن يكون صدقا
جواب آخر لو قبح الإقدام على المنافع لتجويز كونها مفسدة لقبح
الإحجام عنها لتجويز كونه مفسدة وفي ذلك وجوب الانفكاك منهما وذلك وجوب ما لا يطاق فبطل أن يكون تجويز كون الفعل مفسدة وجه قبح ولا يلزم إذا قبح الخبر لجواز كونه كذبا أن يقبح تركه لأن تركه ليس بخبر فيجوز كونه كذبا ولا يلزمنا وجوب فعل الخبر لجواز كونه صدقا لأن القطع على كونه صدقا لا يوجب فعله فضلا عن جواز كونه صدقا
فان قيل ليس بأن يقبح لجواز كونه كذبا بأولى من أن يحسن لجواز كونه صدقا قيل اعتبار وجه القبح أولى لأنا إذا فعلنا الخبر لم نأمن كونه كذبا قبيحا فاذا تركناه لم نكن خائفين من الوقوع في القبح
فان قيل ليس بأن يقبح الخبر لجواز كونه كذبا باولى من أن يجب لجواز كون الإخلال به مفسدة قيل كيف يلزمنا ذلك ونحن نقول إن تجويز كون الفعل مفسدة من غير أمارة لا يقتضي قبح الفعل ولو لم يدل على ذلك إلا هذا الوجه لكفى
فان قيل إن تجويز المفسدة وجه القبح وهو إن حصل في الإقدام على المنفعة وفي الإحجام عنها فانا نتخلص من هذا الفساد بالترك لأن الشرع لا ينفك منه العقل فيبين هل في ذلك مفسدة أم لا قيل إنا لم نتكلم في العقل لا ينفك من الشرع وإنما تكلمنا على أنه لو انفرد العقل هل كان يقبح هذا الإقدام على المنافع أم لا وقد بان أنه لا وجه يوجب قبحه ثم يقال لهم كيف تستدلون بذلك على وجوب اقتران العقل بالشرع فان قالوا بأن نقول لو انفرد العقل عن الشرع لم يحسن الإقدام على المنافع والإحجام عنها لجواز كون كل واحد منهما مفسدة ولم يقبح الإقدام والإحجام تبعا لاستحالة الانفكاك منهما ومحال إنفكاك المنافع من هذه الأقسام فانفكاك العقل عن سمع قد أدى إلى هذا الفساد فلم يجز أن ينفك من سمع قيل لهم أرأيتم لو انفك العقل عن سمع أكان يجب الانفكاك من الإقدام على المنافع ومن الإحجام فان قالوا ليس بأن لا يجب ذلك لاستحالة بأولى من أن يجب
لقبح الإقدام والإخلال قيل لهم ارأيتم لو أقدم المكلف على المنافع أو أخل بها كان يحسن ذمه فان قالوا لا ندري كانوا قد جوزوا حسن الذم على ما لا يمكن انفكاك منه ومعلوم بطلان ذلك وإن قالوا كان لا يحسن الذم قيل لهم فاذا لم ينفك الشرع عن عقل حسن من المكلف الإقدام وحسن الإحجام وأيضا فكان ينبغي أن لا يقولوا إن المكلف يلزمه الإخلال بالمنافع قبل الشرع لأنهم قد أقروا بأنه ليس بأن يقبح الإقدام بأولى من أن يقبح الإحجام وأيضا فان الانفكاك من شرع لا يؤدي إلى الفساد الذي ذكروه لأن المكلف يقول إن لي إلها حكيما وليس يجوز أن يجب علي الانفكاك من الإقدام على المنافع ومن الإحجام عنها لأن ذلك يستحيل فاذا ليس يجتمع الإقدام والإخلال بها في القبح ولو انفرد أحدهما بالحسن دون الآخر لوجب في حكمة المكلف أن يفرق لي بينهما بدليل عقلي أو سمعي إذ كنت لا أعرف ذلك ضرورة وليس في العقل تجويز كون أحدهما مفسدة دون الآخر وإذا لم يفرق لي بينهما فليس ينفرد أحدهما بالحسن دون القبح ولا يجتمعان في القبح فاذن يجتمعان في الحسن وأيضا فان كان انفكاك العقل من سمع يؤدي إلى هذا المحال فما يصنع الناظر عند ابتدائه بالنظر قبل وصوله إلى النظر في النبوات
فإما القول بأن الإقدام على المنافع قبيح لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فان قاسوه على تصرف بعضنا على ملك بعص بغير إذنه فباطل لأن في الامتناع عنها إضرار بالنفس وهو تصرف في ملك الله بغير إذنه فيجب قبح الإقدام وذلك محال وأيضا فمعنى الملك فينا وفي ملك الله تعالى يختلف والجمع به بين ملك الله تعالى وملكنا جمع بغير علة واحدة وذلك أن معنى كوننا مالكين للشيء هو أنا أحق بالانتفاع به من غيرنا على الإطلاق وذلك مستحيل على الله تعالى ومعنى كونه مالكا للشيء هو أنه قادر على إيجاده وإفنائه فان قالوا بل معنى كونه مالكا للمنافع هو أنه ليس لغيره التصرف فيها إلا بلإذنه وله المنع منها قيل هذا تعليل الحكم بنفسه ومع ذلك فلم نسلم
ما ذكرتموه وأيضا فان الإنسان إنما يكون مالكا للشيء وأحق به من غيره بالشرع لأن عندكم أن العقل لا يقتضي جواز تصرف الإنسان في الشيء فاذا لم يكن هذا الأصل ثابتا في العقل عندكم وكان كلامنا فيما يقتضيه ما يثبت في العقل سقط ما قلتم وأيضا فانه إنما يقبح تصرفنا في ملك غيرنا لأنه يضره لا لأنه مالكه فقط ألا ترى أنه يحسن منا الاستظلال بحائط غيرنا والنظر في مرآته والتقاط ما تناثر من حب غلته بغير إذنه ما لم يضره ذلك والمنافع والمضار يستحيلان على الله تعالى
وقد أجيب عن ذلك بأن إباحة ذلك في العقل تجري مجرى إذن سمعي ولقائل أن يقول إنما نعلم أن الله تعالى قد أباحه في العقل إذا أفسدتم أن يكون كون التصرف في ملك الغير وجه قبح ومتى جوز ذلك لم نعلم إباحة الله تعالى لذلك
دليل خلق الله تعالى الطعوم في الأجسام مع إمكان أن لا يخلقها فيها يقتضي أن يكون له فيها غرض يخصها وإلا كانت عبثا ويستحيل أن يعود إليه ذلك الغرض بنفع أو دفع ضرر لاستحالتهما عليه ولا يجوز أن يعود على غيره بضرر لأنه قد لا يكون فيها ضرر ولأنها إنما تضر بادراكها وفي ذلك إباحة إدراكها ولأنه لا يحسن أن يكون غرضه الإضرار الخالص بمن لا يستحق الإضرار فوجب أن يكون الغرض بادراكها نفعا يعود إلى غيره إما بأن يدركها أو بأن يجتنبها لكون تناولها مفسدة فيستحق الثواب بادراكها وإما بأن يستدل بها وفي ذلك إباحة إدراكها لأنه إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكها وفي ذلك تقدم إدراكها وإنما يستدل بها إذا عرفت والمعرفة بها موقوفة على إدراكها لأن الله تعالى لم يخلق فينا المعرفة بها من دون الإدراك فصح أنه لا فائدة فيها إلا الإباحة للانتفاع بها وذلك يقتضي أن يركب الله في العقول إباحة الانتفاع بتلك الأجسام ليعلم حصول الطعوم فيها فينتفع بها بأحد هذه الوجوه
وقد قيل لو خلقها ليستدل بها لا لينتفع بها بالأكل لكان قد خلق ما يمكن أن ينتفع به من وجهين وقصد الانتفاع بأحدهما فقط مع إمكان الانتفاع بالوجه الآخر وذلك يقتضي كونها عبثا من الوجه الذي لم يقصده لأن كلا الوجهين يجريان مجرى فعلين متميزين فكما أنه لو فعل أحدهما لغرض وفعل الآخر لا لغرض لكان عبثا فكذلك الوجهان ولا يلزم على ذلك أن يقصد الانتفاع للملائكة بأكل المأكولات وأن يقصد استدلال اهل الجنة بما يخلقه لهم لأن استدلالهم بذلك على الله لا يمكن مع علمهم به ضرورة وكذلك انتفاع الملائكة من جهة العقل ولقائل أن يقول ولا يجوز أن يقصد انتفاعنا بالطعوم من جهة الأكل لأن ذلك مفسدة ولو حسن أن يقصد لم يمتنع أن يقصد الانتفاع بالطعوم من أحد الوجهين دون الآخر لأن الأصلح في الدنيا غير واجب على قول الشيخ وقولهم إن الوجهين يجريان مجرى الفعلين إن أرادوا به أنهما كالفعلين في وجوب حصول غرض فيهما لم نسلمه ولنا أن نقول إن الفعلين المتميزين إذا فعل الفاعل أحدهما لا لغرض فقد أوجد فعلا لا غرض فيه وكان عبثا فأما الفعل الواحد إذا أمكن الانتفاع به من وجهين فقصد أحدهما فانه قد فعل الفعل لغرض فلم يكن عبثا
دليل وقد استدل على ذلك بأنه يحسن من العقلاء التنفس في الهواء وأن يدخلوا منه أكثر مما تحتاج إليه الحياة ومن رام أن يقدر على نفسه ذلك ولا يزيد على قدر ما تحتاج إليه الحياة عده العقلاء من المجانين والعلة في حسن ذلك أنه انتفاع لا يعلم في مفسدة ولا مضرة وهذا قائم في غير ذلك وليس لأحد أن يجعل علة حسن ذلك أن فيه بقاء الحياة وفي تركه هلاكها مع أنها ملك الغير وأن الإنسان ملجأ إلى ذلك لأنا فرضنا المسألة في قدر ينفي الحياة من دونه على أن الكف عن التنفس إن أتلف الحياة فليس يجب أن يقبح من الإنسان على قولكم لأنه ليس يجب على الإنسان أن يصلح ملك غيره وإنما يجب عليه أن لا يتلفه
فان قيل إنما يحسن من الإنسان أن يتنفس ليندفع عن قلبه الحرارة وذلك محتاج إليه في الحياة وما زاد عليه يضر ولا يحسن قيل ليس يجب أن يكون ما زاد على ما تحتاج إليه الحياة مضرا بل لا يمتنع أن يكون نافعا ملذا كما لا يمتنع أن لا يكون ما زاد على ما يثبت معه الحياة من المأكل مضرا بل يكون نافعا ملذا يقتضي خصب البدن فلم يلزم ما ذكره السائل من قبح هذه الزيادة وهذه الدلالة ترجع إلى الدلالة المتقدمة وهي أن المنافع لا يقدح في حسنها تجويز المفسدة والمضرة وما ذكرناه الآن من استنشاق الهواء هو مثال لما ذكرناه أن من العقلاء يستحسنون أمثال هذه المنافع فأما من توقف فقال لا أدري هل الأشياء على الحظر أو على الإباحة فقوله باطل بما ذكرناه لأنه إما أن يقول لو انفرد العقل لاستحق من أقدم على المنافع الذم فنجعلها محظورة أو يقول لا يستحق الذم فنجعلها مباحة فاذا صح أن من الأشياء ما هو على الحظر ومنها ما هو على الإباحة كان ذلك أصلا في الدلالة على إباحة المباح منها وحظر المحظور إذا لم تنقلنا عنه الأدلة الشرعية
باب في فصول طرق الأحكام الشرعية
اعلم أنه لا ينبغي أن نتكلم في شروط الاستدلال على الأحكام الشرعية إلا بعد أن نبين أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طرق عقلية أو شرعية نفيا كان الحكم أو إثباتا ونبين الفصل بين ما هو طريق في ذلك وما ليس بطريق ليعمد المستدل إلى ما هو طريق فيستدل به وذلك يقتضي أن نبين أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق إما عقلي وإما شرعي ويدخل في الطريق العقلي فصلان أحدهما أن يبين الفصل بين الاستدلال بالبقاء على حكم العقل وبين ما يلتبس بذلك من استصحاب الحال والآخر أن يبين الفصل بين ما يصح أن يستدل عليه بالعقل وما لا يصح ويدخل في الطريق السمعي فصلان أحدهماأن يبين أن السمع الدال على الحكم يجب أن يتناوله إما صريحا وإما غير صريح ولا يجوز أن يقال للمكلف احكم فانك لا تحكم إلا بالصواب والآخر أن ذلك السمع في شرعنا هو القرآن دون غيره من الكتب المتقدمة
باب في أن الأحكام الشرعية لا يجوز إثباتها إلا بطريق
اعلم أن الحكم الشرعي يجب كونه معلوما وإلا لم يؤمن كونه خطأ ولا يخلو إما أن يكون العلم به في البديهة أو لا يكون فيها فلو كان فيها لاشترك العقلاء فيه ولأنا نعلم أنه ليس في البديهة العلم بوجوب صوم أول يوم من شهر رمضان وسقوط وجوب ما قبله وإذا لم يكن العلم به في البديهة لم يجز حصوله لنا إلا بأمر يوصلنا إليه إما إدراك أو خبر متواتر أو دليل يجوز كونها مدركة والخبر المتواتر إنما يفضي إلى العلم إذا كان المخبر مدركا لما أخبر به فبقي أن يكون الموصل إلى العلم به هو الدليلفأما من لا يثبت الحكم في الشيء فلا يخلو إما أن يكون شاكا في إثباته أو معتقدا أو ظانا لنفيه فان اعتقد أو ظن نفيه وأقر أنه لم يصر إلى اعتقاده أو ظنه بطريقة فقد أقر أنه منحت وأن ظنه جار مجرى ظن السوداوي وإن ادعى أنه صار إلى ذلك بطريقة ودعا إلى اعتقاده وظنه فلا بد من أن يذكر طريقته التي أدته إلى ذلك الاعتقاد أو الظن لأنه إن ألزم غيره المصير إليه من غير أنه يمكنه من طريقته التي أوصلت إلى المذهب فقد ألزمه ما لا يطيقه
والطريقة إلى المذهب ضربان إثبات ونفي أما الإثبات فبأن ينص الله تعالى أو النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك الحكم أو تجمع الأمة عليه أو يدل القياس عليه وأما النفي فبأن يفقد الناظر بعد الفحص الشديد دليلا على ذلك الحكم مع أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل وهذه الطريقة لا بد من البينة عليها غير أنه لا يمكن النافي للحكم أو يوقف المناظر له على دليل من أدلة
العقل أو الشرع ويعرفه أنه لا دليل فيه على ذلك الحكم والواجب على مخالفه أن يريه دليلا على إثبات ما نفاه ليقع الكلام فيه فان كان الدليل إثباتا وجب أن يعينه
وإن كان ممن لا يثبت الحكم في الشيء شاكا فيه فلا يخلو إما أن يكون شاكا فيه لطريقة أفضت به إلى الشك أو لا لطريقة فان شك لا لطريقة بل لأنه لم يكن استدل عليه فهذا ليس له مذهب فيقال أنه صار إليه لطريقة يجب عليه ذكرها إذا استدعى غيره إلى مذهبه وإن كان صار إلى الشك لطريقة فاما أن يكون فقد دلالة على المذهب بعد الفحص الشديد مع أن ذلك الشيء لا يجوز أن يكون ثابتا ولا يدل عليه دليل وإما أن يكون قد دل على فقد الدلالة على ذلك المذهب دليل مبتدأ نحو أن يقول النبي صلى الله عليه و سلم لا دليل على هذا الشيء وفي كلا القسمين يكون الشاك معتقدا أنه لا دليل على ذلك المذهب فيعتقد وجوب الشك فيه وله في الحالين مذهب قد صار إليه بطريقة فمتى دعا إليه غيره فالواجب أن يذكر له طريقة لتؤديه إلى مثل ما أدته إليه
وإن كانت طريقته الإثبات عنها وإن كانت طريقته فقد الدلالة بعد شدة الفحص أخبره بذلك ووقفه على طرق الدلالة على الجملة ونبهه على التفصيل بافساد كل ما يدعي أنه دليل على ذلك المذهب إذا استرشده المسترشد فاذا ثبت ذلك فمن قال ليس على النافي دليل إن أراد به ليس عليه دليل هو إثبات فقد بينا أنه ليس علة ذلك إلا أن يكون دليل إثباته وإن أراد أنه لا يجب عليه ذكر طريقه أصلا فقد بينا وجوب ذلك ولما تقدم علمنا كذب المدعي للنبوة إذا لم يدل على صدقه دلالة من معجز أو غيره لأنه لو كان صادقا لما أخلاه الله من دلالة وإلا كان قد كلفنا ما لا نطيقه وكذلك ما لم يدل على إثباته دليل من الأحكام الشرعية وجب نفيه
واحتج القائلون بأن النافي لنبوة مدعي النبوة لا دليل عليه وإنما الدليل
على من اثبت نبوته والجواب عنه ما تقدم وقال أيضا المدعي لدار في يد غيره عليه البينة ولا بينة على المنكر فذا لم يكن على المنكر بينة فليس عليه دلالة لأن البينة دلالة يقال لهم لم أردتم بهذا الكلام أنه يجوز لمن الدار بيده أن يعتقد كونه مالكا لها من غير طريقة كإرث أو غيره فليس كذلك بل ليس له اعتقاد ذلك إلا بطريقة من الطرق وإن أردتم أنه ليس عليه أن يذكر طريقه فصحيح لأنه ليس يدعو الناس إلىأن يعتقدوا كونه مالكا لها فيلزمه أن يذكر لهم حجته كما يلزم صاحب المذهب إذا دعا الناس إلى مذهبه أن يذكر لهم حجته وإن أردتم أن الذي الدار في يده يدعو الحاكم إلى أن يحكم له بها من غير طريقه يذكرها فباطل بل إنما يدعوه إلى ذلك لطريقة وهي اليد وليس للحاكم أن يحكم له بذلك إلا لدلالة فقد بان أنه لا بد من طريقة في كل هذه الوجوه
باب القول في استصحاب الحال
اعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون حكم ثابت في حالة من الحالات ثم تتغير الحالة فيستصحب الإنسان ذلك الحكم بعينه مع الحالة المتغيرة ويقول من ادعى تغير الحكم فعليه إقامة الدليل وقد ذهب قوم من أهل الظاهر وغيرهم إلى الاحتجاج بذلكوقد يكون الحكم المستصحب عقليا وقد يكون شرعيا فالشرعي أن يقول الإنسان المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه التوضوء به وكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاة ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة فعليه الدليل وهذا باطل لأنه إن شرك بين الحالتين في وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب حال الذي ننكره ويذهبون إليه وإن شرك بينهما في الحكم لاشتراكهما في علته فهذا
قياس وإن شرك بينهما بغير دلالة ولا علة فليس هو بأن يجمع بينهما بأولى من أن لا يجمع بينهما أو بأن يجمع بين المسألة وغيرها ولأن ذلك قياس بغير علة وأهل الظاهر المانعون من القياس بعلة أولى أن يمنعوا من ذلك
فان قيل حدوث الحادث لا يغير الأحكام فحدوث الصلاة إذن لا يغير وجوب الوضوء قيل ليس يمتنع أن تختلف المصالح بحدوث الحوادث ولهذا جاز ورود النص باسقاط الوضوء عن الرائي للماء في الصلاة مع وجوبه على من رآه قبل الصلاة
فان قيل لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة لوجب قصره على الزمان الواحد قيل كذلك يجب إلا أن يكون دليل الحكم وعلته قد عم الأزمنة فان قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيخيل أنه أحدث فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا فأوجب استدامة الحكم قيل إنا لا نمنع من تعدى الحكم من حالة إلى حالة لدلالة وإنما نمنع من ذلك لا لدلالة وقول النبي صلى الله عليه و سلم هو دلالة فان قيل أليس بعض الفقهاء قد جعل حكم الشاك في الحدث بعد تيقن الطهارة كحكمه قبل الشك فيها في إسقاط الوضوء قيل إن هؤلاء إن جمعوا بينهما لدلالة أو علة وإلا فهو موضع الخلاف على أن ذلك خارج عما نحن بسبيله لأن الأصل في العقل أن لا وضوء فاذا لم يدل على وجوبه على الشاك في الحدث دليل شرعي فالواجب البقاء على حكم الأصل لأنه لو كان واجبا لدل الله تعالى عليه وليس كذلك وجوب الوضوء على من رأى الماء لأن الوضوء ليس هو حكم العقل حتى يلزم البقاء عليه ما لم تدل على خلافه دلالة
فان قيل اليس إذا اختلفوا في المسألة على اقاويل يجوز الأخذ بأقل ما قيل إذا لم تدل على الزيادة دلالة قيل لأن أقل ما قيل متفق عليه والزيادة إذا كانت حكما شرعيا فيجب نفيها إذا لم يدل عليها دليل وكذلك القول في الاستدلال ببراءة الذمة
فأما إذا كان المستدام عقليا فمثاله أن يقول القائل المتيمم المصلي إذا لم ير الماء لم يلزمه الطهارة الأخرى ووجب أن يمضي في صلاته فكذلك إذا رأى الماء وهذا يصح من وجه دون وجه أما الوجه الذي لا يصح منه فهو أن يسقط عنه طهارة أخرى لأجل سقوطها إذا لم ير الماء لأن هذا جمع بين حالتين بغير دلالة ولا علة وأما إذا أسقط عنه الوضوء بعد رؤية الماء لأن إيجابه شرعي فلو كان ثابتا لكان عليه دليل شرعي وليس عليه دليل شرعي على ما بينا في الاستدلال بالنفي فصحيح وإن عورض هذا فقيل الأصل في الشرع وجوب الطهارة فلو سقطت عن الرائي للماء في الصلاة وهو متيمم لكان عليه دليل شرعي لم يسلم الخصم أن الطهارة واجبة في كل حال وإن رأى المتيمم الماء فان استدل على وجوب ذلك لعموم الخطاب كان استدلالا بالعموم
باب فيما يعلم بأدلة العقل وما يعلم بأدلة الشرع
اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقط وإما بالشرع فقط وإما بالشرع وبالعقل وأما المعلومة بالعقل فقط فكل ما كان في العقل دليل عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به كالمعرفة بالله وبصفاته وأنه غني لا يفعل القبيح وإنما قلنا إن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بذلك لأنا إنما نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق الأنبياء عليهم السلام وإنما نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا يجوز أن يظهرها الله على يد كذاب وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليه قبيح وأنه لا يفعل القبيح وإنما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم بقبح القبيح عالم باستغنائه عنه والعلم بذلك فرع على المعرفة به فيجب تقدم هذه المعارف للشرع فلم يجز كون الشرع طريقا إليها فأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل فهو كل ما كان في العقل دليل عليه ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به كالعلم بأن الله واحد لا ثاني له في حكمته لأنه إذا ثبتت حكمته فلو كان معه حكيم آخر لم يجز أن يرسلا أو يرسل أحد منهما من يكذب فاذا أخبر الرسول أن الإله واحد لا قديم سواه علمنا صدقه وكذلك وجوب رد الوديعة والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحد
فأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما في السمع دليل عليه دون العقل كالمصالح والمفاسد الشرعية وما له تعلق بهما أما المصالح والمفاسد الشرعية فهي كالأفعال التي تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة نحو كون الصلاة واجبة وشرب الخمر حراما وغير ذلك وإنما قلنا إنه ليس في العقل دليل على ذلك لأنه لو كان في العقل دليل على ذلك لكان ذلك الدليل إما حكما موجبا عن وجوبها أو وجها موجبا لها والحكم الموجب عن وجوبها هو الذم والمدح ومعلوم أنا لا نعلم بالعقل استحقاق من أخر الصوم عن أول يوم من رمضان للذم دون الذي قبله ولا نعلم بالعقول مباينة أول يوم من رمضان لليوم الذي قبله في وجه يقتضي تباينهما في الوجوب سواء وقف ذلك على أمارة مظنونة أو لم يقف على ذلك وقد دخل في ذلك القول بأن العبادات يعرف وجوبها بأمارات من جهة العادات تتعلق بالمنافع والمضار لأن وجوب ما هذه سبيله معلوم وإن تعلق بشرط مظنون ومعلوم أيضا أنا لا نعلم بالعقول في هذه العبادات منافع ودفع مضار عاجله فيقال إنها تجب لأجل ذلك وأما ما له تعلق بالمصالح والمفاسد الشرعية فهي طرق الأحكام الشرعية كالأدلة والأمارات وأسباب هذه الأحكام وعللها وشروطها أما ألأدلة فكون الإجماع حجة وأما الأمارات فكون القياس وخبر الواحد حجتين على قول من قال لا نعلم ذلك بالعقل وأما الأسباب فكون زوال الشمس سببا للصلاة وأما العلل فالكيل الذي هو علة الربا وأما الشروط فضربان أحدهما شروط في أحكام معلومة بالعقل كالشروط التي شرطتها الشريعة في
البياعات لأن وقوع التمليك بالبيع معلوم بالعقل والآخر شروط في أحكام شرعية كستر العورة في الصلاة والطهارة وغير ذلك
وقد فرق بين العلة والسبب بأشياء منها أن العلة لا يجب تكررها والسبب قد يجب تكرره ولهذا كان الإقرار سببا للحد لأنه يتكرر ومنها أن العلة تختص المعلل والسبب لا يختصه كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة ومنها أن السبب يشترك في جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال الشمس يشترك فيه الحائض والطاهر ولا يشتركون في وجوب الصلاة وليس يشتركون في العلة إلا ويشتركون في حكمها
باب في أنه لا يجوز أن يقال للرسول أو العالم احكم فانك لا تحكم إلا
بالصواباعلم أن الناس اختلفوا في جواز ان يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرم ويوجب ويبيح باختياره فمنع أكثر الناس من ذلك على كل حال وأجازه آخرون فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة وذكر ذلك في قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ثم رجع عن هذا القول وأجاز مويس بن عمران أن يقال ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم ولغيره من العلماء وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه جعل ذلك له ولم يقطع عليه بل جوزه وجوز خلافه واحتج قاضي القضاة للمنع من ذلك بان الشرائع إنما يتعبد الله بها لكونها مصالح والإنسان قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد فلو اباح الله تعالى للإنسان الحكم بما يختاره لكان فيه إباحة الحكم بما لا يأمن من كونه فسادا
إن قيل إنه يأمن ذلك لقول الله له إنك لا تحكم إلا بالحق والصواب قيل لا يجوز أن يقول له ذلك لأنه لا يجوز أن يستمر بالمكلف اختيار الصلاح دون الفساد من غير علم بأعيان الصلاح والفساد كما لا يجوز اتفاق الأفعال الكثيرة المحكمة من غير علم وكما لا يجوز أن يتفق من الإنسان الصدق في الأخبار الكثيرة من غير أن يتخللها كذب من غير علم ولو جاز ذلك لخرجت الأخبار عن الغيوب من أن تكون دلالة على نبوتهم ولجاز أن يكلف تصديق نبي دون من ليس بنبي من غير علم ولو جاز اتفاق اختيار الصواب من العالم جاز اتفاقه من العامي فيتعبده الله بالحكم باختياره وليس للمخالف أن يقول إن الأنبياء والعلماء قد أكرمهم الله وخصهم بذلك لأن إمكان اتفاق ذلك لا يفترق فيه العامي والعالم
فان قيل إنما يمتنع اتفاق اختيار الصواب الكثير من غير دلالة فأما القليل فلا يمتنع اتفاق الصواب فيه فيجوز أن يفوض الله تعالى إلى بعض المكلفين الحكم باختياره في الفعل والفعلين والثلاثة قيل قد أجيب عن ذلك بأن الواجب في التكليف أن يكون المكلف عالما بحسن ما يقدم عليه من الأفعال قبل إقدامه وهو لا يعلم ذلك إذا علق الفعل باختياره لأنه كما يجوز أن يختار الصلاح يجوز أن يختار الفساد ولأن حسن اختياره للفعل تابع لحسن الفعل فلم يجز أن يعلم حسنه لعلمه بحسن اختياره له
ولقائل أن يقول إن ما ذكره من أنه لا يجوز استمرار اختيار المصلحة دون المفسدة من غير علم بالمصلحة صحيح إذا كان الفعل مصلحة من دون الاختيار فيمتنع أن يتفق اختيارنا للمصلحة دون المفسدة فأما إذا كان كونه مصلحة هو فعلنا له ونحن مختارون له فليس يبطل بما ذكره لأنه والحال هذه لم يتفق تناول الاختيار لما هو مصلحة في نفسه من دون الاختيار بل المصلحة هو مجموع الفعل والاختيار فلو صح ما ذكره لصح أن يقول من نفى القياس إن الأمارات قد تخطىء وتصيب وليس يتفق فيها الصواب أبدا
فالعامل بحسبها عامل بما لا يأمن كونه مفسدة
فان قلتم إن المصلحة هي علمنا بحسب ما ظنناه من الأمارة وليس كونها مصلحة ينفصل من ذلك إن الأمارة الدالة عليه لا يجب ان تصيب ابدا قيل وليس يقول الله للنبي صلى الله عليه و سلم احكم فانك لا تحكم إلا بالصواب إلا وقد علم أن مصلحته أن يفعل ما يختاره
وأما قوله إن المكلف يجب أن يعلم حسن ما يقدم عليه وهذا المكلف لا يعلم ذلك فالجواب عنه أنه يعلم ذلك لقول الله له إنك لا تحكم بغير الصواب كما يعلم الأنبياء أن ما يقدمون عليه من المعاصي غير كبائر وأما قوله إن حسن الاختيار تابع لحسن الفعل فلا يجوز أن يتبع حسن الفعل الاختيار فالجواب عنه أن حسن الفعل ها هنا غير تابع للاختيار بل هو مصلحة في نفسه بالاختيار وهذا جواب من يجيز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف باختياره في الشيء الواحد والشيئين والثلاثة دون الأشياء الكثيرة
وللخصم أيضا أن يقول ليس يمتنع أن تكون مصلحة الإنسان أن يفعل باختياره كما أن مصلحته في وقت التشديد وفي وقت التسهيل وله ان لا يسلم أن الاختيار لا يحسن إلا أن يكون الفعل حسنا من دونه بل يكون حسنا إذا كان الفعل معه مصلحة
ونحن نرتب الدلالة فنقول إن من أجاز هذا التكليف إما أن يقول إن الاختيار به يتم كون الفعل مصلحة حتى تكون مصلحة الإنسان ما يختاره في الحادثة من فعل أو ترك أو يجعل المصلحة منفصلة عن ذلك ويقول إن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو مصلحة فان قال بالأول اسقط التكليف لأن قول المكلف للمكلف إن شئت أن تفعل فافعل وإن شئت أن لا تفعل فلا تفعل هو محض الاباحة فان قيل بل هو إيجاب أن لا يخلو من الفعل والإخلال به قيل لا يمكن الخلو من ذلك ولا يحسن إيجاب ما لا يمكن
خلافه ولهذا إذا كان العامي مخيرا بين فتوى من أفتاه بالإيجاب ومن أفتاه بالإباحة فقد سقط عنه التكليف وصار الفعل مباحا لأنه إن اختار أن لا يفعله جاز له ذلك وإن قال إن الفعل يكون مصلحة من دون الاختيار فإما أن يخير تكليف الله الإنسان أن يفعل بحسب اختياره أفعالا كثيرة أو أفعالا قليلة فالأول باطل لأنه لا يجوز أن يتفق اختيار الصلاح في الأفعال الكثيرة كما لا يجوز أن يتفق الصدق في الأخبار الكثيرة والأحكام في الأفعال الكثيرة من غير علم فان قيل أليس النبي صلى الله عليه و سلم لا يختار من المعاصي إلا ما يكون صغيرا قيل فمن أين أنه يكثر ذلك منه وما أنكرتم ان الواجب أن يقال إن ما يقع منه قليل وأيضا فلو صادف اختيار العالم المصلحة لم يكن لتكليفه الاجتهاد معنى فان قيل الفائدة فيه أن يكثر ثوابه قيل التكليف لا يحسن لمجرد الثواب فان قيل إذا اجتهد تغيرت المصلحة قيل إن كانت هذه المصلحة مساوية لمصلحته إذا لم ينظر فلا فائدة لتكليف النظر وإن كانت زائدة وجب تكليفه الاجتهاد
وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه إنما يحسن أن يفوض الله تعالى إلى المكلف الحكم باختياره في الأفعال اليسيرة فالذي يفسده ويفسد الوجه الأول أيضا هو أنه إما أن يكون الله تعالى قد أوجب عليه المصلحة من الفعل أو تركه من غير أن يعينه له فيكون قد كلفه ما لا يطيقه وإما أن يكون قد خيره بينه وبين غيره مما ليس بمصلحة فيكون قد خيره بين المصلحة والمفسدة لأنه قد قال له افعل أيهما شئت من الاختيارين والفعلين وهذا تخيير بين المصلحة والمفسدة وذلك باطل
واحتج المخالف بأشياء منها ما احتجوا به على جواز استمرار اختيار الصواب دون الخطأ ومنها ما احتجوا به على جواز ورود التعبد بما ذكروه ومنها ما احتجوا به على ورود التعبد بذلك
أما الأول فقولهم إذا جاز أن يتفق اختيار الأنبياء للصغائر دون الكبائر
وإن لم يكن لهم على عينها دليل جاز اتفاق اختيارهم الصواب دون الخطأ وإن لم يكن لهم على عينه دليل فالجواب ما تقدم
وأما ما استدلوا به على الثاني فمن وجوه
منها قولهم إذا جاز أن يفوض الله إلى المكلف أن يختار واحدة من الكفارات جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره والجواب إن ذلك يلزم من قال إن المصلحة والواجب من الكفارات واحدة فقط وقد جعل إلى المكلف اختيارها لعلم الله سبحانه أنه لا يختار سواها واما من قال إن الكفارات الثلاث تتساوى في الوجوب والمصلحة فلم يقل إنه إذا اختار واحدة منها فقد وقع اختياره على الواجب دون ما ليس بواجب فيلزمه مثله في جميع الأحكام على أن العامي يجوز له ان يختار واحدة من الكفارات فيجب أن يجوز أن يفوض إليه الحكم بما شاء
ومنها قولهم إذا جاز أن يتعبد العامي أن يختار العمل على فتوى أحد الفقيهين ويتعين ذلك باختياره جاز مثله في أصل التعبد فالجواب يقال لهم فينبغي أن يجوز تفويض الحكم بالاختيار إلى العامي وأيضا فان وجوب أخذ العامي بفتوى الفقيه معلوم له لأنه يعلم من دين الإسلام وجوب رجوع من لا معرفة له إلى العلماء فيما ينويه من الشرعيات فاذا اختلف فيه فقيهان وافتاه أحدهما بخلاف ما أفتاه الآخر كانا واجبين عليه على التخيير والقول في ذلك كالقول في الكفارات فإن حرم أحدهما عليه الفعل وأوجبه الآخر كان مخيرا بين فعله وتركه إن تساويا عنده وقد قلنا إن ذلك يرجح إلى الإباحة وإسقاط التكليف إذ لو اختار ترك الفعل جاز له ذلك
ومنها أنه إذا جاز أن يكلف الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد تخطر جاز أن يكلف الإنسان العمل على اختياره وإن كان الإنسان قد يختار الصواب كما يختار الفساد الجواب إن المصلحة أن نعمل بحسب ما ظنناه من الأمارة فالأمارة كالوجه في المصلحة على ما بيناه إلا أنها مميزة للمصلحة من
غيرها فيلزم ما ذكرتم وليس كذلك الاختيار لأنا قد أفسدنا أن يكون وجه المصلحة وأفسدنا أن يكون مميزا لها من المفسدة
ومنها ان الواجب في التكليف أن يجعل للمكلف طريق إلى ما كلف إما على جملة وإما على تفصيل لنا من الخطأ فيما نفعل وإذا قال الله للمكلف احكم فانك لا تحكم إلا بالصواب فقد جعل له طريق مقطوع به على صحة ما يحكم به والجواب أنا قد بينا أنه لا يجوز ان يجعل الله تعالى إليه ذلك لأنه لا يجوز أن يكون اختيار المكلف هو وجه المصلحة ولا يجوز استمرار وقوع اختياره على الصواب والمصلحة وبينا أن الله عز و جل لو قال ذلك لكان قد خيره بين المصلحة والمفسدة
وأما ما استدلوا به على ورود التعبد بذلك فوجوه
منها قول الله عز و جل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فالجواب إن الآية تشهد بأن الطعام كان حلا لبنيه وإسرائيل ليس بداخل في بنيه ويجوز أن يكون حرم على نفسه بالاجتهاد أو بالنذر وأن يكون في شريعتهم إثبات التحريم بالنذر كما ثبت الإيجاب في شريعتنا بالنذر
ومنها أن السنة مضافة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وحقيقة الاضافة تقتضي أنه من قبله والجواب إنه إنما اضيفت إليه لأنها بقوله وجبت وهو السفير فيها ولهذا يضاف إليه جميع السنن ومعلوم أنه ليس جميعها باختياره
ومنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قال في مكة لا يختلي خلاها قال العباس إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه و سلم إلا الإذخر ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال والجواب أنه قد قيل إن الإذخر ليس من الخلا وإنما استثناء العباس
تأكيدا ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد استثناءه فسبق العباس إلى سؤال النبي صلى الله عليه و سلم بذلك
ومنها قول النبي صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت يعني الحج فعلق وجوبه بقوله فالجواب أنه لو قال نعم لوجبت من حيث كان قوله دليلا على وجوبه وليس في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو عن وحي
ومنها قول النبي صلى الله عليه و سلم لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقوله لولا أخشى أن يفرض السواك لاستكت قالوا فبين ان أمره بالسواك موقوف على اختياره فالجواب إنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك على طريق التكليف ولا يمتنع أن يكون الله قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة وأنه أن يكون الله قد اعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة وأنه لا يحصل على صفة المصلحة لأمته إلا إذا فعله عند كل صلاة وإذا لم يفعله عند كل صلاة لم يكن مصلحة
ومنها قولهم إن موسى عليه السلام اثبت الأحكام من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله تعالى عليه فالجواب أنا لا نعلم ذلك ولو علمنا ذلك لم نعلم أن ما عدا التسع الايات لم يوح إليه
ومنها قوله صلى الله عليه و سلم عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق فالجواب أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه لأنه هو الذي يتولى اخذها وهو الذي لم يأخذها الآن وإن كان ذلك بوحي على أن كل هذا أخبار آحاد لا يحتج بها في مثل هذا الموضع
ومنها أن الصحابة لو حكمت في الحوادث عن دلالة لما اضيفت إلى رأيها فالجواب إن الرأي هو القول الصادر عن اجتهاد ونظر في أمارة أو دلالة
مستنبطة وليس هو القول من غير نظر لأن ذلك ليس هو برأي بل هو تنحيت وتشهي
ومنها انهم لو حكموا بدليل لما تركوه لأن الحق لا يترك والجواب إن الأدلة إذا دخلتها الشبهة تركت والأمارات بجواز ذلك اولى على انهم إنما يتركون اقوالهم إذا تغير اجتهادهم لأن الواجب يتغير بحسب تغير اجتهادهم عند من يقول وغن كل مجتهد مصيب فيكون الحق هو القول الثاني دون القول الأول
ومنها أنهم قالوا في حكمهم إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان فلو كان ذلك عن دليل لم يقولوا بذلك فالجواب إنه لو كان ذلك عن اختيار قد ابيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا على أن من يقول إن الحق في واحد يجوز ان يخطئوا فلا سؤال عليه ومن قال إن المجتهد مصيب يقول إنما قالوا وإن كان خطأ فمن الشيطان لخوفهم أن يكون عن النبي صلى الله عليه و سلم نص خلاف حكمهم لم يقع إليهم
ومنها قولهم إنهم لو قالوا عن نظر وقياس لنقلت عنهم التعليلات والاصول والجواب إنه قد نقل عنهم ذلك على ضرب من التنبيه على ما بيناه في القياس
باب في جواز تعبد النبي الثاني بشريعة الأول وفي أن نبينا صلى الله عليه
و سلم لم يكن متعبدا قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم لا هو ولا امتهاعلم أنه لو امتنع أن يتعبد النبي الثاني بشريعة الأول لكان إنما امتنع لوجه معقول ولا وجه لذلك إلا ان يقال إنه يمتنع أن تكون مصلحة النبي الثاني ومصلحة امته مصلحة النبي الأول أو يقال إن مجيء النبي الثاني بشريعة الأول
عبث والأول باطل لأنه كما لا يمتنع في العقل أن تكون مصلحة النبي الثاني مع امته مخالفة الأول كذلك لا يمتنع أن تكون موافقة لمصلحة الأول لا فرق في العقول بين الأمرين واما الثاني فباطل أيضا لأنه لا يمتنع أن يتعبد النبي الثاني بالرجوع إلى دعاء النبي الأول ويوحى إليه بعبادات زائدة او بشروط زائدة على العبادات التي علمها من النبي الأول أو يوحى إليه بشريعة الأول لأنها قد درست أو يوحى إليه بها ويبعث إلى غير من بعث إليه النبي الأول ومع كل هذه الوجوه لا يحصل العبث
فأما كون نبينا صلى الله عليه و سلم متعبدا قبل البعثة بشريعة من تقدمه فقد منع قوم منه وقال به قوم وتوقف فيه آخرون وذكر قاضي القضاة أن الشيخ أبا هشام توقف فيه في بعض المواضع واختلفوا بعد النبوة فقال قوم كان متعبدا بشريعة من قبله إلا ما استثناء الدليل وقال آخرون ما كان متعبدا بذلك واختلف من قال كان متعبدا بذلك قبل النبوة وبعدها فقال قوم كان متعبدا بشريعة إبراهيم وقال آخرون بل بشريعة موسى عليه السلام
والدلالة على انه لم يكن متعبدا قبل النبوة بذلك أنه لو كان متعبدا بذلك لكان يفعل ما تعبد به ولو فعل ذلك لكان يخالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى وغيرهم فيفعل فعلهم وقد نقلت أفعاله قبل الشريعة والبعثة وعرفت أحواله ولم ينقل أنه كان يفعل ما كانت النصارى تفعله ولا يخالطهم أو يخالط غيرهم ويسألهم عن شرعهم
واحتج المخالف بأنه قد كان قبل البعثة يحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويزكي ويأكل اللحم ويركب البهائم ويحمل عليها وكل ذلك لا يحسن إلا شرعا فالجواب إنه لو يثبت أنه حج واعتمر قبل البعثة وتولى التزكية بنفسه ولا أمر بها واما اكل اللحم المزكى فحسن في العقل لأنه ليس فيه ضرر على احد وفيه منفعة للآكل وأما ركوب البهائم والحمل عليها فحسن في العقل عند الشيخ أبي هاشم لأنه ضرر يؤدي إلى نفع أعظم
منه وهو القيام بمصالحها وإيصال النفع إليها واما الطواف بالبيت فيحتمل أن يكون إنما فعله ليتشاغل كما يتشاغل الإنسان بالمشي ويستروح إليه إذا كان مفكرا وعلى أنه ليس يجب أن يكون فعله لذلك كثيرا حتى يمتنع عليه واما تعظيمه للبيت فيحتمل أن يكون عظمه لأن إبراهيم عليه السلام عظمه والعقل يقتضي حسن تعظيم أماكن الأنبياء وتمييزها وتعظيم ما عظموه ما لم يثبت نسخه
وأما الدلالة على انه ما كان متعبدا من قبله بعد البعثة هي أن القائل كان متعبدا بذلك لا يخلو إما أن يريد أن الله تعالى أوحى إليه بلزوم العبادات التي تعبد بها من قبله وأوحى إليها بصفاتها فلا يرجع في كلا الأمرين إلى النقل عمن تقدم أو يقول إنه يرجع في وجوب شرع من تقدم وفي صفاته إلى النقل كما نفعله نحن في شرعه أو يقول إنه أوحى إليه بوجوب العبادات التي هي شرع من تقدم وأمر بالرجوع إلى النقل عمن تقدم في معرفة صفاتها فهو يرجع في وجوبها إلى الوحي في صفاتها إلى النقل أو يقول إنه يرجع في وجوبها إلى النقل المتواتر وفي معرفة صفاتها إلى الوحي المنزل عليه فان أراد الأول فلا يخلو أن يقول إن جميع ما أوحي إليه هو شرع نبي تقدم إما موسى وإما غيره أو يقول إن بعض ما أوحى إليه هو شرع نبي تقدم والأول باطل لأن كثيرا من شرعه لا يوافق شرع موسى والمسيح وغيرهما وإن اراد الثاني لم نأباه ولا يجوز أن يقال لأجل ما وقع الاتفاق فيه إنه متعبد فيه بشرع من تقدمه لأنه إنما علمه بالوحي فاضافة ذلك إلى الوحي المنزل عليه أولى وأما الوجوه الثلاثة فباطلة من وجوه
منها أنه صلى الله عليه و سلم كان ينتظر الوحي عند الحوادث كالظهار واللعان والإفك وغير ذلك ولا يسأل عن التوراة فلو كان متعبدا بالرجوع إليها أو إلى غيرها في معرفة العبادات وفي معرفة صفاتها لرجع إليها فان قيل إنما لم يرجع إليها في معرفة هذه الأحكام وغيرها لأنها مستثناة مما تعبد فيه بالرجوع إليها فكأنه تعبد بالرجوع إلى التوراة إلا في هذه الأحكام قيل إنه لم يرجع
إليها إلا في الرجم فكانه ما تعبد بالرجوع إليها إلا في ذلك فقط وهذا رجوع إلى ما قلناه من أنه لم يكن متعبدا بالتوراة في الأصل ويبقى الخلاف في الرجم وسنبين أنه لم يرجع إليها ليستفيد الحكم منها ولو ثبت أنه أراد الاستفادة للحكم منها لوجب أن لا يكون متعبدا بالرجوع إلى التوراة إلا في الرجم فقط وأيضا فان السلف لم يرجعوا في شيء من الحوادث إلى نقل أهل الملل ولم يسألوهم عن شرعهم فيها ولو كانوا متعبدين بذلك لجرت كتب الأنبياء المتقدمين مجرى القرآن والسنة في وجوب الرجوع إليها فان قيل إنما كانوا متعبدين بما تواتر من شرع من تقدم دون ما نقل بالآحاد لأن نقل الواحد والاثنين من الكفار لا يجوز العمل به ولم يفحصوا عن شرعهم لأن ما تواتر نقله يبلغهم من غير فحص قيل ليس كذلك لأن كثيرا مما تواتر نقله لا يعرفه إلا من خالط النقلة وفحص عن نقلهم ألا ترى أن كثيرا من فتاوى السلف وما شجر بينهم يعرف بالنقل المتواتر ولا يعرفه من لم يخالط النقلة وأيضا فالنبي صلى الله عليه و سلم لما قال له معاذ أحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وقال من بعد أجتهد رأيي صوبه ولم يعرفه أنه يجب عليه الحكم بما في التوارة والإنجيل فان قيل فقد دخلت التوراة في قوله أحكم بكتاب الله قيل إن إطلاق قوله كتاب الله لا يعقل منه في الشريعة إلا القرآن ألا ترى أنه المفهوم من قوله قرأت كتاب الله ورأينا كتاب الله وحكمنا بكتاب الله دليل وأيضا لو كان صلى الله عليه و سلم مخاطبا بشرع من سلف لم يخل إما أن يكون مخاطبا بشرع موسى أو المسيح أو شرع من تقدمهما ولا يجوز كونه مخاطبا بشرع موسى لأنه كان منسوخا بشرع المسيح ولا يجوز أن يكون مستعملا لشرع المسيح لأنه ليس احد من الأمة قال بذلك لأن الأمة على ثلاثة أقاويل منهم من قال لم يكن متعبدا بشرائع من سلف ومنهم من قال إنما تعبد بشرع موسى عليه السلام ولهذا يرجع إلى التوراة ومنهم قال إنه تعبد بشرائع من سلف إلا ما منع منه الدليل دليل آخر لو كان متعبدا بشرع من سلف لم ينسب جميع شرعه إليه كما لا ينسب شرعه إلى بعض أمته لما كانت أمته
استفادت منه شرعه صلى الله عليه و سلم
واحتج المخالف بأشياء
منها قول الله عز و جل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قالوا وشرعه من هداهم فوجب عليه اتباعه فالجواب إن الله عز و جل أمره باتباع هدى مضاف إلى جماعتهم والهدى المضاف إلى جماعتهم هو العدل والتوحيد دون الشرائع التي لم يجتمعوا عليها
ومنها قول الله عز و جل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الآية قالوا فبين أنها منزلة ليحكم بها نبينا صلى الله عليه و سلم إذا هو من جملة النبيين عليهم السلام فالجواب أن ظاهر ذلك يقتضي أن يحكم بها كل النبيين وذلك يوجب حمله على الحكم بالتوحيد والعدل ليدخل جميع النبيين فيه فنحن إذا حملنا الآية على ذلك أمكننا أن يكون المراد جميع النبيين وإذا حملوه على الحكم بالشرائع لم يمكن دخول جميع النبيين فيه لأن بعضهم قد نسخ بعض ما في التوراة فاذا كنا تاركين لأحد ظاهري الآية وهو الحكم بجميعها ومتمسكين بالظاهر الآخر وهو حكم جميع النبيين والمستدل بالآية كذلك يفعل ساويناه وسقط استدلاله
ومنها قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية والجواب إنه عز و جل لم يقل إنه أوحي إليه بما اوحى إلى نوح والنبيين من بعده وإنما قال إنه أوحي إليه كما أوحى إلى غيره ليزيل تعجب من تعجب بأن يوحي الله عز و جل إليه كما أن الإنسان إذا قال لغيره كيف راسلني بك فقال كما راسلك بفلان وفلان لم يفد ذلك أنه راسله بما راسله على لسان فلان وفلان يبين ذلك أنه قال في آخر الكلام
وكلم الله موسى تكليما فبين أن إرساله الرسل غير منكر ولا مستطرف على أنه لو دلت الآية على أنه أوحى إليه بما أوحى إلى غيره لدل ذلك على أنه تعبد بشرائع من قبله بأمر مبتدأ
ومنها قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالجواب إن اسم الملة لا يقع إلا على الاصول من التوحيد والعدل والإخلاص لله بالعبادة دون الفروع لأنه لا يقال ملة أبي حنيفة وملة الشافعي ويراد مذهبهما ولا يقال ملتهما مختلفة ولهذا قال تعالى وما كان من المشركين فعلمنا أنه أراد بالملة أصل الدين ولأن شريعة إبراهيم قد كان انقطع نقلها ولا يجوز أن يحثه الله عز و جل على اتباع ما لا سبيل إليه
ومنها قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية فالجواب إن اسم الدين يقع على الاصول دون الفروع ولهذا لا يقال دين الشافعي ويراد به مذهبه ولا يقال دينه ودين أبي حنيفة مختلف على أن قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا دلالة على أن الذي شرعه لنا مما وصى به نوحا هو ترك التفرق وأن نتمسك بما شرع ولو دلت الآية على أنه صلى الله عليه و سلم تعبد بشرع من قبله لدلت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ
ومنها أن النبي صلى الله عليه و سلم رجع إلى التوراة في رجم اليهوديين يقال لهم ولم قلتم إنه رجع إليها ليستفيد الحكم منها وهلا قلتم إنه رجع إليها ليقررهم على صدقه في حكايته أن الرجم مذكور فيها ولو رجع ليستفيد الحكم منها لرجع إليها في غير ذلك من الأحكام ولرجع إليها في شرائط الرجم كالإحصان وغيره ولما اعتمد على من أخبره في تلك الحال لأنهم لم يكونوا
بصورة المتواترين وأخبار آحاد الكفار غير معلوم بها وأيضا فكون التوراة محرفة يمنع من الرجوع إليها ومن استفادة الحكم منها
باب في ذكر فصول كيفية الاستدلال على الأحكام
اعلم أن الاستدلال على الأحكام ضربان استدلال بدليل شرعي كالخطاب والأفعال والقياس واستدلال بالبقاء على حكم العقل وكلاهما يفتقران إلى المعرفة بحكمة المكلف ويفتقر الاستدلال بالخطاب إلى معرفة ما يفيده الخطاب وقد تقدم بيان فوائد الخطابفالاستدلال بالأدلة يختلف بحسب تجردها عن قرينة وبحسب اقتران القرائن بها والخطاب من الأدلة منه مشترك بين حقيقتين ومنه غير مشترك وحقيقة الخطاب قد تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية والقرائن قد تعدل بالخطاب عن ظاهره وقد تكون مكملة لظاهره وينبغي أن نذكر صفة المكلف التي يمكن معها الاستدلال على الأحكام ونذكر كيفية التوصل إلى الأحكام في الجملة ونذكر الخطاب الذي ليس بمشترك وهو متجرد وكيف يستدل به على حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية ونذكر كيفية الاستدلال مع القياس المكمل ونذكر كيفية الاستدلال بالخطاب الذي ليس بمشترك على مجازه إذا اقترنت به القرائن ونذكر كيفية الاستدلال بالخطاب المشترك إذا اقترنت بها القرائن وإذا لم تقترن به ونذكر ما يشبه بالقرائن مما ليس بقرينة على الحقيقة ونذكر من الذي يجب أن يبين له مدلول الخطاب حتى نحمله على ظاهره
باب في صفة المكلف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام الشرعية وفي
كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعيةاعلم أن صفة المكلف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام هي كونه عالما بقبح القبيح وبوجوب الواجب وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب فمتى علم المستدل ذلك علم أنه لا يجوز أن لا يعرفنا البارىء عز و جل مصالحنا ومفاسدنا لأن تعريف الألطاف واجب والحكيم لا يخل بواجب ويعلم أيضا انه لا يجوز ان يدلنا ويخاطبنا بما يفيد في المواضعة شيئا ما إلا وهو عالم بان ما يفيده الخطاب على ما يفيده إما أن يفيده بمجرده أو بقرينة لأنه لو لم يعلم ذلك لكان قد لبس علينا ودلنا على خلاف الحق وذلك قبيح
أما التوصل إلى الأحكام الشرعية فهو أن المجتهد إذا أراد معرفة حكم الحادثة فيجب أن ينظر ما حكمها في العقل ثم ينظر هل يجوز أن يتغير حكم العقل فيها وهل في أدلة الشرع ما يقتضي تقدم ذلك الحكم أم لا فإن لم يجد ما ينقله عن العقل قضي به والشرط في ذلك هو علمه بانه لو كانت المصلحة قد تغيرت عما يقتضيه العقل لما جاز أن لا يدلنا الله تعالى على ذلك فإن وجد في الشرع ما يدل على نقله قضي بانتقاله لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط أن لا ينقلنا عنه دليل شرعي
والدلالة الشرعية ضربان خطاب وغير خطاب وهو الأفعال والقياس والاستنباط والشرط في الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه و سلم هو علمنا بأنه صلى الله عليه و سلم لا يفعل على وجه العبادة ما ليس بطاعة وان نعلم أن ما هو واجب عليه أو ندب منه فهو واجب علينا أو ندب منا إلا أن يدل دليل على خلافه والشرط في الاستدلال بالقياس هو أن نعلم أنا متعبدون به وأن حكمة الله
تقتضي أنا ما تعبدنا به إلا وذلك مصلحتنا
وأما الأدلة التي هي الخطاب فهو خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه و سلم وخطاب الأمة وقد يستدل على الحكم بالخطاب وبالإمساك عن الخطاب وعن غيره من الأدلة والشرط في الإستدلال بخطاب الله أن نعلم ما يفيده الخطاب بمجرده وما يفيده مع قرينة وأن الله تعالى لا يجرد خطابا يفيد في المواضعة شيئا ما إلا وقد علم أن فائدته على ما أفاده الخطاب إما بمجرده وإما مع قرينة والشرط في الاستدلال بإمساكه عن أن يدلنا على الحكم أن نعلم أنه لو كان الحكم حاصلا لدلنا على حصوله والشرط في الاستدلال بخطاب النبي صلى الله عليه و سلم هو أن نعلم فائدة الخطاب ونعلم أن الله سبحانه لا يبعث من يخبر بالكذب ولا ينهي عن حسن ولا يأمر بقبيح والشرط في الاستدلال بتركه أن يؤدي إلينا العبادة هو علمنا أنه مع حكمته لا يجوز أن يبعث من يعلم أنه يخفي عنا مصالحنا والشرط في الاستدلال بالإجماع هو أن نعلم أن الله عز و جل أو رسوله قد شهد أنهم لا يجمعون على خطأ
باب في كيفية الاستدلال بالخطاب المجرد على حقائقه اللغوية والعرفية
والشرعيةاعلم أن الخطاب إذا كان يستعمل في شيء على سبيل الحقيقة ويستعمل في شيء آخر على سبيل المجاز وتجرد عن قرينة فالواجب حمله على حقيقته دون المجاز لأن الغرض به الإفهام والمخاطب إنما يفهم من الخطاب حقيقته ويحتاج إلى قرينة لفهم مجازه فلو كلفه الله تعالى أن يفهم منه المجاز من غير قرينة لم يكن قد جعل له السبيل إلى ما كلفه
وحقيقة الخطاب ضربان أحدهما حقيقة أصلية وهي اللغوية والأخرى طارئة وهي ضربان إحداهما طارئة بمواضعة عرفية والأخرى بمواضعة
شرعية فمتى كان الخطاب مستعملا في شيء من جهة اللغة ومستعملا في غيره من جهة العرف ولم يخرج بالعرف من أن يكون حقيقة فيما كان مستعملا فيه من جهة اللغة بل كان حقيقة في المعنى اللغوي وفي المعنى العرفي فلا يكون أحدهما إلى الفهم أسبق عند سماع الخطاب فهو مشترك بينهما وسيجيء القول في الاسم المشترك لأنه هو المفهوم من الخطاب فجرى مجرى المجاز
والحقيقة اللغوية ونظير ذلك اسم الغائط كان حقيقة في المكان المطمئن من الأرض ثم صار في العرف حقيقة في قضاء الحاجة ومجازا في المكان المطمئن وإذا استعمل الخطاب في العرف أو اللغة في شيء واستعمل في الشرع في شيء آخر وكان حقيقة في الشرعي واللغوي أو العرفي فهو مشترك بينهما وإن كان مجازا في العرفي أو في اللغوي وجب حمله على الشرعي لأنه المفهوم عند سماع الخطاب وذلك اسم الصلاة كان حقيقة في الدعاء ثم صار مجازا فيه حقيقة في الصلاة الشرعية لا يفهم من إطلاقه سواها فصار حمل الخطاب على معناه الشرعي أولى من حمله على العرفي ثم على الحقيقة اللغوية وحمله على الحقيقة اللغوية أولى من حمله على مجازها فإذا تعذر ذلك حمل على مجازها فإن خطاب الله طائفتين بخطاب هو حقيقة عند إحداهما في شيء وعند الأخرى في شيء آخر فإنه ينبغي أن يحمله كل واحدة من الطائفتين على ما تتعارفه لأنه السابق إلى إفهامنا فلو أراد أحد المعنيين من كلا الطائفتين لدل الطائفة التي لا تعرف ذلك المعنى على أنه قد أراده
فإن قيل فما قولكم لو حرم الله علينا أن نسمي الدعاء صلاة وأوجب أن نسمي الصلاة الشرعية بذلك وعصينا في ذلك ولم نتعارف من اسم الصلاة إلا الدعاء ثم قال لنا أقيموا الصلاة على ماذا كان ينبغي لنا أن نحمله عليه قيل إن كان قد أخبرنا أنه لا يستعمل هذا الاسم إلا في الصلاة الشرعية فإنه يريد به الشرعية وإن لم يخبرنا بذلك فإنه لا يريد به إلا الدعاء لأنه المفهوم عندنا وليس يجب إذا قبح منا استعمال هذا الاسم في الدعاء أن يقبح من الله تعالى ذلك
باب في كيفية الاستدلال بالخطاب مع القرائن المكملة لظاهره
اعلم أن هذه القرائن منها ما ترجع إلى حال المخاطب ومنها ما لا ترجع إلى حاله فالأول كاستدلالنا بكلام النبي صلى الله عليه و سلم وبكونه منتصبا لتعليم الشرع على انه عنى بخطابه حكما شرعيا وهذا إذا كان خطابه مترددا بين حكم شرعي وعقلي لأنه منتصب لتعليم الشرع فأما إذا كان ظاهر خطابه يفيد حكما عقليا ومجازه يفيد الشرعي فالواجب حمله على ظاهره لأنا إنما نرجح حمله على الشرعي بكون النبي صلى الله عليه و سلم منتصبا لتعليم الشرع وذلك إنما يتم مع تردد خطابه بين الشرعي والعقلي على سواء فأما إذا كان ظاهره مع احدهما فلا ترجيح وكذلك إذا تردد خطابه بين تعليم اسم لغوي وشرعي فإنه يجب حمله على تعليم الاسم الشرعي لأن اللغوي يعرف من دونه صلى الله عليه و سلمواعلم أن كل خطاب فإنه لا بد في الاستدلال به من اعتبار حال المتكلم به ألا ترى أنا نعتبر حكمته وإنما أردنا الأحوال التي لها نعدل بالخطاب من معنى إلى معنى مع كونه مترددا بينهما
وأما القرينة التي ليست بحال المتكلم فضربان أحدهما أن تكون القرينة خطابا آخر والآخر أن تكون القرينة تعلقا بين ما تناوله الخطاب وبين ما لم يتناوله
أما الضرب الأول فأشياء
منها أن يكون أحد الخطابين يدل على أن الشيء صفة والآخر يدل على اختصاص تلك الصفة بحكم من الأحكام فنعلم أن ذلك الشيء يختص بذلك الحكم وذلك مثل قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وذلك يدل على أن القرآن ذكر وقوله تعالى ما يأتيهم من
ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يدل على حدث الذكر فوجب من كلا الاثنين كون القرآن محدثا
ومنها ما يدل الخطاب على اختصاص حكم بشيئين ويدل خطاب آخر على أن أحد الشيئين يختص ببعض ذلك الحكم فنعلم أن الشيء الآخر يختص ببقية ذلك الحكم كقول الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يدل على أن مدة الحمل ومدة الرضاع ثلاثون شهرا ودل قوله وفصاله في عامين على أن الحمل يكون ستة أشهر لأن الفصال يكون في عامين
ومنها أن يكون أحد الخطابين طريقا إلى أن لشيء من الأشياء حكما وأنه ليس لغيره ويدل خطاب على أن ذلك الحكم المذكور لبعض الأشياء فنعلم أنه هو الأول أو جزء منه نحو قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يدل على أن ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان لعلمنا أن كثيرا منه قد نزل في غير شهر رمضان وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يدل على أن ابتداء نزوله في ليلة القدر وذلك لا يكون إلا وليلة القدر هي جزء من هر رمضان وهذا إنما يصح متى ثبت بالإجماع أن قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يفيد أن ابتداء نزوله في ليلة القدر
فأما إذا كانت القرينة تعلقا بين فائدة الخطاب وبين غيره فضربان أحدهما أن يكون بينهما تعلق التعليل وهذا هو القياس وقد تقدم القول فيه والآخر لا يكون تعلق التعليل إلا أنه لا يثبت أحدهما إلا مع الآخر وهو ضربان احدهما هذا حكمه لمكان الإجماع وإن لم يعلم التعلق بينهما والآخر هذا حكمه لأنه لا يمكن انفكاك كل واحد منهما من صاحبه أما الأول فمثاله أن
يدل الظاهر على ان الخال يرث وتجمع الأمة على أن الخالة بمثابته في إثبات الإرث ونفيه فنحكم بذلك وإن لم نعرف وجه التعلق بينهما وأما الثاني فضربان أحدهما ان يكون ذلك المعنى وصلة إلى فائدة الآية كالأمر بالطهارة يقتضي وجوب استيفاء الماء والآخر أن لا يكون وصلة إليه وهو ضربان أحدهما أن يكون الحكم إباحة فيعلم إباحة ما لا يتم الفعل المباح إلا معه والآخر أن يكون الحكم وجوبا فيعلم وجوب ما لا يتم الواجب إلا معه فالأول قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الله الأكل والجماع إلى الفجر وليس يمكن إباحة الوطيء إلى الفجر إلا والغسل واقع بعد الفجر فدل على إباحة تأخره عن الفجر وأما إذا كان الحكم إيجابا فمثاله ايجاب ستر جميع الفخذ لا يمكن إلا بستر جزء من الركبة فدل على وجوب ستر جزء من الركبة
باب في كيفية حمل خطاب الحكيم على غير ظاهره إذا اقترنت به القرائن
اعلم ان خطاب الله وخطاب رسوله لا بد من أن يفيد أشياء ولا يخلو إما أن يكون محتملا لأكثر من حقيقة واحدة فيكون مشتركا بينهما وإما أن لا يحتمل أكثر من حقيقة واحدة وهذا القسم إما أن يكون عاما أو خاصا فان كان خاصا فاما أن يتجرد عن قرينة أو لا يتجرد عن قرينة فان تجرد عن قرينة حمل الخطاب على ظاهره وإن لم يتجرد عنها فإما أن تدل القرينة على أن المراد ليس هو ظاهره أو تدل على ان المراد هو ظاهره أو تدل على ان المراد ظاهر الخطاب وغير ظاهره فإن دلت على أن المراد ليس هو ظاهره خرج ظاهره من أن يكون مرادا ولا يخلو ذلك الخطاب إما أن يكون متجوزا به في غير ظاهره أو غير متجوز به في غير ظاهره فان لم يكن متجوزا به في غير ظاهره على تعذر ذلك وجب أن يقترن به قرينة تدل على المراد لأن الخطاب ليس يتناول غير ظاهره فيحمل عليه وإن كان قد تجوز به في غير ظاهره لم يخل وجه المجاز الذي يستعمل الخطاب فيه إما أن يكون واحدا أو أكثر من واحد فان كان واحدا حمل اللفظ عليه من غير افتقار إلى دلالة زائدة لأن الحكيم إذا خلا خطابه من قرينة تدل على أنه أراد غير فائدته اللغوية فلا بد من أن يريد ما يعنيه به أهل اللغة فان لم يعن به الحقيقة فليس إلا المجاز وإن كان وجه المجاز الذي يستعمل فيه الخطاب أكثر من واحد لم يخل من أن تدل دلالة مبتدأة على المراد بعينه أو لا تدل دلالة على ذلك فان دلت دلالة مبتدأة على المراد بعينه لم تخل وجوه المجاز إما أن تكون محصورة أو غير محصورة فان لم تكن محصورة فلا بد من أن تدل دلالة على ما أريد منها
هكذا ذكر قاضي القضاة قال لأنه لا يجوز أن يريدها المخاطب كلها مع تعذر حصرها علينا ويمكن أن يقال إنه أرادها كلها على البدل لأن ذلك يمكن مع فقد الحصر ومع فقد دلالة على التعيين ولا يمكن سواه يبين ذلك أنه يحسن أن نؤمر بذبح بقرة فنكون مخيرين في ذبح أي بقرة شئنا وإن لم يمكنا حصر البقر فبان أن التخيير يمكن مع فقد الحصر
فأما من لم يجز أن يراد بالكلمة الواحدة المعنيان المختلفان فانه يجيء على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على المراد بعينه لأن اللفظة ما وضعت للتخيير فان كانت وجوه المجاز محصورة فانه لا يخلو إما أن تكون متساوية في القرب من الحقيقة وقوة الشبه بها أو لا تكون متساوية في ذلك فان كان بعضها أشبه بالحقيقة من بعض حمل اللفظ عليه لأن أسبق إلى الإفهام لقوة شبهه ويخرج الباقي من أن يكون مرادا كما أن الخطاب إذا حمل على حقيقته لم يحمل على مجازه إلا بدليل وهذا يتم على قول الفريقين وإن كانت وجوه المجاز متساوية
لم يخل إما أن تدل دلالة على أن بعضها غير مراد أو لا تدل دلالة على ذلك فان لم تدل دلالة على ذلك حمل اللفظ عليها لأنه ليس بعضها لحمل الخطاب عليه أولى من بعض فلو أراد الحكيم بعضها لدل عليه فاذا حمل الخطاب عليه فان كانت غير متنافية وأمكن أن يراد بالكلمة الواحدة حمل الخطاب عليها أجمع وإن لم يمكن أن يراد بالكلمة الواحدة معا حمل عليها على البدل والأولى أن يقال على مذهب هؤلاء إنه ينبغي أن الخطاب عليها على البدل وإن أمكن الجميع بينهما لأن الخطاب ليس بعام فيتناول الجميع
ومثال المعاني التي تتنافى أن تراد بالكلمة الواحدة قول القائل لغيره افعل إذا دلت الدلالة على أنه غير امر فانه يصح أن يكون إباحة ويصح أن يكون تهديدا واستعماله في كل واحد منهما مجاز ولا يجوز أن يستعمل فيهما على الجمع مع أنه متناول لفعل واحد فأما من يمنع أن يراد المعنيان بالعبارة الواحدة فانه يقول لا بد في تساوي وجوه المجاز من أن يكون مراد المتكلم واحدا منهما ولا بد من أن يدل على مراده منها فأما إن دلت الدلالة على أن بعض وجوه المجاز لم يرد فانه يجب حمل الخطاب على الوجه الآخر إن لم يبق إلا وجه واحد وإن بقي أكثر من وجه واحد حمل عليها إما على الجمع وإما على البدل على قول من أجاز ذلك ومن لم يجز ذلك يقول لا بد من قرينة فان دلت الدلالة على أن غير الظاهر مراد فلا يخلو إما أن تعينه أو لا تعينه فان لم تعينه فالقول فيه كالقول في القرينة الدالة على أن المراد ليس هو الظاهر وإن عينته وجب حمله على ذلك المعين
وقال قاضي القضاة في الدرس إنه لا تخرج الحقيقة من أن تكون مرادة لأنه لا يتنافى أن تكون مرادة مع أن غيرها مراد إلا أن تدل دلالة على أن المراد شيء غير الظاهر فيخرج الظاهر من كونه مرادا لأن قولنا إن المراد هو غير الظاهر أوجب أن جميع المراد هو غير الظاهر فأما إن دلت الدلالة على أن ظاهر الخطاب مراد وغير ظاهره أيضا مراد فان عينت ذلك الغير
وجب حمله عليهما فيكون الخطاب مستعملا فيهما من جهة اللغة على قول من اجاز ذلك في اللغة ومن منع ذلك في اللغة يقول إن الشريعة قد وضعت تلك الملة لهما أو يقول إن المتكلم تكلم بتلك الكلمة مرتين اراد في إحداهما ظاهر الخطاب وأراد في المرة الأخرى غير ظاهره وإن لم تعين القرينة ذلك الغير فالكلام في ذلك الغير كالكلام إذا دلت الدلالة على أن المراد ليس هو الظاهر ولم تعينه
فهذا هو الكلام في الخطاب الخاص فأما إن كان الخطاب عاما فانه إن تجرد عن قرينة حمل على عمومه وإن لم يتجرد فلا يخلو إما أن تدل القرينة على أن المراد هو ظاهره وغير ظاهره أو تدل على أن المراد غير ظاهره أو ليس هو ظاهره أو تدل على أنه قد أريد بعضه أو تدل على أن بعضه ليس بمراد فان دلت على أن المراد ظاهره وغير ظاهره حمل على ظاهره وعلى غير ظاهره إن كانت الدلالة قد عينته على ما تقدم تفصيله على قول الفريقين وإن لم تعينه فالقول فيه كالقول في الخاص إذا دلت الدلالة على أن المراد غير ظاهره ولم تعينه وإن دلت الدلالة على أن المراد به ليس هو ظاهره أو أن المراد غير ظاهره ولم تعينه لم يجز تجرد هذه القرينة لأنه إذا لم يكن المراد ظاهره جاز أن يكون المراد هو بعض ما تناوله الخطاب وجاز أن يكون المراد شيئا لم يتناوله الخطاب فاذا انقسم إليهما ولم يصح اجتماعهما احتجنا إلى دلالة تعين المراد ويمكن أن تدل الدلالة في العام على أن بعضه مراد ومتى دلت الدلالة على ذلك لم يخرج البعض الآخر أن يكون مرادا لأنه لا يتنافى ذلك فان دلت الدلالة على أن المراد هو البعض خرج البعض الآخر من كونه مرادا لأن ذلك إخبار بأن كمال المراد هو البعض فان دلت الدلالة على أن بعض العموم ليس بمراد خرج ذلك من كونه مرادا وبقي ما عداه تحت الخطاب والله أعلم
باب في كيفية الاستدلال بالخطاب المشترك
اعلم أن الخطاب إذا كان مشتركا بين حقيقتين فان من يمنع من إرادتهما يمنع من تجرد هذا الخطاب عن دلالة تدل على المراد ويقول إن دلت الدلالة على أنه قد أريد به وجب القول بأنه قد تكلم به مرتين أو يقول إن الشرع قد وضع الاسم لمجموعهما ومن لا يمنع من ذلك يجيز أن يتجرد عن قرينة ويقول إذا تجرد عن قرينة وجب أن يحمل الخطاب على المعنيين على البدل إن كان اللفظ واحدا نحو أن يقول القائل للمرأة اعتدي بقرء وإن كان اللفظ لفظ جمع وجب أن يحمل عليهما على الجمع إن لم يتنافيا وعلى البدل إن تنافيا وذكر قاضي القضاة أنه لو تجرد قول الله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لأوجبنا على المعتدة أن تعتد بثلاثة قروء بعضها طهر وبعضها حيض لأن اللفظ يفيدهما فليس بأن يحمل على أحدهما أولى من الآخرولقائل أن يقول هلا أوجب عليها الاعتداء بثلاثة يقع عليها اسم أقراء سواء كان بعضها طهرا وبعضها حيضا أو كلها طهرا أو كلها حيضا لأن ذلك يجري مجرى قولنا رجال يفيد جمعا من الرجال أي جمع كان فأما إذا اقترن بهذا الخطاب قرينة دلت على أن أحد المعنيين غير مراد تعين بأن الآخر مراد وإن دلت على أن أحدهما مراد قضي به
وذكر في العمد أن يخرج الآخر من أن يكون مرادا وهو الصحيح لأن الاسم المشترك الأصل فيه أن يحمل على أحد معنييه لأنه لا يفيده على الجمع وإنما يحمل عليهما إذا لم تقترن قرينة تخص أحدهما وبهذا فارق لفظ العموم
وذكر في الدرس أن قيام الدلالة على أن أحدهما مراد لا يمنع من كون الآخر مرادا فان دلت الدلالة على أن ليس واحد منهما مرادا كان القول فيه كالقول فيما لا يحتمل إلا حقيقة واحدة إذا دلت الدلالة على أنه ليس بمراد ظاهره وكذلك إذا دلت الدلالة على أن المراد غيرها ولم تعينه أو دلت على أن المراد كلا الحقيقتين وغيرهما فلم تعين ذلك الغير أو عينته
والقول في الخطاب العرفي والشرعي كالقول فيما ذكرناه من القسمة فيما يتجرد ولا يتجرد وأكثر هذه الأقسام إنما تتفرع على قول من قال إنه يراد بالكلمة الواحدة الحقيقة والمجاز والحقيقتان فأما من أبى ذلك فانه يقول إن كان الخطاب لا يحتمل وكان خاصا ودلت الدلالة على أن المراد ليس ظاهره أو هو غير ظاهره وكان لا يستعمل إلا في وجه واحد من وجوه المجاز فانه يحمل عليه ويخرج الحقيقة من أن تكون مرادة وإن كان يستعمل في أكثر من وجه واحد من وجوه المجاز وجب أن يكون المراد واحدا منهما ولا بد من أن تدل دلالة عليه بعينه وكذلك إن كان اللفظ عاما ودلت الدلالة على أن المراد ليس شيئا مما تناوله اللفظ فانه لا بد من أن تدل عليه بعينه ولا يجوز أن تدل دلالة على أن المراد هو ظاهره وغير ظاهره لأن الكلمة الواحدة لا يراد بها الحقيقة والمجاز وإن كانت اللفظة محتملة لحقيقتين فلا بد من أن يراد إحداهما أو واحدة مما هي مجاز فيه وأي ذلك أريد فلا بد فيه من دلالة وإن دلت الدلالة على أنهما قد أريدا أو أحدهما معما هي مجاز فيه وجب أن يكون المتكلم قد تكلم بها مرتين أو يكون الاسم قد وضع لهما في الشرع
باب في أن ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يدل على أنه قد
أريد المجاز بالخطاباختلف الناس في ذلك فقال الشيخ أبو عبد الله وحكاه عن أبي الحسن إنه يحكم بذلك قالاه في قول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا
ماء إن قيام الدلالة على وجوب التيمم على المجامع وهو الذي يتناوله اسم الملامسة على طريق الكناية يدل على أنه مراد بالآية وقال الشيخ أبو عبد الله إن الخطاب إذا علق على حكم من الأحكام على صفة من الصفات ودل الدليل على ثبوت ذلك الحكم مع فقد تلك الصفة فانه يعلم بذلك أنه مراد بالخطاب نحو قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فلما أجمع المسلمون على أن السارق إذا تاب يقطع لا على جهة النكال علمنا أنه مراد بالآية وعند قاضي القضاة أنه لا يعلم ذلك في كلا المثالين إلا بدليل زائد ودليله هو أن الخطاب واجب حمله على ظاهره دون مجازه إلا بدلالة وليس في ثبوت حكم الخطاب في مجازه دلالة على أنه قد أريد ذلك المجاز بذلك الخطاب لأنه يجوز أن يكون قد أراد ذلك بدليل آخر
فان قالوا إنا علمنا ذلك لأن الأمة إذا أجمعت على ثبوت حكم الآية في المجاز وكانت لا تجمع إلا عن دلالة ولم يكن في الشرع ما يجوز أن يدل على ذلك الحكم إلا ذلك الخطاب علمنا أنها ما أجمعت على ذلك إلا بالآية وإلا كانت قد أجمعت لغير دلالة قيل هذا حجة عليكم لأن الخطاب لا يكون حجة فيما هو مجاز فيه إذا تجرد فلو أجمعوا على ثبوت الحكم في المجاز لأجل الخطاب لكانوا قد أجمعوا لا لدلالة فان قالوا المجاز يدل على ما هو مجاز فيه مع القرينة فاذا أجمعوا على الحكم لأجل دلالة الخطاب مع القرينة كانوا قد أجمعوا على الحكم لدلالة قيل فإذن لا بد لكم من إثبات أمر زائد على الخطاب ليصح الإجماع على ثبوت الحكم في المجاز فلستم بأن تقولوا بأن ذلك الأمر الزائد هو قرينة اقترنت بالخطاب بأولى من أن تقولوا بل هو دلالة مبتدأة على الحكم فان قالوا لو أجمعوا لدلالة مبتدأة لنقلوها قيل
ولو أجمعوا لقرينة لنقلوها فان قالوا لم ينقلوها اكتفاء بالإجماع على ثبوت الحكم قيل ولم ينقلوا الدليل المبتدأ اكتفاء بالإجماع فان قالوا إنما لم ينقلوا قرينة لجواز أن يكونوا اضطروا من قصد النبي صلى الله عليه و سلم إلى أن المراد بالخطاب المجاز ولم تكن هناك قرينة تنقل قيل إن جاز أن يضطروا من قصده إلى أن المراد بالآية هو المجاز جاز أن يضطروا من قصده إلى هذا الحكم من غير أن يكون مرادا بالآية وكان ينبغي أن ينقلوا إلينا أنهم علموا ذلك من قصد النبي صلى الله عليه و سلم إذ كان هذا هو دليلهم على المراد بالآية على أن هذا لا يتأتى فيما يثبت الحكم فيه بنص نحو وجوب التيمم على المجامع لأن في ذلك خبر عمار رضي الله عنه وغيره فلا يمكن أن يقال في ذلك إنه لا وجه لإجماعهم سوى الآية
باب فيمن يجوز له أن يقضي بظاهر الخطاب وعمومه ومتى يجوز له ذلك
اعلم أن قول الله تعالى إذا تناول أشياء كقوله تعالى اقتلوا المشركين وطرق سمع المكلف فانه لا يجوز أن يحمله على عمومه ولا يحكم بثبوت التعبد بفائدته إلا بعد أن ينظر فيما يخصه أو ينسخه فانه يجوز أن يكون في الأدلة ما ينسخه ويخصه فاذا فحص ووجد في ذلك ما ينسخه أو يخصه قضى بما يقتضيه الدليل وإن لم يصب ذلك لم يخل ظاهر الخطاب إما أن يتناول ذلك المكلف أو لا يتناوله فان تناوله قضى بشمول الخطاب له وقضى بلزوم تلك الأفعال له لأنه لا يجوز أن يسمعه الله عز و جل خطابا عاما لأفعال ويريد منهم فهم مراده ولا يمكنه من العلم بمراده وينصب دلالة يتمكن من الظفر بها فاذا فحص ولم يصب الدلالة قطع على أن الله لم يرد الخصوص وإن كان ظاهر الخطاب لا يتناول ذلك المكلف لم يخل السنن إما أن تكون انتشرت انتشارا لا يخفي معه ما فيها على من طلبها من العلماء أو لم تنتشر فان كانت قد انتشرت كعصرنا هذا فالواجب أن يقضي بعموم الخطاب وثبوت حكمه لأن السنن قد ظهرت ظهورا لا تخفي معه على من التمسها وإن لم تكن السنن قد انتشرت فانه لا يجوز أن يقضى بعموم الخطاب لأنه لا يأمن أن يكون في الشرع ما يخصه لكنه لا يجب في الحكمة ان يمكن منه ولا اتفق بانتشار الشريعة أن يتمكن منه
وذكر قاضي القضاة أنه إذا لم يجز له القطع على بقاء حكمه ولا عمومه لم يجز أن يجعله اصلا يقيس عليه لأنه لا يثق بثبوته وهذا لا يتم لأن من كان من أهل الاجتهاد ففرضه فهم الخطاب لأجل غيره إما فرضا معينا أو على طريق الكفاية فيجب إذا أمكن من فهم الخطاب فاذا لم يجد دليلا ناسخا أو مخصصا وجب أن يقضي بظاهره ويقيس عليه والواجب أن يقال إن من كان أهل الاجتهاد إذا لم يجد ما يعدل بالحكم عن ظاهره فالواجب أن يحمل على ظاهره في تلك الحال لأنه قد كلف الاستدلال به إما ليفتي غيره أو ليفتي نفسه ويفتي غيره ولا يجوز أن لا يجعل له طريقا إلى ما كلف سواء انتشرت السنن أو لم تنتشر إلا أنه إن لم تنتشر السنن قطع المكلف أن فرضه في الحال وفرض من يستفتيه العمل بظاهر ذلك الخطاب وجوز أن يكون في السنن ما يعدل بالخطاب عن ظاهره إذا بلغه تلك السنة يغير فرضه ولهذا يجب أن يكون من عاصر النبي صلى الله عليه و سلم ممن غاب عنه يجوز أن يكون ما يلزمه من العبادات قد نسخه النبي صلى الله عليه و سلم وإن لم يبلغه النسخ بعد وأنه إذا بلغه النسخ بغير فرضه ويعتبر فرض قياسه عليه فأما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يقضي بظاهر الخطاب إذا سمعه في كل هذه الأحوال لأنه لا يأمن أن يكون في الأدلة ما يعدل بالخطاب عن ظاهره ولا يجب في الحكمة أن يبلغه ولا بد مع انتشار السنن أن يبلغه