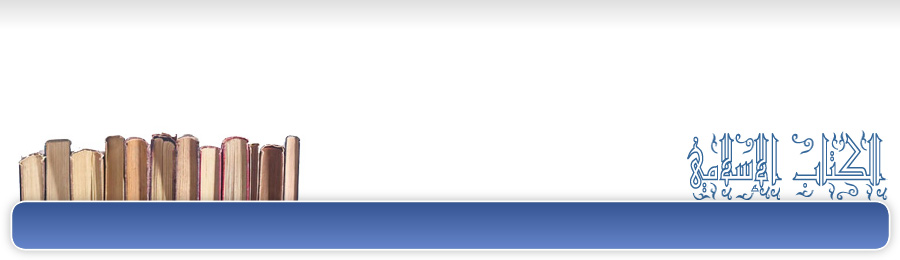الكتاب : أصول السرخسي
المؤلف : ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء في يوم السبت سلخ شوال سنة تسع وسبعين وأربعمائة في زاوية من حصار أوزجند: الحمد لله الحميد المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، ذي البطش الشديد، والامر الحميد، والحكم الرشيد، والوعد والوعيد.نحمده على ما أكرمنا به من ميراث النبوة، ونشكره على ما هدانا إليه بما هو أصل
في الدين والمروة، وهو العلم الذي هو أنفس الاعلاق، وأجل مكتسب في الآفاق.
فهو أعز عند الكريم من الكبريت الاحمر، والزمرد الاخضر، ونثارة الدر والعنبر، ونفيس الياقوت والجوهر، من جمعه فقد جمع العز والشرف، ومن عدمه فقد عدم مجامع الخير واللطف، يقوي الضعيف، ويزيد عز الشريف، يرفع الخامل الحقير، ويمول العائل الفقير، به يطلب رضا الرحمن، وتستفتح أبواب الجنان، وينال العز في الدين والدنيا، والمحمدة في البدء والعقبى، لاجله بعث الله النبيين، وختمهم بسيد المرسلين، وإمام المتقين: محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين.
وبعد فإن من أفضل الامور، وأشرفها عند الجمهور، بعد معرفة أصل الدين، الاقتداء بالائمة المتقدمين، في بذل المجهود لمعرفة الاحكام، فبها يتأتى الفصل بين الحلال والحرام، وقد سمي الله تعالى ذلك في محكم تنزيله الخير الكثير فقال: (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الحكمة بعلم الفقه، وهو المراد بقوله عزوجل: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) أي ببيان الفقه ومحاسن الشريعة، فقال صلى الله عليه وسلم برواية ابن عباس رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه السلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا تفقهوا وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين هم
أعلام الدين، وقدوة المتأخرين فقال: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ما عبد الله بشئ أفضل من الفقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال صلى الله عليه وسلم قليل من الفقه خير من كثير من العمل.
غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء: العلم بالمشروبات، والاتقان
في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الاصول بفروعها، ثم العمل بذلك.
فتمام المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم، ومن كان حافظا للمشروبات من غير إتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة، وبعد الاتقان إذا لم يكن عاملا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه، فأما إذا كان عاملا بما يعلم فهو الفقيه المطلق الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هو أشد على الشيطان من ألف عابد وهو صفة المقدمين من أئمتنا: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم، ولا يخفى ذلك على من يتأمل في أقوالهم وأحوالهم عن إنصاف.
فذلك الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمد بن الحسن رحمه الله، بآكد إشارة وأسهل عبارة.
ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبين للمقتسبين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب، ليكون الوقوف على الاصول معينا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع، ومرشدا لهم إلى ما وقع الاخلال به في بيان الفروع.
فالاصول معدودة، والحوادث ممدودة، والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، وإنا فيما قصدته بهم من المقتدين، رجاء أن أكون من الاشباه فخير الامور الاتباع، وشرها الابتداع.
وما توفيقي إلا بالله عليه أتكل، وإليه أبتهل، وبه أعتصم، وله أستسلم، وبحوله أعتضد، وإياه أعتمد، فمن اعتصم به فاز بالخيرات سهمه، ولاح في الصعود نجمه.
فأحق ما يبدأ به في البيان الامر والنهى، لان معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام، ويتميز الحلال من الحرام.
باب الامر قال رضي الله عنه: اعلم أن الامر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار،
وهو عند أهل اللسان قول المرء لغيره افعل، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر، وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا، لان الامر يتعلق بالمأمور.
فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب كان أمرا، وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمرا، كقول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني، يكون سؤالا ودعاء لا أمرا.
ثم المراد بالامر يعرف بهذه الصيغة فقط ولا يعرف حقيقة الامر بدون هذه الصيغة في قول الجمهور من الفقهاء.
وقال بعض أصحاب مالك والشافعي يعرف حقيقة المراد بالامر بدون هذه الصيغة.
وعلى هذا يبتني الخلاف في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها موجبة أم لا ؟ واحتجوا في ذلك بقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) : أي عن سمته وطريقته في أفعاله، وقال تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) والمراد فعله وطريقته، وقال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) : أي أفعالهم، وقال تعالى: (وتنازعتم في الامر) : أي فيما تقدمون عليه من الفعل، وقال تعالى: (قل إن الامر كله لله)
المراد الشأن والفعل، والعرب تقول: أمر فلان سديد مستقيم: أي حاله وأفعاله، وإذا ثبت أن الامر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه، يوضحه أن العرب تفرق بين جمع الامر الذي هو القول فقالوا فيه: أوامر، والامر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه: أمور، ففي التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة، ومن يقول إن استعمال الامر في الفعل بطريق المجاز والاتساع، فلا بد له من بيان الوجه الذي اتسع فيه لاجله، لان الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك الطريق لغير حقيقته مجازا.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله.
وحجتنا في ذلك أن المراد بالامر من أعظم المقاصد فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل والحال، وهذا لان العبارات لا تقصر عن المقاصد، ولا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها، ثم قد تستعمل تلك العبارة لغيره مجازا بمنزلة أسماء الاعيان، فكل عين مختص باسم هو موضوع له وقد يستعمل في غيره مجازا نحو أسد فهو في الحقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل في غيره مجازا، يوضحه أن قولنا أمر مصدر والمصادر لا بد أن توجد عن فعل أو يوجد عنها فعل على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك، ثم لا تجد أحدا من أهل اللسان يسمي الفاعل للشئ آمرا، ألا ترى أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمرا، فبهذا تبين أن اسم الامر لا يتناول الفعل حقيقة، ولا يقال الامر اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره، لان الامر مشتق في الاصل، فإنه يقال: أمر يأمر أمرا فهو آمر، وما كان مشتقا في الاصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة، وإنما يقال ذلك فيما هو غير مشتق في الاصل
كاللسان ونحوه، وفي قول القائل: رأيت فلانا يأمر بكذا ويفعل بخلافه دليل ظاهر على أن الفعل غير الامر حقيقة.
فأما ما تلوا من الآيات فنحن لا ننكر استعمال الامر في غير ما هو حقيقة فيه، لان ذلك في القرآن على وجوه: منها القضاء قال الله تعالى: (يدبر الامر من السماء إلى الارض) وقال تعالى: (ألا له الخلق والامر) ومنها الدين قال الله تعالى: (حتى جاء الحق وظهر أمر الله) ومنها القول قال الله تعالى: (يتنازعون بينهم أمرهم) ومنها الوحي قال الله تعالى: (يتنزل الامر بينهن) ومنها القيامة قال تعالى: (أتى أمر الله) ومنها العذاب قال الله تعالى: (فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شئ لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب) ومنها الذنب قال الله تعالى: (فذاقت
وبال أمرها) فإما أن نقول: كل ذلك يرجع إلى شئ واحد وهو أن تمام ذلك كله بالله تعالى كما قال تعالى: (قل إن الامر كله لله) ثم فهمنا ذلك بما هو صيغة الامر حقيقة فقال: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وكما قال تعالى: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) أو نقول ما كان حقيقة لشئ لا يجوز نفيه عنه بحال، وما كان مستعملا بطريق المجاز لشئ يجوز نفيه عنه كاسم الاب فهو حقيقة للاب الادنى فلا يجوز نفيه عنه، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره، ثم يجوز نفي هذه العبارة عن الفعل وغيره مما لا يوجد فيه هذه الصيغة، فإن الانسان إذا قال ما أمرت اليوم بشئ كان صادقا وإن كان قد فعل أفعالا، فعرفنا أن الاستعمال فيه مجاز، وطريق هذا المجاز أنهم في قولهم: أمر فلان سديد مستقيم أجروا اسم المصدر على المفعول به كقولهم: هذا الدرهم ضرب الامير، وهذا الثوب نسج اليمن، وأيد ما قلنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال عليه السلام: ما حملكم على ما صنعتم ؟ ولو كان فعله يوجب الاتباع مطلقا لم يكن لهذا السؤال منه معنى.
ولما واصل صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه فأنكر عليهم وقال: إني لست
كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وفي استعمال صيغة الامر في قوله: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي بيان أن نفس الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك، ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع فيما يرجع إلى إحكام البيان.
فصل: في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل اعلم أن صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه: على الالزام كما قال الله تعالى:
(آمنوا بالله ورسوله) وقال تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وعلى الندب كقوله تعالى: (وافعلوا الخير) وقوله تعالى: (وأحسنوا) وعلى الاباحة كقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) وعلى الارشاد إلى ما هو الاوثق كقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) وعلى التقريع كقوله تعالى: (فأتوا بسورة من مثله) وعلى التوبيخ كقوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) وعلى السؤال كقوله تعالى: (ربنا تقبل منا) .
ولا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الامر وإن كان في صورة الامر، ولا خلاف أن اسم الامر يتناول ما هو للالزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للاباحة أو الارشاد أو الندب فذكر الكرخي والجصاص رحمهما الله أن هذا لا يسمى أمرا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازا، واختلف فيه أصحاب الشافعي فمنهم من يقول: اسم الامر يتناول ذلك كله حقيقة، ومنهم من يقول: ما كان للندب يتناوله اسم الامر حقيقة لانه يثاب على فعله ونيل الثواب يكون بالطاعة والطاعة في الائتمار بالامر، وهذا ليس بقوي فإن نيل الثواب بفعل النوافل من الصوم
والصلاة لانه عمل بخلاف هوى النفس الامارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله تعالى كما قال تعالى: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) وليس من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به.
والفريق الثاني يقولون: ما يفيد الاباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو الايجاب لان بالايجاب هذا وزيادة، فيكون هذا قاصرا لا مغايرا، والمجاز ما جاوز أصله وتعداه.
وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة، وهذا ضعيف أيضا، فإن موجب الامر حقيقة الايجاب وقطع التخيير، لان ذلك من ضرورة الايجاب وبالاباحة والندب لا ينقطع التخيير.
عرفنا أن موجبه غير موجب الامر حقيقة وإنما يتناوله اسم الامر مجازا.
والدليل عليه أن العرب تسمي
تارك الامر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى: (أفعصيت أمري ؟) وقال القائل: أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أنني غير مهتدي وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصبا، فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة، ثم حد الحقيقة في الاسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه، ورأينا أن الانسان لو قال: ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا، ولو قال: ما أمرني الله بصوم رمضان كان كاذبا، ولو قال: ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا، ولو قال: ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا.
ففي تجويز نفي صيغة الامر عن المندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازا لا حقيقة.
فأما الكلام في موجب الامر، فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الالزام إلا بدليل.
وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافعي، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أنه يحتمل أمرين.
وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الاطلاق، وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم،
وزعموا أنه جزم على أن الامر للوجوب في سائر كتبه.
وقال بعض أصحاب مالك: إن موجب مطلقه الاباحة، وقال بعضهم: موجبه الندب.
أما الواقفون فيقولون قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بينا فلا يتعين شئ منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال، وهذا فاسد جدا فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما سمعوا منه صيغة الامر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل، ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الاحوال لا بصيغة الامر لان من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الامر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبا، وحين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه فأخر المجئ لكونه في الصلاة فقال له: أما سمعت الله يقول: (استجيبوا لله وللرسول) فاستدل عليه بصيغة الامر فقط، وعرف الناس كلهم دليل على ما قلنا، فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا، ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال لم يكن معاتبا.
ثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع، ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض، وصيغة الامر أحد تصاريف الكلام، فلا بد من أن يكون لمعنى خاص في أصل الوضع، ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص في العام.
ومن يقول بأن موجب مطلق الامر الوقف لا يجد بدا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا للاحتمال، فيكون هذا قولا باتحاد موجبهما وهو باطل، وفي القول بأن موجب الامر الوقف إبطال حقائق الاشياء ولا وجه للمصير إليه، والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في أن لا نجعله محكما بمجرد الصيغة لا في أن لا يثبت موجبه أصلا، ألا ترى أن من يقول لغيره: إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء، واحتمال غيره وهو الزجر قائم كما قال الله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) .
وأما الذين قالوا موجبه الاباحة اعتبروا الاحتمال لكنهم قالوا من ضرورة الامر
ثبوت صفة الحسن للمأمور به، فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح فيثبت بمطلقه ما هو من ضرورة هذه الصيغة وهو التمكين من الاقدام عليه والاباحة، وهذا فاسد أيضا، فصفة الحسن بمجرده تثبت بالاذن والاباحة، وهذه الصيغة موضوعة لمعنى خاص، فلا بد أن تثبت بمطلقها حسنا بصفة، ويعتبر الامر بالنهي، فكما أن مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجه يجب الانتهاء عنه فكذلك مطلق الامر يقتضي حسن المأمور به على وجه يجب الائتمار.
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب المأمور به من المخاطب وذلك يرجح جانب الاقدام عليه ضرورة.
وهذا الترجيح قد يكون بالالزام وقد يكون بالندب فيثبت أقل الامرين لانه المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة، وهذا ضعيف فإن الامر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب، إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم، فإنه مفترض الطاعة بملك الالزام.
ثم إما أن يكون الامر حقيقة في الايجاب خاصة فعند الاطلاق يحمل على حقيقة، أو يكون حقيقة في الايجاب والندب جميعا فيثبت بمطلقه الايجاب لتضمنه الندب والزيادة، لا يجوز أن يقال: هو للندب حقيقة وللايجاب مجازا، لان هذا يؤدي إلى تصويب قول من قال: إن الله لم يأمر بالايمان ولا بالصلاة، وبطلان هذا لا يخفى على ذي لب.
وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك، ثم عند الاطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الاقل وإنما يحمل على الجنس لتكثير الفائدة به.
وكذا صيغة الامر، ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الاخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلنا، فإن المندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه العقاب، والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب، فالقول بأن مقتضى مطلق الامر الايجاب وفيه معنى الاحتياط من كل وجه، أولى.
ثم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ففي نفي التخيير بيان أن موجب الامر الالزام، ثم قال تعالى: (ومن يعص الله ورسوله) ولا يكون عاصيا بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الالزام، وقال: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) : أي أن تسجد، فقد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الواجب، وقال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة) وخوف العقوبة في ترك الواجب، ولا معنى لقول من يقول ترك الائتمار لا يكون خلافا فإن المأمور في الصوم هو الامساك ولا شك في أن ترك الائتمار بالفطر من غير عذر يكون خلافا فيما هو المأمور به.
ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوه، يشهد به الكتاب والاجماع والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: (ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره) فإضافة الوجود والقيام إلى الامر ظاهره يدل على أن الايجاد يتصل بالامر، وكذلك قوله: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم فإنا نستدل به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق، لانه سابق على المحدثات أجمع، وحرف الفاء للتعقيب.
فبهذا يتبين أن هذه الصيغة لطلب المأمور بآكد الوجوه، والاجماع دليل عليه، فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجد لفظا موضوعا لاظهار مقصوده سوى قوله افعل، وبهذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة كما أن اللفظ الماضي موضوع للمضي، والمستقبل للاستقبال، وكذلك الحال.
ثم سائر المعاني التي وضعت
الالفاظ لها كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه، فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة، ولان قولنا أمر فعل متعد لازمه ائتمر والمتعدي لا يتحقق
بدون اللازم، فهذا يقتضي أن لا يكون أمرا بدون الائتمار، كما لا يكون كسرا بدون الانكسار، وحقيقة الائتمار بوجود المأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالامر ولا صنع للمخاطب فيه سقط التكليف، وهذا لا وجه له، لان في الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به الجبر ويستحق الثواب بالاقدام على الائتمار، وذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الامر، فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بالجبر، فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الالزام، ألا ترى أن بمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الاعدام وهو وجوب الانتهاء، ولا يثبت الانعدام بمطلق النهي، وكذلك بالامر، لان إحدى الصيغتين لطلب الايجاد والاخرى لطلب الاعدام.
ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الحظر، فالصحيح عندنا أن مطلقه للايجاب أيضا لما قررنا أن الالزام مقتضى هذه الصيغة عند الامكان إلا أن يقوم دليل مانع.
وبعض أصحاب الشافعي يقولون: مقتضاه الاباحة لانه لازالة الحظر ومن ضرورته الاباحة فقط فكأن الآمر قال: كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه.
فاستدلوا على هذا بقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله) .
وبقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) ولكنا نقول: إباحة الاصطياد للحلال بقوله: (أحل لكم الطيبات) الآية لا بصيغة الامر مقصودا به، وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله: (وأحل الله البيع) لا بصيغة الامر، ثم صيغة الامر ليست لازالة الحظر ولا لرفع المنع، بل لطلب المأمور به، وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة.
فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرار
الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الامر لا توجب التكرار ولا تحتمله، ولكن الامر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل ولا يكون موجبا للكل إلا بدليل.
وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به.
وقال الشافعي مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والعدد أيضا إذا اقترن به دليل.
وقال بعضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه، ويحكى هذا عن المزني، واحتج صاحب هذا المذهب بحديث أقرع بن حابس رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أم مرة ؟ فقال: بل مرة ولو قلت في كل عام لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها فلو لم تكن صيغة الامر في قوله حجوا محتملا التكرار أو موجبا له لما أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ، فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الاكتفاء بمرة واحدة عرفنا أن موجب هذه الصيغة التكرار.
ثم المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام وموجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص.
وبيان هذا أن قول القائل افعل طلب الفعل بما هو مختصر من المصدر الذي هو نسبة الاسم وهو الفعل، وحكم المختصر ما هو حكم المطول، والاسم يوجب إطلاقه العموم حتى يقوم دليل الخصوص فكذلك الفعل، لان للفعل كلا وبعضا كما للمفعول، فمطلقه يوجب الكل ويحتمله، ثم الكل لا يتحقق إلا بالتكرار.
واعتبروا الامر بالنهي فكما أن النهي يوجب إعدام المنهي عنه عاما فكذلك الامر يوجب إيجاده تماما حتى يقوم دليل الخصوص وذلك يوجب التكرار لا محالة.
وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بنحو هذا أيضا ولكن على وجه يتبين به الفرق
بين الامر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الايجاب، وذلك أن قوله افعل يقتضي مصدرا على سبيل التنكير أي افعل فعلا.
بيانه في قوله طلق: أي طلق طلاقا، وإنما أثبتناه على سبيل التنكير لان ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالمنكر يحصل هذا المقصود فيكون الثابت بمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة في الاثبات والنكرة في الاثبات تخص كقوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولكن احتمال التكرار والعدد فيه لا يشكل، لان ذلك المنكر متعدد في نفسه.
ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه التفسير، وتقول طلقها اثنتين أو مرتين أو ثلاثا ويكون ذلك نصبا على التفسير، ولو لم يكن اللفظ محتملا له لم يستقم تفسيره به بخلاف النهي فصيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا مصدرا على سبيل التنكير أي لا تفعل فعلا ولكن النكرة في النفي تعم.
قال الله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) ومن قال لغيره لا تتصدق من مالي يتناول النهي كل درهم من ماله، بخلاف قوله تصدق من مالي فإنه لا يتناول الامر إلا الاقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله، ولهذا قال إن مطلق الصيغة لا توجب التكرار لان ثبوت المصدر فيه بطريق الاقتضاء ولا عموم للمقتضى، يوضحه أن هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الاقسام.
وقول القائل: دخل فلان الدار إخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة أو مرتين أو مرارا، فكذلك قوله ادخل يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون المراد مرة أو مرارا، ثم الموجب ما هو المتيقن به دون المحتمل.
وأما الذين قالوا في المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف إنه يتكرر بتكرر الشرط والوصف، استدلوا بالعبادات التي أمر الشرع بها مقيدا بوقت أو حال وبالعقوبات التي أمر الشرع بإقامتها مقيدا بوصف أن ذلك يتكرر بتكرر ما قيد به.
قال رضي الله عنه: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله، فإن من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول
ولم تطلق إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك، وهذا لان المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط، وإنما يحكى هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله فإنه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) إلى قوله: (فتيمموا) وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الدليل فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام.
وهذا سهو، فالمراد بقوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) : أي وأنتم محدثون، عليه اتفق أهل التفسير، وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم، وهذا هو الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات، فإن تكررها ليس بصيغة مطلق الامر ولا بتكرر الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له، ففي قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أمر بالاداء وبيان للسبب الموجب وهو دلوك الشمس، فقد جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل: أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح يفهم منه الامر بالاداء والاشارة إلى السبب الموجب لما طولب بأدائه.
ولما أشكل على الاقرع بن حابس رضي الله عنه حكم الحج حتى سأل فقد كان من المحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لذلك بمنزلة الصوم والصلاة، ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت والوقت شرط الاداء والنبي عليه السلام بين له بقوله: بل مرة، أن السبب هو البيت وفي قوله عليه السلام: ولو قلت في كل عام لوجبت دليل على أن مطلق الامر لا يوجب التكرار، لانه لو كان موجبا له كان الوجوب في كل عام بصيغة الامر لا بهذا القول منه، وقد نص على أنها كانت تجب بقوله لو قلت
في كل عام...ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله أن قوله افعل
لطلب فعل معلوم بحركات توجد منه وتنقضي، وتلك الحركات لا تبقى ولا يتصور عودها إنما المتصور تجدد مثلها، ولهذا يسمى تكرارا مجازا من غير أن يشكل على أحد أن الثاني غير الاول.
وبهذا تبين أنه ليس في هذه الصيغة احتمال العدد ولا احتمال التكرار، ألا ترى أن من يقول لغيره اشتر لي عبدا لا يتناول هذا أكثر من عبد واحد، ولا يحتمل الشراء مرة بعد مرة أيضا ؟ وكذلك قوله زوجني امرأة لا يحتمل إلا امرأة واحدة، ولا يحتمل تزويجا بعد تزويج إلا أن ما به يتم فعله عند الحركات التي توجد منه له كل وبعض فيثبت بالصيغة اليقين الذي هو الاقل للتيقن به، ويحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نيته فيه، وليس فيه احتمال العدد أصلا فلا تعمل نيته في العدد، وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلقي نفسك أو لاجنبي طلقها إنه يتناول الواحد إلا أن ينوي الثلاث فتعمل نيته، لان ذلك كل فيما يتم به فعل الطلاق، ولو نوى اثنتين لم تعمل نيته لانه مجرد نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة فتكون نيته الثنتين في حقها نية كل الطلاق، وكذلك لو قال لعبده تزوج يتناول امرأة واحدة إلا أن ينوي اثنتين فتعمل نيته لانه كل النكاح في حق العبد لا لانه نوى العدد، ولا معنى لما قالوا: إن صحة اقتران العدد والمرات بهذه الصيغة على سبيل التفسير لها دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك، لان هذا القران عمله في تغيير مقتضى الصيغة لا في التفسير لما هو من محتملات تلك الصيغة بمنزلة اقتران الشرط والبدل بهذه الصيغة.
ألا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثا لا يحتمل وقوع الثنتين به مع قيام الثلاث في ملكه، ولا التأخير إلى مدة، ولو قرن به إلا واحدة إلى شهر أو اثنتين كان صحيحا وكان عاملا في تغيير مقتضى الصيغة لا أن يكون مفسرا
لها ؟ ولهذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الايقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بأصل الصيغة حتى لو قال لامرأته طلقتك ثلاثا أو قال واحدة فماتت المرأة قبل ذكر العدد لم يقع شئ.
فبهذا تبين أن عمل هذا القران في التغيير والتفسير يكون مقررا للحكم المفسر لا مغيرا، يحقق ما ذكرناه أن قول القائل اضرب أي اكتسب ضربا، وقوله طلق أي أوقع طلاقا، وهذه صيغة فرد فلا تحتمل الجمع ولا توجبه، وفي التكرار والعدد جمع لا محالة والمغايرة بين الجمع والفرد على سبيل المضادة، فكما أن صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة، فكذا صيغة الفرد لا تحتمل الجمع حقيقة بمنزلة الاسم الفرد نحو قولنا زيد لا يحتمل الجمع والعدد، فالبعض مما تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى، وكل فرد من حيث الجنس معنى، فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الاجناس كان جنسا واحدا وهو جمع صورة فعند عدم النية لا يتناول إلا الفرد صورة ومعنى، ولكن فيه احتمال الكل لكون ذلك فردا معنى بمنزلة الانسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض، والطلاق أيضا فرد جنسا وله أجزاء وأبعاض فتعمل نية الكل في الايقاع ولا تعمل نية الثنتين أصلا، لانه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات الكلام أصلا، وعلى هذا الاصل تخرج أسماء الاجناس ما يكون منها فردا صورة أو حكما.
أما الصورة فكالماء والطعام إذا حلف لا يشرب ماء أو لا يأكل طعاما يحنث بأدنى ما يتناوله الاسم على احتمال الكل حتى إذا نوى ذلك لم يحنث أصلا.
ولو نوى مقدارا من ذلك لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صيغة الفردية صورة ومعنى، والفرد حكما كاسم النساء إذا حلف لا يتزوج النساء فهذه صيغة الجمع ولكن جعلت عبارة عن الجنس مجازا، لانا لو جعلناها جمعا لم يبق لحرف اللام الذي هو للمعهود فيه فائدة، ولو جعلناه جنسا كان حرف العهد فيه معتبرا فإنه يتناول المعهود من ذلك
الجنس ويبقى معنى الجمع معتبرا فيه أيضا باعتبار الجنس، فيتناول أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس على احتمال الكل حتى إذا نواه لم يحنث قط، وعلى هذا لو حلف لا يشتري العبيد، أو لا يكلم بني آدم، أو وكل وكيلا بأن يشتري له الثياب فإن التوكيل صحيح بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له أثوابا على ما بيناه في الزيادات.
وحكي عن عيسى بن أبان رحمه الله أنه كان يقول: صيغة مطلق الامر فيما له نهاية معلومة تحتمل التكرار وإن كان لا يوجه إلا بالدليل، وفيما ليست له نهاية معلومة لا تحتمل التكرار لان فيما لا نهاية له يعلم يقينا أن المخاطب لم يرد الكل فإن ذلك ليس في وسع المخاطب ولا طريق له إلى معرفته، وهذا نحو قوله: صم وصل، فليس لهذا الجنس من الفعل نهاية معلومة وإنما يعجز العبد عن إقامته بموته، فعرفنا يقينا أن المراد بهذا الخطاب الفرد منه خاصة، وأما فيما له نهاية معلومة كالطلاق والعدة فالكل من محتملات الخطاب، وذلك تارة يكون بتكرار التطليق، وتارة يكون بالجمع بين التطليقات في اللفظ فيكون صيغة الكلام محتملا له كله.
وخرج على هذا الاصل قول الرجل لامرأته: أنت طالق للسنة أو للعدة فإنه يحتمل نية الثلاث في الايقاع جملة واحدة، ونية التكرار في أن ينوي وقوع كل تطليقة في طهر على حدة.
وفيما قررناه من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تأملت.
والكلام في مقتضى صيغة الفرد دون ما إذا قرن به ما يدل على التغيير من قوله للسنة أو للعدة.
واستدل الجصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صيغة الامر تقتضي التكرار فقال: بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أتى بالمأمور به، وخرج عن موجب الامر وكان مصيبا في ذلك، فلو كان موجبه التكرار لكان آتيا ببعض المأمور به، ولا معنى لقول من يقول: فإذا أتى به ثانيا وثالثا يقال أيضا في العادة أتى بالمأمور به، لان قائل هذا لا يكون مصيبا في ذلك في الحقيقة، فإن
المخاطب في المرة الثانية متطوع من عنده بمثل ما كان مأمورا به لا أن يكون آتيا بالمأمور به، بمنزلة المصلي أربع ركعات في الوقت بعد صلاة الظهر يكون متطوعا بمثل ما كان مأمورا به إلا أن الذي يسميه آتيا بالمأمور به إنما يسميه بذلك توسعا ومجازا، فلهذا لا نسميه كاذبا، والله أعلم.
فصل: في بيان موجب الامر في حكم الوقت الامر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به، فنبدأ ببيان المطلق: قال رضي الله عنه: والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الاداء على الفور بمطلق الامر، نص عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهرا: يعتكف أي شهر شاء، وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا.
والوفاء بالنذر واجب بمطلق الامر.
وفي كتاب الصوم أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متى شاء، وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطا بتأخير الاداء وأن له أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدة أخرى.
وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مطلق الامر يوجب الاداء على الفور، وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله فقد ذكر في كتابه: إنا استدللنا بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مع الامكان على أن وقته موسع، وهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق الامر على الفور حتى يقوم الدليل.
وبعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على البيان لانه ليس في الصيغة ما ينبئ عن الوقت فيكون مجملا في حقه، وهذا فاسد جدا فإنهم يوافقونا على ثبوت أصل الواجب بمطلق الامر، وذلك يوجب الاداء عند الامكان ولا إمكان إلا بوقت فثبت بدليل الاشارة إلى الوقت بهذا الطريق.
ثم بهذا الكلام يستدل الكرخي فيقول: وقت الاداء ثابت بمقتضى الحال ومقتضى الحال دون مقتضى اللفظ، ولا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الحال،
وأول أوقات إمكان الاداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للامر فلا يثبت ما بعده مرادا إلا بدليل، يوضحه أن التخيير ينتفي بمطلق الامر بين الاداء والترك
فيثبت هذا الحكم وهو انتفاء التخيير في أول أوقات إمكان الاداء كما ثبت حكم الوجوب، والتفويت حرام بالاتفاق، وفي هذا التأخير تفويت لانه لا يدري أيقدر على الاداء في الوقت الثاني أو لا يقدر ؟ وبالاحتمال الثاني لا يثبت التمكن من الاداء على وجه يكون معارضا للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الامكان تفويتا، ولهذا استحسن ذمه على ذلك إذا عجز عن الاداء، ولان الامر بالاداء يفيدنا العلم بالمصلحة في الاداء، وتلك المصلحة تختلف باختلاف الاوقات، ولهذا جاز النسخ في الامر والنهي، وبمطلق الامر يثبت العلم بالمصلحة في الاداء في أول أوقات الامكان ولا يثبت المتيقن به فيما بعده.
ثم المتعلق بالامر اعتقاد الوجوب وأداء الواجب، وأحدهما وهو الاعتقاد يثبت بمطلق الامر للحال فكذلك الثاني، واعتبر الامر بالنهي، والانتهاء الواجب بالنهي يثبت على الفور فكذلك الائتمار الواجب بالامر.
وحجتنا في ذلك أن قول القائل لعبده افعل كذا الساعة يوجب الائتمار على الفور، وهذا أمر مقيد، وقوله افعل مطلق وبين المطلق والمقيد مغايرة على سبيل المنافاة فلا يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد فيما يثبت التقييد به، لان في ذلك إلغاء صفة الاطلاق وإثبات التقييد من غير دليل، فإنه ليس في الصيغة ما يدل على التقييد في وقت الاداء، فإثباته يكون زيادة وهو نظير تقييد المحل، فإن من قال لعبده تصدق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل، يلزمه أن يتصدق على أول من يدخل إذا كان فقيرا، ولو قال تصدق بهذا الدرهم لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل وكان له أن يتصدق به على أي فقير شاء، لان الامر مطلق فتعيين المحل فيه يكون زيادة، والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالاداء في أي جزء عينه من أوقات الامكان
في عمره، ولو تعين للاداء الجزء الاول لم يكن ممتثلا بالاداء بعده، وفي اتفاق الكل
على أنه مؤدي الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا.
وبهذا تبين فساد ما قال إن المصلحة في الاداء غير معلوم إلا في أول أوقات الامكان فإن المطالبة بالاداء وامتثال الامر لا يحصل إلا به، ألا ترى أن بعد الانتساخ لا يبقى ذلك ؟ فعرفنا أن بمطلق الامر يصير معنى المصلحة في الاداء معلوما له في أي جزء أداه من عمره ما لم يظهر ناسخه، والتفويت حرام كما قال إلا أن الفوات لا يتحقق إلا بموته وليس في مجرد التأخير تفويت لانه متمكن من الاداء في كل جزء يدركه من الوقت بعد الجزء الاول حسب تمكنه في الجزء الاول، وموت الفجأة نادر، وبناء الاحكام على الظاهر دون النادر.
فإن قيل: فوقت الموت غير معلوم له وبالاجماع بعد التمكن من الاداء إذا لم يؤد حتى مات يكون مفرطا مفوتا آثما فيما صنع فبه يتبين أنه لا يسعه التأخير.
قلنا الوجوب ثابت بعد الامر، والتأخير في الاداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا، وتقييد المباح بشرط فيه خطر مستقيم في الشرع كالرمي إلى الصيد مباح بشرط أن لا يصيب آدميا، وهذا لانه متمكن من ترك هذا الترخص بالتأخير ولا ينكر كونه مندوبا للمسارعة إلى الاداء.
قال الله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) فقلنا بأنه يتمكن من البناء على الظاهر من التأخير ما دام يرجو أن يبقى حيا عادة، وإن مات كان مفرطا لتمكنه من ترك الترخص بالتأخير.
ثم هذا الحكم إنما يثبت فيما لا يكون مستغرقا لجميع العمر فأما ما يكون مستغرقا له فلا يتحقق فيه هذا المعنى، واعتقاد الوجوب مستغرق جميع العمر، وكذلك الانتهاء الذي هو موجب النهي يستغرق جميع العمر.
فأما أداء الواجب فلا يستغرق جميع العمر فلا يتعين للاداء جزء من العمر إلا بدليل، فإن جميع العمر في أداء هذا الواجب كجميع وقت الصلاة لاداء الصلاة وهناك لا يتعين الجزء الاول من الوقت للاداء فيه على وجه لا يسعه التأخير عنه، فكذلك ههنا.
ومن أصحابنا من جعل هذا الفصل على الخلاف المشهور بين أصحابنا في الحج
أنه على الفور أم على التراخي ؟ قال رضي الله عنه: وعندي أن هذا غلط من قائله، فالامر بأداء الحج ليس بمطلق بل هو موقت بأشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقد بينا أن المطلق غير المقيد بوقت، ولا خلاف أن وقت أداء الحج أشهر الحج.
ثم قال أبو يوسف رحمه الله: تتعين أشهر الحج من السنة الاولى للاداء إذا تمكن منه، وقال محمد رحمه الله لا تتعين ويسعه التأخير، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه روايتان: ف محمد يقول الحج فرض العمر ووقت أدائه أشهر الحج من سنة من سني العمر وهذا الوقت متكرر في عمر المخاطب فلا يجوز تعيين أشهر الحج من السنة الاولى إلا بدليل، والتأخير عنها لا يكون تفويتا بمنزلة تأخير قضاء رمضان.
وتأخير صوم الشهرين في الكفارة، فالايام والشهور تتكرر في العمر ولا يكون مجرد التأخير فيها تفويتا فكذلك الحج، ألا ترى أنه متى أدى كان مؤديا للمأمور.
وأبو يوسف يقول أشهر الحج من السنة الاولى بعد الامكان متعين الاداء لانه فرد في هذا الحكم لا مزاحم له، وإنما يتحقق التعارض وينعدم التعيين باعتبار المزاحمة، ولا يدري أنه هل يبقى إلى السنة الثانية ليكون أشهر الحج منها من جملة عمره أم لا ؟ ومعلوم أن المحتمل لا يعارض المتحقق، فإذا ثبت انتفاء المزاحمة كانت هذه الاشهر متعينة للاداء فالتأخير عنها يكون تفويتا كتأخيرة الصلاة عن الوقت، والصوم عن الشهر إلا أنه إذا بقي حيا إلى أشهر الحج من السنة الثانية فقد تحققت المزاحمة الآن وتبين أن الاولى لم تكن متعينة فلهذا كان مؤديا في السنة الثانية وقام أشهر الحج من هذه السنة مقام الاولى في التعيين، لانه لا يتصور الاداء في وقت ماض، ولا يدري أيبقى بعد هذا أم لا ؟ وهذا بخلاف الامر المطلق فبالتأخير عن أول أوقات الامكان لا يزول تمكنه من الاداء هناك، وههنا يزول تمكنه من الاداء بمضي يوم عرفة إلى أن يدرك هذا
اليوم من السنة الثانية ولا يدري أيدركه أم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن اليوم الاول لا يكون تفويتا أيضا لتمكنه منه في اليوم الثاني، ولا يقال بمجئ الليل يزول تمكنه، ثم لا يدري أيدرك اليوم الثاني أم لا ؟ لان الموت في ليلة واحدة قبل
ظهور علاماته يكون فجأة وهو نادر ولا يبنى الحكم عليه، وإنما يبنى على الظاهر، بمنزلة موت المفقود، فإنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا يحكم بموته باعتبار الظاهر، لان بقاءه بعد موت أقرانه نادر، فأما موته في سنة لا يكون نادرا، فيثبت احتمال الموت والحياة في هذه المدة على السواء، فلهذا كان التأخير تفويتا، وعلى هذا صوم الكفارة، والتأخير هناك لا يكون تفويتا لان تمكنه من الاداء لا يزول بمضي بعض الشهور.
فأما النوع الثاني وهو الموقت فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام: فالاول ما يكون الوقت ظرفا للواجب بالامر ولا يكون معيارا، والثاني ما يكون الوقت معيارا له، والثالث ما هو مشكل مشتبه.
فنبدأ ببيان القسم الاول وذلك وقت الصلاة فإن الله تعالى قال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ثم الوقت يكون ظرفا للاداء وشرطا له وسببا للوجوب، وبيانه أنه ظرف للاداء لصحته في أي جزء من أجزاء الوقت أدى، وهذا لان الصلاة عبادة معلومة بأركانها، فإذا لم يطول أركانها يصير مؤديا في جزء قليل من الوقت، فإذا طول منها ركنا يخرج الوقت قبل أن يصير مؤديا لها، فعرفنا أن الوقت ليس بمعيار ولكنه ظرف للاداء وهو شرط أيضا.
فالاداء إنما يتحقق في الوقت والتأخير عنه يكون تفويتا، ومعلوم أن الاداء بأركان يتحقق من المؤدي قبل خروج الوقت، فعرفنا أن خروج الوقت مفوت باعتبار أنه يفوت به شرط الاداء.
وبيان أنه سبب للوجوب أنه لا يجوز تعجيلها قبله، وأن الواجب تختلف صفته باختلاف الاوقات،
فهذا علامة كون الوقت سببا لوجوبها، فأما ما هو الدليل على ذلك نذكره في بيان أسباب الشرائع في موضعه، ثم لا يمكن جعل جميع الوقت سببا للوجوب، لانه ظرف للاداء، فلو جعل جميع الوقت سببا لحصل الاداء قبل وجود السبب أولا يتحقق الاداء فيما هو ظرف للاداء، فإن شهود جميع الوقت لا يكون إلا بعد مضي الوقت، فلا بد أن يجعل جزء من الوقت سببا للوجوب، لانه ليس بين الكل والجزء الذي هو أدنى
مقدار معلوم، وإذا تقرر هذا قلنا الجزء الاول من الوقت سبب للوجوب فبإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحة أداء الواجب.
هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع رحمه الله: أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا وهو الاصح.
وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا ويقولون الوجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، ويستدلون على ذلك بما لو حاضت المرأة في آخر الوقت فإنها لا يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، والمقيم إذا سافر في آخر الوقت يصلي صلاة المسافرين، ولو ثبت الوجوب بأول جزء من الوقت لكان المعتبر حاله عند ذلك، وكذلك لو مات في الوقت لقي الله ولا شئ عليه، ولو ثبت الوجوب في أول الوقت لكانت الرخصة في التأخير بعد ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته كما بينا في الامر المطلق.
ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدي في أول الوقت، فمنهم من يقول هو نفل يمنع لزوم الفرض إياه في آخر الوقت إذا كان على صفة يلزمه الاداء فيها بحكم الخطاب، قال لانه يتمكن من ترك الاداء في أول الوقت لا إلى بدل، وهذا حد النفل ولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب وهو إظهار فضيلة الوقت فيمنع لزوم الفرض إياه في آخر الوقت، أو يغير صفة ذلك المؤدي حين أدرك آخر الوقت، بمنزلة مصلي الظهر في بيته يوم الجمعة إذا شهد الجمعة مع الامام تتغير صفة المؤدى قبلها فيصير نفلا بعد أن كان
فرضا، وهذا غلط بين، فإنه لا تتأدى له هذه الصلاة إلا بنية الظهر، والظهر اسم للفرض دون النفل، ولو نوى النفل كان مؤديا للصلاة، ولا يمنع ذلك لزوم الفرض إياه في آخر الوقت، ولا تتغير صفة المؤدى إلى صفة الفرضية، وهذا لان باعتبار آخر الوقت يجب الاداء، وليس لوجوب الاداء أثر في المؤدى فكيف يكون مغيرا صفة المؤدى ومن يقول بهذا القول لا يجد بدا من أن يقول إذا أديت الجمعة في أول الوقت كان المؤدى نفلا والتنفل بالجمعة غير مشروع، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم :
وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ما يبطل ما قالوا، لان المراد وقت الاداء ووقت الوجوب، فعلى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء الظهر فهو مخالف للنص.
ومنهم من قال المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت، وهكذا القول في الزكاة إذا عجلها قبل الحول، واستدل عليه بما قال محمد رحمه الله في الزيادات: إذا عجل شاة أربعين ودفعها إلى الساعي ثم تم الحول وفي يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد المدفوع من الساعي، وإن كان الساعي تصدق به كان تطوعا له، ولو تم الحول وفي يده تسع وثلاثون وجبت عليه الزكاة إذا كان المؤدى قائما في يد الساعي بعينه وجاز عن الزكاة، وهذا ضعيف أيضا، فالاداء لا يصح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة، ولو نوى الفرض صحت نيته، ولو نوى النفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة، فلو كان حكم المؤدى التوقف لاستوت فيه النيتان، ولتأدى بمطلق نية الصلاة، والقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قويا في الصلاة والزكاة جميعا، وكان الكرخي رحمه الله يقول: المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو بالفعل، لان الوجوب إنما لا يثبت بأول الوقت لانعدام الدليل المعين لذلك الجزء في كونه سببا وبفعل الاداء يحصل التعيين، فيكون
المؤدى واجبا، بمنزلة ما لو باع قفيزا من صبرة يتعين البيع في قفيز بالتسليم، ولو أدى شاة من أربعين في الزكاة يتعين المؤدى واجبا بالاداء، والحانث باليمين إذا كفر بأحد الاشياء يتعين ذلك واجبا بأدائه، وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلنا، ففي هذه الفصول الوجوب ثابت بأصل السبب قبل تعين الواجب بالاداء فكذلك هنا الوجوب ثابت بإدراك الجزء الاول من الوقت والتعيين يحصل بالاداء، وهذا لانه لا يمكن إثبات حكم الوجوب بعد الاداء مقصورا على الحال، لانه إنما يجب على المرء ما يفعله لا ما قد فعله، وإذا تقدم الوجوب على الفعل ضرورة يتحقق به ما قلنا إن الوجوب وصحة الاداء يثبت بالجزء الاول من الوقت.
ثم قال الشافعي رحمه الله: لما تقرر الوجوب لزمه الاداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض من حيض أو سفر، وقلنا
نحن: الاداء إنما يجب بالطلب، ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته في حجر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه، لان حصوله في حجره كان بغير صنعه ؟ فكذلك ههنا الوجوب تسببه كان جبرا إذ لا صنع للعبد فيه فإنما يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له الحق في الاداء ما لم يتضيق الوقت، يقرره أن وجوب الاداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة، فإن البيع بثمن مؤجل يوجب الثمن في الحال، إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي الاجل لم يصح البيع، ثم وجوب الاداء يكون متأخرا إلى حلول الاجل فههنا أيضا وجوب الاداء يتأخر إلى توجه المطالبة، وذلك باعتبار استطاعة تكون مع الفعل فقبل فعل الاداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقطع به الخيار، والدليل عليه أن النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما، ثم الخطاب بالاداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والافاقة.
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذي يتصل به الاداء من الوقت، فإن اتصل
بالجزء الاول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثاني ثم إلى الثالث هكذا لمعنيين: أحدهما أن في المجاوزة عن الجزء الذي يتصل به الاداء في جعله سببا لا ضرورة وليس بين الادنى والكل مقدار يمكن الرجوع إليه، والثاني أنه إذا لم يتصل الاداء بالجزء الذي تتعين به السببية يكون تفويتا، كما إذا لم يتصل الاداء بالجزء الاخير من الوقت يكون تفويتا حتى يصير دينا في الذمة ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت، لان الشرع خيره في الاداء، فعرفنا أن هذا المعنى تخيير له في نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي الوقت واسعا يبقى هذا الخيار له فلا يكون مفرطا، ولهذا لا يلزمه شئ إذا مات، ولا إذا حاضت المرأة، لان الانتقال يتحقق في حقها لبقاء خيارها، والجزء الذي تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب عليها الصلاة، والجزء الذي يدركه المسافر بعدما صار مسافرا لا يوجب عليه إلا ركعتين.
ثم قال زفر رحمه الله: إذا تضيق الوقت على وجه لا يفصل عن الاداء تتعين السببية في ذلك الجزء، ألا ترى أنه ينقطع خياره ولا يسعه التأخير بعد ذلك فلا يتغير بما يعترض بعد ذلك من سفر أو مرض ؟ وقلنا نحن إنما لا يسعه التأخير كي لا يفوت شرط الاداء وهو الوقت على ما بينا أن الوقت ظرف للاداء وما بعده من آخر الوقت صالح لانتقال السببية إليه فيحصل الانتقال بالطريق الذي قلنا إلى آخر جزء من أجزاء الوقت، فتتعين السببية فيه ضرورة إذا لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه، فيتحقق التفويت بمضيه ويعتبر صفة ذلك الجزء وحاله عند ذلك الجزء حتى إذا كانت حائضا لا يلزمها القضاء، وإذا طهرت عن الحيض عند ذلك الجزء وأيامها عشرة تلزمها الصلاة، نص عليه في نوادر أبي سليمان، فإذا أسلم الكافر أو أدرك الصبي عند ذلك الجزء يلزمهما الصلاة، وإذا كان مسافرا عند ذلك الجزء يلزمه صلاة السفر، ولهذا قلنا إنه إذا طلعت الشمس وهو في خلال الفجر يفسد الفرض، لان الجزء الذي
يتصل به طلوع الشمس من الوقت سبب صحيح تام فثبت الوجوب بصفة الكمال فلا يتأدى في الاداء مع النقصان، بخلاف ما إذا غربت الشمس وهو في خلال صلاة العصر فإن الجزء الذي يتصل به الغروب من الوقت في المعنى سبب فاسد للنهي الوارد عن الصلاة بعد ما تحمر الشمس، فيثبت الوجوب مع النقصان بحسب السبب وقد وجد الاداء بتلك الصفة، ولا يدخل على هذا ما إذا انعدم منه الاداء أصلا ثم أدى في اليوم الثاني بعدما احمرت الشمس فإنه لا يجوز، لانه إذا لم يشتغل بالاداء حتى مضي الوقت فحكم السببية يكون مضافا إلى جميع الوقت وهو سبب صحيح تام، وإنما يتأدى بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة، واشتغاله بالاداء يمنع صيرورته دينا في ذمته، فأما إذا لم يشتغل بالاداء حتى تحقق التفويت بمضي الوقت صار دينا في ذمته فيثبت بصفة الكمال، وهذا هو الانفصال عن الاشكال الذي يقال على هذا، وهو ما إذا أسلم الكافر بعدما احمرت الشمس ولم يصل ثم أداها في اليوم
الثاني بعدما احمرت الشمس فإنه لا يجوز لانه مع تمكن النقصان في السببية إذا مضى الوقت صار الواجب دينا في ذمته بصفة الكمال.
وما ذهب إليه زفر ضعيف، فإن من تذكر صلاة الظهر وقد بقي إلى وقت تغير الشمس مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين يمنع من الاشتغال بالاداء وإن كان وقت التذكر وقتا للفائتة بالنص، لانه لا يتمكن من الاداء قبل تغير الشمس وإذا تغيرت فسدت صلاته، فكذلك عند تضيق الوقت يؤمر بالاداء ولا يسعه التأخير، لا باعتبار أن السببية تتعين في ذلك الجزء، ولكن ليتمكن من الاداء فيما هو ظرف للاداء وهو الوقت، وهذا التمكن يفوت بالتأخير بعدها.
ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله حتى لو قال عينت هذا الجزء، إن لم يشتغل بالاداء بعده لا يتعين، لان خياره لم ينقطع وله أن يؤخر الاداء بعد
هذا القول، والتعيين من ضرورة انقطاع خياره في نقل السببية من جزء إلى جزء وذلك لا يتم إلا بفعل الاداء كالمكفر إذا قال عينت الطعام للتكفير به لا يتعين ما لم يباشر التكفير به، ولا معنى لقول من يقول إن نقل السببية من جزء إلى جزء تصرف في المشروعات وليس ذلك إلى العبد، لان الشرع لما خيره فقد جعل له هذه الولاية فيثبت له حق التصرف بهذه الصفة، لان الشرع قد ولاه ذلك كما ثبت له ولاية الايجاب فيما كان مشروعا غير واجب بنذره.
ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه، لان الوقت ظرف للاداء، وللواجب أركان معلومة يؤديها بمنافع هي حقه وبعد الوجوب بقيت المنافع حقا له أيضا فكان له أن يتصرف فيها بالصرف إلى أداء واجب آخر، بمنزلة من دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه في هذا اليوم فإنه يستحق على الخياط إقامة العمل ولا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم، لان منافعه بقيت حقا له بعد ما استحق عليه خياطة الثوب بالاجارة.
ومن حكمه أنه لا يتأدى إلا بالنية لان صرف ما هو حقه من المنافع إلى أداء الواجب عليه لا يكون إلا بالنية.
ومن حكمه اشتراط تعيين النية فيه، لان منافعه لما بقيت على صفة يصلح لاداء فرض الوقت وغيره من الصلوات بها لم يتعين فرض الوقت ما لم يعينه بالنية، واشتراط تعيين الوقت لاصابة فرض الوقت حكم ثبت شرعا فلا يسقط ذلك بتقصير يكون من العبد في الاداء حتى إذا تضيق الوقت على وجه لا يسع إلا لاداء الفرض أو لا يسع له أيضا لا يسقط اعتبار نية التعيين فيه بهذا المعنى.
وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له كصوم رمضان، لان ركن الصوم هو الامساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت معيارا له بمنزلة الكيل
في المكيلات.
ومن حكمه أن الامساك الذي يوجد منه في الايام من شهر رمضان لما تعين لاداء الفرض لم يبق غيره مشروعا فيه، إذ لا تصور لاداء صومين بإمساك واحد، وما يتصور في هذا الوقت لا يفضل عن المستحق بحال فلا يكون غيره مشروعا فيه مستحقا ولا متصور الاداء شرعا.
ثم قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يستوي في هذا الحكم المسافر والمقيم، لان وجوب صوم الشهر يثبت بشهود الشهر في حق المسافر ولهذا صح الاداء، إلا أن الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع المشقة عنه، فإذا ترك الترخص كان هو والمقيم سواء فيكون صومه عن فرض رمضان فتلغو نيته لتطوع أو لواجب آخر.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا نوى المسافر واجبا آخر صح صومه عما نوى، لان انتفاء صوم آخر في هذا الزمان ليس من حكم الوجوب واستحقاق الاداء بمنافعه فذلك موجود فيما كان الوقت ظرفا له، بل هو من حكم تعينه مستحقا للاداء فيه ولا تعين في حق المسافر فهو مخير بين الاداء أو التأخير إلى عدة من أيام أخر، فلا تنفي صحة أداء صوم آخر منه بهذا الامساك، ولان الوجوب وإن ثبت في حقه ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت في حقه أيضا وهو ما ترك الترخص حين
ما صرف الامساك إلى ما هو دين في ذمته فإن ذلك أهم عنده، وإذا كان هو بالفطر مترخصا لان فيه رفقا ببدنه فلان يكون في صرفه إلى واجب آخر مترخصا لانه نظر منه لدينه كان أولى، وعلى الطريق الاول إذا نوى النفل كان صائما عن النفل، وعلى الطريق الثاني يكون صائما عن الفرض لانه في نية النفل لا يكون مترخصا بالصرف إلى ما هو الاهم، وفيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله.
فأما المريض إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجب آخر أو نوى النفل،
لان الرخصة في حق المريض إنما تثبت إذا تحقق عجزه عن أداء الصوم، وإذا صام فقد انعدم دليل سبب الرخصة في حقه فكان هو كالصحيح، وأما الرخصة في حق المسافر، باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر، وذلك لا ينعدم بفعل الصوم فيبقى له حق الترخص وهو في نيته واجبا آخر مترخص كما بيناه.
وقال زفر رحمه الله: ولما تعين صوم الفرض مشروعا في هذا الزمان وركن الصوم هو الامساك فالذي يتصور فيه من الامساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة على عزيمة منه، بل على أي وجه أتى به يكون من المستحق، كمن استأجر خياطا ليخيط له ثوبا بعينه بيده فسواء خاطه على قصده الاعانة أو غيره يكون من الوجه المستحق، ومن عليه الزكاة في نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للزكاة وإن لم ينو لهذا المعنى.
ولكنا نقول مع تعين الصوم مشروعا منافعه التي توجد في الوقت باقية حقا له وهو مأمور بأن يؤدي بما هو حقه ما هو مستحق عليه من العبادة، وذلك بأداء يكون منه على اختيار فلا يتحقق ذلك بدون العزيمة، لانه ما لم يعزم على الصوم لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم العزم ليس بشئ، وإنما لا يتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لانه غير مشروع في هذا الوقت، كما لا يتحقق منه أداء صوم بالليل لانه غير مشروع فيه، بخلاف الاجير ففي أجير الواحد المستحق منافعه بعينه وفي الاجير المشترك المستحق هو الوصف
الذي يحدث في الثوب بعمله وذلك لا يتوقف على عزم يكون منه، وبخلاف الزكاة فالمستحق صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى وقد تحقق ذلك، فالهبة صارت عبارة عن الصدقة في حقه مجازا، لان المبتغى بها وجه الله تعالى دون العوض من المصروف إليه.
وقال الشافعي: لا يتحقق صرف ماله إلى ما هو مشروع في الوقت مستحقا ما لم يعينه
في عزيمته، لان معنى القربة معتبر في الصفة كما هو معتبر في الاصل، فكما تشترط عزيمته في أداء أصل الصوم ليتحقق معنى العبادة يشترط ذلك في وصفه ليكون له اختيار في الصفة كما في الاصل، ومن قال بنية النفل يصير مصيبا للمشروع فقد أبعد، لانه لو اعتقد هذه الصفة في المشروع في هذا الوقت كفر بربه فكيف يصير بهذه العزيمة مصيبا للمشروع ؟ ولكنا نقول: لما كان المشروع في هذا الوقت من الصوم الذي يتصور أداؤه منه واحدا عينا كان هو بالقصد إلى الصوم مصيبا له، فالواحد المعين في زمان أو مكان يصاب باسم جنسه كما يصاب باسم نوعه، وكان هذا في الحقيقة منا قولا بموجب العلة أن تعيين المستحق في العزيمة لا بد منه، ولكن هذا التعيين يحصل بنية الصوم، لا أن نقول التعيين غير معتبر ولكن لا يشترط عزيمته في الوصف مقصودا، لان بعد وجود أصل الصوم منه في هذا الزمان لا اختيار له في صفته، ولهذا لا يتصور أداؤه بصفة أخرى شرعا، فأما إذا نوى النفل فهذا الوصف من نيته لغو، لان النفل غير مشروع فيه كما تلغو نية أداء الصوم في الليل لانه غير مشروع فيه، وكما تلغو نية الفرض خارج رمضان ممن لا فرض عليه، وإنما يعتبر من نيته عزيمة أصل الصوم وهو مأمور بأن يعتقد في صوم المشروع أنه صوم، فبه يكون مصيبا للمشروع، وعلى هذا نقول فيمن نذر الصوم في وقت بعينه خارج رمضان إنه يتأدى منه بمطلق النية ونية النفل، لان المشروع في الوقت قبل نذره عين وهو النفل وقد جعل له الشرع ولاية جعل المشروع واجبا بنذره، فبمطلق النية يكون مصيبا للمشروع وهو المنذور بعينه، ونية النفل منه بعد النذر لغو،
لانه لما صار واجبا بنذره لم يبق نفلا في حقه، فأما إذا نوى واجبا آخر كان عن ذلك الواجب، لان المشروع في الوقت قبل نذره كان صالحا لاداء واجب آخر به إذا صرفه إليه بعزمه، وتلك الصلاحية لا تنعدم بنذره، لان تصرف الناذر صحيح في محل
حقه، وذلك في جعل ما كان مشروعا له نفلا واجبا بنذره، فأما نفي الصلاحية فليس من حقه في شئ فلا يعتبر تصرفه فيه، وإذا بقيت الصلاحية تأدي الواجب الآخر به عند عزمه بخلاف شهر رمضان فقد انتفى فيه صلاحية الامساك لاداء صوم آخر سوى الفرض شرعا فتلغو نيته لواجب آخر كما تلغو نية النفل.
وقال الشافعي: صرف الامساك الذي يتصور منه في نهار رمضان إلى صوم الفرض مستحق عليه من أول النهار إلى آخره ولا يتحقق هذا الصرف إلا بعزيمته، فإذا انعدمت العزيمة في أول النهار لم يكن ذلك الجزء مصروفا إلى الصوم، وهو بالعزيمة بعد ذلك إنما يكون صارفا لما بقي لا لما مضى، والصوم منه لا يتحقق فيما مضى، ولهذا لو نوى بعد الزوال لا يصح، ولا صحة لما بقي بدون ما مضى، ألا ترى أن الاهلية لاداء الفرائض تشرط من أول النهار إلى آخره فرجحت المفسد على المصحح إذا انعدمت النية في أول النهار أخذا بالاحتياط في العبادة، بخلاف النفل فهو غير مقدر شرعا، وأداؤه موكول إلى نشاطه فيتأدى بقدر ما يؤديه، مع أن هناك لو رجحنا المفسد فاته الاداء لا إلى خلف فرجحنا المصحح لكيلا يفوته أصلا وههنا يفوته الاداء إلى خلف، وهذا بخلاف ما إذا قدم النية فإن ما تقدم منه من العزيمة يكون قائما حكما إذا جاء وقت الاداء، وفي هذا المعنى أوله وآخره سواء، فتقترن العزيمة بأداء الكل حكما، ألا ترى أن صوم
القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال ؟ ولكنا نقول ما يتأدى به هذا الصوم في حكم شئ واحد فإنه لا يحتمل التجزي في الاداء، وبالاتفاق لا يشترط اقتران النية بأداء جميعه، فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع في الصوم يتأدى صومه، ولا يشترط اقترانه بأول حالة الاداء، فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه عند ابتداء الاداء بالنوم، فأما أن يكون ابتداء حال الصوم في أنه يسقط اعتبار العزيمة
فيه بمنزلة الدوام في الصلاة أو يكون حال الابتداء معتبرا بحال الدوام وكان ذلك لدفع الحرج، فوقت الشروع في الاداء ههنا مشتبه بحرج المرء في الانتباه في ذلك الوقت، ثم لا يندفع هذا الحرج بجواز تقديم النية في جنس الصائمين، ففيهم صبي يبلغ ومجنون يفيق في آخر الليل، وفي يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبين، ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تبين، وإذا بقي معنى الحرج قلنا: لما صح الاداء بنية متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع ولا حالة الاداء فلان تصح بنية متأخرة لاقترانها بما هو ركن الاداء كان أولى.
وتبين بهذا أن الموجود من الامساك في أول النهار لم يتعين للفطر، لانه بقي متمكنا من جعل الباقي صوما بعزيمته، والواحد الذي لا يتجزى في حكم لا ينفصل بعضه من بعض، فمن ضرورة بقاء الامكان فيما بقي بقاؤه فيما مضى حكما بأن تستند العزيمة إليه لتوقف الامساك عليه ولكن هذا إذا وجدت العزيمة في أكثر الركن، لان الاكثر بمنزلة الكمال من وجه، فكما أنه ما بقي الامكان في صرف جميع الركن إلى ما هو المستحق بعزيمته يبقى حكم صحة الاداء، فكذلك إذا بقي الامكان في صرف أكثر الركن إلى ما هو المستحق عليه بعزيمته، لان الكل من وجه يجوز إقامته مقام الكل من جميع الوجوه حكما، وفيه أداء العبادة في وقتها فيكون
المصير إليه أولى من المصير إلى التفويت لانعدام صفة الكمال من جميع الوجوه، وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة، فهي حالة تبتنى على وجود الاصل، والترجيح بإيجاد أصل الشئ أولى بالمصير إليه من الترجيح بالصفة، والصفة تتبع الاصل ولا يتبع الاصل الصفة، وعلى هذا نقول في المنذور في وقت بعينه إنه يتأدى بمثل هذه العزيمة، لانه بهذه العزيمة يكون مؤديا للمشروع قبل نذره، والمشروع في الوقت بعد نذره على ما كان عليه من قبل فيصير مؤديا له بهذه العزيمة أيضا
وفي أدائه وفاء بالمنذور، وكذلك في صوم القضاء يصير مؤديا للمشروع في الوقت بهذه العزيمة وهو النفل.
وأما القضاء فهو مستحق في ذمته لا اتصال له بالوقت قبل أن يعزم على صرف المشروع في الوقت إليه فلم يتوقف إمساكه في أول النهار عليه ولم يزل تمكنه من أداء ما في ذمته بعزيمة تقترن بالجميع من كل وجه، ولهذا لا نصير إلى اعتبار الكل من وجه واحد فيه، ولهذا شرطنا الاهلية في جميع النهار لان مع انعدام الاهلية في أول النهار لا يثبت استحقاق الاداء، والمصير إلى طلب الكمال من وجه لتقرر استحقاق الاداء، فإذا لم توجد تلك الاهلية في أول النهار لم نشتغل بطلب الكمال من وجه، ألا ترى أنه يشترط وجود الاهلية للعبادة عند النية وإن سبقت وقت الاداء ولم يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن الاداء ؟ وعلى هذا الاصل قلنا في صوم النفل إنه لا يتأدى بدون العزيمة قبل الزوال، لان الركن الذي به يتأدى الصوم كما لا يتجزى وجوبا لا يتجزى وجودا ولا يتصور الاداء إلا بكماله، وصفة الكمال لا تثبت بالنية بعد الزوال حقيقة ولا حكما، وتثبت بالنية قبل الزوال حكما باعتبار إقامة الاكثر مقام الكل، ولم يرد على ما قلنا الامساك الذي يندب إليه المرء في يوم الاضحى إلى أن يفرغ من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم، وإنما ندب إليه ليكون أول ما يتناوله في هذا اليوم من القربان والناس أضياف الله تعالى يتناول
القربان في هذا اليوم وإلا حسن أن يكون أول ما يتناول منه الضيف طعام الضيافة، ولهذا ثبت هذا الحكم في حق أهل الامصار دون أهل السواد فلهم حق التضحية بعد طلوع الفجر، وليس لاهل المصر أن يضحوا إلا بعد الصلاة.
ومن هذا الجنس صوم الكفارة والقضاء، فالوقت معيار له على معنى أن مقداره يعرف به ولكنه ليس بسبب لوجوبه، بخلاف صوم رمضان فالوقت هناك معيار وسبب الوجوب على ما نبينه في بابه، ولهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم
واحد، وأداء كفارتين بالصوم في شهرين، لان الوقت معيار بمنزلة الكيل للمكيل فكما لا يتحقق قفيزان في قفيز واحد في حالة واحدة، لا يتحقق صوم يومين في يوم واحد.
ومن حكم هذا النوع أنه لا يتأدى بدون العزيمة منه على الاداء في جميع الوقت وأنه لا يتحقق الفوات فيه ما بقي حيا، وقد قررنا هذا فيما سبق.
وأما القسم الثالث، وهو المشكل فوقت الحج، وبيان الاشكال فيه أن الحج عبادة تتأدى بأركان معلومة، ولا يستغرق الاداء جميع الوقت، فمن هذا الوجه (يشبه الصلاة ولا يتصور من الاداء في الوقت في سنة واحدة إلا حجة واحدة فمن هذا الوجه) يشبه الصوم الذي يكون الوقت معيارا له وفي وقته اشتباه أيضا، فالحج فرض العمر ووقته أشهر الحج من سنة من سني العمر، وأشهر الحج من السنة الاولى تتعين على وجه لا تفضل عن الاداء، وباعتبار أشهر الحج من السنين التي يأتيها الوقت تفضل عن الاداء، وكون ذلك من عمره محتمل في نفسه فكان مشتبها، ثم يترتب على ما قلنا حكمان: صحة الاداء باعتبار الوقت، ووجوب التعجيل بكون الوقت متعينا، وفي أحد الحكمين اتفاق حتى إنه يكون مؤديا في أي سنة أداه للتيقن بكون ذلك من عمره ولاتساع الوقت بإدراكه، وفي الحكم الثاني اختلاف، فعند أبي يوسف رحمه الله الوقت متعين قبل إدراك السنة الثانية فلا يسعه التأخير، وعند محمد رحمه الله الوقت غير متعين ما بقي حيا فيسعه التأخير بشرط أن لا يفوته.
ومن حكمه أنه بعدما لزمه الاداء بالتمكن منه يصير مفوتا بالموت قبل الاداء حتى يؤمر بالوصية بأن يحج عنه، بخلاف الصلاة فإن هناك بعد التمكن من الاداء لا يصير مفوتا إذا مات في الوقت قبل الاداء، لان الوقت هنا مقدر بعمره فبموته يتحقق مضي الوقت وقد تمكن من الاداء فإذا أخر حتى مضي الوقت كان مفوتا،
وهناك الوقت مقدر بزمان لا ينتهي ذلك بموته فلا يكون هو مفوتا بتأخير الاداء وإن مات لبقاء الوقت فلهذا لا يلزمه شئ، ويكون آثما هنا إذا مات بعد التمكن بتأخير الاداء.
أما عند أبي يوسف رحمه الله فلان وقت الاداء كان متعينا فالتأخير عنه كان تفويتا، وعند محمد رحمه الله إباحة التأخير له كان مقيدا بشرط وهو أن يؤديه في عمره، فإذا انعدم هذا الشرط كان آثما في التأخير، لانه تبين بموته أن الوقت كان عينا وأن التأخير ما كان يسعه بعد التمكن من الاداء.
ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل.
أما عند محمد رحمه الله فلان وقت الاداء من عمره متسع يفضل عن الاداء فهو كوقت الصلاة، وعند أبي يوسف رحمه الله وقت الاداء وإن كان متعينا فالاداء يكون بأركان معلومة فيكون بمنزلة الصلاة بعد ما تضيق الوقت بها، ثم وقت أداء النفل ووقت أداء الفرض في الحج غير مختلف فتصح منه العزيمة على أداء النفل فيه وبه تنعدم العزيمة على أداء الفرض، وبدون العزيمة لا يتأدى، بخلاف الصوم فلا تصور لاداء النفل هناك في الوقت المعين لاداء الفرض، فتلغو نية النفل هناك ويكون مؤديا للفرض بعزيمة أصل النية.
وقال الشافعي: أنا الغي نيته النفل منه أيضا لانه نوع سفه، فالحج لا يتأدى إلا بتحمل المشقة وقطع المسافة، ولهذا لم يجب في العمر إلا مرة، فنية النفل قبل أداء الفرض تكون سفها والسفيه عندي محجور عليه فتلغو نية النفل بهذا الطريق ولكن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نيته الحج لان الصفة تنفصل عن الاصل في هذه العبادة، ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة لا ينعدم أصل الاحرام، بخلاف الصوم فالصفة هناك لا تنفصل عن الاصل، ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة ينعدم أصل الصوم مع أن الحج قد يتأدى من غير عزيمة كالمغمى عليه يحرم عنه أصحابه فيصير هو محرما،
والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد العزيمة منهما.
ولكنا نقول: الواجب
عليه أداء ما هو عبادة والمؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف لا يتحقق بدون اختيار يكون منه بالعزم على الاداء، وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل يكون أبلغ من إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل العزيمة، وفي إثبات الحجر بالطريق الذي قاله انتفاء اختياره وجعله مجبورا فيه وهذا ينافي أداء العبادة فيعود هذا القول على موضوعه بالنقض، وأما الاحرام فعندنا شرط الاداء بمنزلة الطهارة للصلاة، ولهذا جوزنا تقديمه على وقت الحج، أو أقمنا هناك دلالة الاستعانة مقام حقيقة الاستعانة عند الحاجة استحسانا، فيصير العزم به على أداء الفرض موجودا حكما، وهذا المعنى ينعدم عند العزم على النفل.
ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسقط اشتراط نية التعين فيه فإن الوقت لما كان قابلا لاداء الفرض والنفل فيه لا بد من تعيين الفرض ليصير مؤدى، ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الانسان في العادة لا يتحمل المشقة العظيمة ثم يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة الاسلام، ودلالة العرف يحصل التعيين بها ولكن إذا لم يصرح بغيرها، فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف، كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف، فإن صرح باشتراط نقد آخر عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما صرح به.
فصل: في بيان حكم الواجب بالامر وذلك نوعان: أداء، وقضاء.
فالاداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه، قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) وقال عليه السلام: أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والقضاء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقه، قال عليه السلام: خيركم أحسنكم قضاء.
وقال: رحم الله امرأ سهل البيع والشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء ويتبين هذا في المغصوب
رد الغاصب عينه تسليم نفس الواجب عليه بالغصب، ورد المثل بعد هلاك العين إسقاط الواجب بمثل من عنده، فيسمى الاول أداء والثاني قضاء لحقه، وقد يدخل النفل في قسم الاداء على قول من يقول مقتضى الامر الندب أو الاباحة، لانه يسلم عين ما ندب إلى تسليمه، ولا يدخل في قسم القضاء، لانه إسقاط الواجب بمثل من عنده ولا وجوب هناك، وقد تستعمل عبارة القضاء في الاداء مجازا لما فيه من إسقاط الواجب، قال الله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) وقال تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) وقد تستعمل عبارة الاداء في القضاء مجازا لما فيه من التسليم إلا أن حقيقة كل عبارة ما فسرناها به، ففي الاداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم عين الواجب، وليس في القضاء من معنى الاستقصاء وشدة الرعاية شئ، بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من المأمور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام المأمور به بعد فواته.
واختلف مشايخنا في أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به الاداء أم بدليل آخر غير الامر الذي به وجب الاداء ؟ (فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الامر الذي به وجب الاداء) لان الواجب بالامر أداء العبادة ولا مدخل للرأي في معرفة العبادة، فإذا كان نص الامر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك الوقت، ومعنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الامر، وفي المقيد بالوقت لا تصور لذلك بعد فوات الوقت، عرفنا أن الوجوب بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى في الصوم (فعدة من أيام أخر) وقوله عليه السلام في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يوضحه أن الاداء بفعل من المأمور والفعل الذي يوجد منه في وقت غير الفعل الذي يوجد منه في وقت آخر فإذا كان الامر مقيدا بوقت لا يتناول فعل الاداء في وقت آخر، كمن استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضي ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لاقامة العمل بحكم ذلك العقد، وهذا لان في التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة
الوقت وذلك لا يحصل بالاداء بعد مضي الوقت، فعرفنا أنه إن فات بمضي الوقت
فإنما يفوت على وجه لا يمكن تداركه، فلا يجب القضاء إلا بدليل آخر.
وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الاداء عند فواته وهو الاصح، فإن الشرع لما نص على القضاء في الصلاة والصوم كان المعنى فيه معقولا وهو أن مثل المأمور به في الوقت مشروع حقا للمأمور بعد خروج الوقت، وخروج الوقت قبل الاداء لا يكون مسقطا لاداء الواجب في الوقت بعينه بل باعتبار الفوات فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات وهو فضيلة الوقت، فلا يبقى ذلك مضمونا عليه بعد مضي الوقت إلا في حق الاثم إذا تعمد التفويت، فأما في أصل العبادة التفويت لا يتحقق بمضي الوقت لكون مثله مشروعا فيه للعبد متصور الوجود منه حقيقة وحكما، وما يكون سقوطه للعجز بسبب الفوات يتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات فيبقى هو مطالبا بإقامة المثل من عنده مقام نفس الواجب بالامر وهو الاداء في الوقت، وإذا عقل هذا المعنى في المنصوص عليه تعدى به الحكم إلى الفرع وهي الواجبات بالنذر الموقت من الصوم والصلاة والاعتكاف، وهذا أشبه بأصول علمائنا رحمهم الله فإنهم قالوا: لو أن قوما فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة، ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار فقضوها بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة، ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الاقامة صلى ركعتين، ولو فاتته حين كان مقيما فقضاها في السفر صلى أربعا، وهذا لان الاداء صار مستحقا بالامر في الوقت، ونحن نعلم أنه ليس المقصود عين الوقت، فمعنى العبادة في كونه عملا بخلاف هوى النفس، أو في كونه تعظيما لله تعالى وثناء عليه، وهذا لا يختلف باختلاف الاوقات، وبعدما صار مضمون التسليم لا يسقط ذلك عنه بترك الامتثال بل يتقرر به حكم الضمان إلا أن بقدر ما يتحقق العجز عن أدائه بالمثل الذي هو قائم مقامه يسقط ضرورة وما وراء ذلك يبقى، ولهذا قلنا: من فاتته صلاة من أيام التكبير فقضاها بعد أيام التكبير لم يكبر عقيبها، لان الجهر بالتكبير دبر الصلاة غير مشروع
للعبد في غير أيام التكبير بل هو منهي عنه لكونه بدعة، فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط، أصل الصلاة مشروع له بعد أيام التكبير فيبقى الواجب
باعتباره، وكذلك من فاتته الجمعة لم يقضها بعد مضي الوقت، لان إقامة الخطبة مقام ركعتين غير مشروع للعبد في غير ذلك الوقت، فبمضي الوقت يتحقق العجز فيه وتلزمه صلاة الظهر، لان مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت.
ومن نصر القول الاول استدل بما ذكره محمد رحمه الله في الجامع أن من نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف ثم قضى اعتكافه في الرمضان الثاني لا يجزيه عن المنذور، ولو كان وجوب القضاء بما وجب به الاداء وهو الامر بالوفاء بالنذر لجاز، لان الثاني مثل الاول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه وصحة أداء الاعتكاف به، فعرفنا أنه إنما لم يجز لان وجوب القضاء بدليل آخر وهو تفويت الواجب في الوقت عند مضيه على وجه هو مقدور فيه، وهذا السبب يوجب الاعتكاف دينا في ذمته فيلتحق باعتكاف يجب بالنذر مطلقا عن الوقت، فلا يتأدى بالاعتكاف في رمضان.
ولكنا نقول: أصل النذر أوجب عليه الاعتكاف، ولوجوب الاعتكاف أثر في وجوب الصوم باعتبار أنه شرط فيه وشرط الشئ تابع له فموجب الاصل يكون موجبا لتبعه إلا أنه امتنع وجوب الصوم به لعارض على شرف الزوال وهو اتصاله بوقت لا يجوز أن يجب الصوم فيه بإيجاب من العبد، فبمضي الوقت قبل أن يعتكف زال هذا الاتصال وتحقق وجوب الصوم لوجوب الاعتكاف في ذمته، ثم الصوم الواجب في الذمة لا يتأدى بصوم رمضان، وإنما لم يجب عليه الصوم لاتصال حكم الاداء بصوم رمضان وقد انقطع ذلك حين صام في الرمضان الاول ولم يعتكف حتى إنه لو لم يصم ولم يعتكف ثم اعتكف في قضاء الصوم خرج عن عهدة المنذور لبقاء الاتصال حين لم يصم في رمضان، وإن تحقق مضي الوقت، وبهذا تبين فساد ما ذهبوا إليه لان وجوب
القضاء لو كان بدليل آخر كان سببا آخر، والنذر بالاعتكاف ما كان متصلا به فلا يتأدى باعتباره كما لا يتأدى في الرمضان الثاني وإن صامه، يقرره أن امتناع وجوب الصوم عليه بالنذر لمعنى شرف الوقت المضاف إليه النذر، وقد بينا أن شرف الوقت يفوت بمضيه على وجه لا يمكن تداركه، فبفواته ينعدم ما كان متعلقا به وهو امتناع
وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف، حتى قال أبو يوسف رحمه الله في رواية: يبطل نذره لانه يبقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا يكون واجبا.
وقلنا يجب الصوم لوجوب الاعتكاف لان بانعدام التبع لا ينعدم الاصل، وبوجوب الاصل يجب التبع عند زوال المانع.
قال رضي الله عنه: واعلم بأن الاداء في الامر الموقت يكون في الوقت، وفي غير الموقت يكون الاداء في العمر، لان جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيما هو موقت، وهو أنواع ثلاثة: كامل، وقاصر، وأداء يشبه القضاء حكما.
فالكامل هو الاداء المشروع بصفته كما أمر به، والقاصر بأن يتمكن نقصان في صفته، وذلك مثل الصلاة المكتوبة بالجماعة فهي أداء محض، أو الاداء من المنفرد يكون قاصرا لنقصان في صفة الاداء فإنه مأمور بالاداء بالجماعة، ولهذا لا يكون الجهر بالقراءة عزيمة في حق المنفرد في صلاة الليل، لان ذلك من شبه الاداء المحض، ومن اقتدى بالامام من أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محضا، ولو اقتدى به في القعدة الاخيرة ثم قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصرا، لانه يؤديها في الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدي، لان اقتداءه بالامام فيما فرغ الامام من أدائه لا يتحقق فكان منفردا في الاداء وإن كان مقتديا في التحريمة لانه أدركها مع الامام، ولهذا لا يصح اقتداء الغير به وتلزمه القراءة وسجود السهو لو سها لكونه منفردا وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر بالقراءة.
ولو اقتدى بالامام في أول الصلاة ثم نام
خلفه حتى فرغ الامام أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الامام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء في الحكم، لان باعتبار بقاء الوقت هو مؤد، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الامام حين تحرم معه كان هو قاضيا لما فاته بفراغ الامام، ولهذا جعلناه في حكم المقتدي حتى لا تلزمه القراءة، ولو سها لا يلزمه سجود السهو، لان القضاء بصفة الاداء واجب بما وجب به الاداء فإن قيل هذا على العكس فصاحب الشرع جعل المسبوق قاضيا بقوله عليه السلام: وما فاتكم فاقضوا فكيف يستقيم جعل المسبوق مؤديا وجعل اللاحق قاضيا حكما ؟ قلنا: قد بينا أن استعمال
إحدى العبارتين مكان الاخرى مجازا جائز، وإنما سمي المسبوق قاضيا مجازا لما في فعله من إسقاط الواجب، أو سماه قاضيا باعتبار حال الامام، وإليه أشار في قوله: وما فاتكم فاقضوا ونحن إنما نجعله مؤديا أداء قاصرا باعتبار حاله، وعلى هذا الاصل قلنا لو أن مسافرا اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الاقامة وهو في موضع الاقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ، فإن كان ذلك قبل فراغ الامام من صلاته صلى أربع ركعات، وإن كان بعد فراغه صلى ركعتين إلا أن يتكلم فحينئذ يصلي أربعا، لانه بمنزلة القاضي في الاتمام حكما، ووجوب القضاء بالسبب الذي به وجب الاداء فلا يتغير إلا بما يتغير به الاصل، وقبل فراغ الامام نية الاقامة (ودخول موضع الاقامة) مغير للفرض في حق الاصل وهو الامام، فيكون مغيرا في حق من يقضي ذلك الاصل، وبعد الفراغ نية الاقامة ودخول المصر غير مغير للفرض في حق الاصل، فكذلك لا يغير في حق من يقضي ذلك الاصل إلا أن يتكلم فحينئذ ينعدم معنى القضاء لخروجه بالكلام من تحريمة المشاركة وهو المؤدي لبقاء الوقت فيتغير فرضه بنية الاقامة، ولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهين لانه مؤد إتمام صلاته أداء قاصرا، سواء تكلم أو لم يتكلم، فرغ الامام أو لم يفرغ، كانت نية الاقامة مغيرة للفرض لكونه
مؤديا باعتبار بقاء الوقت.
وأما القضاء فهو نوعان: بمثل معقول كما بينا، وبمثل غير معقول كالفدية في حق الشيخ الفاني مكان الصوم، وإحجاج الغير بماله عند فوات الاداء بنفسه لعجزه فإن ذلك ثابت بالنص، قال الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) : أي لا يطيقونه، هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الحج حديث الخثعمية حيث قالت: يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه ؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك ؟ فقالت: نعم، فقال عليه السلام: الله أحق أن يقبل ثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى،
وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق الحج وبين مباشرة أداء الحج وسقوط الواجب عن المأمور باعتبار ذلك، فأما أصل الاعمال يكون من الحاج دون المحجوج عنه فهو قضاء بمثل غير معقول وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص، ولهذا قلنا: إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الاركان لا يضمن بشئ سوى الاثم، لانه ليس لذلك الوصف منفردا عن الاصل مثل صورة ولا معنى، ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا: لا يلزمه شئ آخر لانه ليس لصفة الجودة التي تحقق فيها الفوات مثل صورة ولا معنى من حيث القيمة، فإنها لا تتقوم شرعا عند المقابلة بجنسها.
وقال محمد رحمه الله: يلزمه أداء الفضل احتياطا، لان سقوط قيمة الجودة في حكم الربا للحاجة إلى جعل الاموال أمثالا متساوية قطعا، ومعنى الربا لا يتحقق فيما وجب عليه أداؤه لله تعالى بمثله في صفة المالية حقيقة ويقوم مقامه في أداء الواجب به احتياطا، وعلى هذا نقول: رمي
الجمار يسقط بمضي الوقت لانه ليس له مثل معقول صورة ولا معنى فإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت.
فإن قيل: كيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رمي الجمار ؟ قلنا: إيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه، بل لانه جبر لنقصان تمكن في نسكه بترك الرمي، وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص، قال الله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) .
فإن قيل: فقد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان ذلك غير معقول المعنى لم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرأي ؟ قلنا لا نعدي ذلك الحكم
إلى الصلاة بالرأي، ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى معقول وإن كنا لا نقف عليه والصلاة نظير الصوم في القوة أو أهم منه، ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول فإن ما لا نقف عليه لا يكون علينا العمل به، فلاحتمال الوجه الاول يفدي مكان الصلاة ولاحتمال الوجه الثاني لا يجب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطا، لان التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة، وقال عليه السلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها ولهذا لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعا ولكنا نرجو القبول من الله فضلا.
وقال محمد في الزيادات: يجزيه ذلك إن شاء الله، وكذلك قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم: يجزيه إن شاء الله تعالى، وعلى هذا الاصل حكم الاضحية، فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول المعنى فيفوت بمضي الوقت، لان مثله غير مشروع قربة للعبد في غير ذلك الوقت.
فإن قيل: فعندكم يجب التصدق بالقيمة بعد مضي أيام النحر وما ذاك إلا باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحي به وقد أثبتم ذلك بالرأي ؟ قلنا: لا كذلك، ولكن يحتمل أن يكون المقصود بما هو الواجب في الوقت إيصال منفعة اللحم
إلى الفقراء إلا أن الشرع أمره بإراقة الدم لما فيها من تطييب اللحم وتحقيق معنى الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الاضاحي في هذه الايام، ويحتمل أن يكون المقصود إراقة الدم الذي هو نقصان للمالية عند محمد رحمه الله، وتفويت للمالية عند أبي يوسف رحمه الله، يتبين ذلك بالشاة الموهوبة إذا ضحى بها الموهوب له، فإن الواهب لا يرجع فيها عند أبي يوسف رحمه الله، وله أن يرجع فيها عند محمد رحمه الله، لانها نقصان محض إلا أن الاحتمال ساقط الاعتبار في مقابلة النص، ففي أيام النحر هو قادر على أداء المنصوص عليه بعينه فلا يصار إلى الاحتمال بإقامة القيمة مقامه، وبعد مضي أيام النحر قد تحقق العجز عن أداء المنصوص عليه، فجاء أوان اعتبار الاحتمال،
واحتمال الوجه الاول يلزمه التصدق بالقيمة، لان ذلك قربة مشروعة له في غير أيام النحر والمعنى فيه معقول والاخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل، فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم، وعلى هذا الاصل قال أبو يوسف رحمه الله: من أدرك الامام في الركوع في صلاة العيد لا يأتي بالتكبيرات في الركوع لان محلها القيام وقد فات، ومثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحقق الفوات فيه.
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الاسفل في الركوع، وبه يفارق القائم القاعد، فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات، وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد وهو مؤدي في حالة الانتقال، فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة محلا لجميع التكبيرات احتياطا، وعلى هذا لو ترك قراءة الفاتحة والسورة في الاوليين قضاها في الاخريين وجهر، لان محل أداء ركن القراءة القيام الذي هو ركن الصلاة، إلا أنه تعين القيام في الاوليين لذلك بدليل موجب للعمل وهو خبر الواحد، والقيام في الاخريين مثل القيام في الاوليين في كونه ركن
الصلاة، ولهذه المشابهة لا يتحقق الفوات ويقضي القراءة في الاخريين.
ولو قرأ الفاتحة في الاوليين ولم يقرأ السورة قضى السورة في الاخريين لاعتبار هذا الشبه أيضا، والقيام في الاخريين غير محل لقراءة السورة أداء وهو محل لقراءة السورة قضاء بالمعنى الذي بينا.
ولو قرأ السورة في الاوليين ولم يقرأ الفاتحة لم يقض الفاتحة في الاخريين لان القيام في الاخريين محل للفاتحة أداء، فلو قرأها على وجه القضاء كان مغيرا به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة الاداء، وذلك ليس في ولاية العبد، فيتحقق فوات قراءة الفاتحة بتركها في الاوليين لا إلى خلف، فلا بد من القول بسقوطها عنه، إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام مقامها.
وهذه الاقسام كلها تتحقق في حقوق العباد أيضا.
أما بيان الاداء المحض فهو في تسليم عين المغصوب إلى المغصوب منه على الوجه الذي غصبه، وتسليم عين المبيع إلى المشتري على الوجه الذي اقتضاه العقد، ويتفرع عليه ما لو باع الغاصب المغصوب
من المغصوب منه أو وهبه له وسلمه فإنه يكون أداء العين المستحق بسببه ويلغو ما صرح به، وكذلك لو أن المشتري شراء فاسدا باع المبيع من البائع بعد القبض أو وهبه وسلمه يكون أداء العين المستحق بسبب فساد البيع، وعلى هذا قلنا لو أطعم الغاصب المغصوب منه الطعام المغصوب أو ألبسه الثوب المغصوب وهو لا يعلم به فإنه يكون ذلك أداء للعين المستحق بالغصب، ويتأكد ذلك بإتلاف العين فلا يبقى بعد ذلك للمغصوب منه عليه شئ.
والشافعي أبى ذلك في أحد قوليه، لان أداء المستحق مأمور به شرعا والموجود منه غرور فلا يجعل ذلك أداء للمأمور، ولكن يجعل استعمالا منه للمغصوب منه في التناول، فكأنه تناول لنفسه فيتقرر عليه الضمان، وهذا ضعيف، فالغرور في إخباره أنه طعامه وأداء الواجب في وضع الطعام بين يديه وتمكينه منه وهما غيران، وبالقول إنما جاء الغرور بجهل المغصوب منه لا لنقصان
في تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فعله أداء لما هو المستحق، كما لو اشترى عبدا ثم قال البائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشتري وهو لا يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا بما أخبره البائع به ولكن قبضه بالاعتاق، وخبر البائع وجهل المشتري غير مؤثر في ذلك فبقي إعتاقه قبضا تاما.
ومن الاداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء المستحق بسببه حكما بطريق أن الاستبدال متعذر فيه شرعا قبل القبض، فيجعل كأن المقبوض عين ما تناوله العقد حكما وإن كان غيره في الحقيقة، لان العقد تناول الدين والمقبوض عين.
وأما الاداء القاصر وهو رد المغصوب مشغولا بالدين أو الجناية بسبب كان منه عند الغاصب، ومعنى القصور فيه أنه أداه لا على الوصف الذي استحق عليه أداؤه، فلوجود أصل الاداء قلنا إذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولي الجناية برئ الغاصب، ولقصور في الصفة قلنا إذا دفع إلى ولي الجناية أو بيع في الدين يرجع المالك على الغاصب بقيمته كأن الرد لم يوجد، فكذلك البائع إذا سلم المبيع وهو
مباح الدم، فهذا أداء قاصر، لانه سلمه على غير الوصف الذي هو مقتضى العقد، فإن هلك في يد المشتري لزمه الثمن لوجود أصل الاداء، وإن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم رجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله، لان الاداء كان قاصرا فإذا تحقق الفوات بسبب يضاف إلى ما به صار الاداء قاصرا جعل كأن الاداء لم يوجد.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الاداء قاصر لعيب في المحل، فإن حل الدم في المملوك عيب، وقصور الاداء بسبب العيب يعتبر ما بقي المحل قائما، فأما إذا فات بسبب عيب حدث عند المشتري لم ينتقض به أصل الاداء وقد تلف هنا بقتل أحدثه القاتل عند المشتري باختياره، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: استحقاق هذا
القتل كان بالسبب الذي به صار الاداء قاصرا فيحال بالتلف على أصل السبب.
ومن الاداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا فإنه قاصر باعتبار أنه دون حقه في الصفة، ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: له أن يرد المقبوض في المجلس ويطالبه بالجياد، ولو هلك المقبوض في يده قبل أن يرده لم يرجع بشئ، لان باعتبار الاصل كان فعله أداء فما لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم معنى الاداء فيه، وبعد هلاكه تعذر فسخ الاداء في الهالك، ولا يمكن إيجاب مثله لان المقبوض ملك القابض فلا يكون مضمونا عليه، وصفة الجودة منفردة عن الاصل ليس لها مثل لا صورة ولا معنى في أموال الربا فسقط حقه.
وقال أبو يوسف رحمه الله: أستحسن أن يرد مثل المقبوض (لان حقه في الصفة مرعي وتتعذر رعايته منفصلا عن الاصل فيرد مثل المقبوض) حتى يقام ذلك مقام رد العين عند تعذر رد العين، وينعدم به أصل الاداء فيطالبه بالاداء المستحق بسببه.
قال: وهذا بخلاف الزكاة فيما قبض الفقير هناك لا يمكن أن يجعل مضمونا عليه، لانه في الحكم كأنه بقبضه كفاية له من الله تعالى لا من المعطي، وبدون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة منفردة عن الاصل، ألا ترى أن المقبوض وإن كان قائما في يده لا يتمكن من رده ؟
ومن الاداء الذي هو بمنزلة القضاء حكما أن يتزوج امرأة على عبد لغيره بعينه ثم يشتري ذلك العبد فيسلمه إليها فإن ذلك يكون أداء للعين المستحق بسببه وهو التسمية في العقد، ولهذا لا يكون لها أن تمتنع من القبول، وهذا لان كون المسمى مملوكا لغير الزوج لا يمنع صحة التسمية وثبوت الاستحقاق بها على الزوج، ألا ترى أنه تلزمه القيمة إذا تعذر تسليم العين ؟ وما ذلك إلا لاستحقاق الاصل، غير أن هذا أداء هو في معنى القضاء حكما، فإن ما اشتراه الزوج قبل أن يسلم إليها مملوك له حتى لو تصرف فيه بالاعتاق ينفذ تصرفه، ولو أعتقته المرأة قبل التسليم إليها لا ينفد
عتقها، ولو كان أباها لم يعتق عليها، فهذا التسليم من الزوج أداء مال من عنده مكان ما استحق عليه، فمن هذا الوجه يشبه القضاء.
ولو قضى القاضي لها بالقيمة قبل أن يتملكه الزوج ثم تملكه فسلمه إليها لم يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية ولكن يكون مبادلة بالقيمة التي تقرر حقها فيه حتى إنها إذا لم ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجبرها على القبول، بخلاف ما قبل القضاء لها بالقيمة.
وأما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفات، فإن الغاصب يؤدي مالا من عنده وهو مثل لما كان مستحقا عليه بسبب الغصب، وهو نوعان: مثل صورة ومعنى كما في المكيل والموزون، ومثل معنى لا صورة، والمقصود جبران حق المتلف عليه، وفي المثل صورة ومعنى هذا المقصود أتم منه في المثل معنى، فلا يصار إلى المثل معنى لا صورة إلا عند الضرورة، كما لا يصار إلى المثل إلا عند تعذر رد العين، فلو أراد أداء القيمة مع وجود المثل في أيدي الناس كان للمغصوب منه أن يمتنع من قبوله، وإذا انقطع المثل من أيدي الناس فحينئذ تتحقق الضرورة في اعتبار المثل في معنى المالية وسقط اعتبار المثل صورة لتحقق فواته.
ثم قال محمد رحمه الله: تعتبر قيمته في آخر أوقات وجوده، لان الضرورة تتحقق عند انقطاعه من أيدي الناس.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: تعتبر وقت الخصومة، لان المثل قائم بالذمة حكما وأداء المثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه، فإنما تتحقق الضرورة
عند المطالبة وذلك وقت قضاء القاضي.
وقال أبو يوسف رحمه الله: بالانقطاع يتحقق الفوات وذلك غير موجب للضمان إنما الموجب أصل الغصب فتعتبر قيمته وقت الغصب، وهذا لان القيمة خلف عن رد العين، ولهذا كان قضاء والخلف إنما يكون واجبا بالسبب الذي به كان الاصل واجبا، وفيما ليس له مثل صورة يجب قيمته وقت الغصب ويكون ذلك قضاء بالمثل معنى لما تعذر اعتبار المثل صورة، حتى إن فيما يتعذر
اعتبار المثل صورة ومعنى بتحقق الفوات غير موجب شيئا سوى الاثم، وذلك بأن يغصب زوجة إنسان أو ولده فإن الاداء مستحق عليه، ولو مات في يده لم يضمن شيئا لتحقق الفوات بانعدام المثل صورة ومعنى.
وعلى هذا الاصل قلنا: المنافع لا تضمن بالمال بطريق العدوان المحض، لان ضمان العدوان مقدر بالمثل نصا، ولا مماثلة بين العين والمنفعة صورة ولا معنى، لان من ضرورة كون الشئ مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له، ثم العين لا تضمن بالمنفعة بطريق العدوان قط، فعرفنا أنه لا مماثلة بينهما، وكذلك المنفعة لا تضمن بالمنفعة، فإن الحجر المبنية على تقطيع واحد وتؤاجر بأجرة واحدة لا تكون منفعة إحداهما مثلا لمنفعة الاخرى في ضمان العدوان مع وجود المشابهة صورة ومعنى في الظاهر فلان لا يضمن المنفعة بالعين ولا مشابهة بينهما صورة ولا معنى كان أولى، وانتفاء المشابهة صورة لا يخفى.
وأما المعنى فلان المنافع أعراض لا تبقى وقتين والعين تبقى، وبين ما يبقى وبين ما لا يبقى تفاوت عظيم في المعنى، وبهذا تبين أنه لا مالية في المنفعة حقيقة، لان المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالاحراز والتمول وذلك لا يتصور فيما لا يبقى وقتين، وبهذا تبين أيضا أن الاتلاف والغصب لا يتحقق في المنفعة، فإن المعدوم ليس بشئ فلا يتحقق فيه فعل هو غصب أو إتلاف، وكما يوجد يتلاشى، وفي حال تلاشيه لا يتصور فيه الغصب والاتلاف، إلا أن الشرع في حكم العقد جعل المعدوم حقيقة من المنفعة كالموجود، أو أقام العين المنتفع به مقام المنفعة للحاجة إلى ذلك، وهذه الحاجة إنما تتحقق في العقد
فيثبت هذا الحكم فيما يترتب على العقد من الضمان جائزا كان أو فاسدا، لان الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا بنفسه ليعرف حكمه من عينه فلا بد من أن يرد حكمه إلى الجائز، ثم ضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يبتنى على التراضي لا على التساوي
نصا، والتراضي يتحقق مع انعدام المماثلة، فلهذا كان مضمونا بالعقد فاسدا كان أو جائزا، ووجوب الضمان يلزمه الخروج عنه بالاداء فيكون ذلك بحسب الامكان، يوضحه أن قوام الاعراض بالاعيان والعين يقوم بنفسه، ولا مماثلة بين ما يقوم بنفسه وبين ما يقوم بغيره، بل ما يقوم بنفسه أزيد في المعنى لا محالة، ولكن هذه الزيادة يسقط اعتبارها في ضمان العقد لوجود التراضي فاسدا كان العقد أو جائزا، ولا وجه لاسقاط اعتبار هذه الزيادة في ضمان العدوان، لان بظلم الغاصب لا تسقط حرمة ماله، فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها في حقه، ولو لم نوجب الضمان لم يهدر حق المغصوب منه بل يتأخر إلى الآخرة، وضرر التأخير دون ضرر الاهدار، وإذا ألزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافا إلينا، وإذا لم نوجب الضمان لتعذر إيجاب المثل صورة ومعنى لا يكون سقوط حق المغصوب منه في حق أحكام الدنيا مضافا إلينا، بمنزلة من ضرب إنسانا ضربا لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة بها في الدنيا.
وعلى هذا الاصل قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله عمدا قبل البرء يتخير الولي، لان القطع ثم القتل مثل الاول صورة ومعنى، والقتل بدون القطع مثل معنى، فالرأي إلى الولي في ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: القتل بعد القطع قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الاول والقتل به من الولي يكون مثلا كاملا فلا يصار إلى القطع.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا باعتبار المعنى فأما من حيث الصورة المثل الاول هو القطع ثم القتل، والقتل بعد القطع تارة يكون محققا لموجب الفعل الاول وتارة يكون ماحيا أثر الفعل الاول، حتى إذا كان القاتل غير القاطع كان القصاص في النفس على الثاني خاصة فلا يسقط اعتبار المماثلة صورة بهذا المعنى.
فأما القضاء بمثل غير معقول فهو ضمان المحترم المتقوم الذي ليس بمال بما هو مال
معنى ضمان النفس والاطراف بالمال في حالة الخطأ، فإنه ثابت بالنص من غير أن يعقل فيه المعنى، لانه لا مماثلة بين الآدمي والمال صورة ولا معنى، فالآدمي مالك للمال والمال مخلوق لاقامة مصالح الآدمي به، ثم الشرع أوجب الدية في القتل خطأ فما عقل من ذلك إلا معنى المنة على القاتل بتسليم نفسه له لعذر الخطأ، ومعنى المنة على المقتول لصيانة دمه عن الهدر وإيجاب مال يقضي به حوائجه أو حوائج ورثته الذين يخلفونه، ولهذا لا يوجبه مع إمكانه إيجاب المثل بصفته وهو القصاص، لانه هو المثل صورة ومعنى، فالمعنى المطلوب هو الحياة وفي القصاص حياة لا في المال، فإذا لم تكن هذه الحالة في معنى المنصوص عليه من كل وجه يتعذر إلحاقها به وإيجاب المال.
وعلى هذا الاصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص شيئا، لان ملك القصاص الثابت له ليس بمال فلا يكون المال مثلا له لا صورة ولا معنى، وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا باعتبار ما فوت عليه من ملك النكاح، لان ذلك ليس بمال فلا يكون المال مثلا له صورة ومعنى، وهذا لان ملك النكاح مشروع للسكن والنسل، والمال بذلة لاقامة المصالح فكيف يكون بينهما مماثلة ! وإذا تحقق انعدام المثل تحقق الفوات.
وعلى هذا الاصل قلنا شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لم يضمنوا شيئا، وكذلك المكره للولي على العفو بغير حق لا يضمن شيئا، لانه أتلف عليه ما ليس بمال متقوم ولا وجه لايجاب الضمان هنا صيانة لملكه في القصاص، فالعفو مندوب إليه شرعا وإهدار مثله لا يقبح.
وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لم يضمنوا للزوج شيئا، والمكره على الطلاق بعد الدخول كذلك، والمرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيئا، ولو جامعها ابن الزوج لا يضمن للزوج شيئا، لانه أتلف عليه ملك النكاح وذلك ليس بمال متقوم فلا يكون المال مثلا له صورة
ولا معنى، والصيانة هنا للمحل المملوك لا للملك الوارد عليه، ألا ترى أن إزالة هذا الملك بالطلاق صحيح من غير شهود وولي وعوض ؟ ولهذا قلنا إن البضع لا يتقوم عند الخروج من ملك الزوج وإن كان يتقوم عند الدخول في ملكه، لان معنى الخطر للمحل ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل بإثبات الملك فيكون متقوما لاظهار خطره، فأما وقت الخروج فهو وقت إطلاق المحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حكم التقوم فيه، ولا يدخل على ما قلنا شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا فإنهم يضمنون نصف الصداق للزوج، لانهم لا يضمنون شيئا من قيمة ما أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر المثل، ولا يضمنون شيئا منه، ولكن سقوط المطالبة بتسليم البضع قبل الدخول يكون مسقطا للمطالبة بالعوض المسمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج، فهما بالاضافة إلى الزوج بشهادتهما على الطلاق كالملزمين له نصف الصداق حكما، أو كأنهما فوتا عليه يده في ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع فيكونان بمنزلة الغاصبين في حقه.
ومن القضاء الذي هو في حكم الاداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه فأتاها بالقيمة أجبرت على القبول وكان ذلك قضاء بالمثل المسمى من عنده وهو في معنى الاداء، لان العبد المطلق معلوم الجنس مجهول الوصف، فباعتبار كونه معلوم الجنس يكون أداء للمسمى بتسليم العبد، ولهذا لو أتاها به أجبرت على القبول، ومن حيث إنه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالبة بعين المسمى فيكون تسليم القيمة قضاء في حكم الاداء فتجبر على قبولها، بخلاف العبد إذا كان بعينه (أو المكيل أو الموزون إذا كان موصوفا أو معينا لان المسمى معلوم بعينه) ووصفه فتكون القيمة بمقابلته قضاء ليس في معنى الاداء، فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم ما هو المستحق كما في ضمان الغصب على ما قررنا، والله أعلم.
فصل: في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به قال رضي الله عنه: اعلم أن مطلق مقتضى الامر كون المأمور به حسنا شرعا، وهذا الوصف غير ثابت للمأمور به بنفسه، فإنه أحد تصاريف الكلام فيتحقق في القبيح والحسن جميعا لغة كسائر التصريفات، ولا نقول إنه ثابت عقلا كما زعم بعض مشايخنا رحمهم الله، لان العقل بنفسه غير موجب عندنا.
وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله تعالى لم يأمر بالفحشاء كما نص عليه في محكم تنزيله، والامر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ الجهات، ولهذا كان مطلقة موجبا شرعا، والقبيح واجب الاعدام شرعا، فما هو واجب الايجاد شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا.
ثم هو في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في نفسه، وحسن لمعنى في غيره.
والنوع الاول قسمان: حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال، وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض الاحوال.
والقسم الثاني نوعان أيضا: حسن لمعنى في غيره وذلك مقصود في نفسه لا يحصل منه ما لاجله كان حسنا، وحسن لمعنى في غيره يتحقق بوجوده ما لاجله كان حسنا.
وأما النوع الاول من القسم الاول فهو الايمان بالله تعالى وصفاته، فإنه مأمور به، قال الله تعالى: (آمنوا بالله ورسوله) وهو حسن لعينه، وركنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان، فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال، ومتى بدله بغيره فهو كفر منه على أي وجه بدله، والاقرار حسن لعينه وهو يحتمل السقوط في بعض الاحوال.
حتى إنه إذا بدله بغيره بعذر الاكراه لم يكن ذلك كفرا منه إذا كان مطمئن القلب بالايمان، وهذا لان اللسان ليس بمعدن التصديق ولكن يعبر اللسان عما في قلبه، فيكون دليل التصديق وجودا وعدما، فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكنا من إظهاره يكون كافرا وإذا زال تمكنه من الاظهار بالاكراه
لم يصر كافرا، لان سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق بالقلب، وأن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد،
فأما في وقت التمكن تبديله دليل تبدل الاعتقاد فكان ركن الايمان وجودا وعدما، وإن كان دون التصديق بالقلب لاحتماله السقوط في بعض الاحوال.
ومن هذا النوع الصلاة، فإنها حسنة لانها تعظيم لله تعالى قولا وفعلا بجميع الجوارح، وهي تحتمل السقوط في بعض الاحوال فكانت في صفة الحسن نظير الاقرار ولكنها ليست بركن الايمان في جميع الاحوال، فالاقرار دليل التصديق وجودا وعدما والصلاة لا تكون دليل التصديق وجودا وعدما، وقد تدل على ذلك إذا أتى بها على هيئة مخصوصة، ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين يحكم بإسلامه.
ومما يشبه هذا النوع معنى: الزكاة والصوم والحج.
فالزكاة حسنة لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج بأمر الله، والصوم حسن لما فيه من قهر النفس الامارة بالسوء في منع شهوتها بأمر الله تعالى، والحج حسن بمعنى شرف البيت بأمر الله تعالى، غير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن تكون حسنة لعينها، فحاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا بصنع باشره بنفسه، وكون النفس أمارة بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا لكونها جانية بنفسها، وشرف البيت بجعل الله تعالى إياه مشرفا بهذه الصفة، فعرفنا أنها في المعنى من النوع الذي هو حسن لعينه، ولهذا جعلناها عبادة محضة، وشرطنا للوجوب فيها الاهلية الكاملة، وحكم هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب بالامر لا يسقط إلا بالاداء أو بإسقاط من الآمر فيما يحتمل السقوط.
وبيان القسم الثاني في السعي إلى الجمعة فإنه حسن لمعنى في غيره، وهو أنه يتوصل به إلى أداء الجمعة، وذلك المعنى مقصود بنفسه لا يصير موجودا بمجرد وجود المأمور
به من السعي، وحكمه أنه يسقط بالاداء إذا حصل المقصود به ولا يسقط إذا لم يحصل المقصود به حتى إنه إذا حمله إنسان إلى موضع مكرها بعد السعي قبل أداء الجمعة ثم خلى عنه كان السعي واجبا عليه، وإذا حصل المقصود بدون السعي بأن حمل مكرها إلى الجامع حتى صلى الجمعة سقط اعتبار السعي ولا يتمكن بانعدامه نقصان فيما هو المقصود، وإذا سقط عنه الجمعة لمرض أو سفر سقط عنه السعي.
ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لمعنى في غيره وهو التمكن من أداء الصلاة، وما هو المقصود لا يصير مؤدى بعينه، ولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال بغير النية، وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافر، ولا ينكر معنى القربة في الوضوء، حتى إذا قصد به التقرب، وهو من أهله، بأن توضأ وهو متوضئ كان مثابا على ذلك، وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعا كتطهير المكان والثياب، قال الله تعالى: (أن طهرا بيتي للطائفين) وقال تعالى: (وثيابك فطهر) إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة يتحقق بدون هذا الوصف وهو قصد التقرب، لان شرط أداء الصلاة أن يقوم إليها طاهرا عن الحدث، وبدون هذا الوصف يزول الحدث، وهو معنى قولنا: إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء وإن لم ينوه ولكنه لا يكون مثابا عليه، ثم حكمه حكم السعي كما بينا، إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء الجمعة، وبدون الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث، لان من شرط الجواز الطهارة عن الحدث.
وبيان النوع الآخر: في الصلاة على الميت، وقتال المشركين، وإقامة الحدود.
فالصلاة على الميت حسنة لاسلام الميت وذلك معنى في غير الصلاة مضاف إلى كسب واختيار كان من العبد قبل موته وبدون هذا الوصف يكون قبيحا منهيا عنه، يعني الصلاة على الكفار والمنافقين، قال الله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)
وكذلك القتال مع المشركين حسن لمعنى في غيره وهو كفر الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين، وذلك مضاف إلى اختياره.
وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل.
وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي، وتلك المعاصي تضاف إلى كسب واختيار ممن تقام عليه ولكن لا يتم إلا بحصول ما لاجله كان حسنا، وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالاداء وبانعدام المعنى الذي لاجله كان يجب، حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي، أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فرضيته إلا أنه خلاف للخبر، لانه لا يتحقق انعدام هذا المعنى في الظاهر.
وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو غيره، وإذا قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين.
وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وإذا
تحقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الامر يثبت النوع الثاني من الحسن ولا يثبت النوع الاول إلا بدليل يقترن به، لان ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء وإنما ثبت بهذا الطريق الادنى على ما نبينه في باب الاقتضاء، والادنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن بمطلق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه شرعا فإن الامر لطلب الايجاد وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الايجاب فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن، لانه استعباد فإن قوله: (أقيموا الصلاة) و (اعبدوني) هما في المعنى سواء، والعبادة لله تعالى حسنة لعينها، ولان ما يكون حسنا لمعنى في غيره فهذه الصفة له شبه المجاز لانه ثابت من وجه دون وجه، وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثبت الحقيقة دون المجاز، وإذا ثبت هذا قلنا: اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به كما قررنا أن مقتضى الامر حسن المأمور به حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد
جوازه شرعا، ولان مقتضى مطلقه الايجاب ولا يجوز أن يكون واجب الاداء شرعا إلا بعد أن يكون جائزا شرعا، وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الامر لا يثبت جواز الاداء حتى يقترن به دليل.
واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا، لا يكون جائزا إذا أداها على هذه الصفة، ومن أفسد حجه فهو مأمور بالاداء شرعا ولا يكون المؤدى جائزا إذا أداه، وهذا سهو منهم، فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته، نص عليه في كتاب التحري فيما إذا توضأ بماء نجس فقال صلاته جائزة ما لم يعلم فإذا علم أعاده.
فإن قيل: فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الاعادة والامر لا يقتضي التكرار ؟ قلنا: المؤدى جائز حتى لو مات قبل أن يعلم لقي الله ولا شئ عليه، فأما إذا علم فقد تبدل حاله ووجوب الاداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا، وتحقيقه أن الامر يتوجه بحسب التوسع، قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبت الامر في حقه على حسب ما يليق بحاله، ومن ضرورته
الجواز على تلك الحالة، وإذا تبدل حاله بالعلم ثبت الامر بالاداء كما يليق بحاله، ولكن لما كان له طريق يتوصل به إلى هذه الحالة إذا تحرز وأحسن النظر لم يسقط الواجب في هذه الحالة بالاداء الاول وإن كان معذورا فيه لدفع الحرج عنه، والحج بمعزل مما قلنا، فالثابت بالامر وجوب أداء الاعمال بصفة الصحة، وأما بعد الافساد فالثابت وجوب التحلل عن الاحرام بطريقه، وهذا أمر آخر سوى الاول، والمأمور به في هذا الامر مجزى، فإن التحلل بأداء الاعمال بعد الافساد جائز شرعا.
ويحكى عن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه كان يقول: صفة الجواز وإن كانت تثبت بمطلق الامر شرعا فقد تتناول الامر على ما هو مكروه شرعا أيضا، واستدل على ذلك بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس فإنه جائز مأمور به شرعا وهو مكروه أيضا وكذلك قوله
سبحانه وتعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) يتناول طواف المحدث عندنا حتى يكون طوافه ركن الحج، وذلك جائز مأمور به شرعا، ويكون مكروها.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن بمطلق الامر كما تثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة، لان الامر استعباد ولا كراهة في عبادة العبد لربه، وانتفاء الكراهة تثبت بالاذن شرعا ومعلوم أن الاذن دون الامر في طلب إيجاد المأمور به فلان يثبت انتفاء الكراهة بالامر أولى، فأما الصلاة بعد تغير الشمس والكراهة ليست للصلاة ولكن للتشبه بمن يعبد الشمس والمأمور به هو الصلاة، وكذلك الطواف الكراهة ليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت بل لوصف في الطواف وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شئ.
ثم تكلم مشايخنا رحمهم الله فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور به لقيام الدليل هل تبقى صفة الجواز أم لا ؟ فالعراقيون من مشايخنا يقولون: هو على هذا الخلاف عندنا لا تبقى، وعلى قول الشافعي تبقى، فيثبتون هذا الخلاف في قوله عليه السلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير فإن صيغة الامر بهذه الصفة توجب التكفير سابقا على الحنث وقد انعدم هذا الوجوب
بدليل الاجماع فبقي الجواز عنده ولم يبق عندنا، وحجته في ذلك أن من ضرورة وجوب الاداء جواز الاداء والثابت بضرورة النص كالمنصوص، وليس من ضرورة انتفاء الوجوب انتفاء الجواز فيبقى حكم الجواز بعدما انتفى الوجوب بالدليل، واستدل عليه بصوم عاشوراء فبانتساخ وجوب الاداء فيه لم ينتسخ جواز الاداء، ولكنا نقول: موجب الامر أداء هو متعين على وجه لا يتخير العبد بين الاقدام عليه وبين تركه شرعا، والجواز فيما يكون العبد مخيرا فيه، وبينهما مغايرة على سبيل المنافاة، فإذا قام الدليل على انتساخ موجب الامر لا يجوز إبقاء غير موجب الامر مضافا إلى الامر.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن بانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل ينتسخ الامر ويخرج من أن يكون أمرا شرعا والمصير إلى بيان موجبه ابتداء وبقاء في حال ما يكون أمرا شرعا، فأما بعد خروجه من أن يكون أمرا شرعا فلا معنى للاشتغال بهذا التكليف، وبعدما انتسخ الامر بصوم عاشوراء لا نقول جواز الصوم في ذلك اليوم موجب ذلك الامر، بل هو موجب كون الصوم مشروعا فيه للعبد كما في سائر الايام، وقد كان ذلك ثابتا قبل إيجاب الصوم فيه بالامر شرعا فبقي على ما كان، حتى إذا بقي الامر يبقى حكم الجواز عندنا، ولهذا قلنا: الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة جازت صلاته، والواجب عليه في المصر أداء الجمعة بعدما شرعت الجمعة ولكن بقي أصل أمر أداء الظهر ولهذا يلزمه بعد مضي الوقت قضاء الظهر، ولو شهد الجمعة بعد الظهر كان مؤديا فرض الوقت، فبه تبين أن الواجب أداء الجمعة دون أداء الظهر، إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجمعة، فكذلك يجب نقض الظهر المؤدي بأداء الجمعة ولهذا سوينا بذلك بين المعذور وغير المعذور، لان جواز ترك أداء الجمعة للمعذور رخصة فلا يتغير به حكم ما هو عزيمة، والله أعلم.
فصل: في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر قال رضي الله عنه: اعلم أن من شرط وجوب أداء المأمور به القدرة التي بها يتمكن المأمور من الاداء، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولان الواجب أداء ما هو عبادة، وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه ربه فينال الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة، غير أنه لا يشترط وجودها وقت الامر لصحة الامر، لانه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الامر بحال،
وإنما يتأدى بالموجود منها عند الاداء وذلك غير موجود سابقا على الاداء، فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الامر لا يمنع صحة الامر ولا يخرجه من أن
يكون حسنا بمنزلة انعدام المأمور، فإن النبي عليه السلام كان رسولا إلى الناس كافة، قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) وقال تعالى: (نذيرا للبشر) ولا شك أنه أمر جميع من أرسل إليهم بالشرائع ثم صح الامر في حق الذين وجدوا بعده ويلزمهم الاداء بشرط أن يبلغهم فيتمكنون من الاداء، قال تعالى: (لانذركم به ومن بلغ) وكما يحسن الامر قبل وجود المأمور به يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الاداء ولكن بشرط التمكن عند الاداء، ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم صفة الحسن في الامر، فإن المريض يؤمر بقتال المشركين إذا برئ فيكون ذلك حسنا، قال تعالى: (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) وهذا الشرط نوعان: مطلق، وكامل.
فالمطلق أدنى ما يتمكن به من أداء المأمور به ماليا كان أو بدنيا، لان هذا شرط وجوب الاداء في كل أمر فضلا من الله تعالى ورحمة خصوصا في حق هذه الامة فقد رفع الله عنهم الحرج ووضع عنهم الاصر والاغلال، وفي لزوم الاداء بدون هذه القدرة من الحرج والثقل ما لا يخفى، وعلى هذا وجوب الطهارة بالماء فإنه لا يثبت في حال عدم الماء لانعدام هذه القدرة، وكذلك في حال العجز عن الاستعمال إلا بحرج بأن يخاف زيادة المرض أو العطش، أو يلحقه نوع حرج في ماله بأن لا يباع منه بثمن مثله، وكذلك أداء الصلاة لا يجب بدون هذه القدرة، ولهذا كان وجوب الاداء بحسب ما يتمكن منه قائما أو قاعدا أو بالايماء، وكذلك وجوب أداء الحج لا يكون إلا بهذه القدرة بملك الزاد والراحلة، لان التمكن من السفر الذي يتوصل به إلى الاداء لا يكون إلا به، وكذلك وجوب أداء الصدقة المالية لا يكون إلا بهذا الشرط، فإنه لا يتمكن من الاداء عبادة إلا بملك المال، ولهذا لا يعتبر التمكن منه بمال غيره وإن أذن له في ذلك في وجوب الاداء، بخلاف الطهارة فصفة العبادة هناك غير مقصودة وهنا مقصودة، ومع ذلك صفة الغني في المؤدى معتبر هنا،
قال عليه السلام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى وبدون ملك المال لا تثبت صفة الغنى، ولهذا قال زفر والشافعي رحمهما الله: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت لا يلزمهم الاداء لانعدام الشرط وهو التمكن، ولكن علماءنا رحمهم الله قالوا: يلزمهم أداء الصلاة استحسانا، لان السبب الموجب جزء من الوقت وشرط وجوب الاداء كون القدرة على الاداء متوهم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق الاداء وهذا التوهم موجود ههنا لجواز أن يظهر في ذلك الجزء من الوقت امتداد بتوقف الشمس فيسع الاداء كما كان لسليمان صلوات الله عليه فيثبت وجوب الاداء به، ثم العجز عن الاداء فيه ظاهر لينتقل الحكم إلى ما هو خلف عن الاداء وهو القضاء، بمنزلة الحلف على مس السماء تنعقد موجبة للبر لتوهم الكون فيما خلف عليه، ثم بالعجز الظاهر ينتقل الواجب في الحال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة، وكذلك الحدث في وقت الصلاة ممن كان عادما للماء يكون موجبا للطهارة بالماء لتوهم القدرة عليها ثم تتحول إلى التراب باعتبار العجز الظاهر في الحال، غير أن في فصل الحائض بشرط حقيقة الطهر في جزء من الوقت بأن تكون أيامها عشرة، أو الحكم بالطهر بدليل شرعي بأن تكون أيامها دون العشرة فينقطع الدم والباقي من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه وتحرم للصلاة، وهذا لان في أوامر العباد صفة الحسن، ولزوم الاداء يثبت بهذا القدر من القدرة، فإن من قال لامرئ اسقني ماء غدا يكون أمرا صحيحا موجبا للاداء فلا يتعين للحال، فإنه يقدر على ذلك في غد، لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين التمكن من الاداء، فكذلك في أوامر الشرع وجوب الاداء يثبت بهذا القدر.
ثم هذا الشرط مختص بالاداء دون القضاء فإنه شرط الوجوب ولا يتكرر الوجوب في واجب واحد فلا يشترط بقاء هذا التمكن لبقاء الواجب ولكن إن كان الفوات بمضي الوقت لا عن تقصير
منه بقي الاداء واجبا على أن يتأتى بالخلف وهو القضاء، وإن كان عن تقصير منه
فهو متعد في ذلك وباعتبار تعديه يجعل الشرط كالقائم حكما، ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك، لان التمكن من الاداء بملك المال كان شرط وجوب الاداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط.
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للاداء وهي زائدة على الاولى بدرجة كرامة من الله تعالى، وفرق ما بينهما أنه لا يتغير بالاولى صفة الواجب فكان شرط الوجوب فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب والثانية يغير صفة الواجب فيجعلها سمحا سهلا لينا، ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب، لانه متى وجب الاداء بصفة لا يبقى الاداء واجبا إلا بتلك الصفة، ولا يكون الاداء بهذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للاداء وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الاداء، لان الشرع إنما أوجب الاداء بصفة اليسر ولهذا خصه بالمال النامي، وما أوجب الاداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء فيكون المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية في اليسر، فأما أصل التمكن من الاداء يثبت بكل مال، فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب ولا وجه لايجاب غيره إلا بسبب متجدد، ولهذا لو استهلك المال بقي عليه وجوب الاداء، لانه صار النصاب مشغولا بحق المستحق للزكاة، فالاستهلاك تعد منه على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب للغرم عليه، كالعبد الجاني إذا استهلكه مولاه وهو لا يعلم بجنايته يصير غارما لقيمته، وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا المعنى، فلوجود سبب آخر أمكن إيجاب الاداء لا بالصفة التي بها وجب ابتداء، ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بعض النصاب فإن الواجب يبقى بقدر ما بقي منه وإن كان كمال النصاب شرط الوجوب في الابتداء، لان اشتراط كمال النصاب
ليس لاجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب، فإن أداء درهم من أربعين وأداء خمسة من مائتين في معنى اليسر سواء، إذ كل واحد منهما أداء ربع العشر، ولكن شرط كمال النصاب ليثبت به صفة الغنى فيمن يجب عليه، فالمطلوب بالاداء إغناء المحتاج وإنما
يتحقق الاغناء بصفة الحسن من الغني كما يتحقق التمليك من المالك، وأحوال الناس تختلف في صفة الغنى بالمال فجعل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسيرا، ثم هذا الغنى شرط وجوب الاداء بمنزلة أدنى التمكن الذي هو شرط وجوب الاداء من غير أن يكون مغيرا صفة الواجب، فلهذا لا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب ولكن بقدر ما بقي من المال يبقى الواجب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه، وعلى هذا قلنا يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الاداء، لان القدرة الميسرة شرط الاداء فيه، فالعشر مؤونة الارض النامية ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج، فإنما يجب قليل من كثير من النماء فيكون الاداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج، وكذلك الخراج لا يبقى إذا اصطلم الزرع آفة، لان وجوب الاداء باعتبار القدرة الميسرة، ولهذا يتقدر الواجب بحسب الربع، حتى إذا قل الخارج لا يجب من الخارج أكثر من نصف الخارج إلا أن عند التمكن من الزراعة إذا لم يفعل جعلت القدرة الميسرة كالموجود حكما بتقصير كان منه في الزراعة، وذلك لا يوجد فيما إذا اصطلم الزرع آفة، فلو بقي الخراج كان غرما، ولهذا قلنا لا يسقط العشر بموت من عليه مع بقاء الخارج، لان القدرة الميسرة لاداء المالي بالمال تكون وهو باق بعد موته فيجعل هو كالحي حكما باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة التي يثبت بها الوجوب ابتداء، وكذلك الزكاة لا تسقط بموته في أحكام الآخرة، ولهذا يؤمر بالايصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد موته إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة، وباعتبار حياته حكما وبقاء المحل الذي هو خالص حقه وهو الثلث فيكون الاداء منه بصفة
اليسر إلا أنه إذا لم يوص لا يبقى في أحكام الدنيا بعد موته لان الواجب أداء العبادة، وباعتبار الخلافة التي تثبت بعد موته لا يمكن تحقيق هذا الوصف لان ذلك يثبت من غير اختيار له منه وفي العشر معنى العبادة لما لم يكن مقصودا بقي بعد موته وإن لم يوص به، وكذلك الخراج إذا حصل الخارج ثم هلك قبل أدائه، وعلى هذا قلنا إن الحانث في يمينه إذا عجز عن التكفير بالمال يجوز له أن يكفر بالصوم، لان وجوب الكفارة باعتبار القدرة الميسرة، ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا في أنواع التكفير
بالمال والواجب أحد الانواع عند أهل الفقه، بخلاف ما يقوله بعض المتكلمين أن الكل واجب لاستواء الكل في صيغة الامر والتخيير لاسقاط الواجب بما يعينه منها، ويجعلون الامر مثل قياس النهي، فإن مثل هذا التخيير في النهي لا يخرج حكم النهي من أن يكون متناولا جميع ما تناوله الصيغة فكذلك الامر، ولكنا نقول: في النهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف أو، لان ذلك في موضع النفي وحرف أو في موضع النفي يوجب التعميم، قال الله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) فأما في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الاثبات فإنما يفيد الايجاب في أحد الانواع، ألا ترى أنه لو كفر بالانواع كلها لم يكن مؤديا للواجب في جميعها ويستحيل أن يكون واجبا قبل الاداء، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واجبا ويتأدي الواجب بنوع واحد، وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفا عن غيره، ولو كان الكل واجبا لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف عنه، فعرفنا أن الواجب أحد الانواع، والتخيير ليكون الاداء بصفة اليسر، ولهذا تحول إلى الصوم عند العجز عن الاداء بالمال، والمعتبر فيه العجز للحال لا تحقق العجز بعجز مستدام في العمر، فإن في قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام) ما يدل على أنه يعتبر العجز في الحال، إذ لو اعتبر العجز في جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد
هذا العجز، وكذلك التكفير بالطعام في الظهار يعتبر العجز في الحال عن التكفير بالصوم، ولهذا لو مرض أياما فكفر بالاطعام جاز.
فتبين بهذا كله أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للاداء، وبعد هلاك المال لا يبقى ذلك لو بقي التكفير بالمال عينا فجوزنا له التكفير بالصوم، ولا تفصيل هنا بين أن يهلك المال بصنعه أو بغير صنعه، لان الواجب لا يصادف المال قبل الاداء ولا يجعل المال مشغولا به فلا يكون الاستهلاك تعديا على محل مشغول بحق المستحق، ولهذا لا يسقط بهلاك المال حتى إنه إذا أيسر بمال آخر يلزمه التكفير بالمال، لان القدرة الميسرة تثبت بملك المال ولا تختص بمال دون مال، فكان المال المستفاد فيه والمال الذي عنده سواء، ولهذا لا يعتبر فيه كون المال ناميا ولا يعتبر صفة الغنى فيمن يجب عليه، لان
الواجب ليس من نماء المال، وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة للاداء على وجه ينال الثواب بالاداء، فيكون ذلك ساترا لما لحقه لارتكاب المحظور، وفي هذا يستوي المال النامي وغير النامي، ويخرج على ما بينا أنه إذا هلك المال بعد وجوب الحج بأن كان مالكا للزاد والراحلة وقت خروج القافلة من بلدته فإنه لا يسقط عنه الحج، لان الشرط هناك أدنى التمكن دون اليسر، فاليسر في سفر الحج يكون بالخدم والمراكب والاعوان وذلك ليس بشرط، وأدنى التمكن شرط وجوب الاداء فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب.
وكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفطر، أو هلك من وجب عليه بعد وجوب الاداء فإنه لا يسقط الواجب، لان شرط الوجوب هناك أدنى التمكن وصفة الغنى فيمن يجب عليه الاداء دون اليسر، ولهذا لو ملك من مال البذلة والمهنة فضلا على حاجته ما يساوي نصابا يجب عليه، وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن والغنى إذا بلغ نصابا، فأما صفة اليسر فهو مختص بالمال النامي ليكون الاداء من فضل المال وذلك ليس بشرط هنا، فعرفنا أن التمكن والغنى
شرط وجوب الاداء باعتبار أنه غني، قال عليه السلام: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم والاغناء إنما يتحقق من الغنى، ولم يتغير صفة المؤدى بهذا الشرط فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب، وعلى هذا الاصل قلنا لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين، لان الوجوب باعتبار الغنى واليسر وذلك ينعدم بالدين، والغنى إنما يحصل بفضل عن حاجته، وحاجته إلى قضاء الدين حاجة أصلية فلا يحصل الغنى بملك ذلك القدر من المال، ولهذا حل له أخذ الصدقة وهي لا تحل لغني، وإنما تيسر الاداء إذا كان المؤدى فضل مال غير مشغول بحاجته.
وكذلك لا تجب صدقة الفطر على المديون إذا لم يملك نصابا فضلا عن دينه لان الغني يملك المال معتبر في إيجاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للمحتاج وبحاجته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الغنى، وإن كان الدين على العبد الذي هو عبد
للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر، لان صفة الغنى ثابت له بملك من النصاب سوى هذا القدر، وأصل المالية غير معتبرة فيمن يجب الاداء عنه، ولهذا تجب عن ولده الحر، وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الاداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما، فكذلك إذا كان العبد مشغولا بالدين لان ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به، ولو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة، لان الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الاداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد، ولا يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر على المديون مع اعتبار صفة اليسر في التكفير بالمال، لان المذكور في كتاب الايمان أنه إذا حنث في يمين وله ألف درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعدما يقضي دينه بالمال، ولم يتعرض لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر، فقال بعض مشايخنا: يكفر
بالصوم أيضا لان ما في يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته، وفي التكفير بالمال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير المثابت بالنص، وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم، ومنهم من يقول: يلزمه التكفير بالمال لان الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة وما أوجبت شكرا للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإنها أوجبت شكرا للنعمة والغنى، ولهذا يشترط لايجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي، وحاجته إلى قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى، ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك ساترا للاثم الذي لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة، قال تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) يوضحه أن معنى الاغناء غير معتبر في التكفير بالمال، ألا ترى أنه يحصل بالاعتاق وليس فيه إغناء، ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الاباحة وإن كان الاغناء لا يحصل به، فعرفنا أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته وتيسير الاداء قائم بملك المال مع قيام
الدين عليه، فأما في الزكاة المعتبر هو الاغناء، ولهذا لا يتأدى إلا بتمليك المال، والاغناء لا يتحقق ممن ليس بغني كامل الغنى وبسبب الدين ينعدم الغنى، ولهذا يمتنع وجوب أداء الزكاة وصدقة الفطر على المديون.
فصل: في بيان موجب الامر في حق الكفار لا خلاف أنهم مخاطبون بالايمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الايمان، قال تعالى: (قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) إلى قوله تعالى: (فآمنوا بالله ورسوله) فهذا الخطاب منه يتناولهم لا محالة.
ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها لانها تقام بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الاقدام على أسبابها، وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك ولا تنعدم الاهلية لاقامة ذلك عليه بطريقه، بل هو جزاء
وعقوبة فبالكفار أليق منه بالمؤمنين.
ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا لان المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق، فقد آثروا الدنيا على الآخرة ! ولانهم ملتزمون لذلك، فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت حكم الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين لوجود الالتزام إلا فيما يعلم لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له.
ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والاداء وهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد، فإن صحة التصديق والاقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شئ من الشرائع.
وقال محمد رحمه الله في السير الكبير: من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله، فقد ذكر بعض من لا يعتمد على قوله من أهل زماننا في تصنيف له أن المسلم إذا أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره مؤمن فيما سوى ذلك، وهو شبه المحال من الكلام يبتلى المرء بمثله لقلة التأمل
أو إعجابه بنفسه، أعاذنا الله من ذلك، ومع ذلك هو مخالف للرواية المنصوصة عن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله، فإذا ثبت أنه ترك ذلك استحلالا وجحودا يكون كفرا منه ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة كما هو معاقب على أصل الكفر، وهو المراد بقوله تعالى: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) : أي لا يقرون بها، وقال تعالى: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة.
فهذا معنى قولنا: إن الخطاب يتناولهم فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة.
فأما في وجوب الاداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من مشايخنا رحمهم الله أن الخطاب يتناولهم أيضا والاداء واجب عليهم فإنهم لا يعاقبون على ترك الاداء إذا لم يكن الاداء واجبا عليهم، وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتناع من
الاداء في الدنيا، ولان الكفر رأس المعاصي فلا يصلح سببا لاستحقاق التخفيف، ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر في حقهم، وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فيها بسببه موجود في حقهم، وشرط وجوب الاداء التمكن منه وذلك غير منعدم في حقهم، فلو سقط الخطاب بالاداء كان ذلك تخفيفا والكفر لا يصلح تخفيفا لذلك، ولا معنى لقول من يقول إن التمكن من الاداء على هذه الصفة لا يتحقق حتى لو أدى لم يكن ذلك معتدا به، لانه يتمكن به من الاداء بشرط أن يقدم الايمان والخطاب به ثابت في حقه، فهو نظير الجنب والمحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الطهارة وهو مطالب بذلك، فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه عليه الخطاب بأدائها مع أن انعدام التمكن من الاداء بإصراره على الكفر وهو جان في ذلك، فيجعل التمكن قائما حكما إذا كان انعدامه بسبب جنايته، ألا ترى أن زوال التمكن بسبب الشكر لا يسقط الخطاب بأداء العبادات، وكذلك انعدام التمكن بسبب الجهل إذا كان بتقصير منه لا يسقط الخطاب بالاداء، فبسبب الكفر أولى.
ومشايخ ديارنا يقولون إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، وجواب هذه المسألة غير محفوظ من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله نصا، ولكن
مسائلهم تدل على ذلك، فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا وتلزمه عند الشافعي والمرتد كافر.
واستدل بعض أصحابنا على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي أن تنصيص علمائنا أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الاسلام دليل على أنه لم يكن مخاطبا بأدائها في حالة الكفر وهذا ضعيف، فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الاصلي بعد الاسلام بوجود الدليل المسقط وهو قوله تعالى: (إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وقال عليه السلام: الاسلام يجب ما قبله والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب.
ومنهم من استدل على ذلك بمن
صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم في آخر الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا، لان بالردة ينعدم خطاب الاداء في حقه والاعتداد بما مضى كان بناء عليه، فإذا أسلم وقد بقي شئ من الوقت يثبت الوجوب باعتباره ويصير مخاطبا بالاداء ابتداء، وعلى قول الشافعي لا يلزمه الاداء لان الخطاب بالاداء لا ينعدم في حقه بالردة فبقي المؤدى معتدا به، وعلى هذا لو حج ثم ارتد ثم أسلم ولكن هذا ضعيف أيضا، فإن المؤدى إنما لا يكون معتدا به بعد الردة لان الردة تحبط العمل، قال الله تعالى: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) يعني ما اكتسب من العبادات وما حبط لا يكون معتدا فلهذا ألزمناه الاداء ثانيا.
ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لاصل معروف بيننا وبينهم أن الشرائع عندهم من نفس الايمان وهم مخاطبون بالايمان (فيخاطبون بالشرائع وعندنا الشرائع ليست من نفس الايمان وهم مخاطبون بالايمان) فلا يخاطبون بالاداء بالشرائع التي تبتنى على الايمان ما لم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضا، فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات وليس شئ من ذلك من نفس الايمان أيضا.
فالذي يصح من الاستدلال لمشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب لفظ مذكور في الكتاب، وهو أن من نذر أن يصوم شهرا ثم ارتد ثم أسلم فليس عليه من الصوم المنذور شئ، لان الردة تبطل كل عبادة ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة فهو ما أدى المنذور بعد، فعرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة، فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التي تحتمل السقوط لا يتناولهم
ما لم يؤمنوا.
والدليل على صحة هذا القول أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث، ففي هذا تنصيص على أن وجوب أداء الشرائع يترتب على الاجابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين، والدليل على
ذلك من طريق المعنى أن الامر بأداء العبادة لينال به المؤدي الثواب في الآخرة حكما من الله تعالى (كما وعده في محكم تنزيله والكافر ليس بأهل لثواب العبادة عقوبة له، على كفره حكما من الله تعالى) كما أن العبد لا يكون أهلا لملك المال حكما من الله تعالى والمرأة لا تكون أهلا لثبوت ملك المتعة لها على الرجل بسبب النكاح أو بسبب ملك الرقبة حكما من الله تعالى، وإذا تحقق انعدام الاهلية للكافر فيما هو المطلوب بالاداء يظهر به انعدام الاهلية للاداء، وبدون الاهلية لا يثبت وجوب الاداء وبه فارق الخطاب بالايمان، فإنه بالاداء يصير أهلا لما وعد الله المؤمنين، فبه تبين الاهلية للاداء أيضا.
فإن قيل: هو بالايمان يصير أهلا لما هو موعود على أداء العبادات وهو مطالب بالايمان فينبغي أن يجعل في حكم توجه الخطاب بالاداء عليه كأن ما هو مطالب به بالايمان موجود في حقه كما جعل النطفة في الرحم كالحي حكما في حق الارث والوصية والاعتاق ويجعل البيض كالصيد حكما في وجوب الجزاء على المحرم بكسره وإن لم يكن فيها معنى الصيدية حقيقة.
قلنا: هذا أن لو كان مآل أمره الايمان باعتبار الظاهر كالبيض والنطفة فمآلهما إلى الحياة والصيدية ما لم يفسدا، ومآل أمر الكافر ليس للايمان ظاهرا، بل الظاهر من حال كل معتقداته يستديم اعتقاده، ثم هذا المعنى إنما يستقيم اعتباره إذا كان عند إيمانه يتقرر وجوب الاداء فيما يتقرر سببه في حال الكفر، فيقال يخاطب بالاداء على أن يسلم فيتقرر وجوب الاداء كما في النطفة والبيض فإن حكم العتق والملك والصيدية يتقرر إذا تحقق صفة الحياة فيهما، وههنا ينعدم بالاتفاق، فإنه بعد الايمان لا يبقى وجوب الاداء في شئ مما سبق في حالة الكفر.
فإن قيل: أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب لملك المال وإن لم يكن أهلا لملك المال ؟ فكذلك يجوز أن يكون الكافر يخاطب بأداء العبادات وإن لم يكن
أهلا لما هو المقصود بالآداء.
قلنا: صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى
في حكمه أو على أن يتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب، فأما هنا لا تثبت أهلية الاداء في حقه على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغي بالاداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد إيمانه، وهذا بخلاف الجنب والمحدث في الخطاب بأداء الصلاة، لان الاهلية لما هو موعود للمصلين لا ينعدم بالجنابة والحدث، ولكن الطهارة شرط الاداء، وبانعدام الشرط لا تنعدم الاهلية لاداء الاصل، وما هذا إلا نظير من يقول لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتقه، يصح إعتاقه عن الآمر باعتبار أن الملك في المحل شرط الاعتاق فانعدامه عند الامر لا يمنع صحة الامر على أن يكون موجبا للحكم له إذا وجد الشرط عند إيجاد العتق.
ولو قال المولى لعبده: أعتق عن نفسك عبدا فأعتق لم يصح هذا الامر ولم يكن الاعتاق عن العبد، لانه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للاعتاق عن نفسه فلا يصح أمره إياه بالاعتاق عن نفسه مع انعدام الاهلية، وتبين بهذا أن سقوط الخطاب بالاداء عنهم ليس للتخفيف عليهم كما ظنوا بل لتحقق معنى العقوبة والنقمة في حقهم، فإن الاخراج من الاهلية لثواب العبادة يكون نقمة، يوضحه أن الامر لطلب أداء العبادة وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا للعبادة بل يحبط عمله، كما قال الله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) ومعلوم أن في العبادة المنفعة للمؤدي المأمور لا للآمر، قال الله تعالى: (ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون) والكافر لا يستحق هذا النظر والمنفعة عقوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفيف عليه ! والايجاب من الآمر نظر من الشرع للمأمور فعسى أن يقصر فيما لا يكون واجبا عليه ولا يقصر في أداء ما هو واجب عليه والكافر غير مستحق لهذا النظر، فقولنا وجوب الاداء لا يتناوله يكون تغليظا عليه لا تخفيفا، ولهذا أثبتنا حكم وجوب الاداء فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة في حقه، ثم هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حكما فيما يرجع إلى ما هو المقصود بالعبادات فيكون بمنزلة من قتل نفسه حقيقة، ولا يجعل قاتل النفس حقيقة كالحي حكما في توجه الخطاب عليه بأداء العبادات لا للتخفيف عليه،
فكذلك الكافر لا يجعل متمكنا من الاداء حكما مع إصراره على الكفر لا بطريق التخفيف عليه ولكن تجعل ذمته كالمعدومة حكما في الصلاحية لوجوب أداء العبادات فيها تحقيقا لمعنى الهوان في حقهم وهو أن يلحقهم بالبهائم التي لا ذمة لها في هذا الحكم
كما وصفهم الله تعالى قال: (إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا) ثم الخطاب بأداء العبادات ليسعى المرء بأدائها في فكاك نفسه، قال عليه السلام: الناس غاديان: بائع نفسه فموبقها، ومشتر نفسه فمعتقها يعني بالائتمار بالاوامر، والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه ما لم يؤمن لا يكون تخفيفا عليه، وهو نظير أداء بدل الكتابة لما كان ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه، فإسقاط المولى هذه المطالبة عنه عند عجزه بالرد في الرق لا يكون تخفيفا عليه، فإن ما بقي فيه من ذل الرق فوق ضرر المطالبة بالاداء.
وإنما استنبطنا هذا من تعليل محمد رحمه الله في قوله: ما فيه من الشرك أعظم من ذلك، علل به في أنه لا يلزمه كفارة الظهار وكفارة اليمين وإن حنث، وفي الكفارات معنى العبادة على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا للذنب والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت في حقه الخطاب بأداء الكفارة كما لا يثبت في حق العبد الخطاب بالتكفير بالمال لانه ليس بأهل لذلك.
ونظير ما قلنا من الحسيات أن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدواء إذا كان يرجو له الشفاء يكون نظرا من الطبيب لا إضرارا به، فإذا أيس من شفائه فترك مطالبته بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيفا عليه بل إجبارا له بما هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق من كأس الحمام، فكذلك هنا أن الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن معنى التخفيف عليهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة فيما هو مصر عليه من الشرك، والله أعلم.
باب: النهي
قال رضي الله عنه: اعلم بأن موجب النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لانه ضد الامر.
أما من حيث اللغة فصيغة الامر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يكون، وصيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون، وأما شرعا فالامر لطلب إيجاد المأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار المخاطب في حقيقة الايجاد، وذلك
في وجوب الائتمار، والنهي لطلب مقتضى الامتناع عن الايجاد على ابلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء، فإذا تبين موجب النهي قلنا: مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا، كما أن مقتضى الامر حسن المأمور به شرعا ألا ترى أن التحريم لما كان ضد الاحلال كان مقتضى أحدهما ضد مقتضى الآخر ولان صاحب الشرع جاء بتتميم المحاسن ونفي القبائح فكان نهيه موجبا قبح المنهي عنه كما كان أمره موجبا صفة الحسن للمأمور به.
فإن قيل: لماذا لا يجعل مقتضى النهي شرعا حسن الانتهاء كما كان مقتضى الامر حسن الائتمار ؟ قلنا لانه يصير مقتضاهما واحدا وبينهما مغايرة على سبيل المضادة، ثم الائتمار بفعل يقصده المخاطب ويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن الائتمار لكون ذلك مضافا إليه، فأما الانتهاء يكون بامتناعه عن إيجاد الفعل المنهي عنه ثم انعدامه لا يكون مضافا إلى كسبه وقصده، بل الانعدام أصل فيه ما لم يوجده، وإذا لم يكن مضافا إلى فعله الذي هو اختياري لا يستقيم أن يوصف امتناعه عن الايجاد بالحسن مقصودا، فعرفنا به أن قبح المنهي عنه ثابت بمقتضى وجوب الانتهاء شرحا.
فإن قيل: تركه الفعل الذي يكون إيجادا فعل مقصود منه على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل لما فيه من استعمال أحد الضدين والانتهاء به يتحقق، قلنا هو كذلك ولكن موجب النهي هو الانتهاء وحقيقته
الامتناع عن الايجاد، ثم إن دعته نفسه إلى الايجاد يلزمه الترك ليكون ممتنعا والنهي عنه يبقى عدما كما كان، ألا ترى أن الامتناع الذي به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع العمر، والترك الذي هو فعل منه لا يستغرق، فإنه قبل أن يعلم به يكون منتهيا بالامتناع عنه ولا يكون مباشرا للفعل الذي هو ترك الايجاد فإن ذلك لا يكون إلا عن قصد منه بعد العلم به.
وبيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتضاء السهرتين في حال الصوم فلا يتحقق منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به ويقصده، والمعتدة ممنوعة من التزوج والخروج والتطيب وذلك ركن الاعتداد ويتم ذلك وإن لم تعلم به حتى يحكم بانقضاء عدتها بمضي
الزمان قبل أن نشعر به، وعلى هذا لو قال لامرأته: إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق ثم قال لا أشاء طلاقك لم تطلق، ولو قال: إن أبيت طلاقك فأنت طالق ثم قال قد أبيت طلقت، لان الاباء فعل يقصده ويكسبه فيصير موجودا بقوله قد أبيت ولا يكون ذلك مستغرقا للمدة، وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك يستغرق عمره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا أشاء ولا بامتناعه من المشيئة في جزء من عمره.
وإذا تبين أن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا فنقول: المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغيره، وهذا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعا، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفا.
فأما بيان القسم الاول في العبث والسفه فإنهما قبيحان شرعا، لان واضع اللغة وضع هذين الاسمين لما يكون خاليا عن الفائدة، ومبنى الشرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة، فما يخلو عن ذلك قطعا يكون قبيحا شرعا، ومن هذا النوع فعل اللواطة، فالمقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النسل وهذا المحل ليس بمحل له
أصلا فكان قبيحا شرعا، ونظيره من العقود بيع الملاقيح والمضامين، فإنه قبيح شرعا لان البيع مبادلة المال بالمال شرعا وهو مشروع لاستنماء المال به، والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه فلم يكن محلا للبيع شرعا، وكذلك الصلاة بغير الطهارة لان الشرع قصر الاهلية لاداء الصلاة على كون المصلي طاهرا عن الحدث والجنابة فتنعدم الاهلية بانعدام صفة الطهارة، وانعدام الاهلية فوق انعدام المحلية، فكان كل واحد منهما قبيحا شرعا بهذا الطريق.
وحكم هذا النوع من المنهي بيان أنه غير مشروع أصلا لان المشروع لا يخلو عن حكمة، وبدون الاهلية والمحلية لا تصور لذلك فيعلم به أنه غير مشروع أصلا.
وبيان النوع الثاني من الافعال وطئ الرجل زوجته في حالة الحيض، فإنه حرام منهي عنه ولكن لمعنى استعمال الاذى واستعمال الاذى مجاور للوطئ جمعا غير متصل به وصفا، ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم في قول محمد رحمه الله لانه لا يجاور فعله استعمال الاذى، وفي قول أبي حنيفة رحمه الله يستمتع بها
فوق المئزر ويجتنب ما تحته احتياطا، لانه لا يأمن الوقوع في استعمال الاذى إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع الاذى.
ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء، فإنه منهي عنه لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعين لزوم السعي وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وصفا، والصلاة في الارض المغصوبة منهي عنها لمعنى شغل ملك الغير بنفسه وذلك مجاور لفعل الصلاة جمعا غير متصل به وصفا، فعرفنا أن قبحه لمعنى في غيره.
وحكم هذا النوع أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي من قبل أن القبح لما كان باعتبار فعل آخر سوى الصلاة والبيع والوطئ لم يكن مؤثرا في المشروع لا أصلا ولا وصفا، ألا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة
هو مطيع فيه وإن كان عاصيا في ترك الصلاة، وهنا يكون مطيعا في الصلاة وإن كان عاصيا في شغل ملك الغير بنفسه، ومباشرا للوطئ المملوك بالنكاح وإن كان عاصيا مرتكبا للحرام باستعمال الاذى، ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الاول بالوطئ الثاني إياها في حالة الحيض، ويثبت به إحصان الواطئ أيضا.
وأما النوع الثالث فبيانه في الزنا فإنه وطئ غير مملوك فكان قبيحا شرعا، لان الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطئ على محل مملوك، فقال الله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) ونظيره من العقود الربا فإنه قبيح لمعنى اتصل بالبيع وصفا وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الاموال شرعا، ومن العبادات النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فإنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الاداء وصفا وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة.
ثم لا خلاف فيما يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع أنه في صفة القبح ملحق بالقسم الاول، فإن الزنا وشرب الخمر حرام لعينه غير مشروع أصلا، ولهذا تتعلق بهما العقوبة التي تندرئ بالشبهات، وما كان مشروعا من وجه وحراما لغيره لا يخلو عن شبهة، فإيجاب العقوبة فيهما دليل ظاهر على أن حرمتهما لعينهما وذلك دليل على قبح المنهي عنه لعينه
واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات.
قال علماؤنا رحمهم الله: موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعا وجعل أداء العبد إذا باشرها فاسدا إلا بدليل.
وقال الشافعي: موجب مطلق النهي في هذا النوع انتساخ المنهي عنه وخروجه من أن يكون مشروعا أصلا إلا بدليل.
وحجته في ذلك أن النهي ضد الامر.
ثم مقتضى مطلق الامر شرع المأمور به، فمقتضى مطلق النهي ضده وهو انعدام كون المنهي عنه مشروعا، وهذا لان الحقيقة هو المراد من كل نوع حتى يقوم دليل
المجاز، ثم الحقيقة في مطلق الامر إثبات صفة الحسن في المأمور به شرعا لعينه لا لغيره.
وكذلك الحقيقة في مطلق النهي إثبات صفة القبح في المنهي عنه لعينه لا لغيره، وهذا لان المطلق ينصرف إلى الكامل دون الناقص، فإن الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه، فبهذا تبين أن المطلق يتناول الكامل، والكمال في الامر الذي هو طلب الايجاد بأن يحسن المأمور به لعينه، فكذلك الكمال فيما هو طلب الاعدام إثبات صفة القبح في إيجاده لعينه.
وإذا تقرر هذا خرج المنهي عنه من أن يكون مشروعا لمقتضى النهي وحكمه، أما مقتضاه فلان أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مباحا فكذلك لا يجوز أن يكون مشروعا، وبهذا تبين أن النهي بمعنى النسخ في إخراج المنهي عنه من أن يكون مشروعا.
وأما حكمه فوجوب الانتهاء ليكون معظما مطيعا للناهي في الانتهاء، ويكون عاصيا لا محالة في ترك الانتهاء، وإنما يكون عاصيا بمباشرة ما هو خلاف المشروع، فعرفنا أن بالنهي يخرج من أن يكون مشروعا.
يقرره أن المنهي عنه لا يكون مرضيا به أصلا وإن كان لا تنعدم به الارادة، والقضاء والمشيئة بمنزلة الكفر والمعاصي، فإنها تكون من العباد بالارادة والمشيئة والقضاء ولا يكون مرضيا به، قال الله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر) والمشروع ما يكون مرضيا به، قال الله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية، فبهذا تبين أن المنهي عنه غير مشروع أصلا، ثم صفة القبح في المنهي عنه وإن كان لمعنى اتصل به وصفا فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعا لان ذلك الوصف لا يفارق
المنهي عنه ومع وجوده لا يكون مشروعا، فبه يخرج من أن يكون مشروعا أصلا بمنزلة نكاح المعتدة والنكاح بغير شهود فإن النهي عنهما كان لمعنى زائد على ما به يتم العقد من فقد شرط أو زيادة صفة في المحل، ثم يخرج به من أن يكون مشروعا أصلا
مقيدا بما هو الحكم المطلوب من النكاح.
إذا تقرر هذا فالمسائل تخرج له على هذا الاصل منها أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لان ثبوتها بطريق النعمة والكرامة حتى تكون أمهاتها وبناتها في حقه كأمهاته وبناته في المحرمية فيستدعي سببا مشروعا والزنا قبيح لعينه غير مشروع أصلا فلا يصلح سببا لهذه الكرامة.
ومنها أن البيع الفاسد نحو الربا والبيع بأجل مجهول وبيع المال بالخمر لا يكون موجبا للملك بحال، لان الملك نعمة وكرامة، ألا ترى أن صفة المالكية إذا قوبلت بالمملوكية كان معنى النعمة بالمالكية فيستدعي سببا مشروعا والقبيح لعينه لا يكون مشروعا أصلا.
يقرره أن النعمة تستدعي سببا مرغوبا فيه شرعا ليرغب العاقل في مباشرته لتحصيل النعمة والمنهي عنه شرعا لا يجوز أن يكون مرغوبا فيه شرعا.
ومنها أن الغصب لا يكون موجبا للملك عند تقرر الضمان لهذا المعنى.
ومنها أن استيلاء الكفار على مال المسلم لا يكون موجبا للملك لهم شرعا لان ذلك عدوان محض فلا يكون ذلك مشروعا في نفسه ولا يصلح سببا لحكم مشروع مرغوب فيه.
ومنها أن صوم يوم العيد لم يبق بعد النهي صوما مشروعا حتى لا يصح التزامه بالنذر لان الصوم المشروع عبادة والعبادة اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربه، فما يكون هو بمباشرته عاصيا مرتكبا للحرام لا يكون صوما مشروعا.
ومنها أن العاصي في سفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق لا يترخص برخص المسافرين، لان ثبوت ذلك بطريق النعمة لدفع الحرج عنه عند السير المديد، فإذا كان سيره معصية لم يصلح سببا لما هو نعمة في حقه، إذ النعمة تستدعي سببا مشروعا وما يكون المرء عاصيا بمباشرته فإنه لا يكون مشروعا.
ومنها بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعا مفيدا لحكمه لان النجاسة لما اتصلت بالدهن وصفا فصارت بحيث لا تفارقه خرج الدهن من أن يكون محلا للبيع المشروع
والتحق بودك الميتة فخرج من أن يكون محلا للبيع مفيدا لحكمه وهو الملك كما
بينا في بيع الملاقيح والمضامين.
قال: ولا يدخل على ما ذكرنا الظهار فإنه موجب للكفارة التي هي مشروعة وإن كان هو في نفسه قبيحا حراما لانه منكر من القول وزور، هذا لان الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب المحظور بمنزلة الحدود لا أصلا بنفسه على سبيل الكرامة والنعمة، والجزاء يستدعي سببا محظورا فيكون الظهار محظورا يحقق معنى السببية لما هو في معنى الجزاء، ولا تعدم الصلاحية لذلك.
ولا يدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة، فإنه يثبت النسب والملك للمستولد في نصيب شريكه وذلك حكم مشروع يثبت بسبب وطئ محظور، لان ثبوت النسب باعتبار وطئه ملك نفسه والنهي باعتبار أن وطأه يصادف ملك الشريك أيضا وملك الشريك مجاور لملكه جمعا غير متصل بملكه وصفا وكان في الصلاحية لثبوت النسب به بمنزلة الوطئ في حالة الحيض.
ثم إنما يملك نصيب الشريك حكما لثبوت أمية الولد في نصيبه، وكون الاستيلاد مما لا يحتمل الوصف بالتجزي وذلك غير محظور.
ولا يدخل على هذا الطلاق في حالة الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه فإنه منهي عنه ومع ذلك كان واقعا موجبا لحكم مشروع وهو الفرقة، لان هذا النهي لاجل الحيض وهو صفة المرأة غير متصل بالطلاق وصفا ولكنه مجاور له جمعا حين أوقعه في وقته.
وكان النهي لمعنى الاضرار بها من حيث تطويل العدة عليها، أو تلبيس أمر العدة عليها إذا أوقع في الطهر الذي جامعها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذي هو سبب الفرقة أصلا ولا وصفا.
ولا يدخل على ما ذكرنا إحرام المجامع لاهله فإنه ينعقد موجبا أداء الاعمال وإن كان منهيا عنه، لان النهي عن الجماع مع عقد الاحرام والجماع غير متصل بالاحرام أصلا ولا وصفا، ولهذا كان موجبا للقضاء والشروع بصفة الفساد غير موجب للقضاء بالاتفاق، فتبين به أنه ينعقد صحيحا ثم فسد لارتكاب المحظور به،
ولكن الاحرام مشروع على أنه لا يخرج منه المرء بعدما شرع فيه إلا بالطريق الذي
عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الاعمال أو الدم عند الاحصار فيلزمه أداء الاعمال ليكتسب به طريق الخروج من الاحرام شرعا وذلك مشروع فيجوز أن يلزمه أداء الاعمال أيضا.
وكذلك لو جامعها بعدما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الاعمال لهذا المعنى، ولان الجماع في الاحرام محظور شرعا فيجوز أن يقال ما يلزمه من أداء الاعمال بعده على وجه لا يكون معتدا به في إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو محظور، وكلامنا فيما هو مشروع ابتداء لا جزاء، وقبل الجماع لزمه أداء الاعمال بسبب مشروع وليس إلى العبد ولاية تغيير المشروع وإن كان الاداء يفسد بفعل منه كما تفسد الصلاة بالتكلم فيها ولا يتغير به المشروع، وإذا لم يصلح فعله مغيرا بقي طريق الخروج بأداء الافعال مشروعا كما كان قبل الجماع، وللشرع ولاية نفي المشروع وإخراجه من أن يكون مشروعا كما له ولاية الشرع بمطلق نهيه الذي هو دليل القبح في المنهي عنه، فصلح أن يكون مخرجا للمنهي عنه من أن يكون مشروعا، فلهذا لم يبق مشروعا بعد النهي.
وحجتنا ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الطلاق، فإنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فنهانا عما يتكون وعما لا يتكون والنهي عما لا يتكون لغو، حتى لا يستقيم أن يقال للاعمى لا تبصر، وللآدمي لا تطر، ومعلوم أنه إنما نهى عن صوم شرعي، فالامساك الذي يسمى صوما لغة غير منهي عنه، ومن أتى به لحمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكبا للمنهي عنه، فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد النهي كما كان قبله.
وتقرير هذا الكلام من وجهين: أحدهما أن موجب النهي هو الانتهاء وإنما يتحقق الانتهاء عن شئ والمعدوم ليس بشئ، فكان من ضرورة صحة النهي موجبا للانتهاء كون المنهي عنه مشروعا في الوقت، فكيف يستقيم أن يجعل المنهي عنه
غير مشروع بحكم النهي بعدما كان مشروعا ! وبه تبين أن النهي ضد النسخ، فالنسخ
تصرف في المشروع بالرفع ثم ينعدم أداء العبد باعتبار أنه لم يبق مشروعا وليس للعبد ولاية الشرع، والنهي تصرف في منع المخاطب من أداء ما هو مشروع في الوقت فيكون انعدام الاداء منه انتهاء عما نهي عنه، ومقتضى النهي حرمة الفعل الذي هو أداء لوجوب الانتهاء فبقي المشروع مشروعا كما كان، ويصير الاداء فاسدا حراما، لان فيه ترك الانتهاء الواجب بالنهي.
وبيان هذا في قوله تعالى: (ولا تقربا هذه الشجرة) فإنه كان تحريما لفعل القربان ولم يكن تحريما لعين الشجرة، وكما لا يتصور تحريم قربان الشجرة بدون الشجرة لا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقت ليس فيه صوم مشروع.
وبهذا الحرف يتبين الفرق بين الافعال الحسية والعقود الحكمية والعبادات الشرعية، فإنه ليس من ضرورة حرمة الافعال الحسية انعدام التكون، فقلنا تأثير التحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلا وإلحاقها بما هو قبيح لعينه، ومن ضرورة تحريم العقود الشرعية بقاء أصلها مشروعا إذ لا تكون لها إذا لم تبق مشروعة، وبدون التكون لا يتحقق تحريم فعل الاداء، وكذلك في العبادات، فكان في إبقاء المشروع مشروعا مراعاة حقيقة النهي لا أن يكون تركا للحقيقة كما قرره الخصم.
يوضحه أن صفة الفساد للعقد لا يكون إلا عند وجود العقد فإن الصفة لا تسبق الموصوف، وكذلك فساد المؤدى من الصوم لا يسبق الاداء، ولا أداء إذا لم يبق مشروعا، فبه تبين أنه بقي مشروعا والمشروعات لا تكون قبيحا لعينه، فعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به الاداء قبيحا فاسدا، إلا في موضع يتعذر الجمع بين صفة الحرمة وبقاء الاصل، فحينئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك نسخا من طريق المعنى في صورة النهي لا أن يكون نهيا حقيقة ولا ضرورة هنا.
فالصوم والصلاة يستقيم أن يكون أصله مشروعا مع كون الاداء حراما كصوم يوم الشك
والصلاة في وقت مكروه، وكذلك العقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعا مع حرمة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق في حالة الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه امرأته.
وتقرير آخر أن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد
واختياره لانه ابتلاء كالامر، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار، حتى إذا انتهى معظما لحرمة الناهي كان مثابا عليه، وإذا أقدم عليه تاركا تعظيم حرمة الناهي كان معاقبا على إيجاده، ولا يتحقق ذلك إلا فيما هو مشروع، فبهذا تبين أن موجب النهي إنما يتحقق في العقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد النهي، فأما صفة القبح فهو ثابت بمقتضى النهي، ولكن ثبوت المقتضى لتصحيح المقتضى لا لابطاله، وإذا انعدم المشروع بمقتضى صفة القبح ينعدم موجب النهي، وبانعدامه يبطل النهي فلا يجوز إثبات المقتضى على وجه يكون مبطلا للمقتضي.
والشافعي رحمه الله فعل ذلك فكان قوله فاسدا، ونحن أثبتنا أصل النهي موجبا للانتهاء، ثم أثبتنا المقتضى بحسب الامكان على وجه لا يبطل به الاصل ولكن يثبت القبح والحرمة صفة لاداء العبد المشروع في الوقت، فإن القبح إذا كان في وصف الشئ لا يعدم أصله كالاحرام بعد الفساد فإنه يبقى أصله وإن كان قبيحا لمعنى اتصل بوصفه وهو الفساد، والعذر الذي ذكره يرجع إلى تحقيق ما ذكرنا، فإن فساد الاحرام بالجماع حكم ثابت شرعا وإلى الشرع ولاية إعدام أصل الاحرام فلو كان من ضرورة صفة الفساد انعدام الاصل في المشروعات لكان الحكم بفساده شرعا معدما لاصله، ألا ترى أن بسبب الردة ينعدم أصل الاحرام وإن كان ذلك من أعظم الجنايات، لان حبوط العمل بالردة حكم شرعي، وبسبب الاحصار يتمكن من الخروج من الاحرام قبل أداء الاعمال وذلك جناية من العبد ولكن جواز دفع ضرر استدامة الاحرام
عن نفسه حكم شرعي فيتمكن به من الخروج قبل أداء الاعمال، وكان ما بيناه نهاية في التحقيق، ومراعاة لحقيقة موجب النهي، وإثباتا بمقتضاه بحسب الامكان وبهذا يتبين الفرق بين الامر والنهي على ما استدل به الخصم، فإن مطلق الامر يوجب حسن المأمور به لعينه، لانه طلب الايجاد بأبلغ الجهات، فتمام ذلك بالوجود حقيقة فكان في إثبات صفة الحسن بمقتضى الامر على هذا الوجه تحقيق المأمور به، فأما النهي فطلب الاعدام بأبلغ الجهات، ولكن مع بقاء اختيار العبد فيه ليكون مبتلى كما في الامر، وحقيقة ذلك إنما يتكون به فيما هو مشروع ويبقى بعد النهي مشروعا،
فيثبت مقتضاه على الوجه الذي يوجبه ما هو الموجب الاصلي فيه حقيقة، وكما أن المأمور به لا يصير موجودا بمقتضى الامر لانه ينعدم به معنى الابتلاء فكذلك المنهي عنه لا ينعدم بمجرد النهي لتحقيق معنى الانتهاء وإذا لم ينعدم بقي مشروعا لا محالة.
وبيان تخريج المسائل على هذا الاصل أن نقول: الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة، والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتغاء مرضاة الله تعالى، ويوم العيد كسائر الايام في هذا فكان الصوم مشروعا فيه وبالنهي لم ينعدم هذا المعنى، ثم النهي ليس لانه صوم شرعي ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة، وإليه وقعت الاشارة في قوله عليه السلام: فإنها أيام أكل وشرب وهذا المعنى باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح في الصفة دون الاصل وهو أنه يكون حرام الاداء، والمؤدى يكون عاصيا بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعا في الوقت لانه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه، ولهذا قلنا يصح التزامه بالنذر، لانه بالنذر يصير ملتزما في ذمته ما هو عبادة مشروعة في الوقت ولا فساد في المشروع، وذكر اليوم لبيان مقدار ما التزمه على ما بينا أن الوقت معيار للصوم، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله (إنه) لا يلزمه بالشروع، وإن أفسده بعد الشروع لا يلزمه
القضاء لان الشروع أداء منه فيكون حراما فاسدا فيكون هذا مطالبا بالكف عنه شرعا لا بإتمامه فلا يكون الافطار جناية منه على حق الشرع ولا يبقى في عهدته حتى يحتاج إلى القضاء، فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام فيصح نذره ويؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر، وبه يتم التحرز عن ارتكاب المحرم، ولكن لو صام فيه خرج عن موجب نذره لانه التزم المشروع في الوقت ونتيقن أنه أدى المشروع في الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب وإن كان الاداء فاسدا منه كمن نذر أن يعتق عبدا بعينه فعمى ذلك العبد أو كان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق بينهما، فالعبد مستهلك باعتبار
وصفه (قائم باعتبار أصله، والصوم في هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الاداء باعتبار وصفه) ولهذا لا يتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم، لان ذلك وجب في ذمته كاملا وبصفة الفساد والحرمة في الاداء ينعدم الكمال ضرورة، وعلى هذا الصلاة في الاوقات المكروهة، فالاداء منهي لمعنى هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة الشيطان الشمس على ما ورد به الاثر فلا ينعدم أصل العبادة مشروعا فيه ولكن يحرم الاداء ويلزم بالشروع كما يلزم بالنذر، لان الصلاة عبادة معلومة بأركانها والوقت ظرف لها لا معيار فلا يصير مؤديا بمجرد الشروع والمحرم هو الاداء، ويتصور بهذا الشروع الاداء بدون صفة الحرمة بأن يصير حتى تبيض الشمس فلم يكن الشروع فاسدا كما لم يكن النذر فاسدا فيلزمه القضاء لهذا ولكن لا يتأدى به واجب آخر، لان النهي باعتبار وصف الوقت الذي هو ظرف للاداء يمكن نقصانا في الاداء والواجب في ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص إلا عصر يومه، فإن الوجوب باعتبار ذلك الجزء الذي هو سبب وإنما يثبت الوجوب بصفة النقصان وقد أدى بتلك الصفة فسقط عنه الواجب، وعلى هذا قلنا: البيع الفاسد يكون مشروعا بأصله موجبا لحكمه وهو الملك إذا تأيد بالقبض، لان المشروع إيجاب وقبول من أهله في محله
وبالشرط الفاسد لا يختل شئ من ذلك، ألا ترى أن الشرط لو كان جائزا لم يكن مبدلا لاصله بل يكون مغيرا لوصفه، والشرط الفاسد لا يكون معدما لاصله أيضا بل يكون مغيرا لوصفه فصار فاسدا، وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصله لان بالفساد يثبت صفة الحرمة، وهذا السبب مشروع لاثبات الملك، وملك اليمين مع صفة الحرمة يجتمع، ألا ترى أن من اشترى أمة مجوسية أو مرتدة يثبت الملك له مع الحرمة، وأن العصير إذا تخمر يبقى مملوكا له مع الحرمة فلهذا أثبتنا في البيع الفاسد ملكا حراما مستحق الدفع لفساد السبب ولم ينعدم به أصل المشروع بخلاف النكاح الفاسد فإنه ليس في النكاح إلا ملكا ضروريا يثبت به حل الاستمتاع، ولهذا سمي ذلك الملك حلالا في نفسه، ومن ضرورة فساد السبب ثبوت صفة الحرمة، وبين الحرمة
وبين ملك النكاح منافاة فينعدم الملك، ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون مشروعا، لان الاسباب الشرعية تراد لاحكامها وثبوت النسب ووجوب المهر والعدة من حكم الشبهة لا من حكم أصل العقد شرعا، وهذا الكلام يتضح في النكاح بغير شهود، فإن قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشهود إخبار عن عدمه بدون هذا الشرط فيكون نفيا لا نهيا، بمنزلة قول الرجل لا رجل في الدار، وكذلك في نكاح المحارم، فإن النص الوارد فيه تحريم العين بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى آخر الآية ولا يجتمع الحل والحرمة في محل واحد فكان ذلك نفيا للحل بالنكاح لا نهيا، وكذلك نكاح المعتدة فإن قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) معطوف على قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) معناه: وحرمت المحصنات من النساء، وذلك عبارة عن منكوحة الغير ومعتدته فيكون نفيا لا نهيا، وكذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة بالمصاهرة هي الثابتة بالنسب على أن تقوم المصاهرة مقام النسب في ذلك، فكان
تقديره: وحرمت عليكم ما نكح آباؤكم، وتصير صورة النهي عبارة عنه مجازا باعتبار هذا المعنى فكان نفيا كما هو موجب النسخ لا نهيا، وكذلك قوله عليه السلام: لا تنكح الامة على الحرة فإنه إخبار فيكون نفيا للنكاح مع أن الدلالة قد قامت على أن الامة من جملة المحرمات مضمومة إلى الحرة فإن الحل فيه على النصف من حل الحرة على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى، ومن ضرورة حرمة المحل انتفاء النكاح المشروع فيه كما قررناه، وعلى هذا عقد الربا فإنه نوع بيع ولكنه فاسد لا بخلل في ركنه بل لانعدام شرط الجواز وهو المساواة في القدر فكما أن بوجود شرط مفسد لا ينعدم أصل المشروع فكذلك بانعدام شرط مجوز لا ينعدم أصل المشروع وثبوت ملك حرام به كما اقتضاه مثل هذا السبب.
فإن قيل قوله تعالى: (وحرم الربا) يوجب نفي أصله مشروعا كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) بل أولى لانه أضاف هذا التحريم إلى نفسه، وهناك الحرمة مضافة إلى الام.
قلنا الربا عبارة عن الفضل، فمعنى قوله تعالى: (وحرم الربا) أي حرم اكتساب الفضل الخالي عن العوض بسبب التجارة ونحن نثبت هذه الحرمة ولكن بينا أنه ليس من ضرورة الحرمة في ملك اليمين انتفاء أصل الملك، وعلى هذا قلنا بيع العبد بالخمر فإن الخمر فاسد التقوم شرعا ولم تنعدم به أصل المالية الثابتة فيه بالتمول فإن تموله ما فسد شرعا لما فيه من عرضية التخلل إذ التمول للشئ عبارة عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك الخمر إلى أن يتخلل لا يكون حراما شرعا، بمنزلة من أحرم وله صيد فإن الصيد لا يكون متقوما في حق تصرفه حتى لا يتمكن من التصرف فيه ويكون محرم العين في حقه ولكن لا ينعدم أصل المالية فيه باعتبار ماله وهو ما بعد التحلل من الاحرام، ولهذا اختلف العلماء في جواز هذا البيع، فمنهم من يقول هو جائز بالقيمة ولو قضى القاضي بهذا نفذ قضاؤه، فإذا تبين أنه
لم ينعدم ما هو ركن العقد قلنا ينعقد العقد موجبا حكمه في محل يقبله وهو العبد ولا ينعقد موجبا للحكم في محل لا يقبله وهو الخمر حتى لا يملك الخمر وإن قبضه بحكم العقد، بخلاف البيع بالميتة والدم فإنه لا مالية في الميتة والدم باعتبار الحال ولا باعتبار المآل، وكذلك جلد الميتة لا مالية فيه باعتبار الحال فإنه لو ترك كذلك فإنه يفسد وإنما تحدث فيه المالية بصنع مكتسب وهو الدباغة، ولهذا اتفق العلماء على بطلان هذا العقد، ولو قضى قاض بجوازه لم ينفذ قضاؤه، فلانعدام ما هو ركن العقد لم ينعقد العقد، لان انعقاده شرعا لا يكون بدون ركنه، وعلى هذا جوزنا بيع الدهن الذي وقع فيه نجاسة لان الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما انعدم أصله ولا تغير وصفه إنما جاوره أجزاء النجاسة ولاجله حرم تناوله فيكون بمنزلة النهي الذي ورد لمعنى في غير المنهي عنه وهو غير متصل به وصفا، ومثل هذا النهي لا يمنع جواز العقد كما لا يمنع كمال العبادة، ولهذا يتأدى الفرض بأداء الصلاة في الارض المغصوبة،
ويتأدي صوم الفرض في أيام الوصال إذا نواه، لان النهي بالمجاورة لا لمعنى اتصل بالوقت الذي يؤدى فيه الصوم إلا أن الوصال لا يتحقق، لان الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقتا لركن الصوم وهو الامساك باعتبار أن الامساك فيه عادة فكان ذلك نسخا استعير لفظ النهي له مجازا، ولا كلام في جواز ذلك إنما الكلام في موجب النهي حقيقة.
ثم في البيع يمكن تمييز الدهن مما جاوره حكما فيكون البيع متناولا للدهن دون النجاسة وفي التناول لا يمكن تمييز الدهن مما جاوره فلا يحل تناوله، فلهذا جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه، وعلى هذا قلنا العاصي في سفره يترخص بالرخص، لان سبب الرخصة السير المديد وهو موجود بصفة الكمال لا قبح في أصله ولا في صفته وإنما القبح في معنى جاوره وهو قصده إلى قطع الطريق أو تمرد العبد على مولاه، ألا ترى أنه إذا ترك قصده بقصد الحج
خرج من أن يكون عاصيا ولم يتغير سفره وإنما تبدل قصده، وكذلك العبد إذا لحقه إذن مولاه لم يتغير سفره وخرج من أن يكون عاصيا، وعلى هذا قلنا في قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) إن هذا النهي لا يعدم أصل الشهادة للقاذف حتى ينعقد النكاح بشهادته ولكن يفسد أداؤه حتى يخرج من أن يكون أهلا للعان لان اللعان أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهي المطلق، وعلى هذا قلنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لان الزنا قبيح لعينه، وحرمة المصاهرة ليست تثبت بالزنا ولا بالوطئ الحلال بعينه إنما الاصل فيه الولد المخلوق من الماءين وهو محترم مخلوق بخلق الله تعالى على أي وجه اجتمع الماءان في الرحم كما قال تعالى: (ثم أنشأناه خلقا آخر) فلا يتمكن فيه صفة القبح وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ثم تتعدى الحرمة إلى أطرافه وإلى أسباب خلقه، فيقام السبب وهو الوطئ في المحل الصالح لحدوث الولد فيه مقام نفس الولد في إثبات الحرمة، وما قام مقام غيره في إثبات حكم فإنما تراعى صلاحية السبب للحكم في الاصل لا فيما قام مقامه، بمنزلة التراب فإنه قائم مقام الماء في الطهارة
وصلاحية السبب لهذا الحكم في استعمال الماء الذي هو الاصل لا في استعمال التراب فإنه تلويث، ولهذا لم يكن وطئ الميتة والاتيان في غير المأتى ووطئ الصغيرة موجبا الحرمة، لان قيام الوطئ مقام الولد في هذا الحكم باعتبار كون المحل محلا يخلق فيه الولد وذلك لا يوجد في هذه المواضع، وعلى هذا قلنا في استيلاء الكفار على أموالنا إذا تم بالاحراز فهو موجب للملك، لان صفة الحرمة والقبح لهذا الفعل بواسطة العصمة في المحل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الحكم في حقنا لا في حقهم فإنهم لا يعتقدون ذلك وولاية الالزام منقطعة بانعدام ولايتنا عنهم في دار الحرب، لان هذه الواسطة هي العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام عندنا وقد انتهت هذه العصمة بانتهاء سببها حين أحرزوها بدارهم حتى إن في زمان الاحراز لما كانت
العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة بالاسلام ولم تنته بالاحراز الموجود منهم قلنا لا يملكون رقابنا، وعلى هذا قلنا الغصب سبب موجب للملك عند تقرر الضمان، لانه قبيح بأنه غصب والملك لا يثبت به وإنما يثبت الملك للغاصب بتملك المغصوب منه بدله وهو القيمة عليه، وهذا حكم شرعي لا قبح فيه، بل فيه حكمة بالغة وهو التحرز عن فضل خال عن العوض سالم للمغصوب منه شرعا فإنه إذا اجتمع الاصل والبدل في ملكه يتحقق هذا المعنى فيه مع أن الملك إنما لا يبقى للمغصوب منه ليتم به شرط سلامة الضمان له فإن الضمان ضمان جبر وإنما يجبر الفائت لا القائم فكان انعدام ملكه في العين شرطا لسلامة الضمان له وشرط الشئ تبعه فإنما تراعى صلاحية السبب في الاصل لا في التبع، وفي المدبر على هذا الطريق نقول: لما سلم الضمان للمغصوب منه بجعل الاصل زائلا عن ملكه حكما لان المدبر محتمل لذلك، ولهذا لو اكتسب هو كسبا ثم لم يرجع من إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للغاصب وإنما لم يثبت الملك للغاصب فيه صيانة لحق المدبر، والتدبير موجب حق العتق له عند الموت ولهذا امتنع بيعه، وفي القن بعد ما زال ملك المغصوب منه لا مانع
من دخوله في ملك الغاصب الضامن وهذا أحق الناس به لانه ملك عليه بدله، أو نقول في المدبر لا يمكن أن يجعل الضمان بدلا عن العين، لان من شرطه انعدام ملكه في العين وهذا الشرط لا يمكن إيجاده بحق المدبر، فجعلنا الضمان ضمان الجناية واجبا باعتبار الجناية على يده وهذا جائز عند الضرورة ولا ضرورة في القن فيجعل بدلا عن العين، ولهذا قلنا لو أخذ القيمة بطريق الصلح بغير قضاء القاضي لا يملك عليه المدبر ويملك عليه القن.
وهذا طريق في تخريج جنس هذه المسائل.
فصل: في بيان حكم الامر والنهي في أضدادهما قال رضي الله عنه اعلم أن العلماء يختلفون فيهما جميعا، فنبين كل واحد منهما
على الانفراد ليكون أوضح.
أما بيان حكم الامر فقد قال بعض المتكلمين: لا حكم للامر في ضده.
وقال الجصاص رحمه الله: الامر بالشئ يوجب النهي عن ضده سواء كان له ضد واحد أو أضداد.
وقال بعضهم: يوجب كراهة ضده، والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده ولا نقول إنه يوجبه أو يدل عليه مطلقا.
وحجة الفريق الاول أن الضد مسكوت عنه والسكوت عنه لا يكون موجبا شيئا، ألا ترى أن التعليق بشرط لا يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط لانه مسكوت عنه فيبقى على ما كان قبل التعليق فهنا أيضا الضد مسكوت عنه فيبقى على ما كان قبل الامر.
يقرره أن الامر فيما وضع له لا يوجب حكما فيما لم يتناوله النص إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل فلان لا يوجب حكما في ضد ما وضع له كان أولى، وعلى قول هؤلاء الذم والاثم على من ترك الائتمار باعتبار أنه لم يأت بما أمر به.
قال الجصاص رحمه الله: وهو قول قبيح فإن فيه قولا باستحقاق العبد العقوبة على ما لم يفعله واستحقاق العقوبة إنما هو باعتبار فعل فعله العبد، ثم إنه بنى مذهبه على أن الامر المطلق يوجب الائتمار على الفور، فقال: من ضرورة وجوب الائتمار على الفور حرمة الترك الذي هو ضده والحرمة حكم النهي فكان موجبا للنهي عن ضده بحكمه.
يوضحه أن الامر طلب الايجاد للمأمور به على
أبلغ الجهات والاشتغال بضده يعدم ما وجب بالامر وهو الايجاد فكان حراما منهيا عنه لمقتضى حكم الامر، ولهذا يستوي فيه ما يكون ضد واحد أو أضداد، فبأي ضد اشتغل ينعدم ما هو المطلوب، ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سواء اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج.
وهذا هو الحجة للفريق الثالث، إلا أنهم يقولون حرمة الضد بهذا الطريق تثبت بواسطة حكم الامر فإنما ثبت أدنى الحرمة فيه، لان ما ثبت بطريق الدلالة لا يكون مثل الثابت
بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجه وهذا ثابت من وجه دون وجه لتحقيق حكم الامر، ويكفي لذلك أدنى الحرمة، بمنزلة حرمة تثبت بالنهي لمعنى في غير المنهي عنه غير متصل بالنهي عنه فتثبت به الكراهة فقط.
ووجه القول المختار هذا الكلام أيضا إلا أنا نقول ثبوت الحرمة بطريق الاقتضاء هنا لان طلب الوجود بالامر يقتضي حرمة الضد ولا يثبت بدلالة النص إلا مثل ما هو ثابت بالنص أو أقوى منه كالتنصيص على حرمة التأفيف بدليل حرمة الشتم، لان فيه ذلك الاذى وزيادة، فأما ما ثبت بطريق الاقتضاء فهو ثابت لاجل الضرورة وإنما يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة، ووجود أحد الضدين يقتضي انتفاء الضد الآخر كالليل مع النهار فكان وجوب الاداء بالامر مقتضيا نفي الضد، وإنما حرم الضد بهذا الاقتضاء، فلهذا قلنا: إن الامر بالشئ يقتضي كراهة ضده لا أن يكون موجبا له أو دليلا عليه.
وما ذكره الجصاص أن مطلق الامر يوجب الائتمار على الفور دعوى منه، وقد ذكرنا أن الرواية بخلاف ذلك.
والجواب عما قاله الفريق الاول أن الضد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذي قلنا في وجه المختار، وهو أن ثبوت كراهة ضده بطريق الاقتضاء والمقتضى مسكوت عنه فإن ما يكون منصوصا عليه لا يكون ثبوته بطريق الاقتضاء، ولا خلاف بيننا وبينهم أن الاقتضاء طريق صحيح لاثبات المقتضى وإن كان مسكوتا عنه بعد أن يكون محتاجا إليه، وليس هذا نظير التعليق بالشرط فإن ذلك يوجب وجود الحكم ابتداء عند وجود الشرط، ومن ضرورة وجود الحكم عند وجود الشرط ابتداء أن لا يكون موجودا قبله ولكن انعدامه قبل وجود الشرط عدم أصلي فلا يصير مضافا إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء، لان العدم الاصلي لا يستدعي دليلا معدما يضاف إليه، وأما ههنا وجوب الاقدام على الايجاد
يقتضي حرمة الترك والحرمة الثابتة بمقتضى الشئ تكون مضافا إليه، فجعلنا قدر
ما يثبت من الحرمة وهو الموجب للكراهة مضافا إلى الامر اقتضاء.
وإذا تبين حكم الامر فكذلك حكم النهي في ضده على هذه الاقاويل الاربعة.
فالفريق الاول يقولون لا حكم له في ضده لانه مسكوت عنه، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فإنه لا يكون أمرا بضده وهو ترك قتل النفس إذ لو كان أمرا به لكان تارك قتل النفس مباشرا لفعل الطاعة وهو الائتمار بالامر فإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين، وهذا فاسد.
وقال الجصاص رحمه الله: النهي عن الشئ يوجب ضده إن كان له ضد واحد وإن كان له أضداد فلا موجب له في شئ من أضداده، وبين ذلك في الحركة والسكون، فإن قول القائل لا تتحرك يكون أمرا بضده وهو السكون لان للمنهي عنه ضدا واحدا، وقوله لا تسكن لا موجب له في ضده لان له أضدادا وهي الحركة من الجهات الست فإن السكون ينعدم من أي جانب كانت الحركة فلا يتعين واحد من الاضداد مأمورا به بموجب النهي، وإذا قال لغيره لا تقم فللمنهي عنه أضداد من القعود والاضطجاع فلا موجب لهذا النهي في شئ من أضداده.
قال لان موجب النهي إعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه، وإذا كان له ضد واحد فمن ضرورة وجوب الاعدام الكف عن الايجاد فيكون النهي موجبا الامر بالضد بحكمه.
واستدل على ذلك بقوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فإنه نهى عن الكتمان وهو موجب الامر بالاظهار ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره، لانها مأمورة بالاظهار، ونهى المحرم عن لبس المخيط لا يكون أمرا بلبس شئ عين من غير المخيط لان للمنهي عنه أضدادا هنا، وبحكم النهي لا يثبت الامر بجميع الاضداد وليس بعضها بأولى من البعض.
يوضح الفرق بينهما أن مع التصريح بالنهي فيما له ضد واحد لا يستقيم التصريح بالاباحة في الضد، فإنه لو قال نهيتك عن التحرك وأبحت لك السكون أو أنت بالخيار في السكون كان كلاما مختلا، لان موجب النهي تحريم المنهي عنه
ومع تحريمه لا يتصور التخيير في ضده لاستحالة انعدامهما جميعا وصفة الاباحة تقتضي
التخيير، وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الفريق الاول من أن الضد مسكوت عنه، ولا تعويل على استدلالهم بالنهي عن قتل النفس، لانا نجعل ذلك بمنزلة التصريح بالكف عن قتل النفس لتحقيق موجب النهي، والناس تكلموا في أن الامر بالكف عن قتل النفس ما حكمه ؟ منهم من قال معنى الابتلاء لا يتحقق في مثل هذا لان طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب في العمل بخلاف هوى النفس ليتحقق فيه الابتلاء.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أنه ينال به ثواب المطيعين عند قصد امتثال الامر وإظهار الطاعة، وهكذا نقول إذا ثبت ذلك بحكم النهي، فأما إذا كان للمنهي عنه أضداد يستقيم التصريح بالاباحة في جميع الاضداد بأن تقول لا تسكن وأبحت لك التحرك من أي جهة شئت، فعرفنا أنه لا موجب لهذا النهي في شئ من الاضداد، وقول من يقول بأن مثل هذا النهي يكون أمرا بأضداده يؤدي إلى القول بأنه لا يتصور من العبد فعل مباح أو مندوب إليه، فإن المنهي عنه محرم وأضداده واجب بالامر الثابت بمقتضى النهي فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه ؟ وفي اتفاق العلماء على أن أقسام الافعال التي يأتي بها العبد عن قصد أربعة: واجب ومندوب إليه ومباح ومحظور، دليل على فساد قول هذا القائل.
وأما الفريق الثالث فيقولون: موجب النهي في ضده إثبات سنة تكون في القوة كالواجب، لان هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موجب الثابت بالنص، وعلى القول المختار يحتمل أن يكون مقتضيا هذا المقدار على قياس ما بينا في الامر، وكذلك إذا كان للمنهي عنه أضداد فإنه يثبت هذا القدر من المقتضي في أي أضداده يأتي به المخاطب، ولهذا قلنا بأن النهي عن لبس المخيط في حالة الاحرام
يثبت أن السنة لبس الازار والرداء، وذلك أدنى ما يقع به الكفاية من غير المخيط.
فأما قوله: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فهو نسخ وليس بنهي بمنزلة قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) وإنما كان هذا أمرا بالاظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا وهو نظير قوله: لا نكاح إلا بشهود وقد
بينا تحقيق هذا المعنى فيما سبق، فأما بيان فائدة الاصل المذكور في هذا الفصل من مسائل الفقه أن نقول: لما كان الامر مقتضيا كراهة الضد لم يكن ضده مفسدا للعبادة إلا أن يكون مفوتا لما هو واجب بصيغة الامر ولكن يكون مكروها في نفسه، فإن المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد لا تفسد صلاته لانه لم يفت بهذا الضد ما هو الواجب بالامر وهو القيام إذا أتى به بعد القعود ولكن القعود مكروه في نفسه، ولكون النهي مقتضيا في ضده ما بينا من صفة السنة قلنا لا ينعدم بالضد ما هو موجب صيغة النهي، فإن ركن العدة الامتناع من الخروج والتزوج، ثبت ذلك بصيغة النهي، قال تعالى: (ولا يخرجن) وقال: (ولا تعزموا عقدة النكاح) فإن فعلت ذلك لم ينعدم به مأمور ما هو ركن الاعتداد حتى تنقضي العدة، بخلاف الكف في باب الصوم فإنه واجب بصيغة الامر نصا، قال تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فينعدم الاداء بمباشرة الضد وهو الاكل، وعلى هذا قلنا العدتان تنقضيان بمضي مدة واحدة، لان الكف في العدة ثابت بمقتضى النهي ولا تضايق فيما هو موجب النهي نصا وهو التحريم، ولا يتحقق أداء الصومين في يوم واحد لتضايق الوقت في ركن كل صوم وهو الكف إلى وقت فإنه ثابت بالامر نصا ولا يتحقق اجتماع الكفين في وقت واحد، وعلى هذا قال أبو يوسف رحمه الله: من سجد في صلاته على مكان نجس ثم سجد على مكان طاهر جازت صلاته، لان المأمور به السجود على مكان طاهر ومباشرة
الضد بالسجود على مكان نجس لا يفوت المأمور به فيكون مكروها في نفسه ولا يكون مفسدا للصلاة، وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تفسد به الصلاة لان تأدي المأمور به لما كان باعتبار المكان فما يكون صفة للمكان الذي يؤدى الفرض عليه يجعل بمنزلة الصفة له حكما فيصير هو كالحامل للنجاسة إذا سجد على مكان نجس والكف عن حمل النجاسة مأمور به في جميع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود على مكان نجس، كما أن الكف عن اقتضاء الشهوة لما كان مأمورا به في جميع وقت الصوم يتحقق الفوات بالاكل في جزء من الوقت فيه، وعلى هذا قال أبو يوسف بترك القراءة في شفع من التطوع لا يخرج عن حرمة الصلاة، لانه مأمور بالقراءة في الصلاة وذلك نهي عن ضده اقتضاء، فترك القراءة ما لم يكن مفوتا للفرض
لا يكون مفسدا، ومع احتمال أداء شفع آخر بهذه التحريمة لا يتحقق فوات هذا الفرض فتبقى التحريمة صحيحة قابلة لبناء شفع آخر عليها وإن فسد أداء الشفع الاول بترك القراءة.
وقال محمد رحمه الله: القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكما، ولهذا لا يصلح الامي خليفة للقارئ وإن كان قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وأتى بفرض القراءة في محلها، وإذا كان مستديما حكما يتحقق فوات ما هو الفرض بترك القراءة في ركعة فيخرج به من تحريمة الصلاة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا تفترض القراءة في كل ركعة من الشفع عندنا كما تفترض في كل ركعة من الفجر إلا أن بترك القراءة في ركعة من التطوع لا يفوت ما هو المأمور به من القراءة في الصلاة نصا فلا تنقطع التحريمة وبترك القراءة في الركعتين يفوت ما هو الفرض قطعا فيكون ذلك قطعا للتحريمة، وهكذا نقول في الفجر فإن بترك القراءة في ركعة يفسد الفرض ولكن لا تنحل التحريمة بل تنقلب تطوعا في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله، وفي الرواية
الاخرى يقول في التطوع احتمال بناء شفع آخر عليه قائم فإذا فعل ذلك كان الكل في حكم صلاة واحدة ولا تنقطع التحريمة بترك القراءة في ركعة منها، ومثل هذا الاحتمال غير موجود في الفجر حتى إن في ظهر المسافر لبقاء هذا الاحتمال بنية الاقامة قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لا تفسد بترك القراءة في ركعة منها حتى إذا نوى الاقامة أتم صلاته وقضى ما ترك من القراءة في الشفع الثاني فيجزيه ذلك، وعلى هذا نقول إن بترك القراءة في التطوع في الركعتين جميعا لا تنحل التحريمة عنده لاحتمال بناء شفع آخر عليه كما في فصل المسافر ولكنه يفسد لتحقق فوات ما هو فرض في هذه الصلاة، فإنه وإن بنى الشفع الثاني على تحريمته لا يخرج به من أن يكون الشفع الاول صلاة على حدة حقيقة وحكما، ولهذا لا يفسد الشفع الاول بمفسد يعترض في الشفع الثاني، والمسائل التي تخرج على هذا الاصل يكثر تعدادها، والله أعلم.
فصل: في بيان أسباب الشرائع قال رضي الله عنه: اعلم بأن الامر والنهي على الاقسام التي بيناها لطلب أداء المشروعات ففيها معنى الخطاب بالاداء بعد الوجوب بأسباب جعلها الشرع سببا لوجوب المشروعات، والموجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للاسباب في الايجاب بأنفسها، والخطاب يستقيم أن يكون سببا موجبا للمشروعات إلا أن الله تعالى جعل أسبابا أخر سوى الخطاب سبب الوجوب تيسيرا للامر على العباد حتى يتوصل إلى معرفة الواجبات بمعرفة الاسباب الظاهرة، وقد دل على ما بينا قوله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فإن الالف واللام دليل على أن المراد أقيموا الصلاة التي أوجبتها عليكم بالسبب الذي جعلته سببا لها وأدوا الزكاة الواجبة عليكم بسببها، كقول القائل أد الثمن فإنما يفهم منه الخطاب بأداء الثمن الواجب
بسببه وهو البيع.
ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر لا صنع للعبد فيه ولا اختيار، فإن الموجب هو الله تعالى تعبد العباد بما أوجبها عليهم، فكما لا صنع لهم في صفة العبودية الثابتة عليهم لا صنع لهم في أصل الوجوب، وباعتبار الاسباب التي جعلها الشرع سببا لا اختيار لهم في أصل الوجوب أيضا، كما أنه لا اختيار لهم في السبب، فأما وجوب الاداء الثابت بالخطاب لا ينفك عن اختيار يكون فيه للعبد عند الاداء، وبه يتحقق معنى العبادة والابتلاء في المؤدي، وهذا لان التكليف بقدر الوسع شرعا، وأصل الوجوب يثبت بتقرر السبب مع انعدام الخطاب بالاداء الثابت بالامر والنهي، فإن من مضى عليه وقت الصلاة وهو نائم تجب عليه الصلاة حتى يؤدى الفرض إذا انتبه، فالخطاب موضوع عن النائم، وكذلك المغمى عليه إذا لم يبق لتلك الصفة أكثر من يوم وليلة أو المجنون إذا لم يزدد جنونه على يوم وليلة يثبت حكم وجوب الصلاة
في حقه حتى يلزمه القضاء والخطاب موضوع عنه، ألا ترى أن المجنون أو المغمى عليه لو كان كافرا فكما أفاق أسلم لم تلزمه قضاء الصلوات لما لم يثبت الوجوب في تلك الحالة في حقه لانعدام الاهلية، فإن الاسباب إنما توجب على من يكون أهلا للوجوب عليه، وكذلك المغمى عليه في جميع شهر رمضان أو المجنون في بعض الشهر يثبت الوجوب في حقهما حتى يجب القضاء بعد الافاقة والخطاب موضوع عنهما، وكذلك الزكاة على أصل الخصم تجب على الصبي والمجنون والخطاب موضوع عنهما، وبالاتفاق يجب عليهما العشر وصدقة الفطر، وكذلك يجب عليهما حقوق العباد عند تحقق الاسباب منهما أو من الولي على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذي يلزمهما بتزويج الولي إياهما، والعتق الذي يستحقه القريب عليهما عند دخوله في ملكهما بالارث وإن كان الخطاب موضوعا عنهما.
إذا تقرر هذا فنقول: الاسباب التي جعلها الشرع موجبا للمشروعات هي الاسباب التي تضاف المشروعات إليها وتتعلق بها شرعا، لان إضافة الشئ إلى الشئ في الحقيقة تدل على أنه حادث به كما يقال: كسب فلان أي حدث له باكتسابه، وقد يضاف إلى الشرط مجازا أيضا على معنى أن وجوده يكون عند وجود الشرط ولكن المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز، وتعلق الشئ بالشئ يدل على نحو ذلك، فحين رأينا إضافة الصلاة إلى الوقت شرعا وتعلقها بالوقت شرعا أيضا حتى تتكرر بتكررها مع أن مطلق الامر لا يوجب التكرار وإن كان معلقا بشرط، ألا ترى أن الرجل إذا قال (لغيره) تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس لا يقتضي هذا الخطاب التكرار، ورأينا أن وجوب الاداء الثابت بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) غير مقصور على المرة الواحدة، ثبت أن تكرار الوجوب باعتبار تجدد السبب بدلوك الشمس في كل يوم، ثم وجوب الاداء مرتب عليه بحكم هذا الخطاب، وحرف اللام في قوله تعالى: (لدلوك الشمس) دليل على تعلقها بذلك الوقت، كما يقال تأهب للشتاء وتطهر للصلاة ولم يتعلق بها وجودا
عندها، فعرفنا أن تعلق الوجوب بها بجعل الشرع ذلك الوقت سببا لوجوبها فنقول: وجوب الايمان بالله تعالى كما هو بأسمائه وصفاته بإيجاب الله، وسببه في الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم لمن وجب عليه، وهذه الآيات غير موجبة لذاتها، وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضا ولكن الله تعالى هو الموجب بأن أعطاه آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب، كمن يقول لغيره هاك السراج فإن أضاء لك الطريق فاسلكه كان الموجب للسلوك في الطريق هو الامر بذلك لا الطريق بنفسه ولا السراج، فالعقل بمنزلة السراج والآيات الدالة على حدث العالم بمنزلة الطريق، والتصديق من العبد والاقرار بمنزلة السلوك في الطريق فهو واجب بإيجاب الله تعالى
حقيقة، وسببه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم ولهذا تسمى علامات، فإن العلم للشئ لا يكون موجبا لنفسه، ولا نعني أن هذه الآيات توجب وحدانية الله تعالى ظاهرا أو حقيقة، وإنما نعني أنها في الظاهر سبب لوجوب التصديق والاقرار على العبد، ولكون هذه الآيات دائمة لا تحتمل التغير بحال إذ لا يتصور للمحدث أن يكون غير محدث في شئ من الاوقات فكان فرضية الايمان بالله تعالى دائما بدوام سببه غير محتمل للنسخ والتبديل بحال، ولهذا صححنا إيمان الصبي العاقل، لان السبب متقرر في حقه والخطاب بالاداء موضوع عنه بسبب الصبا، لان الخطاب بالاداء يحتمل السقوط في بعض الاحوال ولكن صحة الاداء باعتبار تقرر السبب الموجب لا باعتبار وجوب الاداء، كالبيع بثمن مؤجل سبب لجواز أداء الثمن قبل حلول الاجل وإن لم يكن الخطاب بالاداء متوجها حتى يحل الاجل، والمسافر إذا صام في شهر رمضان كان صحيحا منه فرضا لتقرر السبب في حقه وإن كان الخطاب بالاداء موضوعا عنه قبل إدراك عدة من أيام أخر، وهذا لان صحة الاداء تكون بوجود ما هو الركن ممن هو أهل والركن هو التصديق والاقرار، والاهلية لذلك لا تنعدم بالصبا، فبعد ذلك بامتناع صحة الاداء لا يكون إلا بحجر شرعي، والقول بالحجر لاحد عن الايمان بالله تعالى محال، فأما الصلاة فواجبة بإيجاب الله تعالى بلا شبهة، وسبب وجوبها
في الظاهر هو الوقت في حقنا وأمرنا بأدائها بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أي لوجوبها بدلوك الشمس، والدليل عليه أنها تنسب إلى الوقت شرعا، فيقال فرض الوقت وصلاة الفجر والظهر، وإنما يضاف الواجب إلى سببه، وكذلك يتكرر الوجوب بتكرر الوقت، والخطاب لا يوجب التكرار وهي لا تضاف إلى الخطاب شرعا وليس هنا سوى الوقت والخطاب، فتبين بهذا أن الوقت هو السبب ولهذا لا يجوز تعجيلها قبل الوقت ويجوز بعد دخول الوقت مع تأخير لزوم الاداء بالخطاب
إلى آخر الوقت.
فإن قيل: لا يفهم من وجوب العبادة شئ سوى وجوب الاداء ولا خلاف أن وجوب الاداء بالخطاب فما الذي يكون واجبا بسبب الوقت ؟ قلنا: الواجب بسبب الوقت ما هو المشروع نفلا في غير الوقت الذي هو سبب للوجوب، وبيان هذا في الصوم فإنه مشروع نفلا في كل يوم وجد الاداء أو لم يوجد، وفي رمضان يكون مشروعا واجبا بسبب الوقت سواء وجد خطاب الاداء بوجود شرطه وهو التمكن من الاداء أو لم يوجد، ألا ترى أن من كان مغمى عليه أو نائما في وقت الصلاة ثم أفاق بعد مضي الوقت يصير مخاطبا بالاداء لوجوبها عليه لوجود السبب وهو الوقت ولو كان هذا المغمى عليه أو النائم غير بالغ ثم بلغ بعد مضي الوقت ثم أفاق وانتبه لم يكن عليه قضاؤها وقد صار مخاطبا عند الافاقة في الموضعين بصفة واحدة ولكن لما انعدمت الاهلية عند وجود السبب لم يثبت الوجوب في حقه، فلما وجدت الاهلية في الفصل الاول ثبت الوجوب، ومن باع بثمن مؤجل فالثمن يجب بنفس العقد والخطاب بالاداء متأخر إلى مضي الاجل فهذا مثله.
وسبب وجوب الصوم شهود الشهر في حال قيام الاهلية ولهذا أضيف إلى الشهر شرعا ويتكرر بتكرر الشهر ولم يجب الاداء قبل وجود الشهر وجاز بعد وإن كان الاداء متأخرا كما في حق المريض والمسافر، فإن الامر بالاداء في حقهما بعد إدراك عدة من أيام أخر، والوجوب ثابت في الشهر بتقرر سببه حتى لو صاما كان ذلك فرضا، ألا ترى أن من كان مسافرا في رمضان غير بالغ ثم صار مقيما بعدما بلغ
خارج رمضان لا يلزمه الصوم، ولو كان بالغا في رمضان مسافرا لزمه الاداء إذا صار مقيما وحالهما عند الاقامة بصفة واحدة، فعرفنا أن الوجوب ثبت في حق أحدهما بتقرر سببه دون الآخر.
وبيان ما قلنا في قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
معناه: فليصم فيه، لان الوقت ظرف للصوم وإنما يفهم من هذا فليصم فيه الصوم الواجب بشهوده، ولهذا ظن بعض المتأخرين ممن صنف في هذا الباب أن سبب الوجوب أيام الشهر دون الليالي، لان صلاحية الاداء مختص بالايام.
قال رضي الله عنه: وهذا غلط عندي بل في السببية للوجوب الايام والليالي سواء، فإن الشهر اسم لجزء من الزمان يشتمل على الايام والليالي وإنما جعله الشرع سببا لاظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالي والايام جميعا، والرواية محفوظة في أن من كان مفيقا في أول ليلة من الشهر ثم جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو مجنون ثم أفاق يلزمه القضاء، ولو لم يتقرر السبب في حقه بما شهد من الشهر في حالة الافاقة لم يلزمه القضاء (وكذلك المجنون إذا أفاق في ليلة من الشهر ثم جن قبل أن يصبح ثم أفاق بعد مضي الشهر يلزمه القضاء) والدليل عليه أن نية أداء الفرض تصح بعد دخول الليلة الاولى بغروب الشمس قبل أن يصبح، ومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب لا يصح، ألا ترى أنه لو نوى قبل غروب الشمس لم تصح نيته، وأيد ما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته فإنه نظير قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وقد بينا في الصلاة أن في تقرر الوجوب بتقرر السبب لا يعتبر التمكن بالاداء، فإن من أسلم في آخر الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت يلزمه فرض الوقت فهنا وإن لم يثبت التمكن من الاداء بشهود الليل يتقرر سبب الوجوب ولكن بشرط احتمال الاداء في الوقت، ولهذا لو أسلم في آخر يوم من رمضان قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصوم وإن أدرك جزءا من الشهر، لانه ليس هنا معنى احتمال الاداء في الوقت، وقد قررنا هذا فيما سبق.
وسبب وجوب الحج البيت ولهذا يضاف إليه شرعا، قال الله تعالى: (ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولهذا لا يتكرر بتكرر وقت الاداء، لان ما هو السبب غير متجدد، فأما الوقت فهو شرط جواز الاداء وليس بسبب للوجوب ولا يقال بدخول شوال يدخل الوقت ويتأخر الاداء إلى يوم عرفة، فعرفنا أن الوقت سبب للوجوب إذ لو لم يكن سببا له لم يكن إضافة الوقت إليه مفيدا ويقال أشهر الحج كما يقال وقت الصلاة، فعرفنا أنه سبب فيه، وهذا لان عندنا يجوز الاداء كما دخل شوال، ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعضها مختص بوقت ومكان وبعضها لا يختص، فما كان مختصا بوقت أو مكان لا يجوز في غير ذلك الوقت كما لا يجوز في غير ذلك المكان وما لم يكن مختصا بوقت فهو جائز في جميع وقت الحج، حتى إن من أحرم في رمضان وطاف وسعى لم يكن سعيه معتدا به من سعى الحج حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه إعادة السعي، ولو كان طاف وسعى في شوال كان سعيه معتدا به حتى لا يلزمه إعادته يوم النحر، لان السعي غير مؤقت فجاز أداؤه في أشهر الحج، وأما الوقوف موقت فلم يجز أداؤه قبل وقته كما لا يجوز أداء طواف الزيارة يوم عرفة لانه موقت بيوم النحر، وكما لا يجوز رمي اليوم الثاني في اليوم الاول، وهو نظير أركان الصلاة فإن السجود ترتب على الركوع فلا يعتد به قبل الركوع، ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت الاداء، وبهذا تبين أن الوقت ليس بسبب للوجوب ولكنه شرط جواز الاداء ووجوب الاداء فيه، وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبب للوجوب فإن هذه عبادة بدنية وإنما كان البيت سببا لوجوبها لانها عبادة هجرة وزيارة تعظيما لتلك البقعة فلا يصلح المال سببا لوجوبها ولا هو شرط لجواز الاداء أيضا، فالاداء من الفقير صحيح وإن كان لا يملك شيئا وإنما المال شرط وجوب الاداء فإن السفر الذي يوصله إلى الاداء لا يتهيأ له بدون الزاد والراحلة إلا بحرج عظيم والحرج مدفوع، فعرفنا أن المال شرط وجوب الاداء وهو نظير عدة من أيام أخر في باب الصوم (في حق المسافر) فإنه شرط
وجوب الاداء حتى كان الاداء جائزا قبله، ولا يتكرر وجوب الاداء بتجدد هذه الايام، وهنا أيضا لا يتكرر وجوب الاداء بتجدد ملك الزاد والراحلة، فعرفنا أنه شرط لوجوب الاداء.
وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها شرعا، فيقال تطهر للصلاة، فأما الحدث فهو شرط وجوب الاداء بالامر وهو قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) الآية، لا أن يكون سببا للوجوب، وكيف يكون سببا (للوجوب) وهو ناقض للطهارة ؟ فما كان مزيلا للشئ رافعا له لا يصلح سببا لوجوبه ولهذا جاز الاداء بدونه، وكان الوضوء على وضوء نورا على نور، ولا يجب الاداء مع تحقق الحدث بدون وجوب الصلاة، فإن الجنب إذا حاضت لا يجب عليها الاغتسال ما لم تطهر لانه ليس عليها وجوب الصلاة، وبهذا تبين أن الطهارة ليست بعبادة مقصودة ولكنها شرط الصلاة وما يكون شرطا للشئ يتعلق به صحته، ووجوبه بوجوب الاصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود في باب النكاح ثبوتها بثبوت النكاح لكون الشهود شرطا في النكاح.
وسبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا، ألا ترى أنه يضاف إلى المال وأنه يتضاعف بتضاعف النصب في وقت واحد ولكن الوجوب بواسطة غنى المالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صدقة إلا عن ظهر غنى والغنى لا يحصل بأصل المال ما لم يبلغ مقدارا وذلك في النصاب شرعا، والوجوب بصفة اليسر ولا يتم ذلك إلا إذا كان المال ناميا ولهذا يضاف إلى سبب النماء أيضا فيقال زكاة السائمة وزكاة التجارة، فأما مضي الحول فهو شرط لوجوب الاداء من حيث إن النماء لا يحصل إلا بمضي الزمان ولهذا جاز الاداء بعد كمال النصاب قبل حولان الحول وجواز الاداء لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كمال النصاب لم يجز.
فإن قيل: الزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الاحوال، وبتكرر الشرط لا يتجدد الواجب ؟ قلنا: ليس كذلك بل يتكرر الوجوب بتجدد النماء الذي هو وصف
للمال وباعتباره يكون المال سببا للوجوب، فإن لمضي كل حول تأثيرا في حصول النماء المطلوب من عين السائمة بالدر والنسل، والمطلوب من ربح عروض التجارة زيادة القيمة.
وسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغني رأس يموله بولايته عليه، ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس، ويتضاعف الواجب بتعدد الرؤوس من الاولاد الصغار والمماليك، وإنما عرفنا هذا بقوله عليه السلام: أدوا عن كل حر وعبد وقال عليه السلام: أدوا عمن تمونون وحرف عن للانتزاع، فأما أن يكون المراد طريق الانتزاع بالوجوب على الرأس، ثم أداء الغير عنه وهذا باطل، فإنه لا يجب على الكافر والرقيق والفقير والصغير، فعرفنا أن المراد انتزاع الحكم عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التي قلنا هو السبب الموجب للوجوب، وأما الفطر فهو شرط وجوب الاداء والاضافة إليه بطريق المجاز على معنى أن الوجوب عنده يكون، وإنما جعلنا الفطر شرطا والرأس سببا مع وجود الاضافة إليهما لان تضاعف الواجب بتعدد الرؤوس دليل محكم على أنه سبب والاضافة دليل محتمل، فقد بينا أن الاضافة قد تكون إلى الشرط مجازا، ولان التنصيص على المئونة دليل على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطر، فالمئونة إنما تجب عن الرؤوس، ولهذا اشتمل هذا الواجب على معنى المئونة وعلى معنى العبادة لان صفة الغنى فيمن يجب عليه الاداء يعتبر لوجوب الاداء وذلك دليل كونه عبادة، وصفة المئونة في المؤدي دليل على أنه بمنزلة النفقة، وجواز الاداء قبل الفطر دليل على أن الفطر ليس بسبب في وجوب الاداء بشهود وقت الفطر في حق من لا يؤدي الصوم أصلا دليل على أن الفطر شرط وجوب الاداء، فإن الكافر إذا أسلم ليلة العيد أو الصبي بلغ
أو العبد عتق يلزمه الاداء بطلوع الفجر من يوم الفطر، ولهذا لو أسلم بعد طلوع الفجر لم يلزمه وإن أدرك اليوم، لان وقت الفطر عن رمضان في حق وجوب الصدقة عند طلوع الفجر، فإذا انعدمت الاهلية عند ذلك لم يجب الاداء، وتكرر الوجوب
بتكرر الفطر في كل سنة بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول، فإن الوصف الذي لاجله كان الرأس موجبا وهو المئونة يتجدد بمضي الزمان، كما أن النماء الذي لاجله كان المال سببا للوجوب يتجدد بتجدد الحول.
وسبب وجوب العشر الارض النامية باعتبار حقيقة النماء، وسبب وجوب الخراج الارض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة، ولهذا لو اصطلم الزرع آفة لم يجب العشر ولا الخراج، ولهذا لم يجتمع العشر والخراج بسبب أرض واحدة بحال، لان كل واحد منهما مئونة الارض النامية إلا أن العشر الواجب جزء من النماء فلا بد من حصول النماء ليثبت حكم الوجوب في محله بسببه، ولهذا كان في العشر معنى المئونة ومعنى العبادة، فباعتبار أصل الارض هو مئونة لان تملك الارض سبب لوجوب مئونة شرعا وباعتبار كون الواجب جزءا من النماء فيه معنى العبادة بمنزلة الزكاة، وفي الخراج معنى المئونة باعتبار أصل الارض، ومعنى المذلة باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة، فالاشتغال بالزراعة مع الاعراض عن الجهاد سبب للمذلة على ما روي أن النبي عليه السلام رأى شيئا من آلات الزراعة في دار فقال: ما دخل (هذا) بيت قوم إلا ذلوا ولهذا يتكرر وجوب العشر بتجدد الخارج لتجدد الوصف وهو النماء ولا يتكرر وجوب الخراج في حول واحد بحال، ولهذا جاز تعجيل الخراج قبل الزراعة ولم يجز تعجيل العشر لان الارض باعتبار حقيقة النماء توجب العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة، ولهذا أوجب أبو حنيفة رحمه الله العشر في قليل الخارج وكثيره وفي كل ما يستنبت في الارض مما له ثمرة
باقية وما ليست له ثمرة باقية سواء، لان الوجوب باعتبار صفة النماء ولا معتبر بصفة الغنى فيمن يجب عليه باعتبار النصاب لاجله.
وسبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة، وهو أن يكون كافرا حرا له بنية صالحة للقتال، ولهذا يضاف إليه فيقال: جزية الرأس، ويتكرر الوجوب
بتكرر الحول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة، فإن المعنى الذي كان الرأس سببا موجبا باعتبار نصرة القتال، وهذا لان أهل الذمة يصيرون منا دارا، والقتال بنصرة الدار واجب على أهلها، ولا تصلح أبدانهم لهذه النصرة لميلهم إلى أهل الدار المعادية لدارنا اعتقادا فأوجب عليهم في أموالهم جزية عقوبة لهم على كفرهم، وخلفا عن النصرة التي قامت بإصرارهم على الكفر في حقنا، ولهذا تصرف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار، وهذه النصرة يتجدد وجوبها بتجدد الحاجة في كل وقت، فكذلك ما كان خلفا عنها بتجدد وجوبها، إلا أنه لا نهاية للحاجة إلى المال فيعتبر الوقت لتجدد الوجوب كما يعتبر في الزكاة.
وسبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه نحو الزنا للرجم والجلد، والسرقة للقطع، وشرب الخمر والقذف للحد، والقتل العمد للقصاص.
وسبب وجوب الكفارات التي هي دائرة بين العقوبة والعبادة ما يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والاباحة نحو اليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث فيها، والظهار عند العود، والفطر في رمضان بصفة الجناية، والقتل بصفة الخطأ.
فأما سبب المشروع من المعاملات فهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها، وبيان ذلك أن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة، وهذا البقاء إنما يكون ببقاء الجنس وبقاء النفس، فبقاء الجنس بالتناسل، والتناسل بإتيان الذكور الاناث في موضع الحرث، والانسان هو المقصود بذلك، فشرع لذلك التناسل طريقا لا فساد فيه
ولا ضياع، وهو طريق الازدواج بلا شركة، ففي التغالب فساد العالم، وفي الشركة ضياع الولد لان الاب إذا اشتبه يتعذر إيجاب مئونة الولد عليه، وبالامهات عجز عن اكتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيع الولد، وبقاء النفس إلى أجله إنما يقوم بما تقوم
به المصالح للمعيشة وذلك بالمال، وما يحتاج إليه كل واحد لكفايته لا يكون حاصلا في يده وإنما يتمكن من تحصيله بالمال، فشرع سبب اكتساب المال وسبب اكتساب ما فيه كفاية لكل واحد وهو التجارة عن تراض لما في التغالب من الفساد والله لا يحب الفساد، ولان الله تعالى جعل الدنيا دار محنة وابتلاء، كما قال تعالى: (إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) والانسان الذي هو مقصود غير مخلوق في الدنيا لنيل اللذات وقضاء الشهوات بل للعبادة التي هي عمل بخلاف هوى النفس، قال الله تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فعرفنا أن ما جعل لنا في الدنيا من اقتضاء الشهوات بالاكل وغير ذلك ليس لعين اقتضاء الشهوة بل لحكم آخر وهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها، إلا أن في الناس مطيعا وعاصيا، فالمطيع يرغب فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الامر، والعاصي يرغب فيه لقضاء شهوة النفس فيتحقق البقاء المقدور بفعل الفريقين، وللمطيع الثواب باعتبار قصده إلى الاقدام عليه، والعاصي مستوجب للعقاب باعتبار قصده في اتباع هوى النفس الامارة بالسوء، تبارك الله الحكيم الخبير القدير، هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
فصل: في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها قال رحمه الله: هذه المشروعات تنقسم على أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة ونفل.
فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع، وفي الاسم ما يدل على ذلك كله، فإن الفرض لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف
ما فرضتم) : أي قدرتم بالتسمية، وقال تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) : أي قطعنا الاحكام قطعا، وفي هذا الاسم ما ينبئ عن شدة الرعاية في الحفظ لانه مقطوع به وما ينبئ عن التخفيف لانه مقدر متناه كيلا يصعب علينا أداؤه، ويسمى مكتوبة أيضا لانها كتبت علينا في اللوح المحفوظ.
وبيان هذا القسم في الايمان بالله تعالى، والصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن التصديق بالقلب
والاقرار باللسان بعد المعرفة فرض مقطوع به، إلا أن التصديق مستدام في جميع العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال، والاقرار لا يكون واجبا في جميع الاحوال وإن كان لا يجوز تبديله بغيره من غير عذر بحال، والعبادات التي هي أركان الدين مقدرة متناهية مقطوع بها.
وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده، وموجب للعمل بالبدن للزوم الاداء بدليله، فيكون المؤدي مطيعا لربه والتارك للاداء عاصيا، لانه بترك الاداء مبدل للعمل لا للاعتقاد وضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الاداء فيما هو من أركان الدين، لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فإن استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر، فاسق لخروجه من طاعة ربه، فالفسق هو الخروج، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها، ولهذا كان الفاسق مؤمنا لانه غير خارج من أصل الدين وأركانه اعتقادا، ولكنه خارج من الطاعة عملا، والكافر رأس الفساق في الحقيقة إلا أنه اختص باسم هو أعظم في الذم، فاسم الفاسق عند الاطلاق يتنازل المؤمن العاصي باعتبار أعماله.
فأما الواجب فهو ما يكون لازم الاداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة، والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط، قال الله تعالى: (فإذا وجبت
جنوبها) : أي سقطت على الارض، فما يكون ساقطا على المرء عملا بلزومه إياه من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا يسمى واجبا، أو هو ساقط في حق الاعتقاد قطعا وإن كان ثابتا في حق لزوم الاداء عملا، والفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضا لبقاء أثره على كل حال، ويسمى السقوط على الارض وجوبا لانه قد لا يبقى أثره في الباقي، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا، لبقاء أثره وهو العلم به أدى أو لم يؤد، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجبا، وقيل الاسم مشتق من الوجبة وهي الاضطراب قال القائل:
وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر أي اضطراب، فلنوع شبهة في دليله يتمكن فيه اضطراب فسمي واجبا، وهذا نحو تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، وتعديل الاركان، والطهارة في الطواف، والسعي في الحج وأصل العمرة والوتر.
والشافعي ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض، فإن كان إنكاره ذلك للاسم فقد بينا معنى الاسم، وإن كان للحكم فهو إنكار فاسد، لان ثبوت الحكم بحسب الدليل، ولا خلاف بيننا وبينه أن هذا التفاوت يتحقق في الدليل فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته، فيثبت حكم هذا القسم بحسب دليله وهو أنه لا يكفر جاحده، لان دليله لا يوجب علم اليقين، ويجب العمل به لان دليله موجب للعمل ويضلل جاحده إذا لم يكن متأولا بل كان رادا لخبر الواحد، فإن كان متأولا في ذلك مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد فحينئذ لا يضلل، ولوجوب العمل به يكون المؤدي مطيعا والتارك من غير تأويل عاصيا معاقبا، وهذا لان الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا
بما يثبت النسخ به والنسخ لا يثبت بخبر الواحد، فكذلك لا نثبت الزيادة فلا يكون موجبا للعلم بهذا المعنى ولكن يجب العمل به، لان في العمل تقرير الثابت بالنص لا نسخ له، إلا أن هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكي عن يوسف بن خالد السمتي رحمه الله: قدمت على أبي حنيفة رضي الله عنه فسألته عن الصلاة المفروضة كم هي ؟ فقال: خمس، فسألته عن الوتر، فقال: واجب، فقلت لقلة تأملي: كفرت فتبسم في وجهي، ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب والفريضة فرق كما بين السماء والارض، فيرحم الله أبا حنيفة ويجازيه خيرا على ما هداني إليه.
وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به، وهو قوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد
فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص، ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه، وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل.
وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص، وتعديل الاركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التعديل كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خبر الواحد عما هو درجته في الحجة، ولو لم ندخل نقصانا في الصلاة بترك التعديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل.
وكذلك الوتر فإنه ثابت بخبر الواحد، فلو لم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر الواحد من أن يكون موجبا للعمل، ولو جعلناه فرضا كنا قد ألحقنا خبر الواحد بالنص الذي هو مقطوع به.
وكذلك شرط الطهارة في الطواف فإن فرضية الطواف بدليل مقطوع به، واشتراط الطهارة فيه بخبر الواحد حيث شبهه رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقا لدليله بالنص المقطوع به، والقول بأنه يتمكن نقصان في الطواف حتى يعيد ما دام بمكة وإذا رجع إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون عملا بدليله كما هو موجبه.
وكذلك ترك الطواف بالحطيم، فإن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد.
وكذلك السعي فإن ثبوته بخبر الواحد لان المنصوص عليه في الكتاب: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا لا يوجب الفرضية.
وكذلك العمرة ثبوتها بخبر الواحد، فأما الثابت بالنص: (ولله على الناس حج البيت) وهذا لا يوجب نوعين من الزيارة قطعا، والاضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا تخرج.
وأما السنة: فهي الطريقة المسلوكة في الدين، مأخوذة من سنن الطريق، ومن قول القائل: سن الماء إذا صبه حتى جرى في طريقه، وهو اشتقاق معروف، والمراد به شرعا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا.
وقال
الشافعي: مطلق السنة يتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا لانه لا يرى تقليد الصحابي ويقول: القياس مقدم على قول الصحابي فإنما يتبع حجته لا فعله، وقوله بمنزلة من بعد الصحابة فإنه يتبع حجتهم لا مجرد فعلهم وقولهم إذا لم يبلغوا حد الاجماع، ولهذا قال في قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية: السنة تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك قوله في استحقاق الفرقة بسبب العجز عن النفقة: السنة أنها تنصرف إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكذلك قوله في أن الحر لا يقتل بالعبد: السنة تنصرف إلى سنة رسول الله عليه السلام) فأما عندنا إطلاق هذا اللفظ لا يوجب الاختصاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة،
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والسلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين، وقال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إذا ثبت هذا فنقول: حكم السنة هو الاتباع، فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متبع فيما سلك من طريق الدين قولا وفعلا، وكذلك الصحابة بعده، وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين، فإن ذلك بمنزلة الواجب في حكم العمل على ما قال مكحول رحمه الله: السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها ضلالة، وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به، فالاول نحو صلاة العيد والاذان والاقامة والصلاة بالجماعة، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها، والثاني نحو ما نقل من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه، وسننه في العبادات متبوعة أيضا، فمنها ما يكره تركها، ومنها ما يكون التارك مسيئا، ومنها ما يكون
المتبع لها محسنا ولا يكون التارك مسيئا، وعلى هذا تخرج الالفاظ المذكورة في باب الاذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به، وحيث قيل يعيد فهو دليل الوجوب، وعلى هذا الخلاف قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا عندنا لا يقتضي مطلقه أن يكون الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعند الشافعي مطلقه يقتضي ذلك، وقد كانوا يطلقون لفظ الامر على ما أمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كما كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين، وتمام بيان هذا يتأتى في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأما النافلة: فهي الزيادة، ومنه تسمى الغنيمة نفلا لانه زيادة على ما هو
المقصود بالجهاد شرعا، ومنه سمي ولد الولد نافلة لانه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه، فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا، والتطوعات كذلك فإن التطوع اسم لما يتبرع به المرء من عنده ويكون محسنا في ذلك ولا يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولهذا قلنا: إن الشفع الثاني من ذوات الاربع في حق المسافر نفل، لانه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولهذا جوزنا صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وراكبا مع القدرة على النزول بالايماء في حق الراكب وإن لم يكن متوجها إلى القبلة، لانه مشروع زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد بوقت، وفي مراعاة تمام الاركان والشرائط في جميع الاوقات حرج ظاهر، فلدفع الحرج جوزنا الاداء على أي وصف يشرع فيه لتحقيق كونه زيادة لنا.
وقال الشافعي: آخره من جنس أوله نفل فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع وبين أن لا يشرع لكونه نفلا فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، وإذا ترك الاتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه شيئا كما في المظنون.
وقلنا نحن: المؤدي موصوف بأنه لله تعالى وقد صار مسلما بالاداء، ولهذا لو مات كان مثابا على ذلك فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق، وهذا التحرز
لا يتحقق إلا بالاتمام فيما لا يحتمل الوصف بالتجزي عبادة فيجب الاتمام لهذا وإن كان في نفسه نفلا، ويجب القضاء إذا أفسده لوجود التعدي فيما هو حق الغير بمنزلة المنذور، فالمنذور في الاصل مشروع نفلا ولهذا يكون مستداما كالنوافل إلا أن لمراعاة التسمية بالنذر يلزمه أداء المشروع نفلا، فإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية فلان يجب الاتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء ابتداء كان أولى، وهو نظير الحج فإن المشروع منه نفلا يصير واجب الاداء لمراعاة التسمية حقا للشرع، فكذلك الاتمام بعد الشروع في الاداء يجب حقا للشرع، وهذا هو الطريق في بيان الانواع
الاربعة.
ومما هو ثابت بخبر الواحد أيضا تأخير المغرب للحاج إلى أن يجمع بينه وبين العشاء في وقت العشاء بالمزدلفة، فإنه ثابت بقوله عليه السلام لاسامة بن زيد رضي الله عنهما الصلاة أمامك ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لو صلى المغرب في الطريق في وقت المغرب يلزمه الاعادة بالمزدلفة ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر يسقط عنه الاعادة، لان الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل يوجب الجمع بينهما في وقت العشاء وقد تحقق فوات هذا العمل بطلوع الفجر، فلو ألزمناه القضاء مطلقا كنا قد أفسدنا ما أداه أصلا وذلك حكم ترك الفريضة، فكذلك الترتيب بين الفوائت، وفرض الوقت ثابت بخبر الواحد فيكون موجبا للعمل ما لم يتضيق الوقت، لان عند التضيق تتحقق المعارضة بتعين هذا الوقت لاداء فرض الوقت، وكذلك عند كثرة الفوائت لان الثابت بخبر الواحد الترتيب عملا وبعد التكرار في الفوائت يتحقق فوات ذلك، وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا ترك صلاة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لها فليس عليه إلا قضاء الفائتة، لان فساد الخمس بعدها لم يكن بدليل مقطوع به ليجب قضاؤها مطلقا وإنما كان لوجوب الترتيب بخبر الواحد وقد سقط وجوب الترتيب عملا عند كثرة الصلوات فلا يلزمه إلا قضاء المتروكة، والله أعلم.
فصل: في بيان العزيمة والرخصة قال رحمه الله: العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض.
سميت عزيمة لانها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة والقوة حقا لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده، وله الامر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وعلينا الاسلام والانقياد.
والرخصة: ما كان بناء على عذر يكون للعباد، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء
الدليل المحرم، وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة.
والاسمان من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا، لان العزم في اللغة هو: القصد المؤكد، قال الله تعالى: (فنسي ولم نجد له عزما) : أي قصدا متأكدا في العصيان، وقال تعالى: (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) ومنه جعل العزم يمينا، حتى إذا قال القائل: أعزم كان حالفا، لان العباد إنما يؤكدون قصدهم باليمين.
والرخصة في اللغة عبارة عن: اليسر والسهولة، يقال: رخص السعر إذا تيسرت الاصابة لكثرة وجود الاشكال وقلة الرغائب فيها، وفي عرف اللسان تستعمل الرخصة في الاباحة على طريق التيسير، يقول الرجل لغيره: رخصت لك في كذا، أي أبحته لك تيسيرا عليك، وقد بينا ما هو العزيمة في الفصل المتقدم، فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداء عزيمة، ولهذا لا تحتمل التغيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة.
وزعم بعض أصحابنا أنها ليست بعزيمة لانها شرعت جبرا للنقصان في أداء ما هو عزيمة من الفرائض، أو قطعا لطمع الشيطان في منع العباد من أداء الفرائض، من حيث إنهم لما رغبوا في أداء النوافل مع أنها ليست عليهم فذلك دليل رغبتهم في أداء الفرائض بطريق الاولى، والاول أوجه، فهذا الذي قالوا مقصود الاداء، فأما النوافل فمشروع ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العباد.
وأما الرخصة قسمان: أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فالحقيقة نوعان: أحدهما أحق من الآخر، والمجاز نوعان أيضا: أحدهما أتم من الآخر في كونه مجازا.
فأما النوع الاول فهو: ما استبيح مع قيام السبب المحرم وقيام حكمه، ففي ذلك الرخصة الكاملة بالاباحة لعذر العبد مع قيام سبب الحرمة وحكمها، وذلك نحو إجراء كلمة الشرك على اللسان بعذر الاكراه، فإن حرمة الشرك باتة لا ينكسف عنه لضرورة وجوب حق الله تعالى في الايمان به قائم أيضا ومع هذا أبيح لمن خاف التلف
على نفسه عند الاكراه إجراء الكلمة رخصة له، لان في الامتناع حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى وبإجراء الكلمة لا يفوت ما هو الواجب معنى، فإن التصديق بالقلب باق والاقرار الذي سبق منه مع التصديق صح إيمانه، واستدامة الاقرار في كل وقت ليس بركن إلا أن في إجراء كلمة الشرك هتك حرمة حق الله تعالى صورة، وفي الامتناع مراعاة حقه صورة ومعنى فكان الامتناع عزيمة، لان الممتنع مطيع ربه مظهر للصلابة في الدين وما ينقطع عنه طمع المشركين وهو جهاد فيكون أفضل، والمترخص بإجراء الكلمة يعمل لنفسه من حيث السعي في دفع سبب الهلاك عنها، فهذه رخصة له إن أقدم عليها لم يأثم، والاول عزيمة حتى إذا صبر حتى قتل كان مأجورا، وعلى هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الهلاك، فإن السبب الموجب لذلك وحكم السبب وهو الوجوب حقا لله تعالى قائم ولكن يرخص له في الترك، والتأخير بعذر كان من جهته وهو خوف الهلاك وعجزه عن شد المعاضد عنه، ولهذا لو أقدم على الامر بالمعروف حتى يقتل كان مأجورا لانه مطيع ربه فيما صنع، وفي هذا الفصل يباح له الاقدام عليه وإن كان يعلم أنه لا يتمكن من منعهم عن المنكر، بخلاف ما إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم حتى يقتل فإنه لا يسعه الاقدام، لان الفسقة معتقدون لما يأمرهم به وإن كانوا يعملون بخلافه ففعله يكون مؤثرا في باطنهم لا محالة وإن لم يكن مؤثرا في ظاهرهم ويتفرق جمعهم عند إقدامه على الامر بالمعروف وإن قتلوه والمقصود تفريق جمعهم، وأما المشركون غير معتقدين لما يأمرهم به المسلم فلا يتفرق جمعهم بصنيعه فإذا كان فعله لا ينكأ فيهم كان مضيعا نفسه في الحملة عليهم، ملقيا بيده إلى التهلكة لا أن يكون عاملا لربه في إعزاز الدين.
وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه للمضطر عند خوف الهلاك فإنه رخصة مع قيام سبب الحرمة وحكمها وهو حق المالك، ولهذا وجب الضمان
حقا له، وكذلك إباحة إتلاف مال الغير عند تحقق الاكراه فإنه رخصة مع قيام سبب الحرمة وحكمها، وكذلك إباحة الافطار في رمضان للمكره، وإباحة الاقدام على الجناية على الصيد للمحرم.
ولهذا النوع أمثلة كثيرة والحكم في الكل واحد له أن يرخص بالاقدام على ما فيه رفع الهلاك عن نفسه فذلك واسع له، تيسيرا من الشرع عليه، وإن امتنع فهو أفضل له ولم يكن في الامتناع عاملا في إتلاف نفسه بل يكون متمسكا بما هو العزيمة.
والنوع الثاني: ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب (فلكون السبب القائم موجبا للحكم كانت الاستباحة ترخصا للمعذور ولكون الحكم متراخيا عن السبب) كان هذا النوع دون الاول، فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة، فإذا كان الحكم ثابتا في السبب فذلك في العزيمة أقوى منه إذا كان الحكم متراخيا عن السبب، بمنزلة البيع بشرط الخيار مع البيع البات، والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال، فالحكم وهو الملك في المبيع والمطالبة بالثمن ثابت في البات المطلق متراخ عن السبب في المقرون بشرط الخيار أو الاجل، وبيان هذا النوع في الصوم في شهر رمضان للمسافر والمريض فإن السبب الموجب شرعا وهو شهود الشهر قائم، ولهذا لو أديا كان المؤدى فرضا ولكن الحكم متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخر، ولهذا لو ماتا قبل الادراك لم يلزمهما شئ ولو كان الوجوب ثابتا للزمهما الامر بالفدية عنهما، لان ترك الواجب بعذر يرفع الاثم ولكن لا يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية، والتعجيل بعد تمام السبب مع تراخي الحكم صحيح كتعجيل الدين المؤجل.
ثم قال الشافعي رحمه الله: لما كان حكم الوجوب متأخرا إلى إدراك عدة من أيام أخر كان الفطر أفضل ليكون إقدامه على الاداء متراخيا بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر، وقلنا نحن: الصوم أفضل لان مع إباحة الترخص بالفطر للمشقة التي تلحقه بالصوم في المرض أو السفر
السبب الموجب قائم فكان المؤدى للصوم عاملا لله تعالى في إدراك الفرائض، والمترخص بالفطر عاملا لنفسه فيما يرجع إلى الترفة فالاول عزيمة والتمسك بالعزيمة أفضل مع أن
في معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر، فمن وجه الصوم مع الجماعة في شهر رمضان يكون أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر وإن كان أشق على بدنه، ومن وجه الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الاقامة أيسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان في وقت واحد: مشقة السفر ومشقة أداء الصوم، وإذا كان في كل جانب نوع ترفه يخير بينهما للتيسير عليه، وبعد تحقق المعارضة بينهما يترجح جانب أداء الصوم لكونه مطيعا فيه عاملا لله تعالى إلا أن يخاف الهلاك على نفسه إن صام فحينئذ يلزمه أن يفطر، لانه إن صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل الصوم فيكون قاتلا نفسه وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه، بخلاف ما إذا أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى قتله لان القتل هنا مضاف إلى فعل الظالم، فأما هو في الامتناع عن الفطر عند الاكراه مستديم للعبادة، مظهر للطاعة عن نفسه في العمل لله تعالى، وذلك عمل المجاهدين.
وبيان النوع الثالث في الاصر والاغلال التي كانت على من قبلنا، وقد وضعها الله تعالى عنا، كما قال تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم) وقال تعالى: (ربنا ولا تحمل علينا إصرا) الآية، فهذا النوع غير مشروع في حقنا أصلا، لا بناء على عذر موجود في حقنا بل تيسيرا وتخفيفا علينا، فكانت رخصة من حيث الاسم مجازا وإن لم تكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصلا في حقنا، فإن حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرم، ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصة مجازا.
وأما بيان النوع الرابع فما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة، فإنه من حيث انعدام السبب الموجب للحكم يشبه هذا النوع الثالث فكان مجازا، ومن حيث إنه بقي السبب مشروعا في الجملة يشبه
النوع الثاني وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من وجه دون وجه.
وبيان هذا النوع في فصول: منها السلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم والسلم نوع بيع، واشتراط العينية في المبيع المشروع قائم في الجملة ثم سقط هذا الشرط في السلم أصلا حتى كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد لا مصححة، وكان سقوط هذا الشرط للتيسير على المحتاجين حتى يتوصلوا إلى مقصودهم من الاثمان قبل إدراك غلاتهم، ويتوصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن يكون موجبا اعتبار العينية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب موجبا له في الجملة.
وكذلك المسح على الخفين رخصة مشروعة لليسر على معنى أن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم لا على معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالمسح، ولهذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة في الرجلين، وأن يكون أول الحدث بعد اللبس طارئا على طهارة كاملة ولو نزع الخف بعد المسح يلزمه غسل رجليه، فعرفنا أن التيسير من حيث إخراج السبب الموجب للحدث من أن يكون عاملا في الرجل ما دام مستترا بالخف، وتقدم الخف على الرجل في قبول حكم الحدث ما لم يخلعهما مع بقاء أصل السبب في الجملة.
وكذلك الزيادة في مدة المسح للمسافر فإنه رخصة من حيث إن السبب لم يبق في حقه موجبا غسل الرجل بعد مضي يوم وليلة ما لم ينزع الخف، وعلى هذا ما ذكر في كتاب الاكراه أن من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب
الخمر لخوف الهلاك على نفسه من الجوع أو العطش أو للاكراه فإنه لا يسعه الامتناع من ذلك ولو امتنع حتى مات كان آثما، لان السبب غير موجب للحكم عند الضرورة للاستثناء المذكور في قوله تعالى: (إلا ما اضطررتم إليه) فالمستثنى لا يتناوله الكلام موجبا لحكمه، ولكن السبب بهذا الاستثناء لم ينعدم أصلا، فكانت الرخصة ثابتة باعتبار عذر العبد خرج به السبب من أن يكون موجبا للحكم في حقه ويلتحق الحرام في هذه الحالة في حقه بالحلال لما انعدم سبب الحرمة في حقه، ومن امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما، يوضحه أن سبب الحرمة
وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب الخمر، وصيانة بدنه عن ضرر تناول الميتة وصيانة البعض لا يتحقق في إتلاف الكل، فكان الامتناع في هذه الحالة إتلافا للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ما هو المقصود بالحرمة فلا يكون مطيعا لربه بل يكون متلفا نفسه بترك الترخص فيكون آثما.
ومن هذا النوع ما قال علماؤنا رحمهم الله: إنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر أربعا في سفره وإن ذلك بمنزلة ما لو صلى المقيم الفجر أربعا، لان السبب لم يبق في حقه موجبا إلا ركعتين فكانت الاخريان نفلا في حقه، ولهذا يباح له تركهما لا إلى بدل، وخلط النفل بالفرض قصدا لا يحل، وأداء النفل قبل إكمال الفرض يكون مفسدا للفرض فإذا لم يقعد القعدة الاولى فسدت صلاته.
والشافعي رحمه الله يقول: السبب الموجب للظهر أربع ركعات إلا أنه رخص له في الاكتفاء بالركعتين لدفع مشقة السفر فإن أكمل الصلاة كان مؤديا للفرض بعد وجود سببه فيستوي هو والمقيم في ذلك، كما إذا صام المسافر في شهر رمضان، وجعل معنى الرخصة في تخييره بين أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات وبين أن يؤدي ركعتين بمنزلة العبد يأذن له مولاه في أداء الجمعة فإنه يتخير بين أن يؤدي فرض الوقت بالجمعة
ركعتين وبين أن يؤدي بالظهر أربعا.
وهذا غلط منه يتبين عند التأمل في مورد الشرع على ما روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما بالنا نصلي في السفر ركعتين ونحن آمنون ؟ فقال: هذه صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته ونحن نعلم أن المراد التصدق بالاسقاط عنا وما يكون واجبا في الذمة فالتصدق ممن له الحق بإسقاطه يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدين، ومثل هذا الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف على القبول كالطلاق وإسقاط الشفعة، فبهذا يتبين أن السبب لم يبق موجبا للزيادة على الركعتين بعد هذا التصدق، فإن معنى الترخص في إخراج السبب من أن يكون موجبا للزيادة على الركعتين في حقه لا في التخيير، فإن التخيير عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخير وتمليكه منه وذلك لا يتحقق هنا، فالعبادات إنما تلزمنا بطريق الابتلاء، قال الله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وتفويض المشيئة إلى العبد بهذه الصفة في أصل الوجوب أو في مقدار الواجب يعدم معنى
الابتلاء، وبهذا تبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : فاقبلوا صدقته بالوقوف على أداء الواجب من غير خلط النفل به، وهكذا نقول في الصوم إلا أن الرخصة هناك في تأخير الحكم عن السبب وليس للعباد اختيار في رد ذلك إلا أن أصل السبب موجب في حقه ولهذا يلزمه القضاء إذا أدرك عدة من أيام أخر.
وبيان هذا في قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع المسافر شطر الصلاة وأداء الصوم يحقق ما ذكرنا أن المشيئة التامة والاختيار الكامل لا يثبت للعبد أصلا، فإن ذلك بربوبته، وذلك معنى قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) : أي يتعالى أن يكون له رفيق فيما يختار، ويتعالى أن يكون له اختيار لدفع ضرر عنه، وهذا هو الاختيار الكامل، فأما الاختيار للعبد لا ينفك عن معنى الرفق به وذلك في أن يجر
إلى نفسه منفعة باختياره أو يدفع عن نفسه ضررا.
ألا ترى أن الله تعالى خير الحالف بين الانواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفق لنفسه باختياره الايسر عليه وهذا لا يتحقق في التخيير بين القليل والكثير في الجنس الواحد بوجه، وسواء صلى ركعتين أو أربعا فهو ظهر وببداهة العقول يعلم أن الرفق متعين في أداء الركعتين، فمن قال بأنه يتخير بين الاقل والاكثر من غير رفق له في ذلك فإنه لا يثبت له خيارا يليق بالعبودية والعجز، وخطأ هذا غير مشكل، ومن يقول بأن للعبد أن يرد ما أسقط الله تعالى عنه بطريق التصدق عليه فخطؤه لا يشكل أيضا لان عفو الله تعالى عن العباد في الآخرة لا يقول فيه أحد من العقلاء إنه يرتد برد العبد وإنه تخيير للعبد، وهذا بخلاف العبد المأذون في أداء الجمعة لان الجمعة غير الظهر، ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخر وعند المغايرة لا يتعين الرفق في الاقل عددا، فأما ظهر المقيم وظهر المسافر فواحد في الحكم فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شئ من معنى الرفق فيه.
ونظير هذا العبد الجاني إذا جنى جناية يخير المولى بين الدفع والفداء فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية أو كان الجاني مدبرا تكون على المولى قيمته ولا خيار له في ذلك، لان الجنس لما كان واحدا فالرفق كله متعين في الاقل.
وكذلك من اشترى شيئا لم يره يثبت له خيار الرؤية لتحقيق معنى الرفق باسترداد الثمن عند فسخ
البيع، وفي السلم لا يثبت خيار الرؤية لان برد المقبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد الثمن ولكنه يرجع بمثل المقبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق.
فإن قيل: معنى الرفق هنا يتحقق من حيث إن ثوابه في أداء الاربع أكثر وأداء الركعتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا المعنى.
قلنا: أحكام الدنيا لا تبنى على ما هو من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله في امتثال الامر بأداء الواجب لا في عدد الركعات، فإن جمعة الحر في الثواب لا يكون دون ظهر العبد، وفجر المقيم
في الثواب لا يكون دون ظهره، فعرفنا أن هذا المعنى لا يتحقق في ثواب الصلاة أيضا وإنما يتحقق معنى الرفق في الصوم من الوجه الذي قررنا أن في الفطر نوع رفق له وفي الصوم نوع رفق آخر فكان التخيير بينهما مستقيما.
ويخرج على هذا من نذر صوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة على قول محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إليه قبل موته بأيام لانهما مختلفان حكما، ففي صوم سنة وفاء بالمنذور وأداء ما هو قربة ابتداء، وصوم ثلاثة أيام كفارة لما لحقه بخلف الوعد المؤكد باليمين، وقد بينا أن التخيير عند المغايرة يتحقق فيه معنى الرفق، ولا يدخل على ما ذكرنا التخيير المذكور في حق موسى عليه السلام أنه فيما التزمه من الصداق بين الاقل والاكثر في جنس واحد، كما قال تعالى: (على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك) لان الزيادة على الثماني كان فضلا من عنده متبرعا به، فأما الواجب من الصداق وهو الاقل عندنا.
هكذا في مسألة الخلاف فالفرض ركعتان عندنا والزيادة عليه نفل مشروع للعبد يتبرع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض، والله أعلم.
باب: أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها قال رضي الله عنه: اعلم بأن هذه الاسماء أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول.
فالخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على
الانفراد، ومنه يقال: اختص فلان بملك كذا: أي انفرد به ولا شركة للغير معه، وخصني فلان بكذا: أي أفرده لي، وفلان خاص فلان، ومنه سميت الخصاصة للانفراد عن المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة، ومعنى الخصوص في الحاصل الانفراد وقطع الاشتراك، فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان، وإذا أريد به خصوص
النوع قيل رجل، وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد.
وأما العام كل لفظ ينتظم جمعا من الاسماء لفظا أو معنى، ونعني بالاسماء هنا المسميات، وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام: أي ينتظم جمعا من الاسماء لفظا مرة كقولنا زيدون، ومعنى تارة كقولنا من وما وما أشبههما.
ومعنى العموم لغة: الشمول، تقول العرب: عمهم الصلاح والعدل: أي شملهم، وعم الخصب: أي شمل البلدان أو الاعيان، ومنه سميت النخلة الطويلة عميمة، والقرابة إذا اتسعت انتهت إلى العمومة، فكل لفظ ينتظم جمعا من الاسماء سمي عاما لمعنى الشمول، وذلك نحو اسم الشئ فإنه يعم الموجودات كلها عندنا.
وذكر أبو بكر الجصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم جمعا من الاسامي أو المعاني، وهذا غلط منه، فإن تعدد المعاني لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف، وعند ذلك اللفظ الواحد لا ينتظمهما وإنما يحتمل أن يكون كل واحد منهما مرادا باللفظ وهذا يكون مشتركا لا عاما ولا عموم للمشترك عندنا، وقد نص الجصاص في كتابه على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم له، فعرفنا أن هذا سهو منه في العبارة أو هو مؤول، ومراده أن المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى معاني مجازا، فإنه يقال: مطر عام لانه عم الامكنة وهو في الحقيقة معنى واحد ولكن لتعدد المحال الذي تناوله سماه معاني، ولكن هذا إنما يستقيم إذا قال: ما ينتظم جمعا من الاسامي والمعاني.
قال رضي الله عنه: وهكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه، فأما قوله أو المعاني فهو سهو منه، وذكر أن إطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام كما هو في الاسماء والالفاظ.
ويقال عمهم الخوف وعمهم الخصب باعتبار المعنى من غير أن يكون هناك لفظ، وهذا غلط أيضا فإن المذهب أنه لا عموم للمعاني حقيقة وإن كان
يوصف به مجازا، وسيأتيك بيان هذا الفصل في باب بيان إبطال القول بتخصيص
العلل الشرعية.
وأما المشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخر، مثل اسم العين فإنه للناظر، ولعين الماء، وللشمس، وللميزان، وللنقد من المال، وللشئ المعين لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الاطلاق، وهذا لان الاسم يتناول كل واحد من هذه الاشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر، وقد بينا أن لفظ الواحد لا ينتظم المعاني المختلفة.
وبيان هذا في لفظ البينونة فإنه يحتمل معنى الابانة ومعنى البين ومعنى البيان، يقول الرجل بان فلان عني: أي هجرني، وبان العضو من الجسم: أي انفصل، وبان لي كذا: أي ظهر، فيعلم أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعاني ولكن يحتمل كل واحد منها أن يكون مرادا ولهذا سميناه مشتركا، فالاشتراك عبارة عن المساواة، وفي الاحتمال وجدت المساواة بينهما فبقي المراد به مجهولا لا يمكن العمل بمطلقه في الابتداء بمنزلة المجمل إلا أن الفرق بين المشترك والمجمل أنه قد يتوصل إلى العمل بالمشترك عند التأمل في صيغة اللفظ فيرجح بعض المحتملات ويعرف أنه هو المراد بدليل في اللفظ من غير بيان آخر، والمجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل.
وبيان المشترك في لفظ القرء، فبين العلماء اتفاق أنه يحتمل الاطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظم لهما بل إذا حملناه على الحيض لدليل في اللفظ وهو أن المرأة لا تسمى ذات القرء إلا باعتبار الحيض فينتفي كون الاطهار مرادا عندنا، وإذا حمله الخصم على الاطهار لدليل في اللفظ وهو الاجتماع أخرج الحيض من أن يكون مرادا باللفظ.
وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله: لو أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لا تصح الوصية،
لان الاسم مشترك يحتمل أن يكون المراد به هو المولى الاعلى ويحتمل الاسفل وفي
المعنى تغاير، فالوصية للاعلى بمعنى المجازاة وشكرا للنعم، وللاسفل للزيادة في الانعام والترحم عليه، ولا ينتظم اللفظ المعنيين جميعا للمغايرة بينهما فبقي الموصى له مجهولا.
ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول يمينه الاعلى والاسفل جميعا باعتبار أن المعنى الذي دعاه إلى اليمين غير مختلف في الاعلى والاسفل، فلايجاد المعنى لا يتحقق فيه الاشتراك بل اللفظ في هذا الحكم بمنزلة العام، فإن اسم الشئ يتناول الموجودات كلها باعتبار معنى واحد وهو صفة الوجود فكان منتظما للكل، والمشترك احتماله الجمع من الاشياء باعتبار معان مختلفة، فعرفنا به أن المراد واحد منها، فاسم المولى إذا استعمله فيما يختلف فيه المعنى والمقصود كان مشتركا، وفيما لا يختلف فيه المعنى كان بمنزلة العام.
وأما المؤول فهو تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد، ومن قولك آل يؤول: أي رجع، وأوليته بكذا إذا رجعته وصرفته إليه، ومآل هذا الامر كذا: أي تصير عاقبته إليه، فالمؤول ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الامر، قال تعالى: (هل ينظرون إلا تأويله) أي عاقبته وما يؤول إليه الامر، وهو خلاف المجمل، فالمراد بالمجمل إنما يعرف ببيان من المجمل وذلك البيان يكون تفسيرا يعلم به المراد بلا شبهة، مأخوذ من قولك: أسفر الصبح إذا أضاء وظهر ظهورا منتشرا، وأسفرت المرأة عن وجهها: أي كشفت وجهها، وهذا اللفظ مقلوب من التفسير فالمعنى فيهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لا شبهة فيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يعني قطع القول بأن المراد هذا برأيه، فإن من فعل ذلك فكأنه نصب نفسه صاحب الوحي فليتبوأ مقعده من النار، وبهذا تبين خطأ المعتزلة أن كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة، فالاجتهاد عبارة عن غالب الرأي، فمن يقول إنه يستدرك به الحق قطعا بلا شبهة فإنه
داخل في جملة من تناولهم هذا الحديث.
وصار الحاصل أن العام أكثر انتظاما للمسميات من الخاص، والخاص في معرفة المراد به أثبت من المشترك، ففي المشترك احتمال غير المراد ومع الاحتمال لا يتحقق الثبوت، والمشترك في إمكان معرفة المراد عند
التأمل في لفظه أقوى من المجمل فليس في المجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره في بابه، إن شاء الله تعالى.
فصل: في بيان حكم الخاص قال رضي الله عنه: حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له لغة، لا يخلو خاص عن ذلك وإن كان يحتمل أن تغير اللفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه مجازا ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا، فإنه مبين في نفسه عامل فيما هو موضوع له بلا شبهة، وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله في قوله تعالى: (ثلاثة قروء) : إن المراد الحيض، لانا لو حملناه على الاطهار كان الاعتداد بقرأين وبعض الثالث، ولو حملناه على الحيض كان التربص بثلاثة قروء كوامل، واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه، بمنزلة اسم الفرد فإنه لا يحتمل العدد، واسم الواحد ليس فيه احتمال المثنى، ففي حمله على الاطهار ترك العمل بلفظ الثلاث فيما هو موضوع له لغة ولا وجه للمصير إليه، وقلنا في قوله: (اركعوا واسجدوا) إن فرض الركوع يتأدى بأدنى الانحطاط، لان اللفظ لغة موضوع للميل عن الاستواء، يقال: ركعت النخلة إذا مالت، وركع البعير إذا طأطأ رأسه، فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون فرضا ثابتا بهذا النص لا يكون عملا بما وضع له هذا الخاص لغة، ولكن إنما يكون وفي العثمانية إنما يثبت بصفة الاعتدال بخبر الواحد فيكون موجبا للعمل ممكنا للنقصان في الصلاة إذا تركه ولا يكون مفسدا للصلاة، لان ذلك حكم ترك الثابت
بالنص، ومن ذلك قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) فالطواف موضوع لغة لمعنى معلوم لا شبهة فيه وهو: الدوران حول البيت، ثم إلحاق شرط الطهارة بالدوران ليكون فرضا لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون نسخا له وجعل الطهارة واجبا فيه حتى يتمكن النقصان بتركه يكون عملا بموجب كل دليل، فإن ثبوت شرط الطهارة بخبر الواحد وهو موجب للعمل فبتركه يتمكن النقصان في العمل شرعا فيؤمر بالاعادة أو الجبر بالدم ليرتفع به النقصان، ومن ذلك قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) الآية فإن اللفظ موضوع لغة لغسل هذه الاعضاء،
ففرضية الغسل في المغسولات والمسح في الممسوحات ثابت بهذا النص، واشتراط النية والموالاة والترتيب والتسمية ليكون فرضا لا يزول الحدث بدونها مع وجود الغسل والمسح لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون نسخا له، وجعل ذلك واجبا أو سنة للاكمال كما هو موجب خبر الواحد يكون عملا بكل دليل ومراعاة لمرتبة كل دليل.
فتبين أن فيما ذهب إليه الخصم حط درجة النص عن مرتبته أو رفع درجة خبر الواحد فوق مرتبته فلا يكون القول به صحيحا.
وقال الشافعي في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) : فإن القطع لفظ خاص لمعنى معلوم، فإبطال عصمة المال والتقوم الذي كان ثابتا قبل فعل السرقة أو بعده قبل القطع لا يكون عملا بهذا الخاص، بل يكون زيادة أثبتموه بالرأي أو بخبر الواحد، فقد دخلتم فيما أبيتم.
ولكنا نقول: ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص في الآية وهو قوله تعالى: (جزاء بما كسبا نكالا من الله) فاسم الجزاء يطلق على ما يجب حقا لله تعالى بمقابلة أفعال العباد، فثبت بهذا اللفظ الخاص أن القطع حق الله تعالى خالصا، وتبين به أن سببه جناية على حق الله تعالى، ولا يجب القطع إلا باعتبار العصمة والتقوم في المسروق، فبه يتبين أن العصمة والتقوم عند فعل السرقة صار حقا لله تعالى حيث وجب القطع
باعتباره حقا له ويتم ذلك بالاستيفاء، لان ما يجب حقا لله تعالى فتمامه يكون بالاستيفاء إذ المقصود به الزجر وذلك يحصل بالاستيفاء، وبهذا التحقيق تبين أن العصمة والتقوم لم يبق حقا للعبد فلا يجب الضمان به، أو عرفنا ذلك من قوله تعالى: (جزاء بما كسبا) فإن الجزاء لغة يستدعي الكمال، من قولهم: جزى: أي قضى، أو جزأ بالهمزة: أي كفى، وكمال الجزاء باعتبار كمال السبب، وهو أن يكون الفعل حراما لعينه، فمع بقاء التقوم والعصمة حقا للمالك لا يكون الفعل حراما لعينه بل لغيره وهو حق المالك، فعرفنا أنه لم يبق العصمة والتقوم في المحل حقا للعبد عندنا باعتبار خاص منصوص عليه، ولا يدخل عليه الملك فإنه يبقى للمالك حتى يسترده إن كان قائما بعينه، لان مع بقاء الملك له لا تنعدم صفة الكمال في السبب وهو كون
الفعل حراما لعينه، ألا ترى أن العصير إذا تخمر يبقى مملوكا ويكون الفعل فيه حراما لعينه حتى يجب الحد بشربه، ولكن لم يبق معصوما متقوما لانه حينئذ يكون بمنزلة عصير الغير فلا يكون شربه حراما لعينه.
ثم وجوب القطع باعتبار العصمة والتقوم في محل مملوك، فأما المالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بخصومته عند الامام، ولهذا لو ظهر بخصومة غير المالك نقيم الحد بخصومة المكاتب والعبد المأذون المستغرق بالدين في كسبه والمتولي في مال الوقف، ونحن إنما جعلنا ما وجب القطع باعتباره حقا لله تعالى لضرورة كون الواجب محض حق الله تعالى وذلك في العصمة والتقوم دون أصل الملك.
ومن هذه الجملة قوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم) فالابتغاء موضوع لمعنى معلوم وهو الطلب بالعقد، والباء للالصاق، فثبت له اشتراط كون المال ملصقا به بالابتغاء تسمية أو وجوبا، والقول بتراخيه عن الابتغاء إلى وجود حقيقة المطلوب كما قاله الخصم في المفوضة أنه لا يجب المهر لها إلا بالوطئ يكون ترك العمل بالخاص، فيكون في معنى النسخ له ولا يجوز المصير
إليه بالرأي.
ومن ذلك قوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) فالفرض لمعنى معلوم لغة وهو التقدير والكتابة في قوله تعالى: (فرضنا) لمعنى معلوم لغة وهو إرادة المتكلم نفسه، فالقول بأن المهر غير مقدر شرعا بل يكون إيجاب أصله بالعقد وبيان مقداره مفوضا إلى رأي الزوجين يكون ترك العمل بهذا الخاص، فإنما العمل به فيما قلنا إن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعا لا خيار له فيه للزوجين.
ومن هذا النوع ما قال محمد والشافعي في قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) إن كلمة حتى موضوع لمعنى لغة وهو الغاية والنهاية، فجعله لمعنى موجب حلا حادثا يكون ترك العمل بهذا الخاص، وإنما العمل به في أن يجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد الطلاق ولا تصور للغاية قبل وجود أصل الشئ، فإن المنتهى بالغاية بعض الشئ فكيف يتحقق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: ما تناوله هذا الخاص فهو غاية لما وضع
اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني، فإن النكاح وإن كان حقيقة للوطئ فقد يطلق بمعنى العقد، والمراد العقد هنا بدليل الاضافة إلى المرأة، وإنما يضاف إليها العقد لتحقق مباشرته منها، ولا يضاف إليها الوطئ حقيقة لانها محل الفعل لا مباشرة للوطئ، فأما شرط الدخول فأثبتناه بحديث مشهور وهو ما روي أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها، كانت تتهمه بالعنة، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ فقالت: نعم، فقال: لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك ففي اشتراط الوطئ للعود إشارة إلى السبب الموجب للحل.
وقال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له ولا خلاف
بين العلماء أن الوطئ من الزوج الثاني شرط لحل العود إلى الاول بهذه الآثار، فنحن عملنا بما هو موجب أصل هذا الدليل بصفته فجعلناه موجبا للحل، وهم أسقطوا اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالا بنص ليس فيه بيان أصل هذا الشرط ولا صفته، فيكون هذا ترك العمل بالدليل الموجب له لا عملا بكل خاص فيما هو موضوع له لغة.
ومن ذلك قولنا في قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له) لان الفاء موضوع لغة للوصل والتعقيب فذكره بعد الخلع المذكور في قوله تعالى: (فيما افتدت به) يكون بيانا خاصا أن إيقاع التطليقتين بعد الخلع متصلا به يكون عاملا موجبا حرمة المحل، بخلاف ما يقوله الخصم إن المختلعة لا يلحقها الطلاق.
ومن ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ففي الاضافة إليها ثم تخصيص جانبها بالذكر بيان أن الذي يكون من جانب الزوج في الخلع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لا غيره وهو الفسخ، فجعل الخلع فسخا يكون ترك العمل بهذا الخاص، وجعله طلاقا كما هو موجب هذا الخاص يكون عملا بالمنصوص، هذا بيان الطريق فيما يكون من هذا الجنس.
فصل: في بيان حكم العام قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة: حكمه الوقف فيه حتى يتبين المراد منه بمنزلة المشترك أو المجمل، ويسمى هؤلاء الواقفية، إلا أن طائفة منهم يقولون يثبت به أخص الخصوص وفيما وراء ذلك الحكم هو الوقف حتى يتبين المراد بالدليل.
وقال الشافعي: هو مجرى على عمومه موجب للحكم فيما تناوله مع ضرب شبهة فيه لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص فلا يوجب الحكم قطعا بل على تجوز أن يظهر معنى الخصوص فيه لقيام الدليل، بمنزلة القياس فإنه يجب العمل به في الاحكام الشرعية
لا على أن يكون مقطوعا به بل مع تجوز احتمال الخطأ فيه أو الغلط، ولهذا جوز تخصيص العام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد، فقد جعل القياس وخبر الواحد الذي لا يوجب العلم قطعا مقدما على موجب العام حتى جوز التخصيص بهما، وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العام، على هذا دلت مسائله، فإنه رجح خبر العرايا على عموم قوله عليه السلام: التمر بالتمر كيلا بكيل في حكم العمل به، وجعل هذا قولا واحدا له فيما يحتمل العموم وفيما لا يحتمل العموم لانعدام محله، فقال: يجب العمل فيهما بقدر الامكان حتى يقوم دليل التخصيص على الوجه الذي ذكرنا.
والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله، يستوي في ذلك الامر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله، فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل، فعلى هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله.
قال محمد رحمه الله في الزيادات: إذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بفصه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع، فالحلقة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفان، لان الايجاب الثاني في عين ما أوجبه للاول لا يكون
رجوعا عن الاول فيجتمع في الفص وصيتان إحداهما بإيجاب عام والاخرى بإيجاب خاص، ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين.
وقال في الوصايا: لو كانت الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصول كان الفص للموصى له خاصة، لانه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لاوله، فيظهر به أن مراده بالايجاب العام الحلقة دون الفص.
وقال في المضاربة: إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم أيهما كان، فلولا المساواة بين الخاص والعام حكما فيما يتناوله لم يصر إلى الترجيح بمقتضى العقد.
قال: وإذا
أقاما جميعا البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخا أولى سواء كان مبينا للعموم أو الخصوص فقد جعل العام المتأخر رافعا للخاص المتقدم كما جعل الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة، وظهر من مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترجيح العام على الخاص في العمل به، نحو حفر بئر الناضح فإنه رجح قوله عليه السلام: من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا على الخاص الوارد في بئر الناضح أنه ستون ذراعا، فرجح قوله عليه السلام: ما أخرجت الارض ففيه العشر على الخاص الوارد بقوله عليه السلام: ليس في الخضراوات صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ونسخ الخاص بالعام أيضا كما فعله في بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين فيه منسوخا بالعام وهو قوله عليه السلام: استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون أيضا إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس، فزعموا أن المذهب هذا، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا يكون موجبا تخصيص العموم في قوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضا.
وكذلك قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) عام لم يثبت خصومه فإن الناسي جعل
ذاكرا حكما بطريقة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفا عليه، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس (وكذلك قوله: (ومن دخله كان آمنا) عام لم يثبت تخصيصه، ولا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس) حتى يثبت الامن بسبب الحرم المباح الدم باعتبار العموم، ومتى ثبت التخصيص في العام بدليله فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس على ما نبينه، إن شاء الله تعالى.
أما الواقفون استدلوا بالاشتراك في الاستعمال، فقد يستعمل لفظ العام والمراد به
الخاص، قال تعالى: (الذين قال لهم الناس) والمراد به رجل واحد، وقد يستعمل لفظة الجماعة للفرد، قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال: (رب ارجعون) وهذا في كلام الخطباء ونظم الشعراء معروف، فعند الاطلاق يشترك فيه احتمال العموم واحتمال الخصوص فيكون بمنزلة المشترك يجب الوقف فيه حتى يتبين المراد، أو نقول لفظ العام مجمل في معرفة المراد به حقيقة لاحتمال أن يكون المراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ، ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه البيان والتفسير (مطلق هذا اللفظ) ما هو المراد به من العموم بأن نقول جاءني القوم كلهم أو أجمعون، ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ لم يستقم تفسيره بلفظ آخر كالخاص، فإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون ثابتا بموجبه بأن يقول جاءني زيد كله أو جميعه، ولما استقام ذلك في العام عرفنا أنه غير موجب للاحاطة بنفسه والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم، فيكون بمنزلة المجمل.
والذين قالوا بأخص الخصوص قالوا: ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواء كان المراد الخصوص أو العموم فللتيقن به جعلناه مرادا، وإنما الوقف فيما وراء ذلك، وبيانه أن إرادة الثلاث من لفظ الجماعة وإرادة الواحد من لفظ الجنس متيقن به، فمطلق اللفظ في ذلك بمنزلة الاحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكلام، فكذلك أخص الخصوص موجب مطلق لفظ العام.
والدليل لعامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعالى: (اتبعو ما أنزل إليكم من ربكم) والاتباع لفظ خاص في اللغة بمعنى معلوم، وفي المنزل عام وخاص فيجب بهذا الخاص اتباع جميع المنزل، والاتباع إنما يكون بالاعتقاد والعمل به وليس في التوقف اتباع للمنزل، فعرفنا أن العمل واجب بجميع ما أنزل على ما أوجبه
صيغة الكلام إلا ما يظهر نسخه بدليل، فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم على وجه لا يمكن إنكاره، فإن النبي عليه السلام حين دعا أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في الصلاة فلم يجبه بين له خطأه فيما صنع بالاستدلال بقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) وهذا عام، فلو كان موجبه التوقف على ما زعموا لم يكن لاستدلاله عليه به معنى، والصحابة رضي الله عنهم في زمن الصديق حين خالفوه في الابتداء في قتال مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهو عام، ثم استدل عليهم بقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فرجعوا إلى قوله وهذا عام.
وحين أراد عمر رضي الله عنه أن يوظف الجزية والخراج على أهل السواد استدل على من خالفه في ذلك بقوله تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم) وقال أرى لمن بعدكم في هذا الفئ نصيبا ولو قسمته بينكم لم يبق لمن بعدكم فيه نصيب، وهذه الآية في هذا الحكم نهاية في العموم.
ولما هم عثمان رضي الله عنه برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال: أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال: (وفصاله في عامين) فإذا ذهب للفصال عامان بقي للحمل ستة أشهر، وهذا استدلال بالعام.
وحين اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الاختين وطئا بملك اليمين قال علي رضي الله عنه: أحلتهما قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) وحرمتهما قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الاختين) فالاخذ بما يحرم أولى احتياطا، فوافقه عثمان في هذا، إلا أنه قال: عند تعارض الدليلين أرجح الموجب للحل باعتبار الاصل.
وحين اختلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، فقال علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الاجلين، واستدل بالآيتين: قوله تعالى: (أربعة أشهر وعشرا) وقوله تعالى: (وأولات الاحمال أجلهن
أن يضعن حملهن) قال ابن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى، يعني قوله تعالى: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فاستدل بهذا العام على أن عدتها بوضع الحمل لا غير وجعل الخاص في عدة المتوفى عنها زوجها منسوخا بهذا العام في حق الحامل.
واحتج ابن عمر على ابن الزبير في التحريم بالمصة والمصتين بقوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) واحتج ابن عباس على الصحابة رضي الله عنهم في الصرف بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا ربا إلا في النسيئة واحتجوا عليه بالعموم الموجب لحرمة الربا من الكتاب والسنة فرجع إلى قولهم.
فبهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على عمومه.
ولا معنى لقول من يقول: إنهم عرفوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو ببيان سمعوه، لان المنقول احتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم فقط، وفي القول بما قال هذا القائل تعطيل المنقول والاحالة على سبب آخر لم يعرف.
ثم لزوم العمل بالمنزل حكم ثابت إلى يوم القيامة، فلو كان ذلك في حقهم باعتبار دليل آخر ما وسعهم ترك النقل فيه، ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر.
يؤيد ما قلنا حديث أبي بكر رضي الله عنه حين بلغه اختلاف الصحابة في نقل الاخبار جمعهم فقال: إنكم إذا اختلفتم فمن بعدكم يكون أشد اختلافا، الحديث إلى أن قال: فيكم كتاب الله تعالى فأحلوا حلاله وحرموا حرامه.
ولم يخالف أحد منهم في ذلك، فعرفنا أنهم عرفوا المراد بعين ما هو المنقول إلينا لا بدليل آخر غير منقول إلينا.
ثم العموم معنى مقصود من الكلام عام بمنزلة الخصوص فلا بد أن يكون له لفظ موضوع يعرف المقصود بذلك اللفظ، لان الالفاظ لا تقصر عن المعاني، وبيان هذا أن المتكلم باللفظ الخاص له في ذلك مراد لا يحصل باللفظ العام
وهو تخصيص الفرد بشئ فكان لتحصيل مراده لفظ موضوع وهو الخاص، والمتكلم باللفظ العام بمعنى العام له مراد في العموم لا يحصل ذلك باللفظ الخاص ولا يتيسر عليه التنصيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ العام، فلا بد من أن يكون
لمراده لفظ موضوع لغة وذلك صيغة العموم، فإن من أراد عتق جميع عبيده فإنما يتمكن من تحصيل هذا المقصود بقوله عبيدي أحرار، وهذا لفظ عام، فمن جعل موجبه الوقف فإنه يشق على المتكلم بأن يحصل مقصوده في العموم باستعمال صيغته، وما قالوا إنه قد استعمل العام بمعنى الخاص، قلنا ويستعمل أيضا بمعنى الاحاطة على وجه لا يحتمل غيره، قال تعالى: (إن الله بكل شئ عليم) وقال تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وقال تعالى: (وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها) فهذا الاستعمال يمنعهم عن القول بالتوقف في موجب العموم.
ثم العموم بهذه الصيغة حقيقة واحتمال إرادة المجاز لا يخرج الحقيقة من أن تكون موجب مطلق الكلام، ألا ترى أن بعد تعين الاحاطة فيه بقوله تعالى أجمعون أو كلهم لا ينتفي هذا الاحتمال من كل وجه حتى يستقيم أن يقرن به الاستثناء، قال تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) ويقول الرجل: جاءني القوم كلهم أجمعون إلا فلانا وفلانا.
ثم هذا لا يمنع القول بأن موجبه الاحاطة فيما تناوله فكذلك في مطلق اللفظ، مع أنا لا نقول إن ما يقرن به يكون تفسيرا، ولكن نقول وإن كان موجبه العموم قطعا فهو غير محكم لاحتمال إرادة الخصوص فيه فيصير بما يقرن به محكما إذا أطلق ذلك كما في قوله: جاءني القوم كلهم، فإنه لا ينفي احتمال الخصوص بعد هذا إذا لم يقرن به استثناء يكون مغيرا له، ومثله في الخاص موجود فإن قوله جاءني فلان خاص موجب لما تناوله ولكنه غير محكم فيه لاحتمال المجاز، فإذا قال جاءني فلان نفسه يصير محكما وينتفي احتمال المجاز في أن الذي جاءه رسوله أو عبده أو كتابه.
ثم قال الشافعي
رحمه الله: أجعل مطلق العام موجبا للعمل فيما تناوله ولكن احتمال الخصوص فيه قائم ومع الاحتمال لا يصير مقطوعا به فلا أجعله موجبا للعمل فيما تناوله قطعا.
ولكنا نقول: المراد بمطلق الكلام ما هو الحقيقة فيه والحقيقة ما كانت الصيغة موضوعة له لغة، وهذه الصيغة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فيها، وحقيقة الشئ ثابت بثبوته قطعا ما لم يقم الدليل على مجازه كما في لفظ الخاص، فإن ما هو حقيقة فيه يكون ثابتا به قطعا حتى يقوم الدليل على صرفه إلى المجاز.
فإن قال قائل: إن الخاص أيضا لا يوجب موجبه قطعا لاحتمال إرادة المجاز منه وإنما يوجب موجبه ظاهرا ما لم يتبين أنه ليس المراد به المجاز بدليل آخر بمنزلة النص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن بقاء الحكم الثابت بالنص يكون ظاهرا لا مقطوعا به لاحتمال النسخ وإن لم يظهر الناسخ بعد.
قلنا: هذا فاسد، لان مراد المتكلم بالكلام ما هو موضوع له حقيقة، هذا معلوم وإرادة المجاز موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم ولا يؤثر في حكمه، وكذلك المجاز لا يعارض الحقيقة بل ثبوت المجاز بإرادة المتكلم لا بصيغة الكلام وهي إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته، فما لم يظهر الناقل بدليله يثبت حكم الكلام مقطوعا به بمنزلة النص المطلق يوجب الحكم قطعا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد بقيده ولكن ذلك ناقل للكلام عن حقيقته فما لم يظهر كان حكم الكلام ثابتا قطعا، بخلاف النص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النص يوجب الحكم، فأما بقاء الحكم ليس من موجبات النص ولكن ما ثبت فالاصل فيه البقاء حتى يظهر الدليل المزيل، فكان بقاؤه لنوع من استصحاب الحال وعدم الناسخ، وهذا المعدوم غير مقطوع به فلهذا لا يكون بقاء الحكم مقطوعا به في ذلك الوقت حتى إن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع احتمال النسخ كان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقيا قطعا.
فإن قيل: فكذلك عدم إرادة المتكلم للمجاز ليس بمعلوم قطعا بل هو ثابت بنوع من الظاهر بمنزلة عدم الناسخ في ذلك الوقت بخلاف الشرط والاستثناء فانعدامهما ثابت بالنص، لان الشرط والاستثناء يكون مقارنا للنص فالاطلاق فيه على وجه يكون ساكتا عن ذكر الشرط، والاستثناء تنصيص على عدم الشرط والاستثناء ؟ قلنا: نعم ولكن الارادة المغيرة للخاص عن حقيقته يكون في باطن المتكلم وهو غيب عنا وليس في وسعنا الوقوف على ذلك وإنما يثبت التكليف شرعا بحسب الوسع فما ليس في وسعنا الوقوف عليه لا يكون معتبرا أصلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره بدليله يجعل ثابتا ابتداء، فقبل الظهور يكون حكم الخاص ثابتا قطعا وهو بمنزلة خطاب الشرع لا يوجب الحكم في حق المخاطب ما لم يسمع به لانه ليس في وسعه العمل به قبل
السماع وعند السماع يثبت الحكم في حقه ابتداء كأن الخطاب نزل الآن، وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته إن كنت تحبينني فأنت طالق، أو قال: إن كنت تحبين النار فأنت طالق فقالت أنا أحب ذلك يقع الطلاق، لان حقيقة المحبة والبغض في باطنها ولا طريق لنا إلى معرفته فلا يتعلق الطلاق بحقيقته، ولكن طريق معرفتنا في الظاهر إخبارها فيجعل الزوج معلقا الطلاق بإخبارها حكما، فإذا قالت أحب يقع الطلاق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو الخبر فإن الخبر يحتمل الصدق والكذب، وإذا ثبت هذا في الخاص فكذلك في العام فإن احتمال الخصوص باطن وهو غيب عنا ما لم يظهر بدليله فقبل ظهوره يكون موجبا الحكم فيما تناوله قطعا، إلا أن الشافعي يقول مع هذا احتمال إرادة الخصوص لم ينعدم ولكن ليس في وسعنا الوقوف عليه عند الخطاب فنجعل العام موجبا الحكم فيما تناوله عملا ولا نجعله موجبا للحكم قطعا فيما يرجع إلى العلم به لبقاء احتمال الخصوص.
وهكذا أقول في الخاص: الارادة المغيرة فيها احتمال إلا أن ذلك مانع عن ثبوت حكم الحقيقة عملا به فيكون
في معنى الناسخ الذي هو مبدل للحكم أصلا، والناسخ لا يكون مقترنا بالنص الموجب للحكم بل إنما يرد النسخ على البقاء، فكذلك في الخاص أجعل ظهور إرادة المجاز بدليله عاملا ابتداء فقبل ظهوره يكون حكم الخاص ثابتا قطعا، وأما إرادة الخصوص لا يكون رافعا للحكم أصلا فيبقى معتبرا مع وجود العمل بالعام فلا يثبت العلم بموجبه قطعا، وعلى هذا نقول في قوله إن كنت تحبينني إنه يقع الطلاق إذا أخبرت به لان ما ليس في وسعه الوقوف عليه وهو حقيقة المحبة والبغض بحال فيسقط اعتباره في حكم العمل، ولو قال: إن كنت تحبين النار فأنت طالق فقالت أحب لا يقع الطلاق، لان كذبها ههنا معلوم قطعا فإن أحدا ممن له طبع سليم لا يحب النار، ويكون هذا بمنزلة العام الذي ليس فيه احتمال الخصوص، كقوله تعالى: (إن الله بكل شئ عليم) فإن حقيقة الموجب بمثل هذا العام معلوم قطعا بخلاف العام الذي هو محتمل الخصوص.
ولكن الجواب عنه أن نقول: كما أن الله تعالى لم يكلفنا ما ليس في وسعنا فقد أسقط عنا ما فيه حرج علينا كما قال تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وفي اعتبار الارادة الباطنة في العام الذي هو محتمل لها نوع حرج،
فالتمييز بين ما هو مراد المتكلم وبين ما ليس بمراد له قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم وسقط اعتباره شرعا، ويقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج، ألا ترى أن خطاب الشرع يتوجه على المرء إذا اعتدل حاله، ولكن اعتدال الحال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة وهو البلوغ عن عقل، فأقام الشرع هذا السبب الظاهر مقام ذلك المعنى الباطن للتيسير، ثم دار الحكم معه وجودا وعدما حتى إنه وإن اعتدل حاله قبل البلوغ يجعل ذلك كالمعدوم حكما في (حق) توجه الخطاب عليه، ولو لم يعتدل حاله بعد البلوغ عن عقل كان الخطاب متوجها أيضا لهذا المعنى، ومن نظر عن إنصاف لا يشكل
عليه أن الحرج في التأمل في إرادة المتكلم ليتميز به ما هو مراد له مما ليس بمراد فوق الحرج بالتأمل في أحوال الصبيان ليتوقف على اعتدال حالهم، وهذا أصل كبير في الفقه، فإن الرخصة بسبب السفر تثبت لدفع المشقة، كما قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ثم حقيقة المشقة باطن تختلف فيه أحوال الناس وله سبب ظاهر وهو السير المديد فأقام الشرع هذا السبب مقام حقيقة ذلك المعنى وأسقط وجود حقيقة المشقة في حق المقيم لانعدام السبب الظاهر إلا إذا تحققت الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه فذلك أمر وراء المشقة، وأثبت الحكم عند وجود السبب الظاهر وإن لم تلحقه المشقة حقيقة.
وكذلك الاستبراء فإنه يجب التحرز عن خلط المياه المحترمة إلا أن ذلك باطن وله سبب ظاهر وهو استحداث ملك الوطئ بملك اليمين لان زوال ملك اليمين لا يوجب ما يستدل به على براءة الرحم من عدة أو استبراء، فأقام الشرع استحداث ملك الوطئ بملك اليمين مقام المعنى الباطن وهو اشتغال الرحم بالماء في حق وجوب التحرز عن الخلط بالاستبراء، ولهذا قلنا: لو اشتراها من صبي أو امرأة أو اشتراها وهي بكر أو حاضت عند البائع بعد الوطئ قبل أن يبيعها يجب الاستبراء لاعتبار السبب الظاهر، ولهذا قلنا في النكاح لا يجب الاستبراء وإن علم أنها وطئت قبل أن يتزوجها وطئا محرما بأن تزوج أمة كان قد وطئها قبل أن يتزوجها لان الاصل في النكاح الحرة، فإن الرق عارض والازدواج بين الشخصين باعتبار