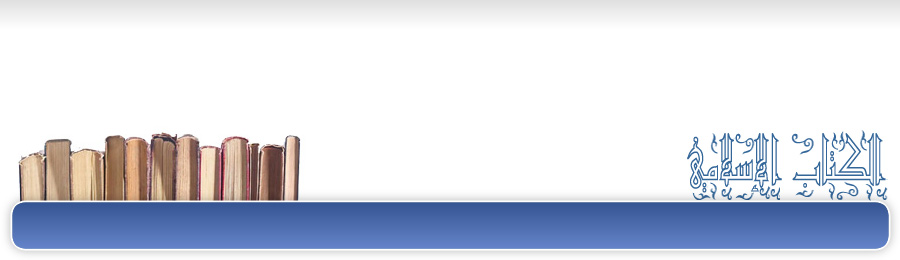كتاب: الصارم المسلول على شاتم الرسول
المؤلف : شيخ الإسلام ابن تيمية
الطريقة السابعة و العشرون : أنه سبحانه و تعالى قال : { إن شانئك هو الأبتر } [ الكوثر : 3 ] فأخبر سبحانه أن شانئه هو الأبتر و البتر : القطع يقال : بتر يبتر بترا و سيف بتار إذا كان قاطعا ماضيا و منه في الاشتقاق الأكبر تبره تتبيرا إذا أهلكه و التبار : الهلاك و الخسران و بين سبحانه أنه هو الأبتر بصيغة الحصر و التوكيد لأنهم قالوا : إن محمدا ينقطع ذكره لأنه لا ولد له فبين الله أن الذي يشنأه هو الأبتر لا هو [ صلى الله عليه و سلم ] و الشنآن منه ما هو باطن في القلب لم يظهر و منه ما يظهر على اللسان و هو أعظم الشنآن و أشده و كل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه و نقيم عليه حد الله
فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه و أبدى عداوته و إذا كان ذلك واجبا وجب قتله و إن أظهر التوبة بعد القدرة وإلا لما انبتر له شانىء بأيدينا في غالب الأمر لأنه لا يشاء شانىء أن يظهر شنآنه ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف إلا فعل ذلك فإن ذلك سهل على من يخاف السيف
تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه و الاسم المشتق المناسب إذا علق به حكم كان ذلك دليلا على أن المشتق منه علة لذلك الحكم فيجب أن يكون شنآنه هو الموجب لانبتاره و ذلك أخص مما تضمنه الشنآن من الكفر المحض أو نقض العهد و الانبتار يقتضي وجوب قتله بل يقتضي انقطاع العين و الأثر فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان في ذلك إبقاء لعينه و أثره و إذا اقتضى الشنآن قطع عينه و أثره كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص
و ليس شيء يوجب قتل الذمي إلا و هو موجب لقتله بعد الإسلام إذ الكفر المحض مجوز للقتل لا موجب له على الإطلاق و هذا لأن الله سبحانه لما رفع ذكر محمد عليه الصلاة و السلام فلا يذكر إلا ذكر معه و رفع ذكر من اتبعه إلى يوم القيامة حتى إنه يبقى ذكر من بلغ عنه و لو حديثا و إن كان غير فقيه أثر من شنأه من المنافقين و إخوانهم من أهل الكتاب و غيرهم فلا يبقى له ذكر حميد و إن بقيت أعيانهم وقتا لم يظهروا الشنآن فإذا أظهروه محقت أعيانهم و أثارهم تقديرا و تشريعا فلو استبقى من أظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا إذ البتر يقتضي قطعه و محقه من جميع الجوانب و الجهات فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتورا يوضح ذلك أن العقوبات التي شرعها الله نكالا مثل قطع السارق و نحوه لا تسقط بإظهار التوبة إذ النكال لا يحصل بذلك فما شرع لقطع صاحبه و بتره و محقه كيف يسقط بعد الأخذ فإن هذا اللفظ يشعر بأن المقصود اصطلام صاحبه و استئصاله و اجتياحه و قطع شنآنه و ما كان بهذه المثابة كان عما يسقط عقوبته أبعد من كل أحد و هذا بين لمن تأمله و الله أعلم
و الجواب عن حججهم : أما قولهم [ هو مرتد فيستتاب كسائر المرتدين ] فالجواب أن هذا مرتد بمعنى أنه تكلم بكلمة صار بها كافرا حلال الدم مع جواز أن يكون مصدقا للرسول معترفا له بنبوته لكن موجب التصديق توقيره في الكلام فإذا انتقضه في كلامه ارتفع حكم التصديق و صار بمنزلة اعتراف إبليس لله بالربوبية فإنه موجب للخضوع له فلما استكبر عن أمره بطل حكم ذلك الاعتراف فالإيمان بالله و رسوله قول و عمل ـ أعني بالعمل ما ينبعث عن القول و الاعتقاد من التعظيم و الإجلال ـ فإذا عمل ضد ذلك من الاستكبار و الاستخفاف صار كافرا و كذلك كان قتل النبي باتفاق العلماء فالمرتد : كل من أتى بعد الإسلام من القول أو الفعل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه و إذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يحقن دمه بالإسلام فإن ذلك لم يثبت بلفظ عام عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أصحابه و إنما جاء عنه و عن أصحابه في ناس مخصوصين أنهم استتابوهم أو أمروا باستتابهم ثم إنهم أمروا بقتل الساب و قتلوه من غير استتابة
و قد ثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قتل العرنيين من غير استتابة و أنه أهدر دم ابن خطل و مقيس بن صبابة و ابن أبي سرح من غير استتابة فقتل منهم اثنان و أراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائبا
فهذه سنة النبي عليه الصلاة و السلام و خلفائه الراشدين و سائر الصحابة تبين لك أن من المرتدين من يقتل و لا يستتاب و لا تقبل توبته و منهم من يستتاب و تقبل توبته فمن لم يوجد منه إلا مجرد تبديل الدين و تركه و هو مظهر لذلك فإذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويد و أصحابه و الذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله عنه و من كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم ـ من قتل مسلم و قطع الطريق و سب الرسول و الافتراء عليه و نحو ذلك ـ و هو في دار الإسلام غير ممتنع بفئة فإنه إذا أسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم فيقتل للسب و قطع الطريق مع قبول إسلامه
هذه طريقة من يقتله لخصوص السب و كونه حدا من الحدود أو حقا للرسول فإنه يقول : الردة نوعان : ردة مجردة و ردة مغلظة و التوبة إنما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة و هذه ردة مغلظة و قد تقدم تقرير ذلك في الأدلة ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال : جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة أصحابه ممنوع فلا بد له من دليل و لا نص في المسألة و القياس متعذر لوجود الفرق
و من يقتله لدلالة السب على الزندقة فإنه يقول : هذا لم يثبت إذ لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدم
و بهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق و تقدم الجواب عن قول ابن عباس و أما استتابة الأعمى أم ولده فإنه لم يكن سلطانا و لم تكن إقامة الحدود واجبة عليه و إنما النظر في جواز إقامته للحد و مثل هذا لا ريب أنه يجوز له أن ينهى الساب و يستتيبه فإنه ليس عليه أن يقيم الحد و لا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده فإنه لا ينفع و نظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب الكفر فتارة ينقلها إلى النبي صلى الله عليه و سلم و تارة ينهى صاحبها و يخوفه و يستتيبه و هو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنا أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل أن يرفع إلى السلطان و لو رفع قبل التوبة لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك
و أما الحجة الثانية فالجواب عنها من وجوه :
أحدها : أنه مقتول بالكفر بعد الإسلام و قولهم : [ كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل ]
قلنا : هذا ممنوع و الآية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إذا لم يزدد كفرا أما من كفر و زاد على الكفر فلم تدل الآية على قبول توبته بل قوله : { إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا } [ آل عمران : 90 ] قد يتمسك بها من خالف ذلك على أنه إنما استثنى من تاب و أصلح و هذا لا يكون فيمن تاب بعد أخذه و إنما استفدنا سقوط القتل عن التائب بمجرد توبته من السنة و هي إنما دلت على من جرد الردة مثل الحارث بن سويد و دلت على أن من غلظها كابن أبي سرح يجوز قتله بعد التوبة و الإسلام
الوجه الثاني : أنه مقتول لكونه كفر بعد إسلامه و لخصوص السب كما تقدم تقريره فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظا لجرمه و مؤكدا لقتله
الوجه الثالث : أنه عام و أنه قد خص منه تارك الصلاة و غيرها من الفرائض عند من يقتله و لا يكفره و خص منه قتل الباغي و قتل الصائل بالسنة و الإجماع فلو قيل [ إن السب موجب للقتل بالأدلة التي ذكرناها و هي أخص من هذا الحديث ] لكان كلاما صحيحا و أما من يحتج بهذا الحديث في الذمي إذا سب ثم أسلم فيقال له : هذا وجب قتله قبل الإسلام و النبي صلى الله عليه و سلم إنما يريد إباحة الدم بعد حقنة بالإسلام و لم يتعرض لمن وجب قتله ثم أسلم أي شيء حكمه و لا يجوز أن يحمل الحديث عليه فإنه إذا حمل على حل الدم بالأسباب الموجودة قبل الإسلام و بعده لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا قتل أو زنى ثم شهد شهادتي الحق أن يقتل بذلك القتل و الزنا لشمول الحديث على هذا التقدير له و هو باطل قطعا لا يجوز أن يحمل على أن كل من أسلم لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث إن صدر عنه بعد ذلك لأنه يلزمه أن لا يقتل الذمي بقتل أو صدر منه قبل الإسلام
فعلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم دمه لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوصا بما ذكرناه من أن قتله حد من الحدود و ذلك أن كل من أسلم فإن الإسلام يعصم دمه قلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث و يتخلف الحكم عن هذا المقتضي لمانع من ثبوت حد قصاص أو زنا أو نقض عهد فيه ضرر و غير ذلك و مثل هذا كثير في العمومات
و أما الآية على الوجهين الأولين فنقول : إنما تدل على [ أن ] من كفر بعد إيمانه ثم تاب و أصلح فإن الله غفور رحيم و نحن نقول بموجب ذلك أما من ضم إلى الكفر انتهاك عرض الرسول و الأفتراء عليه أو قتله أو قتل واحدا من المسلمين أو انتهك عرضه فلا تدل الآية على سقوط العقوبة عن هذا على ذلك و الدليل على ذلك قوله سبحانه : { إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا } [ آل عمران : 89 ] فإن التوبة عائدة إلى الذنب المذكور و الذنب المذكور هو الكفر بعد الإيمان و هذا أتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصها كما تقدم و الآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر
و من قال : [ هو زنديق ] قال : أنا لا أعلم أن هذا تاب ثم إن الآية إنما استثنى فيها من تاب و أصلح و هذا الذي رفع إلي لم يصلح و أنا لا أؤخر العقوبة الواجبة عليه إلا أن يظهر صلاحه نعم الآية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب و أصلح قبل أن يرفع إلى الإمام و هذا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة على أن الآية التي بعدها قد تشعر بأن المرتد قسمان : قسم تقبل توبته و هو من كفر فقط و قسم لا تقبل توبته و هو من كفر ثم ازداد كفرا قال سبحانه و تعالى : { إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم } [ آل عمران : 90 ]
و هذه الآية و إن كان قد تأولها أقوام على من ازداد كفرا إلى أن عاين الموت فقد يستدل بعمومها على هذه المسألة فقال : من كفر بعد إيمانه و ازداد كفرا بسب الرسول و نحوه لم تقبل توبته خصوصا من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد و أراد السلطان قتله فهذا قد يقال : إنه إزداد كفرا إلى أن رأى أسباب الموت و قد يقال فيه : { فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ـ إلى قوله ـ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا } [ غافر : 85 ] و أما قوله سبحانه و تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال : 38 ] فإنه يغفر لهم ما قد سلف من الآثام و أما من الحدود الواجبة على مسلم مرتد أو معاهد فإنه يجب استيفاؤها بلا تردد على أن سياق الكلام يدل أنها في الحربي
ثم نقول : الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى : { لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ـ إلى قوله ـ أينما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتيلا } [ الأحزاب : 61 ] فمن لم يتب حتى أخذ فلم ينته
و يقال أيضا : إنما تدل الآية على أنه يغفر لهم و هذا مسلم و ليس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه في الدنيا فإن الزاني أو السارق لو تاب توبة نصوحا غفر الله له و لا بد من إقامة الحدود عليه
و قوله صلى الله عليه و سلم : [ الإسلام يجب ما قبله ] كقوله : [ التوبة تجب ما قبلها ] ومعلوم أن التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد كما دل عليه القرآن و ذلك أن الحديث خرج جوابا لعمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه و سلم : أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال : [ يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله و أن التوبة تهدم ما كان قبلها و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله ]
فعلم أنه عنى بذلك أنه يهدم الآثام و الذنوب التي سأل عمرو مغفرتها و لم يجر للحدود ذكر و هي لا تسقط بهذه الأشياء بالاتفاق و قد بين صلى الله عليه و سلم في حديث ابن أبي سرح أن ذنبه سقط بالإسلام و أن القتل إنما سقط عنه بعفو النبي صلى الله عليه و سلم كما تقدم و لو فرض أنه عام فلا خلاف أن الحدود لا تسقط عن الذمي بإسلامه و هذا منها كما تقدم
و أما قوله سبحانه و تعالى : { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } [ التوبة : 66 ] فالجواب عنها من وجوه :
أحدها : أنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية نزلت فيمن سب النبي صلى الله عليه و سلم و شتمه و إنما فيها أنها نزلت في المنافقين و ليس كل منافق يسبه و يشتمه فإن الذي يشتمه من أعظم المنافقين و أقبحهم نفاقا و قد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة و هو لا يشتمه كحال كثير من الكفار و لو أن كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتما و لاستحالت هذه المسألة و ليس الأمر كذلك فإن الشتم قدر زائد على النفاق و الكفر على ما لا يخفى و قد كان ممن هو كافر من يحبه صلى الله عليه و سلم و يوده و يصطنع إليه المعروف خلق كثير و كان ممن يكف عنه أذاه من الكفار خلق كثير أكثر من أولئك و كان ممن يحاربه و لا يشتمه خلق آخرون بالآية تدل على أنها نزلت في منافقين غير الذين يؤذونه فإنه سبحانه و تعالى قال : { و منهم الذين يؤذون النبي ـ إلى قوله ـ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون و لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب قل أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤن ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين } [ التوبة : 66 ] فليس في هذا ذكر سب و إنما فيه ذكر استهزاء بالدين ما لا يتضمن سبا و لا شتما للرسول
و في هذا الوجه نظر كما تقدم في سبب نزولها إلا أن يقال : تلك الكلمات ليست من السب المختلف فيه و هذا ليس بجيد
الوجه الثاني : أنهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذي استمع أذاهم و لم يتكلم و هو مخشي بن حمير هو الذي تيب عليه و أما الذين تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحد منهم
يحقق هذا أن العفو المطلق إنما هو ترك المؤاخذة بالذنب و إن لم يتب صاحبه كقوله تعالى : { إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا الله عنهم } [ آل عمران : 155 ]
و الكفر لا يعفى عنه : فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة ـ إما بسماع الكفر دون إنكاره و الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله أو بكلام هو ذنب و ليس هو كفرا أو غير ذلك ـ و على هذا فتكون الآية دالة على أنه لابد من تعذيب أولئك المستهزئين و هو دليل على أنه لا توبة لهم لأنهم من أخبر الله بأنه يعذب و هو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب فيصلح أن يجعل هذا دليلا في المسألة
الوجه الثالث : أنه سبحانه و تعالى أخبر أنه لابد أن تعذب طائفة من هؤلاء إن عفا عن طائفة و هذا يدل عل أن العذاب واقع بهم لا محالة و ليس فيه ما يدل على وقوع العفو لأن العفو معلق بحرف الشرط فهو محتمل و أما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو معلق بحرف الشرط فهو محتمل و أما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو و هو بتقدير عدمه أوقع فعلم أنه لابد من التعذيب : إما عاما أو خاصا لهم و لو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا
و إذا ثبت أنهم لا بد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم و إنه يحرم تعذيبهم إذا أظهروها و سواء أراد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين لأنه سبحانه و تعالى أمر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار و المنافقين فكان من أظهره عذب بأيدي المؤمنين و من كتمه عذبه الله بعذاب من عنده و في الجملة فليس في الآية دليل على أن العفو واقع و هذا كاف هنا
الوجه الرابع : أنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول توبتهم فهو حق و تكون هذه التوبة إذا تابوا قبل أن يثبت النفاق عند السلطان كما بين ذلك قوله تعالى : { لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض } [ الأحزاب : 61 ] الآيتين فإنها دليل على أن من لم ينته حتى أخذ فإنه يقتل و على هذا فلعله و الله أعلم عنى : { إن نعف عن طائفة منكم } [ التوبة : 66 ] و هم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه { نعذب طائفة } و هم الذين أظهروه حتى أخذوا : فتكون دالة على وجوب تعذيب من أظهره
الوجه الخامس : أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر النفاق و تاب أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى : { جاهد الكفار و المنافقين } [ التوبة : 73 ] كما أسلفناه و بيناه
و يؤيده أنه قال : { إن نعف } و لم يبت و سبب النزول يؤيد أن النفاق ثبت عليهم و لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه و سلم و ذلك كان في غزوة تبوك قبل أن تنزل براءة و في عقبها نزلت سورة براءة فأمر فيها بنبذ العهود إلى المشركين و جهاد الكفار و المنافقين
فالجواب عما احتج به منها من وجوه :
أحدها : أنه سبحانه و تعالى إنما ذكر أنهم قالوا كلمة الكفر و هموا بما لم ينالوا و ليس في هذا ذكر للسب و للكفر أعم من السب و لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص لكن فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على أنها نزلت فيمن سب فيبطل هذا
الوجه الثاني : أنه سبحانه و تعالى إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالله ما قالوا و هذا حال من أنكر أن يكون تكلم بكفر و حلف على إنكاره فأعلم الله نبيه أنه كاذب في يمينه و هذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم عنه الكلمة من النفاق و لا تقوم عليه به بينة هذا لا يقام عليه حد إذ لم يثبت عليه في الظاهر شيء و النبي صلى الله عليه و سلم إنما يحكم في الحدود و نحوها بالظاهر و الذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إنما فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بما قالوه بخبر واحد إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم أو غير هؤلاء أو أنه أوحى إليه وحي بحالهم
و في بعض التفاسير أن المحكي عنه هذه الكلمة [ الجلاس بن سويد ] اعترف بأنه قالها و تاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك منه و هذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة و هو توبة من ثبت عليه نفاق و هذا لا خلاف فيه إذا تاب فيما بينه و بين الله سرا كما نافق سرا أنه تقبل توبته و لو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم و لتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت توبته أيضا على القول المختار كما تقبل توبة من جاء مظهرا للتوبة من زنا أو سرقة عليه على الصحيح و أولى من ذلك و أما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الآية و لا فيما ذكر من سب نزولها ما يدل على قبول توبته بل و ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز أن يحمل على توبته فيما بينه و بين الله فإن ذلك نافع وفاقا و إن أقيم عليه الحد كما قال تعالى : { و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله } [ آل عمران : 135 ] و قال تعالى : { و من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما } [ النساء : 110 ] و قال الله تعالى : { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا } [ الزمر : 53 ] و قال تعالى : { ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده } [ التوبة : 104 ] و قال تعالى : { غافر الذنب و قابل التوب } [ غافر : 3 ] إلى غير ذلك من الآيات مع أن هذا لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة عمن أتى بفاحشة موجبة للحد أو ظلم نفسه بشرب أو سرقة فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينة أو إقرار : [ ليس في الآية ما يدل على سقوط الحد عنه ] لكان لقوله مساغ
الوجه الثالث : أنه قال سبحانه و تعالى : { جاهد الكفار و المنافقين و أغلظ عليهم ـ إلى قوله ـ يحلفون بالله ما قالوا } الآية [ التوبة : 73 ] و هذا تقرير لجهادهم و بيان لحكمته و إظهار لحاكم المقتضي لجهادهم فإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على أنه علة له و قوله : { يحلفون بالله ما قالوا } [ التوبة : 74 ] وصف لهم و هو مناسب لجهادهم فإن كونهم يكذبون في أيمانهم و يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر بموجب للإغلاظ عليهم بحيث لا يقبل منهم و لا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمان بل ينتهرون و يرد ذلك عليهم
و هذا كله دليل على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذه إذا لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن الماضي أنه لم يكفر و فيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر فإذا بين سبحانه و تعالى من حالهم ما يوجب أن لا يصدقوا وجب أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بكافر بعد ثبوت كفره بل يجري عليه حكم قوله تعالى { و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون } [ المنافقين : 1 ] لكن بشرط أن يظهر كذبه فيها بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس و لا نشق بطونهم و على هذا فقوله تعالى : { فإن يتوبوا يك خيرا لهم } [ التوبة : 74 ] أي قبل ظهور النفاق و قيام البينة به عند الحاكم حتى يكون للجهاد موضع و للتوبة [ موضع ] و إلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية الوجه الرابع : أنه سبحانه و تعالى قال بعد ذلك : { و إن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا و الآخرة } [ التوبة : 74 ] و فسر ذلك في قوله تعالى : { و نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا } [ التوبة : 52 ]
و هذا دليل على أن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر النفاق و شهد عليه به و أخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه فيجب أن يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا و القتل عذاب أليم فيصلح أن يعذب به لأن المتولي أبعد أحواله أن ترك التوبة إلى أن لا يتركه الناس لأنه لو كان المراد به تركها إلى الموت لم يعذب في الدنيا لأن عذاب الدنيا قد فات فلا بد أن يكون التولي ترك التوبة و بينه و بين الموت مهل يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد الأخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك بل تولى فيستحق أن يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا و الآخرة و من تأمل هذه الآية و التي قبلها و جدهما دالتين على أن التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه
و أما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه و بين الله و إن تضمنت التوبة من عرض الرسول فنقول أولا ـ و إن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية ـ هذا القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك كما أن الزاني و الشارب و قاطع الطريق إذا تاب فيما بينه و بين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته و إذا اطلعنا عليه ثم تاب قوله تعالى فلا بد من إقامة الحد عليه و يكون ذلك من تمام توبته و جميع الجرائم من هذا الباب
و قد يقال : إن المنتهك لأعراض الناس إذا استغفر لهم قبل أن يعلموا بذلك رجي أن يغفر الله له على ما في ذلك الخلاف المشهور و لو ثبت ذلك عند السلطان ثم أظهر التوبة لم يسقط عقوبته ذلك أن الله سبحانه لا بد أن يجعل للمذنب طريقا إلى التوبة فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يخرج منها جهده و يعوضهم عنها ما يمكنه و رحمة الله من وراء ذلك ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظهرنا عليه و نحن إنما نتكلم في التوبة المسقطة للحد و العقوبة لا في التوبة الماحية للذنب
ثم نقول ثانيا : إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين و ناقضي العهد من سفك دماء المسلمين و أخذ أموالهم و انتهاك أعراضهم فإنهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب إباحة ذلك ثم إذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبة المتعلق بحق الله و حق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب للكافر الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه مع أن المرتد أو الناقص متى فعل شيئا من ذلك قبل الإمتناع أقيم عليه حده و إن عاد إلى الإسلام سواء كان لله أو لآدمي فيحد على الزنا و الشرب و قطع الطريق و إن كان في زمن الردة و نقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك اليمين إذا قهر مسلمة على نفسها و يعتقد حل دماء المسلمين و أموالهم كما يؤخذ منه القود و حد القذف و إن كان يعتقد حلهما و يضمن ما أتلفه من الأموال و إن اعتقد حلها
و الحربي الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام فكان الفرق أن ذاك كان ملتزما بأيمانه و أمانه أن يفعل شيئا من ذلك فإذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف الحربي الأصل و إن في إقامة هذه الحدود عليه زجرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على إسلامه بخلاف الحربي الأصل فإن ذلك لا يزجره بل هو منفر له عن الإسلام و لأن الحربي الأصل ممتنع و هذان ممكنان
و كذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربي إذا زنى بعد الأسر أقيم عليه الحد لأنه صار في أيدينا كما أن الصحيح عنه و عن أكثر أهل العلم أن المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحربي إذ الممتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاده و قوة من غير زاجر له ففي إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير و إغلاق لباب التوبة عليهم و هو بمنزلة تضمين أهل الحرب سواء و ليس هذا موضع استقصاء هنا و إنما نبهنا عليه و إذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد و الناقض إذا آذيا الله و رسوله ثم تابا من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا كانا بمنزلتهما إذا حربا باليد في قطع الطريق أو زنيا و تابا بعد أخذهما و ثبوت الحد عليهما و لا فرق بينهما و ذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في دينه و إن كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له
و كذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمة فاعتقاده إباحتها إذا لم يتصل به قوة و منعة ليس عذرا له في أن يفعلها لما كان ملتزما له من الدين الحق و لما هو به من الضعف و لما في سقوط الحد عنه من الفساد و إن كان السب صادرا عن غير اعتقاد بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأكبر مما يوجبه اعتقاده أو بغير ما يوجبه اعتقاده فهذا من أعظم الناس كفرا بمنزلة إبليس و هو من نوع العناد أو السفه و هو بمنزلة من شتم بعض المسلمين أو قتلهم و هو يعتقد أن دماءهم و أعراضهم حرام
و قد اختلف الناس في سقوط حق المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به سواء كان نبيا أو غيره فمن اعتقد أن التوبة لا تسقط حق الآدمي له أن يمنع هنا أن توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الإطلاق و له أن يقول : إن للنبي صلى الله عليه و سلم أن يطالب هذا بشتمه مع علمه بأن حرام كسائر المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمهم و سابهم بل ذلك أولى و هذا القول قوي في القياس و كثير من الظواهر يدل عليه
و من قال : [ هذا من باب السب و الغيبة و نحوهما مما يتعلق بأعراض الناس و قد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء و الاستغفار بما يزن حق عرضه ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا له و استغفر فيسلم له سائر عمله فكذلك من صدرت منه كلمة سب أو شتم فليكثر من الصلاة و التسليم و يقابلها بضدها ] فمن قال : [ إن ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا و باطنا ] أدخله في قوله تعالى : { إن الحسنات يذهبن السيئات } [ هود : 114 ] [ و أتبع السيئة الحسنة تمحها ]
و من قال لابد من القصاص قال : قد أعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص و ليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا و إنما الغرض أن الحد لا يسقط بالتوبة لأنه إن كان عن اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحق الرسول في الآخرة و هي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم و إن كانت عن غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف
فإن قيل [ لا يسقط ] و إن قيل يسقط الحق و لم يسقط الحد كتوبة الأولي و أولى فحاصله أن الكلام في مقامين : أحدهما أن التوبة إذا كانت صحيحة نصوحا فيما بينه و بين الله هل يسقط معها حق المخلوق ؟ و فيه تفضيل و خلاف فإن قيل [ لم يسقط ] فلا كلام و إن قيل [ يسقط ] فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة فتكون كالتوبة من سائر أنواع الفساد و تلك التوبة إذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود و إن كانت تجب الإثم في الباطن
و حقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة و مجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره بل لردة مغلظ بالضرر و مثله لا يسقط موجبه بالتوبة لأنه من محاربة الله و رسوله و السعي في الأرض فسادا و هو من جنس الزنا و السرقة أو هو من جنس القتل و القذف فهذه حقيقة الجواب و به يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة
ثم نبينه مفصلا فنقول : أما قولهم [ إن ما جاء به من الإيمان به ماح لما أتى به من هتك عرضه ] فنقول : إن كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من الاعتقاد توبة من موجبه و أما من زاد على موجب الاعتقاد أو أتى بضده ـ و هم أكثر السابين ـ فقد لا يسلم أن ما يأتي به من التوبة ماح إلا بعد عفوه بل يقال : له المطالبة و إن سلم ذلك فهو كالقسم الأول و هذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة
و أما قولهم [ حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب فتبعته في السقوط ] فنقول : هذا مسلم إن كان السب موجب اعتقاد و إلا ففيه الخلاف و أما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد فإن التائب من اعتقاد الكفر و موجباته و التائب من الزنا سواء و من لم يسو بينهما قال : ليست أعظم من حق الله إذا لم يسقط في الباطن بسقوطه و لكن الأمر إلى مستحقها : إن شاء جزى و إن شاء عفا و لم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه و قد أعلمنا أنه يغفر لكل من تاب
و أيضا فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرة و المعرة بهذا و يتألمون به فجعل الأمر إليهم و الله سبحانه و تعالى إنما حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة فإنه لا ينتفع بالطاعة و لا يستضر بالمعصية فإذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما أراده ربه منه فلما كان الأنبياء عليهم السلام فيهم نعت البشر و لهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حق الله و نعت حق سائر العباد و إنما يكون حقهم مندرجا في حق الله إذا صدر عن اعتقاد فإنهم لما وجب الإيمان بنبوتهم صار كالإيمان بوحدانية الله فإذا لم يعتقد معتقد نبوتهم كان كافرا كما إذا لم يقر بوحدانية الله و صار الكفر بذلك كفرا برسالات الله و دينه و غير ذلك فإذا كان السب موجبا بذا الاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك و تاب منه توبة نصوحا قبلت توبته كتوبة المثلث و إذا زاد على ذلك ـ مثل قدح في نسب أو وصف بمساوئ أخلاق أو فاحشة أو غير ذلك مما يعلم هو أنه باطل أو لا يعتقد صحته أو كان مخالفا للاعتقاد مثل أن يحسد أو يتكبر أو يغضب لفوات غرض أو حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب ـ فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال موجب السب إنما غير نيته و قصده و هو قد آذاه فهذا السب لم يتألم به البشر و لم يكن معذورا بعدم اعتقاد النبوة فهو لحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي السبب الذي بين الله و بين خلقه فوجب قتله و هو كحق البشر من حيث إنه آذى آدميا يعتقد أنه لا يحل أذاه فلذلك كان له أن يطالبه بحق أذاه و أن يأخذ من حسناته بقدر أذاه و ليست له حسنة تزن ذلك إلا ما يضاد السب من الصلاة و التسليم و نحوهما و بهذا يظهر أن التوبة من سب صدر من غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر ثم هو حق يتعلق بالنبوة لا محالة فهذا قول القائل و إن كنا لم نرجح واحدا من القولين
ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فمن الذي يقول : إن حقوق الله تسقط عن المرتد و ناقض العهد بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة و إنما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة و النقض المجرد و هذا ليس كذلك
و أما قوله : [ إن الرسول يدعو الناس إلى الإيمان به و يخبرهم أن الإيمان يمحو الكفر فيكون قد عفا لمن كفر عن حقه ] فنقول : هذا جيد إذا كان السب موجب الاعتقاد لأنه هو الذي اقتضاه و دعاه إلى الإيمان به فإنه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيمان به زال موجبه أما من زاد على ذلك و سبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو عنه و قد كان له أن يعفو و له أن لا يعفو
و التقدير المذكور في السؤال إنما يدل على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيمان لأنه هو الذي كان يدعو إليه الكفر و قد زال بالإيمان و أما ما سوى ذلك فلا فرق بينه و بين سب الناس من هذه الجهة و ذلك أن الساب إن كان حربيا فلا فرق بين سبه للرسول أو لواحد من الناس من هذه الجهة و إن كان مسلما أو ذميا فإذا سب الرسول سبا لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل و ينهاه عنه و إن لم يرفع موجبه فإنه موجب هذا السب لم يكن الكفر به إذ كلامنا في سب لا يوجبه الكفر به مثل فرية عليه يعلم أنها فرية و نحو ذلك لكن إذا أسلم الساب فقد عظم في قلبه عظيمة تمنعه أن يفتري عليه كما أنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته و جاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعا لكون موجب السب كان شيئا غير الكفر و قد يضعف هذا الإسلام عن دفعه كما يضعف هذه التوبة عن موجب الأذى و فرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو بوجوده ضده فإن ما أوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد زال سببه فلم يخش عوده إلا بعود السبب و ما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية و نحوها على النبي عليه الصلاة و السلام و غيره يرفعها الإسلام و التوبة رفع الضد للضد إذ قبح هذا الأمر و سوء عاقبته و العزم الجازم على فعل ضده و تركه ينافي وقوعه لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله فهذا يبين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سب يوجبه مجرد الكفر بالإيمان به الموجب لعدم ذلك السب و بين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب
و اعتبر هذا برجل له غرض في أمر فزجر عنه و قيل له : هذا قد حرمه النبي عليه الصلاة و السلام فلا سبيل إليه فحمله فرط الشهوة و قوة الغضب لفوات المطلوب على أن لعن و قبح فيما بينه و بين الله مع أنه لا يشك في النبوة ثم إنه جدد إسلامه و تاب و صلى على النبي صلى الله عليه و سلم و لم يزل باكيا من كلمته و رجل أراد أن يأخذ مال المسلم بغير حق فمنعه منه فلعن و قبح سرا ثم إنه تاب من هذا و استغفر لذلك الرجل و لم يزل خائفا من كلمته أليست توبة هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته ؟ و إن كانت توبة هذا يجب أن تكون أعظم لعظم كلمته لكن نسبة هذه إلى هذه كنسبة هذه إلى هذه بخلاف من إنما يلعن و يقبح من يعتقده كذابا ثم تبين له أنه كان ضالا في ذلك الاعتقاد و كان في مهواة التلف فتاب و رجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله فإنه يندرج فبه جميع ما أوجبه
و مما يقرر هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا بلغه سب مرتد أو معاهد سئل أن يعفو عنه بعد الإسلام و دلت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه و توبته و لو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد لم يجز ذلك فعلم أنه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين
فهذا الكلام في كون توبة الساب فيما بينه و بين الله هل تسقط حق الرسول أم لا ؟ و بكل حال ـ سواء أسقطت أم لم تسقط ـ لا يقتضي ذلك أن إظهارها مسقط للحد إلا أن يقال : هو مقتول لمحض الردة أو محض نقض العهد فإن توبة المرتد مقبولة و إسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل
و قد قدمنا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتول لردة مغلظة و نقض مغلظ بمنزلة من حارب و سعى في الأرض فسادا
ثم من قال : [ يقتل حقا لآدمي ] قال : العقوبة إذا تعلق بها حقان حق لله و حق لآدمي ثم تاب سقط حق الله و بقي حق الآدمي من القود و هذا التائب إذا تاب سقط حق الله و بقي حق الآدمي
و من قال [ يقتل حدا لله ] قال : هو بمنزلة المحارب و قد يسوى بين من سب الله و بين من سب الرسول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى
و قولهم في المقدمة الثانية : [ إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها منه ] قلنا : هذا مبني على أن هذه التوبة مقبولة مطلقا و قد تقدم الكلام فيه
ثم الجواب هنا من وجهين : أحدهما : القول بموجب ذلك فإنا نقبل منه هذه التوبة و نحكم بصحة إسلامه كما نقبل توبة القاذف و نحكم بعدالته و نقبل توبة السارق و غيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه و من تاب بعد القدرة لم يسقط عنه شيء من حقوق العباد إذا قبلنا توبته أن يطهر بإقامة الحد عليه كسائر هؤلاء و ذلك أنا نحن لا ننازع في صحة توبته و مغفرة الله له مطلقا فإن ذلك إلى الله و إنما الكلام في : هل هذه التوبة مسقطة للحد عنه و ليس في الحديث ما يدل على ذلك فإنا قد نقبل إسلامه و توبته و نقيم عليه الحد تطهيرا له و هذا جواب من يقتله حدا محضا مع الحكم بصحة إسلامه
الثاني : أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي و هنا قد ثبت خلافه و هذا جواب من يقتله لزندقته و قد يجيب به من يقتل الذمي أيضا بناء على أنه زنديق في حال العهد فلا يوثق بإسلامه
و أما إسلام الحربي و المرتد و نحوهما ـ عند معاينة القتل ـ فإنما جاز لأنا إنما نقاتلهم لآن يسلموا و لا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بألسنتهم فوجب قبول ذلك منهم و إن كانوا في الباطن كاذبين و إلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو لم يسلم و لا تكون المقاتلة حتى يسلموا بل يكون القتال دائما و هذا باطل ثم إنه قد يسلم الآن كارها ثم إن الله يحبب إليه الإيمان و يزينه في قلبه كذلك أكثر من يسلم لرغبته في المال و نحوه أو لرهبته من السيف و نحوه و لا دليل يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرها عليه بحق و هذا لا يلتفت إليه
أما هنا فإنما نقتله لما مضى من جرمه من السب كما نقتل الذمي لقتله النفس أو لزناه بمسلمة و كما نقتل المرتد لقتله مسلما و لقطعه الطريق كما تقدم تقريره فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يسلم و لا تجب مقاتلته على أن يسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا و نكالا لأمثاله عن مثل هذه الجريمة فإذا أسلم فإن صححنا إسلامه لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة و قد قتل فإنه يقتل وفاقا فيما علمناه و إن حكم بصحة إسلامه و إن لم يصحح إسلامه فالفرق بينه و بين الحربي و المرتد من وجهين :
أحدهما : أن الحربي و المرتد لم يتقدم منه ما دل على أن باطنه بخلاف ظاهره بل إظهاره للردة لما ارتد دليل على أن ما يظهره من الإسلام صحيح و هذا مازال مظهرا للإسلام و قد أظهر ما دل على فساد عقده فلم يوثق بما يظهره من الإسلام بعد ذلك و كذلك ناقض العهد قد عاهدنا على أن لا يسب و قد سب فثبتت جنايته و غدره فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخوف و يغدر فإنه كان ممنوعا من إظهاره و إسراره ؟ و لم يكن له غدر فيما فعله من السب بل كان محرما عليه في دينه فإذا لم يف به صار من المنافقين في العهد
الثاني : أن الحربي أو المرتد نحن نطلب منه أن يسلم فإذا أعطانا ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه و الحكم بصحته و الساب لا نطلب منه إلا القتل عينا فإذا أسلم ظهر إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل الواجب عليه كما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو سلم أو تاب سائر الحياة بعد أخذهم فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام فلا يسقط ما وجب من الحد قبله
و حقيقة الأمر أن الحربي أو المرتد يقتل لكفر حاضر و يقاتل ليسلم فلا يمكن أن يظهر و هو مقاتل أو مأخوذ الإسلام إلا مكرها فوجب قبوله منه إذ لا يمكن بذله إلا هكذا و هذا الساب و الناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين لما ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مؤثر في قتله و يكون قد بذل التوبة التي لن تطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منه
و على هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول بوجوب قتله :
أحدهما : لا يحكم بصحة إسلامه و هو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية
و الثاني : يحكم بصحة إسلامه و عليه يدل كلام الإمام أحمد و أصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد و أما المسلم إذا سب ثم قتل بعد أن أسلم فمن قال [ يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمي أو حدا محضا لله ] قال بصحة هذا الإسلام و قبله و هذا قول كثير من أصحابنا و غيرهم و قول من قال يقتل من أصحاب الشافعي
و كذلك من قال : [ يقتل من سب الله ] و من قال [ يقتل لزندقته ] أجرى عليه ـ إذا قتل بعد إظهار الإسلام ـ أحكام الزنادقة و هو قول كثير من المالكية و عليه يدل كلام بعض أصحابنا و على ذلك ينبني الجواب عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه و سلم ظاهر الإسلام من المنافقين فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام في الجملة فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها
أحدها : أن الإسلام إنما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافه و كانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه فأما أن البينة تقوم عند رسول الله عليه الصلاة و السلام على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادئ الأمر
و الثاني : أنه كان في أول الأمر مأمورا في مبادئ الأمر أن يدع أذاهم و يصبر عليهم لمصلحة التأليف و خشية التنفير إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : { جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم } [ التوبة : 73 ]
الثالث : أنا نقول بموجبه فنقبل من هذا الإسلام و نقيم عليه حد السب كما لو أتى حدا غيره و هذا جواب من يصحح إسلامه و يقتله حدا لفساد السب
الرابع : أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يستتب أحدا منهم و يعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه مع أن هذا مجمع على وجوبه فإن الرجل منهم إذا شهد عليه الكفر و الزندقة فإما أن يقتل عينا أو يستتاب فإن لم يتب و إلا قتل
و أما الاكتفاء منه بمجرد الجحود فما أعلم به قائلا بل أقل ما قيل فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين و التبري من تلك المقالة فإذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم أن ترك هذا الحكم لفوات شرطه ـ و هو إما ثبوت النفاق أو العجز عن إقامة الحد أو مصلحة التأليف في حال الضعف ـ حتى قوي الدين فنسخ ذلك
و إن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام ممن سب فعنه جواب خامس و هو أنه صلى الله عليه و سلم كان له أن يعفو عمن شتمه في حياته و ليس هذا العفو لأحد من الناس بعده
و أما تسمية الصحابة الساب غادرا محاربا فهو بيان لحل دمه و ليس كل من نقض العهد و حارب سقط القتل عنه بإسلامه بدليل ما لو قتل مسلما أو قطع الطريق عليه أو زنى بمسلمة بل تسميته محاربا ـ مع كون السب فسادا ـ يوجب دخوله في حكم الآية كما تقدم
و أما الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و سبوه ثم عفا عنهم فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الأولى لما ذكرنا قصصهم و بينا أن السب غلب فيه حق الرسول إذا علم فله أن يعفو و أن ينتقم [ و ليس في ] هؤلاء ما يدل على أن العقوبة إنما سقطت عنهم مع عفوه و صفحه لمن تأمل أحوالهم معه و التفريق بينهم و بين من لم يهجه و لم يسبه
و أيضا فهؤلاء كانوا محاربين و الحربي لا يؤخذ بما أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض و المسلم و المعاهد يؤخذ بذلك
و قولهم : [ الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي و إن لم يعتقد حل الدم و المال ] غلط فإن عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا و أوجب عليهم الكف عن أن يسبوا نبينا كما منعهم دماءنا و أموالنا و أبلغ فهو إن لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقادنا نحن في دمائهم و أموالهم و أعراضهم و نحن لم نعاهدهم على أن نكف عن سب دينهم الباطل و إظهار معائبهم بل عاهدناهم على أن يظهروا في دارنا ما شئنا و أن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم و إلا فأين الصغار ؟
و أما قولهم : [ الذمي إذا سب فإما أن يقتل لكفره و حرابه كما يقتل الحربي الساب أو يقتل حدا من الحدود ] قلنا : هذا تقسيم منتشر بل يقتل لكفره و حرابه بعد الذمة و ليس من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الأصل فإن الذمي إذا قتل مسلما اجتمع عليه أنه نقض العهد و أنه وجب عليه القود فلو عفا ولي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد و كذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي إذا فعلها و ليس حكمه فيها كحكم الحربي الأصل إجماعا و إذا قتل لحرابه و فساده بعد العهد فهو حد من الحدود فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل أحدهما للآخر و قد بينا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لمجرد كونه كافرا غير ذي عهد بل حد أو عقوبة على سب نبينا الذي أوجبت عليه الذمة تركه و الإمساك عنه مع أن السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه و أنه يصير بالسب محاربا غادرا و ليس هو كحد الزنا و نحوه مما لا مضرة علينا فيه و إنما أشبه الحدود به حد المحاربة
و أما قولهم : [ ليس في السب أكثر من انتهاك العرض و هذا القدر لا يوجب إلا الجلد ] ففي الكلام عنه ثلاثة أجوبة :
أحدها : أن هذا كلام في رأس المسألة فإنه إذا لم يوجب إلا الجلد و الأمور الموجبة للجلد لا تنقض العهد ـ لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين و قد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمي إذا فعل ذلك و أنه لا عهد له يعصم دمه مع ذلك و بينا أن انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد و أما انتهاك عرض الرسول فإنه يوجب القتل و قد صولح على إمساك على العرضين فمتى انتهك عرض الرسول فقد أتى بما يوجب القتل مع التزامه أن لا يفعله فوجب أن يقتل كما لو قطع الطريق أو زنى و التسوية بين عرض الرسول و عرض غيره في مقدار العقوبة من أفسد القياس
و الكلام في الفرق بينهما يعد تكلفا فإنه عرض قد أوجب الله على جميع الخلق أن يقابلوه من الصلاة و السلام و الثناء و المدحة و المحبة و التعظيم و التعزيز و التوقير و التواضع في الكلام و الطاعة للأمر و رعاية الحرمة في أهل البيت و الأصحاب بما لا خفاء به على أحد من علماء المؤمنين عرض به قام دين الله و كتابه و عبادة المؤمنين به وجبت الجنة لقوم و النار لآخرين به كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس عرض قرن الله ذكره بذكره و جمع بينه و بينه في كتابة واحدة و جعل بيعته بيعة له و طاعته طاعة له و أذاه أذى له إلى خصائص لا تحصى و لا يقدر قدرها أفيليق ـ لو لم يكن سبه كفرا ـ أن تجعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره ؟
و لو فرضنا أن لله نبيا بعثه إلى أمة و لم يوجب على أمة أخرى أن يؤمنوا به عموما و لا خصوصا فسبه رجل و لعنه عالما بنبوته إلى أولئك أفيجوز أن يقال : إن عقوبته و عقوبة من سب واحدا من المؤمنين سواء ؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا
قولهم : [ الذمي يعتقد حل ذلك ] قلنا : لا نسلم فإن العهد الذي بيننا و بينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا و أموالنا و أعراضنا فهو إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل فبها و إلا فلا يجب لآن مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق فإنه إذا علم تحريم ذلك عوقب العقوبة المشروعة و إن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك و أن عقوبته دون ما هو مشروع 0000 ]
و أيضا فإن دينهم لا يبيح لهم السب و اللعنة للنبي و إن كان دينا باطلا أكثر ما يعتقدون أنه ليس بنبي أو ليس عليهم اتباعه أما أن يعتقدوا أن لعنته و سبه جائزة فكثير منهم أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك على أن السب نوعان أحدهما : ما كفروا به و اعتقدوه و الثاني : ما لم يكفروا به فهذا الثاني لا ريب أنهم لا يعتقدون حله
و أما قولهم : [ صولح على ترك ذلك فإنه فعله انتقض العهد ] فإنه إذا فعله انتقض عهده و عوقب على نفس تلك الجريمة و إلا كان يستوي حال من ترك العهد و لحق بدار الحرب من غير أذى لنا و حال من قتل و سرق و قطع الطريق و شتم الرسول مع نقض العهد و هذا لا يجوز
و أما قولهم : [ كون القتل حدا حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ] فصحيح و قد تقدمت الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة و الأثر و النظر الدالة على أن نفس السب ـ من حيث خصوصيته ـ موجب للقتل و لم يثبت ذلك استحسانا صرفا و استصلاحا محضا بل أثبتاه بالنصوص و آثار الصحابة و ما دل عليه إيماء الشارع و تنبيهه و بما دل عليه الكتاب و السنة و إجماع الأمة من الخصوصية لهذا السب و الحرمة لهذا العرض التي يوجب أن لا يصونه إلا القتل لا سيما إذا قوي الداعي على انتهاكه و خفة حرمته بخفة عقابه و صغر في القلوب مقدار من هو أعظم العالمين قدرا إذا ساوى في قدر العرض زيدا و عمرا و تمضمض بذكره أعداء الدين من كافر غادر و منافق ماكر فهل يستريب من قلب الشريعة ظهرا لبطن أن محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم حرمات المخلوقين و حرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد من الناس ؟ مع أعظم النظر عن الكفر و الارتداد فإنهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد و لسنا الأن نتكلم في المصالح المرسلة فإنا لم نحتج إليها في هذه المسألة لما فيها من الأدلة الخاصة الشرعية و إنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقيادا و النفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادا ثم لو لم يكن في المسألة نص و لا أثر لكان اجتهاد الرأي يقضي بأن يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخصوصه لا لعموم كونه كفرا أو ردة حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجبا للقتل أخذا له من قاعدة العقوبات في الشرع فإنه يجعل أعلى العقوبات في مقابلة أرفع الجنايات و أوسطها في مقابلة أوسطها و أدناها في مقابلة أدناها فهذه الجناية إذا انفردت تمتنع أن تجعل في مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها و بين الجناية على عرض زيد و عمرو فإنه لا يخفى على من له أدنى نظر بأسباب الشرع أن هذا من أفسد أنواع الاجتهاد و مثله في الفساد خلوها عن العقوبة تخصها و أما جعله في الأوسط كما اعتقده المهاجر بن أبي أمية حتى قطع يد الجارية السابة و قلع ثنيتها فباطل أيضا كما أنكره عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن الجناية جناية على أشرف الحرمات و لأنه لا مناسبة بينها و بين أوسط العقوبات من قطع عضو من الأعضاء فتعين أن تقابل بأعلى العقوبات و هو القتل
و لو نزلت بنا نازلة السب و ليس معنا فيها أثر يتبع ثم استراب مستريب في الواجب إلحاقها بأعلى الجنايات لما عد من بضراء الفقهاء و مثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث أن لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فإذا فرض أنه ليس لها أصل خاص تلحق به و لابد من الحكم فيها فيجب أن يحكم فيها بما هو أشبه بالأصول الكلية و إذا لم يعمل بالمصلحة لزم العمل بالمفسدة و الله لا يحب الفساد
و لا شك أن العلماء في الجملة ـ من أصحابنا و غيرهم ـ قد يختلفون في هذا الضرب من المصالح إذا لم يكن فيها أثر و لا قياس خاص و الإمام أحمد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس المسلم و نحوه إن جعلت من أفرادها و ربما عمل بها و ربما تركها إذا لم يكن معه فيها أثر أو قياس خاص و من تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم يضطرون إلى رعايتها إذا لم يخالف أصلا من الأصول و لم يحالف في اعتبارها الطوائف من أهل الجدل و الكلام من أصحابنا و غيرهم و لو أنهم مخاض الفقهاء لعلموا أنه لابد من اعتبارها و ذوق الفقه ممن لجج فيه شيء و الكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شيء آخر و أهل الكلام و الجدل إنما يتكلمون في القسم الثاني فيلتزمون غيرهم مالا يقدرون على التزامه و يتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف إلا أمور كلية و عمومات إحاطية و للتفاصيل خصوص نظر و دلائل يدركها من عرف أعيان المسائل
و أثبتناه أيضا بالقياس الخاص و هو القياس على كل من ارتد و نقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة فيها العقوبة بالقتل و بينا أن هذا أخص من مجرد الردة و مجرد نقض العهد و أن الأصول فرقت بينهما
و أثبتناه أيضا بالنافي لحقن دمه و بينا أن هذا حل دمه بما فعله و الأدلة العاصمة لمن أسلم من مرتد و ناقض لا تتناوله لفظا و لا معنى
و قولهم : [ القياس في الأسباب لا يصح ] خلاف ما عليه الفقهاء و هو قول باطل قطعا ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك
و قولهم : [ معرفة نوع الحكمة و قدرها متعذر ] قلنا لا نسلم هذا على الإطلاق بل قد يمكن و قد يتعذر بل ربما علم قطعا : لأن الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الأصل و زيادة
قولهم : [ هو يخرج السبب عن أن يكون سببا ] ليس كذلك فإن سبب السبب لا يمنعه أن يكون سببا و الإضافة إلى السبب لا تقدح في الإضافة إلى سبب السبب و العلم بها ضروري
وأما قولهم : [ ليس في الجنايات الموجبة للقتل حدا ما يجوز إلحاق السب بها ] قلنا بل هو يلحق بالردة المقترنة بما يغلظها و النقض المقترن بما يغلظه و إن الفساد الحاصل في السب أبلغ من الفساد الحاصل بتلك الأمور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الأصول الشرعية على أن هذا الحكم مستغن عن أصل يقاس به بل هو أصل في نفسه كما تقدم ثم إن هذا الكلام مقابل بما هو أنور منه بيانا و أبهر منه برهانا و ذلك أن القول بوجوب الكف عن هذا الساب ـ بعد الاتفاق على حل دمه ـ قول لا دليل عليه إلا قياس له على بعض المرتدين و ناقضي العهد مع ظهور الفرق بينهما و من قاس الشيء على ما يخالفه و يفارقه كان قياسه فاسدا فإن جعل هذا سببا عاصما قياس لسبب على سبب مع تباينهما في نوع الحكمة و قدرها ثم إنه إخلاء للسب الذي هو أعظم الجناية على الأعراض من العقوبات و لا عهد لنا بهذا في الشرع فهو إثبات حكم خارج عن القياس و جعل لكونه موجبا للقتل موجبا لكونه أهون من أعراض الناس في باب السقوط و هذا تعليق على العلة ضد مقتضاها و خروج عن موجب الأصول فإن العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط قط لكن إن كان جنسها مما يسقط سقطت خفيفة كانت أو غليظة كحقوق الله في بعض المواضع و لم تسقط خفيفة كانت أو غليظة كحقوق العباد
ثم إن القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله و يخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و سنة خلفائه و أصحابه و القول بأن لا حق للرسول على الساب إذا أسلم : الذمي أو المسلم و لا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم و يخالف أصول الشريعة و يثبت حكما ليس له أصل و لا نظير إلا أن يلحق بما ليس مثلا له
الجواب الثاني : أنا لم ندع أن مجرد السب موجب للقتل و إنما بينا أن كل سب فهو محاربة و نقض للعهد بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الأمرين السب و نقض العهد و لا يجوز أن يقال : خصوص السب عديم التأثير فإن فساد هذا معلوم قطعا بما ذكرناه من الأدلة القاطعة على تأثيره و إذا كان كذلك لم نثبته سببا خارجا عن الأسباب المعهودة و إنما هو مغلظ السبب المعروف و هو الكفر كما أن قتل النفوس موجب لحل دمه ثم إن كان قد قتله في المحاربة تغلظ بحتم القتل و إلا بقي الأمر فيه إلى الأولياء و معلوم أن المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه [ قتل قودا و لا قصاصا ] حتى يرتب عليه أحكام من يجب عليه القود و إنما يضاف القتل إلى خصوص جنايته و هو القتل في المحاربة كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة
و قولهم : [ الأدلة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة أو لخصوص السب ] قلنا : هي نصوص في أن السب مؤثر تأثير زائدا على مطلق تأثير الكفر الخالي عن عهد فلا يجوز إهمال خصوصه بعد اعتبار الشرع له و أن يقال : إنما المؤثر مجرد ما في ضمنه و طيه من زوال العهد و لذلك و جب قتل صاحبة عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى و إذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على أن القتل المباح يسقط بالإسلام و إن كان هذا من فروع الكفر كما أن الذمي إذا استحل دماء المسلمين و أموالهم و أعراضهم فانتهكها لاعتقاده أنهم كفار و أن ذلك حلال لهم منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : إما بالقتل إن كان فيها ما يوجب القتل أو بغيره
و لذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي ـ مثل أن يقتل نصراني يهوديا أو يأخذ ماله لاعتقاده أن ذلك حلال له أو يقذفه أو يسبه ـ فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله و إن أسلم
و كذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون و معاهدون فقتل بعض أولئك المسلمين أو المعاهدين قتل لأجل ذلك حتما و انتقض عهده و إن أسلم بعد ذلك و إن كان هذا من فروع الكفر فهذا رجل انتقض عهده بأمر يعتقد حله قبل العهد و لو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان المقتول ذميا و كل واحد من الكفر و من القتل مؤثر في قتله و إن كان عهده إنما زال بهذا القتل فهذا نظير السب ثم لو أسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حدا أو قصاصا سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم ـ بأن يكون المقتول مسلما ـ أو لا يقتل به بأن يكون المقتول ذميا و على التقديرين يقتل هذا الرجل بعد إسلامه لقطعه الطريق مثلا و قتله ذلك المعاهد من غير أهل دينه و إن كان إنما فعل هذا مستحلا له لكفره و هو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه توبة من فروعه و ذلك لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر بل هو محرم عليه في دينه لأجل الذمة كما أن تلك الدماء و الأموال محرمة عليه لأجل الذمة و منشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد أن الذمي يستبيح هذا السب فإن هذا غلط إذ لا فرق ـ بالنسبة إليه ـ بين إظهار الطعن في المسلمين و بين سفك دمائهم و أخذ أموالهم إذ الجميع إنما حرمه عليهم العهد لا الدين المجرد فكيف لم يندرج أخذه لعرض بعض الأمة أو لعرض واحد من غير أهل دينه من أهل الذمة في ضمن التوبة من كفره مع أنه فرعه و اندرج أخذه لعرض نبينا عليه الصلاة و السلام في ضمن التوبة من كفره ؟
الجواب الثالث : هب أنه إنما يقتل للكفر و الحراب فقوله : [ الإسلام يسقط القتل الثابت للكفر و الحراب بالإتفاق ] غلط و ذلك أنا إنما اتفقنا على أنه يسقط القتل الثابت للكفر و الحراب الأصلي فإن ذلك إذا أسلم لم يؤخذ بما أصاب في الجاهلية من دم أو مال أو عرض للمسلمين أما الحراب الطارىء فمن الذي وافق على أن القتل الثابت بجميع أنواعه يسقط بالإسلام ؟ نعم نوافق على ما إذا نقض العهد بما لا ضرر على المسلمين فيه ثم أسلم أما إذا أسلم ثم حارب و أفسد بقطع طريق أو زنا بمسلمة أو قتل مسلم أو طعن في الدين فهذا يقتل بكل حال كما دل عليه الكتاب و السنة و هو يقتل في مواضع بالإجماع كما إذا قتل في المحاربة و حيث لم يكن مجمعا عليه فهو كمحل النزاع و القرآن يدل على أن يقتل لأنه إنما استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة فهذه المقدمة ممنوعة و التميز بين أنواع الحراب يكشف اللبس
و أما ما ذكروه من أن الكافر و المسلم إذا سب فيما بينه و بين الله و قذف الأنبياء ثم تاب قبل الله توبته و لم يطالبه النبي بموجب قذفه في الدنيا و لا في الآخرة و أن الإسلام يجب قذف اليهود لمريم و ابنها و قولهم في الأنبياء و الرسل فهو كما قالوا و لا ينبغي أن يستراب في مثل هذا و قد صرح [ به ] بعض أصحابنا و غيرهم و قالوا : إنما الخلاف في سقوط القتل عنه أما توبته و إسلامه فيما بينه و بين الله فمقبولة فإن الله يقبل التوبة عن عباده من الذنوب كلها و عموم الحكم في توبة المسلم و الذمي
فأما توبة المسلم فقد تقدم القول فيها و أما توبة الذمي من ذلك فإن كان ذلك السب ليس ناقضا للعهد بأنة يقوله سرا فتوبته منه كتوبة الحربي من جميع ما يقوله و يفعله و توبة الذمي من جميع ما يقر عليه من الكفر فإن هذا لم يكن ممنوعا بعقد الذمة و ليس كلامنا فيه و به يخرج الجواب عما ذكروه
فإن السب الذي قامت الأدلة على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي إذا فعله و إنما فرق بين الجهر بالسب و الإسرار به بخلاف المسلم لأن ما يسره من السب لا يمنعه منه إيمان و لا أمان ألا ترى أنه لو قذف واحدا من المسلمين سرا مستحلا لذلك ثم أسلم كان كما لو قذفه و هو حربي ثم أسلم و معلوم أن الكافر الذي لا عهد معه يمنعه من شيء متى أسلم سقط عنه جميع الذنوب تبعا للكفر نعم لو أتى من السب بما يعتقده حراما في دينه ثم أسلم ففي سقوط حق المسبوب هنا نظر و نظيره أن يسب الأنبياء بما يعتقده محرما في دينه و أما إن كان السب ناقضا للعهد فإظهاره له مستحلا له في الأصل و غير مستحل كقتله المسلم مستحلا أو غير مستحل فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن و أما إسقاطها لحق الآدمي ففيه نظر
و الذي يقضيه القياس أنه كتوبة المسلم : إن كان قد بلغ المشتوم فلا بد من استحلاله و إن لم يبلغه ففيه خلاف مشهور و ذلك لأنه حق آدمي يعتقده محرما عليه و قد انتهكه فهو كما لو قتل المعاهد مسلما سرا ثم أسلم وتاب أو أخذ له مالا سرا ثم أسلم فإن إسلامه لا يسقط عنه حق الآدمي الذي كان يعتقده محرما لا عهد لا ظاهرا و لا باطنا و هذا معنى قول من قال من أصحابنا : [ إن توبته فيما بينه و بين الله مقبولة ] فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها و إن الله يقبل التوبة من حقوقه مطلقا أما من حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم بل إما أن يستوفيها صاحبها ممن ظلمه أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم
و جماع هذا الأمر أن التوبة من كل شيء كان يستحله في كفره تسقط حقوق الله و حقوق العباد ظاهرا و باطنا لكن السب الذي نتكلم فيه هو السب الذي يظهره الذمي و ليس هذا مما كان يستحله كما لم يكن يستحل دماءنا و أموالنا و إن كان ذلك مما يستحله لولا العهد
و قد تقدم ذكر هذا و بينا أن العهد يحرم عليه في دينه كثيرا مما كان يعتقده حلالا لولا العهد و نظير هذا التوبة المرتد من السب الذي يعتقد صحته و أما ما لم يكن يستحله و هو إظهار السب ففيه حقان : حق لله و حق الآدمي فتوبته تسقط فيما بينه و بين الله حقه لكن لا يلزم أن تسقط حق الآدمي في الباطن فهذا الكلام على قبول التوبة فيما بينه و بين الله
و حينئذ فالجواب من وجوه :
أحدهما : أن الموضع الذي ثبت فيه قبول توبته فيما بينه و بين الله من حق الله و حق عباده ليس هو الموضع الذي ينتقض فيه عهده و يقتل و إن تاب فإن ادعى أنه يسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل منع لما فيه من الخلاف فلابد من إقامة الدلالة على ذلك و الأدلة المذكورة لم تتناول السب الظاهر الذي ينتقض به العهد
الوجه الثاني : أن صحة التوبة فيما بينه و بين الله لا تسقط حقوق العباد من العقوبة المشروعة في الدنيا فإن من تاب من قتل أو قذف أو قطع طريق أو غير ذلك فيما بينه و بين الله فإن ذلك لا يسقط حقوق العباد من القود و حد القذف و ضمان المال و هذا السب فيه حق لآدمي فإن كانت التوبة يغفر له بها ذنبه المتعلق بحق الله و حق عباده فإن ذلك لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة
الوجه الثالث : أن من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكل حال يقول : [ إن توبة العبد فيما بينه و بين الله ممكنة من جميع الذنوب حتى إنه لو سب سرا آحادا من الناس موتى ثم تاب و استغفر لهم بذل سبهم لرجي أن يغفر الله له و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكذلك ساب الأنبياء و الرسل لو لم تقبل توبته و تغفر زلته لانسد باب التوبة و قطع طريق المغفرة و الرحمة و قد قال الله تعالى لما نهى عن الغيبة : { أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه و اتقوا الله إن الله تواب رحيم } [ الحجرات : 12 ]
فعلم أن المغتاب له سبيل إلى التوبة بكل حال و إن كان الذي اغتيب ميتا أو غائبا بل أصح الروايتين ليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن علم فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه و في الأثر : [ كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ] و قد قال تعالى : { إن الحسنات يذهبن السيئات } [ هود : 114 ]
أما إذا كان الرسول حيا و قد بلغه السب فقد يقول هنا : إن التوبة لا تصح حتى يستحل الرسول و يعفو عنه كما فعل أنس بن زنيم و أبو سفيان ابن الحارث و عبد الله بن أبي أمية و عبد الله بن سعد بن أبي سرح و ابن الزبعرى و إحدى القينتين و كعب بن زهير و غيرهم كما دلت عليه السيرة لمن تدبرها و قد قال كعب بن زهير :
( نبئت أن رسول الله أوعدني ... و العفو عند رسول الله مأمول )
و إنما بطلب العفو في شيء يجوز فيه العفو و الانتقام و إنما يقال [ أوعده ] إذا حكم الإيعاد باقيا بعد الإسلام و إلا فلو كان الإيعاد معلقا ببقائه على الكفر لم يبق إيعاد
إذا تقرر هذا فصحة التوبة فيما بينه و بين الله و سقوط حق الرسول بما أبدله من الإيمان به الموجب لحقوقه لا يمنع أن يقيم عليه حد الرسول إذا ثبت عند السلطان و إن أظهر التوبة بعد ذلك كالتوبة من جميع الكبائر الموجبة للعقوبات المشروعة سواء كانت حقا لله أو حقا لآدمي فإن توبة العبد فيما بينه و بين الله ـ بحسب الإمكان ـ صحيحة مع أنه إذا ظهر عليه أقيم عليه الحد و قد أسلفنا أن حق الرسول فيه حق لله و حق لآدمي و أنه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان و إن أظهر الجاني التوبة بعد الشهادة
و أما ما ذكروه من كون سب الرسول ليس بأعظم من سب الله و أن ما فيه من الشرف فلأجله ففي الجواب عنه طريقتان :
أحدهما : أنه لا فرق بين البابين فإن ساب الله أيضا يقتل و لا تسقط التوبة القتل عنه إما لكونه دليلا على الزندقة في الإيمان و الأمان أو لكونه ليس مجرد ردة و نقض و إنما هو من باب الاستخفاف بالله و الاستهانة و مثل هذا لا يسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه كما لا يسقط القتل عنه إذا انتهك محارمه فإن انتهاك حرمته أعظم من انتهاك محارمه و سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك و من قاله من أصحابنا و غيرهم و من أجاب بهذا لم يورد عليه صحة إسلام النصراني و نحوه و قبول توبتهم لأنه لا خلاف في قبول التوبة فيما بينه وبين الله و في قبول التوبة مطلقا إذا لم يظهروا السب و إنما الخلاف فيما إذا أظهر النصراني ما هو سب و طعن و دعاؤهم إلى التوبة لا يمنع إقامة الحدود عليهم إذا كانوا معاهدين كقوله سبحانه و تعالى : { إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا } [ البروج : 10 ] و كانت فتنتهم أنهم ألقوهم في النار حتى كفروا و لو فعل هذا معاهد بمسلم فإنه يقتل و إن أسلم بالاتفاق و إن كانت توبته فيما بينه و بين الله مقبولة
و أيضا فإن مقالات الكفار التي يعتقدونها ليست من السب المذكور فإنهم يعتقدون هذا تعظيما لله و دينا له و إنما الكلام في السب الذي هو سب عند الساب و غيره من الناس و فرق بين من يتكلم في حقه بكلام يعتقده تعظيما له و بين من يتكلم بكلام يعلم أنه استهزاء به و استخفاف به و لهذا فرق في القتل و الزنا و السرقة و الشرب و القذف و نحوهن بين المستحل لذلك المعذور و بين من يعلم التحريم
و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ]
و قوله فيما يروي عن ربه عز و جل : [ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر و أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل و النهار ]
فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه و إنما قصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له إلى الدهر فيقع السب على الله لأنه هو الفاعل في الحقيقة سواء قلنا إن الدهر اسم من أسماء الله تعالى كما قال [ نعيم بن حماد ] أو قلنا إنه ليس باسم و إنما قوله : [ أنا الدهر ] أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر و يوقعون السب عليه كما قال أبو عبيدة و الأكثرون
و لهذا يكفر من سب الدهر و لا يقتل لكن يؤدب و يعزر لسوء منطقه و السب المذكور في قوله تعالى : { و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } [ الأنعام : 108 ]
قد قيل : إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلهة الكفار من يأمرهم بذلك و إلههم الذين يعبدونه معرضين عن كونه ربهم و إلههم فيقع سبهم على الله لأنه إلهنا و معبودنا فيكونوا سابين لمصوف و هو الله سبحانه و لهذا قال سبحانه : { عدوا بغير علم } و هو شبيه الدهر من بعض الوجوه
و قيل : كانوا يصرحون بسب الله عدوا و غلوا في الكفر قال قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار الله بغير علم فأنزل الله : { و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم }
و قال أيضا : كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون عليهم فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بالله و ذلك أنه في اللجاجة أن يسب الجاهل من يعظمه مراغمة لعدوه إذا كان يعظمه أيضا كما قال بعض الحمقى :
( سبوا عليا كما سبوا عتيقكم ... كفرا بكفر و إيمانا بإيمان )
و كما يقول بعض الجهال : مقابلة الفاسد بمثله و كما قد تحمل بعض جهال المسلمين الحمية على أن يسب عيسى إذا جاهره المحاربون بسب رسول الله عليه الصلاة و السلام و هذا من الموجبات للقتل
الطريقة الثانية : طريقة من فرق بين سب الله و سب رسوله و ذلك من وجوه :
أحدها : أن سب الله حق محض لله و ذلك يسقط بالتوبة كالزنا و السرقة و شرب الخمر و سب النبي عليه الصلاة و السلام فيه حقان : لله و للعبد و لا يسقط حق الآدمي بالتوبة كالقتل في المحاربة هذا فرق القاضي أبي يعلى في خلافه
الوجه الثاني : أن النبي عليه الصلاة و السلام تلحقه المعرة بالسب لأنه مخلوق و هو جنس الآدميين الذين تلحقهم المعرة و الغضاضة بالسب و الشتم و كذلك يثابون على سبهم و يعطيهم الله من حسنات الشاتم أو من عنده عوضا على ما أصابهم من المعصية بالشتم فمن سبه فقد انتقص حرمته و الخالق سبحانه لا تلحقه معرة و لا غضاضة بذلك فإنه منزه عن لحوق المنافع و المضار كما قال سبحانه فيما يرويه عنه رسول الله عليه الصلاة و السلام : [ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ]
و إذا كان سب النبي صلى الله عليه و سلم قد يؤثر انتقاصه في النفوس و تلحقه بذلك معرة و ضيم و ربما كان سببا للتنفير عنه و قلة هيبته و سقوط حرمته شرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه بالتوبة كالعقوبة على جميع الجرائم و أما ساب الله سبحانه فإنه يضر نفسه بمنزلة الكافر و المرتد فمتى تاب زال ضرر نفسه فلا يقتل
و هذا الفرق ذكره طوائف من المالكية و الشافعية و الحنبلية منهم القاضي عبد الوهاب بن نصر و القاضي أبو يعلى في : المجرد و أبو علي ابن البناء و ابن عقيل و غيرهم و هو يتوجه مع قولنا : [ إن سب النبي عليه الصلاة و السلام حد الله كالزنا و السرقة ]
يؤيد ذلك أن القذف بالكفر أعظم من القذف بالزنا ثم لم يشرع عليه حد مقدر كما شرع على الرمي بالزنا و ذلك لأن المقذوف بالكفر لا يلحق العار الذي يلحقه بالرمي بالزنا لأنه بما يظهر من الإيمان يعلم كذب القاذف و بما يظهره من التوبة تزول عنه تلك المعرة بخلاف الزنا فإنه يستسر به و لا يمكنه إظهار البراءة منه و لا تزول معرته في عرف الناس عند إظهار التوبة فلذلك ساب الرسول يلحق بالذين و أهله من المعرة ما لا يلحقهم إذا سب الله لكون المنافي لسب الله ظاهرا معلوما لكل أحد يشترك فيه كل الناس
الوجه الثالث : إن النبي عليه الصلاة و السلام إنما يسب على وجه الاستخفاف به و الاستهانة و للنفوس الكافرة و المنافقة إلى ذلك داع : من جهة الحسد على ما آتاه الله من فضله و من جهة المخالفة في دينه و من جهة المراغمة لأمته و كل مفسدة يكون إليها داع فلا بد من شرع العقوبة عليها حدا و كل ما شرعت العقوبة عليه يسقط بالتوبة كسائر الجرائم و أما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في الغالب استخفافا و استهانة و إنما يقع تدينا و اعتقادا و ليس للنفوس في الغالب داع إلى إلقاء السب إلا عن اعتقاد يرونه تعظيما و تمجيدا و إذا كان كذلك لم يحتج خصوص السب إلى شرع زاجر بل هو نوع من الكفر فيقتل الإنسان عليه كردته و كفره إلا أن يتوب
و هذا الوجه من نمط الذي قبله و الفرق بينهما أن ذلك بيان لن مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة بخلاف مفسدة سب الله تعالى و الثاني بيان لأن سب الرسول إليه داع طبعي فيشرع الزجر عليه لخصوصه كشرب الخمر و سب الله تعالى ليس إليه داع طبعي فلا يحتاج خصوصه إلى زجر آخر كشرب البول و أكل الميتة و الدم
و الوجه الرابع : أن سب النبي عليه الصلاة و السلام حد وجب لسب آدمي ميت لم يعلم أنه عفا عنه و ذلك لا يسقط بالتوبة بخلاف سب الله تعالى فإنه قد علم أنه قد عفا عمن سبه إذا تاب و ذلك أن سب الرسول متردد في سقوط حده بالتوبة بين سب الله و سب سائر الآدميين فيجب إلحاقه بأشبه الأصليين به و معلوم أن سب الآدمي إنما لا يسقط عقوبته بالتوبة لأن حقوق الآدميين لا يسقط بالتوبة لأنهم ينتفعون باستيفاء حقوقهم و لا ينتفعون بتوبة التائب فإذا تاب من للآدمي عليه حق قصاص أو قذف فإن له أن يأخذه منه لينتفع به تشفيا و درك ثأر و صيانة عرض و حق الله قد علم سقوطه بالتوبة لأنه سبحانه إنما أوجب الحقوق لينتفع بها العباد فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود الإيجاب و حينئذ فلا ريب أن حرمة الرسول ألحقت بحرمة الله من جهة التغليظ لأن الطعن فيه طعن في دين الله و كتابه و هو من الخلق الذين لا تسقط حقوقهم بالتوبة لأنهم ينتفعون باستفاء الحقوق ممن هي عليه
و قد ذكرنا ما دل على ذلك من أن رسول الله عليه الصلاة و السلام كان له أن يعاقب من آذاه و إن جاءه تائبا و هو عليه الصلاة و السلام كما أنه بلغ الرسالة لينتفع بها العباد فإذا تابوا و رجعوا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصودة فهو أيضا يتألم بأذاهم له فله أن يعاقب من آذاه تحصيلا لمصلحة نفسه كما أنه يأكل و يشرب فإن تمكين البشر من استيفاء حقه ممن بغى عليه من جملة مصالح الإنسان و لو لا ذلك لماتت النفوس غما ثم إليه الخيرة في العفو و الانتقام فقد تترجح عنده مصلحة الانتقام فيكون فاعلا لأمر مباح و حظ جائز كما له أن يتزوج النساء و قد يترجح العفو
و الأنبياء عليهم السلام منهم من كان قد يترجح عنده أحيانا الانتقام و يشدد الله قلوبهم فيه حتى تكون أشد من الصخر كنوح و موسى و منهم من كان يترجح عنده العفو فيلين الله قلوبهم فيه حتى تكون ألين من اللين كإبراهيم و عيسى فإذا تعذر عفوه عن حقه تعين استفاؤه و إلا لزم إهدار حقه بالكلية
قولهم : [ إذا سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أولى ]
قلنا : هو تابع من حيث تغلظت عقوبته لا من حيث إن له حقا في الاستيفاء لا ينجبر بالتوبة
قولهم : [ ساب الواحد من الناس لا يختلف حاله بين ما قبل الإسلام و بعده و بخلاف ساب الرسول ]
عنه جوابان :
أحدهما المنع فإن سب الذمي للمسلم جائز عنده لأنه يعتقد كفره و ضلاله و إنما يحرمه عنده العهد الذي بيننا و بينه فلا فرق بينهما و إن فرض الكلام في سب خارج عن الدين مثل الرمي بالزنا و الافتراء عليه و نحو ذلك فلا فرق ذلك بين سب الرسول و سب الواحد من أهل الذمة و لا ريب أن الكافر إذا أسلم صار أخا للمسلم يؤذيه ما يؤذيهم و صار معتقدا لحرمة أعراضهم و زال المبيح لانتهاك أعراضهم و مع ذلك لا يسقط حق المشتوم بإسلامه و قد تقدم هذا الوجه غير مرة
الثاني : أن شاتم الواحد من الناس لو تاب و أظهر براءة المشتوم و أثنى عليه و دعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفى حده مع ذلك فلا فرق بينه و بين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته و علو منزلته و سبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من الغضاضة و المعرة بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة و تبقى آثار السب الأول جارحة فإن لم يمكن المشتوم من أخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه
قولهم : [ القتل حق الرسالة و أما البشرية فإنما لها حقوق البشرية و التوبة تقطع حق الرسالة ]
قلنا : لا نسلم ذلك بل هو من حيث هو بشر مفصل في بشريته على الآدميين تفضيلا يوجب قتل سابه و لو كان القتل إنما وجب لكونه قدحا في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر و لم يكن خصوص السب موجبا للقتل و قد قدمنا من الأدلة ما يدل على أن خصوص السب موجب للقتل و انه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفر و من سوى بين الساب و بين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب و السنة الظاهرة و الإجماع الماضي و خالف المعقول و سوى بين الشيئين المتباينين كون القاذف له لم يجب عليه مع القتل جلد ثمانين أوضح دليل على أن القتل عقوبة لخصوص السب و إلا كان قد اجتمع حقان : حق لله ـ و هو تكذيب رسوله فيوجب القتل ـ و حق لرسوله ـ و هو سبه فيوجب الجلد على هذا الرأي ـ فكان ينبغي قبل التوبة على هذا أن يجتمع عليه الحدان كما لو ارتد و قذف مسلما و بعد التوبة يستوفي منه حد القذف فكان إنما للنبي عليه الصلاة و السلام أن يعاقب من سبه و جاء تائبا بالجلد فقط كما أنه ليس لإمام أن يعاقب قاطع الطريق إذا جاء تائبا إلا بالقود و نحوه مما هو خالص حق الآدمي و لو سلمنا أن القتل حق الرسالة فقط فهو ردة مغلظة بما فيه ضرر أو نقض مغلظ بما فيه ضرر كما لو اقترن بالنقض حراب و فساد بالفعل من قطع طريق و زنا بمسلمة و غير ذلك فإن القتل هنا حق لله و مع هذا لم يسقط بالتوبة و الإسلام و هذا المأخذ متحقق سواء قلنا إن ساب الله يقتل بعد التوبة أو لا يقتل كما تقدم تقريره
قولهم : [ إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة ]
قلنا : هذا ممنوع أما إذا سوينا بينه و بين سب الله فظاهر و إن فرقنا فإن هذا شبه من باب فعل المحارب لله و رسوله الساعي في الأرض فسادا و الحاجة داعية إلى ردع أمثاله كما تقدم و إن سلمنا سقوط الحق المتعلق بالكفر بالرسالة لكن لم يسقط الحق المتعلق بشتم الرسول و سبه فإن هذه جناية زائدة على نفس الرسول مع إلتزام تركها فإن الذمي يلتزم لنا أن لا يظهر السب و ليس ملتزما لنا أن لا يكفر به فكيف يجعل ما التزم تركه من جنس ما أقررناه عليه ؟ و جماع الأمر أن هذه الجناية على الرسالة له نقض يتضمن حرابا و فسادا أو ردة تضمنت فسادا و حرابا و سقوط القتل عن مثل هذا ممنوع كما تقدم
قولهم : [ حق البشرية انغمر في حق الرسالة و حق الأدمي انغمر في حق الله ]
قلنا : هذه دعوى محضة و لو كان كذلك لما جاز للنبي عليه الصلاة و السلام العفو عمن سبه و لا جاز عقوبته بعد مجيئه تائبا و لا احتيج خصوص السب أن يفرد بذكر العقوبة لعلم كل أحد أن سب الرسول أغلظ من الكفر به فلما جاءت الأحاديث و الآثار في خصوص سب الرسول بالقتل علم أن ذلك لخاصة في السب و إن اندرج في عموم الكفر
و أيضا فحق العبد لا ينغمر في حق الله قط نعم العكس موجود كما تندرج عقوبة القاتل و القاذف على عصيانه في القود و حد القذف و أما أن يندرج حق العبد في حق الله فباطل فإن من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان لله و لآدمي ثم سقط حق الله لم يسقط حق الآدمي سواء كان من جنس أو جنسين كما لو جنى جنايات متفرقة كمن قتل في قطع الطريق فإنه إذا سقط عنه تحتم القتل لم يسقط عنه القتل و لو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغرم بإجماع المسلمين حتى عند من قال : [ إن القطع و الغرم لا يجتمعان نعم إذا جنى جناية واحدة فيها حقان لله و لآدمي : فإن كان موجب الحقين من جنس واحد تداخلا و إن كانا من جنسين ففي التداخل خلاف معروف مثال الأول قتل المحارب فإنه يوجب القتل حقا لله و للآدمي و القتل لا يتعدد فمتى قتل لم يبق للآدمي حق في تركته من الدية و إن كان له أن يأخذ الدية إذا قتل عدة مقتولين فيقتل بعضهم عند الشافعي و أحمد و غيرهما
أما إن قلنا : [ إن موجب العمد القود عينا ] فظاهر و إن قلنا : [ إن موجبه أحد شيئين ] فإنما ذاك حيث يمكن العفو و هنا لا يمكن العفو و صار موجبه القود عينا و ولي استيفائه الإمام لأن ولايته أعم و مثال الثاني : أخذ المال سرقة و إتلافه فإنه موجب للقطع حدا لله و موجب للغرم حقا لآدمي و لهذا قال الكوفيون : [ إن حق الآدمي يدخل في القطع فلا يجب ] و قال الأكثرون : [ بل يغرم للآدمي ماله و إن قطعت يده ]
و إما إذا جنى جنايات متفرقة لكل جناية حد فإن كانت لله و هي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق و إن كانت من أجناس و فيها القتل تداخلت عند الجمهور و لم تتداخل عند الشافعي و إن كانت لآدمي لم تتداخل عند الجمهور و عند مالك تتداخل في القتل إلا حد القذف فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب أنه يتعلق بسبه حق لآدمي و نحن نقول : [ إن موجب كل منهما القتل ] و من ينازعنا إما أن يقول : [ اندرج حق الآدمي في حق الله أو موجبه الجلد ] فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقول : إن موجبه الجلد فإنه يجب أن يخرج على الخلاف و أما إذا أسقط حق الله بالتوبة فكيف يسقط حق العبد ؟ فإنا لا نحفظ لهذا نظيرا بل النظائر تخالفه كما ذكرناه و السنة تدل على خلافه و إثبات حكم بلا أصل و لا نظير غير جائز بل مخالفته للآصول دليل على بطلانه
و أيضا فهب أن هذا حد محض لله لكن لم يقال : [ أنه يسقط بالتوبة ] ؟ و قد قدمنا أن الردة و نقض العهد نوعان : مجرد و مغلظ فما تغلظ منه بما يضر المسلمين يجب قتل صاحبه بكل حال و إن تاب و بينا أن السب من هذا النوع
و أيضا فأقصى ما يقال أن يلحق هذا السب بسب الله و فيه من الخلاف ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى
و أما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم و سب الكافر فهو ـ و إن كان له توجه كما للتسوية بينهما في سقوط توجه أيضا ـ فإنه معارض بما يدل على أن الكافر أولى بالقتل بكل حال من المسلم و كذلك أن الكافر قد ثبت المبيح لدمه و هو الكفر و إنما عصمه العهد و إظهاره السب لا ريب أنه محاربة لله و رسوله و إفساد في الأرض و نكاية في المسلمين فقد تحقق الفساد من جهته و إظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثق بها كتوبة غيره من المحاربين لله و رسوله الساعين في الأرض فسادا بخلاف من علم منه الإسلام و صدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن اعتقاد بل خرجت سفها أو غلظا فإذا عاد إلى الإسلام ـ مع أنه لم يزل يتدين به لم يعلم منه خلافه ـ كان أولى لقبول توبته لأن ذنبه أصغر و توبته أقرب إلى الصحة
ثم إنه يجاب عنه بأن إظهار المسلم تجديد الإسلام بمنزلة إظهار الذمي الإسلام لأن الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما أظهره من الأمان كما يزع المسلم ما أظهره من عقد الإيمان فإذا كان المسلم الآن إنما يظهر عقد إيمان قد ظهر ما يدل على فساده فكلك الذمي إنما يظهر عقد إيمان قد ظهر ما يدل على فساده فإن من يتهم في أمانه يتهم في إيمانه و يكون منافقا في الإيمان كما كان منافقا في الأمان بل ربما كان حال هذا الذي تاب بعد معاينة السيف أشد على المسلمين من حاله قبل التوبة فإنه كان في ذلة الكفر و الآن فإنه قد يشرك المسلمين في ظاهر العز مع ما ظهر من نفاقه و خبثه الذي لم يظهر ما يدل على زواله على أن في تعليل سبه بالزندقة نظرا فإن السب أمر ظاهر أظهره و لم يظهر منه ما يدل على استبطانه إياه قبل ذلك و من الجائز أن يكون قد حدث له ما أوجب الردة
نعم إن كان ممن تكرر ذلك منه أو له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة ظاهرة لكن يقال نحن نقتله للأمرين لكونه زنديقا و لكونه سابا كما نقتل الذمي لكونه كافرا غير ذي عهد و لكونه سابا فإن الفرق بين المسلم و الذمي في الزندقة لا يمنع اجتماعهما في علة أخرى تقتضي كون السب موجبا للقتل و إن أحدث الساب اعتقادا صحيحا بعد ذلك بل قد يقال : إن السب إذا كان موجبا للقتل قتل صاحبه و إن كان صحيح الاعتقاد في الباطن في حال سبه كسبه لله تعالى و كالقذف في إيجايه للجلد و كسب جميع البشر
و أما الفرق الثاني الذي مبناه على أن السب يوجب قتل المسلم حدا لأن مفسدته لا تزول بسقوطه تجديد الإسلام بخلاف سب الكافر فمضمونه أنا ترخص لأهل الذمة في إظهار السب إذا أظهروا بعده الإسلام و نأذن لهم أنم يشتموا ثم بعد ذلك يسلمون و ما هذا إلا بمثابة أن يقال : علم الذمي بأنه إذا زنى بمسلمة أو قطع الطريق أخذ فقتل إلا أن يسلم يزعه عن هذه المفاسد إلا أن يكون ممن يريد الإسلام و إذا أسلم فالإسلام يجب ما كان قبله و معلوم أن معنى هذا أن الذمي يحتمل منه ما يقوله و يفعله من أنواع المحاربة و الفساد إذ قصد أن يسلم و معلوم من أن هذا غير جائز
فإن الكلمة الواحدة من سب النبي صلى الله عليه و سلم لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفار و لأن يظهر دين الله ظهورا يمنع أحدا أن ينطق فيه بطعن أحب إلى الله و رسوله أن يدخل فيه أقوام و هو منتهك مستهان
و كثير ممن يسب الأنبياء من أهل الذمة قد يكون زنديقا لا يبالي إلى أي دين انتسب فلا يبالي أن ينال غرضه من السب ثم يظهر الإسلام كالمنافق سواء ثم هذا يوجب الطمع منهم في عرضه فإنه ما دام العدو يرجو أن يستبقى و لو بوجه لم يزعه ذلك عن إظهار مقصودة في وقت ما ثم إن ثبت ذلك عليه و رفع إلى السلطان و آمر بقتله أظهر الإسلام و إلا فقد حصل غرضه و كل فساد قصد إزالته بالكلية لم يجعل لفاعله سبيل إلى استبقائه بعد الأخذ كالزنا و السرقة و قطع الطريق فإن كان مقصود الشارع من تطهير الدار من ظهور كلمة الكفر و الطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجوه هذه القبائح ابتغى أن يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك أبلغ من تحتم عقوبة هؤلاء
و فقه هذا الجواب أن تعلم أن ظهور الطعن في الدين من سب الرسول و نحوه فساد عريض وراء مجرد الكفر فلا يكون حصول الإسلام ماحيا لذلك الفساد
و اما الفرق الثالث قولهم : [ إن الكافر لم يلتزم تحريم السب ] فباطل فإنه لا فرق بين إظهار لسب النبي صلى الله عليه و سلم و بين إظهاره لسب آحاد من المسلمين و بين سفك دمائهم و أخذ أموالهم فإنه لولا العهد لم يكن فرق عنده بيننا و بين سائر من يخالفه في دينه من المحاربين و معلوم انه يستحل ذلك كله منهم ثم إنه بالعهد صار ذلك محرما عليه في دينه منا لأجل العهد فإذا فعل شيئا من ذلك أقيم عليه حده و إن أسلم سواء انتقض عهده بما يفعله أو لم ينتقض فتارة يجب عليه الحد مع بقاءه العهد كما لو سرق أو قذف مسلما و تارة ينتقض عهده و لا حد عليه فيصير بمنزلة المحاربين و تارة يجب عليه الحد و ينتقض عهده كما إذا سب الرسول أو زنى بمسلمة أو قطع الطريق على المسلمين فهذا يقتل و إن أسلم و عقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتما كعقوبة القاتل في المحاربة من المسلمين جزاء له على ما فعل من فساد الذي التزم بعقد الإيمان أن لا يفعله مع كونه مثل ذلك الفساد موجبا للقتل و نكالا لأمثاله عن فعل مثل هذا إذا علموا أنه لا يترك صاحبه حتى يقتل فهذا هو الجواب عما ذكر من الحجج للمخالف مع أن فيما تقدم من كلامنا ما يغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ و الله سبحانه و تعالى أعلم
و ذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم فنقول :
لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله من تحتم القتل و الصلب و النفي و قطع الرجل و كذلك قطع اليد عند عامة العلماء إلا في وجه لأصحاب الشافعي و قد نص الله على ذلك بقوله : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } [ المائدة : 34 ] و معنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالنية او بالإقرار و كونهم في قبضة المسلمين فإذا تابوا قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم
و أما من لم يوجد منه إلا مجرد الردة و قد أظهرها فذلك أيضا تقبل توبته عند العامة إلا ما يروى عن الحسن و من قيل إنه وافقه
و أما القاتل و القاذف فلا أعلم مخالفا أن توبتهم لا تسقط عنهم حق الآدمي بمعنى أنه إذا طلب بالقود وحد القذف فله ذلك و إن كانوا قد تابوا قبل ذلك
و أما الزاني و السارق و الشارب فقد أطلق بعض أصحابنا إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد ؟ على روايتين :
أصحهما : أنه يسقط عنه بمجرد التوبة و لا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل
و الثانية لا يسقط و يكون من توبته تطهيره بالحد
و قيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام و ليس بين الكلامين خلاف في المعنى فإنه لا خلاف أنه لا يسقط حد المحارب بتوبته و إن اختلفت عباراتهم : هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإقضاء سقوط الحد إلى المفسدة ؟
فقال القاضي أبو يعلى و غيره و هو ممن أطلق الروايتين : التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عليه لجواز أن يكون أظهرها تقية من الإمام و الخوف من عقوبته قال : و لهذا نقول في توبة الزاني و السارق و الشارب : لا يحكم بصحتها بعد علم الإمام بحدهم و ثبوته عنده و إنما يحكم بصحتها قبل ذلك قال : و قد ذكره أبو بكر في الشافي فقال : إذا تاب ـ يعني الزاني ـ بعد أن قدر عليه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلد و إذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته
فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقط للحد في كل موضع فلم يحتج إلى التقييد هو و من سلك طريقته من أصحابه مثل الشريف أبي جعفر و أبي الخطاب و مأخذ أبي بكر و غيره الفرق بين ما قبل القدرة و بعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة و يكون الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا فلا فرق في الحكم بين القولين و التقيد بذلك موجود في كلام الإمام أحمد نقل عنه أبو الحارث في سارق جاء تائبا و معه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه قال : لم يقطع و قال : قال الشعبي : ليس على تائب قطع و كذلك نقل حنبل ـ و مهنا : في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبا : [ يدرأ عنه القطع ] و نقل عنه الميموني في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد : إنه تقبل توبته فلا يقام عليه الحد و ذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ فهلا تركتموه ]
قال الميموني : و ناظرته في مجلس آخر قال : إذا رجع عما أقر به لم يرجم قلت : فإن تاب قال : من توبته أن يطهر بالرجم قال : و دار بيني و بينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه و إن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد قال القاضي : و المذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث و حنبل و مهنا
فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد و أما إن تاب قبل أن يقدر عليه ـ بأن يتوب قبل أخذه و بعد إقراره الذي له أن يرجع عنه ـ ففيه روايتان و قد صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد قال : فأما الزنا فإنه لا خلاف أنه فيما بينه و بين الله تصح توبته منه
فأما إذا تاب الزاني و قد رفع إلى الإمام فقول واحد : لا يسقط الحد فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان و إن كان ذلك بينة فقول واحد : لا يسقط لأنه إذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة و الإقرار بخلاف البينة لأنه إذا رجع عن إقراره قبل منه
و قال في السرقة : لا خلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع أو بعده و إنما الخلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد فإن كان ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع و أما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه لأنه حق يتعلق بالإمام فلا يجوز تركه
قال : و كذلك المحارب إذا تاب من حق الله و قد قدمنا أنا إذا قلنا يسقط الحد عن غير قطاع الطريق بالتوبة فإنه يكفي مجرد التوبة و هذا هو المشهور من المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق
و فيه وجه ثان : لابد من إصلاح العمل مع التوبة و على هذا فقد قيل : يعتبر مضي مدة يعتبر بها صدق توبته و صلاح نيته و ليست مقدرة بمدة معلومة لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف و يتحرج أن يعتبر مضي سنة كما نص عليه الإمام أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يتعين فيه مضي سنة اتباعا لما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية صبيغ بن عسل فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة و أمر المسلمين بهجره فلما حال الحول و لم يظهر منه إلا خير أمر المسلمين بكلامه و هذه قضية مشهورة بين الصحابة و هذه طريقة أكثر أصحابنا
و ظاهر طريقة أبي بكر أنه يفرق بين التوبة قبل أن يقر ـ بأن يجيء تائبا ـ و بين أن يقر ثم يتوب لأن أحمد رضي الله عنه إنما أسقط الحد عمن جاء تائبا فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول بسقوط الحد
و للشافعي أيضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان أصحهما أنه يسقط لكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل القدرة و حد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الإصلاح في زمن يوثق بتوبته و قيل : مدة ذلك سنة
هكذا ذكر العراقيون من أصحابه و ذكر بعض الخراسانيين أن في توبة المحارب و غيره بعد الظفر قولين إذا اقترن بها الإصلاح و استشكلوا ذلك فيما إذا أنشأ التوبة حيث أخذ لإقامة الحد فإنه لا يؤخر حتى يصلح العمل
و مذهب أبي حنيفة و مالك أنه لا يسقط بالتوبة و ذكر بعضهم أن ذلك إجماع و إنما هو إجماع في التوبة بعد ثبوت الحد
إذا تلخص ذلك فمن سب الرسول صلى الله عليه و سلم و رفع إلى السلطان و ثبت ذلك عليه بالبينة ثم أظهر التوبة لم يسقط عنه الحد عند من يقول [ إنه يقتل حدا ] سواء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة لأن هذه توبة بعد أخذه و القدرة عليه فهو كما لو تاب قاطع الطريق و الزاني و السارق في هذه الحال و كذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان و البينة بذلك ممكنة و هذا لا ريب فيه و الذمي في ذلك كالملي إذا قيل [ إنه يقتل حدا ] كما قررناه
و أما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منع فمذهب المالكية أنه يقتل أيضا لأنه حد من الحدود لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة و لا بعدها و لهم في الزنديق إذا جاء تائبا قولان لكن قال القاضي عياض : [ مسألته أقوى لا يتصور فيها الخلاف لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه و سلم و لأمته بسببه لا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين ] و كذلك يقول من يرى أنه يقتله حدا كما يقوله الجمهور و يرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولي الشافعي و إحدى الروايتين عن أحمد و أما على المشهور في المذهبين ـ من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد ـ فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله فأما حدود الآدميين من القود و حد القذف فلا تسقط بالتوبة
فعلى هذا لا يسقط القتل عنه و إن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة لأنه حق آدمي ميت فأشبه القود و حد القذف و هذا قول القاضي أبي يعلى و غيره و هو مبني على أن قتله حق لآدمي و أنه لم يعف عنه و لا يسقط إلا بالعفو و هو قول من يفرق بين من سب الله و من سب رسوله
و أما من سوى بين من سب الله و من سب رسوله و قال : [ إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة ] فإنه يسقط القتل هنا لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه و هذا موجب قول من قال : [ إن توبته تنفعه فيما بينه و بين الله و يسقط عنه حق الرسول في الآخرة ] و به صرح غير واحد من أصحابنا و غيرهم لأن التوبة المسقطة لحق الله و حق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه و ذك أن هذا الحد ليس له عاف عنه فإن لم تكن التوبة مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة و لا عفو و ليس لهذا نظير نعم لو كان الرسول صلى الله عليه و سلم حيا لتوجه أن يقال : لا يسقط الحد إلا عفوه بكل حال
و أما إن أخذ وثبت السب بإقراره ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الإقرار : فإذا لم يقبل رجوعه أقيم عليه الحد بلا تردد و إن قبل رجوعه و أسقط الحد عمن جاء تائبا ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان و إن أقيم الحد على من جاء تائبا فعلى هذا أولى و القول في الذمي إذا جاء مسلما معترفا أو أسلم بعد إقراره كذلك
فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه و تعالى
و قد حان أن نذكر المسألة الرابعة فنقول :
و قبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة و قد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى و ذكرها هنا مناسب أيضا لينكشف سر المسألة
و ذلك أن نقول : إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا و باطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول و عمل
و قد قام الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية ـ و هو أحد الأئمة يعدل بالشافعي و أحمد ـ : [ و قد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول الله عليه الصلاة و السلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافرا بذلك و إن كان مقرا بما أنزل الله ]
و كذلك قال محمد بن سحنون ـ و هو أحد الأئمة من أصحاب مالك و زمنه قريب من هذه الطبقة ـ : [ أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة و السلام المنتقض له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر ]
و قد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا و كذا ـ أعنى أنت و من خلقك ـ : هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه و قال في رواية عبد الله و أبي طالب : [ من شتم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و ذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام و لا يشتم مسلم النبي عليه الصلاة و السلام ] فبين أن هذا مرتد و أن المسلم لا يتصور أن يشتم و هو مسلم
و كذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال : هو كافر و استدل بقول الله تعالى : { قل : أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } [ التوبة : 66 ]
و كذلك قال أصحابنا و غيرها : من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية و هذا هو الصواب المقطوع به
و قال القاضي أبو يعلى في المعتمد : من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن قال : [ و لم أستحل ذلك ] لم يقبل منه ظاهر الحكم رواية واحدة و كان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر لأنه لا غرض له في سب الله و سب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة و السلام و يفارق الشارب و القاتل و السارق إذا قال : [ أنا غير مستحل لذلك ] أنه يصدق في الحكم لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاده تحريمها و هو ما يتعجل من اللذة قال : و إذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر من الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم قلنا في الزنديق : [ لا تقبل توبته في الظاهر الحكم ]
و ذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي عليه الصلاة و السلام إن كان مستحلا كفر و لم يكن مستحلا فسق و لم يكفر كساب الصحابة و هذا نظير ما يحكى أنه بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب النبي عليه الصلاة و السلام أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك و هو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به
و قد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد و حمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به أو أن الفتوى كانت في كلمة اختلف في كونها سبا أو كانت فيمن تاب و ذكر أن الساب إذا أقر بالسب و لم يتب منه قتل كفرا لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب و نحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بها و ترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك و هو كفر أيضا قال : فهذا كافر بلا خلاف و قال في موضع آخر : [ إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة و إنما يوجب القتل فيه حدا و إنما نقول ذلك مع انكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه و التوبة و نقتله حدا كالزنديق إذا تاب ] قال : [ و نحن و إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد و إنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا و معصية و أنه مقلع عن ذلك نادم عليه ] قال و أما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك و كذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره و نحوه فهذا ما لا إشكال فيه و كذلك من لم يظهر التوبة و اعتراف بما شهد به و صمم عليه فهو كافر بقوله و استحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه و هذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا
و هذا موضع لابد من تحريره و يجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة و هفوة عظيمة و يرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا و إنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين ـ و هم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب و إن لم يقترن به قول اللسان و لم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح ـ و صرح القاضي أبو يعلى هنا قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه : [ و على هذا لو قال الكافر : أنا معتقد بقلبي معرفة الله و توحيده لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرها من العبادات كسلا ] لم يحكم بإسلامه في الظاهر و يحكم به باطنا قال : و قول الإمام أحمد [ من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي ] محمول على أحد وجهين أحدهما : أنه جهمي في ظاهر الحكم و الثاني : على أن يمتنع من الشهادتين عنادا لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه و لم يكن مؤمنا
و معلوم أن إبليس اعتقد أن لا يلزم امتثال أمره تعالى [ بالسجود ] لآدم و قد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة و بقلبه و أن الإيمان قول و عمل كما هو مذهب الأئمة كلهم : مالك و سفيان و الأوزاعي و الليث و الشافعي و أحمد و إسحاق و من قبلهم و بعدهم من أعيان الأمة
و ليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل و إنما الغرض البينة على ما يختص هذه المسألة و ذلك من وجوه :
أحدها : أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه كان مستحلا كفر و إلا فلا ليس لها أصل و إنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء هؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا و قد حكينا نصوص أئمة الفقهاء و حكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف و الاجتهاد و إنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة
الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر و لا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي و بين قذف المؤمنين و الكذب عليه و الغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلما أو اغتابه كفر و يعني بذلك إذا استحله
الوجه الثالث : أن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن فإذا لا أثر للسب في التكفير وجودا و عدما و إنما المؤثر هو الاعتقاد و هو خلاف ما أجمع عليه العلماء
الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل فيجب أن لا يكفر لا سيما إذا قال [ أنا أعتقد أن هذا حرام و إنما أقول غيظا و سفها أو عبثا أو لعبا ] كما قال المنافقون : { إنما كنا نخوض و نلعب } [ التوبة : 65 ]
و كما إذا قال : إنما قذفت هذا و كذبت عليه لعبا و عبثا فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن و إن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا و قول القائل : أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال : [ أنا أعتقد أن ذلك ذنب و معصية و أنا أفعله ] فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ؟ و لهذا قال سبحانه و تعالى : { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } [ التوبة : 66 ] و لم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض و نلعب فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض و اللعب
و إذا تبين أن مذهب سلف الأمة و من اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى : { و منهم الذين يؤذون النبي } [ التوبة : 61 ] و قوله تعالى : { إن الذين يؤذون الله و رسوله } [ الأحزاب : 57 ] و قوله تعالى { لا تعتذروا قد كفرتهم بعد إيمانكم }
و ما ذكرناه من الأحاديث و الأثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله و رسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا و عدما : فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر و أنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره و قتله حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء
و منشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين و من حذا حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به و رأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب و الشتم بالذات كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله و يفعل ما يعتقد وجوب تركه ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب فقالوا : إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام و اعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة و إنما الإهانة دليل على التكذيب فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا و إن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره فهذا مأخذ المرجئة و معتضديهم و هم الذين يقولون : [ الإيمان هو الاعتقاد و القول ] و غلاتهم و هم الكرامية الذين يقولون : [ مجرد القول و إن عري عن الاعتقاد ] و أما الجهمية الذين يقولون : [ هو مجرد المعرفة و التصديق بالقلب فقط و إن لم يتكلم بلسانه ] فلهم مأخذ آخر و هو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه فإذا كان في قلبه التعظيم و التوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن
و جواب الشبهة الأولى من وجوه :
أحدها : أن الإيمان و إن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد أن يوجب حالا في القلب و عملا له و هو تعظيم الرسول و إجلاله و محبته و ذلك أمر لازم كالتألم و التنعم عند الإحساس بالمؤلم و المنعم و كالنفرة و الشهوة عند الشعور بالملائم و المنافي فإذا لم تحصل هذه الحال و العمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق و لم يغن شيئا و إنما يمتنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول و التكبير عليه أو الإهمال له و إعراض القلب عنه و نحو ذلك كما أن إدراك الملائم و المنافي يوجب اللذة و الألم إلا أن يعارضهم عارض و متى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب و بتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب و هذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق الإلف و العادة مع علمه بأنهم صادقون و كفرهم أغلظ من كفر الجهال
الثاني : أن الإيمان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق و إنما هو الإقرار و الطمأنينة و ذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر و كلام الله خبر و أمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر و الأمر يستوجب الانقياد و الاستسلام و هو عمل في القلب جماعه الخضوع و الانقياد للأمر و إن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق و الأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب و هو الطمأنينة و الإقرار فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار و الطمأنينة و ذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق و الانقياد و إذا كان كذلك فالسب إهانة و استخفاف و الانقياد للأمر إكرام و إعزاز و محال أن يهين القلب من قد انقاد له و خضع و استسلم أو يستخف به
فإذا حصل في القلب استخفاف و استهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه إيمان و هذا هو بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولا و لكن لم ينقد للأمر و لم يخضع له و استكبر عن الطاعة فصار كافرا و هذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف : تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس و فرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب و كفره من أغلظ الكفر فيتحيرون و لو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعملوا أن الإيمان قول و عمل أعني في الأصل قولا في القلب و عملا في القلب
فإن الإيمان بحسب كلام الله و رسالته و كلام الله و رسالته يتضمن إخباره و أوامره فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به و التصديق هو من نوع العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الإنقياد و الاستسلام هو من نوع الإرادة و العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين و إن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا و جهلا و يكون استكبارا و ظلما و لهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار دون التكذيب و لهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان كفر من يجهل مثل النصارى و نحوهم ضلالا و هو الجهل
ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا : نشهد أنك نبي و لم يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا التصديق ؟
ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا فإنه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ أشهد أن لا إله إلا الله ] فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقياد لأمره [ و أشهد أن محمدا رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار
فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين ـ و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ـ ظن من ظن أن أصل لجميع الإيمان و غفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و إلا فقد يصدق الرسول ظاهرا و باطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه و تعالى كإبليس و هذا مما بين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره
فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه و كلاهما كفر صريح و من استخلف به و استهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره فإن الانقياد إجلال و إكرام و الاستخفاف إهانة و إذلال و هذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف و الاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد
الوجه الثالث : أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه و اعتقاد انقياد لله فيما حرمه و أوجبه فهذا ليس بكافر فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم و أبى أن يذعن لله و ينقاد فهو إما جاحد أو معاند و لهذا قالوا : من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق و من عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة و الجماعة و إنما يكفره الخوارج فإن العاصي المستكبر و إن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له و محادته تنافي هذا التصديق
و بيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه و كذلك لو استحلها من غير فعل و الاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها و تارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية و لخلل في الإيمان بالرسالة و يكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة و تارة يعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم و يعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله و قد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبة الله و عذبه
ثم إن هذا الامتناع و الإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر و قدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته و قد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس و حقيقة كفر هذا لأنه يعترف لله و رسوله بكل ما أخبر به و يصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك و يبغضه و يسخطه لعدم موافقته لمراده و مشتهاه و يقول : أنا لا أقر بذلك و لا ألتزمه و أبغض هذا الحق و أنفر عنه فهذا نوع من غير النوع الأول و تكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام و القرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد و في مثله قيل : [ أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ] ـ و هو إبليس و من سلك سبيله ـ و بهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه و يحب أنه يفعله لكن الشهوة و النفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيمان بالتصديق و الخضوع و الانقياد و ذلك قول و قول لكن لم يكمل العمل
و أما إهانة الرجل من يعتقد و وجوب كرامته كالوالدين و نحوهما فلأنه لم يهن من كان الانقياد له و الإكرام شرطا في إيمانه و إنما أهان من إكرامه شرط في بره و طاعته و تقواه و جانب الله و الرسول إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع و الانقياد فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إيمانا بل كان وجوده شرا من عدمه فإن من خلق له حياة و إدراك و لم يرزق إلا بالعذاب كان فقد تلك الحياة و الإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الألم و إذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله و حصول النعم له و اللذة في الدنيا و الآخرة فلم يحصل معه إلا فساد حاله و البؤس و الألم في الدنيا و الآخرة كان أن لا يوجد أحب إليه من أن يوجد
و هنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمور و من حكم الكتاب و السنة على نفسه قولا و فعلا و نور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه فيه سعادة النفوس بعد الموت و شقاوتها جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب و بما أرسل الله به و رسله و نبذوا الكتاب وراء ظهورهم و اتباعا لما تتلوه الشياطين
و أما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن من تكلم بالتكذيب و الجحد و سائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا و من جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
الثاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة و أن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان حتى اختلفوا في تكفير من قال : [ إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح ] و ليس هذا موضع تقرير هذا
و ما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو و غيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك مادل عليه كلام القاضي عياض فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين و من بعدهم ـ إلا من ينسب إلى بدعة ـ قالوا : الإ يمان قول وعمل وبسط هذا له مكان غير هذا
الثالث : أن من قال [ إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان ] يقول : لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله فإن القول قولان : قول يوافق تلك المعرفة و قول يخالفها فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر [ فإنه يكفر بذلك ظاهرا و باطنا و لأنا لا نجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا و من قال ذلك فقد مرق من الإسلام قال سبحانه : { من كفر بالله من بعد إيمانه ـ إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا ـ فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم } [ النحل : 106 ]
و معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه و هو قد استثنى من أكره و لم يرد من قال و اعتقد لأنه استثنى المكره و هو لا يكره على العقد و القول و إنما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله و له عذاب عظيم و أنه كافر بذلك إلا من أكره و هو مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أمره فقال بلسانه كلمة الكفر و قلبه مطمئن بالإيمان و قال تعالى في حق المستهزئين : { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } [ التوبة : 66 ]
فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته و هذا باب واسع و الفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم و إرادة فعل فيه استهانة و استخفاف كما أنه يوجب المحبة و التعظيم و اقتضاؤه وجود هذا و عدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته كاقتضاء إدراك الموافق للذة و إدراك المخالف للألم فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة و إذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر فالكلام و الفعل المتضمن للاستخلاف و الاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع و لعدم الانقياد و الاستسلام فلذلك كان كفرا
و اعلم أن الإيمان و إن قيل هو التصديق فالقلب يصدق يالحق و القول يصدق في القلب و العمل يصدق القول و التكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب و رافع للتصديق الذي كان في القلب و التكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب و رافع للتصديق الذي كان في القلب إذ أعمال الجوارح يؤثر في القلب كما أن أعمال القلب يؤثر في الجوارح فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر و الكلام في هذا واسع و إنما نبهنا على هذه المقدمة
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول :
قد ثبت أن كل سب و شتم يبيح الدم فهو كفر و إن لم يكن كل كفر سبا و نحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة :
قال الإمام أحمد : [ كل من شتم النبي عليه الصلاة و السلام أو تنقصه ـ مسلما كان أو كافرا ـ فعليه القتل و رأى أن يقتل و لا يستتاب ]
و قال في موضع آخر : [ كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه و تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا و هذا مذهب أهل المدينة ]
و قال أصحابنا : التعريض بسب الله و سب رسوله صلى الله عليه و سلم ردة و هو موجب للقتل كالتصريح و لا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم من جملة سبه الموجب للقتل و أغلظ لأن ذلك يقضي إلى القدح في نسبه و في عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي عليه الصلاة و السلام يقتل مسلما كان أو كافرا و ينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه و سلم
و قال القاضي عياض : [ جميع من سب النبي صلى الله عليه و سلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له و الإزراء عليه أو البغض منه و العيب له فهو سابله و الحكم فيه حكم الساب : يقتل و لا تستثن فضلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد و لا تمتر فيه تصريحا كان أو تلويحا و كذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب لإليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام و هجر و منكر منن القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء و المحنة عليه أو غمضه ببعض العوارض البشرية الجائزة و المعهود لديه ] قال : [ و هذا كله إجماع من العلماء و أئمة الفتوى من لدن أصحابه و هلم جرا ]
وقال ابن القاسم عن مالك : من سب النبي صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب قال ابن القاسم : أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق و قد فرض الله توقيره
و كذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه : [ من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا و لا يستتاب ]
و روى ابن وهب عن مالك أنه قال [ من قال إن رداء النبي صلى الله عليه و سلم ـ و روي برده ـ [ وسخ ] و أراد عيبه قتل ]
و روى بعض المالكية [ إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة ]
و ذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية بعضهم :
منها : رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه و سلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه و اللحية فقال : تريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار في خلقه و لحيته ]
و منها : رجل قال : [ النبي صلى الله عليه و سلم أسود ]
و منها : رجل قيل له : [ لا و حق رسول الله ] فقال : فعل الله برسول الله كذا و كذا ثم قيل له : ما تقول يا عدو الله فقال أشد من كلامه الأول ثم قال : إنما أردت برسول الله العقرب قالوا : لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان و هو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا موقر له فوجبت إباحة دمه
و منها عشار قال : أدوا شك [ ؟ ] إلى النبي أو قال : إن سألت أوجهلت فقد سأل النبي و جهل
و منها : متفقة كان يستخف بالنبي صلى الله عليه و سلم و يسميه في أثناء مناظرته [ اليتيم و ختن حيدرة ] و يزعم أنه زهده لم يكن قصدا و لو قدر على الطيبات لأكلها و أشباه هذا
قال : فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا و تنقصا يجب قتل قائله و لم يختلف في ذلك متقدمهم و متأخرهم و إن اختلفوا في سبب حكم قتله
و كذلك قال أبو حنيفة و أصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه : [ إنه مرتد ] و كذلك قال أصحاب الشافعي : [ كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه و سلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي كفر و هل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة ؟ على الوجهين و قد نص الشافعي على هذا المعنى
فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح للدم و هم في استتابته على ما تقدم من الخلاف و لا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل و يمزح أو يفعل غير ذلك
فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب و من قال ما هو سب و تنقص له فقد آذى الله و رسوله و هو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى و إن لم يقصد أذاهم ألم تسمع إلى الذين قالوا : إنما كنا نخوض و نلعب فقال الله تعالى : { أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تتعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } [ التوبة : 66 ]
و هذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة و السلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيعلن و يقبح و نحو ذلك و قد قال تعالى : { فلا و ربك لا يؤمنون حتىيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما } [ النساء : 65 ]
فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر غيره في حكم و حرج لذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أفحش فيه منطقه فهو كافر بنص التنزيل و لا يعذر بأن مقصوده رد الخصم فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده و والده و الناس أجمعين
و من هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله و قول الآخر : إعدل فإنك لم تعدل و قول ذلك الأنصاري : أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض حيثزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته و لذلك أنزل الله تعالى هذه الآية و أقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه و إنما عفا عنه النبي عليه الصلاة و السلام كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله و عن الذي قال : إعدل فإنك لم تعدل و قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي عليه الصلاة و السلام فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه ؟
و قد ذكر طائفة من الفقهاء ـ منهم ابن عقيل و بعض أصحاب الشافعي ـ أن هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال : لم يعزره النبي صلى الله عليه و سلم لأن التعزير [ غير ] واجب و منهم من قال : عفا عنه لأن الحق له و منهم من قال : عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقى ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر و هذه أقوال ردية و لا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن
فإن قيل : ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر و في الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ] و لو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر و الكفر لا يغفر و لا يقال عن بدري : إنه كفر
فيقال : هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب و لم يذكرها أكثر الرواة فيمكن أنها و هم كما وقع في حديث كعب و هلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا و كذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري و لكن الظاهر صحتها
فنقول : ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر و سمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا
فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير : [ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ] فغضب الأنصاري ثم قال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال للزبير : [ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ] فقال الزبير : و الله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } [ النساء : 65 ] متفق عليه
و في رواية البخاري من حديث عروة قال : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ حقه و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له و للأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه و سلم استوعى رسول الله عليه الصلاة و السلام للزبير حقه في صريح الحكم و هذا يقوي أن القصة نتقدمة قبل بدر لأن النبي عليه الصلاة و السلام قضي في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم حتى يبلغ الماء إلى الكعبين فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه و هذا القضاء ظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه و سلم لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم و لعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء
و أيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشرف و هذا إنما كان قبل بدر لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرار يتحاكم إليه فيه و إن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب و استقر و قد عفا له النبي صلى الله عليه و سلم عن حقه فغفر له و المضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة : إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك إما بدون أن يستغفروا
ألا ترى قدامة بن مظعون ـ و كان بدريا ـ تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى : { ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا } [ المائدة : 93 ] الآية حتى أجمع رأى عمر و أهل الشورى أن يستتاب هو و أصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا و إن لم يقروا به كفروا ثم إنه تاب و كاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة و أنهم مغفور لهم و إن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر فإن التوبة تجب ما قبلها
و إذا ثبت أن كل سب ـ تصريحا أو تعريضا ـ موجب للقتل فالذي يجب أن يعتني به الفرق بين السب الذي لا يقبل منه التوبة و الكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول :
هذا الحكم قد نيط في الكتاب و السنة باسم أذى الله و رسوله و في بعض الأحاديث ذكر الشتم و السب و كذلك جاء في ألفاظ الصحابة و الفقهاء ذكر السب و الشتم و الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض و السماء و البحر و الشمس و القمر و لا في الشرع كاسم الصلاة و الزكاة و الحج و الإيمان و الكفر فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض و الحرز و البيع و الرهن و الكري و نحوها فيجب أن يرجع الأذى و السب إلى العرف فما عده أهل العرف سبا و انتقاصا أو عيبا أو طعنا و نحو ذلك فهو من السب و ما لم يكن كذلك فهو كفر به فيكون ليس يسب حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهرا له و إلا فهو زندقة و المعتبر أن يكون سبا و أذى للنبي عليه الصلاة و السلام و إن لم يكن سبا و أذى لغيره
فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي عليه الصلاة و السلام أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب النبي عليه الصلاة و السلام كالقذف و اللعن و غيرهما من الصور التي تقدم التنبيه عليها و أما ما يختض بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا بمجرد عدم التصديق بنبوته كفر محض و إن كان فيه استخفاف و استهانة مع عدم التصديق فهو من السب و هنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زنديق حكمه الزنديق و إلا فهو مرتد محض و استقصاء الأنواع بينها ليس هذا موضعه
أما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به و بين سبه فإن كفره به لا ينقض العهد و لا يبيح دم المعاهد بالاتفاق لأنا صالحناهم على هذا و أما سبه له فإنه ينقض العهد و يوجب القتل كما تقدم
قال القاضي أبو يعلى : [ عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي عليه الصلاة و السلام لا على شتمهم و سبهم له ]
و قد تقدم أن هذا الفرق أيضا معتبر في المسلم حيث قتلناه بخصوص السب و كونه موجبا للقتل حدا من الحدود بحيث لا يسقط بالتوبة و إن صحت و أما حيث قتلناه لدلالته على الزندقة أو لمجرد كونه مرتدا فلا فرق حينئذ بين مجرد الكفر و بين ما يضمنه من الأنواع فنقول : الآثار عن الصحابة و التابعين و الفقهاء ـ مثل مالك و احمد و سائر الفقهاء القائلين بذلك ـ كلها مطلقة في شتم النبي عليه الصلاة و السلام من مسلم أو معاهد فإنه يقتل و لم يفصلوا بين شتم و شتم ولا بين ان يكرر الشتم أو لا يكرره أو يظهره و أعنيس بقولي لا يظهره : أن لا يتكلم به في ملأ من المسلمين و إلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتمه أو حتى يقر بالشتم و كونه يشتمه بحيث يسمعه المسلمون إظهار له اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم
قال مالك و أحمد : [ كل من شتم النبي عليه الصلاة و السلام أو تنقصه مسلما أو كافرا فإنه يقتل و لا يستتاب ] فنصا على أن الكافر يجب قتله بتنقصه له كما يقتل بشتمه و كما يقتل المسلم بذلك و كذلك أطلق سائر أصحابنا أن سب النبي عليه الصلاة و السلام من الذمي يوجب القتل
و ذكر القاضي و ابن عقيل و غيرهما أن ما أبطل الإيمان فإنه يبطل الأمان إذا أظهروه فإن كان من الكلام ما يبطل حقن الإسلام فأن يبطل حقن الذمة أولى مع الفرق بينهما من وجه آخر فإن المسلم إذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه و سلم فلذلك كفر و الذمي قد علم أن اعتقاده و إنما أخذ عليه كتمه و أن لا يظهره فبقي تفاوت ما بين الإظهار و الإضمار
قال ابن عقيل : فكما أخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أخذ على الذمي أن لا يظهره فإظهار هذا كإضمار ذاك و إضماره لا ضرر على الإسلام و لا إزراء فيه و في إظهاره ضرر و إزراء على الإسلام و لهذا ما بطن من الجرائم لا يتبعها في حق المسلم و لو أظهرها أقمنا عليهم حد الله
و طرد القاضي و ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقص الإيمان من الكلام مثل التثنية و التثليث كقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة و نحوه ذلك : أن الذمي أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض العهد ن كما انه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا عليه الصلاة و السلام نقض العهد
قال القاضي : و قد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل : [ كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل ـ مسلما كان او كافرا ـ و هذا مذهب اهل المدينة ]
و قال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بؤذن و هو يؤذن فقال له : كذبت فقال : يقتل لأنه شتم فقد نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الأذان ن و هي قول [ الله أكبر ] أو [ أشهد أن لا إله إلا الله ] أو [ أشهد أن محمدا رسول الله ] و قد ذكرها الخلال و القاضي في سب الله بناء على أنه كذبه فيما يتعلق بذكر الرب سبحانه و الأشبه أنه عام في تكذيبه فيما يتعلق بذكر الرب و ذكر الرسول بل هو في هذا أولى لأن اليهودي لا يكذب من قال : [ لا إله إلا الله ] و لا من قال [ الله أكبر ] و إنما يكذب من قال إن محمدا رسول الله ن و هذا قول جمهور المالكيين قالوا : إنه يقتل بكل سب سواء كانوا يستحلونه لأنهم و إن استحلوه فإنا لم نعطيهم العهد على إظهاره مصعب و طائفه من المدنيين
قال أبو مصعب في نصراني قال [ و الذي اصطفى عيسى على محمد ] : اختلف العلماء فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما و ليلة و أمرت من جر برجله و طرح على مزبلة فأكلته الكلاب ]
و قال أبو مصعب في نصراني قال : [ عيسى خلق محمدا ] قال : يقتل
و أفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية و بنوه عيسى لله
و قال ابن القاسم فيمن سبه فقال : [ ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن و إنما شيء يقوله و
نحو هذا : فقيل فإن قال [ إن محمدا لم يرسل إلينا و إنما أرسل إليكم و إنما نبينا موسى أو عيسى ] و نحو هذا : لا شيء عليهم لأن الله أقرهم على مثله
قال ابن القاسم : و إذا قال النصراني [ ديننا خير من دينكم و إنما دينكم دين الحمير ] و نحو هذا من القبيح أو سمع المؤذن يقول : [ أشهد أن محمدا رسول الله ] فقال : كذلك يعظكم الله ففي هذا الأدب الموجع و السجن الطويل و هذا قول محمد بن سحنون و ذكره عن أبيه و لهم قول آخر فيما إذا سبه بالوجه الذي به كفروا أنه لا يقتل
قال سحنون عن ابن القاسم : من شتم الأنبياء من اليهود و النصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم و قال سحنون في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد قوله سبحانه كذبت ] : يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل ]
و قد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم
و كذلك اختلف أصحاب الشافعي في سب الذي ينتقض به عهد الذمي و يقتل به إذا قلنا بذلك على الوجهين : أحدهما : ينتقض بمطلق السب لنبينا و القدح في ديننا إذا أظهروه و إن كانوا يعتقدون ذلك دينا و هذا قول أكثرهم و الثاني : أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول و القرآن ليس بكلام الله فهو كإظهار قولهم في المسيح و معتقدهم في التثليث قالوا : و هذا لا ينقض العهد بلا تردد بل يعزرون على إظهار و أما ما ذكروه بما يعتقدونه ديناكالطعن في سبه فهو الذي قيل فيه : ينقض العهد و هذا اختيار الصيدلاني و أبي المعالي و غيرهما
و حجة من فرق بين ما يعتقدونه دينا و ما لا يعتقدونه ـ كما اختاره بعض المالكية و بعض الشافعية ـ أنهم قد أقروا على دينهم الذي يعتقدونه لكن منعوا من إظهره كان كما لو أظهره سائر المناكير التي هي من دينهم كالخمر و الخنزير و الصليب و رفع الصوت بكتابهم و نحو ذلك و هذا إنما يستحقون عليه العقوبة و النكال بما دون القتل
يؤيد ذلك أن إظهار معتقدهم في الرسول ليس بأعظم من إظهار معتقدهم في الله و قد علم هؤلاء أن إظهار معتقدهم لا يوجب القتل و استبعدوا أن ينتقض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكورا في الشرط ن و هذا بخلاف ما إذا سبوه بما يعتقدونه دينا فإنا لم نقرهم على ذلك ظاهرا و لا باطنا ن و ليس هو من دينهم فصار بمنزلة الزنا و السرقة و قطع الطريق و هذا القول مقارب لقول الطكوفيين و قد ظن من سلكه انه لخص بذلك من سؤالهم و ليس الأمر كما اعتقده فإن الأدلة التي ذكرناها من الكتاب و السنة و الإجماع و الاعتبار كلها تدل على السب بما يعتقده فيه دينا و ما لا يعتقده فيه دينا و أن مطلق السب موجب للقتل
و من تأمل كل دليل بانفراده لم يخف عليه أنها جميعا تدل على السب المعتقد دينا كما تدل على السب الذي لا يعتقد دينا و منها ما هو نص في السب الذي يعتقد دينا بل أكثرهم فإن الذين كانوا يهجونه من الكفار الذين أهدر دماءهم لم يكونوا يهجونه إلا بما يعتقدونه دينا مثل نسبته إلى الكذب و السحر و ذم دينه و من اتبعه و تنفير الناس عنه إلى غير ذلك من الأمور ن فأما الطعن في نسبه أو خلقه أو خلقه أو أمانه أو وفائه أو صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن أحد يتعرض لذلك في غالب الأمور و لا يتمكن من ذلك و لا يصدقه أحد في ذلك لا مسلم و لا كافر لظهور كذبه و قد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادته
ثم نقول : هذا الفرق منهافت من وجوه :
أحدها أن الذمي لو أظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه بالسخط و جهنم و العذاب أو نحو ذلك فإن قيل [ ليس من السب ينتقض به العهد ] كان هذا قولا مردودا سمجا فإنه من لعن شخصا و قبحه لم يبق من سبه غاية و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال [ لعن المؤمن كقتله ] و معلوم أن هذا أشد من الطعن في خلقه و أمانته أو وفائه و إن قيل [ هو سب له ] فقد علم أن من الكفار من يعتقد ذلك دينا و يرى أنه من قرباته كتقريب المسلم بلعن مسيلمة و الأسود العنسي
الوجه الثاني : أنه على القول بالفرق المذكور إذا سبه بما لا يعتقده دينا مثل الطعن في نسبه أو خلقه أو خلقه و نحو ذلك فمن أين ينتقض عهده و يحل دمه ؟ و معلوم أنه قد أقر على ما هو أعظم من ذلك من الطعن في دينه الذي هو أعظم من الطعن في نسبه و من الكفر بربه الذي هو أعظم الذنوب و من سب الله بقوله : إن له صاحبه و ولدا و إنه ثالث ثلاثة فإنه لا ضرر يلحق الأمة في دينها بإظهار ما لا يعتقد صحته من السب إلا و يلحقهم بإظهار ما كفر به أعظم من ذلك فإذا أقر على أعظم السبين ضررا فإقراره على أدناهما ضررا أولى نعم بينهما من الفراق أنه إذا طعن في نسبه أو خلقه فإنه يقر لنا بأنه كاذب أو أهل دينه يعتقدون أنه كاذب آثم بخلاف السب الذي يعتقده دينا فإنه و أهل دينه متفقون على أنه ليس بكاذب فيه و لا آثم فيعود الأمر إلى أنه قال كلمة أثم بها عندهم و عندنا لكن في حق من لا حرمة له عنده بل عنده بل مثاله عنده أن يقذف الرجل مسيلمة أو العنسي أو ينسبه إلى أنه كان أسود أو أنه كان دعيا أو كان يسرق أو كان قومه يستخفون به و نحو ذلك من الوقيعة في عرضه بغير حق معلوم أن هذا لا يوجب القتل و لا يوجب الجلد أيضا فإن العرض يتبع الدم فمن لم يعصم دمه لم يصن عرضه فلو لم يجب قتل الذمي إذا سب الرسول لكونه قد قدح في ديننا لم يوجب قتله بشيء من السب أيضا فإن خطب ذلك يسير
يبين أن المسلم إنما قتل إذا سبه بالقذف و نحوه لأن القدح في نسبه قدح في نبوته فإذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي فإن لا نقتله بإظهار القدح مما لا يقدح في النبوة أولى و إذ الوسائل أضعف من المقاصد
و هذا البحث إذا حقق اضطر المنازع إلى أحد الأمرين : إما مواقفه من قال من أهل الرأي إن العهد لا ينقض من السب و إما مواقفه الدهماء في أن العهد ينتقض بكل سب و أما الفرق بين سب و سب في انتقاض العهد و استحلال الدم فمتهافت
ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إيجاب القتل و لا نقض العهد بذلك أصلا و من ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه أن يقيم عليه دليلا
الثالث : أنا إذا لم نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه دينا لم يمكنا أن نقتلهم بإظهار شيء من السب فإنه ما من أحد منهم يظهر شيئا من ذلك إلا و يمكنه أن يقول : إني معتقد لذلك متدين به و إن طعنا في السب كما يتدينون بالقدح في عيسى و أمه عليهما السلام و يقولون على مريم بهتانا عظيما
ثم إنهم فيما بينهم قد يخلفون في أشياء من أنواع السب : هل هي صحيحة عندهم أو باطلة ؟ و هم قوم بهت ضالون فلا يشاءون أن يأتوا ببهتان و نوع من الضلال الذي لا راد القلوب منه ثم يقولون : [ هو معتقدنا ] إلا فعلوه فحينئذ لا يقتلون حتى يثبت أنهم لا يعتقدونه دنيا و هذا القدر هو محل اختلاف و بعضه لا يعلم إلا من جهتهم و قول بعضهم في بعض غير مقبول
و نحن إن كنا نعرف أكثر عقائدهم فما تخفي صدورهم أكبر و تجدد الكفر و البدع منهم غير مستنكر فهذا الفرق مفضاة إلى حتم القتل بسب الرسول و هو لعمري قول أهل الرأي و مستندهم ما أبداه هؤلاء و قد قدمنا الجواب عن ذلك و بينا أنا إنما أقررناهم على إخفاء دينهم و لا على إظهار باطل قولهم و المجاهرة بالطعن في ديننا و إن كانوا يستحلون ذلك
فإن المعاهدة على تركه صيرته حراما في دينهم كالمعاهدة على الكف عن دمائنا و أموالنا و بينا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهرة بضرب السيف بل أشد على أن الكفر أعم من السب فقد يكون الرجل كافرا و لا يسب و هذا هو سر المسألة فلا بد من بسطه فنقول :
التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب و اللسان و نحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين و الفقيه يأخذ حظه من ذلك فنقول : السب نوعان دعاء و خبر أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره : لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره فهذا و أمثاله سب للأنبياء و لغيرهم و كذلك لو قال عن نبي : لا صلى الله عليه أو لا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محا الله اسمه و نحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة
فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب فأما المسلم فيقتل به بكل حال و أما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره
فأما إن أظهر الدعاء للنبي و أبطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول يفهمه بعض الناس دون البعض ـ مثل قوله : السام عليكم ـ إذا أخرجه و مخرج التحية و أظهر أنه يقول السلام ففيه قولان :
أحدهما : أنه من السب الذي يقتل به و إنما كان عفو النبي صلى الله عليه و سلم عن اليهود الذين حيوه بذلك حال ضعف الإسلام بالبقاء عليه لما كان مأمورا بالعفو عنهم و الصبر على أذاهم و هذا قول طائفة من المالكية و الشافعية و الحنبلة مثل القاضي عبد الوهاب و القاضي أبي يعلى و أبي إسحاق الشيرازي و أبي الوفاء ابن عقيل و غيرهم و ممن ذهب إلى أن هذا سب من قال : [ لم يعلم أن هؤلاء كانوا أهل عهد ] و هذا ساقط لأنا قد بينا فيما تقدم أن اليهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين و قال آخرون : كان الحق له و له أن يعفو عنهم فأما بعده فلا عفو
و القول الثاني : أنه ليس من السب الذي ينتقض به العهد لأنهم لم يظهروا السب و لم يجهروا به إنما أظهروا التحية و السلام لفظا و حالا و حذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين و قد لا يفطن له الأكثرون و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم : السام عليكم فقولوا : و عليكم فجعل هذا شرعا باقيا في حياته و بعد موته حتى صارت السنة أن يقال للذمي إذا سلم : و عليكم ] و كذلك لما سلم عليهم اليهودي قال : أتدرون ما قال ؟ إنما قال : السام عليكم و لو كان هذا من السب الذي هو سب لوجب أن يشرع عقوبة لليهودي إذا سمع منه ذلك و لو بالجلد فلما لم يشرع ذلك علم أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك و قد أخبر الله عنهم بقوله تعالى { و إذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله و يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير } [ المجادلة : 8 ]
فجعل عذاب الآخرة حسبهم يدل على أنه لم يشرع على ذلك عذابا في الدنيا و هذا لو أنهم قد قرروا على ذلك لقالوا إنما قلنا السلام و إنما السمع يخطئ و أنتم تتقولون علينا فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلام و يعرفون في لحن القول و يعرفون بسيماهم فإنه لا يمكن عقوبتهم باللحن و السيماء فإن موجبات العقوبات لابد أن تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس و هذا القدر من المسلم فإنما يكون نقضا للعهد إذا أظهره الذمي و إتيانه به على هذا الوجه غاية ما يكون من الكتمان و الإخفاء
و نحن لا نعاقبهم على ما يسرونه و يخفونه من السب و غيره و هذا قول جماعات من العلماء من المتقدمين و من أصحابنا و المالكيين و غيرهم و ممن أجاز هذا القول ممن زعم أن هذا دعاء بالسام و هو الموت على أصح القولين أو دعاء بالسامة و أما الذين قالوا إن الموت محتوم على الخليفة قالوا : و هذا تعريض بالأذى لا بالسب و هذا القول ضعيف فإن الدعاء على الرسول و المؤمنين بالموت و ترك الدين من أبلغ السب كما أن الدعاء بالحياة و العافية و الصحة و الثبات على الدين من أبلغ الكرامة
النوع الثاني : الخبر فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو نقضا فإنه يجب به القتل كما تقدم فإن الكفر ليس مستلزما للسب و قد يكون الرجل كافرا ليس يساب و الناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل و يعتقد فيه العقيدة القبيحة و لا يسبه و قد يضم إلى ذلك مسبه و إن كانت المسبة مطابقة للمعتقد فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا و لا ما يحتمل أن يقال سرا يحتمل أن يقال جهرا و الكلمة الواحدة تكون في سبا و في حال ليست بسب فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال و الأحوال و إذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس فما كان في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة و العلماء و ما لا فلا و نحن نذكر من ذلك أقساما فنقول : لا شك أن إظهار التنقص و الاستهانه عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحمار أو الكلب أو وصفه بالمسكنة و الخزي و المهانة أو الإخبار بأنه في العذاب و أن عليه آثام الخلائق و نحو ذلك و كذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال و أنه يضر من اتبعه و أن ما جاء به كله زور و باطل و نحو ذلك فإن نظم ذلك شعرا كان أبلغ في الشتم فإن الشعر يحفظ و يروى و هو الهجاء و ربما يؤثر في نفوس كثيرة ـ مع العلم ببطلانه ـ أكثر من تأثير البراهين فإن غني به بين ملأ من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره
و أما من أخبر عن معتقده بغير طعن فيه ـ مثل أن يقول : أنا لست متبعه أو لست مصدقة أو لا أحبه أو لا أرضى دينه و نحو ذلك ـ فإنما أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا لأن عدم التصديق و المحبة قد يصدر عن الجهل و العناد و الحسد و الكبر و تقليد الأسلاف و إلف الدين أكثر مما يصدر عن العلم بصفات النبي خلاف ما إذا قال من كان و من هو رأي كذا و كذا و نحو ذلك و إذا قال : لم يكن رسولا و لا نبيا و لم ينزل شيء و نحو ذلك فهو تكذيب صريح و كل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب و وصفه بأنه كذاب لكن بين قوله : [ ليس بنبي ] و قوله : [ هو كذاب ] فرق من حيث إن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول : إني رسول الله و ليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها ناسبا له الكذب في دعواها و المعنى الواحد قد يؤدي بعبارات بعضها يعد سبا و بعضها لا يعد سبا
و قد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن من قال للمؤذن : [ كذبت ] فهو شاتم و ذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن معلنا بذلك ـ بحيث يسمعه المسلمون طاعنا في دينهم مكذبا للأمة في تصديقها بالوحدانية و الرسالة ـ لا ريب أنه شتم
فإن قيل : ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله تبارك و تعالى أنه قال : [ شتمني ابن آدم و ما ينبغي له ذلك و كذبني ابن آدم و ما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله : إني اتخذت ولدا و أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني فقد فرق بين التكذيب و الشتم ]
فيقال قوله : [ لن يعيدني كما بدأني ] يفارق قول اليهودي للمؤذن : [ كذبت ] من وجهين :
أحدهما : أنه لم يصرح بنسبته إلى الكذب و نحن لم نقل : إن كل تكذيب شتم إذا لو قيل ذلك لكان كل كافر شاتما إذ لو قيل ذلك لكان كل كافر شاتما و إنما قيل : إن الإعلان بمقابلة داعي الحق بقوله [ كذبت ] سب للأمة و شتم لها في اعتقاد النبوة و هو سب للنبوة كما أن الذين هجوا من اتبع النبي عليه الصلاة و السلام على اتباعهم إياه كانوا سابين للنبي صلى الله عليه و سلم مثل شعر بنت مروان و شعر كعب بن زهير و غيرهما و أما قول الكافر [ لن يعيدني كما بدأني ] فإنه نفي لمضمون خبر الله بمنزلة سائر أنواع الكفر
الثاني : أن الكافر المكذب بالبعث لا يقول : إن الله أخبر أنه سيعيدني و لا يقول : إن هذا الكلام تكذيب لله و إن كان تكذيبا بخلاف القائل للرسول أو لمن صدق الرسول [ كذبت ] فإنه مقر بأن هذا طعن على المكذب و عيب له و انتقاض به و هذا ظاهر و كل كلام تقدم ذكره في المسألة الأولى من نظم و نحوه و عده النبي عليه الصلاة و السلام سبا حتى رتب على قائله حكم الساب فإنه سب أيضا و كذلك ما كان في معناه و قد تقدم ذكر ذلك و الكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر و إن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب و قد يختلف ذلك باختلاف الأحوال و الاصطلاحات و العادات و كيفية الكلام و نحو ذلك و ما اشتبه فيه الأمر ألحق بنظيره و شبهه و الله سبحانه أعلم
و كل ما كان من الذمي سبا ينتقض عهده و يوجب قتله فإن توبته منه لا تقبل على ما تقدم هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أصحابنا و غيرهم و قد تقدم عن الشيخ أبي محمد المقدسي رضي الله عنه أنه قال : [ إن الذمي إذا سب النبي عليه الصلاة و السلام ثم أسلم سقط عنه القتل و إنه إذا قذفه ثم أسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان و ينبغي أن يبنى كلامه على أنه إن سبه بما يعتقده فيه دينا سقط عنه القتل بإسلامه كاللعن و التقبيح و نحوه و إن سبه بما لا يعتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه لأن ما يعتقده فيه كفر محض سقط حده بالإسلام باطنا فيجب أن يسقط ظاهرا أيضا لأن سقوط الأصل الذي هو الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه و أما لا يعتقده فهو فرية يعلم هو أنها فرية فهي بمنزلة سائر حقوق الأدميين و إن حمل الكلام على ظاهره في أنه يستثنى القذف فقط من بين سائر أنواع السب فيمكن أن يوجه بأن القذف غيره لما تغلظ بأن جعل على صاحبه الحد الموقت و هو ثمانون بخلاف غيره من أنواع السب فإن عقوبته التعزيز المفوض إلى اجتهاد ذي السلطان كذلك يفرق في حقه بين القذف و غيره فيجعل على قاذفه الحد مطلقا و هو القتل و إن أسلم و يدرأ عن الساب الحد إذا تاب لكن هذا الفرق ليس بمرضي فإن قذفه إنما أوجب القتل و نقض العهد في نسبه و كان ذلك قدحا في نبوته و هذا معنى يستوي فيه السب بالقذف و بغيره من أنواع الأكاذيب بل قد توصف من الأفعال أو الأقوال المنكرة بما يلحق بالموصوف شينا و غضاضة أعظم من هذا و إنما فرق في حق غيره بين القذف و غيره لأنه لا يمكن تكذيب القاذف به كما يمكن تكذيب غيره فصار العار به أشد
و هنا كلمات السب القادحة في النبوة سواء في العلم ببطلانها ظهورا و خفاء فإن العلم بكذب القاذف كالعلم بكذب الناسب له إلى منكر من القول و زور لا فرق بينهما
و بالجملة فالمنصوص عن الإمام أحمد و عامة أصحابه و سائر أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف و غيره بل من قال : [ إنه ينتقض عهده و يحتم قتله ] لم يفرق بين القذف و غيره و من قال : [ سقط عنه القتل بإسلامه ] لم يفرق بين القذف و غيره
و من فرق من الفقهاء بين ما يعتقده و ما لا يعتقده فإنما فرق في انتقاض العهد لا في سقوط القتل عنه بالإسلام لكن هو يصلح أن يكون معاضدا لقول الشيخ أبي محمد لأنه فرق بين النوعين في الجملة
و أما الإمام أحمد وسائر المتقدمين فإنما خلافهم في السب مطلقا و ليس شيء من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه تعرض للقذف لخصوصه و إنما ذكره أصحابه في القذف لأنهم تكلموا في أحكام القذف مطلقا فذكروا هذا النوع من القذف أنه موجب للقتل و أنه لا يسقط القتل بالتوبة لنص الإمام على أن السب الذي هو أعلم من القذف موجب للقتل لا يستتاب صاحبه
ثم منه من ذكر المسألة بلفظ السب كما هي في لفظ أحمد و غيره
و منهم من ذكرها بلفظ القذف لأن الباب القذف فكان ذكرها بالاسم الخاص أظهر تأثيرا في الفرق بين هذا القذف و غيره ثم علل الجميع و أدلتهم تعم أنواع السب بل هي في غير القذف أنص منها في القذف و إنما تدل على القذف بطريق عموم أو بطريق القياس و الدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسوية كما تقدم ذكره نفيا و إثباتا و لا حاجة إلى الإطناب هنا
فإن من سلم أن جميع أنواع السب من القذف و غيره ينتقض العهد و يوجب القتل ثم فرق بين بعضها و بعض في السقوط بالإسلام فقد أبعد جدا لأن السب لو كان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العهد و لوجب قتل الذمي و إذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامه إما أن يسقط الكفر فقط أو يسقط الكفر و غيره من الجنابة على عرض الرسول فأما إسقاطه لبعض الجنايات دون بعض ـ مع استوائهما في مقدار العقوبة ـ فلا يتبين له وجه محقق
و الاحتجاج بأن الإسلام يسقط عقوبة من سب الله فإسقاطه عقوبة من سب النبي أولى إن صح فإنما يدل على أن الإسلام يسقط عقوبة الساب مطلقا قذفا كان السب أو غير قذف
و نحن في هذا المقام لا نتكلم إلا في التسوية ين أنواع السب و لا في التسوية بين أنواع السب لا في صحة هذه الحجة و فسادها إذ تقدم التنبيه على ضعفها و ذلك لأن سب النبي إن جعل بمنزلة سب الله مطلقا و قيل بالسقوط في الأصل فيجب أن يقال بالسقوط في الفرع و إن جعل بمنزلة سب الخلق أو جعل موجبا للقتل حدا لله أو سوي بين السبين في عدم السقوط و نحو ذلك من المآخذ التي تقدم ذكرها فلا فرق في هذا الباب بين القذف و غيره في السقوط بالإسلام فإن الذمي لو قذف مسلما أو ذميا أو شتمه بغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير المستحق بالسب كما لا يسقط الحد المستحق بالقذف فعلم أنهما سواء في الثبوت و السقوط و إنما يختلفان في مقدار العقوبة بالنسبة إلى غير النبي أما بالنسبة إلى النبي فعقوبتهما سواء فلا فرق بينهما بالنسبة إليه البتة
و إذ قد ذكرنا حكم الساب للرسول عليه الصلاة و السلام فنردفه بما هو من جنسه مما قد تقدم في الأدل المذكورة بأصل حكمه فإن ذلك من تمام الكلام في هذه المسألة على ما يخفي و نفصله فصولا
فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد و أسوأ من الكافر يعظم الرب و يعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل باستهزاء بالله و لا مسبة له
ثم اختلف أصحابنا و غيرهم في قبول توبته بمعنى أنه أهل يستتاب كالمرتد و يسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان و ثبوت الحد عليه ؟ على قولين : أحدهما بمنزلة ساب الرسول و فيه الروايتان في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب و أكثر من احتذى حذوه من المتأخرين و هو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال : [ كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك و تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا و هذا مذهب أهل المدينة ] فأطلق وجوب القتل عليه و لم يذكر استتابة و ذكر أنه قول أهل المدينة و من وجب عليه القتل يسقط بالتوبة قول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته و لو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المدينة فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل و إنما اختلفوا في توبته فلما أخذ يقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في الذمي على أنه قصد محل الخلاف بإظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في ساب الرسول
و أما الرواية الثانية فإن عبد الله قال : [ سئل أبي عن رجل قال يا ابن كذا و كذا أنت و من خلقك ] قال أبي : هذا مرتد عن الإسلام قلت لأبي : تضرب عنقه ؟ قال : نعم نضرب عنقه ] فجعله من المرتدين
و الرواية الأولى قول الليث بن سعد و قول مالك و روى ابن القاسم قال : [ من سب الله تعالى من المسلمين قتل و لم يستتب إلا أن يكون افترى على اللهب ارتداده إلى دين دان به و أظهره فيستتاب و إن لم يظهره لم يستتب ] و هذا قول ابن القاسم و مطرف و عبد الملك و جماهير المالكية
و الثاني : أنه يستتاب و تقبل توبته بمنزلة المرتد المحض و هذا قول القاضي أبويعلى و الشريف أبي جعفر و أبي علي بن البناء و ابن عقيل مع قولهم : إن من سب الرسول لا يستتاب و هذا قول طائفة من المدنيين : منهم محمد بن مسلمة و المخزومي و ابن أبي حازم قالوا : لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب و كذلك اليهودي و النصراني فإن تابوا قبل منهم و إن لم يتوبوا قتلوا و لا بد من الاستتابة و ذلك كله كالردة و هو الذي ذكره العراقيون من المالكية
و كذلك ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه قالوا : سب الله ردة فإذا تاب قبل توبته و فرقوا بينه و بين سب الرسول على أحد الوجهين و هذا مذهب الإمام أبو حنيفة أيضا
و أما من استتاب الساب لله و لرسوله فمأخذه أن ذلك من أنواع الردة و من فرق بين سب الله و سب الرسول قالوا : سب الله كفر محض و هو حق لله و توبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الطارىء مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع و يدل على ذلك أن النصارى يسبون الله بقولهم : هو ثالث ثلاثة و بقولهم : إن له ولدا كما أخبر النبي عليه الصلاة و السلام عن الله عز و جل أنه قال شتمني ابن آدم و ما ينبغي له ذلك و كذبني ابن آدم و ما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله : إن لي ولدا و أنا الأحد الصمد و قال سبحانه : { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ـ إلى قوله ـ أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه } [ المائدة : 74 ]
و هو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب فإن الرجل لو أتى من الكفر و المعاصي بملء الأرض ثم تاب الله عليه و هو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة و لا معرة و إنما يعود ضرر السب على قائله و حرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب
و بهذا يظهر الفرق بينه و بين الرسول فإن السب هناك قد تعلق به حق آدمي و العقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة و الرسول تلحقه المعرة و الغضاضة بالسب فلا تقوم حرمته و لا تثبت في القلوب مكانته إلا باططلام سابه لما أن هجوه و شتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس و يقدح في مكانه في قلوب كثيرة فإن لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك و إلا أقضى الأمر إلى الفساد
و هذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حد سب الرسول حق لآدمي كما يذكره كثير من الأصحاب و بالنظر إلى أنه حق لله أيضا فإن ما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بإقامة الحد فأشبه الزاني و السارق و الشارب إذا تابوا بعد القدرة عليهم
و أيضا فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب و أكثر ما هو سب في نفس الأمر إنما يصدر عن اعتقاد و تدين يراد به التعظيم لا السب و لا يقصد الساب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر بخلاف سب الرسول فإنه في الغالب إنما يقصد به الإهانة و الاستخفاف و الدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر و منافق فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع فإن حدودها لا تسقط بالتوبة بخلاف الجرائم التي لا داعي إليها
و نكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع غالب الأوقات فيندرج في عموم الكفر بخلاف سب الرسول فإن لخصوصه دواعي متوفرة فناسب أن يشرع لخصوصه حد و الحد المشروع لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود فلما اشتمل سب الرسول على خصائص ـ من جهة توفر الدواعي إليه و حرص أعداء الله عليه و أن الحرمة تنتهك به انتهاك الحرمات بانتهاكها و أن فيه حقا لمخلوق ـ تحتمت عقوبته لا لأنه أغلظ إثما من سب الله بل لأن مفسدته لا تنحسم إلا بتحتم القتل
ألا ترى أنه لا ريب أن الكفر و الردة أعظم إثما من الزنا و السرقة و قطع الطريق و شرب الخمر ثم الكافر و المرتد إذا تابا بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما و لو تاب أولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم مع أن الكفر أعظم من الفسق و لم يدل ذلك على أن الفاسق أعظم إثما من الكافر ؟ فمن أخذ تحتم العقوبة و سقوطها من كبر الذنب و صغره فقد نأى عن مسالك الفقه و الحكمة
و يوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب و لا نقر واحدا منهم و لا من غيرهم على زنا و لا سرقة و لا كبير من المعاصي الموجبة للحدود و قد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في زمنهم لأجل الفاحشة و الأرض مملوءة من المشركين و عم في عافية و قد دفن رجل قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مرات و الأرض تلفظه في كل ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الأرض لتقبل شر منه و لكن الله أراكم هذا لتعتبروا ] و لهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر و الإعراض و الجلد و غير ذلك حالا عند الله و عندنا من الكافر
فقد رأيت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة ما هو أشد منها و سبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجداء و إنما الجزاء يوم الدين يجزي الله العباد بأعمالهم : إن خيرا فخير و إن شرا فشر لكن ينزل الله سبحانه من العقاب و يشرع من الحدود ما يزجر النفوس عما فيه فساد عام لا يحض فاعله أو ما يطهر الفاعل من خطيئته أو لتغلظ الجرم أو لما يشاء سبحانه فالخطيئة إذا خيف أن يتعدى ضررها فاعلها لم تنحسم مادتها إلا بعقوبة فاعلها فلما كان الكفر و الردة إذا قبلت التوبة من بعد القدرة لم تترب على ذلك مفسدة تتعدى التائب وجب قبول التوبة لأن أحدا لا يريد أن يكفر أو يرتد ثم إذا أخذ أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يحصل مقصوده بخلاف أهل الفسوق فإنه إذا سقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك فتحا لباب الفسوق فإن الرجل يعمل ما اشتهى ثم إذا أخذ قال : إني تائب و قد حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها
فكذلك سب الله هو أعظم من سب الرسول لكن لا يخاف أن النفوس تتسرع إلى ذلك إذا استتيب فاعله و عرض على السيف فإنه لا يصدر غالبا إلا عن اعتقاد و ليس للخلق اعتقاد يبعثهم على إظهار السب لله تعالى و أكثر ما يكون ضجرا و برما و سفها و روعة السيف و الاستتابة تكف عن ذلك بخلاف إظهار سب الرسول فإن هناك دواعي متعددة تبعث عليه متى علم صاحبها أنه إذا أظهر التوبة كف عنه لم يزعه ذلك عن مقصوده
و مما يدل على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانوا يسبون الله بأنواع السب ثم لم يتوقف النبي صلى الله عليه و سلم في قبول إسلام أحد منهم و لا عهد بقتل واحد منهم بعينه و قد توقف في قبول توبة من سبه مثل أبي سفيان و ابن أبي أمية و عد بقتل من كان يسبه من الرجال و النساء ـ مثل الحويرث بن نقيذ و القينتين و جارية لبني عبد المطلب و مثل الجال و النساء الذين أمر بقتلهم بعد الهجرة ـ و قد تقدم الكلام على تحقيق الفرق عند من يقول به بما هو أبسط من هذا في المسألة الثالثة
و أما من قال : [ لا تقبل توبة من سب الله سبحانه و تعالى كما لا تقبل توبة من سب الرسول ] فوجهه ما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه من التسوية بين سب الله و سب الأنبياء في إيجاب القتل و لم يأمر بالاستتابة مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد لكن قد ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يستتاب لأنه كذب النبي عليه الصلاة و السلام فيحمل ذلك على السب الذي يتدين به
و أيضا فإن السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد فإن الكافر يتدين بكفره و يقول : إنه حق و يدعو إليه و له عليه موافقون و ليس من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا و استهزاء و سبا لله و إن كان في الحقيقة سبا كما أنهم يقولون : إنهم ضلال جهال معذبون أعداء الله و إن كانوا كذلك و أما الساب فإنه مظهر للتنقص و الاستخفاف و الاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكا يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزىء و يعلم من نفسه أنه قد قال عظيما و أن السموات و الأرض تكاد تنفطر من مقالته و تخر الجبال و أن ذلك أعظم من كل كفر و هو يعلم أن ذلك كذلك
و لو قال بلسانه : إني كنت لا اعتقد وجود الصانع و لا عظمته و الآن قد رجعت عن ذلك علمنا أنه كاذب فإن فطرة الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع و تعظيمه فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب و لا شهوة له في ذلك بل هو مجرد سخرية و استهزاء و استهانة و تمرد على رب العالمين تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وقار لله عنده كصدور قطع الطريق و الزنا عن الغضب و الشهوة و إذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقوبة تخصه حدا من الحدود و حينئذ فلا تسقط تلك العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود
و مما بين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى : { و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } [ الأنعام : 108 ]
و من المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله ثم نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله أعظم عنده من يشرك به و يكذب رسوله و يعادى فلا بد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل و أولى فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتل لأن ذلك أعظم الجرائم فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات
و يدل على ذلك قوله سبحانه و تعالى : { إن الذين يؤذون الله و رسوله } [ الأحزاب : 57 ] إلى آخرها فإنها تدل على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله و الآذى المطلق إنما هو باللسان و قد تقدم تقرير هذا
و أيضا فإن إسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب لله تعالى فإنه لا يشاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا فعل كما في سائر الجرائم الفعلية
و أيضا فإنه لم ينتقل إلى دين يريد المقام [ عليه ] حتى يكون الانتقال عنه تركا له و إنما فعل جريمة لا تستدام بل هي مثل الأفعال الموجبة للعقوبات فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية و مثل هذا لا يستتاب عند من عاقب على ذنب مستمر من كفر أو ردة
و أيضا فإن استتابة هذا توجب أن لا يقام فإنا نعلم أن ليس أحد من الناس مصرا على السب لله الذي يرى أنه سب فإن ذلك لا يدعو إليه عقل و لا طبع و كل ما أفضى إلى تعطيل الحدود بالكلية كان باطلا و لما استتابة الفساق بالأفعال يفضي إ إلى تعطيل الحدود لم يشرع مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه و كذلك المستتاب من سب الرسول قد لا يتوب لما يستحله من سبه فاستتابة السلب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كل أحد أولى أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد و أوجب أن تمضمض الأفواه بهتك حرمة اسم الله و الاستهزاء به و هذا كلام فقيه لكن يعارضه أن ما كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى تحقيق إقامة الحد و يكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب
و لمن ينصر الأول أن يقول : تحقيق إقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد زجر الطباع عما تهواه بل تعظيما لله و إجلالا لذكره و إعلاء لكلمته و ضبطا للنفوس أن تتسرع إلى الاستهانة بجناية و تقيدا للألسن أن تتفوه بالانتقاص لحقه
و أيضا فإن حد سب المخلوق و قذفه لا يسقط بإظهار التوبة فحد سب الخالق أولى و أيضا حدثنا فحد الأفعال الموجبة للعقوبة لا تسقط بإظهار التوبة فكذلك حد الأقوال و تأثيرها أعظم
و جماع الأمر أن كل عقوبة وجبت جزاء و نكالا على فعل أو قول ماض فإنها لا تسقط إذا أظهرت التوبة بعد الرفع إلى السلطان فسب الله أولى بذلك و لا ينتقض هذا بتوبة الكافر و المرتد لأن العقوبة هنا إنما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي فلا يحصل نقضا لوجهين :
أحدهما : أن عقوبة الساب لله ليست كذنب استصحبه و استدامه فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه و لم يستدمه و عقوبة الكافر و المرتد إنما هي الكفر الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقاده
الثاني : أن الكافر إنما يعاقب على اعتقاد هو الآن في قلبه و قوله و عمله دليل على الاعتقاد حتى لو فرض أنا علمنا أن كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره ـ بأن يكون جاهلا بمعناها أو مخطئا قد غلط و سبق لسانه إليها مع قصد خلافها و نحو ذلك ـ و الساب إنما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله و استخفافه بحقه فيقتل و إنما علمنا أنه لا يستحسن السب لله و لا يعتقده دينا إذ ليس أحد من البشر يدين بذلك و لا ينتقض هذا أيضا بتارك الصلاة و الزكاة و نحوهما فإنهم إنما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض فإذا فعلوها زال الترك و إن شئت أن تقول : إن الكافر و المرتد ن و تاركي الفرائض يعاقبون على عدم الإيمان و الفرائض أعني على دوام هذا العدم و هؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال و الأفعال الكثيرة لا على دوام وجودها فإذا وجدت مرة لم يرتفع ذلك بالترك بعد ذلك
و بالجملة فهذا القول له توجه و قوة و قد تقدم أن الردة نوعان : مجردة و مغلظة و بسطنا هذا القول فيما تقدم في المسألة الثالثة و لا خلاف في قبول التوبة فيما بينه و بين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتوبة النصوح
و من الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكا آخر و هو أنه جعله من باب الزنديق كأحد المسلكين اللذين ذكرناهما في ساب الرسول لأن وجود السب منه ـ مع إظهاره للإسلام ـ دليل على خبث سريرته لكن هذا ضعيف فإن الكلام هنا إنما هو في سب لا يتدين به فأما السب الذي يتدين به ـ كالتثليث و دعوى الصاحبة و الولد ـ فحكمه حكم أنواع الكفر و كذلك المقالات المكفرة ـ مثل مقالة الجهمية و القدرية و غيرهم من صنوف البدع ـ و إذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يؤدب أدبا و جيعا حتى يردعه عن العود إلى مثل ذلك هكذا ذكره بعض أصحاب مالك في كل مرتد
و إن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول و قد تقدم نص الإمام أحمد على أن من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل سواء كان مسلما أو كافرا و كذلك أصحابنا قالوا : [ من ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ] فجعلوا الحكم فيه واحدا و قالوا : [ الخلاف في ذكر الله و في ذكر النبي عليه الصلاة و السلام سواء ] و كذلك مذهب مالك و أصحابه و كذلك أصحاب الشافعي ذكروا لمن سب الله و رسوله أو كتابه من أهل الذمة حكما واحدا لكن هنا مسألتان : إحداهما : أن سب الله تعالى على قسمين أحدهما : أن يسبه بما لا يتدين به مما هو استهانة عند المتكلم و غيره مثل اللعن و التقبيح و نحوه فهذا هو السب الذي لا ريب فيه
و الثاني : أن يكون مما يتدين به و يعتقده تعظيما و لا يراه سبا و لا انتقاصا مثل قول النصراني : إن له و صاحبة و نحوه فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي فقال القاضي و ابن عقيل من أصحابنا : [ ينتقض به العهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي عليه الصلاة و السلام ] و هو مقتضى ما ذكره الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و غيرهما : فإنهم ذكروا أن ما ينتقض الإيمان ينقض الذمة و يحكى هذا عن طائفة من المالكية و وجه ذلك أنا عاهدناهم على أن لا يظهروا شيئا من الكفر و إن كانوا يعتقدونه فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله و رسوله و المؤمنين بذلك و خالفوا العهد فينتقض العهد بذلك كسب النبي صلى الله عليه و سلم و قد تقدم عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنصراني الذي كذب بالقدر : لئن عدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك و قد تقدم ما تقرر ذلك
والمنصوص عن مالك أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به قتل و لم يستتب قال ابن القاسم : [ إلا أن يسلم تطوعا ] فلم يجعل ما يتدين به الذمي سبا و هذا قول عامة المالكية و هو مذهب الشافعي ذكره أصحابه و هو منصوصه قال في [ الأم ] في تحديد الإمام ما يخذه من أهل الذمة : [ و على أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بما هو أهله و لا يطعنوا في دين الإسلام و لا يعيبوا من حكمه شيئا فإن فعلوه فلا ذمة لهم و يأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم و قولهم في عزير و عيسى فإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم في عزير و عيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون ]
و هذا ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه سئل عن يهودي مر بؤذون فقال له : [ كذبت ] فقال : [ يقتل لأنه شتم ] فعلل قتله بأنه شتم فعلم أن ما يظهره من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك قال رضي الله عنه : [ من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا و هذا مذهب أهل المدينة ] و إنما مذهب أهل المدينة فيما هو سب عند القائل و ذلك أن هذا القسم ليس من باب السب و الشتم الذي يلحق بسب الله و سب النبي عليه الصلاة و السلام لأن الكافر لا يقول هذا طعنا و لا عيبا و إنما يعتقده تعظيما و إجلالا و ليس هو و لا أحد من الخلق يتدين بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي صلى الله عليه و سلم من السوء فإنه لا يقال إلا طعنا و عيبا و ذلك أن الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله و ليس يتدين بشيء من تعظيم الرسول
ألا ترى أنه قال : [ محمد عليه الصلاة و السلام ساحر أو شاعر ] فهو يقول : إن هذا نقض و عيب و إذا قال : [ إن المسيح أو عزيرا ابن الله ] فليس يقول : إن هذا عيب و نقض و إن كان هذا عيبا و نقضا في الحقيقة
و فرق بين قول يقصد به قائله العيب و النقض و قول لا يقصد به ذلك و لا يجوز أن يجعل قولهم في الله كقولهم في الرسول بحيث يجعل الجميع نقضا للعهد إذ يفرق في الجميع ما يعتقدونه و بين ما لا يعتقدونه لأن قولهم في الرسول كله طعن في الدين و غضاضة على الإسلام و إظهار لعداوة المسلمين يقصدون به عيب الرسول و نقضه و ليس مجرد قولهم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب و نقصه
ألا ترى ان قريشا كانت تقار النبي عليه الصلاة و السلام على ما كان يقوله من التوحيد و عبادة الله وحده و لا يقارونه على عيب آلهتهم و الطعن في دينهم و ذم آبائهم و قد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله مع كونهم لم يزالوا على الشرك فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به فلا يجعل حكمها واحدا
أما القاضي و جمهور أصحابه ـ مثل الشريف و ابن البناء و ابن عقيل و من تبعهم ـ فإنهم توبته و يسقطون عنه القتل بها و هذا ظاهر على أصلهم فإنهم يقبلون توبة المسلم إذا سب الله فتوبة الذمي أولى و هذا هو المعروف من مذهب الشافعي و عليه يدل عموم كلامه حيث قال في شروط أهل الذمة : [ و على أن أحدا منكم إن ذكر محمدا صلى الله عليه و سلم أو كتاب الله و دينه بما لا ينبغي فقد برئت منه ذمة الله ثم قال : و أيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد و أسلم لم يقتل إذا كان قولا ] إلا أنه لم يصرح بالسب لله فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه و كذلك قال ابن القاسم و غيره من المالكية : [ إنه يقتل إلا أن يسلم ]
و قال ابن مسلمة و ابن أبي حازم و المخزومي : [ إنه لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب و إلا قتل ] و المنصوص عن مالك أنه [ يقتل و لا يستتاب كما تقدم و هذا معنى قول أحمد رضي الله عنه في إحدى الروايتين
قال في رواية حنبل : [ من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا و هذا مذهب أهل المدينة ] و ظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوبة فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي صلى الله عليه و سلم في رواية حنبل أيضا قال : [ كل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ] و كان حنبل يعرض عليه مسائل المدنيين و يسأله عنها
ثم إن أصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي عليه الصلاة و السلام بأنه لا يسقط عنه القتل بالتوبة مطلقا و قد تقدم توجيه ذلك و هذا مثله و هذا ظاهر إذا قلنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة لأن المأخذة عندنا ليس هو الزندقة فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه و إنما المأخذ أن يقتل عقوبة على ذلك وحدا عليه مع كونه كافرا يقتل لسائر الأفعال
و يظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى : أن من شأن الرب بما يتدين به ليس فيه سب لدين الإسلام إلا أنه سب عند الله تعالى مثل قول النصارى في عيسى و نحو ذلك فقد قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله : [ شتمني ابن آدم و ما ينبغي له ذلك ] ثم قال : [ أو ما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا الأحد الصمد الذي لم ألد و لم أولد ] فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر سميت شتما أو لم تسم و قد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد مثل هذا و إذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه و هو في الجملة قول الجمهور
المرتبة الثانية : أن يذكر ما يتدين به و هو سب لدين المسلمين و طعن عليهم كقول اليهودي للمؤذن : [ كذبت ] و كرد النصراني على عمر رضي الله عنه و كما لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه و نحو ذلك فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد به و هذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد حيث قالوا : [ إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء ] و لذلك اقتصر كثير منهم على قوله : [ أو ذكر كتاب الله و دينه أو رسوله بسوء ] و أما سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسب الرسول فرق بينه و بين هذا و هي طريقة القاضي و أكثر أصحابه و من قتله لما في ذلك من الجناية على الإسلام و أنه محارب لله و رسوله فإنه يقتل بكل حال و هو مقتضي أكثر الأدلة التي تقدم ذكرها
المرتبة الثالثة : أن يسبه بما لا يتدين به بل هو محرم في دينه كما هو محرم في دين الله تعالى كاللعن و التقبيح و نحو ذلك فهذا النوع لا يظهر بينه و بين سب المسلم فرق بل ربما كان فيه أشد لأنه يعتقد تحريم مثل هذا الكلام في دينه كما يعتقد المسلمون تحريمه و قد عاهدنا على أن نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه فإسلامه لم يجدد له اعتقادا لتحريمه بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم سواء ثم هو مع ذلك مما يؤذي المسلمين كسب الرسول بل هو أشد
فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم سب الله فأن نقول لا تقبل توبة الذمي أولى بخلاف الرسول فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه و لا يتدين بتقبيح خالقه الذي يقر أنه خالقه و قد يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول
و لهذا لم يذكر عن مالك نفسه و أحمد استثناء فيمن سب الله تعالى كما ذكر عنهما الاستثناء لمن سب الرسول و إن كان كثير من أصحابهما يرون الأمر بالعكس و إنما قصدا هذا الضرب مع السب و لهذا قرنا بين المسلم و الكافر فلابد أن يكون سبا منهما و أشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة فإنه محرم في دينه مضر بالمسلمين فإذا أسلم لم يسقط عن بل إما أن يقتل أو يحد حد الزنا كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا الكلام لا ينتقض العهد لوجب أن يقام عليه حده لأن كل أمر يعتقده محرما فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام و إن لم يعلم مأخذه في كتابه مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل هذا الكلام كما أن حده في دين الله القتل
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أقام على الزاني منهم حد الزنا قال : [ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ]
و معلوم أن ذلك الزاني منهم لم يكن يسقط عنه لو أسلم فإقامة الحد على من سب الرب تبارك و تعالى سبا هو سب في دين الله و دينهم عظيم عند الله و عندهم أولى أن يحيا فيه أمر الله و يقام عليه حده
و هذا القسم قد اختلفت الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الذمي يستتاب منه كما يستتاب المسلم منه هذا قول طائفة من المدينيين كما تقدم و كأن هؤلاء لم يروه نقضا للعهد لأن ناقض العهد يقتل كما يقتل المحار و لا معنى لاستتابة الكافر الأصلي المحارب و إنما رأوا حده القتل فجعلوه كالمسلم و هو يستتبون المسلم فكذلك يستتاب الذمي و على قول هؤلاء فالشبه أن استتابته من السب لاتحتاج إلى إسلامه بل تقبل توبته مع بقائه على دينه
القول الثاني : أنه لا يستتاب لكن إن أسلم لم يقتل و هذا قول ابن القاسم و غيره و هو قول الشافعي و
إحدى الروايتين عن أحمد و على طريقة القاضي لم يذكر فيه خلاف بناء على أنه قد نقض عهده فلا يحتاج قتله استتابة لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحربي
القول الثالث : أنه يقتل بكل حال و هو ظاهر كلام مالك و أحمد لأن قتله وجب على جرم محرم في دين الله و في دينه فلم يسقط عنه بموجبه بالإسلام كعقوبته على الزنا و السرقة و الشرب و هذا القول هو الذي يدل عليه أكثر الأدلة المتقدم ذكرها
السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو : الكلام الذي يقصد به الانتقاص و الاستخفاف و هو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كالعن و التقبيح و نحوه و هو الذي دل عليه قوله تعالى : { و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيبوا الله عدوا بغير علم } [ الأنعام : 108 ]
فهذا أعظم ما تفوه به الألسنة فأما ما كان سبا في الحقيقة و الحكم لكن من الناس من يعتقده دينا و يراه صوابا و حقا و يظن أن ليس فيه انتقاص و لا تعييب فهذا نوع من الكفر حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للنفاق و الكلام في الكلام الذي يكفر به صاحبه أو لا يكفر و تفصيل الاعتقادات و ما يوجب منها الكفر أو البدعة فقط أو ما اختلفت فيه من ذلك ليس هذا موضعه و إنما الغرض أن لا يدخل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفيا و إثباتا و الله أعلم
فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم و ذلك يقع على الله سبحانه أو بعض رسله خصوصا أو عموما لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك : إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه أو لأنه و إن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره فهذا القول و شبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام و يعزر مع العلم تعزيزا بليغا لكن لا يكفر بذلك و لا يقتل إن كان يخاف عليه الكفر
مثال الأول : أن يسب الدهر الذي فرق بينه و بين الأحبة أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه و نحو ذلك مما يكثر الناس قوله نظما و نثرا فإنه إنما يقصد أن يسب من يفعل ذلك به ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه و فاعل ذلك إنما هو الله سبحانه فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرء و إلى هذا أشار النبي صلى الله عليه و سلم بقوله : [ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيده الأمر ]
و قوله فيما يروبه عن ربه تبارك و تعالى يقول : [ يا ابن آدم تسب الدهر و أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل و النهار ] فقد نهى رسول الله عليه الصلاة و السلام عن هذا القول و حرمه و لم يذكر كفرا و لا قتلا و القول المحرم يقتضي التعزيز و التنكيل
و مثال الثاني : أن يسب مسمى بلاسم عام يندرج فيه الأنبياء و غيرهم لكن يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام مثل ما نقل الكرماني قال : سألت أحمد قلت : رجل افترى على رجل فقال : يا ابن كذا و كذا إلى آدم و حواء فعظم ذلك جدا و قال : نسأل الله العافية لقد أتى هذا عظيما و سئل عن الحد فيه فقال : لم يبلغني في هذا شيء و ذهب إلى حد واحد و ذكر هذا أبو بكر عبد العزيز أيضا فلم يجعل أحمد رضي الله عنه بهذا القول كافرا مع أن هذا اللفظ يدخل فيه نوح و إدريس و شئت و غيرهم من النبيين لأن الرجل لم يدخل آدم و حواء في عمومه و إنما جعلها غاية و حدا لمن قذفه و إلا لو كان من المقذوفين تعين قتله بلا ريب و مثل هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الأنبياء فعظم الإمام أحمد ذلك لأن أحسن أحواله أن يكون قد قذف خلقا من المؤمنين و لم يوجب إلا حدا و حدا لأن الحد هنا ثبت للحي ابتداء على أصله و هو واحد و هذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك
و قال سحنون و أصبغ و غيرهما في رجل قال له غريمة : صلى الله على النبي محمد فقال له الطالب : لا صلى الله على من صلى عليه قال سحنون : ليس هو كمن شتم رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه إذا كان على ما وصف من الغضب لأنه إنما شتم الناس و قال أصبغ و غيره : لا يقتل إنما شتم الناس و كذلك قال ابن أبي زيد فيمن قال : [ لعن الله العرب و لعن الله بني إسرائيل و لعن الله بني آدم و ذكر أنه لم يرد الأنبياء و إنما أراد الظالمين منهم : إن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان ]
و ذهب طائفة ـ منهم الحارث بن مسكين و غيره ـ إلى القتل في مسألة المصلى و نحوها و كذلك قال أبو موسى بن مياس فيمن قال : [ لعنه الله إلى آدم ] إنه يقتل و هذه مسألة الكرماني بعينها و هذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال : [ عصيت الله في كل ما أمرني به ] فإن أكثر أصحابنا قالوا : ليس لك يمين لأنه إنما التزم المعصية فهو كما لو قال : محوت المصحف أو شربت الخمر إن فعلت كذا و لم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم لأنه لو أراد لذكره باسمه الخاص و لم يكتف بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصي
و منهم من قال : هو يمين لأن مما أمره الله به الإيمان و معصيته فيه كفر و لو التزم الكفر بيمينه بأن قال : [ هو يهودي أو نصراني أو هو برئ من الله أو من الإسلام أو هو يستحل الخمر و الخنزير أو لا يراه الله في مكان كذا إن فعل كذا و نحوه كان يمينا في المشهور عنه ] و وجه هذا القول أن اللفظ عام فلا يقبل منه دعوى الخصوص و لعل من يختار هذا يحمل كلام الإمام أحمد على أن القائل كان جاهلا بأن في النسب أنبياء
و وجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية في المرأة التي كانت تهجو المسلمين يلومه على قطع يدها و يذكر له أنه كان الواجب أن يعاقبها بالضرب مع أن الأنبياء يدخلون في عموم هذا اللفظ و لأن الألفاظ العامة قد كثرت و غلب إرادة الخصوص بها فإذا كان اللفظ لفظ سب و قذف الأنبياء و نحوهم من الخصائص و المزايا ما يوجب ذكرهم بأخص أسمائهم إذا أريد ذكرهم و الغضب يحمل الإنسان على التجوز في القول و التوسع فيه كان ذلك قرائن ـ عرفية و لفظية و حالية ـ في أنه لم يقصد دخولهم في العموم لا سيما إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكاد يشعر به
و يؤيد هذا أن يهوديا قال في عهد النبي عليه الصلاة و السلام : [ و الذي اصطفى موسى على العالمين ] فلطمه المسلم حتى اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تفضيله على موسى لما فيه من انتقاض المفضول بعينه و الغض منه و لو أن اليهودي أظهر القول بأن موسى أفضل من محمد لوجب التعزير عليه إجماعا بالقتل أو بغيره كما تقدم التنبيه عليه
و الحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا فمن سب نبينا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة ـ مثل أن يذكر في حديث أن نبيا فعل كذا أو قال كذا فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي و إن لم يعلم من هو أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق ـ فالحكم في هذا كما تقدم لأن الإيمان بهم واجب عموما و واجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه و سبهم كفر وردة إن كان من مسلم و محاربة إن كان من ذمي
و قد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظا أو معنى و ما أعلم أحدا فرق بينهما و إن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه و أنه وجب التصديق له و الطاعة له جملة و تفصيلا و لا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره و إن شاركه سائر إخوانه من النبيين و المرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم
فأما إن سب نبينا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب و السنة لأن هذا جحد لنبوته إن كان ممن يجهل أنه نبي فإنه سب محض فلا يقبل قوله : [ إني لم أعلم أنه نبي ]
فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال القاضي أبو يعلى : من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف و قد حكى الإجماع على هذا غير واحد و صرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم فروي عن مالك : من سب أبا بكر جلد و من سب عائشة قتل قيل له : لم ؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن لأن الله تعالى قال : { يعظمكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين } [ النور : 17 ]
و قال أبو بكر بن زياد النيسابوري : [ سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق : أتي المأمون [ بالرقة ] برجلين شتم أحدهما فاطمة و الآخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم فاطمة و ترك الآخر فقال إسماعيل : ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن ] و على هذا مضت سيرة أهل الفقه و العلم من أهل البيت و غيرهم
قال أبو السائب القاضي : كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي [ بطرستان ] و كان يلبس الصوف و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة بعشرين ألف دينار إلى المدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة و كان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال : يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويين : هذا رجل من شيعتنا فقال : معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه و سلم قال الله تعالى : { الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة و رزق كريم } [ النور : 26 ] فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه و سلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه و أنا حاضر رواه اللالكائي
و روي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله فقيل له : هذا من شيعتنا و من بني الآباء فقال : هذا سمى جدي قرنان و من سمى جدي قرنان استحق القتل فقتله
و أما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه و سلم ففيه قولان :
أحدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي
و الثاني : و هو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها و قد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس و ذلك لأن هذا فيه عار و غضاضة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و أذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده و قد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله : { إن الذين يؤذون الله و رسوله } [ الأحزاب : 57 ] الآية و الأمر فيه ظاهر
فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ من أهل بيته و غيرهم ـ فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالا و توقفت عن قتله و كفره
قال أبو طالب : سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : القتل أجبن عنه و لكن أضربه ضربا نكالا
و قال عبد الله : سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : أرى أن يضرب قلت له : حد فلم يقف على الحد إلا أنه قال : يضرب و قال : ما أراه على الإسلام
و قال : سألت أبي : من الرافضة ؟ فقال : الذين يشتمون ـ أو يسبون ـ أبا بكر و عمر رضي الله عنها
و قال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخري و غيره : و خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه و سلم أبو بكر و عمر بعد أبي بكر و عثمان بعد عمر و علي بعد عثمان و وقف قوم و هم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم و لا يطعن على أحد منهم بعيب و لا نقض فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه و عقوبته و ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه و يستتيبه فإن تاب قبل منه و إن ثبت أعاد عليه العقوبة و خلده في الحبس حتى يموت أو يراجع
و حكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم و حكاه الكرماني عنه و عن إسحاق و الحميدي و سعيد بن منصور و غيرهم
و قال الميموني : سمعت أحمد يقول : مالهم و لمعاوية ؟ نسأل الله العافية و قال لي : يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بسوء فاتهمه على الإسلام
فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره و استتابته حتى يرجع بالجلد و إن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع و قال : [ ما أراه على الإسلام ] و قال : [ واتهمه على الإسلام ] و قال : أجبن عن قتله
و قال إسحاق بن راهوية : [ من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يعاقب و يحبس ]
و هذا قول كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسى قال : [ و من سب السلف نمن الروافض فليس بكفؤ و لا يزوج و من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين و لم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب و يظهر توبته ] و هذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز و عاصم الأحول و غيرهما من التابعين
قال الحارث بن عتبة : إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال : ما حملك على أن سببته ؟ قال : أبغضه قال : و إن أبغضت رجلا سببته ؟ قال : فأمر به فجلد ثلاثين سوطا
و قال إبراهيم بن ميسرة : ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا رجلا شتم معاوية فضربه أسواطا رواهما اللالكلئي و قد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه : لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه و سلم و لكن أجلده فوق رأسه أسواطا و لول أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل
و روي الإمام أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد سب عثمان قال : فضربته عشرة أسواط قال : ثم عاد لما قال فضربته عشرة أخرى قال : فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطا
و هو المشهور من مذهب مالك قال مالك : من شتم النبي صلى الله عليه و سلم قتل و من سب أصحابه أدب
و قال عبد الملك بن حبيب : من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان و البراءة منه أدب أدبا شديدا و من زاد إلى بغض أبي بكر و عمر فالعقوبة عليه أشد و يكرر ضربه و يطال سجنه حتى يموت و لا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه و سلم
و قال ابن المنذر : [ لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي صلى الله عليه و سلم
و قال القاضي أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة : إن كان مستحلا لذلك لذلك كفر و إن لم يكن مستحلا فسق و لم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم
و قد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة و غيرهم بقتل من سب الصحابة و كفر الرافضة
قال محمد بن يوسف الفريابي و سئل عمن شتم أبا بكر قال : كافر قيل : فيصلى عليه ؟ قال : لا و سأله : كيف يصنع به و هو يقول لا إله إلا الله ؟
قال : لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تراوه في حفرته
و قال أحمد بن يونس : [ لو أن يهوديا ذبح شاة و ذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي و لم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام ]
و كذلك قال أبو بكر بن هاني : لا تؤكل ذبيحة الروافض و القدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد و أهل الذمة يقرون على دينهم و تؤخذ منهم الجزية
و كذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة : ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم
و قال فضيل بن مرزوق : سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة : و الله إن قتلك لقربة إلى الله و ما أمتنع من ذلك إلا بالجواز و في رواية قال : رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح قال : لا و الله ما هو بالمزاح و لكنه الجد قال : و سمعته يقول : لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم و أرجلكم
و صرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي و عثمان و بكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة و فسقوهم و سبوهم
و قال أبو بكر عبد العزيز في المقنع : فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج
و لفظ بعضهم و هو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم و عدالتهم كفر بذلك و إن سبهم سبا لا يقدح ـ مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد به غيظه و نحو ذلك ـ لم يكفر
قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان : هذا زندقة و قال في رواية المروزي : [ من شتم أبا بكر و عمر و عائشة ما أراه على الإسلام ]
قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة و توقف في رواية عبد الله و أبي طالب عن قتله و كمال الحد و إيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره
قال : فيحتمل أن يحمل قوله : [ ما أراه على الإسلام ] إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف و يحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي
قال : و يحتمل قوله : [ ما أراه على الإسلام ] على سب يطعن في عالتهم نحو قوله : ظلموا و فسقوا بعد النبي صلى الله عليه و سلم و أخذوا الأمر بغير حق و يحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله : كان فيهم قلة علم و قلة معرفة بالسياسة و الشجاعة و كان فيهم شح و محبة للدنيا و نحو ذلك قال : و يحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان : إحداهما يكفر و الثانية يفسق و على هذا استقر قول القاضي و غيره حكوا في تكفيرهم روايتن
قال القاضي : و من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها منه كفر بلا خلاف
و نحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما : في سبهم مطلقا و الثاني : في تفصيل أحكام الساب
أما الأول فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرام بالكتاب و السنة
أما الأول فلأن الله سبحانه يقول { و لا يغتب بعضكم بعضا } [ الحجرات : 12 ] و أدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا و قال تعالى : { ويل لكل همزة لمزة } [ الهمزة : 1 ] و قال تعالى : { و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا } [ الأحزاب : 58 ] و هم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا } [ البقرة : 104 ] حيث ذكرت و لم يكتسبوا ما يوجب أذاهم لأن الله سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى : { و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه } [ التوبة : 100 ] فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان و لم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان و قال تعالى : { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } [ الفتح : 18 ] و الرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى و من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا
و قوله تعالى : { إذ يبايعونك } سواء كان ظرفا محضا أو كانت ظرفا فيها معنى التعليل فإن ذلك لتعلق الرضى بهم فإنه يسمى رضى أيضا كما في تعلق العلم و المشيئة و القدرة و غير ذلك من صفات الله سبحانه و قيل : بل الظرف يتعلق بجنس الرضى و إنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه و يسخط عن الكافر بعد أن يعصيه و يحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له و كذلك أمثال هذا و هذا قول جمهور السلف و أهل الحديث و كثيرا من أهل الكلام و هو الأظهر
و على هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى : { و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم } [ التوبة : 100 ]
و قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ]
و أيضا فكل من أخبر الله عنه أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة و إن كان رضاه عنه بعد إيمانه و عمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه و المدح له فلو علم انه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك
و هذا كما في قوله تعالى : { يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي } [ الفجر : 28 ] و لأنه سبحانه و تعالى قال : { لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم } [ التوبة : 117 ] و قال سبحانه و تعالى : { و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه } [ الكهف : 28 ]
و قال تعالى : { محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } [ الفتح : 29 ] الآية و قال تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس } [ آل عمران : 110 ] { و كذلك جعلناكم أمة و سطا } [ البقرة : 134 ] و هم أول من و وجه بهذا الخطاب فهم مرادون بلا ريب و قال سبحانه و تعالى : { و الذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } [ الحشر : 10 ]
فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين و الأنصار و الذين جاؤوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم أن الاستغفار لهم و طهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله و يرضاه و يثنى على فاعله كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى : { فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات } [ محمد : 19 ] و قال تعالى : { فاعف عنهم و استغفر لهم } [ آل عمران : 159 ] و محبة الشيء كراهته لضده فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار و البغض لهم الذي هو ضد الطهارة و هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : [ أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم ] رواه مسلم
و عن مجاهد عن ابن عباس قال : [ لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر بالاستغفار لهم و قد علم أنهم سيقتتلون ] رواه الإمام أحمد
و عن سعد بن أبي وقاص قال : [ الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان و بقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال : ثم قرأ : { للفقراء المهاجرين ـ إلى قوله ـ رضوانا } [ الحشر : 8 ] فهؤلاء المهاجرين و هذه منزلة قد مضيت : { و الذين تبوؤوا الدار و الإيمان من قبلهم ـ إلى قوله ـ و لو كان بهم خصاصة } [ الحشر : 9 ] قال : هؤلاء الأنصار و هذه منزلة قد مضيت ثم قرأ : { و الذين جاؤوا من بعدهم ـ إلى قوله ـ رحيم } [ الحشر : 10 ] قد مضيت هاتان و بقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت : أن تستغفروا لهم و لأن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجز الاستغفار له
كما لا يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى : { ما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } [ التوبة : 113 ]
و كما لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لأن ذلك لا سبيل إليه و لأنه شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا و السب باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه و لو كان الغل عليهم و السب لهم جائزا لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فعله و لأنه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين بالهجرة و النصرة فعلم أن ذلك صفة للمؤثر فيهم و لو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك سائر المباحات بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء لا يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين و أصله
و أما السنة ففي الصحيحين [ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه ]
و في رواية لمسلم و استشهد بها البخاري قال : كان بين خالد بن الوليد و بين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو اتفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدكم و لا نصيفه ]
و في رواية للبرقاني في صحيحه [ لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو اتفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه ]
و الأصحاب : جمع صاحب : و الصاحب اسم فاعل من صحبحه يصبحه و ذلك يقع على قليل الصحابة و كثيرها لأنه يقال : صحبته ساعة و صحبته شهرا و صحبته سنة قال الله تعالى : { و الصاحب بالجنب } [ النساء : 36 ] قد قيل : هو الرفيق في السفر و قيل : هو الزوجة و معلوم أن صحبه الرفيق و صحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها و قد أوصى الله به إحسانا ما دام صاحبا و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره ] و قد دخل في ذلك قليل الصحبة و كثيرها و قليل الجواز و كثيره
و كذلك قال الإمام أحمد و غيره : [ كل من صحب النبي صلى الله عليه و سلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك ]
فإن قيل : فلم نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا ؟ و قال : [ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه ]
قلنا : لأن عبد الرحمن بن عوف و نظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد و أمثاله يعادونه فيه و أنفقوا أموالهم قبل الفتح و قاتلوا و هم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح و قاتلوا و كلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد و نظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية و قاتل فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله و من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين و أبعد
و قوله : [ لا تسبوا أصحابي ] خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة و السلام و هذا كقوله عليه الصلاة و السلام في حديث آخر : [ أيها الناس إني أتيتكم فقلت : إني رسول الله إليكم فقلتم : كذبت و قال أبو بكر : صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي ] أو كما قال بأبي هو و أمي صلى الله عليه و سلم قال ذلك لما عاير بعض الصحابة أبا بكر و ذاك الرجل من فضلا أصحابه و لكن امتاز أبو بكر عنه بصحته و انفرد بها عنه
و عن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم ابن ساعدة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن الله اختارني و اختار لي أصحابا جعل لي منهم و زراء و أنصارا و أصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا ] و هذا محفوظ بهذا الإسناد
و قد روى ابن ماجة بهذا الإسناد حديثا و قال أبو حاتم في تحديثه : هذا محله الصدق يكتب حديثه و لا يحتج به على انفراده و معنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار تحديثه و الاستشهاد به فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به و لا يحتج به على انفراده
و عن عبد الله بن مغفل قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فقد أحبني و من أبغضهم فقد أبغضني و من آذاهم فقد آذاني و من آذاني فقد أذى الله و من آذى الله فيوشك أن يأخذه ] رواه الترمذي : و غيره من حديث عبيدة ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن ابن زياد عنه و قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
و روى هذا المعنى من حديث أنس أيضا لفظه [ من سب أصحابي فقد سبني و من سبني فقد سب الله ] رواه ابن البناء
و عن عطاء بن أبي رباح عن النبي عليه الصلاة و السلام قال : لعن الله من سب أصحابي رواه أبو أحمد الزبيري : حدثنا محمد بن خالد عنه و قد روى عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر و رواهما اللالكائي
و قال علي بن عاصم : أنبأ أبو قحذم حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إذا ذكر القدر فأمسكوا و إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ] رواه اللالكائي
و لما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي : كان يقال : شتم أبي بكر و عمر من الكبائر و كذلك قال أبو إسحاق السبيعي : شتم أبي بكر و عمر من الكبائر التي قال تعالى : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه } [ النساء : 31 ] و إذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد و لا كفارة و قد قال صلى الله عليه و سلم : [ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ] و هذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه و العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و التابعين لهم بإحسان و سائر أهل السنة و الجماعة فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم و الاستغفار لهم و الترحم عليهم و الترضي عنهم و اعتقاد محبتهم و موالاتهم و عقوبة من أساء فيهم القول
ثم من قال : لا أقتل بشتم غير النبي صلى الله عليه و سلم فإنه يستدل بقصة أبي بكر المتقدمة و هو أن رجلا أغلظ له و في رواية شتمه فقال له أبو برزة : أقتله ؟ فانتهره و قال : ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم و بأنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية : إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود كما تقدم و لأن الله تعالى ميز بين مؤذي الله و رسوله و مؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعونا في الدنيا و الآخرة و قال في الثاني : { فقد احتمل بهتانا و إنما مبينا } [ النساء : 114 ] و مطلق البهتان و الإثم ليس بموجب للقتل و إنما هو موجب للعقوبة في الجملة فيكون عليه عقوبة مطلقة و لا يلزم من العقوبة جواز القتل و لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال : [ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو رجل قتل نفسا فيقتل بها ]
و مطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر لأن بعض من كان على عهد النبي عليه الصلاة و السلام كان ربما سب بعضهم بعضا و لم يكفر أحد بذلك و لأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر
و أما من قال : [ يقتل الساب ] أو قال : [ يكفر ] فلهم دلالات احتجوا بها منها : قوله تعالى : { محمد رسول الله و الذين معه أشداد على الكفار رحماء بينهم ـ إلى قوله تعالى ـ : ليغلظ بهم الكفار } [ الفتح : 29 ] فلا بد أن يغيظ بهما لكفار و إذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به و أخزاهم و كتبهم على كفرهم و لا يشارك الكفار في غيظهم الذي كتبوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لأن المؤمن لا يكتب جزاء للكفر
يوضح ذلك أن قوله تعالى : { ليغيظ بهم الكفار } [ الفتح : 29 ] تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه ذلك و هو الكفر
قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام : ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار ـ يعني الرافضة ـ لأن الله تعالى يقول : { ليغيظ بهم الكفار } و هذا معنى قول الإمام أحمد : ما أراه على الإسلام
و من ذلك : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من أبغضهم فقد أبغضني و من آذاهم فقد أذاني و من آذني فقد أذى الله ] و قال : [ فمن سبهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين و لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا ] و أذى الله و رسوله كفر موجب للقتل كما تقدم و بهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة و أذى سائر المسلمين و بين أذاهم بعد صحبتهم له فإنه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقا و يمكن أن يكون مرتدا فأما إذا مات مقيما على الصحبة النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير مزنون بنفاق فأذاه أذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود : اعتبروا الناس بأخدانهم و قالوا :
( عن المرء لا تسأل و سل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي )
و قال مالك رضي الله عنه : إنما هؤلاء أقوم أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة و السلام فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال : رجل سوء و لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين أو كما قال و ذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله و رسوله و يذب عن رسول الله بنفسه و ماله و يعينه على إظهار دين الله و إعلاء كلمة الله و تبليغ رسالات الله وقت الحاجة و هو حينئذ لم يستقر أمره و لم تنتشر دعوته و لم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه و معلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه و عد ذلك أذى له و إلى هذا أشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق : سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول : [ لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله ] رواه اللالكائي و كأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه و سلم [ لو اتفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم أو نصيفه ] و هذا تفاوت عظيم جدا
و من ذلك : ما روي عن علي رضي الله عنه قال : [ و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق ] رواه مسلم
و من ذلك : ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ آية الإيمان حب الأنصار و أية النفاق بغض الأنصار ] و في لفظه قال في الأنصار : [ لا يحبهم إلا مؤمن و لا يبغضهم إلا منافق ]
و في الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الأنصار [ لا يحبهم إلا مؤمن و لا يبغضهم إلا منا فق من أحبهم أحبه الله و من أبغضهم أبغضه الله ]
و لمسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله و اليوم الآخر ]
و روى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله و اليوم الآخر ]
فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر و إنما خص الأنصار ـ و الله أعلم ـ لأنهم هم الذين تبوؤوا الدار و الإيمان من قبل المهاجرين و آووا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نصروه و منعوه و بذلوا في إقامة الدين النفوس و الأموال و عادوا الأحمر و الأسود من أجله و آووا المهاجرين و واسوهم في الأموال و كان المهاجرين إذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين و من عرف السيرة و أيام رسول الله عليه الصلاة و السلام و ما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمنا يحب الله و رسوله لم يملك أن لا يحبهم كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم و أراد بذلك ـ و الله أعلم ـ أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون و الأنصار يقلون و أن الأمر سيكون في المهاجرين فمن شارك الأنصار في نصر الله و رسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله } [ الصف : 14 ] فبغض من نصر الله و رسوله من أصحابه نفاق
و من هذا : ما رواه طلحة بن مصرف قال : [ كان يقال : بغض بني هاشم نفاق و بغض أبي بكر و عمر نفاق و الشاك في أبي بكر كالشاك في السنة ]
و من ذلك : ما رواه كثير النواء [ عن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال رسول الله عليه الصلاة و السلام : يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ] هكذا رواه عبد الرحمن بن أحمد في مسند أبيه
و في السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل : ثنا كثير و رواه أيضا من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفعه قال : [ يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام ] و كثير النواء [ و يضعفونه ]
و روى أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني ـ أو النخعي ـ عن عمه عن علي قال : قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ يا علي أنت و شيعك في الجنة و إن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون ] قال علي : ينتحلون حبنا أهل البيت و ليسوا كذلك و آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما
و رواه عبد الله بن أحمد : [ حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا أبو يحيى و رواه أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال : قال علي : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة ؟ و أنك من أهل الجنة إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون ] قال : و قال علي رضي الله عنه : سيكون بعدنا قوم سيكون ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما
و رواه أبو القاسم البغوي : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن حازم عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي رضي الله عنه قال : [ يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة يعرفون به و ينتحلون شيعتنا و ليسوا من شيعتنا و آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر و عمر و أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون ]
و قال سويد : حدثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن أبيه و كانت أخته سرية لعلي رضي الله عنه قال : سمعت عليا يقول : [ يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون ] فهذا الموقوف على علي رضي الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع
و روي هذا المعنى مرفوعا من حديث أم سلمة و في إسناده سوار بن مصعب و هو متروك
و روى ابن بطة بإسناده عن أنس قال : رسول الله عليه الصلاة و السلام [ [ إن الله ] اختارني و اختار أصحابي فجعلهم أنصاري و جعلهم أصهاري و إنه سيجيء في آخر الزمان قوم يبغضوهم ألا فلا تواكلوهم و لا تشاربوهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تصلوا معهم و لا تصلوا عليهم عليهم حلت اللعنة ] و في هذا الحديث نظر
و روى ما هو أغرب من هذا و أضعف رواه ابن البناء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ و لا تسبوا أصحابي فإن كفارتهم القتل ]
و أيضا فإن هذا مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فروى أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال : بلغ علي بن أبي طالب أن عبد الله بن سوداء يبغض أبا بكر و عمر فهم يقتله فقيل له : تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت ؟ فقال : لا يساكنني في دار أبدا
و في رواية عن شباك قال : بلغ عليا أن ابن السوداء يبغض أبا بكر و عمر قال : فدعاه و دعا بالسيف أو قال : فهم بقتله فكلم فيه فقال : لا يساكنني ببلد أنا فيه فنفاه إلى المدائن و هذا محفوظ عن أبي الأحوص و قد رواه النجاد و ابن بطة و اللالكائي و غيرهم و مراسيل إبراهيم جياد و لا يظهر عن علي رضي الله عنه أنه يريد قتل رجل إلا و قتله حلال عنده و يشبه ـ و الله أعلم ـ أن يكون إنما تركه خوف الفتنة بقتله كما كان النبي عليه الصلاة و السلام يمسك عن قتل بعض المنافقين فإن الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عثمان رضي الله عنه و صار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم و بسبب هذا و شبهه كانت فتنة الجمل
و عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قال : قلت لأبي : يا أبت لو كنت سمعت رجلا يسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكفر أكنت تضرب عنقه ؟ قال : نعم رواه الإمام أحمد و غيره و رواه ابن عيينة عن خلف ابن خوشب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : قلت لأبي : لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعا ؟ قال : أضرب عنقه قلت : فعمر ؟ قال : أضرب عنقه و عبد الرحمن بن أبزى من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أدركه و صلى خلفه و أقره عمر رضي الله عنه عاملآ على مكة و قال : هو ممن رفعه الله بالقرآن بعد أن قيل له : إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله و استعمله علي رضي الله عنه على خراسان
و روى قيس بن الربيع عن وائل عن البهي قال : وقع بين عبد الله بن عمر و بين المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر : [ علي بالحداد أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده يشتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ] و في رواية : [ فهم عمر بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فقال : ذروني أقطع لسان ابني لا يجترئ أحد بعده يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم رواه حنبل و ابن بطة و اللالكائي و غيرهم و لعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق و هم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و لعل المقداد كان فيهم ]
و عن عمر بن الخطاب أنه أتي بأعرابي يهجو الأنصار فقال : [ لولا أن له صحبة لكفيتكموه ] رواه أبو ذر الهروي
و يؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال : [ سمعت عليا يقول لا يفضلني أحد على أبي بكر و عمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري ] و عن علمقة بن قيس قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال : [ إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر عمر و لو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه و لكني أكره العقوبة قبل التقدم و من قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر ] رواهما عبد الله ابن أحمد و روى ذلك ابن بطة و اللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن علي في خطبة طويلة خطبها
و روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال : [ تداروا في أبي بكر و عمر فقال رجل من عطارد : عمر أفضل من أبي بكر فقال الجارود : بل أبو بكر أفضل منه قال : فبلغ ذلك عمر قال : فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجله ثم أقبل إلى الجارود فقال : إليك عنى ثم قال عمر : أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة و السلام في كذا و كذا ثم قال عمر : من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري ]
فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر و علي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر و عمر أو من يفضل عمر على أبي بكر ـ مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب و لا عيب ـ علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير
أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي و إنما غلط جبرئيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره
و كذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات و كتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة و نحو ذلك و هؤلاء يسمون القرامطة و الباطنية و منهم التناسخية و هؤلاء لا خلاف في كفرهم
و أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم ـ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد و نحو ذلك ـ فهذا هو الذي يستحق التأديب و التعزير و لا نحكم بكفره بمجرد ذلك و على هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم
و أما من لعن و قبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد
و أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و السلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم و الثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب و السنة كفار أو فساق و أن هذه الآية التي هي { كنتم خير أمة أخرجت للناس } [ آل عمران : 110 ] و خيرها هو القرآن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارهم و كفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام
و لهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق و عامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم و قد ظهرت لله فيهم مثلات و تواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا و الممات و جمع العلماء ما بلغهم في ذلك ممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب و ما جاء فيه من الإثم و العقاب
و بالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره و منهم من لا يحكم بكفره و منهم من تردد فيه و ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك و إنما ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها
فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب ذكرنا ما يسره الله و اقتضاه الوقت و الله سبحانه يجعله لوجهه خالصا و ينفع به و يستعملنا فيما يرضاه من القول و العمل
و الحمد لله رب العالمين و صلى الله عل سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا كثيرا
* * *
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على رسوله المؤيد بباهر المعجزات و على آله و صحبه ذوي المروءات و على علماء أمته الذين اهتدوا بهداه و وفقهم الله لما يحبه و يرضاه