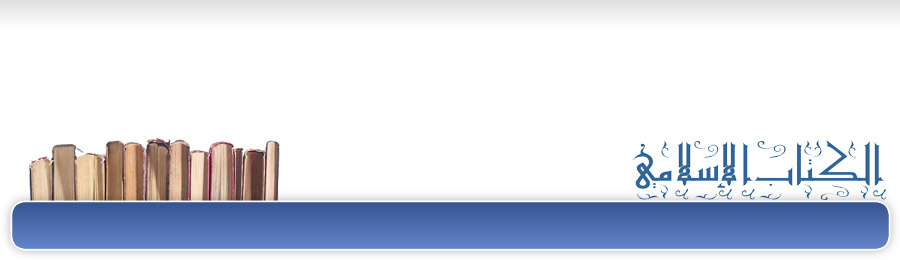كتاب : الرسائل
المؤلف : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ
وخصصنا في أيامنا وزماننا بفتية أشراف، وخلان نظاف، انتظم لهم من آلات الفتوة وأسباب المروءة ما كان محجوباً عن غيرهم، معدوماً من سواهم، فحملني الكلف والمودة لهم والسرور بتخليد فخرهم وتشييد ذكرهم والحرص على تقويم أود ذي الأود منهم حتى يلحق بأهل الكمال في صناعته، والفضل في معرفته، على تمييز طبقة طبقة منهم، وتسمية أهل كل طبقة بأوصافهم، وآلاتهم وأدواتهم، والمذاهب التي نسبوا إليها أنفسهم، واحتملهم إخوانهم عليها. وخلطنا جداً بهزل، ومزجنا تقريعاً بتعريض، ولم نرد بأحد مما سمينا سوءاً، ولا تعمدنا نقداً ولا تجاوزنا حداً.
ولو استعملنا غير الصدق لفضلنا قوماً وحابينا آخرين. ولم نفعل ذلك؛ تجنباً للحيف، وقصداً للإنصاف. وقد نعلم أن كثيراً منهم سيبالغ في الذم، ويحتفل في الشتم، ويذهب في ذلك غير مذهبنا.
وما أيسر ذلك فيما يجب من حقوق الفتيان وتفكيههم، والله حسيب من ظلم، عليه نتوكل وبه نستعين، وهو رب العرش العظيم.
ولم نقصد في وصف من وصفنا من الطبقات التي صنفنا منهم، إلا لمن أدركنا من أهل زماننا ممن حصل بمدينة السلام، إذ من خرج عنها ونزع إلى الفتوة بعد التوبة، وإلى أخلاق الحداثة بعد الحنكة، وذلك في سنة خمس عشرة ومائتين. فرحم الله أمراً أحسن في ذلك أمرنا، وحذا فيه حذونا، ولم يعجل إلى ذمنا، ودعا بالمغفرة والرحمة لنا.
وقد تركنا في كل باب من الأبواب التي صنفنا في كتابنا، فرجاً لزيادة إن زادت، ولاحقة إن لحقت، أو نابتة إن نبتت. ومن عسى أن ينتقل به الحذق من مرتبته إلى ما هو أعلى منها، أو يعجز به القصور عما هو عليه منها إلى ما هو دونها، إلى مكانه الذي إليه نقله ارتفاع درجة أو انحطاطها، ومن لعلنا نصير إلى ذكره ممن عزب عنا ذكره، وأنسينا اسمه، ولم يحط علمنا به، فنصيره في موضعه، ونلحقه بأصحابنا.
وليس لأحد أن يثبت شيئاً من هذه الأصناف إلا بعلمنا، ولا يستبد بأمر فيه دوننا. ويورد ذلك علينا فنمتحنه، ونعرفه بما عنده، ويصير إلى ترتيبه في المرتبة التي يستحقها، والطبقة التي يحتملها.
فلما استتب لنا الفراغ مما أردنا من ذلك خطر ببالنا كثرة العيابين من الجهال برب العالمين، فلم نأمن أن يسرعوا بسفه رأيهم وخفة أحلامهم إلى نقض كتابنا وتبديله، وتحريفه عن مواضعه، وإزالته عن أماكنه التي عليها رسمنا، وأن يقول كل امرىء منهم في ذلك على حاله، وبقدر هواه ورأيه، وموافقته ومخالفته، والميل في ذلك إلى بعض، والذم لطبقة والحمد لأخرى، فيهجنوا كتابنا، ويلحقوا بنا ما ليس من شأننا.
وأحببنا أن نأخذ في ذلك بالحزم، وأن نحتاط فيه لأنفسنا ومن ضمه كتابنا، ونبادر إلى تفريق نسخ منها وتصييرها في أيدي الثقات والمستبصرين، الذين كانوا في هذا الشأن، ثم ختموا ذلك بالعزلة والتوبة منه، كصالح بن أبي صالح، وكأحمد بن سلام، وصالح مولى رشيدة.
ففعلنا ذلك وصيرناه أمانة في أعناقهم، ونسخة باقية في أيديهم، ووثقنا بهم أمناء ومستودعين وحفظة غير مضيعين ولا متهمين. وعلمنا أنهم لا يدعون صيانة ما استودعوا، وحفظ ما عليه ائتمنوا.
فإن شيب به شوب يخالفه، وأضيف إليه ما لا يلائمه، رجعنا إلى النسخة المنصوبة، والأصول المخلدة عند ذوي الأمانة والثقة، واقتصرنا عليها، واستعلينا بها على المبطلين، ودفعنا بها إدغال المدغلين، وتحريف المحرفين، وتزيد المتزيدين، إن شاء الله.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فصل من صدر كتابه في النساء
إنا لما ذكرنا في كتابنا هذا الحب الذي هو أصل الهوى، والهوى الذي يتفرع منه العشق، والعشق الذي يهيم له الإنسان على وجهه أو يموت كمداً على فراشه. وأول ذلك إدخال الضيم على مروءته، واستشعار الذلة لمن أطاف بعشيقته.ولم نطنب مع ذلك في ذكر ما يتشعب من أصل الحب من الرحمة والرقة، وحب الأموال النفيسة والمراتب الرفيعة، وحب الرعية للأئمة، وحب المصطنع لصاحب الصنيعة، مع اختلاف مواقع ذلك من النفوس، ومع تفاوت طبقاته في العواقب، احتجنا إلى الاعتذار من ذكر العشق المعروف بالصبابة، والمخالفة على قوة العزيمة، لنجعل ذلك القدر جنة دون من حاول الطعن على هذا الكتاب، وسخف الرأي الذي دعا إلى تأليفه، والإشادة بذكره. إذا كانت الدنيا لا تنفك من حاسد باغ، ومن قائل متكلف، ومن سامع طاعن، ومن منافس مقصر. كما أنها لا تنفك من ذي سلامة متسلم، ومن عالم متعلم، ومن عظيم الخطر حسن المحضر، شديد المحاماة على حقوق الأدباء، قليل التسرع إلى أعراض العلماء.
وإنما العشق اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه حب. وليس كل حب يسمى عشقاً، وإنما العشق اسم للفاضل عن ذلك المقدار، كما أن السرف اسم لما زاد على المقدار الذي يسمى جوداً، والبخل اسم لما نقص عن المقدار الذي يسمى اقتصاداً، والجبن اسم لما قصر عن المقدار الذي يسمى شجاعة.
وهذا القول ظاهر على ألسنة الأدباء، مستعمل في بيان الحكماء. وقد قال عروة بن الزبير: " والله إني لأعشق الشرف كما تعشق المرأة الحسناء " .
وذكر بعض الناس رجلاً كان مدقعاً محروماً، ومنحوس الحظ ممنوعاً، فقال: " ما رأيت أحداً عشق الرزق عشقه، ولا أبغضه الرزق بغضه! " فذكر الأول عشق الشرف، وليس الشرف بامرأة، وذكر الآخر عشق الرزق والرزق اسم جامع لجميع الحاجات.
وقد يستعمل الناس الكناية، وربما وضعوا الكلمة بدل الكلمة، يريدون أن يظهر المعنى بألين اللفظ، إما تنويهاً وإما تفضيلاً، كما سموا المعزول عن ولايته مصروفاً، والمنهزم عن عدوه منحازاً. نعم، حتى سمى بعضهم البخيل مقتصداً ومصلحاً، وسمي عامل الخراج المتعدي بحق السلطان مستقصياً.
ولما رأينا الحب من أكبر أسباب جماع الخير، ورأينا البغض من أكبر أسباب الشر، أحببنا أن نذكر أبواب السبب الجالب للخير، ليفرق بينه وبين أبواب السبب الجالب للشر حتى نذكر أصولهما وعللهما الداعية إليهما، والموجبة لكونهما.
فتأملنا شأن الدنيا فوجدنا أكبر نعيمها وأكمل لذاتها، ظفر المحب بحبيبه، والعاشق بطلبته، ووجدنا شقوة الطالب المكدي وغمه، في وزن سعادة الطالب المنجح وسروره، ووجدنا العشق كلما كان أرسخ، وصاحبه به أكلف، فإن موقع لذة الظفر منه أرسخ، وسروره بذلك أبهج.
فإن زعم زاعم أن موقع لذة الظفر بعدوه المرصد أحسن من موقع لذة الظفر من العاشق الهائم بعشيقته.
قلنا: إنا قد رأينا الكرام والحلماء، وأهل السؤدد والعظماء، ربما جادوا بفضلهم من لذة شفاء الغيظ، ويعدون ذلك زيادة في نبل النفس، وبعد الهمة والقدر. ويجودون بالنفيس من الصامت والناطق، وبالثمين من العروض. وربما خرج من جميع ماله، وآثر طيب الذكر على الغني واليسر. ولم نر نفس العاشق تسخو بمعشوقه، ويجود بشقيقة نفسه لوالد ولا لولد بار، ولا لذي نعمة سابغة يخاف سلبها، وصرف إحسانه عنه بسببها.
ولم نر الرجال يهبون للرجال إلا ما لا بال به، في جنب ما يهبون للنساء. حتى كأن العطر والصبغ، والخضاب والكحل، والنتف والقص، والتحذيف والحلق، وتجويد الثياب وتنظيفها، والقيام عليها وتعهدها، مما لم يتكلفوه إلا لهن، ولم يتقدموا فيه إلا من أجلهن، وحتى كأن الحيطان الرفيعة، والأبواب الوثيقة، والستور الكثيفة، والخصيان والظؤورة، والحشوة والحواضن لم تتخذ إلا للصون لهن، والاحتفاظ بما يجب من حفظ النعمة فيهن.
فصل منه
وباب آخر: وهو أنا لم نجد أحداً من الناس عشق والديه ولا ولده، ولا من عشق مراكبه ومنزله، كما رأيناهم يموتون من عشق النساء الحرام. قال الله تعالى: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث " .فقد ذكر تبارك وتعالى جملة أصناف ما خولهم من كرامته، ومن عليهم من نعمته، ولم نر الناس وجدوا بشيء من هذه الأصناف وجدهم بالنساء. ولقد قدم ذكرهن في هذه الآية على قدر تقدمهن في قلوبهم.
فإن قال قائل: فقد نجد الرجل الحليم، والشيخ الركين، يسمع الصوت المطرب من المغني المصيب، فينقله ذلك إلى طبع الصبيان، وإلى أفعال المجانين، فيشق جيبه، وينقض حبوته، ويفدي غيره، ويرقص كما يرقص الحدث الغرير، والشاب السفيه. ولم نجد أحداً فعل ذلك عند رؤية معشوقه.
قلنا: أما واحدة فإنه لم يكن ليدع التشاغل بشمها وبرشفها، واحتضانها، وتقبيل قدميها، والمواضع التي وطئت عليها، ويتشاغل بالرقص المباين لها، والصراخ الشاغل عنها. فأما حل الحبوة، والشد حضراً عند رؤية الحبيبة فإن هذا مما لا يحتاج إلى ذكره، لوجوده وكثرة استعمالهم له، فكيف وهو إن خلا بمعشوقه لا يظن أن لذة الغناء تشغله بمقدار العشر من لذته، بل ربما لم يخطر له ذلك الغناء على بال.
وعلى أن ذلك الطرب مجتاز غير لابث، وظاعن غير مقيم؛ ولذة المتعاشقين راكدة أبداً مقيمة غير ظاعنة.
وعلى أن الغناء الحسن من الوجه الحسن والبدن الحسن، أحسن، والغناء الشهي من الوجه الشهي والبدن الشهي أشهى. وكذلك الصوت الناعم الرخيم من الجارية الناعمة الرخيمة.
وكم بين أن يفدى إذا شاع فيك الطرب مملوكك، وبين أن يفدى أمتك وكم بين أن يسمع الغناء من فم تشتهي أن تقبله، وبين فم تشتهي أن تصرف وجهك عنه.
وعلى أن الرجال دخلاء على النساء في الغناء، كما رأينا رجالاً ينوحون، فصاروا دخلاء على النوائح.
وبعد، فأيما أملح وأحسن، وأشهى وأغنج، أن يغنيك فحل ملتف اللحية، كث العارضين، أو شيخ منخلع الأسنان، مغضن الوجه، ثم يغنيك إذا هو تغنى بشعر ورقاء بن زهير:
رأيت زهيراً تحت كلكل خالد ... فأقبلت أسعى كالعجول أبادر
أم تغنيك جارية كأنها طاقة نرجس، أو كأنها ياسمينة، أو كأنها خرطت من ياقوتة، أو من فضة مجلوة، بشعر عكاشة بن محصن:
من كف جارية كأن بناتها ... من فضة قد طرفت عنابا
وكأن يمناها إذا نطقت به ... ألقت على يدها الشمال حسابا
فصل منه
فأما الغناء المطرب في الشعر الغزل فإنما ذلك من حقوق النساء. وإنما ينبغي أن تغني بأشعار الغزل والتشبيب، والعشق، والصبابة بالنساء اللواتي فيهن نطقت تلك الأشعار، ويهن شبب الرجال، ومن أجلهن تكلفوا القول في النسيب.وبعد، فكل شيء وطبقه، وشكله ولفقه، حتى تخرج الأمور موزونة معدلة، ومتساوية مخلصة.
ولو ان رجلاً من أدمث الناس وأشدهم تلخيصاً لكلامهم، ومحاسبة لنفسه، ثم جلس مع امرأة لا تزن بمنطق، ولا تعرف بحسن حديث، ثم كان يعشقها، لتناتج بينهما من الأحاديث، ولتلاقح بينهما من المعاني والألفاظ، ما كان لا يجري بين دغفل بن حنظلة، وبين ابن لسان الحمرة. وإنما هذا على قدر تمكن الغزل في الرجل.
فصل منه
والمرأة أيضاً أرفع حالاً من الرجل في أمور. منها: أنها التي تخطب وتراد، وتعشق وتطلب، وهي التي تفدى وتحمى. قال عنبسة بن سعيد للحجاج بن يوسف: أيفدي الأمير أهله قال: والله إن تعدونني إلا شيطاناً، والله لربما رأيتني أقبل رجل إحداهن!فصل منه
وإنما يملك المولى من عبده بدنه، فأما قلبه فليس له عليه سلطان.والسلطان نفسه وإن ملك رقاب الأمة، فالناس يختلفون في جهة الطاعة، فمنهم من يطيع بالرغبة، ومنهم من يطيع بالرهبة، ومنهم من يطيع بالمحبة، ومنهم من يطيع بالديانة.
وهذه الأصناف، وإن كان أفضلها طاعة الديانة فإن تلك المحبة ما لم يمازجها هوىً لم تقو على صاحبها قوة العشق. وفي الأثر المستفيض والمثل السائر: " إن الهوى يعمي ويصم " ؛ فالعشق يقتل.
فصل منه
ومما يستدل به على تعظيم شأن النساء أن الرجل يستحلف بالله الذي لا شيء أعظم منه، وبالمشي إلى بيت الله، وبصدقة ماله، وعتق رقيقه. فيسهل ذلك عليه، ولا يأنف منه. فإن استحلف بطلاق امرأته تربد وجهه، وطار الغضب في دماغه، ويمتنع ويعصي، ويغضب ويأبى، وإن كان المحلف سلطاناً مهيباً، ولو لم يكن يحبها، ولا يستكثر منها، وكانت نفسها قبيحة المنظر، دقيقة الحسب، خفيفة الصداق، قليلة النسب.ليس ذلك إلا لما قد عظم الله من شأن الزوجات في صدور الأزواج.
فصل منه في ذكر الولد
وباب آخر: وهو أنا لو خيرنا رجلاً بين الفقر أيام حياته، وبين أن يكون ممتعاً بالباه أيام حياته، لاختار الفقر الدائم مع التمتع الدائم.وليس شيء مما يحدث الله لعباده من أصناف نعمه وضروب فوائده، أبقى ذكراً، ولا أجل خطراً من أن يكون للرجل ابن يكون ولي بناته، وساتر عورة حرمه، وقاضي دينه، ومحيي ذكره، مخلصاً في الدعاء له بعد موته، وقائماً بعده في كل ما خلفه مقام نفسه.
فمن أقل أسفاً على ما فارق، ممن خلف كافياً مجرباً، وحائطاً من وراء المال موفراً، ومن وراء الحرم حامياً، ولسلفه في الناس محبباً. وقال رجل لعبد الملك بن مروان، وقد ذكر ولد له: " أراك الله في بنيك ما أرى أباك فيك، وأرى بنيك فيك ما أراك في أبيك! " .
ونظر شيخ وهو عند المهلب إلى بنيه قد أقبلوا فقال: " آنس الله بكم لاحقكم، فوالله إن لم تكونوا أسباط نبوة إنكم أسباط ملحمة " .
وليست النعمة في الولد المحيي، والخلف الكافي، بصغيرة.
فصل منه
وباب آخر: وهو أن الله تعالى خلق من المرأة ولداً من غير ذكر، ولم يخلق من الرجل ولداً من غير أنثى. فخص بالآية العجيبة والبرهان المنير المرأة دون الرجل، كما خلق المسيح في بطن مريم من غير ذكر.فصل منه
في ذكر القراباتوأما أنا فإني أقول: إن تباغض الأقرباء عارض دخيل، وتحابهم واطد أصيل، والسلامة من ذلك أعم، والتناصر أظهر، والتصادق في المودة أكثر. فلذلك القبيلة تنزل معاً وترحل معاً، وتحارب من ناوأها معاً، إلا الشاذ النادر، كخروج غني وباهلة من غطفان، وكنزول عبس في بني عامر، وما أشبه ذلك. وإلا فإن القرابة يد واحدة على من ناوأهم، وسيف واحد على من عاداهم، وما صلاح شأن العشائر إلا بتقارب سادتهم في القدر، وإن تفاوتوا في الرياسة والفضل، كما قال في الأثر المستفيض: " لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا تقاربوا هلكوا " .
وحال العامة في ذلك كحال الخاصة.
فصل منه
وقضية واجبة: أن الناس لا يصلحهم إلا رئيس واحد، يجمع شملهم، ويكفيهم ويحميهم من عدوهم، ويمنع قويهم من ضعيفهم.وقليل له نظام، أقوى من كثير نشر لا نظام لهم، ولا رئيس عليهم. إذ قد علم الله أن صلاح عامة البهائم في أن يجعل لكل جنس منها فحلاً يوردها الماء ويصدرها، وتتبعه إلى الكلأ، كالعير في العانة، والفحل من الإبل في الهجمة، وكذلك النحل العسالة، والكراكي، وما يحمي الفرس الحصان الحجور في المروج، فجعل منها رءوساً متبوعة، وأذناباً تابعة.
ولو لم يقم الله للناس الوزعة من السلطان، والحماة من الملوك وأهل الحياطة عليهم من الأئمة لعادوا نشراً لا نظام لهم، ومستكلبين لا زاجر لهم، ولكان من عز بز، ومن قدر قهر، ولما زال اليسر راكداً، والهرج ظاهراً، حتى يكون التغابن والبوار، وحتى تنطمس منهم الآثار؛ ولكانت الأنعام طعاماً للسباع، وكانت عاجزة عن حماية أنفسها، جاهلة بكثير من مصالح شأنها.
فوصل الله تعالى عجزها بقوة من أحوجه إلى الاستمتاع بها، ووصل جهلها بمعرفة من عرف كيف وجه الحيلة في صونها والدفاع عنها.
وكذلك فرض على الأئمة أن يحوطوا الدهماء بالحراسة لها، والذياد عنها، وبرد قويها عن ضعيفها، وجاهلها عن عالمها، وظالمها عن مظلومها، وسفيهها عن حليمها.
فلولا السائس ضاع المسوس، ولولا قوة الراعي لهلكت الرعية.
فصل منه
وانفراد السيد بالسيادة كانفراد الإمام بالإمامة. وبالسلامة من تنازع الرؤساء تجتمع الكلمة، وتكون الألفة، ويصلح شأن الجماعة. وإذا كانت الجماعة انتهت الأعداء، وانقطعت الأهواء.فصل منه
ولسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل: إن النساء فوق الرجال، أو دونهم بطبقة أو طبقتين، أو بأكثر، ولكنارأينا ناساً يزرون عليهن أشد الزراية، ويحتقرونهن أشد الاحتقار، ويبخسونهن أكثر حقوقهن.وإن من العجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا بأن ينكر حقوق الأمهات والأخوال، فلذلك ذكرنا جملة ما للنساء من المحاسن.
ولولا أن ناساً يفخرون بالجلد وقوة المنة، وانصراف النفس عن حب النساء، حتى جعلوا شدة حب الرجل لأمته، وزوجته وولده، دليلاً على الضعف، وباباً من الخور، لما تكلفنا كثيراً مما شرطناه في هذا الكتاب.
فصل منه
كما نحب أن يخرج هذا الكتاب تاماً، ويكون للأشكال الداخلة فيه جامعاً، وهو القول فيما للذكور والإناث في عامة أصناف الحيوان، وما أمكن من ذلك، حتى يحصل ما لكل جنس منها من الخصال المحمودة والمذمومة. ثم يجمع بين المحاسن منها والمساوىْ، حتى يستبين لقارىء الكتاب نقصان المفضول من رجحان الفاضل، بما جاء في ذلك من الكتاب الناطق، والخبر الصادق، والشاهد العدل، والمثل السائر. حتى يكون الكتاب عربياً أعرابياً، وسنياً جماعياً، وحتى يجتنب فيه العويص والطرق المتوعرة، والألفاظ المستنكرة، وتلزيق المتكلفين، وتلفيق أصحاب الهواء من المتكلمين، حتى نظرنا لمن لا يعلم مقادير ما استخزنها الله من المنافع، وغشاها من البرهانات، وألزمها من الدلالة عليه، وأنطقها به من الحجة له.
فمنع من ذلك فرط الكبرة، وإفراط العلة، وضعف المنة، وانحلال القوة.
فلما وافق هذا الكتاب منا هذه الحال، وألفى قلوبنا على هذه الأشغال، اجتنبنا أن نقصد من جميع ذلك إلى فرق ما بين الرجل والمرأة.
فلما اعتزمنا على ما ابتدأنا به وجدناه قد اشتمل على أبواب يكثر عددها، وتبعد غايتها، فرأينا، والله الموفق، أن نقتصر منه على ما لا يبلغ بالمستمع إلى السآمة، وبالمألوف إلى مجاوزة القدر.
وليس ينبغي لكتب الآداب والرياضيات أن يحمل أصحابها على الجد الصرف، وعلى العقل المحض، وعلى الحق المر، وعلى المعاني الصعبة، التي تستكد النفوس، وتستفرغ المجهود.
وللصبر غاية، وللاحتمال نهاية.
ولا بأس بأن يكون الكتاب موشحاً ببعض الهزل. وعلى أن الكتاب إذا كثر هزله سخف، كما أنه إذا كثر جده ثقل.
ولا بد للكتاب من أن يكون فيه بعض ما ينشط القارىء، وينفي النعاس عن المستمع. فمن وجد في كتابنا هذا بعض ما ذكرنا، فليعلم أن قصدنا في ذلك إنما كان على جهة الاستدعاء لقلبه، والاستمالة لسمعه وبصره. والله تعالى نسأل التوفيق.
فصل منه في ذكر العشق
ورجلان من الناس لا يعشقان عشق الأعراب: أحدهما الفقير المدقع، فإن قلبه يشغل عن التوغل فيه وبلوغ أقصاه.والملك الضخم الشأن، لأن في الرياسة الكبرى، وفي جواز الأمر ونفاذ النهي، وفي ملك رقاب الأمم، ما يشغل شطر قوى العقل عن التوغل في الحب، والاحتراق في العشق.
فصل منه
كثيراً ما يعتري العشاق والمحبين غير المحترقين، كالرجل تكون له جارية وقد حلت من قلبه محلاً، وتمكنت منه تمكناً، ولا يجتث أصل ذلك الحب الغضبة تعرض، وكثرة التأذي بالخلاف يكون منها، فيجد الفترة عنها في بعض هذه الحالات التي تعرض، فيظن أنه قد سلا، أو يظن أنه في عزائه عنها على فقدها محتملاً، فيبيعها إن كانت أمة، أو يطلقها إن كانت زوجة، فلا ينشب ذلك الغضب أن يزول، وذلك الأذى أن ينسى، فتتحرك له الدفائن، و يثمر ذلك الغرس، فيتبعها قلبه، فإما أن يسترجع الأمة من مبتاعها، بأضعاف ثمنها، أو يسترجع الزوجة بعد أن نكحت. فإن تصبر وأمكنه الصبر لم يزل معذباً، وإن أطاع هواه واحتمل المكروه فهذا هو العقابيل والنكس.فليحذر الحازم الفترة في حب حبيبه، والغضبة التي تنسيه عواقب أمره.
فصل منه
قال ابراهيم بن السندي: حدثني عبد الملك بن صالح قال: بينا عيسى بن موسى قد خلا بنفسه، وهو قد كان استكثر من النساء حتى انقطع، إذ مرت به جارية كأنها جان، وكأنها جدل عنان، وكأنها جمارة، وكأنها قضيب فضة، فتحركت نفسه، وخاف أن تخذله قوته، ثم طمع في القوة لطول الترك، واجتماع الماء، فلما صرعها، وجلس منها ذلك المجلس خطر على باله لو عجز كيف يكون حاله فلما فكر فتر، فأقبل كالمخاطب لنفسه فقال: إنك لتجلسيني هذا المجلس، وتحمليني على هذا المركب، ثم تخذليني هذا الخذلان وتغشيني مثل هذا الذل، ولولا حيرة الخجل لم أستعمل ما لا يقتل! وذلك أنه حين رأى أن أبلغ الحيل في توهيمها أن العجز لم يكن من قبله أن يقول لها: تعرضين لي وأنت تفلة، ثم لا ترخين باديك، ولا تستهدفين لسيدك، ولا تعينين على نفسك، حتى كأنك عند عبد يشبهك، أو سوقة لا يقدر إلا على مثلك. أما لو كنت من بنات ملوك العجم لألفاك سيدك على أجود صنعة، وعلى أحسن طاعة، إذ كل رجل ينبسط للتمتع مع التفل.فصل منه
ولم أسمع ولم أقرأ في الأحاديث المولدة، في شأن العشاق، وما صنع العشق في القلوب والأكباد والأحشاء، والزفرات والحنين، وفي التدليه والتوليه، متى تستعر الدمعة، ومتى يورث العين الجمود.
فصل منه
ونحن وإن رأينا أن فضل الرجل على المرأة، في جملة القول في الرجال والنساء، أكثر وأظهر، فليس ينبغي لنا أن نقصر في حقوق المرأة. وليس ينبغي لمن عظم حقوق الآباء أن يصغر حقوق الأمهات، وكذلك الإخوة والأخوات، والبنون والبنات. وأنا وإن كنت أرى أن حق هذا أعظم فإن هذه أرحم.فصل من احتجاجه للإماء
قال بعض من احتج للعلة التي من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر المهيرات: أن الرجل قبل أن يملك الأمة قد تأمل منها كل شيء وعرفه، ما خلا حظوة الخلوة، فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة. والحرة إنما يستشار في جمالها النساء، والنساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن قليلاً ولا كثيراً. والرجال بالنساء أبصر. وإنما تعرف المرأة من المرأة ظاهر الصفة، وأما الخصائص التي تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك.وقد تحسن المرأة أن تقول: كأن أنفها السيف، وكأن عينها عين غزال، وكأن عنقها إبريق فضة، وكأن ساقها جمارة، وكأن شعرها العناقيد، وكأن أطرافها المداري، وما أشبه ذلك.
وهناك أسباب أخر بها يكون الحب والبغض.
فصل منه
وقد علم الشاعر وعرف الواصف، أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبية، وأحسن من البقرة، وأحسن من كل شيء تشبه به، ولكنهم إذا أرادوا القول شبهوها بأحسن ما يجدون.ويقول بعضهم: كأنها الشمس، وكأنها القمر! والشمس وإن كانت بهية فإنما هي شيء واحد، وفي وجه الجارية الحسناء وخلقها ضروب من الحسن الغريب والتركيب العجيب.
ومن يشك أن عين المرأة الحسناء أحسن من عين البقرة، وأن جيدها أحسن من جيد الظبية، والأمر فيما بينهما متفاوت، ولكنهم لو لم يفعلوا هذا وشبهه لم تظهر بلاغتهم وفطنتهم.
فصل منه
ورأيت أكثر الناس من البصراء بجواهر النساء، الذين هم جهابذة هذا الأمر، يقدمون المجدولة، والمجدولة من النساء تكون في منزلة بين السمينة والممشوقة.ولا بد من جودة القد، وحسن الخرط، واعتدال المنكبين، واستواء الظهر، ولا بد أن تكون كاسية العظام، بين الممتلئة والقضيفة.
وإنما يريدون بقولهم: مجدولة، جودة العصب، وقلة الاسترخاء، وأن تكون سليمة من الزوائد والفضول.
وكذلك قالوا: خمصانة وسيفانة، وكأنها جان، وكأنها جدل عنان، وكأنها قضيب خيزران.
والتثني في مشيها أحسن ما فيها، ولا يمكن ذلك الضخمة والسمينة، وذات الفضول والزوائد.
على أن النحافة في المجدولة أعم، وهي بهذا المعنى أعرف، تحبب على السمان الضخام، وعلى الممشوقات والقضاف، كما يحبب هذه الأصناف على المجدولات.
ووصفوا المجدولة بالكلام المنثور فقالوا: " أعلاها قضيب، وأسفلها كثيب " .
فصل من صدر رسالته إلى الفتح بن خاقان
في مناقب الترك وعامة جند الخلافة
وفقك الله لرشدك، وأعان على شكرك، وأصلحك وأصلح على يديك، وجعلنا وإياك ممن يقول بالحق ويعمل به، ويؤثره، ويحتمل ما فيه مما قد يصد عنه، ولا يكون حظه منه الوصف له، والمعرفة به، دون الحث عليه، والانقطاع إليه، وكشف القناع فيه، وإيصاله إلى أهله، والصبر على المحافظة في أن لا يصل إلى غيرهم، والتثبت في تحقيقه لديهم؛ فإن الله تعالى لم يعلم الناس ليكونوا عالمين دون أن يكونوا عاملين، وإنما علمهم ليعملوا، وبين لهم ليتقوا التورط في وسط الخوف، والوقوع في المضار، والتوسط في المهالك. فلذلك طلب الناس التبين.ولحب السلامة من الهلكة، والرغبة في المنفعة احتملوا ثقل التعلم، وتعجلوا مكروه ثقل المعاناة.
ولقلة العاملين وكثرة الواصفين قال الأولون: العارفون أكثر من الواصفين، والواصفون أكثر من العاملين.
وإنما كثرت الصفات وقلت الموصوفات لأن ثواب العمل مؤجل، واحتمال ما فيه معجل.
وقد أعجبني ما رأيت من شغفك بطاعة إمامك، واحتجاجك لتدبير خليفتك، وإشفاقك من كل خلل يدخله وإن دق، ونال سلطانه وإن صغر، ومن كل أمر خالف هواه وإن خفي مكانه، وجانب رضاه وإن قل ضرره. ومن تخوفك أن يجد المتأول إليه متطرقاً، والعدو عليه متعلقاً؛ فإن السلطان لا ينفك من متأول ناقم، ومن محكوم عليه ساخط، ومن معزول عن الحكم زار، ومن متعطل متصفح، ومن معجب برأيه، ذي خطل في بيانه، مولع بتهجين الصواب، وبالاعتراض على التدبير، حتى كأنه رائد لجميع الأمة، ووكيل لسكان جميع المملكة؛ يضع نفسه في مواضع الرقباء، وفي مواضع التصفح على الخلفاء والوزراء. لا يعذر وإن كان مجاز العذر ظاهراً، ولا يقف فيما يكون للشك محتملاً، ولا يصدق بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وأنه لا يعرف مصادر الرأي من لم يشهد موارده، ومستدبره من لم يعرف مستقبله.
ومن محروم قد أضعفه الحرمان، ومن لئيم قد أفسده الإحسان، ومن مستبطىء قد أخذ أضعاف حقه، وهو لجهله بقدره، ولضيق ذرعه، وقلة شكره، يظن أن الذي بقي له أكثر، ولحقه أوجب.
ومن مستزيد لو ارتجع السلطان سالف أياديه البيض عنده، ونعمته السالفة عليه، لكان لذلك أهلاً، وله مستحقاً. قد غره الأمل، وأبطره دوام الكفاية، وأفسده طول الفراغ.
ومن صاحب فتنة خامل في الجماعة، رئيس في الفرقة نعاق في الهرج، قد أقصاه عز السلطان، وأقام صغوه ثقاف الأدب، وأذله الحكم بالحق، فهو مغيظ لا يجد غير التشنيع، ولا يتشفى بغير الإرجاف، ولا يستريح إلا إلى الأماني، ولا يأنس إلا بكل مرجف كذاب، ومفتون مرتاب، وخارص لا خير فيه،وخالف لا غناء عنده، يريد أن يسوى بالكفاة، ويرفع فوق الحماة، لأمر ما سلف له، ولإحسان كان من غيره، وليس ممن يرب قديم مجد، ولا يحفل بدروس شرف، ولا يفصل بين ثواب المحتسبين، وبين الحفظ لأبناء المحسنين.
وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله.
ثم اعلم بعد ذلك أنك بنفسك بدأت في تعظيم إمامك، والحفظ لمناقب أنصار خليفتك، وإياها حطت بحياطتك لأشياعه، واحتجاجك لأوليائه، ونعم العون أنت، إن شاء الله، على ملازمة الطاعة، والموازرة على الخير، والكفاية لأهل الحق.
وقد استدللت بالذي أرى من شدة عنايتك وفرط اكتراثك، وتفقدك لأجناس الأعداء، وبحثك عن مناقب الأولياء على أن ما ظهر من نصحك أمم في جنب ما بطن من إخلاصك. فأمتع الله بك خليفته، ومنحنا وإياك محبته، وأعاذنا وإياك من قول الزور، والتقرب بالباطل، إنه حميد مجيد، فعال لما يريد.
وذكرت أنك جالست أخلاطاً من جند الخلافة، وجماعات من أبناء الدعوة، وشيوخاً من جلة الشيعة، وكهولاً من أبناء رجال الدولة، المنسوبين إلى الطاعة والمناصحة، ومحبة الدينونة دون محبة الرغبة والرهبة، وأن رجلاً من عرض تلك الجماعة ارتجل الكلام ارتجال مستبد، وتفرد به تفرد معجب، وأنه تعسف المعاني وتهجم على الألفاظ فزعم أن جند الخلافة اليوم على خمسة أقسام: خراساني، وتركي، ومولىً، وعربي، وبنوي، وأنه أكثر حمد الله وشكره على إحسانه ومنته، وعلى جميع أياديه، وسبوغ نعمه، وعلى شمول عافيته، وجزيل مواهبه، حين ألف على الطاعة هذه القلوب المختلفة، والأجناس المتباينة، والأهواء المتفرقة، وأنك اعترضت على هذا المتكلم المستبد، وعلى هذا القائل المتكلف الذي قسم هذه الأقسام، وخالف بين هذه الأركان، وفضل بين أنسابهم. وأنك أنكرت ذلك عليه أشد الإنكار، وقذعته أشد القذع.
وزعمت أنهم لم يخرجوا من الاتفاق، أو من شيء يقرب من الاتفاق، وأنك نفيت التباعد في النسب، والتباين في السبب.
وقلت: بل أزعم أن الخراساني والتركي أخوان، وأن الحيز واحد، وأن حكم ذلك الشرق، والقضية على ذلك الصقع متفق غير مختلف، ومتقارب غير متفاوت، وأن الأعراق في الأصل إن لا تكن كانت راسخة، فقد كانت متشابهة، وحدود البلاد المشتملة عليهم إن لا تكن متساوية فإنها متناسبة، وكلهم خراساني في الجملة، وإن تميزوا ببعض الخصائص، وافترقوا ببعض الوجوه.
وزعمت أن اختلاف التركي والخراساني ليس كاختلاف ما بين الرومي والصقلبي، والزنجي والحبشي، فضلاً على ما هو أبعد جوهراً، وأشد خلافاً، بل كاختلاف ما بين المدري والوبري، والبدوي والحضري، والسهلي والجبلي، وكاختلاف ما بين من نزل البطون وبين من نزل النجود، وبين من نزل الأغوار.
وزعمت أن هؤلاء وإن اختلفوا في بعض اللغة، وفارق بعضهم بعضاً في بعض الصورة، فقد نجد أن عليا تميم، وسفلى قيس، وعجز هوازن، وفصحاء الحجاز، خلاف لغة حمير وسكان مخاليف اليمن، وكذلك الصورة والصورة، والشمائل والشمائل، والأخلاق والأخلاق. وكلهم مع ذلك عربي خالص غير مشوب، ولا معلهج ولا مذرع ولا مزلج. ولم يختلفوا كاختلاف ما بين قحطان وعدنان، من قبل ما طبع الله عليه تلك التربة من خصائص الغرائز، وما قسم لأهل كل جزيرة من الشكل والصورة، ومن الأخلاق واللغة.
فإن قلت: وكيف صار أولادهما جميعاً عرباً، مع اختلاف الأبوة قلنا: إن الجزيرة لما كانت واحدة فاستووا في التربة وفي اللغة، وفي الشمائل والهمة، وفي الأنف والحمية، وفي الأخلاق والسجية، فسبكوا سبكاً واحداً، تشابهت الأجزاء وتناسبت الأخلاط، حتى صار ذلك اشد تشابهاً في باب الأعم والأخص، وفي باب الوفاق والمباينة من بعض الأرحام، وجرى عليهم حكم الاتفاق في الحسب، وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى حتى تناكحوا عليها، وتصاهروا من أجلها. وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة بني اسحاق، وهو أخو إسماعيل، وجادوا بذلك في جميع الدهر لبني قحطان.
ففي إجماع الفريقين على التناكح والتصاهر، ومنعهما ذلك جميع الأمم، ككسرى فمن دونه، دليل على أن النسب عندهم متفق، وأن هذه المعاني قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة.
وزعمت أنه أراد الفرقة والتحزيب، وأنك أردت الألفة والتقريب.
ثم زعمت أيضاً أن البنوي خراساني، وأن نسب الأبناء نسب آبائهم، وأن حسن صنيع الآباء، وقديم فعال الأجداد، هو حسب الأبناء، وأن الموالي بالعرب أشبه، وإليهم أقرب، وبهم أمس؛ لأن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في كثير من المعاني، لأنهم عرب في المدعى، وفي العاقلة، وفي الوراثة. وهذا تأويل قوله: " مولى القوم منهم " . و " الولاء لحمة كلحمة النسب " .
ثم زعمت أن الأتراك قد شاركوا القوم في هذا النسب، وصاروا من العرب بهذا السبب، مع الذي بانوا به من الخلال، وحبوا به من شرف الخصال.
على أن ولاء الأتراك للباب قريش، ولمصاص عبد مناف، وهم في سر هاشم، وهاشم موضع العذار من خد الفرس، ومحل العقد من لبة الكعاب. وهو الجوهر المكنون، والذهب المصفى، وموضع المحة من البيضة، والعين في الرأس، والروح من البدن. وهم الأنف المقدم، والسنام الأكوم، والطينة البيضاء، والدرة الزهراء، والروضة الخضراء، والذهب الأحمر.
فقد شاركوا العرب في أنسابهم، وفضلوهم بهذا الفضل الخاص الذي لا يبلغه فضل وإن برع، بل لا يعشره شرف وإن عظم، ولا مجد وإن قدم.
فزعمت أن أنساب الجميع متقاربة غير متباعدة، وعلى حسب ذلك التقارب تكون الموازنة والمكانفة، والطاعة والمناصحة، والمحبة للخلفاء والأئمة.
وذكرت أنه ذكر جملاً من مفاخر هذه الأجناس، وجمهرة من مناقب هذه الأصناف، وأنه جمع ذلك وفصله، وأجمله وفسره، وأنه ألغى ذكر الأتراك فلم يعرض لهم، وأضرب عنهم صفحاً فلم يخبر عنهم، كما أخبر عن حجة كل جيل، وعن برهان كل صنف. فذكر أن الخراساني يقول: نحن النقباء، وأبناء النقباء، ونحن النجباء وأبناء النجباء، ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة، أو تعرف نجابة، وقبل المغالبة والمبادأة، وقبل كشف القناع وزوال التقية.
وبنا زال ملك أعدائنا عن مستقره، وثبت ملك أوليائنا في نصابه، وبين ذلك ما قتلنا وشردنا، ونهكنا ضرباً وطلبا، وبضعنا بالسيوف الحداد، وعذبنا بألوان العذاب.
وبنا شفى الله تعالى الصدور، وأدرك الثأر، ومنا الاثني عشر النقباء، والسبعون النجباء. ونحن الخندقية وأبناء الخندقية، ونحن الكفية وأبناء الكفية، ومنا المستجيبة، ومن بهرج النيمية، ومنا نيم خزان، وأصحاب الجوربين، ومنا الزغندية، والآزاذمردية.
ونحن فتحنا البلاد، وقتلنا العدو بكل واد، ونحن أصل هذه الدولة، ومنبت هذه الشجرة، وأصحاب هذه الدعوة، ومن عندنا هبت هذه الريح
والأنصار أنصاران: الأوس والخزرج، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الزمان، وأهل خراسان نصروا ورثته في آخر الزمان، غذانا بذلك آباؤنا، وغزونا به أبناءنا، وصار لنا نسباً لا نعرف إلا به، وديناً لا نوالي إلا عليه.
ثم نحن على وتيرة واحدة، ومنهاج غير مشترك، نعرف بالشيعة، ودين بالطاعة، ونقتل فيها، ونموت عليها. سيمانا موصوف، ولباسنا معروف، ونحن أصحاب الرايات السود، والروايات الصحيحة، والأحاديث المأثورة، والذين يهدمون مدن الجبابرة، وينتزعون الملك من أيدي الظلمة. وفينا تقدم الخبر، وصح الأثر. وجاء في الحديث صفة الذين يفتحون عمورية، ويظهرون عليها، ويقتلون مقاتليها، ويسبون ذراريها، حيث قالوا في نعتهم: " شعورهم شعور النساء، وثيابهم ثياب الرهبان " . فصدق الفعل القول، وحقق الخبر العيان.
ونحن الذين ذكرنا، وذكر بلاءنا إمام الأئمة، وأبو الخلائف العشرة محمد بن علي، حين أراد توجيه الدعاة إلى الآفاق، وتفريق شيعته في البلدان: " أما البصرة وسوادها فقد غلب عليها عثمان، وصنائع عثمان، فليس بها من شيعتنا إلا القليل.
وأما الكوفة وسوادها فقد غلب عليها علي وشيعة علي، فليس بها من شيعتنا إلا القليل.
وأما الشام فشيعة بني مروان، وآل بني سفيان.
وأما الجزيرة فخارجة، وحرورية ومارقة.
ولكن عليكم بهذا الشرق فإن هناك صدوراً سليمة، وقلوباً باسلة، لم تفسدها الأهواء، ولم تخامرها الأدواء، ولم تعتقبها البدع، وهم مغيظون موتورون. وهناك العدد والعدة، والعتاد والنجدة " .
ثم قال: " وأنا أتفاءل إلى حيث ما تطلع " .
فكنا خير جند لخير إمام، وصدقنا ظنه، وثبتنا رأيه، وصوبنا فراسته.
وقال مرة أخرى: " إن أمرنا هذا شرقي لا غربي، ومقبل غير مدبر، يطلع كطلوع الشمس، ويمتد على الآفاق امتداد النهار، حتى يبلغ حيث ما تبلغه الأخفاف، وتناله الحوافر " .
قالوا: ونحن قتلنا الصحصحية، والدالقية، والذكوانية، والراشدية. ونحن أصحاب الخنادق، ونباتة بن حنظلة، وعامر بن ضبارة، وأصحاب ابن هبيرة. فلنا قديم هذا الأمر وحديثه، وأوله وآخره.
ومنا قاتل مروان.
ونحن قوم لنا أجسام وأجرام، وشعور وهام، ومناكب عظام، وجباه عراض، وقصر غلاظ، وسواعد طوال.
ونحن أولد للذكورة، وأنسل بعولة، وأقل ضوىً وضئولة، وأقل إتآماً، وأنتق أرحاماً، وأشد عصباً، وأتم عظاماً. وأبداننا أحمل للسلاح، وتجفافنا أملأ للعيون.
ونحن أكثر مادة، وأكثر عدداً وعدة، ولو أن يأجوج ومأجوج كاثروا من وراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد.
فأما الأيد وشدة الأسر فليس لأحد بعد عاد وثمود والعمالقة والكنعانيين مثل أيدنا وأسرنا.
ولو أن خيول الآفاق، وفرسان جميع الأطراف جمعوا في حلبة واحدة لكنا أكثر في العيون، وأهول في الصدور.
ومتى رأيت مواكبنا وفرساننا وبنودنا التي لا يحملها غيرنا علمت أنا لم نخلق إلا لقلب الدول، وطاعة الخلفاء، وتأييد السلطان.
ولو أن أهل تبت، ورجال الزابج، ورجال وفرسان الهند، وحلبة الروم، هجم عليهم هاشم بن أشتاخنج لما امتنعوا من طرح السلاح، والهرب في البلاد.
ونحن أصحاب اللحى، وأرباب النهى، وأهل الحلم والحجا، وأهل الثخانة في الرأي، والبعد من الطيش.
ولسنا كجند الشام المتعرضين للحرم، والمنتهكين لكل محرم.
ونحن ناس لنا أمانة، وفينا عفة. ونحن نجمع بين النزاهة والقناعة، والصبر على الخدمة، وعلى التجمير وبعد الشقة.
ولنا الطبول المهولة والبنود العظام.
ونحن أصحاب التجافيف والأجراس، والبازفكند، واللبود الطوال، والأغماد المعقفة والقلانس الشاشية، والخيول الشهرية، ولنا الكافركوبات، والطبرزينات في الأكف، والخناجر في الأوساط.
ولنا تعليق السيوف وحسن الجلسة على ظهور الخيل، ولنا الأصوات التي تسقط الحبالى.
وليس في الأرض صناعة غريبة، من أدب وحكمة وحساب وهندسة، وارتفاع بناء وصنعة، وفقه ورواية، نظرت فيها الخراسانية إلا فرعت فيها الرؤساء، وبذت فيها العلماء.
ولنا صنعة السلاح، عدة للحرب، وتثقيفاً ودربة للمجاولة والمشاولة، وللكر بعد الفر، مثل الدبوق، والنزو على الخيل صغاراً، ومثل الطبطاب والصوالجة كباراً. ثم رمى المجثمة والبرجاس والطائر الخاطف. فنحن أحق بالأثرة، وأولى بشرف المنزلة.
قلت: وزعم أن العربي يقول: إن تكن القربة تستحق بالأنساب الثابتة، والأرحام الشابكة، وبالقدمة، وبطاعة الآباء والعشيرة، وبالشكر النافع، والمديح الباقي، وبالشعر الموزون الذي يبقى بقاء الدهر، ويلوح ما لاح نجم، وينشد ما أهل بالحج، وما هبت الصبا، وما كان للزيت عاصر. وبالكلام المنثور، والقول المأثور، وبصفة مخرج الدولة، والاحتجاج للدعوة، وتقييد المآثر، إذ لم يكن ذلك من عادة العجم، ولا كان يحفظ ذلك معروفاً لسوى العرب، ونحن نرتبطها بالشعر المقفي، ونقيدها بحفظ الأميين الذين لا يتكلون على الكتب المدونة، والخطوط المطرسة.
ونحن أصحاب التفاخر والتنافر، والتنازع في الشرف، والتحاكم إلى كل حكم مقنع، وكاهن سجاع.
ونحن أصحاب التعاير بالمثالب، والتفاخر بالمناقب.
ونحن أحفظ لأنسابنا، وأرعى لحقوقنا، وتقييدها أيضاً بالمنثور المرسل، بعد الموزون المعدل، بلسان أمضى من السنان، وأرهف من السيف الحسام، حتى نذكرهم ما قد درس رسمه، وعفا أثره.
وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق. وليس المعرق في الحفاظ كمن هذا فيه حادث. وهذا باب يتقدم التالد القديم الطارف الحديث.
وطلاب الطوائل رجلان: سجستاني وأعرابي. وهل أكثر النقباء إلا من صميم العرب، ومن صليبة هذا النسب، كأبي عبد الحميد قحطبة بن شبيب الطائي، وأبي محمد سليمان بن كثير الخزاعي، وأبي نصر مالك بن الهيثم الخزاعي، وأبي داود خالد بن ابراهيم الذهلي، وكأبي عمرو لاهز بن قريظ المرئي، وأبي عتيبة موسى بن كعب المرئي، وأبي سهل القاسم بن مشاجع المرئي. ومن كان يجري مجرى النقباء ولم يدخل فيهم، مثل مالك بن الطواف المرئي.
وبعد، فمن هذا الذي باشر قتل مروان، ومن هزم ابن هبيرة، ومن قتل ابن ضبارة، ومن قتل نباتة بن حنظلة، إلا عرب الدعوة، والصميم من أهل الدولة ومن فتح السند إلا موسى بن كعب، ومن فتح إفريقية إلا محمد بن الأشعث وقات: وقال: ويقول الموالي لنا النصيحة الخالصة، والمحبة الراسخة. ونحن موضع الثقة عند الشدة، وعلل المولى من تحت موجبة لمحبة المولى من فوق؛ لأن شرف مولاه راجع إليه، وكرمه زائد في كرمه، وخموله مسقط لقدره، وبوده أن خصال الكرم كلها اجتمعت فيه، لأن ذلك كلما كان مولاه أكبر وأشرف وأظهر، كان هو بها أشرف وأنبل، ومولاك أسلم لك صدراً، وأود ضميراً، وأقل حسداً.
وبعد، فالولاء لحمة كلحمة النسب، فقد صار لنا النسب الذي يصوبه العربي، ولنا الأصل الذي يفتخر به العجمي.
قال: والصبر ضروب، فأكرمها كلها الصبر على إفشاء السر، وللمولى في هذه المكرمة ما ليس لأحد، ونحن أخص مدخلاً، وألطف في الخدمة مسلكاً. ولنا مع الطاعة والخدمة، والإخلاص وحسن النية، خدمة الأبناء للآباء، والآباء للأجداد، وهم بمواليهم آنس، وبناحيتهم أوثق، وبكفايتهم أسر.
وقد كان المنصور، ومحمد بن علي، وعلي بن عبد الله، يخصون مواليهم بالمواكلة والبسط والإيناس، لا يبهرجون الأسود لسواده، ولا الدميم لدمامته، ولا ذا الصناعة الدنيئة لدناءتها. ويوصون بحفظهم أكابر أولادهم، ويجعلون لكثير من موتاهم الصلاة على جنائزهم، وذلك بحضرة من العمومة، وبني الأعمام والإخوة.
ويتذاكرون إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة مولاه، حين عقد له يوم مؤتة على جنة بني هاشم، وجعله أمير كل بلدة يطؤها.
ويتذاكرون حبه لأسامة بن زيد، وهو الحب ابن الحب. وعقد له على عظماء المهاجرين وأكابر الأنصار.
ويتذاكرون صنيعه بسائر مواليه كأبي أنسة وشقران، وفلان وفلان.
قالوا: ولنا صاحب الدولة: أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم، وأبو سلمة حفص بن سليمان. وأبو مسلم مولى الإمام، وعليهما دارت رحى الدولة، وتم الأمر واتسق نظام الملك.
قالوا: ولنا من رءوس النقباء: أبو منصور مولى خزاعة، وأبو الحكم عيسى بن أعين مولى خزاعة، وأبو حمزة عمرو بن أعين مولى خزاعة، وأبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل أبي معيط.
فلنا مناقب الخراسانية، ولنا مناقب الموالي في هذه الدعوة. ونحن منهم وإليهم، ومن أنفسهم، لا يدفع ذلك مسلم. ولا ينكره مؤمن. خدمناهم كباراً، وحملناهم على عواتقنا صغاراً.
هذا مع حق الرضاع والخؤولة، والنشوء في الكتاب، والتقلب في تلك العراص التي لم يبلغها إلا كل سعيد الجد، وجيه في الملوك.
فقد شاركنا العربي في فخره، والخراساني في مجده، والبنوي في فضله، ثم تفردنا بما لم يشاركونا فيه، ولا سابقونا إليه.
قالوا: ونحن أشكل بالرعية، وأقرب إلى طباع الدهماء، وهم بنا آنس، وإلينا أسكن، وإلى لقائنا أحن. ونحن بهم أرحم، وعليهم أعطف، وبهم أشبه. فمن أحق بالأثرة، وأولى بحسن المنزلة ممن هذه الخصال له، وهذه الخلال فيه.
وقلت: وذكرت أن البنوي قال: نحن أصل خراساني، وهو مخرج الدولة، ومطلع الدعوة، ومنها نجم هذا القرن، وصبأ هذا الناب، وتفجر هذا الينبوع، واستفاض هذا البحر، حتى ضرب الحق بجرانه، وطبق الآفاق بضيائه، فأبرأ من السقم القديم، وشفي من الداء العضال، وأغنى من العيلة، وبصر من العمى.
وهذه بغداد وهي مستقر الخلافة، والقرار بعد الجولة، وفيها بقية رجال الدعوة، وأبناء أبناء الشيعة، وهي خراسان العراق، وبيت الخلافة وموضع المادة.
وأنا أعرق في هذا الأمر من أبي، وأكثر ترداداً فيه من جدي، وأحق بهذا الفضل من المولى والعربي.
ولنا بعد في أنفسنا ما لا ينكر من الصبر تحت ظلال السيوف القصار، والرماح الطوال، ولنا معانقة الأبطال عند تحطم القنا، وانقطاع الصفائح، ولنا المواجأة بالسكاكين، وتلقي الخناجر بالعيون.
ونحن حماة المستلحم، وأبناء المضايق، ونحن أهل الثبات عند الجولة، والمعرفة عند الحيرة، وأصحاب المشهرات، وزينة العساكر وحلى الجيوش، ومن يمشي في الرمح، ويختال بين الصفين، ونحن أصحاب الفتك والإقدام.
ولنا بعد التسلق ونقب المدن، والتقحم على ظبات السيوف، وأطراف الرماح، ورضخ الجندل، وهشم العمد، والصبر تحت الجراح، وعلى جر السلاح، إذا طار قلب الأعرابي، وساء ظن الخراساني.
ثم الصبر تحت العقوبة، والاحتجاج عند المسألة، واجتماع العقل، وصحة الطرف، وثبات القدمين، وقلة التكفي بجبل العقابين، والبعد من الإقرار، وقلة الخضوع للدهر، والخضوع عند جفوة الزوار، وجفاء الأقارب والإخوان. ولنا القتال عند أبواب الخنادق ورءوس القناطر.
ونحن الموت الأحمر عند أبواب النقب، ولنا المواجأة في الأزقة، والصبر على قتال السجون. فسل عن ذلك الخليدية والكتفية والبلالية، والحزبية، ونحن أصحاب المكابرات، وأرباب البيات، وقتل الناس جهاراً في الأسواق والطرقات.
ونحن نجمع بين السلة والمزاحفة. ونحن أصحاب القنا الطوال ما كنا رجالة، والمطارد القصار ما كنا فرساناً. فإن صرنا كمناً فالحتف القاضي، والسم الزعاف، وإن كنا طلائع فكلنا يقوم مقام أمير الجيش. نقاتل بالليل كما نقاتل بالنهار، ونقاتل في الماء كما نقاتل في الأرض، ونقاتل في القرية كما نقاتل في المحلة.
ونحن أفتك وأخشب. ونحن أقطع للطريق، وأذكر في الثغور، مع حسن القدود، وجودة الخرط، ومقادير اللحى، وحسن العمة، والنفس المرة، وأصحاب الباطل والفتوة، ثم الخط والكتابة، والفقه والرواية.
ولنا بغداد بأسرها، تسكن ما سكنا، وتتحرك ما تحركنا. والدنيا كلها معلقة بها، وصائرة إلى مغناها، فإذا كان هذا أمرها وقدرها فجميع الدنيا تبع لها، وكذلك أهلها لأهلها، وفتاكها لفتاكها، وخلاعها لخلاعها، ورؤساؤها لرؤسائها، وصلحاؤها لصلحائها.
ونحن تربية الخلفاء، وجيران الوزراء، ولدنا في أفنية ملوكنا، ونحن أجنحة خلفائنا، فأخذنا بآدابهم، واحتذينا على مثالهم، فلسنا نعرف سواهم، ولا نتهم بغيرهم، ولم يطمع فينا أحد قط من خطاب ملكهم، وممن يترشح للاعتراض عليهم. فمن أحق بالأثرة، وأولى بالقرب في المنزلة ممن هذه الخصال فيه، وهذه الخلال له.
إن ذهبنا - حفظك الله - بعقب هذه الاحتجاجات، وعند منقطع هذه الاستدلالات نستعمل المفاوضة بمناقب الأتراك، والمقارنة بين خصالهم وخصال كل صنف من هذه الأصناف، سلكنا في هذا الكتاب سبيل أصحاب الخصومات في كتبهم، وطريق أصحاب الأهواء في الاختلاف الذي بينهم.
وكتابنا هذا إنما تكلفناه لنؤلف بين قلوبهم إن كانت مختلفة، ولنزيد في الألفة إن كانت مؤتلفة، ولنخبر عن اتفاق أسبابهم، لتجتمع كلمتهم، ولتسلم صدورهم، وليعرف من كان لا يعرف منهم موضع التفاوت في النسب كم مقدار الخلاف في الحسب، لئلا يغير بعضهم مغير، ويفسده عدو بأباطيل مموهة، وشبهات مزورة، فإن المنافق العليم، والعدو ذا الكيد العظيم قد يصور لمن دونه الباطل في صورة الحق، ويلبس الإضاعة ثياب الحزم.
إلا أنا على كل حال، سنذكر جملاً من أحاديث رويناها، وأمور رأيناها وشاهدناها، وقصصاً تلقفناها من أفواه الحكماء وسمعناها.
وسنذكر ما حفظ لجميع الأصناف من الآلات والأدوات، ثم ننظر أيهم لها أشد استعمالا، وبها أشد استقلالا، ومن أثقب حسباً، وأيقظ عيناً، وأزكى نفساً، وأشد غوراً، وأعم خواطر، وأكثر نفعاً في الحروب وضراً، وأدرب دربة، وأغمض مكيدة، وأشد احتراساً، وألطف احتيالاً، حتى يكون الخيار في يد الناظر في هذا الكتاب، المتصفح لمعانيه، والمقلب لوجوهه، والمفكر في أبوابه، والمقابل بين أوله وآخره. ولا نكون نحن انتحلنا شيئاً دون شيء، وتقلدنا تفضيل بعض على بعض، بل لعلنا أن لا نخبر عن خاصة ما عندنا بحرف واحد.
فإذا دبرنا كتابنا هذا التدبير، وكان موضوعاً على هذه الصفة كان أبعد له من مذاهب الجدال والمراء، واستعمال الهوى.
وقد ظن ناس كثير أن أسماء أصناف الأجناد لما اختلف فيالصورة والخط والهجاء، أن حقائقها ومعانيها على حسب ذلك. وليس الأمر على ما يتوهمون.
ألا ترى أن اسم الشاكرية وإن خالف في الصورة والخط والهجاء اسم الجندي فإن المعنى فيهما ليس ببعيد، لأنهم يرجعون إلى معنىً واحد، وعلم واحد. والذي يرجعون إليه طاعة الخلفاء وتأييد السلطان.
وإذا كان المولى منقولاً إلى العرب في أكثر المعاني، ومجعولاً منهم في عامة الأسباب لم يكن بأعجب من جعل الخال والداً، والحليف من الصميم، وابن الأخت من القوم.
وقد جعل الله ابن الملاعنة المولود على فراش البعل منسوباً إلى أمه، وقد جعل إسماعيل وهو ابن أعجميين عربياً، لأن الله تعالى لما فتق لهاته بالعربية المبينة على غير التلقين والترتيب، وفطره على الفصاحة العجيبة على غير النشوء والتمرين، وسلخ طباعه من طبائع العجم، ونقل إلى بدنه تلك الأجزاء، وركبه اختراعاً على ذلك التركيب، وسواه تلك التسوية، وصاغه تلك الصيغة، ثم حماه من طبائعهم، ومنعه من أخلاقهم وشمائلهم، وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهممهم على أكرمها وأسناها، وأشرفها وأعلاها، وجعل ذلك برهاناً على رسالته، ودليلاً على نبوته، وصار أحق بذلك النسب، وأولى بشرف ذلك الحسب.
وكما جعل إبراهيم أباً لمن لم يلد، فالبنوي خراساني من جهة الولادة، والمولى عربي من جهة المدعى والعاقلة.
ولو أحاط علمنا بأن زيداً لم يخلق من نجل عمرو إلا عهاراً لنفيناه عنه، وإن أيقنا أنه لم يخلق إلا من ماء صلبه.
وكما جعل النبي أزواجه أمهات المؤمنين، وهن لم يلدنهم ولا أرضعنهم. وفي بعض القراءات: " وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم " على قوله: " ملة أبيكم إبراهيم " ، وجعل المرأة من جهة الرضاع أماً، وجعل امرأة البعل أم ولد البعل من غيرها، وجعل الراب والداً. وجعل العم في كتاب الله أباً. وهم عبيده لا يتقلبون إلا فيما قلبهم فيه.
وله أن يجعل من عباده من شاء عربياً، ومن شاء أعجمياً، ومن شاء قرشياً، ومن شاء زنجياً. كما أن له أن يجعل من شاء ذكراً ومن شاء أنثى، ومن شاء خنثى، ومن شاء أخرجه من ذلك فجعله لا ذكراً ولا أنثى ولا خنثى.
وكذلك خلق الملائكة، وهم أكرم على الله من جميع الخليقة. ولم يجعل لآدم أباً ولا أماً، وخلقه من طين ونسبه إليه، وخلق حواء من ضلع آدم، وجعلها له زوجاً وسكنا.
وخلق عيسى من غير ذكر، ونسبه إلى أمه التي خلقه منها.
وخلق الجان من نار السموم، وآدم من طين، وعيسى من غير نطفة، وخلق السماء من دخان، والأرض من الماء. وخلق إسحاق من عاقر.
وأنطق عيسى في المهد، وأنطق يحيى بالحكمة وهو صبي، وعلم سليمان منطق الطير، وكلام النمل. وعلم الحفظة من الملائكة جميع الألسنة حتى كتبوا بكل خط، ونطقوا بكل لسان. وأنطق ذئب أهبان بن أوس.
والمؤمنون من جميع الأمم إذا دخلوا الجنة، وكذلك أطفالهم والمجانين منهم، يتكلمون ساعة يدخلون الجنة بكلام أهل الجنة، على غير الترتيب والتنزيل، والتعليم على طول الأيام والتلقين. فكيف يتعجب الجاهلون من إنطاق إسماعيل بالعربية على غير تعليم الآباء، وتأديب الحواضن ! وهذه المسألة ربما سأل عنها بعض القحطانية، ممن لا علم له، بعض العدنانية، وهي على حال القحطانية أشد.
فأما جواب العدناني فسلس النظام، سهل المخرج، قريب المعنى؛ لأن بني قحطان لا يدعون لقحطان نبوة فيعطيه الله تعالى مثل هذه الأعجوبة.
وما الذي قسم الله بين الناس من ذلك إلا كما صنع الله في طينة الأرض، فجعل بعضها حجراً، وبعض الحجر ياقوتاً، وبعضه ذهباً، وبعضه نحاساً، وبعضه رصاصاً، وبعضه صفراً، وبعضه حديداً، وبعضه تراباً، وبعضه فخاراً. وكذلك الزاج، والمغرة، والزرنيخ، والمرتك، والكبريت، والقار، والتوتيا، والنوشادر، والمرقشيشا، والمغناطيس.
ومن يحصي عدد جواهر الأرض وأصناف الفلز ! وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالبنوي خراساني. وإذا كان الخراساني مولىً والمولى عربي، فقد صار الخراساني والبنوي والمولى والعربي شيئاً واحداً. وأدنى ذلك أن يكون الذي معهم من خصال الوفاق غامراً لما معهم من خصال الخلاف، بل هم في معظم الأمر، وفي كبر الشأن وعمود النسب متفقون. فالأتراك خراسانية، وموالي الخلفاء قصرة، فقد صار فضل الترك إلى الجميع راجعاً، وصار شرفهم زائداً في شرفهم.
وإذا عرف سائر الأجناد ذلك سامحت النفوس، وذهب التعقيد، ومات الضغن، وانقطع سبب الاستثقال، فلم يبق إلا التحاسد والتنافس الذي لا يزال يكون بين المتقاربين في القرابة، وفي الصناعة، وفي المجاورة.
على أن التوازر والتسالم في القرابات وفي بني الأعمام والعشائر أفشى وأعم من التخاذل والتعادي.
ولحب التناصر والحاجة إلى التعاون انضم بعض القبائل في البوادي إلى بعض، ينزلون معاً، ويظعنون معاً. ومن فارق أصحابه أقل، ومن نصر ابن عمه أكثر، ومن اغتبط بنعمته وتمنى بقاءها والزيادة فيها أكثر ممن بغاها الغوائل وتمنى انقطاعها وزوالها.
ولا بد في أضعاف ذلك من بعض التنافس والتخاذل، إلا أن ذلك قليل من كثير.
وليس يكون أن تصفو الدنيا، وتنقى من الفساد والمكروه، حتى يموت جميع الخلاف، وتستوي لأهلها، وتتمهد لسكانها على ما يشتهون ويهوون؛ لأن ذلك من صفة دار الجزاء، وليس كذلك صفة دار العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب كتبته أيام المعتصم بالله
رضي الله عنه ونضر وجهه
فلم يصل إليه لأسباب يطول ذكرها، فلذلك لم أعرض للإخبار عنها، وأحببت أن يكون كتاباً قصداً، ومذهباً عدلاً، ولا يكون كتاب إسراف في مديح قوم، وإغراق في هجاء آخرين؛ فإن الكتاب إذا كان كذلك شابه الكذب وخالطه التزيد، وبني أساسه على التكلف، وخرج كلامه مخرج الاستكراه والتغليق.وأنفع المدائح للمادح، وأجداها على الممدوح، وأبقاها أثراً وأحسنها ذكراً، أن يكون المديح صدقاً، ولظاهر حال الممدوح موافقاً، وبه لائقاً، حتى لا يكون من المعبر عنه والواصف له إلا الإشارة إليه، والتنبيه عليه.
وأنا أقول: إن كان لا يمكن ذكر مناقب الأتراك إلا بذكر مثالب سائر الأجناد، فترك ذكر الجميع أصوب، والإضراب عن هذا الكتاب أحزم.
وذكر الكثير من هذه الأصناف بالجميل لا يقوم إلا بالقليل من ذكر بعضهم بالقبيح، وهو معصية وباب من ترك الواجب. وقليل الفريضة أجدى علينا، لأن ذكر الأكثر بالجميل نافلة، وباب من التطوع؛ وذكر الأقل بالقبيح معصية، وباب من ترك الواجب. وقليل الفريضة أجدى علينا من كثير التطوع.
ولكل الناس نصيب من النقص، ومقدار من الذنوب، وإنما يتفاضل بكثرة المحاسن وقلة المساوىء. فأما الاشتمال على جميع المحاسن، والسلامة من جميع المساوىء، دقيقها وجليلها، ظاهرها وخفيها، فهذا لا يعرف فيهم.
فإذا كان الخلطاء من جمهور الناس وأهل المعايش من دهماء الجماعة يرون ذلك واجباً في الأخلاق، ومصلحة في المعاش، وتدبيراً في التعامل، على ما فيهم من مشاركة الخطأ للصواب، وامتزاج الضعف بالقوة، فلسنا نشك أن الإمام الأكبر، والرئيس الأعظم مع الأعراق الكريمة، والأخلاق الرفيعة، والتمام في الحلم والعلم، والكمال في العزم والحزم، مع التمكين والقدرة، والفضيلة والرياسة والسيادة، والخصائص التي معه من التوفيق والعصمة، والتأييد وحسن المعونة لم يكن الله ليجلله لباس الخلافة، ويحبوه ببهاء الأمة، وبأعظم نعمة وأسبغها، وأفضل كرامة وأسناها، ثم وصل طاعته بطاعته، ومعصيته بمعصيته، إلا ومعه من الحلم في موضع الحلم، والعفو في موضع العفو، والتغافل في موضع التغافل، ما لا يبلغه فضل ذي فضل، ولا حلم ذي حلم.
ونحن قائلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيما انتهى إلينا من القول في الأتراك.
زعم محمد بن الجهم وثمامة بن الأشرس والقاسم بن سيار في جماعة ممن يغشى دار الخلافة، وهي دار العامة، قالوا جميعاً: بينا حميد بن عبد الحميد جالساً ومعه إخشيد الصغدي، وأبو شجاع شبيب بن بخار خداي البلخي، ويحيى بن معاذ، ورجال من المعدودين المتقدمين في العلم بالحرب، من أصحاب التجارب والمراس، وطول المعالجة والمعاناة بصناعة الحرب، إذ خرج رسول المأمون فقال لهم: يقول لكم مفترقين ومجتمعين: فليثبت كل رجل منكم دعواه وحجته، يقول لكم: أيما أحب إلى كل قائد منكم، إذا كان في مائة من نخبته وثقاته: أن يلقى بهم مائة تركي أو مائة خارجي فقال القوم جميعاً: لأن نلقى مائة تركي أحب إلينا من أن نلقى مائة خارجي! وحميد ساكت، فلما فرغ القوم جميعاً من حججهم قال الرسول لحميد: قد قال القوم فقل واكتب قولك، وليكن حجة لك أو عليك. قال: بل ألقى مائة خارجي أحب إلي؛ لأني وجدت الخصال التي فضل بها التركي جميع المقاتلة غير تامة في الخارجي، ووجدتها تامة في التركي. ففضل التركي على الخارجي بقدر فضل الخارجي على سائر المقاتلة. وذلك بأن التركي بان من الخارجي بأمور ليس فيها للخارجي دعوى ولا متعلق. على أن هذه الأمور التي بان بها التركي من الخارجي أعظم خطراً وأقل نفعاً مما شاركه الخارجي في بعضه.
ثم قال حميد: والخصال التي يصول بها الخارجي على سائر الناس: صدق الشدة عند أول وهلة، وهي الدفعة التي يبلغون بها ما أرادوا، وينالون بها ما أملوا.
والثانية: الصبر على الخبب، وعلى طول السرى حتى يصبحوا القوم الذين مرقوا بهم غارين، فيهجموا عليهم وهم بسوء ولحم على وضم، فيعجلوا بهم عن الروية؛ وعن رد النفس بعد الجولة والنزوة، لا يظنون أن أحداً يقطع في ذلك المقدار من الزمان ذلك المقدار من البلاد.
والثالثة: أن الخارجي موصوف عند الناس بأنه إن طلب أدرك، وإن طلب فات.
والرابعة: خفة الأزواد، وقلة الأمتعة، وأنها تجنب الخيل، وتركب البغال، وإن احتاجت أمست بأرض وأصبحت بأخرى، وأنهم قوم حين خرجوا لم يخلفوا الأموال الكثيرة، والجنان الملتفة، والدور المشيدة، ولا ضياعاً ولا مستغلات، ولا جواري مطهمات، وأنهم لا سلب لهم، ولا مال معهم، فيرغب الجند في لقائهم، وإنما هم كالطير لا تدخر، ولا تهتم لغد، ولها في كل أرض من المياه والبزور ما يقوتها. وإن لم تجد ذلك في بعض البلاد فأجنحتها تقرب لها البعيد، وتسهل لها الحزون. وكذلك الخوارج لا يمتنع عليهم القرى والطعم، فإن يمتنع عليهم ففي بنات أعوج وبنات شحاج، وخفة الأثقال، والقوة على طول الخبب ما يأتيها بأرزاقها، وأكثر من أرزاقها.
والخامسة:أن الملوك إذا أرسلوا إليهم أعدادهم ليكونوا في خفة أزوادهم وأثقالهم، وليقووا على التنقل كقوتهم، لم يقووا عليهم، لأن مائة من الجند لا يقومون لمائة من الخوارج. وإن كثفوا الجيش وضاعفوا العدد ثقلوا عن طلبهم، وعن الغوث إن طلبهم عدوهم. ومتى شاء الخارجي أن يقرب منهم ليتطرفهم، أو ليصيب الغرة أو ليثبتهم، فعل ذلك، ثقة بأنه يغنم عند الفرصة ورؤية العورة، ويمكنه الهرب عند الخوف، وإن شاء كبسهم ليقطع نظامهم، أو ليقتطع القطعة منهم.
قال حميد: فهذه هي مفاخرهم وخصالهم، التي بها كره القواد لقاءهم.
قال القاسم بن سيار: وخصلة أخرى، وهي التي رعبت القلوب وحشتها، ونقضت العزائم وفسختها، وهو ما تسمع الأجناد ومقاتلة العوام من ضرب المثل بالخوارج، كقول الشاعر:
إذا ما البخيل والمحاذر للقرى ... رأى الضيف مثل الأزرقي المجفف
هذه زيادة القاسم بن سيار.
فأما حميد فإنه قال:
فأما الشدة فالتركي فيها أحمد أثرا، وأجمع أمراً، وأحكم شأنا؛ لأن التركي من أجل أن تصدق شدته ويتمكن عزمه، ولا يكون مشترك العزم، ومنقسم الخواطر، قد عود برذونه أن لا ينثني وإن ثناه، أن يملأ فروجه، إلا أن يديره مرة أو مرتين، وإلا فإنه لا يدع سننه، ولا يقطع ركضه، وإنما أراد التركي أن يوئس نفسه من البدوات، ومن أن يعتريه التكذيب بعد الاعتزام، لهول اللقاء، وحب الحياة، لأنه إذا علم أنه قد صير برذونه إلى هذه الغاية حتى لا ينثني، ولا يجيبه إلى التصرف معه إلا بأن يصنع شيئاً بين الصفين فيه عطبه، لم يقدم على الشدة إلا بعد إحكام الأمر، والبصر بالعورة. وإنما يريد أن يشبه نفسه بالمحرج الذي إذا رأى أشد القتال لم يدع جهداً ولم يدخر حيلة، ولينفي عن قلبه خواطر الفرار، ودواعي الرجوع.
وقال: الخارجي عند الشدة إنما يعتمد على الطعان. والأتراك تطعن طعن الخوارج، وإن شد منهم ألف فارس فرموا رشقاً واحداً صرعوا ألف فارس، فما بقاء جيش على هذا النوع من الشد ! والخوارج والأعراب، ليست لهم رماية مذكورة على ظهور الخيل، والتركي يرمي الوحش، والطير، والبرجاس، والناس، والمجثمة، والمثل الموضوعة، والطير الخاطف، ويرمي وقد ملأ فروج دابته مدبراً ومقبلاً، ويمنة ويسرة، وصعدا وسفلا، ويرمي بعشرة أسهم قبل أن يفوق الخارجي سهماً واحداً. ويركض دابته منحدراً من سهل، أو متسفلا إلى بطن واد بأكثر مما يمكن الخارجي على بسيط الأرض.
والتركي له أربعة أعين: عينان في وجهه، وعينان في قفاه.
وللخارجي عيب في مستدبر الحرب، وللخراساني عيب في مستقبل الحرب.
فعيب الخراسانية أن لها جولة عند أول الالتقاء، فإن ركبوا أكساءهم كانت هزيمتهم، وكثيراً ما يثوبون، وذلك بعد الخطار بالعسكر، وإطماع العدو في الشدة.
والخوارج إذا ولوا فقد ولوا، وليس لهم بعد الفر كر إلا ما لا يعد.
والتركي ليست له جولة الخراساني، وإذا أدبر فهو السم الناقع، والحتف القاضي، لأنه يصيب بسهمه وهو مدبر، كما يصيب بسهمه وهو مقبل، ولا يؤمن وهقه.
قال: وهم علموا الفرسان حمل قوسين وثلاث قسي، ومن الأوتار على حسب ذلك.
والتركي في حال شدته معه كل شيء يحتاج إليه، لنفسه، ولسلاحه، ولدابته، وأداة دابته. فأما الصبر على الخبب ومواصلة السير، وعلى طول السرى وقطع البلاد فعجيب جداً.
فواحدة: أن فرس الخارجي لا يصبر صبر برذون التركي.
والخارجي لا يحسن أن يعالج فرسه إلا معالجة الفرسان لخيولهم، والتركي أحذق من البيطار، وأجود تقويماً لبرذونه على ما يريد من الراضة، وهو استنتجه، وهو رباه فلواً، ويتبعه إن سماه، وإن ركض ركض خلفه، قد عوده ذلك حتى عرفه، كما يعرف الفرس: اجدم، والناقة: حلى، والجمل: جاه، والبغل: عدس، والحمار: سأسأ؛ وكما يعرف المجنون لقبه، والصبي اسمه.
ولو حصلت مدة عمر التركي وحسبت أيامه لوجدت جلوسه على ظهر الأرض نادراً. والتركي يركب فحلاً أو رمكة، ويخرج غازياً أو مسافراً، أو متباعداً في طلب صيد، أو سبب من الأسباب، فتتبعه الرمكة وأفلاكها؛ إن أعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش، وإن أخفق منها واحتاج إلى طعام فصد دابة من دوابه، وإن عطش حلب رمكة من رماكه، وإن أراح واحدة ركب أخرى، من غير أن ينزل إلى الأرض.
وليس في الأرض أحد إلا وبدنه ينتقض عن اقتيات اللحم وحده غيره، وكذلك دابته تكتفي بالعنقر والعشب والشجر، لا يظلها من شمس، ولا يكنها من برد.
قال: وأما الصبر على الخبب فإن الثغريين، والفرانقيين، والخصيان، والخوارج، لو اجتمعت قواهم في شخص واحد لما وفوا بتركي واحد. والتركي لا يبقى معه مع طول الغاية إلا الصميم من دوابه، والذي يقتله التركي بإتعابه له. وينفيه عند غزاته هو الذي لا يصبر معه فرس الخارجي، ولايبقى معه كل برذون بخاري، ولو ساير خارجياً لاستفرغ جهده قبل أن يبلغ الخارجي عفوه.
والتركي هو الراعي، وهو السائس، وهو الرائض، وهو النخاس، وهو البيطار، وهو الفارس. فالتركي الواحد أمة على حدة.
قال: وإذا سار التركي في غير عساكر الترك فسار القوم عشرة أميال سار التركي عشرين ميلاً، لأنه ينقطع عن العسكر يمنة ويسرة، ويصعد في ذرى الجبال، ويستبطن قعور الأودية، في طلب الصيد، وهو في ذلك يرمي كل ما دب ودرج، وطار ووقع.
قال: والتركي لم يسر في العسكر سير الناس قط، ولا سار مستقيماً قط.
قال: وإذا طالت الدلجة، واشتد السير، وبعد المنزل، وانتصف النهار، واشتد التعب، وشغل الناس الكلال، وصمت المتسايرون فلم ينطقوا، وقطعهم ما هم فيه عن التشاغل بالحديث، وتفسخ كل شيء من شدة الحر، وجمد كل شيء من شدة البرد، وتمنى كل جليد القوى على طول السرى أن تطوى له الأرض، وكلما رأى خيالاً أو علماً استبشر به، وظن أنه قد بلغ المنزل، وإذا بلغه الفارس نزل وهو متفحج، كأنه صبي محقون، يئن أنين المريض، ويستريح إلى التثاؤب، ويتداوى مما به بالتمطي والتضجع. وترى التركي في تلك الحال، وقد سار ضعف ما ساروا، وقد أتعب منكبيه كثرة النزع، يرى بقرب المنزل عيراً أو ظبياً، أو عرض له ثعلب أو أرنب، كيف يركض ركض مبتدىء مستأنف، حتى كأن الذي سار ذلك السير، وتعب ذلك التعب غيره.
وإن بلغ الناس وادياً فازدحموا على مسلكه أو على قنطرته، بطن برذونه فأقحمه ثم طلع من الجانب الآخر كأنه كوكب. وإن انتهوا إلى عقبة صعبة ترك السنن، وذهب في الجبل صعدا، ثم تدلى من موضع يعجز عنه الوعل، وأنت تحسبه مخاطراً بنفسه، للذي ترى من مطلعه. ولو كان في كل ذلك مخاطراً لما دامت له السلامة، مع تتابع ذلك منه.
قال: ويفخر الخارجي بأنه إذا طلب أدرك، وإذا طلب فات.
والتركي ليس يحوج إلى أن يفوت، لأنه لا يطلب ولا يرام. ومن يروم ما لا يطمع فيه ! فهذا دليل على أنا قد علمنا أن العلة التي عمت بالخوارج بالنجدة استواء حالاتهم في أشد الديانة، واعتقادهم بأن القتال دين؛ لأننا حين وجدنا السجستاني، والجزري، واليماني، والمغربي، والعماني، والأزرقي منهم والنجدي، والإباضي، والصفري، والمولى والعربي، والعجمي والأعرابي، والعبيد والنساء، والحائك والفلاح، كلهم يقاتل مع اختلاف الأنساب، وتباين البلدان علمنا أن الديانة هي التي سوت بينهم في ذلك، كما أن كل حجام في الأرض من أي جنس كان، ومن أهل أي بلد كان، فهو يحب النبيذ. وكما أن أصحاب الخلقان، والسماكين، والنخاسين والحاكة، في كل بلد ومن كل جنس، شرار خلق الله في المبايعة والمعاملة. فعلمنا بذلك أن ذلك خلقة في هذه الصناعات، وبنية في هذه التجارات، حتى صاروا من بين جميع الناس كذلك.
قال: ورأيناه في بلاده ليس يقاتل على دين، ولا على تأويل، ولا على ملك ولا على خراج، ولا على عصبية، ولا على غيرة دون الحرمة، ولا على حمية ولا على عداوة، ولا على وطن ولا على منع دار ولا مال، وإنما يقاتل على السلب والخيار في يده. وليس يخاف الوعيد إن هرب، ولا يرجو الوعد إن أبلى عذراً. وكذلك هم في بلادهم وغاراتهم وحروبهم.
وهو الطالب غير المطلوب، ومن كان كذلك فإنما يأخذ العفو من قوته، ولا يحتاج إلى مجهوده، ثم مع ذلك لا يقوم له شيء، ولا يطمع فيه أحد، فما ظنك بمن هذه صفته، أن لو اضطره إحراج أو غيرة، أو غضب أو تدين، أو عرض له بعض ما يصحب المقاتل المحامي من العلل والأسباب.
قال: وقناة الخارجي طويلة صماء، وقناة التركي مطرد أجوف.
والقنا الجوف القصار أشد طعنة، وأخف محملا. والعجم تجعل القنا الطوال للرجالة، وهي قنا الأبناء على أبواب الخنادق والمضايق.
والأبناء في هذا الباب لا يجرون مع الأتراك والخراسانية، لأن الغالب على الأبناء المطاعنة على أبواب الخنادق، وفي المضايق، وهؤلاء أصحاب الخيل والفرسان، وعلى أصحاب الخيل والفرسان يدور أمر الفروسية. لهم الفر والكر. والفارس هو الذي يطوي الجيش طي السجل، ويفرقهم فرق الشعر. وليس يكون الكمين ولا الطليعة ولا الساقة إلا الكبار منهم. وهم أصحاب الأيام المذكورة، والحروب الكبار، والفتوح العظام.
فصل منها
والشح على الوطن، والحنين إليه، والصبابة به، مذكور في القرآن، مخطوط في الصحف بين جميع الناس، غير أن التركي للعلل التي ذكرناها أشد حنيناً، وأكثر نزوعاً.وباب آخر مما كان يدعوهم إلى الرجوع قبل ثني العزم والعادة المنقوضة: وذلك أن الترك قوم يشتد عليهم الحصر والجثوم، وطول البث والمكث، وقلة التصرف والتحرك. وأصل بنيتهم إنما وضع على الحركة، وليس للسكون فيهم نصيب، وفي قوى أرواحهم فضل على قوى أبدانهم، لأنهم أصحاب توقد وحرارة، واشتعال وفطنة، كثيرة خواطرهم، سريع لحظهم. وكانوا يرون الكفاية معجزة، وطول المقام بلدة، والراحة عقلة والقناعة من قصر الهمة، وأن ترك الغزو يورث الذلة.
وقد قالت العرب في مثل ذلك: قال عبد الله بن وهب الراسبي: " حب الهوينى يكسب النصب " .
والعرب تقول: " من غلا دماغه في الصيف غلت قدره في الشتاء " .
وقال أكثم بن صيفي: " ما أحب أني مكفي كل أمر الدنيا " ، قيل: ولم قال: " أخاف عادة العجز " .
فهذه كانت علل الترك في حب الرجوع، والحنين إلى الوطن.
ومن أعظم ما كان يدعوهم إلى الشرود، ويبعثهم على الرجوع، ويكره عندهم المقام، ما كانوا فيه من جهل قوادهم بأقدارهم، وقلة معرفتهم بأخطارهم، وإغفالهم موضع الرد عليهم، والانتفاع بهم، ولأنهم حين جعلوهم أسوة أجنادهم لم يقنعوا أن يكونوا في الحاشية والحشوة، وفي غمار العامة، ومن عرض العساكر، وأنفوا من ذلك لأنفسهم، وذكروا ما يجب لهم، ورأوا أن الضيم لا يليق بهم، وأن الخمول لا يجوز عليهم، وأنهم في المقام على من لم يعرف حقهم ألوم ممن منعهم حقهم. فلما صادفوا ملكاً حكيماً، وبأقدار الناس عليماً، لا يميل إلى سوء عادة، ولا يجنح إلى هوىً، ولا يتعصب لبلد على بلد، يدور مع التدبير حيثما دار، ويقيم مع الحزم حيثما أقام أقاموا إقامة من منح الحظ، ودان بالحق، ونبذ العادة، وآثر الحقيقة، ورحل نفسه لقطيعة وطنه، وآثر الإمامة على ملك الجبرية، واختار الصواب على الإلف.
ثم اعلم بعد ذلك كله أن كل أمة وقرن وجيل وبني أب وجدتهم قد برعوا في الصناعات، وفضلوا الناس في البيان، أو فاقوهم في الآداب أو في تأسيس الملك، أو في البصر في الحرب. فإنك لا تجدهم في الغاية وفي أقصى النهاية، إلا أن يكون الله تعالى قد سخرهم لذلك المعنى بالأسباب، وقصرهم عليه بالعلل التي تقابل تلك الأمور، وتصلح لتلك المعاني، لأن من كان متقسم الهوى، مشترك الرأي، متشعب النفس، غير موفر على ذلك الشيء، ولا مهيأ له، لم يحذق من تلك الأشياء شيئاً بأسره، ولم يبلغ فيه غايته، كأهل الصين في الصناعات، واليونانيين في الحكم والآداب، والعرب فيما نحن ذاكروه في موضعه، والساسان في الملك، والأتراك في الحروب.
ألا ترى أن اليونانيين الذين نظروا في العلل لم يكونوا تجاراً ولا صناعاً بأكفهم، ولا أصحاب زرع وفلاحة، وبناء وغرس، ولا أصحاب جمع ومنع وكد. وكانت الملوك تفرغهم، وتجري عليهم كفايتهم، فنظروا حين نظروا بأنفس مجتمعة، وقوة وافرة، وأذهان فارغة، حتى استخرجوا الآلات والأدوات، والملاهي التي تكون جماماً للنفس، وراحة بعد الكد، وسروراً يداوي قرح الهموم، فصنعوا من المرافق، وصاغوا من المنافع، كالقرسطونات، والقبانات، والأسطرلابات، وآلة الساعات، وكالكونيا، والكسيران، والبركار، وكأصناف المزامير والمعازف، والطب والحساب، والهندسة، واللحون، وآلات الحرب، وكالمجانيق، والعرادات، والرتيلات، والدبابات، وآلاة النفاطين، وغير ذلك مما يطول ذكره.
وكانوا أصحاب حكمة، ولم يكونوا فعلة. يصورون الآلة، ويخرطون الأداة، ويصوغون المثل ولا يحسنون العمل بها، ويشيرون إليها ولا يمسونها، يرغبون في التعليم، ويرغبون عن العمل.
فأما سكان الصين فإنهم أصحاب السبك والصياغة، والإفراغ والإذابة، والأصباغ العجيبة، وأصحاب الخرط والنجر والتصاوير، والنسج والخط، ورفق الكف في كل شيء يتولونه ويعانونه، وإن اختلف جوهره، وتباينت صنعته، وتفاوت ثمنه.
فاليونانيون يعرفون العلل ولا يباشرون العمل، وسكان الصين يباشرون العمل ولا يعرفون العلل؛ لأن أولئك حكماء، وهؤلاء فعلة.
وكذلك العرب لم يكونوا تجاراً ولا صناعاً، ولا أطباء ولا حساباً ولا أصحاب فلاحة، فيكونوا مهنة، ولا أصحاب زرع، لخوفهم صغار الجزية. ولم يكونوا أصحاب جمع وكسب، ولا أصحاب احتكار لما في أيديهم، وطلب لما عند غيرهم، ولا طلبوا المعاش من ألسنة الموازين ورءوس المكاييل، ولا عرفوا الدوانيق والقراريط، ولم يفتقروا الفقر المدقع الذي يشغل عن المعرفة، ولم يستغنوا الغناء الذي يورث البلدة، والثروة التي تحدث الغرة، ولم يحتملوا ذلاً قط فيميت قلوبهم، ويصغر عندهم أنفسهم. وكانوا سكان فياف، وتربية العراء، لا يعرفون الغمق ولا اللثق، ولا البخار ولا الغلظ، ولا العفن، ولا التخم. أذهان حديدة، ونفوس منكرة. فحين حملوا حدهم، ووجهوا قواهم إلى قول الشعر، وبلاغة المنطق، وتشقيق اللغة، وتصاريف الكلام، وقيافة البشر بعد قيافة الأثر، وحفظ النسب، والاهتداء بالنجوم، والاستدلال بالآثار، وتعرف الأنواء، والبصر بالخيل والسلاح وآلة الحرب، والحفظ لكل مسموع، والاعتبار بكل محسوس، وإحكام شأن المناقب والمثالب، بلغوا في ذلك الغاية، وحازوا كل أمنية. وببعض هذه العلل صارت نفوسهم أكبر، وهممهم أرفع، وهم من جميع الأمم أفخر، ولأيامهم أذكر.
وكذلك الترك، أصحاب عمد، وسكان فياف، وأرباب مواش. وهم أعراب العجم، كما أن هذيلاً أكراد العرب، لم تشغلهم الصناعات ولا التجارات، ولا الطب والفلاحة والهندسة، ولا غراس ولا بنيان، ولا شق أنهار، ولا جباية غلات، ولم يكن همهم غير الغارة والغزو والصيد، وركوب الخيل، ومقارعة الأبطال، وطلب الغنائم، وتدويخ البلاد. وكانت هممهم إلى ذلك مصروفة، وكانت لهذه المعاني والأسباب المسخرة، ومقصورة عليها وموصولة بها، أحكموا ذلك الأمر بأسره، وأتوا على آخره، وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم، ولذتهم في الحرب وفخرهم، وحديثهم وسمرهم.
فلما كانوا كذلك صاروا في الحرب كاليونانيين في الحكمة، وأهل الصين في الصناعات، والأعراب فيما عددنا ونزلنا، وكالساسان في الملك والسياسة.
ومما يستدل به على أنهم قد استقصوا هذا الباب واستفرغوه، وبلغوا أقصى غايته وتعرفوه، أن السيف إلى أن يتقلده متقلد، أو يضرب به ضارب، قد مر على أيد كثيرة، وعلى طبقات من الصناع، كل واحد منهم لا يعمل عمل صاحبه ولا يحسنه، ولا يدعيه ولا يتكلفه؛ لأن الذي يذيب حديد السيف ويميعه ويصفيه ويهذبه، غير الذي يمده ويمطله، والذي يمده ويمطله غير الذي يطبعه ويسوي متنه، ويقيم خشيبته، والذي يطبعه ويسوي متنه غير الذي يسقيه ويرهفه، والذي يسقيه ويرهفه، غير الذي يركب قبيعته، ويستوثق من سيلانه، والذي يعمل مسامير السيلان، وشاربي القبيعة ونعل السيف غير الذي ينحت خشب غمده. والذي ينحت خشب غمده غير الذي يدبغ جلده، والذي يدبغ جلده غير الذي يحليه، والذي يحليه ويركب نصله غير الذي يخرز حمائله.
وكذلك السرج، وحالات السهم والجعبة والرمح، وجميع السلاح مما هو جارح أو جنة.
والتركي يعمل هذا كله بنفسه، من ابتدائه إلى غايته، ولا يستعين برفيق، ولا يفزع إلى رأي صديق، ولا يختلف إلى صائغ، ولا يشغل قلبه بمطاله وتسويفه، وأكاذيب مواعيده، وبغرم كرائه.
وليس في الأرض كل تركي كما وصفنا، كما أنه ليس كل يوناني حكيماً، ولا كل صيني حاذقاً، ولا كل أعرابي شاعراً فائقاً، ولكن هذه الأمور في هؤلاء أعم وأتم، وفيهم أظهر وأكثر.
قد قلنا في السبب الذي تكاملت به النجدة والفروسية في الترك دون جميع الأمم، وفي العلل التي من أجلها نظموا جميع معاني الحرب، وهي معان تشتمل على مذاهب غريبة، وخصال عجيبة، فمنها ما يقضى لأهله بالكرم، وببعد الهمة، وطلب الغاية. ومنها ما يدل على الأدب السديد، والرأي الأصيل، والفطنة الثاقبة، والبصيرة النافذة.
ألا ترى أنه ليس بد لصاحب الحرب من الحلم والعلم، والحزم والعزم، والصبر والكتمان، ومن الثقافة وقلة الغفلة، وكثرة التجربة ولا بد من الصبر بالخيل والسلاح، والخبرة بالرجال والبلاد، والعلم بالمكان والزمان والمكايد، وبما فيه صلاح الأمور كلها.
والملك يحتاج إلى أواخ شداد، وأسباب متان، ومن أمتنها سبباً، وأعمها نفعاً، ما ثبته في نصابه، وسكنه في قراره، وزاده في تمكينه وبهائه، وقطع أسباب المطمعة فيه، ومنع أيدي البغاة من الإشارة إليه، فضلاً عن البسط عليه.
قد قلنا في مناقب جميع الأصناف بجمل ما انتهى إلينا، وبلغه علمنا، فإن وقع بالموافقة فبتوفيق من الله تعالى وصنعه، عز ذكره. وإن قصر دون ذلك فالذي قصر بنا نقصان علمنا، وقلة حفظنا، وأسماعنا. فأما حسن النية، والذي نضمر من المحبة والاجتهاد في القربة، فإنا لا نرجع في ذلك إلى أنفسنا بلائمة. وبين التقصير من جهة العجز وضعف القوة فرق.
ولو كان هذا الكتاب من كتب المناقضات، وكتب المسائل والجوابات، وكان كل صنف من هذه الأصناف يريد الاستقصاء على صاحبه، ويكون غايته إظهار نفسه وإن لم يصل إلى ذلك إلا بإظهار نقص أخيه ووليه، لكان كتابنا كبيراً، كثير الورق عظيماً. ولكن القليل الذي يجمع، خير من الكثير الذي يفرق.
ونحن نعوذ بالله من هذا المذهب، ونسأله العون والتسديد، إنه سميع قريب، فعال لما يريد.
فصل من صدر كتابه في حجج النبوة
الحمد لله الذي عرفنا نفسه، وعلمنا دينه، وجعلنا من الدعاة إليه، والمحتجين له. فنحن نسأله تمام النعمة، والعون على أداء شكره، وأن يوفقنا للحق برحمته، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، والمرغوب إليه فيه، وصلى الله على محمد وآله وسلم.ثم إنا قائلون في الأخبار، ومخبرون عن الآثار، ومفرقون بين أسباب الشبهة، وأسباب الحجة، ثم مفرقون بين الحجة التي تلزم الخاصة دون العامة، ومخبرون عن الضرب الذي يكون الخاصة فيه حجة على العامة، وعن الموضع الذي يكون القليل فيه أحق بالحجة من الكثير، ولم شاع الخبر وأصله ضعيف ولم خفي وأصله قوي وما الذي يؤمن من فساده وتبديله مع تقادم عصره، وكثرة الطاعنين فيه، وعن الحاجة إلى رواية الآثار، وإلى سماع الأخبار، وعن أخلاق الناس وآبائهم، ومذاهب أسلافهم، وعن سير الملوك قبلهم، وما صنعت الأيام بهم، وعن شرائع أنبيائهم، وأعلام رسلهم، وعن أدب حكمائهم، وأقاويل أئمتهم وفقهائهم، وعن حالات من غاب عن أبصارهم في دهرهم، ولم كان الإخبار على الناس أخف من الكتمان ولم كان الصمت أثقل عليهم من الكلام وما الضرب الذي يقدرون على كتمانه وطيه، والضرب الذي لا يقدرون إلا على إذاعته ونشره ولم اجتمعت الأمم على الصدق في أمور، واختلفت في غيرها ولم حفظت أموراً ونسيت سواها ولم كان الصدق أكثر من الكذب ولم كان الصمت أثقل والقول أفضل والعجب من ترك الفقهاء تمييز الآثار، وترك المتكلمين القول في تصحيح الأخبار، وبالأخبار يعرف الناس النبي من المتنبي، والصادق من الكاذب، وبها يعرفون الشريعة من السنة، والفريضة من النافلة، والحظر من الإباحة، والاجتماع من الفرقة، والشذوذ من الاستفاضة، والرد من المعارضة، والنار من الجنة، وعامة المفسدة من المصلحة.
فإذا نزلت الأخبار منازلها وقسمتها، ذكرت حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلائله وشرائعه وسننه، ثم جنست الآثار على أقدارها، ورتبتها في مراتبها، وقربت ذلك واختصرته، وأوضحت عنه وبينته، حتى يستوي في معرفتها من قل سماعه وساء حفظه، ومن كثر سماعه وجاد حفظه، بالوجوه الجليلة، والأدلة الاضطرارية.
ولم أرد في هذا الكتاب جمع حجج الرسول عليه السلام، وتفصيلها والقول فيها، لنقض مسها،أولوهن كان في أصلها من ناقليها والمخبرين عنها، أو لأن طعن الملحدين نهكها وفرق جماعتها، ونقض قواها. ولكن لأمور سأذكرها وأحتج.
وكيف تقصر الحجة عن بلوغ الغاية، وتنقص عن التمام، والله تعالى المتوكل بها، ومسخر أصناف البرية ومهيج النفوس على إبلاغها، وقد أخبر بذلك عن نفسه في محكم كتابه عز ذكره، حين قال: " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون " . وأدنى منازل الإظهار إظهار الحجة على من ضاره وخالف عليه.
وقال عز ذكره: " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " .
وأخبر أنه أمر الأحمر والأسود، ولم يكن ليأمر الأقصى إلا كما يأمر الأدنى ويأمر الغائب على الحاضر، قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: " وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً " .
فأقول: إن كل مطيق محجوج، والحجة حجتان: عيان ظاهر، وخبر قاهر. فإذا تكلمنا في العيان وما يفرع منه فلا بد من التعارف في أصله وفرعه منه. ولا بد من التصادق في أصله، والتعارف في فرعه. فالعقل هو المستدل، والعيان والخبر هما علة الاستدلال وأصله، ومحال كون الفرع مع عدم الأصل، وكون الاستدلال مع عدم الدليل. والعقل مضمن بالدليل، والدليل مضمن بالعقل، ولا بد لكل واحد منهما من صاحبه، وليس لإبطال أحدهما وجه مع إيجاب الآخر.
والعقل نوع واحد، والدليل نوعان: أحدهما شاهد عيان يدل على غائب، والآخر مجيء خبر يدل على صدق.
ثم رجع الكلام إلى الإخبار عن دلائل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلامه، والاحتجاج لشواهده وبرهانه، فأقول: إن السلف الذين جمعوا القرآن في المصاحف بعد أن كان متفرقاً في الصدور، والذين جمعوا الناس على قراءة زيد، بعد أن كان غيرها مطلقاً غير محظور، والذين حصنوه ومنعوه الزيادة والنقصان لو كانوا جمعوا علامات النبي صلى الله عليه وسلم، وبرهانه، ودلائله وآياته وصنوف بدائعه، وأنواع عجائبه في مقامه وظعنه، وعند دعائه واحتجاجه في الجمع العظيم، وبحضرة العدد الكثير الذي لا يستطيع الشك في خبرهم إلا الغبي الجاهل، والعدو المائل، لما استطاع اليوم أن يدفع كونها وصحة مجيئها، لا زنديق جاحد، ولا دهري معاند، ولا متطرف ماجن، ولا ضعيف مخدوع، ولا حدث مغرور؛ ولكان مشهوراً في عوامنا كشهرته في خواصنا، ولكان استبصار جميع أعياننا في حقهم كاستبصارهم في باطل نصاراهم ومجوسهم، ولما وجد الملحد موضع طمع في غني يستميله، وفي حدث يموه له.
ولولا كثرة ضعفائنا مع كثرة الدخلاء فينا، الذين نطقوا بألسنتنا، واستعانوا بعقولنا على أغبيائنا وأغمارنا، لما تكلفنا كشف الظاهر، وإظهار البارز، والاحتجاج الواضح.
إلا أن الذي دعا سلفنا إلى ذلك، الاتكال على ظهورها واستفاضة أمرها.
وإذ كان ذلك كذلك فلم يؤت من أتي من جهالنا وأحداثنا، وسفهائنا وخلعائنا إلا من قبل ضعف العناية، وقلة المبالاة، ومن قبل الحداثة والغرارة، ومن قبل أنهم حملوا على عقولهم من دقيق الكلام قبل العلم بجليله ما لم تبلغه قواهم، وتتسع له صدورهم، وتحمله أقدارهم، فذهبوا عن الحق يميناً وشمالاً، لأن من لم يلزم الجادة تخبط، ومن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سقط، ومن خرق بنفسه وكلفها فوق طاقتها، ولم ينل ما لا يقدر عليه تفلت منه ما كان يقدر عليه.
فإذا كانوا كذلك فإنما أتوا من قبل أنفسهم، ولم يؤتوا من سلفهم، أو لأن الله تبارك وتعالى صرف أسلافنا بنسيان أو غيره ليمتحن بذلك غيرهم في آخر الزمان، وليعرضهم لطاعته بالذب عن دينه، والاحتجاج لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليجري هذا الخير على أيديهم، كما أجرى أكثر منه على أيدي أسلافهم، لئلا يبخس أحد خليقته من العلماء والفقهاء، ولأن يجعل فضله مقسماً بين جميع الأولياء، وإن كان الأول أحق بالتقديم، والآخر أحق بالتأخير، للذي قدموا من الاحتمال، وأعطوا من المجهود، ولأنهم أصل هذا الأمر ونحن فرعه، والأصل أحق بالقوة من الفرع. وهم السابقون ونحن التابعون، وهم الذين وطئوا لنا، وكلفونا ما لم نكن لنكلفه أنفسنا، فتجرعوا دوننا المرار، ومنحونا روح الكفاية. ولأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن نطق بفضيلتهم؛ والله تعالى أعلم بمن بعدهم، والذي جمع أسلافنا الذين جمعوا الناس على قراءة زيد، دون أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، والذين رأوا من قول عبد الله في المعوذتين، وقول أبي في سورتي الحفد والخلع.
ومن تعلق الناس بالاختلاف، فكانوا لا يزالون قد رأوا الرجل يروي الحرف الشاذ، ويقرأ بالحرف الذي لا يعرفونه، فرأوا أن تحصينه لا يتم إلا بحمل الناس على المقروء عندهم، المشهور فيما بينهم، وأنهم إن لم يشددوا في ذلك لم ينقطع الطمع، ولم ينزجر الطير، لأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، لتبين له في نظامها ومخرجها، وفي لفظها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها. ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها. وليس ذلك في الحرف والحرفين، والكلمة والكلمتين.
ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم، ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم: الحمد لله، وإنا لله، وعلى الله توكلنا، وربنا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا كله في القرآن، غير أنه متفرق غير مجتمع؛ ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجه لما قدر عليه، ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن عدنان.
ورأوا بفهمهم وبتوفيق الله تعالى لهم أن يحصنوه مما يشكل، ويمكن أن يفتعل مثله من الحرف والحرفين، والكلمة والكلمتين، وقد كانوا عرفوا الابتداع الكثير على البلغاء والشعراء، وخافوا إن هم لم يتقدموا في ذلك أن يتطرفوا عليه، كما تطرفوا على الرواية، لأنهم حين رأوا كثرة الرواية في غير ذوي السابقة، ورأوا كثرة اختلافها، والغرائب التي لا يعرفونها، لم يكن لهم إلا تحصين الشيء الذي عليه مدار الأمر، وإن كانوا يعلمون أن الله بالغ أمره.
فعلى الأئمة أن تحوط هذه الأمة، كما حاط السلف أولها، وأن يعملوا بظاهر الحيطة، إذ كان على الناس الاجتهاد، وليس عليهم علم الغيوب. وإنما ذلك كنحو رجل أبصر نبياً يحيي الموتى فعرف صدقه، فلما انصرف سأله عنه بعض من لم ير ذلك ولا صح عنده، فعليه أن لا يكتمه، وإن كان يعلم أن الله تعالى سيعلمه ذلك من قبل غيره، وأنه عز ذكره سيسمعه صحته على حبه وكرهه.
ورأوا أن قراءة زيد أحق بذلك، إذ كانت آخر العرض، ولأن الجمع الذين سمعوا آخر العرض أكثر ممن سمع أوله، فحملوا الناس على قراءة زيد، دون أبي وعبد الله، وإن كان الكل حقاً، إذ كان رب حق في بعض الزمان أقطع للقيل والقال، وأجدر أن يميت الخلاف، ويحسم الطمع. فتركوا حقاً إلى حق العمل به أحق.
ولو أن فقيهاً رأى إطباق العلماء على صوم يوم عرفة، واستنكارهم الإفطار فيه، فأفطر وأظهر ذلك ليعلمهم موضع الفريضة من النافلة، أو خاف أن يلحق الفرض على تطاول الأيام ما ليس فيه كان مصيباً، ولكان قد ترك حقاً إلى أحق منه.
وللحق درجات، وللخلاف درجات، وللحرام درجات. ألا ترى أن لولي المقتول أن يقتل ويصفح، وأنه إن قتل قتل بحق، وإن صفح صفح بحق، والصفح أفضل من القتل.
ولو أن رجلاً أخرج ساكناً بيتاً له، أو اقتضى ديناً له ساعة محله، أو طلق زوجته وما دخل بها لكان ذلك له، ولحق فعل. وغير ذلك الحق أولى به.
وكيف لا يكون أولى به وهو أحسن، والثواب فيه أعظم، وإلى سلامة الصدور أقرب.
وقد يكون الأمران حسنين، وأحدهما أحسن. وقد يكون الأمران قبيحين، وأحدهما أقبح.
وبعد، فعلى الناس طاعة الأئمة في كل ما أمروا به، إلا فيما تبين أنه معصية. فأما غير ذلك فإنه واجب مفروض، ولازم غير مرفوع.
وعلموا أيضاً أنهم لا يبقون إلى آخر الزمان، وأن من يجيء بعدهم لا يقوم مقامهم، ولا يفصل الأمور تفصيلهم. ولو عرفوا كمعرفتهم، وأرادوا ذلك كإرادتهم، لما أطيعوا كطاعتهم.
وعلموا أن الأكاذيب والبدع ستكثر، وأن الفتن ستفتح، وأن الفساد سيفشو، فكرهوا أن يجعلوا للمتطرفين علة، ولأهل الزيغ حجة.
بل لا شك أنهم لو تركوا الناس عامة يقرءون على حرف فلان وكل ما أجاز فيه فلان عن فلان، لألحق قوم في آخر الزمان بهم ما ليس منهم، ولا يجري مجراهم، ولا يجوز مجازهم.
فصل منه في الاحتجاج للجمع على قراءة زيد
ولو كان زيد من آل أبي العاص، أو من عرض بني أمية، لوجد ابن مسعود متعلقاً.ولو كان بدا زيد عبد الرحمن بن عوف لوجد إلى القول سبيلاً.
ولو كان ابن مسعود رجلاً من بني هاشم لوجد للطعن موضعاً.
ولو كان عثمان رضي الله تعالى عنه استبد بذلك الرأي على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وسعد وطلحة والزبير رحمهم الله، وجميع المهاجرين والأنصار، لوجد للتهمة مساغاً.
فأما والأمر كما وصفنا ونزلنا، فما الطاعن على عثمان إلا رجل أخطأ خطة الحق، وعجل على صاحبه. ولكل بني آدم من الخطأ نصيب، والله عز ذكره يغفر له ويرحمه.
والذي يخطىء عثمان في ذلك فقد خطأ علياً وعبد الرحمن وسعداً، والزبير وطلحة، وعلية الصحابة.
ولو لم يكن ذلك رأي علي لغيره، ولو لم يمكنه التغيير لقال فيه، ولو لم يمكنه في زمن عثمان لأمكنه في زمن نفسه، وكان لا أقل من إظهار الحجة إن لم يملك تحويل الأمة، وكان لا أقل من التجربة إن لم يكن من النجح على ثقة، بل لم يكن لعثمان في ذلك ما لم يكن لجميع الصحابة، وأهل القدم والقدوة. ومع أن الوجه فيما صنعوا واضح، بل لا نجد لما صنعوا وجهاً غير الإصابة والاحتياط، والإشفاق والنظر للعواقب، وحسم طعن الطاعن.
ولو لم يكن ما صنعوا لله تعالى فيه رضاً لما اجتمع عليه أول هذه أول الأمة وآخرها. وإن أمراً اجتمعت عليه المعتزلة والشيعة، والخوارج والمرجئة، لظاهر الصواب، واضح البرهان، على اختلاف أهوائهم، وبغيتهم لكل ما ورد عليهم.
فإن قال قائل: هذه الروافض بأسرها تأبى ذلك وتنكره، وتطعن فيه، وترى تغييره.
قلنا: إن الروافض ليست منا بسبيل، لأن من كان أذانه غير أذاننا، وصلاته غير صلاتنا، وطلاقه غير طلاقنا، وعتقه غير عتقنا، وحجته غير حجتنا، وفقهاؤه غير فقهائنا وإمامه غير إمامنا، وقراءته غير قراءتنا، وحلاله غير حلالنا، وحرامه غير حرامنا، فلا نحن منه ولا هو منا.
ولأي شيء حامت عن قراءة ابن مسعود، فوالله ما كان أحد أفرط في العمرية منه، ولا أشد على الشيعة منه، ولقد بلغ من حبه لعمر رضي الله عنه أن قال: لقد خشيت الله تعالى في حبي لعمر. فلم يحامون عنه وهو كان شجاهم لو أدركهم.
فصل منه
فآمن الله رجلاً فارقهم ولزم الجماعة، فإن فيها الأنسة والحجة، وترك الفرقة فإن فيها الوحشة والشبهة. والحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين أئمتنا، كما جعلنا لا نفرق بين أنبيائنا.فصل منه
والذي دعانا إلى تأليف حجج الرسول ونظمها، وجمع وجوهها وتدوينها أنها متى كانت مجموعة منظومة، نشط لحفظها وتفهمها من كان عسى أن لا ينشط لجمعها، ولا يقدر على نظمها، وجمع متفرقها، وعلى اللفظ المؤثر عنها، ومن كان عسى أن لا يعرف وجه مطلبها، والوقوع عليها.ولعل بعض الناس يعرف بعضها ويجهل بعضها.
ولعل بعضهم وإن كان قد عرفها بحقها وصدقها فلم يعرفها من أسهل طرقها، وأقرب وجوهها.
ولعل بعضهم أن يكون قد عرف فنسي، أو تهاون بها فعمي، بل لا نشك أنها إذا كانت مجموعة محبرة، مستقصاة مفصلة، أنها ستزيد في بصيرة العالم، وتجمع الكل لمن كان لا يعرف إلا البعض، وتذكر الناسي، وتكون عدة على الطاعن.
ولعل بعض من ألحد في دينه، وعمي عن رشده، وأخطأ موضع حظه أن يدعوه العجب بنفسه، والثقة بما عنده، إلى أن يلتمس قراءتها، ليتقدم في نقضها وإفسادها، فإذا قرأها فهمها، وإذا فهمها انتبه من رقدته، وأفاق من سكرته، لعز الحق، وذل الباطل، ولإشراف الحجة على الشبهة، ولأن من تفرد بكتاب فقرأه ليس كمن نازع صاحبه وجاثاه، لأن الإنسان لا يباهي بنفسه، والحق بعد قاهر له. ومع التلاقي يحدث التباهي، وفي المحافل يقل الخضوع، ويشتد النزوع.
ثم رجع الكلام إلى حاجة الناس إلى استماع الأخبار، والتفقه في تصحيح الآثار، فأقول: إن الناس لو استغنوا عن التكرير، وكفوا مئونة البحث والتنقير لقل اعتبارهم. ومن قل اعتباره قل علمه، ومن قل علمه قل فضله، ومن قل فضله كثر نقصه، ومن قل علمه وفضله وكثر نقصه لم يحمد على خير أتاه، ولم يذم على شر جناه، ولم يجد طعم العز، ولا سرور الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد اليقين، ولا راحة الأمن.
وكيف يشكر من لا يقصد، وكيف يلام من لا يتعمد، وكيف يقصد من لا يعلم. وما عسى أن يبلغ قدر سروره من لا يحسن من السرور إلا ما سر به حواسه ومسه جلده.
وكيف يأتي أربح الأفعال، وأبعد الشرين من ركب في شراسة السباع وغباوة البهائم، ثم لم يعط الآلة التي بها يستطيع التفرقة بين ما عليه وله، والعلم بمصالحه ومفاسده، فيقوى بها على عصيان طبائعه، ومخالفة شهواته، وبها يعرف عواقب الأمور، وما تأتي به الدهور، وفضل لذة القلب على لذة البدن.
وإن سرور الجاهل لا يحسن في جنب سرور العالم، وإن لذة البهائم لا تعشر لذة الحكيم العالم.
وأي سرور كسرور العز والرياسة، واتساع المعرفة، وكثرة صواب الرأي، والنجح الذي لا سبب له إلا حسن النظر والتقدم في التدبير، ثم العلم بالله وحده، وأنك بعرض ولايته والجاه عنده، وأنه الذي يرعاك ويكفيك، وأنك إذا علمت اليسير أعطاك الكثير، ومتى تركت له الفاني أعطاك الباقي، ومتى أدبرت عنه دعاك، ومتى رجعت إليه اجتباك، ويحمدك على حقك، ويعطيك على نظرك، لنفسك ولا يفنيك إلا ليبقيك، ولا يميتك إلا ليحييك، ولا يمنعك إلا ليعطيك. وأنه المبتدىء بالنعمة قبل السؤال، والناظر لك في كل حال.
وهذا كله لا ينال إلا بغريزة العقل. على أن الغريزة لا تنال ذلك بنفسها، بما باشرته حواسها، دون النظر والتفكر، والبحث والتصفح.
ولن ينظر ناظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة التي تبعث على الفكرة، وعلى طلب الحيلة. ولذلك وضع الله تعالى في الإنسان طبيعة الغضب، وطبيعة الرضا، وطبيعة البخل والسخاء، والجزع والصبر، والرياء والإخلاص، والكبر والتواضع، والسخط والقناعة، فجعلها عروقاً. ولن تفي قوة غريزة العقل بجميع قوى طبائعه وشهواته، حتى يقيم ما اعوج منها، ويسكن ما تحرك، دون النظر الطويل الذي يشدها، والبحث الشديد الذي يشحذها، والتجارب التي تحنكها، والفوائد التي تزيد فيها. ولن يكثر النظر حتى تكثر الخواطر، ولن تكثر الخواطر حتى تكثر الحوائج، ولن تبعد الرؤية إلا لبعد الغاية وشدة الحاجة.
ولو أن الناس تركوا وقدر قوى غرائزهم، ولم يهاجوا بالحاجة على طلب مصلحتهم والتفكر في معاشهم، وعواقب أمورهم، وألجئوا إلى قدر خواطرهم التي تولد مباشرة حواسهم، دون أن يسمعهم الله تعالى خواطر الأولين، وأدب السلف المتقدمين، وكتب رب العالمين، لما أدركوا من العلم إلا اليسير، ولما ميزوا من الأمور إلا القليل.
ولولا أن الله تعالى أراد تشريف العالم وتربيته، وتسويد العاقل ورفع قدره، وأن يجعله حكيماً، وبالعواقب عليماً، لما سخر له كل شيء، ولم يسخره لشيء، ولما طبعه الطبع الذي يجيء منه أريب حكيم، وعالم حليم.
كما أنه عز ذكره لو أراد أن يكون الطفل عاقلاً، والمجنون عالماً، لطبعهم طبع العاقل، ولسواهم تسوية العالم، كما أراد أن يكون السبع وثاباً، والحديد قاطعاً، والسم قاتلاً، والغذاء مقيماً؛ فكذلك أراد أن يكون المطبوع على المعرفة عالماً، والمهيأ للحكمة حكيماً، وذو الدليل مستدلاً، وذو النعمة مستنفعاً بها.
فلما علم الله تبارك وتعالى أن الناس لا يدركون مصالحهم بأنفسهم، ولا يشعرون بعواقب أمورهم بغرائزهم، دون أن يرد عليهم آداب المرسلين، وكتب الأولين، والأخبار عن القرون، والجبابرة الماضين طبع كل قرن من الناس على أخبار من يليه، ووضع القرن الثاني دليلاً يعلم به صدق خبر الأول؛ لأن كثرة السماع للأخبار العجيبة، والمعاني الغريبة، مشحذة للأذهان، ومادة للقلوب، وسبب للتفكير، وعلة للتنقير عن الأمور.
وأكثر الناس سماعاً أكثرهم خواطر، وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكراً، وأكثرهم تفكراً أكثرهم علماً، وأكثرهم علماً أرجحهم عملاً. كما أن أكثر البصراء رؤية للأعاجيب أكثرهم تجارب، ولذلك صار البصير أكثر خواطر من الأعمى، وصار السميع البصير أكثر خواطر من البصير.
وعلى قدر شدة الحاجة تكون الحركة، وعلى قدر ضعف الحاجة يكون السكون، كما أن الراجي والخائف دائبان، والآيس والآمن وادعان.
وإذا كان الله تعالى لم يخلق عباده في طبع عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا، وآدم أبي البشر، صلوات الله عليهم أجمعين، وخلقهم منقوصين، وعن درك مصالحهم عاجزين، وأراد منهم العبادة، وكلفهم الطاقة، وترك العنان للأمل البعيد، وأرسل إليهم رسله، وبعث فيهم أنبياءه، وقال: " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " ، ولم يشهد أكثر عباده حجج رسله عليهم السلام، ولا أحضرهم عجائب أنبيائه، ولا أسمعهم احتجاجهم، ولا أراهم تدبيرهم لم يكن بد من أن يطلع المعاينين على أخبار الغائبين، وأن يسخر أسماع الغائبين لأخبار المعاندين، وأن يخالف بين طبائع المخبرين، وعلل الناقلين، ليدل السامعين، ومن يجيب من الناس.
على أن العدد الكثير المختلفي العلل، المتضادي الأسباب، المتفاوتي الهمم، لا يتفقون على تخرص الخبر في المعنى الواحد، وكما لا يتفقون على الخبر الواحد على غير التلاقي والتراسل إلا وهو حق. فكذلك لا يمكن مثلهم في مثل عللهم التلاقي عليه، والتراسل فيه.
ولو كان تلاقيهم ممكناً، وتراسلهم جائزاً لظهر ذلك وفشا، واستفاض وبدا.
ولو كان ذلك أيضاً ممكناً، وكان قولاً متوهماً لبطلت الحجة، ولنقضت العادة، ولفسدت العبرة، ولعادت النفس بعلة الأخبار جاهلة، ولكان للناس على الله أكبر الحجة. وقد قال الله جل وعز: " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " ، إذ كلفهم طاعة رسله، وتصديق أنبيائه ورسله وكتبه، والإيمان بجنته وناره، ولم يضع لهم دليلاً على صدق الأخبار، وامتناع الغلط في الآثار، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
واعلم أن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بينهم، ولم يحب أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم؛ لأن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة، وكانوا مجبرين في الأمور المتفقة والمختلفة، لجاز أن يختاروا بأجمعهم التجارة والصناعة، ولجاز أن يطلبوا بأجمعهم الملك والسياسة. وفي هذا ذهاب العيش، وبطلان المصلحة، والبوار والتواء.
ولو لم يكونوا مسخرين بالأسباب، مرتهنين بالعلل لرغبوا عن الحجامة أجمعين، والبيطرة، والقصابة، والدباغة. ولكن لكل صنف من الناس مزين عندهم ما هم فيه، ومسهل ذلك عليهم. فالحائك إذا رأى تقصيراً من صاحبه أو سوء حذق أو خرقا قال له: يا حجام! والحجام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له: يا حائك! ولذلك لم يجمعوا على إسلام أبنائهم في غير الحياكة والحجامة، والبيطرة والقصابة.
ولولا أن الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبباً للاتفاق والائتلاف، لما جعل واحداً قصيراً والآخر طويلاً، وواحداً حسناً وآخر قبيحاً، وواحداً غنياً وآخر فقيراً، وواحداً عاقلاً وآخر مجنوناً، وواحداً ذكياً وآخر غبياً. ولكن خالف بينهم ليختبرهم، وبالاختبار يطيعون، وبالطاعة يسعدون. ففرق بينهم ليجمعهم، وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوبة. فسبحانه وتعالى، ما أحسن ما أبلى وأولى، وأحكم ما صنع، وأتقن ما دبر! لأن الناس لو رغبوا كلهم عن عار الحياكة لبقينا عراة. ولو رغبوا بأجمعهم عن كد البناء لبقينا بالعراء. ولو رغبوا عن الفلاحة لذهبت الأقوات، ولبطل أصل المعاش. فسخرهم على غير إكراه، ورغبهم من غير دعاء.
ولولا اختلاف طبائع الناس وعللهم لما اختاروا من الأشياء إلا أحسنها، ومن البلاد إلا أعدلها، ومن الأمصار إلا أوسطها. ولو كانوا كذلك لتناجزوا على طلب الأواسط، وتشاجروا على البلاد العليا، ولما وسعهم بلد، ولما تم بينهم صلح. فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة.
وكيف لا يكون كذلك وأنت لو حولت ساكني الآجام إلى الفيافي، وساكني السهل إلى الجبال، وساكني الجبال إلى البحار، وساكني الوبر إلى المدر، لأذاب قلوبهم الهم، ولأتى عليهم فرط النزاع.
وقد قيل: " عمر الله البلدان بحب الأوطان " .
وقال عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى: " ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم " .
وقال معاوية في قوم من اليمن رجعوا إلى بلادهم بعد أن أنزلهم من الشام منزلاً خصباً، وفرض لهم في شرف العطاء: " يصلون أوطانهم بقطيعة أنفسهم " .
وقال الله جل وعز: " ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم " . فقرن الضن بالأوطان إلى الضن بمهج النفوس.
وليس على ظهرها إنسان إلا وهو معجب بعقله، لا يسره أن له بجميع ما له ما لغيره، ولولا ذلك لماتوا كمداً، ولذابوا حسدا، ولكن كل إنسان وإن كان يرى أنه حاسد في شيء فهو يرى أنه محسود في شيء.
ولولا اختلاف الأسباب لتنازعوا بلدة واحدة، واسماً واحداً، وكنية واحدة. فقد صاروا كما ترى مع اختيار الأشياء المختلفة إلى الأسماء القبيحة، والألقاب السمجة. والأسماء مبذولة، والصناعات مباحة، والمتاجر مطلقة، ووجوه الطرق مخلاة، ولكنها مطلقة في الظاهر، مقسمة في الباطن، وإن كانوا لا يشعرون بالذي دبر الحكيم من ذلك، ولا بالمصلحة فيه.
فسبحان من حبب إلى واحد أن يسمي ابنه محمداً، وحبب إلى آخر أن يسميه شيطاناً، وحبب إلى آخر أن يسميه عبد الله، وحبب إلى آخر أن يسميه حماراً، لأن الناس لو لم يخالف بين عللهم في اختيار الأسماء والكنى، جاز أن يجتمعوا على شيء واحد، وكان في ذلك بطلان العلامات، وفساد المعاملات.
وأنت إذا رأيت ألوانهم وشمائلهم واختلاف صورهم، وسمعت لغاتهم ونغمهم علمت أن طبائعهم وعللهم المحجوبة الباطنة، على حسب أمورهم الظاهرة.
وبعض الناس وإن كان مسخراً للحياكة فليس بمسخر للفسق والخيانة، وللإحكام والصدق والأمانة.
وقد يسخر الله الملك لقوم بأسباب قديمة وأسباب حديثة، فلا يزال ذلك الملك مقصوراً عليهم، ما دامت تلك الأسباب قائمة، إذا كانوا للملك مسخرين، وكان الناس لهم مسخرين، بالجبرية والنخوة، والفظاظة والقسوة، ولطول الاحتجاب والاستتار، وسوء اللقاء والتضييع.
وقد يكون الإنسان مسخراً لأمر، ومخيراً في آخر.
ولولا الأمر والنهي لجاز التسخير في دقيق الأمور وجليلها، وخفيها وظاهرها؛ لأن بني الإنسان إنما سخروا له إرادة العائدة إليهم، ولم يسخروا للمعصية، كما لم يسخروا للمفسدة.
وقد تستوي الأسباب في مواضع، وتتفاوت في مواضع. كل ذلك ليجمع الله تعالى لهم مصالح الدنيا، ومراشد الدين.
ألا ترى أن أمة قد اجتمعت على أن عيسى عليه السلام هو الله، وأمة قد اجتمعت على أنه ابن الله، وأمة اجتمعت على أن الآلهة ثلاثة، عيسى أحدها. ومنهم يتبدد، ومنهم من يتدهر، ومنهم من يتحول نسطورياً بعد أن كان يعقوبياً، ومنهم من أسلم بعد أن كان نصرانياً. ولست واجداً هذه الأمة مع اختلاف مذاهبها، وكثرة تنقلها، انتقلت مرة واختلفت مرة، متعمدة أو ناسية، في يوم واحد، فجعلته - وهو الجمعة - يوم السبت، ولم تخطب في يوم جمعة بخطبة يوم خميس، ولا غلطت في كانون الأول فجعلته كانون الآخر، ولا بين الصوم والإفطار؛ لأن الباب الأول في باب الإمكان وتعديل الأسباب والامتحان، والباب الثاني داخل في باب الامتناع وتسخير النفوس وطرح الامتحان.
وقد زعم ناس من الجهال، ونفر من الشكاك، ممن يزعم أن الشك واجب في كل شيء، إلا في العيان، أن أهل المنصورة وافوا مصلاهم يوم خميس على أنه يوم الجمعة، في زمن منصور بن جمهور وأن أهل البحرين جلسوا عن مصلاهم يوم الجمعة على أنه يوم خميس، في زمن أبي جعفر، فبعث إليهم وقومهم.
وهذا لا يجوز ولا يمكن في أهل الأمصار، ولا في العدد الكثير من أهل القرى، لأن الناس من بين صانع لا يأخذ أجرته ولا راحة له دون الجمعة، وبين تجار قد اعتادوا الدعة في الجمع، والجلوس عن الأسواق. ومن معلم كتاب لا يصرف غلمانه إلا في الجمع. وبين معني بالجمع يتلاقى هناك مع المعارف والإخوان والجلساء. وبين معني بالجمع حرصاً على الصلاة، ورغبة في الثواب. ومن رجل عليه موعد ينتظره. ومن صيرفي يصرف ذلك اليوم سفاتجه وكتب أصحابه. ومن جندي فهو يعرف بذلك نوبته. وبعض كالسؤال والمساكين والقصاص، الذين يمدون أعناقهم للجمعة انتظاراً للصدقة والفائدة، في أمور كثيرة، وأسباب مشهورة.
ولو جاز ذلك في أهل البحرين والمنصورة لجاز ذلك على أهل البصرة والكوفة، ولو جاز ذلك في الأيام لكان في الشهور أجوز، ولو جاز ذلك في الشهور لكان في السنين أجوز. وفي ذلك فساد الحج، والصوم، والصلاة، والزكاة، والأعياد.
ولو كان ذلك جائزاً لجاز أن يتفق الشعراء على قصيدة واحدة، والخطباء على خطبة واحدة، والكتاب على رسالة واحدة، بل جميع الناس على لفظة واحدة.
وإنما نزلت لك حالات الناس، وخبرتك عن طبائعهم، وفسرت لك عللهم لتعلم أن العدد الكثير لا يتفقون على تخرص الخبر الواحد في المعنى الواحد في الزمن الواحد، على غير التشاعر، فيكون باطلاً. وسأوجدك موضع اختلافهم واتفاقهم، وأنه لم يخالف بينهم في بعض الوجوه إلا إرهاصاً لمصلحتهم، ولتصح أخبارهم.
ألا ترى أن أحداً لم يبع قط سلعة بدرهم إلا وهو يرى أن ذلك الدرهم خير له من سلعته. ولم يشتر أحد قط سلعة بدرهم إلا وهو يرى أن تلك خير له من درهمه. ولو كان صاحب السلعة يرى في سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم، وكان صاحب الدرهم يرى في الدرهم ما يرى فيه صاحب السلعة ما اتفق بينهم شراء أبداً. وفي هذا جميع المفسدة، وغاية الهلكة.
فسبحان الذي حبب إلينا ما في أيدي غيرنا، وحبب إلى غيرنا ما في أيدينا، ليقع التبايع. وإذا وقع التبايع وقع الترابح، وإذا وقع الترابح وقع التعايش.
ويدلك أيضاً على اختلاف طبائعهم وأسبابهم: أنك تجد الجماعة وبين أيديهم الفاكهة والرطب، فلا تجد يدين تلتقيان على رطبة بعينها، وكل واحد من الجميع يرى ما حواه الطبق، غير أن شهوته وقعت على واحدة غير التي آثرها صاحبه. ولربما سبق الرجل إلى الواحدة، وقد كان صاحبه يريدها في نفسه، غير أن ذلك لا يكون إلا في الفرط، ولو كانت شهواتهم ودواعيهم تتفق على واحدة بعينها لكان في ذلك التمانع والتجاذب، والمبادرة وسوء المخالطة والمؤاكلة. وكذلك هو في شهوة النساء والإماء، والمراكب والكسى. وهذا كثير، والعلم به قليل. وبأقل مما قلنا يعرف العاقل صواب مذهبنا. والله تعالى نسأل التوفيق.
وهو الذي خالف بين طبائعهم وأسبابهم، حتى لا يتفق على تخرص خبر واحد، لأن في اتفاق طبائعهم وأسبابهم في جهة الإخبار فساد أمورهم، وقلة فوائدهم واعتبارهم، وفي فساد أخبارهم فساد متاجرهم والعلم بما غاب عن أبصارهم، وبطلان المعرفة بأنبيائهم ورسلهم عليهم السلام، ووعدهم ووعيدهم، وأمرهم ونهيهم وزجرهم، ورغبتهم، وحدودهم، وقصاصهم الذي هو حياتهم، والذي يعدل طبائعهم، ويسوي أخلاقهم، ويقوي أسبابهم، والذي به يتمانعون من تواثب السباع، وقلة احتراس البهائم، وإضاعة الأعمار. وبه تكثر خواطرهم وتفكيرهم، وتحسن معرفتهم.
ولم نقل أن العدد الكثير لا يجتمعون على الخبر الباطل، كالتكذيب والتصديق، ونحن قد نجد اليهود والنصارى، والمجوس والزنادقة، والدهرية وعباد البددة يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون آياته وأعلامه، ويقولون: لم يأت بشيء، ولا بان بشيء. وإنما قلنا: إن العدد الكثير لا يتفقون على مثل إخبارهم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، التهامي الأبطحي عليه السلام خرج بمكة، ودعا إلى كذا، وأمر بكذا، ونهى عن كذا، وأباح كذا، وجاء بهذا الكتاب الذي نقرؤه، فوجب العمل بما فيه، وأنه تحدى البلغاء والخطباء والشعراء، بنظمه وتأليفه، في المواضع الكثيرة، والمحافل العظيمة. فلم يرم ذلك أحد ولا تكلفه، ولا أتى ببعضه ولا شبيه منه، ولا ادعى أنه قد فعل، فيكون ذلك الخبر باطلاً.
وليس قول جمعهم إنه كان كاذباً معارضة لهذا الخبر، إلا أن يسموا الإنكار معارضة. وإنما المعارضة مثل الموازنة والمكايلة، فمتى قابلونا بأخبار في وزن أخبارنا ومخرجها ومجيئها، فقد عارضونا ووازنونا وقابلونا، وقد تكافينا وتدافعنا. فأما الإنكار فليس بحجة، كما أن الإقرار ليس بحجة، ولا تصديقنا النبي صلى الله عليه وسلم حجة على غيرنا، ولا تكذيب غيرنا له حجة علينا، وإنما الحجة في المجيء الذي لا يمكن في الباطل مثله.
فإن قلت: وأي مجيء أثبت خبر الأنصاري عن عيسى بن مريم عليه السلام وذلك أنك لو سألت النصارى مجتمعين ومتفرقين لخبروك عن أسلافهم أن عيسى قد قال: إني إله.
قلنا: قد علمنا أن نصارى عصرنا لم يكذبوا على القرن الذي كان قبلهم، والذين كانوا يلونهم. ولكن الدليل على أن أصل خبرهم ليس كفرعه، أن عيسى عليه السلام لو قال: إني إله لما أعطاه الله تعالى إحياء الموتى، والمشي على الماء. على أن في عيسى عليه السلام دلالة في نفسه، أنه ليس بإله، وأنه عبد مدبر، ومقهور ميسر، وليس خبرهم هذا إلا كإخبار النصارى عن آبائهم والقرن الذي يليهم أن بولس قد كان جاء بالآيات والعلامات. وكإخبار المنانية عن القرن الذي كان يليهم منه أن ماني قد كان جاءهم بالآيات والعلامات. وكإخبار المجوس عن آبائهم الذين كانوا يلونهم أن زرادشت قد جاءهم بالآيات والعلامات. وقد علمنا أن هؤلاء النصارى لم يكذبوا على القرن الذي كان يليهم، ولا الزنادقة ولا المجوس. ولكن الدليل على أن أصل خبرهم ليس كفرعه أن الله جل وعز لا يعطي العلامات من لا يعرفه، لأن بولس إن كان عنده أن عيسى عليه السلام إله فهو لا يعرف الله تعالى، بل لا يعرف الربوبية من العبودية، والبشرية من الإلهية.
فصل منه
وللنصارى خاصة رياء عجيب، وظاهر زهد، والناس أبطأ شيء عن التصفح، وأسرع شيء إلى تقليد صاحب السن والسمت، وظاهر العمل أدعى لهم من العلم.فصل منه على ذكرهم
وكل قوم بنوا دينهم على حب الأشكال، وشبه الرجال، يشتد وجدهم به وحبهم له، حتى ينقلب الحب عشقاً، والوجد صبابة، للمشاكلة التي بين الطبائع، والمناسبة التي بين النفوس.
وعلى قدر ذلك يكون البغض والحقد، لأن النصارى حين جعلوا ربهم إنساناً مثلهم بخعت نفوسهم بالهيبة له لتوهمهم الربوبية، وأسمحت بالمودة لتوهمهم البشرية، فلذلك قدروا من العبادة على ما لم يقدر عليه من سواهم. وبمثل هذا السبب صارت المشبهة منا أعبد ممن ينفي التشبيه، حتى ربما رأيته يتنفس من الشوق إليه، ويشهق عند ذكر الزيارة، ويبكي عند ذكر الرؤية، ويغشى عليه عند ذكر رفع الحجب. وما ظنك بشوق من طمع في مجالسة ربه عز وجل، ومحادثة خالقه عز ذكره.
ولقد غالت القوم غول، ودعاهم أمر، فانظر ما هو وإن سألتني عنه خبرتك: إنما هو نتيجة أحد أمرين: إما تقليد الرجال، وإما طلب تعظيمهم. ولذلك السبب لم ترض اليهود من إنكار حقه بتكذيبه، حتى طلبت قتله وصلبه، والمثلة به، ثم لم ترض بذلك حتى زعمت أنه لغير رشدة، فلو كانت دون هذه المنزلة منزلة لما انتهت اليهود دون بلوغها، ولو كانت فوق ما قالت النصارى منزلة لما انتهت دون غايتها.
وبذلك السبب صارت الرافضة أشد صبابة وتحرقاً، وأفرط غضباً، وأدوم حقداً. وأحسن تواصلاً من غيرهم أيضاً.
ورب خبر قد كان فاشياً فدخل عليه من العلل ما منعه من الشهرة، ورب خبر ضعيف الأصل، واهن المخرج، قد تهيأ له من الأسباب ما يوجب الشهرة.
فصل منه
واعلم أن لأكثر الشعر ظعنا وحظوظاً، كالبيت يحظى ويسير، حتى يحظى صاحبه بحظه، وغيره من الشعر أجود منه. وكالمثل يحظى ويسير، وغيره من الأمثال أجود. وما ضاع من كلام الناس وضل أكثر مما حفظ وحكي. واعتبر ذلك من نفسك، وصديقك وجليسك.وأمر الأسباب عجيب. ومن ذلك قتل علي بن أبي طالب من السادة والقادة والحماة، ما عسى لو ذكرته لاستكبرته واستعظمته، فأضرب الناس عن ذكرهم، وجهلت العوام مواضعهم، وأخذوا في ذكر عمرو بن عبد ود فرفعوه فوق كل فارس مشهور، وقائد مذكور.
وقد قرأت على العلماء كتاب الفجار الأول، والثاني، والثالث. وأمر المطيبين والأحلاف، ومقتل أبي أزيهر، ومجيء الفيل، وكل يوم جمع كان لقريش، فما سمعت لعمرو هذا في شيء من ذلك ذكراً.
فإن قلت: إن نبل القاتل زيادة في نبل المقتول، فكل من قتله على ابن أبي طالب رضوان الله عليه أنبل منه وأحق بالشهرة، ولكن أشعار ابن دأب، ومناقلة الصبيان في الكتاب هما اللتان أورثتاه ما ترى وتسمع.
فصل منه في أمر الأخبار
وإنما ذكرت هذا لتعلم أن الخبر قد يكون أصله ضعيفاً ثم يعود قوياً، ويكون أصله قوياً فيعود ضعيفاً، للذي يعتريه من الأسباب، ويحل به من الأعراض، من لدن مخرجه وفصوله، إلى أن يبلغ مدته، ومنتهى أجله، وغاية التدبير فيه، والمصلحة عليه.فلما كان هذا مخوفاً، وكان غير مأمون على المتقادم منه وضع الله تعالى لنا على رأس كل فترة علامة، وعلى غاية كل مدة أمارة، ليعيد قوة الخبر، ويجدد ما قد هم بالدروس، بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين. لأن نوحاً عليه السلام هو الذي جدد الأخبار التي كانت في الدهر الذي بينه وبين آدم عليهما السلام، حتى منعها الخلل، وحماها النقصان بالشواهد الصادقة، والأمارات القائمة. وليس أن أخبارهم وحججهم قد كانت درست واختلت، بل حين همت بذلك وكادت. بعثه الله عز وجل بآياته لئلا تخلو الأرض من حججه، ولذلك سموا آخر الدهر الفترة. وبين الفترة والقطعة فرق. فاعرف ذلك.
ثم بعث الله جل وعز إبراهيم عليه السلام على رأس الفترة الثانية التي كانت بينه وبين دهر نوح، وإنما جعلها الله تعالى أطول فترة كانت في الأرض، لأن نوحاً كان لبث في قومه يحتج ويخبر، ويؤكد ويبين، ألف سنة إلا خمسين عاماً، ولأن آخر آياته كانت أعظم الآيات، وهي الطوفان، الذي أغرق الله تعالى به جميع أهل الأرض غيره وغير شيعته، وإنما أفار الماء من جوف تنور، ليكون أعجب للآية، وأشهر للقصة، وأثبت للحجة.
ثم ما زالت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، بعضهم على إثر بعض في الدهر الذي بين إبراهيم، وبين عيسى عليهما السلام. فلترادف حججهم، وتظاهر أعلامهم، وكثرة أخبارهم، واستفاضة أمورهم، ولشدة ما تأكد ذلك في القلوب، ورسخ في النفوس، وظهر على الألسنة، لم يدخلها الخطل والنقص والفساد، في الدهر الذي كان بين النبي عليه السلام وبين عيسى عليه السلام.
فحين همت بالضعف، وكادت تنقص عن التمام، وانتهت قوتها، بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم، فجدد أقاصيص آدم ونوح، وموسى وهارون، وعيسى ويحيى، عليهم السلام، وأموراً بين ذلك، وهو الصادق، بالشواهد الصادقة، وأن الساعة آتية، وأنه ختم الرسل عليهم السلام به، فعلمنا عند ذلك أن حجته ستتم إلى مدتها، وبلوغ أمر الله عز وجل فيها.
فصل
ثم رجع الكلام إلى القول في الأخبار، فأقول: إن الناس موكلون بحكاية كل عجيب، وميسرون للإخبار عن كل عظيم، وليسوا للحسن أحكى منهم للقبيح، ولا لما ينفع أحكى منهم لما يضر، وعلى قدر كبر الشيء تكون حكايتهم له واستماعهم.ألا ترى أن رجلاً من الخلفاء لو ضرب عنق رجل من العظماء لما أمسى وفي عسكره وبلدته جاهل ولا عالم إلا وقد استقر ذلك عنده وثبت في قلبه، لأن الناس بين حاسد فهو يحكي ذلك الذي دخل عليه من الثكل وقلة العدد، وبين واجد يعجب الناس، وبين واعظ معتبر، وبين قوم شأنهم الأراجيف بالفاسد والصالح. ولو كان ضرب عنقه في يوم عيد، أو حلبة، أو استمطار، أو موسم، لكان أشد لاستفاضته، وأسرع لظهوره.
ولو جاز أن يكتم الناس هذا وشبهه على الإيثار للكتمان، وعلى جهة النسيان، لكنا لا ندري: لعله قد كان في زمن صفين والجمل والنهروان حرب مثلها أو أشد منها، ولكن الناس آثروا الكتمان، واتفقوا على النسيان.
فإذا كان قتل الملك الرجل من العظماء بهذه المنزلة من قلوب الأعداء، ومن قلوب الحكماء والغوغاء، فما ظنك بمن لو أبصروا رجلاً قد أحياه بعد أن ضرب عنقه، وأبان رأسه من جسده، أليس كان يكون تعجبهم من إحيائه أشد من تعجبهم من قتله، وكان يكون إخبارهم من خلفوا في منازلهم ومن ورد عليهم عن القتل ليكون سبباً للإخبار عن الإحياء، إذ كان الأول صغيراً في جنب الثاني.
فهذا يدل على أن أعلام الرسل عليهم السلام وآياتهم أحق بالظهور والشهرة، والقهر للقلوب والأسماع، من مخارجهم وشرائعهم. بل قد نعلم أن موسى عليه السلام لم يذكر ولم يشهر إلا لأعاجيبه وآياته. وكذلك عيسى عليه السلام، ولولا ذلك لما كانا إلا كغيرهما ممن لا يشعر بموته ولا مولده.
وكيف تتقدم المعرفة بهما المعرفة بأعلامهما وأعاجيبهما، وأنت لم تسمع بذكرهما قط، دون ما ذكر من أعلامهما.
فإذا كان شأن الناس الإخبار عن كل عجيب، وحكاية كل عظيم، والإطراف بكل طريف، وإيراد كل غريب من أمور دنياهم، فما لا يمتنع في طبائعهم، ولا يخرج من قوى الخليقة في البطش والحيلة، أحق بالإخبار والإذاعة، وبالإظهار والإفاضة، هذا على أن يترك الطباع وما يولد عليه، والنفوس وما تنتج، والعلل وما يسخر.
فكيف إن كان الله عز وجل قد خص أعلام أنبيائه وآيات رسله عليهم السلام من تهييج الناس على الإخبار عنها، ومن تسخير الأسماع لحفظها، بخاصة لم يجعلها لغيرها.
فصل منه
فإن قال القائل: إن الحجة لا تكون حجة حتى تعجز الخليقة وتخرج من حد الطاقة، كإحياء الموتى، والمشي على الماء، وكفلق البحر، وكإطعام الثمار في غير أوان الثمار، وكإنطاق السباع، وإشباع الكثير من القليل، وكل ما كان جسماً مخترعاً، وجرماً مبتدعاً. وكالذي لا يجوز أن يتولاه إلا الخالق، ولا يقدر عليه إلا الله عز ذكره.فأما الأخبار التي هي أفعال العباد، وهم تولوها، وبهم كانت وبقولهم حدثت، فلا يجوز أن يكون حجة، إذ كان لا حجة إلا ما لا يقدر عليه الخليقة، وما لا يتوهم من جميع البرية.
قلنا: إنا لم نزعم أن الأخبار حجة فيحتجون علينا بها، وإنما زعمنا أن مجيئها حجة، والمجيء ليس هو أمر يتكلفه الناس ويختارونه على غيره، ولو كان كذلك لكانوا متى أرادوه فعلوه وتهيئوا له، ولفعلوه في الباطل كما يجيء لهم في الحق. والمجيء أيضاً ليس هو فعلاً قائماً فيستطيعوه أو يعجزوا عنه، وإنما هو الإنسان، يعلم أنه إذا لقي البصريين فأخبروه أنهم قد عاينوا بمكة شيئاً، ثم لقي الكوفيين فأخبروه بمثل ذلك، أنهم قد صدقوا. إذ كان مثلهم لا يتواطأ على مثل خبرهم على جهلهم بالغيب، وعلى اختلاف طبائعهم وهممهم وأسبابهم. فليس بين هذا وبين إحياء الموتى والمشي على الماء فرق، إذ كان الناس لا يقدرون عليه، ولا يطمعون فيه، والمجيء إنما هو معنىً معقول، وشيء موهوم. إذ كان كيف يكون ومعلوم أن الناس لا يمكنهم أن يقدروا، ولا يستطيعون فعله. وإنما مدار أمر الحجة على عجز الخليقة. فمتى وجدت أمراً ووجدت الخليقة عاجزة عنه فهي حجة. ثم لا عليك جوهراً كان أو عرضاً، أو موجوداً أو متوهماً معقولاً. ألا ترى أن فلق البحر ليس هو من جنس اختراع الثمار، لأن الفلق هو انفراج أجزاء، والثمار أجرام حادثة.
وكذلك لو ادعى رجل أن الله عز وجل أرسله وجعل حجته علينا الإخبار بما أكلنا وادخرنا وأضمرنا، لكان قد احتج علينا.
فإن قلتم: إن المنجمين ربما أخبروا بالضمير، وبالأمر المستور، وببعض ما يكون.
قلنا: أما واحدة فإن خطأ المنجمين كثير، وصوابهم قليل، بل هو أقل من القليل. وأنتم لا تقدرون أن تقفونا من أخبار المرسلين عليهم السلام في كثير أخبارهم على خطاء واحد، والذي سهل قليل المنجمين طرافة ذلك منهم، لأنهم لو قالوا فأخطئوا أبداً لما كان عجبا، لأنه ليس بعجب أن يكون الناس لا يعلمون ما يكون قبل أن يكون، ومن أعجب العجب أن يوافق قولهم بعض ما يكون.
وقد نجد المنجمين يختلفون في القضية الواحدة، ويخطئون في أكثرها. وقد نجد الرسول يخبرهم عما يأكلون ويشربون ويدخرون ويضمرون، في الأمور الكثيرة المعاني، والمختلفة في الوجوه، حتى لا يخطىء في شيء من ذلك. وليس في الأرض منجم ذكر شيئاً أو وافق ضميراً إلا وأنت واجد بعض من يزجر قد يجيء بمثله وأكثر منه.
فإن قلت: إن الناس يكذبون في الإخبار عن الأعراب والكهان من كل جيل قلنا: فهم في إخبارهم عن المنجمين أكذب.
وبعد، فالناس غير مستعظمين لكثرة كذب المنجمين وخطاياهم وخدعهم، والناس يستعظمون اليسير من المرسلين عليهم السلام. وكلما كان الرجل في عينك أعظم، وكان عن الكذب أزجر، كان كذبه عندك أعظم. وإنما المنجم عند العوام كالطبيب الذي إن قتل المريض علاجه كان عندهم أن القضاء هو الذي قتله، وإن برأ كان هو أبرأه. على أن صوابهم أكثر،ودليلهم أظهر.
وقد صار الناس لا يقتصرون للمنجمين على قدر ما يسمعون منهم، دون أن يولدوا لهم، ويضعوا الأعاجيب عن ألسنتهم.
وكل ملحد في الأرض للرسول طاعن عليه، عائب له، يرى أن يصدق عليه كل كذاب يريد ذمه، وأن يكذب كل صادق يريد مدحه.
وبعد، فلو كان خبر المنجمين في الصواب كخبر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، الذي هو حجة، لما كان خبر المنجمين حجة.
فإن قلت: ولم ذاك قلت: لأن من كثر صوابه على غير استدلال ومقايسة، وعلى غير حساب وتجربة، أو على نظر ومعاينة لم يكن الأمر من قبل الوحي؛ لأنك لو قلت قصيدة في نفسك فحدثك بها رجل، وأنت تعلم أنه ليس بمنجم، وأنشدكها كلها، لعلمت أن ذلك لا يكون إلا بوحي.
ومثل ذلك رجل اشتد وجع عينه فعالجه طبيب فبرأ، فلو جعل الطبيب ذلك حجة على نبوته لوجب علينا تكذيبه، ولو قال رجل من غير أن يمسه أو يدنو إليه: اللهم إن كنت صادقاً عليك فاشفه الساعة، فبرأ من ساعته لعلمنا أنه صادق.
فإن قالوا: وما علمنا أن محمداً عليه السلام لم يكن منجماً قلنا: إن علمنا بذلك كعلمنا بأن العباس وحمزة وعلياً وأبا بكر وعمر، رضوان الله عليهم أجمعين، لم يكونوا منجمين، ولا أطباء متكهنين. وكيف يجوز أن يصير إنسان عالماً بالنجوم من غير أن يختلف إلى المنجمين، أو يختلفوا إليه، أو يكون علم النجوم فاشياً في أهل بلاده، أو يكون في أهله واحد معروف به. ولو بلغ إنسان في علم النجوم، وليست معه علة من هذه العلل، وكان ذلك يخفى، لكان ذلك كبعض الآيات والعلامات.
ومتى رأينا حاذقاً بالكلام، أو بالطب، أو بالحساب، أو بالغناء، أو بالنجوم، أو بالعروض، خفي على الناس موضعه وسببه ! وجميع ما ذكرنا، فعناية الناس به وعداوتهم، وشهرته في نفسه، دون محمد صلى الله عليه وسلم.
وهل نصب أحد قط لأحد إلا بدون ما نصب له رهطه، وأدانى أهله، ومن معه في بيته وربعه.
وما أعرف - يرحمك الله - المعاند والمسترشد والمصدق والمكذب، ينكر أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن منجماً ولا طبيباً. وإذا قال الجاهل: إنه قد كان يعلم الخط فخفي له ذلك، وتعلم الأسباب والقضاء في النجوم فخفي له ذلك، وتعلم البيان وقدر منه على ما يعجز أمثاله عنه وخفي ذلك، أليس مع قوله ما يعلم خلافه، يعلم أنه قد سلم له أعجوبة كأعجوبة إبراء الأكمه والأبرص، والمشي على الماء، إذ كان ذلك لا يجوز، ولا يمكن في الطبائع والعقل والتجربة.
وافهم يرحمك الله ما أنا واصفه لك: هل يجد التارك لتصديقه أنه لا يدري بزعمه، لعله كان أعلم الخلق بالنجوم، ناظراً لنفسه، غير معاند لحجة عقله. وهو لم يجد أحداً قط برع في صناعة واحدة فخفي على الناس موضعه بكل ما حكينا وفسرنا.
وأنت كيف تعلم أنه ليس في إخوانك من ليس بمنجم، وأن فيهم من ليس بطبيب، إلا بمثل ما يعرف به رهط النبي صلى الله عليه وآله منه.
وكيف لم يشتهر ذلك، ولم لم يحتج به عليه ولقد بلغ من إسرافهم في شتمه، وإفراطهم عليه، أن نافقوا وأحالوا، لأنهم كانوا يقولون له: أنت ساحر، وأنت مجنون! وإنما يقال للرجل: ساحر، لخلابته وحسن بيانه، ولطف مكايده، وجودة مداراته وتحببه. ويقال: مجنون، لضد ذلك كله.
فصل منه
وليس ينتفع الناس بالكلام في الأخبار إلا مع التصادق، ولا تصادق إلا مع كثرة السماع، والعلم بالأصول؛ لأن رجلاً لو نازع في الأخبار، وفي الوعد والعيد، والخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، والفريضة والنافلة، والسنة والشريعة، والاجتماع والفرقة، ثم حسنت نيته، وناضح عن نفسه، لما عرف حقائق باطل دون أن يكون قد عرف الوجوه، وسمع الجمل، وعرف الموازنة، وما كان في الطبائع، وما يمتنع فيها. وكيف أيضاً يقول في التأويل من لم يسمع بالتنزيل وكيف يعرف صدق الخبر من لم يعرف سبب الصدق واعلم أن من عود قلبه التشكك اعتراه الضعف، والنفس عروف، فما عودتها من شيء جرت عليه.والمتحير إلى تقوية قلبه ورد قوته عليه وإفهامه موضع رأيه، وتوقيفه على الأمر الذي أثقل صدره، أحوج منه إلى المنازعة في فرق ما بين المجيء الذي يكذب مثله، والمجيء الذي لا يكذب مثله.
وسنتكلف من علاج دائه، وترتيب إفهامه إن أعان على نفسه، بما لا يبقي سبباً للشك، ولا علة للضعف. والله تعالى المعين على ذلك، والمحمود عليه.
فصل منه
ومتى سمعنا نبي الله عليه السلام اتكل على عدالته، وعلى معرفة قومه بقديم طهارته، وقلة كذبه، دون أن جاءهم بالعلامات والبرهانات ولعمري لو لم نجد الحافظ ينسى، والصادق يكذب، والمؤمن يبدل، لقد كان ما ذهبوا إليه وجهاً.فصل منه في ذكر دلائل النبي
عليه الصلاة والسلام
وباب آخر يعرف به صدقه، وهو إخباره عما يكون، وإخباره عن ضمائر الناس، وما يأكلون وما يدخرون، ولدعائه المستجاب الذي لا تأخير فيه، ولا خلف له. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لقي من قريش والعرب ما لقي من شدة أذاهم له، وتكذيبهم إياه، واستعانتهم عليه بالأموال والرجال، دعا الله جل وعز أن يجدب بلادهم، وأن يدخل الفقر بيوتهم، فقال صلى الله عليه وآله: " اللهم سنين كسني يوسف. اللهم اشدد وطأتك على مضر " .فأمسك الله عز وجل عنهم المطر حتى مات الشجر، وذهب الثمر، وقلت المزارع، وماتت المواشي، وحتى اشتووا القد والعلهز.
فعند ذلك وفد حاجب بن زرارة على كسرى، يشكو إليه الجهد والأزل ويستأذنه في رعي السواد، وهو حين ضمنه عن قومه، وأرهنه قوسه. فلما أصاب مضر خاصة الجهد، ونهكهم الأزل، وبلغت الحجة مبلغها، وانتهت الموعظة منتهاها، عاد بفضله صلى الله عليه وسلم، على الذي بدأهم به، فسأل ربه الخصب وإدرار الغيث، فأتاهم منه ما هدم بيوتهم، ومنعهم حوائجهم، فكلموه في ذلك فقال: " الله حوالينا ولا علينا " . فأمطر الله عز وجل ما حولهم، وأمسك عنهم.
وكتب إلى كسرى يدعوه إلى نجاته وتخليصه من كفره، فبدأ باسمه على اسمه، فأنف من ذلك كسرى لشقوته، وأمر بتمزيق الكتاب، فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم مزق ملكه كل ممزق " . فمزق الله جل وعز ملكه، وجد أصله، وقطع دابره، لأن كل ملك في الأرض، وإن كان قد أخرج من معظم ملكه، فهو مقيم على بقية منه، وذلك أن الإسلام لم يترك ملكاً بحيث تناله الحوافر والأخفاف والأقدام، إلا أزاله عنه، وأخرجه منه إلى عقاب يعتصم بها، ومعاقل يأوي إليها، أو طرده إلى خليج منيع، لا يقطعه إلا السفن، فهم من بين هارب قد دخل في وجار، أو اختفى في غيضة، أو مقيم على فم شعب، ورأس مضيق، قد سخت نفسه عن كل سهل، وأسلم كل مرج أو ملك لا قرار له، وليس بذي مدر فيؤتى، وإنما أصحابه أكراد يطلبون النجعة، أو كخوارج يطلبون الغرة. فأما أن يكون ملك يصحر لهم، ويقيم بإزائهم، ويغاديهم الحرب ويمسيهم، ويساجلهم الظفر ويناهضهم، كما كانت ملوك الطوائف، وكالذي كان بين فارس والروم فلا، وذلك لقوله تعالى: " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله " إلى قوله عز ذكره: " المشركون " . فلم يرض أن أظهر دينه حتى جعل أهله الغالبين بالقدرة، والظاهرين بالمنعة، والآخذين الإتاوة.
وكتب كسرى إلى فيروز الديلمي، وهو من بقية أصحاب سيف بن ذي يزن: أن احمل إلى هذا العبد الذي بدأ باسمه قبل اسمي، واجترأ علي، ودعاني إلى غير ديني! فأتاه فيروز فقال: إن ربي أمرني أن أحملك إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: " إن ربي خبرني أنه قد قتل ربك البارحة، فأمسك علي ريثما يأتيك الخبر، فإن تبين لك صدقي، وإلا فأنت على أمرك " . فراع ذلك فيروز وهاله، وكره الإقدام عليه، والاستخفاف به، فإذا الخبر قد أتاه: أن شيرويه قد وثب عليه في تلك الليلة فقتله. فأسلم وأخلص، ودعا من معه من بقية الفرس إلى الله عز ذكره فأسلموا.
فصل منه في ذكر النبي
صلى الله عليه وآله
ثم إن الذي تقدمه صلى الله عليه وآله من البشارات في الكتب المتقادمة، في الأزمان المتباعدة، والبلدان الموجودة بكل مكان، على شدة عداوة أهلها، وتعصب حامليها، ومع قوة حسدهم، وشدة بغيهم.وما ذلك ببديع منهم ومن آبائهم، على أنهم أشبه بآبائهم منهم بأزمانهم. وكل الناس أشبه بأزمانهم منهم بآبائهم. وآباؤهم الذين قتلوا أنبياءهم عليهم السلام، وتعنتوا رسلهم صلى الله عليهم، حتى خلاهم الله عز وجل من يده، وأفقدهم عصمته وتوفيقه.
ولم استدل على ذكره في التوراة والإنجيل والزبور، وعلى صفته والبشارة به في الكتب إلا لأنك متى وجدت النصراني واليهودي يسلم بأرض الشام وجدته يعتل بأمور، ويحتج بأشياء مثل الأمور التي يحتج بها من أسلم بالعراق. وكذلك من أسلم بالحجاز، ومن أسلم من اليمن، من غير تلاق ولا تعارف، ولا تشاعر. وكيف يتلاقون ويتراسلون، وهم غير متعارفين ولا متشاعرين ولو كانوا كذلك لظهر ذلك ولم ينكتم، كما حكينا قبل هذا. ولو قابلت بين أخبارهم واحتجاجهم مع كثرة الألفاظ واختلاف المعاني، لوجدتها متساوية.
فصل منه
فإن قال قائل: لم كانت أعلام موسى عليه السلام في كثرتها مع غي بني إسرائيل، ونقصان أحلام القبط، في وزن أعلام محمد صلى الله عليه وسلم وفي قدرها، مع أحلام قريش، وعقول العرب.ومتى أحببت أن تعرف غي بني إسرائيل ونقصان أحلام القبط، ورجحان عقول العرب، وأحلام كنانة، فأت بواديهم ورباعهم. وانظر إلى بنيهم وبقاياهم، كما نظرت إلى بني إسرائيل من اليهود وغي بني من مضى من القبط تعتبر ذلك وتعرف ما أقول. ثم انظر في أشعار العرب الصحيحة، والخطب المعروفة، والأمثال المضروبة، والألفاظ المشهورة، والمعاني المذكورة، مما نقلته الجماعات عن الجماعات، وكلام العرب ومعانيهم في الجاهلية.
ثم تفقد، وسل أهل العلم والخبرة عن بني إسرائيل، فإن وجدت لهم مثلاً سائراً كما تسمع للقبط والفرس، فضلاً عن العرب فقد أبطلنا فيما قلنا.
وقد كان الرجل من العرب يقف المواقف، ويسير عدة أمثال، كل واحد منها ركن يبنى عليه، وأصل يتفرع منه.
أو هل تسمع لهم بكلام شريف، أو معنىً يستحسنه أهل التجربة، وأصحاب التدبير والسياسة، أو حكم أو حكمة، أو حذق في صناعة، مع ترادف الملك فيهم، وتظاهر الرسالة في رجالهم.
وكيف لا تقضي عليهم بالغي والجهل، ولم تسمع لهم بكلمة فاخرة، أو معنىً نبيه، لا ممن كان في المبدى، ولا ممن كان في المحضر، ولا من قاطني السواد، ولا من نازلي الشام ثم انظر إلى أولادهم مع طول لبثهم فينا، وكونهم معنا، هل غير ذلك من أخلاقهم وشمائلهم، وعقولهم، وأحلامهم، وآدابهم، وفطنهم فقد صلح بنا كثير من أمور النصارى وغيرهم.
وليس النصارى كاليهود، لأن اليهود كلهم من بني إسرائيل إلا القليل.
وبعد، فلم يضرب فيهم غيرهم، لأن مناكحهم مقصورة فيهم، ومحبوسة عليهم، فصور أولهم مؤداة إلى آخرهم، وعقول أسلافهم مردودة على أخلافهم، ثم اعتبر بقولهم لنبيهم عليه السلام: " اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة " حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها. وكقولهم: " أرنا الله جهرة " ، وكعكوفهم على عجل صنع من حليهم، يعبدونه من دون الله، بعد أن أراهم من الآيات ما أراهم.
وكقولهم: " اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون " ، فكان الذي جاء به موسى عليه السلام، مع نقص بني إسرائيل والقبط، مثل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع رجحان قريش والعرب.
وكذلك وعد محمد عليه السلام بنار الأبد، كوعيد موسى بني إسرائيل بإلقاء الهلاس على زروعهم، والهم على أفئدتهم، وتسليط الموتان على ماشيتهم، وبإخراجهم من ديارهم، وأن يظفر بهم عدوهم. فكان تعجيل العذاب الأدنى في استدعائهم واستمالتهم، وردعهم عما يريد بهم، وتعديل طبائعهم، كتأخير العذاب الشديد على غيرهم، لأن الشديد المؤخر لا يزجر إلا أصحاب النظر في العواقب، وأصحاب العقول التي تذهب في المذاهب.
فسبحان من خالف بين طبائعهم وشرائعهم ليتفقوا على مصالحهم في دنياهم، ومراشدهم في دينهم، مع أن محمداً صلى الله عليه وسلم مخصوص بعلامة لها في العقل موقع، كموقع فلق البحر من العين، وذلك قوله لقريش خاصة، وللعرب عامة، مع ما فيهما من الشعراء والخطباء والبلغاء، والدهاة والحلماء، وأصحاب الرأي والمكيدة، والتجارب والنظر في العاقبة: إن عارضتموني بسورة واحدة فقد كذبت في دعواي، وصدقتم في تكذيبي.
ولا يجوز أن يكون مثل العرب في كثرة عددهم واختلاف عللهم، والكلام كلامهم، وهو سيد علمهم، فقد فاض بيانهم، وجاشت به صدورهم، وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم، حتى قالوا في الحيات والعقارب، والذباب والكلاب، والخنافس والجعلان، والحمير والحمام، وكل ما دب ودرج، ولاح لعين، وخطر على قلب. ولهم بعد أصناف النظم، وضروب التأليف، كالقصيد، والرجز، والمزدوج، والمجانس، والأسجاع والمنثور.
وبعد، فقد هجوه من كل جانب، وهاجى أصحابه شعراءهم، ونازعوا خطباءهم، وحاجوه في المواقف، وخاصموه في المواسم، وبادوه العداوة، وناصبوه الحرب، فقتل منهم، وقتلوا منه، وهم أثبت الناس حقداً، وأبعدهم مطلباً، وأذكرهم لخير أو لشر، وأنفاهم له، وأهجاهم بالعجز، وأمدحهم بالقوة، ثم لا يعارضه معارض، ولم يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر.
ومحال في التعارف، ومستنكر في التصادق، أن يكون الكلام أخصر عندهم، وأيسر مئونة عليهم، وهو أبلغ في تكذيبهم وأنقض لقوله، وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعوا على ترك استعماله، والاستغناء به، وهم يبذلون مهجهم وأموالهم، ويخرجون من ديارهم في إطفاء أمره، وفي توهين ما جاء به، ولا يقولون، بل لا يقول واحد من جماعتهم: لم تقتلون أنفسكم، وتستهلكون أموالكم، وتخرجون من دياركم، والحيلة في أمره يسيرة، والمأخذ في أمره قريب ! ليؤلف واحد من شعرائكم وخطبائكم كلاماً في نظم كلامه، كأقصر سورة يخذلكم بها، وكأصغر آية دعاكم إلى معارضتها. بل لو نسوا، ما تركهم حتى يذكرهم، ولو تغافلوا ما ترك أن ينبههم، بل لم يرض بالتنبيه دون التوقيف.
فدل ذلك العاقل على أن أمرهم في ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكونوا عرفوا عجزهم، وأن مثل ذلك لا يتهيأ لهم، فرأوا أن الإضراب عن ذكره، والتغافل عنه في هذا الباب وإن قرعهم به، أمثل لهم في التدبير، وأجدر أن لا يتكشف أمرهم للجاهل والضعيف، وأجدر أن يجدوا إلى الدعوى سبيلاً، وإلى اختداع الأنبياء سبباً، فقد ادعوا القدرة بعد المعرفة بعجزهم عنه، وهو قوله عز ذكره: " وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا " .
وهل يذعن الأعراب وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجز، والتوقيف على النقص، ثم لا يبذلون مجهودهم، ولا يخرجون مكنونهم وهم أشد خلق الله عز وجل أنفة، وأفرط حمية، وأطلبه بطائلة، وقد سمعوه في كل منهل وموقف. والناس موكلون بالخطابات، مولعون بالبلاغات. فمن كان شاهداً فقد سمعه، ومن كان غائباً فقد أتاه به من لم يزوده.
وإما أن يكون غير ذلك.
ولا يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضة وهم يقدرون عليها، لأنه لا يجوز على العدد الكثير من العقلاء والدهاة والحلماء، مع اختلاف عللهم، وبعد هممهم، وشدة عداوتهم الإطباق على بذل الكثير، وصون اليسير.
وهذا من ظاهر التدبير، ومن جليل الأمور التي لا تخفى على الجهال فكيف على العقلاء، وأهل المعارف فكيف على الأعداء، لأن تحبير الكلام أهون من القتال، ومن إخراج المال.
ولم يقل: إن القوم قد تركوا مساءلته في القرآن والطعن فيه، بعد أن كثرت خصومتهم في غيره.
ويدلك على ذلك قوله عز وجل: " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة " وقوله عز ذكره: " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله " ، وقوله تعالى جل ذكره: " وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون " .
ويدلك كثرة هذه المراجعة، وطول هذه المناقلة، على أن التقريع لهم بالعجز كان فاشياً، وأن عجزهم كان ظاهراً.
ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم بالنظر والتأليف، ولم يكن أيضاً أزاح علتهم، حتى قال تعالى: " قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات " وعارضوني بالكذب، لقد كان في تفصيله له وتركيبه، وتقديمه له واحتجاجه، ما يدعو إلى معارضته ومغالبته وطلب مساويه.
ولو لم يكن تحداهم من كل ما قلنا، وقرعهم بالعجز عما وصفنا وهل هذا إلا بمديحه له، وإكثاره فيه لكان ذلك سبباً موجباً لمعارضته ومغالبته وطلب تكذيبه، إذ كان كلامهم هو سيد عملهم، والمئونة فيه أخف عليهم، وقد بذلوا النفوس والأموال. وكيف ضاع منهم، وسقط على جماعتهم نيفاً وعشرين سنة، مع كثرة عددهم، وشدة عقولهم، واجتماع كلمتهم ! وهذا أمر جليل الرأي، ظاهر التدبير.
فصل منه في ذكر امتناعهم من معارضة القرآن
لعلمهم بعجزهم عنها
والذي منعهم من ذلك هو الذي منع ابن أبي العوجاء، وإسحاق بن طالوت، والنعمان بن المنذر، وأشباههم من الأرجاس، الذين استبدلوا بالعز ذلاً، وبالإيمان كفراً، والسعادة شقوة، وبالحجة شبهة.بل لا شبهة في الزندقة خاصة. فقد كانوا يصنعون الآثار، ويولدون الأخبار، ويبثونها في الأمصار، ويطعنون في القرآن، ويسألون عن متشابهه، وعن خاصه وعامه، ويضعون الكتب على أهله. وليس شيء مما ذكرنا يستطيع دفعه جاهل غبي، ولا معاند ذكي.
فصل منه
ولما كان أعجب الأمور عند قوم فرعون السحر، ولم يكن أصحابه قط في زمان أشد استحكاماً فيه منهم في زمانه، بعث الله موسى عليه السلام على إبطاله وتوهينه، وكشف ضعفه وإظهاره، ونقض أصله لردع الأغبياء من القوم، ولمن نشأ على ذلك من السفلة والطغام.لأنه لو كان أتاهم بكل شيء، ولم يأتهم بمعارضة السحر حتى يفصل بين الحجة والحيلة، لكانت نفوسهم إلى ذلك متطلعة، ولاعتل به أصحاب الأشغاب، ولشغلوا به بال الضعيف، ولكن الله تعالى جده، أراد حسم الداء، وقطع المادة، وأن لا يجد المبطلون متعلقا، ولا إلى اختداع الضعفاء سبيلاً، مع ما أعطى الله موسى عليه السلام من سائر البرهانات، وضروب العلامات.
وكذلك زمن عيسى عليه السلام كان الأغلب على أهله، وعلى خاصة علمائه الطب، وكانت عوامهم تعظم على ذلك خواصهم، فأرسله الله عز وجل بإحياء الموتى، إذ كانت غايتهم علاج المرضى.
وأبرأ لهم الأكمه إذ كانت غايتهم علاج الرمد، مع ما أعطاه الله عز وجل من سائر العلامات، وضروب الآيات؛ لأن الخاصة إذا بخعت بالطاعة، وقهرتها الحجة، وعرفت موضع العجز والقوة، وفصل ما بين الآية والحيلة، كان أنجع للعامة، وأجدر أن لا يبقى في أنفسهم بقية.
وكذلك دهر محمد صلى الله عليه وسلم، كان أغلب الأمور عليهم، وأحسنها عندهم، وأجلها في صدورهم، حسن البيان، ونظم ضروب الكلام، مع علمهم له، وانفرادهم به. فحين استحكمت لفهمهم وشاعت البلاغة فيهم، وكثر شعراؤهم، وفاق الناس خطباؤهم، بعثه الله عز وجل، فتحداهم بما كانوا لا يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه.
فلم يزل يقرعهم بعجزهم، وينتقصهم على نقصهم، حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم، كما تبين لأقويائهم وخواصهم. وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبياً قط، مع سائر ما جاء به من الآيات، ومن ضروب البرهانات.
ولكل شيء باب ومأتىً، واختصار وتقريب. فمن أحكم الحكمة إرسال كل نبي بما يفحم أعجب الأمور عندهم، ويبطل أقوى الأشياء في ظنهم.
فصل في ذكر أخلاق النبي
صلى الله عليه وسلم
وآية أخرى لا يعرفها إلا الخاصة، ومتى ذكرت الخاصة فالعامة في ذلك مثل الخاصة. وهي الأخلاق والأفعال التي لم تجتمع لبشر قط قبله، ولا تجتمع لبشر بعده.وذلك أنا لم نر ولم نسمع لأحد قط كصبره، ولا كحلمه، ولا كوفائه، ولا كزهده، ولا كجوده، ولا كنجدته، ولا كصدق لهجته، وكرم عشرته، ولا كتواضعه، ولا كعلمه، ولا كحفظه، ولا كصمته إذا صمت، ولا كقوله إذا قال، ولا كعجيب منشئه، ولا كقلة تلونه، ولا كعفوه، ولا كدوام طريقته، وقلة امتنانه.
ولم نجد شجاعاً قط إلا وقد جال جولة، وفر فرة، وانحاز مرة، من معدودي شجعان الإسلام، ومشهوري فرسان الجاهلية، كفلان وفلان.
وبعد، فقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه قوم، ولم نر كنجدتهم نجدة، ولا كصبرهم صبراً. وقد كانت لهم الجولة والفرة، كما قد بلغك عن يوم أحد، وعن يوم حنين، وغير ذلك من الوقائع والأيام.
فلا يستطيع منافق ولا زنديق ولا دهري، أن يحدث أن محمداً عليه السلام جال جولة قط، ولا فر فرة قط، ولا خام عن غزوة، ولا هاب حرب من كاثره.
فصل من صدر كتابه في خلق القرآن
ثبتك الله بالحجة، وحصن دينك من كل شبهة، وتوفاك مسلماً، وجعلك من الشاكرين.وقد أعجبني، حفظك الله، استهداؤك العلم وفهمك له، وشغفك بالإنصاف وميلك إليه، وتعظيمك الحق وموالاتك فيه، ورغبتك عن التقليد وزرايتك عليه، ومواترة كتبك على بعد دارك، وتقطع أسبابك، وصبرك إلى أوان الإمكان، واتساعك عند تضايق العذر.
وفهمت، حفظك الله، كتابك الأول، وما حثثت عليه من تبادل العلم، والتعاون على البحث، والتحاب في الدين، والنصيحة لجميع المسلمين.
وقلت: اكتب إلي كتاباً تقصد فيه إلى حاجات النفوس، وإلى صلاح القلوب، وإلى معتلجات الشكوك، وخواطر الشبهات، دون الذي عليه أكثر المتكلمين من التطويل، ومن التعمق والتعقيد، ومن تكلف ما لا يجب، وإضاعة ما يجب.
وقلت: كن كالمعلم الرفيق، والمعالج الشفيق، الذي يعرف الداء وسببه، والدواء وموقعه، ويصبر على طول العلاج، ولا يسأم كثرة الترداد.
وقلت: اجعل تجارتك التي إياها تؤمل، وصناعتك التي إياها تعتمد إصلاح الفساد، ورد الشارد.
وقلت: ولا بد من استجماع الأصول، ومن استيفاء الفروع، ومن حسم كل خاطر، وقمع كل ناجم، وصرف كل هاجس، ودفع كل شاغل، حتى تتمكن من الحجة، وتتهنأ بالنعمة، وتجد رائحة الكفاية، وتثلج ببرد اليقين، وتفضي إلى حقيقة الأمر. إن كان لا بد من عوارض العجز، ولواحق التقصير، فالبر لها أجمل، والضرر علينا في ذلك أيسر.
وقلت: ابدأ بالأقرب فالأقرب، وبكل ما كان آنق في السمع، وأحلى في الصدر، وبالباب الذي منه يؤتى الريض المتكلف، والجسور المتعجرف، وبكل ما كان أكثر علماً، وأنفذ كيدا.
وسألتني بتقبيح الاستبداد، والعجلة إلى الاعتقاد، وصفة الأناة ومقدارها، ومقدمات العلوم ومنتهاها. وزعمت أن من اللفظ ما لا يفهم معناه دون الإشارة، ودون معرفة السبب والهيئة، ودون إعادته وكره وتحريره واختياره.
وقلت: فإن أنت لم تصور ذلك كله صورة تغني عن المشافهة، وتكتفي بظاهرها عن المراسلة أحوجتنا إلى لقائك، على بعد دارك، وكثرة أشغالك، وعلى ما تخاف من الضيعة وفساد المعيشة.
فكتبت لك كتاباً، أجهدت فيه نفسي، وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في الاحتجاج للقرآن، والرد على كل طعان. فلم أدع فيه مسألة لرافضي، ولا لحديثي، ولا لحشوي، ولا لكافر مباد، ولا لمنافق مقموع، ولا لأصحاب النظام، ولمن نجم بعد النظام، ممن يزعم أن القرآن خلق، وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة.
فلما ظننت أني قد بلغت أقصى محبتك، وأتيت على معنى صفتك، أتاني كتابك تذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآن، وإنما أردت الاحتجاج لخلق القرآن. وكانت مسألتك مبهمة، ولم أك أن أحدث لك فيها تأليفاً، فكتبت لك أشق الكتابين وأثقلهما، وأغمضهما معنىً وأطولهما.
ولولا ما اعتللت به من اعتراض الرافضة، واحتجاج القوم علينا بمذهب معمر، وأبي كلدة، وعبد الحميد، وثمامة، وكل من زعم أن أفعال الطبيعة مخلوقة على المجاز دون الحقيقة، وأن متكلمي الحشوية والنابتة قد صار لهم بمناظرة أصحابنا، وبقراءة كتبنا بعض الفطنة لما كتبت لك، رغبة بك عن أقدارهم، وضناً بالحكمة عن إعثارهم، وإنما يكتب على الخصوم والأكفاء، وللأولياء على الأعداء، ولمن يرى للنظر حقاً، وللعلم قدراً، وله في الإنصاف مذهب، وإلى المعرفة سبب.
وزعمت أنك لم تر في كتب أصحابنا إلا كتاباً لا تفهمه، أو كتاباً وجدت الحجة على واضع الكتاب فيه أثبت.
وقلت: وإياك أن تتكل على مقدار ما عندهم، دون أن تعتصر قوى باطلهم، وتوفيهم جميع حقوقهم، وإذا تقلدت الإخبار عن خصمك فحطه كحياطتك لنفسك، فإن ذلك أبلغ في التعليم، وآيس للخصوم.
وقلت: وزعموا أنه يلزمك أن تزعم أن القرآن ليس بمخلوق إلا على المجاز، كما ألزم ذلك نفسه معمر وأبو كلدة وعبد الحميد وثمامة، وكل من ذهب مذهبهم، وقاس قياسهم.
فتفهم - فهمك الله - ما أنا واصفه لك، ومورده عليك: اعلم أن القوم يلزمهم ما ألزموه أنفسهم، وليس ذلك إلا لعجزهم عن التخلص بحقهم، وإلا لذهابهم عن قواعد قولهم، وفروع أصولهم، فليس لك أن تضيف العجز الذي كان منهم إلى أصل مقالتهم، وتحمل ذلك الخطأ على غيرهم. فلرب قول شريف الحسب، جيد المركب، وافر العرض، بريء من العيوب، سليم من الأفن، قد ضيعه أهله، وهجنه المفترون عليه، فألزموه ما لا يلزمه، وأضافوا إليه ما لا يجوز عليه.
ولو زعم القوم على أصل مقالتهم أن القرآن هو الجسم دون الصوت والتقطيع، والنظم والتأليف، وأنه ليس بصوت ولا تقطيع ولا تأليف، إذ كان الصوت عندهم لا يخترع كاختراع الأجسام المصورة، ولا يحتمل التقطيع كاحتمال الأجرام المتجسدة، والصوت عرض، لا يحدث من جوهر إلا بدخول جوهر آخر عليه، ومحال أن يحدث إلا وهناك جسمان قد صك أحدهما صاحبه، ولا بد من مكانين: مكان زال عنه، ومكان آل إليه. ولا بد من هواء بين المصطكين. والجسم قد يحدث وحده ولا شيء غيره، والصوت على خلاف ذلك.
والعرض لا يقوم بنفسه، ولا بد من أن يقوم بغيره، والأعراض من أعمال الأجسام، لا تكون إلا منها، ولا توجد إلا بها وفيها.
والجسم لا يكون إلا من جسم، ولا يكون إلا من مخترع الأجسام.
وليست لكون الجسم من الله علة توجيه، ولا يحدث إذا حدث إلا اختياراً، وإلا ابتداعاً واختراعاً. والصوت لا يكون إلا عن علة موجبة، ولا يكون إلا تولداً ونتيجة، ولا يحدث إلا من جرمين، كاصطكاك الحجرين، وكقرع اللسان باطن الأسنان، وإلا من هواء يتضاغط، وريح تختنق، ونار تلتهب. والريح عندهم هواء تحرك، والنار عندهم ريح حارة. هكذا الأمر عندهم.
فلو قالوا: لا يكون الشيء مخلوقاً في الحقيقة، دون المجاز وعلى مجازي اللغة، إلا وقد بان الله عز وجل باختراعه، وتولاه بابتداعه، وكان منه على اختيار، والابتداع: الذي يمكن تركه وإنشاء عقيبه بدلاً منه، على ما كان يوكده، ونتيجته من أجسام يستحيل أن يخلق من أفعالها، ويجلبها الله تعالى منها.
والقرآن على غير ذلك، جسم وصوت، وذو تأليف وذو نظم، وتوقيع وتقطيع، وخلق قائم بنفسه، مستغن عن غيره، ومسموع في الهواء، ومرئي في الورق، ومفصل وموصل، واجتماع وافتراق، ويحتمل الزيادة والنقصان، والفناء والبقاء، وكل ما احتملته الأجسام، ووصفت به الأجرام. وكل ما كان كذلك فمخلوق في الحقيقة دون المجاز وتوسع أهل اللغة.
فلو كانوا قالوا ذلك لكانوا أصابوا في القياس، ووافقوا أهل الحق، وكانوا مع الجماعة، ولم يضاهوا أهل الخلاف والفرقة، ولم يصموا أنفسهم بقول المشبهة، إذ كان ظاهر قولهم على التشبيه أدل، وبه أشبه.
ولا يجوز أن أذكر موافقتي لهم، ومخالفتي عليهم في صدر هذا الكتاب، لأن التدبير في وضع الكتاب، والسياسة في تعليم الجهال أن يبدأ بالأوضح فالأوضح، والأقرب فالأقرب، وبالأصول قبل الفروع، حتى يكون آخر الكتاب لآخر القياس.
وآخر الكلام لا يفهم - أرشدك الله - ولا يتوهم إلا على ترتيب الأمور، وتقديم الأصول. فإذا رتبنا الأمور، وقدمنا الأصول صارت أواخر المعاني في الفهم كأوائلها، ودقيقها كجليلها.
فصل منه
وقد علمنا أن بعض ما فيه الاختلاف بين من ينتحل الإسلام أعظم فرية، وأشد بلية، وأشنع كفراً، وأكبر إثماً من كثير مما أجمعوا على أنه كفر.وبعد، فنحن لم نكفر إلا من أوسعناه حجة، ولم نمتحن إلا أهل التهمة، وليس كشف المتهم من التجسس، ولا امتحان الظنين من هتك الأسرار. ولو كان كل كشف هتكاً، وكل امتحان تجسساً، لكان القاضي أهتك الناس لستر، وأشد الناس كشفاً لعورة.
والذين خالفوا في العرش إنما أرادوا نفي التشبيه فغلطوا، والذين أنكروا أمر الميزان إنما كرهوا أن تكون الأعمال أجساماً وأجراماً غلاظاً. فإن كانوا قد أصابوا فلا سبيل عليهم، وإن كان قد أخطئوا فإن خطأهم لا يتجاوز بهم إلى الكفر. وقولهم وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيه للخالق بالمخلوق، فبين المذهبين أبين الفرق.
وقد قال صاحبكم للخليفة المعتصم، يوم جمع الفقهاء والمتكلمين والقضاة والمخلصين، إعذاراً وإنذاراً: امتحنتني وأنت تعرف ما في المحنة، وما فيها من الفتنة، ثم امتحنتني من بين جميع هذه الأمة! قال المعتصم: أخطأت، بل كذبت، وجدت الخليفة قبلي قد حبسك وقيدك، ولو لم يكن حبسك على تهمة لأمضى الحكم فيك، ولو لم يخفك على الإسلام ما عرض لك، فسؤالي إياك عن نفسك ليس من المحنة، ولا من طريق الاعتساف، ولا من طريق كشف العورة، إذ كانت حالك هذه الحال، وسبيلك هذه السبيل.
وقيل للمعتصم في ذلك المجلس: ألا تبعث إلى أصحابه حتى يشهدوا إقراره، ويعاينوا انقطاعه، فينقض ذلك استبصارهم، فلا يمكنه جحد ما أقر به عندهم فأبى أن يقبل ذلك، وأنكره عليهم، وقال: لا أريد أن أوتى بقوم إن اتهمتهم ميزت فيهم بسيرتي فيهم، وإن بان لي أمرهم أنفذت حكم الله فيهم، وهم ما لم أوت بهم كسائر الرعية، وكغيرهم من عوام الأمة، وما من شيء أحب إلي من الستر، ولا شيء أولى بي من الأناة والرفق.
وما زال به رفيقاً، وعليه رقيقاً، ويقول: لأن أستحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق! حتى رآه يعاند الحجة، ويكذب صراحاً عند الجواب. وكان آخر ما عاند فيه، وأنكر الحق وهو يراه، أن أحمد بن أبي دواد قال له: أليس لا شيء إلا قديم أو حديث قال: نعم. قال: أو ليس القرآن شيئاً قال: نعم. قال: أو ليس لا قديم إلا الله قال: نعم. قال: فالقرآن إذاً حديث قال: ليس أنا متكلم.
وكذلك كان يصنع في جميع مسائله، حتى كان يجيبه في كل ما سأل عنه، حتى إذا بلغ المخنق، والموضع الذي إن قال فيه كلمة واحدة برىء منه صاحبه قال: ليس أنا متكلم! فلا هو قال في أول الأمر: لا علم لي بالكلام، ولا هو حين تكلم فبلغ موضع ظهور الحجة، خضع للحق. فمقته الخليفة، وقال عند ذلك: أف لهذا الجاهل مرة، والمعاند مرة.
وأما الموضع الذي واجه فيه الخليفة بالكذب، والجماعة بالقحة، وقلة الاكتراث وشدة التصميم، فهو حين قال له أحمد بن أبي دواد: تزعم أن الله رب القرآن قال: لو سمعت أحداً يقول ذلك لقلت. قال: أفما سمعت ذلك قط من حالف ولا سائل، ولا من قاص، ولا في شعر، ولا في حديث ! قال: فعرف الخليفة كذبه عند المسألة، كما عرف عنوده عند الحجة.
وأحمد بن أبي دواد - حفظك الله - أعلم بهذا الكلام، وبغيره من أجناس العلم، من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة، ويعتمد عليها في مثل تلك الجماعة. ولكنه أراد أن يكشف لهم جرأته على الكذب، كما كشف لهم جرأته في المعاندة. فعند ذلك ضربه الخليفة.
وأية حجة لكم في امتحاننا إياكم، وفي إكفارنا لكم.
وزعم يومئذ أن حكم كلام الله كحكم علمه، فكما لا يجوز أن يكون علمه محدثاً ومخلوقاً، فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً محدثاً. فقال له: أليس قد كان الله يقدر أن يبدل آية مكان آية، وينسخ آية بآية، وأن يذهب بهذا القرآن، ويأتي بغيره، وكل ذلك في الكتاب مسطور قال: نعم. قال: فهل كان يجوز هذا في العلم، وهل كان جائزاً أن يبدل الله علمه، ويذهب به، ويأتي بغيره قال: ليس.
وقال له: روينا في تثبيت ما نقول الآثار، وتلونا عليك الآية من الكتاب، وأريناك الشاهد من النقول التي بها لزم الناس الفرائض، وبها يفصلون بين الحق والباطل، فعارضنا أنت الآن بواحدة من الثلاث. فلم يكن ذلك عنده، ولا استخزى من الكذب عليه في غير هذا المجلس، لأن عدة من حضره أكثر من أن يطمع أحداً أن يكون الكذب يجوز عليه. وقد كان صاحبكم هذا يقول: لا تقية إلا في دار الشرك. فلو كان ما أقر به من خلق القرآن كان منه على وجه التقية فقد أعمل التقية في دار الإسلام، وقد أكذب نفسه. وإن كان ما أقر به على الصحة والحقيقة فلستم منه، وليس منكم. على أنه لم ير سيفاً مشهوراً، ولا ضرب ضرباً كثيراً، ولا ضرب إلا ثلاثين سوطاً مقطوعة الثمار، مشعثة الأطراف، حتى أفصح بالإقرار مراراً. ولا كان في مجلس ضيق، ولا كانت حاله حال مؤيسة، ولا كان مثقلاً بالحديد، ولا خلع قلبه بشدة الوعيد. ولقد كان ينازع بألين الكلام، ويجيب بأغلظ الجواب، ويرزنون ويخف، ويحلمون ويطيش.
وعبتم علينا إكفارنا إياكم، واحتجاجنا عليكم بالقرآن والحديث. وقلتم: تكفروننا على إنكار شيء يحتمله التأويل، ويثبت بالأحاديث، فقد ينبغي لكم أن لا تحتجوا في شيء من القدر والتوحيد بشيء من القرآن، وأن لا تكفروا أحداً خالفكم في شيء وأنتم أسرع الناس إلى إكفارنا، وإلى عداوتنا والنصب لنا.
فصل منه
وأصحابنا - حفظك الله - إذا قاسوا خطأهم، ومروا على غلطهم فإنما ينقضون به شيئاً من العرض والجوهر، وشيئاً من قولهم في المعلوم والمجهول فقط. وهم قوم يكفيهم من التنبيه أقله، ومن القول أيسره. وخطأ النابتة وقول الرافضة تشبيه مصرح، وكفر مجلح، فليس هذا الجنس من ذلك الجنس. والحمد لله.وأما إخبارهم عن عيبنا إياهم حين لم يقولوا: إن الله تعالى رب القرآن، وفينا من يقول: إن الله تبارك وتعالى رب الكفر والإيمان، فإنا لم نسألهم عن ذلك من جهة ما يتوهمون، وإنما سألناهم عنه بجحدهم ما يرون بأبصارهم، ويسمعون بآذانهم، في الأشعار المعروفة، وفي الخطب المشهورة، وفي الابتهال عند الدعاء، وعلى ألسنة العوام والدهماء، وعند العهود والأيمان، وعند تعظيم القرآن، وبما يسمعون من السؤال في الطرقات، ومن القصاص في المساجد، لا يرون عائباً، ولا يسمعون زاريا. وليس أنا جعلنا هذا مسألة على من أنكر خلق القرآن، ولكنا أردنا أن نبين للضعفاء معاندتهم، وفرارهم من البهت، ومكابرتهم إذا سمعوا أنهم لم يسمعوا الناس يقولون: ورب القرآن، ورب ياسين، ورب طه، وأشباه ذلك.
ولعمري أن لو سمعوا الناس يقولون عند أيمانهم وابتهالهم إلى ربهم، على غير قصد إلى خلاف ولا وفاق: ورب الزنى والسرق، ورب الكفر والكذب، كما سمعوهم يقولون: ورب القرآن، ورب يس، ورب طه! ثم ألزمناهم خلق القرآن بمثل ما لهم علينا في خلق الزنى لقد كان ذلك معارضة صحيحة، وموازنة معروفة.
وأما قولهم: إن معنا العامة، والعباد، والفقهاء، وأصحاب الحديث، وليس معهم إلا أصحاب الأهواء، ومن يأخذ دينه من أول الرجال، فأي صاحب هو - يرحمك الله - أبعد من الجماعة من الرافضة، وهم في هذا المعنى أشقاؤهم وأولياؤهم، لأن ما خالفوهم فيه صغير في جنب ما وافقوهم عليه، والذين سموهم أصحاب أهواء هم المتكلمون، والمصلحون والمستصلحون، والمميزون. وأصحاب الحديث والعوام هم الذين يقلدون ولا يحصلون، ولا يتخيرون، والتقليد مرغوب عنه في حجة العقل، منهي عنه في القرآن، قد عكسوا الأمور كما ترى، ونقضوا العادات. وذلك أنا لا نشك أن من نظر وبحث، وقابل ووازن، أحق بالتبين، وأولى بالحجة.
وأما قولهم: منا النساك والعباد، فعباد الخوارج وحدهم أكثر عدداً من عبادهم، على قلة عدد الخوارج في جنب عددهم، على أنهم أصحاب نية، وأطيب طعمة، وأبعد من التكسب، وأصدق ورعاً، وأقل رياءً، وأدوم طريقة، وأبذل للمهجة، وأقل جمعاً ومنعا، وأظهر زهداً وجهداً. ولعل عبادة عمرو بن عبيد تفي بعبادة عامة عبادهم.
وأما قولهم: إن للقرآن قلباً وسناماً ولساناً وشفتين، وأنه يقدس ويشفع ويمحل، فإن هذا كله قد يجوز أن يكون مثلا، ويجوز أن يجعله الله كذلك إذا كان جسماً، والله على ذلك قادر، وهو له غير معجز، ومنه غير مستحيل. وكل فعل لا يكون عيباً، ولا ظلماً ولا بخلاً ولا كذباً، ولا خطاءً في التدبير، فهو جائز، والتعجب منه غير جائز.
فصل منه
وما أكثر من يجيب في المسائل، ويؤلف الكتب على قدر ما يسنح له في وهمه، وعلى قدر ما يتصور له في حاله تلك، لا يعمل على أصل، أو لا يشعر بالذي انبنى عليه ذلك الأصل، وإن كان ممن يعمل على أصل.وإنما صار علماؤنا إلى ما صاروا إليه لأنهم لا يقفون من القول في خلق القرآن على جواب مهذب، ومذهب مصفى، وعلى قول مفروغ منه، وعلى جوابات بأعيانها. فقد رددوا فيها النظر، وامتحنوها بأغلظ المحن، وقلبوها أكثر التقليب، وتبطنوا معانيها بأبلغ التفكير، وتعرفوا كل ما فيها، واعتصروا جميع قواها، وسهلوا سبلها، وذللوا العبارة عنها، احتقاراً منهم لمن خالفهم، واتكالاً على طول السلامة منهم، وثقة بطول الظفر بهم.
ومن تمام أمر صاحب الحق أن لا يتكل على عجز الخصم، وأن لا يعجب بظهوره على من لا حظ له في العلم.
وعلى العلماء أن يخافوا دول العلم، كما يخاف الملوك دول الملك. وقد رأيت البكرية، والجبرية، والفضلية، والشمرية، وإنهم لأحقر عند المعتزلة من جعل مما زالوا يستقون من علمائهم، ويستمدون من كبرائهم، ويدرسون كتبهم، ويأخذون ألفاظهم في جميع أمورهم، حتى رأيت شبيبتهم ونابتتهم، يدعون أنهم أكفاء، ويجمع بينهم في البلاء. والنابتة اليوم في التشبيه مع الرافضة، وهم دائبون في التألم من المعتزلة. غدرهم كثير، ونصبهم شديد، والعوام معهم، والحشو يطيعهم.
الآن معك أمران: السلطان وميلهم إليه، وخوفهم منه.
والعاقبة للمتقين.
فصل من صدر كتابه في الرد على النصارى
الحمد لله الذي من علينا بتوحيده، وجعلنا ممن ينفي شبهة خلقه وسياسة عباده، وجعلنا لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نجحد كتاباً أوجب علينا الإقرار به، ولا نضيف إليه ما ليس منه، إنه حميد مجيد، فعال لما يريد.أما بعد فقد قرأت كتابكم، وفهمت ما ذكرتم فيه من مسائل النصارى قبلكم، وما دخل على قلوب أحداثكم وضعفائكم من اللبس، والذي خفتموه على جواباتهم من العجز، وما سألتم من إقرارهم بالمسائل، ومن حسن معونتهم بالجواب.
وذكرتم أنهم قالوا: إن الدليل على أن كتابنا باطل، وأمرنا فاسد، أننا ندعي عليهم ما لا يعرفونه فيما بينهم، ولا يعرفونه من أسلافهم، لأنا نزعم أن الله جل وعز قال في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: " وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله " ، وأنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن مريم إله في سرهم، ولا ادعوا ذلك قط في علانيتهم. وأنهم زعموا أنا ادعينا عليهم ما لا يعرفون، كما ادعينا على اليهود ما لا يعرفون، حين نطق كتابنا، وشهد نبينا: أن اليهود قالوا: إن عزيراً ابن الله، وإن يد الله مغلولة، وإن الله فقير وهم أغنياء. وهذا ما لا يتكلم به إنسان، ولا يعرف في شيء من الأديان.
ولو كانوا يقولون في عزير ما نحلتمون وادعيتموه، لما جحدوه من دينهم، ولما أنكروا أن يكون من قولهم، ولما كانوا بإنكار بنوة عزير أحق منا بإنكار بنوة المسيح، ولما كان علينا منكم بأس بعد عقد الذمة، وأخذ الجزية.
وذكرتم أنهم قالوا: ومما يدل على غلطكم في الأخبار، وأخذكم العلم عن غير الثقات، أن كتابكم ينطق: أن فرعون قال لهامان: " ابن لي صرحاً " . وهامان لم يكن إلا في زمن الفرس، وبعد زمن فرعون بدهر طويل، وإن ذلك معروف عند أصحاب الكتب، مشهور عند أهل العلم. وإنما اتخذ صرحاً ليكون إذا علاه أشرف على الله.
وفرعون لا يخلو من أن يكون جاحداً لله تعالى، أو مقراً به. فإن كان دينه عند نفسه وأهل مملكته نفي الله وجحده، فما وجه اتخاذ الصرح وطلب الإشراف، وليس هناك شيء ولا إله وإن كان مقراً بالله عارفاً به، فلا يخلو من أن يكون مشبهاً أو نافياً للتشبيه. فإن كان ممن ينفي الطول والعرض والعمق والحدود والجهات، فما وجه طلبه له في مكان بعينه، وهو عنده بكل مكان وإن كان مشبهاً فقد علم أنه ليس في طاقة بني آدم أن يبنوا بنياناً، أو يرفعوا صرحاً يخرق سبع سموات بأعماقهن، والأجزاء التي بينهن، حتى يحاذي العرش ثم يعلوه.
وفرعون وإن كان كافراً فلم يكن مجنوناً، ولا كان إلى نقص العقل من بين الملوك منسوباً. على أن الحكم قد يقوم بعقول الملوك بالفضيلة على عقول الرعية.
وذكرتم أنهم قالوا: تزعمون أن الله تعالى ذكر يحيى بن زكريا يخبر أنه " لم يجعل له من قبل سمياً " ، وأنهم يجدون في كتبهم وفيما لا يختلف فيه خاصتهم وعامتهم أنه كان من قبل يحيى بن زكريا غير واحد يقال له يحيى، منهم: يوحنا بن فرح.
وزعمتم أنهم قالوا لكم: إنكم ذكرتم أن الله قال في كتابه لنبيكم: " وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، وإنما عنى بقوله: " أهل الذكر " : أهل التوراة، وأصحاب الكتب يقولون: إن الله قد بعث من النساء نبيات، منهم مريم بنت عمران، وبعث منهم حنة، وسارى، ورفقى.
وذكرتم أنهم قالوا: زعمتم أن عيسى تكلم في المهد، ونحن على تقديمنا له، وتقريبنا لأمره، وإفراطنا بزعمكم فيه، على كثرة عددنا، وتفاوت بلادنا، واختلافنا فيما بيننا، لا نعرف ذلك ولا ندعيه، وكيف ندعيه ولم نسمعه عن سلف، ولا ادعاه منا مدع.
ثم هذه اليهود لا تعرف ذلك، وتزعم أنها لم تسمع به إلا منكم، ولا تعرفه المجوس، ولا الصابئون، ولا عبادة البددة من الهند وغيرهم، ولا الترك والخزر، ولا بلغنا ذلك عن أحد من الأمم السالفة، والقرون الماضية، ولا في الإنجيل، ولا في ذكر صفات المسيح في الكتب والبشارات به على ألسنة الرسل.
ومثل هذا لا يجوز أن يجهله الولي والعدو، وغير الولي وغير العدو، ولا يضرب به مثل، ولا يروح به الناس، ثم يجمع النصارى على رده، مع حبهم لتقوية أمره. ولم يكونوا ليضادوكم فيما يرجع عليهم نفعه. وكيف لم يكذبوكم في إحيائه الموتى، ومشيه على الماء، وإبراء الأكمه والأبرص ! بل لم يكونوا ليتفقوا على إظهار خلاف دينهم، وإنكار أعظم حجة كانت لصاحبهم، ومثل هذا لا ينكتم ولا ينفك ممن يخالف وينم.
والكلام في المهد أعجب من كل عجب، وأغرب من كل غريب، وأبدع من كل بديع؛ لأن إحياء الموتى والمشي على الماء، وإقامة المقعد، وإبراء الأعمى، وإبراء الأكمه قد أتت به الأنبياء، وعرفه الرسل، ودار في أسماعهم. ولم يتكلم صبي قط، ولا مولود في المهد.
وكيف ضاعت هذه الآية، وسقطت حجة هذه العلامة من بين كل علامة ! وبعد، فكل أعجوبة يأتي بها الرجال، والمعروفون بالبيان، والمنسوبون إلى صواب الرأي، تكون الحيلة في الظن إليها أقرب، وخوف الخدعة عليها أغلب. والصبي المولود عاجز في الفطرة، ممتنع من كل حيلة، لا يحتاج فيه إلى نظر، ولا يشبهه من شاهده بدخل.
فصل منه
وسنقول في جميع ما ورد علينا من مسائلكم، وفيما لا يقع إليكم من مسائلهم، بالشواهد الظاهرة، والحجج القوية، والأدلة الاضطرارية، ثم نسألهم بعد جوابنا إياهم عن وجوه يعرفون بها انتقاض قولهم، وانتشار مذهبهم، وتهافت دينهم.ونحن نعوذ بالله من التكلف وانتحال ما لا نحسن، ونسأله القصد في القول والعمل، وأن يكون ذلك لوجهه، ولنصرة دينه، إنه قريب مجيب.
فأنا مبتدىء في ذكر الأسباب التي لها صارت النصارى أحب إلى العوام من المجوس، وأسلم صدوراً عندهم من اليهود، وأقرب مودة، وأقل غائلة، وأصغر كفراً، وأهون عذاباً.
ولذلك أسباب كثيرة، ووجوه واضحة، يعرفها من نظر، ويجهلها من لم ينظر.
أول ذلك أن اليهود كانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرها، وعداوة الجيران شبيهة بعداوة الأقارب في شدة التمكن وثبات الحقد، وإنما يعادي الإنسان من يعرف، ويميل على من يرى، ويناقض من يشاكل، ويبدو له عيوب من يخالط. وعلى قدر الحب والقرب يكون البغض والبعد، ولذلك كانت حروب الجيران وبني الأعمام من سائر الناس وسائر العرب أطول، وعداوتهم أشد.
فلما صار المهاجرون لليهود جيراناً، وقد كانت الأنصار متقدمة الجوار، مشاركة في الدار، حسدتهم اليهود على النعمة في الدين، والاجتماع بعد الافتراق، والتواصل بعد التقاطع، وشبهوا على العوام، واستمالوا الضعفة، ومالئوا الأعداء والحسدة، ثم جاوزوا الطعن وإدخال الشبهة، إلى المناجزة والمنابذة بالعداوة، فجمعوا كيدهم، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في قتالهم، وإخراجهم من ديارهم، وطال ذلك واستفاض فيهم وظهر، وترادف لذلك الغيظ، وتضاعف البغض، وتمكن الحقد.
وكانت النصارى لبعد ديارهم، من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره، لا يتكلفون طعنا، ولا يثيرون كيداً، ولا يجمعون على حرب. فكان هذا أول أسباب ما غلظ القلوب على اليهود، ولينها على النصارى.
ثم كان من أمر المهاجرين إلى الحبشة، واعتمادهم على تلك الجنبة ما حببهم إلى عوام المسلمين. وكلما لانت القلوب لقوم غلظت على أعدائهم، وبقدر ما نقص من بغض النصارى زاد في بغض اليهود.
ومن شأن الناس حب من اصطنع إليهم خيراً أو جرى على يديه، أراد الله بذلك أو لم يرده، وبقصد كان أم باتفاق.
وأمر آخر، وهو من أمتن أسبابهم وأقوى أمورهم، وهو تأويل آية غلطت فيها العامة حتى نازعت الخاصة، وحفظتها النصارى واحتجت، واستمالت قلوب الرعاع والسفلة، وهو قول الله تعالى: " لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى " . إلى قوله: " وذلك جزاء المحسنين " . وفي نفس الآية أعظم الدليل على أن الله تعالى لم يعن هؤلاء النصارى ولا أشباههم: الملكانية واليعقوبية، وإنما عنى ضرب بحيرا، وضرب الرهبان الذين كان يخدمهم سلمان.
وبين حمل قوله: " الذين قالوا إنا نصارى " على الغلط منهم في الأسماء، وبين أن نجزم عليهم لأنهم نصارى فرق.
كما ذكر اليهود أنه جاء الإسلام وملوك العرب رجلان: غساني ولخمي، وهما نصرانيان، وقد كانت العرب تدين لهما، وتؤدي الإتاوة لهما، فكان تعظيم قلوبهم لهما راجعاً إلى تعظيم دينهما.
وكانت تهامة، وإن كانت لقاحاً لا تدين الدين، ولا تؤدي الإتاوة، ولا تدين للملوك، فإنها كانت لا تمتنع من تعظيم ما عظم الناس، وتصغير ما صغروا.
ونصرانية النعمان وملوك غسان مشهورة في العرب، معروفة عند أهل النسب، ولولا ذلك لدللت عليها بالأشعار المعروفة، والأخبار الصحيحة.
وقد كانت تتجر إلى الشام، وينفذ رجالها إلى ملوك الروم، ولها رحلة في الشتاء والصيف، في تجارة مرة إلى الحبشة، ومرة قبل الشام، ومرة بيثرب، ومصيفها بالطائف، ومرة منيحين مستأنفاً بحمده، فكانوا أصحاب نعمة، وذلك مشهور مذكور في القرآن، وعند أهل المعرفة.
وقد كانت تهاجر إلى الحبشة، وتأتي باب النجاشي وافدة، فيحبوهم بالجزيل، ويعرف لهم الأقدار، ولم تكن تعرف كسرى، ولا تأنس بهم. وقيصر والنجاشي نصرانيان، فكان ذلك أيضاً للنصارى، دون اليهود.
والآخر من الناس تبع للأول في تعظيم من عظم، وتصغير من صغر.
وأخرى: أن العرب كانت النصرانية فيهل فاشية، وعليها غالبة، إلا مضر، فلم تغلب عليها يهودية ولا مجوسية، ولم تفش فيها النصرانية، إلا ما كان من قوم منهم نزلوا الحيرة يسمون: العباد، فإنهم كانوا نصارى، وهم مغمورون مع نبذ يسير في بعض القبائل. ولم تعرف مضر إلا دين العرب، ثم الإسلام.
وغلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلها: على لخم، وغسان، والحارث بن كعب بنجران، وقضاعة، وطي، في قبائل كثيرة، وأحياء معروفة. ثم ظهرت في ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكر، ثم في آل ذي الجدين خاصة.
وجاء الإسلام وليست اليهودية بغالبة على قبيلة، إلا ما كان من ناس من اليمانية، ونبذ يسير من جميع إياد وربيعة. ومعظم اليهودية إنما كانت بيثرب وحمير وتيماء ووادي القرى، في ولد هارون، دون العرب.
فعطف قلوب دهماء العرب على النصارى الملك الذي كان فيهم، والقرابة التي كانت لهم. ثم رأت عوامنا أن فيها ملكاً قائماً، وأن فيهم عرباً كثيرة، وأن بنات الروم ولدن لملوك الإسلام، وأن في النصارى متكلمين وأطباء ومنجمين، فصاروا بذلك عندهم عقلاء وفلاسفة وحكماء، ولم يروا ذلك في اليهود.
وإنما اختلفت أحوال اليهود والنصارى في ذلك لأن اليهود ترى أن النظر في الفلسفة كفر، والكلام في الدين بدعة، وأنه مجلبة لكل شبهة، وأنه لا علم إلا ما كان في التوراة وكتب الأنبياء، وأن الإيمان بالطب، وتصديق المنجمين من أسباب الزندقة والخروج إلى الدهرية، والخلاف على الأسلاف وأهل القدوة، حتى إنهم ليبهرجون المشهور بذلك، ويحرمون كلام من سلك سبيل أولئك.
ولو علمت العوام أن النصارى والروم ليست لهم حكمة ولا بيان، ولا بعد روية، إلا حكمة الكف، من الخرط والنجر والتصوير، وحياكة البزيون لأخرجتهم من حدود الأدباء، ولمحتهم من ديوان الفلاسفة والحكماء؛ لأن كتاب المنطق والكون والفساد، وكتاب العلوي، وغير ذلك، لأرسطاطاليس، وليس برومي ولا نصراني.
وكتاب المجسطي لبطليموس، وليس برومي ولا نصراني.
وكتاب إقليدس لإقليدس، وليس برومي ولا نصراني.
وكتاب الطب لجالينوس، ولم يكن رومياً ولا نصرانياً.
وكذلك كتب ديمقراط وبقراط وأفلاطون، وفلان وفلان.
وهؤلاء ناس من أمة قد بادوا وبقيت آثار عقولهم، وهم اليونانيون، ودينهم غير دينهم، وأدبهم غير أدبهم، أولئك علماء، وهؤلاء صناع أخذوا كتبهم لقرب الجوار، وتداني الدار، فمنها ما أضافوه إلى أنفسهم، ومنها ما حولوه إلى ملتهم. إلا ما كان من مشهور كتبهم، ومعروف حكمهم، فإنهم حين لم يقدروا على تغيير أسمائها زعموا أن اليونانيين قبيل من قبائل الروم، ففخروا بأديانهم على اليهود، واستطالوا بها على العرب، وبذخوا بها على الهند، حتى زعموا أن حكماءنا أتباع حكمائهم، وأن فلاسفتنا اقتدوا على أمثالهم، فهذا هذا.
ودينهم - يرحمك الله - يضاهي الزندقة، ويناسب في بعض وجوهه قول الدهرية، وهم من أسباب كل حيرة وشبهة.
والدليل على ذلك أنا لم نر أهل ملة قط أكثر زندقة من النصارى، ولا أكثر متحيراً أو مترنحاً منهم.
وكذلك شأن كل من نظر في الأمور الغامضة بالعقول الضعيفة: ألا ترى أن أكثر من قتل في الزندقة ممن كان ينتحل الإسلام ويظهره، هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى.
على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة لم تجد أكثرهم إلا كذلك.
ومما عظمهم في قلوب العوام، وحببهم إلى الطغام، أن منهم كتاب السلاطين، وفراشي الملوك، وأطباء الأشراف، والعطارين والصيارفة.
ولا تجد اليهودي إلا صباغاً، أو دباغاً، أو حجاماً، أو قصاباً، أو شعاباً.
فلما رأت العوام اليهود والنصارى توهمت أن دين اليهود في الأديان كصناعتهم في الصناعات، وأن كفرهم أقذر الكفر، إذ كانوا هم أقذر الأمم.
وإنما صارت النصارى أقل مساخة من اليهود، على شدة مساخة النصارى، لأن الإسرائيلي لا يزوج إلا الإسرائيلي، وكل مناكحهم مردودة فيهم، ومقصورة عليهم، وكانت الغرائب لا تشوبهم، وفحولة الأجناس لا تضرب ولا تضرب فيهم، لم ينجبوا في عقل ولا أسر ولا ملح. وإنك لتعرف ذلك في الخيل والإبل، والحمير والحمام.
ونحن - رحمك الله - لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى، وأن فيهم ملكاً قائماً، وأن ثيابهم أنظف، وأن صناعتهم أحسن.
وإنما خالفنا في فرق ما بين الكفرين والفرقتين، في شدة المعاندة واللجاجة، والإرصاد لأهل الإسلام بكل مكيدة، مع لؤم الأصول، وخبث الأعراق.
فأما الملك والصناعة والهيئة، فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية، والخيل العتاق، واتخذوا الجوقات، وضربوا بالصوالجة، وتحذفوا المديني، ولبسوا الملحم والمطبقة، واتخذوا الشاكرية، وتسموا بالحسن والحسين، والعباس وفضل وعلي، واكتنوا بذلك أجمع، ولم يبق إلا أن يتسموا بمحمد، ويكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم المسلمون، وترك كثير منهم عقد الزنانير، وعقدها آخرون دون ثيابهم، وامتنع كثير من كبرائهم من إعطاء الجزية، وأنفوا مع أقدارهم من دفعها وسبوا من سبهم، وضربوا من ضربهم.
وما لهم لا يفعلون ذلك وأكثر منه، وقضاتنا أو عامتهم يرون أن دم الجاثليق والمطران والأسقف وفاء بدم جعفر وعلي والعباس وحمزة.
ويرون أن النصراني إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم بالغواية أنه ليس عليه إلا التعزير والتأديب، ثم يحتجون أنهم إنما قالوا ذلك لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مسلمة. فسبحان الله العظيم! ما أعجب هذا القول وأبين انتشاره! ومن حكم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يساوونا في المجلس، ومن قوله: " وإن سبوكم فاضربوهم، وإن ضربوكم فاقتلوهم " .
وهم إذا قذفوا أم النبي عليه السلام بالفاحشة لم يكن له عند أمته إلا التعزير والتأديب. وزعموا أن افتراءهم على النبي ليس بنكث للعهد، ولا بنقض للعقد.
وقد أمر النبي عليه السلام أن يعطونا الضريبة عن يد منا عالية في قبولنا منهم، وعقدنا لذمتهم، دون إراقة دمهم. وقد حكم الله تعالى عليهم بالذلة والمسكنة.
أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن الأئمة الراشدين، والسلف المتقدمين لم يشترطوا عند أخذ الجزية، وعقد الذمة عدم الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، إلا لأن ذلك عندهم أعظم في العيون، وأجل في الصدور من أن يحتاجوا إلى تخليده في الكتب، وإلى إظهار ذكره بالشرط، وإلى تثبيته بالبينات، بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الوهن عليهم، والمطمعة فيهم، ولظنوا أنهم في القدر الذي يحتاج فيه إلى هذا وشبهه.
وإنما يتواثق الناس في شروطهم، ويفسرون في عهودهم ما يمكن فيه الشبهة، أو يقع فيه الغلط، أو يغبى عنه الحاكم، وينساه الشاهد، ويتعلق به الخصم، فأما الواضح الجلي، والظاهر الذي لا يخيل فما وجه اشتراطه، والتشاغل بذكره.
وأما ما احتاجوا إلى ذكره في الشروط، وكان مما يجوز أن يظهر في العهد فقد فعلوه، وهو كالذلة والصغارة، وإعطاء الجزية، ومقاسمة الكنائس، وأن لا يعينوا بعض المسلمين على بعض، وأشباه ذلك. فأما أن يقولوا لمن هو أذل من الذليل، وأقل من القليل، وهو الطالب الراغب في أخذ فديته، والإنعام عليه بقبض جزيته وحقن دمه: نعاهدك على أن لا تفتري على أمة رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، وسيد الأولين والآخرين. فهذا ما لا يجوز في تدبير أوساط الناس، فكيف بالجلة والعلية، وأئمة الخليقة، ومصابيح الدجى، ومنار الهدى، مع أنفة العرب، وبأو السلطان، وغلبة الدولة، وعز الإسلام، وظهور الحجة، والوعد بالنصرة.
على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود، ولا المجوس، ولا الصابئين كما ابتليت بالنصارى. وذلك أنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا، والضعيف بالأسناد من روايتنا، والمتشابه من آي كتابنا، ثم يخلون بضعفائنا، ويسألون عنها عوامنا، مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين، والزنادقة الملاعين، وحتى مع ذلك ربما تبرءوا إلى علمائنا، وأهل الأقدار منا، ويشغبون على القوي، ويلبسون على الضعيف.
ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم، وأنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد.
وبعد، فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا، ومجاننا وأحداثنا شيء من كتب المنانية، والديصانية، والمرقونية، والفلانية، ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها، ومخلاة في أيدي ورثتها. فكل سخنة عين رأيناها في أحداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان أولها.
وأنت إذا سمعت كلامهم في العفو والصفح، وذكرهم للسياحة، وزرايتهم على كل من أكل اللحمان، ورغبتهم في أكل الحبوب، وترك الحيوان، وتزهيدهم في النكاح، وتركهم لطلب الولد، ومديحهم للجاثليق والمطران والأسقف والرهبان، بترك النكاح وطلب النسل، وتعظيمهم الرؤساء علمت أن بين دينهم وبين الزندقة نسباً، وأنهم يحنون إلى ذلك المذهب.
والعجب أن كل جاثليق لا ينكح، ولا يطلب الولد. وكذلك كل مطران، وكل أسقف. وكذلك كل أصحاب الصوامع من اليعقوبية، والمقيمين في الديارات والبيوت من النسطورية. وكل راهب في الأرض وراهبة، مع كثرة الرهبان والرواهب، ومع تشبه أكثر القسيسين بهم في ذلك، ومع ما فيهم من كثرة الغزاة، وما يكون فيهم مما يكون في الناس، من المرأة العاقر، والرجل العقيم.
على أن من تزوج منهم امرأة لم يقدر على الاستبدال بها، ولا على أن يتزوج أخرى معها، ولا على التسري عليها. وهم مع هذا قد طبقوا الأرض، وملئوا الأفاق، وغلبوا الأمم بالعدد، وبكثرة الولد. وذلك مما زاد في مصائبنا، وعظمت به محنتنا.
ومما زاد فيهم، وأنمى عددهم، أنهم يأخذون من سائر الأمم، ولا يعطونهم، لأن كل دين جاء بعد دين، أخذ منه الكثير، وأعطاه القليل.
فصل منه
ومما يدل على قلة رحمتهم، وفساد قلوبهم أنهم أصحاب الخصاء من بين جميع الأمم، والخصاء أشد المثلة، وأعظم ما ركب به إنسان ثم يفعلون ذلك بأطفال لا ذنب لهم، ولا دفع عندهم.ولا نعرف قوماً يعرفون بخصاء الناس حيث ما كانوا إلا ببلاد الروم والحبشة، وهم في غيرهما قليل، وأقل قليل.
على أنهم لم يتعلموا إلا منهم، ولا كان السبب في ذلك غيرهم، ثم خصوا أبناءهم وأسلموهم في بيعهم. وليس الخصاء إلا في دين الصابئين، فإن العابد ربما خصى نفسه، ولا يستحل خصاء ابنه. فلو تمت إرادتهم في خصاء أولادهم في ترك النكاح وطلب النسل كما حكيت لك قبل هذا لانقطع النسل، وذهب الدين، وفتن الخلق.
والنصراني وإن كان أنظف ثوباً، وأحسن صناعة، وأقل مساخة، فإن باطنه ألأم وأقذر وأسمج، لأنه أقلف، ولا يغتسل من الجنابة، ويأكل لحم الخنزير، وامرأته جنب لا تطهر من الحيض، ولا من النفاس، ويغشاها في الطمث، وهي مع ذلك غير مختونة.
وهم مع شرارة طبائعهم، وغلبة شهواتهم ليس في دينهم مزاجر كنار الأبد في الآخرة، وكالحدود والقود والقصاص في الدنيا، فكيف يجانب ما يفسده، ويؤثر ما يصلحه من كانت حاله كذلك. وهل يصلح الدنيا من هو كما قلنا وهل يهيج على الفساد إلا من وصفنا ولو جهدت بكل جهدك، وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم في المسيح، لما قدرت عليه، حتى تعرف به حد النصرانية، وخاصة قولهم في الإلهية.
وكيف تقدر على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري فسألته عن قولهم في المسيح لقال قولاً، ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن قولهم في المسيح لأتاك بخلاف أخيه وصنوه. وكذلك جميع الملكانية واليعقوبية. ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية، كما نعرف جميع الأديان.
على أنهم يزعمون أن الدين لا يخرج في القياس، ولا يقوم على المسائل، ولا يثبت في الامتحان، وإنما هو بالتسليم لما في الكتب، والتقليد للأسلاف. ولعمري، إن من كان دينه دينهم ليجب عليه أن يعتذر بمثل عذرهم.
وزعموا أن كل من اعتقد خلاف النصرانية من المجوس والصابئين والزنادقة فهو معذور، ما لم يتعمد الباطل، ويعاند الحق. فإذا صاروا إلى اليهود قضوا عليهم بالمعاندة، وأخرجوهم من طريق الغلط والشبهة.
فصل منه
فأما مسألتهم في كلام عيسى في المهد: أن النصارى مع حبهم لتقوية أمره لا يثبتونه، وقولهم: إنا تقولناه ورويناه عن غير الثقات، وأن الدليل على أن عيسى لم يتكلم في المهد أن اليهود لا يعرفونه، وكذلك المجوس، وكذلك الهند والخزر والديلم. فنقول في جواب مسألتهم عند إنكارهم كلام المسيح في المهد مولوداً.يقال لهم: إنكم حين سويتم المسألة وموهتموها، ونظمتم ألفاظها، ظننتم أنكم قد أنجحتم، وبلغتم غايتكم. ولعمري لئن حسن ظاهرها، وراع الأسماع مخرجها، إنها لقبيحة المفتش، سيئة المعرى.
ولعمري أن لو كانت اليهود تقر لكم بإحياء الأربعة الذين تزعمون، وإقامة المقعد الذي تدعون، وإطعام الجمع الكثير من الأرغفة اليسيرة، وتصيير الماء جمداً، والمشي على الماء، ثم أنكرت الكلام في المهد من بين جميع آياته وبراهينه لكان لكم في ذلك مقال، وإلى الطعن سبيل. فأما وهم يجحدون ذلك أجمع، فمرة يضحكون، ومرة يغتاظون ويقولون: إنه صاحب رقىً ونيرجات، ومداوي مجانين، ومتطبب، وصاحب حيل وتربص خدع، وقراءة كتب، وكان لسناً مسكيناً، ومقتولاً مرحوماً، ولقد كان قبل ذلك صياد سمك، وصاحب شبك، وكذلك أصحابه. وأنه خرج على مواطأة منهم له، وأنه لم يكن لرشدة.
وأحسنهم قولاً، وألينهم مذهباً من زعم أنه ابن يوسف النجار. وأنه قد كان واطأ ذلك المقعد قبل إقامته بسنين، حتى إذا شهره بالقعدة، وعرف موضعه في الزمنى، مر به في جمع من الناس كأنه لا يريده، فشكا إليه الزمانة وقلة الحيلة، وشدة الحاجة، فقال: ناولني يدك. فناوله يده، فاجتذبه فأقامه، فكان تجمع لطول القعود، حتى استمر بعد ذلك.
وأنه لم يحي ميتاً قط، وإنما كان داوى رجلاً يقال له لا عازر إذ أغمي عليه يوماً وليلة، وكانت أمه ضعيفة العقل، قليلة المعرفة، فمر بها، فإذا هي تصرخ وتبكي، فدخل إليها ليسكتها ويعزيها، وجس عرقه فرأى فيه علامة الحياة، فداواه حتى أقامه، فكانت لقلة معرفتها لا تشك أنه قد مات، ولفرحها بحياته تثني عليه بذلك، وتتحدث به.
فكيف تستشهدون قوماً هذا قولهم في صاحبكم، حين قالوا: كيف يجوز أن يتكلم صبي في المهد مولوداً، فيجهله الأولياء والأعداء.
ولو كانت المجوس تقر لعيسى بعلامة واحدة، وبأدنى أعجوبة، لكان لكم أن تنكروا علينا بهم، وتستعينوا بإنكارهم. فأما وحال عيسى في جميع أمره عند المجوس كحال زرادشت في جميع أمره عند النصارى فما اعتلالهم به، وتعلقهم في إنكارهم وأما قولكم: وكيف لم تعرف الهند والخزر والترك ذلك فمتى أقرت الهند لموسى بأعجوبة واحدة، فضلاً عن عيسى ومتى أقرت لنبي بآية، أو روت له سيرة، حتى تستشهدوا الهند على كلام عيسى في المهد ومتى كانت الترك والديلم والخزر والببر والطيلسان مذكورة في شيء من هذا الجنس، محتجاً بها على هذا الضرب فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا: ما لنا لا نعرف ذلك ولم يبلغنا عن أحد بتة أجبناهم بعد إسقاط نكيرهم وتشنيعهم، وتزوير شهودهم.
وجوابنا: أنهم إنما قبلوا دينهم عن أربعة أنفس: اثنان منهم من الحواريين بزعمهم: يوحنا، ومتى. واثنان من المستجيبة وهما: مارقش ولوقش، وهؤلاء الأربعة لا يؤمن عليهم الغلط ولا النسيان، ولا تعمد الكذب، ولا التواطؤ على الأمور، والاصطلاح على اقتسام الرياسة، وتسليم كل واحد منهم لصاحبه حصته التي شرطها له.
فإن قالوا: إنهم كانوا أفضل من أن يتعمدوا كذباً، وأحفظ من أن ينسوا شيئاً، وأعلى من أن يغلطوا في دين الله تعالى، أو يضيعوا عهدا.
قلنا: إن اختلاف رواياتهم في الإنجيل، وتضادها في كتبهم، واختلافهم في نفس المسيح، مع اختلاف شرائعهم، دليل على صحة قولنا فيهم، وغفلتكم عنهم.
وما ينكر من مثل لوقش أن يقول باطلاً، وليس من الحواريين، وقد كان يهودياً قبل ذلك بأيام يسيرة، ومن هو عندكم من الحواريين خير من لوقش عند المسيح في ظاهر الحكم بالطهارة، والطباع الشريفة، وبراءة الساحة.
فصل منه
سألتم عن قولهم: إذا كان تعالى قد اتخذ عبداً من عباده خليلاً، فهل يجوز أن يتخذ عبداً من عباده ولداً، يريد بذلك إظهار رحمته له، ومحبته إياه، وحسن تربيته وتأديبه له، ولطف منزلته منه، كما سمى عبداً من عباده خليلاً، وهو يريد تشريفه وتعظيمه، والدلالة على خاص حاله عنده.وقد رأيت من المتكلمين من يجيز ذلك ولا ينكره، إذا كان ذلك على التبني والتربية والإبانة له بلطف المنزلة، والاختصاص له بالمرحمة والمحبة، لا على جهة الولادة، واتخاذ الصاحبة. ويقول: ليس في القياس فرق بين اتخاذ الولد على التبني والتربية وبين اتخاذ الخليل على الولاية والمحبة.
وزعم أن الله تعالى يحكم في الأسماء بما أحب، كما أن له أن يحكم في المعاني بما أحب.
وكان يجوز دعوى أهل الكتاب على التوراة والإنجيل والزبور، وكتب الأنبياء صلوات الله عليهم في قولهم: إن الله قال: " إسرائيل بكري " أي هو أول من تبنيت من خلقي. وأنه قال: " إسرائيل بكري، وبنوه أولادي " . وأنه قال لداود: " سيولد لك غلام، ويسمى لي ابناً، وأسمى له أباً " . وأن المسيح قال في الإنجيل: " أنا أذهب إلى أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم " ، وأن المسيح أمر الحواريين أن يقولوا في صلواتهم: " يا أبانا في السماء، تقدس اسمك " . في أمور عجيبة، ومذاهب شنيعة، يدل على سوء عبادة اليهود، وسوء تأويل أصحاب الكتب، وجهلهم مجازات الكلام، وتصاريف اللغات، ونقل لغة إلى لغة، وما يجوز على الله، وما لا يجوز. وسبب هذا التأويل كله الغي والتقليد، واعتقاد التشبيه.
وكان يقول: إنما وضعت الأسماء على أقدار المصلحة، وعلى قدر ما يقابل من طبائع الأمم. فربما كان أصلح الأمور وأمتنها أن يتبناه الله أو يتخذه خليلاً، أو يخاطبه بلا ترجمان، أو يخلقه من غير ذكر، أو يخرجه من بين عاقر وعقيم. وربما كانت المصلحة غير ذلك كله. وكما تعبدنا أن نسميه جواداً ونهانا أن نسميه سخياً أو سرياً وأمرنا أن نسميه مؤمناً ونهانا أن نسميه مسلماً، وأمرنا أن نسميه رحيماً ونهانا أن نسميه رفيقاً.
وقياس هذا كله واحد، وإنما يتسع ويسهل على قدر العادة وكثرتها. ولعل ذلك كله قد كان شائعاً في دين هود وصالح وشعيب وإسماعيل، إذ كان شائعاً في كلام العرب في إثبات ذلك وإنكاره.
وأما نحن - رحمك الله - فإنا لا نجيز أن يكون لله ولد، لا من جهة الولادة، ولا من جهة التبني، ونرى أن تجويز ذلك جهل عظيم، وإثم كبير؛ لأنه لو جاز أن يكون أباً ليعقوب لجاز أن يكون جداً ليوسف، ولو جاز أن يكون جداً وأباً، وكان ذلك لا يوجب نسبا، ولا يوهم مشاكلة في بعض الوجوه، ولا ينقص من عظم، ولا يحط من بهاء، لجاز أيضاً أن يكون عماً وخالاً؛ لأنه إن جاز أن يسميه من أجل المرحمة والمحبة والتأديب أباً، جاز أن يسميه آخر من جهة التعظيم والتفضيل والتسويد أخاً، ولجاز أن يجد له صاحباً وصديقاً، وهذا ما لا يجوزه إلا من لا يعرف عظمة الله، وصغر قدر الإنسان.
وليس بحكيم من ابتذل نفسه في توقير عبده، ووضع من قدره في التوفر على غيره. وليس من الحكمة أن تحسن إلى عبدك بأن تسيء إلى نفسك، وتأتي من الفضل ما لا يجب بتضييع ما يجب. وكثير الحمد لا يقوم بقليل الذم، ولم يحمد الله ولم يعرف إلهيته من جوز عليه صفات البشر، ومناسبة الخلق، ومقاربة العباد.
وبعد، فلا يخلو المولى في رفع عبده وإكرامه من أحد أمرين: إما أن يكون لا يقدر على كرامته إلا بهوان نفسه، ويكون على ذلك قادراً، مع وفارة العظمة، وتمام البهاء.
وإن كان لا يقدر على رفع قدر غيره إلا بأن ينقص من قدر نفسه فهذا هو العجز، وضيق الذرع.
وإن كان على ذلك قادراً فآثر ابتذال نفسه والحط من شرفه فهذا هو الجهل الذي لا يحتمل.
والوجهان عن الله جل جلاله منفيان.
ووجه آخر يعرفون به صحة قولي، وصواب مذهبي، وذلك أن الله تبارك وتعالى لو علم أنه فد كان فيما أنزل من كتبه على بني إسرائيل: إن أباكم كان بكري وابني، وإنكم أبناء بكري لما كان تغضب عليهم إذ قالوا: نحن أبناء الله، فكيف لا يكون ابن ابن الله ابنه، وهذا من تمام الإكرام، وكمال المحبة، ولا سيما إن كان قال في التوراة: بنو إسرائيل أبناء بكري.
وأنت تعلم أن العرب حين زعمت أن الملائكة بنات الله كيف استعظم الله تعالى ذلك وأكبره، وغضب على أهله، وإن كان يعلم أن العرب لم تجعل الملائكة بناته على الولادة واتخاذ الصاحبة، فكيف يجوز مع ذلك أن يكون الله قد كان يخبر عباده قبل ذلك بأن يعقوب ابنه، وأن سليمان ابنه، وأن عزيراً ابنه، وأن عيسى ابنه.
فالله تعالى أعظم من أن يكون له أبوة من صفاته، والإنسان أحقر من أن يكون بنوة الله من أنسابه.
والقول بأن الله يكون أباً وجداً وأخاً وعماً، للنصارى ألزم، وإن كان للآخرين لازماً، لأن النصارى تزعم أن الله هو المسيح بن مريم، وأن المسيح قال للحواريين: " إخوتي " . فلو كان للحواريين أولاد لجاز أن يكون الله عمهم! بل قد يزعمون أن مرقش هو ابن شمعون الصفا، وأن زوزري ابنته، وأن النصارى تقر أن في إنجيل مرقش: " ما زاذ أمك وإخوتك على الباب " وتفسيرها: ما زاذ: معلم. فهم لا يمتنعون من أن يكون الله تبارك وتعالى أباً وجداً وعماً.
ولولا أن الله قد حكى عن اليهود أنهم قالوا: إن " عزيراً ابن الله " ، " ويد الله مغلولة " ، و " إن الله فقير ونحن أغنياء " وحكى عن النصارى أنهم قالوا: " المسيح ابن الله " وقال: " قالت النصارى المسيح ابن الله " . وقال: " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " لكنت لأن أخر من السماء أحب إلي من أن ألفظ بحرف مما يقولون. ولكني لا أصل إلى إظهار جميع مخازيهم، وما يسرون من فضائحهم، إلا بالإخبار عنهم، والحكاية منهم.
فإن قالوا: خبرونا عن الله، وعن التوراة، أليست حقاً قلنا: نعم. قالوا: فإن فيها " إسرائيل بكري " وجميع ما ذكرتم عنا معروف في الكتب.
قلنا: إن القوم إنما أتوا من قلة المعرفة بوجوه الكلام، ومن سوء الترجمة، مع الحكم بما يسبق إلى القلوب. ولعمري أن لو كانت لهم عقول المسلمين ومعرفتهم بما يجوز في كلام العرب، وما يجوز على الله، مع فصاحتهم بالعبرانية، لوجدوا لذلك الكلام تأويلاً حسناً، ومخرجاً سهلاً، ووجهاً قريباً. ولو كانوا أيضاً لم يعطلوا في سائر ما ترجموا لكان لقائل مقال، ولطاعن مدخل، ولكنهم يخبرون أن الله تبارك وتعالى قال في العشر الآيات التي كتبتها أصابع الله: " إني أنا الله الشديد، وإني أنا الله الثقف، وأنا النار التي تأكل النيران، آخذ الأبناء بحوب الآباء، القرن الأول والثاني والثالث إلى السابع " . وأن داود قال في الزبور: " وافتح عينك يا رب " و قم يا رب " ، و " أصغ إلي سمعك يا رب " . وأن داود خبر أيضاً في مكان آخر عن الله تعالى: " وانتبه الله كما ينتبه السكران الذي قد شرب الخمر " . وأن موسى قال في التوراة: " خلق الله الأشياء بكلمته، وبروح نفسه " . وأن الله قال في التوراة لبني إسرائيل: " بذراعي الشديدة أخرجتكم من أهل مصر " . وأنه قال في كتاب إشعياء: " احمد الله حمداً جديداً، احمده في أقاصي الأرض، يملأ الجزائر وسكانها، والبحور والقفار وما فيها، ويكون بنو قيدار في القصور، وسكان الجبال - يعني قيدار بن إسماعيل - ليصيحوا ويصيروا لله الفخر والكرامة، ويسبحوا بحمد الله في الجزائر " .
وأنه قال على إثر ذلك: " ويخرج الرب كالجبار، وكالرجل الشجاع المجرب، ويزجر ويصرخ، ويهيج الحرب والحمية، ويقتل أعداءه، يفرح السماء والأرض " .
وأن الله قال أيضاً في كتاب إشعياء: " سكت. قال: هو متى أسكت، مثل المرأة التي قد أخذها الطلق للولادة أتلهف، وإن تراني أريد أحرث الجبال والشعب، وآخذ بالعرب في طريق لا يعرفونه " .
وكلهم على هذا اللفظ العربي مجمع. ومعنى هذا لا يجوزه أحد من أهل العلم، ومثل هذا كثير تركته لمعرفتكم به.
وأنت تعلم أن اليهود لو أخذوا القرآن فترجموه بالعبرانية لأخرجوه من معانيه، ولحولوه عن وجوهه، وما ظنك بهم إذا ترجموا: " فلما آسفونا انتقمنا منهم " ، و " لتصنع على عيني " ، و " السموات مطوية بيمينه " ، و " على العرش استوى " ، و " ناضرة. إلى ربها ناظرة " ، وقوله: " فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً " ، و " كلم الله موسى تكليماً " ، و " جاء ربك والملك صفاً صفاً " .
وقد يعلم أن مفسري كتابنا وأصحاب التأويل منا أحسن معرفة، وأعلم بوجوه الكلام من اليهود، ومتأولي الكتاب، ونحن قد نجد في تفسيرهم ما لا يجوز على الله في صفته، ولا عند المتكلمين في مقاييسهم، ولا عند النحويين في عربيتهم. فما ظنك باليهود مع غباوتهم وغيهم، وقلة نظرهم وتقليدهم وهذا باب قد غلطت فيه العرب أنفسها، وفصحاء أهل اللغة إذا غلطت قلوبها، وأخطأت عقولها، فكيف بغيرهم ممن لا يعلم كعلمها سمع بعض العرب قول جميع العرب: " القلوب بيد الله " ، وقولهم في الدعاء: " نواصينا بيد الله " وقوله جل ذكره: " بل يداه مبسوطتان " ، وقولهم: " هذا من أيادي الله ونعمه عندنا " وقد كان من لغتهم أن الكف أيضاً يد، كما أن النعمة يد، والقدرة يد، فغلط الشاعر فقال:
هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها
وقد كان إبراهيم بن سيار النظام يجيب بجواب، وأنا ذكره إن شاء الله. وعليه كانت علماء المعتزلة، ولا أراه مقنعاً ولا شافياً.
وذلك أنه كان يجعل الخليل مثل الحبيب، مثل الولي، وكان يقول: خليل الرحمن مثل حبيبه ووليه وناصره. وكانت الخلة والولاية والمحبة سواء.
قالوا: ولما كانت كلها عنده سواء جاز أن يسمي عبداً له ولداً، لمكان التربية التي ليست بحضانة، ولمكان الرحمة التي لا تشتق من الرحم، لأن إنساناً لو رحم جرو كلب فرباه لم يجز أن يسميه ولداً ويسمي نفسه أباً. ولو التقط صبياً فرباه جاز أن يسميه ولداً ويسمي نفسه له أباً، لأنه شبيه ولده، وقد يولد لمثله مثله. وليس بين الكلاب والبشر أرحام، فإذا كان شبه الإنسان أبعد من الله تعالى من شبه الجرو بالإنسان، كان الله أحق بألا يجعله ولده، وينسبه إلى نفسه.
قلنا لإبراهيم النظام عند جوابه هذا وقياسه الذي قاس عليه، في المعارضة والموازنة بين قياسنا وقياسه: أرأيت كلباً ألف كلابه، وجامى وأحمى دونه، هل يجوز أن يتخذه بذلك كله خليلاً، مع بعد التشابه والتناسب
فإذا قال: لا. قلنا: فالعبد الصالح أبعد شبهاً من الله من ذلك الكلب المحسن إلى كلابه، فكيف جاز في قياسك أن يكون الله خليل من لا يشاكله لمكان إحسانه، ولا يجوز للكلاب أن يسمي كلبه خليلاً أو ولداً لمكان حسن تربيته له، وتأديبه إياه، ولمكان حسن الكلب وكسبه عليه، وقيامه مقام الولد الكاسب والأخ، والبار.
والعبد الصالح لا يشبه الله في وجه من الوجوه، والكلب قد يشبه كلابه لوجوه كثيرة، بل ما أشبهه به مما خالفه فيه، وإن كانت العلة التي منعت من تسمية الكلب خليلاً وولداً بعد شبهه من الإنسان.
فلو قلتم: فما الجواب الذي أجبت فيه، والوجه الذي ارتضيته قلنا: إن إبراهيم صلوات الله عليه، وإن كان خليلاً، فلم يكن خليله بخلة كانت بينه وبين الله تعالى، لأن الخلة والإخاء والصداقة والتصافي والخلطة وأشباه ذلك منفية عن الله تعالى عز ذكره، فيما بينه وبين عباده، على أن الإخاء والصداقة داخلتان في الخلة، والخلة أعم الاسمين، وأخص الحالين. ويجوز أن يكون إبراهيم خليلاً بالخلة التي أدخلها الله على نفسه وماله، وبين أن يكون خليلاً بالخلة وأن يكون خليلاً بخلة بينه وبين ربه فرق ظاهر، وبون واضح. وذلك أن إبراهيم عليه السلام اختل في الله تعالى اختلالاً لم يختلله أحد قبله. لقذفهم إياه في النار، وذبحه ابنه، وحمله على ماله في الضيافة والمواساة والأثرة، وبعداوة قومه، والبراءة من أبويه في حياتهما، وبعد موتهما، وترك وطنه، والهجرة إلى غير داره ومسقط رأسه. فصار لهذه الشدائد مختلاً في الله، وخليلاً في الله. والخليل والمختل سواء في كلام العرب. والدليل على أن يكون الخليل من الخلة كما يكون من الخلة قول زهير بن أبي سلمى، وهو يمدح هرماً:
وإن أتاه خليل يوم مسبغة ... يقول لا عاجز مالي ولا حرم
وقال آخر:
وإني إلى أن تسعفاني بحاجة ... إلى آل ليلى مرة لخليل
وهو لا يمدحه بأن خليله وصديقه يكون فقيراً سائلاً، يأتي يوم المسألة ويبسط يده للصدقة والعطية، وإنما الخليل في هذا الموضع من الخلة والاختلال، لا من الخلة والخلال.
وكأن إبراهيم عليه السلام حين صار في الله مختلاً أضافه الله إلى نفسه، وأبانه بذلك عن سائر أوليائه، فسماه خليل الله من بين الأنبياء، كما سمى الكعبة: بيت الله من بين جميع البيوت، وأهل مكة: أهل الله من بين جميع البلدان. وسمى ناقة صالح عليه السلام: ناقة الله من بين جميع النوق. وهكذا كل شيء عظمه الله تعالى، من خير وشر، وثواب وعقاب. كما قالوا: دعه في لعنة الله، وفي نار الله وفي حرقه. وكما قال للقرآن: كتاب الله، وللمحرم: شهر الله. وعلى هذا المثال قيل لحمزة رحمة الله ورضوانه عز ذكره عليه: أسد الله، ولخالد رحمة الله عليه: سيف الله تعالى.
وفي قياسنا هذا لا يجوز: أن الله خليل إبراهيم، كما يقال: إن إبراهيم خليل الله.
فإن قال قائل: فكيف لم يقدموه على جميع الأنبياء، إذ كان الله قدمه بهذا الاسم الذي ليس لأحد مثله قلنا: إن هذا الاسم اشتق له من عمله وحاله وصفته، وقد قيل لموسى عليه السلام: كليم الله، وقيل لعيسى: روح الله، ولم يقل ذلك لإبراهيم، ولا لمحمد صلوات الله عليهما، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أرفع درجة منهم، لأن الله تعالى كلم الأنبياء عليهم السلام على ألسنة الملائكة، وكلم موسى كما كلم الملائكة، فلهذه العلة قيل: كليم الله. وخلق في نطف الرجال أن قذفها في أرحام النساء على ما أجرى عليه تركيب العالم، وطباع الدنيا، وخلق في رحم مريم روحاً وجسداً، على غير مجرى العادة، وما عليه المناكحة. فلهذه الخاصة قيل له: روح الله.
وقد يجوز أن يكون في نبي من الأنبياء خصلة شريفة، ولا تكون تلك الخصلة بعينها في نبي أرفع درجة منه، ويكون في ذلك النبي خصال شريفة ليست في الآخر. وكذلك جميع الناس، كالرجل يكون له أبوان، فيحسن برهما وتعاهدهما، والصبر عليهما، وهو أعرج لا يقدر على الجهاد، وفقير لا يقدر على الإنفاق. ويكون آخر لا أب له ولا أم له، وهو ذو مال كثير، وخلق سوي، وجلد طاهر، فأطاع هذا بالجهاد والإنفاق، وأطاع ذلك ببر والديه والصبر عليهما.
والكلام إذا حرك تشعب، وإذا ثبت أصله كثرت فنونه، واتسعت طرقه. ولولا ملالة القارىء، ومداراة المستمع لكان بسط القول في جميع ما يعرض أتم للدليل، وأجمع للكتاب، ولكنا إنما ابتدأنا الكتاب لنقتصر به على كسر النصرانية فقط.
فصل منه
قلنا في جواب آخر: إن كان المسيح إنما صار ابن الله لأن الله خلقه من غير ذكر، فآدم وحواء إذ كانا من غير ذكر وأنثى أحق بذلك، إن كانت العلة في اتخاذه ولداً أنه خلقه من غير ذكر.وإن كان ذلك لمكان التربية فهل رباه إلا كما ربى موسى، وداود، وجميع الأنبياء. وهل تأويل: رباه إلا غذاه، ورزقه، وأطعمه، وسقاه، فقد فعل ذلك بجميع الناس. ولم سميتم سقيه لهم وإطعامه إياهم تربية ولم رباه وأنتم لا تريدون إلا غذاه ورزقه، وهو لم يحضنه، ولم يباشر تقليبه، ولم يتول بنفسه سقيه وإطعامه، فيكون ذلك سبباً له دون غيره، وإنما سقاه لبن أمه في صغره، وغذاه بالحبوب والماء في كبره.
فصل منه
والأعجوبة في آدم عليه السلام أبدع، وتربيته أكرم، ومنقلبه أعلى وأشرف، إذ كانت السماء داره، والجنة منزله، والملائكة خدامه. بل هو المقدم بالسجود، والسجود أشد الخضوع. وإن كان بحسن التعليم والتثقيف؛ فمن كان الله تعالى يخاطبه، ويتولى مناجاته دون أن يرسل إليه ملائكته ويبعث إليه رسله، أقرب منزلة، وأشرف مرتبة، وأحق بشرف التأديب وفضيلة التعليم.وكان الله تعالى يكلم آدم كما كان يكلم ملائكته، ثم علمه الأسماء كلها؛ ولم يكن ليعلمه الأسماء كلها إلا بالمعاني كلها، فإذا كان ذلك كذلك فقد علمه جميع مصالحه ومصالح ولده، وتلك نهاية طباع الآدميين، ومبلغ قوى المخلوقين.
فصل منه
فأما قولهم إنا نقول على الناس ما لا يعرفونه، ولا يجوز أن يدينوا به، وهو قولنا إن اليهود قالت: إن الله تعالى فقير ونحن أغنياء. وأنها قالت: إن يد الله مغلولة، وإنها قالت: إن عزيراً ابن الله، وهم مع اختلافهم وكثرة عددهم، ينكرون ذلك ويأبونه أشد الإباء.قلنا لهم: إن اليهود لعنهم الله تعالى كانت تطعن على القرآن، وتلتمس نقضه، وتطلب عيبه، وتخطىء فيه صاحبه، وتأتيه من كل وجه، وترصده بكل حيلة، ليلتبس على الضعفاء، وتستميل قلوب الأغبياء.
فلما سمعت قول الله تعالى لعباده الذين أعطاهم، قرضاً، وسألهم قرضاً على التضعيف، فقال عز من قائل: " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له " . قالت اليهود على وجه الطعن والعيب والتخطئة والتعنت: تزعم أن الله يستقرض منا، وما استقرض منا إلا لفقره وغنانا! فكفرت بذلك القول إذ كان على وجه التكذيب والتخطئة، لا على وجه أن دينها كان في الأصل أن الله فقير، وأن عباده أغنياء. وكيف يعتقد إنسان أن الله عاجز عما يقدر عليه، مع إقراره بأنه الذي خلقه ورزقه، وإن شاء حرمه، وإن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه. وقدرته على جميع ذلك كقدرته على واحد.
ومجاز الآية في اللغة واضح، وتأويلها بين وذلك أن الرجل منهم كان يقرض صاحبه لإرفاقه، ليعود إليه مع أصل ماله اليسير من ربحه، ثم هو مخاطر به إلى أن يعود في ملكه. فقال لهم بحسن عادته ومنته: آسوا فقراءكم، وأعطوا في الحق أقرباءكم، من المال الذي أعطيتكم، والنعمة التي خولتكم، بأمري إياكم وضماني لكم، فأعتده منكم قرضاً وإن كنت أولى به منكم، فأنا موفيكم حقوقكم إلى ما لا ترتقي إليه همة ولا تبلغه أمنية. على أنكم قد أمنتم من الخطار، وسلمتم من التغرير.
والرجل يقول لعبده: أسلفني درهماً، عند الحاجة تعرض له، وهو يعلم أن عبده وماله له. وإنما هذا كلام وفعال يدل على حسن الملكة، والتفضل على العبد والأمة، وإخبار منه لعبده أنه سيعيد عليه ما كانت سخت به نفسه.
وهذا ليس بغلط في الكلام ولا بضيق فيه ولكن المتعنت يتعلق بكل سبب، ويتشبث بكل ما وجد.
وأما إخباره عن اليهود أنها قالت: " يد الله مغلولة " ، فلم يذهب إلى أن اليهود ترى أن ساعده مشدودة إلى عنقه بغل. وكيف يذهب إلى هذا ذاهب، ويدين به دائن ! لأنه لا بد أن يكون يذهب إلى أنه غل نفسه أو غله غيره. وأيهما كان، فإنه منفي عن وهم كل بالغ يحتمل التكليف، وعاقل يحتمل التثقيف، ولكن اليهود قوم جبرية، والجبرية تبخل الله مرة، وتظلمه مرة، وإن لم تقر بلسانها، وتشهد على إقرارها، بقولهم: " يد الله مغلولة " يعنون بره وإحسانه. وقولهم: مغلولة، لا يعني أن غيره حبسه ومنعه، ولكن إذا كان عندهم أنه الذي منع أياديه، وحبس نعمه؛ فهي محبوسة بحبسه، وممنوعة بمنعه.
والذي يدل على أنهم أرادوا باليدين النعمة والإفضال، دون الساعد والذراع، جواب كلامهم حين قال: " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " . دليلاً على ما قلنا، وشاهداً على ما وصفنا.
فإن قالوا: فكيف لم نقل إن اليهود بخلت الله وجحدت إحسانه، دون أن يقال إن يد الله مغلولة قلنا: إن أراد الله الإخبار عن كفر قوم وسخط عليهم، فليس لهم عليه أن يعبر عن دينهم وعيوبهم بأحسن المخارج، ويجليها بأحسن الألفاظ. وكيف وهو يريد التنفير عن قولهم، وأن يبغضهم إلى من سمع ذلك عنهم.
ولو أراد الله تعالى تليين الأمر وتصغيره وتسهيله، لقال قولاً غير هذا. وكل صدق جائز في الكلام. فهذا مجاز مسألتهم في اللغة، وهو معروف عند أهل البيان والفصاحة.
وأما قولهم: إن اليهود لا تقول إن عزيراً ابن الله. فإن اليهود في ذلك على قولين: أحدهما خاص، والآخر عام في جماعتهم.
فأما الخاص، فإن ناساً منهم لما رأوا عزيراً أعاد عليهم التوراة من تلقاء نفسه، بعد دروسها وشتات أمرها غلوا فيه، وقالوا ذلك، وهو مشهور من أمرهم. وإن فريقاً من بقاياهم لباليمن والشام وداخل بلاد الروم. وهؤلاء بأعيانهم يقولون: إن إسرائيل الله ابنه، وإذا كان ذلك على خلاف تناسب الناس، وصار ذلك الاسم لعزير بالطاعة والعلامة، والمرتبة لأنه من ولد إسرائيل.
والقول الذي هو عام فيهم، أن كل يهودي ولده إسرائيل، فهو ابن الله، إذ لم يجدوا ابن ابن قط إلا وهو ابن.
فصل منه
فإن قالوا: ليس المسيح روح الله وكلمته، كما قال عز ذكره: " وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه " أو ليس قد أخبر عن نفسه حين ذكر أمه أنه نفخ فيها من روحه أو ليس مع ذلك قد أخبر عن حصانة فرجها وطهارتها أو ليس مع ذلك قد أخبر أنه لا أب له، وأنه كان خالقاً، إذ كان يخلق من الطين كهيئة الطير، فيكون حياً طائراً فأي شيء بقي من الدلالات على مخالفته لمشاكلة جميع الخلق، ومباينة جميع البشر قلنا لهم: إنكم إنما سألتمونا عن كتابنا، وما يجوز في لغتنا وكلامنا، ولم تسألونا عما يجوز في لغتكم وكلامكم. ولو أننا جوزنا ما في لغتنا ما لا يجوز، وقلنا على الله تعالى ما لا نعرف، كنا بذلك عند الله والسامعين في حد المكاثرين، وأسوأ حالاً من المنقطعين، وكنا قد أعطيناكم أكثر مما سألتم، وجزنا بكم فوق أمنيتكم.ولو كنا إذا قلنا: عيسى روح الله وكلمته، وجب علينا في لغتنا أن يجعله الله ولداً، ونجعله مع الله تعالى إلهاً، ونقول: إن روحاً كانت في الله فانفصلت منه إلى بدن عيسى وبطن مريم.
فكنا إذا قلنا: إن الله سمى جبريل روح الله وروح القدس، وجب علينا أن نقول فيه ما يقولون في عيسى. وقد علمتم أن ذلك ليس من ديننا، ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه عندنا، فكيف نظهر للناس قولاً لا نقوله، وديناً لا نرتضيه.
ولو كان قوله جل ذكره: " فنفخنا فيه من روحنا " يوجب نفخاً كنفخ الزق، أو كنفخ الصائغ في المنفاخ، وأن بعض الروح التي كانت فيه انفصلت فاصلة إلى بطنه وبطن أمه، لكان قوله في آدم يوجب له ذلك؛ لأنه قال: " وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله " . . إلى قوله: " ونفخ فيه من روحه " وكذلك قوله: " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين " .
والنفخ يكون من وجوه، والروح يكون من وجوه: فمنها ما أضافه إلى نفسه، ومنها ما لم يضفه إلى نفسه. وإنما يكون ذلك على قدر ما عظم من الأمور، فمما سمى روحاً وأضافه إلى نفسه، جبريل الروح الأمين، وعيسى بن مريم. والتوفيق كقول موسى حين قال: إن بني فلان أجابوا فلاناً النبي ولم يجيبوك. فقال له: " إن روح الله مع كل أحد " .
وأما القرآن فإن الله سماه روحاً، وجعله يقيم للناس مصالحهم في دنياهم وأبدانهم، فلما اشتبها من هذا الوجه ألزمهما اسمهما فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: " وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا " وقال: " تنزل الملائكة والروح " .
فصل منه
قد جعلنا في جواباتهم وقدمنا مسائلهم، بما لم يكونوا ليبلغوه لأنفسهم، ليكون الدليل تاماً، والجواب جامعاً؛ وليعلم من قرأ هذا الكتاب، وتدبر هذا الجواب، أنا لم نغتنم عجزهم، ولم ننتهز غرتهم، وأن الإدلال بالحجة، والثقة بالفلج والنصرة، هو الذي دعانا إلى أن نخبر عنهم بما ليس عندهم، وألا نقول في مسألتهم بمعنىً لم ينتبه له منتبه، أو يشر إليه مشير، وألا يوردوا فيما يستقبلون، على ضعفائنا ومن قصر نظره منا، شيئاً إلا والجواب قد سلف فيهم، وألسنتهم قد مذلت به.وسنسألهم إن شاء الله، ونجيب عنهم، ونستقصي لهم في جواباتهم، كما سألنا لهم أنفسنا، واستقصينا لهم في مسائلهم.
فيقال لهم: هل يخلو المسيح أن يكون إنساناً بلا إله، أو إلهاً بلا إنسان أو أن يكون إلهاً وإنساناً فإن زعموا أنه كان إلهاً بلا إنسان، قلنا لهم: فهو الذي كان صغيراً فشب والتحى، والذي كان يأكل ويشرب، وينجو ويبول، وقتل بزعمكم وصلب، وولدته مريم وأرضعته، أم غيره هو الذي كان يأكل ويشرب على ما وصفنا فأي شيء معنى الإنسان إلا ما وصفنا وعددنا وكيف يكون إلهاً بلا إنسان، وهو الموصوف بجميع صفات الإنسان. وليس القول في غيره ممن صفته كصفته إلا كالقول فيه كاشتمالها على غيره وإن زعموا أنه لم ينقلب عن الإنسانية ولم يتحول عن جوهر البشرية، ولكن لما كان اللاهوت فيه، صار خالقاً وسمي إلهاً. قلنا لهم: خبرونا عن اللاهوت. أكان فيه وفي غيره، أم كان فيه دون غيره فإن زعموا أنه كان فيه وفي غيره، فليس هو أولى بأن يكون خالقاً ويتسمى إلهاً من غيره. وإن كان فيه دون غيره، فقد صار اللاهوت جسماً.
وسنقول في الكسر عليهم إذا صرنا إلى القول في التشبيه، وهو قول معظمهم، والذي كان عليه جماعتهم، إلا من خالفهم من متكلميهم ومتفلسفيهم، فإنهم يقولون بالتشبيه والتجسيم، فراراً من كثرة الشناعة، وعجزاً عن الجواب. وكفى بالتشبيه قبحاً، وهو قول يعم اليهود وإخوانهم من الرافضة، وشياطينهم من المشبهة والحشوية والنابتة، وهو بعد متفرق في الناس. والله تعالى المستعان.
الجزء الرابع
فصل من صدر كتابه في الرد على المشبهة
أما بعد، فقد اختلف أهل الصلاة في معنى التوحيد، وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه. فليس يكون كل من انتحل اسم التوحيد موحداً إذا جعل الواحد ذا أجزاء، وشبهه بشيء ذي أجزاء.ولو أن زاعماً زعم أن أحداً لا يكون مشبهاً وإن زعم أن الله يرى بالعيون، ويوجد ببعض الحواس، حتى يزعم أنه يرى كما يرى الإنسان، ويدرك كما تدرك الألوان كان كمن قال: لا يكون العبد لله مكذباً، وإن زعم أنه يقول ما لا يفعل، حتى يزعم أنه يكذب.
ولا يكون العبد لله مجوراً، وإن زعم أنه يعذب من لم يعطه السبب الذي به ينال طاعته، حتى يزعم أنه يجور.
ولو أن رجلاً قال لفلان: عندي جذر مائة، كان عندنا كقوله: لفلان عشرة. وكذلك إذا قال: فلان قد ناقض في كلامه، فهو عندنا كقوله: فلان قد أحال في كلامه.
ولو قال: ناقض ولم يحل، له عندي جذر مائة وليس له عندي عشرة؛ كان كالذي يقول: ركبت عيراً ولم أركب حماراً، وشربت المدامة ولم أشرب خمراً.
وللمعاني دلالات وأسماء، فمن دل على المعنى بواحدة منها، وباسم من أسمائها، لم نسأله أن يوفينا الجميع؛ وأن يأتي على الكل، ولم يلتفت إلى منع ما منع، إذا كان الذي منع مثل الذي أعطى.
وقد أنبأ الله عن نفسه، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال " ليس كمثله شيء " فأقر القوم بظاهر هذا الكلام؛ ثم جعلوه في المعنى يشبه كل شيء، إذ جعلوه جسماً، فقد جعلوه محدثاً ومخلوقاً؛ لأن دلالة الحدوث، والشهادة على التدبير، ثابتان في الأجسام، وإنما لزمها ذلك لأنهما أجسام لا لغير ذلك؛ لأن الجسم إذا تحرك وسكن، وعجز وقوي، وبقي وفني، وزاد ونقص، ومازج الأجسام وتخلص لأنه جسم؛ ولولا أنه جسم لاستحال ذلك منه، ولما جاز عليه هذه الأمور التي أوجبتها الجسمية، وهي الدالة على حدوث الأجسام. فواجب أن يكون كل جسم كذلك، إذا كانت الأجسام مستوية في الجسمية، وإذا كان كل جسم منها أيضاً لزمه ذلك.
وقد اختلف أصحاب التشبيه في مذاهب التشبيه.
فقال بعضهم: نقول: إنه جسم، وكل جسم طويل.
وقال آخرون: نقول: إنه جسم، ولا نقول إنه طويل، لأنا إنما جعلناه جسماً لنخرجه من باب العدم؛ إذ كنا متى أخبرنا عن شيء، فقد جعلناه معقولا متوهماً، ولا معقول ولا متوهم إلا الجسم. وليست بنا حاجة إلى أن نجعله طويلاً، وليس في كونه جسماً إيجاب لأن يكون طويلاً. لأن الجسم يكون طويلاً وغير طويل، كالمدور، والمثلث، والمربع، وغير ذلك، ولا يكون الشيء إلا معقولا، ولا المعقول إلا جسماً. فلذلك جعلناه جسماً، ولم نجعله طويلا.
فينبغي - يرحمك الله - لصاحب هذه المقالة، إن لم يجعله طويلاً أن يجعله عريضاً، وإن لم يجعله عريضاً أن يجعله مدوراً، وإن لم يجعله مدوراً أن يجعله مثلثاً، وإن لم يجعله مثلثاً أن يجعله مربعاً. وإن أقر بهيئة من الهيئات فقد دخل فيما كره.
ولا أعلم المدور، والمثلث، والمربع، والمخمس، والمصلب، والمزوى، وغير ذلك من الهيئات، إلا أشنع في اللفظ، وأحقر في الوهم.
فصل منه
وقال أصحاب الرؤية: اعتللتم علينا بقول الله تعالى: " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " ، وقلتم: هذه الآية مبهمة، وخرجت مخرج العموم، والعام غير الخاص.وقد صدقتم، كذلك العام إلى أن يخصه الله بآية أخرى؛ وذلك أن الله تعالى لو كان قال: " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " ثم لم يقل: " وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة " لعلمنا أنه قد استثنى أخرة من جميع الأبصار.
قالوا: وإنما ذلك مثل قوله: " قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله " ومثل قوله: " وما كان الله ليطلعكم على الغيب " وهذه الأخبار مبهمة عامة، فلما قال: " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا " ولما قال، أيضاً: " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " علمنا أن القول الثاني قد خص القول الأول. وكذلك أيضاً قوله: " لا تدركه الأبصار " .
قلنا للقوم: إن الله تعالى لما قال: " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك " . بعد أن قال: " وما كان الله ليطلعكم على الغيب " . علمنا أن ذلك استثناء لبعض ما قال إني لا أطلعكم على الغيب. وهذا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه، ولا يحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا.
وعند خصومنا فيه أشد الاختلاف. وظاهر لفظه يحتمل وجهاً آخر غير ما ذهبوا إليه. والفقهاء وأصحاب التفسير يختلفون في تأويله وهم لا يختلفون في تأويل قوله: " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك " قال: ذكر ابن مهدي عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: " وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة " أنه قال: تنتظر ثواب ربها.
وذكر أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح مثل ذلك. وأبو صالح ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس، ومن العاملية، ومن المتقدمين في التفسير.
فهذا فرق بين.
وبعد، ففي حجج العقول أن الله لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه؛ فإذا كان مرئياً فقد أشبهه في أكثر الوجوه.
وإذا كان قولهم في النظر يحتمل ما قلتم، وما قال خصمكم، مع موافقة أبي صالح ومجاهد في التأويل، وكان ذلك أولى بنفي التشبيه الذي قد دل عليه العقل، ثم القرآن: " ليس كمثله شيء " كان التأويل ما قال خصمكم دون ما قلتم.
فصل منه
ثم رجع الكلام إلى أول المسألة، حيث جعلنا القرآن بيننا قاضياً، واتخذناه حاكماً، فقلنا:قد رأينا الله استعظم الرؤية استعظاماً شديداً، وغضب على من طلب ذلك وأراده، ثم عذب عليه، وعجب عباده ممن سأله ذلك، وحذرهم أن يسلكوا سبيل الماضين، فقال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: " يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة " .
فإن كان الله تعالى - في الحقيقة - يجوز أن يكون مرئياً، وببعض الحواس مدركاً، وكان ذلك عليه جائزاً، فالقوم إنما سألوا أمراً ممكناً، وقد طمعوا في مطمع، فلم غضب هذا الغضب، واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام، وضرب به هذا المثل، وجعله غاية في الجرأة وفي الاستخفاف بالربوبية.
فإن قالوا: لأن ذلك كان لا يجوز في الدنيا؛ فقدرة الله تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة.
فإن قالوا: ليس لذلك استعظم سؤالهم، ولكن لأنهم تقدموا بين يديه.
قلنا: لم صار هذا السؤال تقدماً عليه واستخفافاً به، والشيء الذي طلبوه هو مجوز في عقولهم، وقد أطمعهم فيه أن جوزوه عندهم، والقوم لم يسألوا ظلماً ولا عبثاً ولا محالا. ومن عادة المسئول التفضل، وأنه فاعل ذلك بهم يوماً.
فإن قالوا: إنما صار ذلك الطلب كفراً وذنباً عظيماً لأنه قد كان قال لهم: إني لا أتجلى لأحد في الدنيا.
قلنا: فإن كان الأمر على ما قلتم لكان في تفسيره إنكاره لطلبهم دليل على ما يقولون، ولذكر تقدمهم بعد البيان، بل قال: " فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة " لا غير ذلك.
فإن قالوا: إنما غضب الله عليهم لأنه ليس لأحد أن يظن أن الله تعالى يرى جهرة.
قلنا: وأي شيء تأويل قول القائل: رأيت الله جهرة إلا المعاينة، أو إعلان المعاينة؛ قال الله عز ذكره: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول " . والجهر هو الإعلان والرفع والإشاعة؛ فهل يراه أهل الجنة إذا رفع عنهم الحجب، ودخلوا عليه وجلسوا على الكرسي عنده إلا جهرة كما تأولتم الحديث الذي رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في القمر ليلة البدر " ، إلا أن يزعموا أنهم يرون ربهم سراً، لأنه ليس إلا السر والجهر، وليس إلا الإعلان والإخفاء، وليس إلا المعاينة.
فإن قالوا: نحن لا نقول بالمعاينة، ونقول: نراه، ولا نقول نعاينه.
قلنا: ولم، وأنتم ترونه بأعينكم فمن جعل لكم أن تقولوا نراه بالعين، ومنعكم أن تقولوا نعاينه بالعين وهل اشتقت المعاينة إلا من العين فإن قالوا: لا يجوز أن يلفظ بالمعاينة إلا في الشيء الذي تقع عينه علي، وتقع عيني عليه. فأما إذا كان أحدنا ذا عين، والآخر ليس ذا عين، فغير جائز أن تسمى الرؤية معاينة، وإنما المعاينة مثل المخاصمة؛ ولا يجوز أن أقول: خاصمت إلا وهناك من يخاصمني.
قلنا: قد يقول الناس أسلم فلان حين عاين السيف، وليس للسيف عين، وليس هناك من يقاتله. على أنكم قد تزعمون أن لله عيناً لا كالعيون ويداً لا كالأيدي، وله عين بلا كيف، وسمع بلا كيف.
فصل منه
وقالت - أيضاً - المشبهة: الدليل على أنه جسم قوله عز ذكره: " وجاء ربك والملك صفاً صفاً " . قالوا: فلا يجيء إلا إلى مكان هو فيه؛ ولو جاز أن يجيء إلى مكان هو فيه جاز أن يخرج منه وهو فيه. فإذا أخبر الله أنه في السموات والأرض، وقلتم إن الدنيا كلها لا تخلو منه، وإنه فيها، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت الدنيا محدودة، كان الذي يكون في بعضها أو في كلها محدوداً، إذا كان لم يجاوزها. ولو جاوزها لخرج إلى مكان، ولا يجوز أن يخرج منها إلا إلى مكان.وقالوا: قد أخبر الله أنه في السموات والأرض، والله لا يخاطب عباده إلا بما يعقلون، ولو خاطبهم بما لا يعقلون لكان قد كلفهم ما لا يطيقون، ومن خاطب من لا يفي بالفهم عنه فقد وضع المخاطبة في غير موضعها. فهذا ما قال القوم.
ونحن نقول: إن الشيء قد يكون في الشيء على وجوه، وسنذكر لك الوجوه، ونلحق كل واحد منها بشكله وبما يجوز فيه، إن شاء الله تعالى.
قلنا للقوم: أليس قد خاطب الله الصم البكم الذين لا يعقلون، والذين خبر أنهم لا يستطيعون سمعاً فإن قالوا: إن العرب قد تسمي المتعامي أعمى، والمتصامم أصم، ويقولون لمن عمل عمل من لا يعقل: لا يعقل؛ وإنما الكلام محمول على كلام. وذلك أن المتعامي إذا تعامى، صار في الجهل كالأعمى، فلما أشبهه من وجه سمي باسمه.
قلنا: قد صدقتم؛ ولكن ليس الأصل. والمستعمل في تسميتهم بالعمى إنما هو الذي لا ناظر له. فإذا قالوا ذلك، قلنا: فلم زعمتم أن له ناظراً، وأخذتم بالمجاز والتشبيه، وتركتم الأصل الذي هذا الاسم محمول عليه فإن قالوا: إنما قلنا من أجل أن الأول لا يجوز على الله تعالى، والثاني جائز عليه، والله لا يتكلم بكلام إلا ولذلك الكلام وجه إما أن يكون هو الأصل والمحمول عليه؛ وإما أن يكون هو الفرع والاشتقاق الذي تسميه العرب مجازاً.
فإذا نظرنا في كلام الله وهو عندنا عادل غير جائر، وهو جل جلاله يقول: " صم بكم عمي فهم لا يعقلون " علمنا أنهم لو كانوا منقوصين غير وافرين، كانوا قد كلفوا ما لا يطيقون، والمكلف لعباده ما لا يطيقون جائر ظالم. فإذا كان لا يليق ذلك به علمنا أنهم قد كانوا وافرين غير عاجزين ولا منقوصين. وإذا كانوا كذلك، صار الواجب أن نحكم بالفرع والمجاز، وندع الأصل والمحمول عليه وقلنا: هم عمي وصم ولا يعقلون على أنهم تعاموا وتصاموا وعملوا عمل من لا يعقل.
فإذا قالوا ذلك قلنا لهم: فإنا لم نعد هذا المذهب في قوله: " ناضرة " ، " وجاء ربك والملك صفاً صفاً " وفي قوله: " وهو الله في السموات وفي الأرض " .
وقد يقولون: جاءنا فلان بنفسه، ويقولون: جاءنا بولده، وجاءنا بخير كثير. وذلك على معان مختلفة.
ويقولون: جاءتنا السماء بأمر عظيم، والسماء في مكانها.
وقد يقولون - أيضاً - : جاءتنا السماء، وهم إنما يريدون الغيم الذي يكون به المطر من شق السماء وناحيتها ووجهها.
فصل من صدر كتابه في مقالة العثمانية
زعمت العثمانية أن أفضل هذه الأمة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي قحافة. وكان أول ما دلهم عند أنفسهم على فضيلته، وخاصة منزلته، وشدة استحقاقه إسلامه على الوجه الذي لم يسلم عليه أحد من عالمه وفي عصره. وذلك أن الناس اختلفوا في أول الناس إسلاماً: فقال قوم: أبو بكر بن أبي قحافة. وقال آخرون: زيد بن حارثة. وقال نفر: خباب بن الأرت.على أنا إذا تفقدنا أخبارهم، وأحصينا أحاديثهم، وعددنا رجالهم، وصحة أسانيدهم، كان الخبر في تقديم أبي بكر أعم، ورجاله أكثر، وإسناده أصح؛ وهو بذلك أشهر، واللفظ به أظهر. مع الأشعار الصحيحة، والأمثال المستفيضة، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق إذا امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التشاعر، والاتفاق والتواطؤ.
ولكنا ندع هذا المذهب جانباً، ونضرب عنه صفحاً، اقتداراً على الحجة، وثقة بالفلج والقوة، ونقتصر على أدنى منازل أبي بكر، وننزل على حكم الخصم، مع سرفه وميطه، فنقول: لما وجدنا من يزعم أن خباباً وزيد أسلما قبله، فأوسط الأمور وأعدلها وأقربها من محبة الجميع ورضى المخالف، أن نجعل إسلامهم كان معاً؛ إذ ادعوا أن الأخبار في ذلك متكافئة، والآثار متدافعة؛ وليس في الأشعار دلالة، ولا في الأمثال حجة. ولم يجدوا إحدى القضيتين أولى في حجة العقل من الأخرى.
وقالوا: فإن قال لنا قائل: فما بالكم لم تذكروا علياً في هذه الطبقة، وقد تعلمون كثرة مقدميه والرواية فيه
قلنا: لأنا قد علمنا بالوجه الصحيح، والشهادة القائمة أنه أسلم وهو حدث غرير، ولم نكذب الناقلين. ولم نستطع أن نزعم أن إسلامه كان لاحقاً بإسلام البالغين؛ لأن المقلل زعم أنه أسلم وهو ابن خمس سنين، والمكثر زعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين، والقياس يوجب أن يؤخذ بأوسط الروايتين، وبالأمر بين الأمرين. وإنما يعرف حق ذلك من باطله بأن تحصي سنيه التي ولي فيها، وسني عثمان، وسني أبي بكر، وسني الهجرة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بعد أن دعا إلى الله وإلى رسالته، وإلى أن هاجر إلى المدينة، ثم تنظر في أقاويل الناس في عمره، وفي قول المقلل والمكثر، فنأخذ بأوسطها، وهو أعدلها، وتطرح قول المقصر والغالي، ثم تطرح ما حصل في يديك من أوسط ما روي من عمره وسنيه، وسني عثمان، وسني عمر، وسني أبي بكر، والهجرة، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، إلى وقت إسلامه. فإذا فعلت وجدت الأمر على ما قلنا، وكما فسرنا.
وهذه التأريخات والأعمار معروفة، لا يستطيع أحد جهلها، والخلاف عليها؛ لأن الذين نقلوا التاريخ لم يعتمدوا تفضيل بعض على بعض، وليس يمكن ذلك، مع عللهم وأسبابهم. فإذا ثبت عندك بالذي أوضحنا وشرحنا، أنه كان ابن سبع سنين، أقل بسنة وأكثر بسنة علمت بذلك أنه لو كان ابن أكثر من ذلك بسنتين وثلاث وأربع، لا يكون إسلامه إسلام المكلف العارف بفضيلة ما دخل فيه، ونقصان ما خرج منه.
والتأويل المجمع عليه أن علياً قتل سنة أربعين في رمضان.
وقالوا: وإن قالوا: فلعله وهو ابن سبع سنين وثمان، فقد بلغ من فطنته وذكائه، وصحة لبه، وصدق حسه، وانكشاف العواقب له، وإن لم يكن جرب الأمور، ولا فاتح الرجال، ولا نازع الخصوم، أن يعرف جميع ما يجب على البالغ معرفته والإقرار به.
قلنا: إنما نتكلم على ظاهر الأحكام، وما شاهدنا عليه طباع الأطفال، فوجدنا حكم ابن سبع سنين وثمان سنين، وتسع سنين، حيث رأيناه وبلغنا خبره ما لم نعلم مغيب أمره، وخاصة طباعه حكم الأطفال. وليس لنا أن نزيل ظاهر حكمه، والذي نعرف من شكله بلعل وعسى، لأنا كنا لا ندري، لعله قد كان ذا فضيلة في الفطنة، فلعله قد كان ذا نقص فيها. أجاب منهم بهذا الجواب من يجوز أن يكون علي في المغيب قد أسلم إسلام البالغ المختار. غير أن الحكم فيه عنده على مجرى أمثاله وأشكاله، الذين إذا أسلموا وهم في مثل سنه، كان إسلامهم عن تربية الحاضن، وتلقين القيم، ورياضة السائس.
فأما علماء العثمانية ومتكلموهم، وأهل القدم والرياسة فيهم، فإنهم قالوا: إن علياً لو كان، وهو ابن ست سنين، وثمان سنين، وتسع سنين، يعرف فصل ما بين الأنبياء والكهنة، وفرق ما بين الرسل والسحرة، وفرق ما بين المنجم والنبي، وحتى يعرف الحجة من الحيلة، وقهر الغلبة من قهر المعرفة، ويعرف كيد الأريب، وبعد غور المتنبي، وكيف يلبس على العقلاء ويستميل عقول الدهماء، ويعرف الممكن في الطباع من الممتنع فيها، وما قد يحدث بالاتفاق مما يحدث بالأسباب، ويعرف أقدار القوى في مبلغ الحيلة ومنتهى البطش وما لا يحتمل إحداثه إلا الخالق، وما يجوز على الله مما لا يجوز في توحيده وعدله، وكيف التحفظ من الهوى، وكيف الاحتراس من تقدم الخادع في الحيلة كان كونه بهذه الحال وهذه الصفة، مع فرط الصبا والحداثة، وقلة التجارب والممارسة، خروجاً من نشو العادة، والمعروف مما عليه تركيب الأمة.
ولو كان على هذه الصفة، ومع هذه الخاصة، كان حجة على العامة وآية تدل على المباينة. ولم يكن الله تعالى ليخصه بمثل هذه الآية، وبمثل هذه الأعجوبة إلا وهو يريد أن يحتج بها له، ويخبر بها عنه، ويجعلها قاطعة لعذر الشاهد، وحجة الغائب، ولا يضيعها هدراً، ولا يكتمها باطلا.
ولو أراد الاحتجاج له بها شهر أمرها وكشف قناعها، وحمل النفوس على معرفتها، وسخر الألسنة لنقلها. والأسماع لإدراكها، لئلا يكون لغواً ساقطاً، ونسياً منسياً؛ لأن الله تعالى لا يبتدع أعجوبة، ولا يخترع آية، ولا ينقض العادة إلا للتعريف والإعذار، والمصلحة والاستبصار. ولولا ذلك لم يكن لفعلها معنىً، ولا لرسالته حجة. والله تبارك اسمه، تعالى أن يترك الأمور سدىً، والتدبير نشراً.
وأنتم تزعمون أنه لا يصل أحد إلى معرفة نبي، وكذب متنبىء، حتى تجتمع له هذه المعارف التي ذكرنا، والأسباب التي فصلنا.
ولولا أن الله تعالى أخبر عن يحيى بن زكريا أنه آتاه الحكم صبياً، وأنه أنطق عيسى في المهد رضيعاً، ما كانا في الحكم إلا كسائر البشر فإذ لم ينطق لعلي بذلك، ولا جاء الخبر به مجيء الحجة القاطعة والشهادة الصادقة، فالمعلوم عندنا في الحكم والمغيب جميعاً أن طباعه كطباع عميه العباس وحمزة. وهما أمس بمعدن جميع الخير منه، وكطباع أخويه جعفر وعقيل، وكطباع أبويه ورجال عصره وسادة رهطه.
ولو أن إنساناً ادعى مثل ذلك لأخيه جعفر، أو لعمه حمزة أو العباس - وهو حليم قريش - ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فيه.
ولو لم تعلم الروافض ومن يذهب مذهبها في هذا، باطل هذه الدعوى، وفساد هذا المعنى، إذا صدقت نفسها، ولم تقلد رجالها، وتحفظت من الهوى وآثرت التقوى، إلا بترك علي - رضوان الله عليه - ذكر ذلك لنفسه، والاحتجاج على خصمه وأهل دهره، مذ نازع الرجال، وخاصم الأكفاء، وجامع أهل الشورى، ولي وولي عليه، والناس بين معاند يحتاج إلى التقريع، ومرتاد يحتاج إلى المادة، وغفل يحتاج إلى أن يكثر له من الحجة، ويتابع له من الأمارات والدلالات، مع حاجة القرن الثاني إلى معرفة الحق ومعدن الأمر؛ لأن الحجة إذا لم تصح لعلي في نفسه، ولم تقم على أهل دهره، فهي عن ولده أعجز، وعنهم أضعف.
ثم لم ينقل ناقل واحد أن علياً احتج بذلك في موقف، ولا ذكره في مجلس، ولا قام به خطيباً، ولا أدلى به واثقاً، ولا همس به إلى موافق، ولا احتج به على مخالف، فقد ذكر فضائله وفخر بقرابته وسابقته، وكاثر بمحاسنه ومواقفه مذ جامع الشورى وناضلهم، إلى أن ابتلي بمساورة معاوية وطمعه فيه، وجلوس أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله عن عونه. والشد على عضده، كما قال عامر الشعبي: لقد وقعت الفتنة، وبالمدينة عشرون ألفاً من أصحاب رسول الله، ما خف فيها منهم عشرون. ومن زعم أنه شهد الجمل ممن شهد بدراً أكثر من أربعة فقد كذب، كان علي وعمار في شق، وطلحة والزبير في شق.
وكيف يجوز عليه ترك الاحتجاج، وتشجيع الموافق وقد نصب نفسه للخاصة والعامة وللمولى والمعادي ومن لا يحل له في دينه ترك الإعذار إليهم، إذ كان يرى أن قتالهم كان واجباً، وقد نصبه الرسول مفزعا ومعلما، ونص عليه قائماً، وجعله للناس إماماً، وأوجب طاعته، وجعله حجة في الناس، يقوم مقامه.
وأعجب من ذلك أنه لم يدع هذا له أحد في دهره كما لم يدعه لنفسه، مع عظيم ما قالوا فيه في عسكره، وبعد وفاته، حتى يقول إنسان واحد: إن الدليل على إقامته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه إلى الإسلام، فكلف التصديق قبل بلوغه وإدراكه، ليكون ذلك آية له في عصره، وحجة له ولولده على من بعده.
وقد كان علي أعلم بالأمور من أن يدع ذكر أكثر حججه والذي بان به من شكله، ويذكر أصغر حججه، والذي يشاكله فيه غيره.
وقد كان في عسكره من لا يألو في الإفراط، زيادة في القدر.
والعجب له - إن كان الأمر على ما ذكرتم - كيف لم يقف يوم الجمل. أو يوم صفين، أو يوم النهر، في موقف يكون فيه من عدوه بمرأى ومسمع فيقول: " تباً لكم وتعساً! كيف تقاتلوني، وتجحدون فضيلتي، وقد خصصت بآية، حتى كنت كيحيى بن زكريا، وعيسى بن مريم " فلا يمتنع الناس من أن يموجوا، فإذا ماجوا تكلموا على أقدار عللهم، وعللهم مختلفة، فلا يثبت أمرهم أن يعود إلى فرقة، فمن ذاكر قد كان ناسياً، ومن نازع قد كان مصراً، ومن مترنح قد كان غالطاً، مع ما كان يشيع من الحجة في الآفاق، ويستفيض في الأطراف، وتحمله الركبان، ويتهادى في المجالس. فهذا كان أشد على طلحة والزبير وعائشة، ومعاوية، وعبد الله بن وهب، من مائة ألف سنان طرير وسيف شهير.
ومعلوم عند ذوي التجربة والعارفين بطبائع الأتباع وعلل الأجناد أن العساكر تنتقض مرائرها، وينتشر أمرها، وتنقلب على قائدها بأيسر من هذه الحجة وأخفى من هذه الشهادة.
وقد علمتم ما صنعت المصاحف في طبائع أصحاب علي رضوان الله عليه، حين رفعها عمرو أشد ما كان أصحاب علي استبصاراً في قتالهم، ثم لم ينتقض على علي من أصحابه إلا أهل الجد والنجدة، وأصحاب البرانس والبصيرة.
وكما علمت من تحول شطر عسكر عبد الله بن وهب حين اعتزلوا مع فروة بن نوفل لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب كانت تدل عندهم على ضعف الاستبصار، والوهن في اليقين.
وهذا الباب أكثر من أن يحتاج مع ظهوره، ومعرفة الناس له إلى أن نحشو به كتابنا.
فأما إسلامه وهو حدث غرير، وصبي صغير، فهذا ما ندفعه؛ غير أنه إسلام تأديب وتلقين وتربية. وبين إسلام التكليف والامتحان، وبين التلقين والتربية، فرق عظيم، ومحجة واضحة.
وقالت العثمانية: إن قالت الشيع: إن الأمر ليس كما حكيتم ولا كما هيأتموه لأنفسكم، بل نزعم أنه قد كانت هنالك في أيام حداثته وصباه فضيلة ومزيد ذكاء، ولم يبلغ الأمر حد الأعجوبة والآية، قلنا: إن الذي ذهبتم إليه - أيضاً - لا بد فيه من أحد وجهين: إما أن يكون قد كان لا يزال يوجد في الصبيان مثله في الفطنة والذكاء، وإن كان ذلك عزيزاً قائلاً، وكان وجود ذلك ممتنعاً، ومن العادة خارجاً. فإذا كان قد يوجد مثله - على عزته وقلته - فما كان إلا كبعض من نرى اليوم ممن يتعجب من كيسه وفطنته، وحفظه وحكايته، وسرعة قبوله، على صغر سنه، وقلة تجربته. فإن كانت حاله هذه الحال، وطبقته على هذا المثال، فإنا لم نجد صبياً قط وإن أفرط كيسه، وحسنت فطنته، وأعجب به أهله يحتمل ولاية الله وعداوته، والتمييز بين الأمور التي ذكرنا. مع أنه ما جاءنا ولا جاء عند أحد منا بخبر صادق، ولا كتاب ناطق، أنه قد كان لعلي خاصة، دون قريش عامة، في صباه، من إتقان الأمور، وصحة المعارف، وجودة المخارج، ما لم يكن لأحد من إخوته، وعمومته وآبائه.
وإن كان القدر الذي كان عليه علي من المعرفة والذكاء القدر الذي لا نجد له فيه مثلاً، ولا رأينا له شكلاً، فهذا هو البديع الذي يحتج به على المنكرين، ويفلج على المعارضين، ويبين للمسترشدين. وهذا باب قد فرغنا منه مرة.
ولو كان الأمر في علي كما يقولون لكان ذلك حجة للرسول في رسالته ولعلي في إمامته.
والآية إذا كانت للرسول وخليفة الرسول كان أشهر لها؛ لأن وضوح أمر الرسول يزيد على ما للإمام، ويزيده إشراقاً واستنارة وبياناً.
ولا يجوز أن يكون الله تعالى قد عرف أهل عصرهما ذلك، وهم الشهداء على من بعدهم من القرون، ثم أسقط حجته. فلا تخلو تلك الحجة، وتلك الشهادة من ضربين: إما أن تكون ضاعت وضلت، وإما أن تكون قد قامت وظهرت. فإن كانت قد ضاعت فلعل كثيراً من حجج الرسول قد ضاع. وما جعل الباقي أولى بالتمام من الساقط، والساقط من شكل الثابت، لأنه حجة على شيئين، والثابت حجة على شيء. ولا يخلو أمر الساقط من ضربين: إما أن يكون الله - تبارك وتعالى - لم يرد تمامه، أو يكون قد أراده. وأي هذين كان، ففساده واضح عند قارىء الكتاب، وإن كانت الآية فيه قد تمت؛ إذ كانت الشهادة قد قامت علينا بها، كما كانت شهادة العيان قائمة عليهم فيها. فليس في الأرض عثماني إلا وهو يكابر عقله، ويجحد علمه.
ولعمري، إنا لنجد في الصبيان من لو لقنته، أو كتبت له أغمض المعاني وألطفها، وأغمض الحجج وأبعدها، وأكثرها لفظاً وأطولها، ثم أخذته بدرسه وحفظه لحفظه حفظاً عجيباً، ولهذه هذاً ذليقا.
فأما معرفة صحيحه من سقيمه،وحقه من باطله، وفصل ما بين المقر به والدليل، والاحتراس من حيث يؤتى المخدوعون، والتحفظ من مكر الخادعين، وتأتي المجرب، ورفق الساحر، وخلابة المتنبىء، وزجر الكهان، وأخبار المنجمين. وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه، فليس يعرف فروق النظم، واختلاف البحث والنثر إلا من عرف القصيد من الرجز، والمخمس من الأسجاع، والمزدوج من المنثور، والخطب من الرسائل، وحتى يعرف العجز العارض الذي يجوز ارتفاعه، من العجز الذي هو صفة في الذات.
فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام ثم لا يكتفي بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله، وأن حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي، وإن تفاوتوا في العجز العارض.
وهذا ما لا يوجد عند صبي ابن تسع سنين، أو ثمان سنين، أو سبع سنين أبداً، عرف ذلك عارف أو جهله جاهل.
ولا يجوز أن يعرف عارف معنى الرسالة إلا بعد الفراغ من هذه الوجوه، إلا أن يجعل جاعل التقليد والنشو والإلف لما عليه الآباء، وتعظيم الكبراء معرفة ويقيناً.
وليس بيقين ما اضطرب، ودخله الخلاج عند ورود معاني لعل وعسى، مما لا يمكن في المعقول إلا بحجة تخرج القلب إلى اليقين عن التجويز.
ولقد أعيانا أن نجد هذه المعرفة إلا في الخاص من الرجال وأهل الكمال في الأدب؛ فكيف بالطفل الصغير، والحدث الغرير! مع أنك لو أدرت معاني بعض ما وصف لك على أذكى صبي في الأرض، وأسرعه قبولاً وأحسنه حكاية وبياناً، وقد سويته له ودللته، وقربته منه، وكفيته مؤونة الروية، ووحشة الفكرة، لم يعرف قدره، ولا فصل حقه من باطله، ولا فرق بين الدلالة وشبيه الدلالة. فكيف له بأن يكون هو المتولي لتجربته وحل عقده وتخليص متشابهه، واستثارته من معدنه وكل كلام خرج من التعارف فهو رجيع بهرج، ولغو ساقط.
وقد نجد الصبي الذكي يعرف من العروض وجهاً، ومن النحو صدراً، ومن الفرائض أبواباً، ومن الغناء أصواتاً. فأما العلم بأصول الأديان، ومخارج الملل وتأويل الدين، والتحفظ من البدع، وقبل ذلك الكلام في حجج العقول، والتعديل والتجوير، والعلم بالأخبار وتقدير الأشكال، فليس هذا موجوداً إلا عند العلماء. فأما الحشو والطغام، فإنما هم أداة للقادة، وجوارح للسادة؛ وإنما يعرف شدة الكلام في أصول الأديان من قد صلي به، وسال في مضايقه، وجاثى الأضداد ونازع الأكفاء.
فصل منه
وقد علمتم ما صنع أبو بكر في ماله، وكان المال أربعين ألفاً، فأنفقه على نوائب الإسلام وحقوقه، ولم يكن ماله ميراثاً لم يكد فيه، فهو غزير لا يشعر بعسر اجتماعه، وامتناع رجوعه، ولا كان هبة ملك فيكون أسمح لطبيعته، وأخرق في إنفاقه، بل كان ثمرة كده وكسب جولانه وتعرضه.ثم لم يكن خفيف الظهر، قليل النسل، قليل العيال، فيكون قد جمع اليسارين؛ لأن المثل الصحيح السائر المعنى: " قلة العيال أحد اليسارين " ، بل كان ذا بنين وبنات وزوجة، وخدم وحشم، يعول مع ذلك أبويه وما ولدا. ولم يكن فتىً حدثاً فتهزه أريحية الشباب، وغرارة الحداثة. ولم يكن بحذاء إنفاقه طمع يدعوه، ولا رغبة تحدوه.
ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يد مشهورة فيخاف العار في ترك مواساته، وإنفاقه عليه، ولا كان من رهطه دنيا فيسب بترك مكانفته ومعاونته وإرفاقه. فكان إنفاقه على الوجه الذي لا يجد أبلغ في غاية الفضل منه، ولا أدل على غاية البصيرة منه.
وقد تعلمون ما كان يلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببطن مكة من المشركين، وقد تعلمون حسن صنيع كثير منهم، كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقوسه، فبلغ في هامته، في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل يومئذ أمنع أهل البطحاء، وهو رأس الكفر.
ثم صنيع عمر حيث يقول يوم أسلم: " والله لا نعبد الله سراً بعد هذا اليوم " ، حتى قال بعد موته عبد الله بن مسعود : " وما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر " .
فصل منه
ولو كان في ذلك الزمان القتال ممكناً، والوثوب مطمعاً، لقاتل أبو بكر ونهض كما نهض في الردة، وإنما قاتل علي في الزمان الذي قد أقرن فيه أهل الإسلام لأهل الشرك، وطمعوا أن تكون الحرب سجالاً، وقد أعلمهم الله أن العاقبة للمتقين، وأبو بكر مفتون مفرد ومطرود مشرد ومضروب معذب، في الزمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حركة، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: " طوبى لمن مات في نأنأة الإسلام " ، يقول: في أيام ضعفه وقلته، بحيث كانت الطاعة أعظم لفرط الامتحان، والبلاء أغلظ لشدة الجهد، لأن الاحتمال كلما كان أشد وأدوم، كانت الطاعة أفضل، والعزم فيه أقوى.ولا سواء مفتون مشرد لا حيلة عنده، ومضروب معذب لا انتصار به، ولا دفع عنده، ومباطش مقرن يشفي غيظه، ويروي غليله، وله مقدم يكنفه ويشجعه.
ولا سواء مقهور لا يغاث، ولم ينزل القرآن بعد بظفره. وقد هتك اليأس لما ألفى حجاب قلبه ونقض قوى طمعه حتى بقي وليس معه إلا احتسابه؛ ومقاتل في عسكره معه عز الرجال، وقوة الطمع، وطيب نفس الآمل.
فصل منه
وإن سأل سائل فقال: هل على الناس أن يتخذوا إماماً، وأن يقيموا خليفةقيل لهم: إن قولكم الناس يحتمل الخاصة والعامة. فإن كنتم قصدتم إليهما، ولم تفصلوا بين حاليهما، فإنا نزعم أن العامة لا تعرف معنى الإمامة. وتأويل الخلافة، ولا تفصل بين فضل وجودها ونقص عدمها، ولأي شيء ارتدت، ولأي أمر أملت، وكيف مأتاها والسبيل إليها، بل هي مع كل ريح تهب، وناشئة تنجم. ولعلها بالمبطلين أقر عيناً منها بالمحقين، وإنما العامة أداة للخاصة تبتذلها للمهن، وتزجي لها الأمور، وتصول بها على العدو، وتسد بها الثغور.
ومقام العامة من الخاصة مقام جوارح الإنسان من الإنسان، فإن الإنسان إذا فكر أبصر، وإذا أبصر عزم، وإذا عزم تحرك أو سكن، وهما بالجوارح دون القلب.
وكما أن الجوارح لا تعرف قصد النفس، ولا تروي في الأمور، ولم يخرجها ذلك من الطاعة للعزم، فكذلك العامة، لا تعرف قصد القادة ولا تدبير الخاصة، ولا تروي معها، وليس يخرجها ذلك من عزمها، وما أبرمت من تدبيرها.
والجوارح والعوام، وإن كانت مسخرة ومدبرة فقد تمتنع لعلل تدخلها، وأمور تصرفها، وأسباب تنقضها، كاليد يعرض لها الفالج واللسان يعتريه الخرس، فلا تقدر النفس على تسديدهما وتقويتهما، ولو اشتد عزمها، وحسن تأتيها ورفقها. وكذلك العامة عند نفورها وتهيجها، وغلبة الهوى والسخف عليها، وإن حسن تدبير الخاصة، وتعهد السياسة. غير أن معصية الجارحة أيسر ضرراً، وأهون أمراً، لأن العامة إذا انتكثت للخاصة، وتنكرت للقادة، وتشزنت على الراضة، كان البوار الذي لا حيلة له، والفناء الذي لا بقاء معه.
وصلاح الدنيا، وتمام النعمة في تدبير الخاصة وطاعة العامة، كما أن كمال المنفعة وتمام درك الحاجة بصواب قصد النفس؛ لأن النفس لو أدركت كل بغية، وأوفت كل غاية، وفتحت كل مستغلق، واستثارت كل دفين، ثم لم يعطها اللسان بحسن العبارة واليد بحسن الكتابة، كان وجود ذلك المستنبط - وإن جل قدره - وعدمه سواء.
فالخاصة تحتاج إلى العامة كحاجة العامة إلى الخاصة، وكذلك القلب والجارحة، وإنما هم جند للدفع، وسلاح للقطع، وكالترس للرامي، والفأس للنجار. وليس مضي سيف صارم بكف امرىء صارم، بأمضى من شجاع أطاع أميره، وقلد إمامه.
وما كلب أشلاه ربه، وأحمشه كلابه، بأفرط نزقاً ولا أسرع تقدماً، ولا أشد تهوراً من جندي أغراه طمعه، وصاح به قائده.
وليس في الأعمال أقل من الاختيار، ولا في الاختيار أقل من الصواب، فلباب كل عمل اختياره، وصفوة كل اختيار صوابه. ومع كثرة الاختيار يكثر الصواب، وأكثر الناس اختياراً أكثرهم صواباً، وأكثرهم أسباباً موجبه أقلهم اختياراً، وأقلهم اختياراً أقلهم صواباً.
فإن قالوا: فقد ينبغي للعوام أن لا يكونوا مأمورين ولا منهيين، ولا عاصين ولا مطيعين.
قيل لهم: أما فيما يعرفون فقد يعصون ويطيعون.
فإن قالوا: فما الأمر الذي يعرفون من الأمر الذي يجهلون قيل لهم: أما الذي يعرفون، فالتنزيل المجرد بغير تأويله، وجملة الشريعة بغيرها، وما جل من الخبر واستفاض، وكثر ترداده على الأسماع، وكرروه على الأفهام.
وأما الذي يجهلون فتأويل المنزل وتفسير المجمل، وغامض السنن التي حملتها الخواص عن الخواص، من حملة الأثر وطلاب الخبر مما يتكلف معرفته، ويتبع في مواضعه، ولا يهجم على طالبه، ولا يقهر سمع القاعد عنه.
والخبر خبران: خبر ليس للخاصة فيه فضل على العامة، وهو كما سن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، وأبواب القضاء والطلاق، والمناسك، والبيوع، والأشربة، والكفارات، وأشباه ذلك.
وباب آخر يجهله العوام، ويخبط فيه الحشو ولا تشعر بعجزها ولا موضع دائها. ومتى جرى سببه، أو ظهر شيء منه تسنمت أعلاه، وركبت حومته، كالكلام في الله، وفي التشبيه، والوعد والوعيد؛ لأنها قد عجزت عن دعوى الفتيا، ولا تتهافت فيها، ولا تتسكع فيما لا يعرف منها، ولا تتوحش من الكلام في التعديل والتجوير، ولا تفرغ من الكلام في الاختيار والطباع، ومجيء الآثار، وكل ما جرى سببه من دقيق الكلام وجليله، في الله تعالى وفي غيره.
ولو برز عالم على جادة منهج وقارعة طريق، فنازع في النحو واحتج في العروض، وخاض في الفتيا، وذكر النجوم والحساب، والطب والهندسة، وأبواب الصناعات، لم يعرض له، ولم يفاتحه إلا أهل هذه الطبقات.
ولو نطق بحرف في القدر حتى يذكر العلم والمشيئة، والتكليف والاستطاعة، وهل خلق الله تعالى الكفر وقدره أو لم يخلقه ولم يقدره، لم يبق حمال أغثر، ولا بطال غث، ولا خامل غفل ولا غبي كهام، ولا جاهل سفيه، إلا وقف عليه ولاحاه وصوبه وخطأه ثم لا يرضى حتى يتولى من أرضاه، ويكفر من خالف هواه، فإن جاراه محق، وأغلظ له واعظ، واتفق أن يكون بحضرته أشكاله استغوى أمثاله، فأشعلوها فتنة وأضرموها ناراً.
فليس لمن كانت هذه حاله أن يتحيز مع الخاصة، مع أنه لو حسنت نيته، لم تحتمل فطرته معرفة الفصول، وتمييز الأمور.
فإن قالوا: ولعلهم لا يعرفون الله ورسوله، كما لا يعرفون عدله من جوره، وتشبيهه بخلقه من نفي ذلك عنه. وكما لا يعرفون القرآن وتفسير جمله، وتأويل منزله.
قيل لهم: إن قلوب البالغين مسخرة لمعرفة رب العالمين، ومحمولة على تصديق المرسلين، بالتنبيه على مواضع الأدلة، وقصر النفوس على الروية، ومنعها عن الجولان والتصرف، وكل ما ربث عن التفكير، وشغل عن التحصيل، من وسوسة أو نزاع شهوة؛ لأن الإنسان ما لم يكن معتوهأ أو طفلأ، فمحجوج على ألسنة المرسلين، عند جميع المسلمين. ولا يكون محجوجاً حتى يكون عالماً بما أمر به، عارفاً بما نهي عنه؛ لأن من لم يعلم في أي الضربين سخط الله، وفي أي نوع رضاه، ثم ركب السخط أو أتى الرضا لم يكن ذلك منه إلا على اتفاق. وإنما الاستحقاق مع القصد. والله تبارك يتعالى عن أن يعاقب من لم يرد خلافه، ولم يعرف رضاه. أو يحمد من لم يعتمد رضاه، ولم يقصد إليه.
ولم يكن الله تعالى ليعدل صنعته ويسوي أداته ويفرق بينه وبين المنقوص في بنيته وتركيبه، إلا ليفرق بين حاله وبين الطفل والمعتوه. وليس للمعرفة وجه إلا لتبصيره وتخييره، ولولا ذلك لم يكن للذي خص به من الإبانة وتعديل الصنعة، وإحكام البنية معنىً. والله تعالى عن فعل ما لا معنى له.
وفي قول الله تعالى: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " دليل على ما قلنا. وليس لأحد أن يخرج بعض الجن والإنس من أن يكون خلق للعبادة إلا بحجة، ولا حجة إلا في عقل، أو في كتاب، أو خبر.
فإن قالوا: فإن كان الله إنما أبانهم بالتعديل والتسوية للعبادة والاختيار، فلم قلتم: إنهم غير مأمورين بإقامة الأئمة والاختيار مع الأمة، وحكمهم حكم المسلمين المتعبدين. وإنما الإمام إمام المسلمين المتعبدين قلنا: إنما يلزم الناس الأمر فيما عرفوا سبيله. وليس للعوام - خاصة - معرفة بسبيل إقامة الأئمة فيلزمها، أو يجري عليها أمر أو نهي.
والعامة وإن كانت تعرف جمل الدين بقدر ما معها من العقول، فإنه لم يبلغ من قوة عقولها، وكثرة خواطرها أن ترتفع إلى معرفة العلماء ولم يبلغ من ضعف عقولها أن تنحط إلى طبقة المجانين والأطفال.
وأقدار طبائع العوام والخواص، ليست مجهولة فيحتاج إلى الإخبار عنها بأكثر من التنبيه عليها؛ لأنكم تعلمون أن طبائع الرسل فوق طبائع الخلفاء، وطبائع الخلفاء فوق طبائع الوزراء، وكذلك الناس على منازلهم من الفضل، وطبقاتهم من التركيب، في البخل والسخاء، والبلادة والذكاء، والغدر والوفاء، والجبن والنجدة، والصبر والجزع، والطيش والحلم، والكبر والتيه، والحفظ والنسيان، والعي والبيان.
ولو كانت العامة تعرف من الدين والدنيا ما تعرف الخاصة، كانت العامة خاصة، وذهب التفاضل في المعرفة، والتباين في البنية. ولو لم يخالف بين طبائعهم لسقط الامتحان وبطل الاختيار، ولم يكن في الأرض اختيار، وإنما خولف بينهم في الغريزة ليصبر بها صابر، ويشكر شاكر، وليتفقوا على الطاعة، ولذلك كان الاختلاف، وهو سبب الائتلاف.
فصل من صدر كتاب المسائل والجوابات في المعرفة
بالله نستعين، وعليه نتوكل، وما توفيقنا إلا بالله.
اختلف الناس في المعرفة اختلافاً شديداً، وتباينوا فيها تبايناً مفرطاً. فزعم قوم أن المعارف كلها فعل الفاعلين إلا معرفة لم يتقدمها سبب منهم، ولم يوجبها علة من أفعالهم. ولم يرجعوا إلى معرفة الله ورسوله، والعلم بشرائعه، ولا إلى كل ما فيه الاختلاف والمنازعة، وما لا يعرف حقائقه إلا بالتفكر والمناظرة، دون درك الحواس الخمس.فزعموا أن ذلك أجمع فعلهم، على الأسباب الموجبة، والعلل المتقدمة، وجعلوا مع ذلك سبيل المعرفة بصدق الأخبار، كالعلم بالأمصار القائمة، والأيام الماضية، كبدر وأحد والخندق، وغير ذلك من الوقائع والأيام، وكالعلم بفرغانة والأندلس، والصين والحبشة، وغير ذلك من القرى والأمصار سبيل الاكتساب والاختيار؛ إذ كانوا هم الذين نظروا حتى عرفوا فصل ما بين المجيء الذي لا يكذب مثله، والمجيء الذي يمكن الكذب في مثله.
فزعموا أن جميع المعارف سبيلها سبيل واحد، ووجوه دلائلها وعللها متساوية، إلا ما وجد الحواس بغتة، وورد على النفوس في حال عجز أو غفلة، وكان هو القاهر، للحاسة، والمستولي على القوة، من غير أن يكون من البصر فتح، ومن السمع إصغاء ومن الأنف شم، ومن الفم ذوق ومن البشرة مس، فإن ذلك الوجود فعل الله دون الإنسان، على ما طبع عليه البشر، وركب عليه الخلق.
قالوا: فإذا كان درك الحواس الخمس إذا تقدمته الأسباب، وأوجبته العلل فعل المتقدم فيه والموجب له، ودرك الحواس أصل المعارف، وهو المستشهد على الغائب، والدليل على الخفي، وبقدر صحته تصح المعارف، وبقدر فساده تفسد فالذي تستخرجه الأذهان منه، وتستشهده عليه، كعلم التوحيد، والتعديل والتجوير، وغامض التأويل، وكل ما أظهرته العقول بالبحث، وأدركته النفوس بالفكر من كل علم، وصناعة الحساب والهندسة، والصياغة والفلاحة أجدر أن يكون فعله والمنسوب إلى كسبه.
قالوا: فالدليل على درك الحواس فعل الإنسان على ما وصفنا واشترطنا، من إيجاب الأسباب، وتقدم العلل: أن الفاتح بصره لو لم يفتح لم يدرك. فلما كان البصر قد يوجد مع عدم الإدراك، ولا يعدم الإدراك مع وجود الفتح، كان ذلك دليلاً على أن الإدراك إنما كان لعلة الفتح، ولم يكن لعلة البصر؛ لأنه لو كان لعلة صحة البصر كانت الصحة لا توجد أبداً إلا والإدراك موجود. فإذا كانت الصحة قد توجد مع عدم الإدراك، ولا يعدم الإدراك مع وجود الفتح، كان ذلك شاهداً على أنه إنما كان لعلة الفتح دون صحة البصر.
وقالوا: ولأن طبيعة البصر قد كانت غير عاملة حتى جعلها الفاتح بالفتح عاملة، ولأن الفتح علة الإدراك ومقدمة بين يديه، وتوطئة له. وليس الإدراك علة للفتح ولا مقدمة بين يديه، ولا توطئة له، فواجب أن يكون فعل الفاتح، لأن السبب إذا كان موجباًفالمسبب تبع له.
فصل منه
ثم قالوا بعد الفراغ من درك الحواس في معرفة الله ورسوله وكل ما فيه الاختلاف والتنازع، أن ذلك أجمع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون يحدث من الإنسان لعلة النظر المتقدم، أو يكون يحدث على الابتداء، لا عن علة موجبة وسبب متقدم.فإن كانوا أحدثوه على الابتداء، فلا فعل أولى بالاختيار، ولا أبعد من الاضطرار منه.
وإن كان إنما كان لعلة النظر المتقدم، كما قد دللنا في صدر الكلام على أن درك الحواس فعل الإنسان إذا تقدم في سببه، فالعلم بالله وكتبه ورسله أجدر أن يكون فعله. إذ كان من أجل نظره علم، ومن جهة بحثه أدرك.
فهذه جمل دلائل هؤلاء القوم. ورئيسهم بشر بن المعتمر.
ثم هم بعد ذلك مختلفون في درك الحواس إلا ما اعتمد إدراكه بعينه وقصد إليه بالفتح والإرادة؛ لأن الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد وإرادة ما كان فعل الفاتح. فكيف يجوز أن يكون الإدراك فعله من غير قصد.
ولو جاز أن يكون الفتح فعل الإنسان من غير أن يكون أراده وقصد إليه، ما كان بين فعل الإنسان وبين فعل غيره فرق؛ لأنه كان لا يجوز أن يكون ذهاب الحجر إذا لم يدفعه، ولم يقصد إليه، ولم يخطر له على بال، فعله. فكذلك الإدراك إذا لم يخطر على باله، ولم يقصد إليه، ولم يتعمده، لا يكون فعله.
فصل منه
وليس على المخبر بقصة خصمه والواصف لمذهب غيره، أن يجعل باطلهم حقاً، وفاسدهم صحيحاً، ولكن عليه أن يقول بقدر ما تحتمله النحلة، وتتسع له المقالة، وعليه أن لا يحكي عن خصمه ويخبر عن مخالفه إلا وأدنى منازله ألا يعجز عما بلغوه، ولا يغبى عما أدركوه.فصل منه
وقد زعم آخرون أن المعارف ثمانية أجناس: واحد منها اختيار، وسبعة منها اضطرار. فخمسة منها درك الحواس الخمس، ثم المعرفة بصدق الأخبار، كالعلم بالقرى والأمصار، والسير والآثار، ثم معرفة الإنسان إذا خاطب صاحبه أنه موجه بكلامه إليه، وقاصد به نحوه.وأما الاختيار فكالعلم بالله ورسوله، وتأويل كتبه، والمستنبط من علم الفتيا وأحكامه، وكل ما كان فيه الاختلاف والمنازعة. وكان سبيل علمه النظر والفكرة. ورئيس هؤلاء أبو إسحاق.
وزعم معمر أن العلم عشرة أجناس: خمسة منها درك الحواس، والعلم السادس كالسير الماضية والبلدان القائمة، والسابع: علمك بقصد المخاطب إليك وإرادته إياك، عند المحاورة والمنازعة. وقبل ذلك: وجود الإنسان لنفسه، وكان يجعله أول العلوم، ويقدمه على درك الحواس. وكان يقول: ينبغي أن يقدم وجود الإنسان لنفسه على وجوده لغيره. وكان يجعله علماً خارجاً من درك الحواس؛ لأن الإنسان لو كان أصم لأحس نفسه ولم يحس صوته، ولو كان أخشم لأحس نفسه ولم يحس رائحته. وكذلك سبيل المذاقات والملامس. فلما كان المعنى كذلك وجب أن يفرد من درك الحواس، ويجعل علماً ثامناً على حياله وقائماً بنفسه.
ثم جعل العلم التاسع: علم الإنسان بأنه لا يخلو من أن يكون قديماً أو حديثاً.
وجعل العلم العاشر: علمه بأنه محدث وليس بقديم.
فصل منه
ولست آلو جهداً في الكلام والإيجاز في الإدخال على بشر بن المعتمر في درك الحواس، ثم على أبي إسحاق في ذلك، وفي غيره مما ذكرت من مذاهبه، وتركه قياس ما بنى عليه إن شاء الله، لنصير إلى الكلام في المعرفة، فإني إليه أجريت، وإياه اعتقدت، ولكني أحببت أن أبدي فساد أصولهم قبل فروعهم، فإن ذلك أقتل للداء وأبلغ في الشفاء، وأحسم للعرق، وأقطع للمادة، وأخف في المؤونة على من قرأ الكتاب، وتدبر المسألة والجواب. وبالله ذي المن والطول نستعين.فصل من رده على أبي إسحاق النظام وأصحابه
يقال لهم: حدثونا عن العلم بالله ورسوله وتأويل كتبه، وعن علم القدر وعلم المشيئة، والأسماء والأحكام. أباكتساب هو أم باضطرار فإن زعموا أنه باكتساب قيل لهم: فخبرونا عن علمكم بأن ذلك أجمع اكتساب، أباكتساب هو أم باضطرار فإن قالوا: باكتساب. قيل لهم: أو ليس اعتقاد خلاف ذلك أجمع باكتساب فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فإذا كان اعتقاد الحق واعتقاد الباطل باكتساب أفليس كل واحد من المكتسبين عند نفسه على الصواب فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: أو ليس كل واحد منهما ساكن القلب إلى مذهبه واختياره فإذا قالوا نعم قيل لهم: فما يؤمن المحق من الخطأ وليس سكون القلب وثقته علامة للحق، لأن ذلك لو كان علامة لكان المبطل محقاً، إذ كان قد يجد من السكون والثقة ما لا يجد المحق.وقلنا: وما معنى خلافه إلا أن يكون المبطل شاكاً، أو يكون عارفاً بتقصيره، أو يكون مكترثاً لوهن يجده. فإذا لم يكن كذلك فلا فرق بين المعقودين.
فإن قالوا: إن فرق ما بينهما أن سكون قلب المحق حق في عينه، وسكون قلب المبطل باطل في عينه.
قلنا: أو ليس ذلك غير محول لسكون المبطل عن الثقة إلى الاضطراب ولا مغيره إلى الاكتراث فإذا قالوا ذلك، قيل لهم: فما يؤمن المحق أن يكون سكونه أيضاً باطلاً في عينه إذا كان سكونه لا ينقص عن سكون المبطل. ولئن كان فرق السكون بينهما ظاهر الاجتهاد والعبادة، فمن أظهر اجتهاداً من الرهبان في الصوامع، والخوارج في بذل النفوس فإن قالوا: الفرق بينهما أن المحق قد استشهد الضرورات، والمبطل لم يستشهدها.
قلنا: فهل يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهد الضرورات. حتى لو سأله سائل فقال: ما يؤمنك من الخطأ لقال: استشهادي للضرورات.
فإن زعموا أن المبطل لا يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهد الضرورات، لأن ذلك هو علامة الحق، والفصل بينه وبين الباطل.
قلنا: وهل رأيتم أحداً اكتسب علماً قط، أو نظر في شيء إلا وأول نظره إنما هو على أصل الاضطرار؛ لأن المفكر لا يبلغ من جهله أن يستشهد الخفي، بل من شأن الناس أن يستدلوا بالظاهر على الباطن إذا أرادوا النظر والقياس؛ ثم هم بعد ذلك يخطئون أو يصيبون.