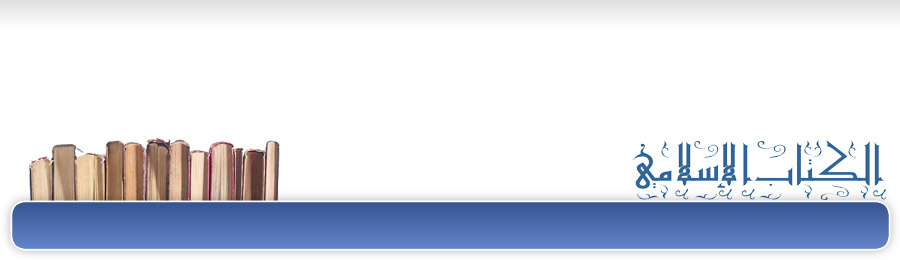كتاب : الرسائل
المؤلف : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ
وقلنا: فينبغي أن يكون كل مبطل في الأرض قد علم حين يقال له: ما يؤمنك أن تكون مبطلا؟ أنه لم يستشهد الضرورات، وأنكر أصله الذي قاس عليه واستنبط منه ضرورة، وأنه إنما قال بالعسف أو بالتقليد. وإذا كانوا كذلك فهل يخلو أمرهم من أن يكونوا قد علموا أنهم على خطاء أو يكونوا شكاكاً، أو يكونوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات، وإن كانوا قد تركوا ذلك عند بعض المقدمات. فإن كانوا قد علموا أنهم لم يستشهدوا الضروريات، وإن كانوا شكاكاً فيها؛ فليس على ظهر الأرض مخطىء إلا وهو عالم بموضع خطائه، أو شاك فيه. أو كانوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات، فما يؤمنكم أن تكونوا كذلك؟ فإن قالوا: ليس أحد يعرف أن علامة الحق استشهاد الضرورات غيرنا.
قلنا: أو لستم معشر أبي إسحاق النظام تختلفون في أمور كثيرة، وقد كنتم تخالفون صاحبكم خلافاً كثيراً، وكلكم إذا سأله سائل: ما يؤمنك أن تكون على باطل؟ قال: لأني مستشهد للضرورات. فهل يخلو أمركم من أحد وجهين: إما أن تكونوا صادقين على أنفسكم، أو كاذبين عليها؟ فإن كنتم صادقين فقد صار قلب المحق كقلب المبطل؛ إذ كان كل واحد عند نفسه مستشهداً للضرورات.
وإن كنتم كاذبين فهل منكم محق إلا وهو يلقى الخصم بمثل دعواه في استشهاد الضرورات؟ وهل منكم واحد على حياله محقاً أو مبطلا إلا وجوابه لنا مثل جواب صاحبه. فإذا كانت القلوب قد تكون عند أنفسها مستشهدة للضرورات، وهي غير مستشهدة لها، وكون القلب كذلك هو علامة الحق، فما الفرق بين قلب المحق والمبطل؟ ومع ذلك إنا وجدنا صاحبكم قبلكم ووجدناكم بعده قد رجعتم عن أقاويل كثيرة، بعد أن كان جوابكم لمن سألكم ما يؤمنكم أن تكونوا على باطل، أن تقولوا: استشهادنا للضرورات. ونحن لو سألناكم عما رجعتم عنه، فقلنا لكم: لعلكم على خطأ، ولعلكم من هذه الأقاويل على غرر، لم يعد جوابكم استشهاد الضرورات.
فصل من هذا الكتاب في الجوابات
ثم إني واصل قولي في المعرفة ومجيب خصمي في معنى الاستطاعة وفي أي أوجهها يحسن التكليف وتثبت الحجة؛ ومع أيها يسمج التكليف وتسقط الحجة.فأول ما أقول في ذلك: أن الله - جل ذكره - لا يكلف أحداً فعل شيء ولا تركه إلا وهو مقطوع العذر، زائل الحجة.
ولن يكون العبد كذلك إلا وهو صحيح البنية، معتدل المزاج، وافر الأسباب، مخلى السرب، عالم بكيفية الفعل، حاضر النوازع، معدل الخواطر، عارف بما عليه وله.
ولن يكون العبد مستطيعاً في الحقيقة دون هذه الخصال المعدودة، والحالات المعروفة، التي عليها مجاري الأفعال، ومن أجلها يكون الاختيار ولها يحسن التكليف، ويجب الفرض، ويجوز العقاب، ويحسن الثواب.
ولو كان الإنسان متى كان صحيحاً كان مستطيعاً، لكان من لا سلم له للصعود مستطيعاً.
ولن يكون أيضاً مع ذلك كله للفعل مختاراً، وله في الحقيقة دون المجاز مستطيعاً، إلا وجميع أوامره في وزن جميع زواجره، حتى إذا ما قابلت بين مرجوهما ومخوفهما، وبين تقديم اللذة وخوف الآخرة، وبين تعجيل المكروه وتأميل العاقبة، وجدتهما في الحدر والرفع، وفي القبض والبسط سواء.
ولا يكون أيضاً كذلك إلا وبقاؤه في الحال الثانية معلوم، لأن الفعل حارس والطباع محروسة، والنفس عليها موقفة. فإن كان الحارس أقوى من طباعها كان ميل النفس معه طباعاً؛ لأن من شأن النفس الميل إلى أقوى الحارسين، وأمتن السببين.
ومتى كانت القوتان متكافئتين كان الفعل اختيارياً، ومن حد الغلبة خارجاً، وإن كانت الغلبة تختلف في اللين والشدة، وبعضها أخفى وبعضها أظهر، كفرار الإنسان من وهج السموم إذا لم يحضره دواعي الصبر، وأسباب المكث. وهو من لهب الحريق أشد نفرة، وأبعد وثبة، وأسرع حركة.
ومتى قويت الطبيعة على العقل أوهنته وغيرته، ومتى توهن وتغير تغيرت المعاني في وهمه، وتمثلت له على غير حقيقتها. ومتى كان كذلك كل عن إدراك ما عليه في العاقبة، وزينت له الشهوات ركوب ما في العاجلة.
ومتى - أيضاً - فضلت قوى عقله على قوى طبائعه أوهنت طبائعه، ومتى كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة، طبعاً لا يمتنع منه، وواجباً لا يستطيع غيره.
وإنما تكون النفس مختارة في الحقيقة، ومجانبة لفعل الطبيعة إذا كانت أخلاطها معتدلة، وأسبابها متساوية، وعللها متكافئة، فإذا عدل الله تركيبه وسوى أسبابه، وعرفه ما عليه وله، كان الإنسان للعقل مستطيعاً في الحقيقة، وكان التكليف لازماً له بالحجة.
ولولا أنك تحتاج إلى التعريف بأن المأمور المنهي لا بد له من التسوية والتعديل لما قال الله تعالى: " والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها " .
ولو جاز أن يعلم موضع غيها ورشدها من غير أن يسويها ويهيئها لكان ذكر التسوية فضلاً من القول. والله يتعالى عن هذا وشبهه علواً كبيراً.
فصل في جواب من يسأل عن المعرفة
باضطرار هي أم باكتساب
قلنا: إن الناس لم يعرفوا الله إلا من قبل الرسل، ولم يعرفون من قبل الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والزيادة والنقصان.على أنا لا نشك أن رجالاً من الموحدين قد عرفوا وجوهاً من الدلالة على الله بعد أن عرفوه من قبل الرسل، فتكلفوا من ذلك ما لا يجب عليهم، وأصابوا من غامض العلم ما لا يقدر عليه عوامهم، من غير أن يكونوا تكلفوا ذلك لشك وجدوه، أو حيرة خافوها؛ لأن أعلام الرسل مقنعة، ودلائلها واضحة، وشواهدها متجلية، وسلطانها قاهر، وبرهانها ظاهر.
فإن قال: أباكتساب علموا صدق الرسل أم باضطرار؟ قلنا: باضطرار.
فإن قالوا: فخبرونا عن من عاين النبي صلى الله عليه وسلم وحجته، والمتنبي وحيلته، كيف يعلم صدق النبي من كذب المتنبي، وهو لم ينظر ولم يفكر؟ فإن قلتم: إنه نظر، وفكر، فقد رجعتم إلى الاكتساب.
وإن قلتم: إنه لم ينظر ولم يفكر فلم عرف الفصل بينهم دون أن يجهله؟ وكيف علم ذلك وهو لا يعرف الحجة من الحيلة؟ وما يؤمنه أن يكون مبطلاً إذا كان لم ينظر في أمور الدنيا، ولم يختبر معانيها حتى يعرف الممتنع من الممكن، وما لا يزال يكون بالاتفاق مما لا يمكن ذلك فيه؟ وكيف ولم يعرف العادة وجرى الطبيعة وإلى أين تبلغ الحيلة وأين تعجز الحيلة، وعند أي ضرب يسقطان، وعلى أي ضرب يقومان؟ ولم عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين عاين شاهده وأبصر أعاجيبه، من غير امتحان لها وتعقب لمعانيها، دون أن يعتقد صدق المتنبي إذا أورد عليه أعاجيبه وخدعه وحيله؟ بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصره على الدنيا من غير فكرة فيها وتقليب لأمرها.
والدنيا بأسرها دلالة عما عرف صدق النبي حين أبصر دلالته من غير تفكير فيها أو تقليب لأمرها.
وقد علمنا أن الدنيا دالة على أن شواهد النبي دالة، ومتى كان ظاهر أحدهما يغني عن التفكير كان الآخر مثله، إذ لم يكن في القياس بينهما فرق، ولا في المعقول فضل.
قلنا: إن تجارب البالغ قبل أن يهجم على دلالات الرسل تأتي على جميع ذلك. ولعمري أن لو كان هجومه عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف الدهور وعلاقات الدنيا، والتجربة لتصريف أمورها، لما وصل إلى معرفة صدق النبي إلا بعد مقدمات كثيرة، وترتيبات منزلة؛ لأن مشاهد الشواهد إنما تضطره المشاهدة لها إذا كان قد جرب الدنيا، وعرف تصرفها وعادتها قبل ذلك.
ولو لم يكن جربها قبل ذلك حين عرف منتهى قوة بطش الإنسان وحيلته، وعرف الممكن من الممتنع، وما يمكن قوله بالاتفاق مما لا يمكن، لما عرف ذلك.
فإن قالوا: وكيف جرب ذلك وعقله، وأتقنه وحفظه، وهو طفل غرير وحدث صغير؛ لأن غير البالغ طفل إلى أن يبلغ، وحين يبلغ فقد هجم على النبي صلى الله عليه وسلم وشواهده، أو هجم عليه النبي بشواهده، إما بخبر مقنع أو بعيان شاف. ففي أية الحالين جرب وعرف، وميز وحفظ، في حال الطفولة والغرارة؟ وهذا غير معروف في التجربة والعادة، والذي عليه ركبت الطبيعة.
أما في حال البلوغ والتمام فحال البلوغ هي الحال التي أبلغه الله الرسالة، وقاده إلى رؤية الحجة، واستماع البرهان ومخرج الرسالة.
فإذا كان الأمر، كما تقولون فقد كان ينبغي أن لا يصل إلى العلم بصدق النبي وقد أراه برهانه، وأسمعه حججه، حتى يمكث بعد ذلك دهراً يمتحن الدنيا ويتعقب أمورها، ويعمل التجربة فيها. فإن كان ذلك كذلك فلم سميتموه بالغاً، وليس في طاقته بعد العلم يفصل ما بين النبي والمتنبي؟ قلنا: إن التجربة على ضربين: أحدهما: أن يقصد الرجل إلى امتحان شيء ليعرف مخبره عما عرف منظره.
والآخر: أن يهجم على علم ذلك من غير قصد.
وقد يسمى الإنسان مجرباً، قاصداً أو هاجماً، فيزعم أن البالغ قد سقط من بطن أمه إلى أن يبلغ، مقلباً في الأمور المختلفة، ومصرفاً في خلال الحالات، بالمعرفة التي تلقحه الدنيا، بما تورد عليه من عجائبها، ويزداد في كل ساعة معرفة، وتفيده الأيام في كل يوم تجربة، كما يزداد لسانه قوة، وعظمه صلابة، ولحمه شدة، من أم تناغيه، وظئر تلهيه، وطفل يلاعبه، وطبيب يعالجه، ونفس تدعوه، وطبيعة تعينه، وشهوة تبعثه، ووجع يقلقه، كما يزيده الزمان في قوته، ويشد من عظمه ولحمه، ويزيده الغذاء عظما، وكثرة الغضب والتقليب جلدا. فإذا درج وحبا، وضحك وبكى، وأمكنه أن يكسر إناءً أو يكفئه، أو يسود ثوباً، أو يضرب دابرة الخادم، وانتهره القيم. فلا يزال ذلك دأبه ودأبهم حتى يفهم الإغراء والزجر، والتغذية والانتهار، كما يعرف الكلب اسمه إذا ألح الكلاب عليه به. وكما يعرف المجنون لقبه، وكما يحضر الفرس من وقع السوط من كثرة وقعه بعد رفعه عليه.
؟؟
فصل منه في هذا المعنى
فإذا استحكمت هذه الأمور في قلبه، وثبتت في خلده وصحت في معرفته، فهو حينئذ بالغ محتمل. وعند ذلك يسخر الله سمعه للخبر المثلج، أو بصره لمعاينة الشاهد المقنع، على يدي الرسول الصادق، ولا يتركه هملا، ولا يدعه غفلا، وقد عدل طبعه وأحكم صنعه، ووفر أسبابه، فلا يحتاج عند معاينته رسولاً يحيي الموتى، ويبرىء الأكمه والأبرص، ويفلق البحر، إلى تفكير، ولا تمييل ولا امتحان ولا تجربة، لأنه قد فرغ من ذلك أجمع، واستحكم عنده العلم الذي أدب به، وهيئ له وأورد عليه.فإن كان لم يكن لذلك عامداً، ولا إليه قاصداً ولا به معنياً، وإنما هو عبد عبأه سيده، ورشحه مولاه، وهيأه خالقه لأمر لا يشعر به من مصلحته، ولا يخطر على باله من الصنع له حين غذاه به، وقاده إليه، وهيأه له.
فإذا أورد عليه دعوى رسول، وأمته تشهد له بإحياء الموتى وفلق البحر، وبكل شيء قد عرف عجز البشر عن فعله والقوة عليه، علم بتجاربه المتقدمة بعادة الدنيا، أن ذلك ليس من صنع البشر، وأن مثله لا يقع اتفاقاً، وأن الحيل لا تبلغه، فلا يمتنع مع رؤية البرهان وفهم الدعوى، أن يعلم أن الرسول صادق، وأن الراد عليه كاذب.
فصل منه
ولولا أن هذا كلام لم يكن من ذكره بد، لأنه تأسيس لما بعده، ومقدمة لما بين يديه، وتوطئة له، لاقتضبت الكلام في المعرفة اقتضابا، ولكن يمنعني عجز أكثر الناس عن فهم غايتي فيه إلا بنزيله وترتيبه.وكل كلام أتيت على فرعه، ولم تخبر عن أصله فهو خداع لا غناء عنده، وواهن لا ثبات له.
فصل من صدر كتابه في المعاد والمعاش
أما بعد فإن جماعات أهل الحكمة قالوا: واجب على كل حكيم أن يحسن الارتياد لموضع البغية، وأن يتبين أسباب الأمور، ويمهد لعواقبها.فإنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمور، واستشفاقهم بعقولهم ما تجيء به العواقب، فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات في استدبارها. وبقدر تفاوتهم في ذلك تستبين فضائلهم.
فأما معرفة الأمور عند تكشفها، وما يظهر من خفياتها. فذلك أمر يعتدل فيه الفاضل والمفضول، والعالم والجاهل.
وإني قد عرفتك - أكرمك الله - في أيام الحداثة، وحيث سلطان الهوى المخلط للأعراض أغلب على نظرائك، وسكر الشباب والجدة المتحيفين للدين والمروءة مستول على لداتك، ففقتهم ببسطة المقدرة، وحميا الحداثة، وفضل الجدة، مع ما تقدمتهم به من الوسامة في الصورة، والجمال في الهيئة.
وهذه أسباب تكاد أن توجب الانقياد للهوى، وتلجج في المهالك ولا يسلم معها إلا المنقطع القرين في صحة الفطرة، وكمال العقل.
فاستعبدتهم الشهوات حتى أعطوها أزمة أديانهم، وسلطوها على مروءاتهم وأباحوها أعراضهم، فآلت بأكثرهم الحال إلى ذل العدم، وفقد عز الغني في العاجل، مع الندامة الطويلة والحسرة في الآجل.
وخرجت نسيج وحدك أوحدياً في نفسك، حكمت وكيل الله عندك - وهو عقلك - على هواك، وألقيت إليه أزمة أمرك، فسلك بك طريق السلامة، وأسلمك إلى العاقبة المحمودة، وبلغ بك من نيل اللذات أكثر مما بلغوا، ونال بك من الشهوات أكثر مما نالوا، وصرفك من صنوف النعم في أكثر مما تصرفوا، وربط عليك من نعم الله التي خولك ما أطلقه من أيديهم إيثار اللهو، وتسليطهم الهوى على أنفسهم فخاض بك تلك اللجج، واستنقذك من تلك المعاطب، فأخرجك سليم الدين، وافر المروءة، نقي العرض، كثير الشراء، بين الجدة. وذلك سبيل من كان ميله إلى الله أكثر من ميله إلى هواه.
فلم أزل في أحوالك كلها تلك بفضيلتك عارفاً، ولك بنعم الله عندك غابطاً، أرى ظواهر أمرك المحمودة تدعوني إلى الانقطاع إليك، وأسأل عن بواطن أحوالك فيزيدني رغبة في الاتصال بك، ارتياداً مني لموضع الخيرة في الأخوة، والتماساً لإصابة الاصطفاء في المودة، وتخيراً لمستودع الرجاء في النائبة.
فلما محصتك الخبرة، وكشف الابتلاء عن المحمدة، وقضت لك التجارب بالتقدمة، وشهدت لك قلوب العامة بالقبول والمحبة، وقطع الله عذر من كان يطلب الاتصال بك، طلبت الوسيلة إليك والاتصال بحبلك، ومتت بحرمة الأدب وذمام كرمك.
وكان من نعمة الله عندي أن جعل أبا عبد الله - حفظه الله - وسيلتي إليك، فوجدت المطلب سهلاً، والمراد محموداً، وأفضيت إلى ما يجوز الأمنية ويفوت الأمل. فوصلت إخاي بمودتك، وخلطتني بنفسك، وأسمتني في مراعي ذوي الخاصة بك تفضلا لا مجازاة، وتطولاً لا مكافاة، فأمنت الخطوب، واعتليت على الزمان، واتخذتك للأحداث عدة، ومن نوائب الدهر حصناً منيعاً.
فلما جرت المؤانسة، وتقلبت من فضلك في صنوف النعمة، وزاد تصرفي في مواهبك في السرور والحبرة، أردت خبرة المشاهدة فبلوت أخلاقك، وامتحنت شيمك، وعجمت مذاهبك، على حين غفلاتك، وفي الأوقات التي يقل فيها تحفظك، أراعي حركاتك، وأراقب مخارج أمرك ونهيك، فأرى من استصغارك لعظيم النعمة التي تنعم بها، واستكثارك لقليل الشكر من شاكريك، ما أعرف به وبما قد بلوت من غيرك وما قد شهدت لي به عليك التجارب، أن ذلك منك طبع غير تكلف.
هيهات ما يكاد ذو التكلف أن يخفى على أهل الغباوة، فكيف على مثلي من المتصفحين؟
فصل منه
ولم أزل - أبقاك الله - بالموضع الذي عرفت من جمع الكتب ودراستها والنظر فيها. ومعلوم أن طول دراستها إنما هو تصفح عقول العالمين، والعلم بأخلاق النبيين - صلوات الله تعالى عليهم أجمعين - وذوي الحكمة من الماضين والباقين من جميع الأمم، وكتب أهل الملل.فرأيت أن أجمع لك كتاباً من الأدب، جامعاً لعلم كثير من أمر المعاد والمعاش، أصف لك فيه علل الأشياء، وأخبرك بأسبابها، وما اتفقت عليه محاسن الأمم. وعلمت أن ذلك من أعظم ما أبرك به، وأرجح ما أتقرب به إليك.
وكان الذي حداني إلى ذلك ما رأيت الله تعالى قسم لك من العقل والفهم، وركب فيك من الطبع الكريم.
وقد اجتمعت الحكماء على أن العقل المطبوع والكرم الغريزي، لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل المكتسب، ومثلوا ذلك بالنار والحطب، والمصباح والدهن، وذلك أن العقل الغريزي آلة والمكتسب مادة، وإنما الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك.
ورأيت كثيراً من واضعي الأدب قبلي، قد عهدوا إلى الغابرين بعدهم في الآداب عهوداً قاربوا فيها الحق، وأحسنوا فيها الدلالة. إلا أني رأيت أكثر ما رسموا من ذلك فروعاً لم يبينوا عللها، وصفات حسنة لم يكشفوا أسبابها، وأموراً محمودة لم يدلوا على أصولها.
فإن كان ما فعلوا من ذلك روايات رووها عن أسلافهم، ووراثات ورثوها عن أكابرهم فقد قاموا بأداء الأمانة، ولم يبلغوا فضيلة من طب لمن استطب، وإن كانوا تركوا الدلالة على علل الأمور، التي بمعرفة عللها يوصل إلى مباشرة اليقين فيها، وينتهى إلى غاية الاستبصار منها، فلم يعدوا في ذلك منزلة الظن بها.
ولم تجد وصايا أنبياء الله تعالى أبداً إلا مبينة بالأسباب، مكشوفة العلل، مضروبة معها الأمثال.
فصل منه
ولن أدع من تلك المواضع الخفية موضعاً إلا أقمت لك بها بإزاء كل شبهة منه دليلاً، ومع كل خفي من الحق حجة ظاهرة، تستنبط بها غوامض البرهان، وتستثير بها دفائن الصواب، وتستشف بها سرائر القلوب، فتأتي بما تأتي عن بينة، وتدع ما تدع عن خبرة، ولا يكون بك وحشة إلى معرفة كثير ما يغيب عنك إذا عرفت العلل والأسباب، حتى كأنك مشاهد لضمير كل امرىء لمعرفتك بطبعه وما ركب عليه.
فصل منه
اعلم أنك إذا أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك إلى الاختلاط، وإن آثرت الهوينى، واتكلت على الكفاية في الأمر الذي لا يجوز فيه إلا نظرك، وزجيت أمرك على رأي مدخول، وأصل غير محكم، رجع ذلك عليك بما لو حكم فيه عدوك كان ذلك غاية أمنيته وشفاء غيظه.واعلم أن إجراءك الأمور مجاريها، واستعمالك الأشياء على وجوهها، يجمع لك ألفة القلوب، فيعاملك كل من عاملك بمودة، وأخذ وإعطاء، وهو على ثقة من بصرك بمواضع الإنصاف، وعلمك بموارد الأمور.
فصل منه
فإن ابتليت في بعض الأوقات بمن يتقرب بحرمة، ويمت بدالة، يطلب المكافأة بأكثر مما يستوجب، فدعاك الكرم والحياء إلى تفضيله على من هو أحق به، إما خوفاً من لسانه، أو مداراة لغيره، فلا تدع الاعتذار إلى من هو فوقه من أهل البلاء والنصيحة وإظهار ما أردت من ذلك لهم؛ فإن أهل خاصتك والمؤتمنين على أسرارك، هم شركاؤك في العيش، فلا تستهينن بشيء من أمورهم، فإن الرجل قد يترك الشيء من ذلك اتكالاً على حسن رأي أخيه، فلا يزال ذلك يجرح في القلب وينمو، حتى يولد ضغناً ويحول عداوة.فتحفظ من هذا الباب، واحمل إخوانك عليه بجهدك.
وستجد من يتصل بك ممن يغلبه إفراط الحرص، وحميا الشره، ولين جانبك له، على أن ينقم العافية، ويطلب اللحوق بمنازل من ليس مثله، ولا له مثل دالته، فتلقاه لما تصنع به مستقلاً. ولمعروفك مستصغرا.
وصلاح من كانت هذه حاله بخلاف ما فسد عليه أمره.
فاعرف طرائفهم وشيمهم، وداو كل من لا بد لك من معاشرته، بالدواء الذي هو أنجع فيه، إن ليناً فليناً، وإن شدة فشدة، فقد قيل في مثل:
من لا يؤدبه الجمي ... ل ففي عقوبته صلاحه
فصل منه
واعلم أن المقادير ربما جرت بخلاف ما تقدر الحكماء، فينال بها الجاهل في نفسه، المختلط في تدبيره، ما لا ينال الحازم الأريب الحذر، فلا يدعونك ما ترى من ذلك إلى التضييع والاتكال على مثل تلك الحال؛ فإن الحكماء قد اجتمعت على أن من أخذ بالحزم وقدم الحذر، فجاءت المقادير خلاف ما قدر، كان عندهم أحمد رأياً، وأوجب عذراً ممن عمل بالتفريط، وإن اتفقت له الأمور على ما أراد.ولا تكونن بشيء مما في يدك أشد ضناً، ولا عليه أشد حدباً منك بالأخ الذي قد بلوته بالسراء والضراء فعرفت مذاهبه، وخبرت شيمه، وصح لك غيبه، وسلمت لك ناحيته، فإنه شقيق روحك، وباب الروح إلى حياتك، ومستمد رأيك وتوأم عقلك.
ولست منتفعاً بعيش مع الوحدة، ولا بد من المؤانسة.
وكثرة الاستبدال يهجم بصاحبه على المكروه.
فإن صفا لك أخ فكن به أشد ضناً منك بنفائس أموالك، ثم لا يزهدنك فيه أن ترى خلقاً أو خلقين تكرههما، فإن نفسك التي هي أخص النفوس بك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف بنفس غيرك.
وبحسبك أن يكون لك من أخيك أكثره. وقد قالت الحكماء: " من لك بأخيك كله " . و: " أي الرجال المهذب " .
فصل منه
واعلم أنك موسوم بسيما من قارنت، ومنسوب إليك أفاعيل من صاحبت. فتحرز من دخلاء السوء، وأظهر مجانبة أهل الريب، وقد جرت لك في ذلك الأمثال، وسطرت فيه الأقاويل، فقالوا: " المرء حيث يجعل نفسه " .وقالوا: " يظن بالمرء ما يظن بقرينه " .
وقالوا: " المرء بشكله " ، و " المرء بأليفه " .
ولن تقدر أن تتحرز من الناس، ولكن أقل المؤانسة إلا بأهل البراءة من كل دنس.
واعلم أن المرء بقدر ما يسبق إليه يعرف، وبالمستفيض من أفعاله يوصف. فإن كان بين ذلك كثير من أخلاقه ألغاه الناس، وحكموا عليه بالغالب من أمره.
فاجهد أن يكون أغلب الأشياء على أفعالك كل ما يحمده العوام ولا تذمه الجماعات، فإن ذلك يعفي على كل خلل إن كان.
فبادر ألسنة الناس واشغلها بمحاسنك، فإنهم إلى كل سيىء سراع، واستظهر على من دونك بالتفضل، وعلى نظائرك بالإنصاف، وعلى كل من فوقك بالإجلال، تأخذ بوثائق الأمور وبأزمة التدبير.
فصل من صدر رسالته إلى محمد بن عبد الملك
في الجد والهزل
جعلت فداك، ليس من اختياري، النخل على الزرع. أقصيتني، ولا على ميلي إلى الصدقة دون إعطاء الخراج عاقبتني، ولا لبغض دفع الإتاوة والرضا بالجزية حرمتني. ولست أدري لم كرهت قربي، وهويت بعدي، واستثقلت روحي ونفسي، واستطلت عمري وأيام مقامي؟ ولم سرتك سيئتي ومصيبتي، وساءتك حسنتي وسلامتي؟ نعم، حتى ساءك عزائي وتجملي، بقدر ما سرك جزعي وتضجري، وحتى تمنيت أن أخطىء عليك، فتجعل خطائي حجة لك في إبعادي، وكرهت صوابي فيك خوفاً من أن تجعله ذريعة إلى تقريبي.فإن كان ذلك هو الذي أغضبك، وكان هو السبب لموجدتك، فليس - أبقاك الله - هذا الحقد في طبقة هذا الذنب، ولا هذه المطالبة من شكل هذه الجريمة.
فصل منه
فأي شيء أبقيت للعدو المكاشف، وللموافق الملاطف، وللمعتمد المصر، وللقادر المدل؟ ومن عاقب على الصغير بعقوبة الكبير، وعلى الهفوة بعقوبة الإصرار، وعلى الخطأ بعقوبة العمد، وعلى معصية المتستر بعقوبة المعلن. ومن لم يفرق بين الأعالي والأسافل، وبين الأقاصي والأداني، عاقب على الزنى بعقوبة السرقة، وعلى القتل بعقوبة القذف. ومن خرج إلى ذاك في باب العقاب، خرج إلى مثله في باب الثواب.ومن خرج من جميع الأوزان، وخالف جميع التعديل كان بغاية العقاب أحق، وبه أولى.
والدليل على شدة غيظك وغليان صدرك، قوة حركتك، وإبطاء فترتك، وبعد الغاية في احتيالك.
ومن البرهان على بيان الغضب وعلى عظم الذنب، تمكن الحقد ورسوخ الغيظ، وبعد الوثبة وشدة الصولة. وهذا البرهان صحيح ما صح النظم، وقام التعديل، واستوت الأسباب.
ولا أعلم ناراً أبلغ في إحراق أهلها من نار الغيظ، ولا حركة أنقض لقوى الأبدان من طلب الطوائل، مع قلة الهدوء، والجهل بمنافع الجمام، وإعطاء الحالات أقسامها من التدبير.
ولا أعلم تجارة أكثر خسراناً ولا أخف ميزاناً، من عداوة العاقل العالم، وإطلاق لسان الجليس والمداخل، والشعار دون الدثار، والخاص دون العام.
والطالب - أبقاك الله - بعرض ظفر ما لم يخرج المطلوب، وإليه الخيار ما لم تقع المنازلة.
ومن الحزم ألا تخرج إلى العدو إلا ومعك من القوى ما يغمر الفضلة التي يتيحها له الإخراج، ولا بد - أيضاً - من حزم يحذرك مصارع البغي، ويخوفك ناصر المطلوب.
فصل منها
والله لقد كنت أكره لك سرف الرضا، مخافة جواذبه إلى سرف الهوى، فما ظنك بسرف الغضب. وبغلبة الغيظ، ولا سيما ممن تعود إهمال النفس ولم يعودها الصبر، ولم يعرفها موضع الحظ في تجرع مرارة العفو. وإنما المراد من الأمور عواقبها لا عواجلها.وقد كنت أشفق عليك من إفراط السرور، فما ظنك بإفراط الغيظ. وقد قال الناس: " لا خير في طول الراحة إذا كان يورث الغفلة، ولا في طول الكفاية إذا كان يؤدي إلى المعجزة. ولا في كثرة الغنى إذا كان يخرج إلى البلدة " .
جعلت فداك إن داء الحزن، وإن كان قاتلا، فإنه داء مماطل، وسقمه سقم مطاول، ومعه من التمهل بقدر قسطه من أناة المرة السوداء. وداء الغيظ سفيه طياش، وعجول فحاش، يعجل عن التوبة، ويقطع دون الوصية.
فصل منها
وربت كلمة لا توضع إلا على معناها الذي جعلت حظه وصارت هي حقه، والدالة عليه دون غيره، كالعزم والعلم، والحلم والرفق؛ والأناة والمداراة، والقصد والعدل، وكالانتهاز والاهتبال، وكاليأس والأمل، وكالخرق والعجلة، والمداهنة والتسرع، والغلو والتقصير.ورب كلمة تدور مع واصلتها، وتتقلب مع جارتها، وإزاء صاحبتها، وعلى قدر ما تقابل من الحالات وتلاقي من الأسباب، كالحب والبغض، والغضب والرضا، والعزم والإرادة، والإقبال والإدبار، والجد والفتور. لأن كل هذا الباب الأخير يكون في الخير والشر، ويكون محموداً ويكون مذموماً.
وصاحب العجلة - أبقاك الله - صاحب لتغرير ومخاطرة، إن ظفر لم يحمده عاقل، وإن لم يظفر قطعته الملاوم. والريث أخو المعجزة، ومقرون بالحسرة، وعلى مدرجة اللائمة.
وصاحب الأناة، إن ظفر نفع غيره بالغنم، ونفع نفسه بثمرة العلم، وطاب ذكره ودام شكره، وحفظ فيه ولده. وإن حرم فمبسوط عذره ومصوب رأيه مع انتفاعه بعلمه، وما يجد من عز حزمه، ونبل صوابه.
فصل منها
ومن كانت طبيعته مأمونة عليه عند نفسه، وكان هواه رائده الذي لا يكذبه، والمتأمر عليه دون عقله، ولم يتوكل لما لا يهواه على ما يهوى، ولم ينصر تالد الإخوان على الطارف، ولم ينصف الملول المبعد من المستطرف المقرب، ولم يخف أن تجتذبه العادة وتتحكم عليه الطبيعة فليرسم حججهما ويصور صورهما في كتاب مقروء أو لفظ مسموع، ثم يعرضهما على جهابذة المعاني وأطباء أدواء العقول. على أن لا يختار إلا من لا يدري أي النوعين يتقي، وأيهما يحامي، وأيهما داؤه، وأيهما دواؤه. فإن لم يستعمل ذلك لم يزل متورطاً في الخطاء مغموراً بالذنب.
سمعتك وأنت تريدني وكأنك تريد غيري، أو كأنك تشير علي من غير أن تنصني، وتقول: إني لأعجب ممن ترك دفاتر علمه متفرقة، وكراريس درسه غير مجموعة ولا منظومة، كيف يعرضها للتخرم، وكيف لا يمنعها من التخرق؟ ! وعلى أن الدفتر إذا انقطعت حزامته وانحل شداده، وتخرمت ربطه، ولم تكن دونه وقاية، ولا دونه جنة، تفرق ورقه، واشتد جمعه، وعسر نظمه، وامتنع تأليفه، وضاع أكثره.
والدفتان أجمع، وضم الجلود لها أصون والحزم لها أصلح.
وينبغي للأشكال أن تنظم، والأشباه أن تؤلف؛ فإن التأليف يزيد الأجزاء الحسنة حسناً، والاجتماع يحدث للمتساوي في الضعف قوة.
فصل منها
أنت - أبقاك الله - شاعر وأنا راوية، وأنت طويل وأنا قصير، وأنت أصلع وأنا أنزع، وأنت صاحب براذين وأنا صاحب حمير، وأنت ركين وأنا عجول. وأنت تدبر نفسك وتقيم أود غيرك، وتتسع لجميع الرعية، وتبلغ بتدبيرك أقصى الأمة. وأنا أعجز عن تدبيري وعن تدبير أمتي وعبدي. وأنت منعم وأنا شاكر، وأنت ملك وأنا سوقة. وأنت مصطنع وأنا صنيعة، وأنت تفعل وأنا أصف. وأنت متقدم وأنا تابع، وأنت إذا نازعت الرجال وناهضت الأكفاء لم تقل بعد فراغك وانقطاع كلامك: لو كنت قلت كذا لكان أجود، ولو تركت قول كذا كان أحسن. وأمضيت الأمور على حقائقها، وسلمت إليها أقساطها، على مقادير حقوقها، فلم تندم بعد قول، ولم تأسف بعد سكوت. وأنا إن تكلمت ندمت، وإن جاريت أبدعت.فصل منها
وقد منحتك جلد شبابي كملاً؛ وغرب نشاطي مقتبلا، فكان لك مهناه، وثمرة قواه، واحتملت دونك عرامه وغربه، فكان لك غنمه وعلي غرمه.وأعطيتك عند إدبار بدني قوة رأيي، وعند تكامل معرفتي نتيجة تجربتي، واحتملت دونك وهن الكبر وإسقام الهرم.
وخير شركائك من أعطاك ما صفا وأخذ لنفسه ما كدر. وأفضل خلطائك من كفاك مؤونته وأحضرك معونته، وكان كلاله عليه ونشاطه لك.
وأكرم دخلائك وأشكر مواليك من لا يظن أنك تسمي جزيل ما تحتمل في بذلك ومؤانستك مؤونة، ولا تتابع إحسانك إليه نعمة. بل يرى أن نعمة الشاكر فوق نعمة الواهب، ونعمة الواد المخلص، فوق نعمة الجواد المغني.
فصل من صدر كتابه في الوكلاء
وفقك الله للطاعة، وعصمك من الشبهة، وأفلجك بالحجة، وختم لك بالسعادة.غبرت - أصلحك الله - أزمان وأنت عندي ممن لا يمضي القول إلا بعد التثبت، ولا يخرج الكتاب إلا بعد التصفح، وكنت حرياً بتهيئة الرأي الفطير، جديراً أن تميل بنفسك عاقبة التفريط. ولولا كثرة مرور أيام المطالبة عليك لما ثقل عليك التثبت، ولولا قصر أيام التحصيل لما وثقت بأول خاطر، ولولا سوء العادة لما كذبك رائد النظر واتهمت الرأي.
واعترام الغضبان يهور الأعمار، فإن الغضبان أسوأ أثراً على نفسه من السكران، ولولا أن نار الغضب تخبو قبل إفاقة المعتوه، وضباب السكر ينكشف قبل انكشاف غروب عقل المدله، وأن حكم الظاعن خلاف حكم المقيم، وقضية المجتاز خلاف قضية الماكث، لكانت حال الغضبان أسوأ مغبة، وجهله أوبى، على أن الحكم له ألزم والناس له ألوم.
وما أكثر ما يقحم الغضب المقاحم التي لا يبلغها جناية الجنون، وفرط جهل المصروع.
فصل منه
وإن الغمر لا يكون إلا عديم الآلة، منقطع المادة، يرى الغي رشدأً والغلو قصداً. فلو كنت إذا جنيت لم تقم على الجناية، وإذا عزمت على القول لم تخلده في الكتب، وإذا خلدته لم تظهر التبجح به، والاستبصار فيه، كان علاج ذلك أيسر، وكانت أيام سقمك أقصر.فأخزى الله التصميم إلا مع الحزم، والاعتزام إلا بعد التثبت والعلم إلا مع القريحة المحمودة، والنظر إلا مع استقصاء الروية.
وأخلق بمن كان في صفتك، وأحر بمن جرى على دربك، ألا يكون سبب تسرعه، وعلة تشحنه إلا من ضيق الصدر.
وجميع الخير راجع إلى سعة الصدر. فقد صح الآن أن سعة الصدر أصل، وما سوى ذلك من أصناف الخير فرع.
وقد رأيتك - حفظك الله - خونت جميع الوكلاء وفجرتهم، وشنعت على جميع الوراقين وظلمتهم، وجمعت جميع المعلمين وهجوتهم، وحفظت مساويهم، وتناسيت محاسنهم، واقتصرت على ذكر مثالب الأعلام والجلة، حتى صوب نفسك عند السامع لكلامك، والقارىء كتابك، أنك ممن ينكر الحق جهلا، أو يتركه معاندة له. وقد علم الناس أن من تركه جهلاً به أصغر إثماً ممن تركه عمداً.
ولعمري إن العلم لطوع يديك، والمتصرف مع خواطرك، والمستملي من بديهتك، كما يستملي من ثمرة فكرك، والمحصل من رويتك. ولكن الرأي لك أن لا تثق بما يرسمه العلم في الخلا، وتتوقاه في الملا.
اعلم أنك متى تفردت بعلمك استرسلت إليه. ومتى ائتمنت على نفسك نواجم خطرك، فقد أمكنت العدو من ربقة عنقك. وبنية الطبائع وتركيب النفوس، والذي جرت عليه العادة، إهمال النفس في الخلا، واعتقالها في الملا.
فتوقف عند العادة، واتهم النفس عند الاسترسال والثقة. قال ابن هرمة:
إن الحديث تغر القوم خلوته ... حتى يكون له عي وإكثار
وبئس الشيء العجب، وحسن الظن بالبديهة! واعلم أن هذه الحال التي ارتضيتها لشأنك هي أمنية العدو، وتهزة الخصم، ومتى أبرزت كتابك على هذه الصورة وأفرغته هذا الإفراغ، ثم سبكته هذا السبك، فليس بعدوك حاجة إلى التكذيب عليك، وقول الزور فيك، لأنك قد مكنته من عرضك، وحكمته في نفسك.
وبعد، فمن يعجز عن عيب كتاب لم يحرس بالتثبت، ولم يحصن بالتصفح، ولم يغب بالمعاودة والنظر، ولم يقلب فيه الطرف من جهة الإشفاق والحذر. فكيف يوفق الله الواثق بنفسه، والمستبد برأيه لأدب ربه، ولما وصى به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال لرجل خاصم عنده رجلا فقال في بعض كلامه: حسبي الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبل الله من نفسك عذراً، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله " وزعمت في أول تشنيعك عليهم، فقلت: قال يعقوب بن عبيد لبعض ولده حين قال له في مرضه: أي شيء تشتهي؟ قال: كبد وكيل.
وقد كان ترك التجارة من سوء معاملتهم وفحش خبائثهم.
فصل من جوابه عن الوكلاء
قد فهمنا عذرك وسمعنا قولك، فاسمع الآن ما نقول: اعلم أن الوكيل، والأجير، والأمين، والوصي، في جملة الأمر، يجرون مجرىً واحداً. فأيش لك أن تقضي على الجميع بإساءة البعض. ولو بهرجنا جميع الوكلاء وخونا جميع الأمناء، واتهمنا جميع الأوصياء وأسقطناهم، ومنعنا الناس الارتفاق بهم، لظهرت الخلة وشاعت المعجزة، وبطلت العقد وفسدت المستغلات، واضطربت التجارات، وعادت النعمة بلية والمعونة حرماناً، والأمر مهملاً، والعهد مريجاً.ولو أن التجار وأهل الجهاز صاحبوا الجمالين والمكارين والملاحين، حتى يعاينوا ما نزل بأموالهم في تلك الطرق والمياه، والمسالك والخانات، لكان عسى أن يترك أكثرهم الجهاز.
فصل منه
وقد قال الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " ، وقال: " فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم " وقال: " ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف " .وقال يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لفرعون وفرعون كافر: " اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " .
وقالت بنت شعيب في موسى بن عمران: " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " : فجمع جميع ما يحتاج إليه في الكلمتين.
وفي قياسك هذا إسقاط جميع ما أدبنا الله به، وجعله رباطاً لمراشدنا في ديننا، ونظاماً لمصالحنا في دنيانا.
والذي يلزمني لك أن لا أعمهم بالبراءة، والذي يلزمك أن لا تعمهم بالتهمة، وأن تعلم أن نفعهم عام، وخيرهم خاص.
وقالوا: مثل الإمام الجائر مثل المطر، فإنه يهدم على الضعيف، ويمنع المسافر.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " حوالينا ولا علينا " .
والمطر وإن أفسد بعض الثمار، وأضر ببعض الأكرة فإن نفعه غامر لضرره.
وليس شيء من الدنيا يكون نفعه محضاً، وشره صرفا. وكذلك الإمام الجائر، وإن استأثر ببعض الفيء، وعطل بعض الحكم، فإن مضاره مغمورة بمنافعه.
قالوا: وكذلك أمر الوكلاء والأوصياء والأمناء، لا تعلم قوماً الشر فيهم أعم ولا الغش فيهم أكثر من الأكرة، وما يجوز لنا مع هذا أن نعمهم بالحكم مع أن الحاجة إليهم شديدة، ونزع هذه العادة وهذا الخلق منهم أشد.
فصل منه
وأنا أظن أن الذنب مقسوم بينك وبين وكلائك. فارجع إلى نفسك فلعلك أن ترى أنك إنما أتيت من قبل الفراسة، أو من قبل أنك لم تقطع لهم الأجرة السنية، وحملتهم على غاية المشقة في أداء الأمانة وتمام النصيحة.فصل منه
ولا بد في باب البصر بجواهر الرجال من صدق الحس، ومن صحة الفراسة، ومن الاستدلال في البعض على الكل، كما استدلت بنت شعيب - صلوات الله عليه - حين قضت لموسى عليه السلام بالأمانة والقوة، وهما الركنان اللذان تبنى عليهما الوكالة.فصل منه
وقد قالوا: ليس مما يستعمل الناس كلمة أضر بالعلم والعلماء، ولا أضر بالخاصة والعامة، من قولهم: " ما ترك الأول للآخر شيئاً " .ولو استعمل الناس معنى هذا الكلام فتركوا جميع التكلف، ولم يتعاطوا إلا مقدار ما كان في أيديهم لفقدوا علماً جماً ومرافق لا تحصى، ولكن أبى الله إلا أن يقسم نعمه بين طبقات جميع عباده قسمة عدل، يعطي كل قرن وكل أمة حصتها ونصيبها، على تمام مراشد الدين، وكمال مصالح الدنيا.
فهؤلاء ملوك فارس نزلوا على شاطىء الدجلة، من دون الصراة إلى فوق بغداد؛ في القصور والبساتين؛ وكانوا أصحاب نظر وفكر، واستخراج واستنباط، من لدن أزدشير بن بابك إلى فيروز بن يزدجرد.
وقبل ذلك ما نزلها ملوك الأشكان، بعد ملوك الأردوان.
فهل رأيتم أحداً اتخذ حراقة، أو زلالة، أو قارباً؟ ! وهل عرفوا الخيش مع حر البلاد ووقع السموم؟ ! وهل عرفوا الجمازات لأسفارهم ومنتزهاتهم؟ ! وهل عرف فلاحوهم الثمار المطعمة، وغراس النخل على الكردات المسطرة؟ وأين كانوا عن استخراج فوه العصفر؟ وأين كانوا عن تغليق الدور والمدن، وإقامة ميل الحيطان والسواري المائلة الروس، الرفيعة السموك المركبة بعضها على بعض؟ ! وأين كانوا عن مراكب البحر في ممارسة العدو الذي في البحر، إن طارت البوارج أدركتها، وإن أكرهتها فاتتها بعد أن كان القوم أسرى في بلاد الهند، يتحكمون عليهم ويتلعبون بهم؟ وأين كانوا عن الرمي بالنيران؟ ! نعم، وكانوا يتخذون الأحصار وينفقون عليها الأموال، رجالهم دسم العمائم،وسخة القلانس، وكان الرجل منهم إذا مر بالعطار، أو جلس إليه، فأراد كرامته دهن رأسه ولحيته، لايحتشم من ذلك الكبير،وكان أهل البيت إذا طبخوا اللحم غرفوا للجار والجارة غرفة غرفة.
فصل من صدر كتابه في الأوطان والبلدان
زينك الله بالتقوى، وكفاك المهم من أمر الآخرة والأولى، وأثلج صدرك باليقين، وأعزك بالقناعة، وختم لك بالسعادة، وجعلك من الشاكرين.سألت - أبقاك الله - أن أكتب لك كتاباً في تفاضل البلدان، وكيف قناعة النفس بالأوطان، وما في لزومها من الفشل والنقص، وما في الطلب من علم التجارب والعقل.
وذكرت أن طول المقام من أسباب الفقر، كما أن الحركة من أسباب اليسر، وذكرت قول القائل: " الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم " .
ونسيت - أبقاك الله - عمل البلدان، وتصرف الأزمان، وأثارهما في الصور والأخلاق، وفي الشمائل والآداب، وفي اللغات والشهوات، وفي الهمم والهيئات، وفي المكاسب والصناعات، على ما دبر الله تعالى من ذلك بالحكمة اللطيفة، والتدابير العجيبة.
فسبحان من جعل بعض الاختلاف سبباً للائتلاف، وجعل الشك داعية إلى اليقين، وسبحان من عرفنا ما في الحيرة من الذلة، وما في الشك من الوحشة، وما في اليقين من العز، وما في الإخلاص من الأنس.
وقلت: ابدأ لي بالشام ومصر، وفضل ما بينهما، وتحصيل جمالهما، وذكرت أن ذلك سيجر العراق والحجاز، والنجود والأغوار، وذكر القرى والأمصار، والبراري والبحار.
واعلم - أبقاك الله - أنا متى قدمنا ذكر المؤخر وأخرنا ذكر المقدم، فسد النظام وذهبت المراتب. ولست أرى أن أقدم شيئاً من ذكر القرى على ذكر أم جميع القرى. وأولى الأمور بنا ذكر خصال مكة، ثم خصال المدينة.
ولولا ما يجب من تقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر لكان، الغالب على النفوس ذكر الأوطان وموقعها من قلب الإنسان.
وقد قال الأول: " عمر الله البلدان بحب الأوطان " ، وقال ابن الزبير: " ليس الناس بشيء من أقسامهم أقتنع منهم بأوطانهم " .
ولولا ما من الله به على كل جيل منهم من الترغيب في كل ما تحت أيديهم، وتزيين كل ما اشتملت عليه قدرتهم، وكان ذلك مفوضاً إلى العقول، وإلى اختيارات النفوس ما سكن أهل الغياض والأدغال في الغمق واللثق، ولما سكنوا مع البعوض والهمج، ولما سكن سكان القلاع في قلل الجبال، ولما أقام أصحاب البراري مع الذئاب والأفاعي وحيث من عز بز، ولا أقام أهل الأطراف في المخاوف والتغرير، ولما رضي أهل الغيران وبطون الأودية بتلك المساكن، ولالتمس الجميع السكنى في الواسطة، وفي بيضة العرب، وفي دار الأمن والمنعة. وكذلك كانت تكون أحوالهم في اختيار المكاسب والصناعات وفي اختيار الأسماء والشهوات. ولاختاروا الخطير على الحقير، والكبير على الصغير.
ألا تراهم قد اختاروا ما هو أقبح على ما هو أحسن من الأسماء والصناعات، ومن المنازل والديارات، من غير أن يكونوا خدعوا أو استكرهوا.
ولو اجتمعوا على اختيار ما هو أرفع، ورفض ما هو أوضع من اسم أو كنية، وفي تجارة وصناعة، ومن شهوة وهمة، لذهبت المعاملات، وبطل التمييز، ولوقع التجاذب والتغالب، ثم التجارب، ولصاروا غرضاً للتفاني، وأكلة للبوار.
فالحمد لله أكثر الحمد وأطيبه على نعمه، ما ظهر منها وما بطن، وما جهل منها وما علم! ذكر الله تعالى الديار فخبر عن موقعها من قلوب عباده، فقال: " ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم " . فسوى بين موقع قتل أنفسهم وبين الخروج من ديارهم. وقال: " وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا " . فسوى بين موقع الخروج من ديارهم وبين موقع هلاك أبنائهم.
فصل منه
فقسم الله تعالى المصالح بين المقام والظعن، وبين الغربة وإلف الوطن، وبين ما هو أربح وأرفع، حين جعل مجاري الأرزاق مع الحركة والطلب. وأكثر ذلك ما كان مع طول الاغتراب، والبعد في المسافة، ليفيدك الأمور، فيمكن الاختبار ويحسن الاختيار.والعقل المولود متناهي الحدود، وعقل التجارب لا يوقف منه على حد. ألا ترى أن الله لم يجعل إلف الوطن عليهم مفترضاً، وقيداً مصمتاً، ولم يجعل كفاياتهم مقصورة عليهم، محتسبة لهم في أوطانهم؟ ألا تراه يقول: " فاقرءوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله " . فقسم الحاجات فجعل أكثرها في البعد. وقال عز ذكره: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " فأخرج الكلام والإطلاق على مخرج العموم، فلم يخص أرضاً دون أرض، ولا قرباً دون بعد.
فصل منه
ونحن، وإن أطنبنا في ذكر جملة القول في الوطن، وما يعمل في الطبائع، فإنا لم نذكر خصال بلدة بعينها، فنكون قد خالفنا إلى تقديم المؤخر وتأخير المقدم.قالوا: ولم نجهل ولم ننكر أن نفس الإلف يكون من صلاح الطبيعة، حتى إن أصحاب الكلاب ليجعلون هذا من مفاخرنا على جميع ما يعاشر الناس في دورهم من أصناف الطير وذوات الأربع: وذلك أن صاحب المنزل إذا هجم منزله واختار غيره، لم يتبعه فرس ولا بغل ولا حمار، ولا ديك ولا دجاجة، ولا حمامة ولا حمام، ولا هر ولا هرة، ولا شاة، ولا عصفور؛ فإن العصافير تألف دور الناس، ولا تكاد تقيم فيها إذا خرجوا منها. والخطاطيف تقطع إليهم لتقيم فيها إلى أوان حاجتها إلى الرجوع إلى أوطانها، وليس شيء من هذه الأنواع مما تبوأ في الدور باجتلابهم لها، ولا ما تبوأ في دورهم مما ينزع إليهم أحن من الكلب، فإنه يؤثره على وطنه، ويحميه ممن يغشاه.
فذكروا الكلب بهذا الخلق الذي تفرد به دون جميع الحيوان.
وقالوا في وجه آخر: أكرم الصفايا أشدها ولهاً إلى أولادها، وأكرم الإبل أحنها إلى أعطانها، وأكرم الأفلاء أشدها ملازمة لأمهاتها، وخير الناس آلفهم للناس.
فصل منه
وقلتم: خبرونا عن الخصال التي بانت بها قريش عن جميع الناس. وأنا أعلم أنك لم ترد هذا، وإنما أردت الخصال التي بانت بها قريش من سائر العرب، كما ذكرنا في الكتاب الأول الخصال التي بانت بها العرب عن العجم؛ لأن قريشاً والعرب قد يستوون في مناقب كثيرة. قد يلفى في العرب الجواد المبر وكذلك الحليم الشجاع، حتى يأتي على خصال حميدة؛ ولكنا نريد الخصائص التي في قريش دون العرب.
فمن ذلك أنا لم نر قريشياً انتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، وقد رأينا في قبائل العرب الأشراف رجالاً - إلى الساعة - ينتسبون في قريش، كنحو الذي وجدنا في بني مرة بن عوف، والذي وجدنا من ذلك في بني سليم، وفي خزاعة، وفي قبائل شريفة.
ومما بانت قريش أنها لم تلد في الجاهلية ولداً قط لغيرها ولقد أخذ ذلك منهم سكان الطائف، لقرب الجوار وبعض المصاهرة، ولأنهم كانوا حمساً، وقريش حمستهم.
ومما بانت به قريش من سائر العرب أن الله تعالى جاء بالإسلام وليس في أيدي جميع العرب سبية من جميع نساء قريش، ولا وجدوا في جميع أيدي العرب ولداً من امرأة من قريش.
ومما بانت به قريش من سائر العرب أنها لم تكن تزوج أحداً من أشراف العرب إلا على أن يتحمس، وكانوا يزوجون من غير أن يشترط عليهم، وهي عامر بن صعصعة، وثقيف، وخزاعة، والحارث بن كعب، وكانوا ديانيين، ولذلك تركوا الغزو لما فيه من الغصب والغشم، واستحلال الأموال والفروج.
ومن العجب أنهم مع تركهم الغزو كانوا أعز وأمثل، مثل أيام الفجار وذات كهف.
ألا ترى أنهم عند بنيان الكعبة قال رؤساؤهم: لا تخرجوا في نفقاتكم على هذا البيت إلا من صدقات نسائكم، ومواريث آبائكم! أرادوا مالاً لم يكسبوه ولا يشكون أنه لم يدخله من الحرام شيء.
ومن العجب أن كسبهم لما قل من قبل تركهم الغزو، ومالوا إلى الإيلاف والجهاد، لم يعترهم من بخل التجار قليل ولا كثير، والبخل خلقة في الطباع، فأعطوا الشعراء كما يعطي الملوك، وقروا الأضياف، ووصلوا الأرحام، وقاموا بنوائب زوار البيت، فكان أحدهم يحيس الحيسة في الأنطاع فيأكل منها القائم والقاعد، والراجل والراكب وأطعموا بدل الحيس الفالوذج. ألا ترى أمية بن أبي الصلت يقول، ويذكر عبد الله بن جدعان:
له داع بمكة مشمعل ... وحفص فوق دارته ينادي
إلى ردح من الشيزي ملاء ... لباب البر يلبك بالشهاد
فلباب البر هو هذا النشا، والشهاد يعني به العسل.
ألا ترى أن عمر بن الخطاب يقول: " أتروني لا أعرف طيب الطعام؟ لباب البر بصغار المعزى " ، يعني خبز الحوارى بصغار الجداء.
ولقد مدحتهم الشعراء كما يمدح الملوك، ومدحتهم الفرسان والأشراف وأخذوا جوائزهم؛ منهم: دريد بن الصمة، وأمية بن أبي الصلت.
ومن خصالهم أنهم لم يشاركوا العرب والأعراب في شيء من جفائهم، وغلظ شهواتهم؛ وكانوا لا يأكلون الضباب، ولا شيئاً من الحشرات؛ ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتوا خوانه بضب فقال: " ليس من طعام قومي " ، لأنهم لم يكونوا يحرشون الضباب، ويصيدون اليرابيع، ويملون القنافذ، أصحاب الخمر والخمير، وخبز التنانير.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر " .
وذلك أن جميع قبائل العرب إنما كانت القبيلة لا تكاد ترى وتسمع إلا من قبيلتها ورجالها، فليس عندهم، إلا عند قبيل واحد، من البيان والأدب والرأي والأخلاق، والشمائل، والحلم والنجدة والمعرفة، إلا في الفرط.
وكانت العرب قاطبة ترد مكة في أيام المواسم، وترد أسواق عكاظ وذا المجاز؛ وتقيم هناك الأيام الطوال، فتعرف قريش، لاجتماع الأخلاق لهم والشمائل والألفاظ، والعقول والأحلام، وهي وادعة وذلك قائم لها، راهن عندها في كل عام، تتملك عليهم فيقتسمونهم، فتكون غطفان للميرة، وبنو عامر لكذا، وتميم لكذا، تغلبها المناسك وتقوم بجميع شأنها.
فصل منه
وفتح مكة يسمى فتح الفتوح؛ وهو بيت الله، وأهله وحجاجه زوار الله؛ وهو البيت العتيق والبيت الحرام؛ وفيه الحجر، والحجر الأسود.وله زمزم، وهي هزمة جبريل - صلوات الله عليه - ، ومقام إبراهيم. وماء زمزم لما شرب له، العاكف فيه والبادي سواء.
وبسبب كرامته أرسل الله طير الأبابيل وحجارة السجيل. وأهله حمس ولقاح لا يؤدون إتاوة؛ ولهم السقاية، ودار الندوة، والرفادة، والسدانة.
قال: وأقسم الله تعالى بها، قال: " لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد " . وقوله جل ذكره: " لا أقسم " أي: أقسم، وإنما قوله " لا " في هذا الموضع صلة، ليس علة معنى " لا " الذي هو خلاف " نعم " .
وقالوا: ولو كان قوله: " وليطوفوا بالبيت العتيق " يراد به تقادم البنيان، وما تعاوره من كرور الزمان، لم يكن فضله على سائر البلدان، لأن الدنيا لم تخل من بيت ودار، وسكان وبنيان. وقد مرت الأيام على مصر، وحران، والحيرة، والسوس الأقصى، وأشباه ذلك، فجعل البيت العتيق صفة له، ولو كان ذهب إلى ما يعنون، كان من قبل أن يعتق وتمر عليه الأزمنة ليس بعتيق. وهذا الاسم قد أطلق له إطلاقاً، فاسمه البيت العتيق، كما أن اسمه بيت الله.
ومن زعم أن الله تعالى حرمه يوم خلق السموات والأرض، فقولنا هذا مصداق له.
ومن زعم أنه إنما صار حراماً مذ حرمه إبراهيم، كان قد زعم أنه قد كان ولا يقال له عتيق ولا حرام.
قالوا: ومما يصدق تأويلنا أنه لم يعرف إلا وهو لقاح، ولا أدى أهله إتاوة قط، ولا وطئته الملوك بالتمليك: أن سابور ذا الأكتاف، وبخت نصر وأبا يكسوم وغيرهم، قد أرادوه فحال الله تعالى دونه، فتلك عادة فيه، وسنة جارية له.
ولولا أن تبع أتاه حاجاً، على جهة التعظيم والتدين بالطواف، فحجه وطاف به، وكساه الوصائل، لأخرجه الله منه.
وحجه بعض ملوك غسان ولخم، وهم نصارى، تعظيماً له، ولما جعل الله له في القلوب.
والعتيق يكون من رق العبودية، كالعبد يعتقه مولاه. ويكون عتيقاً من النار، كالتائب من الكبائر، وكالرجل يدعو إلى الإيمان فيستجاب له، ويتعلم ناس على يده، فهم أيضاً عتقاء.
ويكون الرجل عتيقاً من عتق الوجه.
وربما كان عتيقاً كما يقال للفرس عتيق وليس بهجين ولا مقرف. وقد سمي أبو بكر بن أبي قحافة - رضوان الله عليه - عتيقاً، من طريق عتق الوجه، ومن طريق أنهم طلبوا المثالب والعيوب التي كانت تكون في الأمهات والآباء فلم يجدوها، قالوا: ما هذا إلا عتيق.
فصل منه
قد قلنا في الخصال التي بانت بها قريش دون العرب. ونحن ذاكرون - وبالله التوفيق - الخصال التي بانت بها بنو هاشم دون قريش.فأول ذلك النبوة، التي هي جماع خصال الخير، وأعلاها وأفضلها، وأجلها وأسناها.
ثم وجدنا فيهم ثلاثة رجال بني أعمام في زمان واحد، كلهم يسمى علياً، وكل واحد من الثلاثة سيد فقيه، عالم عابد، يصلح للرياسة والإمامة؛ مثل علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن هاشم، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وعلي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم.
ثم وجدنا ثلاثة رجال بني أعمام، في زمان واحد، كلهم يسمى محمداً، وكلهم سيد وفقيه عابد، يصلح للرياسة والإمامة، مثل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ومثل محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم.
وهذا من أغرب ما يتهيأ في العالم، ويتفق في الأزمنة، وهذه لا يشركهم فيها أحد، ولا يستطيع أن يدعي مثلها أحد.
ولبني هاشم واحدة مبرزة، وثانية نادرة، يتقدمون بها على جميع الناس. وذلك أنا لا نعرف في جميع مملكة العرب، وفي جميع مملكة العجم، وفي جميع الأقاليم السبعة، ملكاً واحداً ملكه من نصاب واحد، وفي مغرس رسالة، إلا من بني هاشم، فإن ملكهم العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعم وارث، والعم أب. ولا نعلم أمة تدعي مثل هذا لملكها.
وهذا شيء سمعته من أبي عبيدة، ومنه استمليت هذا المعنى.
ولبني هاشم - مذ ملكوا هذه الدفعة - دون أيام علي بن أبي طالب والحسين بن علي إلى يومنا هذا مائة وست عشرة سنة. كان أول بركتهم أن الله تعالى رفع الطواعين والموتان الجارف، فإنهم كانوا يحصدون حصداً بعد حصد.
ثم الذي تهيأ واتفق، وخص به آل أبي طالب من الغرائب والعجائب والفضائل، ما لم نجده في أحد سواهم: وذلك أن أول هاشمي هاشمي الأبوين كان في الدنيا ولد لأبي طالب، لأن أباهم عبد مناف. وهو أبو طالب بن شيبة وهو عبد المطلب بن هاشم وهو عمرو وهو أبو شيبة. وشيبة هو عبد المطلب. وهو أبو الحارث وسيد الوادي غير مدافع، بن عمرو، وهو هاشم بن المغيرة، وهو عبد مناف.
ثم الذي تهيأ لبني أبي طالب الأربعة: أن أربعة إخوة كان بين كل واحد منهم وبين أخيه في الميلاد عشر سنين سواء، وهذا عجب.
ومن الغرائب التي خصوا بها، أعني ولد أبي طالب، أنا لا نعلم الإذكار في بلد من البلدان، وفي جيل من الأجيال، إلا أهل خراسان فمن دونهم، فإن الإذكار فيهم فاش؛ كما أنك لا تجد من وراء بلاد مصر إلا مئناثاً، ثم لا ترى فيهن مفذاً بل لا ترى إلا التؤام ومن البنات.
فتهيأ في آل أبي طالب أحصوا منذ أعوام وحصلوا، فكانوا قريباً من ألفين وثلثمائة، ثم لا يزيد عدد نسائهم على رجالهم إلا دون العشر. وهذا عجب.
وإن كنت تريد أن تتعرف فضل البنات على البنين، وفضل إناث الحيوانات على ذكورها، فابدأ فخذ أربعين ذراعاً عن يمينك، وأربعين ذراعاً عن يسارك، وأربعين خلفك، وأربعين أمامك، ثم عد الرجال والنساء حتى تعرف ما قلنا، فتعلم أن الله تعالى لم يحلل للرجل الواحد من النساء أربعاً ثم أربعاً، متى وقع بهن موت أو طلاق، ثم كذلك للواحد ما بين الواحدة من الإماء إلى ما يشاء من العدد، مجموعات ومتفرقات، لئلا يبقين إلا ذوات أزواج.
ثم انظر في شأن ذوات البيض وذوات الأولاد فإنك سترى في دار خمسين دجاجة وديكاً واحداً، ومن الإبل الهجمة وفحلاً واحداً، ومن الحمير العانة وعيراً واحداً. فلما حصلوا كل مئناث وكل مذكار، فوجدوا آل أبي طالب قد برعوا على الناس وفضلوهم، عرف الناس موضع الفضيلة له والخصوصية.
وفي ولد أبي طالب - أيضاً - أعجوبة أخرى؛ وذلك أنه لم يوجد قط في أطفالهم طفل يحبو، بل يزحف زحفاً لئلا ينكشف منه عن شيء يسوءه، ليكون أوفر لبهائه، وأدل على ما خصوا به.
ولهم من الأعاجيب خصلة أخرى: وذلك أن عبيد الله بن زياد قتل الحسين في يوم عاشوراء، وقتله الله يوم عاشوراء في السنة الأخرى.
وقالوا: لا نعلم موضع رجل من شجعان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له من عدد القتلى ما كان لعلي رضوان الله عليه، ولا كان لأحد مع ذلك من قتل الرؤساء والسادة، والمتبوعين والقادة، ما كان لعلي بن أبي طالب. وقتل رئيس واحد، وإن كان دون بعض الفرسان في الشدة، أشد؛ فإن قتل الرئيس أرد على المسلمين وأقوى لهم من قتل الفارس الذي هو أشد من ذلك السيد.
وأيضاً أنه قد جمع بين قتل الرؤساء وبين قتل الشجعان.
وله أعجوبة أخرى؛ وذلك أنه مع كثرة ما قتل وما بارز، وما مشى بالسيف إلى السيف، لم يجرح قط ولا جرح إنساناً إلا قتله، ولا نعلم في الأرض متى ذكر السبق في الإسلام والتقدم فيه، ومتى ذكر الفقه في الدين، ومتى ذكر الزهد في الأموال التي تشاجر الناس عليها، ومتى ذكر الإعطاء في الماعون، كان مذكوراً في هذه الحالات كلها إلا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
قالوا: وكان الحسن يقول: قد يكون الرجل عالماً وليس بعابد، وعابداً وليس بعالم، وعابداً وليس بعاقل، وعاقلاً وليس بعابد. وسليمان بن يسار عالم عاقل عابد، فانظر أين يقع خصال سليمان من خصال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ولم يكن قصدنا في أول هذا الكتاب إلى ذكر هاشم، وقد كان قصدنا الإخبار عن مكة بما قد كتبناه في صدر هذا الكتاب، ولكن ذكر خصال مكة جر ذكر خصال قريش، وذكر خصال قريش جر ذكر خصال بني هاشم.
فإن أحببت أن تعرف جملة القول في خصال بني هاشم فانظر في كتابي هذا الذي فرقت فيه بين خصال بني عبد مناف وبين بني مخزوم، وفرقت ما بين عبد شمس؛ فإنه هناك أوفر وأجمع، إن شاء الله تعالى.
فصل منه
قالوا: وقد تعجب الناس من ثبات قريش، وجزالة عطاياهم، واحتمالهم المؤن الغلاظ في دوام كسبهم من التجارة، وقد علموا أن البخل والبصر في الطفيف مقرون في التجارة؛ وذلك خلق من أخلاقهم. وعلى ذلك شاهد أهل الترقيح والتكسب والتدنيق.فكان في ثبات جودهم العالي على جود الأجواد، وهم قوم لا كسب لهم إلا من التجارة، عجب من العجب.
ثم جاء ما هو أعجب من هذا وأطم، وذلك أنا قد علمنا أن الروم قبل التدين بالنصرانية، كانت تنتصف من ملوك فارس، وكانت الحروب بينهم سجالاً، فلما صارت لا تدين بالقتل والقتال، والقود والقصاص، اعتراهم مثل ما يعتري الجبناء حتى صاروا يتكلفون القتال تكلفا. ولما خامرت طبائعهم تلك الديانة، وسرت في لحومهم ودمائهم فصارت تلك الديانة تعترض عليهم، خرجوا من حدود الغالبية إلى أن صاروا مغلوبين.
وإلى مثل ذلك صارت حال التغزغز من الترك. بعد أن كانوا أنجادهم وحماتهم، وكانوا يتقدمون الخرلخية، وإن كانوا في العدد أضعافهم، فلما دانوا بالزندقة - ودين الزندقة في الكف والسلم أسوأ من دين النصارى - نقصت تلك الشجاعة، وذهبت تلك الشهامة.
وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس، وتشددوا في الدين، فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان الغصب؛ فلما تركوا الغزو لم تبق مكسبة سوى التجارة، فضربوا في البلاد إلى قيصر بالروم، وإلى النجاشي بالحبشة، وإلى المقوقس بمصر، وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء، وبانوا بالديانة والتحمس، فحمسوا بني عامر بن صعصعة، وحمسوا الحارث بن كعب، فكانوا - وإن كانوا حمساً - لا يتركون الغزو والسبي ووطء النساء، وأخذ الأموال، فكانت نجدتهم - وإن كان أنقص - فإنها على حال النجدة، ولهم في ذلك بقية.
وتركت قريش الغزو بتة، فكانوا - مع طول ترك الغزو - إذا غزوا كالأسود على براثنها، مع الرأي الأصيل، والبصيرة النافذة.
أفليس من العجب أن تبقى نجدتهم، وتثبت بسالتهم، ثم يعلون الأنجاد والأجواد، ويفرعون الشجعان؟ ! وهاتان الأعجوبتان بينتان.
وقد علم أن سبب استفاضة النجدة في جميع أصناف الخوارج وتقدمهم في ذلك، إنما هو بسبب الديانة، لأنا نجد عبيدهم ومواليهم ونساءهم، يقاتلون مثل قتالهم، ونجد السجستاني وهو عجمي، ونجد اليمامي والبحراني والخوزي وهم غير عرب، ونجد إباضية عمان وهي بلاد عرب، وإباضية تاهرت وهي بلاد عجم، كلهم في القتال والنجدة، وثبات العزيمة، والشدة في البأس سواء. فاستوت حالاتهم في النجدة مع اختلاف أنسابهم ويلدانهم. أفما في هذا دليل على أن الذي سوى بينهم التدين بالقتال، وضروب كثيرة من هذا الفن؟ ! وذلك كله مصور في كتبي، والحمد لله.
وقد تجدون عموم السخف والجهل والكذب في المواعيد، والغش في الصناعة، في الحاكة، فدل استواء حالاتهم في ذلك على استواء عللهم. ليست هناك علة إلا الصناعة؛ لأن الحاكة في كل بلد شيء واحد. وكذلك النخاس وصاحب الخلقان، وبياع السمك. وكذلك الملاحون وأصحاب السماد، أولهم كآخرهم، وكهولهم كشبانهم، ولكن قل في استواء الحجامين في حب النبيذ.
فصل منه في ذكر المدينة
وأمر المدينة عجب، وفي تربها وترابها وهوائها، دليل وشاهد وبرهان على قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنها طيبة تنفي خبثها وتنصع طيبها " لأن من دخلها أو أقام فيها، كائنا من كان من الناس، فإنه يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة، ليس لها اسم في الأرابيح، وبذلك السبب طاب طيبها والمعجونات من الطيب فيها. وكذلك العود وجميع البخور، يضاعف طيبها في تلك البلدة على كل بلد استعمل ذلك الطيب بعينه فيها.وكذلك صياحها والبلح والأترج والسفرجل، أعني المجعول منها سخباً للصبيان والنساء.
فإن ذكروا طيب سابور بطيب أرياح الرياحين، وذلك من ريح رياحينها وبساتينها وأنوارها، ولذلك يقوى في زمان، ويضعف في زمان.
ونحن قد ندخل دجلة في نهر الأبلة بالأسحار، فنجد من تلك الحدائق، ونحن في وسط النهر، مثل ما يجد أهل سابور من تلك الرائحة.
وطيبة التي يسمونها المدينة، هذا الطيب خلقة فيها، وجوهرية منها، وموجود في جميع أحوالها. وإن الطيب والمعجونات لتحمل إليها فتزداد فيها طيباً، وهو ضد قصبة الأهواز وأنطاكية، فإن الغوالي تستحيل الاستحالة الشديدة.
ولسنا نشك أن ناساً ينتابون المواضع التي يباع فيها النوى المنقع، فيستنشقون تلك الرائحة، يعجبون بها ويلتمسونها، بقدر فرارنا نحن من مواقع النوى عندنا بالعراق، ولو كان من النوى المعجوم ومن نوى الأفواه.
ونحن لا نشك أن الرجل الذي يأكل بالعراق أربع جرادق في مقعد واحد من الميساني والموصلي، أنه لا يأكل من أقراص المدينة قرصين؛ ولو كان ذلك لغلظ فيه أو لفساد كان في حبه وطحينه لظهر ذلك في التخم وسوء الاستمراء، ولتولد على طول الأيام من ذلك أوجاع وفساد كثير.
ولم يكن بها طاعون قط ولا جذام.
وليس لبلدة من البلدان من الشهرة في الفقه ما لهم ولرجالهم، وذكر عبد الملك بن مروان روح بني زنباع فمدحه فقال: " جمع أبو زرعة فقه الحجاز، ودهاء العراق، وطاعة أهل الشام " .
فصل منه في ذكر مصر
قال أبو الخطاب: لم يذكر الله جل وعز شيئاً من البلدان باسمه في القرآن كما ذكر مصر، حيث يقول: " وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه " . وقال: " فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " وقال: " وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة " وقال تعالى: " اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم " وقال في آية: " أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي " .وذكر مصر في القرآن بالكناية عن خاصة اسمها، فمن ذلك: " وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه " قالوا: هي مدينة منف، وهو موضع منزل فرعون.
وأخبرني شيخ من آل أبي طالب من ولد علي صحيح الخبر: منف دار فاعون، ودرت في مجالسه ومثاويه وغرفه وصفافه، فإذا كله حجر واحد منقور؛ فإن كانوا هندموه وأحكموا بناءه حتى صار في الملاسة واحداً لا يستبان فيه مجمع حجرين، ولا ملتقى صخرتين فهذا عجب. ولئن كان جبلاً واحداً، ودكاً واحداً، فنقرته الرجال بالمناقير حتى خرقت فيه تلك المخاريق، إن هذا لأعجب.
وفي القرآن: " فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين " .
قال: والأرض ها هنا مصر. وفي هذا الموضع كلام حسن، ولكنا ندعه مخافة أن نخرج إلى غير الباب الذي ألفنا له هذا الكتاب.
قالوا: وسمى الله تعالى ملك مصر " العزيز " ، وهو صاحب يوسف، وسمي صاحب موسى فرعون.
قالوا: وكان أصل عتو فرعون ملكه العظيم، ومملكته التي لا تشبهها مملكة.
قالوا: ومنهم مؤمن آل فرعون، وهي آسية بنت مزاحم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سيدة نساء العالم خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم " .
قال: ولما هم فرعون بقتل موسى قالت آسية: لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً. وقالت: وكيف تقتله، ووالله ما يعرف الجمرة من التمرة.
ومنهم السحرة الذين كانوا قد أبروا على أهل الأرض، فلما أبصروا بالأعلام، وأيقنوا بالبرهان، استبصروا وتابوا توبة ما تابها ماعز بن مالك، ولا أحد من العالمين، حتى قالوا لفرعون: " اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر " .
وجاء في الحديث: " من أخرب خزائن الله فعليه لعنة الله " . قالوا: خزائن الله هي مصر، أما سمعتم قول يوسف: " اجعلني على خزائن الأرض " ؟ وقال عبد الله بن عمرو: " البركة عشر بركات: تسع بمصر والواحدة في جميع الأرض " .
فصل منه
وقال أهل العراق: سألنا بطريق خرشنة عن خراج الروم، فذكر مقداراً من المال، وقال: هو كذا وكذا قنطاراً. فنظر بعض الوزراء فإذا خراج مصر وحده يضعف على خراج بلاد الروم إذا جمعت أبواب المال من البلاد جميعاً.وزعم أبو الخطاب أن أرض مصر جبيت أربعة آلاف ألف دينار.
فصل منه
ولا أعلم الفرقة في المغرب إلا أكثر من الفرقة في المشرق، إلا أن أهل المغرب إذا خرجوا لم يزيدوا على البدعة والضلالة، والخارجي في المشرق لا يرضى بذلك حتى يجوزه إلى الكفر، مثل المقنع وشيبان والإصبهبذ وبابك، وهذا الضرب.فصل منه
وقد علمنا أن لجماعة بني هاشم طابعاً في وجوههم يستبين به كرم العتق وكرم النجار، وليس ذلك لغيرهم.ولقد كادت الأهواز تفسد هذا المعنى على هاشمية الأهواز، ولولا أن الله غالب على أمره لقد كادت طمست على ذلك العتق ومحته. فتربتها خلاف تربة الرسول صلى الله عليه وسلم: وذلك أن كل من تخرق طرق المدينة وجد رائحة طيبة ليست من الأراييح المعروفة الأسماء.
فصل منه
قال زياد: الكوفة جارية جميلة لا مال لها، فهي تخطب لجمالها. والبصرة عجوز شوهاء ذات مال فهي تخطب لمالها.فصل منه
والفرات خير من ماء النيل. وإما دجلة فإن ماءها يقطع شهوة الرجال. ويذهب بصهيل الخيل، ولا يذهب بصهيلها إلا مع ذهاب نشاطها، ونقصان قواها؛ وإن لم يتنسم النازلون عليها أصابهم قحول في عظامهم، ويبس في جلودهم.وجميع العرب النازلين على شاطئ دجلة من بغداد إلى بلد لا يرعون الخيل في الصيف على أواريها على شاطئ دجلة، ولا يسقونها من مائها، لما يخاف عليها من الصدام، وغير ذلك من الآفات.
وأصحاب الخيل من العتاق والبراذين إنما يسقونها بسر من رأى، مما احتفروها من كارباتهم ولا يسقونها من ماء دجلة؛ وذلك أن ماء دجلة مختلط، وليس هو ماءً واحداً، ينصب فيها من الزابين والنهروانات وماء الفرات، وغير ذلك من المياه.
واختلاف الطعام إذا دخل جوف الإنسان من ألوان الطبيخ والإدام غير ضار، وإن دخل جوف الإنسان من شراب مختلف كنحو الخمر والسكر ونبيذ التمر والداذي كان ضاراً. وكذلك الماء، لأنه متى أراد أن يتجرع جرعاً من الماء الحار لصدره أو لغير ذلك، فإن أعجله أمر فبرده بماء بارد ثم حساه ضره ذلك، وإن تركه حتى يفتر ببرد الهواء لم يضره. وسبيل المشروب غير سبيل المأكول .
فإن كان هذا فضيلة مائنا على ماء دجلة فما ظنك بفضله على ماء البصرة، وهو ماء مختلط من ماء البحر ومن الماء المستنقع في أصول القصب والبردي؟ قال الله تعالى: " هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج " .
والفرات أعذبها عذوبة، وإنما اشتق الفرات لكل ماء عذب، من فرات الكوفة.
فصل منه في ذكر البصرة
كان يقال: الدنيا البصرة.وقال الأحنف لأهل الكوفة: " نحن أعذى منكم برية، وأكثر منكم بحرية، وأبعد منكم سرية، وأكثر منكم ذرية " .
وقال الخليل بن أحمد في وصف القصر المذكور بالبصرة:
زر وادي القصر نعم القصر والوادي ... لا بد من زورة عن غير ميعاد
ترقى بها السفن والظلمان واقفة ... والضب والنون والملاح والحادي
ومن أتى هذا القصر وأتى قصر أنس رأى أرضاً كالكافور، وتربة ثرية، ورأى ضباً يحترش، وعزالاً يقتنص، وسمكاً يصاد، ما بين صاحب شص وصاحب شبكة، ويسمع غناء ملاح على سكانه، وحداء جمال على بعيره.
قالوا: وفي أعلى جبانة البصرة موضع يقال له الحزيز يذكر الناس أنهم لم يروا قط هواءً أعدل، ولا نسيماً أرق، ولا ماء أطيب منها في ذلك الموضع.
وقال جعفر بن سليمان: " العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري عين المربد " .
وقال أبو الحسن وأبو عبيدة: " بصرت البصرة سنة أربع عشرة، وكوفت الكوفة سنة سبع عشرة "
فصل منه
زعم أهل الكوفة أن البصرة أسرع الأرض خراباً، وأخبثها تراباً، وأبعدها من السماء وأسرعها غرقاً، ومفيض مائها البحر، ثم يخرج ذلك إلى البحر الأعظم.وكيف تغرق، وهم لا يستطيعون أن يوصلوا ماء الفيض إلى حياضهم إلا بعد أن يرتفع ذلك الماء في الهواء ثلاثين ذراعاً، في كل سقاية بعينها، لا لحوض بعينه.
وهذه أرض بغداد في كل زيادة ماء ينبع الماء في أجواف قصورهم الشارعة بعد إحكام المسنيات التي لا يقوى عليها إلا الملوك، ثم يهدمون الدار التي على دجلة فيكسون بها تلك السكك، ويتوقعون الغرق في كل ساعة.
قال: وهم يعيبون ماء البصرة، وماء البصرة رقيق قد ذهب عنه الطين والرمل المشوب بماء بغداد والكوفة، لطول مقامه بالبطيحة، وقد لان وصفا ورق.
وإن قلتم: إن الماء الجاري أمرأ من الساكن، فكيف يكون ساكناً مع تلك الأمواج العظام والرياح العواصف، والماء المنقلب من العلو إلى السفل؟ ومع هذا إنه إذا سار من مخرجه إلى ناحية المذار ونهر أبي الأسد وسائر الأنهار، وإذا بعد من مدخله إلى البصرة من الشق القصير، جرى منقضاً إلى الصخور والحجارة، فراسخ وفراسخ، حتى ينتهي إلينا.
ويدل على صلاح مائهم كثرة دورهم، وطول أعمارهم، وحسن عقولهم، ورفق أكفهم، وحذقهم لجميع الصناعات، وتقدمهم في ذلك لجميع الناس.
ويستدل على كرم طينهم ببياض كيزانهم وعذوبة الماء البائت في قلالهم، وفي لون آجرهم، كأنما سبك من مح بيض. وإذا رأيت بناءهم وبياض الجص الأبيض بين الآجر الأصفر لم تجد لذلك شبهاً أقرب من الفضة بين تضاعيف الذهب.
فإذا كان زمان غلبة ماء البحر فإن مستقاهم من العذب الزلال الصافي، النمير في الأبدان، على أقل من فرسخ، وربما كان أقل من ميل.
ونهر الكوفة الذي يسمونه إنما هو شعبة من أنهار الفرات، وربما جف حتى لا يكون لهم مستقىً إلا على رأس فرسخ، وأكثر من ذلك، حتى يحفروا الآبار في بطون نهرهم، وحتى يضر ذلك بخضرهم وأشجارهم. فلينظروا أيما أضر وأيما أعيب.
وليس نهر من الأنهار التي تصب في دجلة إلا هو أعظم وأكبر وأعرض من موضع الجسر من نهر الكوفة، وإنما جسره سبع سفائن، لا تمر عليه دابة لأنها جذوع مقيدة بلا طين، وما يمشي عليها الماشي إلا بالجهد؛ فما ظنك بالحوافر والخفاف والأظلاف؟ ! وعامة الكوفة خراب يباب، ومن بات فيها علم أنه في قرية من القرى ورستاق من الرساتيق، بما يسمع من صياح بنات آوى، وضباح الثعالب، وأصوات السباع. وإنما الفرات دمما إلى ما اتصل به إلى بلاد الرقة، وفوق ذلك.
فإما نهرهم فالنيل أكبر منه، وأكثر ماءً، وأدوم جرية.
وقد تعلمون كثرة عدد أنهار البصرة، وغلبة الماء، وتطفح الأنهار.
وتبقى النخلة عشرين ومائة سنة وكأنها قدح. وليس يرى من قرب القرية التي يقال لها النيل إلى أقصى أنهار الكوفة نخلة طالت شيئاً إلا وهي معوجة كالمنجل. ثم لم نر غارس نخل قط في أطراف الأرض يرغب في فسيل كوفي، لعلمه بخبث مغرسه، وسوء نشوه، وفساد تربته، ولؤم طبعه.
وليس لليالي شهر رمضان في مسجدهم غضارة ولا بهاء، وليس منار مساجدهم على صور منار البصرة، ولكن على صور منار الملكانية واليعقوبية.
ورأينا بها مسجداً خراباً تأويه الكلاب والسباع، وهو يضاف إلى علي بن أبي طالب، رضوان الله عليه.
ولو كان بالبصرة بيت دخله علي بن أبي طالب ماراً لتمسحوا به وعمروه بأنفسهم وأموالهم.
وخبرني من بات أنه لم ير كواكبها زاهرة قط، وأنه لم يرها إلا ودونها هبوة، وكأن في مائهم مزاج دهن. وأسواقهم تشهد على أهلها بالفقر. وهم أشد بغضاً لأهل البصرة من أهل البصرة لهم؛ وأهل البصرة هم أحسن جواراً، وأقل بذخاً، وأقل فخراً.
ثم العجب من أهل بغداد وميلهم معهم، وعيبهم إيانا في استعمال السماد في أرضنا ولنخلنا، ونحن نراهم يسمدون بقولهم بالعذرة اليابسة صرفاً، فإذا طلع وصار له ورق ذروا عليه من تلك العذرة اليابسة حتى يسكن في خلال ذلك الورق.
ويريد أحدهم أن يبني داراً فيجيء إلى مزبلة، فيضرب منها لبناً، فإن كانت داره مطمئنة ذات قعر حشا من تلك المزبلة التي لو وجدها أصحاب السماد عندنا لباعوها بالأموال النفيسة.
ثم يسجرون تنانيرهم بالكساحات التي فيها من كل شيء، وبالأبعار والأخثاء، وكذلك مواقد الكيران.
وتمتلىء ركايا دورهم عذرة فلا يصيبون لها مكاناً، فيحفرون لذلك في بيوتهم آباراً، حتى ربما حفر أحدهم في مجلسه، وفي أنبل موضع من داره. فليس ينبغي لمن كان كذلك أن يعيب البصريين بالتسميد.
فصل منه
وليس في الأرض بلدة أرفق بأهلها من بلدة لا يعز بها النقد، وكل مبيع بها يمكن.فالشامات وأشباهها الدينار والدرهم بها عزيزان، والأشياء بها رخيصة لبعد المنقل، وقلة عدد من يبتاع. ففي ما يخرج من أرضهم أبداً فضل عن حاجاتهم.
والأهواز، وبغداد، والعسكر، يكثر فيها الدراهم ويعز فيها المبيع لكثرة عدد الناس وعدد الدراهم.
وبالبصرة الأثمان ممكنة والمثمنات ممكنة، وكذلك الصناعات، وأجور أصحاب الصناعات. وما ظنك ببلدة يدخلها في البادي من أيام الصرام إلى بعد ذلك بأشهر، ما بين ألفي سفينة تمر أو أكثر في كل يوم، لا يبيت فيها سفينة واحدة، فإن باتت فإنما صاحبها هو الذي يبيتها، لأنه لو كان حط في كل ألف رطل قيراطاً لانتسفت انتسافا.
ولو أن رجلاً ابتنى داراً يتممها ويكملها ببغداد، أو بالكوفة، أو بالأهواز، وفي موضع من هذه المواضع، فبلغت نفقتها مائة ألف درهم، فإن البصري إذا بنى مثلها بالبصرة لم ينفق خمسين ألفاً؛ لأن الدار إنما يتم بناؤها بالطين واللبن، وبالآجر والجص، والأجذاع والساج والخشب، والحديد والصناع، وكل هذا يمكن بالبصرة على الشطر مما يمكن في غيرها. وهذا معروف.
ولم نر بلدة قط تكون أسعارها ممكنة مع كثرة الجماجم بها إلا البصرة: طعامهم أجود الطعام، وسعرهم أرخص الأسعار، وتمرهم أكثر التمور، وريع دبسهم أكثر، وعلى طول الزمان أصبر، يبقى تمرهم الشهريز عشرين سنة، ثم بعد ذلك يخلط بغيره فيجيء له الدبس الكثير، والعذب الحلو، والخاثر القوي.
ومن يطمع من جميع أهل النخل أن يبيع فسيلة بسبعين ديناراً، أو بحونة بمائة دينار، أو جريباً بألف دينار غير أهل البصرة؟
فصل منه
ولأهل البصرة المد والجزر على حساب منازل القمر لا يغادران من ذلك شيئاً. يأتيهم الماء حتى يقف على أبوابهم؛ فإن شاءوا أذنوا، وإن شاءوا حجبوه.ومن العجب لقوم يعيبون البصرة لقرب البحر والبطيحة؛ ولو اجتهد أعلم الناس وأنطق الناس أن يجمع في كتاب واحد منافع هذه البطيحة، وهذه الأجمة، لما قدر عليها.
قال زياد: قصبة خير من نخلة.
وبحق أقول: لقد جهدت جهدي أن أجمع منافع القصب ومرافقه وأجناسه، وجميع تصرفه وما يجيء منه، فما قدرت عليه حتى قطعته وأنا معترف بالعجز، مستسلم له.
فأما بحرنا هذا فقد طم على كل بحر وأوفى عليه؛ لأن كل بحر في الأرض لم يجعل الله فيه من الخيرات شيئاً، إلا بحرنا هذا، الموصول ببحر الهند إلى ما لا تذكر.
وأنت تسمع بملوحة ماء البحر، وتستسقطه وتزري عليه. والبحر هو الذي يخلق الله تعالى منه الدر الذي بيعت الواحدة منه بخمسين ألف دينار؛ ويخلق في جوفه العنبر، وقد تعرفون قدر العنبر. فشيء يولد هذين الجوهرين كيف يحقر؟ ولو أنا أخذنا خصال هذه الأجمة وما عظمنا من شأنها، فقذفنا بها في زاوية من زوايا بحرنا هذا لضلت حتى لا نجد لها حسا، وهما لنا خالصان دونكم، وليس يصل إليكم منهما شيء إلا بسببنا وتعدينا فضل غنا.
وقال بعض خطبائنا: نحن أكرم بلاداً، وأوسع سواداً، وأكثر ساجاً وعاجاً وديباجاً، وأكثر خراجاً.
لأن خراج العراق مائة ألف ألف واثنا عشر ألف ألف، وخراج البصرة من ذلك ستون ألف ألف، وخراج الكوفة خمسون ألف ألف.
فصل منه في ذكر الحيرة
ورأيت الحيرة البيضاء وما جعلها الله بيضاء، وما رأيت فيها داراً يذكر إلا دار عون النصراني العباداني.ورأيت التربة التي بينها وبين قصبة الكوفة، ورأيت لون الأرض فإذا هو أكهب كثير الحصى، خشن المس.
والحيرة أرض باردة في الشتاء، وفي الصيف ينزعون ستور بيوتهم مخافة إحراق السمائم لها.
فصل من صدر رسالته في البلاغة والإيجاز
قال عمرو بن بحر الجاحظ: درجت الأرض من العرب والعجم على إيثار الإيجاز، وحمد الاختصار، وذم الإكثار والتطويل والتكرار، وكل ما فضل عن المقدار.وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، دائم السكت يتكلم بجوامع الكلم، لا فضل ولا تقصير، وكان يبغض الثرثارين المتشدقين.
وكان يقال: أفصح الناس أسهلهم لفظاً، وأحسنهم بديهة.
والبلاغة إصابة المعنى والقصد إلى الحجة مع الإيجاز، ومعرفة الفصل من الوصل.
وقيل: العاقل من خزن لسانه، ووزن كلامه، وخاف الندامة.
وحسن البيان محمود، وحسن الصمت حكم.
وربما كان الإيجاز محموداً، والإكثار مذموماً. وربما رأيت الإكثار أحمد من الإيجاز. ولكل مذهب ووجه عند العاقل. ولكل مكان مقال، ولكل كلام جواب. مع أن الإيجاز أسهل مراما وأيسر مطلباً من الإطناب، ومن قدر على الكثير كان على القليل أقدر.
والتقليل للتخفيف، والتطويل للتعريف، والتكرار للتوكيد، والإكثار للتشديد.
فصل منه
وأما المذموم من المقال، فما دعا إلى الملال، وجاوز المقدار، واشتمل على الإكثار، وخرج من مجرى العادة.وكل شيء أفرط في طبعه، وتجاوز مقدار وسعه، عاد إلى ضد طباعه، فتحول البارد حاراً، ويصير النافع ضاراً، كالصندل البارد إن أفرط في حكه عاد حاراً مؤذياً، وكالثلج يطفىء قليله الحرارة، وكثيره يحركها.
وكذلك القرد لما فرط قبحه، وتناهت سماجته استملح واستظرف.
وإلى هذا ذهب من عد الإكثار عياً، والإيجاز بلاغة.
فصل من صدر كتابه في تفضيل البطن على الظهر
عصمنا الله وإياك من الشبهة، وأعاذنا وإياك من زيغ الهوى، وفضلات المنى، ووهب لنا ولك تأديباً مؤدياً إلى الزيادة في إحسانه، وتوفيقاً موجباً لرحمته ورضوانه.وقد كان كتابك يا ابن أخي - وفقك الله - ورد علي، تصف فيه فضيلة الظهور وصفاً يدل على شغفك بها، وحبك إياها، وحنينك إليها وإيثارك لها، وفهمته.
فلم تمنع - أعاذك الله من عدوك - من الإجابة عن كتابك في وقت وروده، إلا عوارض أشغال مانعة، وحوادث من التصرف والانتقال من مكان إلى مكان عائقة.
ولم آمن أن لو تأخر الجواب عليك أكثر مما تأخر، أن يسبق إلى قلبك أني راض باختيارك، ومسلم لمذهبك، وموافق لك فيه، مساعد لك عليه، ومنقاد معك فيما اعتقدت منه، ومجد في طلبه، ومحرض عليه.
فبادرت بكتابي هذا، منبها لك من سنة رقدتك، وداعياً إلى رشدك. فإنك تعلم - وإن كنت لي في مذهبي مخالفاً، وفي اعتقادي مبايناً - أن اجتماع المتباينين فيما يقع بصلاحهما أولى في حكم العقل، وطريق المعرفة منه فيما أبادهما، وعاد بالضرر في اختيارهما عليهما.
وأنا، وإن كنت كشفت لك قناع الخلاف، وأبديت مكنون الضمير بالمضادة، وجاهدتني بنصرة الرأي والعقيدة في حب الظهور، وتلفيق الفضائل لها، غير مستشعر لليأس من رجعتك، ولا شاك في لطائف حكمتك، وغوامض فطنتك.
وقد أعلم أن معك - بحمد الله - بصيرة المعتبرين، وتمييز الموفقين وأنك إذا أنعمت فكراً وبحثاً ونظراً، رجعت إلى أصل قوي الانقياد والموافقة، ولم تتورط في اللجاج فعل المعجبين، ولم يتداخلك غرة المنتحلين؛ فإنا رأينا قوماً انتحلوا الحكمة وليسوا من أهلها، بل هم أعلام الدعوى، وحلفاء الجهالة، وأتباع الخطأ، وشيع الضلالة، وخول النقص، الذين قامت عليهم الحجة بما نحلوه أنفسهم من اسمها، وسلبوه من فهم عظيم قدرها ومعرفة جليل خطرها، ولم يجلوا الرين عن قلوبهم والصدأ عن أسماعهم، بالتنقير والبحث والتكشف، ولم ينصبوا في عقولهم لأنفسهم أصلاً يئلون في اعتقادهم عليه، ويرجعون عند الحيرة في اختلاف آرائهم إليه. فضلوا، وأصبح الجهل لهم إماماً، والسفهاء لهم قادة وأعلاما.
ونحن نسأل الله بحوله وطوله ومنه، ألا يجعلك من أهل هذه الصفة، وأن يريك الحق حقاً فتتبعه، والباطل باطلاً فتجتنبه، وأن يعمنا ببركة هذا الدعاء، وجماعة المسلمين، وأن يأخذ إلى الخير بنواصينا، ويجمع على الهدى قلوبنا، ويؤلف فيه ذات بيننا، فإنك ما علمت - وأتقلد في ذلك أمانة القول - ممن أحب موافقته ومخالطته، وأن يكون في فضله مقدماً، وعن كل عضيهة منزها.
وما أعلم حالاً أنا عليها في الرغبة لك فيما أرغب لنفسي فيه، والسرور بتكامل أحوالك، واستواء مذهبك، وما أزابن به من إرشادك ونصيحتك، وتسديدك وتوفيقك، إلا وصدق الطوية مني فيها أبلغ من إسهامي في فضل صفتها. والله تعالى المعين والمؤيد والموفق، والمبدع، وحده لا شريك له. والحمد لله، كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيراً.
يا أخي - أرشدك الله - إنك أغرقت في مدح الظهر من الجهة التي كان ينبغي لك أن تذمها، وقدمتها من الحجة التي ينبغي لك أن تؤخرها. وآثرتها وهي محقوقة بأن ترفضها.
وما رأينا هلاك الأمم الخالية، من قوم لوط، وثمود وأشياعهم وأتباعهم، وحلول الخسف والرجفة والآيات المثلات والعذاب الأليم والريح العقيم، والغير والنكير ووجوب نار السعير، إلا بما دانوا به من اختيار الظهور. قال الله تعالى، في قصة لوط: " أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون " .
فذمهم الله - تبارك وتعالى - كما ترى، وبلغ بهم في ذكر ما استعظم من عتوهم إلى غاية لا تدرك صفتها، ولا يوقف على حدها مع آي كثيرة قد أنزلها فيهم، وقصص طويلة قد أنبأ بها عنهم، وروايات كثيرة أثرها فيمن كان من طبقتهم.
وسنأتي منها بما يقع به الكفاية دون استفراغ الجميع، مما حملته الرواة، ونقله الصالحون.
فصل منه
والحق بين لمن التمسه، والمنهج واضح لمن أراد أن يسلكه. وليس في العنود درك فلج. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وترك الذنب أيسر من التماس الحجة، كما كان غض الطرف أهون من الحنين إلى الشهوة. وبالله تعالى التوفيق.فصل منه
نبدأ الآن بذكر ما خص الله به البطون من الفضائل، ليرجع راجع، وينيب منيب مفكر، وينتبه راقد، ويبصر متحير، ويستغفر مذنب، ويستقيل مخطىء، وينزع مصر، ويستقيم عاند، ويتأمل غمر، ويرشد غوي، ويعلم جاهل، ويزداد عالم.قال الله عز وجل فيما وصف به النحل: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " .
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير بطون قريش.
ووجدنا الأغلب في صفة الرجل أن يقال إنه معروف بكذا مذ خرج من بطن أمه، ولا يقال من ظهر أبيه.
ويقال في صفات النساء: " قب البطون نواعم " . ويقال: خمصانة البطن، ولا يقال: خمصانة الظهر.
ويقال: فلان بطن بالأمور، ولا يقال: ظهر. ويقال: بطانة الرجل وطهارته، فيبدأ بالبطانة.
وبطن القرطاس خير من ظهره، وبطن الصحيفة موضع النفع منها لا ظهرها، وببطن القلم يكتب لا بظهره، وببطن السكين يقطع لا بظهرها.
وخلق الله جل وعز آدم من طين، ونسله من بطن حواء.
ورأينا أكثر المنافع من الأغذية في البطون لا في الظهور؛ فبطون البقر أطيب من ظهورها، وبطن الشاة كذلك.
ومن أفضل صفات علي رضي الله عنه أن كان أخمص بطينا.
وأسمع من غنائهم:
بطني على بطنك يا جارية ... لا نمطاً نبغي ولا باريه
ولم يقل ظهري على ظهرك، فجعل مماسة البطن غانياً عن الوطاء، كافياً من الغطاء.
ولو لم يكن في البطن من الفضيلة إلا أن الوجه الحسن، والمنظر الأنيق من حيزه، وفي الظهر من العيب، إلا أن الدبر في جانبه، لكان فيها أوضح الأدلة على كرم البطن ولؤم الظهر.
ولم نرهم وصفوا الرجل بالفحولة والشجاعة إلا من تلقائه، وبالخبث والأبنة إلا من ظهره.
وإذا وصفوا الشجاع قالوا: مر فلان قدماً، وإذا وصفوا الجبان قالوا: ولى مدبراً.
ولشتان بين الوصفين: بين من يلقى الحرب بوجهه وبين من يلقاه بقفاه، وبين الناكح والمنكوح، والراكب والمركوب، والفاعل والمفعول، والآتي والمأتي، والأسفل والأعلى، والزائر والمزور، والقاهر والمقهور.
ولما رأينا الكنوز العادية والذخائر النفيسة، والجواهر الثمينة مثل الدر الأصفر، والياقوت الأحمر، والزمرد الأخضر، والمسك والعنبر والعقيان واللجين، والزرنيخ والزئبق، والحديد والبورق، والنفط والقار، وصنوف الأحجار، وجميع منافع العالم وأدواتهم وآلاتهم، لحربهم وسلمهم، وزرعهم وضرعهم، ومنافعهم ومرافقهم ومصالحهم، وسائر ما يأكلونه ويشربونه، ويلبسونه ويشمونه، وينتفعون برائحته وطعمه، ودائع في بطون الأرض، وإنما يستنبط منها استنباطاً، ويستخرج منها استخراجاً، وأن على ظهرها الهوام القاتلة، والسباع العادية التي في أصغرها تلف النفوس ودواعي الفناء وعوارض البلاء، وأنه قل ما يمشي على ظهرها من دابة، إلا وهو للمرء عدو، وللموت رسول، وعلى الهلكة دليل لم يمتنع في عقولنا، وآرائنا ومعرفتنا من الإقرار بتفضيل البطن على الظهر في كل وقت، وعلى كل حال.
ومن فضيلة البطن على الظهر أن أحداً إن ابتلي فيه بداء كان مستوراً، وإن شاء أن يكتمه كتمه عن أهله، ومن لا ينطوي عنه شيء من أمره، وغابر دهره.
ومن بلية الظهر أنه إن كان داء ظهر وبان، مثل الجرب والسلع والخنازير وما أشبهها، مما سلمت منه البطون وجعل خاصاً في الظهور.
وفضل الله تعالى البطون بأن جعل إتيان النساء، وطلب الولد، والتماس الكثرة مباحاً من تلقائها، محرماً في المحاش من ورائها، لأنه حرام على الأمة إتيان النساء في أدبارهن، لما جاء في الحديث عن الصادق صلى الله عليه وسلم: " لا تأتوا النساء في محاشهن " .
وقد ترى بطانة الثوب تقوم بنفسها، ولا ترى الظهارة تستغني.
وجعل الله تعالى البطن وعاءً لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعل أول دلائل نبوته أن أهبط إليه ملكاً حين أيفع، وهو يدرج مع غلمان الحي في هوازن، وهو مسترضع في بني سعد، حين شق عن بطنه، ثم استخرج قلبه فحشي نوراً، ثم ختم بخاتم النبوة. ولم يكن ذلك من قبل الظهر.
فصل منه
ومما فضلت به البطون: أن لحم السرة من الشاة أطيب اللحم، ولحم السرة من السمك الموصوف، وسرة حمار الوحش شفاء يتداوى به، ومن سرة الظباء يستخرج المسك. وهذا كله خاص للبطون ليس للظهور منه شيء.وبدأ الله عز وجل في ذكر الفواحش بما ظهر منها، ولم يبدأه بما بطن فقال: " إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن " ، فجعله ابتداءً في الذم.
والظهر في أكثر أحواله سمج، والبطن في أكثر أحواله حسن. والظهر في كل الأوقات وحشة ووحش، والبطن في كل الأوقات سكن وأنس.
ولم نرهم حين بالغوا في صفات النساء بدءوا بذكرها إلا من جهة البطن فقالوا: مدمجة الخصر، لذيذة العناق، طيبة النكهة، حلوة العينين، ساحرة الطرف، كأن سرتها مدهن، وكأن فاها خاتم، وكأن ثدييها حقان، وكأن عنقها إبريق فضة. وليس للظهور في شيء من تلك الصفات حظ.
وأنى نبلغ في صفة البطون، وإن أسهبنا، وكم عسى أن نحصي من معايب الظهور وإن اجتهدنا وبالغنا. ألا ترى أن حد الزاني ثمانون جلدة ما لم يكن محصناً، وحد اللوطي أن يحرق. وكلاهما فجور ورجاسة، وإثم ونجاسة. إلا أن أيسر المكروهين أحق بأن يميل إليه من ابتلي، وخير الشرين أحسن في الوصف من شر الشرين.
ولو أنا رأينا رجلاً في سوق من أسواق المسلمين يقبل امرأة فسألناه عن ذلك، فقال: امرأتي. وسألوها فقالت: زوجي لدرأنا عنهما الحد، لأن هذا حكم الإسلام. ولو رأيناه يقبل غلاماً لأدبناه وحبسناه؛ لأن الحكم في هذا غير الحكم في ذاك.
ألا ترى أنه ليس يمتنع في العقول والمعرفة أن يقبل الرجل في حب ما ملكت يمينه حتى يقبلها في الملا كما يقبلها في الخلا، يصدق ذلك حديث ابن عمر: " وقعت في يدي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة فما صبرت حتى قبلتها والناس ينظرون " .
فصل منه
وقد رأيت منك أيها الرجل إفراطك في وصف فضيلة الظهور، وفي محل الريبة وقعت، لأنا روينا عن عمر أنه قال: " من أظهر لنا خيراً ظننا به خيراً، ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً " .وإنما يصف فضل الظهر من كان مغرماً بحب الظهور، وإلى ركوبه صباً، وبالنوم عليه مستهتراً، وبالولوع بطلبه موكلا، ومن كان للحلال مبايناً، ولسبيله مفارقاً، ولأهله قالياً، وللحرام معاوداً، وبحبله مستمسكا وإلى قربه داعياً، ولأهله موالياً.
وقد اضطررتنا بتصييرك المفضول فاضلا، والعام خاصاً، والخسيس نفسياً ، والمحمود مذموماً، والمعروف منكراً، والمؤخر مقدماً، والمقدم مؤخراً، والحلال حراماً، والحرام حلالا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، والحظر إطلاقاً، والإطلاق حظراً، والحقيقة شبهة والشبهة حقيقة، والشين زيناً والزين شيناً، والزجر أمراً والأمر زجرأ، والوهم أصلا والأصل وهماً، والعلم جهلاً والجهل فضلاً إلى أن أدخلنا عليك الظن، وألحقناك التهمة، ونسبناك إلى غير أصلك، ونحلناك غير عقيدتك، وقضينا عليك بغير مذهبك. و " يداك أوكتا، وفاك نفخ " . فلا يبعد الله غيرك! أوجدنا أيها الضال المضل، المغلوب على رأيه، المسلوب فهمه، المولى على تمييزه، الناكص على عقبه في اختياره، المفارق لأصل عقده، المدبر بعد الإقبال في معرفته، الساقط بعد الهوى في ورطته، المتخلي من فهمه، الغني عن إفهامه، المضيع لحكمته، المنزوع عقله، المختلس لبه، المستطار جنانه، المعدوم بيانه، في الظهور بعد الفضائل التي أوجدناكها في البطون، إما قياساُ، وإما اختياراً، وإما ضرورة، وإما اختباراً وإما اكتساباً، أو في كتاب منزل، أو سنة مأثورة، أو عادة محمودة، أو صلاح على خير.
أم هل لك في مقالتك من إمام تأتم به، أو أستاذ تقتفى أثره، وتهتدي بهداه، وتسلك سننه.
فصل منه
وقد حضتني عليك عند انتهائي إلى هذا الموضع رقة، وتداخلتني لك رحمة، ووجدت لك بقية في نفسي؛ لأنه إنما يرحم أهل البلاء.والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به، وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً.
فرأيت أن أختم بأبسط الدعاء لك كتابي، وأن أحرز به أجري وثوابي، ورجوت أن تنيب وترجع بعد الجماح واللجاج، فإن للجواد استقلالاً بعد الكبوة،وللشجاع كرة بعد الكشفة، وللحليم عطفةً بعد النبوة.
وأنا أقول: جعلنا الله وإياك ممن أبصر رشده، وعرف حظه، وآثر الإنصاف واستعمله، ورفض الهوى وأطرحه؛ فإن الله تعالى لم يبتل بالهوى إلا من أضله، ولم يبعد إلا من استبعده.
فصل من صدر كتابه في النبل والتنبل وذم الكبر
قد قرأت كتابك وفهمته، وتتبعت كل ما فيه واستقصيته، فوجدت الذي ترجع إليه بعد التطويل، وتقف عنده بعد التحصيل، قد سلف القول منا في عيبه، وشاع الخبر عنا في ذمه، وفي النصب لأهله، والمباينة لأصحابه، وفي التعجب منهم، وإظهار النفي عنهم.والجملة أن فرط العجب إذا قارن كثرة الجهل، والتعرض للعيب إذا وافق قلة الإكتراث، بطلت المزاجر، وماتت الخواطر. ومتى تفاقم الداء، وتفاوت العلاج، صار الوعيد لغواً مطرحاً، والعقاب حكماً مستعملاً.
وقد أصبح شيخك، وليس يملك من عقابهم إلا التوقيف، ولا من تأديبهم إلا التعريف.
ولو ملكناهم ملك السلطان، وقهرناهم قهر الولاة، لنهكناهم عقوبة بالضرب، ولقمعناهم بالحصر.
والكبر - أعزك الله تعالى - باب لا يعد احتماله حلماً، ولا الصبر على أهله حزماً، ولا ترك عقابهم عفواً، ولا الفضل عليهم مجداً، ولا التغافل عنهم كرماً، ولا الإمساك عن ذمهم صمتاً.
واعلم أن حمل الغنى أشد من حمل الفقر، واحتمال الفقر أهون من احتمال الذل. على أن الرضا بالفقر قناعة وعز، واحتمال الذل نذالة وسخف. ولئن كانوا قد أفرطوا في لوم العشيرة، والتكبر على ذوي الحرمة، لقد أفرطت في سوء الاختيار، وفي طول مقامك على العار.
وأنت مع شدة عجبك بنفسك، ورضاك عن عقلك، خالطت من موته يضحك السن، وحياته تورث الحزن، وتشاغلك به من أعظم الغبن.
وشكوت تنبلهم عليك، واستصغارهم لك، وأنك أكثر منهم في المحصول، وفي حقائق المعقول. ولو كنت كما تقول لما أقمت على الذل ولما تجرعت الصبر وأنت بمندوحة منهم، وبنجوة عنهم. ولعارضتهم من الكبر بما يهضهم، ومن الامتعاض بما يبهرهم.
وقلت: ولو كانوا من أهل النبل عند الموازنة، أو كان معهم ما يغلط الناس فيه عند المقايسة لعذرتهم واحتججت عنهم، ولسترت عيبهم، ولرقعت وهيهم. ولكن أمرهم مكشوف، وظاهرهم معروف.
وإن كان أمرهم كما قلت، وشأنهم كما وصفت، فذاك ألوم لك، وأثبت للحجة عليك.
وسأؤخر عذلك إلى الفراغ منهم، وتوقيفك بعد التنويه بهم.
أقول: وإن كان النبل بالتنبل، واستحقاق العظم بالتعظم وبقلة الندم والاعتذار، وبالتهاون بالإقرار، فكل من كان أقل حياءً، وأتم قحة، وأشد تصلفاً، وأضعف عدة، أحق بالنبل وأولى بالعذر.
وليس الذي يوجب لك الرفعة أن تكون عند نفسك دون أن يراك الناس رفيعاً، وتكون في الحقيقة وضيعاً.
ومتى كنت من أهل النبل لم يضرك التنبل، ومتى لم تكن من أهله لم ينفعك التنبل.
وليس النبل كالرزق، يكون مرزوقاً الحرمان أليق به، ولا يكون نبيلاً السخافة أشبه به.
وكل شيء من أمر الدنيا قد يحظى به غير أهله، كما يحظى به أهله.
وما ظنك بشيء المروءة خصلة من خصاله، وبعد الهمة خلة من خلاله، وبهاء المنظر سبب من أسبابه، وجزالة اللفظ شعبة من شعبه، والمقامات الكريمة طريق من طرقه.
فصل منه
واعلم أنك متى لم تأخذ للنبل أهبته، ولم تقم له أداته، وتأته من وجهه، وتقم بحقه، كنت مع العناء مبغضاً، ومع التكلف مستصلفاً. ومن تبغض فقد استهدف للشتام، وتصدى للملام.فإن كان لا يحفل بالشتم، ولا يجزع من الذم، فعده ميتاً إن كان حياً؛ وكلباً إن كان إنساناً.
وإن كان ممن يكترث ويجزع، ويحس ويألم، فقد خسر الراحة والمحبة، وربح النصب والمذمة.
وبعد، فالنبل كلف بالمولي عنه، شنف للمقبل عليه، لازق بمن رفضه، شديد النفار ممن طلبه.
فصل منه
والسيد المطاع لم يسهل عليه الكظم، ولم يكن له كنف الحلم، إلا بعد طول تجرع للغيظ، ومقاساة للصبر. وقد كان معنى القلب دهره، ومكدود النفس عمره، والحرب سجال بينه وبين الحلم، ودول بينه وبين الكظم. فلما انقادت له العشيرة، وسمحت له بالطاعة، ووثق بظهور القدرة خلاف المعجزة سهل عليه الصبر، وغمر بعلوه دواعي الجزع، بطلت المجاذبة، وذهبت المساجلة.والذي كان دعاه إلى تكلف الحلم في بدء أمره وإلى احتمال المكروه في أول شأنه، الأمل في الرياسة، والطمع في السيادة، ثم لم يتم له أمره، ولم يستحكم له عقده إلا بعد ثلاثة أشياء: الاحتمال، ثم الاعتياد، ثم ظهور طاعة الرجال.
ولولا خوف جميع المظلومين من أن يظن بهم العجز، وألا يوجه احتمالهم إلى الذل لزاحم السادة في الحلم رجال ليسوا في أنفسهم بدونهم، ولغمرهم بعض من ليس معه من أسبابهم.
فصل منه
ولا يكون المرء نبيلاً حتى يكون نبيل الرأي، نبيل اللفظ، نبيل العقل، نبيل الخلق، نبيل المنظر، بعيد المذهب في التنزه، طاهر الثوب من الفحش، إن وافق ذلك عرقاً صالحاً، ومجداً تالداً.فالخارجي قد يتنبل بنفسه، والنابتي قد يخرج بطبعه. ولكل عز أول، وأول كل قديم حادث.
ومن حقوق النبل أن تتواضع لمن هو دونك، وتنصف من هو مثلك، وتتنبل على من هو فوقك.
فصل منه
وكان بعض الأشراف في زمان الأحنف، لا يحتقر أحداً، ولا يتحرك لزائر، وكان يقول: " ثهلان ذو الهضبات ما يتحلحل " فكان الأحنف ما يزداد إلا علواً، وكان ذلك الرجل لا يزداد إلا تسفلاً.وقد ذم الله تعالى المتكبرين، ولعن المتجبرين، وأجمعت الأمة على عيبه، والبراءة منه، وحتى سمي المتكبر تائهاً، كالذي يختبط في التية بلا أمارة، ويتعسف الأرض بلا علامة.
ولعل قائلاً أن يقول: لو كان اسم المتكبر قبيحاً، ولو كان المتكبر مذموماً، لما وصف الله تعالى بهما نفسه، ولما نوه بهما في التنزيل حين قال: " الجبار المتكبر " ، ثم قال: " له الأسماء الحسنى " .
قلنا لهم: إن الإنسان المخلوق المسخر، والضعيف الميسر، لا يليق به إلا التذلل، ولا يجوز له إلا التواضع.
وكيف يليق الكبر بمن إن جاع صرع، وإن شبع طغى، وما يشبه الكبر بمن يأكل ويشرب، ويبول وينجو. وكيف يستحق الكبر ويستوجب العظمة من ينقصه النصب، ويفسده الراحة؟.
فإذا كان الكبر لا يليق بالمخلوق فإنما يليق بالخالق؛ وإنما عاند الله تعالى بالكبر لتعديه طوره، ولجهله لقدره، وانتحاله ما لا يجوز إلا لربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " العظمة رداء الله، فمن نازعه رداءه قصمه " .
فصل منه
والنبيل لا يتنبل، كما أن الفصيح لا يتفصح؛ لأن النبيل يكفيه نبله عن التنبل، والفصيح تغنيه فصاحته عن التفصح. ولم يتزيد أحد قط إلا لنقص يجده في نفسه، ولا تطاول متطاول إلا لوهن قد أحس به في قوته.والكبر من جميع الناس قبيح، ومن كل العباد مسخوط، إلا أنه عند الناس من عظماء الأعراب، وأشباه الأعراب أوجد، وهو لهم أسرع، لجفائهم وبعدهم من الجماعة، ولقلة مخالطتهم لأهل العفة والرعة، والأدب والصنعة.
فصل منه
ولم نر الكبر يسوغ عندهم ويستحسن إلا في ثلاثة مواضع: من ذلك أن يكون المتكبر صعباً بدوياً، وذا عرضية وحشياً، ولا يكون حضرياً ولا مدرياً، فيحمل ذلك منه على جهة الصعوبة ومذهب الجاهلية، وعلى العنجهية والأعرابية.أو يكون ذلك منه على جهة الانتقام والمعارضة، والمكافأة والمقابلة.
أو على أن لا يكون تكبره إلا على الملوك والجبابرة، والفراعنة وأشباه الفراعنة.
وصاحبك هذا خارج من هذه الخصال، مجانب لهذه الخلال. إن أصاب صديقاً تعظم عليه، وإن أتاه ضيف تغافل عنه، وإن أتاه ضعيف من عليه، وإن صادف حليماً اعتمر به.
وينبغي أن يكون خضوعه لمن فوقه على حسب تكبره على من دونه.
ومن صفة اللئيم أن يظلم الضعيف، ويظلم نفسه للقوي، ويقتل الصريع، ويجهز على الجريح، ويطلب الهارب، ويهرب من الطالب، ولا يطلب من الطوائل إلا ما لا خطار فيه ولا يتكبر إلا حيث لا يرجع مضرته عليه، ولا يقفو التقية ولا المروءة، ولا يعمل على حقيقته.
ومن اختار أن يبغي تبدى، ومن أراد أن يسمع قوله ساء خلقه، إذ كان لا يحفل ببغض الناس له ووحشة قلوبهم منه، واحتيالهم في مباعدته، وقلة ملابسته.
وليس يأمن اللئيم على إتيان جميع ما اشتمل عليه اسم اللؤم إلا حاسد.
فإذا رأيته يعق أباه، ويحسد أخاه، ويظلم الضعيف، ويستخف بالأديب، فلا تبعده من الخيانة، إذ كانت الخيانة لؤماً؛ ولا من الكذب، إذ كان الكذب لؤماً؛ ولا من النميمة، إذ كانت النميمة لؤماً. ولا تأمنه على الكفر فإنه ألأم اللؤم، وأقبح الغدر.
ومن رأيته منصرفاً عن بعض اللؤم، وتاركاً لبعض القبيح، فإياك أن توجه ذلك منه على التجنب له، والرغبة عنه، والإيثار لخلافه، ولكن على أنه لا يشتهيه أو لا يقدر عليه، أو يخاف من مرارة العاقبة أمراً يعفي على حلاوة العاجل؛ لأن اللؤم كله أصل واحد وإن تفرقت فروعه، وجنس واحد وإن اختلفت صوره، والفعل محمول على غلبته، تابع لسمته. والشكل ذاهب على شكله، منقطع إلى أصله، صائر إليه وإن أبطأ عنه، ونازع إليه وإن حيل دونه. وكذلك تناسب الكرم وحنين بعضه لبعض.
ولم تر العيون، ولا سمعت الآذان، ولا توهمت العقول عملاً اجتباه ذو عقل، أو اختاره ذو علم، بأوبأ مغبة، ولا أنكد عاقبة، ولا أوخم مرعىً، ولا أبعد مهوىً، ولا أضر على دين، ولا أفسد لعرض، ولا أوجب لسخط الله، ولا أدعى إلى مقت الناس، ولا أبعد من الفلاح، ولا أظهر نفوراً عن التوبة، ولا أقل دركاً عند الحقيقة، ولا أنقض للطبيعة، ولا أمنع من العلم، ولا أشد خلافاً على الحلم، من التكبر في غير موضعه، والتنبل في غير كنهه.
وما ظنك بشيء العجب شقيقه، والبذخ صديقه، والنفج أليفه، والصلف عقيده.
والبذاخ متزيد، والنفاج كذاب، والمتكبر ظالم، والمعجب صغير النفس. وإذا اجتمعت هذه الخصال، وانتظمت هذه الخصال في قلب طال خرابه، واستغلق بابه.
وشر العيوب ما كان مضمناً بعيوب، وشر الذنوب ما كان علة للذنوب.
والكبر أول ذنب كان في السماوات والأرض، وأعظم جرم كان من الجن والإنس، وأشهر تعصب كان في الثقلين، وعنه لج إبليس في الطغيان، وعتا على رب العالمين، وخطأ ربه في التدبير، وتلقى قوله بالرد. ومن أجله استوجب السخطة، وأخرج من الجنة، وقيل له: " ما يكون لك أن تتكبر فيها " .
ولإفراطه في التعظيم خرج إلى غاية القسوة، ولشدة قسوته اعتزم على الإصرار، وتتايع في غاية الإفساد، ودعا إلى كل قبيح، وزين كل شر، وعن معصيته أخرج آدم من الجنة، وشهر في كل أفق وأمة، ومن أجله نصب العداوة لذريته، وتفرغ من كل شيء إلا من إهلاك نسله، فعادى من لا يرجوه ولا يخافه، ولا يضاهيه في نسب، ولا يشاكله في صناعة، وعن ذلك قتل الناس بعضهم بعضاً، وظلم القوي الضعيف، ومن أجله أهلك الله الأمم بالمسخ والرجف، وبالخسف وبالطوفان، والريح العقيم، وأدخلهم النار، وأقنطهم من الخروج.
والكبر هو الذي زين لإبليس ترك السجود، ووهمه شرف الأنفة، وصور له عز الانتقاض، وحبب إليه المخالفة، وآنسه بالوحدة والوحشة، وهون عليه سخط الرب، وسهل عليه عقاب الأبد، ووعده الظفر، ومناه السلامة، ولقنه الاحتجاج بالباطل، وزين له قول الزور، وزهده في جوار الملائكة، وجمع له خلال السوء، ونظم له خلال الشر؛ لأنه حسد والحسد ظلم، وكذب والكذب ذل، وخدع والخديعة لؤم. وحلف على الزور، وذلك فجور. وخطأ ربه، وتخطئة الله جهل، وأخطأ في جلي القياس وذلك غي، ولج واللجاج ضعف. وفرق بين التكبر والتبدي. وجمع بين الرغبة عن صنيع الملائكة وبين الدخول في أعمال السفلة.
واحتج بأن النار خير من الطين. ومنافع العالم نتائج أربعة أركان: نار يابسة حارة، وماء بارد سيال، وأرض باردة يابسة، وهواء حار رطب. ليس منها شيء مع مزاوجته لخلافه إلا وهو محي مبق. على أن النار نقمة الله من بين جميع الأصناف، وهي أسرعهن إتلافاً لما صار فيها. وأمحقهن لما دنا منها.
هذا كله ثمرة الكبر، ونتاج النية. والتكبر شر من القسوة، كما أن القسوة شر المعاصي. والتواضع خير الرحمة، كما أن الرحمة خير الطاعات.
والكبر معنىً ينتظم به جماع الشر، والتواضع معنىً ينتظم به جماع الخير، والتواضع عقيب الكبر، والرحمة عقيب القسوة. فإذا كان للطاعة قدر من الثواب فلتركها وعقيبها، ولما يوازنها ويكايلها، مثل ذلك القدر من العقاب. وموضع الطاعة من طبقات الرضا، كموضع تركها من طبقات السخط إذ كانت الطاعة واجبة، والترك معصية.
والكبر من أسباب القسوة. ولو كان الكبر لا يعتري إلا الشريف والجميل، أو الجواد، أو الوفي أو الصدوق، كان أهون لأمره، وأقل لشينه، وكان يعرض لأهل الخير، وكان لا يغلط فيه إلا أهل الفضل، ولكنا نجده في السفلة، كما نجده في العلية، ونجده في القبيح كما نجده في الحسن، وفي الدميم كما نجده في الجميل، وفي الدني الناقص، كما نجده في الوفي الكامل، وفي الجبان كما نجده في الشجاع، وفي الكذوب كما نجده في الصدوق، وفي العبد كما نجده في الحر، وفي الذمي ذي الجزية والصغار والذلة، كما نجده في قابض جزيته والمسلط على إذلاله.
ولو كان في الكبر خير لما كان في دهر الجاهلية أظهر منه في دهر الإسلام، ولما كان في العبد أفشى منه في الحر، ولما كان في دهره الجاهلية أظهر منه في دهره الإسلام، ولما كان في العبد أفشى منه في الحر، ولما كان في السند أعم منه في الروم والفرس.
وليس الذي كان فيه آل ساسان وأنو شروان وجميع ولد أزدشير بن بابك كان من الكبر في شيء. تلك سياسة للعوام، وتفخيم لأمر السلطان، وتسديد للملك.
ولم يكن في الخلفاء أشد نخوة من الوليد بن عبد الملك، وكان أجهلهم وألحنهم. وما كان في ولاة العراق أعظم كبراً من يوسف بن عمر، وما كان أشجعهم ولا أبصرهم، ولا أتمهم قواماً، ولا أحسنهم كلاماً.
ولم يدع الربوبية ملك قط إلا فرعون، ولم يك مقدماً في مركبه، ولا في شرف حسبه، ولا في نبل منظره، وكمال خلقه، ولا في سعة سلطانه وشرف رعيته وكرم ناحيته. ولا كان فوق الملوك الأعاظم والجلة الأكابر، بل دون كثير منهم في الحسب وشرف الملك وكرم الرعية، ومنعة السلطان، والسطوة على الملوك.
ولو كان الكبر فضيلة وفي التيه مروءة، لما رغب عنه بنو هاشم ولكان عبد المطلب أولى الناس منه بالغاية، وأحقهم بأقصى النهاية.
ولو كان محمود العاجل ومرجو الآجل، وكان من أسباب السيادة أو من حقوق الرياسة، لبادر إليه سيد بني تميم، وهو الأحنف بن قيس؛ ولشح عليه سيد بكر بن وائل وهو ملك، ولاستولى عليه سيد الأزد وهو المهلب.
ولقد ذكر أبو عمرو بن العلاء جميع عيوب السادة، وما كان فيهم من الخلال المذمومة، حيث قال: " ما رأينا شيئاً يمنع من السودد إلا وقد وجدناه في سيد: وجدنا البخل يمنع من السودد، وكان أبو سفيان بن حرب بخيلا. والعهار يمنع من السودد، وكان عامر بن الطفيل سيداً، وكان عاهراً. والظلم يمنع من السودد، وكان حذيفة بن بدر ظلوماً، وكان سيد غطفان. والحمق يمنع من السودد، وكان عتيبة بن حصن محمقاً، وكان سيداً. والإملاق يمنع من السودد، وكان عتبة بن ربيعة مملقاً. وقلة العدد تمنع من السودد وكان شبل بن معبد سيداً، ولم يكن من عشيرته بالبصرة رجلان. والحداثة تمنع من السودد، وساد أبو جهل وما طر شاربه، ودخل دار الندوة وما استوت لحيته.
فذكر الظلم، والحمق، والبخل، والفقر، والعهار، وذكر العيوب ولم يذكر الكبر؛ لأن هذه الأخلاق وإن كانت داءً فإن في فضول أحلامهم وفي سائر أمورهم ما يداوى به ذلك الداء، ويعالج به ذلك السقم؛ وليس الداء الممكن كالداء المعضل، وليس الباب المغلق كالمستبهم؛ والأخلاق التي لا يمكن معها السودد، مثل الكبر والكذب والسخف، ومثل الجهل بالسياسة.
وخرجت خارجة بخراسان فقيل لقتيبة بن مسلم: لو وجهت إليهم وكيع بن أبي سود لكفاهم فقال: وكيع رجل عظيم الكبر، في أنفه خنزوانة، وفي رأسه نعرة، وإنما أنفه في أسلوب؛ ومن عظم كبره اشتد عجبه، ومن أعجب برأيه لم يشاور كفياً، ولم يؤامر نصيحاً، ومن تبجح بالانفراد وفخر بالاستبداد كان من الظفر بعيداً، ومن الخذلان قريباً، والخطاء مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة. وإن كانت الجماعة لا تخطىء والفرقة لا نصيب.
ومن تكبر على عدوه حقره، وإذا حقره تهاون بأمره. ومن تهاون بخصمه ووثق بفضل قوته قل احتراسه، ومن قل احتراسه كثر عثاره.
وما رأيت عظيم الكبر صاحب حرب إلا كان منكوباً ومهزوماً ومخدوعاً. ولا يشعر حتى يكون عدوه عنده، وخصمه فيما يغلب عليه أسمع من فرس، وأبصر من عقاب، وأهدى من قطاة، وأحذر من عقعق، وأشد إقداماً من الأسد، وأوثب من فهد، وأحقد من جمل، وأروغ من ثعلب، وأغدر من ذئب، وأسخى من لافظة، وأشح من صبي، وأجمع من ذرة، وأحرص من كلب، وأصبر من ضب. فإن النفس إنما تسمح بالعناية على قدر الحاجة، وتتحفظ على قدر الخوف، وتطلب على قدر الطمع، وتطمع على قدر السبب.
فصل منه
وأقول بعد هذا كله: إن الناس قد ظلموا أهل الحلم والعزم، حين زعموا أن الذي يسهل عليهم الاحتمال معرفة الناس بقدرتهم على الانتقام، فكيف والمذكور بالحلم والمشهور بالاحتمال يقيض له من السفهاء، ويؤتى له من أهل البذاء ما لا يقوم له صبر، ولا ينهض به عزم. بل على قدر حلمه يتعرض له، وعلى قدر عزمه يمتحن صبره ولأن الذي سهل عليه الحلم، ومكنه من العزم، معرفة الناس بقدرته على الانتقام، واقتداره على شفاء الغيظ؛ فإن منعه لنفسه، ومجاذبته لطبعه مع الغيظ الشديد، والقدرة الظاهرة، أشد عليه في المزاولة وأبلغ في المشقة والمكابدة، من صبر الشكل على أذى شكله، واحتمال المظلوم عن مثله، وإن خاف الطمس، وتوقع العيب.فصل منه
ومن بعد هذا، فمن شأن الأيام أن يظلم المرء أكثر محاسنه ما كان تابعاً، فإذا عاد متبوعاً عادت عليه من محاسن غيره بأضعاف ما منعته من محاسن نفسه، حتى يضاف إليه من شوارد الأفعال، ومن شواذ المكارم إن كان سيداً، ومن غريب الأمثال إن كان منطيقاً، ومن خيار القصائد إن كان شاعراً، مما لا أمارات لها، ولا سمات عليها.
فكم من يد بيضاء وصنيعة غراء، ضلت فلم يقم بها ناشد، وخفيت فلم يظهرها شاكر. والذي ضاع للتابع قبل أن يكون متبوعاً، أكثر مما حفظ، والذي نسي أكثر مما ذكر، وما ظنك بشيء بقيته تهب السادة، ومشكوره يهب الرياسة، على قلة الشكر، وكثرة الكفر.
وقد يكون الرجل تام النفس ناقص الأداة، فلا يستبان فضله، ولا يعظم قدره، كالمفرج الذي لا عشيرة له، والإتاوي الذي لا قوم له. وقد يعظم المفرج الذي لا ولاء له ولا عقد جوار، ولا عهد حلف، إذا برع في الفقه وبلغ في الزهد، بأكثر من تعظيم السيد، كجهة تعظيم الديان. كما أن طاعة السلطان غير طاعة السادة، والسلطان إنما يملك أبدان الناس،ولهم الخيار في عقولهم، وكذلك الموالي والعبيد.
وطاعة الناس للسيد، وطاعة الديان طاعة محبة ودينونة، والقلوب أطوع لهما من الأبدان، إلا أن يكون السلطان مرضياً، فإن كان كذلك فهو أعظم خطراً من السيد، وأوجه عند الله من ذلك الديان.
وربما ساد الأتاوي لأنه عربي على حال. والمفرج لا يسود أبداً لأنه عجمي لا حلف له، ولا عقد جوار، ولا ولاء معروف، ولا نسب ثابت. وليس التسويد إلا في العرب، والعجم لا تطيع إلا للملوك.
والذي أحوج العرب في الجاهلية إلى تسويد الرجال وطاعة الأكابر، بعد دورهم من الملوك والحكام والقضاة، وأصحاب الأرباع، والمسالح والعمال. فكان السيد، في منعهم من غيرهم ومنع غيرهم منهم، ووثوب بعضهم عل بعض، في كثير من معاني السلطان.
فصل من رسالته إلى أبي الفرج الكاتب
في المودة والخلطة
أطال الله بقاءك، وأعزك وأكرمك، وأتم نعمته عليك.زعم - أبقاك الله - كثير ممن يقرض الشعر ويروي معانيه، ويتكلف الأدب ويجتبيه، أنه قد يمدح المرجو المأمول، والمغشي المزور، بأن يكون مخدوعاً، وعمي الطرف مغفلا، وسليم الصدر للراغبين، وحسن الظن بالطالبين، قليل الفطنة لأبواب الاعتذار، عاجزاً عن التخلص إلى معاني الاعتلال، قليل الحذق برد الشفعاء، شديد الخوف من مياسم الشعراء، حصراً عند الاحتجاج للمنع، سلس القياد إذا نبهته للبذل، واحتجوا بقول الشاعر:
إيت الخليفة فاخدعه بمسألة ... إن الخليفة للسؤال ينخدع
فانتحال المأمول للغفلة التي تعتري الكرام، وانخداع الجواد لخدع الطالبين ومخاريق المستميحين، باب من التكرم، ومن استدعاء الراغب، والتعرض للمجتدي، والتلطف لاستخراج الأموال، والاحتيال لحل عقد الأشحاء، وتهييج طبائع الكرام.
وأنا أزعم - أبقاك الله - أن إقرار المسئول بما ينحل من ذلك نوك، وإضماره لؤم، حتى تصح القسمة، ويعتدل الوزن.
وأنا أعوذ بالله من تذكير يناسب الاقتضاء، ومن اقتضاء يضارع الإلحاح. ومن حرص يعود إلى الحرمان، ومن رسالة ظاهرها زهد، وباطنها رغبة. فإن أسقط الكلام وأوغده، وأبعده من السعادة وأنكده، ما أظهر النزاهة وأضمر الحرص، وتجلى للعيون بعين القناعة، واستشعر ذلة الافتقار.
وأشنع من ذلك، وأقبح منه وأفحش، أن يظن صاحبه أن معناه خفي وهو ظاهر، وتأويله بعيد الغور وهو قريب القعر.
فنسأل الله تعالى السلامة فإنها أصل النعمة عليكم، ونحمده على اتصال نعمتنا بنعمتكم، وما ألهمنا الله من وصف محاسنكم.
والحمد لله الذي جعل الحمد مستفتح كتابه، وآخر دعوى أهل جنته.
ولو أن رجلاً اجتهد في عبادة ربه، واستفرغ مجهوده في طاعة سيده، ليهب له الإخلاص في الدعاء لمن أنعم عليه؛ وأحسن إليه، لكان حرياً بذلك أن يدرك أقصى غاية الكرم في العاجل، وأرفع درجات الكرامة في الآجل.
وعلى أني لا أعرف معنىً أجمع لخصال الشكر، ولا أدل على جماع الفضل، من سخاوة النفس بأداء الواجب.
ونحن وإن لم نكن أعطينا الإخلاص جميع حقه، فإن المرء مع من أحب، وله ما احتسب.
ولا أعلم شيئاً أزيد في السيئة من استصغارها، ولا أحبط للحسنة من العجب بها.
ومما يستديم الخطأ لبث لبتقصير وإهمال النفس، وترك التوقف، وقلة المحاسبة، وبعد العهد بالتثبت. ومهما رجعنا إليه من ضعف في عزم، وهان علينا ما نفقد من مناقل الحلم، فإنا لا نجمع بين التقصير والإنكار.
ونعوذ بالله أن نقصر في ثناء على محسن، أو دعاء لمنعم. ولئن اعتذرنا لأنفسنا بصدق المودة وبجميل الذكر، فلما يعد لكم، من تحقق الآمال، والنهوض بالأثقال أكثر.
على أنكم لم تحملونا إلا الخف، وقد حملناكم الثقل. ولم تسألونا الجزاء على إحسانكم، وقد سألناكم الجزاء على ما سألناكم. ولم تكلفونا ما يجب لكم، وكلفناكم ما لا يجب.
ومن إفراط الجهل أن نتذكر حقنا في حسن الحظ، ولا نتذكر حقكم في تصديق ذلك الظن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت عليه مؤنة الناس " .
وأنا أسأل الله الذي ألزمكم المؤن الثقال، ووصل بكم آمال الرجال، وامتحنكم بالصبر على تجرع المرار، وكلفكم مفارقة المحبوب من الأموال، أن يسهلها عليكم، ويحببها إليكم، حتى يكون شغفكم بالإحسان الداعي إليه، وصبابتكم بالمعروف الحامل عليه، وحتى يكون حب التفضل، والمحبة الاعتقاد المنن الغاية التي تستدعي المدبر، والنهاية التي تعذر المقصر، وحتى تكرهوا على الخير من أخطأ حظه، وتفتحوا باب الطلب لمن قصر به العجز.
ثم اعلم - أصلحك الله - أن الذي وجد في العبرة، وجرت عليه التجربة، واتسق به النظم، وقام عليه وزن الحكم، واطرد منه النسق، وأثبته الفحص، وشهدت له العقول. أن من أول أسباب الخلطة، والدواعي إلى المحبة، ما يوجد على بعض الناس من القبول عند أول وهلة، وقلة انقباض النفوس مع أول لحظة، ثم اتفاق الأسباب التي تقع بالموافقة عند أول المجالسة، وتلاقي النفوس بالمشاكلة عند أول الخلطة.
والأدب أدبان: أدب خلق، وأدب رواية، ولا تكمل أمور صاحب الأدب إلا بهما، ولا يجتمع له أسباب التمام إلا من أجلهما، ولا يعد في الرؤساء، ولا يثنى به الخنصر في الأدباء، حتى يكون عقله المتأمر عليهما، والسائس لهما.
فصل منه
فإن تمت بعد ذلك أسباب الملاقاة تمت المصافاة، وحن الإلف إلى سكنه. والشأن قبل ذلك لما يسبق إلى القلب، ويخف على النفس، ولذلك احترس الحازم المستعدى عليه من السابق إلى قلب الحاكم عليه.وكذلك التمسوا الرفق والتوفيق، والإيجاز وحسن الاختصار، وانخفاض الصوت، وأن يخرج الظالم كلامه مخرج لفظ المظلوم.
نعم، وحتى يترك اللحن بحجته بعد، ويخلف الداهية كثيراً من أدبه، ويغض من محاسن منطقه. التماساً لمواساة خصمه في ضعف الحيلة، والتشبه به في قلة الفطنة.
نعم، وحتى يكتب كتاب سعاية ومحل وإغراق وتحد، فيلحن في إعرابه، ويتسخف في ألفاظه، ويتجنب القصد، ويهرب من اللفظ المعجب ليخفي مكان حذقه، ويستر موضع رفقه، حتى لا يحترس منه الخصم، ولا يتحفظ منه صاحب الحكم، بعد أن لا يضر بعين معناه، ولا يقصر في الإفصاح عن تفسير مغزاه، وهذا هو الموضع الذي يكون العي فيه أبين، وذو الغباوة أفطن، والردي أجود، والأنوك أحزم، والمضيع أحكم؛ إذ كان غرضه الذي إياه يرمي، وغايته التي إليها يجري، الانتفاع بالمعنى المتخير دون المباهاة باللفظ، وإنما كانت غايته إيصال المعنى إلى القلب دون نصيب السمع من اللفظ المونق، والمعنى المتخير؛ بل ربما لم يرض باللفظ السليم حتى يسقمه ليقع العجز موقع القوة، ويعرض العي في محل البلاغة. إذا كان حق ذلك المكان اللفظ الدون، والمعنى الغفل.
هذا إذا كان صاحب القصة ومؤلف لفظ المحل والسعاية، ممن يتصرف قلمه، ويعلل لسانه، ويلتزق في مذاهبه، ويكون في سعة وحل لأن يحط نفسه إلى طبقة الذل وهو عزيز، ومحل العي وهو بليغ، ويتحول في هيئة المظلوم وهو ظالم، ويمكنه تصوير الباطل في صورة الحق، وستر العيوب بزخرف القول؛ وإذا شاء طفا، وإذا شاء رسب، وإذا شاء أخرجه غفلاً صحيحاً.
وما أكثر من لا يحسن إلا الجيد، فإن طلب الردى جاوزه. كما أنه ما أكثر من لا يستطيع إلا الردى، فإن طلب الجيد قصر عنه.
وليس كل بليغ يكون بذلك الطباع، وميسر الأداة، وموسعاً عليه في تصريف اللسان، وممنونا عليه في تحويل القلم.
وما أكثر من البصراء من يحكي العميان، ويحول لسانه إلى صورة لفظ الفأفاء بما لا يبلغه الفأفاء ولا يحسنه التمتام. وقد نجد من هو أبسط لساناً وأبلغ قلماً، لا يستطيع مجاوزة ما يشركه، والخروج مما قصر عنه.
فصل منها
ولولا الحدود المحصلة والأقسام المعدلة، لكانت الأمور سدىً، والتدابير مهملة، ولكانت عورة الحكيم بادية، ولاختلطت السافلة بالعالية.فصل منها
وأنا أقول بعد هذا كله: لو لم أضمر لكم محبة قديمة، ولم أضر بكم بشفيع من المشاكلة، ولا سبب الأديب إلى الأديب، ولم يكن علي قبول، ولا علي حلاوة عند المحصول، ولم أكن إلا رجلاً من عرض المعارف، ومن جمهور الأتباع لكان في إحسانكم إلينا، وإنعامكم علينا، دليل على أنا قد أخلصنا المحبة، وأصفينا لكم المودة.وإذا عرفتم ذلك بالدليل النير الذي أنتم سببه، والبرهان الواضح الذي إليكم مرجعه، لم يكن لنا عند الناس إلا توقع ثمرة الحب، ونتيجة جميل الرأي، وانتظار ما عليه مجازاة القلوب.
وبقدر الإنعام تجود النفوس بالمودة، وبقدر المودة تنطلق الألسن بالمدحة.
وهذه الوسيلة أكثر الوسائل وأقواها في نفسي: أني لم أصل سببي بمحرم غمر ولا بمبخل غفل، ولا بضيق العطن حديث الغنى، ولا بزمر المروة مستنبط الثرى؛ بل وصلته بحمال أثقال ومقارع أبطال، وبمن ولد في اليسر وربي فيه، وجرى منه على عرق ونزع إليه.
فصل منها
ولا خير في سمين لا يحتمل هزال أخيه، وصحيح لا يجبر كسر صاحبه.فصل منها
وقد تنقسم المودة إلى ثلاث منازل: منها: ما يكون على اهتزاز الأريحية وطبع الحرية.ومنها: ما يكون على قدر فرط وسائل الفاقة ومنها: مايحسن موقعه على قدر طباع الحرص وجشع النفس.
فأرفعها منازل حب المشغوف شكر النعمة. وهو الذي يدوم شكره، ويبقى على الأيام وده. والثاني هو الذي إنما اشتد حبه على قدر موضع المال من قلب الحريص الجشع، واللئيم الطمع. فهذا الذي لا يشكر، وإن شكر لم يشكر إلا ليستزيد، ولم يمدح إلا ليستمد. وعلى أنه لا يأتي الحمد إلا زحفاً، ولا يفعله إلا تكلفاً.
وأنا أسأل الله الذي قسم له أفضل الحظوظ في الإنعام، أن يقسم لنا أفضل الحظوظ في الشكر. وما غاية قولنا هذا ومدار أمرنا إلا على طاعة توجب الدعاء، وحرية توجب الثناء، شاكرين كنا أو منعمين، وراجين كنا أو مرجوين.
ومن صرف الله حاجته إلى الكرام، وعدل به عن اللئام فلا يعدن نفسه في الراغبين ولا في الطالبين المؤملين، لأن من لم يجرع مرارة المطال، ولم يمد للرحيل التسويف، ويقطع عنقه بطول الانتظار، ويحمل مكروه ذل السؤال، ويحمل على طمع يحثه يأس، كان خارجاً من حدود المؤملين.
ومن استولى على طمعه الثقة بالإنجاز، وعلى طلبته اليقين بسرعة الظفر، وعلى ظفره الجزيل من الإفضال، وعلى إفضاله العلم بقلة التثريب، بالسلام من التنغيص بالتماس الشكر، وبالبكور وبالرواح وبالخضوع إذا دخل، والاستكانة إذا جلس. ثم مع ذلك لم يكن ما أنعم به عليه ثواباً لسالف يد، ولا تعويضاً من كد، كانت النعمة محضة خالصة، ومهذبة صافية، وهب نعمتكم التي ابتدأتمونا بها.
ولا تكون النعمة سابغة ولا الأيدي شاملة، ولا الستر كثيفاً ذيالاً، وكثير العرض مطبقاً، ودون الفقر حاجزاً، وعلى الغنى ملتحفاً، حتى يخرج من عندكم، ثم يحتسب إلى شاكر حر.
فصل منها
وأنتم قوم تقدمتم بابتناء المكارم في حال المهلة، وأخذتم لأنفسكم فيها بالثقة على مقادير ما مكنتم الأواخي، ومددتم الأطناب، وثبتم القواعد. ولذلك قال الأول:عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود
وأبو الفرج - أعزه الله - فتى العسكرين، وأديب المصرين جمع أريحية الشباب، ونجابة الكهول، ومحبة السادة، وبهاء القادة وأخلاق الأدباء، ورشاقة عقول الكتاب، والتغلغل إلى دقائق الصواب، والحلاوة في الصدور، والمهابة في العيون، والتقدم في الصناعة، والسبق عند المحاورة، شقيق أبيه وشبه جده، حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة. لم يتأخر عنهما إلا في ما لا يجوز أن يتقدمهما فيه، ولم يقصر عن شأوهما إلا بقدر ما قصرا عن سنخهما، وهم وإن قصروا عن مدى آبائهم، وعن غايات أوائلهم، فلم يقصروا عن جلة الرؤساء، وأهل السوابق من الكبراء، ولست ترى تاليهم إلا سابقاً، ومصليهم إلا للغاية مجاوزاً. ليس فيهم سكيت ولا مبهور ولا منقطع، قد نقحت أعراقهم من الإقراف والهجنة، ومن الشوب ولؤم العجمة.
ومتى عاينت أبا الفرج وكماله، ورأيت ديباجته وجماله، علمت أنه لم يكن في ضرائبهم وقديم نجلهم، خارجي النسب، ولا مجهول المركب، ولا بهيم مصمت، ولا كثير الأوضاح مغرب، بل لا ترى إلا كل أغر محجل، وكل ضخم المحزم هيكل.
إني لست أخبر عن الموتى ولا أستشهد الغيب، ولا أستدل بالمختلف فيه ولا الغامض الذي تعظم المؤنة في تعرفه، والشاهد لقولي يلوح في وجوههم، والبرهان على دعواي ظاهر في شمائلهم؛ والأخبار مستفيضة، والشهود متعاونة.
وأنت حين ترى عتق تلك الديباجة، ورونق ذلك المنظر، علمت أن التالد هو قياد هذا الطارف.
أما أنا فلم أر لأبي الفرج - أدام الله كرامته - ذاماً ولا شائناً ولا عائباً ولا هاجياً، بل لم أجد مادحاً قط إلا ومن سمع تسابق إلى تلك المعاني، ولا رأيت واصفاً له قط إلا وكل من حضر يهش له ويرتاح لقوله. قال الطرماح:
هل المجد إلا السودد العود والندى ... ورأب الثأى والصبر عند المواطن
ولكن هل المجد إلا كرم الأرومة والحسب، وبعد الهمة، وكثرة الأدب، والثبات على العهد إذا زلت الأقدام، وتوكيد العقد إذا انحلت معاقد الكرام، وإلا التواضع عند حدوث النعمة، واحتمال كل العثرة، والنفاذ في الكتابة، والإشراف على الصناعة.
والكتاب هو القطب الذي عليه مدار علم ما في العالم وآداب الملوك، وتلخيص الألفاظ، والغوص على المعاني السداد، والتخلص إلى إظهار ما في الضمائر بأسهل القول، والتمييز بين الحجة والشبهة وبين المفرد والمشترك، وبين المقصور والمبسوط، وبين ما يحتمل التأويل مما لا يحتمله، وبين السليم والمعتل.
فبارك الله لهم فيما أعطاهم، ورزقهم الشكر على ما خولهم، وجعل ذلك موصولاً بالسلامة، وبما خط لهم من السعادة، إنه سميع قريب، فعال لما يريد.
فصل من صدر كتابه في استحقاق الإمامة
بعون الله تعالى نقول، وإليه نقصد، وإياه ندعو، وعلى الله قصد السبيل.أعلم أن الشيعة رجلان: زيدي، ورافضي، وبقيتهم نزر جاء لازماً لهم. وفي الإخبار عنهما غنى عمن سواهما.
قالت علماء الزيدية: وجدنا الفضل في الفعل دون غيره، ووجدنا الفعل كله على أربعة أقسام: أولها القدم في الإسلام، حيث لا رغبة ولا رهبة إلا من الله تعالى وإليه.
ثم الزهد في الدنيا، فإن أزهد الناس في الدنيا أرغبهم في الآخرة وآمنهم على نفيس المال، وعقائل النساء، وإراقة الدماء.
ثم الفقه الذي به يعرف الناس مصالح دنياهم، ومراشد دينهم.
ثم المشي بالسيف كفاحاً بالذب عن الإسلام، وتأسيس الدين، وقتل عدوه، وإحياء وليه. فليس وراء بذل المهجة واستفراغ القوة غاية يطلبها طالب، ويرتجيها راغب.
ولم نجد فعلاً خامساً فنذكره. فمتى رأينا هذه الخصال مجتمعة في رجل دون الناس كلهم وجب علينا تفضيله عليهم، وتقديمه دونهم وذلك أنا إذا سألنا العلماء والفقهاء، وأصحاب الأخبار وحمال الآثار، عن أول الناس إسلاماً، قال فريق منهم: علي. وقال فريق منهم: أبو بكر. وقال آخرون: زيد بن حارثة. وقال قوم: خباب. ولم نجد كل واحد من هذه الفرق قاطعاً لعذر صاحبه، ولا ناقلاً له عن مذهبه، وإن كانت الرواية في تقدم علي أكثر، واللفظ به أظهر.
وكذلك إذا سألناهم عن الذابين عن الإسلام بمهجهم، والماشين إلى الأقران بسيوفهم، وجدناهم مختلفين. فمن قائل يقول: علي، ومن قائل يقول: الزبير، ومن قائل يقول: ابن عفراء، ومن قائل يقول: أبو دجانة، ومن قائل يقول: محمد بن مسلمة، ومن قائل يقول: طلحة، ومن قائل يقول: البراء بن مالك.
على أن لعلي - رضي الله عنه - من قتل الأقران والفرسان والأكفاء، ما ليس لهم، فلا أقل من أن يكون في طبقتهم.
وإن نحن سألناهم عن الفقهاء قالوا: علي، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب. على أن علياً كان أفقههم، لأنه كان يسأل ولا يسأل، ويفتي ولا يستفتي، ويحتاج إليه ولا يحتاج إليهم، ولكن لا أقل من أن نجعله في طبقتهم وكأحدهم.
وإن نحن سألناهم عن أهل الزهادة وأصحاب التقشف، والمعروفين برفض الدنيا وخلعها والزهد فيها، قالوا: علي، وأبو الدرداء، ومعاذ، وأبو ذر، وعمار، وبلال، وعثمان بن مظعون. على أن علياً أزهدهم؛ لأنه شاركهم في خشونة الملبس وخشونة المأكل، والرضا باليسير، والتبلغ بالحقير وظلف النفس عن الفضول، ومخالفة الشهوات. وفارقهم بأن ملك بيوت الأموال، ورقاب العرب والعجم، فكان ينضح بيت المال في كل جمعة، ويصلي فيه ركعتين. ورقع سراويله بأدم، وقطع ما فضل من كميه عن أطراف أصابعه بالشفرة، في أمور كثيرة. مع أن زهده هو أفضل من زهدهم؛ لأنه أعلم منهم. وعبادة العالم ليست كعبادة غيره، كما أن زلته ليست كزلة غيره، فلا أقل من أن يعد في طبقتهم.
ولم نجدهم ذكروا لأبي بكر، وزيد، وخباب، مثل الذي ذكروا له من بذل النفس والعناء، والذب عن الإسلام بالسيف، ولا ذكروهم في طبقة الفقهاء وأهل القدم في الإسلام. ولم نجدهم ذكروا لابن عفراء، والزبير، وأبي دجانة، والبراء بن مالك، مثل الذي ذكروا له من التقدم في الإسلام والزهد والفقه. ولا ذكروا أبا بكر، وزيداً، وخباباً، في طبقة عمرو بن مسعود، وأبي بن كعب، كما ذكروا علياً في طبقتهم. ولا ذكروا أبا بكر، وزيداً، وخباباً، في طبقة معاذ، وأبي الدرداء، وأبي، وعمار، وبلال، وعثمان بن مظعون، كما ذكروا علياً في طبقتهم.
فلما رأينا هذه الأمور مجتمعة فيه، ومتفرقة في غيره من أصحاب هذه المراتب، وأهل هذه الطبقات، الذين هم الغايات، علمنا أنه أفضل، وأن كل واحد منهم وإن كان قد أخذ من كل خير بنصيب، فإنه لن يبلغ مبلغ من قد اجتمع له الخير وصنوفه.
فهذا دليل هذه الطبقة من الزيدية على تفضيل علي - رضوان الله عليه - وتقديمه على غيره.
وزعموا أن علياً كان أولاهم بالخلافة، إلا أنهم كانوا على غيره أقل فساداً واضطراباً، وأقل طعناً وخلافاً. وذلك أن العرب وقريشاً كانوا في أمره على طبقات: فمن رجل قد قتل علي أباه أو ابنه، أو أخاه أو ابن عمه، أو حميمه أو صفيه، أو سيده أو فارسه، فهو بين مضطغن قد أصر على حقده، ينتظر الفرصة ويترقب الدائرة، قد كشف قناعه، وأبدى عداوته.
ومن رجل قد زمل غيظه وأكمل ضغنه، يرى أن سترهما في نفسه، ومداراة عدوه، أبلغ في التدبير، وأقرب من الظفر، فإن ما يجزيه أدنى علة تحدث، وأول تأويل يعرض، أو فتنة تنجم؛ فهو يرصد الفرصة ويترقب الفتنة، حتى يصول صولة الأسد، ويروغ روغان الثعلب، فيشفي غليله، ويبرد ثائره.
وإذا كان العدو كذلك كان غير مأمون عليه سرف الغضب، وإن يموه له الشيطان الوثوب، ويزين له الطلب؛ لأنه قد عرف مأتاه، وكيف يختله من طريق هواه.فإذا كان القلب كذلك اشتد تحفظه ولم يقو احتراسه، وكان بعرض هلكة وعلى جناح تغرير؛ لأنه منقسم الرأي متفرق النفس،قد اعتلج على قلبه غيظ الثأر على قرب عهده بأخلاق الجاهلية، وعادة العرب من الثأر وتذكر الأحقاد والأمر القديم، وشدة التصميم.
ومن رجل غمته حداثته، وأنف أن يلي عليه أصغر منه.
ومن رجل عرف شدته في أمره، وقلة اغتفاره في دينه،وخشونة مذهبه.
ومن رجل كره أن يكون الملك والنبوة يثبتان في نصاب واحد، وينبتان في مغرس واحد، لأن ذلك أقطع لأطماع قريش أن يعود الملك دولة في قبائلها، ومن قريش خاصة في بني عبد مناف، الأقرب فالأقرب، والأدنى فالأدنى، لأن الرحم كلما كانت أمس، والجوار أقرب، والصناعة أشكل، كان الحسد أشد، والغيظ أفرط. فكان أقرب الأمور إلى محبتهم إخراج الخلافة من ذلك المعدن، ترفيهاً عن أنفسهم من ألم الغيظ، وكمد الحسد.
فصل منها
وضرب من الناس همج هامج، ورعاع منتشر، لا نظام لهم، ولا اختيار عندهم، وأعراب أجلاف، وأشباه الأعراب، يفترقون من حيث يجتمعون، ويجتمعون من حيث يفترقون، لا تدفع صولتهم إذا هاجوا، ولا يؤمن تهيجهم إذا سكنوا. إن أخصبوا طغوا في البلاد وإن أجدبوا آثروا العناد. هم موكلون ببغض القادة، وأهل الثراء والنعمة، يتمنون له النكبة، ويشمتون بالعشيرة، ويسرون بالجولة، ويترقبون الدائرة.فلما كان الناس عند علي وأبي بكر على الطبقات التي نزلنا، والمراتب التي رتبنا، أشفق علي أن يظهر إرادة القيام بأمر الناس مخافة أن يتكلم متكلم أو يشغب شاغب، فدعاه النظر للدين إلى الكف عن الإظهار، والتجافي عن الأمر، فاغتفر المجهول ضناً بالدين، وإيثاراً للآجلة على العاجلة.
فدل ذلك على رجاجة حلمه، وقلة حرصه، وسعة صدره، وشدة زهده، وفرط سماحته، وأصالة رأيه.
وعلم أن هلكتهم لا تقوم بإزاء صرف ما بين حاله وحال أبي بكر في مصلحتهم. وقد علم بعد ذلك أن مسيلمة قد أطبق عليه أهل اليمامة ومن حولها من أهل البادية، وهم القوم الذين لا يصطلى بنارهم، ولا يطمع في ضعفهم وقلة عددهم، فكان الصواب ما رآه علي من الكف عن تحريك الهرج، إذ أبصر أسباب الفتن شارعة، وشواكل الفساد بادية، ولو هرج القوم هرجة وحدثت بينهم فرقة، كان حرب بوارهم أغلب من الطمع في سلامتهم.
وقد كان أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وفضلاء أصحابه، يعرفون من تلك الآراء شبيهاً بما يعرفه علي، فعلموا أن أول أحكام الدين المبادرة إلى إقامة إمام المسلمين، لئلا يكونوا نشراً، ولئلا يجعلوا للمفسدين علة وسبباً. فكان أبو بكر أصلح الناس لها بعد علي، فأصاب في قيامه، والمسلمون في إقامته، وعلي في تسويغه والرضا بولايته منعقدة منه على الإسلام وأهله. فلما قمع الله تعالى أهل الردة بسيف النقمة، وأباد النفاق، وقتل مسيلمة وأسر طلحة، ومات أصحاب الأوتار، وفنيت الضغائن، راح الحق إلى أهله، وعاد الأمر إلى صاحبه.
قالوا: وقد يكون الرجل أفضل الناس ويلي عليه من هو دونه في الفضل حتى يكلفه الله طاعته وتقديمه: إما للمصلحة والإشفاق من الفتنة كما ذكرنا وفسرنا، وإما للتغليط في المحنة وتشديد البلوى والكلفة، كما قال الله تعالى للملائكة: " اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر " . والملائكة أفضل من آدم، ولأن جبريل وميكائيل وإسرافيل عند الله من المقربين قبل خلق آدم بدهر طويل، لما قدمت من العبادة واحتملت من ثقل الطاعة. وكما ملك الله طالوت على بني إسرائيل وفيهم يومئذ داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبيهم الذي أخبر الله عنه في القرآن بقوله تعالى: " إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له الملك علينا " إلى آخر الآية.
فصل من صدر رسالته في استنجاز الوعد
قد شاع الخبر وسار المثل بقولهم: " اطلبوا الحاجات من حسان الوجوه " .فإن كان الوجه إنما وقع على الوجه الذي فيه الناظر والسامع، والشام والذائق، إذا كان حسناً جميلاً، وعتيقاً بهياً، فوجهك الذي لا يخيل على أحد كماله، لا يخطىء حواله.
وإن كان ذكر الوجه إنما يقع على حسن وجه المطلب وجماله على جهة الرغبة؛ وإن كان ذلك على طريق المثل، وعلى سبيل اللفظ المشتق من اللفظ، والفرع المأخوذ من الأصل، فوجه المطلب إليك أفضل الوجوه وأسناها، وأصونها وأرضاها. وهو المنهج الفسيح والمتجر الربيح؛ وجماله ظاهر، ونفعه حاضر، وخيره غامر، إلا أن الله تعالى قرنه مع ذلك باليمن، وسهله باليسر، وحببه بالبشر الحسن، ودعا إليه بلين الخطاب، وأظهر في أسمائكم وأسماء آبائكم وفي كناكم وكنى إخوانكم، من برهان الفأل الحسن ونفي الطيرة السيئة ما جمع لكم به صنوف الأمل، وصرف إليكم وجوه المطالب؛ فاجتمع فيكم تمام القوام وبراعة الجمال، والبشر عند اللقاء، ولين الخطاب والكنف للخلطاء، وقلة البذخ بالمرتبة الرفيعة، والزيادة في الإنصاف عند النعمة الحادثة. فجعل الناس وعدكم من أكرم الوعد، وعقدكم من أوثق العقد، وإطماعكم من أصح الإنجاز. وعلموا أنكم تؤيسون في مواضع اليأس، وتطمعون في مواضع الضمان، وأن الأمور عندكم موزونة معدلة، والأسباب مقدرة محصلة.
هذا مع الصولة والتصميم في موضع التصميم.
والتقية أحزم، والصفح إذا كان الصفح أكرم، والرحمة لمن استرحم، والعقاب لمن صمم.
ثم المعرفة بفرق ما بين اعتزام الغمر واعتزام المستبصر، وفصل ما بين اعتزام الشجاع والبطل، وبين إقدام الجاهل والمتهور.
وقد علم الناس بما شاهدوه منكم، وعاينوه من تدبير، وعرفوه من تصرف حالاتكم، أني لم أتزيد لكم، ولم أتكلف فيكم ما ليس عندكم. وخير المديح ما وافق جمال الممدوح، وأصدق الصفات ما شاكل مذهب الموصوف، وشهد له أهل العيان الظاهر، والخبر المتظاهر. ومتى خالف هذه القضية وجانب الحقيقة، ضار المادح ولم ينفع الممدوح.
هذا إلى الثبات على العهد، وإحكام العقد، مع الوفاء العجيب، والرأي المصيب، وتمام ذلك وكماله، وسناء ذلك وبهائه، وكثرة الشهود لكم، وإجماع الناس على ذلك فيكم.
ومن قبل لنفسه مديحاً لا يعرف به كان كمادح نفسه. ومن أثاب الكذابين على كذبهم كان شريكهم في إثمهم، وشقيقهم في سخفهم، بل كان المحتقب لكبره، المحتمل لوزره، إذ كان المثيب عليه والداعي إليه.
معاذ الله أن نقول إلا معروفاً غير مجهول، ونصف إلا صحيحاً غير مدخول، أو نكون ممن يتودد بالملق، ويتقحم على أهل الأقدار شرهاً إلى مال، أو حرصاً على تقريب. وأبعد الله الحرص وأخزى الشره والطمع! فإن شك شاك أو توقف مرتاب فليعترض العامة، وليتصفح ما عند الخاصة حتى يتبين الصبح.
وقالوا في تأديب الولاة وتقديم تدبير الكفاة: " إذا أبردتم البريد فاجعلوه حسن الوجه، حسن الاسم " . فكيف إذا قارن حسن الوجه وحسن الاسم كرم الضريبة، وشرف العرق.
وأعيان الأعراق الكريمة، والأخلاق الشريفة، إذا استجمعت هذا الاستجماع، واقترنت هذا الاقتران، كان أتم للنعمة، وأبرع للفضيلة وكانت الوسيلة إليها أسهل، والمأخذ نحوها أقرب، والأسباب أمتن.
فإذا انتظمت في هذا السلك، وجمعها هذا النظم، كان الذي يبرد البريد أولى بها من البريد، وكان مقوم البلاد أحق بها من حاشيته الكفاة، إذ التأميل لا يجمع أوجه الصواب، ولا يحصي مخارج الأسباب، ولا يظهر برهانه ويقوى سلطانه، حتى يصيب المعدن.
ولن يكون موضع الرغبة معدناً إلا بعد اشتماله على ترادف خصال الشرف وبعد أن يتوافى إليه معاني الكرم بالأعراق الكريمة، والعادات الحسنة، على حادث يشهد لمتقادم، وطارف يدل على تالد.
فإذا كان الأمل يخبر بالحسب فالحسب ثاقب، والمجد راسخ. وإن كان الشأن في صناعة الكلام وفي القدم والرياسة، وفي خلف يأثره عن سلف، وآخر يلقاه عن أول، فلكم ما لا يذهب عنه جاحد، ولا يستطيع جحده معاند.
فصل منها
وأسماؤكم وكناكم بين فرج ونجح، وبين سلامة وفضل، ووجوهكم وفق أسمائكم، وأخلاقكم وفق أعراقكم، لم يضرب التفاوت فيكم بنصيب.وبعد هذا فإني أستغفر الله من تفريطي في حقوقكم، وأستوهبه طول رقدتي عما فرضته لكم.
ولا ضير إن كان هذا الذي قلنا على إخلاص وصحة عهد، وعلى صدق سيرة وثبات عقد. ينبو السيف وهو حسام، ويكبو الطرف وهو جواد، وينسى الذكور، ويغفل الفطن.
ونعوذ بالله تعالى من العمى بعد البصيرة، والحيرة بعد لزوم الجادة.
كان أبو الفضل - أعزه الله - على ما قد بلغك من التبرع بالوعد وسرعة الإنجاز وتمام الضمان. وعلى الله تمام النعمة والعافية.
وكان - أيده الله - في حاجتي، كما وصف زيد الخيل نفسه حين يقول:
وموعدتي حق كأن قد فعلتها ... متى ما أعد شيئاً فإني لغارم
وتقول العرب: " من أشبه أباه فما ظلم " ، تقول: لم يضع الشبه إلا في موضعه، لأنه لا شاهد أصدق على غيب نسبه وخفي نجله من الشبه القائم فيه، الظاهر عليه.
وقد تقيلت - أبقاك الله - شيخك: خلقه وخلقه، وفعله وعزمه، وعز الشهامة، والنفس التامة.
ومرجع الأفعال إلى الطبائع، ومدار الطبائع على جودة اليقين وقوة المنة، وبهما تتم العزيمة، وتنفذ البصيرة.
هذا مع ما قسم الله لك من المحبة ومنحك من المقة، وسلمك عنه من المذمة.
والله لو لم يكن فيكم من خصال الحرية وخلال النفوس الأبية إلا أنكم لا تدينون بالنفاق، ولا تعدون بالكذب ولا تستعملون المواربة في موضع الاستقامة، وحيث تجب الثقة.
ولا يكون حظ الأحرار بالمواعيد صرفا، ولا تتكلون على ملالة الطالب، ولا عجز الراغب، إذا استنفدت أيامه، وعجزت نفقته، وماتت أسبابه، بل تعجلون لهم الراحة عند تعذر الأمور إليكم بالإياس، وتحققون أطماعهم عند إمكان الأمور لكم بالإنجاح.
فصل منها
وإنك والله - أيها الكريم المأمول، والمستعطف المسئول - لا تزرع المحبة إلا وتحصد الشكر، ولا تكثر المودات إلا إذا أكثر الناس الأموال، ولا يشيع لك طيب الأحدوثة وجمال الحال في العشيرة، إلا لتجرع مرار المكروه. ولن تنهض بأعباء المكارم التي توجبها النعمة وتفرضها المرتبة حتى تستشعر التفكر في التخلص إلى إغنائهم، والقيام بحسن ظنهم، وحتى ترحمهم من طول الانتظار، وترق عليهم من موت الأمل وإحياء القنوط، وحتى تتغلغل ذلك بالحيل اللطيفة، والعناية الشديدة الشريفة، وحتى تتوخى الساعات، وتنتهز الفرص في الحالات، وتتخير من الألفاظ أرقها مسلكاً، وأحسنها قبولاً، وأجودها وقوعاً.فصل من صدر رسالته في تفضيل النطق على الصمت
أمتع الله بك وأبقى نعمه عندك؛ وجعلك ممن إذا عرف الحق انقاد له، وإذا رأى الباطل أنكره وتزحزح عنه.قد قرأت كتابك فيما وصفت من فضيلة الصمت، وشرحت من مناقب السكوت، ولخصت من وضوح أسبابهما، وأحمدت من منفعة عاقبتهما وجريت في مجرى فنون الأقاويل فيهما، وذكرت أنك وجدت الصمت أفضل من الكلام في مواطن كثيرة وإن كان صوابا، وألفيت السكون أحمد من المنطق في مواضع جمة، وإن كان حقاً.
وزعمت أن اللسان من مسالك الخنا، الجالب على صاحبه البلا وقلت: إن حفظ اللسان أمثل من التورط في الكلام.
وسميت الغبي عاقلاً، والصامت حليماً، والساكت لبيباً، والمطرق مفكراً. وسميت البليغ مكثاراً والخطيب مهذاراً والفصيح مفرطاً، والمنطيق مطنباً.
وقلت: إنك لم تندم على الصمت قط، وإن كان منك عياً، وأنك ندمت على الكلام مراراً وإن كان منك صواباً.
واحتجاجك في ذلك بقول كسرى أنو شروان، واعتصامك فيها بما سار من أقاويل الشعراء والمتسق من كلام الأدباء، وإفراطهم في مذمة الكلام، وإطنابهم في محمدة السكوت.
وأتيت - حفظك الله - على جميع ما ذكرت من ذلك، ووصفت ولخصت، وشرحت وأطنبت فيها وفرطت بالفهم، وتصفحتها بالعلم، وبحثت بالحزم، ووعيت بالعزم، فوجدتها كلام امرىء قد أعجب برأيه وارتطم في هواه، وظن أنه قد نسج فيها كلاماً، وألف ألفاظاً ونسق له معاني على نحو مأخذه.
ومقصده أن لا يلفي له ناقضاً في دهره بعد أن أبرمها، ولا يجد فيها مناوياً في عصره بعد أن أحكمها. وأن حجته قد لزمت جميع الأنام، ودحضت حجة قاطبة أهل الأديان، لما شرح فيها من البرهان، وأوضح بالبيان. وحتى كان القول من القائل نقضاً، ورفع الوصف من الواصف تغلباً، وكان في موضع لا ينازعه فيه أحد، وقلما يجد من يخاصمه، ولا يلفي أبداً من يناضله، وصار فلجاً بحجته أوحدياً في لهجته، إذ كان محله محل الوحدة، والأنس بالخلوة، وكان مثله في ذلك مثل من تخلص إلى الحاكم وحده فلج بحجته.
وإني سأوضح ذلك ببرهان قاطع، وبيان ساطع، وأشرح فيه من الحجج ما يظهر، ومن الحق ما يقهر، بقدر ما أتت عليه معرفتي، وبلغته قوتي، وملكته طاقتي، بما لا يستطيع أحد رده، ولا يمكنه إنكاره وجحده. ولا قوة إلا بالله، وبه أستعين، وعليه أتوكل وإليه أنيب.
إني وجدت فضيلة الكلام باهرة، ومنقبة المنطق ظاهرة، في خلال كثيرة، وخصال معروفة.
منها: أنك لا تؤدي شكر الله ولا تقدر على إظهاره إلا بالكلام.
ومنها: أنك لا تستطيع العبارة عن حاجاتك والإبانة عن ماربك إلا باللسان. وهذان في العاجل والآجل مع أشياء كثيرة لو ينحوها الإنسان لوجدها في المعقول موجودة، وفي المحصول معلومة وعند الحقائق مشتهرة، وفي التدبير ظاهرة.
ولم أجد للصمت فضلاً على الكلام مما يحتمله القياس، لأنك تصف الصمت بالكلام، ولا تصف الكلام به. ولو كان الصمت أفضل والسكوت أمثل لما عرف للآدميين فضل على غيرهم، ولا فرق بينهم وبين شيء من أنواع الحيوان وأخياف الخلق في أصناف جواهرها واختلاف طبائعها، وافتراق حالاتها وأجناس أبدانها في أعيانها وألوانها. بل لم يمكن أن يميز بينهم وبين الأصنام المنصوبة والأوثان المنحوتة، وكان كل قائم وقاعد، ومتحرك وساكن، ومنصوب وثابت، في شرع سواء ومنزلة واحدة، وقسمة مشاكلة؛ إذ كانوا في معنى الصمت بالجثة واحداً، وفي معنى الكلام بالمنطق متبايناً. ولذلك صارت الأشياء مختلفة في المعاني، مؤتلفة الأشكال، إذ كانت في أشكال خلقتها متفقة بتركيب جواهرها، وتأليف أجزائها، وكمال أبدانها، وفي معنى الكمال متباينة عند مفهوم نغماتها، ومنظوم ألفاظها، وبيان معالمها وعدل شواهدها.
مع أني لم أنكر فضيلة الصمت، ولم أهجن ذكره إلا أن فضله خاص دون عام، وفضل الكلام خاص وعام، وأن الاثنين إذا اشتمل عليهما فضل كان حظهما أكثر، ونصيبهما أوفر من الواحد. ولعله أن يكون بكلمة واحدة نجاة خلق، وخلاص أمة.
ومن أكثر ما يذكر للساكت من الفضل، ويوصف له من المنقبة أن يقال يسكت ليتوقى به عن الإثم، وذلك فضل خاص دون عام.
ومن أقل ما يحتكم عليه أن يقال غبي أو جاهل، فيكون في ذلك لازم ذنب على التوهم به، فيجتمع مع وقوع اسم الجاهل عليه ما ورط فيه صاحبه من الوزر.
والذي ذكر من تفضيل الكلام ما ينطق به القرآن، وجاءت فيه الروايات عن الثقات، في الأحاديث المنقولات، والأقاصيص المرويات، والسمر والحكايات، وما تكلمت به الخطباء ونطقت فيه البلغاء أكثر من أن يبلغ آخرها، ويدرك أولها، ولكن قد ذكرت من ذلك على قدر الكفاية، ومن الله التوفيق والهداية.
ولم نر الصمت - أسعدك الله - أحمد في موضع إلا وكان الكلام فيه أحمد، لتسارع الناس إلى تفضيل الكلام، لظهور علته، ووضوح جليته، ومغبة نفعه.
وقد ذكر الله جل وعز في قصة إبراهيم عليه السلام حين كسر الأصنام وجعلها جذاذاً، فقال حكاية عنهم: " قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون " . فكان كلامه سبباً لنجاته، وعلة لخلاصه، وكان كلامه عند ذلك أحمد من صمت غيره في مثل ذلك الموضع، لأنه عليه السلام لو سكت عند سؤالهم إياه لم يكن سكوته إلا على بصر وعلم، وإنما تكلم لأنه رأى الكلام أفضل، وأن من تكلم فأحسن قدر أن يسكت فيحسن، وليس من سكت فأحسن قدر أن يتكلم فيحسن.
واعلم - حفظك الله - أن الكلام سبب لإيجاب الفضل، وهداية إلى معرفة أهل الطول.
ولولا الكلام لم يكن يعرف الفاضل من المفضول، في معان كثيرة، لقول الله عز وجل، في بيان يوسف عليه السلام وكلامه عند عزيز مصر، لما كلمه فقال: " إنك اليوم لدينا مكين أمين " . فلو لم يكن يوسف عليه السلام أظهر فضله بالكلام، والإفصاح بالبيان، مع محاسنه المونقة، وأخلاقه الطاهرة، وطبائعه الشريفة، لما عرف العزيز فضله، ولا بلغ تلك المنزلة لديه، ولا حل ذلك المحل منه، ولا صار عنده بموضع الأمانة، ولكان في عداد غيره ومنزلة سواه عند العزيز. ولكن الله جعل كلامه سبباً لرفع منزلته، وعلو مرتبته، وعلة لمعرفة فضيلته، ووسيلة لتفضيل العزيز إياه.
ولم أر للصمت فضيلة في معنى ولا للسكوت منقبة في شيء إلا وفضيلة الكلام فيها أكثر، ونصيب المنطق عندها أوفر، واللفظ بها أشهر. وكفى بالكلام فضلاً، وبالمنطق منقبة، أن جعل الله الكلام سبيل تهليله وتحميده، والدال على معالم دينه وشرائع إيمانه، والدليل إلى رضوانه. ولم يرض من أحد من خلقه إيماناً إلا بالإقرار، وجعل مسلكه اللسان، ومجراه فيه البيان، وصيره المعبر عما يضمره والمبين عما يخبره، والمنبىء عن ما لا يستطيع بيانه إلا به. وهو ترجمان القلب. والقلب وعاء واع.
ولم يحمد الصمت من أحد إلا توقياً لعجزه عن إدراك الحق والصواب في إصابة المعنى. وإنما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عند جهلهم الله تعالى وإنكارهم إياه، ليقروا به، فإذا فعلوه حقنت دماؤهم، وحرمت أموالهم، ورعيت ذمتهم. ولو أنهم سكتوا ضناً بدينهم لم يكن سبيلهم إلا العطب.
فاعلم أن الكلام من أسباب الخير لا من أسباب الشر.
والكلام - أبقاك الله - سبيل التمييز بين الناس والبهائم، وسبب المعرفة لفضل الآدميين على سائر الحيوان، قال الله عز وجل: " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر " . كرمهم باللسان وجملهم بالتدبر.
ولو لم يكن الكلام لما استوجب أحد النعمة، ولا أقام على أداء ما وجب عليه من الشكر سبباً للزيادة، وعلة لامتحان قلوب العباد. والشكر بالإظهار في القول، والإبانة باللسان. ولا يعرف الشكر إلا بهما. والله تعالى يقول: " لئن شكرتم لأزيدنكم " ، فجعل الشكر علة لوجوب الزيادة، عند إظهاره بالقول، والحمد مفتاحاً للنعمة.
وقد جاء في بعض الآثار: لو أن رجلاً ذكر الله تعالى وآخر يسمع له كان المعدود للمستمع من الأجر، والمذكور له من الثواب واحداً وللمتكلم به عشرة أو أكثر.
فهل ترى - أبقاك الله - أنه وجب لصاحب العشر ذلك وفضل به على صاحبه إلا عند استعماله بالنطق به لسانه. ولم يلزم الصمت أحد إلا على حسب وقوع الجهل عليه.فأما إذا كان الرجل نبيها مميزاً، عالماً مفوها فالصمت مهجن لعلمه وساتر لفضله. كالقداحة لم يستبن نفعها دون تزنيدها. ولذلك قيل: " من جهل علماً عاداه " .
فصل منها
ولم أجد الصامت مستعاناً به في شيء من المعاني، ولا مذكوراً في المحافل.ولم يذكر الخطباء ولا قدمتهم الوفود عند الخلفاء إلا لما عرفوه من فضل لسانهم وفضيلة بيانهم. وإن أصح ما يوجد في المعقول، وأوضح ما يعد في المحصول للعرب من الفضل، فصاحتها وحسن منطقها، بعد فضائلها المذكورة، وأيامها المشهورة.
ولفضل الفصاحة وحسن البيان بعث الله تعالى أفضل أنبيائه وأكرم رسله من العرب، وجعل لسانه عربياً، وأنزل عليه قرآنه عربياً، كما قال الله تعالى: " بلسان عربي مبين " . فلم يخص اللسان بالبيان، ولم يحمد بالبرهان إلا عند وجود الفضل في الكلام، وحسن العبارة عند المنطق، وحلاوة اللفظ عند السمع.
واعلم أن الله تعالى لم يرسل رسولاً ولا بعث نبياً إلا من كان فضله في كلامه وبيانه كفضله على المبعوث إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لساناً، وأحسنهم بياناً، وأسهلهم مخارج للكلام وأكثرهم فوائد من المعاني؛ لأنه كان من جماهير العرب، مولده في بني هاشم، وأخواله من بني زهرة، ورضاعه في بني سعد بن بكر، ومنشؤه في قريش، ومتزوجه في بني أسد بن عبد العزى، ومهاجره إلى بني عمرو، وهم الأوس والخزرج من الأنصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر " .
ولو لم يكن مما عددنا من هؤلاء الأحياء إلا قريش وحدها لكان فيها مستغنىً عن غيرها، وكفاية عن من سواها، لأن قريشاً أفصح العرب لساناً وأفضلها بياناً، وأحضرها جواباً، وأحسنها بديهة، وأجمعها عند الكلام قلبا.
ثم للعرب أيضاً خصال كثيرة، ومشاهد كثيرة، مما يشاكل هذا الباب، ويضارع هذا المثال، حذفت ذكرها خوف التطويل فيها.
فصل منها
فهذه كلها دلائل على دحض حجتك ونقض قضيتك. وإنما أرسل الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين الأمم، وأمرهم بالإبلاغ ليلزمهم الحجة بالكلام لا بالصمت، إذ لا يكون للرسالة بلاغ ولا للحجة لزوم ولا للعلة ظهور إلا بالنطق.فصل منها في صفة من يقدر على الإبانة
وليس يقوى على ذلك إلا امرؤ في طبيعته فضل عن احتمال نحيزته وفي قريحته زيادة من القوة على صناعته، ويكون حظه من الاقتدار في المنطق فوق قسطه من التغلب في الكلام، حتى لا يضع اللفظ الحر النبيل إلا على مثله من المعنى، ولا اللفظ الشريف الفخم إلا على مثله من المعنى. نعم، وحتى يعطي اللفظ حقه من البيان، ويوفر على الحديث قسطه من الصواب، ويجزل للكلام حظه من المعنى، ويضع جميعها مواضعها، ويصفها بصفتها، ويوفر عليها حقوقها من الإعراب والإفصاح.فصل منها
وبعد، فأي شيء أشهر منقبة وأرفع درجة وأكمل فضلاً، وأظهر نفعاً، وأعظم حرمة، من شيء لولا مكانه لم يثبت لله ربوبية ولا لنبي حجة، ولم يفصل بين حجة وشبهة، وبين الدليل وما يتجلى في صورة الدليل.ثم به يعرف فضل الجماعة من الفرقة، والشبهة من البدعة، والشذوذ من الاستفاضة.
والكلام سبب لتعرف حقائق الأديان، والقياس في تثبيت الربوبية وتصديق الرسالة، والامتحان للتعديل والتجوير والاضطرار والاختيار.
فصل من صدر كتابه في صناعة الكلام
ذكرت - حفظك الله - تفضيلك صناعة الكلام، والذي خصصت به مذهب النظام، وشغفك بالمبالغة في النظر، وصبابتك بتهذيب النحل، مع أنسك بالجماعة، ووحشتك من الفرقة، والذي تم عليه عزمك من إدامة البحث والتنقير ومن حمل النفس على مكروهها من التفكير، ومن الانتساب إليهم والتعرف بهم. والذي تهيأ لك من الاحتساب في الأجر، والرغبة في صالح الذكر، والذي رأيت من النصب للرافضة والمارقة، وطول مفارقة المرجئة والنابتة، ولكل من اعترض عليهم، وانحرف عنهم، والذي يخص به الجبرية ويعم به المشبهة.فيأيها المتكلم الجماعي، والمتفقه السني، والنظار المعتزني، الذي سمت همته إلى صناعة الكلام مع إدبار الدنيا عنها، واحتمل ما في التعرض للعوام من الثواب عليها، ولم يقنعه من الأديان إلا الخالص الممتحن ولا من النحل إلا الإبريز المهذب، ولا من التمييز إلا المحض المصفى. والذي رغب بنفسه عن تقليد الأغمار والحشوة، كما رغب عن ادعاء الإلهام والضرورة، ورغب عن ظلم القياس بقدر رغبته في شرف اليقين: إن صناعة الكلام علق نفيس، وجوهر ثمين، وهو الكنز الذي لا يفنى ولا يبلى، والصاحب الذي لا يمل ولا يغل، وهو العيار على كل صناعة، والزمام على كل عبارة، والقسطاس الذي به يستبان نقصان كل شيء ورجحانه، والراووق الذي به يعرف صفاء كل شيء وكدره، والذي كل أهل علم عليه عيال، وهو لكل تحصيل آلة ومثال.
ألا إنه ثغر والثغر محروس، وحمىً والحمى ممنوع، والحرم مصون، ولن تصونه إلا بابتذال نفسك دونه، ولن تمنعه إلا بأن تجود بمهجتك ومجهودك، ولن تحرسه إلا بالمخاطرة فيه. والثواب على قدر المشقة، والتوفيق على مقدار حسن النية.
وكيف لا يكون حرماً وبه عرفنا حرمة الشهر الحرام والحلال المنزل، والحرام المفصل؟ ! وكيف لا يكون ثغراً وكل الناس لأهله عدو، وكل الأمم له مطالب.
وأحق الشيء بالتعظيم، وأولاه بأن يحتمل فيه كل عظيم ما كان مسلماً إلى معرفة الصغير والكبير، والحقير والخطير، وأداة لإظهار الغامض، وآلة لتخليص الغاشية، وسبباً للإيجاز يوم الإيجاز والإطناب يوم الإطناب.
وبه يستدل على صرف ما بين الشرين من النقصان، وعلى فضل ما بين الخيرين من الرجحان، والذي يصنع في العقول من العبارة وإعطاء الآلة مثل صنيع العقل في الروح، ومثل صنيع الروح في البدن.
وأي شيء أعظم من شيء لولا مكانه لم يثبت للرب ربوبية، ولا لنبي حجة، ولم يفصل بين حجة وشبهة، وبين الدليل وما يتخيل في صورة الدليل. وبه يعرف الجماعة من الفرقة، والسنة من البدعة، والشذوذ من الاستفاضة.
فصل منه
واعلم أن لصناعة الكلام آفات كثيرة، وضروباً من المكروه عجيبة، منها ما هو ظاهر للعيون والعقول، ومنها ما يدرك بالعقول ولا يظهر للعيون، وبعضها وإن لم يظهر للعيون وكان مما يظهر للعقول فإنه لا يظهر إلا لكل عقل سليم جيد التركيب، وذهن صحيح خالص الجوهر، ثم لا يدركه أيضاً إلا بعد إدمان الفكر، وإلا بعد دراسة الكتب، وإلا بعد مناظرة الشكل الباهر، والمعلم الصابر. فإن أراد المبالغة وبلوغ أقصى النهاية، فلا بد من شهوة قوية، ومن تفضيله على كل صناعة، مع اليقين بأنه متى اجتهد أنجح، ومتى أدمن قرع الباب ولج.فإذا أعطى العلم حقه من الرغبة فيه، أعطاه حقه من الثواب عليه.
فصل منه
ومن آفات صناعة الكلام أن يرى من أحسن بعضها أنه قد أحسنها كلها، وكل من خاصم فيها ظن أنه فوق من خاصمه حتى يرى المبتدىء أنه كالمنتهي ويخيل إلى الغبي أنه فوق الذكي. وأيضاً أنه يعرض عن أهله وينصب لأصحابه من لم ينظر في علم قط، ولم يخض في أدب منذ كان، ولم يدر ما التمثيل ولا التحصيل، ولا فرق ما بين الإهمال والتفكير.وهذه الآفات لا تعتري الحساب ولا الكتاب، ولا أصحاب النحو والعروض، ولا أصحاب الخبر وحمال السير، ولا حفاظ الآثار ولا رواة الأشعار، ولا أصحاب الفرائض، ولا الخطباء ولا الشعراء، ولا أصحاب الأحكام ومن يفتي في الحلال والحرام، ولا أصحاب التأويل، ولا الأطباء ولا المنجمين ولا المهندسين، ولا لذي صناعة ولا لذي تجارة، ولا لذي عيلة ولا لذي مسألة.
فهم لهذه البلية مخصوصون، وعليها مقصورون، فللصابر منهم من الأجر حسب ما خص به من الصبر. وهي الصناعة لا يكاد تظهر قوتها ولا يبلغ أقصاها إلا مع حضور الخصم.
ولا يكاد الخصم يبلغ محبته منها إلا برفع الصوت وحركة اليد، ولا يكاد اجتماعهما يكون إلا في المحفل العظيم والاحتشاد من الخصوم، ولا تحتفل نفوسهما، ولا تجتمع قوتهما، ولا تجود القوة بمكنونها وتعطي أقصى ذخيرتها، التي استخزنت ليوم فقرها وحاجتها، إلا يوم جمع وساعة حفل. وهذه الحال داعية إلى حب الغلبة.
وليس شيء أدعى إلى التغلب من حب الغلبة. وطول رفع الصوت مع التغلب، وإفساد التغلب طباع المفسد، يوجبان فساد النية، ويمنعان من درك الحقيقة. ومتى خرجا من حد الاعتدال أخطآ جهة القصد.
وعلم الكلام بعد ملقىً من الظلم، متاح له الهضم. فهو أبداً محمول عليه ومبخوس حظه وباب الظلم إليه مفتوح، لا مانع له دونه.
والعلم بما فيه من الضرر يخفى على أكثر العقلاء، ويغمض على جمهور الأدباء. وإذا كان ملقىً من أكبر العقلاء، ومخذولاً عند أكثر الأدباء، فما ظنك بمن كان عقله ضعيفاً ونظره قصيراً؟ بل ما ظنك بالظلوم الغادر، والغمر الجاسر؟ فهذا سبيل العوام فيه، وجهل عوام الخواص به، وانحرافهم عنه، وميل الملوك عليه، وعداوة بعض لبعض فيه.
وصناعة الكلام كثيرة الدخلاء والأدعياء، قليلة الخلص والأصفياء والنجابة فيها غريبة، والشروط التي تستحكم بها الصناعة بعيدة سحيقة؛ ولدعي القوم من العجز ما ليس لصحيحهم، ولردي الطبع في صناعة الكلام من ادعاء المعرفة ما ليس للمطبوع عليها منهم، بل لا تكاد تجده إلا مغموراً بالحشوة مقصوداً بمخاتل السفلة.
ومن مظالم صناعة الكلام عند أصحاب الصناعات أن أصحاب الحساب والهندسة يزعمون أن سبيل الكلام سبيل اجتهاد الرأي، وسبيل صواب الحدس، وفي طريق التقريب والتمويه، وأنه ليس العلم إلا ما كان طبيعياً واضطرارياً لا تأويل له، ولا يحتمل معناه الوجوه المشتركة، ولا يتنازع ألفاظه الحدود المتشابهة. ويزعمون أنه ليس بين علمهم بالشيء الواحد أنه شيء واحد وأنه غير صاحبه فرق في معنى الإتقان والاستبانة، وثلج الصدور والحكم بغاية الثقة.
فصل منه
فلو كان هذا المهندس الذي أبرم قضيته، وهذا الحاسب الذي قد شهر حكومته، نظر في الكلام بعقل صحيح وقريحة جيدة، وطبيعة مناسبة، وعناية تامة، وأعوان صدق وقلة شواغل، وشهوة للعلم، ويقين بالإصابة، لكان تهيب الحكم أزين به، والتوقي أولى به. فكيف بمن لا يكون عرف من صناعة الكلام ما يعرفه المقتصد فيه، والمتوسط له.على أنا ما وجدنا مهندساً قط ولا رأينا حاسباً يقول ذلك إلا وهو ممن لا يتوقى سرف القول، ولا يشفق من لائمة المحصلين، وقضيته قضية من قد عرف الحقائق، واستبان العواقب، ووزن الأمور كلها وعجم المعاني بأسرها، وعلم من أين وثق كل واثق، ومن أين غر كل مغرور.
وعلى أنهم يقرون أن في الحساب ما لا يعلم، وأن في الهندسة ما لا يدرك ولا يفهم. والمتكلمون لا يقرون بذلك العجز في صناعتهم، وبذلك النقص في غرائزهم.
فصل منه
وأقول: إنه لو لم يكن في المتكلمين من الفضل إلا أنهم قد رأوا إدبار الدنيا عن علم الكلام، وإقبالها إلى الفتيا والأحكام، وإجماع الرعية والراعي على إغناء المفتي، وعلم الفتوى فرع؛ وإطباقهم على حرمان المتكلم، وعلم الكلام أصل، فلم يتركوا مع ذلك تكلفه، وشحت نفوسهم عن ذلك الحظ، مخافة إدخال الضيم على علم الأصل، وإشفاقاً من أن لا تسع طبائعهم اجتماع الأصل والفرع، فكان الفقر والقلة آثر عندهم مع إحكام الأصول، من الغنى والكثرة، مع حفظ الفروع، فتركوا أن يكونوا قضاة، وتركوا القضاة وتعديلهم وتركوا أن يكونوا حكاماً وقنعوا بأن يحكم عليهم، مع معرفتهم بأن آلتهم أتم، وآدابهم أكمل، وألسنتهم أحد، ونظرهم أثقب، وحفظهم أحضر، وموضع حفظهم أحصن.والمتكلم اسم يشتمل على ما بين الأزرقي والغالي وعلى مادونها من الخارجي والرافضي، بل على جميع الشيعة وأصناف المعتزلة، بل على جميع المرجئة وأهل المذاهب الشاذة.
فصل من صدر رسالته في مدح التجار وذم عمل السلطان
أدام الله لك السلامة، وأسعدك بالنعمة، وختم لك بالسعادة، وجعلك من الفائزين.فهمت كتاب صاحبك، ووقفت منه على تعد في القول، وحيف في الحكم؛ وسمعت قوله. وهو على كل حال حائر، وطريقه طريقهم، وكتبه تشاكل كتبهم، وألفاظه تطابق ألفاظهم.
وكذلك حالنا وحال صاحب كتابك فيما يسخطه من أمرنا، أني لا أعتذر منه، وأستنكف من الانتساب إليه، بل أستحي من الكتابة، وأستنكف بأن أنسب إليها من البلاغة أن أعرف بها في غير موضعها، ومن السجع أن يظهر مني، ومن الصنعة أن تعرف في كتبي، ومن العجب بكثير ما يكون مني.
وقديماً كره ذلك أهل المروءة والأنفة، وأهل الاختيار للصواب والصد عن الخطأ. حتى إن معاوية مع تخلفه عن مراتب أهل السابقة، أملى كتاباً إلى رجل فقال فيه: " لهو أهون علي من ذرة، أو كلب من كلاب الحرة " ثم قال: " امح: من كلاب الحرة، واكتب: من الكلاب " . كأنه كره اتصال الكلام والمزاوجة وما أشبه السجع، وأري أنه ليس في موضعه.
فصل منه
وهذا الكلام لا يزال ينجم من حشوة أتباع السلطان. فأما عليتهم ومصاصهم، وذوو البصائر والتمييز منهم، ومن فتقته الفطنة، وأرهفه التأديب، وأرهقه طول الفكر وجرى فيه الحياء وأحكمته التجارب، فعرف العواقب وأحكم التفصيل وتبطن غوامض التحصيل، فإنهم يعترفون بفضيلة التجار ويتمنون حالهم، ويحكمون لهم بالسلامة في الدين، وطيب الطعمة، ويعلمون أنهم أودع الناس بدناً وأهنؤهم عيشاً، وآمنهم سرباً، لأنهم في أفنيتهم كالملوك على أسرتهم، يرغب إليهم أهل الحاجات، وينزع إليهم ملتمسو البياعات، لا تلحقهم الذلة في مكاسبهم، ولا يستعبدهم الضرع لمعاملاتهم.وليس هكذا من لابس السلطان بنفسه، وقاربه بخدمته؛ فإن أولئك لباسهم الذلة، وشعارهم الملق، وقلوبهم ممن هم لهم خول مملوءة، قد لبسها الرعب، وألفها الذل، وصحبها ترقب الاحتياج؛ فهم مع هذا في تكدير وتنغيص، خوفاً من سطوة الرئيس وتنكيل الصاحب، وتغيير الدول، واعتراض حلول المحن. فإن هي حلت بهم، وكثيراً ما تحل، فناهيك بهم مرحومين يرق لهم الأعداء فضلاً عن الأولياء.
فكيف لا يميز بين من هذا ثمرة اختياره وغاية تحصيله، وبين من قد نال الرفاهية والدعة، وسلم من البوائق، مع كثرة الإثراء وقضاء اللذات، من غير منة لأحد، ولا منة يعتد بها رئيس ومن هو من نعم المفضلين خلي، وبين من قد استرقه المعروف، واستعبده الطمع، ولزمه ثقل الصنيعة، وطوق عنقه الامتنان، واسترهن بتحمل الشكر.
فصل منها
وقد علم المسلمون أن خيرة الله تعالى من خلقه، وصفيه من عباده، والمؤتمن على وحيه، من أهل بيت التجارة، وهي معولهم وعليها معتمدهم، وهي صناعة سلفهم، وسيرة خلفهم.ولقد بلغتك بسالتهم، ووصفت لك جلادتهم، ونعتت لك أحلامهم، وتقرر لك سخاؤهم وضيافتهم، وبذلهم ومواساتهم. وبالتجارة كانوا يعرفون. ولذلك قالت كاهنة اليمن " لله در الديار لقريش التجار " .
وليس قولهم: قرشي لقولهم: هاشمي، وزهري وتيمي؛ لأنه لم يكن لهم أب يسمى قريشاً فينتسبون إليه، ولكنه اسم اشتق لهم من التجارة والتقريش، فهو أفخم أسمائهم وأشرف أنسابهم، وهو الاسم الذي نوه الله تعالى به في كتابه، وخصهم به في محكم وحيه وتنزيله، فجعله قرآناً عربياً يتلى في المساجد، ويكتب في المصاحف، ويجهر به في الفرائض، وحظوة على الحبيب والخالص.
ولهم سوق عكاظ، وفيهم يقول أبو ذؤيب:
إذا ضربوا القباب على عكاظ ... وقام البيع واجتمع الألوف
وقد غبر النبي صلى الله عليه وسلم برهة من دهره تاجراً، وشخص فيه مسافراً، وباع واشترى حاضراً، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
ولم يقسم الله مذهباً رضياً، ولا خلقاً زكياً ولا عملاً مرضياً إلا وحظه منه أوفر الحظوظ، وقسمه فيه أجزل الأقسام.
ولشهرة أمره في البيع والشراء قال المشركون: " ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق " ، فأوحى الله إليه: " وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق " . فأخبر أن الأنبياء قبله كانت لهم صناعات وتجارات.
فصل منه
وإن الذي دعا صاحبك إلى ذم التجارة توهمه بقلة تحصيله، أنها تنقص من العلم والأدب وتقتطع دونهما وتمنع منهما. فأي صنف من العلم لم يبلغ التجار فيه غاية، أو يأخذوا منه بنصيب، أو يكونوا رؤساء أهله وعليتهم؟ !هل كان في التابعين أعلم من سعيد بن المسيب أو أنبل؟ وقد كان تاجراً يبيع ويشتري، وهو الذي يقول: ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي - رضوان الله عليهم - قضاءً إلا وقد علمته.
وكان أعبر الناس للرؤيا وأعلمهم بأنساب قريش. وهو من كان يفتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون. وله بعد علم بأخبار الجاهلية والإسلام، مع خشوعه وشدة اجتهاده وعبادته، وأمره بالمعروف، وجلالته في أعين الخلفاء، وتقدمه على الجبارين.
ومحمد بن سيرين في فقهه وورعه وطهارته.
ومسلم بن يسار في علمه وعبادته، واشتغاله بطاعة ربه.
وأيوب السختياني، ويونس بن عبيد، في فضلهما وورعهما.
فصل من صدر كتابه في الشارب والمشروب
سألت - أكرم الله وجهك، وأدام رشدك، ولطاعته توفيقك، حتى تبلغ من مصالح دينك ودنياك منازل ذوي الألباب، ودرجات أهل الثواب - أن أكتب لك صفات الشارب والمشروب وما فيهما من المدح والعيوب، وأن أميز لك بين الأنبذة والخمر، وأن أقفك على حد السكر، وأن أعرفك السبب الذي يرغب في شرب الأنبذة وما فيها من اجتلاب المنفعة، وما يكره من نبيذ الأوعية.وقلت: وما فرق ما بين الجر والسقاء، والمزفت والحنتم والدباء، وما القول في الممتل والمكسوب، وما فرق ما بين النقيع والداذي، وما المطبوخ والباذق، وما الغربي والمروق، وما الذي يحل من الطبيخ، وما القول في شرب الفضيخ، وهل يكره نبيذ العكر، وما القول في عتيق السكر، وأنبذة الجرار، وما يعمل من السكر، ولم كره النقير والمقير.
وسألت عن نبيذ العسل والعرطبات وعن رزين سوق الأهواز، وعن نبيذ أبي يوسف وجمهور، والمعلق والمسحوم. والحلو والترش شيرين ونبيذ الكشمش والتين، ولم كره الجلوس على البواطي والرياحين.
وقلت: وما نصيب الشيطان، وما حاصل الإنسان؟ وسألت عمن شرب الأنبذة أو كرهها من الأوائل، وما جرى بينهم فيها من الأجوبة والمسائل، وما كانوا عليه فيها من الآراء، وتشبثوا فيها من الأهواء، ولأي سبب تضادت فيها الآثار، واختلفت فيها الأخبار.
وسألت أن أقصد في ذلك إلى الإيجاز والاختصار، وحذف الإكثار وقلت: وإذ جعل الله تعالى للعباد عن الخمر المندوحة بالأشربة الهنية الممدوحة، فما تقول فيما حسن من الأنبذة صفاه، وبعد مداه، واشتدت قواه، وعتق حتى جاد، وعاد بعد قدم الكون صافي اللون، هل يحل إليه الاجتماع، وفيه الاكتراع، إذ كان يهضم الطعام ويوطىء المنام. وهو في لطائف الجسم سار، وفي خفيات العروق جار، ولا يضر معه برغوث ولا بعوض ولا جرجس عضوض.
وقلت: وكيف يحل لك ترك شربه إذا كان لك موافقاً، ولجسمك ملائماً. ولم لا قلت إن تارك شربه كتارك العلاج من أدوأ الأدواء وإنه كالمعين على نفسه إذا ترك شربه أفحش الداء. وأنت تعلم أنك إذا شربته عدلت به طبيعتك، وأصلحت به صفار جسمك، وأظهرت به حمرة لونك، فاستبدلت به من السقم صحة، ومن حلول العجز قوة، ومن الكسل نشاطاً، وإلى اللذة انبساطاً، ومن الغم فرجاً، ومن الجمود تحركاً، ومن الوحشة أنساً. وهو في الخلوة خير مسامر، وعند الحاجة خير ناصر. يترك الضعيف وهو مثل أسد العرين يلان له ولا يلين.
وقلت: الجيد من الأنبذة يصفي الذهن ويقوي الركن، ويشد القلب والظهر، ويمنع الضيم والقهر، ويشحذ المعدة، ويهيج للطعام الشهوة، ويقطع عن إكثار الماء، الذي منه جل الأدواء، ويحدر رطوبة الرأس، ويهيج العطاس، ويشد البضعة، ويزيد في النطفة، وينفي القرقرة والرياح، ويبعث الجود والسماح، ويمنع الطحال من العظم، والمعدة من التخم، ويحدر المرة والبلغم، ويلطف دم العروق ويجريه، ويرقه ويصفيه، ويبسط الآمال، وينعم البال، ويغشي الغلظ في الرئة، ويصفي البشرة ويترك اللون كالعصفر، ويحدر أذى الرأس في المنخر، ويموه الوجه ويسخن الكلية، ويلذ النوم ويحلل التخم، ويذهب بالإعياء، ويغذو لطيف الغذاء، ويطيب الأنفاس، ويطرد الوسواس، ويطرب النفس، ويؤنس من الوحشة، ويسكن الروعة، ويذهب الحشمة، ويقذف فضول الصلب بالإنشاط للجماع، وفضول المعدة بالهراع، ويشجع المرتاع ويزهي الذليل، ويكثر القليل، ويزيد في جمال الجميل، ويسلي الحزن ويجمع الذهن، وينفي الهم، ويطرد الغم، ويكشف عن قناع الحزم، ويولد في الحليم الحلم، ويكفي أضغاث الحلم، ويحث على الصبر، ويصحح من الفكر، ويرجي القانط، ويرضي الساخط، ويغني عن الجليس، ويقوم مقام الأنيس وحتى إن عز لم يقنط منه، وإن حضر لم يصبر عنه، يدفع النوازل العظيمة، وينقي الصدر من الخصومة، ويزيد في المساغ، وسخونة الدماغ، وينشط الباه حتى لا يزيف شيئاً يراه، وتقبله جميع الطبائع، ويمتزج به صنوف البدائع، من اللذة والسرور، والنضرة والحبور. وحتى سمي شربه قصفاً، وسمي فقده خسفاً. وإن شرب منه الصرف بغير مزاج، تحلل بغير علاج. ويكفي الأحزان والهموم، ويدفع الأهواء والسموم، ويفتح الذهن، ويمنع الغبن، ويلقن الجواب، ولا يكيد منه العتاب، به تمام اللذات، وكمال المروءات. ليس لشيء كحلاوته في النفوس، وكسطوته في الجباه والروس، وكإنشاطه للحديث والجلوس، يحمر الألوان، ويرطب الأبدان، ويخلع عن الطرب الأرسان.
وقلت: ومع كل ذلك فهو يلجلج اللسان، ويكثر الهذيان، ويظهر الفضول والأخلاط، ويناوب الكسل بعد النشاط. فأما إذا تبين في الرأس الميلان، واختلف عند المشي الرجلان، وأكثر الإخفاق، والتنخع والبصاق، واشتملت عليه الغفلة، وجاءت الزلة بعد الزلة ولا سواء إن دسع بطعامه، أو سال على الصدر لعابه، وصار في حد المخرفين، لا يفهم ولا يبين، فتلك دلالات النكر، وظهور علامات السكر، ينسي الذكر، ويورث الفكر، ويهتك الستر، ويسقط من الجدار، ويهور في الآبار، ويغرق في الأنهار، ويصرف عن المعروف، ويعرض للحتوف، ويحمل على الهفوة، ويؤكد الغفلة، ويورث الصياح أو الصمات، ويصرع الفهم للسبات فلغير معنىً يضحك، ولغير سبب يمحك، ويحيد عن الإنصاف، وينقلب على الساكت الكاف. ثم يظهر السرائر، ويطلع على ما في الضمائر، من مكنون الأحقاد، وخفي الاعتقاد.
وقد يقل على السكر المتاع، ويطول منه الأرق والصداع، ثم يورث بالغدوات الخمار، ويختل سائر، النهار ويمنع من إقامة الصلوات، وفهم الأوقات، ويعقب السل، ويعقب في القلوب الغل، ويجفف النطفة، ويورث الرعشة، ويولد الصفار، وضروب العلل في الإبصار، ويعقب الهزال، ويجحف بالمال ويجفف الطبيعة ويقوي الفاسد من المرة ويذيل النفس، ويفسد مزاج الحس، ويحدث الفتور في القلب، ويبطىء عند الجماع الصب، حتى يحدث من أجله الفتق، الذي ليس له رتق، ويحمل على المظالم، وركوب المآثم، وتضييع الحقوق حتى يقتل من غير علم، ويكفر من غير فهم.
فصل منه
وقلت: ومن الحلو في المعد التخم، وفي الأبدان الوخم، وللترش شيرين رياح كمثل رياح العدس، وحموضة تولد في الأسنان الضرس.والسكر فحسبك بفرط مرارته، وكسوف لونه، وبشاعة مذاقه، ولفار الطبيعة عنه.
وأنواع ما يعالج من التمور والحبوب فشربها الداء العضال.
وللمسجور، والبتي، وأشباهها كدورة ترسب في المعدة، وتولد بين الجلدتين الحكة. وأشباه هذا كثيرة تركت ذكرها، لأني لم أقصدك بالمسألة أبتغي منك تحليل ما يجلب المضرة.
ولكن ما تقول فيما يسرك ولا يسوءك، وما إذا شربته تلقته العروق فاتحة أفواهها كأفواه الفراخ، محسنة للون ملذة للنفس، يجثم على المعدة، ويرود في العروق، ويقصد إلى القلب فيولد فيه اللذة، وفي المعدة الهضم، وهو غسولها ونضوحها، ويسرع إلى طاعة الكبد، ويفيض بالعجل إلى الطحال، وينتفخ منه العروق، وتظهر حمرته بين الجلدتين، ويزيد في اللون، ويولد الشجاعة والسخاء، ويريح من اكتنان الضغن، ويعفي على تغير النكهة، وينفي الذفر، ويسرع إلى الجبهة، ويغني عن الصلاء، ويمنع القر؟ ! وما تقول في نبيذ الزبيب الحمصي. والعسل الماذي إذا تورد لونه، وتقادم كونه، ورأيت حمرته في صفرته تلوح. تراه في الكأس لكأنه بالشمس ملتحف، شعاعه يضحك بالأكف؟ وما تقول في عصير الكرم إذا أجدت طبخه وأنعمت إنضاجه، وأحسن الدن نتاجه، فإذا فض فض عن غضارة قد صار في لون البجادي في صفاء ياقوتة تلمع في الأكف لمع الدنانير، ويضيء كالشهاب المتقد.
وما تقول في نبيذ عسل مصر، فإنه يؤدي إلى شاربه الصحيح من طعم الزعفران، لا يلبس الخلقان ولا يجود إلا في جدد الدنان، ولا يستخدم الأنجاس ولا يألف الأرجاس. وكذلك لا يزكو على علاج الجنب والحائض، ولا ينفض على شيء من الأجسام لونه حتى لو غمس فيه قطن لخرج أبيض يققاً. وحسبك به في رقة الهواء، يكدره صافي الماء، وهو مع ذلك كالهزبر ذي الأشبال، المفترس للأقران، من عاقره عقره، ومن صارعه صرعه؟ ! وما تقول في رزين الأهواز من زبيب الداقياد إذ يعود صلباً من غير أن يسل سلافه، أو يماط عنه ثفله، حتى يعود كلون العقيق، في رائحة المسك العتيق. أصلب الأنبذة عريكة، وأصلبها صلابة، وأشدها خشونة. ثم لا يستعين بعسل ولا سكر ولا دوشاب. وما ظنك به وهو زبيب نقيع، لا يشتد ولا يجود إلا بالضرب الوجيع؟ ! وما تقول في الدوشاب البستاني، سلالة الرطب الجني بالحب الرتيلي، إذا أوجع ضرباً، وأطيل حبسا، وأعطى صفوه ومنح رفده، وبذل ما عنده، فإذا كشف عنه قناع الطين ظهر في لون الشقر والكمت وسطع برائحة كالمسك. وإذا هجم على المعدة لانت له الطبائع، وسلست له الأمعاء، وأيس الحصر، وانقطع طمع القولنج، وانقادت له اليبوسة، وأذعنت له بالطاعة، وابتل به الجلد القحل، وارتحل عنه الباسور، وكفى شاربه الوخز. فإذا شج بماء تلظى ورمى بشرره، هل يحل أن يشعشع إذا سكن جأشه، وآب إليه حلمه.
وما تقول في المعتق من أنبذة التمر، فإنك تنظر إليه وكأن النيران تلمع من جوفه. قد ركد ركود الزلال حتى لكأن شاربه يكرع في شهاب، ولكأنه فرند في وجه سيف. وله صفيحة مرآة مجلوة تحكي الوجوه في الزجاجة، حتى يهم فيها الجلاس؟ ! وما تقول في نبيذ الجزر، الذي منه تمتد النطفة وتشتد النقطة، يجلب الأحلام، ويركد في مخ العظام؟ ! وما تقول في نبيذ الكشمش الذي لونه لون زمردة خضراء، صافية، محكم الصلابة، مفرط الحرارة، حديد السورة، سريع الإفاقة عظيم المؤنة، قصير العمر، كثير العلل، جم البدوات تطمع الآفات فيه، وتسرع إليه؟ ! وما تقول في نبيذ التين فإنك تعلم أنه مع حرارته لين العريكة، سلس الطبيعة، عذب المذاق، سريع الإطلاق، مرهم للعروق، نضوح للكبد فتاح للسدد، غسال للأمعاء، هياج للباه، أخاذ للثمن، جلاب للمؤن، مع كسوف لون وقبح منظر؟ ! وما تقول في نبيذ السكر الذي ليس مقدار المنفعة به على قدر المؤونة فيه، هل يوجد في المحصول لشربه معنىً معقول؟ ! وما تقول في المروق والغربي والفضيخ؟ ألذ مشروبات في أزمانها وأنفع مأخوذات في إبانها. أقل شيء مؤونة، وأحسنه معونة، وأكثر شيء قنوعاً، وأسرعه بلوغاً، ضموزات عروفات للرجل ألوفات. ولها أراييح على الشاهسفرم كأذكى رائحة تشم، أقل المشروبات صداعاً، وأشدهن خداعا.
فصل منه
وكرهت أيضاً تقليد المختلف من الآثار فأكون كحاطب ليل، دون التأمل والاعتبار بأن ظلام الشك لا يجلوه إلا مفتاح اليقين.فصل منه
قد فهمت - أسعدك الله تعالى بطاعته - جميع ما ذكرت من أنواع الأنبذة، وبديع صفاتها، والفصل بين جيدها ورديها، ونافعها وضارها، وما سألت من الوقوف على حدودها. ولا زلت من عداد من يسأل ويبحث، ولا زلنا في عداد من يشرح ويفصح.اعلم - أكرمك الله - أنك لو بحثت عن أحوال من يؤثر شرب الخمور على الأنبذة، لم تجد إلا جاهلاً مخذولا، أو حدثاً مغروراً، أو خليعاً ماجناً، أو رعاعاً همجاً؛ ومن إذا غدا بهيمة، وإذا راح نعامة؛ ليس عنده من المعرفة أكثر من انتحال القول بالجماعة؛ قد مزج له الصحيح بالمحال، فهو مدين بتقليد الرجال، يشعشع الراح، ويحرم المباح، فمتى عذله عاذل ووعظه واعظ قال: الأشربة كلها خمر، فلا أشرب إلا أجودها.
وقد أحببت - أيدك الله - التوثق من إصغاء فهمك، وسؤت ظناً بالتغرير فقدمت لك من التوطئة ما يسهل لك سبيل المعرفة. وذلك إلى مثلك من مثلي حزم سيما فيما خفيت معالمه ودرست مناهجه، وكثرت شبهه، واشتد غموضه.
ولو لم يكن ذلك وكان قد اعتاص على البرهان في إظهاره، واحتجت في الإبانة عنه إلى ذكر ضده، ونظيره وشكله، لم أحتشم من الاستعانة بكل ذلك. فكيف والقدرة - بحمد الله - وافرة، والحجة واضحة.
قد يكون الشيء من جنس الحرام فيعالج بضرب من العلاج حتى يتغير بلون يحدث له، ورائحة وطعم ونحو ذلك، فيتغير لذلك اسمه، ويصير حلالاً بعد أن كان حراماً.
فصل منه في تحليل النبيذ دون الخمر
فإن قال لنا قائل: ما تدرون، لعل الأنبذة قد دخلت في ذكر تحريم الخمر، ولكن لما كان الابتداء أجري في ذكر تحريم الخمر، خرج التحريم عليها وحدها في ظاهر المخاطبة، ودخل سائر الأشربة في التحريم بالقصد والإرادة.قلنا: قد علمنا أن ذلك على خلاف ما ذكر السائل، لأسباب موجودة، وعلل معروفة.
منها: أن الصحابة الذين شهدوا نزول الفرائض، والتابعين من بعدهم، لم يختلفوا في قاذف المحصنين أن عليه الحد، واختلفوا في الأشربة التي تسكر، ليس لجهلهم أسماء الخمور ومعانيها، ولكن للأخبار المروية في تحريم المسكر، والواردة في تحليلها.
ولو كانت الأشربة كلها عند أهل اللغة في القديم خمراً لما احتاجوا إلى أهل الروايات في الخمر، أي الأجناس من الأشربة هي؟ كما لم يخرجوا إلى طلب معرفة العبيد من الإماء.
وهذا باب يطول شرحه إن استقصيت جميع ما فيه من المسألة والجواب.
وما ينكر من خالفنا في تحليل الأنبذة مع إقراره أن الأشربة المسكرة الكثيرة لم تزل معروفة بأسمائها وأعيانها، وأجناسها وبلدانها، وأن الله تعالى قصد للخمر من بين جميعها فحرمها، وترك سائر الأشربة طلقاً مع أجناس سائر المباح.
والدليل على تجويز ذلك أن الله تعالى ما حرم على الناس شيئاً من الأشياء في القديم والحديث إلا أطلق لهم من جنسه، وأباح من سنخه ونظيره وشبهه، ما يعمل مثل عمله أو قريباً منه، ليغنيهم بالحلال عن الحرام. أعني ما حرم بالسمع دون المحرم بالعقل. قد حرم من الدم المسفوح، وأباح غير المسفوح، كجامد دم الطحال والكبد وما أشبههما وحرم الميتة وأباح الذكية. وأباح أيضاً ميتة البحر وغير البحر، كالجراد وشبهه، وحرم الربا وأباح البيع، وحرم بيع ما ليس عندك وأباح السلم، وحرم الضيم وأباح الصلح، وحرم السفاح وأباح النكاح. وحرم الخنزير وأباح الجدي الرضيع، والخروف والحوار.
والحلال في كل ذلك أعظم موقعاً من الحرام.
فصل منه
ولعل قائلاً يقول: وأهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسكان حرمه ودار هجرته، أبصر بالحلال والحرام، والمسكر والخمر، وما أباح الرسول وما حظره، وكيف لا يكون كذلك والدين ومعالمه من عندهم خرج إلى الناس؛ والوحي عليهم نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم دفن. وهم المهاجرون السابقون، والأنصار المؤثرون على أنفسهم. وكلهم مجمع على تحريم الأنبذة المسكرة، وأنها كالخمر.وخلفهم على منهاج سلفهم إلى هذه الغاية، حتى إنهم جلدوا على الريح الخفي.
وكيف لا يفعلون ذلك ويدينون به وقد شهدوا من شهد النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها وذمها، وأمر بجلد شاربها.
ثم كذلك فعل أئمة الهدى من بعده. فهم إلى يوم الناس على رأي واحد، وأمر متفق، ينهون عن شربها، ويجلدون عليها.
وإنا نقول في ذلك: إن عظم حق البلدة لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وإنما يعرف الحلال والحرام بالكتاب الناطق، والسنة المجمع عليها، والعقول الصحيحة، والمقاييس المصيبة.
وبعد، فمن هذا المهاجري أو الأنصاري، الذي رووا عنه تحريم الأنبذة ثم لم يرووا عنه التحليل؟ بل لو أنصف القائل لعلم أن الذين من أهل المدينة حرموا الأنبذة ليسوا بأفضل من الذين أحلوا النكاح في أدبار النساء، كما استحل قوم من أهل مكة عارية الفروج، وحرم بعضهم ذبائح الزنوج، لأنهم فيما زعموا مشوهو الخلق. ثم حكموا بالشاهد واليمين خلافاً لظاهر التنزيل. وأهل المدينة وإن كانوا جلدوا على الريح الخفي فقد جلدوا على حمل الزق الفارغ؛ لأنهم زعموا أنه آلة الخمر، حتى قال بعض من ينكر عليهم: فهلا جلدوا أنفسهم؟ لأنه ليس منهم إلا ومعه آلة الزنى! وكان يجب على هذا المثال أن يحكم بمثل ذلك على حامل السيف والسكين والسم القاتل، في نظائر ذلك؛ لأن هذه كلها آلات القتل.
وبعد، فأهل المدينة لم يخرجوا من طبائع الإنس إلى طبع الملائكة. ولو كان كل ما يقولونه حقاً وصواباً لجلدوا من كان في دار معبد، والغريض، وابن سريج، ودحمان وابن محرز وعلويه وابن جامع، ومخارق، وشريك، ووكيع، وحماد، وإبراهيم وجماعة التابعين، والسلف والمتقدمين؛ لأن هؤلاء فيما زعموا كانوا يشربون الأنبذة التي هي عندهم خمر؛ وأولئك كانوا يعالجون الأغاني التي هي حل طلق، على نقر العيدان والطنابير، والنايات والصنج والزنج، والمعازف التي ليست محرمة ولا منهياً عن شيء منها.
ولو كان ما خالفونا فيه من تحليل الأنبذة وتحريمها، كالاختلاف في الأغاني وصفاتها وأوزانها، واختلاف مخارجها، ووجوه مصارفها ومجاريها، وما يدمج ويوصل منها، وما للحنجرة والحنك والنفس واللهوات وتحت اللسان من نغمها. وأي الدساتين أطرب، وأي أصوب، وما يحفز بالهمز أو يحرك بالضم؛ وكالقول بأن الهزج بالبنصر أطيب، أو بالوسطى؟ والسريع على الزير ألذ، أو على المثنى؟ والمصعد في لين أطرب أم المحدر في الشدة؟ لسهل ذلك ولسلمنا علمه لمن يدعيه، ولم نجاذب من يدعي دوننا معرفته.
فصل منه
ولهج أصحاب الحديث بحكم لم أسمع بمثله في تزييف الرجال، وتصحيح الأخبار. وإنما أكثروا في ذلك، لتعلم حيدهم عن التفتيش، وميلهم عن التنقير، وانحرافهم عن الإنصاف.فصل منه
والذي دعاني إلى وضع جميع هذه الأشربة والوقوف على أجناسها وبلدانها، مخافة أن يقع هذا الكتاب عند بعض من عساه لا يعرف جميعها، ولم يسمع بذكرها، فيتوهم أني في ذكر أجناسها المستشنعة وأنواعها المبتدعة، كالهاذي برقية العقرب، وإن كان قصدي لذكرها في صدر الكتاب لأقف على حلالها وحرامها، وكيف اختلفت الأمة فيها، وما سبب اعتراض الشك واستكمان الشبهة؛ ولأن أحتج للمباح وأعطيه حقه، وأكشف أيضاً عن المحظور فأقسم له قسطه، فأكون قد سلكت بالحرام سبيله، وبالحلال منهجه، اقتداءً مني بقول الله عز وجل: " يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .وقد كتبت لك - أكرمك الله - في هذا الكتاب ما فيه الجزاية والكفاية، ولو بسطت القول لوجدته متسعاً، ولأتاك منه الدهم. وربما كان الإقلال في إيجاز أجدى من إكثار يخاف عليه الملل. فخلطت لك جداً بهزل، وقرنت لك حجة بملحة، ليخف مؤونة الكتاب على القارىء، وليزيد ذلك في نشاط المستمع، فجعلت الهزل بعد الجد جماماً، والملحة بعد الحجة مستراحاً.
فصل من صدر كتابه في الجوابات في الإمامة
يحكي فيه قول من يجيز أكثر من إمام واحد
زعم قوم أن الإمامة لا تجب لرجل واحد بعينه، من رهط واحد بعينه، ولا لواحد من عرض الناس، وإن كان أكثرهم فضلاً، وأعظمهم عن المسلمين غناء، بعد أن يكون فرداً في الإمامة لا ثاني له. وأن الناس إن تركوا أن يقيموا إماماً واحداً جاز لهم ذلك، ولم يكونوا بتركه ضالين ولا عاصين ولا كافرين؛ فإن أقاموه كان ذلك رأياً رأوه، وغير مضيق عليهم تركه.ولهم أن يقيموا اثنين، وجائز لهم أن يقيموا أكثر من ذلك، ولا بأس أن يكونوا عجما وموالي، ولكن لابد من حاكم، واحداً كان أو أكثر على حال. ولا يجوز أن يكون الرجل حاكماً على نفسه وقائماً عليها بالحدود.
ولم يقل أحد ألبتة أن من الحكم والحاكم بداً، ولكنهم اختلفوا في جهاتهم ومعانيهم.
وقالوا: وأي ذلك كان، إقامة الواحد والاثنين أو أكثر من ذلك، فعلى الناس الكف عن محارمهم، وترك التباغي فيما بينهم، والتخاذل عند الحادثة تنوبهم، من عدو يدهمهم من غيرهم، أو خارب يخيف سبلهم من أهل دعوتهم.
وعليهم فيما شجر بينهم إعطاء النصفة من أنفسهم بالغاً ما بلغ، في عسر الأمر ويسره. وعلى كل رجل في داره وبيته وقبيلته، وناحيته ومصره، إذا كان مأموناً ذا صلاح وعلم، إذا ثبتت عنده على أخيه وصاحبه وجاره، وحاشيته من خدمه، حد أو حكم جناه جان عليهم أو على نفسه أو ظلم ركبه من غيره، إقامة ذلك الحكم والحد عليه، إذا أمكنه مستحقه؛ إلا أن يكون فوقه كاف قد أجزى عنه.
وعلى المجترح للذنب الموجب على نفسه الحد، والمستحق له، إمضاء الحكم في بدنه وماله، والإمكان من نفسه، وأن لا يعاز بقوة، ولا يروغ بحيلة، ولا يسخط حكم التنزيل فيما نزل به، وفيما هو بسبيله من مال أو غيره. وإنما يجب ذلك إذا كان على الفريقين من القيم، والجاني يمكنه ما كلفه الله من ذلك. فإن أبى القيم إقامة الحق والحد على الجاني بعد استيجابه، والإمكان من نفسه لإقامة الحد عليه، فقد عصى الله تعالى ولم يؤت في ذلك الأمر نفسه، لأن الله تعالى قد بينه له، وأوجبه عليه، وقرره حين أوضح له الحجة وقرب الدلالة، وطوقه المعرفة، ومكنه من الفعل.
وقد بسطنا العذر لذوي العجز في صدر الكلام.
وإن أبى الجاني المستحق للحكم والحد، الإمكان من نفسه وماله، وما هو بسبيله، فقد عصى الله في ذلك ، كما عصاه في ركوبه ما أوجب عليه الحد، ولم يؤت من ربه لما ذكرنا من إيضاح الحجة وإثبات القدرة.
فصل منه
وقد علمنا أن من شأن الناس الهرب إذا خافوا نزول المكروه، والامتناع من إمضاء الحدود بعد وجوبها عليهم، ما وجدوا السبيل إلى ذلك. وهذا سبب إسقاط الأحكام والتفاسد.وقد أمرنا أن نترك أسباب الفساد ما استطعنا، وبالنظر للرعية ما أمكننا، فوجب علينا عند الذي قلنا، أنا لو لم نقم إماماً واحداً كان الناس على ما وصفنا من التسرع إلى الشيء إذا طمعوا، والهرب إذا خافوا. وهذا أمر قد جرت به عامة المعرفة، وفتحت عندنا فيه التجربة.
قلنا عند ذلك إن الإمامة لا تجب على الناس من طريق الظنون وإشفاق النفوس.
وقد رأينا أعظم منه خطراً، وقدراً ونفعاً، في كل جهة على خلاف ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى أمة وقد علم أنهم يزدادون مع كفرهم المتقدم من قبل ذلك الرسول كفراً، بجحدهم له، وإخراجهم إياه، وقصدهم قتله، ثم لا يكون ذلك مانعاً له من الإرسال إليهم والاحتجاج به عليهم، لمكان علمه أنهم يزدادون فساداً وتباغياً؛ إذ كان قدم لهم ما به ينالون مصالح دينهم ودنياهم. وإنما على الحكيم أن يأتي الأمر الحكيم، عرف ذلك عارف أم جهله جاهل.
وعلى الجواد ذي الرحمة في جوده ورحمته، أن يفعل ما هو أفضل في الجود، وأبلغ في الإحسان، وألطف في الإنعام من إيضاح الحجة وتسهيل الطرق، والإبلاغ في الموعظة، مع ضمان الوعد بالغاية من الثواب والدوام واللذة، والتوعد بغاية العقاب في الدوام والمكروه إلى عباده الذين كلفهم طاعته، وأهل الفاقة إلى عائدته ونظره وإحسانه.
فإن قبل ذلك قابل فقد أصاب حظه، وإن أبى ذلك فنفسه ظلم، وقد صنع الله به ما هو أصلح وإن لم يستطع العبد نفسه.
قالوا: فإذا كان الله تبارك وتعالى عالماً بأن القوم يزدادون فساداً عند إرسال الرسل، وكان غير صارف لهم عن الإرسال إليهم، إذ كان قد عدل خلقهم، ومكنهم من مصلحتهم، فما بال الظن والحسبان بأن الناس يتفاسدون ويتنازعون، إذا لم يقيموا إماماً واحداً يوجب فرضاً لم ينطق به كتاب ولم يؤكده خبر. وقد رأينا العلم بأن الناس يتفاسدون بما لا يرد به فرض.
فصل منه
وقالوا: قد رأينا أهل الصلاح والقدر، عند انتشار أمر السلطان، وغلبة السفلة والدعار، وهيج العوام، يقوم منهم العدد اليسير في الناحية والقبيلة، والدرب والمحلة فيفل لهم حد المستطيل، ويقمع شذاذ الدعار، حتى يسرح الضعيف ويأمن الخائف، وينتشر التاجر، ويكبر جانبهم الداعر.وإنما صلاح الناس بقدر تعاونهم وتخاذلهم. مع أن الناس لو تركهم المتسلطون عليهم، وألجئوا إلى أنفسهم حتى يتحقق عندهم أن لا كافي إلا بطشهم وحيلهم، وحتى تكون الحاجة إلى الذب والحراسة، والعلم بالمكيدة، هي التي تحملهم على منع أنفسهم؛ ولذهبت عادة الكفاية، وضعف الاتكال، ولتعودوا اليقظة، ولدربوا بالحراسة، واستثاروا دفين الرأي؛ لأن الحاجة تفتق الحيلة وتبعث على الروية، وكان بالحرى أن يصلح أمر الجميع؛ لأن طمع الراعي إذا عاد بأساً صرفه في البغي. وكان في ذلك منبهة للنائم ومشحذة لليقظان، وضراوة للمواكل، ومزجرة للبغاة، حتى ينبت عليه الصغير، ويتفحل معه الكبير.
فصل منه
وزعم قوم أن الإمامة لا تجب إلا بأحد وجوه ثلاثة: إما عقل يدل على سببها، أو خبر لا يكذب مثله، أو أنه لا يحتمل شيئاً من التأويل إلا وجهاً واحداً.قالوا: فوجدنا الأخبار مختلفة، والمختلف منها متدافع، وليس في المتدافع والمتكافىء بيان ولا فضل.
فمن ذلك قول الأنصار، وهم شطر الناس وأكثرهم، مع أمانتهم على دين الله تعالى، وعلمهم بالكتاب والسنة، حيث قالت عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: " منا أمير ومنكم أمير " .
فلو كان قد سبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر ما كان أحد أعلم به منهم، ولا أخلق للإقرار والعمل بما يلزم، والصبر عليه منهم، بعد الذي ظهر من احتمالهم في جنب الله تعالى، والجهاد في سبيله، والنصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم مع الإيواء والإيثار، بعد المواساة، ومحاربة القريب والبعيد، والعرب قاطبة وقريش خاصة. ثم الذي نطق القرآن به من تزكيتهم وتفضيلهم، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وثقته بهم وثنائه عليهم، وهو يقول: " أما والله ما علمتكم إلا لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع " ، في أمور كثيرة.
ثم لم يكن قولهم: " منا أمير ومنكم أمير " من سفيه من سفهائهم ضوى إليه أمثاله منهم، فإن لكل قوم حسدة وجهالا، وأحداثاً وسرعانا، من حدث تبعثه الغرارة والأشر، ورجل يحب الجاه والفتنة، أو مغفل مخدوع، أو غر ذي حمية يؤثر حسبه ونسبه على دين الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولا كان ذلك القول، إن كان من عليتهم، في الواحد الشاذ القليل، بل كان في ذوي أحلامهم والقدم منهم.
ثم كان المرشح والمأمول عندهم سعد بن عبادة، سيداً مطاعاً، ذا سابقة وفضل، وحلم ونجدة، وجاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغاثة به في الحوادث والمهم من أمره.
ثم كان في الدهم من الأنصار، والوجوه والجمهور من الأوس والخزرج. فكيف يكون سبق من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أمر يقطع عذراً ويوجب رضاً، وهؤلاء الأمناء على الدين، والقوام عليه، قد قاموا هذا المقام، وقالوا هذا المقال.
قالوا: فإن قال قائل: فإن القوم كانوا على طبقات، من ذاكر متعمد، وناس قد كان سقط عن ذكره وحفظه، ومن رجل كان غائباً عن ذلك القول والتأكيد الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وآله، في إقامة إمام يقدم في أيام وفاته وشكاته، ومن رجل قدم في الإسلام لم يكن من حمال العلم، فأذكرهم أبو بكر وعمر فذكروا، ووعظاهم فاتعظوا. فقد كان فيهم الناشىء الفاضل الذي يزجره الذكر، وينزع إذا بصر؛ والمعتمد الذي لم يبلغ من لجاجه وتتايعه، وركوب ردعه ما يؤثر معه التصميم على حسن الرجوع عند الموعظة الحسنة، والتخويف بفساد العاجل، في كثير ممن لم يكن له في الإسلام القدر النبيه، إما للغفلة، وإما للإبطاء عنه، وإما للخمول في قومه مع إسلامه وصحة عقده. فداواهم أبو بكر وعمر يوم السقيفة حين قالا: " نحن الأئمة وأنتم الوزراء " . وحيث رووا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأئمة من قريش " . فلما استرجعوا رجعوا.
قلنا: الدليل على أن القوم لم يروا في كلام أبي بكر وعمر حجة عليهم، وأن انصرافهم عما اجتمعوا له لم يكن لأنهم رأوا أن ذلك القول من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح حجة، غضب رئيسهم وخروجه من بين أظهرهم مراغماً، في رجال من رهطه، مع تركه بيعة أبي بكر رضوان الله عليه، وتشنيعه عليهم بالشام.
وقد قال قيس بن سعد بن عبادة، وهو يذكر خذلان الأنصار لسعد بن عبادة: واستبداد الرهط من قريش عليهم، بالأمر:
وخبرتمونا أنما الأمر فيكم ... خلاف رسول الله يوم التشاجر
وأن وزارات الخلافة دونكم ... كما جاءكم ذو العرش دون العشائر
فهلا وزيراً واحداً تجتبونه ... بغير وداد منكم وأواصر
سقى الله سعداً يوم ذاك ولا سقى ... عراجلة هابت صدور المنابر
وقال رجل من الأنصار، ودعاه علي رضوان الله عليه إلى عونه ونصرته، إما يوم الجمل، أو يوم صفين:
ما لي أقاتل عن قوم إذا قدروا ... عدنا عدواً وكنا قبل أنصارا
ويل لها أمة لو أن قائدها ... يتلو الكتاب ويخشى النار والعارا
أما قريش فلم نسمع بمثلهم ... غدراً وأعجب في الإسلام آثارا
إلا تكن عصبة خالوا نبيهم ... بالعرف عرفاً وبالإنكار إنكارا
أبا عمارة والثاوي ببلقعة ... في يوم مؤتة لا ينفك طيارا
أبا عمارة: حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه، وقد كان يكنى أبا يعلى، والثاوي في يوم مؤتة: جعفر بن أبي طالب.
وقال رجل من الأنصار من ولد أبي زيد القارىء، وذكر أمر الأنصار وأمر قريش:
دعاها إلى استبدادها وحقودها ... تذكر قتلى في القليب تكبكبوا
هنالك قتلى لا تؤدى دياتهم ... وليس لباكيها سوى الصبر مذهب
فإن تغضب الأبناء من قبل من مضى ... فوالله ما جئنا قبيحاً فتعتبوا
فصل منه
قد حكينا قول من خالفنا في وجوب الإمامة وتعظيم الخلافة، وفسرنا وجوه اختلافهم، واستقصينا جميع حججهم، إذ كان على عذر لما غاب عنه خصمه، وقد تكفل بالإخبار عنه في ترك الحيطة له، والقيام بحجته. كما أنه لا عذر له في التقصير عن إفناد من يخالفه، وكشف خطاء من يضاده عند ما قرأ كتابه، وتفهم حجته. لأن أقل ما يزيل عذره، ويزيح علته، أن يكون قول خصمه قد استهدف لعقله، وأصحر للسانه، وقد مكنه من نفسه، وسلطه على إظهار عورته. فإذا استراح شغب المنازع، ومداراة المستمع لم يبق إلا أن يقوى على خلافه أو يعجز عنه.ومن شكر المعرفة بمغاوي الناس ومراشدهم، ومضارهم ومنافعهم: أن يحتمل ثقل مؤنتهم وتعريفهم، وأن يتوخى إرشادهم، وإن جهلوا فضل من يسدي إليهم.
ولن يصان العلم بمثل بذله، ولن تستبقى النعمة فيه بمثل نشره.
وأعلم أن قراءة الكتب أبلغ في إرشادهم من تلاقيهم، إذ كان مع التلاقي يقوى التصنع، ويكثر التظالم، وتفرط النصرة، وتنبعث الحمية. وعند المزاحمة تشتد الغلبة وشهوة المباهاة، والاستحياء من الرجوع، والأنفة من الخضوع. وعن جميع ذلك تحدث الضغائن، ويظهر التباين، وإذا كانت القلوب على هذه الصفة، وبهذه الحالة، امتنعت من المعرفة وعميت عن الدلالة.
وليست في الكتب علة تمنع من درك البغية، وإصابة الحجة؛ لأن المتوحد بقراءتها، والمتفرد بفهم معانيها، لا يباهي نفسه ولا يغالب عقله ولا يعاز خصمه.
والكتاب قد يفضل ويرجح على واضعه بأمور: منها: أن الكتاب يقرأ بكل مكان وفي كل زمان، على تفاوت الأعصار، وبعد ما بين الأمصار. وذلك أمر يستحيل في الواضع ولا يطمع فيه من المنازع. وقد يذهب العالم وتبقى كتبه، ويفنى ويبقى أثره.
ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها، وخلقت من عجيب حكمها ودونت من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها ما غاب عنا، وفتحنا بها المستغلق علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم، لقد خس حظنا في الحكمة، وانقطع سبيلنا إلى المعرفة.
ولو ألجئنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا، ومنتهى تجاربنا، بما أدركته حواسنا، وشاهدته نفوسنا، لقد قلت المعرفة وقصرت الهمة وضعفت المنة، فاعتقم الرأي ومات الخاطر، وتبلد العقل، واستبد بنا سوء العادة.
وأكثر من كتبهم نفعاً، وأحسن مما تكلفوا موقعاً، كتب الله تعالى، التي فيها الهدى والرحمة، والإخبار عن كل عبرة، وتعريف كل سيئة وحسنة.
فينبغي أن يكون سبيلنا فيمن بعدنا سبيل من قبلنا فينا. مع أنا قد وجدنا في العبرة أكثر مما وجدوا، كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا.
فما ينتظر الفقيه بفقهه والمحتج لدينه، والذاب عن مذهبه، ومواسي الناس في معرفته، وقد أمكن القول وأطرق السامع، ونجا من التقية، وهبت ريح العلماء.
فصل منه
واعلم أن قصد العبد بنعم الله تعالى إلى مخالفته، غير مخرج إنعام الله تعالى عليه، ولا يحول إحسانه إليه إلى غير معناه وحقيقته، ولم يكن إحسان الله في إعطائه الأداة وتبيين الحجة لينقلبا إفساداً وإساءة؛ لأن المعان على الطاعة عصى بالمعونة، وأفسد بالإنعام، وأساء بالإحسان.
وفرق بين المنعم والمنعم عليه؛ لأن المنعم عليه يجب أن يكون شكوراً، ولحق النعمة راعياً، والمنعم منفرد بحسن الإنعام، وشريك في جميل الشكر. ولأن المنعم أيضاً هو الذي حبب الشكر إلى فاعله، بالذي قدم إليه من إحسانه، وتولى من يساره، ولذلك جعلوا النعمة لقاحاً، والشكر ولاداً. وإنما مثل إعطاء الآلة والتكليف لفعل الخير مثل رجل تصدق على فقير ليستر عورته، ويقيم من أود صلبه، وليصرف في منافعه، ولا يكون إنفاق الفقير ذلك الشيء في الفساد والخلاف والفواحش، لينقلب إحسان المتصدق إساءة. وإنما هذا بصواب الرأي الذي لا ينقلب صواباً وإن أنجح صاحبه.
وقد يؤتى الرجل من حزمه ولا يكون مذموماً، ويحظى بالإضاعة ولا يكون محموداً.
فصل منه
ولم يكن الله تعالى ليضع العدل ميزاناً بين خلقه، وعياراً على عباده، في نظر عقولهم في ظاهر ما فرض عليهم، وييسر خلافه، ويستخفي بضده، ويعلم أن قضاءه فيهم غير الذي فطرهم على استحسانه، وتحبب إليهم به، في ظاهر دينه، والذي استجوب به على الشكر على جميع خلقه.فصل منه
وإن لم يكن العبد على ما وصفنا من الاستطاعة والقدرة، والحال التي هي أدعى إلى المصلحة، ما كان متروكاً على طباعه ودواعي شهواته، دون تعديل طبعه وتسوية تركيبه.ولذلك أسباب نحن ذاكروها، وجاعلوها حجة في إقامة الإمامة،وأن عليها مدار المصلحة، وأن طبع البشر يمتنع من الإخبار إلا على ما نحن ذاكروه، فنقول: إنا لما رأينا طبائع الناس وشهواتهم، من شأنها التقلب إلى هلكتهم وفساد دينهم ، وذهاب دنياهم، وإن كانت العامة أسرع إلى ذلك من الخاصة، فكل لا تنفك طبائعهم من حملهم على ما يرديهم، ما لم يردوا بالقمع الشديد في العاجل، من القصاص العادل، ثم التنكيل في العقوبة على شر الجناية،وإسقاط القدر، وإزالة العدالة، مع الأسماء القبيحة، والألقاب الهجينة، ثم بالإخافة الشديدة والحبس الطويل، والتغريب عن الوطن، ثم الوعيد بنار الأبد، مع فوت الجنة.
وإنما وضع الله تعالى هذه الخصال لتكون لقوة العقل مادة، ولتعديل الطبائع معونة؛ لأن العبد إذا فضلت قوى طبائعه وشهواته على قوى عقله ورأيه، ألفي بصيراً بالرشد غير قادر عليه، فإذا احتوشته المخاوف كانت مواد لزواجر عقله، وأوامر رأيه. فإذا لم يكن في حوادث الطبائع ودواعي الشهوات وحب العاجل فضل على زواجر العقل وأوامره ألفي العبد ممتنعاً من الغي قادراً عليه؛ لأن الغضب والحسد والبخل والجبن، والغيرة، وحب الشهوات والنساء، والمكاثرة، والعجب والخيلاء وأنواع هذه إذا قويت دواعيها لأهلها، واشتدت جواذبها لصاحبها، ثم لم يعلم أن فوقه ناقماً عليه، وأن له منتقماً لنفسه من نفسه، أو مقتضياً منه لغيره، كان ميله وذهابه مع جواذب الطبيعة ودواعي الشهوة طباعاً لا يمتنع منه، وواجباً لا يستطيع غيره.
أو ما رأيته كيف يخرق في ماله، ويسرع فيما أثلت له رجاله، وشيدت له أوائله، من غير أن يرى للعوض وجهاً، وللخلف سبباً في عاجل دينه، ولا آجل دنياه، حتى يكون والي المسلمين هو الذي يحجر عليه؛ ليكون مضض الحجر وذل الخطر، وغلظة الجفوة. واللقب القبيح، وتسليط الأشكال، مادة للذي معه من معرفته وبقية عقله.
فصل منه
وقد يكون الرجل معروفاً بالنزق مذكوراً بالطيش مستهاماً بإظهار الصولة حتى يتحامى كلامه الصديق، ويداريه الجليس، ويترك مجاراته الكريم، للذي يعرفون من شذاته، وبوادر حدته وشدة تسعره والتهابه، وكثرة فلتاته. ثم لا يلبث أن يحضر الوالي الصليب والرجل المنيع، فيلفى ذليلاً خاضعاً، أو حليماً وقوراً، أو أديباً رفيقاً، أو صبوراً محتسباً.وقد نجده يجهل على خصمه، ويستطيل على منازعه، ويهم بتناوله والغدر به، فإذا عرف له حماة تكفيه، وجهالاً تحميه، وجاهاً يمنعه، ومالاً يصول به، طامن له من شخصه، وألان له من جانبه، وسكن من حركته، وأطفأ نار غضبه.
أو ما علمت أن الخوف يطرد السكر، ويميت الشهوة، ويطفىء الغضب، ويحط الكبر، ويذكر بالعاقبة، ويساعد العقل، ويعاون الرأي، وينبت الحيلة ويبعث على الروية؛ حتى يعتدل به تركيب من كان مغلوباً على عقله، ممنوعاً من رأيه، بسكر الشباب وسكر الغناء وإهمال الأمر، وثقة العز، وبأو القدرة.
فصل منه
وإنما أطنبت لك في تفسير هذه الأحوال التي عليها الوجود والعبرة، لتعلم أن الناس لو تركوا وشهواتهم، وخلوا وأهواءهم وليس معهم من عقولهم إلا حصة الغريزة ونصيب التركيب، ثم أخلوا من المرشدين والمؤدبين، والمعترضين بين النفوس وأهوائها، وبين الطبائع وغلبتها، من الأنبياء وخلفائها، لم يكن في قوى عقولهم ما يداوون به أدواءهم، ويجبرون به من أهوائهم، ويقوون به لمحاربة طبائعهم، ويعرفون به جميع مصالحهم.وأي داء هو أردى من طبيعة تردي، وشهوة تطغي؟ ! ومن كان لا يعد الداء إلا ما كان مؤلماً في وقته، ضارباً على صاحبه في سواد ليله وبياض نهاره، فقد جهل معنى الداء. وجاهل الداء جاهل بالدواء.
فصل منه
ولكنا نقول: لا يجوز أن يلي أمر المسلمين على ظاهر الرأي والحزم والحيطة أكثر من واحد، لأن الحكام والسادة إذا تقاربت أقدارهم وتساوت عنايتهم قويت دواعيهم إلى طلب الاستعلاء، واشتدت منافستهم في الغلبة.وهكذا جرب الناس من أنفسهم في جيرانهم الأدنين في الأصهار وبني الأعمام، والمتقاربين في الصناعات، كالكلام، والنجوم، والطب والفتيا، والشعر، والنحو والعروض، والتجارة، والصباغة، والفلاحة أنهم إذا تدانوا في الأقدار، وتقاربوا في الطبقات، قويت دواعيهم إلى طلب الغلبة، واشتدت جوانبهم في حب المباينة، والاستيلاء على الرياسة.
ومتى كانت الدواعي أقوى كانت النفس إلى الفساد أميل، والعزم أضعف، وموضع الروية أشغل، والشيطان فيهم أطمع؛ وكان الخوف عليهم أشد، وكانوا بموافقة المفسد أحرى، وإليه أقرب.
وإذا كان ذلك كذلك فأصلح الأمور للحكام والقادة، إذا كانت النفوس ودواعيها ومجرى أفعالها على ما وصفنا، أن ترفع عنهم أسباب التحاسد والتغالب، والمباهاة والمنافسة.
وإن ذلك أدعى إلى صلاح ذات البين، وأمن البيضة، وحفظ الأطراف.
وإذا كان الله تبارك وتعالى، قد كلف الناس النظر لأنفسهم، واستيفاء النعمة عليهم، وترك الخطار بالهلكة والتغرير بالأمة، وليس عليهم مما يمكنهم أكثر من الحيطة والتباعد من التغرير. ولا حال أدعى إلى ذلك أكثر مما وصفنا، لأنه أشبه الوجوه بتمام المصلحة، والتمتع بالأمن والنعمة.
فصل منه
فلما كان ذلك كذلك علمنا أنه إذا كان القائم بأمور المسلمين بائن الأمر، متفرداً بالغاية من الفضل، كانت دواعي الناس إلى مسابقته ومجاراته أقل.ولم يكن الله ليطبع الدنيا وأهلها على هذه الطبيعة، ويركبها وأهلها هذا التركيب، حتى تكون إقامة الواحد من الناس أصلح لهم، إلا وذلك الواحد موجود عند إرادتهم له، وقصدهم إليه؛ لأن الله لا يلزم الناس في ظاهر الرأي والحيطة إقامة المعدوم، وتشييد المجهول؛ لأن على الناس التسليم، وعلى الله تعالى قصد السبيل.
وهل رأيتم ملكين أو سيدين في جاهلية أو إسلام، من العرب جميعاً أو من العجم، لا يتحيف أحدهما من سلطان صاحبه ولا ينهك أطرافه، ولا يساجله الحروب؛ إذ كل واحد منهما يطمع في حد صاحبه وطرفه، لتقارب الحال، واستواء القري. كما جاءت الأخبار عن ملوك الطوائف كيف كانت الحروب راكدة وأمرهم مريج، والناس نهب، ليس ثغر إلا معطل، ولا طرف إلا منكشف، والناس فيما بينهم مشغولون بأنفسهم، ملوكهم من عز بز، مع إنفاق المال، وشغل البال، وشدة الخطار بالجميع، والتغرير بالكل.
فصل منه
وإن قالوا: فما صفة أفضلهم؟ قلنا: أن يكون أقوى طبائعه عقله، ثم يصل قوة عقله بشدة الفحص وكثرة السماع، ثم يصل شدة فحصه وكثرة سماعه بحسن العادة. فإذا جمع إلى قوة عقله علماً، وإلى علمه حزماً، وإلى حزمه عزماً، فذلك الذي لا بعده.وقد يكون الرجل دونه في أمور وهو يستحق مرتبة الإمامة، ومنزلة الخلافة، غير أنه على حال لا بد من أن يكون أفضل أهل دهره. لأن من التعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقام فيه إلا أشبه الناس به في كل عصر. ومن الاستهانة به أن يقام فيه من لا يشبهه وليس في طريقته.
وإنما يشبه الإمام الرسول بأن يكون لا أحد آخذ بسيرته منه. فأما أن يقاربه أو يدانيه فهذا ما لا يجوز، ولا يسع تمنيه، والدعاء به.
فصل منه
وإذا كان قول المهاجرين والأنصار والذين جرى بينهم التنافس والمشاحة على ما وصفنا في يوم السقيفة، ثم صنيع أبي بكر وقوله لطلحة في عمر؛ وصنيع عمر في وضع الشورى وتوعدهم له بالقتل إن هم لم يقيموا رجلاً قبل انقضاء المدة، ونجوم الفتنة؛ ثم صنيع عثمان وقوله وصبره حتى قتل دونهما ولم يخلعها؛ وأقوال طلحة والزبير وعائشة وعلي رحمة الله عليهم وعليها، ليست بحجة على ما قلنا فليست في الأرض دلالة ولا حجة قاطعة.وفي هذا الباب الذي وصفنا، ونزلنا من حالاتهم وبينا، دليل على أنهم كانوا يرون أن إقامة الإمام فريضة واجبة، وأن الشركة عنها منفية، وأن الإمامة تجمع صلاح الدين وإيثار خير الآخرة والأولى.
فصل منه
وأي مذهب هو أشنع، وأي قول هو أفحش، من قول من قال: لا بد للشاهد من أن يكون طاهراً عدلا مأموناً، ولا بأس أن يكون القاضي جائراً، نطفاً فاجراً، وهذا لا يشبه حكم الحكيم، وصفة الحليم، ونظر المرشد، وترتيب العالم.فصل من صدر كتابه في مقالة الزيدية والرافضة
اعلم - يرحمنا الله وإياك - أن شيعة علي رضي الله عنه زيدي ورافضي، وبقيتهم بدد لا نظام لهم، وفي الإخبار عنهما غناء عمن سواهما.قالت علماء الزيدية: وجدنا الفضل في الفعل دون غيره، ووجدنا الفعل كله في أربعة أقسام: أولها: القدم في الإسلام حين لا رغبة ولا رهبة إلا من الله تعالى وإليه.
ثم الزهد في الدنيا؛ فإن أزهد الناس في الدنيا أرغبهم في الآخرة، وآمنهم على نفائس الأموال، وعقائل النساء، وإراقة الدماء.
ثم الفقه الذي به يعرف الناس مصالح دنياهم، ومراشد دينهم.
ثم المشي بالسيف كفاحاً في الذب عن الإسلام وتأسيس الدين؛ وقتل عدوه وإحياء وليه؛ فليس فوق بذل المهجة واستغراق القوة غاية يطلبها طالب، أو يرتجيها راغب.
ولم نجد قولاً خامساً فنذكره.
فلما رأينا هذه الخصال مجتمعة في رجل دون الناس كلهم وجب علينا تفضيله عليهم، وتقديمه دونهم.
وذاك أنا سألنا العلماء والفقهاء، وأصحاب الأخبار، وحمال الآثار، عن أول الناس إسلاماً، فقال فريق منهم: علي، وقال قوم: زيد بن حارثة، وقال قوم: خباب. ولم نجد قول كل واحد منهم من هذه الفرق قاطعاً لعذر صاحبه، ولا ناقلاً عن مذهبه، وإن كانت الرواية في تقديم علي أشهر، واللفظ به أكثر.
وكذلك إذا سألناهم عن الذابين عن الإسلام بمهجهم. والماشين إلى الأقران بسيوفهم، وجدناهم مختلفين: فمن قائل يقول: علي رضي الله عنه، ومن قائل يقول: الزبير، ومن قائل يقول: ابن عفراء، ومن قائل يقول: محمد بن مسلمة، ومن قائل يقول: طلحة، ومن قائل يقول: البراء بن مالك.
على أن لعلي من قتل الأقران والفرسان ما ليس لهم، فلا أقل من أن يكون علي في طبقتهم.
وإن سألناهم عن الفقهاء والعلماء، رأيناهم يعدون علياً كان أفقههم، وعمر، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب.
على أن علياً كان أفقههم؛ لأن كان يسأل ولا يسأل، ويفتي ولا يستفتي، ويحتاج إليه ولا يحتاج إليهم. ولكن لا أقل من أن نجعله في طبقتهم وكأحدهم.
وإن سألناهم عن أهل الزهادة وأصحاب التقشف، والمعروفين برفض الدنيا وخلعها، والزهد فيها، قالوا: علي، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبو ذر، وعمار، وبلال، وعثمان بن مظعون.
على أن علياً أزهدهم؛ لأنه شاركهم في خشونة الملبس وخشونة المأكل، والرضا باليسير، والتبلغ بالحقير، وظلف النفس، ومخالفة الشهوات. وفارقهم بأن ملك بيوت الأموال ورقاب العرب والعجم، فكان ينضح بيت المال في كل جمعة ويصلي فيه ركعتين. ورقع سراويله بالقد، وقطع ما فضل من ردنه عن أطراف أصابعه بالشفرة. في أمور كثيرة. مع أن زهده أفضل من زهدهم؛ لأنه أعلم منهم. وعبادة العالم ليست كعبادة غيره، كما أن زلته ليست كزلة غيره. فلا أقل من أن نعده في طبقتهم.
ولا نجدهم ذكروا لأبي الدرداء، وأبي ذر، وبلال، مثل الذي ذكروا له في باب الغناء والذب، وبذل النفس. ولم نجدهم ذكروا للزبير، وابن عفراء وأبي دجانة، والبراء بن مالك، مثل الذي ذكروا له من التقدم في الإسلام، والزهد، والفقه. ولم نجدهم ذكروا لأبي بكر وزيد، وخباب، مثل الذي ذكروا له من بذل النفس والغناء، والذب بالسيف، ولا ذكروهم في طبقة الفقهاء والزهاد.
فلما رأينا هذه الأمور مجتمعة فيه، متفرقة في غيره من أصحاب هذه المراتب وهذه الطبقات، علمنا أنه أفضلهم، وإن كان كل رجل منهم قد أخذ من كل خير بنصيب فإنه لن يبلغ ذلك مبلغ من قد اجتمع له جميع الخير وصنوفه.
فصل منه
وضرب آخر من الناس همج هامج، ورعاع منتشر، لا نظام لهم، ولا اختبار عندهم، أعراب أجلاف، وأشباه الأعراب. يفترقون حيث يفترقون، ويجتمعون حيث يجتمعون؛ لا تدفع صولتهم إذا هاجوا، ولا يؤمن هيجانهم إذا سكنوا. إن أخصبوا طغوا في البلاد، وإن أجدبوا آثروا العناد.ثم هم موكلون ببغض القادة، وأهل الثراء والنعمة، يتمنون النكبة، ويشتمون بالعثرة، ويسرون بالجولة، ويترقبون الدائرة.
وهم كما وصفوا الطغام والسفلة.
وقال علي رضي الله عنه في دعائه: " نعوذ بالله من قوم إذا اجتمعوا لم يملكوا، وإذا افترقوا لم يعرفوا " . فهؤلاء هؤلاء.
وضرب آخر قد فقهوا في الدين، وعرفوا سبب الإمامة، وأقنعهم الحق وانقادوا له بطاعة الربوبية وطاعة المحبة، وعرفوا المحنة وعرفوا المعدن، ولكنهم قليل في كثير، ومختار كل زمان. وإن كثروا فهم أقل عدداً وإن كانوا أكثر فقهاً.
فلما كان الناس عند علي وأبي بكر وعمر، وأبي عبيدة، وأهل السابقة المهاجرين والأنصار، على الطبقات التي نزلنا، والمنازل التي رتبنا، وبالمدينة منافقون يعضون عليهم الأنامل من الغيظ، وفيها بطانة لا يألونهم خبالاً، لا يخفى عليهم موضع الشدة وانتهاز الفرصة، وهم في ذلك على بقية، ووافق ذلك ارتداد من حول المدينة من العرب، وتوعدهم بذلك في شكاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به الخبر.
ثم الذي كان من اجتماع الأنصار حيث انحازوا من المهاجرين وصاروا أحزاباً وقالوا: " منا أمير ومنكم أمير " ، فأشفق علي أن يظهر إرادة القيام بأمر الناس، مخافة أن يتكلم متكلم أو يشغب شاغب ممن وصفنا حاله، وبينا طريقته، فيحدث بينهم فرقة، والقلوب على ما وصفنا، والمنافقون على ما ذكرنا، وأهل الردة على ما أخبرنا، ومذهب الأنصار على ما حكينا.
فدعاه النظر للدين إلى الكف عن الإظهار والتجافي عن الأمور، وعلم أن فضل ما بينه وبين أبي بكر في صلاحهم لو كانوا أقاموه، لا يعادل التغرير بالدين، ولا يفي بالخطار بالأنفس؛ لأن في الهيج البائقة، وفي فساد الدين فساد العاجلة والآجلة. فاغتفر الخمول ضناً بالدين، وآثر الآجلة على العاجلة، فدل ذلك على رجاجة حلمه، وقلة حرصه، وسعة صدره، وشدة زهده، وفرط سماحته وأصالة رأيه.
ومتى سخت نفس امرىء عن هذا الخطب الجليل، والأمر الجزيل، نزل من الله تعالى بغاية منازل الدين.
وإنما كانت غايتهم في أمرهم أربح الحالين لهم، وأعون على المقصود إذ علم أن هلكتهم لا تقوم بإزاء صرف ما بين حاله وحال أبي بكر في مصلحتهم.
فصل منه
وإنما ذكرت لك مذهب من لا يجعل القرابة والحسب سبباً إلى الإمامة، دون من يجعل القرابة سبباً من أسبابها وعللها، لأني قد حكيته في كتاب الرافضة، وكان ثم أوقع، وبهم أليق؛ وكرهت المعاد من الكلام والتكرار؛ لأن ذلك يغني عن ذكره في هذا الكتاب، وهو مسلك واحد، وسبيل واحد.وإنما قصدت إلى هذا المذهب دون مذهب سائر الزيدية في دلائلهم وحججهم، لأنه أحسن شيء رأيته لهم. وإنما أحكي لك من كل نحلة قول حذاقهم وذوي أحلامهم، لأن فيه دلالة على غيره، وغنىً عما سواه.
وقالوا: وقد يكون الرجل أفضل الناس ويلي عليه من هو دونه في الفضل، حتى يكلفه الله طاعته وتقديمه؛ إما للمصلحة، وإما للإشفاق من الفتنة، كما ذكرنا وفسرنا، وإما للتغليظ في المحنة وتشديد البلوى والكلفة، كما قال تعالى للملائكة: " اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى " . والملائكة أفضل من آدم، فقد كلفهم الله أغلظ المحن وأشد البلوى، إذ ليس في الخضوع أشد من السجود على الساجد له. والملائكة أفضل من آدم، لأن جبريل وميكائيل وإسرافيل عند الله تعالى من المقربين قبل خلق آدم بدهر طويل، لما قدمت من العبادة، واحتملت من ثقل الطاعة.
وكما ملك الله طالوت على بني إسرائيل وفيهم يومئذ داود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبيهم الذي أخبر عنه في القرآن: " وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً " .
ثم صنيع النبي صلى الله عليه وسلم حين ولى زيد بن حارثة على جعفر الطيار يوم مؤتة، وولى أسامة على كبراء المهاجرين وفيهم أبو بكر وعمر، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، ورجال ذوو أخطار وأقدار، من البدريين والمهاجرين، والسابقين الأولين.
فصل منه
ولو ترك الناس وقوى عقولهم وجماح طبائعهم، وغلبة شهواتهم، وكثرة جهلهم، وشدة نزاعهم إلى ما يرديهم ويطغيهم، حتى يكونوا هم الذين يحتجزون من كل ما أفسدهم بقدر قواهم، وحتى يقفوا على حد الضار والنافع، ويعرفوا فصل ما بين الداء والدواء، والأغذية والسموم، كان قد كلفهم شططا، وأسلمهم إلى عدوهم، وشغلهم عن طاعته التي هي أجدى الأمور عليهم وأنفعها لهم، ومن أجلها عدل التركيب وسوى البنية، وأخرجهم من حد الطفولة والجهل إلى البلوغ والاعتدال والصحة، وتمام الأداة والآلة. ولذلك قال عز ذكره: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " .ولو أن الناس تركهم الله تعالى والتجربة، وخلاهم وسبر الأمور وامتحان السموم، واختبار الأغذية، وهم على ما ذكرنا من ضعف الحيلة وقلة المعرفة وغلبة الشهوة، وتسلط الطبيعة، مع كثرة الحاجة، والجهل بالعاقبة، لأثرت عليهم السموم، ولأفناهم الخطأ ولأجهز عليهم، الخبط، ولتولدت الأدواء وترادفت الأسقام، حتى تصير منايا قاتلة، وحتوفاً متلفة، إذ لم يكن عندهم إلا أخذها، والجهل بحدودها ومنتهى ما يجوز منها والزيادة فيها، وقلة الاحتراس من توليدها.
فلما كان ذلك كذلك علمنا أن الله تعالى حيث خلق العالم وسكانه لم يخلقهم إلا لصلاحهم، ولا يجوز صلاحهم إلا بتبقيتهم ولولا الأمر والنهي ما كان للتبقية وتعديل الفطرة معنىً.
ولما أن كان لا بد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيين، بين عدو عاص ومطيع ولي، علمنا أن الناس لا يستطيعون مدافعة طبائعهم، ومخالفة أهوائهم، إلا بالزجر الشديد، والتوعد بالعقاب الأليم في الآجل، بعد التنكيل في العاجل، إذ كان لا بد من أن يكونوا منهيين بالتنكيل معجلاً، والجزاء الأكبر مؤجلا، وكان شأنهم إيثار الأدنى وتسويف الأقصى.
وإذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في دنياهم فهم عن مصالح دينهم أعجز، إذ كان علم الدين مستنبطاً من علم الدنيا.
وإذا كان العلم مباشرة أو سبباً للمباشرة وعلم الدنيا غامض، فلا يتخلص إلى معرفته إلا بالطبيعة الفائقة، والعناية الشديدة، مع تلقين الأئمة. ولأن الناس لو كانوا يبلغون بأنفسهم غاية مصالحهم في دينهم ودنياهم كان إرسال الرسل قليل النفع، يسير الفضل.
وإذا كان الناس مع منفعتهم بالعاجل وحبهم للبقاء، ورغبتهم في النماء، وحاجتهم إلى الكفاية، ومعرفتهم بما فيها من السلامة لا يبلغون لأنفسهم معرفة ذلك وإصلاحه، وعلم ذلك جليل ظاهر سببه بعضه ببعض، كدرك الحواس وما لاقته، فهم عن التعديل والتجوير وتفصيل التأويل، والكلام في مجيء الأخبار وأصول الأديان، أعجز، وأجدر ألا يبلغوا منه الغاية، ولا يدركوا منه الحاجة؛ لأن علم الدنيا أمران: إما شيء يلي الحواس، وإما شيء يلي علم الحواس، وليس كذلك الدين.
فلما كان ذلك كذلك علمنا أنه لا بد للناس من إمام يعرفهم جميع مصالحهم.
ووجدنا الأئمة ثلاثة: رسول، ونبي، وإمام.
فالرسول نبي إمام، والنبي نبي إمام، والإمام ليس برسول ولا نبي.
وإنما اختلفت أسماؤهم ومراتبهم لاختلاف النواميس والطبائع، وعلى قدر ارتفاع بعضهم عن درجة بعض، في العزم والتركيب، وتغير الزمان بتغير الفرض وتبدل الشريعة.
فأفضل الناس الرسول، ثم النبي، ثم الإمام.
فالرسول هو الذي يشرع الشريعة ويبتدىء الملة، ويقيم الناس على جمل مراشدهم، إذ كانت طبائعهم لا تحتمل في ابتداء الأمر أكثر من الجمل. ولولا أن في طاقة الناس قبول التلقين وفهم الإرشاد، لكانوا هملاً، ولتركوا نشراً جشراً، ولسقط عنهم الأمر والنهي. ولكنهم قد يفضلون بين الأمور إذا أوردت عليهم، وكفوا مئونة التجربة، وعلاج الاستنباط. ولن يبلغوا بذلك القدر قدر المستغني بنفسه، المستبد برأيه، المكتفي بفطنته عن إرشاد الرسل، وتلقين الأئمة.
وإنما جاز أن يكون الرسول مرة عربياً ومرة عجمياً، وليس له بيت يخطره ولا شرف يشهر موضعه؛ لأنه حين كان مبتدىء الملة ومخرج الشريعة، كان ذلك أشهر من شرف الحسب المذكور، وأنبه من البيت المقدم. ولأنه يحتاج من الأعلام والآيات والأعاجيب، إلى القاهر المعقول والواضح الذي لا يخيل أن يشتهر مثله في الآفاق، ويستفيض في الأطراف حتى يصدع عقل الغبي، ويفتق طبع العاقل، وينقض عزم المعاند، وينتبه من أطال الرقدة وتخضع الرقاب وتضرع الخدود حتى يتواضع له كل شرف، ويبخع له كل أنف، فلا يحتاج حاله معه إلى حال، ولا مع قدره إلى حسب.
وعلى قدر جهل الأمة وغباء عقولها، وسوء رعتها، وخبث عادتها، وغلظ محنتها، وشدة حيرتها، تكون الآيات، كفلق البحر، والمشي على الماء، وإحياء الموتى، وقصر الشمس عن مجراها. لأن النبي الذي ليس برسول ولا مبتدىء ملة، ولا منشىء شريعة، إنما هو للتأكيد والبشارة، كبشارة النبي بالرسول الكائن على غابر الأيام، وطول الدهر.
وتوكيد المبشر يحتاج من الأعلام إلى دون ما يحتاج إليه المبتدىء لأصل الملة، والمظهر لفرض الشريعة، الناقل للناس عن الضلال القديم، والعادة السيئة، والجهل الراسخ. فلذلك التقى بشهرة أعلامه، وشرف آياته، وذكر شرائعه، من شهرة بيته وشرف حسبه، لأنه لا ذكر إلا وهو خامل عند ذكره، ولا شرف إلا وهو وضيع عند شرفه.