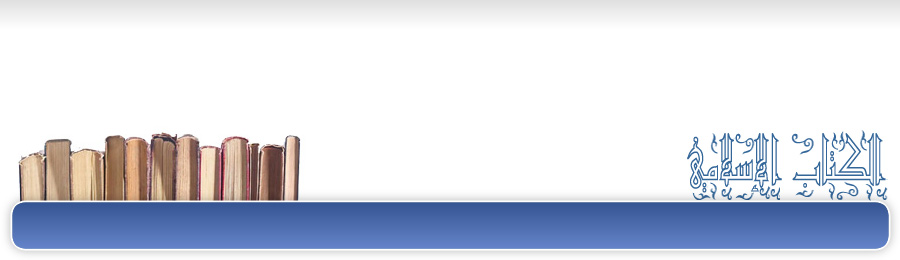كتاب : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة
المؤلف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
حقا ولم يصل له رحما ولا بر له والدا فإن الباعث على هذه الافعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدةوإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق قد تبين انه لولا الحياء إما من الخالق او من الخلائق لم يفعلها صاحبها وفي الترمذي وغيره مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال ان تحفظ الراس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال صلى الله عليه و سلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول ابي عبيد والاكثرين انه تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وقوله كلوا وتمتعوا قليلا وقالت طائفة هو إذن وإباحة والمعنى إنك اذا اردت ان تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح وعندي ان هذا الكلام صورة صرة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحى صنع ما يشتهى فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر والمعنى ان الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستح فإنه يصنع ماشاء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكته بديعة جدا وهي ان للانسان آمرين وزاجرين آمروزاجر من جهة الحياء فإذا اطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره اطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون ان يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي
تنبيه ثم تأمل نعمة الله على الانسان بالبيانين البيان النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه علىالعبد فقال في أول سورة انزلت على رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الاربعة بأوجز لفظ واوضحه واحسنه فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاءالوجود الخارجي ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الانسان لانه موضع العبرة والاية فيه عظيمةومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الاصل وهو التراب والطين او الصلصال الذي كالفخار او مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر في هذا الموضع اول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من اعظم نعمه على عباده إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد اخبار الماضين للباقين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت اخبار بعض الازمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الاحكام ولم يعرف
الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنمايعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الامتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عن وجل بتعليم القلم بعد القرآن من اجل النعم والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الانسان بالفطنةوالحيلة فإنه الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل اعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإن علمه فتعلم كما انه علمه الكلام فتكلم هذا ومن اعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يحط به ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي انطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعلم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد امسكت القلم وهو جماد وضعته على القرطاس وهو جماد فتولد من بينهما انواع الحكم واصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فمن الذي اجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم اجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيبا معناه اعجب من صورته فتقضى به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الاقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك مالا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يتسلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب ودل قوله خلق على انه يعطى الوجود العيني فدلت هذه الايات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على ان مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين وتلعيمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وتعليما عاما وذكر من صفاته ها هنا اسم الاكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفا ومنه كل خير فعلا فهو الاكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغني الحميد وقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقوله خلق الانسان إخبار عن الايجاد الخارجي العيني وخص الانسان بالخلق لما تقدم وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الانسان القرآن بتعليمه كما انه إنما صار إنسانا بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه ثم قال علمه البيان والبيان يتناول مراتب راتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا احدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات الثاني البيان
اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الالفاظ فيتبين الناظر معانيها كما يتبين للسامع معاني الالفاظ فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والاول بيان للقلب وكثيرا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وقوله والله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله صم بكم عمي وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وقد تقدم بسط هذا الكلام تنبيه ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما اعطى الانسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم اتم تيسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم اعظم كان تيسيره اياه عليه اتم فاعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والاقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو اجل منها ولا اظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا ابين ولا اوضح فكلما تراه بعينك او تسمعه بأذنك اوتعقله بقلبك وكلما يخطر ببالك وكلما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم اجلي منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده اظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لاممهم افي الله شك فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي ان يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الادلة على وجوده وحدانيته وصفات كماله الادلة على اختلاف انواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله فذكر إن نفعت الذكرى وقوله إنما انت مذكر وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين وهو كثير في القرآن ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الاقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإسائته مودعا في الفطرة مركوزا فيها فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه ولأقرت بوحدنيه ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت
عليه انكرت ما انكرت وجحدت ما جحدت فبعث الله رسله مذكرين لاصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعا واختيارا ومحبة وإذعانا بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى ان منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم انها دعوة حق برهانها فيها ومعذرين ومقيمين البينة على اصحاب الفطر الفاسدة لئلا نحتج على الله بأنه ما ارشدها ولا هداها فيحق القول عليها بإقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظالما لها بتعذيبها واشقائها وقد بين ذلك سبحانه في قوله إن هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد واثبات اسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر ولم يكن ليعرف بها انها ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه به مستقرا في فطرته شاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا اعظم ما يكون من الايمان وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب اوليائه وخاصته فقال اولئك كتب في قلوبهم الايمان فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ولله الحمد والمنه والمقصود ان الله سبحانه اعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاده اليها ثم وضع في العقل من الاقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في ارضه وعدله بين عباده ونوره في العالم مالوا اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على عقل اعقل رجل واحد منهم لما امكنهم ان يقترحوا شيئا احسن منه ولا اعدل ولا اصلح ولا انفع للخليقة في معاشها ومعادها فهو اعظم آياته واوضح بيناته وأظهر حججه على انه الله الذي لا إله إلا هو وإنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلا عن ان يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالادلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينه وان الله لسميع عليم فأثبت في الفطرة حسن العدل والانصاف والصدق والبر والاحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة اهل الحاجة والفاقة وأداء الامانات ومقابلة الاحسان بالاحسان والاساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتؤدة وحسن الاخلاق وجميل المعاشرة مع الاقارب والاباعد وستر العورات وإقالة العثرات والايثار عند الحاجات واغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على انواع
الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لاهله والشدة على اهل الباطل والغلظة عليهم والاصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الاهانةوتنزيل الناس منازلهم وأعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به انفسهم من الاعمال والاموال والاخلاق ولارشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه اولاهم بالحق وان كان بعيدا و ابعدهم عنه ابعدهم من الحق وان كان حبيبا قريبا إلى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما اودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له وان نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه وإيثاره على ما سواه واثبت في الفطر علمها بقبيح اضداد ذلك ثم بعث رسله في الامر بما اثبت في الفطر حسنه وكماله والنهي عما اثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكلمة مطابقة التفصيل بجملته وقامت وشواهد دينه في الفطرة تنادي للايمان حي على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والايات دياجي ظلم الاباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح
فصل وكذلك اعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر
حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الابنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الادوية وصنعة الاطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معايشهم ثم منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وامواج البحر وذرات الرمال ومساقط الاوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الثرى وما في لجج البحار واقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد إلى سائر ما عزب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه ولم يحصل الا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر امره وجرت سنة الله وحكمته ان هذا الضرب من الناس اجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صوابا فترى عند من لا يرفعون به رأسا من الحكم والعلم الحق النافع مالا يخطر ببالهم اصلا وذلك من حكمة الله في خلقه وهوالعزيز الحكيم ولا يعرف هذا الا من اطلع على ما عند القوم من انواع الخيالوضروب المحال وفنون الوساوس والهوى والهوس والخبط وهم يحسبون انهم على شيء إلا انهم هم الكاذبون فالحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
فصل ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم
وفي ذلك من الحكمة البالغة مالا يحتاج إلى نظر فلو عرف الانسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لميتهنأ بالعيش وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت فلولا طول الامل لخربت الدنيا وأنما عمارتها بالامال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت احدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز و جل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه احوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه فلو ان عبدا من عبيدك عمل على ان يستحضك اعواما ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن انه صائر اليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك وكذا سنة الله عز و جل ان العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الان وقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي خلت في عباده والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضفعه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت مالا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الايمان له فهو يجيب داعي النفس تاره وداعي الايمان تارات فاما من بنى امره على ان لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذي يخاف عليه ان يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الاجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالبا لان النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها اثقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الايمان فنفسه لا تطوع له ان يبيع نقدا بنسيئة ولا عاجلا بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل ايما احب اليك درهم اليوم او دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من اول امس فحرام على هؤلاء ان يوفقوا للتوبة إلا ان يشاء الله فإذا بلغالعبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه وقد اوجبت له تلك الاعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاولات تعطى الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها اثرا أثرا زائدا على اثر ما قبله فيقوى الاثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته واوساخه وادرانه لم يتطهر للقدوم على الله فما ظنه بربه ولو انه تاب وأناب وقت القدرة والامكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء اشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفذ المال ولو أداه وقت الامكان لقبله ربه وسيعلم المسرف والمفرط أي ديان ادان وأي غريم بتقاضاه ويوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فنيت فيحمل السيئات فبان ان من حكمة الله ونعمه على عباده ان ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ اعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم فإن قلت فها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار اجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأي فائدة وحكمة حصلت بستر اجله عنه قيل لعمر الله ان الامر كذلك وهو الموضع الذي حير الالباب والعقلاء وافترق الناس لاجله فرقا شتى ففرقة انكرت الحكمة وتعليل افعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على انفسهم الباب وقالوا لا تعلل افعال الرب تعالى ولاهي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الارادة فأنكروا حكمة الله في امره ونهيه وفرقة نفت لاجله القدر جملة وزعموا ان أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وابداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب الا اقل القليل منها فهاتان الطائفتان متقابلتان اعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وانكار الحكم المقصودة في أفعال الله والثانية غلت في القدر واخرجت كثيرا من الحوادث بل اكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله اهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأثبتوا لله عز و جل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى ان يكون في مسلكه مالا يشاء او يشاء مالا يكون وأن اهل سمواته وارضه اعجز واضعف من ان يخلقوا مالا يخلقه الله او يحدثوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان ووجد وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وانه لا حول ولا قوة الا به ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة الا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا لحكمة بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كمالا تجحد قدرته
والطائفة الاولى جحدت الحكمة والثانية جحدت القدرة والامة الوسط اثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الاولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الاشجار ونحوها والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله والامة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وايثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الاول لها سؤال ربها والتذلل والتضرع له ان يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته وان يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وان يعذبها بغير استحقاق منها او يعذبها على ما لم تعمله فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب وانها تنتهي إلى ثمانية مشاهد احدها المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع والثاني مشهد الجبر وان الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين واعداء الرسل الثالث مشهد القدر وهو انه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدرية المجوسية الرابع مشهد اهل العلم والايمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وانه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر السادس مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه إنفراد الله عز و جل بالخلق والابداع ونفوذ المشيئة وان الخلق اعجز من ان يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الخامس ان صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والابداع وأنه لا حول ولا قوة الا به السابع مشهد الحكمة وهو ان يشهد حكمة الله عز و جل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الاحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريبا من اربعين حكمة وقد تقدم في اول هذا الكتاب التنبيه على بعضها الثامن مشهد الاسماء والصفات وهو ان يشهد ارتباط الخلق والامر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وان ذلك موجبها ومقتضاها فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحليم وهذه اسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله اجل هذه المشاهد واشرفها وارفعها قدرا
وهما لخواص الخليفة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الاول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم امورا لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من ابواب المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الاوامر والنواهي وخاضوا فيها واتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا ايضا بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم واما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل ان ترى لاحدهم فيه ما يشفى او يلموكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده ان اعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته اصلا وكيف يتطلب لها حكمة او يثبتها ام كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن افعاله غير معللة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل اصلا وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء في افعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون الحق خارجا عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض اقوالهم الفاسدة ولا يدرى أين يذهب ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى اقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدي إلى ذلك البر وكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد ان الحق لا يخرج عن اقوالهم فما اكثر خروج الحق عن اقوالهم وما اكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب والمقصود ان المتكلمين لو اجمعوا على شيء لم يكن اجماعهم حجة عند احد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود ان مشاهدة حكمة الله في اقضيته واقداره التي يجربها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من الطف ما تكلم فيه الناس وأدقه واغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى انه من محبته لهم يفرح بتوبة احدهم اعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الارض الدوية المهلكة إذا فقدها وايس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا اعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح ومن المعلوم ان وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه او غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين ولو لم تكن التوبة احب الاشياء إليه لما ابتلى بالذنب اكرم المخلوقات عليه فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال ابيهم بها فكم بين حالة وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الاولى حال أكل وشرب
وتمتع والحال الاخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه ايضا بها كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فكمال الادمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الاول والمقصود انه سبحانه لمحبته التوبة وفرحة بها يقتضي على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته اقام عليه حجة عدله وعاقبة بذنبه
فصل ومنها انه سبحانه يجب ان يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم
مواقع بره وكرمه فلمحبته الافضال والانعام ينوعه عليهم اعظم الانواع واكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن اعظم انواع الاحسان والبر ان يحسن إلى من اساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لم اذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقدندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والافعال الحميدة وهو أولى بها منهم واحق وكان له في تقدير اسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده وحكى بعض العارفين انه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمني حتى لا اعصيك فهتف بي هاتف انت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من اتفضل ولمن اغفر قال فبقيت ليلتي إلى الصباح استغفر الله حياء منه هذا ولو شاء الله عز و جل ان لا يعصي في الارض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئيه ما هوموجب حكمته سبحانه فمن اجهل بالله ممن يقول انه يعصي قسرا بغير اختياره وميشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرافصل ومنها انه سبحانه له الاسماء الحسنى ولكل اسم من اسمائه اثر من
الاثار في الخلق والامر لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الاسماء فلو لم يكن في عباده من يخطيء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر اثر اسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها وظهور اثر هذه الاسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الاسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما ان اسمه الخالق يقتضي مخلوقا والبارئ يقتضي مبروا والمصوريقتضي مصورا ولا بد فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له ما يغفره له وكذلك من يتوب عليه وامورا يتوب عليه من اجلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو فإن هذه الامور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها وهذا باب اوسع من ان يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد
وان كان اثل الواد يجمع بيننا ... فغير خفي شيجه من خزامه فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى وما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل في اعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما كان له من قيام اصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشاته الثانية إما مختصا بهذه النشأة
فصل ومنه انه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته
وجريان حكمته وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة مالكه وسيده وأنه عبده وابن عبده وابن امته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤهفصل ومنها انه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته وانه
كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت الشياطين ايديها إليه من كل جان بتريد تمزيق حاله كله إفاسد شأنه كله وإن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله فقد أجمع العلماء بالله على ان التوفيق ان لا يكل الله العبد إلى نفسه واجمعوا على ان الخذلان ان يخلى بينه وبين نفسهفصل ومنها انه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من اعظم أسباب
السعادة له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن انواع الدعاء والتضرع والابتهال والانابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وانواع من كمالات العبد تبلغ نحو المائة ومنها مالا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الاسباب ويجد العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مولاه بعد ان كان نائيا عنه وهذا الذي أثمر له ان الله يحب التوابين وهو ثمرة لله افرح بتوبة عبده واسرار هذا الوجه يضيق عنهاالقلب واللسان وعسى ان يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك ان شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شامخ بأنفه كلما طلب منه اوصافالعبد قامت صور تلك الاعمال في نفسه فحجبته عن معبوده والهه وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر واحرق ما فيه من الرعونات والحماقات والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئا كما لا يرى ربه إلا محسنا فهو لايرضى ان يرى نفسه طرفة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الراس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة والله المستعان
فصل ومنها انه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام
العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد واكمل الخلق عبودية اكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لاحسانه إليه وانعامه عليه فإن من احسن اليك فقد استعبدك وصار قبلك معبدا له وذليلا تعبد له لحاجته إليه على مدى الانفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره وهنا نوعان من انواع التذلل والتعبد لهما اثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما احدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولبها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قلب المحب من انواع التقرب والتودد والتملق والايثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظائم مالا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلبي من طاعته مالا يستخرجه خوفه او كما قال فهذا ذل المحبين الثاني ذل المعصية فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فنيت الرسوم وتلاشت الانفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحانات ومحيي من القلب واللسان انا وانا واستراح المسكين من شكاوى الصدود والاعراض والهجر وتحرد الشهودان فلم يبق الاشهود العز والجلال الشهود المحض الذي تفرد به ذو الجلال والاكرام الذي لا يشاركه احد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغتاه فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه الا شاهدها فيه بالفعل وقد شهد مقابلها هناك فلله أي مقام اقيم فيه هذا القلب إذ ذاك وأي قرب حظي به وأي نعيم ادركه واي روح باشره فتأمل الان موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن ما اعجبها وما اعظم موقعها كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوي والرعونات وانواع الاماني الباطلة ثم اوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم اوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره اصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنب متكسرا ذللا خاضعا لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي اورثه إياه مباشرة الذائب فأي شيء انفع له من هذا الدواء
لعل عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الاجسام بالعلل ونكتة هذا الوجه ان العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بانفه وتعاظمت نفسه وظن انه وأنه أي عظيما فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن انه وأنه أي عبدا ذليلا
فصل ومنها ان العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة وان ما صدر منها
من شر فقد صدر من اهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وان كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى هو الذي زكاها به وأعطاها إياه لا منها فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله فهو تعالى الذي يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتي بأنواع الشر والخبث وكان من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم اللهم آت نفسي تقوها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة منها انه يانف من نقصها ويجتهد في كمالها ومنها أنه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها ومنها انه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التي ادعاها اهل الجهل في انفسهم من قدم او اتصال بالقديم او اتحاد به او حلول فيه اوغير ذلك من المحالات فلولا ان هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص انفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيهفصل ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه وأنه لو
شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش ابدا ولكن جلله بستره غشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك بل كان شاهدا وهو يبارزه بالمعاصي والاثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لاتنام وقد جاء في بعض الاثار يقول الله تعالى انا الجواد الكريم من اعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزوننيبالعظائم وأنا أكلوهم في منازلهم فأي حلم اعظم من هذا الحلم وأي كرم اوسع من هذا الكرم فلولا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والارض في أماكنها وتأمل قوله تعالى ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده الاية هذه الاية تقتضي الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزالتا عن اماكنهما ومن هذا قوله تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا
فصل ومنها تعريفه عبده انه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته
وانه رهين بحقه فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس احد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمتهفصل ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على
ظلمه واساءته فهو الذي جاد عليه بان وفقه للتوبة والهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه اولا وآخرا فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا فله الفضل في التوبة والكرم اولا وآخرا لا إله إلا هوفصل ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد ان لله عليه الحجة
البالغة فإذا اصابه ما اصابه من المكروه فلا يقال من اين هذا ولا من اين اتيت ولا باي ذنب اصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة الا بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه اكثر ومانزل بلاء قط الا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من اعظم نعمه عليهم وان كرهتها انفسهم ولا يدري العبد أي النعمتين عليه اعظم نعمته عليه فيما يكره او نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا اذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وايسر وأسهل بكثيرفصل ومنها ان يعامل العبد بني جنسه في إسائتهم إليه وزلاتهم معه
بما يحب ان يعامله الله به في اساءته وزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفى الله عنه ومن سامح اخاه في إساءته إليه سامحه الله في سيئاته ومن أغضي وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى عليه
ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيرا هل عملت حسنة قال ما اعلمه قيل تذكر قال كنت ابايع الناس فكنت انظر الموسر واتجاوز عن المعسر او قال كنت امر فتياني ان يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن احق بذلك منك وتجاوز الله عنه فالله عز و جل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو انفع الاشياء له
فصل ومنها انه إذا عرف هذا فاحسن إلى من اساء إليه ولم يقابله
بإساءته إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقال اساءته وذنوبه باحسانه كما كان هو يقابل بذلك اساءة الخلق إليه والله اوسع فضلا وأكرم واجزل عطاء فمن احب ان يقابل الله إساءته بالاحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالاحسان ومن علم ان الذنوب والاساءة لازمة للانسان لم تعظم عنده اساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط احسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكران يكون الناس له بتلك المنزلة ومنها انه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم ويتفرج بطانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف واكل بعضه بعضا ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال الله ان يخسف بهم الارض ويسلط عليهم البلاء فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة ادخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه اكثر مما يخاف عليهم فأين هذا منحاله الاولى وهو ناظر اليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يجد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة فالذنب في حق مثل هذا من اعظم اسباب رحمته مع هذا فيقيم امر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا اليهم إذ هوعين مصالحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة
فصل ومنها ان يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر
والعظمة الذي ليس له ويلبس ردءا الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من اعظم الافات كما في الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو اشد من ذلك العجب او كما قال صلى الله عليه و سلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب والبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه لا يوحشنك ذاك العتب ان له لطفا يريك الرضا في حالة الغضب فبينما هو لابس ثوب الاذلال الذي لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فنزعه عنه والبسه ثوب الذل الذل لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوبا اكمل عليه ولا احسن ولا ابهى من ثوب العبودية وهوثوب المذلة الذي لا عزله بغيره
فصل ومنها ان لله عز و جل على القلوب انواعا من العبودية من الخشية
والخوف والاشفاق وتوابعها من المحبة والانابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات لها اسباب تهيجها وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعالى لعبده من الاسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من اسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والاشفاق والوجل ولانابة والمحبة والايثار والفرار إلى الله مالا يهيجه له كثير من الطاعات وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده اخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء ازال تلك الاخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعطب وان من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو اعجب والطف منه لحقيق بان يكون الحب كله له والطاعات كلها له وان يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر
فصل ومنها انه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له
وحفظه إياه فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف اهل طاعة الله انهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وان الله عليهم من الشكر اضعاف ما على غيرهم وان تسودوا التراب ومضغوا الحصى فهم اهل النعمة المطلقة وان من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه وان ذلك ليس من كرامته على ربه وان وسع الله عليه في الدنيا ومد له من اسبابها فإنهم اهل الابتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والاقسام وأرته انه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ فحينئذ يكون اكثر أمانيه وآماله العود إلى حالة وان يمنعه الله بعافيته
فصل ومنها ان التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا
تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخر فإنه إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول انواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها بل يزال يتقلب في بركتها وآثارها مالم ينقضها ويفسدهافصل ومنها ان الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته اعظم فرح وقد تقرر ان
الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عند التوبة النصوح وتامل كيف تجدالقلب يرقص فرحا وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو وهذا امر لا يحس به الا حيي القلب وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من انواع الاحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الابدو انظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويبسابك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبهفصل ومنها انه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر
القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعلمه ان الواصل إليه فيها كثير على مسيء مثله واستقل الكثير من عمله لعلمه بان الذي ينبغي ان يغسل به نجاسته واوضاره واوساخه اضعاف ما اتي به فهو دائما مستقل لعلمه كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقدتقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من الطف الوجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولو لم يكن في فوائدالذنب إلا هذا لكفى به فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى انه كان ينبغي ان يعطي ما هو فوقها وأجل منها وانه لايقدر ان يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكماله وانه كان ينبغي له ان ينال الثريا ويطأ بأخمصه هنالك ولكنه مظلوم مبخوس الحظ وهذا الضرب من ابغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضي انهم لا يزالون في سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة اليهم وخدمة لهم اشغل الناس قلوبا بارباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقذفون به اليهم من عظامهم وغسالة ايديهم واوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرة العين بخشيته والرضاء به فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيتهوفجأة نقمته ومن جميع سخطه
فصل ومنها ان الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والتحرز من مصائد عدوه
ومكامنه ومن اين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم ومن اين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو انه مر عليهم على غرة وطمأنينه لم يأمن ان يظفروا به ويجتاحوه جملةفصل ومنها ان القلب يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض
مهماته فإذا اصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحميته وطلب بثاره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما والقلب الجبان المهين إذا جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولى هاربا والجراحات في اكتافه وكذلك الاسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلا خير فيمن لا مروءة له يطلب اخذ ثاره من اعدى عدوه فما شيء اشفى للقلب من اخذه بثاره من عدوه ولاعدو اعدى له من الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في اخذ الثأر وغاظ عدوه كل الغيظ واضناه كما جاء عن بعض السلف ان المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى احدكم بعيره في سفرهفصل ومنها ان مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم
ودوائهم والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه احذق واخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا هذا في أمراض الابدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية اعرف الناس بالافات اكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ فيالاسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة اعرف الامة بالاسلام وتفاصيله وابوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لاعدائه وتكلما بأعلامهبالامة وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده فجاءهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الارمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قيضت له اسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن ان كثيرا من اسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والامن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما اكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف اسباب الهلاك على التفصيل كان احرى ان تدوم له النعمة مالم يؤثر اسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل
عرفت الشر لا للشر لكن لتقوقيه ... ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا اعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر واسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من ابر الناس والمقصود ان من بلى بالافات صار من اعرف الناس بطرقها وامكنه ان يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه
فصل ومنها انه سبحانه يذيق عبده الم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك
الانس والقرب ليمتحن عبده فإن اقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه حالها الاول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره علم انه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المركوب ودعا دعاء المضطر وعلم انه قد فاتته حياته حقا فهو يهتف بربه ان يردعليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم انه موضع لما اهل له فرد عليه احوج ما هو إليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الارض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما اعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله اسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشرفقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا ... بعشك فادرج طالبا عشك البالي ولا تك ممن مد باعا إلى جنا ... فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي فالعبد إذا بلى بعد الانس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وانت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض ابدا ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل كما قال القائل وقد فاته طواف الوادع فركب الاخطار ورجع إليه
ولما تذكرت المنازل بالحمى ... ولم يقض لي تسليمة المتزود تيقنت ان العيش ليس بنافعي ... إذا انا لم انظر اليها بموعد وان استمر اعراضها ولم تحن إلى معهدها الاول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها
إلى مراجعة قربها من ربها فهي ممن إذا غاب لم يطلب وإذا ابق لم يسترجع وإذا جنى لم يتعتب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك وبحسب المعترض هذا الحرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه
فصل ومنها ان الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الانسان
وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهماوبهما وقعت المحنةوالابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى واللحاق بالرفيق الاعلى والهبوط إلى اسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الابرار او يضعانه تحت اقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما اعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروفة في هواه وامانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد ان يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال اكثر الرؤساء اعاذنا الله منها فلن يجعله الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى اعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين والمقصود ان تركيب الانسان على هذا الوجه هوغاية الحكمة ولا بد ان يقتضي كل واحد من القوتين اثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلقا في الانسان لم يكن انسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الانسانية كما قال النبي صلى الله عليه و سلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم اقل افراد النوع الانساني وهم خلاصته ولبهفصل ومنها ان الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا انساه رؤية طاعاته
ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه امامه ان قام او قعد او غدا او راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف ان العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النارقالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلاتزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها اعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلاتزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها فلا تزال هذه الامور به حتىتقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة ان تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة ان يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان
فصل ومنها ان شهود العبد ذنوبه وخطاياه موجب له ان لا يرى لنفسه
على احد فضلا ولا له على احد حقا فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن انه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرلها على الناس حقوقا من الاكرم يتقاضاهم اياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده اخس قدرا واقل قيمة من ان يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها اوله عليهم فضل يستحق ان يكرم ويعظم ويقدم لاجلها فيرى ان من سلم عليه او لقيه بوجه منبسط فقد احسن إليه وبذل له مالا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود واهله فما اطيب عيشه وما انعم باله وما اقرعينه واين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه اسخطفصل ومنها انه ويوجب له الامساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في
شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما ان الاول من امارات السعادة ومنها انه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل اخوانه الخطائين وشهد ان المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضورروة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يحب ان يستغفر له اخوه المسلم كذلك هو ايضا ينبغي ان يستغفر لاخيه المسلم فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل احد ان يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلا عظيما لا احفظه وربما كان من جملة اوراده التي لا يخل بها وسمعته يقول ان جعله بين السجدتين جائز فإذا شهدالعبد ان اخوانه مصابون بمثل ما اصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم الا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا ان لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب علىالملائكة بسبب قولهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعوالله لهم
فصل ومنها انه إذا شهدنفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان
الله إليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا وهذه حاله معه فكيف يطمع ان يكون الناس معه كما يحب وان يعاملوه بمحض الاحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع ان يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه لا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له ان يستغفر لمسيئهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الاثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتنى منه اضدادها واوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعض قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنةبعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا اظهر عند الناس من ان تضرب له الامثال وتطلب له الشواهد والله المستعانفصل وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم
به إلى اجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوايعبرون اليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء ولامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكم لله من نعمة جسيمة ومنه عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان فتأمل حال ابينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكم بين حالته الاولى وحالته الثانية في نهايته وتأمل حال ابينا الثاني نوح صلى الله عليه و سلم وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى اقر الله عينه واغرق اهل الارض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم اولو العزم الذين هم افضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه و سلم ان يصبر كصبره واثنى عليه بالشكر فقال إنه كان عبدا شكورا فوصفه بكمال الصبر والشكر ثم تأمل حال ابينا الثالث إبراهيم صلى الله عليه و سلم إمام الحنفاء وشيخ الانبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه الىان اتخذه الله خليلا لنفسه وامر رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه و سلم ان يتبع ملته وأنبهك على خصلة واحدة مما اكرمه الله به في محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بان بارك في نسله وكثرة حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه احد وهو اكرم الاكرمين فمن ترك لوجهه امرا او فعله لوجهه بذل الله له اضعاف ما تركه من ذلك الامر اضعافا مضاعفة وجازاه باضعاف ما فعله لاجله اضعافا مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لامر الله ووافق عليه الولد أباه رضاء منهما وتسليما وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم واعطاهما ما اعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه ان بارك في ذريتهما حتى ملؤا الارض فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه و سلم وقد ذكر ان داود عليه السلام اراد ان يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وامرهم ان يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود ان قد علمت اني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة امري ان أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم واجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد اردت ان يحصى عددا قدرت انه لا يحصى وذكر باقي الحديث فجعل من نسله هاتين الامتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم الا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسمايعل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على السنة جميع الامم وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معاملته فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره ما اخسر صفقته وما اعظم حسرته
فصل ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته
وفتونه من اول ولادته إلى منتهى امره حتى كلمه الله تكليما وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى اعلى السموات واحتمل له مالا يحتمل لغيره فإنه رمى الالواح على الارض حتىتكسرت اخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه وخاصم ربه ليلة الاسراء في شأن
رسول الله صلى الله عليه و سلم وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ماتقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاسات الامر الشديد بين فرعون وقومه ثم بنى إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله لم يكن ذلك ثم تأمل حال المسيح صلى الله عليه و سلم وصبره على قومه واحتماله في الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من اعدائه وقطعهم في الارض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر
فصل فإذا جئت الىالنبي صلى الله عليه و سلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله
واحتماله مالم يحتمله نبي قبله وتلون الاحوال عليه من سلم وخوف وغني وفقر وأمن وإقامة في وطنه وظعن عنه وتركه لله وقتل احبابه واوليائه بين يديه واذى الكفار له بسائر انواع الاذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على امر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما اعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمعه باسمه وجعله سيدالناس كلهم وجعله اقرب الخلق إليه وسيلة واعظمهم عنده جاها واسمعهم عنده شفاعة وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الامثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن اولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في اهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضى من رضى وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز اوليائه وان تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه انبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء
كذا المعالي إذا ما رمت ندركها ... فاعبر اليها على جسر من التعب والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا إلى يوم الدين ورضى الله عن اصحاب رسول الله اجمعين
فصل وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة
الحنيفية والشريعة المحمدية التي لاتنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على اكمل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة ان ادركت حسنها وشهدت بفضلها وانه ما طرق العالم شريعة اكمل ولا اجل ولا اعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على انها من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمةوالبر والاحسان والاحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمباديء والعواقب وأنها من اعظم نعم الله التي انعم بها على عباده فما انعم عليهم بنعمة اجل من ان هداهم لها وجعلهم من اهلها وممن ارتضاهم لها فلهذا امتن على عباده بان هداهم لها قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيا منهم شكره على ان جعلهم من اهلها اليوم اكملت لكم دينكم الاية وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي اسبغها عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين اليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها واتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء خصوا به دون الامم وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة فجاء اتممت في مقابلة أكملت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم واكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله ورضيت لكم الاسلام دينا وكان بعض السلف الصالح يقول ياله من دين لو ان له رجالا وقد ذكرنا فصلا مختصرا في دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى واردنا ان نختم به القسم الاول من الكتاب ثم راينا ان نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة وقد كان الاولى بنا الامساك عن ذلك لان ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو كما يدخل الرجل اصبعه في اليم ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على إصبعه من البلل وأين ذلك من البحر فيظن السامع ان تلك الصفة احاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالاصبع منه وإلا فالأمر اجل وأعظم وأوسع من ان تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى
ان يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضى الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع انه لايحصى ثناء عليه ابدا بل هو كما اثنى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ احد من الامة ثناء على رسوله كما هو اهل ان يثني عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا ان الله تعالى يحب ان يحمد ويثني عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من راكب هذا البحر الاعظم والله عليم بمقاصد العباد دنياهم وهو اولى بالعذر والتجاوز
فصل وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة اقسام احدها
من عدم بصيرة الايمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف الا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل اصبعيه في اذنه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية ان يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمةواسباب الحياة الابدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لانه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه القسم الثاني اصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة ابصارهم إلى هذا النور كنسبة ابصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع لابائهم واسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم امير المؤمنين على بن ابي طالب او منقادا للحق لا بصيره له في إصابة فهؤلاء إذا كانوا منقادين لاهل البصائر لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة القسم الثالث وهو خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم اولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لراوه كالليل البهم الاسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن اولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم علي بن ابي طالب اتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق هذا علامة من عدم البصيرة فإنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما مخالفته ثم هو من اشد الناس مخالفة له ونفيا لما اثبته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما اوتي احد افضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل
وإسحق ويعقوب اولي الايدي والابصار قال ابن عباس اولي القوة في طاعة الله والابصار في المعرفة في امر الله وقال قتادة ومجاهد اعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين واعلم الناس ابصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وتحت كل من هذه الاقسام انواع لا يحصى مقادير تفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الاول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به الا ضلالة والقسم الثاني ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث واليهم هذا الحديث يساق وهم اولو الالباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والارشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال تعالى وما يتذكر لا اولو الالباب
فصل قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادرا حليما عليما رحيما
كاملا في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدا للخير لعباده مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه احكم الحاكمين وأرحم الراحمين وانه المحيط بكل شيء علما وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الالهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم انهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه واطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في انفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيمو في بلد فيها إلا اخبروا من تحت ايديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثا ولا يسوسونهم سياسة إلا اخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف بهم الاحوال في مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم إلا اوقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك ان هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين واحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته احد ابدا فحسب العقول الكاملة ان تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم ان له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة ان يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولي ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهي عنه وفي تدبيره لرعيتهوسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من افعاله اللهم إلا ان يبلغ الامر في ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة اصلا فحينئذ يخرج بذلك عن استحاق اسم الحكيم ولن يجد احد في خلق الله ولا في أمره ولا واحدا من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت امور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأما ان ينفى ذلك عنها فمعاذ الله إلا ان يكون ما اخرجه كذب على الخلق الامر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعة وإذا عرف هذا فقد علم ان رب العالمين احكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغني عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وابداعه وامره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام ان تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به فيكفيهم في ذلك الاسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم هذا وأن الله تعالى بني امور عباده على ان عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما وهذا مطرد في الاشياء اوصولها وفروعها فأنت إذا رايت الرجلين مثلا أحدهما اكثر شعرا من الاخر أو اشد بياضا او احد ذهنا لامكنك ان تعرف من جهة السبب الذي اجرى الله عليه سنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في اختلاف الصور والاشكال ولكن لو اردت ان تعرف ماذا كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الاخر بعدد معين او المعنى الذي فضله به في القدر المخصوص والتشكيل المخصوص ومعرفة القدر الذي بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك اصلا وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال والاشجار ومقادير الكواكب وهيآتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة فهكذا في الامر يعلم ان جميع ما امر به متضمن لحكمة بالغة واما تفاصيل اسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشرية ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم بهذا الاصل تم الجزء الاول من كتاب مفتاح دار السعادة ويليه الجزء الثاني واوله فصل حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية
تم تصحيحه سميرة أبو عفيفة مرتين 2
فصل مفتاح دار السعادة
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها إلا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء حتى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فمبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسمفصل الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في
العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعا واستكانة ثم استواؤه قائما ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوعالأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه واستكانة وخضوعا لعظمته وذلا لعزته قد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوي قاعدا يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيا على ربه مسلما على نبيه وعلى عباده ثم يصلى على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأي شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأي كمال وراء هذا الكمال وأي عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليعز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سماةأهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الآمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله فالصائم يندع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي صلى الله عليه و سلم هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فأنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلى حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضى الله وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده
واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم 0 وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف حتى قيل في قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين أي حجاجا وجعل الله بيته الحرام قياما للناس فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياما ما زال هذا البيت محجوجا فالحج هو خاصة الحنيفة ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه 0 وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار وسائر شعائر الحج فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة فوق حكمته وسنعود أن شاء الله إلى الكلام في ذلك موضعه 0
وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعى فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقربا إليه ببذل أعز ما بحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذلها في حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحي ثم قتل ثم أحي فهو يفدي ثم قتل بنفسه حبيبه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول 0
يفديك بالنفس صب لو يكون له ... أعز من نفسه شيء فذاك به
فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة إلا له وكل محبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب فالمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدا ومحبة لله 0
وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله وتشبها بإمام الحنفاء وإحياء لسنته أن فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا وأما الإيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله ولله فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود به وله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه بل أن حلف فباسمه تعظيما وتبجيلا وتوحيدا وإجلالا وأن نذر فله توحيدا وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده 0 وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام ومسديه وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتي إن شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل مستهجن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الآمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى محض الأمر والنهى المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تدخل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكارا له وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وانجاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما
الفرق بينهما الأمر المجرد وأي جحد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا بمنزلة من يقول أنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل سواء في نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد فأي فرق بين مدعى هذا الباطل وبين مدعى ذلك الباطل وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر ولا للمنكر إلا ما نهى عنه فصار منكرا بنهيه فأي معنى لقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه كما قال بعض الأعراب وقد سئل بم عرفت أنه رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد اقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذا صريخ في أن الحلال كان طيبا قبل حله وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب فقال
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوارة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما بحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضا باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بأحلاله طيبا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معا فتأمل هذا الموضع حق
التأمل يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر مالا يليق به
ومما يدل على ذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على أنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم ومن هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهي عنه وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي ومن ذلك قوله تعالى ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب
وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد
قوله ولا الظفر عليه أصلا فانه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف في باطلها منكر له وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلا وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافا إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب أنعامه عليهم بإيجادهم وإنما من قبلهم وجعل الأرض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناء وسقفا فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منبها بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكيا عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجا عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا سيما إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنها أقبح شيء في العقل وأنكره فقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدرهإن الله لقوي عزيز فضرب لهم
سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوى في العقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجده وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فذكر توحيده وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله فتأمل قوله سيئة عند ربك مكروها أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروها له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروها لله إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غير مراد من الآية وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه ولهذا جعله علة وحكمة للأمر فتأمله والعلة غير المعلول وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطا وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن ومخالفته قبيحة وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا ومن هذا قوله تعالى وذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا
عليها آباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك وانه يتعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فأخبر انه يتعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر فإنه أمر بالقسط لا بالجور وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وإنه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواه ومثل هذا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم مع كونه طيبات أحلت لهم فأي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه بأنه حرمه عليهم مع كونه طيبا في نفسه فلو لا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الكل سواء فإنه سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانا وإنعاما عليهم لآن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من الناس ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحمية لهم إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغنى الحميد ولا حرم عليهم
ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر وإنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبدا ودينا وهذه مخالفة صريحة للقرآن وإنه من المحال أن يتبع الحق أهوائهم وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه وإن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربو بيته يأبى ذلك ويمنع منه ومن يقول الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافها 0
ومثل هذا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أي لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبدا وإنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السماوات والأرض فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وأن لم يرد النبي عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك 0
فصل وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين
كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجتر حوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وإنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد في الأرض فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله 0 ومن هذا أيضا إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي رضى الله عنه أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهى فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهى في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى احكم الحاكمين 0
ومثله وقوله تعالى أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصلا مبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال بم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته فأن أكذب الخلق وأفجرهم من أدعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه فدعوته تليق به وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول ومالا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهي وكذلك مسئلة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجى من مجرد خوارق
العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه و سلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به وإنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه و سلم إبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيمانا من كان إيمانه صادرا من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه و سلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العدد والمخافة من الناس ومع هذا فقلبه ممتلىء بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين وأضعف من هؤلاء إيمانا من إيمانه إيمان العادة والمربا والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينها غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له قال لا قال فكذلك الإيمان إذ خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكماله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه
فصل وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين أحدهما في الأعمال خصوصا
ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة واما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأت بها الشرائع فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة ولراجحه أو تكميلهما بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة وتنازع الناس هنا في مسئلتينالمسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه قالوا والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لآجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لإن له فيه غرضا ووطرا ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهى عنه وتركه فأتت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جدا في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالربا والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمر وإن كانت شرورا ومفاسد ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها ويختارها وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما أثرها العاقل ولا فعلها أصلا ولما كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته
ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيها بوجه ما قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلا وإن النار شر محض لا خير فيه أصلا وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المخل بوجودهما في الدنيا قالوا أيضا فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلا كالأنبياء والملائكة
ومنها هو شر محض لا خير فيه أصلا كإبليس والشياطين ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من
يغلب شره على خيره فهكذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها وخالص المفسدة وراجحها هذا في الأعمال كما أن ذلك في العمال قالوا وقد قال تعالى في السحرة ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فهذا دليل على أنه مضرة خالصة لا منفعة فيها إما لأن بعض أنواعه مضرة خالصة لا منفعة فيها بوجه فما كل السحر يحصل غرض الساحر بل يتعلم مائة باب منه حتى يحصل غرضه باب والباقي مضرة خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص المفسدة وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة فيه جعلت كلا منفعته فيكون من القسم الراجح المفسدة وعلى القولين فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها فمصلحته راجحة وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما وقال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم وفصل الخطاب في المسئلة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الإعتبار إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وإن من آثر الراحة فاتته الراحة وإن بحسب ركوب الأهوال وإحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلا كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال المتنبي :
وإذا كانت النفوس كبارا ... تعبت في مرادها الأجسام
وقال ابن الرومي :
قلب يظل على أفكاره وئد ... تمضي الأمور ونفس لهوها التعب
وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن ولا ريب
عند كل عاقل أن كمان الراحة بحسب التعب وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام فأما في هذه الدار فكلا ولما
وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسئلة وتعود مسئلة وفاق
فصل وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف
في وجوده وحكمه فاثبت وجوده قوم ونفاه آخرونوالجواب أن هذا القسم لا وجود له إن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمها في المحل الواحد وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين قولكم أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلان يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره اشد من منعه تأثير غير فإذا قوى على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا قيل لا ينتقض بما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما في مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبة مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية له بل المانع عاقها عن اقتضائها وهذا غير ممتنع وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها
فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين النقيضين لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطلة غير باطلة وهذا محال فثبت أنهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها
فإن قيل فما تقولون فيمن توسط أرضا مغصوبة ثم بدا له في التوبة فإن أمرتموه باللبث فهو محال وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في ارض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئة مثبتة بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فإن أقام على من هو فوقه قتله وان انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد صومه وان نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فهاهنا أيضا قد تضادت العلتان وكذلك أيضا إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين فهاهنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضا إذا ألقى في مركبهم نار وعاينوا الهلاك بها فان أقاموا احترقوا وان لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فان اشتغل بها فاته الوقوف وان اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة فهاهنا تحد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدرالغسل أو الصلاة بالتيمم فان اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فان ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وان تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قويين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة فانه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم إنكاره وأنتم تقولون بالموازنة وإن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فان حسناته
قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة ابن اليمان وابن مسعود وغيرهما
فالجواب من وجهين مجمل ومفصل
وأما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع فان مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافعا ويبطل أثرهما وليس في هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة فأما من توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج وان استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمن ترك الغصب فهي من باب مالا خلاص عن الحرام إلا به وان قيل إنها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن الغصب وإذا قدر تساوي الجواب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدها وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك الغصب فليس مما نحن فيه بسبيل وأما مسئلة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم فهذا ليس مكلفا في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفا اتفاقا فإنه لا قصد له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد إلا إلى الآخر فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار
وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره
أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي أبي يعلي والثاني لا شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح والثالث عليه القضاء دون الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع والمفسدة التي في حركة النزع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فانه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى فحينئذ يكون رمي الأسارى ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فلو انعكس الامر وكانت مصلحة الاسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم
فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم لمصلحتين بتفويت أدناهما فان فرض الشك وتساوي الأمران لم يجز رمي الأسرى لأنه
على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة ببضه الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه وأما إذا ألقى في مركبهم نار فانهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وان شكوا هل السلامة في في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يترجح أحد طرفيها ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحد إحداهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عرضتا لهم فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخيرون بينهما والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنيفية السمحة فيشتغل بادراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلى الهارب من سيل أو سبع أو عدو ايفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع وقد قال عبد الله بن أبي أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خالد ابن سفيان العرنى وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلى أومي ايماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال أني لفي ذلك قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى يرد رواه أبو داود
وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وأن طلعت الشمس ولا تجزيه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للماء وأن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه
كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم وفي المسألة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلى في الوقت لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة وهكذا هذا النائم وأن كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلا القولين لم تتساو المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع
وأما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التي تساوت مفاسدها كإتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لا بد من أتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير والولي وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقي على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وان الأثر هو أثر الحسنات فقط فبان أنه لا دليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه فأن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجع منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر
ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة وهو خبث التغذية والغازي شبيه بالمغتذى فيصير المفتذي بهذه الخبائث خبيث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك أن لم يتناولها أبيحت له فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب
وإن كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه بستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذه قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتفذي به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتفذي والمفتذي به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المفتذي به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يختلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقته إليها وميله منعه من التضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته فأنا لم تقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهيأه لقطع القابل ونظير هذا الملابس المحرمة إذا اضطر إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من ارقاق ولده ثم أبيح عند الضرورة إليه وهي خوف العنة الذي هو اعظم فسادا من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتقض بما قررناه فإن الله سبحانه لم حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواقعة المحظور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد
وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور فأن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث أن لم يجامع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير
والميتة والدم وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره فرحمه أرحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعا من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفا عنه لضعفه ولهذا قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم إلى قوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفا عنهم لضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم وإحسانا إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لهم أعظم المصلحتين وأن فاتت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وأن فاتت أدناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وان تزاحمت قدم أهمها وأجلها وأن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وأن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهما وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها حقا وفرقا إلا على هذه الطريقة وأما طريقة إنكار الحكم التعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وأن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة ينبه على السبب يذكره صريحا وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى
بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة يخير بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها وتارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه ولا يمكن من له أدني اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمسام بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك مالا ينفع ولا يغذي ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن أرادته وشرعه وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنه من النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي ومجمع الحواس التي تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله علية وسلم بالذكر في قوله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمني ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي وقد أشار النبي صلى الله عليه و سلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره وقال أبو إمامة يا رسول الله كيف الوضوء فقال أما فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأنا ملك فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت
برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواه النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبا فاسدا فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقا ومشقة ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فإن قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتقبيح على كثرتها
قيل قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء اتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين الآمدى واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد المسالك واعتمد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ما سواها والقدح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالاتفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري
فلأنه أن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وأن كان متمكنا من فعله وتركه كان جائزا فأما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولا فأن لم يفتقر كان اتفاقيا والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وان افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه أما أن يكون لازما وأما جائزا فإن كان لازما فهو اضطراري وأن كان جائزا عاد التقسيم فإما أن ينتهى إلى ما يكون لازما فيكون ضروريا أولا فينتهى إليه فيتسلسل وهو محال أن يكون إتفاقيا فلا يوصف بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذي يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقبيح وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس والشرع فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسا وشرعا فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال
الوجه الثاني لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا فان كان لازما كان ضروريا وان كان جائزا فان احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي ويكفي في بطلان الدليل المذكور إن يستلزم كون الرب غير مختار * الوجه الثالث أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح *
الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا * قلنا هو لازم عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون ضروريا أتعني به أنه لا بد منه أو تعني به أنه لا يكون اختياريا فإن عنيت الأول منعنا انتفاء اللازم فانه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري وإن عنيت الثاني وهو أنه لا يكون اختياريا منعنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير اختياري وأنت لم تذكر على ذلك دليلا بل هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة * الوجه الخامس أن يقال هو جائز قولك أما أن يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أولا قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزا * قلنا هو واجب بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمرجح هو الإختيار وما وجب بالإختيار لا ينافي أن يكون اختياريا فلزوم الفعل بالإختيار لا ينافي كونه اختياريا * الوجه السادس أن هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا اختياريا وإلا كان اختياريا غير اختياري وهو جمع بين النقيضين والدليل المذكور حجة على
فساد قولك وأن الفعل الواجب بالإختيار اختياري * الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدورا له وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدورا فهو اختياري قطعا *
الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي إن عنيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختياريا ويجعله اضطراريا فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقيا إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريا غير اختياري وان عنيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختياريا * الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي ما تعني بالاتفاقي أتعني به ما لا فاعل له أو ما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثا فإن عنيت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطراريا أن يكون الفعل صادرا من غير فاعل وإن عنيت الثاني لم يلزم منه كونه اضطراريا وإن عنيت معنى ثالثا فابده * الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عند وجود سببه وأنت لم تقم دليلا على أن ما كان كذلك يمتنع تحسينه وتقبيحه سوى الدعوة المجردة فأين الدليل على أن ما كان لازما بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقبيحه ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقبيحه فمحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه فدليلك لم يفد شيئا * الوجه الحادي عشر ان قولك يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين باطل فال منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ما وجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبدا * الوجه الثاني عشر أن هذا الدليل لوصح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده وأن يكلف المحموم بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهى بها فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وابطل أدلة غيره وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآمدي فهو أن حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى وهو محال لأن العرض لا يقوم بالعرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله فإنه منقوض مالا يحصي من المعاني التي توصف بالمعاني كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحس رخيم ورفيع
ودقيق وغليظ وأضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصى مما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض وجودية ومن أدعى أنها عدمية فهو مكابر وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدة والضعف فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء * الوجه الثاني أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل فيكون المعنيان جميعا قائمين بالمحل وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع للمحل فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعا بالجوهر فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة للآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا في غاية الوضوح
الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لاعدميان لأن نقيضهما يحمل على العدم فهو عدمي فهما إذا وجوديان لأن كون أحد النقيضين عدميا يستلزم كون نقيضه وجوديا فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعا ولا خلاص عن هذا إلا بالتزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الآثر على مؤثره المقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدما محضا إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأيضا فإنه لا معنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقة للذم والعقاب وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه ومحبة الرب له وأمره به كساه أمرا وجوديا زاده حسنا إلى حسنه وبعضه له ونهيه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا إلى قبحه فجعل ذلك كله عدما محضا ونفيا صرفا لا يرجع إلى أمر ثبوتي في غاية البطلان والإحالة وظهر والإحالة وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان ولم نتعرض للوجوه التي قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فمن اكتفى بها فهي موجودة في كتبهم وأما المسلك الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمرو بن الحاجب من المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان ولا ستحال ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نبي أو مسلم ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا اين وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحا ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ قالوا وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من
قال لأكذبن غدا إذا فإنه لا يخلوا إما أن يكذب في الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه مصدق الخبر الأول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والقبح وهما نقيضان وإن صدق لزم حسن الخبر الثاني من حيث أنه صدق في نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيضان قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الاطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فإذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن ها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسئلة وألزمونا مالا يلزمنا وإنما نعنى بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتيبهما عليه كترتيب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتيب الري على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لاتخرجه عن كونه مقتضيا لذلك حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعا في ذاته وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء يكون الأمر منشأ المصلحة وتابعا للمأمور في وقت دون وقت فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حتى لم يكن بد منه في التناسل
وحفظ النوع الإنساني ثم صار قبيحا لما استغنى عنه فحرمه على عباده فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل ما نسخه من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا لئلا تحملهم إباحتها على القتال لأجلها والعمل لغير الله فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم ليتمحض قتالهم لله لا للدنيا فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا وأرسخهم إيمانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا أباح لهم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت قبحة بالنسبة إلى من قبلهم فكانت كإباحة الطبيب اللحم للصحيح الذي لا يخشى عليه من مضرته وحميته منه للمريض المحموم وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع فخيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه فلما عرفت علته يعني حكمته والفقه وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواء فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا معتادين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما ذالت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم وأطمأنت اليها قلوبهم وباشرت نعيمها لذتها وطيبها وذاقت حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته زيدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولمشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة والحكمة شاهدا لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين الذي بهرت حكمته العقول والألباب وبدا على صفحاتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة والصواب ومن هذا أمره سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك آذاهم والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم في ذلك أذنا من غير إيجاب عليهم ليذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان الجهاد أشق شيء على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لاحتما فلما ذاقوا عز النصر
والظفر وعرفوا عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتما فانقادوا له طوعا ورغبة ومحبة فلو أتاهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم بل مصدقا لهم مؤمنا بهم فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام افضل بقاع الارض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولا وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير وأن له ملك السموات والأرض ثم حذرهم التعنت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفارا فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية وأن أهله هم السعداء الفائزون لا أهل الأماني الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء فحقيق بأهل الإسلام إن لا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه وأنه بذلك ساع في خرابها لأن عمارتها إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلى فثم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلا ربه وقبلته فإن الله واسع عليم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنهم كل له قانتون ثم نبه على عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجى معه إيمانهم وأنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر إمامته للناس وإنه أحق من اتبع ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه أمن للناس ومثابة لهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعهده وإذنه ورفعهما قواعده وسؤالهما ربهما القبول منهما وأن تجعلهما مسلمين له ويريهما مناسكهما ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالته وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجلالته وأنه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواه وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم لئلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع لم يهلهم ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر انه كما جعلهم أمة وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولا هي بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقها ومن ينقلب على عقبيه ممن لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشك في النبوة وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا أن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق وأن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضاق عقله المنكوس عن القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال وأن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وأن رأفته ورحمته بهم تأبي إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالته قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخيما له وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره فندبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفاسد الناشئة من خلافه وان كل جهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد
الحرام فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته ولا ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه و سلم بذبح ولده لأن الله اتخذه خليلا والخلة منزلة تقتضى إفراد الخليل بالمحبة وأن لا يكون له فيها منازع أصلا بل قد تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وآثر عنده ولا يبقى في القلب سوى محبته فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت المحبة لوليها ومستحقها فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال فبقي الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه فنسخه في حقه لما صار مفسدة وأمر به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصلحة لهما فأي حكمة فوق هذا وأي لطف وبر وإحسان يزيد على هذا وأي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخة وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجوده إدراك
فصل وههنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر
وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم ابطله وأعدمه بالكلية بل لا بد أن يثبته بوجه ما لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي ابقاءه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى في الأولى ما شاء من الوجه الذي يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقا تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تفطن له من الناس فتأمل الأحكام المنسوخة حكما حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه ليصلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه والتوجه إليه قصدا لفضيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبالبالصلوات فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشد الرحال إليه والصلاة فيه منشأ للمصلحة فتمت للأمة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين البيتين وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمل هذا الموضع ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يفد فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدية وندب إلى الصدقة في شهر رمضان فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحتان معا وهذا أكمل ما يكون من الصوم وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه و سلم فإنه كان أجود ما يكون في رمضان فلم تبطل المصلحة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للإثنين ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه بل بقي استحبابه وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدوهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمة يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس فإنها لم تبطل بالكلية بل اثبتت خمسين في الثواب والأجر خمسا في العمل والوجوب وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدى هي خمس وهي خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلا المنازل واقتضت أيضا أن تكون خمسا لعجز الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه جمعا بين المصالح وتكميلا لها ولو لم نطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلا على ما راءها فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون
وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحمد فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كما للورثة يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثيه كما للورثةأن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين وهذا الثاني أقيس وأفقه وسره أن الثلث لما صار مستحقا لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى أبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام على ما أخذها له موضع آخر والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم يبطل بالكلية بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القولين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة
ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مغيا بالموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقد جعل الله لهن سبيلا بالحد وعلى القول الأخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولا ثم لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى ما هو أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت بشرعه وأمره وأما ما كان مستصحبا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم أياه وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصابا لعدم التحريم فإنها لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرعها الله تعالى ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخا إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه
فصل وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجاده فإذا اقتضت
حكمته إعدامه جملة أعدمه وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبدليه وتغييره وتحويله من صورة بدله وغيرهوحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه فإن القرآن والسنة إنما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لا جعله عدما محضا وإعدامه بالكلية فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسماوات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وإنزال المطر على أجزاء بنى آدم المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحيلت ثم أنشئت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعثر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش وتقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وتميد الأرض وتدنو والشحى من رؤس الناس فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي كلها فيجعلها عدما محضا ثم يعيد ذلك العدم وجودا ويا ليت شعري أين في القرآن والسنة أن الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجودا وهذا هو المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الالزامات واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المكابرات وأما المعاد الذي أخبرت به الرسل فبريء من ذلك كله مصون عنه لا مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحد وقد أخبر سبحانه أنه يحي العظام بعد ما صارت رميما وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشىء تلك الأجساد بعينها بعد ما بليت نشأه أخري ويرد إليها تلك الأرواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتى تصير عدما محضا فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا ولا دل على أنه يفني الأرض والسموات ويعدمهما عدما صرفا ثم يجدد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تقضى به فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للعبد أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتيا لما اختلف إلى آخره فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لا يخرجه عن كونه ذاتيا الثاني أنه ليس المعنى من كونه ذاتيا إلا أنه ناشىء من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا
لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور الثالث انه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلا في محل معين بشرط معين والتسخين في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضي السكون فإذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة واللحم يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض الممتنع منه الغذاء ويقتضي المرض بشرط كون الجسم محموما ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فإن قيل محل النزاع أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع أن يكون كل واحد منهما وصفا لازما لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه قيل معنى كونه يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فإذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا واضح جدا : الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبى أو مسلم فهذا فيه طريقان أحدهما لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلا عنأن يجب بل لا يكون الكذب إلا قبيحا وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض إبراهيم للملك الظالم بقوله هذه أختي لزوجته وكما قال أني سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوما ما وكما فعل في قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم أن كانوا ينطقون فأن الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما ومع هذا فسماها صلى الله عليه و سلم ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف يصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك * فأن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح * قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذا الغرض أبطال استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد في هذا المقام للناس جوابا شافيا يسكن القلب إليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إياه مضمونه فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وأن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريض وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل عليه السلام اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا
قبيحا وأن الذي يحسن ويجب إنما هو التورية وهي صدق وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الإفهام لا إلى العناية الطريق الثاني ان تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجعة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من قال لأكذبن غدا إلى آخر ما ذكر جوابه أنه متى يجتمع النقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو إذا كانا باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فإن عنيتم الأول فمسلم ولكن لا نسلم الملازمة فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس ممتنعا فإنه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسنا بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول ونظيره إن يقول والله لأشربن الخمر غدا أو والله لآسرقن هذا الثوب غدا ونحوه وأن عنيتم الثاني فهو حق ولكن لا نسلم انتفاء اللازم وأن عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني وهذا واضح جدا الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حدا أو قصاصا وقبيح في غيره فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان كلام في غاية الفساد فإن القتل والضرب واحد بالنوع والقبيح ما كان ظنا وعدوانا والحس منه ما كان جزاء على إساءة أما حدا وأما قصاصا فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للواحد المعبود وفي غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حدا أو قصاصا فإنه يكون حسنا قبيحا لم يكن ذلك محالا لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه وهذا كما أنه مكروه مبغوض له وهو محبوب مرضى لفاعله والآمر به فأي محال في هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم
فصل فهذه أقوى أدلة النفاة باعترافهم بضعف ما سواها فلا حاجة بنا
إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصبح لذي عينين وجلبت عليك المسئلة رافلة في حلل أدلتها الصحيحة وبراهينها المستقيمة ولا تغضض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فأن شأنها عظيم وخطبها جسيم وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته او لصفته لم يكن الباريء تعالى مختارا في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فليزم الآخر فلا اختيار وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولا وبيان انتفاء اللازم ثانيا أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فإن الفعل لو حسن لذاته او لصفته لكان راجحا على الحسن في كونه متعلقا للوجوب أو الندب ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن في كونه متعلقا للتحريم أو الكراهة فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له او المرجوح المقتضي لضده
والثاني باطل قطعا لا لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فإذا كان تعلق الحكم بالراجح لازما ضرورة لم يكن الباري مختارا في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها والعجب ممن يرضى لنفسه ان يحتج يمثلها وحسبك فساد الحجة مضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره ويحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقا بين المتماثلين فأي برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة
الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم إذا لحكم بالمرجح لازم فإن قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقا بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه له ما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضعين متعلقا باختياره تعالى وإرادته فإنه الحكيم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه ووضعه وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم يفعل شيئا إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتماله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراجح أن لا يكون الحكم اختياريا فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة
الثالث أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختارا تلبيس فإنه إنما تعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لا يكون مختارا واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح الرابع إن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهي عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم فإن كان جائز الطرفين لم بترجح أحدهما إلا بمرجح وإن كان راجحا فالتعلق لازم لأن الحكم
يمتنع ثبوته مع المساواة ومع المرجوحية
أما الأول فلا ستلزامه الترجيح بلا مرجح وأما الثاني فلا ستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحينئذ فيلزله عدم الاختيار وما يجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة لأحد الأمرين ولا بد أما الترجيح بلا مرجح وإما أن لا يكون الباري تعالى مختارا كما قررتم وكلاهما باطل السادس أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختارا وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة واحتج النفاة أيضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفي التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا الواجب لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل فهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا أثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين إثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس إبطال القول بمجموع الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا فأن الله سبحانه إنما أقام الحجة على العباد برسله قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهذا صريح بأن الحجة إنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل إليهم لأن الحجة حينئذ لم تقم عليهم فالصواب في المسئلة اثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمة مخالفة المرسلين وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث نمنع العفو بعد البعثة إذا أو عد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا بارتكاب القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إيعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لا نتفاء شرطه لا لعدم
سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسئلة وينقشع غيمها ويسفر صبحها والله الموفق للصواب
واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لا متنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فأنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسئلة وبه تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه احكم الحاكمين وأنه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين
ومما احتج به النفاة أيضا أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد
وتقرير هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا يجوز ان يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوبا للشارع أيجاده ولا لقبحه إلا كونه مطلوبا له إعدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعي لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أولا فإن قلتم الطلب وأن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضي لتعلق الطلب به قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللا بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللا لم يكن ذاتيا وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وان كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه
آخر لا يفيد شيئا وبعد فهي شبهة فاسدة من وجوه : أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له أتعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب وأن تقوم الماهية به كتقومها بجنسها وفصلها أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب الا بالتعلق المذكور أم أمرا آخر فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون أنه ليس لمتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسي وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية وأن عنيتم الثاني فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطا في الطلب وأن عنيتم أمرا ثالثا فلا بد بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقف التعلق على الشرط المذكور الثاني أن غاية ما قررتموه قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعلل كما ادعيتموه في المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تبينوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من يدرى ما يقول وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغايرة لعلة وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب لا ينافي توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانتفاء شرطه وهذا مما لم يتعرضوا لبطلانه أصلا ولا سبيل لكم إلى أبطالة الثالث أن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا تزيد عليه بل هي صفة من صفاته فإن قلتم التوقف هاهنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا تجدون محذورا في توقف التعلق لأنه حادث قلنا فهلا قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه بالآخر فتبين فسادا الدليل المذكور وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وإنه ليس بقبيح واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق
الصادقين وأنه لا يقبح منه واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا وقد التزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها السمع فقط وانه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه وأن لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصا واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك الإمام سعيد بن على الزنجانى بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعرى القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهى لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطا للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في نفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها
فصل وإذا قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع وهو بحرها
ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها فبذلك تتم الفائدة فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه وللمسئلة ثلاثة أصول هي أساسهاالأصل الأول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه
وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم الأصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد فما وجد منها مراد له محبوب مرضى طاعة كان أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وأن لم يشأ تكوينها وإيجادها لأن في مشيئة لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها وأن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمه ومصلحة هي أحب إليه منها
ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسئلة ومسائل القدر والشرع وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعاله باء السببية وإنما هي باء المصاحبة ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الاصلين الأولين كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات
فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا نقيض فأنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مراد الله بوجه وأما الجبرية فعندهم انه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة فما شاءه فقد أحبه ورضيه وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها فالمعاصي كلها مقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشاها ممن لم يطعه ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئة ولا محبته وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا لما رأى القدرية والجبرية أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذه تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب
بالكلية وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادي من يشاء إلى صراط مستقيم
فصل وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى
الملاءمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى إستلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة اتفاقية وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثباب تعلق الملاءمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال ومحبته لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان وأستلزامه له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملاءمة ومنافرة واستلزامه عقلي فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مسحوطا مبغوضا أمر عقلي بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علما بما اسلفناه في ذلك انكشفت له المسئلة واسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتفي عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا انتفاءه لا انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقف على شرطه وعلىهذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي وأن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالاستحاق الاستحقاق التام فالحق نفيه وأن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته فعادت الأقسام الثلاثة أعنى الكمال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوبا أو مبغوضا ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا وأن يستحق عليه المدح والثواب ومن كونه مبعوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع ويعيد المسئلة اتفاقية ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من التناقص إذا طردوا أصولهم وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنهما أمر وراء المشيئة العامة فأصول مستلزمه لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه لا تتناقص وأدلته لا تتمانع ولا تتعارض قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الخلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الأبوين ولا تربي في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الاثنين أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوما عليه لم نشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول وعاند كعناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دون الثاني بمجرد عقله والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلا كما يقال أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب أخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسنا أو قبيحا فلم يدخل الحسن والقبح إذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها ولوازمها في الوهم بالبديهة كما بينا ولألزمها في الوجود ضرورة فأن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه من الدلالة على هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما عندهم ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبديهة ولا بالنظر فإن النظر لا بد أن يرد إلى الضروري أي
البديهي وإذ لا بديهي فلا مرد له أصلا فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضر بهم قبيحا وما ينفعهم حسنا ونحن لا ننكر أمثال تلك الاسامي على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لا حقيقة له في الذات فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا وربما يكون قبيحا لكنا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوبا يثاب عليه قطعا ولا يتطرق إليه لوم أصلا ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلا قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ما تحرر قالوا وأيضا فنحن لا ننكر اشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثني على فاعلها أو مذمومه مذموما فاعلها ولكنا نثبتها إما بالشرائع وأما بالأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز و جل لانتفاء الأغراض عنه فإما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض وتخفي فلا ينتبه لها إلا المحققون قالوا ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه وهي ثلاثة مثارات يغلط الوهم فيها الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وأن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضي بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح مخطىء في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض الغلطة الثانية سببها أن الوهم غالب للعقل في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أو ولى وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه إنغرس في قلبه استقباحه والنفرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في الصغر كالنقش في الحجر وينغرس في النفس ويجد التصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال اعتقده مطلقا الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس فأن من رأى شيئا مقرونا بشيء يظن أن الشيء لا محالة مقرون به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون الأعمبالأعم لا يلزم
أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس الذي نهشته الحية عن الحبل المرقش اللون لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى وكذلك ينفر عن العسل إذا شبهه بالعذرة لأنه وجد الاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر يقترن به الاستقذار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتعذر الأكل وأن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وأن كانت كاذبة حتى أن الطبع ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلازم الاسم ولهذا يورد على بعض العوام مسئلة عقلية جلية فيقبلها فإذا قلت هذا مذهب الاشعري أو المعتزلي أو الظاهري أو غيره نفر عنه أن كان سيء الاعتقاد فيمن نسبتها إليه وليس هذا طبع العامي بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على إتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر أقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فأن الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعة بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا انتبهت لهذه المثارات عرفت بها سر القضايا التي تستحسنها العقول وسر استحسانها إياها والقضايا التي تستقبحها العقول وسر استقباحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما مما يحتج بهما علينا أهل الإثبات
المثل الأول الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وأن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو مجازاة ولا سيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت وأن كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض الكفرة وعلى الجملة فاستحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم لا ينكره إلا من عاند المثل الثاني العاقل إذا سنحت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن بالكذب بحيث تساويا في حصول الغرض منهما كل التساوي فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه وما ذاك إلا لحسنه فلو لا أن الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنه وإلا لما ترجح الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح في حق من أنكر الشرائع وفي حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزموننا كون الترجيح بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فتبين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى في حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسببه دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الأنفكاك عنه وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفة غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح
المتوهم فإن فرض في بهيمة أو شخص لا رقة فيه يفيد تصوره لو تصوره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المنفذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقي ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل فطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا نتهي إليه أحس في نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر
أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا
وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان
وحبب أوطان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكر تهموا ... عهودا جرت فيها فحنوا لذلكا
قال وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصبر على السيف في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه فإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين فكم من شجاع ركب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثروا الثناء عليهما فمن يحتمل الضرر لا لله فإنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقبح السعي في هلاك نفسه بغير فائدة ويستحمق من يفعل ذلك قطعا فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر الهلاك على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عمن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستويا عنده وإيثاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إيثار الكذب ومنع إيثار الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إيثار الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعا وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فغايته أن يدل على حسن الصدق شاهدا ولكن لا
يلزم حسنه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد لو رأى عبيده وإماءه يموج بعضهم في بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر على منعهم لقبح ذلك منه والله عز و جل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم ولم يقبح منه سبحانه ولا يصح قولهم انه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لم يمنعهم قهرا فكم من ممنوع من الفواحش لعلة وعجز وذلك أحسن من تمكينه مع العلم بأنه لا ينزجر وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعا ومحض التشبيه في الأفعال ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معلم من الطرفين كيف وأن إنقاذ الغريق الذي استدللتم به حجة عليكم فإن نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أقبح شيء منا فالأنقاذ إن كان حسنا فالإغراق يجب أن يكون قبيحا فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضا لم نصل إليه فقدروا مثله في ترك إنقاذنا نحن للغرقى بل في إهلاكنا لمن نهلكه والفعلان من حيث التكليف والإيجاب مستويان عقلا وشرعا فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كلما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية وإعداد الآلة وإتمام الأداة تعديل القامة وما متعه به من روح الحياة وفضله من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهداه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دواما فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة في الحال لارتقاب ثواب في ثاني الحال أليس لو ألقي إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جريا على سوق طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران :
أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم على فعلهم الثاني أنه لا يكلفهم بأمر ولا نهى إذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة لا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثوابا بل ابتداء وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما حقا وقطعا فكيف تعرفنا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب قالوا ولا سيما على أصول المعتزلة القدرية فإن التكليف بالأمر والنهى والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فإنه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها آمرا ناهيا موجبا مكلفا بالأمر والنهى للخلق ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة
والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضي ويطلب منه شيئا أو يأمره وينهاه بشيء كما يعقل كما يعقل الأمر والنهي بالطلب القائم بالآمر والناهي فإذا لم يقم به طلب استحال أن يكون آمرا ناهيا فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثوابا أو يكره منه معصية يستحق عليها عقابا وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذا هما فرع الأمر والنهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون أنه يخلق في الهواء أو في بحر أفعل أو لا تفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهى المخلوق على صفة في ذاته غير كونه عالما قادرا ومعلوم أن هذا لا يدل ألا على كون الفاعل قادرا عالما حيا مريدا لفعله وأما دلالته على حقيقة الأمر والنهى المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا فتعرف من ذلك أن من نفي قيام الكلام والأمر والنهى بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبدا ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلا عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والأمكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفي قول الله وكلامه فقد نفي التكليف جملة وصار من أخبث القدرية وشرهم مقالة حيث أثبت تكليفا وإيجابا وتحريما بلا أمر ولا نهي ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته في حق الرب تعالى وأثبت فعلا وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته في حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة
قالوا وأيضا فما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلا ومن جنسه في العقل أمر آخر يعارضه يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجحه من تلقائة فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثالا فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة
مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصا ردعا للجناة وزجرا للطغاة وحفظا للحياة وشفاء للغيظ وتبريدا لحر المصيبة اللاحقة لأولياء القتيل ويعارضه معنى آخر أنه إتلاف بازاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فقد تعارض الأمر ان وربما يعارضه أيضا معنى ثالث وراء هما فيفكر العقل أيراعى شرائط آخر وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية أولا فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة ويقرر قانونا يطرد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم
وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة إذا كانت راجعة إلى مجرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة واحوال متنافرة وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص والحركات نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل مجرد الخواطر الطارئة على الأصل وهي متعارضة
قالوا وأيضا لوثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا على العبد والرب واللازم محال فالملزوم كذلك
أما الملازمة فقد كفانا أهل الإثبات تقريرها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلا بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعبث ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأيضا فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعثة فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فإنما احتج عليهم بالنذير وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين وقال تعالى كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده إليهم على ألسنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره ونهيه الذي بلغته رسله وقال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فهذا في حكم الوجوب والتحريم على العباد قبل البعثة وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فمن وجوه متعددة
أحدها أن الوجوب والتحريم في حقه سبحانه غير
معقول على الإطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فيم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا فأنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم ونحن نرى كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى كإيلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأنشد السائل
ويقبح من سواك الفعل عندي ... فتفعله فيحسن منك ذاكا
ونحن نرى ترك إنقاذ الفرقي والهلكي قبيحا منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحا منه ونرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ويسيء بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصبح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحريم عليه وجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضي موجبا ومحرما آمرا ناهيا وبينه فرق وبين الذي يجب عليه ويحرم وهذا محال في حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائبا
قالوا وأيضا فلهذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضا في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب و لا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذي يلحق الشاهد دون الغائب لآن ذلك لو كان فارقا في محل الإلزام لكان فارقا في أصل الصلاح فأن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله وأن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور اللازم الثاني إن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجبا وجب وجوب الفرائض اللازم الثالث أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحا لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عتابهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إماتتهم
واعدا مهم ولم يتضرر سبحانه بذلك
اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح وألاصلح وتركه من الفساد والعبث لو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمدا وثناء فإنه في فعله ذلك قد قضي ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر
اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون اللازم السادس انه مع كون خلقه أصلح لهم وأنفع أن يكون أنظاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته
اللازم السابع أن يكون تمكينه من إغوائهم وجريانه منهم مجرى الدم في أبشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه
اللازم الثامن أن يكون إماتة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينه اللازم الثامن أن يكون إمانة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعرى للجبائي وقد سأله عن ثلاثة أخوة أمات الله أحدهم صغيرا وأحيا الآخرين فاختار أحدهما الإيمان والآخر الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يا رب لم لا تبلغني منزلة أخي فقال إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة
فقال يا رب فهلا أحييتني حتى أعمل مثل عمله فقال كان الأصلح لك أن توفيتك صغيرا لأني علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيرا فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار يا رب فهلا عملت معي هذا الأصلح واختر متني صغيرا كما عملته مع أخي واخترمتني صغيرا فأسكت الجبائي ولم يجبه بشيء فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان ناجيا ولو أمهله وسهل له النظر لعاند وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصلح في حقه إبقاؤه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعويض بأسني الدرجات التي لا تنال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطي مالا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده انه لو أعطاه سيفا أو سلاحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطاؤهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدى فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى حبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخنق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبدا من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم
أنه يكفر عند تكليفه الإلزام الحادي عشر أنهم قالوا وصدقوا بأن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأي غرض له في تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم قالوا وكذبوا الغرض في التكليف أن استيفاء المستحق حقه أهنا له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته ومساو بينه وبين أحاد الناس وهو من أقبح النسبة وأخبثه تعالى الله عن ضلالهم علوا كبيرا فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل المنة في الحقيقة إلا الله المان بفضله قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما قال النبي صلى الله عليه و سلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي فأجابوه بقولهم الله ورسوله أمن ويا للعقول التي قد خسف بها أي حق للعبد على الرب حتى يمتنع من قبول منته عليه فبأي حق استحق الأنعام عليه بالإيجاد وكمال الخلقة وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير ما في السموات وما في الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس في الهواء الذي لا يكاد يخطر بباله أنه من النعم وهو في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فإذا كانت أقل نعمه عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن بما هو أجل منها من النعم فيا للعقول السخيفة المخسوف بها أي علم لكم وأي سعي يقابل القليل من نعمه الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منه إذا أثابكم لأنكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأي أمة من الأمم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منته وزعمت أن لها الحق على ربها وأن تفضله عليها ومنته مكدر لا لتذاذها بعطائه ولو أن العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقته وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة إنما المنعم في الحقيقة هو الله ولى النعم وموليها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرأي السخيف والمذهب القبيح والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقهم عليه وحقهم قبله وأنه لا يستحق الحمد والثناء على أداء ما عليه من الدين والخروج مما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضي غيره تعالى الله عن إفكهم وكذبهم علوا كبيرا
الإلزام الثاني عشر أنه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز و جل أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند فإن اخترامه هو الأصلح له بلا ريب أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم الخبيث الذين
اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا نقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإيلام سبب مضاعفة الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالحيوان البهيم وينتقض بالأطفال الذين لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل ينتفع به في الآخرة في زيادة ثوابه لا نتقاضه عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود فأي مصلحة له في إيلامه وأي معنى ذكر تموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه
الإلزام الرابع عشر ان من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الإيمان والعمل الصالح فأن الأصلح في حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وأن لا يحترمه صغيرا وهذا مما لا جواب لكم عنه الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصحها الزاما وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له فلو كان في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده لو جب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لا من من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لآتي كل نفس هداها
الإلزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضا أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر وأن نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحيح وإجماع الأمة ردا لهذا القول وتكذيبا له الإلزام السابع عشر أن ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه والاقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح إذ لا نهاية له فلا يمكن في الفعل رعايته
الإلزام الثامن عشر أن الإيجاب والتحريم يقتضي سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا محال في حق من لا يسئل عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجملة فتحتم بهذه المسئلة طريقا للإستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصابئة والبراهمة وكل منكر للنبوات فهذه المسئلة بيننا وبينهم فانكم إذا زعمتم أن العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الإستغناء عنها بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريرا قد اشتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق
مرفوض في العقل لذاته والممتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقبح سواء حمله عليه شارع أو لم يحمله ثم الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكمال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميزا من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه راجحا عليهم بعقله الرزين ورأية المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبيح إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة ثم زادت الصائبة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالاتها نظر سعيد ونحس واجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فنحن لا نحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكما أنا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء ومنافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبيحها فنلابس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأي حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا وزادت التناسخية على الصائبية بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفا بنوع اختيار في أفعاله مخصوصا بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبدا في أحد
أمرين إما فعل يقتضي جزاء أو مجازاة على فعل فما باله يحتاج في أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقبح فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعال غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقبحها صورا حيوانية روحانية وإنما يصير الحسن والقبح في الحيوانات أفعالا إنسانية وليس بعد هذا العالم عالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلا فأن ما يأمر به النبي لا يخلو إما أن يكون معقولا أو غير معقول فإن كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن النبي وأن لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه الطوائف كلها لما جعلت في العقل حاكما بالحسن والقبح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة وأنتم يا معاشر المثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموهم على هذا الأصل وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم الأبواب فمن طرق لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام مناجزة القوم فقد رام مرتقى صعبا فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافتك بعددها وعديدها وأقبلت إليك بحدها وحديدها فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقى الزحفان وتقابل الصفان وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حمى وإن كنت من اهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء
فدع الحروب لأقوام لها خلقوا ... ومالها من سوى أجسامهم جنن
ولا تلمهم على ما فيك من جبن ... فبئست الحلتان اللؤم والجبن
قال المتوسطون من أهل الإثبات ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه ونبطل ما معه من الباطل وترده عليه فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن ننتسب لي ذي مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحق حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين فمن أدلى بحجته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع وأن كان المحكوم عليه حيث يدلى خصمه بحجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله تجتبيء إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم
فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين واحد ونهانا عن التفريق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب وهذه حال المحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره
ثم قال لا حجة بيننا وبينكم والحجة ههنا هي الخصومة أي للخصومة ولا وجه لخصومة بيننا وبينكم بعدما ظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدرى ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد ناظر النبي صلى الله عليه و سلم جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالمته ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة فقوله لا
حجة بيننا وبينكم أي لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضح الحق واستبان ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على المبطل وإليه المصير قالوا وهما نحن نتحرى القسط بين الفريقين عما يقوله صلى الله عليه و سلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم مما ولوا ويكفي في هذا قوله تعالى يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهى عنه وأنه لم يجيء بما يخالف العقل والفطرة وأن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فالشرائع جاءت بمجازات العقول لا محالاتها وفرق بين مالا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني وأخطؤا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطؤا في موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها الموضع الثاني انهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبتها إليه كنسة صفاته إلى ذاته فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى ومن هاهنا استطال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم ثائرة الشناعة وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عقولهم وآرئهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما
حرمه هو على نفسه فهو الذي كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده وأصابوا في قولهم أنه سبحانه لا يحب الشر
والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه يحب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أو في الشجرة ولم يجعلوها معاني ما يهدى به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفي الصفات فنفوا المحبة والكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فإن شرع الله هو أمره ونهيه ولم يقم به عندهم أمر ولا نهى فحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ما سدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا في قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحة بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لانتصفوا من خصومهم فمثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فإن مصالحها ناشئة منها ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفى والمروة ورمي الجمار ونحو ذلك فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال الثلث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معا فالفعل يتضمن مصلحة والأمر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه صلى الله عليه و سلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الأصل ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطؤا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الحواس التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهى وسلبوا الأفعال حتى خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فخالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جدا ولم يجدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعناء وجحدوا الضرورة وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبتته القدرية من المعتزلة
ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى مالا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا في نفيهم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه وأخطاوا أيضا في نفسهم حكمته تعالى في خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء وفي إنكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومة اعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو مجردا عن ذلك والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة الأنفي للحكمة وإثبات لأمر آخر وأخطاوا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيتة وما لم يشأه نقد كرهه وأبغضه فمحبته مشيئته وإرادته العامة وكراهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبا له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة ممقوتة عنده فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها وأخيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم
فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانه إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من افعاله على حسب ما أثبتوه لخلقه والجبرية نفوا والقدرية أثبتوا له حكمته اللائقة به التي لا يشابهه فيها أحد والقدرية قالت أنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدرية قالت أنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له والجبرية قالت أنه يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يطعه قط وينعم أعداءه ومن كفر به
وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وأنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساوى بينهم في مقدوره ولو قدر أن يهدى أحدا ولم يهده كان بخلا وأنه لا يهدى أحدا ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا أن أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال حكمته والطائفتان سلبته كمال حمده وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره واثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بآرائهم كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرداها ففازوا بالقدح المعلى وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز باخس المطالب والهدى هدى يختص به من يشاء من عباده
فصل إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه :
أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة من غير تأدب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران : أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمرا غير معلوم الصحة فإن تقدير الإنسان كذلك محالالوجه الثاني سلمنا إمكان التقدير لكن لم قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحا بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجزم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة الوجه الثالث سلمنا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون قبيحا لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرجه عن كونه عقليا ولا يجب التساوي في العقليات إذ بعضها أجلي من بعض فإن قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضروريا وهو يبطل قولكم
قلنا هذا إنما لزم من التقدير المستحيل في الواقع
والمحال قد يلزمه محال آخر سلمنا أنه ينفي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فلم قلتم أنه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر
والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بوسط ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط
الوجه الرابع أن نصور ماهية الكذب يقتضي جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس فكما أن أدراك الحواس المتنافرات يقتضي نفرتها عنها فكذلك أدراك العقل لحقيقة الكذب ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين أدراك الحس وأدراك العقل فإن جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس الوجه الخامس إنكم فتحتم باب السفسطة فإن القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها فمن لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فتح باب المكابرة في المحسوسات ولهذا كانت السفسطة تعرض أحيانا في هذا وهذا وليست مذهبا لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وإنما هي حال عارضة لكثير من الناس وهي تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أبي وسنذكر أن شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه أن جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا
الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه أنكم أن أردتم بالتسوية كونهما معقولان في الجملة فمن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها إلا من منع هذا الحكم فإن أردتم بالتسوية الاستواء في الإدراك وأن كليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم من عدم هذا الاستواء أن لا يكون العلم بقبح الكذب عقليا
الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الآمران في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فإنه من المتقرر أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وإنما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليت شعري من أين يلزم أن يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحدة وهل هذا الا مجرد تحكم ودعوى باطلة الوجه الثامن أنه لا يلزم من كون الحكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن أن لا يحب هذا ولا يبغض هذا بل تكون نسبتهما إليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو أن حكمته تقتضي بغضه للقبيح وأن لم يتضرر به ومحبته للحسن وأن لم ينتفع به وحينئذ ينقلب هذا الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند النافي أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها العلم أن الأمرين أعني الصدق والكذب بالنسبة
إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وانه يستحيل في حكمته التسوية بينهما وأن يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول
الوجه التاسع قولكم أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وأن الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما الذاتية ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في الوجود ضرورة جوابه أنكم أن أردتم أن الحسن والقبح لا يدخل في مسمى الصدق والكذب فمسلم ولكن لا يفيدكم شيئا فإن غايته إنما يدل على تغاير المفهومين فكان ماذا وإن أردتم أن ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما فهل هذا إلا مجرد المذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المطلوب وخصومكم يقولون أن معنى كونهما ذاتيين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلة في مسمى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا
الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في الوجود دعوى مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة الوجه الحادي عشر قولكم أن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما
جوابه من وجوه أحدها أنا لا نسلم أن الصدق يقبح في حال ولا أن الكذب يحسن في حال أبدا ولا تنقلب ذاته وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض المخبر ولم يور بما يقتضي سلامة النبي أو الولي الوجه الثاني أنه أخبر بما لا يجوز له الأخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا بل الأخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الأعلام بها فالقبح إنما نشأ من الأعلام لا من النسبة الصادقة والأعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده إذا الخبر غير الأخبار ولا يلزم من كون الأخبار قبيحا أن يكون الخبر قبيحا وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما
الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين في بعض المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضي عدم اتصاف ذات كل منهما بحكمه عقلا فإن العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لفوات شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك الوجه الثاني عشر قولكم أنه لم يبق للمثبتين إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحا وما ينفعهم حسنا كلام باطل فإن استرواحهم إلى ما ركبة الله تعالى في عقولهم وفطرهم وبعث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم أنها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون
مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبائح والمستحسنات عن كون الحسن والقبح ناشئا من ذواتهما وأن الزمان المعين والمكان المخصوص والشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن لا نعنى بكون الحسن والقبح ذاتيين إلا هذا والمشاحنة في الاصطلاحات لا تنقع طالب الحق ولا تجدي عليه إلا المناكدة والتعنت فكم يعيدوا ويبدوا في الذاتي وغير الذاتي سموا هذا المعنى بما شئتم ثم أن أمكنكم إبطاله فأبطلوه
الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا ننكر اشتهار القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذموماولكن سبب ذكرها أما التدين بالشرائع وأما الاعراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز و جل لانتفاء الاعراض عنه فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فنقول لكم ما تعنون معاشرة النفاة بالاعراض التي نفيتموها عن الله عز و جل ونفيتم لاجلها حسن أوامر الذاتية وقبح نواهيه الذاتية وزعمتم لاجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وأنها بالنسبة إليه سواه فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفطة البديعة المحتملة أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها أم تعنون بها امرا وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الارادات فان اردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأتيتم ما لا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقربه به عين كل طالب للحق وهاهنا من ادلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والامر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل لانسبه لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقمت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير كاتب نصبت شاهدة لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللطف والخبرة
تأمل سطور الكائنات فإنها ... من الملأ الأعلى إليك رسائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها ... ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها أن تزيد على المئين وما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى أن اثباتها يستلزم افتقارا منها واستكمالا بغيره فهوس ووساواس
فان هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل أيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع وأيضا فأنه سبحانه فعاله عن كماله فأنه كمل ففعل لا أن كماله عن فعاله فلا يقال فعل فكمل كما يقال للمخلوق وأيضا فأن مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة ومن المحال أن يكون سبحانه وتعالى فقيرا إلى غيره فأما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغنى المطلق عن كل شيء فأي محذور في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره وهل الغنى إلا ذلك ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وكلمه وغناه وقيوميته وملكه لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة :
ولله في كل تسكينة ... وتحريكة أبدا شاهد
وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أعراضا وإخراجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعى لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال الأمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل ننكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها أعراضا ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخيرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخيرهم لها أحسن الألفاظ وأتباعهم محبوسون في قبول تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لا تهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض فحينئذ يتبين له الحق من الباطل والحالي من العاطل
الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح التدين بالشرائع فيقال لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان في الفطرة مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسنه فصار حسنا من الجهتين وما كان في الفطرة مستقبحاجاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الجهتين وأيضا فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بنبوة وأيضا فمجيء الرسول بالأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى
عن شيء فقال العقل ليته أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزا في الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علما من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من اكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم
الوجه السادس عشر قولكم في مثارات الغلط التي يغلط الوهم فيها أنها ثلاث مثارات الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وان كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فان كل طبع مشغوف بنفسه فيقضى بالقبح مطلقا فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره فحاصله أمران أحدهما أنه إنما قضى بالحسن والقبح لموافقة غرضه ومخالفته
الثاني أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبت المخالفة والموافقة إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضى حسنا ولا قبحا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فما لجأتم إليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح فان ما لاءم منها الإنسان ووافقه مخالف بالذات والوصف لما نافره منها وخالفه ولم تكن تلك الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات ففي الخبز والما واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملاءمتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله فهكذا ما لاءم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملاءمة والمنافرة فملاءمة العدل والإحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والإساءة وليست هذه الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره
الوجه السابع عشر أنا لا ننكر أن للعادة واختلاف الزمان والمكان والإضافة والحال تأثيرا في الملاءمة والمنافرة ولا ننكر أن الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمساكن والملابس وينافره ما لم يعتده منها وان كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الأوطان وحب المساكن والحنين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملاءمة والمنافرة كلها ترجع إلى الالف والعادة المجردة ومعلوم أن هذا مما لا سبيل إليه إذ الحكم على فرد
جزئي من أفراد النوع لا يقتضي الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع اللازم المعين لا يقتضي استلزام النوع له وثبوت خاصة معينه للفرد الجزئي لا يقتضي ثبوتها للنوع الكلي :
الوجه الثامن عشر أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في اعتقاده إضافة القبح إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا مما قد يعرض في بعض الأفعال فهل يلزم من ذلك أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غالطا بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلي على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلي مطابقا لحكمه فمن أين لكم الحكم بغلطه
فان قلتم إذا ثبت أنه يغلط في حكم ما لم يكن حكمه مقبولا إذ لا ثقة بحكمه قلنا إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان حاكم الوهم وحاكم العقل ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم في بعض القضايا التي يجزم العقل بها هي من حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التي يجزم بها العقل ويحكم بها لاحتمال أن يكون مستندها حكم الوهم لا حكم العقل فلا بد لكم من التفريق بينهما ولا بد أن تكون قضاياه ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكم طريق إلى التفريق
الوجه التاسع عشر أن هذا الذي فرضتموه فيمن يتقبح شيئا لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مورده الحسنات غالبا كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح فأنها بحسب الدواعي والميول والعوائد والمناسبات فهي إنما تكون في الحركات وأما الكليات العقلية فلا تكاد تعارض تلك فلا يكون العدل والصدق والإحسان حسنا عند بعض العقول قبيحا عند بعضها كما يكون اللون اسود مشتهى حسنا موافقا لبعض الناس مبغوضا مستقبحا لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء بما لا يصح اعتباره به ويؤيد هذا
الوجه العشرون أن العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فانه لا يختلف حكمه بذلك في حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وأن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فلما أصاب في استقباحها أصاب في نسبة القبح إلى ذاتها وأصاب في حكمه بقبحها مطلقا ومن غلطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فانه يعلم أن غيره يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاص فلا يحكم به حكما كليا ألا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكما كليا بأن كل ظمآن يستحسن شرب الماء ما لم يمنع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفؤه ما لم يمنع منه مانع وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلي في هذه الأمور المستحسنة لا غلط فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس في استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض
والعوائد والالف فما الظن بالأمور الكلية العقلية التي لا تختلف إنما هي نفى واثبات
الوجه الحادي والعشرون قولكم من منارات الغلط إنما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال ألا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيقضى بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره فحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقليه 1 عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في قلبه استقباح مستند إلى أخر فمضمونه بعد الإطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته لما تخلف عليه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبي ففي هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحا وهي حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقا ويغفل عن هذه الحالة وهي تنافي حكمه بقبحه مطلقا ثم تترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقا وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وان تخلف القبح عنه لمعارض راجح كما أن الاغذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير ويوجب نباتا خبيثا وان يخلف عنه ذلك عند المخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلا وأما إذا تضمن عصمة ولي فالحسن إنما هو التعريض
والصدق لا يقبح أبدا وانما القبيح الأعلام به وفرق بين الخبر والأخبار فالقبح إنما وقع في الأخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله لتخلف الحكم العقلي لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه وحسبك ضعفا بحكم إنما يستند إليها والى أمثالها الوجه الثاني والعشرون أن الوهم قد سبق إلى العكس كمن يرى شيئا مقرونا بشيء فيظن الشيء لا محالة مقرونا به مطلقا ولا يدرى أن الأخص أبدا مقرون بالأعم من غير عكس وتمثيلكم ذلك بنفرة السليم من الحبل المرقش ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كنفرة الطبع عن الحسناء ذات الاسم القبيح ونفرة الرجل عن البيت الذي فيه الميت ونفرة كثير من الناس عن الأقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيؤن الظن بهم فنحن لا ننكر أن للوهم تأثير في النفوس وفي الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الأحوال ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول كما إذا سلط العقل الصريح والحسن على الحبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها
الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نفرته عنها لقبح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد وهكذا نظائر ذلك أفتري يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في أهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا فان الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل لأنا أن سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسنها وقبحا فأنا إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبدا ألا أن يلجؤا إلى دبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك والى الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تصولون به سواه وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعا لم يجز أن يبطل بهما ماركبه الله في العقول والفطر وألزمها إياه التزاما لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولو لا أن ذلك قبيح عقلا لما أنكره على العقول التي جوزته فان الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا
ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلا قطعا لما جوزه أولئك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم أو لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال أن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنها لاستحسان بعض العقلاء لها فان قيل فهذا حجة عليكم فان عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أقبح القبائح قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك ألا كمثل من قال إذا كان الأحوال يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفم إذا ذاق الشيء المر يذوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في
كل مسألة فانه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فسادا وبطلانا وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله رب العالمين
الوجه الثالث والعشرون قولكم أن الملك العظيم إذا رأى مسكينا مشرفا على الهلاك استحسن إنقاذه والسبب في ذلك دفع الأذي الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فان مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والتنزل من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجهود مضرور قد مسه الضر وتقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلا حسنا في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وان يلقى عليه حجرا يغرقه وانما مال إليه طبعه لرقه الجنسية ولتصويره نفسه في تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه وألا فلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضربنا صفحا عن لوازمه وما يقترن به ويبعث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتى يغرقه هذا قول يكفى في فساده مجرد تصوره وليس في المقدمات البديهية ما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسنا لذاته حتى يحتج بها عليه فان الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخفى فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويرا مجردا يعرضان على العقول التي لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشئها فهي تسعى بنصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولا أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بأربابها فلو تجردت من حب من ولدته وبغض من خالفته وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسير في المسئلة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن * حبك الشيء يعمى ويصم * والنظر بعين البغض يرى المحاسن مساوى هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك البصيرة لا سيما إذا صادق مشكلا فهذه بلية أكثر العالم
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة ... وألا فإني لا أخالك ناجيا
الوجه الرابع والعشرون أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد إنفاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان فيقوم الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضي حسنه وان يكون ذاته مقتضية لحسنة وان اقترن بفاعل هذا الأمور وما مثلكم في ذلك ألا كمثل من قال أن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسنا لذاته فانه يقترن بمتناولها من لذة المرة لفم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنيه وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا ينافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضي الانتفاع بها فكذلك تلك
البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الغريق والحريق وما ينجى الهالك لا ينافى ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من الصفات التي تقتضي حسنها وقبح أضدادها
الوجه الخامس والعشرون قولكم أنه يقدر نفسه في تلك الحال وتقديره غيره معرضا عن الانقاذ فيستقبحه منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق في ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به فالقبح محقق في ترك إنقاذه ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له فلولا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الانقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا ينبغي أن يكون في ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة الوجه السادس والعشرون قولكم فلو فرض هذا في بهيمة أو شخص لارقة فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضي أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك ألا لأنه في نفسه على صفة تقتضي الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لضده في نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده وفعله لتوقع الثناء لا ينفى أن يكون على صفة لأجلها استحق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه
الوجه السابع والعشرون قولكم فان فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه فيقال يا عجبا كيف يرد أعظم الإحسان الذي فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش * فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشنع وهل سوى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه واحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا في العلم ببطلانها ولكنا زدنا الأمر إيضاحا وبيانا
الوجه الثامن والعشرون قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى ... وقوله
وحبب أوطان الرجال إليهم ... فيقال لا ريب أن الأمر هكذا ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب في نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فانه لم يمل طبعه
إلى ذلك المكان مع مساواته لجميع الأمكنة عنده وكذلك حنينه إلى وطنه ومحته له وكذلك حنينه إلى الفه من الناس وغيرهم فان هذا لا يقع منه مع تساوي تلك الأماكن والأشخاص عنده بل لظنه اختصاصهما بأمور لا توجد في سواهما فترتب ذلك الحب والميل على هذا الظن ثم له حالان أحدهما أن يكون كما ظنه بل ذلك المكان أو الشخص مساولغيره وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبه والميل إليه فهذا إذا سلط العقل الحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد الف أو عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقرر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشيء دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تعلق النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات باينة عن المحل وليست فيه بل يكون المحل مقرونا بتلك الصفات فيحب ويبغض لأجل تلك المفارقة فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقوله
وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا
وقول الآخر
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عهودا ... جرت فيها فحبوا لدالكا
الوجه التاسع والعشرون قولكم أن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فان فرض حيث لا تنافيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم المقرون فيقال لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا مخالف وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غيرها لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها وقولكم أنه إذا وجب فرض حيث لاثناء ينفى ميل الوهم للمقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقتضي ذاته المصلحة والاستحسان وان حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا تكون ذاته منشأ للأمر الموهوم فيتوهم الذهن حيث تنتفي الحقيقة
الوجه الثلاثون قولكم أن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر الصدق لأنه وجده مقرونا بالثناء فهو يؤثره لما يقترن به من الثناء فجوابه أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اختص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب متضمن لفساد تظلم العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معادهم بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشأ كل وفساد
الأعضاء لسان كذوب وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتعطلت به من معايش وفسدت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافتقر به غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورميت به محصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الابن وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدوا مبينا ورد الغنى العزيز مسكينا وكم فرق بين الحبيب وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته وكم جلا عن الأوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه ألا فما يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحيم ألا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية وهل عمرت الجنان ألا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فمن أبطل الباطل دعوى تساويهما وان العقل إنما يؤثر الصدق لتوهم اقترانه بالثناء وانما يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقبح كتوهم اقتران اللسع في الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقابح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن الألف وما من عاقل ألا وعند العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزا في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبدا ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والأيمان وخراب العالم واهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى استواء الجوع والشبع والري والظمأ والفرح والغم وأنه لا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا
الوجه الحادي والثلاثون قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلتموه فانهما إذا كانا متنافيين ذاتا وصفاتا لم يرجع الفرق بينهما استحسانا واستقباحا إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل في التناقض أقبح من هذا
الوجه الثاني والثلاثون قولكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهدا ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائبا ألا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم في الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يموج بعضهم في بعض ظلما وإفسادا وقبح ذلك مشاهد فيالله العجب كيف يجوز العقل التزام مذهب ملتزم معه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كجواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا ألا من أعظم الإفك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازا كنسبة ما لا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمن اصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وهل هذا الإفك المفترى ألا رافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده وتجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبائح التي تنزه عنها بعض عبيده ولا يليق به فضلا عنه سبحانه فلو التزمتم كل إلزام بلزوم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإد التي تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الازدراء والذم والمقت للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتنزه أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العالم جوز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءته
ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بمذهب بطلانا وفسادا هذا القول العظيم والإفك المبين لازمة ومع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيرا له من هذا ونحن نستغفر الله من التقصير في رد أهل المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساويهم محاسن وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنهم مساوي كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيء إلا انهم هم الكاذبون ولا يتعجب من هذا فان مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحكم صداؤها فليس ببدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه فمبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المرآة ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به وقيامك
لله وشهادتك بالقسط وأن لا يحملك بغض منازعيك وخصومك على جحد دينهم وتقبيح محاسنهم وترك العدل فيهم فان الله لا يعتد بتعب من هذا ثناه ولا يجدي علمه نفعا أحوج ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين
الوجه الثالث والثلاثون قولكم أن مستند الحكم يقبح الكذب غائبا على الشاهد وهو فاسد فيقال الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شهود يستوي أفراده فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلالنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال فمن جعل غيره سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكيما قادرا مريدا رحيما محسنا فهو أولى بذلك وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد من كمال علته ولكن نحن ننزه الله عز و جل عن إطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب مطلقا وان لم يتنزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله في الشاهد ففي حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كما لا فينا فالرب تعالى أولى به وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كما لا في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبهها وأرشدها إلى ذلك كقوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون ومملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله تحبونها كما يحبونه وتخافونها كما يخافونه وترجونها كما يرجونه وكقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وهجه مسودا وهو كظيم يعني أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله مالا ترضونه لأنفسكم وكقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل
يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يعني إذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث كقوله في حديث الحارث الأشعري وان الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا وان مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدي إلى غيره فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك فالله سبحانه لا تضرب الأمثال التي يشترك هو وخلقه فيها لا شمولا ولا تمثيلا وانما يستعمل في حقه قياس الأولى كما تقدم
الوجه الخامس والثلاثون أن النفاة إنما ردوا على خصومهم من الجهمية المعتزلة في إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهدا من له العلم والمتكلم من قام به الكلام والحي والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الاسم شاهدا وجود هذه الصفات ولا يستحق الاسم في الشاهد إلا من قامت به فكذلك في الغائب قالوا ولأن شرط العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياة فكذلك في الغائب قالوا ولأن علم كون العالم عالما شاهدا وجود العلم وقيامه به فكذلك في الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد في العلة والشرط والاسم والحد فقالوا حد العالم شاهدا من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهدا قيام العلم به فكذلك غائبا وعليه كونه عالما شاهدا قيام العلم به فكذلك غائبا فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به في مواضع أخرى فأي تناقض أكثر من هذا فان كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بطل احتجاجكم علينا به في هذه المواضع وان كان صحيحا بطل ردكم في هذا الموضع فأما أن يكون صحيحا إذا استدللتم به باطلا إذا استدل به خصومكم فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع
الوجه السادس والثلاثون قولكم أن الله خلى بين العباد وظلم بعضهم بعضا وأن ذلك ليس بقبيح منه فانه قبيح منا فذلك فاسد على أصل التكليف فان التكليف إنما يتم بإعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقدر عباده على الطاعات والمعاصي والصلاح والفساد وهذا الأقدار هو مناط الشرع والأمر والنهي فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي لارتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت فوائد البعثة ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله وتعطلت
به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لأقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نبهنا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفصل وفي أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لإرسال الرسل وانزال الكتب والأمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لا يحصل إلا بأقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبين ما هم فاعلوه وقبح من أحدنا أن يخلى بين عبيده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه مالا يفعله السيد من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم فقولكم أنه خلى بين عباد وبين إفساد بعضهم بعضا وظلم بعضهم بعضا كذب عليه فانه لم يخل بينهم شرعا ولا قدرا بل حال بينهم وبين ذلك شرعا أتم حيلولة ومنعهم قدرا بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه لهم حيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعي طباعهم لأهلك بعضهم بعضا وخرب العالم ومن عليه بل ألجمهم لجام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليقة كما الجمهم بلجام الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الأمر والشرع جملة وانتقت حكمة البعثة والإرسال والثواب والعقاب فأي حكمة فوق هذه الحكمة وأي أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه يتعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثا أو سدى أو باطلا أو بغير الحق أو لا لمعنى ولا لداع وباعث وان مصدر ذاك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم الموفقون عن الله عز و جل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه
ووصلت إليه إفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت عقولهم أن الله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرا وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يسألون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام أنى توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخيره وقدرته وانه آخذ بنواصيهم فلا محيص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالأخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالإحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفساد فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما ولطفا وبرا ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا لمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب الملوك وغيرهم بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه * فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين فأنها من كنوز القرآن ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمها فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفى ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وينفى العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينبغي أن لا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه ولا يفعل إلا بأقداره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدرية فالطائفتان ما وفوا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته واضلاله وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه واغناه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وانعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وإحيائه وإماتته وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للضم وعابديه والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بينه وبين الصنم الذي له مثل السوء فما فعله الرب تبارك
وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في اقدارهم واعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخلية السيد بين عبيده وامائه يفجر بعضهم ببعض ويسيء بعضهم بعضا اكذب دعوى وأبطلها والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه والحمد لله الغني الحميد فغناه التام فارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته للمغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطلبون مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويجاهدون أعداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليه من عدوه ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فيترتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذم لأعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه في غير موضع كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء هذه الآية من كنوز القرآن نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تمييز الخبيث من الطيب وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب والولى من العدو ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل وأنه لا بد منه وان الله تعالى لا يليق به الإخلال به وان من جحد رسالة رسله فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من الفكر فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد
الوجه السابع والثلاثون قولكم أن الإغراق والإهلاك بخس منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف يدعون حسن إنقاذ الغرقى عقلا إلى آخره كلام فاسد جدا فان الإغراق والإهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وان أغرق أولياءه وأهل طاعته فهو سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل قربه ولا بد من موت على كل حال فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعهما لهم في معادهم ليوصلهم إلى درجات عالية لا تنال إلا بتلك الأسباب التي نصبها الله موصلها كإيصال سائر الأسباب إلى مسبباتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما سلط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم في دار
الهوان وينال أولياؤه وحزبه ما هيئ لهم من الدرجات العلي والنعيم المقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك ووراء ذلك من الحكم ما لا تبلغه العقول والأفه والإفهام وكان إغراقه واهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فلهذا حسن منه
ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموتة وأعاضهم عليها أفضل الثواب فانه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تنوعت الأسباب والموت واحد
فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة وإحسانا ولطفا وكذلك الغرق والحرق والردم والتردى والبطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة فلهذا قبح منه الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير
الوجه الثامن والثلاثون قولكم إذا كان لله في إغراقه واهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله في ترك إنقاذنا الغرقى كلام تغى ركته وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا انجاء الغرقى ونصر المظلوم سد الخلة وستر العورة حكما وأسرارا لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت وثقلت على النفوس ومحتها القلوب والأسماع الوجه التاسع والثلاثون قولكم العقلان من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر وبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم فما جعل الله ذلك واحدا أصلا وليس إماتة الله لعبده مثل قتل المخلوق له ولا أجاعته واعراؤه وابتلاؤه مساويا في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوي كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوي هذا الفعل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق فيا لله العجب أن بتناولهما اسم الفعل المشترك صارا سواء في الصفات النفسية أترى حصل لهما هذا التساوي من جهة الفعلين والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فانه شفا جرف هار والله المستعان
الوجه الأربعون قولكم مواجب العقول في أصل التكليف معارضة الأصول فيقال معاذ الله من تعارضهما بل هي متفقة الأصول مستقر حسنها في العقول والفطر مركوز ذلك فيها فما شرع الله شيئا فقال العقل
السليم ليته شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها ويأمر بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالبا إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباحا لما أمر به ولا استحسانا لما نهى عنه وأن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأمورا مع الهوى مقهورا في قبضته وتحت سلطانه
الوجه الحادي والأربعون قولكم نطالبكم بإظهار وجه الحسن في أصل التكليف وايجابه عقلا وشرعا فيقال يالله العجب أيحتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلا حتى يطالب بحسنه عقلا وشرعا فأي حسن لم يأمر الله به ويستحبه لعباده ويندبهم إليه وأي حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأي قبيح لم ينه عنه ولم يزجر عباده من ارتكابه وأي قبح فوق قبح ما نهى عنه وهل في العقل دليل أوضح من علمه بحسن ما أمر الله به من الأيمان والإحسان وتفاصيلها من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لا شريك له على أكمل الوجوه وأتمها والإحسان إلى خلقه بحسب الإمكان فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلا له وكذلك ليس في العقل دليل أوضح من قبح ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عديل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم * ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذي فيه خراب العالم وفساد الوجود فأي عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك
وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
فما أبقى الله عز و جل حسنا إلا أمر به وشرعه ولا قبيحا إلا نهى عنه وحذر منه ثم أنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجهين ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد إقامتها عليها برسله وان كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشهدها عليه من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة إقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح
الوجه الثاني والأربعون أنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب فنقول لا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملا كالأنعام لا يعرفون معروفا
ولا ينكرون منكرا وينزو بعضهم على بعض نزو الكلاب والحمر ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكلاب والذئاب ويأكل قويهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجدونه ولا يدينون بدين بل هم من جنس الأنعام السائمة ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية وما نظير مطالبتكم هذه إلا مطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل في خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبد فان هذه أسباب ووسائل ووسائط
وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعادة في المعاش والمعاد ولا ريب عنه العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية وان كان الحسن هو الغالب على الناس وانما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإيثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف ولعل الله أن يساعده بمصنف في ذلك مع أن هذه المسألة بابه وقاعدته التي عليها بناؤه
الوجه الثالث والأربعون قولكم أنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط
فيقال هذا حق ولكن لا يلزم فيه أن لا تكون الشريعة والأمر والنهى معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يلزم منه أيضا عدم حسن التكليف عقلا ولا شرعا فذكركم كم هذا عديم الفائدة فانه لم يقل منازعوكم ولا غيرهم أن الله سبحانه يتضرر بمعاصي العباد وينتفع بطاعاتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان إليهم بلا واسطه ولكن ترك التكليف وترك العباد هملا كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون مناف لحكمته وحمده وكمال ملكه والهيته فيجب تنزيهه عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره وحكمته البالغة اقتضت الأنعام عليهم ابتداء وبواسطة الأيمان والواسطة في إنعامه عليهم أيضا فهو المنعم بالوسيلة والغاية وله الحمد والنعمة في هذا وهذا يوضحه
الوجه الرابع والأربعون وهو أن إنعامه عليه ابتداء بالإيجاد واعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعم التي سخرها له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وأصح الأقوال في الآية أن معناها ما يصنع بكم ربي لو لا عبادتكم إياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قادر على الأنعام عليهم بالجزاء من غير توسط العبادة الوجه الخامس والأربعون أن قدرته سبحانه على الشيء لا تنفي حكمته البالغة من وجوده
فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنع بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي صلى الله عليه و سلم وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على أماتة إبليس وجنوده واراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وأنا على ذهاب به لقادرون وقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني وقوله لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه وانما امتنعت لكمال حكمته فهي التي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتصي حسنه وموافقته لحكمته ونحن إنما نتكلم معهم في الثاني لا في الأول فالكلام في الحكمه يقتضي الحكمة
والعناية غير الكلام في المقدور فتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن انتم إنما لويتم من إنكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيتم على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى اصعب مضيق
الوجه الثالث والأربعون قولكم أنه تعالى لو ألقى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فيقال لكم ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهاه بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة أم تعنون به أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه فان عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل وأعظمه نقصا في الآدمي ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم أكمل منه ولم يكن مكرما مفضلا على كثير ممن خلق الله تفضيلا بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه فانه يكون مصدودا عن كماله الذي هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالا وأعظم نقصا مما منع كمالا ليس قابلا له
وتأمل حال الآدمي المخلى ورسوم طبعه المتروك ودواعي هواه كيف تجه في شرار الخليقة وأفسدها للعالم ولو لا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شرا من الخنازير والذئاب والحيات فكيف يستوي في العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع وغيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحا وأي قبح أعظم
من هذا ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا ثياب ولا يعاقب وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقول نسبة مثله إليه لمنافاته لحكمته وربوبيته والهيته وحمده فقال فتعالى الله الملك الحق لا اله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو ألهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فمحال أن يكون على غير هذا الوجه فانه يكون باطلا وعبثا فتعالى الله عنه لمنافاته ألهيته وحكمته وكمال ملكه وحمده وقال تعالى أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياب لأولى الألباب الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعها لا يفي به إفهام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة ونفى البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فان الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين ومعلوم قطعا أن هذا ليس مراد الرب تعالى مما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا ولا يكون المنزه به مثنيا ولا حامدا ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينكره الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة واثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة واثبات الحكم الباهرة في خلقه تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحا في العقل فان عنيتم أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع أمره ونهيه فهذا حق فانه جعله مختارا مأمورا منهيا وان كان اختياره مخلوقا له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن
هذا الاختيار لا ينافى التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكليف إلا به
الوجه السابع والأربعون قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيتهم وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران فكيف يهدي العقل إلى اختيار أحدهما عقلا فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب
فيقال لكم لم يتعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبحه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وانما يتعارض الجائزات على كل سواء بحيث لا يترجح بعضها عن بعض فأما الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استواؤهما وقد قررنا مما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الأنعام السائمة وحسن الأمر والنهى وأستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال أن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضى باستوائهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين * فان قيل إنما تعارضا في المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة * قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدورا أن لا يكون ممتنعا لمنافاته الحكمة وقد بينا ذلك قريبا فيكون تركهم هملا وسدى مقدورا للرب تعالى لا يقتضي معارضته لمقدوره الآخر في تكليفهم وأمرهم ونهيهم
الوجه الثامن والأربعون قولكم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشيئه معصيتهم قلنا ومن الذي نازع في هذا ولكن حسن التكليف لا ينفى ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغوا ضره فيضروه ولا يبلغوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملكه شيئا وههنا اختلفت الطرق بالناس في علة التكليف وحكمته مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فسلكت الجبرية مسلكها المعروف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لا علة له ولا باعث عليه سوى محض الإرادة وسلكت القدرية مسلكها المعروف وهل ذلك إلا استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنة والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانهما وفسادهما وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل ممن يرى أن الشرائع وضعت نواميس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم فان فائدتها تكميل قوة النفس والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز و جل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به
المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته ومن الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان أهلا أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسله ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وأفراده بالعبادة كما أن فيهما ما يقتضي المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فان الله فطر خليقته على محبته والأقبالعليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليهما منه وان فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا أن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ومنيبين نصب على الحال من المفعول أي فطرهم منيبين إليه والإنابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والأعراض عما سواه وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في مقامي هذا أنه قال كل مال نحلته عبدا فهو له حلال واني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفة المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذي خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله هلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره فكونه سبحانه أهلا أن يعبد ويحب ويحمد ويثني عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أن الغنى القادر الحي القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذي يستحق أن يوله محبة
وتعظيما وخشية وخضوعا وتذللا وعبادة فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقا إلا له حقا المحمود حقا ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم يألهوه فهو الله الذي لا اله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يغنيهم لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد بل الإلهية وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له لحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد وان لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولو لم يخلق جنة ولا نارا علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الأعراض عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسنا إلى حسنه فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعتهم إلى وليهم والههم وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريبا وشكا ولأمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم حي على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم وانما يحمد القوم السرى عند الصباح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة تعتريه
أنى أدين بدين الحب ويحكم ... فذاك ديني ولا إكراه في الدين
ومن يكن دينه كرها فليس له ... إلا العناء وألا السير في الطين
وما استوى سير عبد في محبته ... وسير خال من الأشواق في دين
فقل لغير أخي الأشواق ويحك قد ... غبنت حظك لا تغتر بالدون
نجائب الحب تعلوا بالمحب إلى ... أعلى المراتب من فوق السلاطين
وأطيب العيش في الدارين قد رغبت ... عنه التجار فباعت بيع مغبون
فان ترد علمه فاقرأه ويحك في ... آيات طه وفي آيات ياسين
ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا ومن هذا شأنه فان القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه وهذا الباعث اكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر
والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود الحق ومن هذا قول بعض السلف أنه ليستخرج حبه من قلبي ما لا يستخرجه قوله ومنه قول عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما قال بعضهم
هب البعث لم تأتنا رسله ... وجاحمة النار لم تضرم
أليس من الواجب المستحق ... طاعة رب الورى الأكرم
وقد قام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى تفطرت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا واقتصر صلى الله عليه و سلم من جوابهم على ما تدركه عقولهم وتناله إفهامهم وألا فمن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر أمر يجل عن الوصف ولا تناله العبادة ولا الأذهان فأين هذا الشهود من شهود طائفة القدرية والجبرية فليعرض العاقل اللبيب ذينك المشهدين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فالله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لأنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرتهم ولا إرادتهم ولا تتصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته ولا يوفيه حقه من المحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصى ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه و سلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل عليه صلوات الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته واجلاله وكانت المحبة نوعين محبة تنشأ عن الأنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كما لها ونقصانها ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين واما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبته فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية المعارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وانما تتعلق بمخلوقاته مما في الجنة من النعيم فهم لا يحبونه لذاته ولا لإحسانه وينكرون محبته لذلك وانما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل
وستذكر في القسم الثاني أن شاء الله في هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مائة وجه
ولو عرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلموا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وانما هو كالمكره أو كأجير السوء الذي أن أعطى عمل وان لم يعط كفر وأبق * وسيرد عليك بسط الكلام في هذا قريب عن أن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الأنعام والإحسان وفرق عظيم بين ما تعلق بالحي الذي لا يموت وبين ما تعلق بالمخلوق وان شمل النوعين اسم المحبة ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك
فصل والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية
والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أعنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ذكر هذا عقب قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني أني لست إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا فأنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقه فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبغلون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل في حقه * ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادي لو أن أو لكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والأمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغني الحميد ومن كان هكذا فانه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فانه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي
أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وان جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له والثاني متعلق بإحسانه وانعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وانه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد
في مرضاته فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين وانما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي حرمهم من العلم والأيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة والله الفتاح العليم
الوجه التاسع والأربعون قولكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا فان أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وقال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين وهذا في القرآن كثير يبين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الأعمال والأعمال ثمنا لها فانه لن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينافي ما تقدم من النصوص فأنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان والذي نفاه النبي صلى الله عليه و سلم في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه فالمثبت باء السببية والمنفي باء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفى باء السببية جملة وتنكر أن تكون الأعمال سببا في النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم والقدرية النفاة تثبت باء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة وأخطؤا في نفي السببية وأصاب المقدرية في إثبات السببية وأخطؤا في إثبات المعاوضة فإذا ضممت أحد نفي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فان أردتم بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنة
في هذا وهذا ونعمه بالثواب من غير استحقاق ولا ثمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المان بهدايته للأيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للأيمان أن كنتم صادقين
الوجه الخمسون قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما قلنا قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلا وانما يقدر التعارض بين العقل والهوى وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا
الوجه الحادي والخمسون قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب فيقال وأي استبعاد في ذلك وما الذي يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول وذوي الفطر التي لم تتواطأ على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبته وشكر نعمته ومحبته وعرفنا قبح الإشراك به والأعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبهت والاثم والبغي والعدوان فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور المستحسن في العقول التي جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبتقرير ما أدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه الطائفتان أعظم تباين فأثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضعوه شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج عنه وشهوة في ذلك كله بخلقه وبدعهم في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم فيه وبينوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه ومالا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهي أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فانه لا يخل به ولا يقع منه خلافه فهو أيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم
وسيأتي أن شاء الله بسط ذلك وتقريره
الوجه الثاني والخمسون قولكم أنه على أصول المعتزلة يستحيل الأمر والنهي والتكليف وتقديركم ذلك فكلام لا مطعن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وان حقيقة قول القوم أنه لا أمر
ولا نهي ولا شرع أصلا إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الآمر الناهي وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به فانه لا يعقل أصلا كونه آمر ولا ناهيا ولا باعثا للرسل ولا محبا للطاعة باغضا للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كماله فأنها تستلزم أبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه فقد الزمتكم القدرية ما لا محيد لكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهي فان الأمر والنهي لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر والنهي وفي ذلك أبطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المأمور به المنهي عنه ورفع المأمور والمنهي نفسه فان الأمر يستلزم آمر أو مأمورا به ولا يصح له حقيقة إلا بهذه الثلاث ومعلوم أن أمر الآمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل التكليف جملة فان التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع لارادته ومشيئته وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن في الآتيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيئته فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتوه وفي ذلك أبطال للشرائع والرسالة جملة قالوا فليتأمل المنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن تجد عنه محيدا قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيكم الفعل المأمور به فان كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيئته فأنتم أثبتم قدرا على الله وقدرا على العبد أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأمورا به منهيا عنه فأثبتم أمرا ولا مأمور به ونهيا ولا منهي عنه وهذه قدرية محضة في حق الرب وأما في حق العبد فأنكم جعلتموه مأمورا منهيا من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأي قدرية أبلغ من هذه فمن الذي تضمن قوله أبطال الشرائع وتعطيل الأوامر فليتنبه اللبيب لمواقعه هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة ثم ليختر منهما إحدى خطتين ولا والله ما فيهما حظ لمختار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهيه ووعده ووعيده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته
وارادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبري ولا جهمي ولا قدري وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومنتحلها والله الموفق للصواب
الوجه الثالث والخمسون قولكم أنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال أن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو كذب محض وكذلك أن أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأي معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في اهانتهما بلا جرم وأي معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيئته وكفران نعمه وأي معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الإماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها بل نحن لا ننكر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل يتعارضا فان أردتم هذا التعارض فمسلم ولكن لا يجدي عليكم إلا عكس مطلوبكم وكذلك أي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وانعامه وصفات جلاله ونعوت كماله وأفراده بالمحبة والعبادة والتعظيم وأي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة اللهفات والأخذ على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما أن أردتم أن في بعض ما يدق منها مسائل تتعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتحير العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وان كان واقعا فأنها لا تنفى حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفى المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطلب مع أنه حسي تجريبي يدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحس ومع هذا فأنتم ترون اختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد
هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فالاختلاف المذكور لا ينفى عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودفنها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم وجمهور قواعده ومسائله دعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحير العقل ولو ادعى هذا مدع لضحك منه العقلاء مما علموه بالضرورة والحس من ملاءمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذوات للمنافع والمضار في الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب إنكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع
الوجه الرابع والخمسون أن قولكم إذا قتل إنسان انسانا عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره فيقال أن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فبهت للعقل وكذب عليه فانه لا يستوي عند عاقل قط حسن الاختصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والأعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوى بين الأمرين وكيف يستوي أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البغي والعدوان
والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبغاة والمعتدين فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله ومن وجه آخر وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشتد مؤنته فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره فتضمن القصاص الحياة في الوجهين وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى
العظيم فصدر الآية بقوله لكم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصاص إيذانا بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص في اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الاتباع ومنه قوله تعالى وقالت لأخته قصيه أي اتبعي أثره ومنه قوله فارتدا على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصا لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونكر سبحانه الحياة تعظيما وتفخيما لشأنها وليس المراد حياة ما بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتنكير كثيرا ما يجيء للتعظيم والتفخيم كقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقوله ورضوان من الله أكبر وقوله أن هو إلا وحي يوحى ثم خص أولى الألباب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أنفى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته
الوجه الخامس والخمسون قولكم أن القصاص اتلاف بأزاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانا فانه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونفى حسن القصاص الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلما وعدوانا بغير حق والقتل قصاصا وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعى ذلك في غاية المكابرة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الارض على أنهما سواء في الحقيقة حق يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفى في فساد هذا أطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها فما تعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره ويختاره وقولكم أنه
إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه وخراب للعالم فأنى يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الاول بقتل الثاني قلنا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فإن لم يكن في قتل الثاني حياة للأول ففيه حياة العالم كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لكن هذا المعنى لا يدركه حق الأدراك إلا الوا الالباب فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان الفاسد وأن يقال قتل الجاني إتلاف بإزاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عبادة منوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين فيقال لو اعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراحجة وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسده إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة فمن تحير عقله بين هذين المفسدتين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل كقطع الاصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الايلام لدفع إيلام أعظم منه كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفساد وقالوا هذا إيلام محقق لدفع إيلام متوهم لفسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد
الوجه السادس والخمسون قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساده بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الاخذ على ايديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهمه العدو فقال لا نعرض أنفسنا لمشقة قتالهم فإنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلنا فموهوم
فيا ليت شعري من الواهم المخطيء في وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيغ به الدم وتضرر إلى اخراجه لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم محقق لا موهوم ولو اطرد هذا القياس الفاسد لخرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبني على هذا الذي سميتموه أنتم موهوما فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي اطردت به العادة وإن لم يجزموا به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغنم فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب مر موهوم لتعطلت أسفار الناس بالكلية وكذلك عمال الآخرة لو قالوا تعب العمل ومشقة
أمر محقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعطلوا الأعمال جملة وكذلك الاجراء والصناع والملوك والجند وكل طالب امر من الامور الدنيوية والأخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر ومن هاهنا قيل أن إنكار هذه المسئلة يسلتزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة
الوجه السابع والخمسون قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل في انواعه وشروط أخرى وراء مجرد الانسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والاجنبية فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يطرد عليه امر الامة ويستقيم عليه مصالحهم
فيقال لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين اشرعه فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه ان الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدي العقل إليها وأي شيء يلزم من هذا وماذا يقبح لكم ومنازعكم يسلمونه لكم وقولكم ان هذا معارض للوصف المقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما إصلاح طار سيم فيه مالا يهتدي العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة فيالله العجب أي معارضة ها هنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شروط آخر غيره أم يكفي بمجرد وفي تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة يوضح هذا
الوجه الثامن والخمسون أن ما وردت به الشريعة في اصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يستريب فيه عاقل وهو اصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدي إليه إلا الخواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له فاشترط له المكافأة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذي فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته واهله لجواره في جنته والنطر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كدم عدوه وامقت خلقه عليه وشر بريته والعادل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار وللطرود عن بابه والإبعاد عن رحمته وبالجملة فحاشا حكمته أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر
البرية في أخذ هذه بهذه سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم وانما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لاباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأي موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه و سلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم أو قال المؤمنون فعلق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون أبطالا لما اعتبره الشارع واعتبارا لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الأيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعا منصرما وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وليه ولا يكافيه أبدا وجاء الشرع بموجبه فأي معارضة هاهنا وأي حيرة أن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وانما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها
فصل وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم وجهل ولا في كمال
وقبح ولا في شرف وضعة ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقرابة خلا الوالد والولد وهذا من كمال الحكمة وتمام النعمة وهو في غاية المصلحة إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطلت مصلحة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يستوي شخصان من كل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتص إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم الهرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتك الشرائع إلى اعتبار ذلك وأما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فان الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله وجعلوا له من عباده جزأ وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحده أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الأمام أحمد وغيره إلى أن له أن يتملك ما شاء من مال ولده وهو كالمباح في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وبينا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في أيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه وفي المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جدا وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيرا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه واهلاكه بل لا يقصد في الغلب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد وإذا وقع ذلك غلطا الحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء وان وجدت نادرا فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليقة وهنا للناس طريقان
أحدهما أنا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلا أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة والثاني أنه لا يجرى القصاص بحال وأن تحقق قصد القتل لمكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لوالده وان كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الابن فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكما بخلاف الولد فانه جزء حقيقة وليس هذا موضوع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتمالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وان لم يستقل بها فجاءت الشريعة بها مقررة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال أن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفى الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواته والله أعلم
الوجه الثامن والخمسون قولكم وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملا عليها كلام في غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والأنصاف وتصوره حق التصور كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذبه فان أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتمال الأفعال عليها ومدعي ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدي عليه إلا توهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعلمها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة
السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أنا يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم واهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعي ذلك مصاب في عقله فان المعاني التي اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعا ذهنية والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لا حقيقة لها إنما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معاني الشريعة الكلية على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أمورا حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعا ذهنية لا حقيقة لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه
الوجه الثاني أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من باب الخيالات والتقديرات التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لا حقيقة له
الوجه الثالث أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فانه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعاني وإنها منشأها وليس كذلك كان اعتقادا للشيء بخلاف ما هو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعي هذا في اشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمنا لمصالح العباد في المعاش والمعاد وهل هو الا لب الشريعة ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرمى بهذا البهتان
وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكلف رده ولم يقل هذا القول من شم للفقه رائحة أصلا الوجه التاسع والخمسون قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون
الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مشتملا على صفتين مختلفتين تقتضي كل منهما أثرا غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به وتكون مصلحته أرجح فإذا رتب على صفته الأخرى أثرها فاتت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعا وعقلا بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حسا في قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك في الشريعة تزيد على الألف فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار في عبادة الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن المشابهة للكفار حتى في وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث لما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة فان في فعلها في غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها فلا تفوت مصلحتها فيقع فعلها في وقت النهي مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي لترجح مصلحتها فأنها لا تقضى ولا يمكن تداركها وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة فما الذي يحيل اشتمال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقضى للراجح عقلا وشرعا وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولو لا إلاطالة لكتبنا منها ما يبلغ ألف مثال والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية
الوجه الستون قولكم وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبنى عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يكفى في بطلان هذا الكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظا ومعنى فان الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه ومنه قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول والى أولى المر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم أي يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف
ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما ما لا حقيقة له فانه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأي شيء يستنبط منه وانما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا أن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وانما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغه وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعا فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فان كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذي يعرضه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التي تربط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لا نسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن وهذا من أبطل الباطل وأبين المحال ولقد أنصفكم خصومكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقال لم كان كذا أذلا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها لا سيما والتعلق أمر عدمي ولا معتنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعا ولا عقلا لا سيما إذا انضم إلى ذلك نفى فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجبوب محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا إلزامهم لكم كما أنكم الزمتموهم نظير ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموهم في الإلزام الوجه الحادي والستون قولكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا واللازم محال فالملزوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الإيجاب والتحريم غائبا والثاني في انتفاء اللازم وثبوته فأما المقام الأول فلمثبتي الحسن والقبح طريقان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذي نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثاني إثبات الحسن والقبح فانهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفي
أيجاب العقل على الله شيئا البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبي الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الأمام المشهور وغيره ولهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي من المعرفة بالله وثبوته خلاف فالأقوال إذا أربعة لا مزيد عليها
أحدها نفي الحسن والقبح ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات كالمعرفة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين فهذا أحد المقامين
وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاثة طرق
أحدهما التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا و بترتب المدح والذم عليه وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبته منهم لم يثبته على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وحرمته وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله له وغناه قالوا وهذا في الأفعال نظير ما يقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصافت ما يجب له منها وما يمتنع كليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وان كان مقدورا له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء ممكن وردت الإحالة والامتناع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخير فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق العلم لمعلومه والمخبر لخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه فانهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فان الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وحمده وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى
أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم يجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادي أنى حرمت الظلم على نفسي وقال ولا يظلم ربك أحدا وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلمون فتيلا وقال وما الله يريد ظلما للعباد فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وارادته وللناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وارادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه في الأفعال ما يحسن منهما وما لا يحسن بعباده فضر بواله من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به
قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا أنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عنه أيضا أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كان ظالما وقالوا عنه أيضا أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخر كان ظالما إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وانما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك وألا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله أن تعذبهم فانهم عبادك يعني لم تتصرف في غير ملكك بل أن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا ولم
يروا ذلك ظلما بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وبقول النبي صلى الله عليه و سلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم وبقوله صلى الله عليه و سلم في دعاء الهم والحزن اللهم أنى عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن اياس بن معاوية قال ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل شيء والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم أن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب اليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته وكلاهما عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار ممتنعا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حكمته ولا فرق بين المرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لارادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكون والتزموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخلدهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وارادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازي بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فمما يتنزه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلما وعن نفي خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظلما ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضي الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحتمل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فان صاحبها يجزي بها
ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله وانما توفون أجوركم يوم القيامة وقوله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فترك الظلم هو العدل لافعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى أن الله لا يظلم مثقال ذرة أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل على أن اضاعتها وترك المجازاة بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته ولا تحتمل الآية قط غير معناها المفهوم منها وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أي لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظير قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأخبر انه ليس على أحد في وزر غيره شيء
وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه وقال الذي آمن يا قوم أنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذي لا يمكن ولا يكون مقدورا أصلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمد على ذلك وانما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله أنى حرمت الظلم على نفسي وما شاكله من النصوص فاما أن يكون المعنى أنى حرمت على نفسي ما لا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلى ومثل جعل القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك من المحالات ويكون المعنى أنى أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون منى فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مرادا في اللفظ قطعا وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حملة على مثل ذلك قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه أن عذبهم فانهم عباده وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءه فيهم عدل بمناظرة اياس للقدرية فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها والكل من عند الله ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة فالنصوص التي ذكرناها تقتضي كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما وأنه لا يعدل بهما عن سننهما والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه آمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال وأنه
لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمنا لها فإنها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم أي فجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالما لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصلوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولا من شفتيه فانه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فما نجا منهم أحدا إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادرا عليهم وهم ملكه بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم
وأما قوله فانهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأي مدح في هذا ولو قلت لشخص أن عذبت فلانا فانك قادر على ذلك أي مدح يكون في ذلك بل في ضمن ذلك الأخبار بغاية العدل وأنه تعالى أن عذبهم فانهم عباده الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوه بل ابتدأهم بنعمه وفضله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فان من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم
وفيه أيضا أمر آخر ألطف من هذا وهو أن كونهم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه واجلاله كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرا إلا هو فإذا كفروا به أقبح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله وهو أن تعذبهم فانهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وألا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قوله من يقول أن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم