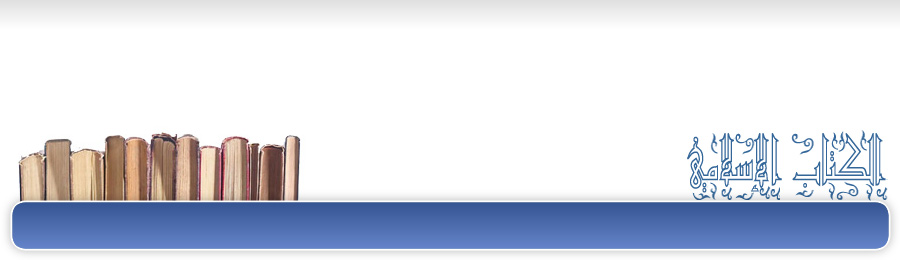الكتاب : بداية المجتهد و نهاية المقتصد
المؤلف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال وهو الذي عليه الجمهور. وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروي أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري وقالوا: يؤذن يوم الجمعة مؤذنان. وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معنى قوله: فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما فيما انفرد به. وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة. فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة واختلفوا في مقدار الجماعة فمنهم من قال: واحد مع الإمام وهو الطبري. ومنهم من قال اثنان سوى الإمام. ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم ثلاثين. ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين
ولا يجوز بالثلاثة والأربعة وهو مذهب مالك وحدهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحد ثان وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الإمام ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة سوى الإمام وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم. وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حدا ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله. وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة: أعني شروط الوجوب وشروط الصحة فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ومنها ما يجمع الأمرين جميعا: أعني أنها شروط وجوب وشروط صحة. وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر عدا في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر. واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا ولم يشترط العدد. وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسلم إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطها ومن رأى بعضها دون بعض
اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان ومن هذا الموضوع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة إذ كان معلوما من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في الصلاة ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر. ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ولقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} والله المرشد للصواب.
الفصل الثالث في الأركان
اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب.
المسألة الأولى : في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن. وقال أقوام: إنها ليست بفرض وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون. فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا؟
لكونها راتبة من سائر الخطب وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وقالوا هو الخطبة.
المسألة الثانية : واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن القاسم: هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله. وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم: أعني الأقوال الراتبة الغير المتبدلة. والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي: أعني اسم خطبة عند العرب. ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس وهو شرط كما قلنا عند الشافعي وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا.
المسألة الثالثة : اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: منهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة وهم الجمهور و مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن فقهاء الأمصار وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت وبعضهم فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت والقول الثاني مقابل القول الأول وهو أن
الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها فإن سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم وبه قال أحمد وعطاء وجماعة والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت" وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات وهذا فيه ضعف والله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام فمن استثنى الزمن الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول, ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت
الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة وهذا يقل وجوده وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربع: عمومان في مرتبة واحدة من القوة وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد أعني أن يستثنى من العموم الخصوص الثالث خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين أضعف من الثاني فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم.
المسألة الرابعة : اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر: هل يركع أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه وهو مذهب مالك وذهب بعضهم إلى أنه يركع. والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين" يوجب الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين" خرجه مسلم وفي بعض رواياته وأكثر رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل ولم يقل إذا جاء أحدكم الحديث. فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها فإنها نص في موضوع الخلاف
والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل.
المسألة الخامسة : أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا. والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة. وقال القاضي: خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما.
الفصل الرابع في أحكام الجمعة
وفي هذا الباب أربع مسائل. الأولى: في حكم طهر الجمعة. الثانية: على من تجب ممن خارج المصر. الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة. الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء.
المسألة الأولى : اختلفوا في طهر الجمعة فذهب الجمهور إلى أنه سنة وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة, والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة" وفيه حديث عائشة قالت: كان الناس
عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لو اغتسلتم؟ والأول صحيح باتفاق والثاني خرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة وقد روي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف. المسألة الثانية: وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر فإن قوما قالوا: لا تجب على من خارج المصر وقوم قالوا: بل تجب وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذ ومنهم من قال يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء وهذان القولان عن مالك وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ثلاثة أميال من المدينة. وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "الجمعة على من سمع النداء" وروي الجمعة على من آواه الليل إلى أهله وهو أثر ضعيف.
المسألة الثالثة : وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة.
المسألة الرابعة : وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فإن قوما قالوا: يفسخ البيع إذا وقع النداء,
وقوم قالوا لا يفسخ. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟. وآداب الجمعة ثلاثة الطيب والسواك واللباس الحسن ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك.
الباب الرابع: في صلاة السفر
الفصل الأول: في القصر
الباب الرابع في صلاة السفروهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في القصر. الفصل الثاني في الجمع.
الفصل الأول في القصر
والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف. أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ وهو قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفا واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع: أحدها في حكم القصر. والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. ومنهم من رأى أن القصر سنة. ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم: أعني أنه فرض متعين وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث أعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه وهو المنصور عند أصحابه. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر: إنما قال
الله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} يريد في قصر الصلاة في السفر فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" فمفهوم هذا الرخصة. وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" وهما في الصحيح, وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين: أعني إما واجبا مخيرا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون فرضا معينا لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم وروى عطاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول. أما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة
وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق. وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقالوا: قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا وذهب قوم إلى خامس كما قلنا وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقد قيل إنه مذهب عائشة وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك وذلك أن مذهب الأربعة برد روي عن ابن عمر وابن عباس ورواه مالك ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما. وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد وممن قال بهذا القول أحمد. ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية وبهذا القول قال مالك والشافعي. ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ والأصل فيه: هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى فاختلف الناس فيها لذلك. وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة فإن مالكا قال في الموطأ:
لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه وبالقول الأول قال الجمهور. والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل: أعني فعله عليه الصلاة والسلام قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلى ركعتين وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم. والثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم. والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا أو أنه جعل لها حكم المسافر. فالفريق الأول احتجوا بمذهبهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير. وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها. والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات وقد روي سبعة عشر يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق. والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام: أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا وإن أقام ما شاء الله. ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة فقالت المالكية مثلا إن الخمسة عشر يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار وهذا بناء على أن اسم السفر وعشرون عليه حتى يقدم مصرا من الأمصار فهذه العالمين المسائل التي تتعلق بالقصر.
الفصل الثاني في الجمع
وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل: إحداها جوازه. والثانية في صفة الجمع. والثالثة في مبيحات الجمع.
المسألة الأولى : أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين,
فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالا والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها وثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة أسباب كما ترى. أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر: أعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. أما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة يوما,
ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك بل لفظ الراوي محتمل. وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في عرفة والمزدلفة أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك فيقال مثلا: صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة وهو مذهب سالم بن عبد الله: أعني جواز هذا القياس لكن القياس في العبادات يضعف فهذه الخلاف الواقع في جواز الجمع.
وأما المسألة الثانية : وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع أعني في السفر. فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز وهي إحدى الروايتين عن مالك ومنهم من سوى بين الأمرين: أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالك والأولى رواية ابن القاسم عنه وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت من حديث أنس ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة: أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذ كان رواة الحديثين عدولا وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل.
وأما المسألة الثالثة : وهي الأسباب المبيحة للجمع فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي وهي إحدى الروايتين عن مالك ومن ذهب هذا المذهب
فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير الحديث. ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع. فمنهم من قال: هو سفر القربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم. ومنهم من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك. والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وإن كان هنالك التعميم لأن القصر نقل قولا وفعلا والجمع إنما نقل فعلا فقط فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. وأما الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك. ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا. وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "في غير خوف ولا سفر ولا مطر" وبهذا تمسك أهل الظاهر. وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل لأنه روى الحديث وتأوله: أعني خصص عمومه من جهة القياس وذلك أنه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر أرى ذلك كان في مطر قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله. أعني تخصيصه بل رد بعضه وتأول بعضه وذلك شيء لا يجوز بإجماع وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله وأحسب أن مالكا رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم
لكن النظر في هذا الأصل لذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوعها منسوخة ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة الظن وإن خالفته أفادت به ضعف الظن فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختلال وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعي. والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر: أعني المشقة فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة: أي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك.
الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف
اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا} الآية ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا وتحرس التي قد صلت. والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن رآها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} الآية ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه منسوخ بها. وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار في هذا الباب: أعني المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف والمشهور من ذلك سبع صفات فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معهوصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة من صلاتهم ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وبهذا الحديث قال الشافعي وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة واختار مالك هذه الصفة فالشافعي آثر المسند على الموقوف ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول: أعني أن لا يجلس1 الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه. والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رواه الثوري وجماعة وخرجه أبو داود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلو العدو فصلى بالذين معه ركعة وسجد سجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم. والصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد وصف بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرسونهم فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد
ـــــــ
1 قوله يجلس لعله يسلم كما يظهر من سابقه ا هـ مصححة.
الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا بهم جميعا فسلم بهم جميعا وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود: وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي موسى وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وخرجها مسلم عن جابر وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه أنه قال الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة واحدة وأجاز هذه الصفة الثوري. والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين وبه كان يفتي الحسن وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه متما وهم مقصرون, خرجه مسلم عن جابر. والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم الحجة
في النقل على من خالفهم وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وإيماء من غير ركوع ولا سجود. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا يصلي أحد في حال المسايفة. وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول وقد رأى قوم أن كلها جائزة وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب وقد قيل: إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن.
الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض
وأجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم جالسا وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما. واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا: هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا وقوم قالوا هو عليه القيام من المرض وهو مذهب مالك. وسبب اختلافهم هو: هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص. وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا: يجلس متربعا: أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام وكره ابن مسعود الجلوس متربعا فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة. وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له وقوم قالوا: يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة وقوم قالوا: إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته وهو الذي اختاره ابن المنذر.
الجملة الرابعة: أفعال الصلاة
مدخل
الجملة الرابعة:وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست
أداء وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود ففي هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب. الباب الأول: في الإعادة. الباب الثاني: في القضاء. الباب الثالث: في الجبران الذي يكون بالسجود.
الباب الأول في الإعادة
وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة وهي مفسدات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا.
وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة.
وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم يبنى على ما قد مضى من الصلاة فذهب الجمهور إلى أنه لا يبنى لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الأحداث كلها. وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره وهو مذهب مالك ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف.
المسألة الثانية : اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء وأنه ليس عليه إعادة وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: "فليقاتله فإنما هو شيطان" .
المسألة الثالثة : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع. وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما.
المسألة الرابعة : اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به.
المسألة الخامسة : اختلفوا في صلاة الحاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن لما روي من حديث زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه
قال: "لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد. وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة, وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون منهم من يجعله عن ثوبان ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا" قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه.
المسألة السادسة : اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعمان وأجاز قوم الرد في نفسه وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب في اختلافهم: هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال: لا يجوز الرد في الصلاة ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة. قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لا يرد ولا يصير فقد خالف السنة فإنه قد أخبر حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة.
الباب الثاني في القضاء
والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم واختلفوا في العامد والمغمى عليه وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله: وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاث" فذكر النائم وقوله: "إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد على الناسي والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناسي, والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر محدد على ما قال المتكلمون لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه والله الموفق للحق. وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته وقوم أوجبوا عليه
القضاء. ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا: يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. وأما صفة القضاء فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقوم قالوا: إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم قالوا: إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي. وقال قوم: إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض: أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحال في الأخرى أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة.
وأما شروط القضاء ووقته: فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات: أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس الصلوات فما دونها وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه وبمثل
ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي لا يجب الترتيب وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام" وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها فإذا فرغ منها قضى التي نسي" والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها" الحديث. وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الوقوف في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء: وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: "فليصلها إذا ذكرها" قالوا: فوقت المنسية هو وقت الذكر ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت وهذا لا معنى له لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة وإذا كان الوقت واحدا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس
إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذ كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا فافهم هذا فإن فيه غموضا. وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ولا معنى لهذا فإن هذا منسوخ وأيضا فإنه كان تركا لعذر وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه إلا أن يقال: إنه إجماع فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم: أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثا قواعد: إحداها متى تفوت الركعة. والثانية هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء. والثالث متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك. أما متى تفوته الركعة فإن في ذلك مسألتين: إحداهما إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع والثانية إذا كان مع الإمام في الصلاة فسها أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره.
أما المسألة الأولى : فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا: هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح وهو مذهب مالك والشافعي والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم: لا بد من تكبيرتين وقال قوم تجزي واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة وأنه لا يدركها ما لم يدركه
قائما وهو منسوب إلى أبي هريرة. والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي. وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط أو على الانحناء والوقوف معا وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: "من أدرك ركعة" على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال: لا بد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال أعني: القيام والانحناء والسجود ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة أعني قوله عليه الصلاة والسلام: "من أدرك ركعة من الصلاة" وما عليه الجمهور أظهر. وأما اختلافهم في: هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع. فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أعني بفعله عليه الصلاة والسلام وكان يرى أن التكبير كله فرض قال: لا بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من
شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "وتحريمها التكبير" وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي بها وحدها. وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام فقيل يبنى على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض وقيل إنما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان: النية المقارنة والأولية: أعني وقوعها في أول الصلاة فمن اشترط الوصفين قال: لا بد من النية المقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة ولم تقارنها النية.
وأما المسألة الثانية : وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام فإن قوما قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها فنقول: إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؟ أعني القيام والانحناء والسجود أم إنما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافا عليه: أعني أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة: أعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام وإلا كان اختلافا عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام: "فلا تختلفوا عليه" قال: متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزأ يسيرا لم يعتد بالركعة ومن اعتبره في بعضها
قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية وليس ذلك اختلافا عليه فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في حكم الثانية وذلك غاية الاختلاف عليه.
وأما المسألة الثانية : من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي: هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب قوم قالوا: إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء وإن ما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ويبني في الأفعال يعنون الأداء فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول: أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة أن يجلس بينهما وعلى المذهب الثاني: أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب والصحيح عن مالك أنه يقضى في الأقوال ويبنى في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفي بعض فاقضوا والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته فمن ذهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك هو أول صلاته ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو آخر صلاته ومن ذهب
مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف: أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذا ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال: ما أدرك فهو آخر صلاته.
وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول : وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الإتباع؟ فإن فيها مسائل: إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة. والثانية: متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو: أعني أخذها الإمام. والثالثة: متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها.
فأما المسألة الأولى : فإن قوما قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية وهو مذهب مالك والشافعي فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا. وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك وهو مذهب أبي حنيفة وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "وما فاتكم فأتموا" أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام: "فقد أدرك الصلاة" أي فقد أدرك حكم الصلاة وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما وكان الآخر بالعموم أولى وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر
معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام: "فقد أدرك الصلاة" أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا.
وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود: أعني في سجود السهو فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة: أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة وقوم لم يعتبروا في ذلك فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "فقد أدرك الصلاة" ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له. وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى: أعني فريضة وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به وفيه مسائل اختلفوا فيها بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة فإن قوما قالوا: يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها وهو قول مالك. وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته, وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا: يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين وهو مذهب الشافعي. وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياسا على قضاء ما الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة: أعني السجود وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود والسجود مكرر فزعم أصحاب أبي حنيفة
أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها وقيل يعيد الصلاة وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول.
الباب الثالث: من الجملة الرابعة في سجود السهو
مدخل
الباب الثالث: من الجملة الرابعة في سجود السهو
والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد. وإما عند الشك في أفعال الصلاة فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: الفصل الأول: في معرفة حكم السجود. الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها. الرابع: في صفة سجود السهو. الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السهو. السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه.الفصل الأول: في سجود السهو
الفصل الأولاختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة فذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب. والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب إذا كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس وذلك أنه لما كان
الفصل الثاني: في مواضع سجود السهو
الفصل الثانياختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام وإن كان لزيادة كان بعد السلام. وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وغير ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان ابنة فليس عليه شيء والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو: أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح. والثاني مذهب الجمع. والثالث مذهب الجمع والترجيح. فمن
رجح حديث ابن بحينة قال: السجود قبل السلام واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان" قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال: السجود بعد السلام واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام قال أبو عمر: ليس مثله في النقل فيعارض به واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا تتناقض وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة والسجود قبل السلام في النقصان فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض وألحق به المسكوت عنه فذلك
ضرب من الترجيح أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده. وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس: أعني لأصحاب القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدها أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة. والثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين. والثالث أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري. والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين. والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي بعد. واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان وهو الأشهر وقيل للسهو نفسه وبه قال أهل الظاهر والشافعي.
الفصل الثالث: أقوال والأفعال سجود السهو
الفصل الثالثوأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. فالرغائب لا شيء عندهم فيها: أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب من أكثر من واحدة. وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة
وما يوجب القضاء أعني على من ترك بعض أركان الصلاة1 وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة وفيما هو منها سنة أو رغيبة مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر: أعني في تأكيد الأمر بها وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب: أعني في تعلق الإثم بها وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس. ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن. وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة: أعني للسهو عنها ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: "أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق" وذلك بعد أن قال له: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه: يعني الفرائض وقد تقدم هذا الحديث. واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها
ـــــــ
1 هكذا هذه العبارة بالأصول, وفيها من الغموض ما لا يخفى تأمل ا هـ.
هل هي فرض أو سنة وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع فمتى يرجع؟ قال الجمهور: يرجع ما لم يستو قائما وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة. وقال قوم: لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر وإذا رجع عند الذين رجوعه فالجمهور على أن صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل صلاته.
الفصل الرابع: صفة سجود السهو
الفصل الرابعوأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط وأن السلام من الصلاة هو سلام منها وبه قال الشافعي إذ كان السجود كله عنده قبل السلام وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة. قال أبو عمر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود أعني من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال: فقالت طائفة: لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم: مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما. وقال قوم: فيها تشهد فقط بدون تسليم وبه قال الحكم وحماد والنخعي. وقال قوم: مقابل هذا وهو أن فيها تسليما وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم وفي ثبوت تشهده فيها نظر.
الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام
الفصل الخامساتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه. واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود أخذها فقال قوم: يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه وسواء أكان سجوده قبل السلام أم بعده وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال قوم: يقضي ثم يسجد وبه قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم: إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم: يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو باع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت سجود الإمام؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا قال: يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع السجود ومن آثر موضع السجود قال: يؤخرها إلى آخر الصلاة ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف.
الفصل السادس: السنة لمن سها في صلاته
الفصل السادسواتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه,
وإنما التصفيق للنساء" واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي وجماعة: للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنما التصفيق للنساء" فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ولذلك يضعف القياس.
وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على ثلاثة مذاهب فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهو وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر وإنما عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب. وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار: أحدها حديث بالبناء على اليقين وهو حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع ينفذ ترغيما للشيطان" خرجه مسلم. والثاني حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين" وفي رواية أخرى عنه "فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم" والثالث
حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم" الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح ومنهم من جمع الأمرين أعني جمع بعضها ورجح بعضها وأول غير المرجح إلى معنى المرجح ومن من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه وذلك من باب الجمع وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة فإنه قال: إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة والزيادة يجب قبولها والأخذ بها وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع. وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود ولذلك كان أضعف الأقوال فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضة فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية وهي الصلوات التي ليست فروض عين.
كتاب الصلاة الثاني
مدخل
كتاب الصلاة الثاني
ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة ومنها ما هي العربي ومنها ما هي فرض على الكفاية وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات وهي بالجملة عشر: ركعتا الفجر والوتر والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن فإنه صلاة فيشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز.الباب الأول القول في الوتر
واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمه ومنها في صفته ومنها في وقته ومنها في القنوت فيه ومنها في صلاته على الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. وأما صفته فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. وقال الشافعي: الوتر ركعة واحدة. ولكل قول من هذه الأقوال سلف من الصحابة والتابعين. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة" وخرج مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: "الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر
بواحدة فليفعل" وخرج أبو داود أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس وخرج عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة وحديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "المغرب وتر صلاة النهار" فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح. فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" وإلى حديث عائشة أنه كان يوتر بواحدة ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: "المغرب وتر صلاة النهار" فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا. وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوتر وأن أقل ذلك ركعتان فالوتر عنده على الحقيقة إما إن يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء وأي شيء يوتر له؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توتر له ما قد صلى" فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو عدد الوتر بنفسه: أعني الغير مركب من الشفع والوتر ذلك أن هذا هو وتر لغيره وهذا التأويل عليه أولى. والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على
ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه فيشبه أن يقال ذلك من شرطه لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا وأيضا فإنه خرج من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع وأن الوتر ينطلق على الثلاث ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى و قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وعن عائشة مثله وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: "الوتر قبل الصبح" واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي في هذا خرجه أبو داود وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ولا خلاف بين أهل
الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية وأن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها مثل قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وقوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعباده بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل: أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة. وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة ونصف خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا الآثار الواردة في ذلك أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ أعني غير أمر الأداء وهذا التأويل بهم أليق فإن أكثر ما الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول أعني أنه كان يقول: إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال: منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما. والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح وهو قول طاووس. والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس وبه قال أبو ثور والأوزاعي. والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير.
وهذا الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواجب أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا وروي عنه القنوت شهرا وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة وأنه نهى عن ذلك وقد تقدمت هذه المسألة. وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أعني أنه كان يوتر على الراحلة: وهو ما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذ كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الراحلة ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة. وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ألا تصلى على الراحلة وردوا الخبر بالقياس وذلك ضعيف. وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وتران في ليلة" خرج ذلك أبو داود وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. وتجويز هذا ولا تجويزه
هو سبب الخلاف في ذلك فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية ومن راعى منه المعنى الشرعي قال: ليس ينقلب شفعا لأن الشفع العربي والوتر سنة مؤكدة أو واجبة.
الباب الثاني في ركعتي الفجر
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها في المستحب من القراءة فيهما فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت: حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيهما ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} قال يقرأ فيهما ما أحب. والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما
جهرا ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة ومن ذهب مذهب ي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام وقال الشافعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟" قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي يفوت
فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" أي قد أدرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. و مالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن المنذر: هو أثر ثابت: أعني قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود. والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وابن جريج وقال قوم: يقضيها بعد طلوع الشمس ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع ومنهم من جعله لها متسعا فقال: يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء ومنهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه. والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة.
الباب الثالث في النوافل
واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينها بسلام, وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى, وصلاة النهار أربع. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا
الباب وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت: وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: "يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: "من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعا" وروى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه الأحاديث لصاحب التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة وأحسب أن فيه خلافا شاذا.
الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد
والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين" محمول على الندب أو على الوجوب فإن الحديث متفق على صحته فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب: قال الركعتان واجبتان ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل
على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال: الركعتان غير واجبتين لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي غيره وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته عند دخول المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع وهي رواية أشهب عن مالك وقال أبو حنيفة: وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين" وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح" فههنا هنا عمومان وخصوصان: أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك وقد قلنا: إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر.
الباب الخامس في قيام رمضان
وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
من ذنبه" وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس ورغب فيها وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو الصلاة آخر الليل؟ أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة" ولقول عمر فيها: ملكا تنامون عنها أفضل واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في أحد قوليه و أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث. وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود ابن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم: يعني القيام بست وثلاثين ركعة.
الباب السادس في صلاة الكسوف
اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها وهل من شروطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف القمر ككسوف الشمس؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب.
المسألة الأولى : ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع,
ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس أعني من ركوعين في ركعة. قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب فمن أخذ بهذين قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة. وورد أيضا من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد. قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس: أعني موافقتها لسائر الصلوات قال: صلاة الكسوف ركعتان: قال القاضي: خرج مسلم حديث سمرة. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير وممن قال بذلك الطبري قال القاضي: وهو الأولى فإن الجمع أولى من الترجيح. قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين وثمان ركعات في ركعتين وست ركعات في ركعتين وأربع ركعات في ركعتين لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر بن المنذر وقال إسحاق بن راهويه: كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية ثم نظر إلى الشمس فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي. وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة لأنه
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول: الاختيار في صلاة الكسوف عين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة ولم يصح عنده ذلك. قال: وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي: هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة. وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط.
المسألة الثانية : واختلفوا في القراءة فيها فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق بن راهويه: يجهر بالقراءة فيها. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام: فقام قياما نحوا من سورة البقرة وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة فمن رجح هذه الأحاديث قال: القراءة فيها سر ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة وفي كل واحدة أم القرآن ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "صلاة النهار عجماء" ووردت هاهنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه فمنها أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم مفهوم هذا أنه جهر وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس قال أبو عمر: سفيان بن الحسن ليس بالقوي. وقال: وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير وكلهم ليس في حديث الزهري مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا: صلاة سنة
تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء وخير في ذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين.
المسألة الثالثة : واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه فقال الشافعي: تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي. وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد.
المسألة الرابعة : واختلفوا أيضا هل من شروطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. والسبب في اختلافهم اختلاف العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته" الحديث فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام.
المسألة الخامسة : واختلفوا في كسوف القمر فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس وبه قال أحمد وداود
وجماعة وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة واستحبوا أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا" خرجه البخاري ومسلم. فمن فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة. ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه. قال المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع وهي النافلة فذا وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية وهو من أقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التي نص عليها لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف.
الباب السابع في صلاة الاستسقاء
أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى
الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من سنة الصلاة. وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين الرجعة فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى خرجه البخاري ومسلم. وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة فمنها حديث أنس ابن مالك خرجه مسلم أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني وفيه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل والحجة للجمهور أنه من لم يذكر شيئا فليس هو بحجة على من ذكره والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر لا أنها ليست من سننه كما ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بأن الصلاة من سننه على أن الخطبة أيضا من سننه لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ لاختلاف الآثار في ذلك فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين وبه قال الشافعي ومالك. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر
في العيدين. وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين. وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلى في العيدين واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل ذلك. فأما كيفية ذلك؟ فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه أسفله وما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه جاء في حديث عبد الله ابن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين وفي بعض رواياته قلت: أجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال أم أجعل أعلاه أسفله؟ أنه قال: بل اجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه وأما متى يفعل الإمام ذلك فإن مالكا والشافعي قالا: يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة وروي ذلك أيضا عن مالك وكلهم يقول: إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم فإنه قال: إن الخروج إليها عند الزوال. وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس.
الباب الثامن في صلاة العيدين
أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة
لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل قاله أبو عمر. وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحب الشافعي القراءة فيهما بـ ق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من اثني عشر قولا إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع فنقول: ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. وقال الشافعي: في الأولى ثمانية1 وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم: فيها تسع في كل ركعة وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس ابن مالك وسعيد بن المسيب وبه قال النخعي. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة لأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره إلى أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل وقد
ـــــــ
1 أي ومنها تكبيرة الإحرام ا هـ مصححة.
خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص. وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا على الجنائز فقال حذيفة: صدق فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم وقال قوم بهذا. وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذلك. وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ومنهم من خير واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد: أعني وجوب السنة فقالت طائفة يصليها الحاضر والمسافر وبه قال الشافعي والحسن البصري وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام. واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور,
وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر ابن المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم قال القاضي: خرجه أبو داود إلا أنه عن صحابي مجهول ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط وبه قال عطاء وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر ومن أحب أن يرجع فليرجع وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأي أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توفيق وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام فقال قوم: يصلي أربعا وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود. وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإن صلى المصلى صلى أربع ركعات. وقال قوم: لا قضاء عليه أصلا وهو قول مالك وأصحابه. وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي فمن قال أربعا الجمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها
الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر: أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته الظهر قضاء بل هي أداء لأنه إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر وبه قال أحمد. وقيل يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب أنس وعروة وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وهو مروي أيضا عن ابن مسعود وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد وهو مشهور مذهب مالك. وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين" وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها؟ فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له أن تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه
الجمهور لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج. واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور. وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وهو قول مالك والشافعي. وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال. وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت ومعناه ولم ينقل في ذلك قول محدود فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم وتلقي ذلك ومعناه وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام فقال مالك والشافعي: يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروي عن ابن عباس أنه يقول: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات ثم يقول الرابعة ولله الحمد. وقال جماعة: ليس فيه شيء مؤقت. والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت: أعني فهم الأكثر. وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك وأجمعوا
على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام.
الباب التاسع في سجود القرآن
والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود. وفي عدد السجدات التي هي عزائم أعني التي يسجد لها. وفي الأوقات التي يسجد لها. وعلى من يجب السجود. وفي صفة السجود. فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب, وقال مالك والشافعي: هو مسنون وليس بواجب. وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً} هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد في المفصل وبما روي أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى من قال إنه سجد ومن قال إنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب أو الأخبار التي تنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو المعالي: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له فإن إيجاب
السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة: أعني قراءة آية السجود قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود ولأبي حنيفة أن يقول قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعني عند التلاوة وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها: أعني أنه عند التلاوة فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه. وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا قال في الموطأ: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء وقال أصحابه: أولها خاتمة الأعراف وثانيها في الرعد عند قوله تعالى: {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} وثالثها في النحل عند قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً} وخامسها في مريم عند قوله تعالى: {خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً} وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى: {وَزَادَهُمْ نُفُوراً} وثامنها في النمل عند قوله تعالى: {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وتاسعها في آلم تنزيل عند قوله تعالى: {وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} وعاشرها في ص عند قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} والحادية عشر في حم تنزيل عند قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} وقيل عند قوله تعالى: {وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة: ثلاث منها في المفصل: في الانشقاق وفي النجم وفي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ولم ير في {ص} سجدة لأنها عنده من باب الشكر. وقال أحمد: هي خمس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة {ص} وقال أبو حنيفة: هي اثنتا عشرة سجدة. قال
الطحاوي: وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. والسبب في اختلافهم اختلافهم في إذنه التي اعتمدوها في تصحيح عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة ومنهم من اعتمد القياس ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه. وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل و آلم تنزيل فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر وهي التي في ص والانشقاق لبعض ثلاث جاءت بلفظ الأمر وهي التي في والنجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} وفي {وَالنَّجْمِ} خرج ذلك مسلم. وقال الأثرم: سئل لأحمدكم في الحج من سجدة؟ قال سجدتان وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحج سجدتان وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه أبو داود. وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة ص لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة {ص} فنزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال: "إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت" وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف لأنه من باب تجويز دليل الخطاب. وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة قال أبو عمر: وهو منكر لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة. وقد روى الثقات عنه أنه سجد عليه الصلاة والسلام
في والنجم, وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه فمنع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع. وأما على من يتوجه حكمها؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة. واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة. وقال مالك: يسجد السامع بشرطين: أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن والآخر أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله
كتاب أحكام الميت
مدخل
كتاب أحكام الميت
والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء. ينقسم إلى ست جمل: الجملة الأولى: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. الثانية: في غسله. الثالثة: في تكفينه. الرابعة: في حمله واتباعه. الخامسة: في الصلاة عليه. السادسة: في دفنه.الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضاروبعده
الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعدهويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله لقوله عليه
الباب الثاني: في غسل الميت
الفصل الأول: في حكم الغسل
الباب الثاني في غسل الميتويتعلق بهذا الباب فصول أربعة: منها في حكم الغسل. ومنها فيمن يجب غسله من الموتى. ومن يجوز أن يغسل وما حكم الغاسل. ومنها في صفة الغسل.
الفصل الأول في حكم الغسل
فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية. وقيل سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل ومعناه لا بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام: "في ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا" وبقوله في المحرم: "اغسلوه" فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة أنه يتضمن الأمر والصفة قال: بوجوبه.
الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى
وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل الشهيد وفي
الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت
وأما من يجوز أن يغسل الميت فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. وقال قوم: ييمم كل واحد منهما صاحبه,
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء وقال قوم: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه وبه قال الليث بن سعد بل يدفن من غير غسل. وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال: لا يغسل كل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه: أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا بعورة وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم, وهو تسبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور. فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة فمرة قال: ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال: أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب. والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه ولكن ييممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم. والثالث الفرق بين الرجال والنساء: أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء. وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبي. وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله إياها فالجمهور على جواز ذلك وقال أبو حنيفة: لا يجوز غسل
الرجل زوجته. وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال: إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت وهذا فيه بعد فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت لذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة وأن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها واختلفوا في الرجعية فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق نجاسة وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها؟ وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه فقال قوم: من غسل ميتا وجب عليه الغسل. وقال قوم: لا غسل عليه. وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" خرجه أبو داود. وأما حديث أسماء فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا وحديث أسماء في هذا صحيح, وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح. لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة.
الفصل الرابع في صفة الغسل
وفي هذا الفصل مسائل
إحداها هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل؟ أم يغسل في قميصه؟
اختلفوا في ذلك فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون الموطأ يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال: يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم: لا تنزعوا القميص وقد ألقي عليهم النوم قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه.
المسألة الثانية : قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقال الشافعي: يوضأ. وقال مالك: إن وضئ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر. وذلك أن القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله. وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لأن المقيد يقضي على المطلق إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ويشبه أيضا أن يكون الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع. و الشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد.
المسألة الثالثة : اختلفوا في التوقيت في الغسل فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان وبه قال ابن سيرين.
ومنهم من أوجب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن الثلاثة ولم يحد الأكثر وهو الشافعي. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: لا يتجاوز به السبعة وهو أحمد بن حنبل. وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس
وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وفي بعض رواياته أو سبعا. وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. وأما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم اختلاف ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. فأما الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام: "أو أكثر من ذلك إن رأيتن" . وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أو سبعا" . وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط. وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور. واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ فقيل لا يعاد وبه قال مالك وقيل يعاد والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث فقيل يعاد الغسل عليه واحدة وبه قال الشافعي. وقيل يعاد ثلاثا. وقيل يعاد سبعا. وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء. واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره فقال قوم: تقلم أظفاره ويؤخذ منه. وقال قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل. فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره. فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب
من الميت كما مطلوب من الحي. ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع وأن الحي في ذلك بخلاف الميت.
الباب الثالث في الأكفان
والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوبا ثوبا فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب, وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه ثلاثة أثواب. ورأى مالك أنه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع ومن فهم من العدو أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب وكله واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر" واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير المحرم. وقال الشافعي: لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص فهو حديث
ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال: "كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي" وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع وقال: لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال: حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره.
الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة
واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها. وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن المشي خلفها أفضل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من صليت عن سلفه وعمل به فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا المشي أمام الجنازة وعن أبي بكر وعمر وبه قال الشافعي. وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي ابن أبي طالب من طريق عبد الرحمن ابن أبزى قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها و أبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقلت له في ذلك فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة وإنهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة وبما روي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدمها" وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها أو عن يسارها قريبا منها" وحديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى قال: "امشوا
خلف الجنازة" , وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم. وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس وذهب قوم إلى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع" واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره.
الباب الخامس: في الصلاة غلى الجنازة
مدخل
الباب الخامس في الصلاة على الجنازةوهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول: أحدها في صفة صلاة الجنازة. والثاني: على من يصلى ومن أولى بالصلاة. والثالث: في وقت هذه الصلاة. والرابع: في موضع هذه الصلاة. والخامس: في شروط هذه الصلاة.
الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل:
المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع: أعني الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع, إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان إنها خمس. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار وجاء في هذا
الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم
وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا. واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم أنه لا يصلى عليه وأجاز آخرون الصلاة عليه ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع. والسبب في اختلافهم في الصلاة أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهم جائزة وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} الآية. وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي
أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: "أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان" واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي: لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وروى من طريق ابن عباس مسندا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم وروى ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري وكذلك روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل كلاهما وأنا شهيد عليه" وكلا الفريقين يرجع الأحاديث التي أخذ بها وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره وقد كان شعبة يطعن فيه وأما المراسيل فليست عندهم بحجة واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر, وبه قال ابن أبي ليلى. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك أنه روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطفل لا يصلى
عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا" وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: الطفل يصلى عليه فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال: معلوم أن المعتبر في الصلاة هو حكم الإسلام والحياة والطفل إذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له ومن الناس من شذ وقال: لا يصلى على الأطفال أصلا. وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام سواء سبي مع والديه أو لم يسب معهما وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك. وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباهم. وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم: يعني إذا بيعوا في السبي. قال: وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه. وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم: أي أن حكمهم حكم آبائهم ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة" أن حكمهم حكم المؤمنين. وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهها
بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال لولا أنها سنة ما تقدمت قال أبو بكر وبه أقول وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له ومن قال إنه يصلى على أقله قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة وكان ممن التابعين الصلاة على الغائب.
الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة فقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا الحديث وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس قول أبي حنيفة وقال الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم.
الفصل الرابع في مواضع الصلاة
واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة أما حديث عائشة فما رواه مالك
الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة
واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها فقال قوم لها إذا خاف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصلي عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عتده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك وشذ قوم فقالوا يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة وهو قول الشعبي وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود.
الباب السادس: في الذقن
الباب السادس في الدفنوأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً} وقوله: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ} وكره مالك والشافعي تجصيص القبور وأجاز ذلك أبو حنيفة وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها ومنها حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: "انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك" واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث أو غائط أو بول قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار" وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما1
ـــــــ
1 تنبيه: حيث أننا التزمنا في التصحيح النسخة المغربية وفيها تقديم كتاب الزكاة على الصيام فقدمناه تبعا لها, وإن كانت النسخة المصرية قدمت الصيام.
كتاب الزكاة
مدخل
كتاب الزكاة
والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل: الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه. الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال. الثالثة: في معرفة كم تجب ومن كم تجب. الرابعة: في معرفة متى تجب ومتى ولا تجب. الخامسة: معرفة لمن تجب وكم يجب له.فأما معرفة وجوبها: فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك.
الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه الزكاة
الجملة الأولى:وأما على من تجب فإنهم اتفقوا على كل مسلم عاقل مالك للنصاب ملكا تاما. واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له دين ومثال المال المحبس الأصل. فأما الصغار فإن قوما قالوا: تجب الزكاة في أموالهم وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلا وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا: عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغير ذلك وهو أبو حنيفة وأصحابه. وفرق آخرون بين الناض وغيره فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر ذلك بلوغا من غيره. وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت. وأما أهل الذمة فإن الأكثر على ألا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وليس عن مالك في ذلك قول وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه. وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلا وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن
لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك إذا كان لا يخلو مال من مالك قال: الزكاة على السيد ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاما لا السيد إذا كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد أيضا لأن للسيد انتزاعه منه قال: لا زكاة في ماله أصلا. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال: الزكاة عليه لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال. وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة فإنهم اختلفوا في ذلك فقال قوم: لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا فلا وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط ألا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. وقال قوم: بمقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا. والسبب في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده. ومن قال هي عبادة قال: تجب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أو لم يكن وأيضا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق لله وحق للآدمي وحق الله أحق أن يقضى والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصلاة والسلام: "فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة وقد كان أبو عبيد يقول: إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ
منه وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة وإنما هو خلاف لمن يقول: يصدق في الدين كما يصدق في المال. وأما المال الذي هو في الذمة أعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين فإنهم اختلفوا فيه أيضا فقوم قالوا: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث أو هو قياس قوله وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض. وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول وفي المذهب تفصيل في ذلك ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الأصول وفي زكاة الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها؟ هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج أعني أهل الذمة وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة.
أما المسألة الأولى : وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول فإن مالكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول وطاووس يقولان لا زكاة فيها وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين ولا معنى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: أحدهما أنها ملك ناقص والثانية أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم.
وأما المسألة الثانية : وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه فإن قوما قالوا: الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء. والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟ إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين
اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد. فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض. وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر من الخراج أم ليس فيها عشر؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر: أعني الزكاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها عشر. وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان: وهما العشر والخراج وإن قلنا: الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الحب وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلنا ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج. وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء. وقال النعمان: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين والخراج هو حق أرض الذميين لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن فإذا أرض عشر كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب. أحدها إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت. والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج. والثالثة إذا مات وعليه زكاة. والرابعة إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة وكذلك إذا وهبه.
فأما المسألة الأولى : وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت فإن قوما قالوا: تجزى عنه وقوم قالوا: هو لها ضامن حتى يضعها موضعها وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك وقول قالوا: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي وبه قال أبو ثور والشافعي وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي,
فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول إنه لا يضمن بإطلاق وقول إنه يضمن بإطلاق وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرظ زكى ما بقي والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي.
وأما المسألة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة فقوم قالوا: يزكى ما بقي وقوم قالوا: حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم. فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه ومن شبههم بالغرماء قال: يضمنون ومن فرق بين التفريط واللاتفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذ كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال: إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجود الزكاة فيه كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط. وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك.
وأما المسألة الثالثة : وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه. فإن قوما قالوا: يخرج من رأس ماله وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وقوم قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث ومنهم من قال: لا يبدأ بها وعن مالك القولان جميعا ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية. وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فإن قوما قالوا: يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع وبه قال أبو ثور. وقال قوم: البيع مفسوخ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على البائع. وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته
وإتلاف عينه فمن شبهه بذلك قال: الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال: الزكاة في عين المال ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يسر فيها تلك الفروق لأنها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة وهي معرفة من تجب عليه الزكاة وشروط الملك التي تجب به وأحكام من تجب عليه. وقد بقي من أحكامه حكم مشهور وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور. وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه؟ فمنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي" فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الأعمال فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال: جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان قال: التصديق فقط هو شرط الإيمان وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن والقولان شاذان واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور.
الجملة الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال
الجملة الثانية:وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على
أشياء واختلفوا في أشياء. أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير وصنفان من الثمر التمر والزبيب وفي الزيت خلاف شاذ. والذي اختلفوا فيه من الذهب هو الحلي فقط وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. والسبب في اختلافهم تردد شبه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء شبهه بالتبر والفضة فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال: ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة. ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار في ذلك. وذلك أنه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت لا قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة لا الانتفاع وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة أعني الانتفاع بها لا المعاملة وأعني بالمعاملة كونها ثمنا واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة.
وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان: فمنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه. أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا. والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها. أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه
صدقة" وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل. فأشبه الإبل والبقر. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: "وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها" فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة وذلك في السائمة منها. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما فيحتج به في الزكاة عدا أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة فقيل إنه كان اختيار منهم. وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة وبه قال الليث ومالك وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الأنواع الثلاثة. وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاة" . وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة" فمن غلب المطلق على المقيد قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم. وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة" يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "في كل أربعين شاة شاة" يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة لكن العموم أقوى من دليل الخطاب كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قولا ثالثا. وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: "في أربعين شاة شاة"
فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك والزكاة إنما هي فضلات الأموال والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل فإنهم اختلفوا فيه فالجمهور على أنه لا زكاة فيه وقال قوم: فيه الزكاة. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "في كل عشرة أزق زق" خرجه الترمذي وغيره.
وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو أبو حنيفة. وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب لجميع المقتات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله
عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" وما بمعنى الذي والذي من ألفاظ العموم وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ} الآية إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} . وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت فمن خصص العموم بهذا القياس
أسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر. وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} الآية ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف. واتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة؟ فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر. والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "أد زكاة البر" . وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف.
الجملة الثالثة: في معرفة كم تجب ومن كم تجب
مدخل
الجملة الثالثة:وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ومعرفة الواجب من ذلك أعني في عينه وقدره فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ولنجعل هذا الكلام في ذلك في فصول: الفصل الأول: في الذهب والفضة.؟ الثاني: في الإبل. الثالث: في الغنم. الرابع: في البقر. الخامس: في النبات. السادس: في العروض.
الفصل الأول في الذهب والفضة
أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" ما عدا المعدن من الفضة فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا, وأما القدر الواجب فيه, فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر: أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن. واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة: أحدها: في نصاب الذهب. والثاني: هل فيهما أوقاص أم لا؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟. والثالث: هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان؟ والرابع: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لا اثنين؟. الخامس: في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه.
أما المسألة الأولى : وهي اختلافهم في نصاب الذهب فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا كما تجب في مائتي درهم هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا ففيها ربع عشرها دينار واحد. وقالت طائفة ثالثة: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل أو أكثر هذا فيما كان منها دون الأربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا كان الاعتبار بها نفسه لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة. وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة. وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا
نصف دينار" فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين. وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الإجماع ولما قيل أيضا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة وجاء في بعض الآثار ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة.
المسألة الثانية : وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها فإن الجمهور قالوا: إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك أعني ربع العشر وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة. وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق: لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب. أما حديث الحسن بن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ففي كل أربعين دينار وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم" . وأما دليل الخطاب
المعارض له فقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر. وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب. فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية. وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص.
وأما المسألة الثالثة : وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب. وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيها الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال: هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم. فرأى مالك ضمهما بصرف محدود وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر. وقال من هؤلاء آخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة فمن كانت عنده مثلا مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم: أعني القيمة أو الصرف المحدود: ومنهم من قال: يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يضم الأكثر إلى الأقل وقال آخرون: تضم الدنانير بقيمتها أبدا كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل
والدنانير فرع إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين. وقال بعضهم: إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره ولم ير الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا وهذا كله لا معنى له ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف.
وأما المسألة الرابعة : فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد. وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر والله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد.
وأما المسألة الخامسة : وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه فإن مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير ولا حولا وقال: الواجب هو الخمس. وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس" وروى أشهب عن مالك أن
المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس. فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ وهو الاختلافات العامة التي ذكرناها.
الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه
وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر. واختلفوا منها في مواضع: منها فيما زاد على العشرين والمائة ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته ما حكمه؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل وإن وجبت فما الواجب؟
فأما المسألة الأولى : وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وعشرين فإن مالكا قال: إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ ثلاث بنات لبون خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون وبهذا القول قال الشافعي. وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ مائة وثلاثين. وقال الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا زادت على عشرين ومائة عادت الفريضة على أولها ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود شاة فإذا كانت الإبل مائة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة الحقتان للمائة والعشرين والشاة للخمس فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان فإذا كانت خمسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض الحقتان
للمائة والعشرين وابنة المخاض للخمس وعشرين كما كانت في الفرض الأول إلى خمسين ومائة فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فإذا زادت على الخمسين ومائة استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة. وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المائة والثلاثين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام: "فما زاد على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" وروي من طريق أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة وفيه "إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة" فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس. وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينات ولا الخمسينات فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقيم الحساب وقص قال: ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة. فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته وابن القاسم والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر. وأما تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين والله أعلم.
وأما المسألة الثانية : وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده
السن الذي فوق هذا السن أو تحته فإن مالكا قال: يكلف شراء ذلك السن. وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج القيم في الزكاة. وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة.
وأما المسألة الثالثة : وهي هل تجب في صغار الإبل وإن وجبت فماذا يكلف؟ فإن قوما قالوا: تجب فيها الزكاة وقوم قالوا: لا تجب. وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله؟ والذين قالوا: لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا أجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع قال: وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال: يكلف شراء السن الواجبة عليهم ومنهم من قال: يأخذ منها وهو الأقيس وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم.
الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك
جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا وفي أربعين مسنة. وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة وهذا عن سعيد بن المسيب. واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ففيها تبيعان ومسنة ثم هكذا
ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته ولذلك لم يخرجه الشيخان. وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال: حتى أسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره.
الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك
وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق فقال مالك: يأخذ من الأكثر عددا فإن استوت خير الساعي. وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف. وقال الشافعي: يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه: تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا ينفذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. وكذلك اتفق جماعة فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار لثبوت ذلك في كتاب الصدقة إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين. واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا؟ فرأى مالك والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد. وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم
يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما؟. واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا؟ فقال مالك يعتد بها وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت وقوم فهموا هذا مطلقا وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ولا يعدون بها لو كانت ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة. واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب وتفسير ذلك أن مالكا والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء أكان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟. الثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير؟. فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن كل واحد من صليت أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" وقوله: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع" يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" إما في الزكاة عند مالك وأصحابه: أعني في قدر الواجب وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابه. وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما خليطان,
ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع" إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث شياة أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد. وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: "أنهما يتراجعان بالسوية" مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد وأن قوله عليه الصلاة والسلام: "أنهما يتراجعان بالسوية" يدل على أن الخليطين ليسا
بشريكين لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال: الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال: نصابهما نصاب الرجل الواحد كما أن زكاتهما زكاة رجل واحد وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع" على ما ذهب إليه. فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال: معنى قوله: "لا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فتكون عليهما فيهما ثلاث شياه فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة ومعنى قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب. وأما الشافعي فقال معنى قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن يكون رجلان لهما أربعون شاة فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك رجل واحد في الحكم. وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة. فأما الشافعي فقال: إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا وتكون فحولهما
مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها. وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب أبي محمد ابن حزم الأندلسي.
الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك
وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بإجماع والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان وفي الصاع إنه ثمانية أرطال. وقال أبو حنيفة: ليس في الحبوب والثمار نصاب. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" أما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" والحديثان ثابتان فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص
وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه. واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب. الثانية: في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص. الثالثة: هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟.
أما المسألة الأولى : فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما: أعني من الجيد والرديء فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه. واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض وفي ضم الحنطة والشعير والسلت فقال مالك القطنية كلها صنف واحد الحنطة والشعير والسلت. أيضا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ولا يضم منها شيء إلى غيره في نجاسة النصاب وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب. وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة ومن قال اتفاق المنافع قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله أعلم.
وأما المسألة الثانية : وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها للضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل وعلى رب المال أن
يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك. أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل. وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا: يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي. أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذ فرغ من الخرص قال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى زفر خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان وكيفما كان فالخرص مستثنى من تلك الأصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما عاما على المسلمين إلا بدليل والله أعلم. ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه ولذلك لم يجز داود خرص العنب. واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب
سلمنا أنها حق للمساكين إن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. والحنفية تقول: إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود.
الفصل السادس في نصاب العروض
والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله: وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فإذا بلغ ما اجتمع عنده من أدى زكاته وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض أو لم وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء. فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده ومنهم من شرطه. والذي شرطه منهم فمنهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها. وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لأن الحول إنما يشترط
في عين المال لا في نوعه. وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس والجواب وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها.
الجملة الرابعة في وقت الزكاة:
وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف ولا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة: إحداها: هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر؟. الثانية: في اعتبار حول ربح المال. الثالثة: حول ملكا الواردة على مال تجب فيه الزكاة. الرابعة: في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. الخامسة: في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. السادسة: في حول فائدة الماشية. السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات إما على رأي من يشترط أن تكون وهو الشافعي وأبو حنيفة وإما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك. والثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول.
أما المسألة الأولى : وهي المعدن فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول. وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين فمن
شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم.
المسألة الثانية : وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان أو لم يكن وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل: أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه سواء كان أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع قال أبو عبيد: ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه أو لا يكون فقالوا: إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله وإن لم يك نصابا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة. وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال: يستقبل به الحول ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال: حكمه حكم رأس المال إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة وذلك لا يكون إلا إذا ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور.
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل. واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول فقال مالك: يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه و الثوري: ملكا كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا وكذلك الربح عندهم. وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال
آخر؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر: أعني مالا فيه زكاة. قال: لا زكاة في الفائدة ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال: إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعضا منه في كله فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثم استفاد مالا في آخر الحول صار به نصابا أنه تجب فيه الزكاة وهذا عنده موجود في هذا المال لأنه لم يستكمل الحول وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه بل زاد ولكن ألفي في طرفي الحول نصابا والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة فإن الزكاة إنما هي فضول الأموال. وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء فواجب عليه أن يقول: تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها الزكاة فكأنه اعتبر أيضا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة وأخذ أيضا ما اعتمده أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه.
وأما المسألة الرابعة : هي اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن قوما قالوا: يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك إن كان حولا فحول وإن كان أحوالا فأحوال أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا: يزكيه لعام واحد وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين. وقوم قالوا:
يستقبل به الحول. وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين. ومن قال فيه: الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر. وأما من قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة أو لا يقول ذلك فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول فإن الزكاة وجبت بشرطين: حضور عين المال وحلول الحول فلم يبق إلا حق العام الأخير وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط لأنه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة وهو شيء يجري على غير قياس وإنما اعتبر مالك فيه العمل. وأما الشافعي فيراه ضامنا لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه. ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث. والثالث دين المدير وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا.
المسألة الخامسة : وهي حول العروض وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض.
وأما المسألة السادسة : وهي فوائد الماشية فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد أعني أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابا كانت فائدة غنم أو فائدة ناض والأرباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية. وأما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابا فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر وإلا فالقياس فيهما واحد أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا وقد تقدم الحديث في باب النصاب.
المسألة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الغنم فإن مالكا قال: حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن كما قال في ربح الناض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال.
وأما المسألة الثامنة : وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي. وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها.
الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة
مدخل
الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة
والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول: الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم. الثاني: في صفتهم التي تقتضي ذلك. الثالث: كم يجب لهم؟.الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة
فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية. واختلفوا من العدد في مسألتين: إحداهما : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى. وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى. ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" .
وأما المسألة الثانية : فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام. وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ أعني في حال الضعف لا في حال القوة ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح.
الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضى صرفهاإليهم
الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها إليهموأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها: فأحدها الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز وما مقدار فلهذا المحرم للصدقة. فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني" وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا مجاهدا كان أو عاملا والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلا. وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة؟ فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال: الحاجة فقط ومن قال: الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم. وأما حد الغني الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب لأنهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في حديث معاذ له: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم. وقال مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد. وسبب اختلافهم هل فلهذا المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ فمن قال معنى شرعي قال: وجود النصاب هو الغنى ومن قال معني لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت
وفي كل شخص جعل حده هذا ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال: هو غير محدود وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك خمسين درهما وفي أثر آخر أنه ملك أوقية وهي أربعون درهما وأحسب أن قوما قالوا بهذه الآثار في حد الغنى. واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما فقال قوم: الفقير أحسن حالا من المسكين وبه قال البغداديون من أصحاب مالك وقال آخرون: المسكين أحسن حالا من الفقير وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على معنى واحد وإلى هذا ذهب ابن القاسم وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن له دلالة شرعية. والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه واختلفوا في قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} فقال مالك: هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين وقال الشافعي وأبو حنيفة: هم المكاتبون وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفذ زاده فلا يجد ما ينفقه. وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. وأما في سبيل الله فقال مالك: سبيل الله مواضع الجهاد والرباط وبه قال أبو حنيفة. وقال غيره: الحجاج والعمار. وقال الشافعي: هو الغازي جار الصدقة وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة.
الفصل الثالث كم يجب لهم؟
وأما قدر ما يعطى من ذلك أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي. واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد وبه قال الشافعي قال: وسواء كان ما يعطى من
ذلك نصابا أو أقل من نصاب. وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة. وقال الثوري: لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما. وقال الليث: يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصبر بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه. وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. وأما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى.
كتاب زكاة الفطر
مدخل
كتاب زكاة الفطر
والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول: أحدها: في معرفة حكمها. والثاني: في معرفة من تجب عليه. والثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب عليه؟. والرابع: متى تجب عليه؟. والخامس: من تجوز له؟.الفصل الأول في معرفة حكمها
فأما زكاة الفطر فإن الجمهور على أنها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق. وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا لفظه وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي المشهور وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت
الفصل الثاني: قيمن تجب عليه وعمن تجب
الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعمن تجبوأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطر وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم. وأما عمن تجب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه وأنها زكاة بدن لا زكاة مال وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال واختلفوا فيما سوى ذلك.
وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أنها أفطر الرجال عمن ألزمه الشرع النفقة عليه ووافقه في ذلك الشافعي. وإنما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن أفطر المرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال فقال: إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وقال الحسن هي على الأب وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب على من تجوز له الصدقة لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه وذلك بين والله أعلم. وإنما اتفق على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير والعبيد فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي يلزمه إخراج الصدقة عن كل من يليه ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق
يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع. وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية ولذلك اختلفوا في الزوجة. وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون ولكنه غير مشهور. واختلفوا من العبيد في مسائل: إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال وذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك. والثانية في العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاة. وقال الكوفيون: عليه الزكاة فيه. والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله: من المسلمين فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. وللخلاف أيضا سبب آخر وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد مكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه قالوا: ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات. والثالثة في المكاتب فإن مالكا وأبا ثور قالا: يؤدي عنه سيده زكاة الفطر وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه. والسبب في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد. والرابعة في عبيد التجارة ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر وقال أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة صدقة. وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروع هذا الباب كثيرة.
الفصل الثالث مماذا تجب؟
وأما مماذا تجب؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال: أي أخرج من هذا أجزأ عنه ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال: بالقول الثاني. وأما كم يجب؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح فقال مالك والشافعي: لا يجزى منه أقل من صاع وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزى من البر نصف صاع. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب وظاهره أنه أراد بالطعام القمح. وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد" خرجه أبو داود. وروي عن ابن المسيب أنه قال: كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا شعير أو صاعا من تمر فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: نصف صاع من البر ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب.
الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر؟
وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال الشافعي. وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد: أو بخروج شهر رمضان؟ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب؟.
الفصل الخامس في معرفتها
وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة: تجوز لهم. وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر مع الإسلام معا؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين ومن قال الفقر فقط أجازها لهم واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم" .
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الصيام
الصوم الواجب
الصوم
معرفة أنواع الصيام الواجب
كتاب الصيام
وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين:أحدهما في الصوم الواجب.
والآخر: في المندوب إليه.
والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: في الصوم.
والآخر: في الفطر.
أما القسم الأول وهو الصيام: فإنه ينقسم أولا إلى جملتين:
إحداهما: معرفة أنواع الصيام الواجب.
والأخرى: معرفة أركانه.
وأما القسم الذي
معرفة أركانه
الجملة الثانية:في الأركان والأركان ثلاثة: اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات. والثالث مختلف فيه وهو النية.
فأما الركن الأول : الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: زمان الوجوب وهو شهر رمضان.
والآخر: زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل وقواعد اختلفوا فيها فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان. وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحددة في حق شخص شخص وأفق أفق. فأما طرفا هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا
على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال. واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. فأما اختلافهم إذا غم الهلال فإن أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عن الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وكان أول رمضان الحادي والثلاثين وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه. وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين. ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب. ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ. وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" وذلك مجمل وهذا مفسر فوجب أن يحمل المجمل على المفسر وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح والله أعلم. وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه لليوم المستقبل كحلم رؤيته بالعشي وبهذا القول قال مالك والشافعي
وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية. وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران: أحدهما عام والآخر مفسر فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر فأما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. قال القاضي: الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها. وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين: أحدهما الحس والآخر الخبر فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر. وقال الشافعي: يفطر وبه قال أبو ثور وهذا لا معنى له فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية والرؤية إنما تكون بالحس ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر وشذ مالك فقال: من أفطر وقد
رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط. وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية في صفتهم. فأما مالك فقال: إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة قبل واحد وإن كانت صاحية بمصر كبير لم يقبل إلا شهادة الجم الغفير. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية. وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة وأجمعوا على أنه لا تقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد. أما الآثار فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" ومنها حديث ابن عباس أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟" قال: نعم قال: "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا" خرجه الترمذي قال: وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا. ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما,
فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس: أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش وذلك أن الذي في حديث ربعي ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنين وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا لا أن ذلك تعارض ولا أن الفضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف إذا عارضه النص فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقاس عليها وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية؟ فيه خلاف فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم وبه قال الشافعي وأحمد. وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا أفطر بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية,
الفطر
معرفة المفَطِّرات و المفطرين وأحكامهم...
القسم الثاني من الصوم المفروض
وهو الكلام في الفطر وأحكامه والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام: وصنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع. وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. وصنف لا يجوز له الفطر وكل واحد من هؤلاء
تتعلق به أحكام أما الذين يجوز لهم الأمران. فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف والحامل الكبير. وهذا التقسيم كله مجمع عليه فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها: هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟ وهل إن كان يجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ ومتى يفطر المسافر؟ ومتى يمسك؟ وهل إذا مرض بعض الشهر له أن ينشىء السفر أم لا؟ ثم إذا أفطر ما حكمه؟. وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر.
أما المسألة الأولى : وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه وأن فرضه هو أيام أخر. والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الحذف في الكلام هو أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ومن قدر فأفطر قال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبما ثبت عنه أيضا أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم
أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا يدل على نسخ الصوم. قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه.
وأما المسألة الثانية : وهي هل الصوم أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: فبعضهم رأى أن الصوم أفضل وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة. وبعضهم رأى أن الفطر أفضل وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة. وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير وأنه ليس أحدهما أفضل. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ومعارضة المنقول بعضه لبعض وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة عن عمرو الأسلمي خرجه مسلم أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس من البر أن تصوم في السفر" ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم أن الفطر أفضل لكن الفطر لما كان ليس حكما وإنما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم. وأما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" خرجه مسلم.
وأما المسألة الثالثة : وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود. فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم السفر وهم أهل الظاهر. والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى وذلك أن ظاهر
اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس في ذلك على الحد في تقصير الصلاة. وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر فإنهم اختلفوا فيه أيضا فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد. وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر.
وأما المسألة الخامسة : وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك فإن قوما قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وبه قال فقهاء الأمصار. واستحبت جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة. واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار فذهب مالك و الشافعي إلى أنه يتمادى على فطره. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكف عن الأكل وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل. والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: "أولئك العصاة أولئك العصاة" وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة قال جعفر راوي الحديث:
فقال: ألست تؤم البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر: فأكل. وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه. فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الأكل لأن الأول أكل موضع الجهل وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل. والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل.
وأما المسألة السادسة : وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشىء سفرا ثم لا يصوم فيه فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له. وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يجيزوا له الفطر. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام: "وعن المجنون حتى يفيق" والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم فقوم قالوا: إنه مفسد. وقوم قالوا: ليس بمفسد. وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. وقوم قالوا: إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار
أجزأه وإن أغمي عليه في أول النهار قضى وهو مذهب مالك وهذا كله فيه ضعف فإن الإغماء والجنون يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم إلا كما يقال في الميت أو فيمن لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله. ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل: منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا؟ ومنها ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر ومنها إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟.
أما المسألة الأولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع والجماعة على ترك إيجاب التتابع. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج. أما ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فقال قوم: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال قوم: لا كفارة عليه وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي. وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال: إنما عليه القضاء فقط. ومن أجاز القياس في الكفارات قال: عليه الكفارة قياسا على من أفطر متعمدا لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع لأن أزمنة الأداء هي محدودة في الشرع وقد شذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص. وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا: لا يصوم أحد عن أحد. وقوم قالوا: يصوم عنه وليه والذين لم يوجبوا الصوم قالوا: يطعم عنه وليه وبه قال الشافعي. وقال
بعضهم: لا صيام ولا سنان إلا أن يوصي به وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض فقالوا يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم عنه في الصيام المفروض. والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" خرجه مسلم وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟" قال نعم قال: "فدين الله أحق بالقضاء" فمن رأى أن الأصول تعارضه وذلك أنه كما لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد قال: لا صيام على الولي ومن أخذ بالنص في ذلك قال: بإيجاب الصيام عليه ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر ومن قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه في رمضان. وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} الآية. ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس. والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا سنان عليهما وهو مقابل الأول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. والثالث أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي. والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} الآية. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض
وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا فإن الصحيح لا يباح له الفطر. ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا فإنه بين. وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا فقال قوم: عليهما الإطعام. وقال قوم: ليس عليهما سنان وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة وبالثاني قال مالك ألا أنه استحبه. وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول مد عن كل يوم وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه. وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءة التي ذكرنا أعني قراءة من قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول قال: الشيخ منهم ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر. وأما النظر في أحكام الصنف الذي لا يجوز له الفطر إذا أفطر فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع وإلى من يفطر بغير جماع وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى من يفطر بأمر مختلف عليه أعني بشبهة أو بغير شبهة وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو طريق الاختيار أو طريق الإكراه. أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟" قال وقعت على امرأتي في رمضان قال: "هل تجد ما تعتق به رقبة؟" قال: لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم
الشهرين متتابعين؟" قال: لا قال: "فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟" قال: لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا" فقال: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتتها أهل بيت أحوج إليه منه قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك" واختلفوا من ذلك في مواضع: منها هل الإفطار متعمدا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء والكفارة أم لا؟ ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا؟ ومنها إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا؟ وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث وأيضا لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا: ليس عليه الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ. وأما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل.
وأما المسألة الأولى : وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما أفطر في الإفطار من الجماع فقط. والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس
المفطر بالأكل والشرب وعلى المفطر بالجماع فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا. ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره وذلك أن العقاب المقصود به الردع قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا كما قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع وهذا إذا كان ممن يرى القياس. وأما من لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدي حكم الجماع إلى الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به.
وأما المسألة الثانية : وهو إذا جامع ناسيا لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء دون الكفاءة. وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة. وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك القياس. وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة. وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" وهذا الأثر يشهد به عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ والمخطئ والناسي حكمهما
واحد فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. وذلك أنا إن قلنا إن الأصل هو أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم إذ لا دليل ههنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي اللهم إلا أن يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا فضعيف فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع والكفارة من أنواع العقوبات وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا مع أن النص إنما جاء في المتعمد وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" حتى يدل الدليل على التخصيص ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجة. ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل وإنما الإجمال في حقنا.
وأما المسألة الثالثة : وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة وقال الشافعي وداود: لا كفارة عليها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا.
وأما المسألة الرابعة : وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير وأعني بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة