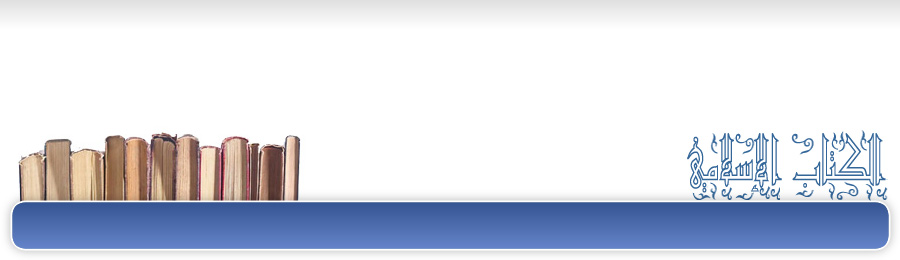كتاب : مقدمة ابن خلدون
المؤلف : ابن خلدون
إعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري، وبكونه عملياً هو جسماني محسوس. والأحوال الجسمانية المحسوسة، نقلها بالمباشرة أوعب لها وأكمل، لأن المباشرة في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة، والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى، حتى ترسخ صورته. وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. ونقل المعاينة أو عب وأتم من نقل الخبر والعلم. فالملكة الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة على الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته. ثم إن الصنائع منها البسيط ومنها المركب. والبسيط هو الذي يختص بالضروريات، والمركب هو الذي يكون للكماليات. والمتقدم منها في التعليم هو البسيط، لبساطته أولاً، ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله، فيكون سابقاً في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصاً. ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل، بالاستنباط شيئاً فشيئاً على التدريج، حتى تكمل. ولا يحصل ذلك دفعة وإنما يحصل في أزمان وأجيال، إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة، لا سيما في الأمور الصناعية. فلا بد له إذن من زمان. ولهذا تجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة، ولا يوجد منها إلا البسيط، فإذا تزايدت حضارتها ودعت أمور الترف فيها إلى استعمال الصنائع، خرجت من القوة إلى الفعل.
وتنقسم الصنائع أيضاً: إلى ما يختص بأمر المعاش، ضرورياً كان أو غير ضروري، وإلى ما يختص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان، من العلوم والصنائع والسياسة. ومن الأول الحياكة والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالها. ومن الثاني الوراقة، وهي معاناة الكتب بالانتساخ والتجليد، والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن الثالث الجندية وأمثالها. والله أعلم.
الفصل السابع عشر
في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران
الحضري وكثرته والسبب في ذلك أن الناس، وما لم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينة إنما همم في الضروري من المعاش، وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه، صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش. ثم إن الصنائع والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوانات، والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية، فهو مقدم لضرورته على العلوم والصنائع، وهي متأخرة عن الضروري. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ، واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة. وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط، خاصة المستعمل في الضروريات من نجار أو حداد أو خياط أو حائك أو جزار. وإذا وجدت هذه بعد، فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة. وإنما يوجد منها بمقدار الضرورة، إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها.إذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات، كان من جملتها التأنق في الصنائع واستجادتها، فكملت بجميع متمماتها وتزايدت صنائع أخرى معها، مما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله، من جزار ودباغ وخراز وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف إذا استبحر العمران إلى أن يوجد فيها كثير من الكمالات، ويتأنق فيها في الغاية، وتكون من وجوه المعاش في المصر لمنتحلها. بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال، لما يدعو إليه الترف في المدينة مثل الدهان والصفار والحمامي والطباخ والسفاج والهراس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع، ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحها، فإن هذه الصناعة إنما يدعو إليها الترف في المدينة من الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك. وقد تخرج عن الحد إذا كان العمران خارجاً عن الحد، كما بلغنا عن أهل مصر، أن فيهم من يعلم الطيور العجم والحمر الإنسية، ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب الأعيان وتعليم الحداء والرقص والمشي على الخيوط في الهواء، ورفع الأثقال من الحيوان والحجارة، وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب. لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام الله عمرانها بالمسلمين. والله الحكيم العليم.
الفصل الثامن عشر
في أن رسوخ الصنائع..
في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها والسبب في ذلك ظاهر، وهو أن هذه كلها عوائد للعمران والوأم. والعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول الآمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيال. وإذا استحكمت الصبغة عسر نزعها. ولهذا فإنا نجد في الأمصار التي كانت استبحرت في الحضارة، لما تراجع عمرانها وتناقص، بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار المستحدثة العمران، ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لأن أحوال تلك القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررها، وهذه لم تبلغ بعد. وهذا كالحال في الأندلس لهذا العهد، فإنا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارها، كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصور، وحسن الترتيب والأوضاع في البناء، وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجميع المواعين، وإقامة الولائم والأعراس وسائر الصنائع التي يدعو إليها الترف وعوائده. فتجدهم أقوم عليها وأبصر بها. وتجد صنائعها مستحكمة لديهم، فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جميع الأمصار. وإن كان عمرانها قد تناقص، والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة. وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوط، وما بعدها من دولة الطوائف وهلم جرا. فبلغت الحضارة فيها مبلغاً لم تبلغه في قطر، إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاً، لطول آماد الدول فيها، فاستحكمت فيها الصنائع وكملت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق. وبقيت صبغتها ثابتة في ذلك العمران، لا تفارقه إلى أن ينتقض بالكلية، حال الصبغ إذا رسخ في الثوب. وكذا أيضاً حال تونس فيما حصل فيها من الحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم، وما استكمل لها في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال، وإن كان ذلك دون الأندلس. إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب المسافة بينهما، وتردد المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة. وربما سكن أهلها هناك عصوراً، فينقلون من عوائد ترفهم وحكم صنائعهم ما يقع لديهم موقع الاستحسان. فصارت أحوالها في ذلك متشابهة من أحوال مصر لما ذكرناة، ومن أحوال الأندلس لما أن أكثر ساكنها من شرق الأندلس حين الجلاء لعهد المائة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال، وإن كان عمرانها ليس بمناسب لذلك لهذا العهد. إلا أن الصبغة إذا استحكمت، فقليلاً ما تحول إلا بزوال محلها. وكذا نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثراً باقياً من ذلك، وإن كانت هذه كلها اليوم خراباً أو في حكم الخراب. ولا يتفطن لها إلا البصير من الناس، فيجد من هذه الصنائع آثاراً تدلة على ما كان بها، كأثر الخط الممحو في الكتاب. والله الخلاق العليم " .
الفصل التاسع عشر
في أن الصنائع إنما تستجاد
وتكثر إذا كثر طالبها والسبب في ذلك ظاهر، وهو أن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع مجاناً، لأنه كسبه ومنه معاشه. إذ لا فائدة له في جميع عمره في شيء مما سواه فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع. وإن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها النفاق كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلب للبيع، فيجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها، ولا يوجه قصد إلى تعلمها، فاختصت بالترك وفقدت للإهمال. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه: " قيمة كل امرء ما يحسن " . بمعنى أن صناعته هي قيمته، أي قيمة عمله الذي هو معاشه. وأيضاً فهنا سر آخر وهو أن الصنائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق سوقها وتوجه الطلبات إليها. وما لم تطلبه الدولة، وإنما يطلبها غيرها من أهل المصر، فليس على نسبتها، لأن الدولة هي السوق الأعظم، وفيها نفاق كل شيء، والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة. فما نفق فيها كان أكثرياً ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام ولا سوقهم بنافقة. والله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء.الفصل العشرون
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب
انتقصت منها الصنائعوذلك لما بيناه من أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبها. فإذا ضعفت أحوال المصر، وأخذ في الهرم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف، ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم، فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف. لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه، فيفر إلى غيرها، أو يموت، ولا يكون خلف منه، فيذهب رسم تلك الصنائع جملة، كما يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ وأمثالهم من الصناع لحاجات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال المصر في التناقص، إلى أن تضمحل. والله الخلاق العليم، سبحانه وتعالى.
الفصل الحادي والعشرون
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع
والسبب في ذلك أنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري، وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها، لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البحر وعمرانه. حتى إن الإبل التي أعانت العرب على التوحش في القفر، والإعراق في البدو، مفقودة لديهم بالجملة، ومفقودة مراعيها، والرمال المهيئة لنتاجها. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة، حتى تجلب إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العجم، من الصين والهند وأرض الترك وأمم النصرانية، كيف استكثرت فيهم الصنائع، واستجلبها الأمم من عندهم.وعجم المغرب من البربر، مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه. فالصنائع بالمغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة، إلا ما كان من صناعة الصوف في نسجه، والجلد في خرزه ودبغه. فإنهم لما استحضروا بلغوا فيها المبالغ، لعموم البلوى بها، وكون هذين أغلب السلع في قطرهم، لما هم عليه من حال البداوة. وأما المشرق فقد رسخت الصنائع فيه، منذ تلك الأمم الأقدمين من الفرس والنبط والقبط وبني إسرائيل ويونان والروم أحقاباً، متطاولة، فرسخت فيهم أحوال الحضارة، ومن جملتها الصنائع كما قدمناه، فلم يمح رسمها. وأما اليمن والبحرين وعمان والجزيرة، وإن ملكه العرب، إلا أنهم تداولوا ملكه آلافاً من السنين في أمم كثيرة منهم، واختطوا أمصاره ومدنه، وبلغوا الغاية في الحضارة والترف. مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواء، فطال أمد الملك والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورسخت، فلم تبل ببلى الدولة كما قدناه. فبقيت مستجدة حتى الآن. واختصت بذلك للوطن، كصناعة الوشي والعصب وما يستجاد من حوك الثياب والحرير فيها. والله وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.
الفصل الثاني والعشرون
في أن من حصلت له ملكة في صناعة
فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى ومثال ذلك الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها، ورسخت في نفسه، فلا يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء، إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. والسبب في ذلك أن الملكات صفات للنفس وألوان، فلا تزدحم دفعة. ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعداداً لحصولها. فإذا تلونت النفس بالملكة الآخرى وخرجت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة، فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. فقل أن تجد صاحب صناعة يحكمها، ثم يحكم من بعدها أخرى، ويكون فيهما معاً على رتبة واحدة من الإجادة. حتى إن أهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة. ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية، فقل أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته، بل يكون مقصراً فيه إن طلبه، إلا في الأقل النادر من الأحوال. ومبني سببه على ما ذكرناه من الاستعداد وتلوينه بلون الملكة الحاصلة في النفس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق، لا رب سواه.الفصل الثالث والعشرون
في الإشارة إلى أمهات الصنائع
اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة، لكثرة الأعمال المتداولة في العمران. فهي بحيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها العد. إلا أن منها ما هو ضروري في العمران أو شريف بالموضوع، فنخصها بالذكر ونترك ما سواها: فأما الضروري فكالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة، وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب. فأما التوليد فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوى، إذ بها تحصل حياة المولود ويتم غالباً. وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه، ويتفرع عن علم الطبيعة، وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة، فهي حافظة على الإنسان حاجته ومقيمة لها عن النسيان، ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب، ومخلدة نتائح الأفكار والعلوم في الصحف، ورافعة رتب الوجود للمعاني. وأما الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع. وكل هذه الصنائع الثلاث داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم، فلها بذلك شرف ليس لغيرها. وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتهنة في الغالب. وقد يختلف ذلك باختلاف الأغراض والدواعي. والله أعلم بالصواب.
الفصل الرابع والعشرون
في صناعة الفلاحة
هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب، بالقيام على إثارة الأرض لها وازدراعها، وعلاج نباتها، وتعهده بالسقي والتنمية إلى بلوغ غايته، ثم حصاد سنبله واستخراج حبه من غلافه وإحكام الأعمال لذلك، وتحصيل أسبابه، ودواعيه. وهي أقدم الصنائع لما أنها محصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالباً، إذ يمكن وجوده من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت. ولهذا اختصت هذه الصناعة بالبدو. إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه، فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية، لا يقوم عليها الحضر ولا يعرفونها، لأن أحوالهم كلها ثانية عن البداوة، فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة لها. والله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد.الفصل الخامس والعشرون
في صناعة البناء
هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري وأقدمها، وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للكن والمأوى للأبدان في المدن. وذلك أن الإنسان لما جبل عليه من الفكر في عواقب أحواله، لا بد له أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد، كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها. والبشر مختلفون في هذه الجبلة الفكرية التي هي معنى الإنسانية، فالمقيدون فيها، ولو على التفاوت، يتخذون ذلك باعتدال، كأهل الإقليم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس و أما أهل البدو فيبعدون عن اتخاذ ذلك، لقصور أفكارهم عن إدراك الصنائع البشرية، فيبادرون للغيران والكهوف المعدة من غير علاج،. ثم المعتدلون والمتخذون البيوت للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد، بحيث يتناكرون ولا يتعارفون فيخشى من طروق بعضهم بعضاً بياتاً، فيحتاجون إلى حفظ مجتمعهم بإدارة سياج الأسوار التي تحوطهم. ويصير جميعها مدينة واحدة ومصراً واحداً يحوطهم فيها الحكام بدفاع بعضهم عن بعض. وقد يحتاجون إلى الاعتصام من العدو ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم. وهؤلاء مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار القبائل. ثم يختلف أحوال البناء في المدن، كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه، ويناسب مزاج أهوائهم واختلاف أحوالهم في الغنى والفقر. وكذا حال أهل المدينة الواحدة. فمنهم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة المشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكبيرة لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه، ويؤسس جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلس، ويعالي عليها بالأصبغة والجص، ويبالغ في كل ذلك بالتنجيد والتنميق، إظهاراً للبسطة بالعناية في شأن المأوى. ويهيىء مع ذلك الأسراب والمطامير لاختزان أقواته، والاصطبلات لربط مقرباته إذا كان من أهل الجنود وكثرة التاج والحاشية، كالأمراء ومن في معناهم. ومنهم من يبني الدويرة والبيوت لنفسه وسكنه وولده لا يبتغي ما وراء ذلك، لقصور حاله عنه واقتصاره على الكن الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة.وقد يحتاج لهذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة والهياكل المرتفعة، ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلو الأجرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. وهذه الصناعة هي التي تحصل الدواعي لذلك كله. وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه، إذ الأقاليم المنحرفة لا بناء فيها. وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أو يأوون إلى الكهوف والغيران. وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون: فمنهم البصير الماهر، ومنهم القاصر. ثم هي تتنوع أنواعاً كثيرة: فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآجر، يقام بها الجدران ملصقاً بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها فيلتحم كأنها جسم واحد، ومنها البناء بالتراب خاصة تقام منه حيطان بأن يتخذ لها لوحان من الخشب مقدران طولاً وعرضاً باختلاف العادات في التقدير. وأوسطه أربع أذرع، في ذراعين فينصبان على أساس، وقد بوعد ما بينهما على ما يراه صاحب البناء في عرض الأساس، ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط عليها بالحبال والجدل. ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين آخرين صغيرين، ثم يوضع فيه التراب مختلطاً بالكلس، ويركز بالمراكز المعدة لذلك، حتى ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه بالكلس، ثم يزاد التراب ثانياً وثالثاً إلى أن يمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين، وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت جسماً واحداً. ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة الأولى، ويركز كذلك إلى أن يتم وتنتظم الألواح كلها سطراً فوق سطر، إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحماً، كأنه قطعة واحدة، ويسمى الطابية وصانعه الطواب. ومن صنائع البناء أيضاً أن تجلل الحيطان بالكلس، بعد أن يحل بالماء ويخمر أسبوعاً أو أسبوعين، على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للألحام. فإذا تم له ما يرضاه من ذلك عالاه من فوق الحائط، وذلك إلى أن يلتحم.
ومن صنائع البناء عمل السقف بأن تمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البيت، ومن فوقها الألواح كذلك موصولة بالدساتر، ويصب عليها التراب والكلس، ويبلط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالى عليها الكلس كما عولي على الحائط. ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتزيين، كما يصنع من فوق الحيطان الأشكال المجسمة من الجص يخمر بالماء، ثم يرجع جسداً وفيه بقية البلل، فيشكل على التناسب تخريماً بمثاقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورواء. وربما عولي على الحيطان بقطع الرخام أو الآجر أو الخزف أو بالصدف أو السبج، يفصل أجزاء متجانسة أو مختلفة، وتوضع في الكلس على نسب وأوضاع مقدرة عندهم، يبدو به الحائط للعيان، كأنه قطع الرياض المنمنمة. إلى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج لسيح الماء، بعد أن تعد في البيوت قصاع الرخام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى الصهريج، يجلب إليها من خارج في القنوات المفضية به إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء.
وتختلف الصناع في جميع ذلك لاختلاف الحذق والبصر، ويعظم عمران المدينة ويتسع فيكثرون. وربما يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيماهم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس في المدن الكثيرة الازدحام والعمران، يتشاحون حتى في الفضاء والهواء للأعلى والأسفل، في الانتفاع بظاهر البناء، مما يتوقع معه حصول الضرر في الحيطان. فيمنع جاره من ذلك، إلا ما كان له فيه حق. ويختلفون أيضاً في استحقاق الطرق والمنافذ، للمياه الجارية، والفضلات المسربة في القنوات. وربما يدعي بعضهم حق بعض في حائطه أو علوه أو قناته لتضايق الجوار، أو يدعي بعضهم على جاره اعتلال حائطه وخشية سقوطه، ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره، عند من يراه، أو يحتاج إلى قسمة دار أو عرصة بين شريكين، بحيث لا يقع معها فساد في الدار ولاإهمال لمنفعتها. وأمثال ذلك. ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر بالبناء العارفين بأحواله، المستدلين عليها بالمعاقد والقمط ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتدالها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها ومنافعها، وتسريب المياه في القنوات مجلوبة ومرفوعة بحيث لا تضر بما مرت عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك. فلهم بهذا كله البصر والخبرة التي ليست لغيرهم. وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوتها.
فإنا قدمنا أن الصنائع، وكمالها إنما هو بكمال الحضارة، وكثرتها بكثرة الطالب لها. فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البناء إلى غير قطرها. كما وقع للوليد بن عبد الملك، حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشام، فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناءة فبعث إليه منهم من حصل له غرضه من تلك المساجد.
وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة، مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء المياه بأخذ الارتفاع، وأمثال ذلك، فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر الأثقال بالهندام، فإن الأجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قدر الفعلة عن رفعها إلى مكانها من الحائط ، فيتحيل لذلك بمضاعفة قوة الحبل، بإدخاله في المعالق من أثقاب مقدرة على نسب هندسية، تصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفاً وتسمى آلة لذلك بالمخال، فيتم المراد من ذلك بغير كلفة. وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة، متداولة بين البشر. وبمثلها كان بناء الهياكل الماثلة لهذا العهد، التي يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية. وأن أبدانهم كانت على نسبتها في العظم الجسماني، وليس كذلك، وإنما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرناه. فتفهم ذلك. والله يخلق ما يشاء سبحانه.
الفصل السادس والعشرون
في صناعة النجارة
هذه الصناعة من ضروريات العمران ومادتها الخشب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للآدمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته، أو حاجاته، وكان منها الشجر، فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر مما هو معروف لكل أحد. ومن منافعها اتخاذها خشباً إذا يبست. وأول منافع الخشب أن يكون وقوداً للنيران في معاشهم، وعصياً للاتكاء والذود، وغيرهما من ضرورياتهم، ودعائم لما يخشى ميله من أثقالهم. ثم بعد ذلك منافع أخرى لأهل البدو والحضر. فأما أهل البدو، فيتخذون منها العمد والأوتاد لخيامهم، والحدوج لظعائنهم، والرماح والقسي والسهام لسلاحهم. وأما أهل الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق لأبوابهم والكراسي لجلوسهم. وكل واحدة من هذه فالخشبة مادة لها، ولا تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة.والصناعة المتكللة بذلك، المحصلة لكل واحد من صورها هي النجارة على اختلاف رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولاً: إما بخشب أصغر، أو ألواح. ثم تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة. فهو في كل ذلك يحاول بصنعته إعداد تلك الفصائل بالانتظام، إلى أن تصيرأعضاء لذلك الشكل المخصوص. والقائم على هذه الصناعة هو النجار وهو ضروري في العمران. ثم إذا عظمت الحضارة وجاء الترف، وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف، من سقف أو باب أو كرسي أو ماعون، حدث التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية، ليست من الضروري في شيء. مثل التخطيط في الأبواب والكراسي، ومثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة الخرط يحكم بريها وتشكيلها، ثم تؤلف على نسب مقدرة وتلحم بالدساتر فتبدو لمرأى العين ملتحمة، وقد أخذ منها اختلاف الأشكال على تناسب. يصنع هذا في كل شيء يتخذ من الخشب فيجيء آنق ما يكون. وكذلك في جميع ما يحتاج إليه من الآلات المتخذة من الخشب، من أي نوع كان.
وكذلك قد يحتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح والدسر، وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكله، ليكون ذلك الشكل أعون لها على مصادمة الماء، وجعل لها عوض الحركة الحيوانية التي للسمك تحريك الرياح. وربما اعينت بحركة المجاذيف كما في الأساطيل. وهذه الصناعة من أصلها محتاجة إلى جزء كبير من الهندسة في جميم أصنافها، لأن إخراج الصور من القوة إلى الفعل على وجه الإحكام، محتاج إلى معرفة التناسب في المقادير، إما عموماً أو خصوصاً. وتناسب المقادير لا بد فيه من الرجوع إلى المهندس.
ولهذا كان أئمة الهندسة اليونانيون كلهم أئمة في هذه الصناعة، فكان أوقليدس صاحب كتاب الأصول في الهندسة نجاراً وبها كان يعرف. وكذلك أبلونيوس صاحب كتاب المخروطات وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه الصناعة في الخليقة هو نوح عليه السلام، وبها أنشأ سفينة النجاة التي كانت بها معجزته عند الطوفان. وهذا الخبر وإن كان ممكناً أعني كونه نجاراً، إلا أن كونه أول من علمها أو تعلمها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الآماد. وإنما معناه والله أعلم الإشارة إلى قدم النجارة لأنه لم تصح حكاية عنها قبل خبر نوح عليه السلام، فجعل كأنه أول من تعلمها. فتفهم أسرار الصنائع في الخليقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق.
الفصل السابع والعشرون
في صناعة الحياكة والخياطة
اعلم أن المعتدلين من بشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبرد. ولا بد لذلك من إلحام الغزل حتى يصير ثوباً واحداً، وهو النسج والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه وإن مالوا إلى الحضارة فصلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدرون منها ثوباً على البدن بشكله وتعدد أعضائه واختلاف نواحيها. ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوباً واحداً على البدن ويلبسونها. والصناعة المحصلة لهذه الملاءمة هي الخياطة. وهاتان الصناعتان ضروريتان في الغمران، لما يحتاج إليه البشر من الرفه. فالأولى لنسج الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداء في الطول وإلحاماً في العرض وإحكاماً لذلك النسج بالالتحام الشديد، فيتم منها قطع مقدرة: فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال، ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة الثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعوائد، تفصل أولاً بالمقراض قطعاً مناسبة للأعضاء البدنية، ثم تلحم تلك القطع بالخياطة المحكمة وصلاً أو حبكاً أوتنبيتاً أو تفتيحاً على حسب نوع الصناعة.وهذه الثانية مختصة بالعمران الحضري لما أن أهل البدو يستغنون عنها، وإنما يشتملون الأثواب اشتمالاً. وإنما تفصيل الثياب وتقديرها وإلحامها بالخياطة للباس من مذاهب الحضارة وفنونها. وتفهم هذا في سر تحريم المخيط في الحج، لما أن مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى. " كما خلقنا أول مرة " . حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه، لا طيباً ولا نساء ولا مخيطاً ولاخفاً، ولايتعرض لصيد ولا لشيء من عوائده التي تكونت بها نفسه وخلقه، مع أنه يفقدها بالموت ضرورة. وإنما يجيء كأنه وارد على المحشر ضارعاً بقلبه مخلصاً لربه، وكان جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
سبحانك ما أرفقك بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك.
وهاتان الصنعتان قديمتان في الخليقة لما أن الدفء ضروري للبشر في العمران المعتدل. وأما المنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء. ولهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من السودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه الصنائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه السلام، وهو أقدم الأنبياء. وربما ينسبونها إلى هرمس، وقد يقال: إن هرمس هو إدريس. والله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم.
الفصل الثامن والعشرون
في صناعة التوليد
وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه، من الرفق في إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك. ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي مختصة بالنساء في غالب الأمر، لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء والقبول، كأن النفساء تعطيها الجنين وكأنها تقبله. وذلك أن الجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته، والمدة التي قدر الله لمكثه، وهي تسعة أشهر في الغالب، فيطلب الخروج بما جعل الله في المولود من النزوع لذلك، وبضيق عليه المنفذ فيعسر. وربما مزق بعض جوانب الفرج بالضغط، وربما انقطع بعض ما كان في الأغشية من الالتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام يشتد لها الوجع، وهو معنى الطلق، فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل تساوق بذلك فعل الدافعة في إخراج الجنين، وتسهيل ما يصعب منه بما يمكنها، وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. ثم إذا خرج الجنين بقيت بينة وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة من سرته بمعاه. وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود خاصة، فتقطعها القابلة من حيث لا تتعدى مكان الفضيلة ولا تضر بمعاه ولا برحم أمه، ثم تحمل مكان الجراحة منه بالكي أو بما تراه من وجوه الاندمال. ثم إن الجنين عند خروجه من ذلك المنفذ الضيق، وهو رطب العظام سهل الانعطاف والانثناء، فربما تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد، فتتناوله القابلة بالغمز والإصلاح، حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه المقدر له، ويرتد خلقه سوياً. ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين، لأنها ربما تتأخر عن خروجه قليلاً. ويخشى عند ذلك أن تراجع الماسكة حالها الطبيعية قبل استكمال خروج الأغشية، وهي فضلات، فتتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع الهلاك، فتحاذر القابلة هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن كانت قد تأخرت، ثم ترجع إلى المولود فتمرخ أعضاءه بالأدهان والذرورات القابضة، لتشده، وتجفف رطوبات الرحم، وتحنكه لرفع لهاته، وتسعطه لاستفراغ نطوف دماغه، وتغرغره باللعوق لدفع السدد من معاه وتجويفها عن الالتصاق. ثم تداوي النفساء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق، وما لحق رحمها من ألم الانفصال، إذ المولود وإن لم يكن عضواً طبيعياً فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام كالعضو المتصل، فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما يلحق الفرج من ألم، من جراحة التمزيق عند الضغط في الخروج. وهذه كلها أدواء نجد هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه إلى حين الفصال نجدهن أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في تلك الحالة إنما هو بدن إنساني بالقوة فقط. فإذا جاوز الفصال صار بدناً إنسانيا بالفعل، فكانت حاجته حينئذ إلى الطبيب أشد. فهذه الصناعة كما تراه ضرورتة في العمران للنوع الإنساني، لا يتم كون أشخاصه في الغالب دونها.
وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعة: إما بخلق الله ذلك لهم معجزة وخرقاً للعادة، كما في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أو بإلهام وهداية، يلهم لها المولود ويفطر عليها، فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة. فأما شأن المعجزة من ذلك، فقد وقع كثيراً. ومنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسروراً مختوناً، واضعاً يديه على الأرض شاخصاً ببصره إلى السماء. وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. وأما شأن الإلهام فلا ينكر. وإذا كانت الحيوانات العجم تختص بغرائب من الإلهامات كالنحل وغيرها، فما ظنك بالإنسان المفضل عليها. وخصوصاً من اختص بكرامة الله.
ثم الإلهام العام للمولودين في الإقبال على الثدي أوضح شاهد على وجود الإلهام العام لهم. فشأن العناية الإلهية أعظم من أن يحاط به. ومن هنا يفهم بطلان رأي وحكماء الأندلس، فيما احتجوا به لعدم انقراض الأنواع، واستحالة انقطاع المكونات. وخصوصاً في النوع الإنساني. وقالوا: لو انقطعت أشخاصه لاستحال وجودها بعد ذلك، لتوقفه على وجود هذه الصناعة التي لا يتم كون الإنسان إلا بها. إذا لو قدرنا مولوداً دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الفصال لم يتم بقاؤه أصلاً. ووجود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعة له. وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه، وذهابه إلى إمكان انقطاع الأنواع، وخراب عالم التكوين، ثم عوده ثانياً لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تندر في الأحقاب بزعمه، فتقتضي تخمير طينة مناسبه لمزاجه بحرارة مناسبة، فيتم كونه إنساناً. ثم يقيض له حيوان يخلق فيه إلهاماً لتربيته والحنو عليه إلى أن يتم وجوده وفصاله وأطنب في بيان ذلك في الرسالة التي سماها رسالة حي بن يقظان وهذا الاستدلال غير صحيح، وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع، لكن من غير ما استدل به. فإن دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجبة ودليل القول بالفاعل المختار يرد عليه، ولا واسطة على القول بالفاعل المختار بين الأفعال والقدرة القديمة، ولا حاجة إلى هذا التكلف.
ثم لو سلمناه جدلاً، فغاية ما ينبني عليه اطراد وجود هذا الشخص بخلق الإلهام، لتربيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان الإلهام يخلق في الحيوان الأعجم، فما المانع من خلقه للمولود نفسه، كما قررناه أولاً. وخلق الإلهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره، فكلا المذهبين شاهدان كلى أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك. والله تعالى أعلم.
الفصل التاسع والعشرون
في صناعة الطب
وأنها محتاج إليها في الحواضر والأمصار دون البادية هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتها، فإن ثمرتها حفظ، للأصحاء، ودفع المرض عن المرضى بالمداواة، حتى يحصل لهم البرء من أمراضهم. واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة، وإن طعن فيه العلماء، وهو قوله: " المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأصل كل داء البردة " . فأما قوله: المعدة بيت الداء، فهو ظاهر، وأما قوله الحمية رأس الدواء، فالحمية الجوع وهو الاحتماء عن الطعام. والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل الأدوية، وأما قوله: أصل كل داء البردة، فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدة، قبل أن يتم هضم الأول. وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله بالأكل، وينفذ فيه القوى الهاضمة والغاذية إلى أن يصير دماً ملائماً لأجزاء البدن من اللحم والعظم. ثم تأخذه النامية فينقلب لحماً وعظماً. ومعنى الهضم طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصير جزءاً بالفعل من البدن. وتفسيره أن الغذاء، إذا حصل في الفم ولاكته الأشداق، أثرت فيه حرارة الفم طبخاً يسيراً، وقلبت مزاجه بعض الشيء، كما تراة في اللقمة إذا تناولتها طعاماً، ثم أجدتها مضغاً، فترى مزاجها غير مزاج الطعام. ثم يحصل في المعدة فتطبخه حرارة المعدة إلى أن يصير كيموساً وهو صفو ذلك المطبوخ، وترسله إلى الكبد وترسل ما رسب منه في المعاء ثفلاً، ثم ينفذ إلى المخرجين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دماً عبيطاً وتطفو عليه رغوة من الطبخ هي الصفراء. وترسب منه أجزاء يابسة هي السوداء، ويقصر الحار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. ثم ترسلها الكبد كلها في العروق والجداول، ويأخذها طبخ الحار الغريزي هناك، فيكون عن الدم الخالص بخار حار رطب يمد الروح الحيواني. وتأخذ النامية مأخذها في الدم فيكون لحماً، ثم غليظه عظاماً. ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضلات مختلفة من العرق واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل لحماً.ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميات. وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن إتمام النضج في طبخه في كل طورمن هذه، فيبقى ذلك الغذاء دون نضج. وسببه غالباً كثرة الغذاء في المعدة، حتى يكون أغلب على الحار الغريزي، أو إدخال الطعام إلى المعدة قبل أن تستوفي طبخ الأول، فيشتغل به الحار الغريزي ويترك الأول بحاله. أو يتوزع عليهما فيقصر عن تمام الطبخ والنضج. وترسله المعدة كذلك إلى الكبد، فلا تقوى حرارة الكبد أيضاً على إنضاجه. وربما بقي في الكبد من الغذاء الأول فضلة غير ناضجة. وترسل الكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو. فإذا أخذ البدن حاجته الملائمة أرسله مع الفضلات الأخرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك. وربما يعجز عن الكثير منه، فيبقى في العروق والكبد والمعدة، وتتزايد مع الأيام. وكل ذي رطوبة من الممتزجات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج يعفن، فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وهو المسمى بالخلط. وكل متعفن ففيه حرارة غريبة، وتلك هي المسماة في بدن الإنسان بالحمى.
واعتبر ذلك بالطعام إذا ترك حتى يتعفن وفي الزبل إذا تعفن أيضاً، كيف تنبعث فيه الحرارة وتأخذ مأخذها. فهذا معنى الحميات في الأبدان وهي رأس الأمراض، وأصلها كما وقع في الحديث. ولهذه الحميات علاجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة ثم تناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه. وكذلك في حال الصحة له علاج في التحفظ من هذا المرض وغيره، وأصله كما وقع في الحديث. وقد يكون ذلك العفن في عضو مخصوص، فيتولد عنه مرض في ذلك العضو، أوتحدث جراحات في البدن: إما في الأعضاء الرئيسة، أو في غيرها. وقد يمرض العضو ويحدث عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها جماع الأمراض، وأصلها في الغالب من الأغذية، وهذا كله مرفوع إلى الطبيب.
ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر، لخصب عيشهم، وكثرة مآكلهم، وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الأغذية، وعدم توقيتهم لتناولها. وكثيراً ما يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه، رطباً ويابساً، في سبيل العلاج بالطبخ، ولا يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع. فربما عددنا في اللون الواحد من ألوان الطبخ أربعين نوعاً من النبات والحيوان، فيصير للغذاء مزاج غريب. وربما يكون بعيداً عن ملاءمة البدن وأجزائه. ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات. والأهوية منشطة للأرواح ومقوية بنشاطها لأثر الحار الغريزي في الهضم. ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار، إذ هم في الغالب وادعون ساكنون، لا تأخذ منهم الرياضة شيئاً، ولا تؤثر فيهم أثراً، فكان وقوع الأمراض كثيراً في المدن والأمصار، وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة.
وأما أهل البدو فمأكولهم قليل في الغالب، والجوع أغلب عليهم لقلة الحبوب، حتى صار لهم ذلك عادة. وربما يظن أنها جبلة لاستمرارها. ثم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة بالجملة وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو إليه ترف الحضارة الذين هم بمعزل عنه، فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها ويقرب مزاجها من ملاءمة البدن. وأما أهويتهم فقليلة العفن، لقلة الرطوبات والعفونات، إن كانوا آهلين، أو لاختلاف الأهوية إن كانوا ظواعن.
ثم إن الرياضة موجودة فيهم من كثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب الحاجات أو مهنة أنفسهم في حاجاتهم، فيحسن بذلك كله الهضم ويجود ويفقد إدخال الطعام على الطعام. فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد عن الأمراض، فتقل حاجتهم إلى الطب. ولهذا لا يوجد الطبيب في البادية بوجه. وما ذاك إلا للاستغناء عنه، إذ لو احتيج إليه لوجد. لأنه يكون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سكناه. " سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاً " .
الفصل الثلاثون
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية
وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية، وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان. وأيضاً فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأذى بها الأغراض إلى البلد البعيد، فتقضى الحاجات، وقد دفعت مؤونة المباشرة لها، ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين، وما كتبوه في علومهم وأخبارهم، فهي شريفة بجميع هذه الوجوه والمنافع. وخروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم، وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك، تكون جودة الخط في المدينة إذ هو من جملة الصنائع. وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران، ولهذا نجد أكثر البدو أميين لا يكتبون ولا يقرأون، ومن قرأ منهم أوكتب فيكون خطه قاصراً وقراءته غير ناففة. ونجد تعليم الخط في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقاً، لاستحكام الصنعة فيها. كما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد، وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط يلقون على المتعلم قوانين وأحكاماً في وضع كل حرف، ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه، فتعتضد لديه رتبة العلم والحس في التعليم، وتأتي ملكته على أتم الوجوه.
وإنما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال.
وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده، على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم، وإنما يتعلم بمحاكاة الخط من كتابة الكلمات جملة. ويكون ذلك من المتعلم ومطالعة المعلم له، إلى أن يحصل له الإجادة ويتمكن في بنانه الملكة، فيسمى مجيداً. وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغة من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة، لما بلغت من الحضارة والترف، وهو المسمى بالخط الحميري. وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة إلى المنذر نسباء التبابعة في العصبية، والمجددين لملك العرب بأرض العراق. ولم يكن الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة، لقصور ما بين الدولتين. فكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك. ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية ويقال حرب بن أمية، وأخذها من أسلم بن سدرة. وهو قول ممكن، وأقرب ممن ذهب إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم:
قوم لهم ساحة العراق، إذا ... ساروا جميعاً، والخط والقلم
وهو قول بعيد لأن إياداً، وإن نزلوا ساحة العراق، فلم يزالوا على شأنهم من البداوة. والخط من الصنائع الحضرية. وإنما معنى قول الشاعر أنهم أقرب إلى الخط والقلم من غيرهم من العرب، لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها، فالقول بأن أهل الحجاز إنما لقنوها من الحيرة، ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال. ورأيت في كتاب التكملة لابن الأبار، عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي، من أصحاب مالك رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا معشر قريش خبروني عن هذا الكتاب العربي، هل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث الله محمداً، صلى الله عليه وسلم تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق، مثل الألف واللام، والميم والنون؟ قال: نعم، قلت: وممن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أمية. قلت: وممن أخذه حرب؟ قال: من عبد الله بن جدعان. قلت: وممن أخذه عبد الله بن جدعان؟ قال من أهل الأنبار. قلت: وممن أخذه أهل الأنبار؟ قال: من طارىء طرأ عليه من أهل اليمن. قلت: وممن أخذه ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود النبي عليه السلام. وهو الذي يقول:
أفي كل عام سنة تحدثونها ... ورأي على غير الطريق يعبر
وللموت خير من حياة تسبنا ... بهاجرهم فيمن يسب وحمير
انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب التكملة. وزاد في آخره: حدثني بذلك أبو بكر بن أبي حميرة في كتابه عن أبي بحر بن العاص عن أبي الوليد الوقشي عن أبي عمر الطلمنكي ابن أبي عبد الله بن مفرح. ومن خطه نقلته عن أبي سعيد بن يونس عن محمد بن موسى بن النعمان عن يحيى بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب المعافري التونسي عن بهلول بن عبيدة الحمي عن عبد الله بن فروخ. انتهى.
وكان لحمير كتابة تسمى المسند حروفها منفصلة، وكانوا يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم. ومن حمير تعلمت مضر الكتابة العربية، إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو، فلا تكون محكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثر، فكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم لهذا العهد، أو نقول إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة، لأن هؤلاء أقرب إلى الحضارة ومخالطة الأمصار والدول. وأما مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومصر، فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوحش لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع.
وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم، وكانت غير مستحكمة في الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاً، ويتبع رسمه خطأ أو صواباً. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه، فاتبع ذلك وأثبت رسماً، ونبه العلماء بالرسم على مواضعه.
ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم أصول الرسم ليس كما يتخيل، بل لكلها وجه. ويقولون في مثل زيادة الألف في لا أذبحنه: إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في بأييد إنه تنبية على كمال القدرة الربانية، وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال، فنزهوهم عن نقصه، ونسبوا إليهم الكمال بإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح. واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر. والكمال في الصنائع إضافي، وليس بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال، وإنما يعود على أسباب المعاش، وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمياً، وكان ذلك كمالاً في حقه، وبالنسبة إلى مقامه، لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية، التي هي أسباب المعاش والعمران كلها. وليست الأمية كمالاً في حقنا نحن، إذ هو منقطع إلى ربه، ونحن متعاونون على الحياة الدنيا، شأن الصنائع كلها، حتى العلوم الاصطلاحية. فإن الكمال في حقه هو تنزهه عنها جملة بخلافنا.
ثم لما جاء الملك للعرب، وفتحوا الأمصار، وملكوا الممالك ونزلوا البصرة والكوفة، واحتاجت الدولة إلى الكتابة، استعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلموه وتداولوه، فترقت الإجادة فيه، واستحكم، وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان، إلا أنها كانت دون الغاية. والخط الكوفي معروف الرسم لهذا العهد.
ثم انتشرت العرب في الأقطار والممالك، وافتتحوا إفريقية والأندلس، واختط بنو العباس بغداد وترقت الخطوط فيها إلى الغاية، لما استبحرت في العمران، وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية، وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة، في الميل إلى إجادة وجمال الرونق وحسن الرواء. واستحكمت هذه المخالفة في الأمصار إلى أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير ثم تلاه في ذلك علي بن هلال، الكاتب الشهير بابن البواب، ووقف سند تعليمها عليه في المائة الثالثة وما بعدها. وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة، حتى انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه، حتى انتهت إلى المتأخرين مثل ياقوت والولي علي العجمي. ووقف سند تعليم الخط عليهم، وانتقل ذلك إلى مصر، وخالفت طريقة العراق بعض الشيء، ولقنها العجم هنالك، فظهرت مخالفة لخط أهل مصر أو مباينة. وكان الخط الإفريقي المعروف رسمه القديم لهذا العهد يقرب من أوضاع الخط المشرقي. وتميز ملك الأندلس بالأمويين، فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط، فتميز صنف خطهم الأندلسي، كما هو معروف الرسم لهذا العهد. وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطر. وعظم الملك ونفقت أسواق العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها، وملئت بها القصور والخزائن الملوكية بما لا كفاء له، وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه.
ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك أجمع، ودرست معالم بغداد بدروس الخلافه، فانتقل شأنها من الخط والكتابة، بل والعلم إلى مصر والقاهرة، فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد. وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها. وأشكالها متعارفة بينهم. فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على أشكال تلك الأوضاع. وقد لقنها حسناً وحلقاً فيها دربة وكتاباً، وأخذها قوانين عملية فتجيء أحسن ما يكون.
وأما أهل الأندلس، فافترقوا في الأقطار، عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من البربر، وتغلبت عليهم أمم النصرانية، فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية، من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهد. وشاركوا أهل الغمران بما لديهم من الصنائع، وتعلقوا بأذيال الدولة، فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفى عليه. ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما. وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها، لتوفر أهل الأندلس بها عند الجالية من شرق الأندلس.
وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم يخالطوا كتاب الأندلس ولا تمرسوا بجوارهم. إنما كانوا يفدون على دار الملك بتونس، فصار خط أهل إفريقية من أحسن خطوط أهل الأندلس، حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الشيء، وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع العمران، نقص حينئذ حال الخط وفسدت رسومه، وجهل فيه وجه التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران. وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي، تشهد بما كان لهم من ذلك، لما قدمناه من أن الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها. وحصل في دولة بني مرين من بعد ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي، لقرب جوارهم وسقوط من خرج منهم إلى فاس قريباً، واستعمالهم اياهم سائر الدولة. ونسي عهد الخط فيما بعد عن سدة الملك وداره كأنه لم يعرف. فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدة عن الجودة، وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحصل لمتصفحها منها، إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة، حتى لا تكاذ تقرأ إلا بعد عسر. ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع، بنقص الحضارة وفساد الدول. والله يحكم لا معقب لحكمه.
ولًلاستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البواب قصيدة من بحر البسيط على روي الراء يذكر فيها صناعة الخط وموادها. من أحسن ما كتب في ذلك. رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه الصناعة. واولها:
يا من يريد إجادة التحرير ... ويروم حسن الخط والتصوير
إن كان عزمك في الكتابة صادقاً ... فارغب إلى مولاك في التيسير
أعدد من الأقلام كل مثقف ... صلب يصوغ صناعة التحبير
وإذا عمدت لبريه فتوخه ... عند القياس بأوسط التقدير
انظر إلى طرفيه فاجعل بريه ... من جانب التدقيق والتخضير
واجعل لجلفته قواماً عادلاً ... خلوا عن التطويل والتقصير
والشق وسطه ليبقى بريه ... من جانبيه مشاكل التقدير
حتى إذا اتقنت ذلك كله ... فالقط فيه جملة التدبير
لاتطمعن في أن أبوح بمسزه إني أضن بسره المستور
لكن جملة ما أقول بأنه ... ما بين تحريف إلى تدوير
وألق دواتك بالدخان مدبراً ... بالخل أو بالحصرم المعصور
وأضف إليه مغرة قد صولت ... مع أصفر الزرنيخ والكافور
حتى إذا ما خمرت فاعمد إلى ... الورق النقي الناعم المخبور
فاكبسه بعد القطع بالمعصار كي ... ينأى عن التشعيث والتغيير
ثم اجعل التمثيل دأبك صابراً ... ما أدرك المأمول مثل صبور
ابدأ به في اللوح منتضياً له ... عزماً تجرده عن التشمير
لاتخجلن من الردى تختطه ... في أول التمثيل والتسطير
فالأمر يصعب ثم يرجع هيناً ... ولرب سهل جاء بعد عسير
حتى إذا أدركت ما أملته ... أضحيت رب مسرة وحبور
فاشكر إلهك واتبع رضوانه ... إن الإله يجيب كل شكور
وارغب لكفك أن تخط بنانها ... خيراً تخلفه بدار غرور
فجميع فعل المرء يلقاه غداً ... عند الشقاء كتابة المنشور
واعلم بأن الخط بيان عن القول والكلام، كما أن القول والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني، فلا بد لكل منهما ان يكون واضح الدلالة.
قال الله تعالى: " خلق الإنسان، علمه البيان " وهو يشتمل بيان الأدلة كلها. فالخط المجرد كماله أن تكون دلالته واضحة، بإبانة حروفه المتواضعة وإجادة وضعها ورسمها كل واحد على حدة متميزعن الاخر، إلأ ما اصطلح عليه الكتاب من إيصال حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض، سوى حروف اصطلحوا على قطعها، مثل الألف المتقدمة في إلكلمة، - وكذا الراء والزأي والدال والذال وغيرها، بخلاف ما إذا كانت متأخرة، وهكذا إلى آخرها. ثم ان المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات، بعضها ببعض، وحذف حروف معروفة عندهم، لا يعرفها إلا أهل مصطلحهم فتستعجم على غيرهم. وهؤلاء كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاة، كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غيرهم، لكثرة موارد الكتابة عليهم، وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من دونهم بمصطلحهم. فإن كتبوا ذلك لمن لا خبرة له بمصطلحهم فينبغي أن يعدلو عن ذلك إلى البيان ما أستطاعوه، وإلا كان بمثابة الخط الأعجمي، لأنهما بمنزلةواحدة من عدم التواضع عليه. وليس بعذر في هذا القدر إلا كتاب الأعمال السلطانية في الأموال والجيوش، لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس ، فإنه من الأسرار السلطانية التي يجب إخفاؤها، فيبالغون في رسم اصطلاح خاص بهم، ويصير بمثابة المعمي 5وهو الاصطلاح على العبارة عن الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الازاهر، ووضع أشكال اخرى غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتادية ما في ضمائرهم با لكتابة. وربما وضع الكتاب للعثور على ذلك، وإن لم يضعوه أولأ، قوانين بمقاييس استخرجوها لذلك بمداركهم يسمونها فك المعمى. وللناس في ذلك دواوين مشهورة. والله العليم الحكيم.
الفصل الحادي والثلاثون
في صناعة الوراقة
كاذت العناية قديما بالدواوين العلمية والسجلات، في نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران، بعد ان كان منه في الملة الإسلامية بحر زاخر بالعراق والأندلس، إذ هو كله من توابع العمران واتساع نطاق الدولة ونفاق أسواق ذلك لديهما. فكثرت التآليف العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناقلهما في الآفاق والأعصار فانتسخت وجلدت. وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتيبة والدواوين، واختصت بالأمصار العظيمة العمران. وكانت السجلات أولاً لانتساخ العلوم، وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات، والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد، لكثرة الرفه وقلة التآليف صدر الملة كما نذكره، وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك ، فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريفا للمكتوبات وميلًا بها إلى الصحة والإتقان.
ثم طما بحر التآليف والتدوين، وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد، وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه. واتخذه الناس من بعده صحفًا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية. وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت. ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول، على ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلفيها وواضعيها، لأنه. الشأن الأهم من التصحيح والضبط، فبذلك تسند الأقوال إلى قائلها، والفتيا إلى الحاكم بها المجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها، فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتيا. وهكذا كان شأن أهل العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق. حتى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فقط، إذ ثمرتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعها، قد ذهبت وتمخضت زبدة في تلك الأمهات المتلقاة بالقبول عند الأمة. وصار القصد إلى ذلك لغواً من العمل. ولم تبق ثمرة الرواية والاشتغال بها، إلا في تصيحيح تلك الأمهات الحديثية، وسواها من كتب الفقه للفتيا، وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية، واتصال سندها بمؤلفيه، ليصح النقل عنهم والإسناد إليهم. وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبدة الطرق واضحة المسالك. ولهذا نجذ الدواوين المنسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة. ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك. وأهل الأفاق يتناقلونها إلي الآن ويشدون عليها يد الضنانة. ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله، لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله. وصارت الأمهات والدواوين تنسخ بالخطوط البدوية، ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد والتصحيف، فتستغلق على متصفحها، ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقل النادر.
وأيضاً فقد دخل الخلل من ذلك في الفتيا، فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن أئمة المذاهب، وإنما تتلقى من تلك الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً ما يتصدى إليه بعض أئمتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته، وعدم الصنائع الوافية بمقاصده. ولم يبق من هذا الرسم بالأندلس، إلا إثارة خفية بالأنحاء، وهي على الاضمحلال. فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. والله غالب على أمره.
ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق، وتصحيح الدواوين لمن يرومه بذلك سهل على مبتغيه، لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكره بعد. إلا أن الخط الذي بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إنما هو للعجم، وفي خطوطهم. وأما النسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق.
الفصل الثاني والثلاثون
في صناعة الغناء
هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة، بتقطيع الأصواات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند قطعه فيكون نغمة. ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب، وما يحدث عنه من الكيفية فى تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب، فيكون: صوت، نصف صوت وربع آخر، وخمس آخر، وجزء من أحد عشر من آخر. واختلاف هذه النسب، عند تأديتها إلى السمع، يخرجها من البساطة إلى التركيب. وليس كل تركيب منها ملذوذاً عند السماع، بل للملذوذ تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم الموسيقى، وتكلموا عليها كما هو مذكوز في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات، إما بالقرع أو بالنفخ في آلات تتخذ لذلك، فتزيدها لذة عن السماع. فمنها لهذا العهد بالمغرب أصناف: منها المزمار ويسمونه الشبابة، وهي قصبة جوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة، ينفخ فيها فتصوت. ويخرج الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأبخاش. ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعاً على تلك الأبخاش وضعاً متعارفاً، حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه، وتتصل كذلك متناسبة، فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. ومن جنس هذه الألة المزمار الذي يسفى الزلامي، وهو شكل القصبة منحوتة الجانبين من الخشب، جوفاء من غير تدوير لأجل ائتلافها من قطعتين منفوذتين كذلك بأبخاش معدودة، ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل، فينفذ النفخ بواسطتها إليها، وتصوت بنغمة حادة. ويجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة.
ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق، وهو بوق من نحاس، أجوف في مقدار الذراع، يتسع إلى أن يكون انفراج مخرجه في مقدار دور الكف في شكل بري القلم.
وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدي الريح من الفم إليه، فيخرج الصوت ثخيناً دوياً، وفيه أبخاش أيضاً معدودة. وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على التناسب، فيكون ملذوذاً. ومنها آلات الأوتار وهي جوفاء كلها: إما على شكل قطعة من الكرة، مثل البربط والرباب، أو على شكل مربع كالقانون، توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دسر جائلة ليتأتى شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها. ثم تقرع الأوتار إما بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي قوسي يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر. ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر. واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأوتار، فيما يقرع أو يحك بالوتر، فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون القرع في الطسوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها ببعض، على توقيع متناسب يحدث عنه التذاذ بالمسموع.
ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. وذلك أن اللذة كما تقرر في موضعه هي إدراك الملائم، والمحسوس إنما تدرك منه كيفية. فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة كانت ملذوذة، وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. فالملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجها، وكذا الملائم من الملموسات، وفي الروائح، ما ناسب مزاج الروح القلبي البخاري لأنه المدرك، وإليه تؤديه الحاسة. ولهذا كانت الرياحين والأزهار العطريات أحسن رائحة وأشد ملاءمة للروح، لغلبة الحرارة فيها، التي هي مزاج الروح القلبي.
وأما المرئيات والمسموعات فالملائم فيها تناسب الأوضاع في أشكالها وكيفياتها، فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة لها. فإذا كان المرئي متناسباً في أشكاله وتخاطيطه التي له بحسب مادته، بحيث لا يخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة والوضع، وذلك هو معنى الجمال والحسن في كل مدرك، كان ذلك حينئذ مناسباً للنفس المدركة فتلتذ بإدراك ملائمها. ولهذا تجد العاشقين المستهترين في المحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج أرواحهم بروح المحبوب. وفي هذا سر تفهمه إن كنت من أهله، وهو اتحاد المبدإ، وإن كل ما سواك إذا نظرته وتأملته رأيت بينك وبينه اتحاداً في البداية، يشهد لك به اتحادكما في الكون. ومعناه من وجه آخر أن الوجود يشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماء. فتود أن تمتزج بما شاهدت فيه الكمال لتتحد به، بل تروم النفس حينئذ الخروج عن الوهم إلى الحقيقة التي هي اتحاد المبدإ والكون. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى مدرك الكمال في تناسب موضوعها هو شكله الإنساني، فكان إدراكه للجمال والحسن في تخاطيطه وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى فطرته، فيلهج كل إنسان بالحسن في المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة. والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك، والتناسب فيها هو الذي يوجب لها الحسن.
فأولاً: أن لا يخرج من الصوت إلى مدة دفعة بل بتدريج، ثم يرجع كذلك وهكذا إلى المثل، بل لا بد من توسط المغاير بين الصوتين. وتأمل هذا من استقباح أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج، فإنه من بابه.
وثانياً: تناسبها في الأجزاء كما مر أول الباب، فيخرج من الصوت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه، على حسب ما يكون التنقل مناسباً على ما حصره أهل صناعة الموسيقى. فإذا كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائمة ملذوذة. ومن هذا التناسب ما يكون بسيطاً، ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه، لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة، كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمثال ذلك. وتسمي العامة هذه القابلية بالمضمار. وكثير من القراء بهذه المثابة، يقرأون القرآن، فيجيدون في تلاحين أصواتهم كأنها المزامير فيطربون بحسن مساقهم وتنا سب نغماتهم. ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب، وليس كل الناس يستوي في معرفته ولا كل الطبائع توافق صاحبها في العمل به إذا علم.
وهذا هو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى، كما نشرحه بعد عند ذكر العلوم. وقد أنكر مالك رحمه الله تعالى القراءة بالتلحين، وأجازها الشافعي رضي الله تعالى عنه. وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، فإنه لا ينبغي أن يختلف في حظره، إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، لأن القراءة والأداء تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء الحروف من حيث إتباع الحركات في مواضعها، ومقدار المد عند من يطلقة أو يقصره، وأمثال ذلك. والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين. فاعتبار أحدهما قد يخل بالأخر إذا تعارضا. وتقديم التلاوة متعين فراراً من تغيير الرواية المنقولة في القرآن، فلا يمكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه. وإنما المراد عن اختلافهم التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه، فيردد أصواته ترديداً على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره، ولا ينبغبي ذلك بوجه كما قاله مالك. هذا هو محل الخلاف. والظاهر تنزية القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى، لأن القرآن هو محل خشوع بذكر الموت وما بعده وليس مقام التذاذ بإدراك الحسن من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كما في أخبارهم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود، فليس المراد به الترديد والتلحين، إنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. وإذ قد ذكرنا معنى الغناء، فاعلم أنه يحدث في العمران، إذا توفر وتجاوز حد الضرروي إلى الحاجي، ثم إلى الكمالي، وتفننوا فيه، فتحدث هذه الصناعة. لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها، إلا الفارغون عن سائر أحوالهم تفنناً في مذاهب الملذوذات. وكان في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم. وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به، حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة، ولهم مكان في دولتهم، وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها. وهذا شأن العجم لهذا العهد في كل أفق من آفاقهم، ومملكة من ممالكهم.
وأما العرب فكان لهم أولاً فن الشعر، يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها، في عدة حروفها المتحركة والساكنة ويفضلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلاً يكون كل جزء منها مستقلاً بالإدادة، لا ينعطف على الآخر. ويسمونه البيت فيلائم الطبع بالتجزئة أولاً، ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع والمبادىء، ثم بتأدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها. فلهجوا به فامتاز من بين كلامهم بحظ من الشرف ليس لغيره، لأجل اختصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديواناً لأخبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكاً لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة الأساليب. واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف، قطرة من بحر من تناسب الأصوات، كما هو معروف في كتب الموسيقى. إلا أنهم لم يشعروا بما سواه، لأنهم حينئذ لم ينتحلوا علماً ولا عرفوا صناعة. وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم، والفتيان في قضاء خلواتهم، فرجعوا الأصوات وترنموا. وكانوا يسمون الترنم إذا كان بالشعر غناء وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغييراً بالغين المعجمة والباء الموحدة. وعللها أبو إسحق الزجاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي، أي بأحوال الآخرة. وربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة، كما ذكره ابن رشيق آخر كتاب العمدة وغيره. وكانوا يسمونه السناد، وكان أكثر ما يكون منهم في الخفيف الذي يرقص عليه ويمشي بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم. وكانوا يسمون هذا الهزج، وهذا البسيط، كله من التلاحين هو من أوائلها، ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شأن البسائط كلها من الصنائع.
ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلما جاء الإسلام، واستولوا على ممالك الدنيا، وحازوا سلطان العجم، وغلبوهم عليه، وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ. وما ليس بنافع في دين ولا معاش، فهجروا ذلك شيئاً ما. ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي كان دينهم ومذهبهم. فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب، وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والزمامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات ولحنوا عليها أشعارهم.
وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب وحائر مولى عبد الله بن جعفر، فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر. ثم أخذ عنهم معبد وطبقته وابن سريج وأنظاره. وما زالت صناعة الغناء تتمزج إلى أن كملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي، وإبراهيم الموصلي وابنه إسحق وابنه حماد. وكان من ذلك في دولتهم ببغداد، ما تبعه الحديث بعده به وبمجالسه لهذا العهد، وأمعنوا في اللهو واللعب، واتخذت آلات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار التي يترنم بها عليه. وجعل صنفاً وحده، واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرج، وهي تماثيل خيل مسرجة من الخشب، معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان، ويحاكين بها امتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويتثاقفون، وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو.
وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. وكان للموصليين غلام اسمه زرياب، أخذ عنهم الغناء فأجاد، فصرفوه إلى المغرب غيرة منه، فلحق بالحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس. فبالغ في تكرمته، وركب للقائه وأسنى له الجوائز والإقطاعات والجرايات، وأحله من دولته وندمائه بمكان. فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف. وطما منها بإشبيلية بحر زاخر، وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب. وانقسم على أمصارها، وبها الأن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها. وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من الوظائف، إلا وظيفة الفراغ والفرح. وهي أيضاً أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. والله أعلم.
الفصل الثالث والثلاثون
في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا
ًوخصوصاً الكتابة والحساب قد ذكرنا في الكتاب أن النفس الناطقة للإنسان، إنما توجد فيه بالقوة. وأن خروجها من القوة إلى الفعل إنما هو بتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولاً، ثم ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً، فتكون ذاتاً روحانية وتستكمل حينئذ وجودها. فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلاً فريداً، والصنائع أبداً يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة. فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلاً، والملكات الصناعية تفيد عقلاً، والحضارة الكاملة تفيد عقلاً، لأنها مجتمعة من صنائع في شأن تدبير المنزل، ومعاشرة أبناء الجنس، وتحصيل الآداب في مخالطتهم، ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانين تنتظم علوماً، فيحصل منها زيادة عقل.
والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك، لأنها تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الصنائع. وبيانه أن في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس، فهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل، ما دام ملتبساً بالكتابة وتتعود النفس ذلك دائماً. فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات، وهو معنى النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم المجهولة، فتكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل. ويحصل به مزيد فطنة وكيس في الأمور، لما تعودوه من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى في كتابه، لما رآهم بتلك الفطنة والكيس، فقال: " ديوانه، أي شياطين أو جنون " . قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. ويلحق بذلك الحساب فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفريق، يحتاج فيه إلى استدلال كثير، فيبقى متعوداً للاستدلال والنظر، وهو معنى العقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلاً ما تشكرون.
الباب السادس من الكتاب الأول
في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه
وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق فالمقدمة في الفكر الإنساني، الذي تميز به البشر عن الحيوانات واهتدى به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه والنظر في معبوده وما جاءت به الرسل من عنده، فصار جميع الحيوانات في طاعته وملك قدرته وفضله به على كثير خلقه.الفصل الأول
في أن العلم والتعليم طبيعي..
في العمران البشريوذلك أن الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات، في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء والكن وغير ذلك. وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به، لتحصيل معاشه، والتعاون عليه بأبناء جنسه، والاجتماع الميء لذلك التعاون، وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى، والعمل به واتباع صلاح أخراه. فهو مفكر في ذلك كله دائماً، لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين، بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع. ثم لأجل هذا الفكر وما جبل عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل ما تستدعيه الطباع، فيكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الإدراكات، فيرجع إلى من سبقه بعلم، أو زاد عليه بمعرفة أو إدراك، أو أخذه ممن تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه، فيلقن ذلك عنهم ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق، وينظر ما يعرض له لذاته واحداً بعد آخر، ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له، فيكون حينئذ علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً. وتتشوف نفوس أهل الجيل الناشيء إلى تحصيل ذلك، فيفزعون إلى أهل معرفته ويجيء التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر. والله أعلم.
الفصل الثاني
في أن تعليم العلم من جملة الصنائع
وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه، إنما هم بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلاً. وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي. لأنا نجد فهم المسئلة الواحدة من الفن الواحد ووعيها، مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن، وبين من هو مبتدىء فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علماً، وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. والملكات كلها جسمانية، سواء كانت في البدن أو في الدماغ، من الفكر وغيره، كالحساب. والجسمانيات كلها محسوسة، فتفتقر إلى التعليم. ولهذا كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إلى مشاهير المعلمين فيها معتبراً عند كل أهل أفق وجيل. ويدل أيضاً على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به، شأن الصنائع كلها، فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم، إذ لو كان من العلم لكان واحداً عند جميعهم. ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين والمتأخرين، وكذا أصول الفقه وكذا العربية، وكذا كل علم يتوجه إلى مطالعته، تجد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة، فدل على أنها صناعات في التعليم. والعلم واحد في نفسه. وإذا تقرر ذلك، فاعلم أن سند تعليم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل المغرب، باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه. وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب والأندلس، واستبحر عمرانها، وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة وبحور زاخرة. ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما، وما كان فيهما من الحضارة. فلما خربتا انقطع التعليم من المغرب إلا قليلاً، كان في دولة الموحدين بمراكش مستفاداً منها. ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في أولها، وقرب عهد انقراضها بمبدئها، فلم تتصل أحوال الحضارة فيها إلا في الأقل.وبعد انقراض الدولة بمراكش، ارتحل إلى المشرق من إفريقية، القاضي أبو القاسم بن زيتون، لعهد أواسط المائة السابعة، فأدرك تلميذ الإمام ابن الخطيب، فأخذ عنهم، ولقن تعليمهم. وحذق في العقليات والنقليات، ورجع إلى تونس بعلم كثير وتعليم حسن. وجاء على أثره من المشرق أبوعبد الله ابن شعيب الدكالي. كان ارتحل إليه من المغرب، فأخذ عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس واستقر بها. وكان تعليمه مفيداً، فأخذ عنهما أهل تونس. واتصل سند تعليمهما في تلاميذهما جيلاً بعد جيل، حتى انتهى إلى القاضي محمد بن عبد السلام، شارح ابن الحاجب، وتلميذه وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن الإمام وتلميذه. فإنه قرأ مع ابن عبد السلام، على مشيخة واحدة، وفي مجالس بأعيانها، وتلميذ ابن عبد السلام بتونس، وابن الإمام بتلمسان لهذا العهد، إلا أنهم من القلة بحيث يخشى انقطاع سندهم.
ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة أبو علي ناصر الدين المشد إلى المشرق وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الحاجب، وأخذ عنهم ولقن تعليمهم. وقرأ مع شهاب الدين القرافي في مجالس واحدة، وحذق في العقليات والنقليات. ورجع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد، ونزل بجاية واتصل سند تعليمه في طلبتها. وربما انتقل إلى تلمسان عمران المشد إلى تلميذه وأوطنها وبث طريقته فيها. وتلميذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل.
وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلوا من حسن التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان، ولم يتصل سند التعليم فيهم، فعسرعليهم حصول الملكة والحذق في العلوم. وأيسر طرق هذه الملكة قوة اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية، فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها. فتجد طالب العلم منهم، بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية، سكوتاً لا ينطقون ولا يفاوضون، وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم. ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل، تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم، وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده. وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم، لشدة عنايتهم به، وظنهم أنه المقصود من المكة العلمية وليس كذلك. ومما يشهد بذلك في المغرب، أصن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة، وهي بتونس خمس سنين. وهذه المدة بالمدارس، على المتعارف، هي أقل ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلها، فطال أمدها في المغرب لهذه العصور لأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة، لا مما سوى ذلك. وأما أهل الأندلس، فذهب رسم التعليم من بينهم، وذهبت عنايتهم بالعلوم، لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين. ولم يبق من رسم العلم عندهم إلا فن العربية والأدب، اقتصروا عليه، وانحفظ سند تعليمة بينهم، فانحفظ بحفظه. وأما الفقه بينهم فرسم خلو وأثر بعد عيني. وأما العقليات فلا أثر ولا عين وما ذاك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران، وتغلب العدو على عامتها، إلا قليلاً بسيف البحر شغلهم بمعايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها. والله غالب على أمره.
وأما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه، بل أسواقه نافقة وبحوره زاخرة، لاتصال العمران الموفور واتصال السند فيه. وإن كانت الأمصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت، مثل بغداد والبصرة والكوفة، إلا أن الله تعالى قد أدال منها بامصار أعظم من تلك. وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان، وما وراء النهر من المشرق، ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب، فلم تزل موفورة وعمرانها متصلاً وسند التعليم بها قائماً. فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم، بل وفي سائر الصنائع. حتى إنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم، أن عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب، وأنهم أشد نباهة وأعظم كيساً بفطرتهم الأولى. وأن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب. ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك، ويولعون به، لما يرون من كيسهم في العلوم والصنائع وليس كذلك.
وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت في الحقيقة الواحدة، اللهم إلا الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسابع، فإن الأمزجة فيها منحرفة والنفوس على نسبتها كما مر. وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب، هو ما يحصل في النفس من آثار الحضارة، من العقل، المزيد، كما تقدم في الصنائع، ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً. وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنيا، وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم، وجميع تصرفاتهم. فلهم في ذلك كله آداب يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به من أخذ وترك، حتى كأنها حدود لا تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلاً جديداً، تستعد به لقبول صناعة أخرى، ويتهيأ بها العقل بسرعة الإدراك للمعارف.
ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك، مثل أنهم يعلمون الحمر الإنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب ندورها، ويعجز أهل المغرب عن فهمها فضلاً عن تعليمها. وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية، تزيد الإنسان ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس، إذ قدمنا أن النفس إنما تنشأ بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات، فيزدادون بذلك كيساً لما يرجع إلى النفس من الاثار العلمية، فيظنه العامي تفاوتاً في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك. ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو، كيف تجد الحضري متحلياً بالذكاء ممتلئاً من الكيس، حتى إن البدوي ليظنة أنه قد فاتة في حقيقة إنسانيته وعقله، وليس كذلك. وما ذاك إلا لإجادته من ملكات الصنائع .والآداب، في العوائد والأحوال الحضرية، ما لا يعرفه البدوي. فلما امتلأ الحضري في الصنائع وملكاتها وحسن تعليمها، ظن كل من قصرعن تلك الملكات أنها لكمال في عقله، وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وحبلتها عن فطرته، وليس كذلك. فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته، وإنما الذي ظهر على أهل الحضر من ذلك فهو رونق الصنائع والتعليم، فإن لهما آثاراً ترجع إلى النفس كما قدمناه. وكذا أهل المشرق لما كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماً، وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة، لما قدمناه في الفصل قبل هذا، ظن المغفلون في بادئ الرأي أنه لكمال في حقيقة الإنسانية اختصوا به عن أهل المغرب، وليس ذلك بصحيح فتفهمه. والله يزيد في الخلق ما يشاء، وهو إله السماوات والأرض.
الفصل الثالث
في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر الثمران
وتعظم الحضارة والسبب في ذلك أن تعليم العلم، كما قدمناه، من جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف، تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم، انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان، وهي العلوم والصنائع. ومن تشوف بفطرته إلى العلم، ممن نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة، فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي، لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدمناه، ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة، شأن الصنائع في أهل البدو.واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة، لما كثرعمرانها صدر الإسلام، واستوت فيها الحضارة، كيف زخرت فيها بحار العلم، وتفننوا في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم، واستنباط المسائل والفنون، حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين. ولما تناقص عمرانها وابذعر سكانها، انطوى ذلك البساط، بما عليه جملة، وفقد العلم بها والتعليم، وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن، لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة، من بلاد مصر، لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت، ومن جملتها تعليم العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها، منذ مائتين من السنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا. وذلك أن أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية - سلطانهم على من يتخلفونة من ذريتهم، لما له عليهم من الرق أو الولاء، ولما يخشى من معاطب الملك ونكباته. فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم، ينظر عليها أو يصيب منها، مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والصلاح والتماس الأجور في المقاصد والأفعال. فكثرت الأوقاف لذلك وعالمت الغلات والفوائد، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها. والله يخلق ما يشاء.
الفصل الرابع
في أصناف العلوم
الواقعة في العمران لهذا العهد اعلم أن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار، تحصيلاً وتعليماً، هي على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه. والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية، وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره، ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطإ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر. والثاني هي العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي. ولا مجال فيها للعقل، إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأ صول، لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة، لا تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه، فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي. إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر، بثبوت الحكم في الأصل، وهو نقلي، فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه. وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات، من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله، وما يتعلق بذلك من العلوم التي تهيأوها للإفادة. ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي، الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة، لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنمق أو بالإجماع أو بالإلحاق، فلا بد من النظر في الكتاب: ببيان ألفاظه أولاً، وهذا هوعلم التفسير، ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، واختلاف روايات القراء في قراءته، وهذا هو علم القراءات، ثم بإسناد السنة إلى صاجها، والكلام في الرواة الناقلين لها، ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم، ويعمل ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك. وهذه هي علوم الحديث.ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني، يفيذنا العلم بكيفية هذا الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى المكلفين، وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف: منها بدني، ومنها قلبي، وهو المختص بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد. وهذه هي العقائد الإيمانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر. والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية، لأنه متوقف عليها وهي أصناف. فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الأدب، حسبما نتكلم عليها كلها. وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها، وإن كانت كل ملة على الجملة لا بد فيها من مثل ذلك، فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إنها علوم الشريعة المنزلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ لها.
وأما على الخصوص فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة لها. وكل ماقبلها من علوم الملل فمهجورة، والنظر فيها محظور. فقد نهى الشرع عن النظر في الكتب المنزلة غير القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد " . ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة، فغضب حتى تبين الغضب في وجهه، ثم قال: ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي.
ثم إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها، في هذه الملة بما لامزيد عليه وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي لا شيء فوقها، وهذبت الاصطلاحات ورتبت الفنون، فجاءت من ورا الغاية في الحسن والتنميق. وكان لكل فن رجال يرجع إليهم فيه وأوضاع يستفاد منها التعليم. واختص المشرق من ذلك والمغرب بما هو مشهور حسبما نذكره الآن عند تعديد هذه الفنون. وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم، بالمغرب، لتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم، كما قدمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق، والظن به نفاق العلم فيه واتصال التعليم في العلوم، وفي سائر الصنائع الضرورية والكمالية، لكثرة عمرانه والحضارة، ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم. والله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وبيده التوفيق والإعانة.
الفصل الخامس
علوم القرآن من التفسير والقراءات
القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه، المكتوب بين دفتي المصحف. وهو متواتر بين الأمه، إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها، وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة، تواتر نقلها أيضاً بأدائها، واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير، فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة. وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع، إلا أنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في النقل. وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها. وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها عندهم كيفيات للأداء، وهو غير منضبط. وليس كذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن. وأباه الأكثر، وقالوا بتواترها، وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها، كالمد والتسهيل، لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع وهو الصحيح.ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها، إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت فيما كتب من العلوم، وصارت صناعة مخصوصة وعلماً منفرداً، وتناقله الناس بالمشرق والأندلس في جيل بعد جيل، إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي العامريين، وكان معتنياً بهذا الفن من بين فنون القرآن، لما أخذه به مولاه المنصور بن أبي عامر، واجتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته، فكان سهمه في ذلك وافراً. واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية، فنفقت بها سوق القراءة، لما كان هو من أئمتها، وبما كان له من العناية بسائر العلوم عموماً وبالقراءات خصوصاً. فظهر لعهده أبو عمرو الداني وبلغ الغاية فيها، ووقفت عليه معرفتها. وانتهت إلى روايته أسانيدها، وتعمدت تآليفه فيها. وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها، واعتمدوا من بينها كتاب التيسير له.
ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم بن فيره من أهل شاطبة، فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه. فنظم ذلك كله في قصيدة لغز فيها أسماء القراء بحروف " أ ب ج د " ، على ترتيب أحكمه ليتيسرعليه ما قصده من الاختصار، وليكون أسهل للحفظ لأجل نظمها. فاستوعب فيها الفن استيعاباً حسناً، وعني الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين، وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب والأندلس.
وربما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاً، وهي أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطية، لأن فيه حروفاً كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط، كزيادة اليا في باييد وزيادة الألف في لا أذبحنه، ولا أوضعوا، والواو في جزاؤ الظالمين، وحذف الألفات في مواضع دون أخرى، وما رسم فيه من التا آت ممدوداً، والأصل فيه مربوط على شكل الهاء، وغير ذلك. وقد مر تعليل هذا الرسم المصحفي عند الكلام في الخط. فلما جاءت هذه مخالفة لأوضاع الخط وقانونه، احتيج إلى حصرها، فكتب الناس فيها أيضاً عن كتبهم في العلوم. وانتهت بالمغرب إلى أبي عمرو الداني المذكور، فكتبت فيها كتباً، من أشهرها: كتاب المقنع، وأخذ به الناس وعولوا عليه. ونظمه أبو القاسم الشاطبي في قصيدته المشهورة على روي الراء، وولع الناس بحفظها. ثم كثر الخلاف في الرسم، في كلمات وحروف أخرى، ذكرها أبو داود سليمان بن نجاج من موالي مجاهد، في كتبه، وهو من تلاميذ أبي عمرو الداني، والمشتهر بحمل علومه ورواية كتبه. ثم نقل بعده خلاف آخر، فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع خلافاً كثيراً، وعزاه لناقليه، واشتهرت بالمغرب، واقتصر الناس على حفظها. وهجروا بها كتب أبي وأبي عمرو والشاطبي في الرسم.
التفسيروأما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. وكان ينزل جملاً جملاً، وآيات آيات، لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع. ومنها ما هو في العقائد الإيمانية، ومنها ما هو في أحكام الجوارح، ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخاً له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك كما قال تعالى: " لتبين للناس ما نزل إليهم " ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ، ويعرفه أصحابه، فعرفوه، وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولاً عنه. كما علم من قوله تعالى: " إذا جاء نصر الله والفتح " ، أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقل ذلك عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاً بين الصدر الأول والسلف، حتى صارت المعارف علوماً، ودونت الكتب، فكتب الكثير من ذلك، ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين. وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالبي وأمثالهم من المفسرين، فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار.
ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب، فوضعت الدواوين في ذلك، بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب، فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان. فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن، لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم. وصار التفسيرعلى صنفين: تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي. وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ! بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم، مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم، في أمثال هذه الأغراض، أخباراً موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل. وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات. وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية، ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم، لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة، فتلقيت بالقبول من يومئذ. فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص، وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب، فلخص تلك التفاسير كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب أخر مشهور بالمشرق.
والصنف الآخر من التفسير، وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول، إذ الأول هو المقصود بالذات. وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالباً. ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفسير، كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق، إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه، مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السنية، محسناً للحجاج عنها، فلا جرم أنه مأمون من غوائله، فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان.
ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين، وهو شرف الدين الطيبي، من أهل توريز من عراق العجم، شرح فيه كتاب الزمخشري هذا، وتتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها. ويبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة، لا على ما يراه المعتزلة، فأحسن في ذلك ما شاء، مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة. وفوق كل ذي علم عليم.
الفصل السادس
علوم الحديث
وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة، لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه، وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفاً من الله بعباده وتخفيفاً عنهم، باعتبار مصالحهم التي تكفل الله لهم بها قال تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " . ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عاماً للقرآن والحديث، إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره، وبقي ما كان خاصاً بالحديث راجعاً إلى علومه، فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات، وتعذر الجمع بينهما ببعض التآويل، وعلم تقدم أحدهما، تعين أن المتأخر ناسخ. وهو من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: " أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه " . وكان للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة. ومن علوم الحديث النظر في الأسانيد، ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط، لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخباررسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن، وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط. وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة، ويكون لنا ذلك دليلاً على القبول أو الترك.
وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين، وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحداً واحداً. وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها، بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه، وبسلامتها من العلل الموهنة لها، وتنتهي بالتفاوت إلى طرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل. ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن. ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة، مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب، وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم. وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة اللسان أو الوفاق. ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة، وتفاوت رتبها، وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد.
ثم اتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق منها أو مفترق، وما يناسب ذلك. هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلده، فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق، ومنهم بالشام ومصر. والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة، لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط، وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه، ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وابن وهب وابن بكير والقعنبي ومحمد بن الحسن ومن بعدهم الإمام أحمد بن حنبل في آخرين من أمثالهم.
وكان علم الشريعة في مبدإ هذا الأمر نقلاً صرفاً، شمر لها لسلف وتحروا الصحيح حتى أكملوها. وكتب مالك رحمه اللة كتاب الموطإ، أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه، ورتبه على أبواب الفقه، ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة. وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين، وقد يقع الحديث أيضاً في أبواب متعدده باختلاف المعاني التي اشتمل عليها. وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره، فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب، بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث، فتكررت لذلك أحاديثه، حتى يقال: إنه اشتمل على تسعة ألاف حديث ومائتين، منها ثلاثة آلاف متكررة، وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفه في كل باب.
ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى، فألف مسنده الصحيح، حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه، وحذف المتكرر منها. وجمع الطرق والأسانيد، وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله. وقد استدرك الناس عليهما في ذلك. ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي، في السنن بأوسع من الصحيح، وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل، إما من الرتبة العالية في الأسانيد، وهو الصحيح، كما هو معروف، وإما من الذي دونه من الحسن وغيره، ليكون ذلك إماماً للسنة والعمل. وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة، وهي أمهات كتب الحديث في السنة، فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب. ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث، وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ، فيجعل فناً برأسه وكذا الغريب. وللناس فيه تآليف مشهورة، ثم المؤتلف والمختلف. وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا. ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم، وتآليفه فيه مشهورة، وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه. وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح، كان لعهد أوئل المائة السابعة، وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك. والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما تحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة. وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين، إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة، على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم، لم يكونوا ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر، هذا بعيد عنهم. وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات المكتوبة، وضبطها بالرواية عن مصنفيها، والنظر في أسانيدها إلى مؤلفها، وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام، لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمس إلا في القليل.
فأما البخاري، وهو أعلاها رتبة، فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه، من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق، ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم. ولذلك يحتاح إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه، لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث، في أبواب كثيرة، بحسب معانيه وأخلافها. ومن شرحه، ولم يستوف هذا فيه، فلم يوف حق الشرح: كابن بطال وابن المهذب وابن التين ونحوهم. ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة، يعنون أن أحداً من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من بهذا الاعتبار. وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به، وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري، من غير الصحيح، مما لم يكن على شرطه، وأكثر ما وقع له في التراجم. وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحاً، وسماه المعلم بفوائد مسلم. اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. ثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه، وسماه إكمال المعلم. وتلاهما محيي الدين النووي، بشرح استوفى ما في الكتابين، وزاد عليهما، فجاء شرحاً وافياً.
وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء، فأكثر شرحها في كتب الفقه، إلا ما يختص بعلم الحديث، فكتب الناس عليها، واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموضوعاتها، والأسانيد التي اشتملت على الأحاديث المعمول بها في السنة.
واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد، بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها، تنزلها أئمة الحديث وجهابذته وعرفوها. ولم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل، ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها، بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه. ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، حين ورد على بغداد، وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قبلوا أسانيدها فقال: " لا أعرف هذه، ولكن حدثني فلان!. ثم أتى بجميع تلك الاحاديث على الوضع الصحيح، ورد كل متن إلى سنده، وأقروا له بالامامة.
واعلم أيضاً أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال فابو حنيفة رضي اللة تعالى عنه، يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها، ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده خمسون ألف حديث، ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك. وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين، إلى ان منهم من كان قليل البضاعة في الحديث، فلهذا قلت! روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. ومن كان قليل البضاعة من الحديث، فيتعين عليه طلبه وروايتة والجد والتشمير في ذلك لياخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقى الاحكام عن صاحبها المبلغ لها. وإنما قلل منهم من قلل الرواية، لأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها، سيما والجرح مقدم عند الأكثر، فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الاخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد. ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق.
هذا مع أن! أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق، لأن المدينة دار الهجرة وما8 وى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثروالامام أبوحنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي. وقلت من أجلها روايته فقل حديثه. لا أنه ترك رواية الحديث متعمدا، فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من كبإر المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم، والتعويل عليه واعتباره رداً وقبولا. واما غيره من المحدثين وهم الجمهور، فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم، والكل عن اجتهاد. وقد توسع اصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم.
وروى الطحاوي فاكثر وكتب مسنده، وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين، لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه. وشروط الطحاوي في غير متفق عليها، كالرواية عن المستور الحال وغيره، فلهذا قدم الصحيحان، بل وكتب السنن المعروفة قدمت عليه لتأخر شروطه عن شروطهم. ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفقق عليها. فلا تأخذك ريبة في ذلك ، فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم، والتماس المخارج الصحيحة لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بما في حقائق الآمور.
الفصل السابع
علم الفقه وما يتبعه من الفرائض
الفقة هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة ، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقة. وكان السلف يستخرجونها من تلك الادلة على اختلاف فيها بينهم. ولا بد من وقوعه ضرورة. فإن الأدلة من النصوص وهي بلغة العرب، وفي اقتضا آت ألفاظها بكثير من معانيها خصوصاً الأحكام الشرعية اختلاف بينهم معروف. وايضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها، فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا. فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها، وايضاً فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص. وما كان منها غير ظاهر في النصوص فيحمل على منصوص لمشابهة بينهما، وهذه كلها مثارات للخلاف ضرورية الوقوع. ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.ثم إن الصحابة لم يكونوا كلهم أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنما كان ذلك
مختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالاته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منهم من عليتهم، وكانوا يسمون لذلك القراء، أي الذين يقرأون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر الملة. ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب، وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعةً وعلماً فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث، وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلاً في أهل العراق كما قدمناه، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل أهل الرأي. ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة، وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به. وهم الظاهرية. وجعلوا مدارك الشرع كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص، لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها. وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابهما. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به، وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية. وشذ بمثل ذلك الخوارج. ولم يحفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح. فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشي، منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن، والخوارج كذلك. ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة. ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله، ولم يبق إلا في الكتب المجلدة. وربما يعكف كثير من الطالبين، ممن تكلف بانتحال مذهبهم، على تلك الكتب، يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم، فلا يحلو بطائل، ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه. وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بتلقيه العلم من الكتب، من غير مفتاح المعلمين.
وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس، على علو رتبته في حفظ الحديث، وصار إلى مذهب أهل الظاهر، ومهر فيه، باجتهاد زعمه في أقوالهم. وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين، فنقم الناس ذلك عليه، وأوسعوا مذهبه استهجاناً وإنكاراً، وتلقوا كتبه بالإغفال والترك، حتى إنها يحظر بيعها بالأسواق، وربما تمزق في بعض الأحيان. ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز.
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومقامه في الفقه لا يلحق، شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعي.
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. واختص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره، وهو عمل أهل المدينة. لأنه رأى أنهم، فيما يتفقون عليه، من فعل أو ترك، متابعون لمن قبلهم، ضرورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره، لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة من سواهم، بل هو شامل للأمة.
واعلم أن الإجماع إنما هو الإنفاق على الأمر الديني عن اجتهاد. ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى، وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة،. ذكرت في باب الإجماع لأنها أليق الأبواب بها، من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع. إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة، واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. ولو ذكرت المسئلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها.
ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمهما الله تعالى. رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم، ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق، واختص بمذهب. وخالف مالكاً رحمه الله تعالى في كثير من مذهبه. وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل رحمه الله. وكان من علية المحدثين. وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث، فاختصوا بمذهب آخر. ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، ودرس المقلدون لمن سواهم. وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله، ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه، فصرحوا بالعجز والإعواز، وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء، كل من اختص به من المقلدين. وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب. ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية، لا محصول اليوم للفقه غير هذا.
ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقليلده. وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. فأما أحمد بن حنبل، فمقلدوه قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية، وللاخبار بعضها ببعض. وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها، وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية الحديث وميلاً بالاستنباط إليه عن القياس ما أمكن، وكان لهم ببغداد صولة وكثرة، حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة من أجل ذلك، ثم انقطع ذلك عند استيلاء التتر عليها. ولم يراجع وصارت كثرتهم بالشام. وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين، وما وراء النهر وبلاد العجم كلها. ولما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام، وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس، فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسنت مباحثهم في الخلافيات، وجاؤوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس. وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما.
وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها، وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم. ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره. وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر، أخذ عنه جماعة منهم. وكان من تلميذه بها: البويطي والمزني وغيرهم وكان بها من المالكية جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم. ثم الحارث بن مسكين وبنوه، ثم القاضي أبو إسحق بن شعبان وأصحابه.
ثم انقرض فقه أهل السنة والجماعة من مصر بظهور دولة الرافضة، وتداول بها فقه أهل البيت وكان من سواهم يتلاشوا ويذهبوا. وارتحل إليها القاضي عبد الوهاب من بغداد، آخر المائة الرابعة، على ما أعلم، من الحاجة والتقليب في المعاش. فتأذن خلفاء العبيديين بإكرامه، وإظهار فضله نعياً على بني العباس في اطراح مثل هذا الإمام، والاغتباط به. فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاً، إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب، فذهب منها فقه أهل البيت وعاد فقه الجماعة إلى الظهور بينهم ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام، فعاد إلى أحسن ما كان ونفقت سوقه. واشتهر فيهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضاً، ثم ابن الرفعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العيد، ثم تقي الدين السبكي بعدهما. إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد، وهو سراج الدين البلقيني، فهو اليوم كبير الشافعية بمصر، لا بل كبير العلماء من أهل العصر.
وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس. وإن كان يوجد في غيرهم، إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل، لما أن رحلتهم كانت غالباً إلى الحجاز، وهو منتهى سفرهم. والمدينة يومئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق، ولم يكن العراق في طريقهم، فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة. وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده. فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره، ممن لم تصل إليهم طريقته. وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة. ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضاً عندهم، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب. ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه، بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم. وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة، يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة، واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا.
وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد. وأهل المغرب جميعاً مقلدون لمالك رحمه الله. وقد كان تلاميذه افترقوا بمصر والعراق، فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خويز منداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري، والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوهاب ومن بعدهم. وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين وطبقتهم. ورحل من الأندلس يحيى بن يحيى الليثي، ولقي مالكاً. وروى عنه كتاب الموطأ، وكان من جملة أصحابه. ورحل بعده عبد الملك بن حبيب، فأخذ عن ابن القاسم وطبقته، وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية. ورحل من إفريقية أسد بن الفرات، فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً، ثم انتقل إلى مذهب مالك. وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه، وجاء إلى القيروان بكتابه وسمي الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات، فقرأ بها سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه، وعارضه بمسائل الأسدية، فرجع عن كثير منها. وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه منها، وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يمحو من أسديته ما رجع عنه، وأن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك، فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون، على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة والمختلطة. وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية. ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه المسمى بالمختصر ولخصه أيضاً أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب، واعتمده المشيخة من أهل إفريقية واخذوا به، وتركوا ما سواه. وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها. ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الامهات بالشرح والإيضاح والجمع ، فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن محرز والتونسي وابن بشير وأمثالهم. وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا، مثل ابن رشد وأمثاله. وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الامهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر،. فاشتمل عين جميع أقوال المذاهب، وفرع الامهات كلها في هذا الكتاب. ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة، وزخرت بحار المذهب المالكي في الآفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك، أ إلى ان جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب، لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب، وتعديد أقوالهم في كل مسئلة، فجاء كالبرنامج للمذهب. وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين، وابن المبشر وابن اللهيت وابن رشيق وابن شاس. وكانت بالإسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء الله. ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب، لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين، وذهاب فقه أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية. ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة، عكف عليه الكثير من طلبة المغرب، وخصوصا أهل بجاية، لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب. فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك، فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلميذه، ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية. وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه، لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه. وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون، وكلهم من مشيخة أهل تونس، وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام، وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الفصل الثامن
علم الفرائض
وأما علم الفرائض، وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة، من كم تصح، باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وأنكرت سهامه على فروض ورثته، فإنه حينئذ يحتاج إلى حسبان يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعاً في الفريضتين إلى فروضهم من غير تجزئة. وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين، وتتعدد كذلك بعدد أكثر. وبقدر ما تتعدد تحتاج إلى الحسبان، وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجهيبن، مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره الآخر فتصحح على الوجهين حينئذ. وينظر مبلغ السهام، ثم تقسم التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان، فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه، لما اجتمع فيه إلى الفقه من الحسبان. وكان غالبا فيه، وجعلوه فناً مفرداً. وللناس فيه تآليف كثيرة، أشهرها عند المالكية من متأخري الأندلس كتاب ابن ثابت، ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي ثم الجعدي ومن متأخري إفريقية ابن النمر الطرابلسي وأمثالهم.
وأما الشافعية والحنفية والحنابلة، فلهم فيه تآليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة، شاهدة لهم باتساع الباع في الفقه والحساب، وخصوصأ أبا المعالي رضي الله تعالى عنه وأمثاله من أهل المذهب. وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول، والوصول به إلى الحقوق في الوراثات، بوجوه صحيحة يقينية، عندما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمين. وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الغلو في الحساب، وفرض المسائل التي تحتاج إلى استخراج المجهولات من فنون الحساب: كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور وأمثال ذلك، فيملؤون بها تآليفهم. وهو وإن لم يكن متداولأ بين الناس، ولا يفيد فيما يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه، فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على أكمل الوجوه.
وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله، بالحديث المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، ان الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما ينسى، وفي رواية: نصف العلم، خرجه أبو نعيم الحافظ. واحتج به أهل الفرائض، بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة. والذي يظهر أن هذا المحمل بعيد، وأن المراد بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية.
وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علوم الشريعة كلها. ويعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص، أوتخصيصه بفروض الوراثة، إنما هو اصطلاح ناشىء للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات. ولم يكن، صدر الإسلام، يطلق هذا اللفظ إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو، لغة، التقدير أو القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه، وهي حقيقته الشرعية، فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق بمرادهم منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق.
الفصل التاسع
أصول الفقه
وما يتعلق به من الجدل والخلافيات إعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن، ثم السنة المبينة له. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه، بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله، بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر. وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها، قولا أو فعلا، بالنقل الصحيح، الذي يغلب على الظن صدقه. وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار، ثم تنزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم. ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت، مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماغ دليلاً ثابتاً في الشرعيات.ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه منها بالأشباه. ويناظرون الأمثال بالامثال بإجماع منهم، وتسليم بعضهم لبعض في ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه، لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسموها بما ثبت، وألحقوها بما نص عليه، بشروط في ذلك الإلحاق، تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين. حتى يغلب على الظن ان حكم الله تعالى فيهما واحد، وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه، وهو القياس، وهو رابع الأدلة.
وأتفق جمهور العلماء على أن هذه هي اصول الأدلة، وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس، إلا أنه شذوذ. وألحق بعضهم بهذه الأدلة الأربعة أدلة اخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها، لضعف مداركها وشذوذ القول فيها. فكان من أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة. فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه، والتواتر في نقله ، فلم يبق فيه مجال للاحتمال. وأما السنة وما نقل إلينا منها، فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قلناه، معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه، من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع أمراً وناهياً. واما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الثابتة للآمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه اصول الآدلة. ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر، بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين، لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه، الذي هو مناط وجوب العمل بالخبر. وهذه أيضاً من قواعد الفن.
وبلحق بذلك، عند التعارض بين الخبرين، وطلب المتقدم منهما، معرفة الناسخ والمنسوخ، وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالات الألفاظ ، وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق، من تراكيب الكلام على الإطلاق، يتوقف طى معرفة الدلالات الوضعية مفردةً ومركبةً. والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علومأ ولا قوانين،ولم يكن الفقه حينئذ! يحتاج إليها، لأنها جبلة وملكة. فلما فسدت الملكة في لسان العرب، قيدها الجهابذة المتجردون لذلك، بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة، وصارت علومأ يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى. ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام، وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة بين تراكيب الكلام وهو الفقه.
ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق، بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة، وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك،، وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة. مثل أن اللغة لا تثبت قياساً، والمشترك لا يراد به معنياً، معاً، والواو لا تقتضي الترتيب، والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة فيما عداها، والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي، والنهي يقتضي الفساد أو الصحة، والمطلق هل يحمل على المقيد، والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية. ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن، لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاسس ويماثل من الأحكام وتنقيح الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به في الأصل، من تبين أوصاف ذلك المحل، أو وجود ذلك الوصف في الفرع، من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك، كلها قواعد لهذا الفن.
واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً، فعنهم أخذ معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها، لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف، وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، احتاح الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد، لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه أصول الفقه. وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه. أملى فيه رسالتة المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب المتكلمون أيضاً كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع، لكثرة الأمثلة منها والشواهد، وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائهل عن الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم، فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، وكملت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده، وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه. وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون، كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية. وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة، قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكفمين، المتأخرين، وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول، وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام. واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والأمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريغ المسائل. وأما كتاب المحصول، فاختصره تلميذ الإمام مثل سراج الدين الأموي في كتاب التحصيل، وتاج الدين الأرموي في كتاب الحاصل. واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه التنقيحات. وكذلك فعل البيضاوي في كتاب المنهاج. وعني المبتدئون بهذين الكتابين، وشرحهما كثير من الناس. وأما كتاب الإحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقاً في المسائل، فلخصه أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير. ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم، وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه. وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً، وكان من أحسن كتابة المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي، وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم، وهو مستوعب. وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين، وسمى كتابه بالبدائع، فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها، وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونة قراءة وبحثاً. وأولع كثيرمن علماء العجم بشرحه. والحال على ذلك لهذا العهد.
هفه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه.
والله ينفعنا بالعلم، ويجعلنا من أهله، بمنه وكرمه، إنه على كل شي قدير.
الخلافيات
وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين، باختلاف مداركهم وأنظارهم، خلافاً لا بد من وقوعه لما قدمناه. واتسع ذلك في الملة اتساعاً عظيماً، وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم، اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم، لذهاب الاجتهاد، لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده، باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة، وأجري الخلاف بين المتمسكين بها، والأخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية.
وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة، يحتج بها كل على صحة مذهبه الذي قلده وتمسك به. وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه: فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدهما، وتارة يكون مالك وأبي حنيفة، والشافعي يوافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة، ومالك يوافق أحدهما. وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة، ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات. ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد، إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط، وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته.
وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم، ومران المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه. وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية، لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت، فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر. وأيضاً فأكثرهم أهل المغرب، وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل. وللغزالي رحمه الله تعالى فيه كتاب المآخذ، ولأبي بكر العربي من المالكية كتاب التلخيص جلبه من المشرق، ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة، ولابن القصار من شيوخ المالكية عيون الأدله، وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصول الفقه جميع ما ينبني عليها من الفقه الخلافي، مدرجاً في كل مسألة منه ما ينبني عليها من الخلافيات.
الجدالوأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج. ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً، وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت لخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد، من الحدود والآداب، في الاستدلال، التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره. وهي طريقتان: طريقة البزدوي، وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال، وطريقة العميدي، وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان، وأكثره استدلالاً. وهو من المناحي الحسنة، والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة. وإذا اعتبرتا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي. إلا أن صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة يتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى بالإرشاد مختصراً، وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره، جاؤوا على أثره وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التآليف. وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية. وهي مع ذلك كمالية وليست ضرورية. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق.
الفصل العاشر
علم الكلام
وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية، بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد. فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق والمآخذ، ثم نرجع إلى تحقيق علم الكلام وفيما ينظر ونشير إلى حدوثه في الملة، وما دعا إلى وضعه فنقول: إعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة، وعنها يتم كونه. وكل واحد من تلك الأسباب حادث أيضاً، فلا بد له من أسباب أخرى. ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها، لا إله إلا هو سبحانه.
وتلك الأسباب في ارتقائها تتضاعف فتنفسح طولاً وعرضاً، ويحار العقل في إدراكها وتعديدها. فإذا لا يحصرها إلا العلم المحيط، سيما الأفعال البشرية والحيوانية، فإن من جملة أسبابها في الشاهد القصود والإدارات، إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه. والقصودات والإرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة، يتلو بعضها بعضاً. وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل. وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى، وكل ما يقع في النفس من التصورات فمجهول سببه، إذ لا يطلع أحد على مبادئ الأمور النفسانية، ولا على ترتيبها. إنما هي أشياء يلقيها الله في الفكر، يتبع بعضها بعضاً، والإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنما يحيط علماً في الغالب بالأسباب التي هي طبيعة ظاهرة، وتقع في مداركها على نظام وترتيب، لأن الطبيعة محصورة للنفس وتحت طورها. وأما التصورات فنطاقها أوسع من النفس، لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس، فلا تكاد النفس تدرك الكثير منها فضلاً عن الإحاطة. وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها، فإنه واد يهيم فيه الفكر ولا يخلو منه بطائل، ولا يظفر بحقيقة. قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه، وأصبح من الضالين الهالكين. نعوذ بالله من الحرمان والخسران المبين.
ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك أو اختيارك، بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها. إذ لو علمناها لتحرزنا منها، فلنتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جملة. وأيضاً فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول، لأنها إنما يوقف عليها بالعادة، وقضية الاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة، " وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " ، فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة، والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها، لترسخ صبغة التوحيد في النفس، على ما علمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح ديننا، وطرق سعادتنا، لاطلاعه على ما وراء الحس.
قال صلى الله عليه وسلم: " من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة " . فإن وقف عند تلك الأسباب، فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر، وإن سبح في بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحداً بعد واحد، فأنا الضامن له أن لا يعود إلا بالخيبة فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق. " قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد " . ولا تثقن بما يزعم لك الفكر مني أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها، والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفه رايه في ذلك. واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك، والحق من ورائه. ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات. وكذلك الأعمى أيضاً يسقط من الوجود عنده صنف المسوعات، ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة، لما أقروا به. لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف، لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم، ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق، لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية. فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق الله أكبر من خلق الناس. والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك، والله من ورائهم محيط. فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر، واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك، وأعلم بما ينفعك، لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، يل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال.
ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدرك. على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدى طوره، حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه. وتفطن من هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا، وقصور فهمه واضمحلال رأيه، فقد تبين لك الحق من ذلك. وإذا تبين ذلك، فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا، خرجت عن أن تكون مدركة، فيضل العقل في بيداء الأوهام، ويحار وينقطع. فإذا: التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيراتها، وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها، إذ لا فاعل غيره. وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته، وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا عنه لا غير.
وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: " العجز عن الإدراك إدراك " . ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط، الذي هو تصديق حكمي، فإن ذلك من حديث النفس. وإنما الكمال فيه حصول صفة منه، تتكيف بها النفس. كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد، وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود، حتى ينقلب المريد السالك ربانياً. والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف. وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين، قربة إلي الله تعالى، مندوب إليها، ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة، وهو لو رأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء المستضعفين، لفر عنه، واستنكف أن باشره، فضلاً عن التمسيح عليه للرحمة، وما بعد ذاك من مقامات العطف والحنو والصدقة. فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم، ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف. ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الاؤل، وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها. فمتى رأى يتيماً أو مسكيناً بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه، لا يكاد يصبر عن ذلك، ولو دفع عنه. ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده. وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به، والعلم الحاصل عن الاتصاف ضرورة، هو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم، حتى يقع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة، فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق، وبجيء العلم الثاني النافع في الآخرة. فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع، وهذا علم أكثر النظار، والمطلوب إنما هو العلم الحالي الناشىء عن العادة.
واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا: فما طلب اعتقاده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف، وما طلب عمله من العبادات، فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقيق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل لهذه الثمرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم: " في رأس العبادات جعلت قرة عيني في الصلاة " ، فإن الصلاة صارت له صفة وحالاً يجد فيها منتهى لذته وقرة عينه، وأين هذا من صلاة الناس ومن لهم بها؟ " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " اللهم وفقنا، " واهدنا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين " .
فقد تبين لك من جميع ما قررناه، أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس، ينشأ عنها علم اضطراري للنفس، هو التوحيد، وهو العقيدة الإيمانية، وهو الذي تحصل به السعادة، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف كلها وينبوعها، هو بهذه المثابة وأنه ذو مراتب: أولها التصديق القلبي الموافق للسان، وأعلاها حصول كيفية، من ذلك الاعتقاد القلبي، وما يتبعه من العمل، مستولية على القلب، فيستتبع الجوارح. وتندرج في طاعتها جميع التصرفات، حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني. وهذا أرفع مراتب الإيمان، وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة. إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " . وفي حديث هرقل، لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فقال في أصحابه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا! قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها، شأن الملكات إذا استقرت، فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة. وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان، وهي في المرتبة الثانية من العصمة. لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوباً سابقاً، وهذه حاصلة للمؤمنين حصولاً تابعاً لأعمالهم وتصديقهم. فبهذه الملكة ورسوخها، يقع التفاوت في الإيمان، كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف.
وفي تراجم البخاري رضي الله عنه، في باب الإيمان، كثير منه، مثل: " أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأن الصلاة والصيام من الإيمان، وأن تطوع رمضان من الإيمان، والحياء من الإيمان " . والمراد بهذا كله الإيمان الكامل، الذي أشرنا إليه وإلى ملكته، وهو فعلي. وأما التصديق الذي هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه. فمن اعتبر أوائل الأسماء، وحمله على التصديق منع من التفاوت، كما قال أئمة المتكلمين، ومن اعتبر أواخر الأسماء، وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت. وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق، إذ التصديق موجود في جميع رتبه، لأنه أول ما يطلق عليه اسم الإيمان، وهو المخلص من عهدة الكفر، والفيصل بين الكافر والمؤمن، فلا يجزي أقل منه. وهو في نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت، وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه، فافهم.
واعلم أن الشارع وصف لنا هذا الإيمان، الذي في المرتبة الأولى، الذي هو تصديق، وعين أموراً مخصوصة، كلفنا التصديق بها بقلوبنا، واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بها بألسنتنا، وهي العقائد التي تقررت في الدين. قال صلى الله عليه وسلم، حين سئل عن الإيمان فقال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر، وتؤمن بالقدر: خيره وشره " .
وهذه هي العقائد الإيمانية المقررة في علم الكلام. ولنشر إليها مجملة لتتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه، فنقول: اعلم أن الشارع لما أمرنا بالإيمان بهذا الخالق، الذي رد الأفعال كلها إليه، وأفرده بها كما قدمناه، وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عند الموت إذا حضرنا، لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود، إذ ذلك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا: أولاً، اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين، وإلا لما صح أنه خالق لهم، لعدم الفارق على هذا التقدير، ثم تنزيهه عن صفات النقص، وإلا لشابه المخلوقين، ثم توحيده بالاتحاد، وإلا لم يتم الخلق للتمانع، ثم اعتقاد أنه عالم قادر، فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الإيجاد والخلق، ومريد وإلا لم يخصص شيء من المخلوقات، ومقدر لكل كائن، وإلا فالإرادة حادثة. وأنه يعيدنا بعد الموت تكميلاً لعنايته بالإيجاد، ولو كان للغناء الصرف كان عبثاً، فهو للبقاء السرمدي بعد الموت. ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد، لاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة، وعدم معرفتنا بذلك، وتمام لطفه بنا في الإنباء بذلك، وبيان الطريقين. وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيمانية، معللة بأدلتها العقلية، وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة، إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد، أكثر مثارها من الآي المتشابهة، فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل. فحدث بذلك علم الكلام.
ولنبين لك تفصيل هذا المجمل. وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود، بالتنزيه المطلق، الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة، وهي سلوب كلها وصريحة في بابها، فوجب الإيمان بها. ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي آخرى قليلة توهم التشبيه، مرة في الذات وأخرى في الصفات. فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتها، وعلموا استحالة التشبيه. وقضوا بأن الآيات من كلام الله، فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها، ببحث ولا تأويل. وهذا معنى قول الكثير منهم: اقرأوها كما جاءت، أي آمنوا بأنها من عند الله. ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها، لجواز أن يكون ابتلاء، فيجب الوقف والإذعان له. وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات، وتوغلوا في التشبيه: ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه، عملاً بظواهر وردت بذلك، فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلق، لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار. وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق، التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة، أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية، وجمع بين الدليلين بتأويلها. ثم يفرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام. وليس ذلك بدافع عنهم، لأنه قول متناقض، وجمع بين نفي وإثبات: إن كانا لمعقولية واحدة من الجسم، وإن خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة، ففد وافقونا في التنزيه، ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسماً من أسمائه. ويتوقف مثله على الإذن. وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات، كإثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك. وآل قولهم إلى التجسيم، فنزعوا مثل الأولين إلى قولهم صوت لا كالأصوات، جهة لا كالجهات، نزول لا كالنزول، يعنون من الأجسام.
واندفع ذلك بما اندفع به الأول، ولم يبق في هذه الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي، لئلا يكر النفي على معانيها بنفيها، مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن. ولهذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد وكتاب المختصر له، وفي كتاب الحافظ بن عبد البر وغيرهم، فإنهم يحومون على هذا المعنى. ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهم. ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء، وألف المتكلمون في التنزيه، حدثت بدعة المعتزلة، في تعميم هذا التنزيه في آي السلوب، فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة، زائدة على أحكامها، لما يلزم ذلك من تعدد القديم بزعمهم، وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها، وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر لأن معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام. وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ، وإنما هو إدراك للمسموع أو المبصر. وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر، ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس، فقضوا بأن القرآن مخلوق، وذلك بدعة صرح السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة، ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم، فحمل الناس عليها. وخالفهم أئمة السلف، فاستحل لخلافهم أيسار كثير منهم ودماؤهم.
وكان ذلك سبباً لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد، دفعاً في صدور هذه البدع. وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين، فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه. وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف. وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه، فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق العقل والنقل. ورد على المبتدعة في ذلك كله، وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح، وكمل العقائد في البعثة وأحوال المعاد والجنة والنار والثواب والعقاب. وألحق بذلك الكلام في الإمامة، لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية، في قولهم إنها من عقائد الإيمان. وإنها يجب على النبي تعيينها والخروج عن العهدة فيها لمن هي له، وكذلك على الأمة. وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية، ولا تلحق بالعقائد، فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعة علم الكلام: إما لما فيه من المناظرة على البدع، وهي كلام صرف، وليست براجعة إلى عمل، وإما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي. وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري، واقتفى طريقته من بعده تلميذه، كابن مجاهد وغيره. وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم، وهذبها ووضع المقدمات العقلية، التي تتوقف عليها الأدلة، والأنظار، وذلك مثل: إثبات الجوهر الفرد والخلاء، وأن العرض لا يقوم بالعرض، وأنه لا يبقى زمانين. وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم. وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها، لتوقف تلك الأدلة عليها، وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. فكملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صور الأدلة فيها بعض الأحيان، على غير الوجه الصناعي لسذاجة القوم، ولأن صناعة المنطق التي تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة، لم تكن حينئذ ظاهرة في الملة، ولو ظهر منها بعض الشىء، فلم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة، فكانت مهجورة عندهم لذلك.
ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام الحرمين أبو المعالي، فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه. ثم لخصه في كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماماً لعقائدهم. ثم انتشر من بعد ذلك علم المنطق في الملة.
وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية، بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط، يسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها. ثم نظروا في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين، فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي أدتهم إلى ذلك. وربما أن كثيراً منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات. فلما سبروها بمعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها، ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله، كما صار إليه القاضي، فصارت هذه الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى، وتسمى طريقة المتأخرين. وربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية، وجعلوهم من خصوم العقائد، لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم. وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله، وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة، والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحداً، من اشتباه المسائل فيهما.
واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود الباري وصفاته، وهو نوع استدلالهم غالباً. فالجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف في الطبيعيات، هو بعض من هذه الكائنات. إلا أن نظره فيها مخالف لنظر المتكلم، وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن، والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف في الإلهيات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته، ونظر المتكلم في الوجود من حيث إنه يدل على الموجود. وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فروضها صحيحة من الشرع، من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية، فترفع البدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك العقائد. وإذا تأملت حال الفن في حدوثه، وكيف تدرج كلام الناس فيه صدراً بعد صدر، وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة، علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن، وأنه لا يعدوه.
ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين، والتبست مسائل الكلام، بمسائل الفلسفة، بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر. ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في الطوالع، ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تأليفهم. إلا أن هذه الطريقة، قد يعنى بها بعض طلبة العلم، للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج، لوفور ذلك فيها. وأما محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام، فإنما هو في الطريقة القديمة للمتكلمين، وأصلها كتاب الإرشاد، وما حذا حذوه.
ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده، فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن الخطيب، فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم، فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع، ما في طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهم. وعلى الجملة، فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم، إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا، والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وأما الآن، فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارىء عن الكثير من إيهاماته وإطلاقاته. ولقد سئل الجنيد رحمه الله، عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص؟ فقال: " نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب " . لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة، إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها. والله ولي المؤمنين.
الفصل الحادي عشر
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر
أعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة، كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة عنها، التي هي المعدن والنبات والحيوان. وهذه كلها متعلقات القدرة الإلهية وعلى أفعال صادرة في الحيوانات، واقعة بمقصودها، متعلقة بالقدرة التي جعل الله لها عليها: فمنها منتظم مرتب، وهي الأفعال البشرية، ومنها غير منتظم ولامرتب، وهي أفعال الحيوانات غير البشر. وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع ، فإذا قصد إيجاد شيء من الأشيا، فلأجل الترتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسببه أو علته أو شرطه، وهي على الجملة مبادئه، إذ لا يوجد إلا ثانياً عنها ولا يمكن إيقاع المتقدم متأخراً ولا المتأخر متقدماً. وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادئ لا يوجد إلا متأخراً عنه، وقد يرتقي ذلك أو ينتهي. فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في مرتبتين أو ثلاث أو أزيد، وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكر، فكان أول عمله. ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات التي كانت أول فكرته مثلاً، لو فكر في إيجاد سقف يكنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه، ثم إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر ثم يبدأ في العمل بالأساس، ثم بالحائط، ثم بالسقف، وهو آخر العمل.وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل، فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لتوقف بعضها على بعض. ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير، وهو آخرها في العمل. وأولها في العمل هو المسبب الأول وهو آخرها في الفكر. ولأجل العثور على هذا الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية.
وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل، إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس ومدركاتها متفرقة خلية من الربط لأنه لا يكون إلا بالفكر. ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة، وغير المنتظمة إنما هي تبع لها، اندرجت حينئذ أفعال الحيوانات فيها فكانت مسخرة للبشر. واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث، بما فيه، فكان كله في طاعته وتسخره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة " فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس من تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث، ومنهم من لا يتجاوزها، ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست فتكون إنسانيته أعلى. واعتبر ذلك بلاعب الشطرنج: فإن في اللاعبين من يتصور الثلاث حركات والخمس الذي ترتيبها وضعي، ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه. وإن كان هذا المثال غير مطابق، لأن لعب الشطرنج بالملكة، ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع، لكنه مثال يحتذي به الناظر في تعقل ما يورد عليه من القواعد. والله خلق الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً.
الفصل الثاني عشر
في العقل التجريبي وكيفية حدوثه
إنك تسمع في كتب الحكماء قولهم أن الإنسان هو مدني الطبع، يذكرونه في إثبات النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة، وهي عندهم كناية عن الإجتماع البشري. ومعنى هذا القول، أنه لا تمكن حياة المنفرد من البشر، ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه. وذلك لما هوعليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبداً بطبعه. وتلك المعاونة لا بد فيها من المفاوضة أولاً، ثم المشاركة وما بعدها. وربما تفضي المعاملة عند اتحاد الأعراض إلى المنازعة والمشاجرة فتنشأ المنافرة والمؤالفة، والصداقة والعداوة. ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمم والقبائل. وليس ذلك على أي وجه اتفق، كما بين الهمل من الحيوانات، بل للبشر بما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال وترتيبها بالفكر، كما تقدم. جعل منتظماً فيهم، ويسرهم لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكمية، ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصالح، وعن الحسن إلى القبيح، بعد أن يميزوا القبائح والمفسدة، بما ينشأ عن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة، وعوائد معروفة بينهم ، فيفارقون الهمل من الحيوان، وتظهر عليهم نتيجة الفكر في انتظام الأفعال وبعدها عن المفاسد.هذه المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد ولا يتعمق فبها الناظر، بل كلها تدرك بالتجربة وبها يستفاد، لأنها معان جزئية تتعلق بالمحسوسات وصدقها وكذبها، يظهر قريباً في الواقع، فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر الذي يسر له منها مقتنصاً له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه، حتى يتعين له مايجب وينبغي، فعلاً وتركاً. وتحصل في ملابسة الملكة في معاملة أبناء جنسه. ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثورعلى كل قضية قضية. ولا بد بما تسعه التجربة من الزمن. وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن التجربة، إذ قلد فيها الأباء والمشيخة والأكابر، ولقن عنهم ووعى تعليمهم، فيستغني عن طول المعاناة في تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى من بينها. ومن فقد العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه، طال غناؤه في التأديب بذلك، فيجري في غير مألوف ويدركها على غير نسبة، فتوجد آدابه ومعاملاته سيئة الأوضاع بادية الخلل، ويفسد حاله في معاشه بين أبناء جنسه. وهذا معنى القول المشهور: " من لم يؤدبه والده أدبه الزمان " . أي من لم يلفن الآداب في معاملة البشر من والديه وفي معناهما المشيخة والأكابر ويتعلم ذلك منهم، رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيام، فيكون الزمان معلمه ومؤدبه لضرورة ذلك بضرورة المعاونة التي في طبعه.
وهذا هو العقل التجريبي، وهو يحصل بعد العقل التمييز في الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظر في الذي تكفل بتفسيره أهل العلوم، فلا يحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون.
الفصل الثالث عشر
في علوم البشر وعلوم الملائكة
إنا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالم: أولها: عالم الحس، ونعتبره بمدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات بالإدراك، ثم نعتبر الفكر الذي اختص به البشر فنعلم منه وجود النفس الإنسانية علماً ضرورياً بما بين جنبينا من مدارك العلمية التي هي فوق مدارك الحس، فتراه عالماً آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل على عالم ثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي تلقى في أفئدتنا كالإرادات والوجهات، نحو الحركات الفعلية، فنعلم أن هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنا وهو عالم الأرواح والملائكة. وفيه ذوات مدركة لوجود آثارها فينا مع ما بيننا وبينها من المغايرة. وربما يستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما نجد في النوم، ويلقى إلينا فيه من الأمور التي نحن في غفلة عنها في اليقظة، وتطابق الواقع في الصحيحة منها، فنعلم أنها حق ومن عالم الحق. وأما أضغاث الأحلام فصور خيالية يخزنها الإدراك في الباطن ويجول فيها الفكر بعد الغيبة عن الحس. ولا نجد على هذا العالم الروحاني برهاناً أوضح من هذا، فنعلمه كذلك على الجملة ولا ندرك له تفصيلاً.وما يزعمه الحكماء الإلهيون في تفصيل ذواته وترتبها، المسماة عندهم بالعقول، فليس شيء من ذلك بيقيني لاختلال شرط البرهان النظري فيه، كما هو مقرر في كلامهم في المنطق. لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية. وهذه الذوات الروحانية مجهولة الذاتيات، فلا سبيل للبرهان فيها. ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه من الشرعيات التي يوضحها الإيمان ويحكمها. وأعقد هذه العوالم في مدركنا عالم البشر، لأنه وجداني مشهود في مداركنا الجسمانية والروحانية. ويشترك في عالم الحس مع الحيوانات وفي عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من جنس ذواته، وهي ذوات مجردة عن الجسمانية والمادة، وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول، وكأنه ذات حقيقتها الإدراك والعقل، فعلومهم حاصلة دائماً مطابقة بالطبع لمعلوماتهم لا يقع فيها خلل البتة.
وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد أن لا تكون حاصلة. فهو كله مكتسب، والذات التي يحصل فيها صور المعلومات وهي النفس مادة هيولانية تلبس صور الوجود بصور المعلومات الحاصلة فيها شيئاً شيئاً، حتى تستكمل، ويصح وجودها بالموت في مادتها وصورتها. فالمطلوبات فيها مترددة بين النفي والإثبات دائماً، بطلب أحدهما بالوسط الرابط بين الطرفين. فإذا حصل وصار معلوماً افتقر إلى بيان المطابقة، وربما أوضحها البرهان الصناعي، لكنه من وراء الحجاب. وليس كالمعاينة التي في علوم الملائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المعطابقة بالعيان الإدراكي. فقد تبين أن البشر جاهل بالطبع للتردد الذي في علمه، وعالم بالكسب والصناعة لتحصيله المطلوب بفكرة الشروط الصناعية. وكشف الحجاب الذي أشرنا إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار التي أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتنزه عن المتناولات المهمة ورأسها الصوم، وبالوجهة إلى الله بجميع قواه. والله علم الإنسان ما لم يعلم.
الفصل الرابع عشر
في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
إنا نجد هذا الصنف من البشرتعتريهم حالة إلهية خارجة عن منازع البشر وأحوالهم فتغلب الوجهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية من الشهوة والغضب وسائر الأحوال البدنية، فتجدهم متنزهين عن الأحوال الربانية، من العبادة والذكر لله بما يقتضي معرفتهم به، مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة، من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم لا يتبدل فيهم كأنه جبلة فطرهم الله عليها. وقد تقدم لنا الكلام في الوحي أول الكتاب في فصل المدركين للغيب. وبينا هنالك أن الوجود كله في عوالمه البسيطة والمركبة على تركيب طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالاً لا ينخرم. وأن الذوات التي في آخر كل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب إلى الذات التي تجاورها من الأسفل والأعلى، استعداداً طبيعياً، كما في العناصر الجسمانية البسيطة، وكما في النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق الحيوان وكما في القردة التي استجمع فيها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر والرويه. وهذا الاستعداد الذي في جانبي كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها.وفوق العالم البشر في عالم روحاني، شهدت لنا به الآثار التي فينا منه، بما يعطينا من قوى الإدراك والإرادة فذوات العلم العالم إدراك صرف وتعقل محض، وهو عالم الملائكة، فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانية استعداد للإنسلاخ من البشرية إلى الملكية، لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات، وفي لمحة من اللمحات. ثم تراجع بشريتها وقد تلقت في عالم الملكية ما كفلت بتبليغه إلى أبناء جنسها في البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه، كأنه جبلة لهم ويعالجون في ذلك الانسلاخ من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم. وعلومهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان، لا يلحقه الخطأ والزلل، ولا يقع فيه الغلط والوهم، بل المطابقة قيه ذاتية لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة، عند مفارقة هذه الحالة إلى البشرية، لا يفارق علمهم الوضوح، استصحاباً له من تلك الحالة الأولى، ولما هم عليه من الذكاء المفضي بهم إليها، يتردد ذلك فيهم دائماً إلى أن تكمل هداية الأمة التي بعثوا لها، كما في قوله تعالى: " إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستنفروه " . فافهم ذلك وراجع ما قدمناه لك أول الكتاب، في أصناف المدركين للغيب، يتضح لك شرحه وبيانه، فقد بسطناه هنالك بسطاً شافياً. والله الموفق.
الفصل الخامس عشر
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب
قد بينا أول هذه الفصول أن الإنسان من جنس الحيوانات، وأن الله تعالى ميزه عنها بالفكر الذي جعل له، يوقع به أفعاله على انتظام وهو العقل التمييزي أو يقتنص به العلم بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه، وهو العقل التجريبي، أو يحصل به في تصور الموجودات غائباً وشاهداً، على ما هي عليه، وهو العقل النظري. وهذا الفكر إنما يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه، ويبدأ من التمييز فهو قبل التمييز خلو من العلم بالجملة، معدود من الحيوانات، لاحق بمبدئه في التكوين، من النطفة والعلقة والمضغة. وما حصل له بعد ذلك فهو بما جعل الله له من مدارك الحس والأفئدة التي هي الفكر. قال تعالى في الامتنان علينا: " وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة " فهو في الحالة الأولى قبل التمييز هيولا فقط، لجهله بجميع المعارف. ثم تستكمل صورته بالعلم الذي يكتسبه بآلاته، فكمل ذاته الإنسانية في وجودها. وانظر إلى قولى تعالى مبدأ الوحي على نبيه: " اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم " ، أي أكسبه من العلم ما لم يكن حاصلاً له بعد أن كان علقة ومضغة فقد كشفت لنا طبيعته وذاته ما هوعليه من الجهل الذاتي والعلم الكسبي وأشارت إليه الآية الكريمة تقرر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وجوده، وهي الإنسانية. وحالتاه الفطرية والكسبية في أول التنزيل ومبدأ الوحي. وكان الله عليماً حكيماً.
الفصل السادس عشر
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة
وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في الاعتقادات إعلم أن الله سبحانه بعث إلينا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة والفوز بالنعيم، وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربي المبين، يخاطبنا فيه بالتكاليف المفضية بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب، ومن ضروراته، ذكر صفاته سبحانه وأسمائه، ليعرفنا بذاته، وذكر الروح المتعلقة بنا، وذكر الوحي والملائكة، الوسائط بينه وبين رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته ولم يعين لنا الوقت في شيء منه. وثبت في هذا القرآن الكريم حروفاً من الهجاء مقطعة في أوائل بعض سوره، لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها. وسمى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهاً. وذم على اتباعها فقال تعالى: " هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب " وحمل العلماء من سلف الصحابة والتابعين هذه الآية على أن المحكمات هي المبينات الثابتة الأحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: المحكم المتضح المعنى. وأما المتشابهات فلهم فيها عبارات. فقيل هي التي تفتقر إلى نظم وتفسير يصحح معناها، لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل، فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن عباس: " المتشابه يؤمن به ولا يعمل به " وقال مجاهد وعكرمة: " كلما سوى آيات الأحكام والقصص متشابه " وعليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. وقال الثوري والشعبي وجماعة من علماء السلف: " المتشابه، ما لم يكن سبيل إلى علمه، كشروط الساعة وأوقات الإنذارات وحروف الهجاء في أوائل السور، وقوله في الآية: " هذه أم الكتاب " أي معظمه وغالبه والمتشابه أقله، وقد يرد إلى المحكم. ثم ذم المتبعين للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به. وسماهم أهل زيغ، أي ميل عن الحق من الكفار والزنادقة وجهلة أهل البدع. وأن فعلهم ذلك قصد الفتنة التي هي الشرك أو اللبس على المؤمنين أو قصداً لتأويلها بما يشتهونه فيقتدون به في بدعتهم.ثم أخبر سبحانه بأنه استأثر بتأويلها ولا يعلمه إلا هو فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم أثنى على العلماء بالإيمان بها فقط فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولهذا جعل السلف والراسخون مستأنفاً، ورجحوه على العطف لأن الإيمان بالغيب أبلغ في الثناء ومع عطفه إنما يكون إيماناً بالشاهد، لأنهم يعلمون التأوبل حينئذ فلا يكون غيباً. ويعضد ذلك قوله: " كل من عند ربنا " ويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر. إن الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني التي وضعها العرب لها، فإذا استحال إسناد الخبر إلى مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه إليه ولا نشغل أنفسنا بمدلول نلتمسه، فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: " إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن، فهم الذين عنى الله " ، فاحذروهم. هذا مذهب السلف في الآيات المتشابهة. وجاء في السنة ألفاط مثل ذلك حملها عندهم محمل الآيات لأن المنبع واحد.
وإذا تقررت أصناف المتشابهات على ما قلناه، فلنرجع إلى اختلاف الناس فيها.
فأما ما يرجع منها على ما ذكروه إلى الساعة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية وامثال ذلك، فليس هذا والله أعلم من المتشابه، لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا غيره وإنما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه. وقال: " إنما علمها عند الله " والعجب ممن عدها من المتشابه وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فحقيقتها حروف الهجاء وليس ببعيد أن تكون مرادة. وقد قال الزمخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في الإعجاز، لأن القرآن المنزل مؤلف منها، والبشر فيها سواء، والتفاوت موجود في دلالتها بعد التأليف. وإن عدل عن هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإنما يكون بنقل صحيح، كقولهم في طه، إنه نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك. والنقل الصحيح متعذر، فيجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. وأما الوحي والملائكة والروح والجن، فاشتباهها من خفاء دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفة، فجاء التشابه فيها من أجل ذلك. وقد ألحق بعض الناس بها كل ما في معناها من أحوال القيامة والجنة والدخال والفتن والشروط، وما هو بخلاف العوائد المألوفة، وهو غير بعيد، إلا أن الجمهور لا يوافقونهم عليه. وسيما المتكلمون فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهبم، ولم يبق من المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، مما يوهم ظاهره نقصاً اوتعجيزاً. وقد اختلف الناس في هذه الظواهر من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم. وتنازعوا وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان مذاهبهم وإيثار الصحيح منه على الفاسد فنقول، " وما توفيقي إلا بالله " : إعلم أن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بأنه عالم، قادر، مريد، حي، سميع، بصير متكلم، جليل، كريم، جواد، منعم، عزيز، عظيم. وكذا أثبت لنفسه اليدين والعينين والوجه والقم واللسان، إلى غيرذلك من الصفات: فمنها ما يقتضي صحة ألوهية، مثل العلم والقدرة والإرادة، ثم الحياة التي هي شرط جميعها، ومنها ما هي صفة كمال، كالسمع والبصر والكلام، ومنها ما يوهم النقص كالاستواء والنزول والمجيء، وكالوجه واليدين والعينين التي هي صفات المحدثات. ثم أخبر الشارع أنا نرى ربنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدر، لا نضام في رؤيته كما ثبت في الصحيح.
فأما السلف من الصحابة والتابعين فأثبثوا له صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما يوهم النقص ساكتين عن مدلوله. ثم اختلف الناس من بعدهم، وجاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاماً ذهنية مجردة، ولم يثبتوا صفة تقوم بذاته، وسموا ذلك توحيداً، وجعلوا الإنسان خالقاً لأفعاله، ولا تتعلق بها قدرة الله تعالى، سيما الشرور والمعاصي منها، إذ يمتنع على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واجبة عليه. وسموا ذلك عدلاً، بعد أن كانوا أولاً يقولون بنفي القدر، وأن الأمر كله مستأنف بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك، كما ورد في الصحيح. وإن عبد الله بن عمر تبرأ من معبد الجهني وأصحابه القائلين بذلك. وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء الغزالي، منهم، تلميذ الحسن البصري، لعهد عبد الملك بن مروان. ثم آخراً إلى معمر السلمي، ورجعوا عن القول به. وكان منهم أبو الهذيل العلاف، وهو شيخ المعتزلة. أخذ الطريقة عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل. وكان من نفاة القدر، واتبع رأي الفلاسفة في نفي الصفات الوجوددة لظهور مذاهبهم يومئذ.
ثم جاء إبراهيم النظام، وقال بالقدر، واتبعوه. وطالع كتب الفلاسفة وشدد في نفي الصفات وقرر قواعد الاعتزال. ثم جاء الجاحظ والكعبي والجبائي، وكانت طريقتهم تسمى علم الكلام: إما لما فيها من الحجاج والجدال، وهو الذي يسمى كلاماً، وإما أن أصل طريقتهم نفي صلة الكلام. فلهذا كان الشافعي يقول: حقهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم. وقرر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها وردوا، إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر بعض مشيختهم في مسائل الصلاح والأصلح، فرفض طريقتهم، وكان على رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحرث بن أسد المحاسبي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة. فأيد مقالاتهم بالحجج الكلامية وأثبت الصفات القائمة بذات الله تعالى، من العلم والقدرة والإرادة التي يتم بها دليل التمانع وتصح المعجزات للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصر لأنها وإن أوهم ظاهراً النقص بالصوت والحرف الجسمانيين، فقد وجد للكلام عند العرب مدلول آخر غير الحروف والصوت، وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون الأول، فأثبتوها لله تعالى وانتفى إيهام النقص. وأثبتوا هذه الصفة قديمة عامة التعلق بشأن الصفات الأخرى. وصار القرآن اسماً مشتركاً بين القديم بذات الله تعالى، وهو الكلام النفسي والمحدث الذي هو الحروف المؤلفة المقروءة بالأصوات. فإذا قيل قديم
فالمراد الأول، وإذا قيل مقروء، مسموع، فلدلالة القراءة والكتابة عليه. وتوزع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث عليه، لأنه لم يسمع من السلف قبله: لا إنه يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة، ولا أن القراءة الجارية على السنة قديمة، وهو شاهدها محدثة. وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه. وأما غير ذلك فإنكار للضروريات، وحاشاه منه. وأما السمع والبصر، وإن كان يوهم إدراك الجارحة، فهو يدل أيضاً لغة على إدراك المسموع والمبصر، وينتفي إيهام النقص حينئذ لأنه حقيقة لغوية فيهما. وأما لفظ الاستواء والمجيء والنزول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك، فعدلوا عن حقائقها اللغوية فما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتها، على طريقة العرب، حيث تتعذر حقائق الألفاظ، فيرجعون إلى المجاز. كما في قوله تعالى: " يريد أن ينقض " وأمثاله، طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة. وحملهم على هذا التأويل، وإن كان مخالفاً لمذهب السلف في التفويض أن جماعة من أتباع السلف وهم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة ارتكبوا في محمل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى، مجهولة الكيفية. فيقولون في: " استوى على العرش " تثبت له استواء، بحيث مدلول اللفظة، فراراً من تعطيله. ولا نقول بكيفيته فراراً من القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب، من قوله: " ليس كمثله شيء " ، " سبحان الله عما يصفون " ، " تعالى الله عما يقول الظالمون " ، " لم يلد ولم يولد " ، ولا يعلمون مع ذلك أنهم ولجوا من باب التشبيه في قولهم بإثبات استواء، والاستواء عند أهل اللغة إنما موضوعه الاستقرار والتمكن، وهو جسماني. وأما التعديل الذي يشنعون بإلزامه، وهو تعطيل اللفظ، فلا محذور فيه. وإنما المحذور في تعطيل الآلة. وكذلك يشنعون بإلزام التكليف بما لا يطاق، وهو تمويه. لأن التشابه لم يقع في التكاليف. ثم يدعون أن هذا مذهب السلف، وحاشا لله من ذلك. وإنما مذهب السلف ما قررناه أولاً من تفويض المراد بها إلى الله، والسكوت عن فهمها. وقد يحتجون لإثبات الاستواء لله بقول مالك: " إن الاستواء معلوم الثبوت لله " وحاشاه من ذلك، لأنه يعلم مدلول الاستواء. وإنما أراد أن الاستواء معلوم من اللغة، وهو الجسماني، وكيفيته أي حقيقته. لأن حقائق الصفات كلها كيفيات، وهي مجهولة الثبوت لله. وكذلك يحتجون على إثبات المكان بحديث السوداء، وأنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أين الله؟ وقالت: في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم
يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان لله، بل لأنها آمنت بما جاء به من ظواهر، أن الله في السماء، فدخلت في جملة الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النافي للافتقار. ومن أدلة السلوب المؤذنة بالتنزيه مثل " ليس كمثله شيء " وأشباهه. ومن قوله: " وهو الله في السموات وفي الأرض " ، إذ الموجود لا يكون في مكانين، فليست في هذا للمكان قطعاً، والمراد غيره. ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين، والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلون لها مدلولات أعم من الجسمانية وينزهونه عن مدلول الجسماني منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم. ونافرهم أهل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية. ورفضوا عقائدهم في ذلك، ووقع بين متكلمي الحنفية ببخارى وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ما هو معروف. وأما المجسمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسمية، وأنها لا كالأجسام. ولفظ الجسم له يثبت في منقول الشرعيات. وإنما جرأهم عليه إثبات هذه الظواهر، فلم يقتصروا عليه، بل توغلوا وأثبتوا الجسمية، يزعمون فيها مثل ذلك وينزهونه بقول متناقض سفساف، وهو قولهم: جسم لا كالأجسام. والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالذات أو المركب من الجواهر وغير ذلك، فاصطلاحات للمتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغوي. فلهذا كان المجسمة أوغل في البدعة بل والكفر. حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يوهم النقص لم يرد في كلامه، ولا كلام نبيه. فقد تبيين لك الفرق بين مذاهب السلف والمتكلمين السنية والمحدثين والمبتدعة من المعتزلة والمجسمة بما أطلعناك عليه. وفي المحدثين غلاة يسمون المشبه لتصريحهم بالتشبيه، حتى إنه يحكى عن بعضهم أنه قال: اعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواهما. وإن لم يتأول ذلك لهم، بأنهم يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الموهمة، وحملها على ذلك المحمل الذي لأئمتهم، وإلا فهو كفر صريح والعياذ بالله. وكتب أهل السنة مشحونة بالحجاج على هذه البدع، وبسط الرد عليهم بالأدلة الصحيحة. وإنما أومأنا إلى ذلك إيماء يتميز به فصول المقالات وجملها. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وأما الظواهر الخفية الأدلة والدلالة، كالوحي والملائكة والروح والجن والبرزخ وأحوال القيامة والدجال والفتن والشروط، وسائر ما هو متعذر على الفهم أو مخالف للعادات، فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله، وهم أهل السنة، فلا تشابه، وإن قلنا فيه بالتشابه، فلنوضح القول فيه بكشف الحجاب عنه فنقول: اعلم أن العالم البشري أشرف العوالم من الموجودات، وأرفعها. وهو وإن اتحدت حقيقة الإنسانية فيه فله أطوار يخالف كل واحد منها الآخر بأحوال تختص به حتى كأن الحقائق فيها مختلفة.
فالطور الأول: عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره المعاشي وسائر تصرفاته التي أعطاه إياها وجوده الحاضر.
الطور الثاني: عالم النوم، وهو تصور الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة في باطنه فيدرك منها بحواسه الظاهرة مجردة عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية، ويشاهدها في إمكان ليس هو فيه. ويحدث للصالح منها البشرى بما يترقب من مسراته الدنيوية والأخروية، كما وعد به الصادق صلوات الله عليه. وهذان الطوران عامان في جميع أشخاص البشر، وهما مختلفان في المدارك كما تراه.
الطور الثالث: طور النبوة، وهو خاص بإشراف صنف البشر بما خصهم الله به من معرفته وتوحيده، وتنزل ملائكته عليهم بوحيه، وتكليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها مغايرة للأحوال البشرية الظاهرة.
الطور الرابع: طور الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة إلى وجود قبل القيامة يسمى البرزخ يتنعمون فيه ويعذبون على حسب أعمالهم ثم يفضون إلى يوم القيامة الكبرى، وهي دار الجزاء الأكبر نعيماً وعذاباً في الجنة أو في النار. والطوران الأولان شاهدهما وجداني، والطور الثالث النبوي شاهده المعجزة والأحوال المختصة بالأنبياء، والطور الرابع شاهده ما تنزل على الانبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزخ والقيامة، مع أن العقل يقتضي به، كما نبهنا الله عليه، في كثير من آيات البعثة. ومن أوضح الدلالة على صحتها أن أشخاص الإنسان لو لم يكن لهم وجود آخر بعد الموت غير هذه المشاهد يتلقى فيه أحوالاً تليق به. لكان إيجاده الأول عبثاً. إذ الموت إذا كان عدماً كان مآل الشخص إلى العدم، فلا يكون لوجوط الأول حكمة. والعبث على الحكيم محال. وإذا تقررت هذه الأحوال الأربعة، فلنأخذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيف تختلف اختلافاً بيناً يكشف لك غور المتشابه. فأما مداركه في الطور الأول فواضحة جلية. قال الله تعالى: " والله أخرجكم من بطون أمهاثكم لا تعلمون شيئاً، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة " فبهذه المدارك يستولي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة إنسانية ويوفي حق العبادة المفضية به إلى النجاة.
وأما مداركه في الطور الثاني، وهو طور النوم، فهي المدارك التي في الحس الظاهر بعينها. لكن ليست في الجوارح كما هي في اليقظة. لكن الرأي يتيقن كل شيء أدركه في نومه لا يشك فيه ولا يرتاب، مع خلو الجوارح عن الاستعمال العادي لها. والناس في حقيقة هذه الحال فريقان: الحكماء، ويزعمون أن الصور الخيالية يدفعها الخيال بحركة الفكر إلى الحس المشترك الذي هو الفصل المشترك بين الحس الظاهر والحس الباطن، فتصور محسوسه بالظاهر في الحواس كلها. ويشكل عليهم هذا بأن المرائي الصادقة التي هي من الله تعالى أو من الملك أثبت وأرسخ في الإدراك من المرائي الخيالية الشيطانية، مع أن الخيال فيها على ما قرروه واحد.
الفريق الثاني: المتكلمون، أجملوا فيها القول، وقالوا: هو إدراك يخلقه الله في الحاسة فيقع كما يقع في اليقظة، وهذا أليق، وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النومي أوضح شاهد على ما يقع بعده من المدارك الحسية في الأطوار.
وأما الطور الثالث، وهو طور الأنبياء، فالمدارك الحسية فيها مجهولة الكيفية عند وجدانيته عندهم بأوضح من اليقين. فيرى النبي الله والملائكة، ويسمع كلام الله منه أو من الملائكة، ويرى الجنة والنار، والعرش والكرسي، ويخترق السموات السبع في إسرائه ويركب البراق فيها، ويلقى النبيين هنالك، ويصلي بهم، ويدرك أنواع المدارك الحسية، كما يدرك في طوره الجسماني والنومي، بعلم ضروري يخلقه الله له، لا بالإدراك العادي للبشر في الجوارح، ولا يلتفت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله أمر النبوة على أمر النوم في دفع الخيال صوره إلى الحس المشترك. فإن الكلام عليهم هنا أشد من الكلام في النوم، لأن هذا التنزيل طبيعة واحدة كما قررناه، فيكون على هذا حقيقة الوحي والرؤيا من النبي واحدة في يقينها وحقيقتها، وليست كذلك على ما علمت من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ستة أشهر وأنها كانت بمئة الوحي ومقدمته، ويشعر ذلك بأنه رؤية في الحقيقة. وكذلك حال الوحي في نفسه فقد كان يصعب عليه ويقاسي منه شدة كما هي في الصحيح، حتى كان القرآن يتنزل عليه آيات مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه " براءة " في غزوة تبوك جملة واحدة، وهو يسير على ناقته. فلو كان ذلك من تنزل الفكر إلى الخيال فقط، ومن الخيال إلى الحس المشترك، لم يكن بين هذه الحالات فرق. وأما الطور الرابع، وهو طور الأموات في برزخهم الذي أوله القبر، وهم مجردون عن البدن، أو في بعثتهم عندما يرجعون إلى الأجسام، فمداركهم الحسية موجودة، فيرى الميت في قبره الملكان يسائلانه، ويرى مقعده من الجنة أو النار بعيني رأسه، ويرى شهود الجنازة ويسمع كلامهم وخفق نعالهم في الانصراف عنه، ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو من تقرير الشهادتين، وغير ذلك. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر، وفيه قتلى المشركين من قريش، وناداهم بأسمائهم، فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: " والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول " . ثم في البعثة يوم القيامة يعاينون بأسمائهم وأبصارهم - كما كانوا يعاينون في الحياة من نعيم الجنة على مراتبه وعذاب النار على مراتبه، ويرون الملائكة ويرون ربهم، كما ورد في الصحيح: إنكم ترون ربكم يوم القيامة، كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذه المدارك لم تكن لهم في الحياة الدنيا وهي حسية مثلها، وتقع في الجوارح بالعلم الضروري الذي يخلقه الله كما قلنا وسر هذا أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن وبمداركه، فإذا فارقت البدن بنوم أو بموت أو صار النبي حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية، فقد استصحبت ما كان معها من المدارك البشرية مجردة عن الجوارح، فيدرك بها في ذلك الطور أي إدراك شاءت منها، أرفع من إدراكها، وهي في الجسد. قاله الغزالي رحمه الله، وزاد على ذلك أن النفس الإنسانية صورة تبقى لها، بعد المفارقة فيها العينان والأذنان وسائر الجوارح المدركة أمثالاً لها، كان في البدن وصوراً.
وأنا أقول: إنما يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لها كله علمت أن هذه المدارك موجودة في الأطوار الأربعة، لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنيا، وإنما هي تختلف بالقوة والضعف بحسب ما يعرض لها من الأحوال. ويشير المتكلمون إلى ذلك إشارة مجملة بأن الله يخلق فيها علماً ضرورياً بتلك المدارك، أي مدرك كان، ويعنون به هذا القدر الذي أوضحناه. وهذه نبذة أومأنا بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه لقصرت المدارك عنه. فلنفزع إلى الله سبحانه في الهداية والفهم عن أنبيائه وكتابه، بما يحصل به الحق في توحيدنا، والظفر بنجاتنا والله يهدي من يشاء.
الفصل السابع عشر
في علم التصوف
هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم، لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، طريقة الحق والهداية و أصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة. وقال القشيري رحمه الله: ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس. والظاهر أنه لقب. ومن قال: اشتقاقه من الصفاء، أو من الصفة، فبعيد من جهة القياس اللغوي، قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه.
قلت: والأظهر أن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف، وهم في الغالب مختصون بلبسه، لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف. فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة، اختصوا بمآخذ مدركة لهم، وذلك أن الإنسان بما هو إنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك، وإدراكه نوعان: إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم، وإدراك للأحوال القائمة من الفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصبر والشكر، وأمثال ذلك. فالروح العاقل والمتصرف في البدن تنشأ من إدراكات وإرادات وأحوال، وهي التي يتميز بها الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض، كما ينشأ العلم عن الأدلة، والفرح والحزن عن إدراك المؤلم أو المتلذذ به، والنشاط عن الحمام، والكسل عن الإعياء. وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته، لا بد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك المجاهدة. وتلك الحالة إما أن تكون نوع عبادة، فترسخ وتصير مقاماً للمريد، وإما أن لا تكون عبادة، وإنما تكون صفة حاصلة للنفس. من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات. ولا يزال المريد يترقى من مقام إلى مقام، إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: " من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة " . فالمريد لا بد له من الترقي في هذه الأطوار، وأصلها كلها الطاعة والإخلاص، ويتقدمها الإيمان ويصاحبها، وتنشأ عنها الأحوال والصفات نتائج وثمرات. ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع تقصير في النتيجة أو خلل فنعلم أنه إنما أتى من قبل التقصير في الذي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية. فلذا يحتاج المريد إلى محاسبة نفسه في سائر أعماله، وينظر في حقائقها، لأن حصول النتائج عن الأعمال ضروري وقصورها من الخلل فيها كذلك. والمريد يجد ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسبابه. ولا يشاركهم في ذلك إلا القليل من الناس، لأن الغفلة عن هذا كأنها شاملة.
وغاية أهل العبادات، إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع، أنهم يأتون بالطاعات مخلصة من نظر الفقه في الأجزاء والامتثال. وهؤلاء يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجد، ليطلعوا على أنها خالصة من التقصير أولاً، فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك، والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات، ثم تستقر للمريد مقاماً، ويترقى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم، إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة. فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف، اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه. وصار علم الشريعة على صنفين: صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا، وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات، وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها، وكيفية الترقي منها من فوق إلى فوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك.
فلما كتبت العلوم ودونت، وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتهم. فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك، كما فعله المحاسبي في كتاب الرعاية له، ومنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال كما فعله القشيري في كتاب الرسالة، والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم. وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياء، فدون فيه أحكام الورع والاقتداء، ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصار علم التصوف في الملة علما مدوناً، بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال، كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك.
ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالباً كشف حجاب الحس، والاطلاع على عوالم من أمر الله، ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها، والروح من تلك العوالم. وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس، وقويت أحوال الروح، وغلب سلطانه وتجدد نشؤه، وأعان على ذلك الذكر، فإنه كالغذاء لتنمية الروح، ولا يزال في نمو وتزيد، إلى أن يصير شهوداً بعد أن كان علماً. ويكشف حجاب الحس، ويتم وجود النفس الذي لها من ذاتها، وهو عين الإدراك. فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم المدنية والفتح الإلهي، وتقرب ذاته في تحقيق حقيقتها من الأفق الأعلى، أفق الملائكة. وهذا الكشف كثيراً ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم. وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعها ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم في الموجودات السفلية، وتصير طوع إرادتهم. فالعظماء منهم لا يعتبرون هذا الكشف ولا يتصرفون، ولا يخبرون عن حقيقة شيء لم يؤمروا بالتكلم فيه، بل يعدون ما يقع لهم من ذلك محنة، ويتعوذون منه إذا هاجمهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة، وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ، لكنهم لم يقع لهم بها عناية. وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كثير منها. وتبعهم في ذلك أهل الطريقة، ممن اشتملت رسالة القشيري على ذكرهم، ومن تبع طريقتهم من بعدهم.
ثم إن قوماً من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في المدارك التي وراءه، واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك، باختلاف تعليمهم في إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر، حتى يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتها. فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركها حينئذ، وأنهم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقها كلها من العرش إلى الطش. هكذا قال الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء بعد أن ذكر صورة الرياضة.
ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحاً كاملاً عندهم، إلا إذا كان ناشئاً عن الاستقامة، لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة، وإن لم يكن هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشىء عن الاستقامة. ومثاله أن المرآة الصقيلة إذا كانت محدبة أو مقعرة، وحوذي بها جهة المرئي، فإنه يتشكل فيه معوجاً على غير صورته. وإن كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحاً. فالاستقامة للنفس، كالانبساط للمرآة، فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولما عني المتأخرون بهذا النوع من الكشف، تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسفلية، وحقائق الملك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك، وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم في ذلك. وأهل الفتيا بين منكرعليهم ومسلم لهم. وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق، رداً وقبولاً، إذ هي من قبيل الوجدانيات.
تفصيل وتحقيق: يقع كثيراً في كلام أهل العقائد، من علماء الحديث والفقه أن الله تعالى مباين لمخلوقاته. ويقع للمتكلمين أنه لا مباين ولا متصل. ويقع للفلاسفة أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ويقع للمتأخرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات: إما بمعنى الحلول فيها، أو بمعنى انه هو عينها، وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلاً. فلنبين تفصيل هذه المذاهب ونشرح حقيقة كل واحد منها، حتى تتضح معانيها فنقول، إن المباينة تقال لمعنيين:
أحدهما المباينة في الحيز والجهة، ويقابله الاتصال. وتشعر هذه المقابلة على هذه التقيد بالمكان: إما صريحاً، وهو تجسيم، أو لزوماً وهو تشبيه من قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء السلف من التصريح بهذه المباينة، فيحتمل غير هذا المعنى. من أجل ذلك أنكر المتكلمون هذه المباينة وقالوا: لا يقال في البارىء أنه مباين مخلوقاته، ولا متصل بها، لأن ذلك إنما يكون للمتحيزات. وما يقال من أن المحل لا يخلو عن الاتصاف بالمعنى وضده، فهو مشروط بصحة الاتصاف أولاً، وأما مع امتناعه فلا، بل يجوز الخلو عن المعنى وضده، كما يقال في الجماد، لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا كاتب ولا أمي. وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقرر من مدلولها. والبارىء سبحانه منزة عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في شرح اللمع لإمام الحرمين وقال: " ولا يقال في البارىء مباين للعالم ولا متصل به، ولا داخل فيه ولا خارج عنه. وهو معنى ما يقوله الفلاسفة أنه لا داخل العالم ولا خارجه، بناء على وجود الجواهر غير المتحيزة. وأنكرها المتكلمون لما يلزم من مساواتها للبارىء في أخص الصفات، وهو مبسوط في علم الكلام.
وأما المعنى الآخر للمباينة، فهو المغايرة والمخالفة، فيقال: البارىء مباين لمخلوقاته في ذاته وهويته ووجوده وصفاته. ويقابله الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه المباينة هي مذهب أهل الحق كلهم من جمهور السلف وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين كأهل الرسالة ومن نحا منحاهم. وذهب جماعة من المتصوفة المتأخرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية، إلى أن البارىء تعالى متحد بمخلوقاته في هويته ووجوده وصفاته. وربما زعموا أنه مذهب الفلاسفة قبل أرسطو، مثل أفلاطون وسقراط، وهو الذي يعينه المتكلمون حيث ينقلونه في علم الكلام عن المتصرفة ويحاولون الرد عليه لأنه ذاتان، تنتفي إحداهما، أو تندرج اندراج الجزء، فإن تلك مغايرة صريحة، ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه النصارى في المسيح عليه السلام، وهو أغرب لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به. وهو أيضاً عين ما تقوله الإمامية من الشيعة في الأمامية. وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على طريقين: الأولى: أن ذات القديم كائنة في المحدثات محسوسها ومعقولها، متحدة بها في المتصورين، وهي كلها مظاهر له، وهو القائم عليها، أي المقوم لوجودها، بمعنى لولاه كانت عدماً وهو رأي أهل الحلول.
الثانية: طريق أهل الوحدة المطلقة وكأنهم استشعروا من تقرير أهل الحلول الغيرية المنافية لمعقول الاتحاد، فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات. وغالطوا في غيرية المظاهر المدركة بالحس والعقل بأن ذلك من المدارك البشرية، وهي أوهام. ولا يريدون الوهم الذي هو قسيم العلم والظن والشك، وإنما يريدون أنها كلها عدم في الحقيقة، وجود في المدرك البشري فقط. ولا وجود بالحقيقة إلا للقديم، لا في الظاهر ولا في الباطن كما نقرره بعد، بحسب الإمكان. والتعويل في تعقل ذلك على النظر والاستدلال، كما في المدارك البشرية، غير مفيد، لأن ذلك إنما ينقل من المدارك الملكية، وإنما هي حاصلة للأنبياء بالفطرة ومن بعدهم للأولياء بهدايتهم. وقصد من يصد الحصول عليها بالطريقة العلمية ضلال. وربما قصد بعض المصنفين ذلك في كشف الموجودات وترتيب حقائقه على طريق أهل المظاهر فأتى بالأغمض فالأغمض.
وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه، فأتى بالأغمض فالأغمض، بالنسبة إلى أهل النظر والاصطلاحات والعلوم. كما فعل الفرغاني، شارح قصيدة ابن الفارض، في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك الشرح، فإنه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه، أن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية، التي هي مظهر الأحدية، وهما معاً صادران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لا غير. ويسمون هذا الصدور بالتجلي.
وأول مراتب التجليات عندهم تجلي الذات، على نفسه، وهو يتضمن الكمال بإفاضة الإيجاد والظهور، لقوله في الحديث الذي يتناقلونه: " كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق ليعرفوني " . وهذا الكمال في الإيجاد المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق، وهو عندهم عالم المعاني والحضرة الكمالية والحقيقة المحمدية، وفيها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الأنبياء والرسل أجمعين، والكمل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة الهبائية، وهي مرتبة المثال، ثم عنها العرش، ثم الكرسي، ثم الأفلاك، ثم عالم العناصر، ثم عالم التركيب. هذا في عالم الرتق،، فإذا تجلت، فهي في عالم الفتق. انتهى.
ويسمى هذا المذهب مذهب أهل التجلي والمظاهر والحضرات، وهوكلام لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه، وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجدان وصاحب الدليل. وربما أنكر بظاهر الشرع هذا الترتيب فإنه لا يعرف في شيء من مناحيه. وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة، وهو رأي أغرب من الأول في تعقله وتفاريعه، يزعمون فيه أن الوجود له قوى في تفاصيله، بها كانت حقائق الموجودات وصورها وموادها.
والعناصر إنما كانت بما فيها من القوى، وكذلك مادتها لها في نفسها قوة بها كان وجودها. ثم إن المركبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة التي كان بها التركيب. كالقوة المعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها، وزيادة القوة المعدنية، ثم القوة الحيوانية تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتها في نفسها، وكذا القوة الإنسانية مع الحيوانية، ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة. وكذا الذوات الروحانية والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل، هي القوة الإلهية التي انبثت في جميع الموجودات كلية وجزئية، وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه، لا من جهة الظهور ولا من جهة الخفاء ولا من جهة الصورة، ولا من جهة المادة، فالكل واحد وهو نفس الذات الإلهية، وهي في الحقيقة واحدة بسيطة، والاعتبار هو المفضل لها، كالإنسانية مع الحيوانية. ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. فتارة يمثلونها بالجنس مع النوع، في كل موجود كما ذكرناه، وتارة بالكل مع الجزء، على طريقة المثال. وهم في هذا كله يفرون من التركيب والكثرة بوجه من الوجوه، وإنما أوجبها عندهم الوهم والخيال. والذي يظهر من كلام ابن دهقان في تقرير هذا المذهب، أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بما يقوله الحكماء في الألوان، من أن وجودها مشروط بالضوء، فإذا عدم الضوء لم تكن الألوان موجودة بوجه.
وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسي، بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضاً مشروطة بوجود المدرك العقلي، فإذا، الوجود المفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصيل في الوجود، بل هو بسيط واحد. فالحر والبرد، والصلابة واللين، بل والأرض والماء، والنار والسماء والكواكب، إنما وجدت لوجود الحواس المدركة لها، لما جعل في المدرك من التفصيل، الذي ليس في الموجود، وإنما هو في المدارك فقط. فإذا فقدت المدارك المفصلة فلا تفصيل، إنما هو إدراك واحد، وهو أنا لا غيره. ويعتبرون ذلك بحال النائم، فإنه إذا نام وفقد الحس الظاهر، فقد كل محسوس، وهو في تلك الحالة، إلا ما يفصله له الخيال. قالوا: فكذلك اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كلها على التفصيل بنوع مدركه البشري، ولو قدر فقد مدركه فقد التفصيل، وهذا هو معنى قولهم: الوهم، لا الوهم الذي هو من جملة المدارك البشرية.
هذا ملخص رأيهم على ما يفهم من كلام ابن دهقان، وهو في غاية السقوط، لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون إليه يقيناً مع غيبته عن أعيينا، وبوجود السماء المظلة والكواكب وسائر الأشياء الغائبة عنا. والإنسان قاطع بذلك، ولا يكابر أحد نفسه في اليقين، مع أن المحققين من المتصوفة المتأخرين يقولون: إن المريد عند الكشف ربما يعرض له توهم هذه الوحدة، ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات، ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق، وهو مقام العارف المحقق. ولا بد للمريد عندهم من عقبة الجمع، وهي عقبة صعبة، لأنه يخشى على المريد من وقوفه عندها، فتخسر صفقته. فقد تبينت مراتب أهل هذه الطريقة.
ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس، توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه، وملأوا الصحف منه، مثل الهروي، في كتاب المقامات له، وغيره. وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ثم ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإلهية الأئمة، مذهباً لم يعرف لأولهم، فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر. واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم. وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب، ومعناه رأس العارفين. يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة، حتى يقبضه الله. ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات، في فصول التصوف منها، فقال: " جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد، أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد " . وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي، وإنما هو من أنواع الخطابة، وهو بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب، كما قاله الشيعة في النقباء. حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف، ليجعلوه أصلاً لطريقتهم ونحلتهم، رفعوه إلى علي رضي الله عنه، وهو من هذا المعنى أيضاً. وإلا فعلي، رضي الله عنه، لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لباس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة. ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه على الخصوص، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة.
تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. نعم إن الشيعة يخيلون بما ينقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل دون من سواه من الصحابة ذهاباً مع عقائد التشيع المعروفة لهم. والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق، لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة، وظهر كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف، فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع، وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقرر في الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين، وأفردوه بذلك تشبيهاً بالإمام في الظاهر، وأن يكون على وزانه في الباطن وسموه قطباً لمدار المعرفة عليه، وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل ذلك.
يشهد بذلك كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي، وما شحنوا به كتبهم في ذلك، مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو إثبات، وإنما هو مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم. والله يهدي إلى الحق.
تذييل: وقد رأيت أن أجلب هنا فصلاً من كلام شيخنا العارف، كبير الأولياء بالأندلس، أبي مهدي عيسى بن الزيات، كان يقع له أكثر الأوقات على أبيات الهروي التي وقعت له في كتاب المقامات توهم القول بالوحدة المطلقة أو يكاد يصرح بها وهي قوله:
ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد
توحيد من ينطق عن نعته ... تثنية أبطلها الواحد
توحيدة إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد
فيقول رحمه الله على سبيل العذر عنه: استشكل الناس إطلاق لفظ الجحود على كل من وحد الواحد ولفظ الإلحاد على من نعته ووصفه. واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا قائلها على الكفر واستخفوه. ونحن نقول على رأي هذه الطائفة أن معنى التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم وأن الوجود كله حقيقة واحدة وآنية واحدة. وقد قال أبو سعيد الجزار من كبار القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد في تلك الحقيقة وجود الاثنينية. وهم باعتبار حضرات الحس بمنزلة صور الضلال والصدا والمرأى. وأن كل ما سوى عين القدم، إذا استتبع فهو عدم. وهذا معنى: كان الله، ولا شيء معه، وهو الآن على ما هو عليه، كان عندهم. ومعنى قول لبيد الذي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " ألا كل شيء، ما خلا الله، باطل " . قالوا فمن وحد ونعت، فقد قال بموجد محدث، هو نفسه، وتوحيد محدث هو فعله، موجد قديم، هو معبود.
وقد تقدم معنى التوحيد انتفاء عين الحدوث، وعين الحدوث الآن ثابتة بل متعددة، والتوحيد مجحود، والدعوى كاذبة. كمن يقول لغيره، وهما معاً في بيت واحد: ليس في البيت غيرك! فيقول الآخر بلسان حاله: " لا يصح هذا إلا لوعدمت أنت " !...
وقد قال بعض المحققين في قولهم: خلق الله الزمان، هذه ألفاظ تناقض أصولها، لأن خلق الزمان متقدم على الزمان، وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمان، وإنما حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق وعجز اللغات عن تأدية الحق فيها وبها. فإذ تحقق أن الموحد هو الموحد، وعدم ما سواه جملة، صح التوحيد حقيقة. وهذا معنى قولهم: " لا يعرف الله إلا الله " . ولا حرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم والآثار، وإنما هو من باب: " حسنات الأبرار سيئات المقربين " . لأن ذلك لازم التقييد والعبودية والشفعية. ومن ترقى إلى مقام الجمع كان في حقه نقصاً، مع علمه بمرتبته، وأنه تلبيس تستلزمه العبودية ويرفعه الشهود، ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع. وأعرق الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة. ومدار المعرفة بكل اعتبار على الانتهاء إلى الواحدة وإنما صدر هذا القول من الناظم على سبيل، التحريض والتنبيه والتفطين، لمقام أعلى، ترتفع فيه الشفعية ويحصل التوحيد المطلق، عيناً لا خطاباً. وعبارة فمن سلم استراح، ومن نازعته حقيقة أنس بقوله: كنت سمعه وبصره. وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كله تحقق أمر فوق هذا الطور، لا نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا المقدار من الإشارة كاف. والتعلق في مثل هذا حجاب، وهو الذي أوقع في المقالات المعروفة " . انتهى كلام الشيخ أبي مهدي الزيات، ونقلته من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي ألفه في المحبة، وسماه التعريف بالحب الشريف. وقد سمعته من شيخنا أبي مهدي مراراً إلا أني رأيت رسوم الكتاب. أوعى له، لطول عهدي به. والله الموفق.
ثم إن كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا، انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالها، وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة. والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل، فإن كلامهم في أربعة مواضع: أحدها الكلام على المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال، لتحصل تلك الأذواق، التي تصير مقاماً ويترقى منه إلى غيره كما قلناه، وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب، مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد، وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدها ومكونها كمامر، وثالثها التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات، ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم، يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات، تستشكل ظواهرها، فمنكر ومحسن ومتأول. فأما الكلام في المجاهدات والمقامات، وما يحصل من الأذواق والمواجد في نتائجها، ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابها، فأمر لا مدفع فيه لأحد، وأذواقهم فيه صحيحة، والتحقق بها هو عين السعادة، وأما الكلام في كرامات القوم وإخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات، فأمر صحيح غير منكر. وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني من أئمة الأشعرية على إنكارها، لالتباسها بالمعجزة، فقد فرق المحققون من أهل السنة بينهما بالتحدي، وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور، لأن دلالة المعجزة على الصدق عقلية، فإن صفة نفسها التصديق. فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسها وهو محال. هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات، وإنكارها نوع مكابر.
وقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثير من ذلك، وهو معلوم مشهور. وأما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات، فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه، لما أنه وجداني عندهم، وفاقد الوجدان عندهم بمعزل عن أذواقهم فيه. واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه، لأنها لم توضع إلا للمتعارف، وأكثره من المحسوسات. فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك، ونتركه فيما تركناه من المتشابه. ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات، على الوجه الموافق لظاهر الشريعة، فأكرم بها سعادة. وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشطحات، ويؤاخذهم بها أهل الشرع، فاعلم أن الإنصاف. في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس، والواردات تملكهم حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب، والمجبور معذور.
فمن علم منهم فضله واقتداؤه، حمل على القصد الجميل من هذا وأمثاله. وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع لها، كما وقع لأبي يزيد البسطامي وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر، فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك، إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه. وأما من تكلم بمثلها، وهو حاضر في حسه، ولم يملكه الحال، فمؤاخذ أيضاً. ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج، لأنه تكلم في حضور، وهو مالك لحاله. والله أعلم.
وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام الملة الذين أشرنا إليهم من قبل، لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب، ولا هذا النوع من الإدراك، إنما همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعوا. ومن عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به، بل يفرون منه ويرون أنه من العوائق والمحن، وأنه إدراك من إدراكات النفس مخلوق حادث، وأن الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان. وعلم الله أوسع وخلقه أكبر، وشريعته بالهداية أملك، فلم ينطقوا بشيء مما يدركون. بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا من يكشف له الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده، بل ويلتزمون طريقتهم كما كانوا في عالم الحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء، ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا ينبغي أن يكون حال المريد. والله الموفق للصواب.
الفصل الثامن عشر
علم تعبير الرؤيا
هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الملة عندما صارت العلوم صنائع، وكتب الناس فيها. وأما الرؤيا والتعبير لها، فقد كان موجوداً في السلف كما هو في الخلف. وربما كان في الملوك والأمم من قبل، إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من تعبيرها. فلقد كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا، كما وقع في القرآن. وكذلك ثبت في الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر رضي الله عنه. والرؤيا مدرك من مدارك الغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وقال: " لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح، أو ترى له " .
وأول ما بدىء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاة الغداة يقول لأصحابه: " هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ " يسألهم عن ذلك ليستبشر بما وقع من ذلك، مما فيه ظهور الدين وإعزازه.
وأما السبب في كون الرؤيا مدركاً للغيب فهو أن الروح القلبي، وهو البخار اللطيف المنبعث من تجويف القلب اللحمي، ينتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدن، وبه تكمل أفعال القوى الحيوانية وإحساسها. فإذا أدركه الملال بكثرة التصرف في الإحساس بالحواس الخمس، وتصريف القوى الظاهرة، وغشي سطح البدن ما يغشاه من برد الليل، انخنس الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي، فيستجم بذلك لمعاودة فعله، فتعطلت الحواس الظاهرة كلها، وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول الكتاب. ثم إن هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من الإنسان، والروح العاقل مدرك لجميع ما في عالم الأمر بذاته، إذ حقيقته وذاته عين الإدراك. وإنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية، ما هو فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد خلا من هذا الحجاب وتجرد عنه، لرجع إلى حقيقته وهو عين الإدراك، فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خفت شواغله، فلا بد له من إدراك لمحة من عالمه بقدر ما تجرد له، وهو في هذه الحالة قد خفت شواغل الحس الظاهر كلها، وهي الشاغل الأعظم، فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك اللائقة به من عالمه. وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رجع به إلى بدنه. إذ هو ما دام في بدنه جسماني، لا يمكنه التصرف إلا بالمدارك الجسمانية. والمدارك الجسمانية للعلم إنما هي الدماغية، والمتصرف منها هو الخيال. فإنه ينترع من الصور المحسوسة صوراً خيالية، ثم يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت للحاجة إليها عند النظر والاستدلال. وكذلك تجرد النفس منها صوراً أخرى نفسانية عقلية، فيترقى التجريد من المحسوس إلى المعقول، والخيال واسطة بينهما. وكذلك إذا أدركت النفس من عالمها ما تدركه، ألقته إلى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له، ويدفعه إلى الحس المشترك، فيراه النائم كأنه محسوس، فيتنزل المدرك من الروح العقلي إلى الحسي. والخيال أيضاً واسطة. هذه حقيقة الرؤيا.
ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة وأضغاث الأحلام الكاذبة، فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. لكن إن كانت تلك الصور متنرلة من الروح العقلي المدرك فهي رؤيا، وإن كانت مأخوذة من الصور التي في الحافظة التي كان الخيال أودعها إياها، منذ اليقظة، فهي أضغاث أحلام.
واعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتها، فيستشعر الرائي البشارة من الله بما ألقى إليه في نومه: فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤيا، كأنه يعاجل الرجوع إلى الحس باليقظة، ولو كان مستغرقاً في نومه، لثقل ما ألقي عليه من ذلك الإدراك فيفر من تلك الحالة إلى حالة الحس التي تبقى النفس فيها منغمسة بالبدن وعوارضه، ومنها ثبوت ذلك الإدراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه، فلا يتخللها سهو ولا نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكر، بل تبقى متصورة في ذهنه إذا انتبه. ولا يغرب عنه شيء منها، لأن الإدراك النفساني ليس بزماني ولا يلحقه ترتيب، بل يدركه دفعة في زمن فرد. وأضغاث الأحلام زمانية، لأنها في القوى الدماغية يستخرجها الخيال من الحافظة إلى الحس المشترك كما قلناه. وأفعال البدن كلها زمانية فيلحقها الترتيب في الإدراك والمتقدم والمتأخر. ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. وليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانية، ولا ترتيب فيها. وما ينطبع فيها من الإدراكات فينطبع دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر. وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرة في الحفظ أياماً من العمر، لا تشذ بالغفلة عن الفكر بوجه، إذا كان الإدراك الأول قوياً، وإذا كان إنما يتذكر الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمال الفكر والوجهة إليها، وينسى الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادقة، وإنما هي من أضغاث الأحلام. وهذه العلامات من خواص الوحي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه " والرؤيا لها نسبة من النبوة والوحي كما في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فلخواصها أيضاً نسبة إلى خواص النبوة، وبذلك القدر، فلا تستبعد ذلك، فهذا وجه الحق. والله الخالق لما يشاء.
وأما معنى التعبير، فاعلم أن الروح العقلي إذا أدرك مدركه وألقاه إلى الخيال، فصوره، فإنما يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء، كما يدرك معنى السلطان الأعظم، فيصوره الخيال بصورة البحر، أو يدرك العداوة فيصورها الخيال في صورة الحية. فإذا استيقظ، وهو لم يعلم من أمره، إلا أنه رأى البحر أو الحية، فينظر المعبر بقوة التشبيه، بعد أن يتيقن أن البحر صورة محسوسة، وأن المدرك وراءها، وهو يهتدي بقرائن أخرى تعين له المدرك ، فيقول مثلاً هو السلطان: لأن البحر خلق عظيم يناسب أن تشبه به السلطان، وكذلك الحية، يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررها، وكذا الأواني تشبه بالنساء لأنهن أوعية، وأمثال ذلك. ومن المرئي ما يكون صريحاً، لا يفتقر إلى تعبير، لجلائها ووضوحها أو لقرب النسبة فيها بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيح، الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان. فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا تفتقر إلى تأويل، والتي من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إلى التعبير، والرؤيا التي من الشيطان هي الأضغاث.
واعلم أيضاً أن الخيال إذا ألقى إليه الروح مدركه، فإنما يصوره في القوالب المعتادة للحس، وما لم يكن الحس أدركه قط من القوالب فلا يصور فيه شيئأً. فلا يمكن من ولد أعمى اكمه أن يصور له السلطان بالبحر، ولا العدو بالحية، ولا النساء بالآواني، لآنه لم يدرك شيئاً من هذه. وإنما يصور له الخيال أمثال هذه، في شبهها ومناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشمومات. وليتحفظ المعبرمن مثل هذا، فربما اختلط به التعبيروفسد قانونه.
ثم إن علم التعبير، علم بقوانين كلية، يبني عليها المعبرعبارة ما يقص عليه. وتأويله كما يقولون: البحر يدل على السلطان، وفي موضع آخريقولون: البحريدل على الغيظ، وفي موضع آخر على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على العدو وفي موضع آخريقولون تدل على الحياة وفي موضع آخر هي كاتم سر وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية. ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هوأليق بالرؤيا. وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم، ومنها ما ينقدح في نفس المعبربالخاصية التي خلقت فيه، وكل ميسرلما خلق له. ولم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف. وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء، وكتبت عنه في ذلك قوانين، وتناقلها الناس لهذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعده. ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثروا. والمتداول بين أهل المغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني، من علماء القيروان، مثل الممتع وغيره، وكتاب الإشارة للسالمي من أنفع الكتب فيه وأحضرها. وكذلك كتاب المرقبة العليا لابن راشد من مشيختنا بتونس.
وهوعلم مضيء بنور النبوة للمناسبة التي بينهما ولكونها كانت من مدارك الوحي، كما وقع في الصحيح. والله علام الغيوب.
الفصل التاسع عشر
العلوم العقلية وأصنافها
وأما العلوم العقلية التي هي طبيعية للإنسان، من حيث إنه ذوفكرفهي غيرمختصة بملة ، بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها. وهي موجودة في النوع الإنساني، منذكان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة، وهي مشتملة على أربعة علوم: الأول علم المنطق، وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الآمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطأ من الصواب، فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها،، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره. ثم النظر بعد ذلك عندهم إما في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكونة عنها من المعدن والنبات والحيوان والأجسام الفلكية والحركات الطبيعية. أو النفس التي تنبعث عنها الحركات وغيرذلك، ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو العلم الثاني منها. وإما أن يكون النظر في الأمور التي وراء الطبيعة من الروحانيات، ويسمونه العلم الإلهي وهو العلم الثالث منها. والعلم الرابع وهو الناظر في المقادير، ويشتمل على اربعة علوم، وهي تسمى التعاليم.أولها: علم الهندسة، وهو النظر في المقادير على الإطلاق. إما المنفصلة من حيث كونها معدودة، أو المتصلة، وهي إما ذو بعد واحد وهو الخط، أو ذو بعدين وهو السطح، أو ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذين المقادير وما يعرض لها، أما من حيث ذاتها، أومن حيث نسبة بعضها إلى بعض.
وثانيها: علم الأرتماطيقي، وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد، ويؤخذ له من الخواص والعوارض اللاحقة.
وثالثها: علم الموسيقى، وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض وتقديرها بالعدد، وثمرته معرفة تلاحين الغناء.
ورابعها: علم الهيئة وهو تعيين الأشكال للأفلاك، وحصر أوضاعها وتعددها لكل كوكب من السيارة والثابتة، والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية! المشاهدة الموجودة لكل واحد منها، ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها.
فهذه اصول العلوم الفلسفية وهي سبعة: المنطق وهو المقدم منها وبعده التعاليم، فالآرتماطيقي أولا ثم الهندسة ثم الهيئة ثم الموسيقى، ثم الطبيعيات، ثم الإلهيات، ولكل واحد منها فروع تتفرع عنه. فمن فروع الطبيعيات الطب، ومن فروع علم العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الهيئة الأزياج، وهي قوانين لحسبانات حركات الكواكب وتعديلها، للوقوف على مواضعها متى قصد ذلك: ومن فروع النظر في النجوم علم الأحكام النجومية. ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها.
واعلم أن أكثر من عني بها في الأجيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في الدولة قبل الإسلام، وهما فارس والروم، فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما كان العمران موفوراً فيهم، والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره لهم، فكان لهذه العلوم بحور زاخرة في آفاقهم وأمصارهم. وكان للكلدانيين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسم. واخذ ذلك عنهم الامم من فارس ويونان، فاختص بها القبط، وطمى بحرها فيهم، كما وقع في المتلومن خبر هاروت وماروت، وشأن السحرة، وما نقله أهل العلم من شأن البرابي بصعيد مصر. ثم تتابعت الملل بحظر ذلك وتحريمه، فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن، إلا بقايا يتناقلها منتحلو هذه الصنائع. الله أعلم بصحتها. مع ان سيوف الشرع قائمة على ظهورها، مانعة من اختبارها.
وأما الفرس، فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيماً، ونطاقها متسعاً، لما كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك. ولقد يقال: إن هذه العلوم، إنما وصلت إلى يونان منهم، حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكة الكينية، فاستولى على كتبهم وعلومهم. إلأ أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس، وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم، ما لا يأخذه الحصر كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين. فكتب إليه عمرأن اطرحوها في الماء. فإن يكن ما فيها هدًى، فقد هدانا الله بأهدى منه ، وإن يكن ضلالاً فقد كفاناه الله. فطرحوها في الماء أو في النار، وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا.
وأما الروم فكانت الدولة منهم ليونان أولاً، وكان لهذه العلوم بينهم مجال رحب، وحملها مشاهير من رجالهم مثل أساطين الحكمة وغيرهم. واختص فيها المشاؤون منهم، أصحاب الرواق بطريقة حسنة في التعليم. كانوا يقرأون في رواق يظلهم من الشمس والبرد على ما زعموا. واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمون، من لدن لقمان الحكيم في تلميذه إلى سقراط الدن، ثم إلى تلميذه أفلاطون، ثم إلى تلميذه أرسطو، ثم إلى تلميذه الإسكندر الأفروسي وتامسطيوس وغيرهم. وكان أرسطو معلما للإسكندر ملكهم، الني غلب الفرس علي ملكهم، وانتزع الملك من أيديهم. وكان أرسخهم في هذه العلوم قدما وأبعدهم فيها صيتاً وشهرةً. وكان يسمى المعلم الأول، فطار له في العالم ذكر.
ولما انقرض أمر اليونان، وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين النصرانية، هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها. وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدةً باقيةً في خزائنهم. ثم ملكوا الشام، وكتب هذه العلوم باقيةٌ فيهم.
ثم جاء الله بالإسلام، وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له، وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم. وابتدأ أمرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع، حتى إذا تبحبح السلطان والدولة، وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم، وتفننوا في الصنائع والعلوم. تشوفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية، بما سمعوا من الأساقفة والأقسة المعاهدين بعض ذكر منها، وبما تسموا إليه أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم، أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب أوقليدوس وبعض كتب الطبيعيات. فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها، وازدادوا حريصاً على الظفر بما بقي منها. وجاء المأمون بعد ذلك، وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحله، فانبعث لهذه العلوم حرصاً، وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي. وبعث المترجمين لذلك، فأوعى منه واستوعب. وعكف عليها النظار من أهل الإسلام وحذقوا في فنونها، وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها. وخالفوا كثيراً من آراء المعلم الأول، واختصوه بالرد والقبول، لوقوف الشهرة عنه. ودونوا في ذلك الدواوين، واربوا على من تقدمهم في هذه العلوم. وكان من أكابرهم في الملة أبو نصر الفارابي، وأبو علي بن سينا بالمشرق، والقاضي أبو الوليد ابن رشد، والوزير أبو بكر بن الصائني بالأندلس، إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه العلوم. واختص هؤلاء بالشهرة والذكر، واقتصر كثيرون على انتحال التعاليم، وما ينضاف إليها من علوم النجامة والسحر والطلسمات. ووقفت الشهرة في هذا المنتحل على جابر بن حيان من أهل المشرق وعلى مسلمة بن أحمد المجريطي، من أهل الأندلس وتلميذه. ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة، واستهوت الكثير من الناس بما جنحوا إليها وقلدوا آراءها، والذنب في ذلك لمن ارتكبه. ولو شاء ربك ما فعلوه.
ثم إن المغرب والأندلس، لما ركدت ريح العمران بهما، وتناقصت العلوم بتناقصه، اضمحل ذلك منهما، إلا قليلاً من رسومه تجدها في تفاريق من الناس، وتحت رقبة من علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة، وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر، وأنهم على ثبج من العلوم العقلية والنقلية، لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم. ولقد وقفت بمصر على تآليف في المعقول متعددة لرجل من عظماء هراة، من بلاد خراسان، يشتهر بسعد الدين التفتازاني، منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان، تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية وتضلعاً بها وقدماً عالية في سائر الفنون العقلية. والله يؤيد بنصره من يشاء.
وكذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة، من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق، وأن رسومها هناك متجددة، ومجالس تعليمها متعددة، وداوينها جامعة وحملتها متوفرون، وطلبتها متكثرون. والله أعلم بما هنالك، وهو يخلق مايشاء ويختار.
الفصل العشرون
العلوم العددية
وأولها الأرتماطيقي، وهو معرفة خواص الأعداد من حيث التأليف، إما على التوالي أو بالتضعيف. مثل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة بعدد واحد: فإن جمع الطرفين منها مساو لجمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد، ومثل ضعف الواسطة، إن كانت عدة تلك الأعداد فرداً مثل الأعداد على تواليها والأزواج على تواليها والأفراد على تواليها. ومثل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة بأن يكون أولها نصف ثانيها، وثانيها نصف ثالثها إلخ، أو يكون أولها ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها إلخ. فإن ضرب الطرفين أحدهما في الأخر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد أحدهما في الآخر. ومثل مربع الواسطة إن كانت العدة فرداً، وذلك مثل أعداد زوج الزوج المتوالية من اثنين فأربعة فثمانية فستة عشر. ومثل ما يحدث من الخواص العددية في وضع المثلثات العددية والمربعات والمخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها بأن تجمع من الواحد إلى العدد الأخير، فتكون مثلثة. وتتوالى المثلثات هكذا في سطر تحت الأضلاع، ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله، فتكون مربعة. وتزيد على كل مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة وهلم جرا. وتتوالى الأشكال على توالي الأضلاع ويحدث جدول ذو طول وعرض. ففي عرضه الأعداد على تواليها، ثم المثلثات على تواليها، ثم المربعات، ثم المخمسات إلخ، وفي طوله كل عدد وأشكاله بالغاً ما بلغ. ويحدث في جمعها وقسمة بعضها على بعض طولاً وعرضاً خواص غريبة، استقريت منها، وتقررت في دواوينهم مسائلها. وكذلك ما يحدث للزوج والفرد، وزوج الزوج وزوج الفرد، وزوج الزوج والفرد، فإن لكل منها خواص مختصة به تضمنها هذا الفن وليست في غيره.
وهذا الفن أول أجزاء التعاليم وأثبتها، ويدخل في براهين الحساب. وللحكماء المتقدمين والمتأخرين فيه تآليف، وأكثرهم يدرجونه في التعاليم ولا يفرعونه بالتأليف.
فعل ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما المتأخرون فهم عندهم مهجوز إذ هو غير متداول، ومنفعته في البراهين لا في الحساب، فهجروه لذلك بعد أن استخلصوا زبدته في البراهين الحسابية، كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم.
علم الحساب
ومن فروع علم العدد صناعة الحساب، وهي صناعة عملية في حسبان الأعداد بالضم والتفريق. فالضم يكون في الأعداد بالأفراد وهو الجمع. وبالتضعيف، أي يضاعف عدد بآحاد عدد آخر، وهذا هو الضرب، والتفريق أيضاً يكون في الأعداد، إما بالإفراد، مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح، أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية، تكون عدتها محصلة وهو القسمة. وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد، وتلك النسبة تسمى كسراً. وكذلك يكون الضم والتفريق في الجذور، ومعناها العدد الذي يضرب في مثله، فيكون منه العدد المربع. والعدد الذي يكون مصرحاً به يسمى المنطق، ومربعه كذلك، ولا يحتاج فيه إلى تكلف عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرحاً به يسمى الأصم ومربعه: إما منطق مثل جذور ثلاثة الذي مربعه ثلاثة، وإما أصم، مثل جذر ثلاثة الذي مربعه جذر ثلاثة، وهو أصم، ويحتاج إلى عمل من الحسبان. فإن تلك الجذور أيضاً يدخلها الضم والتفريق. وهذه الصناعة الحسابية حادثة احتيج إليها للحسبان في المعاملات، وألف الناس فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها لأنها معارف متضحة وبراهينها منتظمة، فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصواب. وقد يقال من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره، إنه يغلب عليه الصدق لما في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس، فيصير ذلك له خلقاً ويتعود الصدق ويلازمه مذهباً. ومن أحسن التآليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغير. ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد، ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء، بما فيه من البراهين الوثيقة المباني، وهو كتاب جليل القدر أدركنا المشيخة تعظمه، وهو كتاب جدير بذلك. وساوق فيه المؤلف رحمه الله كتاب فقه الحساب، لابن منعم، والكامل للأحدب، ولخص براهينها وغيرها عن اصطلاح الحروف فيها، إلى علل معنوية ظاهرة، هي سر الإشارة بالحروف وزبدتها. وهي كلها مستغلقة، وإنما جاءها الاستغلاق من طريق البرهان شأن علوم التعاليم، لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها. وإذا قصد شرحها، فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال. وفي ذلك من العسرعلى الفهم، مما لا يوجد في أعمال المسائل، فتأمله. والله يهدي بنوره من يشاء، وهو القوي المتين.
علم الجبرومن فروعه الجبر والمقابلة، وهي صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض، إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. فاصطلحوا فيها على أن جعلوا للمجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب: أولها العدد لأن به يتعين المطلوب المجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه، وثانيها الشيء، لأن كل مجهول فهو من جهة إبهامه شيء، وهو أيضاً جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة الثانية، وثالثها المال وهو أمر مبهم، وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس من المضروبين. ثم يقع العمل المفروض في المسألة فيخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثرمن هذه الأجناس، فيقابلون بعضها ببعض. ويجبرون ما فيها من الكسر. حتى يصير صحيحاً. ويحطون المراتب إلى أقل الأسوس إن أمكن، حتى يصير إلى الثلاثة التي عليها مدار الجبر عندهم، وهي العدد والشيء والمال. فإن كانت المعادلة بين واحد وواحد، تعين، فالمال والجذر يزول إبهامه بمعادلة العدد ويتعين. والمال إن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن كانت المعادلة بين واحد واثنين أخرجه العمل الهندسي من طريق تفصيل الضرب في الاثنين، وهي مبهمة، فيعينها ذلك الضرب المفصل. ولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين. وأكثرما انتهت المعادلة عندهم إلى ست مسائل، لأن المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردة أو مركبة تجيء ستة. وأول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بن أسلم وجاء الناس على أثره فيه. وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة فيه. وشرحه كثير من أهل الأندلس فأجادوا. ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي. وقد بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلات إلى أكثر من هذه الستة الأجناس، وبلغها إلى فوق العشرين، واستخرج لها كلها أعمالاً وثيقة وأتبعها ببراهين هندسية. والله يزيد في الخلق ما يشاء، سبحانه وتعالى.
المعاملات والفرائض
ومن فروعه أيضاً المعاملات، وهو تصريف الحساب، في معاملات المدن، في البياعات والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات، تصرف في ذلك صناعتا الحساب في المجهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها. والغرض من تكثير المسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار العمل، حتى ترسخ الملكة في صناعة الحساب. ولأهل الصناعة الحسابية من أهل الأندلس تآليف فيها متعددة، من أشهرها معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة المجريطي وأمثالهم.ومن فروعه أيضاً الفرائض: وهي صناعة حسابية، في تصحيح السهام لذوي الفروض، في الوراثات إذا تعددت، وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته، أو زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على المال كله، أو كان في الفريضة، إقراراً أو انكار من بعض الورثة دون بعض، فيحتاج في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضة إلى كم تصح، وسهام الورثة من كل بطن مصححاً، حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة. فيدخلها من صناعة الحساب جزء كبير من صحيحه وكسوره وجذوره ومعلومه ومجهوله، ويترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها. فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه، وهو أحكام الوراثات في الفروض، والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلها، وعلى جزء من الحساب في تصحيح السهمان باعتبار الحكم الفقهي، وهي من أجل العلوم. وقد يورد أهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها، مثل: الفرائض ثلث العلم، وإنها أول ما يرفع من العلوم، وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلك الأحاديث كلها إنما هي في الفرائض العينية كما تقدم لا فرائض الوراثات، فإنها أقل من أن تكون في كميتها ثلث العلم. وأما الفرائض العينية فكثيرة، وقد ألف الناس في هذا الفن قديماً وحديثاً وأوعبوا. ومن أحسن التآليف فيه على مذهب مالك رحمه الله تعالى كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي، وكتاب ابن المنمر والجعدي والصردي وغيرهم. لكن الفضل للحوفي، فكتابه مقدم على جميعها. وقد شرحه من شيوخنا أبو عبد الله محمد بن سليمان الشطي كبير مشيخة فاس، فأوضح وأوعب. ولإمام الحرمين فيها تآليف على مذهب الشافعي، تشهد باتساع باعه في العلوم، ورسوخ قدمه، وكذا للحنفية والحنابلة. ومقامات الناس في العلوم مختلفة. والله يهدي من يشاء بمنه وكرمه، لا رب سواه.
الفصل الحادي والعشرون
العلوم الهندسية
هذا العلم هو النظر في المقادير: إما المتصلة كالخط والسطح والجسم، وإما المنفصلة، كالأعداد فيما يعرض لها من العوارض الذاتية. مثل أن كل مثلث فزواياه مثل قائمتين. ومثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان في جهة ولو خرجا إلى غير نهاية. ومثل أن كل خطين متقاطعين، فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان، ومثل أن الأربعة مقادير المتناسبة، ضرب الأول منها في الثالث كضرب الثاني في الرابع، وأمثال ذلك. والكتاب المترجم لليونانيين في هذه الضناعة كتاب أوقليدس، ويسمى كتاب الأصول الأركان، وهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمين، وأول ما ترجم من كتب اليونانيين في الملة أيام أبي جعفر المنصور، ونسخه مختلفة باختلاف المترجمين. فمنها لحنين بن إسحاق، ولثابت بن قرة، وليوسف بن الحجاج، ويشتمل على خمس عشرة مقالة. أربعة في السطوح، وواحدة في الأقدار المتناسبة، وواحدة في نسبة السطوح بعضها إلى بعض، وثلاثة في العدد، والعاشرة في المنطقات والقوى على المنطقات، ومعناه الجذور وخمس في المجسمات. وقد اختصره الناس مختصرات كثيرة، كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاء. أفرد له جزءاً منها اختصة به. وكذلك ابن أبي الصلت في كتاب الاقتصار وغيرهم. وشرحه آخرون شروحاً كثيرة وهو مبدأ العلوم الهندسية بإطلاق.واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره، لأن براهينها كلها بينة الانتظام جلية الترتيب، لا يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامها، فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع. وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: " من لم يكن مهندساً، فلا يدخلن منزلنا " . وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: " ممارسة علم الهندسة للفكر، بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضار والأدران " . وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه. ومن فروع هذا الفن الهندسة المخصوصة بالأشكال الكرية والمخروطات. أما الأشكال الكرية، ففيها كتابان من كتب اليونانيين لثاوذوسيوس وميلاوش فى سطوحها وقطوعها. وكتاب ثاوذوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميلاوش، لتوقف كثير من براهينه عليه. ولا بد منهما لمن يريد الخوض في علم الهيئة ، لأن براهينها متوقفة عليهما. فالكلام في الهيئة كله كلام في الكرات السماوية، وما يعرض فيها من القطوع والدوائر بأسباب الحركات كما نذكر، فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكرية سطوحها وقطوعها. وأما المخروطات، فهو من فروع الهندسة أيضاً. وهو علم ينظر فيما يقع في الأجسام المخروطة من الأشكال والقطوع، ويبرهن على ما يعرض لذلك من العوارض، ببراهين هندسية، متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهر في الصنائع العلمية التي موادها الأجسام، مثل النجارة والبناء، وكيف تصنع التماثيل الغريبة والهياكل النادرة، وكيف يتحيل على جر الأثقال ونقل الهياكل بالهندام والمخال وأمثال ذلك. وقد أفرد بعض المؤلفين في هذا الفن كتاباً في الحيل العملية، يتضمن من الصناعات الغريبة والجيل المستظرفة كل عجيبة. وربما استغلق على الفهوم لصعوبة براهينه الهندسية، وهو موجود بأيدي الناس، ينسبونه إلى بني شاكر. والله تعالى أعلم.
المساحةومن فروع الهندسة المساحة، وهو فن يحتاج إليه في مسح الأرض، ومعناه استخراج مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهما، أو نسبة أرض من أرض إذا قويست بمثل ذلك. ويحتاج إلى ذلك في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين الغراسة، وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. وللناس فيها موضوعات حسنة وكثيرة. والله الموفق للصواب بمنه وكرمه.
المناظرة من فروع الهندسة: وهوعلم يتبين به أسباب الغلط في الإدراك البصري، بمعرفة كيفية وقوعها، بناء على أن إدراك البصر يكون بمخروط شعاعي، رأسه نقطة الباصر وقاعدته المرثي. ثم يقع الغلط كثيراً في رؤية القريب كبيراً والبعيد صغيراً. وكذا رؤية الأشباح الصغيرة تحت الماء وراء الأجسام الشفافة كبيرة ورؤية النقط النازلة من المطر خطاً مستقيماً، والسلقة دائرة وأمثال ذلك. فيبتين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفياته بالبراهين الهندسية، ويتبين به أيضاً اختلاف المنظر في القمر، باختلاف العروض الذي ينبني عليه معرفة رؤية الأهلة وحصول الكسوفات وكثير من أمثال هذا. وقد ألف في هذا الفن كثير من اليونانيين. وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن الهيثم. ولغيره فيه الإسلاميين تآليف وهو من هذه العلوم الرياضية وتفاريعها.
الفصل الثاني والعشرون
علم الهيئة
وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة. ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك، لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية. كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك الشمس، بوجود حركة الإقبال والإدبار، وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب، على وجود أفلاك صغيرة، حاملة لها، متحركة داخل فلكها الأعظم ، وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن بحركة الكواكب الثابتة، وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعداد الميول له، وأمثال ذلك. وإدراك الموجود من الحركات وكيفياتها وأجناسها إنما هو بالرصد، فإنا إنما علمنا حركات الإقبال والإدبار به. وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرجوع والاستقامة وأمثال ذلك.وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيراً، ويتخذون له الآلات التي توضع ليرصد بها حركة الكوكب المعين. وكانت تسمى عندهم ذات الحلق. وصناعة عملها والبراهين عليه في مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليل. وكان في أيام المأمون شيء منه، وصنع لهذه الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق. وشرع في ذلك فلم يتم. ولما مات ذهب رسمه وأغفل، واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة، وليست بمغنية لاختلاف الحركات باتصال الأحقاب. وإن مطابقة حركة الآلة في الرصد لحركة الأفلاك والكواكب إنما هو بالتقريب ولا يعطي التحقيق، فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك التقريب. وهذه الهيئة صناعة شريفة، وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة ، بل إنما تعطي أن هذه الصور والهيآت للأفلاك لزمت عن هذه الحركات. وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازماً لمختلفين، وإن قلنا إن إن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم، ولا يعطي الحقيقة بوجه، على أنه علم جليل، وهو أحد أركان التعاليم. ومن أحسن التآليف فيه كتاب المجسطي، منسوباً لبطليموس. وليس من ملوك اليونان الذين أسماوهم بطليموس على ما حققه شراح الكتاب وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام كما فعله ابن سينا، وأدرجه في تعاليم الشفاء. ولخصه ابن رشد أيضاً من حكماء الأندلس، وابن السمح. وابن أبي الصلت في كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قربها وحذف براهينها هندسية. والله علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه لا إله إلا هو رب العالمين.
علم الأزياجومن فروعه علم الأزياج وهو صناعة حسابية على قوانين عددية، فيما يخص كل كوكب من طريق حركته، وما أدى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك، يعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها، على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة.
ولهذه الصناعة قوانين، كالمقدمات والأصول، لها في معرفة الشهور والأيام والتواريخ الماضية، وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات، واستخراج بعضها من بعض يضعونها في جداول مرتبة تسهيلاً على المتعلمين، وتسمى الأزياج. ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الضناعة تعليلاً وتقويماً. وللناس فيه تآليف كثيرة للمتقدممن والمتأخرين، مثل البتاني وابن الكماد. وقد عول المتأخرون لهذا العهد بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق من منجمي تونس في أول المائة السابعة. ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد. وأن يهودياً كان بصقلية ماهراً في الهيئة والتعاليم، وكان قد عني بالرصد وكان يبعث إليه بما يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها، فكأن أهل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء في آخر سماه المنهاج، فولع الناس لما سهل من الأعمال فيه، وإنما يحتاج إلى مواضع الكواكب من الفلك لتبنى عليها الأحكام النجومية، وهو معرفة الآثار التي تحدث عنها بأوضاعها في عالم الإنسان من الملك والدول والمواليد البشرية والكوائن الحادثة كما نبينه بعد، ونوضح فيه أدلتهم إن شاء الله تعالى. والله الموفق لما يحبه ويرضاه، لا معبود سواه.
الفصل الثالث العشرون
علم المنطق
وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات، والحجج المفيدة للتصديقات، وذلك لأن الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس. وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره، وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من المحسوسات. وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص المتفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص المحسوسة، وهي الكلي. ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى، توافقها في بعض، فيحصل له صورة تنطبق أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلي الذي لا يجد كلياً آخر معه يوافقه، فيكون لأجل ذلك بسيطاً. وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها. ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة عليهما، ثم ينظر بينهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي، وهو الجوهر، فلا يجد كلياً يوافقه في شيء، فيقف العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنائع، وكان العلم: إما تصوراً للماهيات، ويعني به إدراك ساذج من غير حكم معه، وإما تصديقاً، أي حكماً بثبوت أمر لأمر فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إما بأن تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض على جهة التآليف، فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج، فتكون تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص، وإما بأن يحكم بأمر على أمر فيثبت له ويكون ذلك تصديقاً. وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصور، لأن فائدة ذلك إذا حصل، فإنما هي معرفة حقائق الأشياء التي هي مقتضى العلم الحكمي. وهذا السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح وقد يكون بطريق فاسد، فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلمية، ليتميز فيها الصحيح من الفاسد، فكان ذلك قانون المنطق. وتكلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملاً جملاً ومتفرقاً متفرقاً. ولم تهذب طرقه ولم تجمع مسائله، حتى ظهر في يونان أرسطو، فهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله، وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها. ولذلك يسمى بالمعلم الأول، وكتابه المخصوص بالمنطق يسمى النص، وهو يشتمل على ثمانية كتب: أربعة منها في صورة القياس، وأربعة في مادته. وذلك أن المطالب التصديقية على أنحاء: فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه، ومنها ما يكون المطلوب فيه الظن، وهو على مراتب. فينظر في القياس من حيث المطلوب الذي يفيده، وما ينبغي أن تكون مقدماتة بذلك الاعتبار، ومن أي جنس يكون من العلم أو من الظن. وقد ينظر في القياس، لا باعتبار مطلوب مخصوص بل من جهة إنتاجه خاصة. ويقال للنظر الأول إنه من حيث المادة، ونعني به المادة المنتجة للمطلوب المخصوص من يقين أو ظن، ويقال للنظر الثاني إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على الإطلاق، فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية: الأول: في الأجناس العالية التي ينتهي إليها تجريد المحسوسات في الذهن، وهي التي ليس فوقها جنس، ويسمى كتاب المقولات.
والثاني: في القضايا التصديقية وأصنافها، ويسمى كتاب العبارة.
والثالث: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق، ويسمى كتاب القياس، وهذا آخر النظر من حيث الصورة.
ثم الرابع: كتاب البرهان، وهو النظر في القياس المنتج لليقين، وكيف يجب أن تكون مقدماته يقينية. ويختص بشروط أخرى لإفادة اليقين مذكورة فيه، مثل كونها ذاتية وأولية وغير ذلك. وفي هذا الكتاب الكلام في المعرنات والحدود، إذ المطلوب فيها إنما هو اليقين لوجوب المطابقة بين الحد والمحدود لا يحتمل غيرها، فلذلك اختصت عند المتقدمين بهذا الكتاب.
والخامس: كتاب الجدل وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم، وما يجب أن يستعمل فيه من المشهورات، ويختص أيضاً من جهة إفادته لهذا الغرض بشروط أخرى، وهي مذكورة هنالك. وفي هذا الكتاب يذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب القياس قياسه، بتمييز الجامع بين طرفي المطلوب المسمى بالوسط وفيه عكوس القضايا.
والسادس: كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد خلاف الحق، ويغالط به المناظر صاحبه وهو فاسد، وهذا إنما كتب ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه.
والسابع: كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم، وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات.
والثامن: كتاب الشعر، وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشببه خاصة للإقبال على الشيء أو النفرة عنه، وما يجب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية.
هذه هي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليونانيين، بعد أن تهذبت الصناعة ورتبت، رأوا أنه لا بد من الكلام في الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق للماهيات في الخارج، أو لأجزائها أو عوارضها وهي الجنس والفصل والنوع والخاص والعرض العام، فاستدركوا فيها مقالة، تختص بها مقدمة بين يدي الفن، فصارت مقالاته تسعاً، وترجمت كلها في الملة الإسلامية. وكتبها وتناولها فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص، كما فعله الفارابي وابن سينا، ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفاء، استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق، وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته، وهي الكلام في الحدود والرسوم، نقلوها من كتاب البرهان وحذفوا المقولات، لأن نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات. وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس، وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الكلام في القضايا ببعض الوجوه. ثم تكلموا في القياس، من حيث إنتاجه للمطالب على العموم، لا بحسب مادة. وحدقوا النظر فيه بحسب المادة، وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. وربما يلم بعضهم باليسير منها إلماماً وأغفلوها كأن لم تكن، وهي المهم المعتمد في الفن. ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاماً مستبجراً ونظروا فيه من حيث إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم، فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل الإمام فخر الدين ابن الخطيب، ومن بعده أفضل الدين الخونجي، وعلى كتبه معتمد المشارقة لهذا العهد. وله في هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل، ومختصر الموجز وهو حسن في التعليم، ثم مختصر الجمل في قدر أربعة أوراق، أخذ بمجامع الفن وأصوله، يتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعون به. وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن، وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه. والله الهادي للصواب. اعلم أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاء المتأخرون من بعدهم من لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب، فسامحوا في ذلك بعض الشيء. وأكب الناس على انتحاله من يومئذ إلا قليلاً، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين، فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبين لك نكتة القبول والرد في ذلك، لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم، وذلك أن المتكلمين لما وضعوا علم الكلام، لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، كانت طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل علىحدث العالم بأثبات الآعراض وحدوثها وامتناع خلو الآجسام عنها وما لا يخلو عن الحوادث حادث وكأثبات التوحيد بدليل التمانع وأثبات الصفات القديمة بالجوامع الآربعة إلحاقاً
للغائب بالشاهد وغير ذلك " من أدلتهم المذكورة في كتبهم ثم قرروا تلك الآدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لها مثل إثبات الجوهر الفرد والزمن الفرد والخلاء بين الآجسام ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات وأن العرض لا يبقى زمنين وإثبات الحال وهي صفة لموجود لاموجودة ولامعدومة وغير ذلك من قواعدهم التي بنوا عليها أدلتهم الخاصة ثم ذهب الشيخ أبوالحسن والقاضي أبو بكر والآستاذ أبو إسحق إلى أن أدلة العقائد منعكسة بمعنى أنها إذا بطلت بطل مدلولها ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها بمثابة العقائد، والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها. وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس، التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض والعام وهذا باطل عند المتكلمين. والكلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبار ذهني ليس في الخارج ما يطابقه، أو حال عند من يقول بها فتبطل الكليات الخمس والتعريف المبني عليها والمقولات العشر، ويبطل العرض الذاتي، فتبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان وتبطل المواضع التي هي لباب كتاب الجدل. وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين الطرفين في القياس، ولا يبقى إلا القياس الصوري. ومن التعريفات المساوىء في الصادقية على إفراد المحمود، لا يكون أعم منها، فيدخل غيرها، ولا أخص فيخرج بعضها، وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنع، والمتكلمون بالطرد والعكس، وتنهدم أركان المنطق جملة. وإن أثبتنا هذه كما في علم المنطق ابطلنا كثيرا من مقدمات المتكلمين فيؤدي إلى إبطال أد لتهم على العقائد كما مر، فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق، وعدوه بدعة أو كفرا على نسبة الدليل الذي يبطل. والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس الأدلة، ولم يلزم عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلوله،وصح عندهم رأي أهل المنطق في التركيب العقلي ووجود الماهيات الطبيعية وكلياتها في الخارج، قضوا بأن المنطق غير مناف للعقائد الإيمانية، وإن كان منافيا لبعض أدلتها، بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية، كنفي الجوهر الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرها، ويستبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى يصححونها بالنظر والقياس العقلي. ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه، وهذا راي الإمام والغزالي وتابعهما لهذا العهد، فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يذهبون إليه. والله الهادي والموفق للصواب.
الفصل الرابع والعشرون
الطبيعيات
وهوعلم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون، فينظرفي الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن، وما يتكون في الأرض من العيون والزلازل، وفي الجو من السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك. وفي مبدإ الحركة للأجسام وهو النفس على تنوعها في الإنسان والحيوان والنبات. وكتب ارسطوفيه موجودة بين ايدي الناس ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة، أيام المأمون، وألف الناس على حذوها مستتبعين لها بالبيان والشرح.وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء، جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة كما قدمنا ، ثم لخصه في كتاب النجاة وفي كتاب الإشارات، وكأنه يخالف ارسطو في الكثيرمن مسائلها ويقول برأيه فيها. وأما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعا له غيرمخالف. وألف الناس بعده! في ذلك كثيراً، لكن هذه هي المشهورة لهذا العهدوالمعتبرة ، فى الصناعة. ولأهل المشرق عناية بكتاب الإشارات لابن سينا، وللإمام ابن الخطيب عليه شرح حسن، وكذا الآمدي. وشرحه أيضاً نصير الدين الطوسي المعروف بخواجة، من أهل المشرق، وبحث مع الإمام في كثير من مسائله، فأوفى على أنظارهوبحوثه. وفوق كل ذي علم عليم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الفصل الخامس والعشرون
علم الطب
ومن فروع الطبيعيات صناعة الطب، وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالآدوية والآغذية، بعد أن يبين المرض الذي يخص كل عضومن أعضاء البدن، وأسباب تلك الامراض التي تنشأ عنها وما لكل مرض من الآدوية، مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية وقواها، وعلى المرض بالعلامات المؤذية بنضجه وقبوله للدواء، أولاً: في السجية والفضلات والنبض، محاذين لذلك قوة الطبيعة، فإنها المدبرة في حالتي الصحة والمرض. وإنما الطيبب يحاذيها ويعينها بعض الشيء، بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن،ويسمى العلم الجامع لهذا كله علم الطب. وربما أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علماًخاصاً، كالعين وعالمها وأكحالها. وكذلك ألحقوا بالفن منافع الأعضاء ومعناه التي خلق لأجلها كل عضو من أعضاء البدن الحيواني. وإن لم يكن ذلك من موضوع علم الطب، إلا إنهم جعلوه من لواحقه وتوابعه.
ولجالينوس في هذا الفن كتاب جليل، عظيم المنفعة، وهو إمام هذه الصناعة التي ترجمت كتبه فيها من الأقدمين، يقال إنه كان معاصرا لعيسى عليه السلام، ويقال إنه مات بصقلية في سبيل تغلب ومطاوعة اغتراب. وتآليفه فيها هي الآمهات التي اقتدى بها جميع الآطباء من بعده. وكان في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء الغاية، مثل الرازي والمجوسي وابن سينا، ومن أهل الأندلس أيضاً كثيرٌ. وأشهرهم ابن زهر. وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه، وهي من الصنائع التي لا تستدعيها إلا الحضارة والترف كما نبينه بعد.
وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصره علىبعض الأشخاص، ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه، وربما يصح منه البعض، إلا أنه ليس على قانون طبيعي، ولا عن موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم أطباء معروفون: كالحرث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، وليس من الوحي في شىءوإنما هوأمر كان عادياً للعرب. ووقع في ذكر أحوال النبي صلىالله عليهوسلم، من نوع ذكرأحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: " أنتم أعلم بأموردنياكم . فلا ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه ، اللهم إلا إن استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإيماني ، فيكون له اثر عظيم في النفع. وليس ذلك من الطب المزاجي وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية، كما وقع في مداواة المبطون بالعسل ونحوه. والله الهادي إلى الصواب لا رب سواه.
الفصل السادس والعشرون
الفلاحة
هذه الصناعة من فروع الطبيعيات، وهي النظرفي النبات من حيث تنميته ونشؤه بالسقي والعلاج واستجادة المنبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من ذلك كله. وكان للمتقدمين بها عناية كثيرة، وكان النظر فيها عندهم عاماً في النبات من جهة غرسه وتنميته ومن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب والهياكل المستعمل ذلك كله في باب السحر، فعظمت عنايتهم به لأجل ذلك. وترجم من كتب اليونانيين، كتاب الفلاحة النبطية، منسوبة لعلماء النبط، مشتملة من ذلك على علم كبير. ولما نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب، وكان باب السحر مسدوداً، والنظر فيه محظوراً، فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في ذلك، وحذفوا الكلام في الفن الآخرمنه جملةً. واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج، وبقي الفن الآخرمنه مغفلأ. نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمهات من مسائله كما نذكره عند الكلام على السحر إن شإء الله تعالى.وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة، ولا يعدون فيها الكلام في الغراس والعلاج وحفظ النبات من حوائجه وعوائقه وما يعرض في ذلك كله وهي موجودة.
الفصل السابع والعشرون
علم الإلهيات
وهي علم ينظر في الوجود المطلق. فأولاً في الأمور العامة للجسمانيات والروحانيات، من الماهيات والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان وغير ذلك، ثم ينظر في مبادىء الموجودات وأنها روحانيات، ثم في كيفية صدور الموجودات عنها ومراتبها، ثم في أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام وعودها إلى المبدإ. وهو عندهم علم شريف يزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوجود على ما هو عليه، وأن ذلك عين السعادة في زعمهم وسيأتي الردعليهم بعد. وهوتال للطبيعيات في ترتيبهم، ولذلك يسمونه علم ماوراء الطبيعة وكتب المعلم الأول فيه موجودة بين أيدي الناس ولخصه ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وكذلك لخصها ابن رشد من حكماء الأندلس ولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيها، ورد عليهم الغزالي مارده منها، ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث، وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات ومسائله بمسائلها، فصارت فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء فى مسائل الطبيعيات والإلهيات وخلطوهما فناً واحداً قدموا فيه الكلام في الأمور العامة، ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيات وتوابعها، إلى آخر العلم، كما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية، وجميع من بعده من علماء الكلام.
وصار علم الكلام مختلطاً بمسائل الحكمة، وكتبه محشوة بها، كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد. والتبس ذلك على الناس، وهو صواب، لأن مسائل علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من الشريعة، كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه، بمعنى أنها لا تثبت إلا به. فإن العقل معزول عن الشرع وأنظاره. وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج، فليس بحثاً عن الحق فيها ليعلم بالدليل بعد أن لم يكن معلوماً هو شأن الفلسفة، بل إنما هو التماس حجة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها، وتدفع شبه أهل البدع عنها، الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية. وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها، وكثير ما بين المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية، فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلهية، فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك، فينبغي أن نقدمة على مداركنا ونثق به دونها، ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولوعارضه، بل نعتقد ما أمرنا به اعتقاداً وعلماً، ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه.
والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد في معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية، فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس معارضتهم، واستدعى ذلك الحجج النظرية، ومحاذاة العقائد السلفية بها. وأما النظر في مسائل الطبيعيات والإلهيات بالتصحيح والبطلان، فليس من موضوع علم الكلام، ولا من جنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما مختلطان عند المتأخرين في الوضع والتآليف. والحق، مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل. وإنما جاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال، وصار احتجاج أهل الكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل، وليس كذلك. بل إنما هو رد على الملحدين، والمطلوب مفروض الصدق معلومة.
وبهذا جاء المتأخرون من غلاة المتصوفة المتكلمين بالمواجد أيضاً، فخلطوا مسائل الفنين بفنهم وجعلوا الكلام واحداً فيها كلها. مثل كلامهم في النبوات والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة متغايرة مختلفة، وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة، لأنهم يدعون فيها الوجدان ويفرون عن الدليل. والوجدان بعيد عن المدارك العلمية وأبحاثها وتوابعها كما بيناه ونبينه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم بالصواب.
الفصل الثامن والعشرون