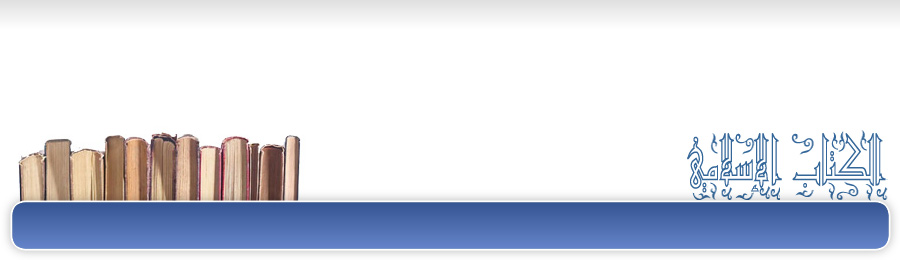كتاب : الإمامة في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف : شيخ الإسلام ابن تيمية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الكتاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
وبعد ...
إن
مسألة الإمامة أو الولاية في اعتقاد الرافضة من أساسيات دينهم، وإن لها من
المنزلة في نفوس معتنقيها ما يفوق منزلة الشهادتين وبقية أركان الدين:
1
- عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بُني الإسلام على خمس: على
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية(1).
2
- عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: بُني الإسلام على خمس:
على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي
بالولاية، فأخذ الناس بأربعة وتركو هذه - يعني الولاية -(2).
3 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بُني الإسلام على خمسة أشياء:
على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية.
قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل ؟
فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن...(3).
وروايات كثيرة وضعوها في ذلك أعرضنا عنها خشية الإطالة.
ومن
ضمن اعتقادات الرافضة أن الله تعالى لا يقبل عمل عامل إلا إذا أقرّ
بالولاية للأئمة المعصومين وأن الله تعالى نصّ على إمامتهم ولا يسع الناس
إلا متابعتهم واعتقاد ولايتهم والبراءة من أعدائهم الذين ناصبوهم،
فالولاية محور كل شيء، وأن العبد إن جاء يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة
وجهاد وحجّ ولم يأت بهذا الاعتقاد فعمله غير مقبول، فيزعمون أن الصادق
رحمه الله تعالى قال: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جلّ
جلاله عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض، وعن
الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقرّ بولايتنا ثم مات عليها
قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه، وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي الله
جلّ جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئاً من أعماله(4).
بل لو أن
الإنسان منذ خلق السماوات والأرض عَبَدَ الله بين الركن والمقام، ومكث تلك
الفترة في الدعاء والإنابة ثم لم يقرّ بتلك الولاية المزعومة لدخل النار،
فيقولون: "نزل جبرئيل على النبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا محمد السلام
يقرئك السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأرضين السبع ومن
عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني هناك
منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية عليّ لأكببته في
سقر(5).
وفي رواية أخرى "فمن وصلنا وصله الله ومن احبنا أحبه الله،
ومن حرمنا حرمه الله، أفتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم
أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، قال: ذلك مكة الحرام التي رضيها الله
لنفسه حرماً وجعل بيته فيها، ثم قال: أتردون أي البقاع أفضل فيها عند الله
حرمة؟ فلم يتكلم أحد منّا. فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك المسجد
الحرام، ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة؟ فلم
يتكلم أحد منّا، فكان هو الراد على نفسه فقال: ذاك بين الركن والمقام وباب
الكعبة، وذلك حطيم إسماعيل عليه السلام ذاك الذي كان يزود فيه غنيماته
ويصلّي فيه، والله لو أن عبداً صفّ قدميه في ذلك المقام، قام الليل مصلياً
حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقّنا وحرمتنا
أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبداً(6).
وأيضاً: "ولو أن عبداً
عمره الله فيما بين الركن والمقام وفيما بين القبر والمنبر يعبده ألف عام،
ثم ذبح عليّ فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح، ثم لقي الله عز وجل
بغير ولايتنا لكان حقيقاً على الله عز وجل أن يكبّه على منخريه في نار
جهنم(7).
وأضفوا على الأئمة صفات الله تعالى، بل تجاوزوا ذلك حيث وصفوا
الله تعالى بالبداء وهو العلم بالشيء بعد حدوثه، بينما نفوا عن أئمتهم
المزعومين الجهل والسهو، وزعموا أن الأئمة يعلمون الغيب وما تخفي الصدور
وما في الأرحام.
والرافضة يُكفّرون كل من يخالفهم في مسألة الإمامة بل
بنجاسة المخالف، وفي مقابل ذلك وضعت الرافضة فضائل ومناقب عديدة لمعتقد
الولاية فاقت تزكية اليهود لأنفسهم، والأغرب من ذلك أن كل رافضي يقترف
الخطايا فإنما إثم لك يُحسب على المخالف لهم وهم أهل السنة(8)، وحديث
الطينة مشهور عندهم.
ونظراً لاتخاذ الرافضة الكذب ديناً في إرساء
قواعد دينهم، فإنهم تأولوا القرآن الكريم بما يناسب خدمة دينهم، بل تجرّؤا
أكثر من ذلك فقاموا كأسلافهم من اليهود بالتحريف في الكتب السماوية، وإن
الناظر في تحريف الرافضة للقرآن الكريم وإضافة أسماء أئمتهم ضمن الآيات
القرآنية ليجد العجب العجاب، ويكفينا أن نذكر مثالاً واحداً على ذلك ومن
أراد التوسع في ذلك فليراجع الكتب التي بحثت في موضوع تحريف الرافضة
للقرآن الكريم.
عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام
قال: سألته عن قول الله جل وعز: { يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ }، قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام
بأفواههم.
قلت: { وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ }(9).
قال: والله متم الإمامة لقوله عز وجل: { الذين آمنوا(10) بالله ورسوله
والنور الذي أنزلنا }(11) فالنور هو الإمام.
قلت: { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ }.
قال: وهو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق.
قلت: { لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ }.
قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه، والولاية هي دين الحق.
قلت: { لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ }.
قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم، قال يقول الله: "والله متم
ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية عليّ عليه السلام".
قلت: هذا تنزيل ؟
قال: نعم، أما هذا الحرف فتنزيل، وأما غيره فتأويل.
قلت: { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا }.
قال:
إن الله تبارك وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيّه منافقين، وجعل
من جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمداً وأنزل بذلك قرآنا، فقال: "يا محمد إذا
جاءك بولاية وصيّك قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله
يشهد أن المنافقين بولاية عليّ لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنّة فصدّوا عن
سبيل الله (والسبيل هو الوصي) إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا
برسالتك وكفروا بولاية وصيّك { فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا
يَفْقَهُونَ }(12)".
قلت: ما معنى "لا يفقهون" ؟
قال: يقول: لا يعقلون بنبوتك.
قلت: "وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله".
قال:
وإذا قيل لهم: ارجعوا إلى ولاية عليّ يستغفر لكم النبي من ذنوبكم {
لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ } قال: { وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ } عن ولاية عليّ
{ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ } عليه، ثم عطف القول من الله بمعرفته بهم فقال:
{ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ } يقول: الظالمين لوصيّك.
قلت: { أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي
سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }(13).
قال:
إن الله ضرب مثل من حاد عن ولاية عليّ كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره
وجعل من تبعه سوياً على صراط مستقيم، والصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه
السلام.
قال: قلت: قوله: { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }.
قال: يعني جبرئيل عن الله في ولاية علي.
قال: قلت: { وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ }.
قال:
قالوا: إن محمداً كذّاب على ربّه وما أمره الله بهذا في عليّ، فأنزل الله
بذلك قرآنا فقال: "إن ولاية عليّ تنزيل من رب العالمين، ولو تقوَّل علينا
محمد بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين" ثم عطف
القول فقال: "إن ولاية عليّ لتذكرة للمتقين للعالمين" وإنا لنعلم أن منكم
مكذبين. وإن عليّاً لحسرة على الكافرين. وإن ولايته لحق اليقين. فسبح يا
محمد باسم ربك العظيم"(14).
يقول: اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل.
قلت: قوله: { لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ }.
قال: الهدى الولاية آمنا بمولانا، فمن آمن بولاية مولاه { فَلا يَخَافُ
بَخْسًا وَلا رَهَقًا }.
قلت: تنزيل ؟
قال: لا تأويل.
قلت: قوله: { إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا }.
قال:
إن رسول الله صلّى الله عليه وآله دعا الناس إلى ولاية عليّ فاجتمعت إليه
قريش فقالوا: يا محمد أعفنا من هذا، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه
وآله: هذا إلى الله ليس إليّ، فاتهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله: "قل إني
لن يجيرني من الله إن عصيته أحداً ولن أجد من دونه ملتحداً، إلا بلاغاً من
الله ورسالاته في عليّ"(15).
قلت: هذا تنزيل ؟
قال: نعم، ثم قال توكيدا: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}.
قلت: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عدداً.
قلت: يعني بذلك القائم وأنصاره.
قلت: { فَاْصِبْر عَلَى مَا يَقُولُونَ }.
قال: يقولون فيك { وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً، وَذَرْنِي
وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً }(16).
قلت: إن هذا تنزيل ؟
قال: نعم.
قلت: { لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }.
قال: يستيقنون أن الله ورسوله ووصيّه حقّ.
قلت: { وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا }.
قال: يزدادون بولاية الوصي إيماناً.
قلت: { وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْمُؤْمِنُونَ }.
قال: بولاية عليّ.
قلت: ما هذا الارتياب ؟
قال: يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله، فقال: ولا يرتابون
في الولاية.
قلت: { وَمَا هِيَ إِلاّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ }.
قال: نعم ولاية عليّ.
قلت: { إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ }.
قال: الولاية.
قلت: { لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ }.
قال: من تقدم إلى ولايتنا أُخّر عن سقر، ومن تأخر عنّا تقدّم إلى سقر.
قلت: { إِلاّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ }.
قال: هم والله شيعتنا.
قلت: { لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ }.
قال: إنّا لم نتولّ وصيّ محمد والأوصياء من بعده ولا يصلّون عليهم.
قلت: { فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ }.
قال: عن الولاية معرضين.
قلت: { كَلاّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ }.
قال: الولاية.
قلت: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ }.
قال: يوفون الله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا.
قلت: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً }.
قال: بولاية عليّ تنزيلا.
قلت: هذا تنزيل ؟
قال: نعم ذا تأويل.
قلت: { إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ }(17).
قال: الولاية.
قلت: { يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ }(18).
قال: في ولايتنا.
قلت: { وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا }(19).
قال: ألا ترى أن الله يقول: { وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }(20).
قال:
إن الله أعز وأمنع من أن يظلم أو أن يظلم أو أن ينسب نفسه إلى ظلم، ولكن
الله خلطنا نفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قرآناً
على نبيه فقال: "وما ظلمناهم { وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }.
قلت: هذا تنزيل ؟
قال: نعم.
قلت: { وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }.
قال: يقول: ويل للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية عليّ.
{ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ }(21).
قال: الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء.
{ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ }(22).
قال: من أجرم إلى آل محمد وركب ومن وصيّه ما ركب.
قلت: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ }(23).
قال: نحن والله وشيعتنا، ليس على ملة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها
براء.
قلت: { يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ
} الآية(24).
قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً.
قلت: ما تقولون إذا تكلمتم ؟
قال: نمجّد ربنا ونصلّي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا.
قلت: { ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ }(25).
قال: يعني أمير المؤمنين عليه السلام.
قلت: تنزيل ؟
قال: نعم(26).
ولا
عجب أن يكون الرافضة على هذا المنوال، فمؤسس دينهم يهودي يدعى عبد الله بن
سبأ حيث "إن الصبغة الانتقائية التي أضفاها اليهود لأنفسهم قديماً وحديثاً
هي التي دفعت ابن سبأ وأمثاله إلى ضرب من الحيرة والشك والتساؤل: أيمكن
للخليقة وللقيادة أن تكون منتخبة؟. لقد تاهت نفوسهم المكية بتقديس
الممتازين، وما زادتها الأحداث التاريخية إلا شكاً واضطراباً، وبحثوا لهم
عن مخرج فوجدوه في القول بالوصية وبالإمامة التي تعد جزءاً من الرسالة
السماوية. ولما لم يجدوا في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة ما يدعم
مذهبهم، أباحوا لأنفسهم أن تتشبث بالسراب، فوضعوا أحاديث مخاطبة الشمس
لعلي، ومناظرات الرهبان للمسلمين، وأنطقوا الجماجم، وكان هدفهم إرضاء
عقدهم النفسية وإفساد سماحة الدين، ونقاوة الأحاديث النبوية تحت ستار
الدفاع عن آل البيت، ورفعهم إلى درجة تجعل المعجزات الكثيرة تظهر على
أيديهم لتبرهن أنهم القادة، وأن أتباعهم هم الفائزون.
وقد غاب عن هؤلاء أن ما ذهبوا إليه مفضوح، لأن الإسلام أتى بمبدأ
تقديم العمل على النسبة(27).
والباعث
على جمع هذا الكتاب أن كثيراً من الأخوة اقترحوا عليّ أن أقوم بتصنيف كتاب
يرد على الشبهات التي يثيرها الرافضة في كتبهم حول مسألة الإمامة لا سيما
استشهادهم على صحة معتقدهم بروايات أهل السنة، فاستخرت الله تعالى وجمعت
ما تيسر جمعه من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى "منهاج
السنة" وعلّقت على مواضع يسيرة منه مكتفياً بتعليقات الدكتور محمد رشاد
سالم رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير
الجزاء ورمزت إلى تعليقاتي بـ"قال أبو عبد الرحمن"، و"م" حيث هو مذكور في
نهاية التعليق.
وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته العليّ القدير أن يجعل
ثواب ذلك في ميزان حسناتي يوم القيامة وأن يغفر لي ويجعلني من عباده
الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبو عبد الرحمن
محمد مال الله
17 صفر الخير 1413هـ
الفصل الأول
الرد على من قال أن علياّ ثبتت له الولاية كما أثبتها الله تعالى لنفسه
ولرسوله
قال الرافض: "المنهج الثاني: في الأدلة المأخوذة من القرآن، والبراهين
الدّالّة على إمامة عليّ من الكتاب العزيز كثيرة.
البرهان
الأول: قوله تعالى: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } [المائدة: 55] وقد أجمعوا أنها نزلت في
عليّ.
قال الثعلبي في إسناده إلى أبي ذر: قال: سمعت رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم بهاتين وإلا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: "عليٌّ
قائد البررة، وقاتل الكفرة، فمنصور من نصره، ومخذول من خذله"(28) أمَا
إنّي صليت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوماً صلاة الظهر، فسأل سائل
في المسجد، فلم يعطه أحدٌ شيئاً، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال: اللهم
إنك تشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يعطني
أحدٌ شيئاً، وكان عليُّ راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى، وكان متختماً فيها،
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم، وذلك بعين النبي صلّى الله عليه وسلّم.
فلما
فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء، وقال: "اللهم إن موسى سألك وقال: {
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ
أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي
أَمْرِي} [طه: 25-32] فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: { سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا
بِآيَاتِنَا } [القصص: 35] اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي
صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، عليّاً اشدد به ظهري".
قال
أبو ذر: فما استتم كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(29) حتى نزل عليه
جبريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: {
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }
[المائدة: 55].
ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي أن هذه نزلت
في عليّ(30)، والوليّ هو المتصرف، وقد أثبت له الولاية في الآية، كما
أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله".
والجواب من وجوه: أحدها: أن
يقال: ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظناً، بل كل ما ذكره كذب وباطل، من
جنس السفسطة. وهو لو أفاده ظنوناً كان تسميته براهين تسمية براهين تسمية
منكرة؛ فإن البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين،
كقوله تعالى: { وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ
هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ
إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [البقرة: 111].
وقال تعالى: { أَمَّن
يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ
وَالأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ } [النمل: 64].
فالصادق لابد له من برهان على صدقه، والصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم.
وهذا
الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب، فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميع
مقدماتها صادقة، فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باطل. وسنبين إن
شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها، فتسمية هذه براهين من
أقبح الكذب.
ثم إنه يعتمد في تفسير القرآن على قولٍ يحكى عن بعض الناس،
مع أنه قد يكون كذباً عليه، وإن كان صدقاً فقد خالفه أكثر الناس. فإن كان
قول الواحد الذي لم يُعلم صدقه، وقد خالفه الأكثرون برهاناً، فإنه يقيم
براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله، فتتعارض البراهين فتتناقض،
والبراهين لا تتناقض.
بل سنبين إن شاء الله تعالى قيام البراهين
الصادقة التي لا تتناقض على كذب ما يدّعيه من البراهين، وأن الكذب في
عامتها كذب ظاهر، لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه، وأن البراهين
الدّالّة على نبوة الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن دين الإسلام حق، تناقض
ما ذكره من البراهين، فإنه غاية ما يدّعيه من البراهين إذا تأمله اللبيب،
وتأمل لوازمه وجده يقدح في الإيمان والقرآن والرسول.
وهذا لأن أصل
الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين، مقصودهم الطعن في القرآن والرسول
ودين الإسلام، فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به طعناً في دين
الإسلام، وروجوها على أقوام، فمنهم من كان صاحب هوى وجهل، فقبلها لهواه،
ولم ينظر في حقيقتها. ومنهم من كان له نظر فتدبرها، فوجدها تقدح في حق
الإسلام، فقال بموجبها، وقدح بها في دين الإسلام، إما لفساد اعتقاده في
الدين، وإما لاعتقاده أن هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من دين الإسلام.
ولهذا
دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب؛ فإن ما تنقله الرافضة من الأكاذيب
تسلَّطوا به على الطعن في الإسلام، وصارت شبهاً عند من لم يعلم أنها كذب،
وكان عنده خبرة بحقيقة الإسلام.
وضلّت طوائف كثيرة من الإسماعيلية
والنصيرية، وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين. وكان مبدأ ضلالهم
تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث، كأئمة
العُبَيْديين إنما يقيمون مبدأ دعوتهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة،
ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضُّلاّل، ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة،
إلى القدح في عليّ، ثم في النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم في الإلهية، كما
رتّبه لهم صاحب البلاغ الأكبر، والناموس الأعظم. ولهذا كان الرفض أعظم باب
ودهليز إلى الكفر والإلحاد.
ثم نقول: ثانياً: الجواب عن هذه الآية حق من وجوه:
الأول:
أنّا نطالبه بصحة هذا النقل، أو لا يُذكر هذا الحديث على وجه تقوم به
الحجة؛ فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي، أو نقل الإجماع على ذلك من غير
العالمين بالمنقولات، الصادقين في نقلها، ليس بحجة باتفاق أهل العلم، إن
لم نعرف ثبوت إسناده.
وكذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر وعمر، لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت
روايته باتفاق أهل العلم.
فالجمهور - أهل السنة - لا يثبتون بمثل هذا شيئاً يريدون إثباته: لا
حكماً، ولا فضيلة، ولا غير ذلك، وكذلك الشيعة.
وإذا
كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها، بطل الاحتجاج به. وهكذا
القول في كل ما نقله وعزاه إلى أبي نُعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن
المغازلي ونحوهم.
الثاني: قوله "قد أجمعوا أنها نزلت في عليّ" من أعظم
الدعاوي الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في عليّ
بخصوصه، وأن عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث
على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع(31).
وأما ما نقله من
تفسير الثعلبي(32)، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من
الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في
فضل تلك السورة، وكأمثال ذلك.. ولهذا يقولون: "هو كحاطب ليل".
وهكذا الواحدي(33) تلميذه، وأمثالهما من المفسرين: ينقلون الصحيح والضعيف.
ولهذا
لما كان البغوي(34) عالماً بالحديث، أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان
تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث
الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها
الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من
الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال.
وأما أهل
العلم الكبار: أهل التفسير، مثل تفسير: محمد بن جرير الطبري، وبقيّ بن
مخلد(35)، وابن أبي حاتم(36)، وابن المنذر(37)، وعبد الرحمن بن إبراهيم
دحيم(38)، وأمثالهم، فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات.
دع من هو أعلم
منهم، مثل تفسير أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه(39). بل ولا يُذكر مثل
هذا عند ابن حُميد(40) ولا عبد الرزاق(41)، مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى
التشيع، ويروي كثيراً من فضائل عليّ، وإن كانت ضعيفة، لكنه أجلُّ قدراً من
أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر.
وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه
لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد، من جنس الثعلبي والنقّاش
والواحدي، وأمثال هؤلاء المفسرين، لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون
ضعيفاً، بل موضوعاً. فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى، لم يجز أن
نعتمد عليه، لكون الثعلبي وأمثاله رووه، فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟!.
وسنذكر
إن شاء الله تعالى ما يبيّن كذبه عقلاً ونقلاً، وإنما المقصود هنا بيان
افتراء هذا المصنف أو كثرة جهله، حيث قال: "قد أجمعوا أنها نزلت في عليّ"
فياليت شعري من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين بالإجماع في مثل
هذه الأمور؟ فإن نقل الإجماع في مثل هذا لا يُقبل من غير أهل العلم
بالمنقولات، وما فيها من إجماع واختلاف.
فالمتكلم والمفسّر والمؤرخ ونحوهم، لو ادّعى أحدهم نقلاً مجرداً بلا إسناد
ثابت لم يُعتمد عليه، فكيف إذا ادّعى إجماعاً؟!.
الوجه
الثالث: أن يقال: هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم، هم - ومن هم أعلم
منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدَّعَى، والثعلبي قد نقل في
تفسيره أن ابن عباس يقول: نزلت في أبي بكر. ونقل عن عبد الملك: قال: سألت
أبا جعفر، قال: هم المؤمنون. قلت: فإن ناساً يقولون: هو عليّ. قال: فعليٌّ
من الذين آمنوا. وعن الضحاك مثله.
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه
قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا عليّ بن أبي
طلحة، عن ابن عباس في هذه، قال: "كل من آمن فقد تولّى الله ورسوله والذين
آمنوا". قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجّ، عن المحاربيّ، عن عبد الملك بن أبي
سليمان، قال: سألت أبا جعفر محمد بن عليّ عن هذه الآية، فقال: "هم الذين
آمنوا". قلت: نزلت في عليّ؟ قال: عليٌّ من الذين آمنوا. وعن السديّ مثله.
الوجه
الرابع: أنّا نعفيه من الإجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح.
وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف، فيه رجال متهمون. وأما نقل
ابن المغازلي الواسطي(42) فأضعف وأضعف، فإن هذا قد جمع في كتابه من
الأحاديث الموضوعات ما لا يخفي أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث،
والمطالبة بإسناد يتناول هذا وهذا.
الوجه الخامس: أن يُقال: لو كان
المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه، كما يزعمون أن عليّاً تصدق
بخاتمه في الصلاة، لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة، وأن لا يتولى
المسلمون إلا عليّاً وحده، فلا يُتَوَلّى الحسن ولا الحسين ولا سائر بني
هاشم. وهذا خلاف إجماع المسلمين.
الوجه السادس: أن قوله: "الذين" صيغة جمع، فلا يصدق على عليٌّ وحده.
الوجه
السابع: أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده: إما
واجب، وإما مستحب. والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح
والطلاق، وغير ذلك من العقود في الصلاة، ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق
المسلمين، بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، بل تبطل
بالإشارة المفهمة. وآخرون يقولون: لا يحصل المِلْك بها لعدم الإيجاب
الشرعي. ولو كان هذا مستحبّاً، لكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يفعله
ويحض عليه أصحابه، ولكان عليّ يفعله في غير هذه الواقعة.
فلما لم يكن
شيء من ذلك، عُلم أن التّصدُّق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء
السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلَّم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلاً.
الوجه
الثامن: أنه لو قُدِّر أن هذا مشروع في الصلاة، لم يختص بالركوع، بل يكون
في القيام والقعود أولى منه في الركوع، فكيف يُقال: لا وليّ لكم إلا الذين
يتصدقون في كل الركوع. فلو تصدّق المتصدّق في حال القيام والقعود: أما كان
يستحق هذه الموالاة ؟
فإن قيل: هذه أراد بها التعريف بعليّ على خصوصه.
قيل
له: أوصاف عليّ التي يُعرف بها كثيرة ظاهرة، فكيف يَتْرُك تعريفه بالأمور
المعروفة، ويعرفه بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا وصدَّقه؟.
وجمهور الأمة
لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح،
ولا السنن، ولا الجوامع، ولا المعجمات، ولا شيء من الأمّهات. فأحد الأمرين
لازم: إن قصد به المدح بالوصف فهو باطل، وإن قصد به التعريف فهو باطل.
الوجه
التاسع: أن يُقال: قوله: { وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }
على قولهم يقتضي أن يكون قد آتى الزكاة في حال ركوعه. وعليّ رضي الله عنه
لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم. فإنه كان
فقيراً، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً وعليُّ لم يكن من
هؤلاء.
الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من
الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحُلِيّ. وقيل: إنه يخرج من جنس
الحلي. ومن جوَّز ذلك بالقيمة، فالتقويم في الصلاة متعذّر، والقيم تختلف
باختلاف الأحوال.
الوجه الحادي عشر: أن هذه الآية بمنزلة قوله: {
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ
الرَّاكِعِينَ } [البقرة: 43] هذا أمر بالركوع.
وكذلك قوله: { يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ } [آل عمران:43] وهذا أمر بالركوع.
قد
قيل: ذكر ذلك ليبيّن أنهم يصلُّون جماعة، لأن المصلّي في الجماعة إنما
يكون مدرِكاً للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود، فإنه
قد فاتته الركعة. وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك.
وبالجملة "الواو"
إما واو الحال، وإما واو العطف. والعطف هو الأكثر، وهي المعروفة في مثل
هذا الخطاب. وقوله إنما يصح إذا كانت واو الحال، فإن لم يكن ثمَّ دليل على
تعيين ذلك بطلت الحجة، فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه؟!.
الوجه
الثاني عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير، خلفاً عن سلف، أن
هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بموالاة المؤمنين،
لَمّا كان بعض المنافقين، كعبد الله بن أُبَيّ، يوالي اليهود، ويقول: إني
أخاف الدوائر. فقال بعض المؤمنين، وهو عبادة بن الصامت: إنّي يا رسول الله
أتولّى الله ورسوله، وأبرأ إلى الله ورسوله من حِلف هؤلاء الكفّار
وولايتهم.
ولهذا لَمّا جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن
أُبَيّ بن سلول، فأنزل الله هذه الآية، يُبيّن فيها وجوب موالاة المؤمنين
عموماً، وينهى عن موالاة الكفار عموماً. وقد تقدّم كلام الصحابة والتابعين
أنها عامة لا تختص بعليّ.
الوجه الثالث عشر: أن سياق الكلام يدل على
ذلك لمن تدبّر القرآن، فإنه قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [المائدة: 51] فهذا نهي عن
موالاة اليهود والنصارى.
ثم قال: { فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا
دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ
عِندِهِ } { فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ } [المائدة: 52، 53]. فهذا وصف
الذين في قلوبهم مرض، الذين يوالون الكفَّار كالمنافقين.
ثم قال:
{َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [المائدة: 54] فذكر
فعل المرتدّين وأنهم لن يضروا الله شيئاً، وذكر من يأتي به بدلهم.
ثم
قال: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [المائدة: 55، 56].
فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين، وممن يرتد
عنه، وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطناً.
فهذا
السياق، مع إتيانه بصيغة الجمع، مما يوجب لمن تدبّر ذلك علماً يقيناً لا
يمكنه دفعه عن نفسه: أن الآية عامّة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات،
لا تختص بواحد بعينه: لا أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليّ، ولا
غيرهم. لكن هؤلاء أحقّ الأمة بالدخول فيها.
الوجه الرابع عشر: أن
الألفاظ المذكورة في الحديث مما يُعلم أنها كذب على النبي صلّى الله عليه
وسلّم، فإن عليّاً ليس قائداً لكل البررة، بل لهذه الأمة رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم، ولا هو أيضاً قاتلاً لكل الكفرة، بل قتل بعضهم، كما قتل
غيره بعضهم. وما أحد من المجاهدين القاتلين لبعض الكفّار، إلا وهو قاتل
لبعض الكفرة.
وكذلك قوله: "منصور من نصره، مخذول من خذله" هو خلاف
الواقع. والنبي صلّى الله عليه وسلّم لا يقول إلا حقّاً، لا سيما على قول
الشيعة، فإنهم يدّعون أن الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان.
ومن
المعلوم أن الأمة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة، نصراً لم يحصل
لها بعده مثله. ثم لَمّا قُتل عثمان، وصار الناس ثلاثة أحزاب: حزب نصره
وقاتل معه، وحزب قاتلوه، وحزب خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء،
لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين ولا على الكفَّار،
بل أولئك الذين نُصروا عليهم وصار الأمر لهم، لَمّا تولّى معاوية،
فانتصروا على الكفار، وفتحوا البلاد، إنما كان عليٌّ منصوراً كنصر أمثاله
في قتال الخوارج والكفّار.
والصحابة الذين قاتلوا الكفّار والمرتدين
كانوا منصورين نصراً عظيماً، فالنصر وقع كما وعد الله به حيث قال: {إِنَّا
لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ} [غافر: 51].
فالقتال الذي كان بأمر الله
وأمر رسوله من المؤمنين للكفار والمرتدين والخوارج، كانوا فيه منصورين
نصراً عظيماً إذا اتّقوا وصبروا، فإن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي
علق به النصر.
وأيضاً فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلّى الله عليه وسلّم
عقب التصدّق بالخاتم من أظهر الكذب. فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا في
سبيل الله وقت الحاجة إليه، ما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتماً.
وفي
الصحيحين عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "ما نفعني مال كمال أبي
بكر"(43)، "إنّ أَمَنَّ الناس عليَّ في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت
متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً"(44).
وقد تصدق عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة، حتى قال النبي
صلّى الله عليه وسلّم: "ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد اليوم"(45).
والإنفاق
في سبيل الله وفي إقامة الدين في أول الإسلام أعظم من صدقةٍ على سائل
محتاج. ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه"
أخرجاه في الصحيحين(46).
قال تعالى: { لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ
أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ
اللَّهُ الْحُسْنَى } [الحديد: 10] فكذلك الإنفاق الذي صدر في أول الإسلام
في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه.
وأما إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا
البر يوجد مثله إلى يوم القيامة. فإذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم
لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الضرورية لا يدعو بمثل هذا الدعاء، فكيف
يدعو به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذباً في سؤاله ؟.
ولا ريب أن
هذا ومثله من كذب جاهلٍ أراد أن يعارض ما ثبت لأبي بكر بقوله:
{وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا
لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، إِلاّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى } [الليل: 17-21] بأن يذكر لعليّ شيئاً من
هذا الجنس، فما أمكنه أن يكذِّب أنه فعل ذلك في أول الإسلام، فَكذب هذه
الأكذوبة التي لا تروج إلا على مفرط في الجهل.
وأيضاً فكيف يجوز أن
يقول النبي صلّى الله عليه وسلّم في المدينة - بعد الهجرة والنصرة: واجعل
لي وزيراً من أهلي، عليّاً اشدد به ظهري، مع أن الله قد أعزّه بنصره
وبالمؤمنين، كما قال تعالى: { هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ } [الأنفال: 62]، وقال: { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ
نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ
اللَّهَ مَعَنَا } [التوبة: 40].
فالذي كان معه حين نَصَرَه الله، إذ
أخرجه الذين كفروا، هو أبو بكر وكانا اثنين الله ثالثهما. وكذلك لما كان
يوم بدر، لما صُنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش. دون سائر الصحابة
أبو بكر، وكل من الصحابة له في نصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سعي
مشكور وعمل مبرور.
وروى أنه لَمّا جاء عليٌّ بسيفه يوم أحد، قال
لفاطمة: "اغسليه يوم أحدٍ غير ذميم". فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:
"إن تك أحسنت فقد أحسن فلان وفلان وفلان" فعدد جماعة من الصحابة(47).
ولم
يكن لعليّ اختصاص بنصر النبي صلّى الله عليه وسلّم دون أمثاله، ولا عُرِف
موطن احتاج النبي صلّى الله عليه وسلّم فيه إلى معونة عليّ وحده، لا باليد
ولا باللسان، ولا كان إيمان الناس برسول الله صلّى الله عليه وسلّم
وطاعتهم له لأجل عليّ، بسبب دعوة عليّ لهم، وغير ذلك من الأسباب الخاصة،
كما كان هارون مع موسى، فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدّاً ويهابون
موسى، وكان هارون يتألّفهم.
والرافضة تدَّعي أن الناس كانوا يبغضون
عليّاً، وأنهم لبغضهم له لم يبايعوه. فكيف يُقال: إن النبي صلّى الله عليه
وسلّم احتاج إليه، كما احتاج موسى إلى هارون؟.
وهذا أبو بكر
الصّدّيق أسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة: عثمان، وطلحة، والزبير
وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة. ولم يُعلم أنه أسلم على يد عليّ
وعثمان وغيرهما أحدٌ من السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار.
ومصعب
بن عمير هو الذي بعثه النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة لَمّا بايعه
الأنصار ليلة العقبة، وأسلم على يده رؤوس الأنصار، كسعيد بن معاذ، الذي
اهتز عرض الرحمن لموته(48)، وأُسَيْد بن حضير وغير هؤلاء.
وكان أبو بكر
يخرج مع النبي صلّى الله عليه وسلّم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في
الموسم، ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة، بخلاف غيره. ولهذا قال النبي
صلّى الله عليه وسلّم في الصحيح: "لو كنت مُتّخذاً من أهل الأرض خليلاً
لاتخذت أبا بكر خليلاً"(49).
وقال: "أيها الناس إني جئت إليكم، فقلت: إنّي رسول الله، فقلتم: كَذَبْت.
وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي"؟(50).
ثم
إن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلّغ الرسالة إلى الكفّار ليُعَاوَنَ
عليها. ونبينا صلّى الله عليه وسلّم كان قد بلّغ الرسالة لَمّا بعثه الله:
بلَّغَها وحده، وأوّل من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من آمن به من
الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان عليّ، ومن الموالي زيد.
وكان
أنفع الجماعة في الدعوة باتفاق الناس أبو بكر، ثم خديجة. لأن أبا بكر هو
أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس، وكان له قدر عند قريش لما كان فيه
من المحاسن، فكان أمنَّ الناس عليه في صحبته وذات يده. ومع هذا فما دعا
الله أن يَشُدَّ أزره بأحد: لا بأبي بكر ولا بغيره، بل قام مطيعاً لربه،
متوكلاً عليه، صابراً له، كما أمره بقوله: { قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ
فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَلا تَمْنُن
تَسْتَكْثِرُ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ } [المدثر: 2-7] وقال: {فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: 123].
فمن زعم أن النبي صلّى الله عليه
وسلّم سأل الله أن يشد أزره بشخص من الناس، كما سأل موسى أني شد أزره
بهارون، فقد افترى على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبخسه حقّه. ولا
ريب أن الرفض مشتق من الشرك والإلحاد والنفاق، لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه
وتارة يخفى.
الوجه الخامس عشر: أن يُقال: غاية ما في الآية أن المؤمنين
عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيوالون عليّاً. ولا ريب أن موالاة
عليّ واجبة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين.
وقال
تعالى: { وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } [التحريم: 4]. فبيّن الله أن كل
صالحٍ من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والله مولاه،
وجبريل مولاه، وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم، كما أن الله مولاه، وجبريل مولاه، أن يكون صالح المؤمنين
متولياً على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا متصرّفاً فيه.
وأيضاً
فقد قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [التوبة: 71]، فجعل كل مؤمن وليّاً لكل مؤمن. وذلك
لا يوجب أن يكون أميراً عليه معصوماً، لا يتولى عليه إلا هو.
وقال
تعالى: { أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ
هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ } [يونس: 62،
63]، فكل مؤمن تقي فهو وليُّ الله، والله وليُّه. كما قال تعالى: {
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ } [البقرة: 257]، وقال: { ذَلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا
مَوْلَى لَهُمْ } [محمد: 11]، وقال: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ
وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ } إلى قوله: { وَأُوْلُواْ
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [الأنفال:
72-75].
فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأن
هذا وَلِيّ هذا، وهذا ولي هذا، وأنهم أولياء الله، وأن الله وملائكته
والمؤمنين موالي رسوله، كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء
المؤمنين. وليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليّاً للآخر كان أميراً
عليه دون غيره، وأنه يتصرف فيه دون سائر الناس.
الوجه السادس عشر: أن
الفرق بين "الولاية" بالفتح و"الولاية" بالكسر معروف، فالولاية ضد
العداوة، وهي المذكورة في هذه النصوص، ليس هي الولاية بالكسر التي هي
الإمارة. وهؤلاء الجهّال يجعلون الولي هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية
والولاية. والأمير يسمّى الوالي لا يُسمَّى الولي، ولكن قد يُقال: هو ولي
الأمر، كما يقال: وليت أمركم، ويقال: أولو الأمر.
وأما إطلاق القول
بالمولى وإرادة الولي، فهذا لا يُعرف، بل يُقال في الوليّ: المولى، ولا
يقال: الوالي. ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والوليّ،
فقيل: يُقدّم الوالي، وهو قول أكثرهم. وقيل: يُقدّم الوليّ.
فبَيِّنٌ
أن الولاية دلّت على الموالاة، المخالفة للمعاداة، الثابتة لجميع المؤمنين
بعضهم على بعض. وهذا ما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر، وأهل
بيعة الرضوان، فكلهم بعضهم أولياء بعض. ولم تدل الآية على أحدٍ منهم يكون
أميراً على غيره بل هذا باطل من وجوه كثيرة، إذ لفظ "الولي" و"الولاية"
غير لفظ "الوالي". والآية عامة في المؤمنين، والإمارة لا تكون عامة.
الوجه
السابع عشر: أنه لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال: إنما يتولّى عليكم
الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل: ومن يتول الله ورسوله، فإنه لا يُقال
لمن وَلِيَ عليهم والٍ: إنهم يقولون: تولّوه، بل يُقال: تولَّى عليهم.
الوجه
الثامن عشر: أن الله سبحانه لا يُوصف بأنه متولٍّ على عباده وأنه أمير
عليهم، جلّ جلاله، وتقدّست أسماؤه، فإنه خالقهم ورازقهم، وربهم ومليكهم،
له الخلق والأمر، ولا يُقال: إن الله أمير المؤمنين، كما يُسمَّى
المتولّي، مثل عليّ وغيره: أمير المؤمنين، بل الرسول صلّى الله عليه وسلّم
أيضاً لا يُقال أنه متولٍّ على الناس، وأنه أمير عليهم، فإن قَدْرَهُ أجلّ
من هذا. بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول
الله. وأول من سُمِّي من الخلفاء "أمير المؤمنين" هو عمر رضي الله عنه.
وقد
رُوي أن عبد الله بن جحش كان أميراً في سرية، فسُمِّي أمير المؤمنين، لكن
إمارة خاصة في تلك السرية، لم يسم أحد بإمارة المؤمنين عموماً قبل عمر،
وكان خليقاً بهذا الاسم.
وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولّى
عباده المؤمنين، فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له
وليّاً فقد بارزه بالحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية
المخلوق للمخلوق لحاجته إليه.
قال تعالى: { وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ } [الإسراء: 111]
فالله تعالى ليس له وليٌّ من الذل، بل هو القائل: {مَن كَانَ يُرِيدُ
الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [فاطر: 10]، بخلاف الملوك
وغيرهم ممن يتولاه لذاته، إذا لم يكن له ولي ينصره.
الوجه التاسع عشر:
أنه ليس كل من تولّى عليه إمام عادل فيكون من حزب الله، ويكون غالباً؛ فإن
أئمة العدل يتولُّون على المنافقين والكفّار، كما كان في مدينة النبي صلّى
الله عليه وسلّم تحت حكمه ذمّيون ومنافقون. وكذلك كان تحت ولاية عليّ
كفّار ومنافقون. والله تعالى يقول: { وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ }
[المائدة: 56]، فلو أراد الإمارة لكان المعنى: إن كل من تأمّر عليهم الذين
آمنوا يكونون من حزبه الغالبين، وليس كذلك. وكذلك الكفّار والمنافقون تحت
أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره، مع كونه لا يتولاهم بل يبغضهم.
الفصل الثاني
الرد على من ادَّعى أن القرآن يدل على أن إمامه
عليّ مما أمر بتبليغه صلّى الله عليه وسلّم
قال
الرافضي: "البرهان الثاني: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ
مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ } [المائدة: 67]، اتفقوا على نزولها في عليّ، وروى أبو نُعيم
الحافظ - من الجمهور - بإسناده عن عطية(51) قال: نزلت هذه الآية على رسول
الله صلّى الله عليه وسلّم في عليّ بن أبي طالب.
ومن تفسير الثعلبي
قال: معناه: بلِّغ ما أنزل إليك من ربك في فضل عليّ، فلما نزلنا هذه الآية
أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيد عليّ، فقال: من كنت مولاه فعليٌّ
مولاه. والنبي صلّى الله عليه وسلّم مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة
بالإجماع، فيكون عليٌّ مولاهم، فيكون هو الإمام.
ومن تفسير الثعلبي:
لما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بغدير خُم نادى الناس فاجتمعوا،
فأخذ بيد عليّ، وقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فشاع ذلك وطار في البلاد،
فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
على ناقته، حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته وأناخها فعقلها، فأتى رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم وهو في ملأ من الصحابة.
فقال: يا محمد أمرتنا عن
الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك. وأمرتنا أن
نصلّي خمساً فقبلناه منك. وأمرتنا أن نزكّي أموالنا فقبلناه منك. وأمرتنا
أن نصوم شهراً فقبلناه منك. وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك. ثم لم ترض
بهذا حتى رفعت بضَبْعَيْ(52) ابن عمك وفضّلتَه علينا، وقلتَ: من كنت مولاه
فعليّ مولاه. وهذا منك أم من الله؟
قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:
والله الذي لا إله إلا هو هو من أَمْرِ الله، فولَّى الحارث يريد راحلته،
وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء
أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته
وخرج من دبره فقتله، وأنزل الله تعالى: { سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ
وَاقِعٍ، لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، مِّنَ اللَّهِ } [المعارج:
1-3]. وقد روى هذه الرواية النقَّاش(53) من علماء الجمهور في تفسيره".
والجواب
من وجوه: أحدها: أن هذا أعظم كذباً وفرية من الأول، كما سنبيّنه إن شاء
الله تعالى. وقوله: "اتفقوا على نزولها في عليّ" أعظم كذباً مما قاله في
تلك الآية. فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون.
وأما
ما يرويه أبو نُعيم في "الحلية" أو في "فضائل الخلفاء" والنقَّاش والثعلبي
والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما
يروونه كثيراً من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي
رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع، وسنبين أدلة يُعرف بها أنه موضوع،
وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث.
ولكن المقصود هنا أنّا نذكر قاعدة
فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز
بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو
العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من
اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجال يُعرفون به،
والعلماء بالحديث أجلُّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلة، وأكثر
ديناً.
وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة، وعلماً وخبرة، فيما يذكرونه من
الجرح والتعديل، مثل مالك، وشعبة، وسفيان، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن
مهدي، وابن المبارك، ووكيع، واشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي
عُبيد، وابن معين، وابن المديني، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، وأبي زُرعة،
وأبي حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبي أحمد بن عدي، وأبي حاتم البستي،
والدارقطني، وأمثال هؤلاء: خلق كثير لا يحصى عددهم، من أهل العلم بالرجال
والجرح والتعديل، وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض، وبعضهم أعدل من بعض في
وزن كلامه، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك.
وقد صنَّف للناس
كتباً في نقلة الأخبار: كباراً وصغاراً، مثل الطبقات لابن سعد، وتاريخي
البخاري، والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما.
وقبلها عن يحيى بن سعيد القطَّان وغيره، وكتاب يعقوب بن سفيان، وابن أبي
خيثمة، وابن أبي حاتم، وكتاب ابن عدي، وكتب أبي حازم وأمثال ذلك.
وصنّفت
كتب الحديث تارة على المساند، فتذكر ما أسنده الصاحب عن رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم، كمسند أحمد، وإسحاق، وأبي داود الطيالسي، وأبي بكر بن
أبي شيبة، ومحمد بن أبي عمر، والعدني، وأحمد بن منيع، وأبي يعلى الموصلي،
وأبي بكر البزّار البصري، وغيرهم.
وتارة على الأبواب، فمنهم من قصد
مقصده الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي حاتم وغيرهم. وكذلك من خرَّج
على الصحيحين، كالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم وغيرهم. ومنهم من خرَّج
أحاديث السنن، كأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ومنهم من خرَّج
الجامع الذي يذكر فيه الفضائل وغيرها، كالترمذي وغيره.
وهذا علم عظيم
من أعظم علوم الإسلام. ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في
أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به، فإن سائر أهل الأهواء - كالمعتزلة
والخوارج - مقصّرون في معرفة هذا، ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج،
والخوارج أعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة وأَدْيَن
وأورع، بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمّدون الكذب، بل هم من أصدق الناس.
والمعتزلة
- مثل سائر الطوائف - فيهم من يكذب، وفيهم من يصدق، لكن ليس لهم من
العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسنة، فإن هؤلاء يتدينون به
فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق.
وأهل البدع سلكوا طريقاً أخر ابتدعوها اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث،
بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد.
والرافضة
أقل معرفة وعناية بهذا، إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة
الشرعية والعقلية: هل توافق ذلك أو تخالفه؟ ولهذا لا يوجد لهم أسانيد
متصلة صحيحة قط، بل كل إسناد متصل لهم، فلابد أن يكون فيه من هو معروف
بالكذب أو كثرة الغلط.
وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى، فإنه ليس لهم
إسناد. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في
الإسلام من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية، غذ كانوا لا
يصدّقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. ولهذا قال
عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا
يكتبون إلا ما لهم.
ثم إن أوّلهم كانوا كثيري الكذب، فانتقلت أحاديثهم
إلى قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق
الجميع أو تكذيب الجميع، والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد.
فيقال:
ما يرويه مثل أبي نُعيم والثعلبي والنقّاش وغيرهم: أتقبلونه مطلقاً؟ أم
تردّونه مطلقاً؟ أم تقبلونه إذا كان لكم لا عليكم، وتردّونه إذا كان
عليكم؟ فإن تقبلوه مطلقاً، ففي ذلك أحاديث كثيرة في فضائل أبي بكر وعمر
وعثمان تناقض قولكم.
وقد روى أبو نُعيم في أول "الحلية" في فضائل
الصحابة، وفي كتاب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ أحاديث بعضها صحيحة
وبعضها ضعيفة، بل منكرة(54). وكان رجلاً عالماً بالحديث فيما ينقله، لكن
هو وأمثاله يرونن ما في الباب، لا يُعرف أنه روى كالمفسِّر الذي ينقل
أقوال الناس في التفسير، والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه، والمصنِّف
الذي يذكر حجج الناس، ليذكر ما ذكروه، وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته،
بل يعتقد ضعفه، لأنه يقول: أنا نقلت ما ذكر غيري، فالعُهدة على القائل لا
على الناقل.
وهكذا كثير ممن صنَّف في فضائل العبادات، وفضائل
الأوقات وغير ذلك: يذكرون أحاديث كثيرة وهي ضعيفة، بل موضوعة، باتفاق أهل
العلم، كما يذكرون أحاديث في فضل صوم رجب كلها ضعيفة، بل موضوعة، عند أهل
العلم. ويذكرون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة منه، وألفية نصف شعبان،
وكما يذكرون في فضائل عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال، وفضائل
المصافحة والحناء والخضاب والاغتسال ونحو ذلك، ويذكرون فيها صلاة.
وكل
هذا كذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لم يصح في عاشوراء إلا فضل
صيامه. قال حرب الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: الحديث الذي يُروى: من وسَّع
على عياله يوم عاشوراء وسَّع الله عليه سائر سنته؟ فقال: لا أصل له(55).
وقد
صنَّف في فضائل الصحابة: علي وغيره، غير واحد، مثل خيثمة بن سليمان
الأطرابلسي وغيره. وهذا قبل أبي نُعيم. يروي عنه إجازة. وهذا وأمثاله جروا
على العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب: أنه يروي ما سمعه في
هذا الباب.
وهكذا المصنّفون في التواريخ، مثل "تاريخ دمشق" لابن عساكر
وغيره، إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعة، أو غيره يذكر كل ما رواه
في ذلك الباب، فيذكر لعليّ ومعاوية من الأحاديث المروية في فضلهما ما يعرف
أهل العلم بالحديث أنه كذب، ولكن لعليّ من الفضائل الثابتة في الصحيحين
وغيرهما، ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة في الصحيح، لكن قد شهد مع رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم حُنيناً والطائف وتبوك، وحج معه حجة الوداع، وكان
يكتب الوحي، فهو ممن ائتمنه النبي صلّى الله عليه وسلّم على كتابة الوحي،
كما ائتمن غيره من الصحابة.
فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء
وأمثالهم في كتبهم، فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم. وإن كان يرد
الجميع، بطل احتجاجه بمجرد عزوه الحديث بدون المذهب إليهم. وإن قال: أقبل
ما يوافق مذهبي وأردّ ما يخالفه، أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا، وكلاهما
باطل، لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب بمثل هذا، فإنه يُقال: إن كنت إنما
عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب، فاذكر ما يدل على صحته، وإن كنت إنما
عرفت صحته لأنه يوافق المذهب، امتنع تصحيح الحديث بالمذهب، لأنه يكون
حينئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث، وصحة الحديث موقوفة على صحة
المذهب، فيلزم الدَّور الممتنع.
وأيضاً فالمذهب: إن كنت عرفت صحته بدون
هذا الطريق، لم يلزم صحة هذا الطريق. فإن الإنسان قد يكذب على غيره قولاً،
وإن كان ذلك القول حقّاً، فكثير من الناس يروي عن النبي صلّى الله عليه
وسلّم قولاً هو حق في نفسه، لكن لم يقله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،
فلا يلزم من كون الشيء صدقاً في نفسه أن يكون النبي صلّى الله عليه وسلّم
قاله، وإن كنت إنما عرفتَ صحته بهذا الطريق، امتنع أن تعرف صحة الطريق
بصحته، لإفضائه إلى الدَّور.
فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب، سواء كان
المذهب معلوم الصحة، أو غير معلوم الصحة.
وأيضاً
فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق وكذب، وأن الناس
كذبوا في المثالب والمناقب، كما كذبوا في غير ذلك، وكذبوا فيما يوافقه
ويخالفه.
ونحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه في فضائل أبي بكر وعمر
وعثمان، كما كذبوا في كثير مما رووه في فضائل عليّ، وليس في أهل الأهواء
أكثر كذباً من الرافضة، بخلاف غيرهم، فإن الخوارج لا يكادون يكذبون، بل هم
من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم.
وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون
بالنقل ويكذبون به بمجرد موافقة ما يعتقدون، بل قد ينقل الرجل أحاديث
كثيرة فيها فضائل النبي صلّى الله عليه وسلّم وأمته وأصحابه، فيردونها
لعلمهم بأنها كذب، ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتها، وإن كان ظاهرها بخلاف ما
يعتقدونه: إما لاعتقادهم أنها منسوخة، أو لها تفسير لا يخالفونه. ونحو ذلك.
فالأصل
في النقل أن يُرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه، ومن يشركهم في علمهم
عَلِمَ ما يعلمون، وأن يُستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية،
فلابد من هذا وهذا. وإلا فمجرد قول القائل: "رواه فلان" لا يَحْتَج به: لا
أهل السنة ولا الشيعة، وليس في المسلمين من يحتاج بكل حديث رواه كل مصنف،
فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته.
ومجرد عزوه إلى رواية
الثعلبي ونحوه ليس دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم بالنقل. ولهذا لم
يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي ترجع الناس إليها في
الحديث، لا في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ولا غير ذلك، لأن كذب مثل
هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث.
وإنما هذا عند أهل العلم
بمنزلة ظن من يظن من العامة - وبعض من يدخل في غمار الفقهاء - أن النبي
صلّى الله عليه وسلّم كان على أحد المذاهب الأربعة، وأن أبا حنيفة ونحوه
كانوا من قبل النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو كما يظن طائفة من التركمان
أن حمزة له مغازٍ عظيمة وينقلونها بينهم، والعلماء متفقون على أنه لم يشهد
إلا بدراً وأُحداً وقُتل يوم أحد، ومثل ما يظن كثير من الناس أن في مقابر
دمشق من أزواجالنبي صلّى الله عليه وسلّم أم سلمة وغيرها، ومن أصحابه
أُبَيّ بن كعب، وأويس القُرني وغيرهما.
وأهل العلم يعلمون أن أحداً
من أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقدم دمشق، ولكن في الشام أسماء
بنت يزيد بن السكن الأنصاري، وكان أهل الشام يسمونها أم سلمة، فظن الجهّال
أنها أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم. وأبي بن كعب مات بالمدينة،
وأويس تابعي لم يقدم الشام.
ومثل من يظن من الجهّال أن قبر عليّ بباطن
النجف. وأهل العلم - بالكوفة وغيرها - يعلمون بطلان هذا، ويعلمون أن
عليّاً ومعاوية وعمرو بن العاص كل منهم دفن في قصر الإمارة ببلده، خوفاً
عيه من الخوارج أن ينبشوه؛ فإنهم كانوا تحالفوا على قتل الثلاثة، فقتلوا
عليّاً وجرحوا معاوية.
وكان عمرو بن العاص قد استخلف رجلاً يقال له
خارجة، فضربه القاتل يظنه عَمْرًا فقتله، فتبين أنه خارجة، فقال: أردت
عمراً وأراد الله خارجة، فصار مثلاً.
ومثل هذا كثير مما يظنه كثير من الجهّال. وأهل العلم بالمنقولات يعلمون
خلاف ذلك.
الوجه
الثاني: أن نقول: في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة؛
فإن فيه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لَمّا كان بغدير يدعى خُمّاً
نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بِيَدَيْ عليّ وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه،
وأن هذا قد شاع وطار بالبلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، وأنه
أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم على ناقته وهو في الأبطح، وأتى وهو في
ملأٍ من الصحابة، فذكر أنهم امتثلوا أمره بالشهادتين والصلاة والزكاة
والصيام والحج، ثم قال: "ألم ترض بهذا حتى رفعت بضَبْعَي ابن عمك تفضّله
علينا؟، وقلتَ: من كنت مولاه فعليّ مولاه؟ وهذا منك أم من الله؟ فقال
النبي صلّى الله عليه وسلّم: "هو من أمر الله".
فولّى الحارث بن
النعمان يريد راحلته، وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله
بحجر، فسقط على هامته، وخرج من دبره فقتله، وأنزل الله: { سَأَلَ سَائِلٌ
بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، لِّلْكَافِرينَ } [المعارج: 1، 2] الآية.
يقال
لهؤلاء الكذَّابين: أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلّى الله عليه
وسلّم بغدير خُم كان مرجعه من حجة الوداع. والشيعة تسلّم هذا، وتجعل ذلك
اليوم عيداً وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. والنبي صلّى الله عليه
وسلّم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة، وعاش
تمام ذي الحجة والمحرم وصفر، وتوفى في أول ربيع الأول.
وفي هذا الحديث
يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خُم وشاع في البلاد، جاءه الحارث وهو
بالأبطح، والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خُم.
وأيضاً
فإن هذه السورة - سورة سأل سائل - مكّيّة باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل
الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خُم بعشر سنين أو أكثر من ذلك، فكيف تكون تزلت
بعده؟.
وأيضاً قوله: { وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ } [الأنفال: 32] في سورة الأنفال، وقد نزلت
عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خُم بسنين كثيرة، وأهل التفسير متفقون على
أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلّى الله عليه وسلّم قبل الهجرة،
كأبي جهل وأمثاله، وأن الله ذكَّر نبيَّه بما كانوا يقولونه بقوله: {
وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ } أي اذكر قولهم، كقوله:
{ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ } [البقرة: 30]، { وَإِذْ
غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ } [آل عمران: 121]، ونحو ذلك: يأمره بأن يذكر كل
ما تقدّم. فدلّ على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة.
وأيضاً
فإنهم لما استفتحوا بيَّن الله أنه لا ينزّل عليهم العذاب ومحمد صلّى الله
عليه وسلّم فيهم، فقال: { وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ
السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [الأنفال: 32]، ثم قال الله
تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا
كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال: 33]
واتفق الناس على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك،
فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا مما تتوفر الهمم
والدواعي على نقله.
ولو أن الناقل طائفة من أهل العلم، فلما كان هذا لا
يرويه أحد من المصنّفين في العلم: لا المسند، ولا الصحيح، ولا الفضائل،
ولا التفسير، ولا السير ونحوها، إلا ما يُروى بمثل هذا الإسناد المنكر -
عُلم أنه كذب وباطل.
وأيضاً فقد ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل أمر
بمباني الإسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلماً فإنه قال: فقبلناه منك.
ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً من المسلمين على عهد النبي صلّى الله عليه
وسلّم لم يصبه هذا.
وأيضاً فهذا الرجل لا يُعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها
الطرقية، من جنس الأحاديث التي في سيرة عنتر ودلهمة.
وقد
صنّف الناس كتباً كثيرة في أسماء الصحابة الذين ذُكروا في شيء من الحديث،
حتى في الأحاديث الضعيفة، مثل كتاب "الاستيعاب" لابن عبد البر، وكتاب ابن
منده، وأبي نعيم الأصبهاني، والحافظ أبي موسى، ونحو ذلك. ولم يذكر أحدٌ
منهم هذا الرجل، فعُلم أنه ليس له ذكر في شيء من الروايات، فإن هؤلاء لا
يذكرون إلا ما رواه أهل العلم، لا يذكرون أحاديث الطرقية، مثل "تنقّلات
الأنوار" للبكري الكذّاب وغيره.
الوجه الثالث: أن يُقال: أنتم
ادّعيتم أنكم أثبتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك
أصلاً؛ فإنه قال: { بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ }
[المائدة: 67]. وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربِّه، لا يدل على
شيء معيَّن.
فدعوى المدّعي أن إمامة عليّ هي مما بلّغها، أو مما أمر
بتبليغها لا تثبت بمجرد القرآن؛ فإن القرآن ليس فيه دلال على شيء معين،
فإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتاً بالخبر لا بالقرآن فمن ادَّعى أن
القرآن يدلّ على أنّ إمامة عليّ مما أمر بتبليغه، فقد افترى على القرآن،
فالقرآن لا يدل على ذلك عموماً ولا خصوصاً.
الوجه الرابع: أن يُقال:
هذه الآية، مع ما عُلم من أحوال النبي صلّى الله عليه وسلّم، تدل على نقيض
ما ذكروه، وهو أن الله لم ينزّلها عليه، ولم يأمره بها، فإنها لو كانت مما
أمره الله بتبليغه، لبلّغه، فإنه لا يعصي الله في ذلك.
ولهذا قالت
عائشة رضي الله عنها: "من زعم أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد كذب،
والله تعالى يقول: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
} [المائدة: 67].
لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلّى الله
عليه وسلّم لم يبلِّغ شيئاً من إمامة عليّ، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون
بها هذا العلم.
منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو
كان له أصل لنُقل، كما نُقل أمثاله من حديثه، لا سيما مع كثرة ما يُنقل في
فضائل عليّ، من الكذب الذي لا أصل، فكيف لا يُنقل الحق الصدق الذي قد
بُلِّغ للناس؟!.
ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز
عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه.
ومنها:
أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لَمّا مات، وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم
أمير ومن المهاجرين أمير، فأنكر ذلك عليه، وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في
قريش، وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلّى الله عليه
وسلّم في أن: "الإمامة في قريش"(56).
ولم يرو واحد منهم: لا في ذلك المجلس ولا غيره، ما يدل على إمامة عليّ.
وبايع
المسلمون أبا بكر، وكان أكثر بني عبد مناف - من بني أمية وبني هاشم وغيرهم
- لهم ميل قوي إلى عليّ بن أبي طالب يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم
هذا النص. وهكذا أُجري الأمر في عهد عمر وعثمان، وفي عهده أيضاً لَمّا
صارت له ولاية، ولم يذكر هو ولا أحدٌ من أهل بيته ولا من الصحابة
المعروفين هذا النص، وإنما ظهر هذا النص بعد ذلك.
وأهل العلم بالحديث
والسّنة الذين يتولّون عليّاً ويحبّونه، ويقولون: إنه كان الخليفة بعد
عثمان، كأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل
العلم وغيرهم، وقالوا: كان زمانه فتنة واختلاف بين الأئمة، لم تتفق المة
فيه لا عليه ولا على غيره.
وقال طوائف من الناس كالكرّامية: بل هو كان
إماماً ومعاوية إماماً، وجوَّزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة. وهكذا
قالوا في زمن ابن الزبير ويزيد، حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام.
وأحمد
بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث، احتج على إمامة علي بالحديث الذي
في السنن: "تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير مُلكاً"(57). وبعض
الناس ضعّف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه.
فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة عليّ، فلو ظفروا بحديث مسندٍ أو مرسل
موافق لهذا لفرحوا به.
فعُلم
أن ما تدّعيه الرافضة من النصّ، هو مما لم يسمعه أحدٌ من أهل العلم بأقوال
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا قديماً ولا حديثاً.
ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما يعلمون
كذب غيره من المنقولات المكذوبة.
وقد
جرى تحكيم الحكمين، ومعه أكثر الناس، فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا
غيرهم من ذكر هذا النص، مع كثرة شيعته، ولا فيهم من احتج به، في مثل هذا
المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهار مثل هذا النص(58).
ومعلوم
أنه لو كان النصّ معروفاً عند شيعة عليّ - فضلاً عن غيرهم - لكانت العادة
المعروفة تقتضي أن يقول أحدهم: هذا نص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على
خلافته، فيجب تقديمه على معاوية.
وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين،
لو علم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نصّ عليه لم يستحلّ عزله، ولو عزله
لكان من أنكر عزله عليه يقول: كيف تعزل من نصّ النبي صلّى الله عليه وسلّم
على خلافته؟.
وقد احتجّوا بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "تقتل عمّاراً
الفئة الباغية" وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم، وليس هذا
متواتراً(59). والنص عند القائلين به متواتر، فيا لله العجب كيف ساغ عند
الناس احتجاج شيعة عليّ بذلك الحديث، ولم يحتج أحد منهم بالنص؟.
الفصل الثالث
الرد على المدَّعي بأن إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة
هو دليل على إمامة عليّ من هذا الوجه
قال
الرافضي: "البرهان الثالث: قوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلاَمَ دِينًا } [المائدة: 3]. روى أبو نُعيم بإسناده إلى أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعا الناس إلى غدير
خُم، وأمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك، فقام فدعا عليّاً، فأخذ بضَبْعيه
فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم
لم يتفرّقوا حتى نزلت هذه الآية: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }
[المائدة: 3]. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الله أكبر على إكمال
الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وبالولاية لعليٍّ من بعدي. ثم
قال: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه،
وانصر من نصره، واخذل من خذله"(60).
والجواب من وجوه: أحدها: أن
المستدلّ عليه بيان صحة الحديث. ومجرد عزوه إلى رواية أبي نُعيم لا تفيد
الصحة باتفاق الناس: علماء السنة والشيعة؛ فإن أبا نعيم روى كثيراً من
الأحاديث التي هي ضعيفة، بل موضوعة، باتفاق علماء أهل الحديث: السنة
والشيعة. وهو وإن كان حافظاً كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى، كما عادة
المحدِّثين أمثاله يروون جميع ما في الباب، لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا
يُحتج من ذلك إلا ببعضه.
والناس في مصنّفاتهم: منهم من لا يروي عمَّن
يعلم أنه يكذب، مثل مالك، وشُعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي،
وأحمد بن حنبل؛ فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم، ولا يروون
حديثاً يعلمون أنه عن كذّاب، فلا يروون أحاديث الكذّابين الذين يُعرفون
بتعمد الكذب، لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون صاحبه أخطأ فيه.
وقد
يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم، لاتهام رواتها
بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليُعتبر بها ويُستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث
ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها
كذّبها في الباطن، ليس مشهوراً بالكذب، بل يروي كثيراً من الصدق، فيُروى
حديثه.
وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذباً، بل يجب التبيّن في خبره كما
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } [الحجرات: 6] الآية، فيُروى لتنظر سائر الشواهد:
هل تدل على الصدق أو الكذب؟.
وكثير من المصنِّفين يعزّ عليه تمييز ذلك
على وجهه، بل يعجز عن ذلك، فيروي ما سمعه كما سمعه، والدّرْكُ على غيره لا
عليه وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده.
الوجه الثاني: أن
هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات. وهذا يعرفه
أهل العلم بالحديث، والمرجع إليهم في ذلك. ولذلك لا يوجد هذا في شيء من
كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث.
الوجه الثالث: أنه قد
ثبت في الصحاح والمساند والتفاسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلّى الله
عليه وسلّم وهو واقف بعرفة، وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير
المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك
اليوم عيداً. فقال له عمر: وأيّ آية هي؟ قال: قوله: { الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا } [المائدة: 3] فقال عمر: إني لأعلم أي يوم
نزلت، وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة بعرفة، ورسول الله صلّى الله عليه
وسلّم واقف بعرفة. وهذا مستفيض من وجوه آخر، وهو منقول في كتب المسلمين:
الصحاح والمساند والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك(61).
وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خُم بتسعة أيام؛ فإنه كان يوم
الجمعة تاسع ذي الحجة، فكيف يُقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!.
الوجه
الرابع: أن هذه الآية ليس فيها دلالة على عليٍّ ولا إمامته بوجه من
الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين،
ورضا الإسلام ديناً. فدعوى المدَّعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا
الوجه كذب ظاهر.
وإن قال: الحديث يدلّ على ذلك.
فيقال: الحديث إن كان صحيحاً، فتكون الحجة من الحديث لا من الآية. وإن لم
يكن صحيحاً، فلا حجة في هذا ولا في هذا.
فعلى
التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك. وهذا مما يبيّن به كذب الحديث؛ فإن
نزول الآية لهذا السبب، وليس فيها ما يدل عليه أصلاً، تناقضُ.
الوجه
الخامس: أن هذا اللفظ، وهو قوله: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه،
وانصر من نصره واخذل من خذله" كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث(62).
وأما قوله: "من كنت مولاه فعليُّ مولاه" فلهم فيه قولان، وسنذكره إن شاء
الله تعالى في موضعه.
الوجه
السادس: أن دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم مُجاب، وهذا الدعاء ليس
بمجابٍ. فعُلم أنه ليس من دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنه من
المعلوم أنه لَمّا تولّى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف: صنف
قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف قعدوا عن هذا وهذا. وأكثر السابقين
الأوّلين كانوا من القعود. وقد قيل: إن بعض السابقين الأوّلين قاتلوه.
وذكر ابن حزم أن عمّار بن ياسر قتله أبو الغادية، وأن أبا الغادية هذا من
السابقين، ممن بايع تحت الشجرة. وأولئك جميعهم قد ثبت في الصحيحين أنه لا
يدخل النار منهم أحد.
ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "لا
يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة"(63).
وفي الصحيح أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله ليدخلن حاطب
النار. فقال: "كذبت، إنه شهد بدراً والحديبية"(64).
وحاطب
هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وبسبب ذلك
نزل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ }
[الممتحنة: 1] الآية، وكان مسيئاً إلى مماليكه، ولهذا قال مملوكه هذا
القول، وكذّبه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقال: "إنه شهد بدراً
والحديبية" وفي الصحيح: "لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة".
وهؤلاء فيهم من قاتل عليّاً، كطلحة والزبير، وإن كان قاتل عمّار فيهم فهو
أبلغ من غيره.
وكان
الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف وأربعمائة، وهم الذين فتح الله عليهم
خيبر، كما وعدهم الله بذلك في سورة الفتح، وقسَّمها بينهم النبي صلّى الله
عليه وسلّم على ثمانية عشر سهماً، لأنه كان فيهم مائتا فارس، فقسَّم
للفارس ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه، فصار لأهل الخيل ستمائة سهم،
ولغيرهم ألف ومائتا سهم. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة(65)، وعليه
أكثر أهل العلم، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد ذهب طائفة إلى أنه
أَسْهَم للفارس سهمين، وأن الخيل كانت ثلاثمائة، كما يقول ذلك من يقوله من
أصحاب أبي حنيفة.
وأما عليّ فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين
الأوَّلين، كسهل بن حنيف، وعمّار بن ياسر. لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا
أفضل؛ فإن سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه، ولم يكن قد بقي من الصحابة بعد
عليّ أفضل منه. وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار، وقد جاء في الحديث: "أن
الفتنة لا تضره"(66) فاعتزل. وهذا مما استُدل به على أن القتال كان قتال
فتنة بتأويل، لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب.
وعليّ - ومن معه
- أولى بالحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم
أنه قال: "تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين
بالحق"(67) فدلّ هذا الحديث على أن عليّاً أولى بالحق ممن قاتله؛ فإنه هو
الذي قتل الخوارج لَمّا افترق المسلمون، فكان قوم معه وقوم عليه. ثم إن
هؤلاء الذين قاتلوه لم يُخذلوا، بل ما زالوا منصورين يفتحون البلاد
ويقتلون الكفّار.
وفي الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال:
"لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم
حتى تقوم الساعة"(68) قال معاذ بن جبل: "وهم بالشام".
وفي مسلم عن أبي
هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين
حتى تقوم الساعة"(69) قال أحمد بن حنبل وغيره: "أهل الغرب هم أهل الشام".
وهذا
كما ذكروه؛ فإن كل بلد له غرب وشرق، والاعتبار في لفظ النبي صلّى الله
عليه وسلّم بغرب مدينته، ومن الفرات هو غرب المدينة، فالبيرة(70) ونحوها
على سمت المدينة، كما أن حرّان(71) والرَّقَّة(72) وسُمَيْسَاط(73) ونحوها
على سمت مكة. ولهذا يُقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل، بمعنى أنك تجعل
القطب الشمالي خلف ظهرك، فتكون مستقبل الكعبة، فما كان غربي الفرات فهو
غربي المدينة إلى آخر الأرض، وأهل الشام أولا هؤلاء.
والعسكر الذين
قاتلوا مع معاوية ما خُذِلوا قط، بل ولا في قتال عليّ. فكيف يكون النبي
صلّى الله عليه وسلّم قال: "للهم اخذل من خذله وانصر من نصره" والذين
قاتلوا معه لم يُنصروا على هؤلاء، بل الشيعة الذين تزعمون أنهم مختصّون
بعليّ ما زالوا مخذولين مقهورين لا يُنصرون إلا مع غيرهم: إما مسلمين وإما
كفّار، وهم يدّعون أنهم أنصاره، فأين نصر الله لمن نصره؟! وهذا وغيره مما
يبيّن كذب هذا الحديث.
الفصل الرابع
الرد على من روى عن ابن عباس حديث وقوع النجم في دار عليّ
قال
الرافض: "البرهان الرابع: قوله تعالى: {وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى، مَا ضَلَّ
صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى} [النجم: 1-2] روى الفقيه عليّ بن المغازلي
الشافعي(74) بإسناده عن ابن عباس، قال: كنت جالساً مع فتية من بني هاشم
عند النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذ انقضّ كوكبٌ، فقال رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم: "من انقض هذا النجم في منزله، فهو الوصي من بعدي" فقام
فتية من بني هاشم، فنظروا، فإذا الكوكب قد انقضّ في منزل عليّ، قالوا: يا
رسول الله قد غويت في حب عليّ، فأنزل الله تعالى: {وَالنَّجْمِ إذَا
هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى} [النجم: 1-2].
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحته، كما تقدم. وذلك أن القول بلا علم
حرام بالنص والإجماع.
قال تعالى: { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء: 36].
وقال:
{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى
اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [الأعراف: 33].
وقال: { هَا أَنتُمْ
هَؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا
لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ } [آل عمرا: 66].
وقال: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ }
[الحج: 3].
وقال:
{ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ
أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا }
[غافر: 35].
والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله، كما
قال: { أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا
كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ } [الروم: 35].
وقال: { أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ } [الصافات: 156، 157].
وقال: { إنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَآَبَاءُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ } [النجم: 23].
فما
جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان، فالقرآن سلطان، والسنة سلطان, لكن لا
يعرف أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله،
فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فعليه أن يعلم
صحته، قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به. وإذا احتج به على غيره، فعليه بيان
صحته، وإلا كان قائلاً بلا علم، مستدلاً بلا علم.
وإذا عُلم أن في
الكتب المصنَّفة في الفضائل ما هو كذب، صار الاعتماد على مجرد ما فيها،
مثل الاستدلال بشهادة الفاسق، الذي يصدق تارة ويكذب أخرى. بل لو لم يُعلم
أن فيها كذباً، لم يفدنا علماً حتى نعلم ثقة من رواها.
وبيننا وبين
الرسول مئون من السنين، ونحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن
غيره صدقاً وكذباً. وقد رُوي عنه أنه قال: سيُكذب عليّ، فإن كان هذا
الحديث صدقاً، فلابد أن يُكذَّب عليه، وإن كان كذباً فقد كذب عليه. وإن
كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يبيِّن ما به
يثبت، فكيف يحتج في مسائل الأصول، التي يقدح فيها في خيار القرون وجماهير
المسلمين وسادات أولياء الله المقرَّبين، بحيث لا يعلم المحتج به صدقه؟
وهو
لو قيل له: أتعلم أن هذا وقع؟ فإن قال: أعلم ذلك، فقد كذب. فمن أين يعلم
وقوعه؟ ويُقال له: من أين علمت صدق ذلك، وذلك مما لا يُعرف إلا بالإسناد
ومعرفة أحوال الرواة؟ وأنت لا تعرفه، ولو أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب.
وإن قال: لا أعلم ذلك. فكيف يسوغ لك الاحتجاج بما لا تعلم صحته؟
الثاني:
أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلي ليس من أهل الحديث،
كأبي نعيم وأمثاله، ولا هو أيضاً من جامعي العلم الذي يذكرون ما غالبه حق
وبعضه باطل، كالثعلبي وأمثاله، بل هذا لم يكن الحديث من صنعته، فعمد إلى
ما وجده من كتب الناس من فضائل عليّ فجمعها، كما فعل أخطب خوارزم، وكلاهما
لا يعرف الحديث، وكل منهما يروي فيما جمعه من الأكاذيب الموضوعة، ما لا
يخفى أنه كذب على أقل علماء النقل والحديث.
ولسنا نعلم أن أحدهما يتعمد
الكذب فيما ينقله، لكن الذي تيقّناه أن الأحاديث التي يروونها فيها ما هو
كذب كثير باتفاق أهل العلم، وما قد كذبه الناس قبلهم، وهما - وأمثالهما -
قد يروون ذلك ولا يعلمون أنه كذب، وقد يعلمون أنه كذب. فلا أدري هل كانا
من أهل العلم بأن هذا كذب؟ أو كانا مما لا يعلمان ذلك؟.
وهذا الحديث
ذكره الشيخ أبو الفرج في "الموضوعات"(75) لكن بسياق آخر(76)، من حديث محمد
بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما عرج بالنبي صلَّى
الله عليه وسلَّم إلى المساء السابعة، وأراه الله من العجائب في كل سماء
فلما أصبح جعل يحدِّث الناس عن عجائب ربّه(77)، فكذَّبه من أهل مكة من
كذّبه، وصدّقه من صدّقه، فعند ذلك انقضّ نجم من السماء، فقال النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم: في دار من وقع هذا النجم(78) فهو خليفتي من بعدي،
فطلبوا(79) ذلك النجم فوجوده في دار عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال
أهل مكة: ضلّ محمد وغوى، وهوى أهل بيته(80) ومال إلى ابن عمّه علي بن أبي
طالب رضي الله عنه، فعند ذلك نزلت هذه السورة: {وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى،
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى}(81) [النجم: 1-2].
قال أبو
الفرج(82): "هذا حديث موضوع لا شك فيه، وما أبرد الذي وضعه، وما أبعد ما
ذكر، وفي إسناده ظلمات منها أبو صالح وكذلك(83) الكلبي ومحمد بن مروان
السّدي، والمتهم به الكلبي. قال أبو حاتم بن حبّان: كان الكبي من الذين
يقولون: إنّ عليّاً لم يمت، وأنه يرجع إلى الدنيا، وإن رأوا سحابةً قالوا:
أمير المؤمنين فيها. لا يحل الاحتجاج به. قال: والعجب(84) من تغفيل(85) من
وضع هذا الحديث، كيف رتّب ما لا يصح في المعقول(86) من أن النجم يقع في
دار ويثبت إلى أن يُرى(87)، ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس،
وكان ابن عباس زمن(88) المعراج ابن سنتين، فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها؟".
قلت:
إذا لم يكن هذا الحديث في تفسر الكلبي المعروف عنه، فهو مما وضع بعده.
وهذا هو الأقرب. قال أبو الفرج(89): "وقد سَرَق هذا الحديث بعينه قومٌ
وغيَّروا إسناده، ورووه بإسناد غريب(90) من طريق أبي بكر العطّار، عن
سليمان بن أحمد المصري، ومن طريق أبي قضاعة ربيعة بن محمد، حدثنا ثوبان بن
إبراهيم، حدثنا مالك بن غسَّان النهشلي، عن أنس(91) قال: انقضّ كوكب على
عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:
انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقضّ في داره فهو خليفة(92) من بعدي. قال:
فنظرنا، فإذا هو قد(93) انقضّ في منزل عليّ(94)، فقال جماعة(95): قد غوى
محمد في حب علي(96). فأنزل الله تعالى: {وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى، مَا
ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى} الآيات(97) [النجم: 1-2].
قال أبو
الفرج(98): "وهذا الحديث هو المتقدم(99) سرقه(100) بعض هؤلاء الرواة
فغيّر(101) إسناده، ومن تغفيله وَضْعُهُ إيّاه على أنس؛ فإن أنساً لم يكن
بمكة زمن(102) المعراج، ولا حين نزول هذه السورة، لأن المعراج كان قبل
الهجرة بسنة، وأنس إنما عرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة،
وفي هذا الإسناد ظلمات.
أما مالك النهشلي فقال ابن حبّان: يأتي عن
الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، وأما ثوبان فهو أخو ذي النون المصري
ضعيف في الحديث، وأبو قضاعة منكر الحديث متروكه، وأبو بكر(103) العطّار
وسليمان بن أحمد مجهولان".
الوجه الثالث: أنه مما يبيّن أنه كذب أن فيه
ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في منزل عليّ، وسورة النجم
باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة، وابن عبّاس حين مات النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم كان مراهقاً للبلوغ لم يحتلم بعد، هكذا ثبت عنه في الصحيحين.
فعند نزول هذه الآية: إما أن ابن عباس لم يكن وُلد بعد، وإما أنه كان
طفلاً لا يميّز، فإن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما هاجر كان لابن عباس
نحو خمس سنين، والأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم، فإنها من
أوائل ما نزل من القرآن.
الوجه الرابع: أنه لم ينقضّ قط كوكب إلى الأرض
بمكة ولا بالمدينة ولا غيرهما. ولما بُعث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
كثر الرمي بالشهب، ومع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرض. وهذا ليس من الخوارق
التي تُعرف في العالم، بل هو من الخوارق التي لا يُعرف مثلها في العالم،
ولا يُروى مثل هذا إلا من هو من أوقح الناس، وأجرئهم على الكذب، وأقلهم
حياءً وديناً، ولا يَرُوج إلا على من هو من أجهل الناس وأحمقهم، وأقلهم
معرفة وعلماً.
الوجه الخامس: أن نزول سورة النجم كان في أول الإسلام،
وعليّ إذ ذاك كان صغيراً، والأظهر أنه لم يكن احتلم ولا تزوّج بفاطمة، ولا
شُرع بعد فرائض الصلاة أربعاً وثلاثاً واثنين، ولا فرائض الزكاة، ولا حج
البيت، ولا صوم رمضان، ولا عامة قواعد الإسلام.
وأمر الوصية بالإمامة لو كان حقّاً إنما يكون في آخر الأمر كما ادعوه يوم
غدير خُم، فكيف يكون قد نزل في ذلك الوقت؟
الوجه
السادس: أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خلاف هذا، وأن النجم المقسم به:
إما نجوم السماء، وإما نجوم القرآن، ونحو ذلك. ولم يقل أحد: إنه كوكب نزل
في دار أحد بمكة.
الوجه السابع: أنه من قال لرسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم: "غويت" فهو كافر، والكفَّار لم يكن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام.
الوجه الثامن: أن
هذا النجم إن كان صاعقة، فليس نزول الصاعقة في بيت شخص كرامة له، وإن كان
من نجوم السماء فهذه لا تفارق الفلك، وإن كان من الشُّهب فهذه يُرمى بها
رجوماً للشياطين، وهي لا تنزل إلى الأرض. ولو قُدِّر أن الشيطان الذي
رُمِيَ بها وصل إلى بيت عليّ حتى احترق بها، فليس هذا كرامة له، مع أن هذا
لم يقع قط.
الفصل الخامس
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه مطهر ومعصوم
قال
الرافضي: "البرهان الخامس: قوله تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33] فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن
الأسقع قال: طلبت عليّاً في منزله، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ذهب إلى
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال: فجاءا جميعاً فدخلا ودخلت معهما،
فأجلس عليّاً عن يساره، وفاطمة عن يمينه، والحسن والحسين بين يديه، ثم
التفع عليهم بثوبه، وقال: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } اللهم إن هؤلاء
أهلي حقّاً.
وعن أم سلمة قالت: إن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان
في بيتها، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها حريرة، فدخلت بها عليه،
فقال: ادعي زوجك وابنَيْك. قالت: فجاء عليّ والحسن والحسين فدخلوا جلسوا
يأكلون من تلك الحريرة، وهو وهم على منام له علي، وكان تحته كساء
خَيْبَري. قالت: وأنا في الحجرة أصلّي، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }.
قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم
أخرج يده فألوى بها إلى السماء، وقال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهيراً. وكرّر ذلك. قالت: فأدخلت رأسي وقلت: وأنا معهم يا رسول
الله قال: إنك إلى خير.
وفي هذه الآية دلالة على العصمة، مع التأكيد
بلفظة: "إنما" وإدخال اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله: "أهل
البيت" والتكرير بقوله: "ويطهّركم" والتأكيد بقوله: "تطهيراً". وغيرهم ليس
بمعصوم، فتكون الإمامة في عليّ، ولأنه ادّعاها في عدة من أقواله، كقوله:
والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلّي منها محل القطب من
الرحى. وقد ثبت نفي الرجس عنه، فيكون صادقاً، فيكون هو الإمام".
والجواب:
أن هذا الحديث صحيح في الجملة؛ فإنه قد ثبت عن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم أنه قال لعليّ وفاطمة وحسن وحسين: "اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب
عنه الرجل وطهّرهم تطهيراً".
وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم غداةً وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء
الحسن بن عليّ فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها
معه، ثم جاء عليّ فأدخله، ثم قال: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }(104).
وهو مشهور من رواية أم سلمة من رواية أحمد والترمذي(105)، لكن ليس في هذا
دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم.
وتحقيق ذلك في مقامين أحدهما: أن قوله:
{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }، كقوله: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ } [المائدة: 6]، وكقوله: { يُرِيدُ
اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185]،
وكقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا} [النساء:
26-27].
فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد
ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به، ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد،
ولا أنه قضاه وقدَّره، ولا أنه يكون لا محالة.
والدليل على ذلك أن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد نزول هذه الآية قال: "اللهم هؤلاء أهل
بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً" فطلب من الله لهم إذهاب الرجس
والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس
وطهّرهم، لم يحتج إلى الطلب والدعاء.
وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن
إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما
لا يريد، فليس في كونه تعالى مريداً لذلك ما يدل على وقوعه.
وهذا
الرافضي وأمثاله قدرية، فكيف يحتجّون بقوله: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } على وقوع المراد؟ وعندهم
أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده؟
وأما على قول
أهل الإثبات، فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية
دينية تتضمّن محبته ورضاه، وإرادة كونيّة قدرية تتضمن خلقه وتقديره.
الأولى مثل هؤلاء الآيات.
والثانية
مثل قوله تعالى: { فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ } [الأنعام: 125].
وقول نوح: { وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ
إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ } [هود: 34].
وكثير من المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداً، كما يجعلون الإرادة
والمحبة شيئاً واحداً.
ثم
القدرية ينفون إرادته لِمَا بيّن أنه مراد في آيات التقدير، وأولئك ينفون
إرادته لما بيَّن أنه مراد في آيات التشريع، فإنه عندهم كل ما قيل: "إنه
مراد" فلابد أن يكون كائناً.
والله قد اخبر أنه يريد أن يتوب على
المؤمنين وأن يطهّرهم، وفيهم من تاب، وفيهم من لم يتب، وفيهم من تطهّر،
وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير
وإذهاب الرجس، لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادّعاه.
ومما يبيّن ذلك
أن أزواج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مذكورات في الآية، والكلام في
الأمر بالتطهير بإيجابه، ووعد الثواب على فعله، والعقاب على تركه. قال
تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ
النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 30-32] إلى قوله: { وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33].
فالخطاب
كله لأزواج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ومعهن الأمر والنهي والوعد
والوعيد. لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمّهن وتعمّ غيرهن من
أهل البيت، جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره، وليس مختصّاً بأزواجه، بل هو
متناول لأهل البيت كلهم، وعليّ وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك،
ولذلك خصّهم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالدعاء لهم.
وهذا كما أن
قوله: { لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ }
[التوبة: 108] نزلت بسبب مسجد قُباء، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق
منه بذلك، وهو مسجد المدينة.
وهذا يوجّه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه سُئل عن
المسجد الذي أُسس على التقوى، فقال: "هو مسجدي هذا"(106).
وثبت
عنه في الصحيح أنه كان يأتي قُباء كل سبت ماشياً وراكباً، فكان يقوم في
مسجده يوم الجمعة، ويأتي قباء يوم السبت(107). وكلاهما مؤسس على التقوى.
وهكذا
أزواجه وعليّ وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن عليّاً
وفاطمة، والحسن والحسين أخص بذكل من أزواجه، ولهذا خصَّهم بالدعاء.
وقد تنازع الناس في آل محمد: من هم؟ فقيل: هم أمته. وهذا قول طائفة من
أصحاب مالك وأحمد وغيرهم.
وقيل:
المتقون من أمته. ورووا حديثاً: "آل محمد كل مؤمن تقيّ" رواه الخلال وتمام
في "الفوائد" له، وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو حديث
موضوع(108) وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواصّ الأولياء
كما ذكر الحكيم الترمذي.
والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته، وهذا هو
المنقول عن الشافعي وأحمد، وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم. لكن هل
أزواجه من أهل بيته؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنهن لسن من
أهل البيت. ويروى هذا عن زيد بن أرقم. والثاني: - وهو الصحيح - أن أزواجه
من آله.
فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه علّمهم
الصلاة عليه: "اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته"(109).
ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته،
بدلالة القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟.
ولأن هذه الآية تدلّ على أنهن من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك في
الكلام معنى.
وأما
الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. كما ثبت في الصحيح أنه قال: "إن آل بني
فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليِّيَ الله وصالح المؤمنين"(110) فبيّن أن
أولياءه صالح المؤمنين.
وكذلك في حديث آخر: "إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا"(111).
وقد قال تعالى: { وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } [التحريم: 4].
وفي
الصحاح عنه أنه قال: "وددت أني رأيت إخواني" قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال:
"بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يومنون بي ولم يروني"(112).
وإذا
كان كذلك فأولياؤه المتّقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى.
وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية، والقرب بين القلوب
والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان.
ولهذا كان أفضلَ الخلقِ أولياؤه
المتّقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر، والبر والفاجر. فإن كان
فاضلاً منهم كعليّ رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين، فتفضيلهم بما فيهم
في الإيمان والتقوى وهم أولياؤه بهذا الاعتبار، لا بمجرد النسب، فأولياؤه
أعظم درجة من آله، وإن صلَّى على آله تبعاً له لم يقتضِ ذلك أن يكونوا
أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم، فإن الأنبياء والمرسلين هم من
أوليائه، وهم أفضل من أهل بيته، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاً،
فالمفضول قد يختص بأمرٍ، ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل.
ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلّى عليه، كما ثبت ذلك في الصحيحين، فقد ثبت
باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن.
فإن
قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس، لكن
دعاء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لهم بذلك يدل على وقوعه، فإن دعاءه
مستجاب.
قيل: المقصود أن القرآن لا يدل ما ادّعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس،
فضلاً عن أن يدل على العصمة والإمامة.
وأما الاستدلال بالحاديث فذاك مقام آخر.
ثم
نقول في المقام الثاني: هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم،
كما أن الدعاء المستجاب لابد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس
عنهم، لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ.
والدليل عليه أن
الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن لا يصدر من
واحدة منهن خطأ، فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي أنه يريد
ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث كالفواحش - ويطهرهم من الفواحش وغيرها
من الذنوب.
والتطهير من الذنب على وجهين: كما في قوله: {
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } [المدثر: 4] وقوله: { إِنَّهُمْ أُنَاسٌ
يَتَطَهَّرُونَ } [الأعراف: 82]، فإنه قال فيها: { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }
[الأحزاب: 30].
والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد، وإما أن
يتوب منه كما في قوله: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِم بِهَا } [التوبة: 103] لكن ما أمر الله به من الطهارة
ابتداءً وإرادةً فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة، لا يتضمن الإذن فيها بحال،
لكن هو سبحانه ينهى عنها، ويأمر من فعلها بأن يتوب منها.
وفي الصحيح عن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي
كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلني بالثلج والبَرَد والماء البارد،
اللهم نقِّني من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس"(113).
وفي
الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم براءتها، وكان قد ارتاب في أمرها، فقال: "يا عائشة
إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه،
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه"(114).
وبالجملة
لفظ "الرجس" أصله القذر، ويُراد به الشرك، كقوله: { فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ } [الحج: 30]. ويراد به الخبائث المحرَّمة،
كالمطعومات والمشروبات، كقوله: { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا } [الأنعام: 145] وقوله: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } [المائدة:
90]، وإذهاب ذلك إذهاب لكله. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة
الشكر والخبائث.
ولفظ "الرجس" عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس، فإن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم دعا بذلك:
وأما
قوله: "وطَهِّرهُم تطهيرا" فهو سؤال مطلق بما يسمّى طهارة. وبعض الناس
يزعم أن هذا مطلق، فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة، ويقول مثل ذلك في
قوله: { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ } [الحشر: 2] ونحو ذلك.
والتحقيق
أنه أمر بمسمَّى الاعتبار الذي يُقال عند الإطلاق، كما إذا قيل: أكرم هذا،
أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً وكذلك ما يسمى عند الإطلاق
اعتباراً. والإنسان لا يُسمَّى معتَبِراً إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في
نظيرها، وكذلك لا يُقال: هو طاهر، أو متطهراً، أو مطهراً، إذا كان
متطهّراً من شيء متنجّساً بنظيره.
ولفظ "الطاهر" كلفظ الطيب. قال
تعالى: { وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
} [النور: 26]، كما قال: { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ } [النور: 26].
وقد روى أنه قال لعمَّار: "ائذنوا له مرحباً بالطيّب المطيّب"(115).
وهذا
أيضاً كلفظ "المتقي" ولفظ " المزكّي". قال تعالى: { قَدْ أَفْلَحَ مَن
زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } [الشمس: 9-10]. وقال: { خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا }
[التوبة: 103]. وقال: { قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى } [الأعلى: 14]. وقال:
{ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم
مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ } [النور:
21].
وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا
معصومين من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق، بل
من تاب من ذنوبه دخل في المتقين، ومن فعل ما يكفّر سيئاته دخل في المتقين،
كما قال: { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا } [النساء: 31].
فدعاء
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يطهّرهم تطهيراً، كدعائه بأن يزكّيهم
ويطيّبهم ويجعلهم متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك، فهو
داخل في هذا، لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه.
وقد قال: "اللهم طهّرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد". فمن وقع
ذنبه مغفوراً أو مكفّراً فقد طهّره الله منه تطهيراً، ولكن من مات
متوسّخاً بذنوبه، فإنه لم يطهّر منه في حياته.
وقد يكون من تمام
تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. والنبي صلَّى الله عليه
وسلَّم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعدد المحل، فإذا استغفر للمؤمنين
والمؤمنات، لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب، فإن هذا لو كان واقعاً لما
عُذِّب مؤمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يغفر الله لهذا بالتوبة،
ولهذا بالحسنات الماحية، ويغفر الله لهذا ذنوباً كثيرة، وإن واحدة بأخرى.
وبالجملة
فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي صلَّى الله عليه وسلَّم،
ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السنة عنهم لا معصوم إلا النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم. والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلَّى
الله عليه وسلَّم والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء.
وإذا كان
كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمناً للعصمة التي يختص
بها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم له بهذه العصمة: لا لعليّ ولا لغيره، فإنه دعا
بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة.
وأيضاً فالدعاء بالعصمة
من الذنوب ممتنع على أصل القدرية، بل وبالتطهير أيضاً؛ فإن الأفعال
الاختيارية - التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات - عندهم غير مقدورة
للرب، ولا يمكنه أن يجعل العبد مطيعاً ولا عاصياً، ولا متطهراً من الذنوب
ولا غير متطهر، فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلاً للواجبات
تاركاً للمحرمات، وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر، كالسيف الذي
يصلح لقتل المسلم والكافر، والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية،
ثم العبد يفعل باختياره: إما الخير وإما الشر بتلك القدرة.
وهذا الأصل يبطل حجتهم. والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل، حيث دعا
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لهم بالتطهير.
فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم.
كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة.
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة.
والعصمة
مطلقاً - التي هي فعل المأمور وترك المحظور - ليست مقدوره عندهم لله، ولا
يمكنه أن يجعل أحداً فاعلاً لطاعة ولا تاركاً لمعصية، لا لنبي ولا لغيره،
فيمتنع عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله
وهدايته.
وهذا مما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم. ولو
قُدِّر ثبوت العصمة فقد قدّمنا أنه لا يُشترط في الإمام العصمة ولا إجماع
على انتفاء العصمة في غيرهم، وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق.
وأما قوله: "إن علياً ادّعاها، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقاً".
فجوابه
من وجوه: أحدها: أنّا لا نسلم أن عليّاً ادّعاها، بل نحن نعلم بالضرورة
علماً متيقناً أن عليّاً ما ادّعاها قط حتى قُتل عثمان، وإن كان قد يميل
بقلبه إلى أن يُوَلّى، لكن ما قال: إني أنا الإمام، ولا: إني معصوم، ولا:
إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جعلني الإمام بعده، ولا إني أوجب على
الناس متابعتي، ولا نحو هذه الألفاظ.
بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل
هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه. ونحن نعلم أن عليّاً كان أتقى لله من أن
يدَّعي الكذب الظاهر، الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب.
وأما نقل الناقل عنه أنه قال: "لقد تقمّصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن
محلي منها محل القطب من الرحى".
فنقول:
أولاً: أين إسناد هذا النقل، بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلاً إليه؟ وهذا لا
يوجد قط، وإنما يُوجد مثل هذا في كتاب" نهج البلاغة" وأمثاله، وأهل العلم
يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على عليّ، ولهذا لا يوجد غالبها في
كتاب متقدّم، ولا لها إسناد معروف. فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟.
ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدّعي أنه علويّ أو عباسيّ، ولا نعلم أحداً من
سلفه ادّعى ذلك قط، ولا ادعى ذلك له، فيعلم كذبه.
فإن
النسب يكون معروفاً من أصله حتى يتصل بفرعه، وكذلك المنقولات لابد أن تكون
ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا فإذا صنَّف واحد كتاباً ذكر فيه
خطباً كثيرة للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ،
ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف، علمنا قطعاً أن ذلك كذب.
وفي هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا يقيناً من عليّ ما يناقضها.
ونحن
في هذا المقام ليس علينا أن نبيّن أن هذا كذب، بل يكفينا المطالبة بصحة
النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدّقوا بما لم يقم دليل على صدقه،
بل هذا ممتنع بالاتفاق، لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق؛ فإن
هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء عليّ
للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة، لما كثر الكذّابون
عليه، وصار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون، سواء كان صدقاً أو كذباً، وليس
عندهم من يطالبهم بصحة النقل. وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر، وفيما
بيننا وبين الله تعالى.
ثم نقول: هب أن عليّاً قال ذلك، فلم قلت: إنه
أراد إنّي إمام معصوم منصوص عليه، ولم لا يجوز أنه أراد أني كنت أحق بها
من غيري، لاعتقاده في نفسه أنه أفضل وأحق من غيره، وحينئذ فلا يكون مخبراً
عن أمر تعمّد فيه الكذب، ولكن يكون متكلماً باجتهاده، والاجتهاد يصيب
ويخطئ.
ونفي الرجس لا يوجب أن يكون معصوماً من الخطأ بالاتفاق، بدليل
أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأ، فإن ذلك غير مقدور عليه
عندهم، والخطأ مغفور، فلا يضر وجوده.
وأيضاً فالخطأ لا يدخل فيه عموم الرجس.
وأيضاً
فإنه لا معصوم من أن يقرَّ على خطأ إلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
وهم يخصّون ذلك بالأئمة بعده، وإذهاب الرجس قد اشترك فيه عليّ وفاطمة
وغيرهما من أهل البيت.
وأيضاً فنحن نعلم أن عليّاً كان أتقى لله من
أن يتعمد الكذب، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن
يتعمدوا الكذب. لكن لو قيل لهذا المحتج بالآية: أنت لم تذكر دليلاً على أن
الكذب من الرجس، وإذا لم تذكر على ذلك دليلاً لم يلزم من إذهاب الرجس
إذهاب الكذبة الواحدة، إذا قُدِّر أن الرجس ذاهب، فهو فيمن يحتج بالقرآن،
وليس في القرآن ما يدل على إذهاب الرجس، ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ
من الرجس، ولا أن عليّاً قال ذلك. ولكن هذا كله لو صح شيء منه، لم يصح إلا
بمقدمات ليست في القرآن، فأين البراهين التي في القرآن على الإمامة؟ وهل
يدّعي هذا إلا من هو من أهل الخزي والندامة؟
الفصل السادس
الرد على من ادعى أن بيت عليّ من بيوت الأنبياء
قال
الرافضي: "البرهان السادس: في قوله تعالى: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ
أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ، رِجَالٌ } إلى قوله: { يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ } [النور: 36، 37] قال
الثعلبي بإسناده عن أنس وبُريدة قالا: قرأ رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم هذه الآية، فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: "بيوت
الأنبياء". فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعني
بيت عليّ وفاطمة. قال: نعم من أفضلها، وصف فيها الرجال بما يدلّ على
أفضليتهم فيكون عليّ هو الإمام، وإلا لزم تقديم المفضول على الفاضل".
والجواب
من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل. ومجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس
بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة، وليس كل خبر رواه واحدٌ من الجمهور يكون
حجة عند الجمهور، بل علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي
وأمثاله لا يحتجون به، لا في فضيلة أبي بكر وعمر، ولا في إثبات حكم من
الأحكام، إلا أن يُعلم ثبوته بطريق، فليس له أن يقول: إنّ نحتج عليكم
بالأحاديث التي يرويها واحد من الجمهور، فإن هذا بمنزلة من يقول: أنا أحكم
عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور، فهل يقول أحد من علماء الجمهور: إن كل
من شهد منهم فهو عدل، أو قال أحد من علمائهم: إن كل من روى منهم حديثاً
كان صحيحاً.
ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون
الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتّباع ذلك. ولهذا
يقولون في الثعلبي وأمثاله: إنه حاطب ليل يروي ما وجد، سواء كان صحيحاً أو
سقيماً. فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة، ففيه ما هو كذب
موضوع باتفاق أهل العلم.
ولهذا لما اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود
البغوي - وكان أعلم بالحديث والفقه منه، والثعلبي أعلم بأقوال المفسرين -
ذكر البغوي عنه أقوال المفسرين والنحاة وقصص الأنبياء، فهذه الأمور نقلها
البغوي من الثعلبي، وأما الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئاً من الموضوعات
التي رواها الثعلبي، بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخاري وغيره، فإنه
مصنّف كتاب "شرح السنة" وكتاب "المصابيح" وذكر ما في الصحيحين والسنن، ولم
يذكر الأحاديث التي تظهر لعلماء الحديث أنها موضوعة، كما يفعله غيره من
المفسرين، كالواحدي صاحب الثعلبي، وهو أعلم بالعربية منه، وكالزمخشري
وغيرهم من المفسرين، الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه
موضوع.
الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا
لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها، كالصحاح
والسنن والمساند، مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف، بل ما يُعلم أنه كذب، لكن
هذا قليل جداً. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذباً من أن يذكروه في
مثل ذلك.
الثالث: أن يُقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد(116)،
كما قال: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا
اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ } الآية [النور:
36]. وبيت عليّ وغيره ليس موصوفاً بهذه الصفة.
الرابع: أن يقال: بيت
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أفضل من بيت عليّ باتفاق المسلمين، ومع هذا
لم يدخل في هذه الآية، لأنه ليس في بيته رجال، وإنما فيه هو والواحدة من
نسائه، ولما أراد بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: { لا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ } [الأحزاب: 53]، وقال: { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي
بُيُوتِكُنَّ } [الأحزاب: 34].
الوجه الخامس: أن قوله: "هي بيوت
الأنبياء" كذب، فإنه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب. وقوله:
{ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ، رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ
تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ } [النور: 36، 37] متناول لكل
من كان بهذه الصفة.
الوجه السادس: أن قوله: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ
اللَّهُ أَن تُرْفَعَ } نكرة موصوفة ليس لها تعيين. وقوله: { فِي بُيُوتٍ
أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ }: إن أراد بذلك
ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت والصلاة فيها، دخل في ذلك بيوت
أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة، فلا تختص بيوت الأنبياء.
وإن
أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس ونحو ذلك،
كانت مختصة بالمساجد. وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد، وإن
كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها.
الوجه السابع: أن يقال: إن أريد
ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فليس في المدينة من
بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فلا يدخل
فيها بيت عليّ. وإن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم
قد دخل بيوت كثير من الصحابة.
وأي تقدير قُدِّر في الحديث لا يمكن
تخصيص بيت عليّ بأنه من بيوت الأنبياء، دون بيت أبي بكر وعمر وعثمان
ونحوهم. وإذا لم يكن له اختصاص، فالرجال مشتركون بينه وبين غيره.
الوجه
الثامن: أن يقال: قوله: الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله، ليس في الآية ما يدل على أنهم أفضل من غيرهم، وليس
فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير، وفيها الثناء عليهم، ولكن ليس كل من
أثنى عليه أو وُعد بالجنة يكون أفضل من غيره، ولهذا لم يلزم أن يكون هو
أفضل من الأنبياء.
الوجه التاسع: أن يُقال: هب أن هذا يدل على أنهم
أفضل ممن ليس كذلك من هذا الوجه، لكن لم قلت: إن هذه الصفة مختصة بعليّ؟
بل كل من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة ويخاف يوم القيامة، فهو متصف بهذه الصفة. فلم قلت: إنه ليس متصف
بذلك إلا عليّاً؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلاً واحداً، فهذا
دليل على أن هذا لا يختص بعليّ، بل هو وغيره مشتركون فيها. وحينئذ فلا
يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها.
الوجه العاشر: أنه لو سُلِّم أن عليّاً أفضل من غيره في هذه الصفة، فلم
قلت: إن ذلك يوجب الإمامة؟
وأما
امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سُلِّم، فإنما هو في مجموع الصفات
التي تناسب الإمامة، وإلا فليس كل من فُضِّل في خصلة من الخير استحق أن
يكون هو الإمام. ولو جاز هذا لقيل: ففي الصحابة من قتل من الكفّار أكثر
مما قتل عليّ، وفيهم من أنفق من ماله أكثر مما أنفق عليّ، وفيهم من كان
أكثر صلاة وصياماً من عليّ، وفيهم من أوذي في الله أكثر من عليّ، وفيهم من
كان أسنّ من عليّ، وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند عليّ.
وبالجملة
لا يمكن أن يكون واحدٌ من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل
وجه، ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه، بل
يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل، ولكن الاعتبار
في التفضيل بالمجموع.
الفصل السابع
الرد على من ادّعى اختصاص عليّ بالإمامة
والفضيلة بقوله بوجوب موالاته ومودته
قال
الرافضي: "البرهان السابع: قوله تعالى: { قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } [الشورى: 23] روى أحمد بن
حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت: { قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } قالوا: يا رسول الله من
قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: "عليّ وفاطمة وابناهما. وكذا في
تفسير الثعلبي، ونحوه في الصحيحين. وغير عليّ من الصحابة والثلاثة لا تجب
مودته، فيكون عليّ أفضل، فيكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة،
وبامتثال أوامره تكون مودته، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة".
والجواب
من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الحديث: وقوله: "إن أحمد روى هذا في
مسنده" كذب بيّن، فإن هذا مسند أحمد موجود به من النسخ ما شاء الله، وليس
فيه هذا الحديث. وأظهر من ذلك كذباً قوله: إن نحو هذا في الصحيحين وليس هو
في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك.
ولا ريب أن هذا
الرجل وأمثاله جهّال بكتب أهل العلم، لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها.
ورأيت بعضهم جمع لهم كتاباً في أحاديث من كتب متفرقة، معزوّة تارة إلى
الصحيحين، وتارة إلى مسند أحمد، وتارة إلى المغازلي والموفق خطيب خوارزم
والثعلبي وأمثاله، وسمَّاه "الطرائف في الرد على الطوائف". وآخر صنف
كتاباً لهم سماه "العمدة" واسم مصنّفه ابن البطريق.
وهؤلاء مع كثرة
الكذب فيهما يروونه، فهم أمثل حالاً من أبي جعفر محمد بن عليّ الذي صنّف
لهم وأمثاله، فإن هؤلاء يروون من الأكاذيب ما لا يخفى إلا على من هو من
أجهل الناس. ورأيت كثيراً من ذلك المعزوّ الذي عزاه أولئك إلى المسند
والصحيحين وغيرهما باطلاً لا حقيقة له، يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه
أصلاً.
لكن أحمد صنّف كتاباً في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ
وغيرهم، وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند. وليس كل ما رواه أحمد
في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في
المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف،
وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه.
وأما كتب الفضائل فيروي ما
سمعه من شيوخه، سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً، فإنه لم يقصد أن لا يروي في
ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابن أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي
زيادات. وفي زيادات القطيعي أحديث كثيرة كذب موضوعة، فظن ذلك الجاهل أن
تلك من رواية أحمد، وأنه رواها في المسند. وهذا خطأ قبيح؛ فإن الشيوخ
المذكورين شيوخ القطيعي، وكلهم متأخر عن أحمد، وهم ممن يروي عن أحمد، لا
ممن يروي أحمد عنه.
وهذا مسند أحمد وكتاب "الزهد" له، وكتاب "الناسخ
والمنسوخ" وكتاب "التفسير" وغير ذلك من كتبه، يقول: حدثنا وكيع، حدثنا عبد
الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرزاق. فهذا أحمد. وتارة يقول:
حدثنا أبو معمّر القطيعي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو نصر التمار، فهذا
عبد الله.
وكتابه في "فضائل الصحابة" له فيه هذا وهذا، وفيه من
زيادات القطيعي. يقول: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي وأمثاله، ممن هو
مثل عبد الله بن أحمد في الطبقة، وهو ممن غايته أن يروي عن أحمد، فإن أحمد
ترك الرواية في آخر عمره، لما طلب الخليفة أن يحدّثه ويحدّث ابنه ويقيم
عنده، فخاف على نفسه من فتنة الدنيا، فامتنع من الحديث مطلقاً ليسلم من
ذلك، ولأنه قد حدّث بما كان عنده قبل ذلك، فكان يذكر الحديث بإسناده بعد
شيوخه، ولا يقول: حدثنا فلان، فكان من يسمعون منه ذلك يفرحون بروايته عنه.
فهذا
القطيعي يروي عن شيوخه زيادات، وكثير منها كذب موضوع. وهؤلاء قد وقع لهم
هذا الكتاب ولم ينظروا ما فيه من فضائل سائر الصحابة، بل اقتصروا على ما
فيه من فضائل عليّ وكلما زاد حديثاً ظنوا أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل،
فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتهم، وأن شيوخ القطيعي يمتنع أن يروي أحمد
عنهم شيئاً، ثم إنهم لفرط جهلهم ما سمعوا كتاباً إلا المسند فلما ظنوا أن
أحمد رواه، وأنه إنما يروي في المسند، صاروا يقولون لما رواه القطيعي:
رواه أحمد في المسند.
هذا إن لم يزيدوا على القطيعي ما لم يروه، فإن
الكذب عندهم غير مأمون، ولهذا يعزو صاحب "الطرائف" وصاحب "العمدة" أحاديث
يعزوها إلى أحمد، لم يروها أحمد لا في هذا ولا في هذا، ولا سمعها أحد قط،
وأحسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي، وما رواه القطيعي فيه من
الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم.
ونقل هذا الرافضي من جنس
صاحب كتاب "العمدة" و"الطرائف" فما أدري نقل منه أو عمَّن ينقل عنه، وإلا
فمن له بالنقل أدنى معرفة يستحي أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد
والصحيحين، والصحيحان والمسند نسخهما ملء الأرض، وليس هذا في شيء منها.
وهذا الحديث لم يرو في شيء من كتب العلم المعتمدة أصلاً، وإنما يروي مثل
هذا من يحطب بالليل، كالثعلبي وأمثاله، الذين يروون الغث والسمين بلا
تمييز.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة
بالحديث، وهم المرجوع إليهم في هذا. وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث
التي يرجع إليها(117).
الوجه الثالث: أن هذه الآية في سورة الشورى وهي
مكيّة باتفاق أهل السنة، بل جميع آل حم مكيّات، وكذلك آل طس. ومن المعلوم
أن عليّاً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر، والحسن ولد في السنة
الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت
قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة، فكيف يفسر النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق بعد؟!.
الوجه الرابع:
أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. ففي الصحيحين عن
سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: { قُل لا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } [الشورى: 23]، فقلت:
أن لا تؤذوا محمداً في قرابته. فقال ابن عباس: عجلتَ، إنه لم يكن بطن من
قريش إلا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيهم قرابة، فقال: لا أسألكم
عليه أجراً، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم(118).
فهذا
ابن عباس ترجمان القرآن، وأعلم أهل البيت بعد عليّ، يقول: ليس معناها مودة
ذوي القربى، لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه
أجراً، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فهو سأل الناس
الذين أرسل إليهم أولاً أن يصلوا رحمه، فلا يعتدوا عليه حتى يبلّغ رسالة
ربه(119).
الوجه الخامس: أنه قال: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة
في القربى، لم يقل: إلا المودة للقربى، ولا المودة لذوي القربى. فلو أراد
المودة لذوي القربى لقال: المودة لذوي القربى، كما قال: { وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَى } [الأنفال: 41] وقال: { مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى } [الحشر: 7].
وكذلك قوله: { فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ } [الروم: 38] وقوله: { وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى } [البقرة: 177]، وهكذا في غير
موضع.
فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها: ذوي القربى، لم يقل: في
القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دلّ على أنه لم يرد ذوي القربى.
الوجه
السادس: أنه لو أريد المودة لهم، لقال: المودة لذوي القربى، ولم يقل: في
القربى. فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان، ولا في
قربى فلان، ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلما قال: المودة في
القربى، عُلم أنه ليس المراد لذوي القربى.
الوجه السابع: أن يقال: إن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجراً ألبتة،
بل أجره على الله، كما قال: { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } [ص: 86]، وقوله: { أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ } [الطور: 40]
وقوله: { قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ
إِلا عَلَى اللَّهِ } [سبأ: 47].
ولكن الاستثناء هنا منقطع، كما
قال: { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَن شَاءَ أَن
يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً } [الفرقان: 57].
ولا ريب أن محبة
أهل بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه
الآية، ولا محبتهم أجر للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم، بل هو مما أمرنا
الله به، كما أمرنا بسائر العبادات.
وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه
بغدير يدعى خُمّاً بين مكة والمدينة، فقال: "أذكّركم الله في أهل بيتي
أذكركم الله في أهل بيتي". وفي السنن عنه أنه قال: "والذي نفسي بيده لا
يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي"(120) فمن جعل محبة أهل بيته أجراً
له يوفِّيه إياه فقد أخطأ خطأً عظيماً، ولو كان أجراً له نثاب عليه نحن،
لأنّا أعطيناه أجره الذي يستحقّه بالرسالة، فهل يقول مسلم مثل هذا؟!.
الوجه
الثامن: أن القربى معرّفة باللام، فلابد أن يكون معروفاً عند المخاطبين
الذين أمر أن يقول لهم: { قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا } وقد
ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خُلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج عليّ
بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه، بخلاف
القربى التي بينه وبينهم، فإنها معروفة عندهم. كما تقول: لا أسألك إلا
المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم
التي بيننا، وكما تقول: لا أسألك إلا العدل بيننا وبينكم، ولا أسألك إلا
أن تتقي الله في هذا الأمر.
الوجه التاسع: أنّا نسلم أن عليّاً تجب
مودته وموالاته بدون الاستدلال بهذه الآية، لكن ليس في وجوب موالاته ومدته
ما يوجب اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة.
وأما قوله: "والثلاثة لا تجب
موالاتهم" فممنوع، بل يجب أيضاً مودتهم وموالاتهم، فإنه قد ثبت أن الله
يحبهم، ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه، فإن الحب في الله والبغض في
الله واجب، وهو أوثق عرى الإيمان. وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين،
وقد أوجب الله موالاتهم، بل قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه بنصّ
القرآن، وكل من رضي الله عنه فإنه يحبه، والله يحب المتقين والمحسنين
والمقسطين والصابرين، وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة بعد
نبيها.
وفي الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "مثل
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"(121) فهو أخبرنا أن المؤمنين
يتوادون ويتعاطفون ويتراحمون، وأنهم في ذلك كالجسد الواحد.
وهؤلاء قد
ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع، كما قد ثبت إيمان عليّ، ولا يمكن من قدح في
إيمانهم أن يثبت إيمان عليّ، بل كل طريق دلّ على إيمان عليّ فإنها على
إيمانهم أدل، والطريق التي يُقدح بها فيهم يُجاب عنها كما يجاب عن القدح
في عليّ وأوْلى فإن الرافضي الذي يقدح فيهم ويتعصب لعليّ فهو منقطع الحجة،
كاليهود والنصارى الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح في نبوة محمد
صلَّى الله عليه وسلَّم.
ولهذا لا يمكن الرافضي أن يقيم الحجة على
النواصب الذين يبغضون عليّاً، أو يقدحون في إيمانه، من الخوارج وغيرهم.
فإنهم إذا قالوا له: بأي شيء علمت أن عليّاً مؤمن أو ولي لله تعالى؟
فإن قال: بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته.
قيل
له: هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم. بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء، السليمة عن المعارض،
أعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعليّ.
وإن قال: بالقرآن الدّالّ على إيمان عليّ.
قيل
له: القرآن إنما دلّ بأسماء عامة، كقوله: { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ } [الفتح: 18] ونحو ذلك. وأنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة،
فإخراج واحدٍ أسهل.
وإن قال: بالأحاديث الدّالّة على فضائله، أو نزول القرآن فيه.
قيل: أحاديث أولئك أكثر وأصح، وقد قدحتَ فيهم.
وقيل
له: تلك الأحاديث التي في فضائل عليّ إنما رواها الصحابة الذين قدحتَ
فيهم، فإن كان القدح صحيحاً بطل النقل، وإن كان النقل صحيحاً بطل القدح.
وإن قال: بنقل الشيعة أو تواترهم.
قيل
له: الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد. والرافضة تطعن في جميع الصحابة
إلا نفراً قليلاً: بضعة شعر. ومثل هذا قد يُقال: إنهم قد تواطأوا على ما
نقلوه، فمن قدح في نقل الجمهور كيف يمكنه إثبات نقل نفر قليل؟ وهذا مبسوط
في موضعه.
والمقصود أن قوله: "وغير عليّ من الثلاثة لا تجب مودته" كلام
باطل عند الجمهور، بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة عليّ، لأن
وجوب المودة على مقدار الفضل، فكل من كان أفضل كانت موالاته أكمل.
وقد
قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا } [مريم: 96] قالوا: يحبهم ويحببهم
إلى عباده. وهؤلاء أفضل من آمن وعمل صالحاً من هذه الأمة بعد نبيها، كما
قال تعالى: { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ } [الفتح: 29] إلى آخر السورة.
وفي الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه سُئل: أيّ الناس أحب
إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"(122).
وفي
الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما يوم السقيفة: بل أنت سيدنا
وخيرنا وأحبّنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(123).
وتصديق
ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
"لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن مودة
الإسلام".
فهذا يبيّن أنه ليس في أهل الأرض أحق بمحبته ومودته من أبي
بكر، وما كان أحب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فهو أحب إلى الله،
وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون أحب إلى المؤمنين، الذين
يحبون ما أحبه الله ورسوله كما أحب الله ورسوله. والدلائل الدالة على أنه
أحق بالمودة كثيرة، فضلاً عن أن يُقال: إن المفضول تجب مدته، وإن الفاضل
لا تجب مودته.
وأما قوله: "إن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره هو مودته، فيكون
واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة".
فجوابه من وجوه:
أحدها:
إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة ذوي القربى فتجب طاعتهم، فيجب أن
تكون فاطمة أيضاً إماماً، وإن كان هذا باطلاً فهذا مثله.
الثاني: أني
المودة ليست مستلزمة للإمامة في حال وجوب المودة، فليس من وجبت مودته كان
إماماً حينئذ، بدليل أن الحسن والحسين تجب مودتهما قبل مصيرهما إمامين،
وعليُّ تجب مودته في زمن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يكن إماماً، بل
تجب وإن تأخرت إمامته إلى مقتل عثمان.
الثالث: أن وجوب المودة إن كان
ملزوم الإمامة، وانتفاء الملزوم يقتضي انتفاء اللازم، فلا تجب مودة إلا من
يكون إماماً معصوماً. فحينئذ لا يود أحداً من المؤمنين ولا يحبهم، فلا تجب
مودة أحد من المؤمنين ولا محبته، إذا لم يكونوا أئمة: لا شيعة عليّ ولا
غيرهم. وهذا خلاف الإجماع، وخلاف ما عُلم بالاضطرار من دين الإسلام.
الرابع: أن قوله: "والمخالفة تنافي المودة".
يقال:
متى؟ إذا كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقاً؟ الثاني ممنوع، وإلا لكان من أوجب
على غيره شيئاً لم يوجبه الله عليه إن خالفه فلا يكون محبّاً له، فلا يكون
مؤمن محبّاً لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته، وهذا معلوم الفساد.
وأما
الأول فيقال: إذا لم تكن المخالفة قادحة في المودة إلا إذا كان واجب
الطاعة، فحينئذ يجب أن يُعلم أولاً وجوب الطاعة، حتى تكون مخالفته قادحة
في مودته. فإذا ثبت وجوب الطاعة بمجرد وجوب المودة باطلاً، وكان ذلك
دَوْراً ممتنعاً؛ فإنه لا يعلم أن المخالفة تقدح في المودة حتى يعلم وجوب
الطاعة، ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام، ولا يعلم أنه إمام
حتى يعلم أن مخالفته تقدح في مودته.
الخامس: أن يقال: المخالفة تقدح في
المودة إذا أمر بطاعته أو لم يؤمر؟ والثاني منتف ضرورة. وأما الأول فإنّا
نعلم أن عليّاً لم يأمر الناس بطاعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
السادس: يُقال: هذا بعينه يُقال في حق أبي بكر وعمر وعثمان، فإن مودتهم
ومحبتهم وموالاتهم واجبة كما تقدم، ومخالفتهم تقدم في ذلك.
السابع:
الترجيح من هذا الحديث، لأن القوم دعوا الناس إلى ولايتهم وطاعتهم وادّعوا
الإمامة، والله أوجب طاعتهم، فمخالفتهم تقدح في مودتهم، بل تقدح في محبة
الله ورسوله. ولا ريب أن الذي ابتدع الرفض لم يكن محبّاً لله ولرسوله، بل
كان عدواً لله.
وهؤلاء القوم مع أهل السنة بمنزلة النصارى مع المسلمين،
فالنصارى يجعلون المسيح إلهاً، ويجعلون إبراهيم وموسى ومحمداً أقل من
الحواريين الذين كانوا مع عيسى. وهؤلاء يجعلون عليّاً هو الإمام المعصوم،
أو هو النبي أو إله، والخلفاء الأربعة أقل من مثل الأشتر النخعي، وأمثاله
الذين قاتلوا معه. ولهذا كان جهلهم وظلمهم أعظم من أن يوصف، ويتمسكون
بالمنقولات المكذوبة، والألفاظ المتشابهة، والأقيسة الفاسدة، ويدعون
المنقولات الصادقة بل المتواترة، والنصوص البيّنة، والمعقولات الصريحة.
الفصل الثامن
الرد على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص
عن باقي الصحابة بفضيلة الفداء
قال
الرافضي: "البرهان الثامن: قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي
نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ } [البقرة: 207] قال الثعلبي: إن
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لَمّا أراد الهجرة خلف عليّ بن أبي طالب
لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خرج إلى الغار، وقد
أحاط المشركون بالدار، أن ينام على فراشه، فقال له: يا عليّ اتشح ببردي
الحضرمي الأخضر، ونم على فراشي، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله
تعالى، ففعل ذلك.
فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل أني قد آخيت
بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟
فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله إليها: ألا كنتما مثل عليّ بن أبي طالب،
آخيت بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام فبات على فراشه يفديه بنفسه
ويؤثره بالحياة؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه.
فنزلا، فكان جبريل
عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، فقال جريل: بخٍ بخٍ من مثلك يا ابن أبي
طالب يباهي الله بك الملائكة؟ فأنزل الله عزَّ وجلَّ على رسوله صلَّى الله
عليه وسلَّم وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي: { وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ } [البقرة: 207]. وقال ابن
عباس: إنما نزلت في عليّ لَمّا هرب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من
المشركين إلى الغار، وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدل على أفضلية عليّ على
جميع الصحابة، فيكون هو الإمام".
الجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة
بصحة هذا النقل. ومجرد نقل الثعلبي وأمثاله لذلك، بل روايتهم، ليس بحجة
باتفاق طوائف أهل السنة والشيعة، لأن هذا مرسل متأخر، ولم يذكر إسناده،
وفي نقله من هذا الجنس للإسرائيليات والإسلاميات أمور يُعلم أنها باطلة،
وإن كان هو لم يتعمد الكذب.
ثانيها: أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث
والسيرة(124)، والمرجع إليهم في هذا الباب.
الثالث:
أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة لم يكن
للقوم غرض في طلب عليّ، وإنما كان مطلوبهم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
وأبا بكر، وجعلوا في كل واحد منهما ديته لمن جاء به، كما ثبت ذلك في
الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحته(125)، وترك عليّاً في فراشه
ليظنوا أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في البيت فلا يطلبوه، فلما أصبحوا
وجدوا عليّاً فظهرت خيبتهم، ولم يؤذوا عليّاً، بل سألوه عن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم، فأخبرهم أنه لا علم له به، ولم يكن هناك خوف على عليٍّ
من أحد، وإنما كان الخوف على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وصدِّيقه، ولو
كان لهم في عليٍّ غرض لتعرضوا له لما وجدوه، فلما لم يتعرضوا له دلّ على
أنهم لا غرض لهم فيه، فأيّ فداء هنا بالنفس؟.
والذي كان يفديه بنفسه
بلا ريب، ويقصد أن يدفع بنفسه عنه، ويكون الضرر به دونه، هو أبو بكر. كان
يذكر الطلبة فيكون خلفه، ويذكر الرصد فيكون أمامه، وكان يذهب فيكشف له
الخر. وإذا كان هناك ما يخُاف أحب أن يكون به لا بالنبي صلَّى الله عليه
وسلَّم.
وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب، فمنهم من
قُتل يبن يديه، ومنهم من شُلّت يده، كطلحة بن عبد الله وهذا واجب على
المؤمنين كلهم. فلو قُدِّر أنه كان هناك فداء بالنفس لكان هذا من الفضائل
المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، فكيف إذا لم يكن هناك خوف على عليٍّ؟.
قال
ابن إسحاق في "السيرة" - مع أنه من المتولّين لعليّ المائلين إليه - وذكر
خروج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من منزله، واستخلاف عليّ على فراشه
ليلة مكر الكفار به، قال(126): "فأتى جبريل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
فقال له(127): لا تَبِتْ هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال:
فلمّا كانت عَتْمة الليل(128) اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، فيثبون
عليه، فلما رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مقامهم قال لعليّ(129):
نَمْ على فراشي واتشح(130) ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن
يخلص إليك شيء تكرهه منهم.
وعن محمد بن كعب القرظي(131) قال: لَمّا
اجتمعوا له، وفيهم: أبو جهل(132)، فقال وهم على بابه: إن محمداً يزعم أنكم
إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بُعثتم من بعد موتكم،
فجُعلت لكم جناتٌ كجنات(133) الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم
بُعثتم من بعد موتكم، فجعلت(134) لكم نار تحرقون فيها.
قال: وخرج رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهم(135)، فأخذ حَفْنة من تراب في يده، ثم
قال: نعم(136) أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله على أبصارهم عنه، فلا
يَرَوْنه(137)... ولم يبق منهم رجلاً إلا وضع على(138) رأسه تراباً، ثم
انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آتٍ ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون
هاهنا؟ قالوا: محمداً. قال: خيّبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما
ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما
بكم؟
قال: فوضع كلّ رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم
جعلوا يطّلعون(139) فَيَرَوْن عليّاً على الفراش مسجّى(140) ببُرد رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولون: والله إن هذا لمحمدٌ نائماً، عليه
برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام عليّ عن الفراش، فقالوا: والله
لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا(141) وكان مما أنزل الله من القرآن ذلك
اليوم(142): { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ
أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } [الأنفال: 30] وقوله: { أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ } الآية [الطور: 30] وأذن
الله لنبيه(143) في الهجرة عند ذلك"(144).
فهذا يبيّن أن القوم لم يكن لهم غرض في عليٍّ أصلاً.
وأيضاً
فإن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد قال: "اتّشح ببردي هذا الأخضر، فنم
فيه، فإنه لم يخلص إليك منهم رجل بشيء تكرهه" فوعده وهو الصادق، أنه لا
يخلص إليه مكروه، وكان طمأنينته بوعد الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.
الرابع:
أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا يخفى، فإن الملائكة لا يقال
فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق بهم، وليس أحدهما جائعاً فيؤثره الآخر
بالطعام، ولا هناك خوف فيؤثر أحدهما صاحبه بالأمن، فكيف يقول الله لهما:
أيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ ولا للمؤاخاة بين الملائكة أصل، بل جبريل له
عمل يختص به دون ميكائيل، وميكائيل له عمل يختص به دون جبريل، كما جاء في
الآثار أن الوحي والنصر لجبريل، وأن الرزق والمطر لميكائيل.
ثم إنه
كان الله قضى بأن عمر أحدهما أطول من الآخر فهو ما قضاه، وإن قضاه لواحد
وأراد منهما أن يتفقا على تعيين الأطول، أو يؤثر به أحدهما الآخر، وهما
راضيان بذلك، فلا كلام. وأما إن كان يكرهان ذلك، فكيف يليق بحكمة الله
ورحمته أن يحرِّش بينهما، ويلقي بينهما العداوة؟ ولو كان ذلك حقّاً -
تعالى الله عن ذلك - ثم هذا القدر لو وقع مع أنه باطل، فكيف تأخّر من حين
خلقهما الله قبل آدم إلى حين الهجرة؟ وإنما كان يكون ذلك لو كان عقب
خلقهما.
الخامس: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يؤاخ عليّاً ولا
غيره، بل كل ما رُوي في هذا كذب. وحديث المؤاخاة الذي يُروى في ذلك - مع
ضعفه وبطلانه - إنما فيه مؤاخاته له في المدينة، هكذا رواه الترمذي(145)
فأما بمكة فمؤاخاته له باطلة على التقديرين.
وأيضاً فقد عرف أنه لم يكن فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء
النقل.
السادس:
أن هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من الناس من أعظم المنكرات؛ فإن الله
يحفظ من شاء من خلقه بدون هذا. وإنما رُوي هبوطهما يوم بدر للقتال، وفي
مثل تلك الأمور العظام، ولو نزلا لحفظ واحد من الناس لنزلا لحفظ النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم وصديقه، اللذين كان الأعداء يطلبونهما من كل وجه،
وقد بذلوا في كل واحد منهما ديته، وهم عليهما غلاظ شداد سود الأكباد.
السابع:
أن هذه الآية في سورة البقرة، وهي مدنية بلا خلاف، وإنما نزلت بعد هجرة
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة، لم تنزل وقت هجرته. وقد قيل:
إنها نزلت لما هاجر صهيب وطلبه المشركون، فأعطاهم ماله، وأتى المدينة،
فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "ربح البيع أبا يحيى". وهذه القصة
مشهورة في التفسير، نقلها غير واحد(146).
وهذا ممكن؛ فإن صهيباً
هاجر من مكة إلى المدينة. قال ابن جرير(147): "اختلف(148) أهل التأويل
فيمن نزلت هذه الآية فيه، ومن عُني بها. فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين
والأنصار، وعُني بها المجاهدون في سبيل الله". وذكر بإسناده هذا
القول(149) "وعن قتادة قال: وقال بعضهم: نزلت في قومٍ بأعيانهم"(150).
وروي
عن "القاسم قال: حدثنا الحسين، حدثنا حجّاج(151)، حدثنا ابن جريح(152)، عن
عكرمة(153) قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندب(154)، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر
فانفلت منهم، فقدم على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فلما رجع مهاجراً
عرضوا له، وكانوا بمر الظهران فانفلت أيضاً حتى قدم عليه(155)، وأما صهيب
فأخذه أهله، فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجراً فأدركه قنفذ بن عمير بن
جدعان(156)، فخرج له مما بقي من ماله فخلّى(157) سبيله"(158).
"وقال آخرون: عنى(159) بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في سبيل الله،
وأمر(160) بمعروف".
ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباس، وأن صهيباً كان سبب النزول(161).
الثامن:
أن لفظ الآية مطلق، ليس فيه تخصيص. فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد
دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وصدّيقه، فإنهما
شربا نفسهما ابتغاء مرضات الله، وهاجرا في سبيل الله، والعدو يطلبهما من
كل وجه.
التاسع: أن قوله: "هذه فضيلة لم تحصل لغيره فدل على أفضليته فيكون هو
الإمام".
فيقال:
لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة
بالكتاب والسنة والإجماع، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان
وعليّ وغيرهم من الصحابة فيكون هو الإمام.
فهذا هو الدليل الصدق
الذي لا كذب فيه. يقول الله: { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ
إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا }
[التوبة: 40].
ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعاً، بخلاف
الوقاية بالنفس، فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم بنفسه. وهذا واجب على كل مؤمن، ليس من الفضائل
المختصة بالأكابر من الصحابة.
والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا
بالمشتركات. يبيّن ذلك أنه لم ينقل أحدٌ أن عليّاً أوذي في مبيته على فراش
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد أوذي غيره في وقايتهم النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم: تارة بالضرب، وتارة بالجرح، وتارة بالقتل. فمن فداه وأوذي
أعظم ممن فداه ولم يؤذ.
وقد قال العلماء: ما صح لعليّ من الفضائل فهي
مشتركة، شاركه فيها غيره، بخلاف الصدّيق، فإن كثيراً من فضائله - وأكثرها
- خصائص له، لا يشركه فيها غيره، وهذا مبسوط في موضعه.
الفصل التاسع
الرّدّ على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله إنه مساوٍ للرسول صلَّى الله عليه
وسلَّم
لأنه عيّنه للمباهلة
قال
الرافضي: "البرهان التابع: قوله تعالى: { فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ } [آل عمران: 61]. نقل الجمهور كافة أن "أبناءنا" إشارة إلى
الحسن والحسين، و"نساءنا" إشارة إلى فاطمة. و"أنفسنا" إشارة إلى عليّ.
وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعليّ لأنه تعالى قد جعل نفس رسول الله
صلَّى الله عليه وسلَّم، والاتحاد محال، فيبقى المراد بالمساواة له
الولاية. وأيضاً لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم وأفضل منهم في استجابة
الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة، وإذا كانوا هم الأفضل
تعيّنت الإمامة فيهم. وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من
استحوذ الشيطان عليه، وأخذ بمجامع قلبه، وحُبّبت إليه الدنيا التي لا
ينالها إلا بمنع أهل الحق من حقهم؟".
والجواب أن يقال: أما أخذه عليّاً
وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة فحديث صحيح، رواه مسلم عن سعد بن أبي
وقاص، قال في حديث طويل(162): "لما نزلت هذه الآية: { فَقُلْ تَعَالَوْاْ
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ } [آل عمران: 61](163) دعا رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحُسيناً فقال: "اللهم هؤلاء أهلي".
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية.
وقوله: "قد جعله الله نفس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، والاتحاد
محال، فبقي المساواة له، وله الولاية العامة، فكذا المساوية".
قلنا:
لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة، ولا دليل على ذلك، بل حمله على ذلك
ممتنع، لأن أحداً لا يساوي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا عليّاً
ولا غيره.
وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة. قال تعالى في
قصة الإفك: { لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا } [النور: 12] ولم يوجب ذلك أن
يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين.
وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل: {
فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ } [البقرة: 54] أي: يقتل بعضكم بعضاً، ولم يوجب
ذلك أن يكونوا متساوين، ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده.
وكذلك قد قيل في قوله: { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } [النساء: 29] أي
لا يقتل بعضكم بعضاً، وإن كانوا غير متساوين.
وقال
تعالى: { وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ } [الحجرات: 11]: أي لا يلمز بعضكم
بعضاً، فيطعن عليه ويعيبه. وهذا نهي لجميع المؤمنين، أن لا يفعل بعضهم
ببعض هذا الطعن والعيب، مع أنهم غير متساوين لا في الأحكام، ولا في
الفضيلة، ولا الظالم كالمظلوم، ولا الإمام كالمأموم.
ومن هذا الباب قوله تعالى: { ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ
أَنفُسَكُمْ } [البقرة: 85] أي يقتل بعضكم بعضاً.
وإذا
كان اللفظ في قوله: { وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ } كاللفظ في قوله: { وَلا
تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ } [الحجرات: 11]، { لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا } [النور:
12]، ونحو ذلك، مع أن التساوي هنا ليس بواجب بل ممتنع، فكذلك هناك وأشد.
بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة. والتجانس والمشابهة يكون
بالاشتراك في بعض الأمور، كالاشتراك في الإيمان، فالمؤمنون إخوة في
الإيمان، وهو المراد بقوله: { لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا } [النور: 12]
وقوله: { وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ } [الحجرات: 11].
وقد يكون
بالاشتراك في الدِّين، وإن كان فيهم المنافق، كاشتراك المسلمين في الإسلام
الظاهر، وإن كان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو أوكد. وقوم موسى كانوا
أنفسنا بهذا الاعتبار.
قوله تعالى: { تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ }
[آل عمران: 61] أي رجالنا ورجالكم، أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين
والنسب، والرجال الذين هم من جنسكم. أو المراد التجانس في القرابة فقط،
لأنه قال: { أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ }
فذكر الأولاد وذكر النساء والرجال، فعُلم أنه أراد الأقربين إلينا من
الذكور والإناث، من الأولاد والعصبة.
ولهذا دعا الحسن والحسين من
الأبناء، ودعا فاطمة من النساء، ودعا عليّاً من رجاله، ولم يكن عنده أحد
أقرب إليه نسباً من هؤلاء، وهم الذين أدار عليهم الكساء.
والمباهلة
إنما تحصل بالأقربين إليه، وإلا فلو بأهلهم بالأبعدين في النسب، وإن كانوا
أفضل عند الله، لم يحصل المقصود؛ فإن المراد أنهم يدعون الأقربين، كما
يدعو هو الأقرب إليه.
والنفوس تحنو على أقاربها ما لا نحنو على غيرهم،
وكانوا يعلمون أنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ويعلمون أنهم إن
باهلوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقاربهم، واجتمع خوفهم على أنفسهم وعلى
أقاربهم، فكان ذلك أبلغ في امتناعهم، وإلا فالإنسان قد يختار أن يهلك
ويحيا ابنه، والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومالٍ.
وهذا موجود كثير.
فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين،
فلهذا دعا هؤلاء.
وآية
المباهلة نزلت سنة عشر، لما قدم وفد نجران، ولم يكن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم قد بقي من أعمامه إلا العباس، والعباس لم يكن من السابقين
الأوّلين، ولا كان له به اختصاص كعليّ. وأما بنو عمّه فلم يكن فيهم مثل
عليّ، وكان جعفر قد قُتل قبل ذلك. فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران
سنة تسعٍ أو عشر، وجعفر قتل بمؤتة سنة ثمان، فتعيّن عليّ رضي الله عنه.
وكونه
تعيّن للمباهلة، إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه، لا يوجب أن يكون
مساوياً للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم في شيء من الأشياء، بل ولا أن يكون
أفضل من سائر الصحابة مطلقاً، بل له بالمباهلة نوع فضيلة، وهي مشتركة بينه
وبين فاطمة وحسن وحسين، ليست من خصائص الإمامة، فإن خصائص الإمامة لا تثبت
للنساء، ولا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة، كما لم يوجب
أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع الصحابة.
وأما قوله الرافضي: "لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم. أو أفضل منهم في
استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه، لأنه في موضع الحاجة".
فيقال
في الجواب: لم يكن المقصود إجابة الدعاء؛ فإن دعاء النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم وحده كافٍ، ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن يستجاب دعاؤه، لدعا
المؤمنين كلهم ودعا بهم، كما كان يستسقي بهم، وكما كان يستفتح بصعاليك
المهاجرين، وكان يقول: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم
وإخلاصهم؟"(164).
ومن المعلوم أن هؤلاء، وإن كانوا مجابين، فكثرة
الدعاء أبلغ في الإجابة. لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه،
بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل. ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان، وطلحة والزبير، وابن مسعود
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة، لكانوا من أعظم الناس استجابة
لأمره، وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاة، لكن لم يأمره الله
سبحانه بأخذه معه، لأن ذلك لا يحصل به المقصود.
فإن المقصود أن أولئك
يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً، كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم أقرب
الناس إليهم. فلو دعا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قوماً أجانب لأتى
أولئك بأجانب، ولم يكن يشتد عليه نزول البهلة بأولئك الأجانب، كما يشتد
عليهم نزولها بالأقربين إليهم، فإن طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف
على الأجانب، فأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يدعو قرابته، وأن يدعو
أولئك قرابتهم.
والناس عند المقابلة تقول كل طائفة للأخرى: ارهنوا
عندنا أبناءكم ونساءكم، فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبياً لم يرض أولئك،
كما أنه لو دعا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الأجانب لم يرض أولئك
المقابلون له، ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن
يقابله بأهله.
فقد تبيّن أن الآية لا دلالة فيها أصلاً على المطلوب
الرافضي، لكنه وأمثاله ممن في قلبه زيغ، كالنصارى الذين يتعلقون بالألفاظ
المجملة ويدعون النصوص الصريحة، ثم قدحه في خيار الأمة بزعمه الكاذب، حيث
زعم أن المراد بالأنفس: المساوون، وهو خلاف المستعمل في لغة العرب.
ومما
يبين ذلك أن قوله: "نساءنا" لا يختص بفاطمة، بل من دعاه من بناته كانت
بمنزلتها في ذلك، لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة، فإن رقيَّة وأم كلثوم
وزينب كن قد توفين قبل ذلك.
فكذلك "أنفسنا" ليس مختصاً بعليّ، بل
هذه صيغة جمع، كما أن "نساءنا" صيغة جمع وكذلك "أبناءنا" صيغة جمع، وإنما
دعا حسناً وحسيناً لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما، فإن إبراهيم
إن كان موجوداً إذ ذاك فهو طفل لا يُدعى، فإن إبراهيم هو ابن مارية
القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب مصر، وأهدى له البغلة ومارية وسيرين،
فأعطى سيرين لحسّان بن ثابت، وتسرَّى مارية فولدت له إبراهيم، وعاش بضعة
عشر شهراً ومات، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إن له مرضعاً في
الجنة تتم رضاعه"(165).
وكان إهداء المقوقس بعد الحديبية، بل بعد حُنين.
الفصل العاشر
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله هو مساوي للنبي صلَّى الله عليه
وسلَّم في التوسل به إلى الله تعالى
قال
الرافضي: "البرهان العاشر: قوله تعالى: { فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ
كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ } [البقرة: 37] روى الفقيه ابن المغازلي
الشافعي(166) بإسناده عن ابن عباس، قال: سُئل النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. قال: سأله بحق محمد
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين أن يتوب عليه، فتاب عليه. وهذه فضيلة لم
يلحقه أحد من الصحابة فيها، فيكون هو الإمام لمساواته النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم في التوسل به إلى الله تعالى".
والجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل، فقد عُرف أن مجرد رواية ابن المغازلي لا
يسوغ الاحتجاج بها باتفاق أهل العلم.
الثاني:
أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في
"الموضوعات" من طري قالدارقطني(167)، فإن له كتباً في الأفراد
والغرائب(168). قال الدارقطني: "تفرّد به عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي
المقدام، لم يروه عنه غير حسن الأشقر. قال يحيى بن معين: عمرو بن ثابت ليس
ثقة ولا مأموناً. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات".
الثالث:
أن الكلمات التي تلقّاها آدم قد جاءت مفسّرة في قوله تعالى: { رَبَّنَا
ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [الأعراف: 23] وقد رُوي عن السلف هذا
وما يشبهه(169) وليس في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذكره من القسم.
الرابع:
أنه معلوم بالاضطرار أن من هو دون آدم من الكفّار والفساق إذا تاب أحدهم
إلى الله تاب الله عليه، وإن لم يقسم عليه بأحد. فكيف يحتاج آدم في توبته
إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين: لا مؤمن ولا كافر؟ وطائفة قد رووا
أنه توسّل بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم حتى قَبِلَ توبته، وهذا كذب.
ورُوي عن مالك في ذلك حكاية في خطابه للمنصور، وهو كذب على مالك، وإن كان
ذكرها القاضي عياض في "الشفا".
الخامس: أن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم لم يأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا الدعاء، بل ولا أمر أحداً بمثل هذا
الدعاء في توبة ولا غيرها، بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق،
كان هذا الدعاء مشروعاً لشرعه لأمته.
السادس: أن الإقسام على الله
بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب ولا سنة، بل قد نصّ غير واحد من
أهل العلم - كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما - على أنه لا يجوز أن يقسم على
الله بمخلوق. وقد بسطنا الكلام على ذلك.
السابع: أن هذا لو كان مشروعاً
فآدم نبيّ كريم، كيف يقسم على الله بمن هو أكرم عليه منه؟ ولا ريب أن
نبينا صلَّى الله عليه وسلَّم أفضل من آدم، لكن آدم أفضل من عليّ وفاطمة
وحسن وحسين.
الثامن: أن يُقال: هذه ليست من خصائص الأئمة، فإنها قد
ثبتت لفاطمة. وخصائص الأئمة لا تثبت للنساء وما لم يكن من خصائصهم لم
يستلزم الإمامة، فإن دليل الإمامة لابد أن يكون ملزوماً لها، يلزم من
وجوده استحقاقها، فلو كان هذا دليلاً على الإمامة لكان من يتصف به
يستحقها، والمرأة لا تكون إماماً بالنص والإجماع.
الفصل الحادي عشر
الرد على من روى عن ابن مسعودٍ حديث انتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ
قال
الرافضي: "البرهان الحادي عشر: قوله تعالى: { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي } [البقرة: 124]. روى الفقيه ابن
المغازلي(170) الشافعي عن ابن مسعود، قال: قال النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم: انتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ، لم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخذني نبي
واتخذ عليّاً وصي. وهذا نص في الباب".
والجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة بصحة هذا كما تقدّم.
الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث(171).
الثالث:
أن قوله: "انتهت الدعوة إلينا" كلام لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم، فإنه إن أريد: أنها لم تُصب من قبلنا كان ممتنعاً، لأن
الأنباء من ذرية إبراهيم دخلوا في الدعوة.
قال تعالى: { وَوَهَبْنَا
لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ،
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا
إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ
} [الأنبياء: 72، 73].
وقال تعالى: { وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
إِسْرَائِيلَ } [الإسراء: 2].
وقال
عن بني إسرائيل: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } [السجدة: 24].
وقال:
{ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ
لَهُمْ فِي الأَرْضِ } [القصص: 5، 6].
فهذه عدة نصوص في القرآن في جعل الله أئمة من ذرية إبراهيم قبل أمتنا.
وإن
أريد: انتهت الدعوة إلينا: أنه لا إمام بعدنا، لزم أن لا يكون الحسن
والحسين ولا غيرهما أئمة، وهو باطل بالإجماع. ثم التعليل بكونه لم يسجد
لصنم هو علة موجودة في سائر المسلمين بعدهم.
الوجه الرابع: أن كون
الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد على الإسلام، مع أن
السابقين الأوّلين أفضل منه، فكيف يجعل المفضول مستحقاً لهذه المرتبة دون
الفاضل؟
الخامس: أنه لو قيل: إنه لم يسجد لصنم لأنه أسلم قبل البلوغ،
فلم يسجد بعد إسلامه، فهكذا كل مسلم، والصبيّ غير مكلف. وإن قيل: إنه لم
يسجد قبل إسلامه. فهذا النفي غير معلوم، ولا قائله ممن يوثق به. ويقال:
ليس كل من لم يكفر، أو من لم يأت بكبيرة، أفضل ممن تاب عنها مطلقاً. بل قد
يكون التائب من الكفر والفسوق أفضل ممن لم يكفر ولم يفسق، كما دل على ذلك
الكتاب العزيز؛ فإن الله فضَّل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وأولئك كلهم أسلموا بعد الكفر. وهؤلاء فيهم
من ولد على الإسلام. وفضَّل السابقين الأوَّلين على التابعين لهم بإحسان،
وأولئك آمنوا بعد الكفر، وأكثر التابعين ولدوا على الإسلام.
وقد ذكر
الله في القرآن أن لوطاً آمن لإبراهيم، وبعثه الله نبياً. وقال شعيب: {
قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم
بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ
فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا } [الأعراف: 89].
وقال
تعالى: { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم
مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا } [إبراهيم: 13].
وقد
أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر، ثم نبأهم بعد توبتهم، وهم الأسباط الذين
أمرنا أن نؤمن بما أوتوا في سورة البقرة وآل عمران والنساء.
وإذا
كان في هؤلاء من صار نبيّاً، فمعلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم. وهذا مما
تُنازع فيه الرافضة وغيرهم، ويقولون: من صدر منه ذنب لا يصير نبيّاً.
والنّزاع فيمن أسلم أعظم، لكن الاعتبار بما دلّ عليه الكتاب والسنة.
والذين منعوا من هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصاً مذموماً لا
يستحق النبوة، ولو صار من أعظم الناس طاعةً. وهذا هو الأصل الذي نُوزعوا
فيه، والكتاب والسنة والإجماع يدل على بطلان قولهم فيه.
الفصل الثاني عشر
الرّدّ على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله إن الله خصّه بالود دون سائر
الصحابة
قال
الرافضي: "البرهان الثاني عشر: قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا } [مريم:
96] روى الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني بإسناده إلى ابن عباس، قال: نزلت في
عليّ. والوُدُّ محبة في القلوب المؤمنة. وفي تفسير الثعلبي عن البراء بن
عازب قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعليّ: يا عليّ قل: اللهم
اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله: { إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
الرَّحْمَنُ وُدًّا } [مريم: 96] ولم يثبت لغيره ذلك، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه:
أحدها:
أنه لابد من إقامة الدليل على صحة المنقول، وإلا فالاستدلال بما لا تثبت
مقدماته باطل بالاتفاق، وهو من القول بلا علم، ومن قفو الإنسان ما ليس له
به علم، ومن المحاجّة بغير علم والعزو المذكور لا يفيد الثبوت باتفاق أهل
السنة والشيعة.
الوجه الثاني: أن هذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث(172).
الثالث:
أن قوله: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [مريم:
96] عامّ في جميع المؤمنين، فلا يجوز تخصيصها بعليّ، بل هي متناولة لعليّ
وغيره(173). والدليل عليه أن الحسن والحسين وغيرهما من المؤمنين الذين
تعظّمهم الشيعة داخلون في الآية، فعُلم بذلك الإجماع على عدم اختصاصها
بعليّ.
وأما قوله: "ولم يثبت مثل ذلك لغيره من الصحابة" فممنوع كما
تقدم، فإنهم خير القرون، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في
سائر القرون، وهم بالنسبة إليهم أكثر منهم في كل قرن بالنسبة إليه.
الرابع:
أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودّاً، وهذا وعد
منه صادق. ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودّة في قلب كل مسلم، لا سيما
الخلفاء رضي الله عنهم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامّة الصحابة
والتابعين كانوا يودُّونهما، وكانوا خير القرون.
ولم يكن كذلك عليّ،
فإن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. وأبو
بكر وعمر رضي الله عنهما قد أبغضهما وسبّهما الرافضة والنصيرية والغالية
والإسماعيلية. لكن معلوم أن الذين أحبوا ذينك أفضل وأكثر، وأن الذين
أبغضوهما أبعد عن الإسلام وأقل، بخلاف عليّ، فإن الذين أبغضوه وقاتلوه هم
خير من الذين أبغضوا أبا بكر وعمر، بل شيعة عثمان الذين يحبونه ويبغضون
عليّاً، وإن كانوا مبتدعين ظالمين، فشيعة عليّ الذين يحبونه ويبغضون عثمان
أنقص منهم علماً وديناً، وأكثر جهلاً وظلماً.
فعُلم أن المودة التي جُعلت للثلاثة أعظم.
وإذا قيل: عليّ قد ادّعِيت فيه الإلهية والنبوة.
قيل:
قد كفّرته الخوارج كلها، وأبغضته المروانية. وهؤلاء خير من الرافضة الذين
يسبّون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلاً عن الغالية.
الفصل الثالث عشر
الرد على من يثبت الإمامة لعليّ باعتماده على مقولة: بك يا علي يهتدي
المهتدون
قال
الرافضي: "البرهان الثالث عشر: قوله تعالى: { إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } [الرعد: 7] من كتاب "الفردوس" عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أنا المنذر وعليّ الهادي، بك يا
عليّ يهتدي المهتدون. ونحوه رواه أبو نُعيم، وهو صريح في ثبوت الولاية
والإمامة".
والجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا لم يقم دليل على صحته،
فلا يجوز الاحتجاج به. وكتاب "الفردوس" للديلمي(174) فيه موضوعات كثيرة
أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث، وكذلك رواية
أبي نعيم لا تدل على الصحة.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث(175)، فيجب تكذيبه
ورده.
الثالث:
أن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. فإن قوله:
أنا المنذر وبك يا عليّ يهتدي المهتدون، ظاهره أنهم بك يهتدون دوني، وهذا
لا يقوله مسلم؛ فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما.
فهذا نذيرٌ لا يُهتدى به، وهذا هادٍ، وهذا لا يقوله مسلم.
الرابع:
أن الله تعالى قد جعل محمداً هادياً فقال: { وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ } [الشورى: 52، 53] فكيف يُجعل
الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به؟!
الخامس: أن قوله: "بك يهتدي
المهتدون" ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد فيه اهتدى، وهذا كذب بيّن؛
فإنه قد آمن بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم خلق كثير، واهتدوا به، ودخلوا
الجنة، ولم يسمعوا من عليّ كلمة واحدة، وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلَّى
الله عليه وسلَّم واهتدوا به لم يهتدوا بعليّ في شيء. وكذلك لما فتحت
الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم، كان جماهير
المؤمنين لم يسمعوا من عليّ شيئاً، فكيف يجوز أن يُقال: بك يهتدي
المهتدون؟!.
السادس: أنه قد قيل معناه: إنما أنت نذير ولكل قوم هاد،
وهو الله تعالى، وهو قول ضعيف. وكذلك قول من قال: أنت نذير وهاد لكل قوم،
قول ضعيف. والصحيح أن معناها: إنما أنت نذير، كما أرسل من قبلك نذير، ولكل
أمة نذير يهديهم أي يدعوهم، كما في قوله: { وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاّ خلا
فِيهَا نَذِيرٌ } [فاطر: 24]. وهذا قول جماعة من المفسرين، مثل قتادة
وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن زيد. قال ابن جرير الطبري(176): "حدثنا
بشر، حدثنا(177) يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة، وحدثنا أبو كريب(178) حدثنا
وكيع، حدثنا(179) سفيان، عن السدي عن عكرمة، ومنصور عن أبي الضحى: "إنما
أنت منذر ولكل قوم هاد" قالا: محمد هو المنذر وهو الهادي".
"حدثنا
يونس(180)، حدثنا ابن وهب(181)، قال: قال ابن زيد: لكل قوم نبي(182).
"الهادي": النبي(183) و "المنذر" أيضاً(184) وقرأ: { وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ
إِلاّ خلا فِيهَا نَذِيرٌ } [فاطر: 24]. وقرأ(185): { نَذِيرٌ مِنَ
النُّذُرِ الأُولَى } [النجم: 56] قال: نبي من الأنبياء. "حدثنا
بشار(186)، حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: "المنذر":
محمد(187)، "ولكل قوم هاد" قال: نبيٌّ.
وقوله: { يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ
أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ } [الإسراء: 71] إذ الإمام هو الذي يؤتمّ به، أي
يُقتدى به. وقد قيل: إن المراد به هو الله الذي يهديهم، والأول أصح.
وأما
تفسيره بعليّ فإنه باطل، لأنه قال: { وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } وهذا يقتضي
أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء، فيتعدد الهداة، فكيف يُجْعل عليّ
هادياً لكل قوم من الأوَّلين والآخرين؟!.
السابع: أن الاهتداء بالشخص
قد يكون بغير تأميره عليهم، كما يهتدي بالعالم. وكما جاء في الحديث الذي
فيه: "أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم"(188) فليس هذا صريحاً في أن
الإمامة كما زعمه هذا المفتري.
الثامن: أن قوله: { لِكُلِّ قَوْمٍ
هَادٍ } نكرة في سياق الإثبات وهذا لا يدل على معيّن، فدعوى دلالة القرآن
على عليٍّ باطل، والاحتجاج بالحديث ليس احتجاجاً بالقرآن، مع أنه باطل.
التاسع:
أن قوله: كل قوم، صيغة عموم. ولو أريد أن هادياً واحداً للجميع لقيل:
لجميع الناس هاد. لا يُقال: (لكل قوم)، فإن هؤلاء القوم غير هؤلاء القوم،
وهو لم يقل: لجميع القوم، ولا يُقال ذلك، بل أضاف "كلاًّ" من نكرة، لم
يضفه إلى معرفة.
كما في قولك: "كل الناس يعلم أن هنا قوماً وقوماً
متعددين وأن كل قوم لهم هادٍ ليس هو هاد للآخرين". وهذا يبطل قول من يقول:
إن الهادي هو الله تعالى، ودلالته على بطلان قول من يقول "هو عليّ" أظهر.
الفصل الرابع عشر
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إن الأمة ستسأل عن ولاية عليّ وحبه
قال
الرافضي: "البرهان الرابع عشر: قوله تعالى: { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم
مَّسْئُولُونَ } [الصافات: 24] من طريق أبي نُعيم عن الشعبي عن ابن عباس
قال في قوله تعالى: { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ } عن ولاية
عليّ. وكذا في كتاب "الفردوس" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم. وإذا سئلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له، ولم
يثبت لغيره من الصحابة ذلك، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة بصحة النقل، والعزو إلى "الفردوس" وإلى أبي نُعيم لا تقوم
به حجة باتفاق أهل العلم.
الثاني: أن هذا كذب موضوع بالاتفاق(189).
الثالث:
أن الله تعالى قال: {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ، وَإِذَا ذُكِّرُوا لا
يَذْكُرُونَ، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، وَقَالُوا إِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَوَ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ، قُلْ
نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا
هُمْ يَنظُرُونَ، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، هَذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، احْشُرُوا الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، مِن دُونِ اللَّهِ
فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم
مَّسْئُولُونَ، مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ، بَلْ هُمُ الْيَوْمَ
مُسْتَسْلِمُونَ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، قَالُوا بَل
لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ
بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا
لَذَائِقُونَ، فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، فَإِنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاّ
اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا
لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ، بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}
[الصافات: 12-37].
فهذا خطاب عن المشركين المكذِّبين بيوم الدين،
وهؤلاء يسألون عن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر. وأي مدخل لحب
عليٍّ في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو أحبّوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك
ينفعهم؟ أو تراهم لو أبغضوه أين كان بغضهم له في بغضهم لأنبياء الله
ولكتابه ودينه؟.
وما يفسر القرآن بهذا، ويقول: النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم فسَّره بمثل هذا، إلا زنديق ملحد، متلاعب بالدين، قادح في دين
الإسلام، أو مفرط في الجهل، لا يدري ما يقول. وأي فرق بين حب عليّ وطلحة
والزبير وسعد وأبي بكر وعمر وعثمان؟!.
ولو قال قائل: إنهم مسؤولون عن
حب أبي بكر، لم يكن قوله أبعد من قول من قال: عن حب عليّ، ولا في الآية ما
يدلّ على أن ذلك لقول أرجح، بل دلالتهم على ثبوتهما وانتفائهما سواء،
والأدلة الدالة على وجوب حب أبي بكر أقوى.
الرابع: أن قوله: "مسؤولون"
لفظ مطلق لم يُوصل به ضمير يخصه بشيء، وليس في السياق ما يقتضي ذكر حب
علي، فدعوى المدّعي دلالة اللفظ على سؤالهم عن حب عليّ من أعظم الكذب
والبهتان.
الخامس: أنه لو ادّعى مدّع أنهم مسؤولون عن حب أبي بكر وعمر، لم يكن إبطال
ذلك بوجهٍ إلا وإبطال السؤال عن حب عليٍّ أقوى وأظهر.
الفصل الخامس عشر
الرد على من روى عن أبي سعيد الخدري حديث بغض عليّ
قال
الرافضي: "البرهان الخامس عشر: قوله تعالى: { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي
لَحْنِ الْقَوْلِ } [محمد: 30] روى أبو نُعيم بإسناده عن أبي سعيد الخدري،
في قوله تعالى: { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } قال: ببغضهم
عليّاً. ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل منهم، فيكون هو
الإمام".
والجواب: المطالبة بصحة النقل أولاً.
والثاني: أن هذا من الكذب على أبي سعيد عند أهل المعرفة بالحديث(190).
الثالث:
أن يقال: لو ثبت أنه قاله، فمجرد قول أبي سعيد قول واحدٍ من الصحابة، وقول
الصاحب إذا خالفه صاحبٌ آخر ليس بحجة باتفاق أهل العلم. وقد عُلم قدح كثير
من الصحابة في عليٍّ وإنما احتج عليهم بالكتاب والسنة، لا بقول آخر من
الصحابة.
الرابع: أنّا نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يُعرفون به من
لحن القول هو بغض عليّ، فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة.
الخامس:
أن عليّاً لم يكن أعظم معاداة للكفّار والمنافقين من عمر، بل ولا نعرف
أنهم كانوا يتأذّون منه كما يتأذّون من عمر، بل ولا نعرف أنهم كانوا
يتأذّون منه إلا وكان بغضهم لعمر أشد.
السادس: أن في الصحيح عن النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق
بغض الأنصار"(191). وقال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم
الآخر"(192). فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى.
فإن
هذه الأحاديث أصح مما يروي عن عليّ، أنه قال: "إنه لعهد النبيّ الأميّ
إليّ أنه لا يُحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق". فإن هذا من أفراد
مسلم، وهو من رواية عديّ بن ثابت عن زرّ بن حُبيش عن علي(193)، والبخاري
أعرض عن هذا الحديث، بخلاف أحاديث الأنصار، فإنها مما اتفق عليه أهل
الصحيح كلهم: البخاري وغيره. وأهل العلم يعلمون يقيناً أن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم قاله، وحديث عليّ قد شك فيه بعضهم.
السابع: أن علامات
النفاق كثيرة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه
قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن
خان"(194) فهذه علامات ظاهرة. فعُلم أن علامات النفاق لا تختصّ بحب شخص أو
طائفة ولا بغضهم، إن كان ذلك من العلامات. ولا ريب أن من أحبَّ عليّاً لله
بما يستحقه من المحبة لله، فذلك من الدليل على إيمانه، وكذلك من أحبّ
الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله، فذلك من علامات إيمانه. ومن أبغض عليّاً
والأنصار لما فيهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، فهو منافق.
وأما
من أحب الأنصار أو عليّاً أو غيرهم لأمر طبيعي، مثل قرابة بينهما، فهو
كمحبة أبي طالب للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك لا ينفعه عند الله.
ومن غلا في الأنصار، أو في عليّ، أو في المسيح، أو في نبيّ، فأحبه واعتقد
فيه فوق مرتبته، فإنه لم يحبه في الحقيقة، إنما أحبّ ما لا وجود له، كحب
النصارى للمسيح، فإن المسيح أفضل من عليّ.
وهذه المحبة لا تنفعهم، فإنه إنما ينفع الحب لله، لا الحب مع الله.
قال
تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا
لِّلَّهِ } [البقرة: 165].
ومن قَدَّر أنه سمع عن بعض الأنصار أمراً
يوجب بغضه فأبغضه لذلك، كان ضالاًّ مخطئاً، ولم يكن منافقاً بذلك. وكذلك
من اعتقد في بعض الصحابة اعتقاداً غير مطابق، وظن فيه أنه كان كافراً أو
فاسقاً فأبغضه لذلك، كان جاهلاً ظالماً، ولم يكن منافقاً.
وهذا مما
يُبَيَّن به كذب ما يُروى عن بعض الصحابة كجابر، أنه قال: "ما كنّا نعرف
المنافقين على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلا ببغضهم عليّ بن أبي
طالب"(195) فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذباً، لا يخفى بطلان هذا النفي
على آحاد الناس، فضلاً عن أن يخفى مثل ذلك على جابر أو نحوه.
فإن الله قد ذكر في سورة التوبة وغيرها من علامات المنافقين وصفاتهم
أموراً متعددة، ليس في شيء منها بغض عليّ.
كقوله: { وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ } [التوبة: 49].
وقوله:
{ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا
رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ } [التوبة:
58].
وقوله: { وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ
هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ } [التوبة:
61].
وقوله: { وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن
فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ } [التوبة:
75] إلى قوله: { وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ } [التوبة: 77].
إلى أمثال ذلك من الصفات التي يصف بها المنافقين، وذكر علاماتهم وذكر
الأسباب الموجبة للنفاق.
وكل
ما كان موجباً للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له. فكيف يجوز لعاقل أن يقول:
لم يكن للمنافقين علامة يعرفون بها غير بُغض عليّ؟ وقد كان من علامتهم
التخلّف عن الجماعة، كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: أيها الناس
حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادى بهن، فإنهن من سنن الهدي، وإن
الله شرع لنبيّه سنن الهدي، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلّي هذا
المتخلّف في بيته لتركتم سنة نبيّكم، ولو تركتم سنة نبيّكم لضللتم، ولقد
رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به
يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف"(196).
وعامة علامات النفاق
وأسبابه ليست في أحدٍ من أصناف الأمة أظهر منها في الرافضة، حتى يوجد فيهم
من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في غيرهم. وشعار دينهم "التقيّة" التي
هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا علامة النفاق.
كما قال تعالى:
{ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ
لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ
قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ
يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا
لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ } [آل
عمران: 166-167].
وقال تعالى: { يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ
وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ
وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ } [التوبة: 74].
وقال تعالى: { فِي
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } [البقرة: 10] وفيها قراءتان: يَكذِبُون
ويُكَذِّبُونَ(197).
وفي الجملة فعلامات النفاق مثل الكذب والخيانة
وإخلاف الوعد والغدر، لا يوجد في طائفة أكثر منها في الرافضة. وهذا من
صفاتهم القديمة، حتى أنهم كانوا يغدرون بعليّ وبالحسن والحسين.
وفي
الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال:
"أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر،
وإذا خاصم فجر"(198). وهذا لبسطه موضوع آخر.
والمقصود هنا أنه يمتنع أن
يُقال: لا علامة للنفاق إلا بغض عليّ، ولا يقول هذا أحد من الصحابة، لكن
الذي قد يُقال: إن بغضه من علامات النفاق، كما في الحديث المرفوع: "لا
يبغضني إلا منافق"(199)، فهذا يمكن توجيهه، فإنه من علم ما قام به عليّ
رضي الله عنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، ثم أبغضه على
ذلك، فهو منافق.
ونفاق من يبغض الأنصار أظهر؛ فإن الأنصار قبيلة عظيمة
لهم مدينة، وهم الذين تبوّؤا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وبالهجرة
إلى دارهم عزّ الإيمان، واستظهر أهله، وكان لهم من نصر الله ورسوله ما لم
يكن لأهل مدينة غيرهم، ولا لقبيلة سواهم فلا يبغضهم إلا منافق. ومع هذا
فليسوا بأفضل من المهاجرين، بل المهاجرون أفضل منهم.
فعُلم أنه لا
يلزم من كون بُغض الشخص من علامات النفاق أن يكون أفضل من غيره. ولا يشك
من عرف أحوال الصحابة أن عمر كان أشد عداوة للكفار والمنافقين من عليّ،
وأن تأثيره في نصر الإسلام وإعزازه وإذلال الكفّار والمنافقين أعظم من
تأثير عليّ، وأن الكفار والمنافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون
عليّاً.
ولهذا كان الذي قتل عمر كافراً يبغض دين الإسلام، ويبغض الرسول
وأمته، فقتله بغضاً للرسول ودينه وأمته. والذي قتل علياً كان يصلي ويصوم
ويقرأ القرآن، وقتله معتقداً أن الله ورسوله يحب قتل عليّ، وفعل ذلك محبة
لله ورسوله - في زعمه - وإن كان في ذلك ضالاً مبتدعاً.
والمقصود أن
النفاق في بغض عمر أظهر منه في بغض عليّ. ولهذا لما كان الرافضة من أعظم
الطوائف نفاقاً كانوا يسمّون عمر فرعون الأمة. وكانوا يوالون أبا لؤلؤة -
قاتله الله - الذي هو من أكفر الخلق وأعظمهم عداوة لله ولرسوله.
الفصل السادس عشر
الرد على من قال أن فضيلة سبق عليّ إلى محمد لم تثبت لغيره من الصحابة
قال
الرافضي: "البرهان السادس عشر: قوله تعالى: { وَالسَّابِقُونَ
السَّابِقُونَ، أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ } [الواقعة: 10-11] روى أبو
نُعيم عن ابن عباس في هذه الآية: سابق هذه الأمة عليّ بن أبي طالب. روى
الفقيه ابن المغازلي الشافعي، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: {
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ } قال: سبق يوشع بن نون إلى موسى، وسبق
موسى إلى هارون، وسبق صاحب يس إلى عيسى، وسبق عليّ إلى محمد صلَّى الله
عليه وسلَّم. وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة بصحة النقل، فإن الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا.
الثاني: أن هذا باطل عن ابن عباس، ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو
أقوى منه(200).
الثالث:
أن الله يقول: { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا
الأَنْهَارُ } [التوبة: 100].
وقال تعالى: { ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ } الآية [فاطر: 32].
والسابقون الأوّلون هم الذين
أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل.
ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فكيف يُقال:
إن سابق هذه الأمة واحدٌ؟!.
الرابع: قوله: "وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره
من الصحابة" ممنوع؛ فإن الناس متنازعون في أول من أسلم، فقيل: أبو بكر أول
من أسلم، فهو أسبق إسلاماً من عليّ. وقيل: إن عليّاً أسلم قبله. لكن عليّ
كان صغيراً، وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء ولا نزاع في أن إسلام أبي
بكر أكمل وأنفع، فيكون هو أكمل سبقاً بالاتفاق، وأسبق على الإطلاق على
القول الآخر. فكيف يُقال: عليٌّ أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك.
الخامس:
أن هذه الآية فضّلت السابقين الأوّلين، ولم تدل على أن كل من كان أسبق إلى
الإسلام كان أفضل من غيره. وإنما يدل على أن السابقين أفضل قوله تعالى: {
لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ
وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } [الحديد: 10]، فالذين
سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية، أفضل ممن بعدهم، فإن الفتح
فسَّره النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالحديبية.
وإذا كان أولئك
السابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلى الإسلام، فليس في الآيتين ما يقتضي أن
يكون أفضل مطلقاً، بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق
والقتال.
ولهذا كان عمر رضي الله عنه ممن أسلم بعد تسعة وثلاثين، وهو
أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة، وبإجماع الصحابة والتابعين، وما علمت
أحداً قط قال: إن الزبير ونحوه أفضل من عمر، والزبير أسلم قبل عمر. ولا
قال من يعرف من أهل العلم: إن عثمان أفضل من عمر، وعثمان أسلم قبل عمر.
وإن
كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال، فمعلوم أن أبا بكر أخصّ بهذا، فإنه
لم يجاهد قبله أحدٌ: لا بيده ولا بلسانه، بل هو من حين آمن بالرسول ينفق
ماله ويجاهد بحسب الإمكان، فاشترى من المعذّبين في الله غير واحد، وكان
يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال. كما قال تعالى: {
وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا } [الفرقان: 52]. فكان أبو بكر أسبق
الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال.
ولهذا قال النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح: "إنّ أمنّ الناس عليّ في صحبته وذات
يده أبو بكر". والصحبة بالنفس وذات اليد هو المال، فأخبر النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم أنه أمنّ الناس عليه في النفس والمال.
الفصل السابع عشر
الرد على من يثبت لعلي الإمامة بدعوى أنه خصّ
بفضيلة الإيمان والهجرة والجهاد دون غيره
قال
الرافضي: "البرهان السابع عشر: قوله تعالى: { الَّذِينَ آمَنُواْ
وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ } الآيات [التوبة: 20].
روى
رزين بن معاوية في "الجمع بين الصحاح الستة" أنها نزلت في عليّ لما افتخر
طلحة بن شيبة والعباس. وهذه لم تثبت لغيره من الصحابة، فيكون أفضل، فيكون
هو الإمام".
والجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة بصحة النقل. ورزين(201) قد ذكر في كتابه أشياء ليست في
الصحاح.
الثاني:
أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن رزين، بل الذي في الصحيح ما رواه
النعمان بن بشير، قال: كنت عند منبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
فقال رجل: لا أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال
آخر: لا أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام.
وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم: فزجرهم عمر، وقال: لا
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو يوم
الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل
الله تعالى: { أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ } الآية إلى آخرها [التوبة: 19] أخرجه مسلم(202).
وهذا
الحديث يقتضي أن قول عليّ الذي فضَّل به الجهاد على السدانة والسقاية أصح
من قول من فضّل السدانة والسقاية، وأن عليّاً كان أعلم بالحق في هذه
المسألة ممن نازعه فيها. وهذا صحيح.
وعمر قد وافق ربّه في عدة أمور،
يقول شيئاً وينزل القرآن بموافقته. قال للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم: لو
اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى، فنزلت: { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } [البقرة: 125]. وقال: إن نساءك يدخل عليهن البرّ
والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاج فنزلت آية الحجاب. وقال: عسى ربّه إن طلقكن
أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، فنزلت
كذلك(203). وأمثال ذلك. وهذا كله ثابت في الصحيح. وهذا أعظم من تصويب عليّ
في مسألة واحدة.
وأما التفضيل بالإيمان والهجرة والجهاد، فهذا ثابت
لجميع الصحابة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فليس هاهنا فضيلة اختصّ بها
عليّ، حتى يقال: إن هذا لم يثبت لغيره.
الثالث: أنه لو قُدِّر أنه
اختصّ بمزية فهذه ليست من خصائص الإمامة، ولا موجبة لأن يكون أفضل مطلقاً.
فإن الخضر لما علم ثلاث مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى مطلقاً،
والهدهد لما قال لسليمان: { أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ } [النمل: 22]
لم يكن أعلم من سليمان مطلقاً.
الرابع: أن عليّاً كان يعلم هذه
المسألة، فمن أين يعلم أن غيره من الصحابة لم يعلمها؟ فدعوى اختصاصه
بعلمها باطل، فبطل الاختصاص على التقديرين. بل من المعلوم بالتواتر أن
جهاد أبي بكر بماله أعظم من جهاد عليّ، فإن أبا بكر كان موسراً، قال فيه
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "ما نفعني مال كمال أبي بكر" وعليّ كان
فقيراً، وأبو بكر أعظم جهاداً بنفسه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
الفصل الثامن عشر
الرد على من ادّعى أن عليّ وحده هو الذي تصدق
ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره
قال
الرافضي: "البرهان الثامن عشر: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } [المجادلة: 12] من طريق الحافظ أبي نُعيم إلى ابن
عباس، قال: إن الله حرَّم كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلا
بتقديم الصدقة، وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه، وتصدَّق عليٌّ، ولم يفعل
ذلك أحد من المسلمين غيره.
ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر: كان لعليّ
ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحبّ إليّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة،
وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى.
وروى رزين بن معاوية في "الجمع
بين الصحاح الستة" عن عليّ: ما عمل بهذه الآية غيري، وبي خفف الله عن هذه
الأمة. وهذا يدل على فضيلته عليهم، فيكون هو أحق بالإمامة".
والجواب
أن يقال: أما الذي ثبت فهو أن عليّاً رضي الله عنه تصدَّق وناجى، ثم نُسخت
الآية قبل أن يعمل بها غيره(204)، لكن الآية لم توجب الصدقة عليهم، لكن
أمرهم إذا ناجوا أن يتصدّقوا فمن لم يناج لم يكن عليه أن يتصدّق. وإذا لم
تكن المناجاة واجبة، لم يكن أحد ملوماً إذا ترك ما ليس بواجب، ومن كان
فيهم عاجزاً عن الصدقة ولكن لو قَدَر لناجي فتصدّق، فله نيته وأجره، ومن
لم يعرض له سبب يناجي لأجله لم يُجعل ناقصاً، ولكن من عرض له سبب اقتضى
المناجاة فتركه بخلاً، فهذا قد ترك المستحب. ولا يمكن أن يُشهد على
الخلفاء أنهم كانوا من هذا الضرب، ولا يُعلم أنهم كانوا ثلاثتهم حاضرين
عند نزول هذه الآية، بل يمكن غيبة بعضهم، ويمكن حاجة بعضهم، ويمكن عدم
الداعي إلى المناجاة.
ولم يطل زمان عدم نسخ الآية، حتى يُعلم أن الزمان الطويل لابد أن يعرض فيه
حاجة إلى المناجاة.
وبتقدير أن يكون أحدهم ترك المستحب، فقد بيّنّا غير مرّة أن من فعل
مستحباً لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقاً.
وقد
ثبت في الصحيح أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لأصحابه: "من أصبح
منكم اليوم صائماً"؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: "فمن تبع منكم جنازة"؟ قال
أبو بكر: أنا. قال: "هل فيكم من عاد مريضاً"؟ قال أبو بكر: أنا. قال: "هل
فيكم من تصدَّق بصدقة"؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: "ما اجتمع لعبد هذه
الخصال إلا وهو من أهل الجنة"(205). وهذه الأربعة لم ينقل مثلها لعليّ ولا
غيره في يوم.
وفي الصحيحين أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
"من أنفق زوجين في سبيل الله دُعِيَ من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير،
فإن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد
دُعِيَ من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دُعِيَ من باب الصدقة". فقال
أبو بكر: يا سول الله فما على من يُدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل
يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: "نعم وأرجو أن تكون منهم"(206). ولم
يُذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله عنه.
وفي الصحيحين عن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم أنه قال: "بينما رجل يسوق بقرة قد حَمَل عليها، فالتفتت
إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خُلقت للحرث". فقال الناس:
سبحان الله بقرة تتكلم!! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "فإني
أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر" وما هما ثمَّ.
قال أبو هريرة: وقال رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب، فأخذ
منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب، فقال: من
لها يوم السَّبُعٍ، يوم ليس لها راعٍ غيري"؟. فقال الناس: سبحان الله!
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "فإني أؤمن بذلك: أنا وأبو بكر
وعمر" وما هما ثمَّ(207).
وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
"ما نفعني مال كمال أبي بكر"(208) وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة، لم
يشركه فيها عليّ ولا غيره.
وكذلك قوله في الصحيحين: "إنّ أمنّ الناس
عليّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربّي لاتخذت أبا
بكر خليلاً، لكن أخوّة الإسلام ومودّته. لا يبقينَّ بابٌ في المسجد إلا
سدَّ، إلا باب أبي بكر"(209).
وفي سنن أبي داود أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لأبي بكر: "أما إنك
يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي"(210).
وفي
الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم أن نتصدّق، فوافق منّي مالاً، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر
إن سبقته. قال: فجئت بنصف مالي، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "ما
أبقيت لأهلك"؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: "يا أبا بكر ما
أبقيت لأهلك"؟ قال: الله ورسوله. قلت: لا أسابقه إلى شيء أبداً"(211).
وفي
البخاري عن أبي الدرداء، قال: كنت جالساً عند النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم: "أمَّا صاحبكم فقد غامر فسلم". وقال: إنه كان
بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، فأبى
عليّ، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً. ثم إن عمر ندم،
فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثمَّ أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتي النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم فسلّم عليه فجعل وجه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
يتمعّر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، وقال: يا رسول الله والله أنا
كنت أظلم، مرتين. فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إن الله بعثني
إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم
تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما أُوذِيَ بعدها".
وفي لفظ آخر: "إني قلت: أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً، فقلت:
كذبت. وقال أبو بكر: صدقت"(212).
وفي الترمذي مرفوعاً: "لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمَّهم غيره"(213).
وتجهيز
عثمان بألف بعير أعظم من صدقة عليّ بكثير كثير؛ فإن الإنفاق في الجهاد كان
فرضاً، بخلاف الصدقة أمام النجوى فإنه مشروط بمن يريد النجوى، فمن لم
يردها لم يكن عليه أن يتصدق.
وقد أنزل الله في بعض الأنصار: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [الحشر: 9].
وفي
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك
بالحق نبيّاً ما عندي إلا ماء. ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن
مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: "من يضيِّفه هذه
الليلة رحمه الله"؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله.
وانطلق
به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياننا.
فقال: فعلّليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأفطئي السراج، وأريه أنّا نأكل،
فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا فأكل الضيف.
فلما أصبح غدا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: "قد عجب الله
من صنعكما بضيفكما الليلة".
وفي رواية فنزلت هذه الآية: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [الحشر: 9](214).
وبالجملة
فباب الإنفاق في سبيل الله وغيره، لكثير من المهاجرين والأنصار، فيه من
الفضيلة ما ليس لعليّ، فإنه لم يكن له مالٌ على عهد رسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم.
الفصل التاسع عشر
الرد على من قال إن الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية عليّ
قال الرافضي: "البرهان التاسع عشر: قوله تعالى: { وَاسْأَلْ مَنْ
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا } [الزخرف: 45].
قال
ابن عبد البر، وأخرجه أبو نعيم أيضاً: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال: سلهم يا محمد عَلاَم
بُعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوّتك
والولاية لعليّ بن أبي طالب. وهذا صريح بثبوت الإمامة لعليّ".
والجواب
من وجوه: أحدها: المطالبة في هذا وأمثاله بالصحة. وقولنا في هذا الكذب
القبيح وأمثاله: المطالبة بالصحة، ليس بشك منا في أن هذا وأمثاله من أسمج
الكذب وأقبحه، لكن على طريق التنزل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه
كذب لم يجز أن يُحتج به حتى يثبت صدقه؛ فإن الاستدلال بما لا تُعلم صحته
لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
الوجه الثاني: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع.
الوجه
الثالث: أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب الباطل الذي لا
يُصدق به من له عقل ودين، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في
الكذب، فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يُسألون عمّا لا يدخل في أصل
الإيمان؟.
وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلَّى الله
عليه وسلَّم وأطاعه، ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر
وعثمان وعليّاً لم يضره ذلك شيئاً، ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة. فإذا كان
هذا في أمة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، فكيف يقال: إن الأنبياء يجب
عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟!.
والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم
لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. هكذا قال ابن عباس وغيره،
كما قال تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا
آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ } [آل عمران:
81] إلى قوله: { أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي
قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ
الشَّاهِدِينَ } [آل عمران: 81](215).
فأما الإيمان بتفصيل ما بُعث به محمد: فلم يؤخذ عليهم، فكيف يؤخذ عليهم
موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين؟.
الرابع:
أن لفظ الآية: { وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ } [الزخرف: 45].
ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟(216).
الخامس: أن قول القائل: إنهم
بعثوا بهذه الثلاثة. إن أراد أنهم لم يُبعثوا إلا بها، فهذا كذب على
الرسل. وإن أراد أنها أصول ما بُعثوا به، فهذا أيضاً كذب؛ فإن أصول الدين
التي بُعثوا بها: من الإيمان بالله واليوم الآخر وأصول الشرائع، أهم عندهم
من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبيّ غيرهم، بل ومن الإقرار بنبوة محمد
صلَّى الله عليه وسلَّم، فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاً، كما يجب
علينا نحن الإقرار بنبوّاتهم مجملاً، لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيمان
بشرعه على التفصيل كما يجب علينا. وأما الإيمان بشرائع الأنبياء على
التفصيل، فهو واجب على أممهم، فكيف يتركون ذكر ما هو واجب على أممهم،
ويذكرون ما ليس هو الأوجب؟
الوجه السادس: أن ليلة الإسراء كانت بمكة
قبل الهجرة بمدة. قيل: إنها سنة ونصف. وقيل: إنها خمس سنين. وقيل غير ذلك.
وكان عليٌّ صغيراً ليلة المعراج، لم يحصل له هجرة، ولا جهاد، ولا أمر
يُوجب أن يذكره به الأنبياء. والأنبياء لم يكونوا يذكروا عليّاً في كتبهم
أصلاً، وهذه كتب الأنبياء الموجودة التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم، ليس في شيء منها ذكر عليّ، بل ذكروا أن في
التابوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر مع صورة
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنه بها يقيم الله أمره. وهؤلاء الذين
أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحدٌ منهم أنه ذُكر عليٌّ عندهم، فكيف يجوز
أن يُقال: إن كلاً من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية عليّ ولم يذكروا ذلك
لأممهم ولا نقله أحد منهم؟.
الفصل العشرون
الرد على من أثبت لعلي الإمامة بزعمه أنه أذن واعية دون غيره
قال الرافضي: "البرهان العشرون: قوله تعالى: { وَتَعِيَهَا
أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } [الحاقة: 12].
وفي تفسير الثعلبي، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: سألت الله
عزَّ وجلَّ أن يجعلها أذنك يا عليّ.
ومن
طريق أبي نُعيم(217)، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يا عليّ
إن الله أمرني أن أَدْنِيك وأعلّمك، يا عليّ إن الله أمرني أن أدنيك
وأعلمك لتعِيَ، وأنزلت عَلَيَّ هذه الآية: { وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
} فأنت أذن واعية. وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نُعيم يرويان ما
لا يُحتج به بالإجماع.
الثاني: أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم(218).
الثالث:
أن قوله: { لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ،
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } [الحاقة:
11، 12] لم يرد به أذن واحدٍ من الناس فقط، فإن هذا الخطاب لبني آدم.
وحملهم
في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى: { وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا
حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وَخَلَقْنَا لَهُم
مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ } [يس: 41، 42] وقال: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ
الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ
آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } [لقمان:
31]، فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟.
نعم أذن عليّ من
الآذان الواعية، كأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وحينئذ فلا اختصاص
لعليّ بذلك. وهذا مما يُعلم بالاضطرار: أن الأذن الواعية ليست أذن عليّ
وحدها. أترى أذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليست واعية؟ ولا أذن
الحسن والحسين وعمّار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف
وغيرهم ممن يوافقون على فضيلتهم وإيمانهم؟
وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره، لم يجز أن يُقال: هذه
الأفضلية لم تحصل لغيره.
ولا
ريب أن هذا الرافضي الجاهل الظالم يبني أمره على مقدمات باطلة؛ فإنه لا
يُعلم في طوائف أهل البدع أَوْهَى من حجج الرافضة، بخلاف المعتزلة ونحوهم،
فإن لهم حججاً وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل العلم والعقل. وأما الرافضة
فليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهل أو ظالمٍ صاحب هوى، يقبل ما يوافق
هواه، سواء كان حقّاً أو باطلا.
ولهذا يُقال فيهم: ليس لهم عقل ولا نقل، ولا دين صحيح، ولا دنيا منصورة.
وقالت
طائفة من العلماء: لو علّق حكماً بأجهل الناس لتناول الرافضة، مثل أن
يحلف: إني أبغض أجهل الناس، ونحو ذلك. وأما لو وصّى لأجل الناس، فلا تصح
الوصية، لأنها لا تكون إلا قربة، فإذا وصَّى لقوم يدخل فيهم الكافر جاز،
بخلاف ما لو جعل الكفر والجهل جهة وشرطاً في الاستحقاق.
ثم الرافضي
يدّعي في شيء أنه من فضائل عليّ، وقد لا يكون كذلك، ثم يدّعي أن تلك
الفضيلة ليست لغيره، وقد تكون من الفضائل المشتركة؛ فإن فضائل عليّ
الثابتة عامتها مشتركة بينه وبين غيره، بخلاف فضائل أبي بكر وعمر، فإن
عامتها خصائص لم يُشَاركا فيها. ثم يدّعي أن تلك الفضيلة توجب الإمامة،
ومعلوم أن الفضيلة الجزئية في أمرٍ من الأمور ليست مستلزمة للفضيلة
المطلقة ولا للإمامة، ولا مختصة بالإمام، بل تثبت للإمام ولغيره، وللفاضل
المطلق ولغيره.
فبنى هذا الرافضي أمره على هذه المقدمات الثلاث،
والثلاث باطلة. ثم يُردفها بالمقدمة الرابعة، وتلك فيها نزاع، لكن نحن لا
ننازعه فيها، بل نسلّم أنه من كان أفضل كان أحق بالإمامة، لكن الرافضي لا
حجة معه على ذلك.
الفصل الحادي والعشرون
الرد على من أثبت الإمامة لعلي بجملة من الفضائل المأخوذة من سورة هل أتى
قال
الرافضي: "البرهان الحادي والعشرون: سورة هل أتى في تفسير الثعلبي من طرق
مختلفة قال: مرض الحسن والحسين، فعادهما جدهما رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم وعامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم
ثلاثة أيام، وكذا نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضة، فبرئا، وليس عند آل محمد
قليل ولا كثير، فاستقرض عليّ ثلاثة آصع من شعير، فقامت فاطمة إلى صاع
فطحنته، وخبزت منه خمسة أقراص، لكل واحد منهم قرصاً، وصلّى عليّ مع النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم المغرب، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ
أتاهم مسكين، فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلَّى الله عليه وسلَّم،
مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه
عليّ، فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً
إلا الماء القراح.
فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعاً، وصلى
عليّ مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين
يديه، فأتاهم يتيم، فوقف بالباب، وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلَّى
الله عليه وسلَّم، يتيم يكون كذلك، ثم يدّعي أن تلك الفضيلة ليست لغيره،
وقد تكون من الفضائل المشتركة؛ فإن فضائل عليّ الثابتة عامتها مشتركة بينه
وبين غيره، بخلاف فضائل أبي بكر وعمر، فإن عامتها خصائص لم يُشَاركا فيها.
ثم يدّعي أن تلك الفضيلة توجب الإمامة، ومعلوم أن الفضيلة الجزئية في أمرٍ
من الأمور ليست مستلزمة للفضيلة المطلقة ولا للإمامة، ولا مختصة بالإمام،
بل تثبت للإمام ولغيره، وللفاضل المطلق ولغيره.
فبنى هذا الرافضي أمره
على هذه المقدمات الثلاث، والثلاث باطلة. ثم يُردفها بالمقدمة الرابعة،
وتلك فيها نزاع، لكن نحن لا ننازعه فيها، بل نسلّم أنه من كان أفضل كان
أحق بالإمامة، لكن الرافضي لا حجة معه على ذلك.
الفصل الحادي والعشرون
الرد على من أثبت الإمامة لعلي بجملة من الفضائل المأخوذة من
سورة هل أتى
قال
الرافضي: "البرهان الحادي والعشرون: سورة هل أتى في تفسير الثعلبي من طرق
مختلفة قال: مرض الحسن والحسين، فعادهما جدهما رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم وعامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم
ثلاثة أيام، وكذا نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضة، فبرئا، وليس عند آل محمد
قليل ولا كثير، فاستقرض عليّ ثلاثة آصع من شعير، فقامت فاطمة إلى صاع
فطحنته، وخبزت منه خمسة أقراص، لكل واحد منهم قرصاً، وصلّى عليّ مع النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم المغرب، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، غذ
أتاهم مسكين، فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلَّى الله عليه وسلَّم،
مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه
عليّ، فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً
إلا الماء القراح.
فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعاً، وصلى
عليّ مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين
يديه، فأتاهم يتيم، فوقف بالباب، وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلَّى
الله عليه وسلَّم، يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة،
أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، فسمعه عليّ، فأمر بإعطائه، فأعطوه
الطعام، ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح.
فلما كان
اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث، فطحنته وخبزته، وصلّى عليّ مع
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم أتى المنزل فوُضع الطعام بين يديه، إذ
أتى أسير فقال: أتأسروننا وتشردوننا ولا تطعموننا أطعموني فإني أسير محمد
أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه عليّ فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام،
ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شيئاً إلى الماء القراح.
فلما
كان اليوم الرابع، وقد وفّوا نذورهم، أخذ عليّ الحسن بيده اليمنى، والحسين
بيده اليسرى، وأقبل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهم يرتعشون
كالفراخ من شدة الجوع، فلما بَصَرَهما النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى منزل ابنتي
فاطمة، فانطلقوا إليها، وهي في حجرتها، قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع،
وغارت عيناها، فلما رآها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: واغوثاه،
بالله أهل بيت محمد يموتون جوعاً! فهبط جبريل على محمد صلَّى الله عليه
وسلَّم، فقال: يا محمد، خذ ما هنَّأك الله في أهل بيتك. فقال ما آخذ يا
جبريل؟ فأقرأه: { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ } [الإنسان: 1].
وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد، ولا يلحقه أحد، فيكون أفضل من
غيره، فيكون هو الإمام".
والجواب
من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل، كما تقدم. ومجرد رواية الثعلبيّ
والواحدي وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة. ولو
تنازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل، واحتج أحدهما بحديث لم
يذكر ما يدل على صحته، إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيره، لم يكن
ذلك دليلاً على صحته، ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء.
وهؤلاء من
عادتهم يروون ما رواه غيرهم، وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم ضعيف،
ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمر،
لأن وصفهم النقل لما نُقل، أو حكاية أقوال الناس، وإن كان كثير من هذا
وهذا باطلاً، وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات وضعفها، ولكن لا يطردون
هذا ولا يلتزمونه.
الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق
أهل المعرفة بالحديث، الذي هم أئمة هذا الشان وحكامه. وقول هؤلاء هو
المنقول في هذا الباب، ولهذا لم يرو هذا الحديث في شيء من الكتب التي
يُرجع إليها في النقل(219)، لا في الصحاح، ولا في المساند، ولا في
الجوامع، ولا السنن، ولا رواه المصنفون في الفضائل، وإن كانوا قد يتسامحون
في رواية أحاديث ضعيفة، كالنسائي فإنه صنّف خصائص عليّ، وذكر فيها عدة
أحاديث ضعيفة، ولم يرو هذا وأمثاله(220).
وكذلك أبو نُعيم في
"الخصائص"(221)، وخيثمة بن سليمان(222) والترمذي في "جامعه" روى أحاديث
كثيرة في فضائل عليّ، كثير منها ضعيف، ولم يرو مثل هذا لظهور كذبه.
وأصحاب
السير، كابن إسحاق وغيره، يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة، ولم يذكروا مثل
هذا، ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق أهل النقل، من أئمة أهل
التفسير، الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة، كتفسير ابن جُريج، وسعيد بن
أبي عروبة، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأحمد، وإسحاق، وتفسير بقي بن
مخلد، وابن جرير الطبري، ومحمد بن أسلم الطوسي، وابن أبي حاتم، وأبي بكر
بن المنذر، وغيرهم من العلماء الأكابر، الذين لهم في الإسلام لسان صدق،
وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير.
الوجه
الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن عليّاً إنما تزوج فاطمة
بالمدينة، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، كما ثبت ذلك في الصحيح. والحسن
والحسين وُلدا بعد ذلك، سنة ثلاث أو أربع. والناس متفقون على أن عليّاً لم
يتزوج فاطمة إلا بالمدينة ولم يولد له ولد إلا بالمدينة. وهذا من العلم
العام المتواتر، الذي يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور.
وسورة
"هل أتى" مكّيّة باتفاق أهل التفسير والنقل، لم يقل أحد منهم: إنها مدنية.
وهي على طريقة السور المكّيّة في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء،
كالإيمان بالله واليوم الآخر، وذكر الخلق والبعث. ولهذا قيل: إنه كان
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقرؤها مع: (ألم تنزيل)(223). في فجر يوم
الجمعة، لأن فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه تقوم الساعة.
وهاتان
السورتان متضمنتان لابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل
فريق الجنة وفريق النار. وإذا كانت السورة نزلت بمكة قبل أن يتزوج عليّ
بفاطمة، تبين أن نقل أنها نزلت بعد مرض الحسن والحسين من الكذب البيّن.
الوجه
الرابع: أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهّال الكذابين. فمنه قوله:
"فعادهما جدهما وعامة العرب" فإن عامة العرب لم يكونوا بالمدينة، والعرب
الكفّار ما كانوا يأتونهما يعودونهما.
ومنه قوله: "يا أبا الحسن لو
نذرت على ولديك". وعليّ لا يأخذ الدِّين من أولئك العرب، بل يأخذه من
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. فإن كان هذا أمراً بطاعة فرسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم أحق أن يأمره به من أولئك العرب، وإن لم يكن طاعة لم يكن
عليّ يفعل ما يأمرون به. ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلى النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك؟!.
الوجه الخامس: أن في الصحيحين عن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير،
وإنما يُستخرج به من البخيل(224).
وفي طريق آخر: "إن النذر يرد ابن آدم
إلى القدر فيعطي على النذر ما لا يعطي على غيره"(225). وإذا كان رسول الله
صلَّى الله عليه وسلَّم ينهى عن النذر ويقول: إنه لا يأتي بخير وإنما يرد
ابن آدم إلى القدر.
فإن كان عليّ وفاطمة وسائر أهلهما لم يعلموا مثل هذا، وعلمه عموم الأمة،
فهذا قدح في علمهم، فأين المدِّعي للعصمة؟
وإن
كانوا علموا ذلك، وفعلوا ما لا طاعة فيه لله ولرسوله، ولا فائدة لهما فيه،
بل قد نُهيا عنه: إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيل - كان هذا قدحاً إما في
دينهم وإما في عقلهم وعلمهم.
فهذا الذي يروي مثل هذا في فضائلهم جاهل، يقدح فيهم من حيث يمدحهم،
ويخفضهم من حيث يرفعهم، ويذمهم من حيث يحمدهم.
ولهذا قال بعض أهل البيت للرافضة ما معناه: إن محبتكم لنا صارت معرّة
علينا. وفي المثل السائر "عدوّ عاقل خير من صديق جاهل".
والله
تعالى إنما مدح على الوفاء بالنذر، لا على نفس عقد النذر. والرجل يُنهى عن
الظهار، وإن ظاهر وجبت عليه كفّارة للظهار، وإذا عاود مُدح على فعل
الواجب، وهو التكفير، لا على نفس الظهار المحرّم. وكذلك إذا طلّق امرأته
ففارقها بالمعروف، مُدح على فعل ما أوجبه الطلاق، لا نفس الطلاق المكروه.
وكذلك من باع أو اشترى فأعطى ما عليه، مُدح على فعل ما أوجبه العقد، لا
على نفس العقد الموجب. ونظائر هذا كثيرة.
الوجه السادس: أن عليّاً
وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضة، بل ولا لأحدٍ من أقارب النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم. ولا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها فضة، ولا ذكر
ذلك أحد من أهل العلم الذين ذكروا أحوالهم دقها وجلها. ولكن فضة هذه
بمنزلة ابن عقب الذي يُقال: إنه كان معلّم الحسن والحسين، وأنه أعطى تفاحة
كان فيها علم الحوادث المستقبلة، ونحو ذلك من الأكاذيب التي تروج على
الجهّال. وقد أجمع أهل العلم على أنهما لم يكن لهما معلم، ولم يكن في
الصحابة أحد يُقال له ابن عقب.
وهذه الملاحم المنظومة المنسوبة إلى ابن
عقب، هي من نظم بعض متأخري الجهّال الرافضة، الذين كانوا زمن نور الدين
وصلاح الدين، لما كان كثير من الشام بأيدي النصارى، ومصر بأيدي القرامطة
الملاحدة بقايا بني عبيد، فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهلٍ
عامّيّ.
وهكذا هذه الجارية فضة. وقد ثبت في الصحيحين عن عليّ أن
فاطمة سألت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خادماً، فعلّمها أن تسبّح عند
المنام ثلاثاً وثلاثين، وتكبّر ثلاثاً وثلاثين، وتحمد أربعاً وثلاثين.
وقال: "هذا خير لك من خادم". قال عليّ: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم. قيل له: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين.
وهذا خبر صحيح باتفاق أهل العلم(226)، وهو يقتضي أنه لم يعطها خادماً. فإن
كان بعد ذلك حصل لهما خادم فهو ممكن، لكن لم يكن اسم خادمهما فضة بلا ريب.
الوجه
السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيفه بعشائهم، ونوم
الصبْيَة، وبات هو وامرأته طاويين. فأنزل الله سبحانه تعالى: {
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [الحشر:
9](227).
وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا } [الإنسان: 8]، فإن هذا كقوله: { وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ }
[البقرة: 117].
وفي الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه
سُئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: "أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء،
وتخاف الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان
كذا، وقد كان لفلان"(228).
وقال تعالى: { لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ
حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران: 92]. فالتصدّق مما يحبه
الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة. وأما الإيثار مع الخصاصة فهو أكمل من مجرد
التّصدّق مع المحبة، فإنه ليس كل متصدق محبّاً مؤثراً، ولا كل متصدّق يكون
به خصاصة، بل قد يتصدق بما يجب، مع اكتفائه ببعضه، مع محبة لا تبلغ به
الخصاصة.
فإذا كان الله مدح الأنصار بإيثار الضيف ليلةً بهذا المدح،
والإيثار المذكور في قصة أهل البيت هو أعظم من ذلك، فكان ينبغي أن يكون
المدح عليه أكثر، إن كان هذا مما يُمدح عليه. وإن كان مما لا يُمدح عليه،
فلا يدخل في المناقب.
الثامن: أن في هذه القصة ما لا ينبغي نسبته إلى
عليّ وفاطمة رضي الله عنهما؛ فإنه خلاف المأمور به المشروع، وهو إبقاء
الأطفال ثلاثة أيام جياعاً، ووصالهم ثلاثة أيام. ومثل هذا الجوع قد يفسد
العقل والبدن والدين.
وليس هذا مثل قصة الأنصاري؛ فإن ذلك بيَّتهم ليلة واحدة بلا عشاء، وهذا قد
يحتمله الصبيان، بخلاف ثلاثة أيام بلياليها.
التاسع:
أن في هذه القصة أن اليتيم قال: "استشهد والدي يوم العقبة". وهذا من الكذب
الظاهر، فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال، ولكن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة، وقبل أن يُؤمر بالقتال.
وهذا
يدل على أن الحديث، مع أنه كذب، فهو من كذب أجهل الناس بأحوال النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم. ولو قال: "استشهد والدي يوم أُحد" لكان أقرب.
العاشر:
أن يُقال: إن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يكفي أولاد من قُتل معه،
ولهذا قال لفاطمة لما سألته خادماً: "لا أدع يتامى بدر وأعطيكِ".
فقول القائل: إنه كان من يتامى المجاهدين الشهداء من لا يكفيه النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم، كذب عليه وقدح فيه.
الحادي
عشر: أنه لم يكن في المدينة قط أسير يسأل الناس، بل كان المسلمون يقومون
بالأسير الذي يستأسرونه. فدعوى المدّعي أن أسراهم كانوا محتاجين إلى مسألة
الناس كذب عليهم وقدح فيهم. والأسراء الكثيرون إنما كانوا يوم بدر، قبل أن
يتزوج عليّ بفاطمة رضي الله عنهما وبعد ذلك فالأسرى في غاية القلة.
الثاني
عشر: أنه لو كانت هذه القصة صحيحة، وهي من الفضائل، لم تستلزم أن يكون
صاحبها أفضل الناس، ولا أن يكون هو الإمام دون غيره. فقد كان جعفر أكثر
إطعاماً للمساكين من غيره، حتى قال له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:
"أشبهت خَلقي وخُلقي" وكان أبو هريرة يقول: ما احتذى النعال بعد النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم أحد أفضل من جعفر، يعني في الإحسان إلى المساكين،
إلى غير ذلك من الفضائل. فلم يكن بذلك أفضل من عليّ ولا غيره، فضلاً عن أن
يكون مستحقّاً للإمامة.
الثالث عشر: أنه من المعلوم أن إنفاق الصّدّيق
أمواله أعظم وأحب إلى الله ورسوله؛ فإن إطعام الجائع من جنس الصدقة
المطلقة، التي يمكن كل واحد فعلها إلى يوم القيامة، بل وكل أمة يطعمون
جياعهم من المسلمين وغيرهم، وإن كانوا لا يتقربون إلى الله بذلك، بخلاف
المؤمنين، فإنهم يفعلون ذلك لوجه الله، بهذا تميزوا. كما قال تعالى: {
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا
شُكُورًا } [الإنسان: 9].
وأما إنفاق الصّدّيق ونحوه، فإنه كان في أول
الإسلام، لتخليص من آمن، والكفّار يؤذونه أو يريدون قتله. مثل اشترائه
بماله سبعة كانوا يعذَّبون في الله، منهم بلال، حتى قال عمر: أبو بكر
سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالاً(229).
وإنفاقه على المحتاجين من أهل
الإيمان وفي نصر الإسلام، حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام. وتلك
النفقة ما بقي يمكن مثلها. ولهذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في
الحديث المتفق على صحته: "لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق
أحدكم مثل أُحُد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه" وهذا في النفقة التي
اختصوا بها. وأما جنس إطعام الجائع مطلقاً، فهذا مشترك يمكن فعله إلى يوم
القيامة.
الفصل الثاني والعشرون
الرد على من ادّعى الإمامة لعلي بأنه اختص بفضيلة الصدق دون غيره
قال
الرافضي: "البرهان الثاني والعشرون: قوله تعالى: { وَالَّذِي جَاءَ
بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } [الزمر: 33].
من
طريق أبي نُعيم عن مجاهد في قوله: { وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ }: محمد
صلَّى الله عليه وآله، { وَصَدَّقَ بِهِ }: قال: عليّ بن أبي طالب.
ومن
طريق الفقيه الشافعي(230) عن مجاهد: { وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
وَصَدَّقَ بِهِ } قال: جاء به محمد صلَّى الله عليه وسلَّم وصدَّق به
عليّ. وهذه فضيلة اختص بها، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها:
أن هذا ليس منقولاً عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وقول مجاهد وحده ليس
بحجة يجب اتباعها على كل مسلم، لو كان هذا النقل صحيحاً عنه، فكيف إذا لم
يكن ثابتاً عنه؟! فإنه قد عُرف بكثرة الكذب.
والثابت عن مجاهد(231)
خلاف هذا، وهو أن الصدق هو القرآن والذي صدَّق به هو المؤمن الذي عمل به،
فجعلها عامة. رواه الطبري وغيره عن مجاهد قال(232): هم أهل القرآن يجيئون
به يوم القيامة، فيقولون(233): هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا(234) ما فيه.
ورواه أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد فذكره.
وحدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحّاك: وصدَّق به. قال: المؤمنون جميعاً.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن
عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: وصدَّق به. قال: رسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم(235).
الوجه الثاني: أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند
أهل التفسير، وهو أن الذي جاء بالصدق: محمد، والذي صدَّق به: أبو بكر، فإن
هذا يقول طائفة، وذكره الطبري بإسناده إلى عليّ. قال(236): جاء به محمد
وصدَّق به أبو بكر. وفي هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبد العزيز بن
جعفر غلام أبي بكر الخلاَّل: أن سائلاً سأله عن هذه الآية، فقال له هو -
أو بعض الحاضرين -: نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل في عليّ؟. فقال أبو
بكر بن جعفر: اقرأ ما بعدها: { أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } إلى قوله:
{ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا } [الزمر: 35]
الآية، فبهت السائل.
الثالث: أن يُقال: لفظ الآية عام مطلق لا يختص
بأبي بكر ولا بعليّ، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها. ولا ريب أن أبا
بكر وعمر وعثمان وعليّاً أحق هذه الأمة بالدخول فيها، لكنها لا تختص بهم.
وقد قال تعالى: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ } [الزمر: 32، 33] الآية، فقد ذمّ الله سبحانه وتعالى
الكاذب على الله والمكذّب بالصدق، وهذا ذم عام.
والرافضة أعظم أهل
البدع دخولاً في هذا الوصف المذموم؛ فإنهم أعظم الطوائف افتراءً للكذب على
الله، وأعظمهم تكذيباً بالصدق لَمّا جاءهم، وأبعد الطوائف عن المجيء
بالصدق والتصديق به.
وأهل السنة المحضة أُوْلى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدّقون بالحق في
كل ما جاء به، ليس لهم هوى إلا مع الحق.
والله
تعالى مدح الصادق فيما يجيء به، والمصدِّق بهذا الحق. فهذا مدحٌ للنبي
صلَّى الله عليه وسلَّم، ولكل من آمن به وبما جاء به. وهو سبحانه لم يقل:
والذي جاء بالصدق والذي صدّق به، فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفاً
واحداً، لأن المراد مدح النوع الذي يجيء بالصدق ويصدِّق بالصدق، فهو ممدوح
على اجتماع الوصفين، على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق، ومن شأنه
أن يصدِّق بالصدق.
وقوله: (جاء بالصدق) اسم جنس لكل صدق، وإن كان
القرآن أحق بالدخول في ذلك من غيره، ولذلك صدَّق به أي بجنس الصدق. وقد
يكون الصدق الذي صدَّق به ليس هو عين الصدق الذي جاء به، كما تقول: فلان
يسمع الحق، ويقول الحق ويقبله، ويأمر بالعدل ويعمل به. أي هو موصوف بقول
الحق لغيره، وقبول الحق من غيره، وأنه يجمع بين الأمر بالعدل والعمل به.
وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به، ليس هو عين العدل الذي يعمل به.
فلما
ذم الله سبحانه من اتصف بأحد الوصفين: الكذب على الله، والتكذيب بالحق، إذ
كل منهما يستحق به الذم، مدح صدهما الخالي عنهما، بأن يكون يجيء بالصدق لا
بالكذب، وأن يكون مع ذلك مصدِّقاً بالحق، لا يكون ممن يقوله هو، وإذا قاله
غيره لم يصدِّقه، فإن من الناس من يصدق ولا يكذب، لكن يكره أن غيره يقوم
مقامه في ذلك حسداً ومنافسة، فيكذِّب غيره في صدقه أو لا يصدِّقه، بل يعرض
عنه، وفيهم من يصدِّق طائفة فيما قالت، قبل أن يعلم ما قالوه: أصدق هو أم
كذب؟ والطائفة الأخرى لا يصدِّقها فيما تقول وإن كان صادقاً، بل إما أن
يصدقها وإما أن يعرض عنها.
وهذا موجود في عامة أهل الأهواء: تجد كثيراً
منهم صادقاً فيما ينقله، لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه، فلا يدخل هذا
في المدح، بل في الذم، لأنه لم يصدِّق بالحق الذي جاءه.
والله قد ذم
الكاذب والمكذِّب بالحق، لقوله في غير آية: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ }
[العنبكوت: 68] وقال: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ } [الأنعام: 21].
ولهذا لما كان مما
وصف الله به الأنبياء، الذين هم أحق الناس بهذه الصفة، أن كلاًّ منهم يجيء
بالصدق فلا يكذب، فكل منهم صادق في نفسه مصدِّق لغيره.
ولما كان قوله:
(والذي) صنفا من الأصناف، لا يُقصد به واحد بعينه، أعاد الضمير بصيغة
الجمع فقال: { وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ } [الزمر: 33].
وأنت تجد كثيراً من المنتسبين إلى
علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه، بل لا يقولون إلا الصدق، لكن لا يقبلون
ما يخبر به غيرهم من الصدق، بل يحملهم الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن
كان صادقاً: إما تكذيب نظيره، وإما تكذيب من ليس من طائفته.
ونفس تكذيب
الصادق هو من الكذب، ولهذا قرنه بالكاذب على الله، فقال: { فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ
} [الزمر: 32] فكلاهما كاذب: هذا كاذب فيما يخبر به عن الله، وهذا كاذب
فيما يخبر به عن المخبر عن الله.
والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب
على الله، واليهود يكثر فيهم المكذِّبون بالحق. وهو سبحانه ذكر المكذِّب
بالصدق نوعاً ثانياً، لأنه أولاً لم يذكر جميع أنواع الكذب، بل ذكر من كذب
على الله. وأن إذا تدبرت هذا، وعلمت أن كل واحد من الكذب على الله
والتكذيب بالصدق مذموم، وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتياً بالصدق
مصدِّقاً للصدق، علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم.
وإذا
تأملت هذا، تبين لك أن كثيراً من الشر - أو أكثره - يقع من أحد هذين، فتجد
إحدى الطائفتين، أو الرجلين من الناس، لا يكذب فيما يخبر من العلم، لكن لا
يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى، فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب
بالصدق.
وهذا إن كان يوجد في عامة الطوائف شيء منه فليس في الطوائف
أدخل في ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذباً على الله، وعلى رسوله،
وعلى الصحابة وعلى ذوي القربى. وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدق،
فيكذّبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول الصريح.
فهذه
الآية - ولله الحمد - ما فيها من مدحٍ فهو يشتمل على الصحابة الذين افترت
عليهم الرافضة وظلمتهم، فإنهم جاءوا بالصدق وصدَّقوا به، وهم من أعظم أهل
الأرض دخولاً في ذلك، وعليّ منهم، وما فيها من ذمٍّ فالرافضة أدخل الناس
فيه، فهي حجة عليهم من الطرفين، وليس فيها حجة على اختصاص عليّ دون
الخلفاء الثلاثة بشيء، فهي حجة عليهم من كل وجه، ولا حجة لهم فيها بحال.
الفصل الثالث والعشرون
الرد على من يثبت الإمامة لعلي بقوله إنه خصّ بفضيلة تأييده للرسول صلَّى
الله عليه وسلَّم دون غيره من الصحابة
قال الرافضي: "البرهان الثالث والعشرون: قوله تعالى: { هُوَ الَّذِيَ
أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ } [الأنفال: 62].
من
طريق أبي نُعيم عن أبي هريرة قال: مكتبو على العرش لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، محمد عبدي ورسولي أيدته بعليّ بن أبي طالب، وذلك قوله في
كتابه: { هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ }، يعني
بعليّ(237). وهذه من أعظم الفضائل التي لم تحصل لغيره من الصحابة، فيكون
هو الإمام.
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل. وأما مجرد
العزو إلى رواية أبي نُعيم فليس حجة بالاتفاق. وأبو نُعيم له كتاب مشهور
في "فضائل الصحابة"(238)، وقد ذكر قطعة من الفضائل في أول "الحلية"، فإن
كانوا يحتجّون بما رواه، فقد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ما ينقض
بنيانهم ويهدم أركانهم، وإن كانوا لا يحتجون بما رواه فلا يعتمدون على
نقله، ونحن نرجع فيما رواه - هو وغيره - إلى أهل العلم بهذا الفن، والطرق
التي بها يُعلم صدق الحديث وكذبه، من النظر في إسناده ورجاله، وهل هم ثقات
سمع بعضهم من بعض أم لا؟ وننظر إلى شواهد الحديث وما يدل عليه على أحد
الأمرين، لا فرق عندنا بين ما يُروى في فضائل عليّ أو فضائل غيره، فما ثبت
أنه صدق صدَّقناه، وما كان كذباً كذَّبناه.
فنحن نجيء بالصدق ونصدِّق
به، لا نكذب، ولا نكذِّب صادقاً. وهذا معروف عند أئمة السنة. وأما من
افترى على الله كذباً أو كذّب بالحق، فعلينا أن نكذبه في كذبه وتكذيبه
للحق، كأتباع مسيلمة الكذّاب، والمكذبين بالحق الذي جاء به الرسول واتّبعه
عليه المؤمنون به؛ صدِّيقه الأكبر وسائر المؤمنين.
ولهذا نقول في الوجه
الثاني: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا الحديث -
وأمثاله - مما جزمنا أنه كذب موضوع نشهد أنه كذب موضوع، فنحن - والله الذي
لا إله إلا هو - نعلم علماً ضرورياً في قلوبنا، لا سبيل لنا إلى دفعه، أن
هذا الحديث كذب ما حدَّث به أبو هريرة، وهكذا نظائره مما نقول فيه مثل ذلك.
وكل
من كان عارفاً بعلم الحديث وبدين الإسلام يعرف، وكل من لم يكن له بذلك علم
لا يدخل معنا، كما أن أهل الخبرة بالصرف يحلفون على ما يعلمون أنه مغشوش،
وإن كان من لا خبرة له لا يميّز بين المغشوش والصحيح.
الثالث: أن
الله تعالى قال: { هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي
الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ } [الأنفال: 62، 63] وهذا نص في أن المؤمنين عدد مؤلف
بين قلوبهم، وعليّ واحد منهم ليس له قلوب يؤلف بينها. والمؤمنون صيغة جمع،
فهذا نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحداً معيّناً، وكيف يجوز أن يُقال:
المراد بهذا عليٌّ وحده؟.
الوجه الرابع: أن يُقال: من المعلوم بالضرورة
والتواتر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما كان قيام دينه بمجرد موافقة
عليّ، فإن عليّاً كان من أول من أسلم، فكان الإسلام ضعيفاً، فلولا أن الله
هدى من هداه إلى الإيمان والهجرة والنصرة، لم يحصل بعليّ وحده شيء من
التأييد، ولم يكن إيمان الناس ولا هجرتهم ولا نصرتهم على يد عليّ، ولم يكن
عليّ منتصباً لا بمكة ولا بالمدينة للدعوة إلى الإيمان، كما كان أبو بكر
منتصباً لذلك، ولم يُنقل أنه أسلم على يد عليّ أحدٌ من السابقين
الأوَّلين، لا من المهاجرين ولا الأنصار، بل لا نعرف أنه أسلم على يد
عليٍّ أحدٌ من الصحابة، لكن لَمّا بعثه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى
اليمن قد يكون أسلم على يديه من أسلم، إن كان وقع ذلك، وليس أولئك من
الصحابة، وإنما أسلم أكابر الصحابة على يد أبي بكر، ولا كان يدعو المشركين
ويناظرهم، كما كان أبو بكر يدعوهم ويناظرهم، ولا كان المشركون يخافونه،
كما يخافون أبا بكر وعمر.
بل قد ثبت في الصحاح والمساند والمغازي،
واتفق عليه الناس، أنه لما كان يوم أحد وانهزم المسلمون، صعد أبو سفيان
على الجبل وقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم: "لا تجيبوه". فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن
أبي قحافة؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تجيبوه" فقال: أفي
القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تجيبوه". فقال
لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال:
كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء، وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم
بيوم بدر. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم أخذ
أبو سفيان يرتجز ويقول: أعل هبل ... أعل هبل
فقال النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم: "ألا تجيبوه"؟ فقالوا: وما نقول؟ قال: "قولوا: الله أعلى
وأجل". فقال: إن لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم. فقال النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم: "ألا تجيبوه" فقالوا: وما نقول؟ قال: "قولوا: الله مولانا ولا
مولى لكم". فقال: ستجدون في القوم مُثْلَةً لم آمر بها ولم تسؤني"(239).
فهذا
جش المشركين إذ ذاك لا يسأل إلا على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي
بكر وعمر، فلو كان القوم خائفين من عليّ أو عثمان أو طلحة أو الزبير أو
نحوهم، أو كان للرسول تأييد بهؤلاء، كتأييده بأبي بكر وعمر، لكان يُسأل
عنهم كما يُسأل عن هؤلاء، فإن المقتضى للسؤال قائم، والمانع منتفٍ، ومع
وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب معه وجود الفعل.
الوجه
الخامس: أنه لم يكن لعليّ في الإسلام أثر حسن، إلا ولغيره من الصحابة
مثله، ولبعضهم آثار أعظم من آثاره. وهذا معلوم لمن عرف السيرة الصحيحة
الثابتة بالنقل. وأما من يأخذ بنقل الكذَّابين وأحاديث الطرقيّة، فباب
الكذب مفتوح، وهذا الكذب يتعلق بالكذب على الله، { وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُ } [العنكبوت: 68].
ومجموع المغازي التي كان فيها القتال مع
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تسع مغازٍ، والمغازي كلها بضع وعشرون غزاة،
وأما السرايا فقد قيل: إنها تبلغ سبعين(240).
ومجموع من قُتل من
الكفّار في غزوات النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يبلغون ألفاً أو أكثر أو
أقل، ولم يقتل عليٌّ منهم عُشرهم ولا نصف عُشرهم، وأكثر السرايا لم يكن
يخرج فيها. وأما بعد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يشهد شيئاً من
الفتوحات: لا هو، ولا طلحة، ولا الزبير، إلا أن يخرجوا مع عمر حين خرج إلى
الشام. وأما الزبير فقد شهد فتح مصر، وسعد شهد فتح القادسية، وأبو عبيدة
فتح الشام.
فكيف يكون تأييد الرسول بواحدٍ من أصحابه دون سائرهم والحال
هذه؟ وأين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين
والأنصار الذين بايعوه تحت الشجرة والتابعين لهم بإحسان؟
وقد كان
المسلمون يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر، ويوم أحد نحو سبعمائة، ويوم الخندق
أكثر من ألف أو قريباً من ذلك، ويوم بيعة الرضوان ألفاً وأربعمائة، وهم
الذين شهدوا فتح خيبر، ويوم فتح مكة كانوا عشرة آلاف، ويوم حنين كانوا
اثنى عشر ألفاً، تلك العشرة، والطلقاء ألفان.
وأما تبوك فلا يُحصى
من شهدها، بل كانوا أكثر من ثلاثين ألفاً. وأما حجة الوداع فلا يُحصى من
شهدها معه، وكان قد أسلم على عهده أضعاف من رآه وكان من أصحابه، وأيده
الله بهم في حياته باليمن وغيرها. وكل هؤلاء من المؤمنين الذين أيّده الله
بهم، بل كل من آمن وجاهد إلى يوم القيامة دخل في هذا المعنى.
الفصل الرابع والعشرون
الرد على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بفضيلة متابعة الرسول
صلَّى الله عليه وسلَّم دون غيره
قال
الرافضي: "البرهان الرابع والعشرون: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }
[الأنفال: 64].
من طريق أبي نعيم قال: نزلت في عليّ. وهذه فضيلة لم تحصل لأحدٍ من الصحابة
غيره، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: منع الصحة.
الثاني: أن هذا القول ليس بحجة.
الثالث: أن يُقال: هذا الكلام من أعظم الفرية على الله ورسوله.
وذلك
أن قوله: { حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }
[الأنفال: 64] معناه: أن الله حسبك وحسب من اتّبعك من المؤمنين، فهو وحده
كافيك وكافي من معك من المؤمنين. وهذا كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهم.
ومنه قول الشاعر:
فحسبك والضحاك سيف مهند
وذلك
أن "حسب" مصدر، فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة الجارّ، فإن
العطف بدون ذلك، وإن كان جائزاً في أصح القولين فهو قليل، وإعادة الجارّ
أحسن وأفصح، فعطف على المعنى، والمضاف إليه في معنى المنصوب، فإن قوله:
"فحسبك والضحّاك" معناه: يكفيك والضّحّاك.
والمصدر يعمل عمل الفعل، لكن
إذا أضيف عَمِل في غير المضاف إليه، ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نَصَب
المفعول، وإن أضيف إلى المفعول رَفَع الفاعل، فتقول: أعجبني دقّ القصّار
الثوب، وهذا وجه الكلام. وتقول: أعجبني دقّ الثوب القصّار.
ومن
النحاة من يقول: إعماله منكراً أحسن من أعماله مضافاً، لأنه بالإضافة
قَوِيَ شبهُه بالأسماء. والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله في الآخر
أحسن من تنكيره وإعماله فيهما. فقول القائل: أعجبني دقّ القصّار الثوب،
أحسن من قوله: دقّ الثوب القصّار، فإن التنكير أيضاً من خصائص الأسماء،
والإضافة أخف، لأنه اسم، والأصل فيه أن يُضاف ولا يعمل، لكن لما تعذّرت
إضافته إلى الفاعل والمفعول جميعاً، أضيف إلى أحدهما، وأعمل في الآخر.
وهكذا
في المعطوفات: إن أمكن إضافتها إليها كلها، كالمضاف إلى الظاهر، فهو أحسن.
كقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة
والدم والخنزير والأصنام"(241).
وكقولهم: نُهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
وإن تعذر لم يحسن ذلك، كقولك: حسبك وزيداً درهم، عطفا على المعنى.
ومما
يشبه هذا قوله: { وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
حُسْبَانًا } [الأنعام: 96]، نصب هذا على محل الليل المجرور، فإن اسم
الفاعل كالمصدر، ويُضاف تارة ويعمل تارة أخرى(242).
وقد ظن بعض
الغالطين أن معنى الآية: أن الله والمؤمنين حسبك، ويكون { مَنِ اتَّبَعَكَ
} رفعاً عطفاً على الله، وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر؛ فإن الله وحده حسب
جميع الخلق.
كما قال تعالى: { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً
وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [آل عمران: 173]، أي:
الله وحده كافينا كلنا.
وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: "قالها
إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل(243).
فكل من النبيين قال: حسبي الله، فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه، فدلّ
على أن الله وحده حسبه ليس معه غيره.
ومنه
قوله تعالى: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ } [الزمر: 36] وقوله
تعالى: { وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ } [التوبة: 59] الآية فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم اللهم
ورسوله، وإلى أن يقولوا: حسبنا الله، ولا يقولوا: حسبنا الله ورسوله. لأن
الإيتاء يكون بإذن الرسول، كما قال: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } [الحشر: 7].
وأما الرغبة فإلى الله، كما قال تعالى: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ،
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ } [الشرح: 7، 8].
وكذلك
التحسّب الذي هو التوكل على الله وحده، فلهذا أمروا أن يقولوا: حسبنا
الله، ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن،
كيف يكون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟!.
وأيضاً فالمؤمنون محتاجون
إلى الله، كحاجة الرسول إلى الله، فلابد لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون
معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم؛ فإن هذا يستلزم الدَّوْر، بل
قوتهم من الله، وقوة الرسول من الله، فالله وحده يخلق قوتهم، والله وحده
يخلق قوة الرسول.
فهذا كقوله: { هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ } [الأنفال: 62، 63]
فإنه وحده هو المؤيِّد للرسول بشيئين: أحدهما: نصره الذي ينصره به،
والثاني: بالمؤمنين الذين أتى بهم.
وهناك قال: حسبك الله، ولم يقل: نصر
الله. فنصر الله منه، كما أن المؤمنين من مخلوقاته أيضاً، فعطف ما منه على
ما منه، إذ كلاهما منه. وأما هو سبحانه فلا يكون معه غيره في إحداث شيء من
الأشياء، بل هو وحده الخالق لكل ما سواه، ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى
غيره.
وإذا تبين هذا، فهؤلاء الرافضة رتّبوا جهلاً على جهل، فصاروا
في ظلمات بعضها فوق بعض، فظنوا أن قوله: { حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } معناه: أن الله ومن اتبعك من المؤمنين
حسبك، ثم جعلوا المؤمنين الذين اتّبعوه هم عليّ بن أبي طالب.
وجهلهم في
هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه على بعض الناس، وأما هذا
فلا يخفى على عاقل، فإن عليّاً لم يكن وحده من الخلق كافياً لرسول الله
صلَّى الله عليه وسلَّم، ولو لم يكن معه إلا عليّ لما أقام دينه. وهذا
عليٌّ لم يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض، بل لَمّا حاربه معاوية مع أهل
الشام، كان معاوية مقاوماً له أو مستظهراً، سواء كان ذلك بقوة قتالٍ، أو
قوة مكرٍ واحتيال، فالحرب خدعة:
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهي المحل الثاني
فإذا هم اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان(244)
فإذا
لم يغن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتّباع أكثر أهل الأرض له، فكيف يغني عن
الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، وأهل الأرض كلهم أعداؤه؟!.
وإذا قيل: إن عليّاً إنما لم يغلب معاوية ومن معه لأن جيشه لا يطيعونه، بل
كانوا مختلفين عليه.
قيل: فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوه، فكيف يطيعه الكفّار الذين
يكفرون بنبيه وبه؟!.
وهؤلاء
الرافضة يجمعون بين النقيضين، لفرط جهلهم وظلمهم: يجعلون عليّاً أكمل
الناس قدرة وشجاعة، حتى يجعلوه هو الذي أقام دين الرسول، وأن الرسول كان
محتاجاً إليه. ويقولون مثل هذا الكفر، إذ يجعلونه شريكاً لله في إقامة دين
محمد، ثم يصفونه بغاية العجز والضعف والجزع والتقية بعد ظهر الإسلام وقوته
ودخول الناس فيه أفواجاً.
ومن المعلوم قطعاً أن الناس بعد دخولهم في
دين الإسلام أتبع للحق منهم قبل دخولهم فيه، فمن كان مشاركاً لله في إقامة
دين محمد، حتى قهر الكفّار وأسلم الناس، كيف لا يفعل هذا في قهر طائفة
بغوا عليه، هم أقل من الكفّار الموجودين عند بعثة الرسول، وأقل منهم شوكة،
وأقرب إلى الحق منهم؟!.
فإن الكفّار حين بَعَث الله محمداً كانوا أكثر
ممن نازع عليّاً وأبعد عن الحق، فإن أهل الحجاز والشام واليمن ومصر
والعراق وخراسان والمغرب كلهم كانوا كفّاراً، ما بين مشرك وكتابيّ ومجوسيّ
وصابئ، ولما مات النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كانت جزيرة العرب قد ظهر
فيها الإسلام، ولما قُتل عثمان كان الإسلام قد ظهر في الشام ومصر والعراق
وخراسان والمغرب.
فكان أعداء الحق عند موت النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم أقل منهم وأضعف، وأقل عداوة منهم له عند مبعثه، وكذلك كانوا عند
مقتل عثمان أقل منهم وأضعف، وأقل عداوة منهم له حين بُعث محمد صلَّى الله
عليه وسلَّم؛ فإن جميع الحق الذي كان يقاتل عليه عليّ، هو جزء من الحق
الذي قاتل عليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فمن كذَّب بالحق الذي بُعث
به محمد صلَّى الله عليه وسلَّم وقاتله عليه، كذَّب بما قاتل عليه عليّ من
ذلك.
فإذا كان عليٌّ في هذه الحال قد ضعف وعجز عن نصر الحق ودفع
الباطل، فكيف يكون حاله حين المبعث، وهو أضعف وأعجز وأعداء الحق أعظم
وأكثر وأشد عداوة؟!.
ومثل الرافضة في ذلك مثل النصارى: ادّعوا في
المسيح الإلهية، وأنه رب كل شيء ومليكه، وعلى كل شيء قدير. ثم يجعلون
أعداءه صفعوه ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه، وأنه جعل يستغيث فلا يغيثوه،
فلا أفلحوا بدعوى تلك القدرة القاهرة ولا بإثبات هذه الذلة التامة.
وإن قالوا: كان هذا برضاه.
قيل:
فالرب إنما يرضى بأن يُطاع لا بأن يعصى. فإن كان قتله وصلبه برضاه، كان
ذلك عبادة وطاعة لله، فيكون اليهود الذين صلبوه عابدين لله مطيعين في ذلك،
فيُمدحون على ذلك لا يُذمّون وهذا من أعظم الجهل والكفر.
وهكذا يوجد من
فيه شبه من النصارى والرافضة من الغلاة في أنفسهم وشيوخهم، تجدهم في غابة
الدعوى وفي غاية العجز. كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح:
"ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب
أليم: شيخ زانٍ، وملك كذّاب، وفقير مختال" وفي لفظ: "عائل مزهو" وفي لفظ:
"وعائل مستكبر"(245) وهذا معنى قول بعض العامة: الفقر والزنطرة.
فهكذا
شيوخ الدعاوي والشطح: يدَّعى أحدهم الإلهية وما هو أعظم من النبوة، ويعزل
الرب عن ربوبيته، والنبي عن سالته، ثم آخرته شحّاذ يطلب ما يقيته، أو خائف
يستعين بظالمٍ على دفع مظلمته، فيفتقر إلى لقمة، ويخاف من كلمة، فأين هذا
الفقر والذل من دعوى الربوبية المتضمنة للغنى والعز؟!(246).
وهذه حال
المشركين الذين قال الله فيهم: { وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } [الحج: 31].
وقال: { مَثَلُ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ
اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } [العنكبوت: 41].
وقال: { سَنُلْقِي فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا
لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا } [آل عمران: 151].
والنصارى فيهم
شرك بيِّن، كما قال تعالى: { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [التوبة: 31] وهكذا من أشبههم من
الغالية من الشيعة والنّسّاك فيه شرك وغلو، كما في النصارى شرك وغلو،
واليهود فيهم كبر، والمستكبر معاقب بالذل.
قال تعالى: { ضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ
اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ } [آل عمران: 112].
وقال
تعالى: { أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ
اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ }
[البقرة: 87] فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء كان استكباراً.
فالرافضة فيهم
شبه من اليهود من وجه، وشبه من النصارى من وجه. ففيهم شرك وغلوّ وتصديق
بالباطل كالنصارى، وفيهم جبن وكِبر وحسد وتكذيب بالحق كاليهود.
وهكذا غير الرافضة من أهل الأهواء والبدع، تجدهم في نوع من الضلال ونوع من
الغي، فيهم شرك وكبر.
لكن
الرافضة أبلغ من غيرهم في ذلك، ولهذا تجدهم أعظم الطوائف تعطيلاً لبيوت
الله ومساجده من الجمع والجماعات، التي هي أحب الاجتماعات إلى الله. وهم
أيضاً لا يجاهدون الكفّار أعداء الدِّين، بل كثيراً ما يوالونهم ويستعينون
بهم على عداوة المسلمين، فهم يعادون أولياء الله المؤمنين، ويوالون أعداءه
المشركين وأهل الكتاب، كما يعادون أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان، ويوالون أكفر الخلق من الإسماعيلية والنصيرية
ونحوهم من الملاحدة، وإن كانوا يقولون: هم كفار، فقلوبهم وأبدانهم إليهم
أميل منها إلى المهاجرين والأنصار والتابعين وجماهير المسلمين.
وما من
أحد من أهل الأهواء والبدع، حتى المنتسبين إلى العلم والكلام والفقه
والحديث والتصوف إلا وفيه شعبة من ذلك، كما يوجد أيضاً شعبة من ذلك في أهل
الأهواء، من أتباع الملوك والوزراء والكتّاب والتّجّار، لكن الرافضة أبلغ
في الضلال والغيّ من جميع الطوائف أهل البدع.
الفصل الخامس والعشرون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه أفضل الصحابة لاختصاصه بفضيلة
حب الله
قال
الرافضي: "البرهان الخامس والعشرون: قوله تعالى: { فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } [المائدة: 54].
قال الثعلبي: إنما نزلت في عليّ، وهذا يدل على أنه أفضل، فيكون هو الإمام".
والجواب
من وجوه: أحدها: أن هذا كذب على الثعلبي، فإنه قال في تفسيره في هذه
الآية: "قال عليّ وقتادة والحسن: إنهم أبو بكر وأصحابه. وقال مجاهد: هم
أهل اليمن". وذكر حديث عياض بن غنم: أنهم أهل اليمن، وذكر الحديث: "أتاكم
أهل اليمن": فقد نقل الثعلبي أن عليّاً فسَّر هذه الآية بأنهم أبو بكر
وأصحابه.
وأما أئمة التفسير، فروى الطبري(247) عن المثنى، حدثنا عبد
الله بن هاشم(248)، حدثنا سيف بن عمر، عن أبي روق، عن الضّحَّاك، عن أبي
أيوب، عن عليّ في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ
مِنكُمْ عَن دِينِهِ } [المائدة: 54] قال: عَلِمَ الله المؤمنين، ووقع
معنى السوء على الحشو الذي فيهم من المنافقين ومن في علمه أن يرتدوا،
فقال: { مَن يَرْتَدَّ(249) مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
}: المرتدَّة في دورهم، { بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } بأبي بكر
وأصحابه رضي الله عنهم".
وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة والحسن
والضّحّاك وابن جريج(250)، وذكر عن قوم أنهم الأنصار(251)، وعن آخرين أنهم
أهل اليمن(252)، ورجح هذا الآخر أنهم رهط أبي موسى(253)، قال(254): "ولولا
صحة الخبر بذلك عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما كان القول عندي في ذلك
إلا قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه"(255) قال: "ولما ارتد المرتدون جاء
الله بهؤلاء على عهد عمر رضي الله عنه(256).
الثاني: أن هذا قول بلا حجة، فلا يجب قبوله.
الثالث:
أن هذا معارَض بما هو أشهر منه وأظهر، وهو أنها نزلت في أبي بكر وأصحابه،
الذين قاتلوا معه أهل الردة. وهذا هو المعروف عند الناس كما تقدم. لكن
هؤلاء الكذّابون أرادوا أن يجعلوا الفضائل التي جاءت في أبي بكر يجعلونها
لعليّ، وهذا من المكر السيئ الذي لا يحيق إلا بأهله.
وحدّثني الثقة
من أصحابنا أنه اجتمع بشيخ أعرفه، وكان فيه دين وزهد أحوال معروفة، لكن
كان فيه تشيع. قال: وكان عنده كتاب يعظّمه، ويدّعي أنه من الأسرار، وأنه
أخذه من خزائن الخلفاء، وبالغ في وصفه. فلما أحضره، فإذا به كتاب قد كُتب
بخط حسن، وقد عمدوا إلى الأحاديث التي في البخاري ومسلم جميعها في فضائل
أبي بكر وعمر ونحوهما جعلوها لعليّ. ولعل هذا الكتاب كان من خزائن بني
عبيد المصريين، فإن خواصهم كانوا ملاحدة زنادقة غرضهم قلب الإسلام، وكانوا
قد وضعوا من الأحاديث المفتراة التي يناقضون بها الدين ما لا يعلمه إلا
الله.
ومثل هؤلاء الجهّال يظنون أن الأحاديث التي في البخاري ومسلم
إنما أخذت عن البخاري ومسلم، كما يظن مثل ابن الطيب ونحوه ممن لا يعرف
حقيقة الحال، وأن البخاري ومسلماً كان الغلط يروج عليهما، أو كانا يتعمدان
الكذب، ولا يعلمون أن قولنا: رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته،
لا أنه كان صحيحاً بمجرد رواية البخاري ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم
رواها غيرهما من العلماء والمحدِّثين من لا يحصي عدده إلا الله، ولم ينفرد
واحد منهما بحديث: بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد
زمانه طوائف، ولو لم يُخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء، وكانت تلك
الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود.
وإنما
قولنا: رواه البخاري ومسلم كقولنا: قرأه القرّاء السبعة. والقرآن منقول
بالتواتر، لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه، وكذلك التصحيح لم يقلِّد
أئمة الحديث فيه البخاري ومسلماً، بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة
الحديث صحيحاً متلقى بالقبول، وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر أئمة
هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما على تصحيح ما صححاه، إلا مواضع يسيرة،
نحو عشرين حديثاً، غالبها في مسلم، انتقدها عليهما طائفة من الحفّاظ، وهذه
المواضع المنتقدة غالبها في مسلم وقد انتصر طائفة لهما فيها، وطائفة قررت
قول المنتقدة.
والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب، مثل
حديث أم حبيبة، وحديث خلق الله البريّة يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف
بثلاث ركوعات وأكثر.
وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري، فإنه أبعد
الكتابَيْن عن الانتقاد، ولا يكاد يروى لفظاً فيه انتقاد، إلا ويروي اللفظ
الآخر الذي يبيّن أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد، إلا وفي كتابه ما
يبيّن أنه منتقد.
وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم، فلم يرج عليه فيها
إلا دراهم يسيرة، ومع هذا فهي مغيَّرة ليست مغشوشة محضة، فهذا إمام في
صنعته. والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر.
والمقصود أن أحاديثهما انتقدها
الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم، ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله، فلم
ينفردا لا برواية ولا بتصحيح، والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ هذا
الدين، كما قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9].
وهذا مثل غالب المسائل التي توجد في
الكتب المصنّفة في مذاهب الأئمة، مثل القدوري والتنبيه والخرقي والجلاب،
غالب ما فيها إذا قيل: ذكره فلان، عُلم أنه مذهب ذلك الإمام، وقد نقل ذلك
سائر أصحابه، وهم خلق كثير ينقلون مذهبه بالتواتر.
وهذه الكتب فيها
مسائل انفرد بها بعض أهل المذهب، وفيها نزاع بينهم، لكن غالبها هو قول أهل
المذهب. وأما البخاري ومسلم فجمهور ما فيهما اتفق عليه أهل العلم بالحديث،
الذين هم أشد عناية بألفاظ الرسول وضبطاً لها ومعرفة بها من أتباع الأئمة
لألفاظ أئمتهم، وعلماء الحديث أعلم بمقاصد الرسول في ألفاظه من أتباع
الأئمة بمقاصد أئمتهم، والنزاع بينهم في ذلك أقل من تنازع الأئمة في مذاهب
أئمتهم.
والرافضة - لجهلهم - يظنون أنهم إذا قلبوا ما في نسخةٍ من ذلك،
وجعلوا فضائل الصديق لعليّ، أن ذلك يخفى على أهل العلم، الذين حفظ الله
بهم الذكر.
الرابع: أن يقال: إن الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل
الرّدّة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قاتل مسيلمة الكذاب المدّعي
للنبوة وأتباعه بني حنيفة وأهل اليمامة. وقد قيل: كانوا نحو مائة ألف أو
أكثر، وقاتل طليحة الأسدي، وكان قد ادّعي النبوة بنجد، واتّبعه من أسد
وتميم وغطفان ما شاء الله، وادّعت النبوة سجاح، امرأة تزوجها مسيلمة
الكذّاب، فتزوج الكذّاب بالكذّابة.
وأيضاً فكان من العرب من ارتدّ عن
الإسلام، ولم يتبع متنبئاً كذاباً. ومنهم قوم أقرّوا بالشهادتين، لكن
امتنعوا من أحكامهما كمانعي الزكاة. وقصص هؤلاء مشهورة متواترة يعرفها كل
من له بهذا الباب أدنى معرفة.
والمقاتلون للمرتدّين هم من الذين يحبهم
الله ويحبونه، وهم أحق الناس بالدخول في هذه الآية، وكذلك الذين قاتلوا
سائر الكفّار الروم والفرس. وهؤلاء أبو بكر وعمر ومن اتبعهما من أهل اليمن
وغيرهم. ولهذا رُوي أن هذه الآية لَمّا نزلت سُئل النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم عن هؤلاء، فأشار إلى أبي موسى الأشعري، وقال: "هم قوم هذا"(257).
فهذا
أمر يعرف بالتواتر والضرورة: أن الذين أقاموا الإسلام وثبتوا عليه حين
الردة، وقاتلوا المرتدين والكفّار، هم داخلون في قوله: { فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ } [المائدة: 54].
وأما عليّ
رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله لكن ليس بأحق بهذه
الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان، ولا كان جهاده للكفّار والمرتدّين أعظم من
جهاد هؤلاء، ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل بهؤلاء، بل كل منهم
له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة في الإسلام، والله يجزيهم عن الإسلام
وأهله خير جزاء، فهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون الذين قضوا
بالحق، وبه كانوا يعدلون.
وأما أن يأتي إلى أئمة الجماعة الذين كان
نفعهم في الدين والدنيا أعظم، فيجعلهم كفّاراً أو فسّاقاً ظلمة، ويأتي إلى
من لم يجر على يديه من الخير مثل ما جرى على يد واحدٍ منهم، فيجعله الله
أو شريكاً لله أو شريك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، أو الإمام
المعصوم الذي لا يؤمن إلا من جعله معصوماً منصوصاً عليه، ومن خرج عن هذا
فهو كافر، ويجعل الكفّار المرتدّين الذي قاتلهم أولئك كانوا مسلمين، ويجعل
المسلمين الذين يصلّون الصلوات الخمس، ويصومون شهر رمضان، ويحجّون البيت،
ويؤمنون بالقرآن يجعلهم كفّاراً لأجل قتال هؤلاء.
فهذا عمل أهل الجهل والكذب والظلم والإلحاد في دين الإسلام، عمل من لا عقل
له ولا دين ولا إيمان.
والعلماء
دائماً يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان زنديقاً ملحداً مقصوده إفساد دين
الإسلام ولهذا صار الرفض مأوى الزنادقة الملحدين من الغالية والمعطّلة،
كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم.
وأول الفكرة آخر العمل، فالذي ابتدع
الرفض كان مقصوده إفساد دين الإسلام، ونقض عراه، وقلعه بعروشه آخراً، لكن
صار يظهر منه ما يمكّنه من ذلك، ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره
الكافرون.
وهذا معروف عن ابن سبأ وأتباعه، وهو الذي ابتدع النصَّ في
عليّ، وابتدع أنه معصوم. فالرافضة الإمامية هم أتباع المرتدّين، وغلمان
الملحدين، وورثة المنافقين، لم يكونوا أعيان المرتدّين الملحدين.
الوجه
الخامس: أن يقال: هب أن الآية نزلت في عليّ، أيقول القائل: إنها مختصة به،
ولفظها يصرح بأنهم جماعة؟ قال تعالى: { مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ }
[المائدة: 54] إلى قوله: { لَوْمَةَ لآئِمٍ } أفليس هذا صريحاً في أن
هؤلاء ليسوا رجلاً، فإن الرجل لا يُسمّى قوماً في لغة العرب: لا حقيقة ولا
مجازاً.
ولو قال: المراد هو وشيعته.
لقيل: إذا كانت الآية أَدْخَلت
مع عليّ غيره فلا ريب أن الذين قاتلوا الكفّار والمرتدين أحق بالدخول فيها
ممن لم يقاتل إلا أهل القبلة، فلا ريب أن أهل اليمن، الذين قاتلوا مع أبي
بكر وعمر وعثمان، أحق بالدخول فيها من الرافضة، الذين يوالون اليهود
والنصارى والمشركين، ويعادون السابقين الأوَّلين.
فإن قيل: الذين قاتلوا مع عليّ كان كثير منهم من أهل اليمن.
قيل:
والذين قاتلوه أيضاً كان كثير منهم من أهل اليمن. فكلا العسكرين كانت
اليمانية والقيسية فيهم كثيرة جداً، وأكثر أذواء اليمن كانوا مع معاوية،
كذي كلاع، وذي عمرو، وذي رعين، ونحوهم. وهم الذين يُقال لهم: الذوين.
كما قال الشاعر:
وما أعني بذلك أصغريهم ولكنني أريد به الذوينا
الوجه
السادس: قوله: { فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ } لفظ مطلق، ليس فيه تعيين. وهو متناول لمن قام بهذه
الصفات كائناً ما كان، لا يختص ذلك بأبي بكر ولا بعليّ. وإذا لم يكن
مختصاً بأحدهما، لم يكن هذا من خصائصه، فبطل أن يكون بذلك أفضل ممن يشاركه
فيه، فضلاً عن أن يستوجب بذلك الإمامة.
بل هذه الآية تدلّ على أنه لا
يرتدُّ أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوماً يحبهم ويحبونه،
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون هؤلاء المرتدّين.
والرّدّة قد تكون عن أصل الإسلام، كالغالية من النصيرية والإسماعيلية.
فهؤلاء مرتدّون باتفاق أهل السنة والشيعة، وكالعباسية(258).
وقد
تكون الرّدّة عن بعض الدين، كحال أهل البدع، الرافضة وغيرهم. والله تعالى
يقيم قوماً يحبّهم ويحبونه، ويجاهدون من ارتد عن الدين، أو عن بعضه، كما
يقيم من يجاهد الرافضة المرتدّين عن الدين، أو عن بعضه، في كل زمان.
والله سبحانه المسؤول أن يجعلنا من الذين يحبّهم ويحبّونه، الذين يجاهدون
المرتدّين وأتباع المرتدين، ولا يخافون لومة لائم.
الفصل السادس والعشرون
الرد على من روى عن أحمد بن حنبل حديث الصدّيقون ثلاثة
قال
الرافضي: "البرهان السادس عشر: قوله تعالى: { وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ
عِندَ رَبِّهِمْ } [الحديد: 19].
روى أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن أبي
ليلى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "الصّدّيقون
ثلاثة: حبيب بن موسى النجار مؤمن آل ياسين، الذي قال: يا قوم اتّبعوا
المرسلين. وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي
الله. وعلي بن أبي طالب الثالث، وهو أفضلهم. ونحوه رواه ابن المغازلي
الفقيه الشافعي(259)، وصاحب كتاب "الفردوس"(260). وهذه فضيلة تدل على
إمامته".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة الحديث، وهذا ليس
في مسند أحمد. ومجرد روايته له في الفضائل، لو كان رواه، لا يدل على صحته
عنده باتفاق أهل العلم، فإنه يروي ما رواه الناس، وإن لم تثبت صحته. وكل
من عرف العلم يعلم أنه ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول: إنه
صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول: إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي
التي رواها الناس عمَّن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه، وقد
يكون في بعضها علّة تدل على أنه ضعيف، بل باطل. لكن غالبها وجمهورها
أحاديث جيدة يحتجّ بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود. وأما ما رواه في
الفضائل فليس من هذا الباب عنده.
والحديث قد يُعرف أن محدّثه غلط فيه، أو كذبه من غير علمٍ بحال المحدّث،
بل بدلائل أخر.
والكوفيون
كان قد اختلط كذبهم بصدقهم، فقد يخفى كذب أحدهم أو غلطه على المتأخرين،
ولكن يُعرف ذلك بدليل آخر. فكيف وهذا الحديث لم يروه أحمد: لا في المسند
ولا في كتاب "الفضائل"، وإنما هو من زيادات القطيعي(261) رواه(262) عن
محمد بن يونس القرشيّ، حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري(263) حدثنا عمرو بن
جُمَيْع، حدثنا ابن أبي ليلى(264) عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(265)
عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذكره(266).
ورواه
القطيعي أيضاً من طريق آخر قال(267): كتب إلينا عبد الله بن غنام
الكوفي(268) يذكر أن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المكفوف حدّثهم قال:
حدثنا(269) عمرو بن جميع حدثنا محمد بن أبي ليلى عن عيسى(270) ثم ذكر
الحديث(271). وعمرو بن جميع ممن لا يُحتج بنقله، بل قال ابن عدي: يتهم
بالوضع. قال يحيى: كذّاب خبيث. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن
حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، والمناكير عن المشاهير، لا يحل كتب
حديثه إلا على سبيل الاعتبار(272).
الثاني: أن هذا الحديث موضوع على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
الثالث: أن في الصحيح من غير وجه تسمية غير عليّ صدّيقاً، كتسمية
أبي بكر الصّدّيق، فكيف يُقال: الصّدّيقون ثلاثة؟.
وفي
الصحيحين عن أنس أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صعد أُحُداً، وتبعه أبو
بكر وعمر وعثمان فرَجَف بهم، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "اثبت
أُحدُ فما عليك إلا نبيّ وصدّيق وشهيدان". ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن
سعيد عن قتادة عن أنس(273). وفي رواية "ارتج بهم أحد"(274).
وفي الصحيح
عن ابن مسعود عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "عليكم بالصدق؛
فإن الصدق يهدي إلى البرّ، والبرّ يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق
ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِّيقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي
إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب
حتى يُكتب عند الله كذَّاباً"(275).
الوجه الرابع: أن الله تعالى قد سمَّى مريم صدِّيقة، فكيف يقال: الصديقون
ثلاثة؟!
الوجه
الخامس: أن قول القائل: الصديقون ثلاثة، إن أرَاد به أنه لا صدّيق إلا
هؤلاء، فإنه كذب مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن أراد أن الكامل
في الصّدِّيقية هم الثلاثة، فهو أيضاً خطأ، لأن أمتنا خير أمة أخرجت
للناس، فكيف يكون المصدِّق بموسى ورسل عيسى أفضل من المصدِّقين بمحمد؟!
والله
تعالى لم يسمّ مؤمن آل فرعون صدِّيقاً، ولا يُسمَّى صاحب آل ياسين
صدِّيقاً، ولكنهم صدِّقوا بالرسل. والمصدِّقون بمحمد صلَّى الله عليه
وسلَّم أفضل منهم.
وقد سمّى الله الأنبياء صدّيقين في مثل قوله: {
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
} [مريم: 41]، { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ
صِدِّيقًا نَّبِيًّا } [مريم: 56] وقوله عن يوسف: { أَيُّهَا الصِّدِّيقُ
} [يوسف:46].
الوجه السادس: أن الله تعالى قال: { وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ
وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ } [الحديد: 19]. وهذا يقتضي أن كل مؤمن
آمنَ بالله ورسله فهو صدّيق.
السابع: أن يُقال: إن كان الصّدّيق هو
الذي يستحق الإمامة، فأحق الناس بكون صدِّيقاً أبو بكر؛ فإنه الذي ثبت له
هذا الاسم بالدلائل الكثيرة، وبالتواتر الضروري عند الخاص والعام، حتى أن
أعداء الإسلام يعرفون ذلك، فيكون هو المستحق للإمامة. وإن لم يكن كونه
صدِّيقاً يستلزم الإمامة بطلت الحجة.
الفصل السابع والعشرون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بفضيلة الإنفاق بالليل
والنهار والسر والعلانية دون غيره
قال
الرافضي: "البرهان السابع والعشرون: قوله تعالى: { الَّذِينَ يُنفِقُونَ
أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً } [البقرة:
274].
من طريق أبي نُعيم بإسناده إلى ابن عباس نزلت في عليّ، كان معه
أربعة دراهم، فأنفق درهماً بالليل، ودرهماً بالنهار، ودرهماً سرّاً،
ودرهماً علانية، وروى الثعلبي ذلك. ولم يحصل ذلك لغيره، فيكون أفضل. فيكون
هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل. ورواية أبي نُعيم والثعلبي
لا تدل على الصحة.
الثاني: أن هذا كذب ليس بثابت(276).
الثالث:
أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سرّاً وعلانية، فمن عمل بها
دخل فيها، سواء كان عليّاً أو غيره، ويمتنع أن لا يُراد بها إلا واحدٌ
معيّنٌ.
الرابع: أن ما ذُكر من الحديث يناقض مدلول الآية؛ فإن الآية
تدل على الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنهما، وفي الحالين
اللذين لا يخلو الفعل منهما. فالفعل لابد له من زمان، والزمان إما ليل
وإما نهار. والفعل إما سرّاً وإما علانية. فالرجل إذا أنفق بالليل سرّاً،
كان قد أنفق ليلاً سرّاً. وإذا أنفق علانية نهاراً، كان قد أنفق علانية
نهاراً. وليس الإنفاق سرّاً وعلانية خارجاً عن الإنفاق بالليل والنهار.
فمن قال: إن المراد من أنفق درهماً في السر، ودرهماً في العلانية، ودرهماً
بالليل، ودرهما بالنهار - كان جاهلاً، فإن الذي أنفقه سرّاً وعلانية قد
أنفقه ليلاً ونهاراً، والذي قد أنفقه ليلاً ونهاراً قد أنفقه سرّاً
وعلانية. فعُلم أن الدرهم الواحد يتصف بصفتين، لا يجب أن يكون المراد
أربعة.
لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال، كما
يقولون: محمد رسول الله والذين معه (أبو بكر) أشدّاء على الكفار (عمر)
رحماء بينهم (عثمان) تراهم ركّعاً سجّداً (عليّ) يجعلون هذه الصفات
لموصوفات متعددة ويعيّنون الموصوف في هؤلاء الأربعة.
والآية صريحة في
إبطال هذا وهذا، فإنها صريحة في أن هذه الصفات كلها لقوم يتصفون بها كلها،
وإنهم كثيرون ليسوا واحداً، ولا ريب أن الأربعة أفضل هؤلاء، وكل من
الأربعة موصوف بذلك كله، وإن كان بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر.
وأغرب
من ذلك قول بعض جهّال المفسرين: { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ
سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ } [التين: 1-3] إنهم الأربعة؛ فإن
هذا مخالف للعقل والنقل. لكن الله أقسم بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها
كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن، وظهر منها موسى وعيسى ومحمد، كما
قال في التوراة: جاء الله من طور سينا، وأشرق من ساعين، واستعلن من جبال
فاران.
فالتين والزيتون: الأرض التي بُعث فيها المسيح، وكثيراً ما
تسمى الأرض بما ينبت فيها، فيقال: فلان خرج إلى الكرم إلى الزيتون وإلى
الرمان، ونحو ذلك، ويُراد الأرض التي فيها ذلك، فإن الأرض تتناول ذلك،
فعُبِّر عنها ببعضها.
وطور سينين حث كلّم الله موسى، وهذا البلد الأمين مكة أم القرى التي بُعث
بها محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.
والجاهل
بمعنى الآية، لتوهمه أن الذي أنفقه سرّاً وعلانية غير الذي أنفقه بالليل
والنهار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم: إما عليّ وإما غيره، ولهذا
قال: { الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلاَنِيَةً } لم يعطف بالواو، فيقول: "وسرّاً وعلانية" بل هذان
داخلان في الليل والنهار، سواء قيل: هما منصوبان على المصدر، لأنهما نوعان
من الإنفاق. أو قيل: على الحال. فسواء قُدِّرا سرّاً وعلانية، أو مُسِرّاً
ومعلنا، فتبين أن الذي كَذَب هذا كان جاهلاً بدلالة القرآن. والجهل في
الرافضة ليس بمنكر.
الخامس: أنّا لو قدرنا أن عليّاً فعل ذلك، ونزلت
فيه الآية، فهل هنا إلا إنفاق أربعة دراهم في أربعة أحوال؟ وهذا عمل مفتوح
بابه ميسّر إلى يوم القيامة. والعاملون بهذا وأضعافه أكثر من أن يُحصوا،
وما من أحدٍ فيه خير إلا ولابد أن ينفق إن شاء الله، تارة بالليل وتارة
بالنهار، وتارة في السرّ وتارة في العلانية، فليس هذا من الخصائص، فلا يدل
على فضيلة الإمامة.
الفصل الثامن والعشرون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه أفضلهم لأن الله عاتب أصحاب
محمد في القرآن عدا علي
قال
الرافضي: "البرهان الثامن والعشرون: ما رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس
قال: ليس من آية في القرآن: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ } إلا
وعليّ رأسها وأميرها، وشريفها وسيدها، ولقد عاتب الله تعالى أصحاب محمد في
القرآن، وما ذكر عليّاً إلا بخير. وهذا يدل على أنه أفضل، فيكون هو
الإمام".