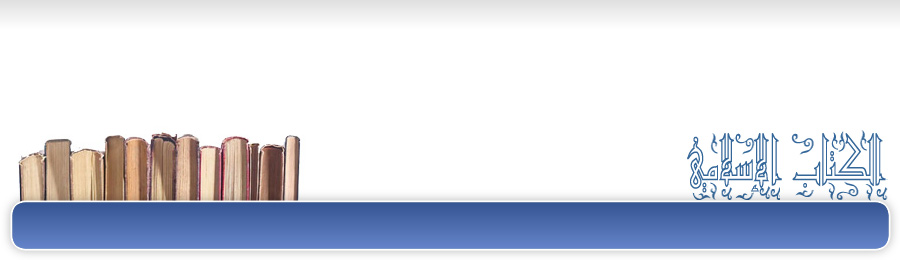كتاب : الإمامة في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف : شيخ الإسلام ابن تيمية.
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل. وليس هذا في مسند أحمد،
ولا مجرد روايته له - لو رواه - في "الفضائل" يدل على أنه صدق، فكيف ولم
يروه أحمد: لا في المسند، ولا في "الفضائل" وإنما هو من زيادات القطيعي،
رواه(277) عن إبراهيم عن شريك الكوفي حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي حدثنا
عيسى(278) عن عليّ بن بَذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباس. ومثل هذا الإسناد لا
يحتج به باتفاق أهل العلم؛ فإن زكريا بن يحيى الكسائي: قال فيه يحيى: "رجل
سوء يحدّث بأحاديث يستأهل أن يُحفر له فيُلقى فيها". وقال الدارقطني:
"متروك". وقال ابن عدي: "كان يحدّث بأحاديث في مثالب الصحابة"(279).
الثاني:
أن هذا كذب على ابن عباس، والمتواتر عنه أنه كان يفضّل عليه أبا بكر وعمر،
وله معايبات يعيب بها عليّاً، ويأخذ عليه في أشياء من أموره، حتى أنه لما
حرق الزنادقة الذين ادّعوا فيه الإلهية قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهى
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يعذِّب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "من بدّل دينه فاقتلوه" رواه البخاري
وغيره(280)، ولما بلغ عليّاً ذلك قال: ويح أم ابن عباس.
ومن الثابت عن ابن عباس أنه كان يفتي - إذا لم يكن معه نص - بقول أبي بكر وعمر. فهذا اتّباعه لأبي بكر وعمر، وهذه معارضته لعلي.
وقد
ذكر غير واحد، منهم الزبير بن بكّار مجاوبته لعليّ لما أخذ ما أخذ من مال
البصرة، فأرسل إليه رسالة فيها تغليظ عليه، فأجاب عليّاً بجواب بتضمن أن
ما فعلتُه دون ما فعلتَه من سفك دماء المسلمين على الإمارة ونحو ذلك.
الثالث:
أن هذا الكلام ليس فيه مدح لعليّ؛ فإن الله كثيراً ما يخاطب الناس بمثل
هذا في مقام عتاب، كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن
تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ } [الصف: 2-3]، فإن كان عليّ رأس هذه الآية،
فقد وقع منه هذا الفعل الذي أنكره الله وذمه.
وقال تعالى: { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ } [الممتحنة: 1]. وثبت في
الصحاح أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بمكة، فأرسل
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عليّاً والزبير ليأتيا بالمرأة التي كان
معها الكتاب، وعليٌّ كان بريئاً من ذنب حاطب، فكيف يُجعل رأس المخاطبين
الملامين على هذا الذنب؟!.
وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ
تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [النساء: 94]. وهذه الآية
نزلت في الذين وجدوا رجلاً في غنيمة له، فقال: إني مسلم، فلم يصدقوه
وأخذوا غنمه، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالتثبيت والتبيّن، ونهاهم عن
تكذيب مدّعي الإسلام طمعاً في دنياه. وعليّ رضي الله عنه بريء من ذنب
هؤلاء، فكيف يقال هو رأسهم؟! وأمثال هذا كثير في القرآن.
الرابع: هو
ممن شمله لفظ الخطاب، وإن لم يكن هو سبب الخطاب، فلا ريب أن اللفظ شمله
كما يشمل غيره. وليس في لفظ الآية تفريق بين مؤمن ومؤمن.
الخامس: أن
قول القائل عن بعض الصحابة؛ إنه رأس الآيات وأميرها وشريفها وسيدها، كلام
لا حقيقة له. فإن أُريد أنه أول من خوطب بها، فليس كذلك؛ فإن الخطاب
يتناول المخاطبين تناولاً واحداً، لا يتقدم بعضهم بما تناوله عن بعض.
وإن قيل: إنه أول من عمل بها، فليس كذلك؛ فإن في الآيات آيات قد عمل بها من قبل عليّ، وفيها آيات لم يحتج عليّ أن يعمل بها.
وإن
قيل: إن تناولها لغيره أو عمل بها مشروط به، كالإمام في الجمعة، فليس
الأمر كذلك، فإن شمول الخطاب لبعضهم ليس مشروطاً بشموله لآخرين، ولا وجوب
العمل على بعضهم مشروط على آخرين بوجوبه.
وإن قيل: إنه أفضل من عُني
بها، فهذا يبني على كونه أفضل الناس. فإن ثبت ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال
بهذه الآية، وإن لم يثبت لم يجز الاستدلال بها، فكان الاستدلال بها باطلاً
على التقديرين.
وغاية ما عندكم أن تذكروا أن ابن عباس كان يفضّل
عليّاً، وهذا مع أنه كذب على ابن عباس، وخلاف المعلوم عنه، فول قُدِّر أنه
قال ذلك - مع مخالفة جمهور الصحابة - لم يكن حجّة.
السادس: أن قول
القائل: لقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذكر عليّاً إلا بخير، كذب
معلوم. فإنه لا يُعرف أن الله عاتب أبا بكر في القرآن، بل ولا أنه ساء
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، بل رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه
قال في خطبته "أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقّه، فإنه لم يسؤني يوماً
قط"(281).
والثابت من الأحاديث الصحيحة يدل على أن النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم كان ينتصر لأبي بكر، وينهى الناس عن معارضته، ولم يُنقل أنه
ساءه، كما نُقل ذلك عن غيره؛ فإن عليّاً لما خطب بنت أبي جهل خطب النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم الخطبة المعروفة(282)، وما حصل مثل هذا في حق أبي
بكر قط.
وأيضاً فعليّ لم يكن يدخل مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في
الأمور العامة كما كان يدخل معه أبو بكر، مثل المشاورة في وريته وحروبه
وإعطائه وغير ذلك، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مع النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم مثل الوزيرين شاورهما في أسرى بدر ما يصنع بهم، وشاورهما
في وفد بني تميم لمن يولِّي عليهم، وشاورهما في غير ذلك من الأمور العامة
يخصّهما بالشورى.
وفي الصحيحين عن عليّ أن عمر لَمّا مات قال له
"والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك؛ فإني كنت كثيراً ما أسمع رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: "دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا
وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر".
وكان يشاور أبا بكر بأمور
حروبه يخصّه، كما شاوره في قصة الإفك، كما استشار أسامة بن زيد، وكما سأل
بريرة. وهذا أمر يخصه، فإنه لما اشتبه عليه أمر عائشة رضي الله عنها،
وتردد هل يطلقها لما بلغه عنها أم يمسكها، صار يسأل عنها بريرة لتخبره
بباطن أمرها، وياشور فيها عليّاً أيمسكها أم يطلقها؟ فقال له أسامة: أهلك
ولا نعلم إلا خيراً، وقال عليّ: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير،
واسأل الجارية تصدقك. ومع هذا فنزل القرآن ببراءتها وإمساكها، موافقة لما
أشار به أسامة بن زيد حب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم(283)، وكان عمر
يدخل في مثل هذه الشورى، ويتكلم مع نسائه فيما يخص النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم، حتى قالت له أم سلمة: يا عمر لقد دخلت في كل شيء حتى دخلت بين
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبين نسائه.
وأما الأمور العامة
الكلّيّة التي تعم المسلمين، إذا لم يكن فيها وحي خاص، فكان يشاور فيها
أبا بكر وعمر، وإن دخل غيرهما في الشورى، لكن هما الأصل في الشورى، وكان
عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيما يراه، وتارة يتبيّن له الحق في خلاف
ما رآه فيرجع عنه.
وأما أبو بكر فلم يُعرف أنه أَنْكَرَ عليه
شيئاً(284)، ولا كان أيضاً يتقدم في شيء، اللهم إلا لما تنازع هو وعمر
فيمن يولّي من بني تميم، حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هذه الآية: {
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ } الآية [الحجرات:
2]، وليس تأذّي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك بأكثر من تأذّيه في
قصة فاطمة.
وقد قال تعالى: { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ } [الأحزاب: 53]. وقد أنزل الله تعالى في عليّ: { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ
سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ } [النساء: 43] لَمّا صلّى
فقرأ وخَلَط(285).
وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "وكان الإنسان
أكثر شيء جدلاً" لما قال له ولفاطمة: "ألا تصليان"؟ فقالا: "إنما أنفسنا
بيد الله سبحانه وتعالى"(286).
الفصل التاسع والعشرون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إن عليّاً أفضل آل محمد
قال
الرافضي: "البرهان التاسع والعشرون: قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [الأحزاب: 56].
من
صحيح البخاري عن كعب بن عجرة قال: سألنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله علمنا كيف
نسلّم؟. قال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد".
وفي صحيح
مسلم: قلنا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟
فقال: "قولوا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم
وآل إبراهيم". ولا شك أن عليّاً أفضل آل محمد، فيكون أولى بالإمامة".
والجواب:
أنه لا ريب أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وأن عليّاً من آل محمد الداخلين
في قوله: "اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله محمد"، ولكن ليس هذا من خصائصه؛
فإن جميع بني هاشم داخلون في هذا، كالعباس وولده، والحارث بن عبد المطلب
وولده، وكبنات النبي صلَّى الله عليه وسلَّم زوجتي عثمان: رقية وأم كلثوم،
وبنته فاطمة. وكذلك أزواجه، كما في الصحيحين عنه قوله: "اللهم صلِّ على
محمدٍ وعلى أزواجه وذريته" بل يدخل فيه سائر أهل بيته إلى يوم القيامة،
ويدخل فيه إخوة عليّ كجعفر وعقيل.
ومعلوم أن دخول كل هؤلاء في
الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل من كل من لم يدخل في ذلك، ولا أنه
يصلح بذلك للإمامة، فضلاً عن أن يكون مختصّاً بها. ألا ترى أن عمّاراً
والمقداد وأبا ذر وغيرهم ممن اتفق أهل السنة والشيعة على فضلهم لا يدخلون
في الصلاة على الآل، ويدخل فيها عقيل والعبّاس وبنوه، وأولئك أفضل من
هؤلاء باتفاق أهل السنة والشيعة، وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من أزواجه،
ولا تصلح امرأة للإمامة، وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة والشيعة، فهذه
فضيلة مشتركة بينه وبين غيره، وليس كل من اتصف بها أفضل ممن لم يتصف بها.
وفي
الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "خير القرون القرن
الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم" فالتابعون أفضل من القرن الثالث.
وتفضيل
الجملة على الجملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل فرد؛ فإن القرن الثالث
والرابع فيهم من هو أفضل من كثير ممن أدرك الصحابة، كالأشتر النخعي
وأمثاله من رجال الفتن، وكالمختار بن أبي عبيد وأمثاله من الكذَّابين
والمفترين؛ والحجّاج بن يوسف وأمثاله من أهل الظلم والشر.
ليس عليّ أفضل أهل البيت، بل أفضل أهل البيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإنه داخل في أهل البيت.
كما قال للحسن: "أما علمت أنّا أهل بيت لا نأكل الصدقة"(287) وهذا الكلام يتناول المتكلم ومن معه.
وكما قالت الملائكة: { رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ } [هود: 73] وإبراهيم فيهم.
وكما قال: "اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم"، وإبراهيم داخل فيهم.
وكما في قوله تعالى: { إِلاّ آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم } [القمر: 34]، فإن لوطاً دخل فيهم.
وكذلك
قوله: { إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ } [آل عمران: 33]، فقد دخل إبراهيم في
الاصطفاء.
وكذلك قوله: { سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ } [الصافات: 130]، فقد دخل ياسين في السلام.
وكذلك قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "اللهم صلِّ على آل أبي أوفى"(288) دخل في ذلك ابو أوفى.
وكذلك قوله: "لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود"(289).
وليس
إذا كان عليّ أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يجب أن
يكون أفضل الناس بعده، لأن بني هاشم أفضل من غيرهم، فإن رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم منهم، وأما إذا خرج منهم فلا يجب أن يكون أفضلهم بعده
أفضل ممن سواهم.
كما أن التابعين إذا كانوا أفضل من تابعي التابعين، وكان فيهم واحد أفضل، لم يجب أن يكون الثاني أفضل من أفضل تابعين التابعين.
بل الجملة إذا فُضِّلت على الجملة، فكان أفضلهما أفضل من الجملة الأخرى، حصل مقصود التفضيل، وما بعد ذلك فموقوف على الدليل.
بل قد يُقال: لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى إلا بدليل.
وفي
صحيح مسلم عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "إن الله اصطفى كنانة
من بني إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم،
واصطفاني من بني هاشم"(290). فإذا كان جملة قريش أفضل من غيرها، لم يلزم
أن يكون كل منهم أفضل من غيرهم، بل في سائر العرب وغيرهم من المؤمنين من
هو أفضل من أكثر قريش، والسابقون الأوَّلون من قريش نفر معدودون، وغالبهم
إنما أسلموا عام الفتح، وهم الطلقاء.
وليس كل المهاجرين من قريش، بل
المهاجرون من قريش وغيرهم - كابن مسعود الهذلي، وعمران بن حصين الخزاعي،
والمقداد بن الأسود الكندي - وهؤلاء وغيرهم من البدريين أفضل من أكثر بني
هاشم، فالسابقون من بني هاشم: حمزة وعليّ وجعفر وعبيدة بن الحارث أربعة
أنفس. وأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر، فمنهم من بني هاشم ثلاثة، وسائرهم
أفضل من سائر بني هاشم.
وهذا كله بناء على أن الصلاة والسلام على آل
محمد وأهل بيته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائر أهل البيوت. وهذا مذهب أهل
السنة والجماعة الذين يقولون: بنو هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب،
والعرب أفضل بني آدم.
وهذا هو المنقول عن أئمة السنة، كما ذكره حرب
الكرماني عمَّن لقيهم، مثل أحمد وإسحاق وسعيد بن منصور وعبد الله بن
الزبير الحميدي وغيرهم.
وذهبت طائفة إلى منع التفضيل بذلك، كما ذكره القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى في "المعتمد" وغيرهما.
والأول
أصحّ، فإنه قد ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الصحيح أنه قال:
"إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى
هاشماً من قريش، واصطفاني من بني هاشم". ورُوي: "أن الله اصطفى بني
إسماعيل" وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
الفصل الثلاثون
الرد على من روى عن ابن عباس تفسيره لمرج البحرين
قال
الرافضي: "البرهان الثلاثون: قوله تعالى: { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ يَبْغِيَانِ } [الرحمن: 19، 20].
من
تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس في قوله: { مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ } قال: علي وفاطمة { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ
لاّ يَبْغِيَانِ }: النبي صلَّى الله عليه وآله { يَخْرُجُ مِنْهُمَا
اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ } [الرحمن: 22]: الحسن والحسين، ولم يحصل
لغيره من الصحابة هذه الفضيلة، فيكون أولى بالإمامة".
والجواب: أن هذا
وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقوله. وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير
القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر
من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه، بل
تفسير القرآن بمثل هذا أعظم القدح فيه والطعن فيه.
ولجهّال
المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، وهي إن كانت باطلة فهي أمثل من
هذا، كقولهم: الصابرين: محمد، والصادقين: أبو بكر، والقانتين: عمر،
والمنفقين: عثمان، والمستغفرين بالأسحار: عليّ.
وكقوله: محمد رسول الله، والذين معه: أبو بكر، أشداء على الكفار: عمر، رحماء بينهم: عثمان، تراهم ركعاً سجّداً: عليّ.
وكقولهم: والتين: أبو بكر، والزيتون: عمر، وطور سينين: عثمان، وهذا البلد الأمين: عليّ.
وكقولهم:
{ وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا
}: أبو بكر { وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }: عمر، { وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
}: عثمان { وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } عليّ.
فهذه التفاسير من جنس تلك
التفاسير، وهي أمثل من إلحادات الرافضة كقولهم: { وَكُلَّ شَيْءٍ
أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } [يس: 12] علي، وكقولهم: { وَإِنَّهُ
فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ } [الزخرف: 4]: إنه
عليّ بن أبي طالب { وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ }
[الإسراء: 60]: بنو أمية، وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من يرجو لله
وقاراً، ولا يقوله من يؤمن بالله وكتابه.
وكذلك قول القائل: { مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ } [الرحمن: 19]: علي وفاطمة، { بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لاّ يَبْغِيَانِ } [الرحمن: 20] النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، {
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ } [الرحمن: 22]: الحسن
والحسين. وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير، وأن
ابن عباس لم يقل هذا.
وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي، وذكره
بإسناد رواته مجهولون لا يُعرفون، عن سفيان الثوري. وهو كذب على سفيان.
قال الثعلبي أخبرني الحسن بن محمد الدينوري، حدثنا موسى بن محمد بن عليّ
بن عبد الله، قال: قرأ أبي على أبي محمد بن الحسن بن علوية القطّان من
كتابه وأنا أسمع، حدثنا بعض أصحابنا، حدثنا رجل من أهل مصر يقال له طسم،
حدثنا أبو حذيفة، عن أبيه، عن أبيه، عن سفيان الثوري في قوله: { مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ يَبْغِيَانِ }
قال: فاطمة وعليّ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين.
وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض، لا يثبت بمثله شيء.
ومما يبيّن كذب ذلك وجوه: أحدها: أن هذا في سورة الرحمن، وهي مكية بإجماع المسلمين، والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة.
الثاني:
أن تسمية هذين بحرين، وهذا لؤلؤاً، وهذا مرجاناً، وجعل النكاح مرجاً - أمر
لا تحتمله لغة العرب بوجه، لا حقيقة ولا مجازاً، بل كما أنه كذب على الله
وعلى القرآن، فهو كذب على اللغة(291).
الثالث: أنه ليس في هذا شيء زائد
على ما يوجد في سائر بني آدم، فإن كل من تزوج امرأة ووُلد لهما ولدان فهما
من هذا الجنس، فليس في ذكر هذا ما يُستعظم من قدرة الله وآياته، إلا ما في
نظائره من خلق الآدميين.
فلا موجب للتخصيص، وإن كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين، فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من عليّ.
وفي
الصحيح أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل: أي الناس أكرم؟ فقال:
"أتقاهم". فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: "يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي
الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله"(292).
وآل
إبراهيم الذين أمرنا أن نسأل لمحمد وأهل بيته من الصلاة مثل ما صلى الله
عليهم، ونحن - وكل مسلم - نعلم أن آل إبراهيم أفضل من آل عليّ، لكن محمدٌ
أفضل من إبراهيم. ولهذا ورد هنا سؤال مشهور، وهو أنه إذا كان محمد أفضل،
فلم قيل: كما صليت على إبراهيم، والمشبَّه دون المشبَّه به.
وقد أجيب
عن ذلك بأجوبة: منها: أن يُقال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، ومحمد فيهم.
قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. فمجموع آل إبراهيم بمحمد أفضل من آل
محمد، ومحمد قد دخل في الصلاة على آل إبراهيم، ثم طلبنا له من الله ولأهل
بيته مثل ما صلى على آل إبراهيم، فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم، ويبقى سائر
ذلك لمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم، فيكون قد طُلب له من الصلاة ما جُعل
للأنبياء من آل إبراهيم. والذي يأخذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل
ما يحصل لنبي، فتعظم الصلاة عليه بهذا الاعتبار صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقيل: إن التشبيه في الأصل لا في القدر.
الرابع: أن الله ذكر أنه مرج
البحرين في آية أخرى، فقال في الفرقان: { وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ } [الفرقان:
53] فلو أريد بذلك عليُّ وفاطمة لكان ذلك ذمّاً لأحدهما، وهذا باطل بإجماع
أهل السنة والشيعة.
الخامس: أنه قال: { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ
يَبْغِيَانِ } فلو أريد بذلك عليّ وفاطمة، لكان البرزخ الذي هو النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم - بزعمهم - أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على
الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح.
السادس: أن أئمة التفسير متفقون
على خلاف هذا، كما ذكره ابن جرير وغيره. فقال ابن عباس: بحر السماء وبحر
الأرض يلتقيان كل عام وقال الحسن: مرج البحرين، يعني بحر فارس والروم،
بينهما برزخ: هو الجزائر(293).
وقوله: { يَخْرُجُ مِنْهُمَا
اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ } [الرحمن: 22] قال الزجّاج: إنما يخرج من
البحر الملح، وإنما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، مثل: {
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا } وقال الفارسي: أراد من أحدهما فحذف
المضاف. وقال ابن جرير: إنما قال منهما، لأنه يخرج من أصداف البحر عن قطر
السماء.
وأما اللؤلؤ والمرجان ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان ما صغر
من اللؤلؤ، واللؤلؤ: العظام. قاله الأكثرون، منهم ابن عباس وقتادة
والفرّاء والضحّاك. وقال الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من
البحر، والمرجان صغاره. الثاني: أن اللؤلؤ الصغار، والمرجان الكبار. قاله
مجاهد والسدي ومقاتل.
قال ابن عباس: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف
أفواهها، فما وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال ابن جرير: حيث وقعت قطرة
كانت لؤلؤة. وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر.
وقال الزجّاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أبي يعلى أن المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان(294).
الفصل الحادي والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بمعرفة علم الكتاب
قال الرافضي: "البرهان الحادي والثلاثون: قوله تعالى: { وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ } [الرعد: 43].
من
طريق أبي نعيم عن ابن الحنفية قال: هو عليّ بن أبي طالب. وفي تفسير
الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال: قلت: من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال:
ذلك عليّ بن أبي طالب. وهذا يدل على أنه أفضل، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية.
الثاني: أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما.
الثالث: أن هذا كذب عليهما.
الرابع:
أن هذا باطل قطعاً. وذلك أن الله تعالى قال: { قُلْ كَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ }
[الرعد: 43] ولو أُريد به عليّ لكان المراد أن محمداً يستشهد على ما قاله
بابن عمه عليّ. ومعلوم أن عليّاً لو شهد له بالنبوة وبكل ما قال، لم ينتفع
محمد بشهادته له، ولا يكون ذلك حجة له على الناس، ولا يحصل بذلك دليل
المستدل، ولا ينقاد بذلك أحد، لأنهم يقولون: من أين لعليّ ذلك؟ وإنما هو
استفاد ذلك من محمد، فيكون محمد هو الشاهد لنفسه.
ومنها أن يُقال: إن
هذا ابن عمه ومن أول من آمن به، فيُظن به المحاباة والمداهنة. والشاهد إن
لم يكن عالماً بما يشاهد به، بريئاً من التهمة، لم يحكم بشهادته، ولم يكن
حجة على المشهود عليه فكيف إذا لم يكن له علم بها إلا من المشهود له؟!
ومعلوم
أنه لو شهد له بتصديقه فيما قال أبو بكر وعمر وغيرهما كان أنفع له، لأن
هؤلاء أبعد عن التهمة، ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا رجالاً وقد سمعوا
من أهل الكتاب ومن الكهّان أشياء علموها من غير جهة محمد، بخلاف عليّ فإنه
كان صغيراً، فكان الخصوم يقولون: لا يعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له.
وأما
أهل الكتاب فغذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت
تلك شهادة نافعة، كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له. لأن ما ثبت نقله
عنهم بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم.
ولهذا نحن نشهد على
الأمم بما علمناه من جهة نبيّنا، كما قال تعالى: { وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } [البقرة: 143].
فهذا
الجاهل الذي جعل هذه فضيلة لعليّ قَدَح بها فيه وفي النبي الذي صار به
عليّ من المؤمنين، وفي الأدلة الدالة على الإسلام. ولا يقول هذا إلا زنديق
أو جاهل مفرط في الجهل.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الخامس:
أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية، كقوله
تعالى: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم
بِهِ } [فصلت: 52]، { وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى
مِثْلِهِ } [الأحقاف: 10] أفترى عليّاً هو من بني إسرائيل؟!.
وقال
تعالى: { فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ
الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ } [يونس: 94]، فهل كان
عليّ من الذين يقرؤون الكتاب من قبله.
وقال: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم } [يوسف: 109]، {
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ } [النحل: 43] فهل أهل الذكر الذين
يسألونهم هل أرسل الله إليهم رجالاً هم علي بن أبي طالب؟!.
السادس: أنه
لو قُدِّر أن عليّاً هو الشاهد، لم يلزم أن يكون أفضل من غيره، كما أن أهل
الكتاب الذين يشهدون بذلك، مثل عبد الله بن سلام وسلمان وكعب الأحبار
وغيرهم، ليسوا أفضل من السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار، كأبي
بكر وعمر وعثمان وعليّ وجعفر وغيرهم(295).
الفصل الثاني والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله هو أفضل من إبراهيم ومحمد صلَّى الله عليه وسلَّم لأنه وسط وهما طرفان
قال
الرافضي: "البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى: { يَوْمَ لا يُخْزِي
اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } [التحريم: 8].
روى
أبو نعيم مرفوعاً إلى ابن عباس قال: أول من يُكسى من حلل الجنة: إبراهيم
عليه السلام بحلته من الله، ومحمد صلَّى الله عليه وسلَّم لأنه صفوة الله،
ثم عليّ يزف بينهما إلى الجنان، ثم قرأ ابن عباس: { يَوْمَ لا يُخْزِي
اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ } قال: عليّ وأصحابه. وهذا
يدل على أنه أفضل من غيره، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل، لا سيما في مثل هذا الذي لا أصل له.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث(296).
الثالث:
أن هذا باطل قطعاً، لأن هذا يقتضي أن يكون عليّ أفضل من إبراهيم ومحمد،
لأنه وسط وهما طرفان. وأفضل الخلق إبراهيم ومحمد، فمن فَضَّل عليهما
عليّاً كان أكفر من اليهود والنصارى.
الرابع: أنه قد ثبت في الصحيحين
عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "أول من يكسى يوم القيامة
إبراهيم"(297). وليس فيه ذكر محمد ولا عليّ. وتقديم إبراهيم بالكسوة لا
يقتضي أنه أفضل من محمد مطلقاً، كما أن قوله: "إن الناس يصعقون يوم
القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشاً بالعرش، فلا أدري هل استفاق
قبلي، أم كان من الذين استثنى الله"(298)، فتجويز أن يكون سبقه في الإفاقة
أو لم يصعق بحال، لا يمنعنا أن نعلم أن محمّداً أفضل من موسى.
ولكن إذا
كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له نُهى عن ذلك، كما نَهَى
في هذا الحديث عن تفضيله على موسى، وكما قال لمن قال: يا خير البريّة.
قال: "ذاك إبراهيم"(299) وصح قوله: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن
دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر"(300).
وكذلك الكلام في تفضيل
الصحابة يُتَّقى فيه نقص أحد عن رتبته أو الغضّ من درجته، أو دخول الهوى
والفرية في ذلك، كما فعلت الرافضة والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة
حقوقهم.
الخامس: أن قوله تعالى: { يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ
النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا
نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [التحريم:
8] وقوله: { يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [الحديد: 12] نصٌّ عامٌّ في المؤمنين الذين
مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وسياق الكلام يدل على عمومه، والآثار
المروية في ذلك تدل على عمومه.
قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا
يُعطي نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيُطفأ نوره يوم القيامة، والمؤمن
يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ربنا أتمم لنا نورنا(301)،
فإن العموم في ذلك يعلم قطعاً ويقيناً، وأنه لم يرد به شخص واحد، فكيف
يجوز أن يُقال: إنه عليُّ وحده، ولو أن قائلاً قال في كل ما جعلوه عليّاً
إنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أي فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى
والافتراء؟ بل يمكن ذكر شبه لمن يدعى اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من
شبه الرافضة التي تدعي اختصاص ذلك بعليّ. وحينئذ فدخول عليّ في هذه الآية
كدخول الثلاثة، بل هم أحق بالدخول فيها، فلم يثبت بها أفضليته ولا إمامته.
الفصل الثالث والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله هو خير البرية
قال
الرافضي: "البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ }
[البيّنة: 7].
روى الحافظ أبو نُعيم بإسناده إلى ابن عباس لما نزلت
هذه الآية قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعليّ: تأتي أنت وشيعتك
يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي خصماؤك غضاباً مفحمين، وإذا كان خير
البريّة، وجب أن يكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالب
بصحة النقل، وإن كنّا غير مرتابين في كذب ذلك، لكن مطالبة المدعي بصحة
النقل لا يأباه إلا معاند. ومجرد رواية أبي نُعيم ليست بحجة باتفاق طوائف
المسلمين.
الثاني: أن هذا مما هو كذب موضوع باتفاق العلماء وأهل المعرفة بالمنقولات.
الثالث:
أن يُقال: هذا معارض بمن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم
النواصب، كالخوارج وغيرهم. ويقولون: إن من تولاّه فهو كافر مرتد، فلا يدخل
في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويحتجّون على ذلك بقوله: { وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
[المائدة: 44]. قالوا: ومن حكَّم الرجال في دين الله فقد حكم بغير ما أنزل
الله فيكون كافراً، ومن تولّى الكافر، فهو كافر، لقوله: { وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [المائدة: 51] وقالوا: إنه هو
وعثمان ومن تولاهما مرتدون بقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليذادن
رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول: أي رب أصحابي أصحابي. فيُقال:
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ
فارقتهم"(302).
قالوا: وهؤلاء هم الذين حكموا في دماء المسلمين وأموالهم بغير ما أنزل الله.
واحتجوا بقوله: "لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"(303). قالوا: والذين ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده كفّاراً.
فهذا
وأمثاله من حجج الخوارج، وهو وإن كان باطلاً بلا ريب فحجج الرافضة أبطل
منه، والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة؛ فإنهم صادقون لا يكذبون،
أهل دين ظاهراً وباطناً، لكنهم ضالون جاهلون مارقون، مرقوا من الإسلام كما
يمرق السهم من الرميّة، وأما الرافضة فالجهل والهوى والكذب غالب عليهم،
وكثير من أئمتهم وعامتهم زنادقة ملاحدة، ليس لهم غرض في العلم ولا في
الدين، بل { إِن يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى } [النجم: 23].
والمروانية
الذين قاتلوا عليّاً، وإن كانوا لا يكفِّرونه، فحججهم أقوى من حجج
الرافضة. وقد صنف الجاحظ كتاباً للمروانية ذكر فيه من الحجج التي لهم ما
لا يمكن الرافضة نقضه، بل لا يمكن الزيدية نقضه، دع الرافضة!.
وأهل
السنة والجماعة لَمّا كانوا معتدلين متوسطين صارت الشيعة تنتصر بهم فيما
يقولونه في حق عليّ من الحق، ولكن أهل السنة قالوا ذلك بأدلة يثبت بها فضل
الأربعة وغيرهم من الصحابة، ليس مع أهل السنة ولا غيرهم حجة تخصُّ عليّاً
بالمدح وغيره بالقدح، فإن هذا ممتنع لا يُنال إلا بالكذب المحال، لا بالحق
المقبول في ميدان النظر والجدال.
الوجه الرابع: أن يُقال: قوله: {
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } [البيّنة: 7] عامّ في
كلّ من اتصف بذلك، فما الذي أوجب تخصيصه بالشيعة؟
فإن قيل: لأن من سواهم كافر.
قيل:
إن ثبت كفر من سواهم بدليل، كان ذلك مغنياً لكم عن هذا التطويل، وإن لم
يثبت لم ينفعكم هذا الدليل، فإنه من جهة النقل لا يثبت، فإن أمكن إثباته
بدليل منفصل، فذاك هو الذي يعتمد عليه لا هذه الآية.
الوجه الخامس:
أن يُقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي غير شيعة عليّ أكثر
مما يوالي كثيراً من الشيعة، حتى الخوارج كان يجالسهم ويفتيهم ويناظرهم.
فلو اعتقد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط، وأن من سواهم
كفّار، لم يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية كانت معاملة ابن عباس وغيره لهم
من أظهر الأشياء دليلاً على أنهم مؤمنون عنده لا كفار.
فإن قيل: نحن لا نكفّر من سوى الشيعة، لكن نقول: هم خير البرية.
قيل:
الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، فإن قلتم:
إن من سواهم لا يدخل في ذلك، فإما أن تقولوا: هو كافر أو تقولوا: فاسق،
بحيث لا يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن دخل اسمهم في الإيمان،
وإلا فمن كان مؤمناً ليس بفاسق فهو داخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
فإن قلتم: هو فاسق.
قيل
لكم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت لم ينفعكم ذلك في
الاستدلال، وما تذكرون به فسق طائفة من الطوائف إلا وتلك الطائفة تبين لكم
أنكم أَوْلى بالفسق منهم من وجوه كثيرة، وليس لكم حجة صحيحة تدفعون بها
هذا.
والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب فيكم الفواحش والظلم فإن ذلك أكثر
فيكم منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم. وأتباع بني أمية كانوا أقل ظلماً
وكذباً وفواحش ممن دخل في الشيعة بكثير، وإن كان في بعض الشيعة صدق ودين
وزهد، فهذا في سائر الطوائف أكثر منهم، ولو لم يكن إلا الخوارج الذين قيل
فيهم: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع
قراءتهم"(304).
الوجه السادس: أنه قال قبل ذلك: { إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } [البيّنة: 6] ثم
قال: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ } [البيّنة: 7] وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين
وأهل الكتاب. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا
الصالحات، وكلها عامة. فما الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟.
وإنما
دعوى الرافضة - أو غيرهم - من أهل الأهواء الكفر في كثير ممن سواهم،
كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهمية، وأنهم هم الذين آمنوا وعملوا
الصالحات دون من سواهم، كقول اليهود والنصارى: { لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ
هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بَلَى مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } [البقرة: 111، 112] وهذا عام
في كل من عمل لله بما أمره الله، فالعمل الصالح هو المأمور به، وإسلام
وجهه لله إخلاص قصده لله.
الفصل الرابع والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بمصاهرته للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم
قال
الرافضي: "البرهان الرابع والثلاثون: قوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا } [الفرقان: 54].
في
تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال: نزلت في النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
وعلي بن أبي طالب: زوَّج فاطمة عليّاً، وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله
نسباً وصهراً، ولم يثبت لغيره ذلك، فكان أفضل، فيكون هو الإمام".
الجواب من وجوه: أولاً: المطالبة بصحة النقل.
وثانياً: أن هذا كذب على ابن سيرين بلا شك.
وثالثاً: أن مجرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة.
الرابع:
أن يُقال: هذه الآية في سورة الفرقان، وهي مكية. وهذا من الآيات المكية
باتفاق الناس قبل أن يتزوج عليّ بفاطمة، فكيف يكون ذلك قد أُريد به عليّ
وفاطمة؟!.
الخامس: أن الآية مطلقة في كل نسب وصهر(305)، لا اختصاص لها
بشخص دون شخص، ولا ريب أنها تتناول مصاهرته لعليّ، كما تتناول مصاهرته
لعثمان مرتين، كما تتناول مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي صلَّى الله عليه
وسلَّم، فإن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تزوج عائشة بنت أبي بكر، وحفصة
بنت عمر من أبويهما، وزوّج عثمان برقية وأم كلثوم بنتيه، وزوّج عليّاً
بفاطمة، فالمصاهرة ثابتة بينه وبين الأربعة. ورُوى عنه أنه قال: "لو كانت
عندنا ثالثة لزوجناها عثمان" وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين عليّ
وغيره، فليس من خصائصه، فضلاً عن أن توجب أفضليته وإمامته عليهم.
السادس:
أنه لو فرض أنه أُريد بذلك مصاهرة عليّ، فمجرد المصاهرة لا تدل على أنه
أفضل من غير باتفاق أهل السنة والشيعة، فإن المصاهرة ثابتة لكل من
الأربعة، مع أن بعضهم أفضل من بعض، فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية للزم
التناقض.
الفصل الخامس والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة بقوله إنه اختص بأنه صدّيق معصوم دون غيره
قال
الرافضي: "البرهان الخامس والثلاثون: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ }
[التوبة: 119] أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق، وليس إلا
المعصوم لتجويز الكذب في غيره، فيكون هو عليّاً، إذ لا معصوم من الأربعة
سواه. وفي حديث أبي نُعيم عن ابن عباس أنها نزلت في عليّ".
والجواب
من وجوه: أحدها: أن الصّدِّيق مبالغة في الصادق، فكل صدِّيق صادق وليس كل
صادق صدّيقاً. وأبو بكر رضي الله عنه قد ثبت أنه صدِّيق بالأدلة الكثيرة،
فيجب أن تتناوله الآية قطعاً وأن تكون معه، بل تناولها له أولى من تناولها
لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرّين بخلافته، امتنع أن نقرَّ بأن
عليّاً كان هو الإمام دونه، فالآية تدل على نقيض مطلوبهم.
الثاني: أن
يُقال: عليٌّ إما أن يكون صدِّيقاً وإما أن لا يكون، فإن لم يكن صدّيقاً
فأبو بكر الصّدّيق، فالكون مع الصادق الصدِّيق أولى من الكون مع الصادق
الذي ليس بصدّق. وإن كان صدِّيقاً فعمر وعثمان أيضاً صدِّيقون، وحينئذ
فإذا كان الأربعة صدِّيقين، لم يكن عليٌّ مختصاً بذلك، ولا بكونه صادقاً،
فلا يتعين الكون مع واحد دون الثلاثة. بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة
أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عدداً، لا سيما وهم أكمل في الصدق.
الثالث:
أن يُقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لَمّا تخلف عن غزوة تبوك،
وصَدَق النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في أنه لم يكن له عذر، وتاب الله
عليه ببركة الصدق، وكان جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب، كما اعتذر
غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا ثابت في الصحاح والمساند وكتب التفسير
والسير، والناس متفقون عليه(306).
ومعلوم أنه لم يكن لعليّ اختصاص في
هذه القصة، بل قال كعب بن مالك: "فقام إليَّ طلحة يهرول فعانقني، والله ما
قام إليّ من المهاجرين غيره" فكان كعب لا ينساها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل
حملها على عليّ وحده.
الوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في هذه القصة،
ولم يكن أحد يُقال إنه معصوم، لا عليّ ولا غيره. فعُلم أن الله أراد (مع
الصادقين) ولم يشترط كونه معصوماً.
الخامس: أنه قال: (مع الصادقين) وهذه صيغة جمع، وعليٌّ واحد، فلا يكون هو المراد وحده.
السادس:
أن قوله تعالى: (مع الصادقين) إما أن يُراد: كونوا معهم في الصدق وتوابعه،
فاصدقوا كما يصدق الصادقون، ولا تكونوا مع الكاذبين. كما في قوله: {
وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ } [البقرة: 43]، وقوله: { وَمَن يُطِعِ
اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء
وَالصَّالِحِينَ } [النساء: 69]، وكما في قوله: { فَأُوْلَئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
} [النساء: 146].
وإما أن يُراد به: كونوا مع الصادقين في كل شيء، وإن لم يتعلق بالصدق.
والثاني
باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات، كالأكل
والشرب واللباس ونحو ذلك. فإذا كان الأول هو الصحيح، فليس في هذا أمر
بالكون مع شخص معيّن، بل المقصود: اصدقوا ولا تكذبوا.
كما قال النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح: "عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي
إلى البرّ، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق
حتى يُكتب عند الله صدّيقاً. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور،
وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب
عند الله كذّاباً".
وهذا كما يُقال: كن مع المؤمنين، كن مع الأبرار. أي ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه، ليس المراد: أنك مأمور بطاعتهم في كل شيء.
الوجه
السابع: أن يُقال: إذا أُريد: كونوا مع الصادقين مطلقاً، فذلك لأن الصدق
مستلزم لسائر البرّ، كقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "عليك بالصدق،
فإن الصدق يهدي إلى البر" الحديث. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به.
الثامن:
أن يُقال: إن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، ولم يقل: مع المعلوم فيهم
الصدق، كما أنه قال: { وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } [الطلاق: 2] لم يقل: من علمتم أنهم ذوو عدل منكم.
وكما قال: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا } [النساء: 58] لم يقل: إلى من علمتم أنهم أهلها. وكما
قال: { وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ }
[النساء: 58] ولم يقل: بما علمتم أنه عدل، لكن علّق الحكم بالوصف.
ونحن
علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة
والعدل، ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. كما أن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم المأمور أن يحكم بالعدل قال: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن
يكون ألحق بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق
أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له من النار"(307).
الوجه التاسع: هب
أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق، لكن العلم كالعلم في قوله: { فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ } [الممتحنة: 10]، والإيمان أخفى من الصدق.
فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يُقال فيه ليس إلا العلم بالمعصوم،
كذلك هنا يمتنع أن يُقال: لا يُعلم إلا صدق المعصوم.
الوجه العاشر: هب
أن المراد: علمنا صدقه، لكن يُقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان ونحوهم ممن
عُلم صدقهم، وأنهم لا يتعمّدون الكذب، وإن جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب،
فإن الكذب أعظم، ولهذا تُردُّ شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد
قَوْلَي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد رُوى في ذلك حديث مرسل.
ونحن
قد نعلم يقيناً أن هؤلاء لم يكونوا يتعمّدون الكذب على رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم، بل ولا يتعمّدون الكذب بحال. ولا نسلّم أنّا لا نعلم
انتفاء الكذب إلا عمّن يُعلم أنه معصوم مطلقاً، بل كثير من الناس إذا
اختبرته تيقّنت أنه لا يكذب، وإن كان يخطئ ويذنب ذنوباً أخرى. ولا نسلّم
أن كل من ليس بمعصوم يجوز أن يتعمّد الكذب.
وهذا خلاف الواقع، فإن
الكذب لا يتعمّده إلا من هو من شرّ الناس. وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من
يتعمّد الكذب على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وأهل العلم يعلمون
بالاضطرار أن مثل مالك وشُعبة ويحيى بن سعيد والثوري والشافعي وأحمد
ونحوهم، لم يكونوا يتعمّدون الكذب على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، بل
ولا على غيره، فكيف بابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم؟!.
الوجه
الحادي عشر: أنه لو قُدِّر أن المراد به: المعصوم لا نسلّم الإجماع على
انتفاء العصمة من غير عليّ، كما تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيراً من الناس الذين
هم خير من الرافضة يدَّعون في شيوخهم هذا المعنى، وإن غيَّروا عبارته.
وأيضاً فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته، بل إما انتفاء الجميع
وإما ثبوت الجميع.
الفصل السادس والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بفضيلة أنه أول من صلّى وركع مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
قال الرافضي: "البرهان السادس والثلاثون: قوله تعالى: { وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ } [البقرة: 43].
من
طريق أبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم وعليّ خاصة، وهما أول من صلّى وركع(308). وهذا يدل على
فضيلته فيدل على إمامته".
الجواب من وجه: أحدها: أنّا لا نسلم صحة هذا، ولم يذكر دليلاً على صحته.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
الثالث:
أن هذه الآية في سورة البقرة، وهي مدنية باتفاق المسلمين، وهي في سياق
مخاطبة لبني إسرائيل، وسواء كان الخطاب لهم، أو لهم وللمؤمنين(309)، فهو
خطاب أنزل بعد الهجرة، وبعد أن كثر المصلّون والراكعون، لم تنزل في أول
الإسلام حتى يُقال: أنها مختصة بأول من صلّى وركع.
الرابع: أن قوله:
(مع الراكعين) صيغة جمع، ولو أريد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وعليّ،
لقيل: مع الرّاكِعَيْن، بالتثنية. وصيغة الجمع لا يُراد بها اثنان فقط
باتفاق الناس، بل إما الثلاثة فصاعداً، وإما الاثنان فصاعداً. أما إرادة
اثنين فقط فخلاف الإجماع.
الخامس: أنه قال لمريم: { اقْنُتِي لِرَبِّكِ
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ } [آل عمران: 43] ومريم كانت
قبل الإسلام، فعُلم أنه كان راكعون قبل الإسلام، فليس فيهم عليّ، فكيف لا
يكون راكعون في أول الإسلام ليس فيهم عليّ وصيغة الاثنين واحدة؟!.
السادس:
أن الآية مطلقة لا تخصُّ شخصاً بعينه، بل أمر الرجل المؤمن أن يصلِّي مع
المصلّين. وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة، لأن الركعة لا تدرك إلا
بإدراك الركوع.
السابع: أنه لو كان المراد الركوع معهما لا نقطع حكمها بموتهما، فلا يكون أحدٌ مأموراً أن يركع مع الراكعين.
الثامن:
أن قول القائل: عليٌّ أول من صلّى مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم،
ممنوع. بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وأن أبا بكر صلّى قبله.
التاسع:
أنه لو كان أمراً بالركوع معه، لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون هو
الإمام، فإن عليّاً لم يكن إماماً مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وكان
يركع معه.
الفصل السابع والثلاثون
الرد على من روى عن ابن عباس حديث واجعل لي وزيراً من أهلي
قال الرافضي: "البرهان السابع والثلاثون: قوله تعالى: { وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي } [طه: 29].
من
طريق أبي نُعيم عن ابن عباس قال: أخذ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بيد
عليّ وبيدي ونحن بمكة، وصلَّى أربع ركعات، ورفع يده إلى السماء، فقال:
اللهم موسى بن عمران سألك، وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري، وتحلل
عقدة من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي، عليّ بن أبي طالب
أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس: سمعت منادياً ينادي: يا
أحمد قد أوتيت ما سألت. وهذا نص في الباب".
والجواب: المطالبة بالصحة كما تقدم أولاً.
الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث(310) بل هم يعلمون أن هذا من أسمج الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
الثالث:
أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمّا كان بمكة في أكثر الأوقات لم يكن
ابن عباس قد وُلد، وابن عباس ولد وبنو هاشم في الشعب محصورون، ولَمّا هاجر
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن ابن عباس بلغ سن التمييز، ولا
كان ممن يتوضأ ويصلّي مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فإن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم مات وهو لم يحتلم بعد، وكان له عند الهجرة نحو خمس سنين
أو أقل منها، وهذا لا يؤمر بوضوء ولا صلاة؛ فإن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في
المضاجع"(311) ومن يكون بهذا السن لا يعقل الصلاة، ولا يحفظ مثل هذا
الدعاء إلا بتلقين، لا يحفظ بمجرد السماع.
الرابع: أنهم قد قدَّموا في
قوله: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } [المائدة: 55]. وحديث
التّصدّق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم دعا بهذا
الدعاء. وهنا قد ذكروا أنه قد دعا بهذا الدعاء بمكة قبل تلك الواقعة بسنين
متعددة، فإن تلك كانت في سورة المائدة، والمائدة من آخر القرآن نزولاً،
وهذا في مكة. فإذا كان قد دعا بهذا في مكة وقد استجيب له، فأي حاجة إلى
الدعاء به بعد ذلك بالمدينة بسنين متعددة؟!.
الخامس: أنّا قد بيّنّا
فيما تقدم وجوهاً متعددة في بطلان مثل هذا، فإن هذا الكلام كذب على رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم من وجوه كثيرة، ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات
كثيرة لم يذكروها هناك، وهي قوله: { وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } [طه: 32]،
فصرَّحوا هنا بأن عليّاً كان شريكه في أمره، كما كان هارون شريك موسى،
وهذا قول من يقول بنبوّته، وهذا كفر صريح، وليس هو قول الإمامية، وإنما هو
من قول الغالية.
وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعده، فإنهم
يدّعون إمامته بعده، ومشاركته له في أمره في حياته. وهؤلاء الإمامية وإن
كانوا يكفِّرون من يقول بمشاركته له في النبوة، لكنه يكثرون سوادهم في
المقال والرجال بمن يعتقدون فيه الكفر والضلال، وبما يعتقدون أنه من الكفر
والضلال، لفرط منابذتهم للدين، ومخالفتهم لجماعة المسلمين، وبغضهم لخيار
أولياء الله المتّقين، واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين. فهم كما قيل في
المثل: "رمتني بدائها وانسلت".
وهذا الرافضي الكذّاب يقول: "وهذا نصٌّ في الباب".
فيقال
له: يا دُبَيْر هذا نص في أن عليّاً شريكه في أمره في حياته، كما كان
هارون شريكاً لموسى. فهل تقول بموجب هذا النص؟ أم ترجع عن الاحتجاج
بأكاذيب المفترين، وترهات إخوانك المبطلين؟!.
الفصل الثامن والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص بمؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
قال الرافضي: "البرهان الثامن والثلاثون: قوله تعالى: { إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ } [الحجر: 47].
من
مسند أحمد بإسناده إلى زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم مسجده، فذكر قصة مؤاخاة رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم، فقال عليّ: لقد ذهبت روحي، وانقطع ظهري، حين فعلت بأصحابك، فإن
كان هذا من سخط الله عليَّ، فلك العقبى والكرامة. فقال رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم: والذي بعثني بالحق نبيّاً، ما اخترتك إلا لنفسي، فأنت
مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، وأنت
معي في قصري في الجنة، ومع ابنتي فاطمة، فأنت أخي ورفيقي. ثم تلا رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: { إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ
}، المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض. والمؤاخاة تستدعي المناسبة
والمشاكلة، فلما اختص عليّ بمؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان هو
الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الإسناد وليس هذا
الحديث في مسند أحمد، ولا رواه أحمد قط لا في المسند ولا في "الفضائل" ولا
ابنه. فقول هذا الرافضي: "من مسند أحمد" كذب وافتراء على المسند، وإنما هو
من زيادات القطيعي التي فيها من الكذب الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه
كذب موضوع، رواه القطيعي عن(312) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي،
حدثنا حسين بن محمد الذارع، حدثنا عبد المؤمن بن عباد، حدثنا يزيد بن معن،
عن عبد الله بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفى(313).
وهذا الرافضي لم
يذكره بتمامه فإن فيه عند قوله: وأنت أخي ووارثي. قال: وما أرث منك يا
رسول الله؟ قال: ما ورَّث الأنبياء من قبلي. قال: وما ورث الأنبياء من
قبلك؟ قال: كتاب الله وسنةنبيهم(314).
وهذا الإسناد مظلم انفرد به عبد
المؤمن بن عباد أحد المجروحين، ضعّفه أبو حاتم(315) عن يزيد بن معن، ولا
يدري من هو، فلعله الذي اختلقه عن عبد الله بن شرحبيل، وهو مجهول، عن رجل
من قريش، عن زيد بن أبي أوفى.
الوجه الثاني: أن هذا مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة.
الثالث:
أن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم من بعض، والأنصار بعضهم مع بعض،
كلها كذب. والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يؤاخ عليّاً، ولا آخى بين أبي
بكر وعمر، ولا بين مهاجرين ومهاجرين، لكن آخى بين المهاجرين والأنصار، كما
آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان الفارسي وأبي
الدرداء، وبين عليّ وسهل بن حنيف.
وكانت المؤاخاة في دور بني النّجّار،
كما أخبر بذلك أنس في الحديث الصحيح، لم تكن في مسجد النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم، كما ذكر في الحديث الموضوع، وإنما كانت في دار كان لبعض بني
النّجّار، وبناه في محلتهم. فالمؤاخاة التي أخبر بها أنس ما في الصحيحين
عن عاصم بن سليمان الأحول، قال: قلت لأنس: أبلغت أن رسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم قال: "لا حلف في الإسلام". فقال أنس: قد حالف رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم بين قريش والأنصار في داري(316).
الرابع: أن قوله في
هذا الحديث: أنت أخي ووارثي، باطل على قوله أهل السنة والشيعة، فإنه إن
أراد ميراث المال بطل قولهم: إن فاطمة ورثته. وكيف يرث ابن العم مع وجود
العم وهو العباس؟ وما الذي خصّه بالإرث دون سائر بني العم الذين هم في
درجة واحدة؟ وإن أراد: وارث العلم والولاية، بطل احتجاجهم بقوله: {
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } [النمل: 16] وقوله: { فَهَبْ لِي مِن
لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي } [مريم: 5، 6]، إذ لفظ "الإرث" إذا كان
محتملاً لهذا ولهذا أمكن أن أولئك الأنبياء ورثوا كما ورث عليّ النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم.
وأما أهل السنة فيعلمون أن ما ورَّثه النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم من العلم لم يختص به عليّ، بل كل من أصحابه حصل له
نصيب بحسبه، وليس العلم كالمال، بل الذي يرثه هذا يرثه هذا ولا يتزاحمان،
إذ لا يمتنع أن يعلم هذا ما علمه هذا، كما يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي
أخذه هذا.
الوجه الخامس: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد أثبت
الأخوة لغير عليّ، كما في الصحيحين أنه قال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".
وقال له أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخي؟ قال: "أنا أخوك، وبنتك حلالٌ
لي"(317). وفي الصحيح أنه قال في حق أبي بكر: "ولكن أخوة الإسلام".
وقال
في الصحيح أيضاً: "وددت أن قد رأيت إخواني". قالوا: أو لسنا إخوانك يا
رسول الله؟ قال: "لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي
ولم يروني" يقول: أنتم لكم من الأخوة ما هو أخص منها، وهو الصحبة، وأولئك
لهم أخوة بلا صحبة.
وقد قال تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
} [الحجرات: 10] وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تقاطعوا ولا تدابروا،
ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً" أخرجاه في
الصحيحين(318).
وقال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"(319).
وقال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه من الخير ما يحب لنفسه"(320).
وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وإذا كان كذلك عُلم أن مطلق المؤاخاة لا يقتضي التماثل من كل وجه، بل من بعض الوجوه.
وإذا
كان كذلك فلم قيل: إن مؤاخاة عليّ لو كانت صحيحة اقتضت الإمامة والأفضلية،
مع أن المؤاخاة مشتركة؟ وثبت عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الصحاح
من غير وجه أنه قال: "لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر
خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدّت، إلا
خوخة أبي بكر. إن أمّن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر". وفي هذا
إثبات خصائص لأبي بكر لا يشركه فيها أحد غيره، وهو صريح في أنه ليس من أهل
الأرض من هو أحب إليه، ولا أعلى منزلة عنده، ولا أرفع درجة، ولا أكثر
اختصاصاً به من أبي بكر.
كما في الصحيحين: قيل له: أي الناس أحب
إليك؟ قال: "عائشة". قيل: من الرجال؟ قال: "أبوها". وفي الصحيحين عن عمر
أنه قال: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
فهذه الأحاديث التي أجمع أهل العلم على صحتها وتلقّيها بالقبول، ولم يقدح
فيها أحد من العلم تبيّن أن أبا بكر كان أحبّ إليه وأعلى عنده من جميع
الناس.
وحينئذ فإن كانت المؤاخاة دون هذه المرتبة لم تعارضها، وإن كانت
أعلى كانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحاديث المؤاخاة، وإن كنا
نعلم أنها كذب بدون هذه المعارضة.
لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة
تبيّن أن أبا بكر كان أحب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من عليّ،
وأعلى قدراً عنده منه ومن كل من سواه، وشواهد هذا كثيرة.
وقد روى بضعة
وثمانون نفساً عن عليّ أنه قال: "خيرة هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم
عمر". رواها البخاري في الصحيح عن عليّ رضي الله عنه. وهذا هو الذي يليق
بعليّ رضي الله عنه فإنه من أعلم الصحابة بحق أبي بكر وعمر، وأعرفهم
بمكانهما من الإسلام، وحسن تأثيرهما في الدين، حتى أنه تمنّى أن يلقى الله
بمثل عمل عمر، رضي الله عنهم أجمعين.
وروى الترمذي - وغيره - مرفوعاً
عن عليّ رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "هذان
سيدا كهول أهل الجنة من الأوَّلين والآخرين، لا تخبرهما يا علي"(321).
وهذا
الحديث وأمثاله لو عورض بها أحاديث المؤاخاة وأحاديث الطير ونحوه، لكانت
باتفاق المسلمين أصح منها، فكيف إذا انضم إليها سائر الأحاديث التي لا شك
في صحتها؟ مع الدلائل الكثيرة المتعددة، التي توجب علماً ضرورياً لمن
علمها، أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم،
وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وكل من كان بسنة رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم وأحواله أعلم كان بهذا أعرف، وإنما يستريب فيه من لا
يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ فإما أن يصدق الكل أو يتوقف في الكل.
وأما
أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه يعلمون هذا علماً ضرورياً. دع هذا، فلا ريب
أن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها وعبَّادها متفقون على تقديم أبي
بكر وعمر، كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه البيهقي بإسناده
قال: "لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله
عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة".
وكذلك أيضاً لم يختلف علماء
الإسلام في ذلك، كما هو قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد
وأصحابه، وداود وأصحابه، والثوري وأصحابه، والليث وأصحابه، والأوزاعي
وأصحابه، وإسحاق وأصحابه، وابن جرير وأصحابه، وأبي ثور وأصحابه، وكما هو
قول سائر العلماء المشهورين، إلا من لا يؤبه له ولا يلتفت إليه.
وما
علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفُتيا، إلا ما نقل عن الحسن بن صالح
بن حيّ أنه كان يفضّل عليّاً. وقيل: إن هذا كذب عليه. ولو صح هذا عنه لم
يقدح فيما نقله الشافعي من الإجماع؛ فإن الحسن بن صالح لم يكن من التابعين
ولا من الصحابة. والشافعي ذكر إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبي بكر،
ولو قاله الحسن، فإذا أخطأ واحد من مائة ألف إمام أو أكثر، لم يكن ذلك
بمنكر.
وليس في شيوخ الرافضة إمام في شيء من علوم الإسلام، لا علم
الحديث ولا الفقه ولا التفسير ولا القرآن، بل شيوخ الرافضة إما جاهل وإما
زنديق، كشيوخ أهل الكتاب.
بل السابقون الأوَّلون وأئمة السنة والحديث
متفقون على تقديم عثمان، ومع هذا إنهم لم يجتمعوا على ذلك رغبة ولا رهبة،
بل مع تباين آرائهم وأهوائهم وعلومهم، واختلافهم وكثرة اختلافاتهم فيما
سوى ذلك من مسائل العلم، فأئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم متفقون
على هذا، ثم من بعدهم، كمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن
الماجشون، وغيرهم من علماء المدينة.
ومالك يحكي الإجماع عمّن لقيه أنهم
لم يختلفوا في تقديم أبي بكر وعمر. وابن جريج وابن عيينة وسعد بن سالم
ومسلم بن خالد، وغيرهم من علماء مكة، وأبي حنيفة والثوري وشريك بن عبد
الله وابن أبي ليلى، وغيرهم من فقهاء الكوفة، وهي دار الشيعة، حتى كان
الثوري يقول: من قدَّم عليّاً على أبي بكر ما أرى أن يصعد له إلى الله
عمل. رواه أبو داود في سننه(322).
وحماد بن زيد وحمّاد بن سلمة وسعيد
بن أبي عروبة، وأمثالهم من علماء البصرة، والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز،
وغيرهم من علماء الشام، والليث وعمرو بن الحارث وابن وهب، وغيرهم من علماء
مصر، ثم مثل عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومثل الشافعي وابن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي
عبيد، ومثل البخاري وأبي داود وإبراهيم الحربي، ومثل الفضيل بن عياض وأبي
سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد وسهل بن عبد الله
التستري.
ومن لا يحصي عدده إلا الله، ممن له في الإسلام لسان صدق،
كلهم يجزمون بتقديم أبي بكر وعمر، كما يجزمون بإمامتهما، مع فرط اجتهادهم
في متابعة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وموالاته. فهل يوجب هذا إلا ما
علموه من تقديمه هو لأبي بكر وعمر، وتفضيله لهما بالمحبة والثناء
والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل.
الفصل التاسع والثلاثون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بأنه أمير على ذرية آدم كلهم
قال
الرافضي: "البرهان التاسع والثلاثون: قوله تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ
مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن
تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ }
[الأعراف: 172].
في كتاب "الفردوس"(323) لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن
اليمان، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لو يعلم الناس متى
سُمّي عليُّ أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سُمِّي أمير المؤمنين وآدم بين
الروح والجسد. قال تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ } [الأعراف: 172] قالت الملائكة: بلى، فقال تبارك وتعالى: أنا
ربكم، ومحمد نبيّكم، وعليّ أميركم. وهو صريح في الباب".
والجواب من
وجوه: أحدها: منع الصحة، والمطالبة بتقريرها. وقد أجمع أهل العلم بالحديث
على أن مجرد رواية صاحب "الفردوس" لا تدل على أن الحديث صحيح، فابن شيرويه
الديلمي الهمذاني ذكر في هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة
وأحاديث موضوعة، وإن كان من أهل العلم والدين، ولم يكن ممن يكذب هو، لكنه
نقل ما في كتب الناس، والكتب فيها الصدق والكذب، ففعل كما فعل كثير من
الناس في جميع الأحاديث: إما بالأسانيد، وإما محذوفة الأسانيد.
الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
الثالث:
أن الذي في القرآن أنه قال: { أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى } ليس
فيه ذكر النبي ولا الأمير، وفيه قوله: { أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا
أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ }
[الأعراف: 173]. فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة، ليس فيه ميثاق النبوة،
فكيف ما دونها؟!
الرابع: أن الأحاديث المعروفة في هذا، التي في المسند
والسنن والموطأ وكتب التفسير وغيرها، ليس فيها شيء من هذا. ولو كان ذلك
مذكوراً في الأصل لم يهمله جميع الناس، وينفرد به من لا يُعرف صدقه، بل
يُعرف أنه كذب.
الخامس: أن الميثاق أخذ على جميع الذرية، فيلزم أن يكون
عليٌّ أميراً على الأنبياء كلهم، من نوح إلى محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.
وهذا كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليّاً، فكيف يكون
أميراً عليهم؟!
وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانه. أما
الإمارة على من خُلق قبله، وعلى من يخلق بعده، فهذا من كذب من لا يعقل ما
يقول، ولا يستحي فيما يقول.
ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي الذي هو
أحمر من عقلاء اليهود، الذين قال الله فيهم: { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا
التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا } [الجمعة: 5] والعامة معذورون في قولهم: الرافضي حمار
اليهودي، وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلاً وشرعاً، وأن هذا
كما يُقال: خرَّ عليهم السقف من تحتهم فيُقال: لا عقل ولا قرآن.
وكذلك
كون عليّ أميراً على ذرية آدم كلهم، وإنما وُلد بعد موت آدم بألوف من
السنين، وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه في الزمان
والمرتبة، وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة
الذين يقولون إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم
الأولياء، الذي وُجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة(324).
فدعوى هؤلاء في
الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية، وكلاهما يبني أمره على الكذب
والغلو والشرك والدعاوي الباطلة، ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
ثم
إن هذا الحمار الرافضي يقول: "وهو صريح في الباب" فهل يكون هذا حجة عند
أحد من أولي الألباب؟! أو يحتج بهذا من يستحق أن يُؤهِّل للخطاب؟! فضلاً
عن أن يُحتج به في تفسيق خيار هذه الأمة وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم؟
ولولا
أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله، وسادات أهل الأرض،
خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح في الدين، ويسلّط الكفّار
والمنافقين، ويورث الشبه والضعف عند كثير من المؤمنين - لم يكن بنا حاجة
إلى كشف أسراره، وهتك أستاره، والله حسيبه وحسيب أمثاله.
الفصل الأربعون
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بأنه صالح المؤمنين
قال
الرافضي: "البرهان الأربعون: قوله تعالى: { فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
ظَهِيرٌ } [التحريم: 4]. أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو عليّ.
روى
أبو نُعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس، قالت: سمعت رسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم يقرأ هذه الآية: { وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ }: قال: صالح
المؤمنين عليّ بن أبي طالب، واختصاصه بذلك يدل على أفضليته، فيكون هو
الإمام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، اقتصرنا على ما ذكرنا للاختصار".
والجواب
من وجوه: أحدها: قوله "أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين هو عليّ" كذب
مبين، فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحدٌ من علماء
التفسير، ولا علماء الحديث ونحوهم. ونحن نطالبهم بهذا النقل، ومن نقل هذا
الإجماع؟
الثاني: أن يُقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا. قال ابن
مسعود وعكرمة ومجاهد والضّحّاك وغيرهم: هو أبو بكر وعمر. وذكر هذا جماعة
من المفسرين، كابن جرير الطبري وغيره.
وقيل: هو أبو بكر، رواه مكحول عن أبي أمامة.
وقيل: عمر، قاله سعيد بن جبير ومجاهد.
وقيل: خيار المؤمنين، قاله الربيع بن أنس.
وقيل: هم الأنبياء، قال قتادة والعلاء بن زياد وسفيان.
وقيل: هو عليّ، حكاه الماوردي، ولم يسم قائله، فلعله بعض الشيعة(325).
الثالث:
أن يُقال: لم يثبت هذا القول بتخصيص عليّ به عمّن قوله حجة. والحديث
المذكور كذب موضوع، وهو لم يذكر دلالة على صحته. ومجرد رواية أبي نُعيم له
لا تدل على الصحة.
الرابع: أن يُقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم
كل صالح من المؤمنين، كما في الصحيحين عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
أنه قال: "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح
المؤمنين".
الخامس: أن يُقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين
مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، كما أخبر أن الله مولاه، والمولى
يمنع أن يُراد به الموالي عليه، فلم يبق المراد به إلا الموالي ومن
المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنبي صلَّى الله
عليه وسلَّم قطعاً، فإنه لو لم يواله لم يكن من صالح المؤمنين، بل قد
يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاً، لكن لا تكون موالاة كاملة. وأما الصالح
فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً أحبَّ ما أحبه الله ورسوله،
وأبغض ما أبغضه الله ورسوله، وأمر بما أمر به الله ورسوله، ونهى عما نهى
الله عنه ورسوله. وهذا يتضمن الموالاة.
وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لابن عمر: "إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل" فما نام بعدها(326).
وقال عن أسامة بن زيد: "إنه من صالحيكم، فاستوصوا به خيراً"(327).
وأما
قوله: "والآيات في هذا المعنى كثيرة" فغايته أن يكون المتروك من جنس
المذكور، والذي ذكره خلاصة ما عندهم، وباب الكذب لا ينسد. ولهذا كان من
الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب، ولكن الله يقذف بالحق على
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وللكذّابين الويل مما يصفون.
وما ذكر
وقال: "أريد به عليّ" إذا ذكر أنه أريد به أبو بكر أو عمر أو عثمان، لم
يكن هذا القول بأبعد من قولهم، بل يرجح على قوله، لا سيما في مواضع كثيرة.
وإذا قال: فهذا لم يقله أحد، بخلاف قولنا.
كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا ممنوع، بل من الناس من يخصّ أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما.
الثاني:
أن قول القائل: خصّ هذا بواحد من الصحابة، إذا أمكن غيره أن يخصه بآخر
تكون حجته من جنس حجته؛ فإنه يدل على فساد قوله. وإن كان لم يقله، فإن
الإنسان إذا كذب كذبة لم يمكن مقابلتها بمثلها، ولم يمكنه دفع هذا إلا بما
يدفع به قوله، ووجب: إما تصديق الاثنين، وإما كذب الاثنين.
كالحكاية
المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرز(328)، قال: دخلت على بعض الشيعة - وقد
قيل: إنه عبّاد بن يعقوب(329)- فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله تعالى.
فقال: تقول من حفره؟ قلت: من حفره؟ قال: عليّ بن أبي طالب. قال: من جعل
فيه الماء؟ قلت: الله: قال: تقول من هو الذي جعل فيه الماء؟ قلت: من هو؟
قال: الحسن. قال: فلما أردت أن أقوم، قال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية،
قال: ومن الذي جعل فيه الماء؟ قلت: يزيد. فغضب من ذلك وقام(330).
وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك، وأنت تكره ذلك وتدفعه، وبما به يدفع ذلك يُدفع به قولك.
وكذلك
ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والرافضة ونحوهم. كقولهم
في قولهم: { فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ } [التوبة: 12] طلحة
والزبير وأبو بكر وعمر ومعاوية. فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم عليّ
والحسن والحسين. وكل هذا باطل، لكن الغرض أنهم يقابلون بمثل حجتهم،
والدليل على فسادها يعمّ النوعين، فعُلم بطلان الجميع.
فهرس محتوى الجزء الأول
الموضوع الصفحة
تقدمة المحقق
الفصل الأول:
الرد على من قال أن عليّاً تثبت له الولاية كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله.
الفصل الثاني:
الرد على من ادّعى أن القرآن يدل على أن إمامة عليّ فيما أمر بتبليغه صلَّى الله عليه وسلَّم.
الفصل الثالث:
الرد على المدعي بأن إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة هو دليل على إمامة علي من هذا الوجه.
الفصل الرابع:
الرد على من روى عن ابن عباس حديث وقوع النجم في دار عليّ.
الفصل الخامس:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه مطهر ومعصوم.
الفصل السادس:
الرد على من ادّعى أن بيت عليّ من بيوت الأنبياء.
الفصل السابع:
الرد على من ادّعى اختصاص عليّ بالإمامة والفضيلة بقوله بوجوب موالاته ومودته.
الفصل الثامن:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقول إنه اختص عن باقي الصحابة بفضيلة الفداء.
الفصل التاسع:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه مساوٍ للرسول صلَّى الله عليه وسلَّم لأنه عينه للمباهلة.
الفصل العاشر:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله هو مساوٍ للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم في التوسل به إلى الله تعالى.
الفصل الحادي عشر:
الرد على من روى عن ابن مسعود حديث انتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ.
الفصل الثاني عشر:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إن الله خصه بالود دون سائر الصحابة.
الفصل الثالث عشر:
الرد على من يثبت الإمامة لعليّ باعتماده على مقولة: بك يا عليّ يهتدي المهتدون.
الفصل الرابع عشر:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إن الأمة ستسأل عن ولاية عليّ وحبه.
الفصل الخامس عشر:
الرد على من روى عن أبي سعيد الخدري حديث بغض عليّ.
الفصل السادس عشر:
الرد على من قال إن فضيلة سبق عليّ إلى محمد لم تثبت لغيره من الصحابة.
الفصل السابع عشر:
الرد على من يثبت لعليّ الإمامة بدعوى أنه خص بفضيلة الإيمان والهجرة والجهاد دون غيره.
الفصل الثامن عشر:
الرد على من ادّعى أن عليّاً وحده هو الذي تصدق ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره.
الفصل التاسع عشر:
الرد على من قال إن الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية عليّ.
الفصل العشرون:
الرد على من أثبت لعليّ الإمامة بزعمه أنه أذن واعية دون غيره.
الفصل الحادي والعشرون:
الرد على من أثبت الإمامة لعليّ بجملة من الفضائل المأخوذة من سورة هل أتى.
الفصل الثاني والعشرون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بأنه اختص بفضيلة الصدق دون غيره.
الفصل الثالث والعشرون:
الرد على من يثبت الإمامة لعليّ بقوله إنه خصّ بفضيلة تأييده للرسول صلَّى الله عليه وسلَّم دون غيره من الصحابة.
الفصل الرابع والعشرون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بفضيلة متابعة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم دون غيره.
الفصل الخامس والعشرون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه أفضل الصحابة لاختصاصه بفضيلة حُبِّ الله.
الفصل السادس والعشرون:
الرد على من روى عن أحمد بن حنبل حديث الصديقون ثلاثة.
الفصل السابع والعشرون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بفضيلة الإنفاق بالليل والنهار والسر والعلانية دون غيره.
الفصل الثامن والعشرون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه أفضلهم لأن الله عاتب أصحاب محمد في القرآن عدا عليّ.
الفصل التاسع والعشرون:
الرد على من ادّعى الإمام لعليّ بقوله إن عليّاً أفضل آل محمد.
الفصل الثلاثون:
الرد على من روى عن ابن عباس تفسيره لمرج البحرين.
الفصل الحادي والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بمعرفة علم الكتاب.
الفصل الثاني والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله هو أفضل من إبراهيم ومحمد صلَّى الله عليه وسلَّم لأنه وسط وهما طرفان.
الفصل الثالث والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله هو خير البرية.
الفصل الرابع والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بمصاهرته للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
الفصل الخامس والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمام لعليّ بأنه صدّيق معصوم دون غيره.
الفصل السادس والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بفضيلة أنه أول من صلى وركع مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
الفصل السابع والثلاثون:
الرد على من روى عن ابن عباس حديث واجعل لي وزيراً من أهلي.
الفصل الثامن والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بمؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
الفصل التاسع والثلاثون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بأنه أمير على ذرية آدم كلهم.
الفصل الأربعون:
الرد على من ادّعى الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بأنه صالح المؤمنين.
تم الجزء الأول ولله الحمد.
(1) الأصول من الكافي للكليني ج2 ص18 .
(2) المصدر السابق.
(3) الأصول من الكافي للكليني ج2 ص18 .
(4) أمالي الصدوق 154، بحار الأنوار 27 ص167 .
(5) أمالي الصدوق 154، بحار الأنوار ج27، ص167 .
(6) بحار النوار 27/177-178 .
(7) بحار الأنوار 27/180 .
(8) انظر كتابنا "الشيعة وصكوك الغفران".
(9) الصف : 2 .
(10) في المصحف الشريف: فآمنوا بالله.
(11) التغابن : 8 .
(12) المنافقون : 3 .
(13) الملك : 22 .
(14) الحاقة: 40-52 .
(15) الجن : 21-23 .
(16) المزمل : 10-11 .
(17) الإنسان : 29 .
(18) الإنسان : 31 .
(19) الإنسان : 31 .
(20) البقرة : 56 .
(21) المرسلات : 16 ، 17 .
(22) المرسلات : 18 .
(23) المرسلات : 41 .
(24) النبأ : 38 .
(25) المطففين : 7 .
(26) الأصول من الكافي للكليني 1/432-435، بحار الأنوار للمجلسي ج24 ص336-340 .
(27) مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية، لأستاذنا الدكتور محسن عبد الناظر ص193-194.
(28)
لم أجد هذه الرواية في المصادر التي بين يدي رغم البحث والتنقيب، ولكن ذكر
الحاكم في المستدرك ج3 ص129 بلفظ مقارب من طريق أبي جعفر بن عبد الله بن
يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن
خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو آخذ بضبع عليّ بن أبي طالب
رضي الله عنه وهو يقول: "هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره،
مخذول من خذله" ثم مدّ بها صوته. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت بل والله موضوع وأحمد كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك.
وذكره
الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - في (تاريخ بغداد) (ج4 ص129) وقال:
ولم يروه عن عبد الرزاق غير أحمد بن عبد الله هذا، وهو أنكر ما حفظ عليه
والله أعلم.
وأيضاً ذكر البغدادي (2/377) بزيادة في آخره: أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد البيت فليأت الباب.
وقال
الحافظ بن عدي في (الكامل) (1/195) عن أحمد بن عبد الله: كان بسرّ من رأى
يضع الحديث. وقال أيضاً على الزيادة التي ذكرها الخطيب: وهذا حديث منكر
موضوع لا أعلم رواه عن عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله المؤدب هذا.
وانظر
ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر (1/197)، ميزان الاعتدال (1/109)، سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني (1/360).
ومن تدليس
بعض الروافض أمثال المرعشي النجفي الملقب بآية الله العظمى - وهو من
المعاصرين في إيران الخميني - في تعليقه على (إحقاق الحق) (4/235) ذكر هذه
الرواية ثم ذكر جملة من رواه الخطيب البغدادي والذهبي وابن حجر رحمهم الله
تعالى دون أن يذكر كلامهم حول هذه الرواية بأنها موضوعة، ليوهم القراء
بتصحيح أولئك الأعلام لهذه الرواية المكذوبة، والأمثلة على ذلك كثيرة لو
أننا تتبعنا تدليسهم وكذبهم على أعلام المسلمين. ولذا فإنني أنصح كافة
القراء الكرام بأن لا يثقوا في نقولات الرافضة عن كتب أهل السنة، ويجب
الرجوع إلى المصادر التي ذكروها والوقوف على كلام العلماء حول ذلك، ونتيجة
خبرتي المتواضعة مع كتب الرافضة رأيت أنهم ينقلون من كتب أهل السنة ما
يوافق عقيدتهم ويحذفون ما ينسف ما استشهدوا به على طريقة (فويل للمصلين)
(م).
(29) في كتابه "مناقب الإمام علي" ص311-314. (م).
(30) في كتابه "مناقب الإمام علي" ص311-314. (م).
(31)
ذكر الطبري في تفسيره (ط. المعارف) 10/425-426 خمسة آثار فيها أن المقصود
بالآية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي الأرقام. 12210-12214 ففي الأثر
الأول جاء عن السدي أنه قال: هؤلاء جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب
مرَّ به سائل وهو راكع في المسجد، فأعطاه خاتمه. وفي الآثار الثلاثة
التالية أن الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب وأنه من الذين آمنوا.
وعلق
الأستاذ محمود شاكر على الأثر 12213 وبيّن ضعف اثنين من رواته، وكذلك
الأثر التالي 12214 ذكر عن أحد رواته وهو غالب بن عبيد الله العقيلي
الجزري ما يلي: "منكر الحديث متروك مترجم في لسان الميزان والكبير للبخاري
4/1/101 وابن أبي حاتم 3/2/48".
ثم قال الأستاذ محمود: "هذا وأرجح
أن أبا جعفر الطبري قد أغفل الكلام في قوله تعالى: {وهم راكعون} وفي بيان
معناها في هذا الموضع مع الشبهة الواردة فيه، لأنه كان يجب أن يعود إليه
فيزيد فيه بياناً، ولكنه غفل عنه بعد".
ونقل الأستاذ محمود بعد ذلك
كلاماً لابن كثير في تفسير هذه الآية قال فيه: "وأما قوله: {وهم راكعون}
فقد توهم بعض الناس أن هذه في موضع الحال من قوله: {ويؤتون الزكاة} أي: في
حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك، لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من
غيره، لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء، ممن نعلمه من أئمة
الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر هذا أثراً على عليّ بن أبي طالب أن هذه الآية
نزلت فيه..." ثم ساق الآثار السالفة وما في معناها من طرق مختلفة.
ثم
قال الأستاذ محمود شاكر: "وهذه الاثار جميعاً لا تقوم بها حجة في الدين،
وقد تكلّم الأئمة في موقع هذه الجملة وفي معناها. والصواب من القول في ذلك
أن قوله {وهم راكعون} يعني به: وهم خاضعون لربهم متذللون له بالطاعة...
إلخ".
وانظر كلام ابن كثير عن الآثار التي تذكر أن الآية نزلت في عليّ رضي الله عنه وتضعيفه لها.
(32)
هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المقرئ المفسر الواعظ
الأديب اللغوي، صاحب كتاب "عرائس المجالس" في قصص الأنبياء وهو مطبوع،
و"الكشف والبيان في تفسير القرآن" وهو مخطوط، وقد توفي الثعلبي سنة 427هـ.
وانظر
ترجمته في: ابن خلكان (1/61-62)، إنباء الرواة (1/119-120)، بغية الوعاة
(ص154)، معجم الأدباء (5/36-39)، اللباب لابن الأثير (1/194)، طبقات
المفسرين للداودي (1/65-66)، الأعلام للزركلي (1/205-206)، معجم المؤلفين
(2/60).
وذكر بروكلمان في مقالته عن الثعلبي في "دائرة المعارف
الإسلامية" عن تفسير الثعلبي: وقد نقده ابن الجوزي فيما رواه ابن تغري
بُردي لأنه أخذ فيه بالروايات الضعيفة وخاصة في السور الأولى. وانظر:
البداية والنهاية (12/40) حيث يقول ابن كثير: وكان كثير الحديث واسع
السماع، ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير.
(33) هو أبو الحسن
علي بن أحمد بن محمد بن عليّ الواحدي، قال عنه الذهبي في سير أعلام
النبلاء (18/340-341): صنف التفاسير الثلاثة: "البسيط" و"الوسيط"
و"الوجيز". وبتلك الأسماء سمى الغزالي تواليفه الثلاثة في الفقه. ولأبي
الحسن كتاب "أسباب النزول" و"كتاب التحبير في الأسماء الحسنى" و"شرح ديوان
المتنبي". وكان طويل الباع في العربي واللغات... وقيل: كان منطلق اللسان
في جماعة من العلماء ما لا ينبغي.
وقال عنه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (4/104): كان أوحد عصره في التفسير. كان إماماً عالماً بارعاً محدثاً...
وانظر
ترجمته في: معجم الأدباء (12/257)، الكامل لابن الأثير (10/101)، وفيات
الأعيان (3/303)، البداية والنهاية لابن كثير (12/114)، طبقات المفسرين
للسيوطي (23)، طبقات المفسرين للداودي (1/387)، شذرات الذهب (3/330). (م).
(34)
هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، قال عنه الذهبي في
سير أعلام النبلاء (19/439): الشيخ الإمم، العلامة القدوة الحافظ، شيخ
الإسلام، محيي السنة.وقال ص441: وكان سيداً إماماً، عالماً علامة، زاهداً
قانعاً باليسير، كان يأكل الخبز وحده، فعذل في ذلك، فصار يتأدم بزيت، وكان
أبوه يعمل الفراء ويبيعها، بورك له في تصانيفه، ورزق فيها القبول التام،
لحسن قصده، وصدق نيته، وتنافس العلماء في تحصيلها، وكان لا يلقي الدرس إلا
على طهارة، وكان مقتصداً في لباسه، له ثوب خام، وعمامة صغيرة على منهاج
السلف حالاً وعقداً، وله القدم الراسخ في التفسير، والباع المديد في الفقه
رحمه الله.
وانظر ترجمته والكلام على تفسيره: وفيات الأعيان (2/136)،
تذكرة الحافظ (4/1257)، الوافي بالوفيات (13/26)، البداية والنهاية
(12/193)، النجوم الزاهرة (5/223)، طبقات المفسرين للسيوطي (12)، مقدمة في
أصول التفسير لابن تيمية (9)، التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي
(1/234)، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للشيخ محمد بن عبد
الرحمن المغراوي (1/169). (م).
(35) هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن
بقي بن مخلد ابن يزيد القرطبي، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء
(13/286): وأدخل جزيرة الأندلس علماً جماً، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك
الناحية دار حديث، وعدة مشيخته الذين حمل عنهم مئتان وأربعة وثمانون
رجلاً... وكان إماماً مجتهداً صالحاً، ربانياً صادقاً مخلصاً، رأساً في
العلم والعمل، عديم المثل، منقطع القرين، يفتي بالأثر، ولا يقلّد أحداً.
وقد تفقه بإفريقية على سحنون بن سعيد.
وانظر ترجمته في: معجم الأدباء
(7/75)، تذكرة الحفاظ (2/629)، البداية والنهاية (11/56)، النجوم الزاهرة
(3/75)، شذرات الذهب (2/169). (م).
(36) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولد سنة 240هـ، وتوفي رحمه الله تعالى 327هـ.
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/829)، مقدمة الجرح والتعديل للعلامة اليماني رحم الله تعالى الجميع. (م).
(37) هو العلامة الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد سنة 242هـ.
وانظر
ترجمته: وفيات الأعيان (4/207)، سير أعلام النبلاء (14/490)، الوافي
بالوفيات (1/336)، اللباب لابن الأثير (3/183)، تذكرة الحفاظ (3/782)،
طبقات الشافعية للسبكي (3/102)، طبقات المفسرين للسيوطي (91)، شذرات الذهب
(2/280)، الأعلام للزركلي (6/184). (م).
(38) هو الإمام الفقيه الحافظ،
محدّث الشام أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي.
ولد سنة 170هـ. أثنى عليه كثير من الأئمة أمثال: ابن أبي حاتم، النسائي،
الحاكم، الخطيب البغدادي، وابن حنبل، والدارقطني وغيرهم من أعلام هذه
الأمة.
وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (5/256)، التاريخ
الصغير له أيضاً (2/382)، تاريخ بغداد (10/265)، البداية والنهاية
(10/346)، تهذيب التهذيب (6/131)، شذرات الذهب (2/108) (م).
(39) هو
الإمام الكبير سيّد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن راهويه، ولد سنة 261هـ أشهر
من أن يعرّف به. سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: مثل إسحاق
يسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام. وقال أيضاً: لا أعرف لإسحاق في الدنيا
نظيراً. وقال الإمام النسائي: ابن راهويه أحد الأئمة، ثقة مأمون. سمعت
سعيد بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. وقال الإمام الحافظ
المتقن ابن خزيمة: والله لو كان إسحاق في التابعين، لأقرّوا له بحفظه
وعلمه وفقهه.
وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد (6/345)، سير أعلام النبلاء
(11/358)، التاريخ الكبير (1/379)، التاريخ الصغير (1/368)، وفيات الأعيان
(1/199)، تذكرة الحفاظ (2/433)، الوافي بالوفيات (8/386)، البداية
والنهاية (10/317)، تهذيب التهذيب (1/216)، النجوم الزاهرة (2/290)، شذرات
الذهب (2/89). (م).
(40) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد بن
نصر، أثنى عليه علماء هذه الأمة، من أشهر مصنفاته (المنتخب)، وقد طبع في
ثلاثة أجزاء بتحقيق الشيخ الفاضل مصطفى العدوي.
و(المنتخب) موضع عناية
ودراسة كثير من العلماء حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى قال فيه: وقد وقع
لنا المنتخب عالياً، ثم لصغار أولادنا.
انظر ترجمته في: سير أعلام
النبلاء (12/235)، تذكرة الحفاظ (2/534)، البداية والنهاية (11/4)، تهذيب
التهذيب (6/455)، شذرات الذهب (1/120). (م).
(41) هو أبو بكر عبد
الرزاق بن همّام بن نافع الحميري الصنعاني، روى عن عبيد الله بن عمر
قليلاً وعن ابن جُريج والأوزاعي والثوري، وروى عنه أحمد وإسحاق وابن معين
وغيرهم. قال أحمد: ... نقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه، بل يحبّ
عليّاً رضي الله عنه، ويبغض من قاتله. قال ابن سعد: مات في نصف شوال سنة
211 وعاش خمساً وثمانين سنة.
انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي (1/296)، شذرات الذهب (2/27)، ميزان الاعتدال (2/609-614).
(42)
هو أبو الحسن - أو أبو محمد - علي بن محمد بن محمد بن الطيب الجُلاّبي
الشافعي الواسطي ثم البغدادي الشهير بابن المغازلي المتوفي سنة 483. ولد
ببلدة واسط ثم انتقل في أواخر عمره إلى بغداد، كان شافعياً في الفقه
وأشعرياً في أصول الدين، وسمي بابن المغازلي لأن أحد أسلافه كان نزيلاً
بمحلة المغازليين في واسط. ذكر السمعاني في الأنساب أن من مؤلفاته "ذيل
تاريخ واسط" وقال إنه غرق ببغداد سنة 483 وحمل ميتاً إلى واسط ودفن بها.
ولم
أجد له ترجمة إلا في: الأنساب للسمعاني (ص146) (ط. مرجليوث) 3/446 (ط.
حيدر آباد 1383/1963)، تاج العروس للزبيدي (1/186). تبصير المنتبه بتحرير
المشتبه لابن حجر (1/380) (ط. 1383/1964)، مقدمة كتاب مناقب الإمام عليّ
بن أبي طالب لابن المغازي (ص3-29) تحقيق محمد باقر البهبودي، نشر دار
الأضواء، بيروت 1403/1983 .
(43) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه
في: سنن ابن ماجه 1/36 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم، باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ونصه: "ما نفعني مال قط
ما نفعني مال أبي بكر" قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله: هل أنا
ومالي إلا لك يا رسول الله؟".
والحديث في المسند (ط. المعارف) 13/183
وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث وخالف تضعيف البوصيري له في
زوائده، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الجامع الصغير (5/190). الحديث
أيضاً في المسند (ط. المعارف) 16/320-321 مطولاً.
(44) الحديث عن أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه في: البخاري 1/96 (كتاب الصلاة، باب الخوخة
والممر في المسجد) وأوله: خطب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: "إن الله
خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده.... الحديث.
وهو في: البخاري 5/4
(كتاب فضائل أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، باب مناقب المهاجرين، باب
قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر)، مسلم
4/1854-1855 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر..)، سنن الترمذي
5/278 (كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق) والحديث فيه عن عائشة.
وقال الترمذي "وفي الباب عن أبي سعيد". المسند (ط. الحلبي) 3/18 وفي فتح
الباري (7/14).
والخوخة طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوها، وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب.
(45)
الحدث - مع اختلاف في الألفاظ - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في:
سنن الترمذي 5/289 (كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان) وأوله: جاء
عثمان إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بألف دينار. الحديث وفيه أن النبي
صلّى الله عليه وسلّم قال: "ما ضر عثمان ما عَمِلَ بعد اليوم" مرتين. قال
الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". والحديث في: المسند (ط.
الحلبي) 5/63 .
وجاء حديث آخر في: سنن الترمذي 5/288-289 (الباب
والكتاب السابقان) عن عبد الرحمن بن خباب وفيه أنَّ النبي صلّى الله عليه
وسلّم حث جيش العمرة على العطاء فقال عثمان: يا رسول الله عليّ مائة
بعير.. ثم قدم عثمان مائتي بعير ثم ثلاثمائة بعير فقال النبي صلّى الله
عليه وسلّم: "ما على عثمان ما عَمِل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد
هذه". قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" رجاء هذا الحديث مرتين
في كتاب "فضائل الصحابة" 1/504، 505 (حديث رقم 822، 823) وقال المحقق عن
كل من الحديثين: "إسناده ضعيف".
قال أبو عبد الرحمن: تطوع عثمان رضي
الله عنه لجيش العسرة ثابت من عدة طرق، وقد ذكرتها في مقدمة الجزء الرابع
من "سلسلة شبهات حول الصحابة والرد عليها" الخاص بذي النورين رضي الله
عنه. وإن شئت الوقوف على الكتب التي ذكرت هذه الروايات، انظر: موسوعة
أطراف الحديث النبوي لأبي هاجر محمد السعيد (9/161 و172).
(46) الحديث
- مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في: البخاري
5/8 (كتاب أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، باب قول النبي صلّى الله
عليه وسلّم لو كنت متخذاً خليلاً)، مسلم 4/1967-1968 (كتاب فضائل الصحابة،
باب تحريم سب الصحابة..)، سنن أبي داود 4/297-298 (كتاب السنة، باب في
النهي عن سباب أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم)، سنن الترمذي
5/357-358 (كتاب المناقب، باب في سب أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم)،
المسند (ط. الحلبي) 3/11، 54، 63-64، سنن ابن ماجه 1/57 (المقدمة، باب فضل
أهل بدر).
وفي اللسان: "المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع، وهو قدر مد
النبي صلّى الله عليه وسلّم، والصاع خمسة أرطا، وقال النووي (شرح مسلم
16/93): "وقال أهل اللغة: النصيف النصف... ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد
ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مُدّاً ولا نصف مُدّ".
(47)
في سيرة ابن هشام (3/106): "فلما انتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: "اغسلي عن هذا دمه يا بنيّة،
فوالله لقد صدقني اليوم" وناولها علي بن أبي طالب سيفه، فقال: وهذا أيضاً
فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم، فقال رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم: "لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة". وذكر
ابن كثير في البداية والنهاية (4/47) روايات أخرى منها: "لئن كنت أحسنت
القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنيف".
(48)
الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في: البخاري 5/35 (كتاب مناقب
الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه) ونصه: "اهتز عرش الرحمن
(أو: العرش) لموت سعد بن معاذ". والحديث عن جابر وأنس بن مالك رضي الله
عنهما في: مسلم 4/1915-1916 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن
معاذ رضي الله عنه)؛ سنن الترمذي 5/353 (كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن
معاذ..) وقال الترمذي: "وفي الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد رُميثة".
والحديث في سنن ابن ماجه ومسند أحمد.
(49) الحديث عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه: البخاري 1/96 (كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد)
وأوله: خطب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن الله خيّر عبداً بين
الدنيا وبين ما عنده... الحديث، وهو في البخاري 5/4 (كتاب فضائل أصحاب
النبي صلّى الله عليه وسلّم، باب مناقب المهاجرين، باب قول النبي صلّى
الله عليه وسلّم: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر)، مسلم 4/1854-1855 (كتاب
فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر...)، سنن الترمذي 5/278 ) كتاب
المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق)، والحديث فيه عن عائشة. وقال الترمذي:
"وفي الباب عن أبي سعيد" المسند (ط. الحلبي) 3/18.
(50) هذا جزء من حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وسيرد الحديث كاملاً فيما بعد انظر ص182.
(51)
هو عطية بن سعد العوفين قال عنه ابن حبان في "المجروحين" ج2 ص176: كنيته
أبو الحسن من أهل الكوفة، يروي عن أبي سعيد الخردي. روى عنه فراس بن يحيى
وفضيل بن مرزوق. سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات أبو سعيد جعل
يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا فيحفظه
وكنّاه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدّثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو
سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد به الكلبي. فلا يحل
الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.
وانظر ترجمة العوفي في:
تهذيب
التهذيب ج7 ص224 ترجمة رقم 413، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج2 ص180
ترجمة رقم 2321، سؤالات أبي عبيد الآجري ص105 ترجمة رقم 24، ميزان
الاعتدال ج3 ص79 ترجمة رقم 5667، الضعفاء الكبير للعقليل ج3 ص359 ترجمة
رقم 1392. (م).
(52) في "لسان العرب": "الضّبْعُ، بسكون الباء: وسط
العَضُد بلحمه يكون للإنسان وغيره. وقيل: العَضُدَ كلها، وقيل: الإبط..
وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه، تقول: أخذ بضبعيه، أي بعضديه".
(53)
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي، قال عنه الخطيب
البغدادي في تاريخه (2/201): وكان عالماً بحروف القرآن، حافظاً للتفسير،
صنّف فيه كتاباً سمّاه "شفاء الصدور"، وله تصانيف في القراءات وغيرها من
العلوم.
وقال أيضاً (2/202) : في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.
وقال
الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/576) : قد اعتمد الدّاني في "التيسير"
على رواياته للقراءات. فالله أعلم، فإن قلبي لا يسكن إليه، وهو عندي متهم،
عفا الله عنه.
وانظر ترجمته في:
وفيات الأعيان (4/298)، تذكرة
الحفاظ (3/908)، ميزان الاعتدال (3/520)، الوافي بالوفيات (2/345)،
البداية والنهاية (11/242)، لسان الميزان (5/132)، شذرات الذهب (3/8). (م).
(54)
قال الذهبي في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد الله الحافظ) في
"ميزان الاعتدال 1/111: "قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها
منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا - ولا يبين. قلت: هذا مذهب رآه أبو نعيم
وغيره وهو ضرب من التدليس. وكلام ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب
حكايته، ولا أقبل قول كل منهما في الآخر؛ بل هما عندي مقبولان، ولا أعلم
لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها". وانظر: لسان الميزان
(1/201-202).
(55) ذكر ابن الجوزي هذا الحديث الموضوع - وهو جزء من
حديث طويل منسوب إلى أبي هريرة - في الموضوعات (2/109-110) وقال: "موضوع
ورجاله ثقات والظاهر أن بعض المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد" وذكره
السيوطي في "الجامع الصغير" ونسبه إلى أبي سعيد وضعفه الألباني في "ضعيف
الجامع الصغير" 6/256.
قال أبو عبد الرحمن: رحم الله تعالى المحقق وغفر
له، فإن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الموضوع في كتابه
الموضوعات، ولكن ليس في الموضع الذي ذكره المحقق رحمه الله تعالى، حيث إن
ابن الجوزي ذكره في ج2 ص200-201 ولم يقل: موضوع ورجاله ثقات... وإنما قال:
هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه.
ولقد أبدع من وضعه وكشف القناع ولم يستحي وأتى فيه المستحيل...
والمحقق
رحمه الله تعالى اعتمد على نقل ابن عراق في "تنزيه الشريعة" ج2 ص105، حيث
ذكر ابن عراق قول ابن الجوزي الذي نقله المحقق رحمة الله تعالى على الجميع.
وهذا الحديث الموضوع ذكره ابن حجر في لسان الميزان ج5 ص302 والشوكاني في "الفوائد المجموعة" 96-97.
(56)
الحديث بلفظ "الأئمة من قريش" ذكره الألباني في "إرواء الغليل" 2/298-301
(حديث رقم 520) وقال: صحيح، ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن
مالك وعليّ بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي" ثم تكلم على طرقه المختلفة.
والحديث عن أنس رضي الله عنه مطولاً في المسند (ط. الحلبي) 3/129 وأوله:
"الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك.. الحديث" وقال السيوطي عنه:
"حم = مسند أحمد، ن = سنن النسائي، الضياء المقدسي" وصححه الألباني، وقال
في "إرواء الغليل" إن الطيالسي أخرجه في مسنده وابن عساكر وأبو نعيم في
"الحلية" والبيهقي في سننه.. إلخ.
وأما حديث عليّ رضي الله عنه فأوله:
"الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها... الحديث.
وقال السيوطي إن البيهقي والحاكم أخرجاه، وذكر الألباني أنه في "المستدرك"
4/75-76 وفي المعجم الصغير للطبراني (ص85) وفي "مجمع الزوائد" 5/192 وفي
غير ذلك، وهو صحيح عند الألباني أيضاً. وحديث أبي برزة في المسند (ط.
الحلبي) 4/421، 424، وذكره الألباني في "السنة" لابن أبي عاصم (رقم 9، 10،
1029).
(57) الحديث في سنن أبي داود 4/293 (كتاب السنة، باب في
الخلفاء)، سنن الترمذي 3/341 (كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة) وقال
الترمذي: (هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا
من حديثه المستدرك للحاكم 3/71.
وتكلم الأستاذ محب الدين الخطيب
(المنتقى من منهاج الاعتدال ص57 ت2) على سند الحديث وبيّن ضعفه وأشار إلى
عدم تصحيح ابن العربي له في العواصم من القواصم، ص201، القاهرة 1371، ولكن
الألباني صحح الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 3/118 .
(58) انظر "العواصم من القواصم" لابن العربي (ط. دار الكتب السلفية، القاهرة، 1405هـ) ص175-182، للوقوف على حقيقة التحكيم (م).
(59)
انظر: البخاري 1/93، 4/21، مسلم 4/2235-2236 المسند (ط. المعارف) الأرقام:
6499، 6500، 6538، 6926، 6927 وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه
الأحاديث كلها وتكلم عليها.
(60) حديث الموالاة صحيح، ولكن الزيادة:
"وانصر من نصره، واخذل من خذله" لا أساس لها من الصحة، وقد تكلم العلامة
الألباني حول أحاديث الموالاة وصححها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ج4
ص330-344. وقال عن تلك الزيادة: ففي ثبوته عندي وقفة، لعدم ورود ما يجبر
ضعفه. (م).
(61) الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه في: البخاري 1/14 (كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه)
6/50 (كتاب التفسير، سورة المائدة)؛ مسلم 4/2312-2313 (كتاب التفسير، حديث
رقم 3، 4، 5)، سنن الترمذي 4/316 (كتاب التفسير، سورة المائدة)، سنن
النسائي 8/100 (كتاب الإيمان وشرائعه، باب زيادة الإيمان)، المسند (ط.
المعارف) 1/237؛ تفسير ابن كثير 3/24.
(62) كلام ابن تيمية رحمه الله
تعالى وغفر له ليس على إطلاقه، بل خالفه كثير من المحدثين في ذلك، وسيأتي
الكلام مفصلاً في "الفصل الثاني" من "الباب الثاني" من هذا الكتبا. (م).
(63) الحديث بهذه الألفاظ في: المسند (ط. الحلبي) 3/350 إلا أن فيه: أحد ممن بايع.
وجاء الحديث عن أم مبشر رضي الله عنهما في: مسلم 4/1942 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة).
وجاء الحديث عن حفصة في:
سنن
ابن ماجه 2/1431 (كتاب الزهد، باب ذكر البعث). وذكر أحمد رواية مسلم في
مسنده (ط. الحلبي) 6/420. وذكر روايتين أخريين بألفاظ مقاربة أو فيهما: لا
يدخل النار أحد - وفي رواية: رجل - شهد بدراً والحديبية): 3/396، 6/285،
362 .
(64) الحديث - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه في: مسلم 4/1942 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر
رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة)، المسند (ط. الحلبي) 6/326.
(65) انظر تفسير ابن كثير للآية (ط. الشعب) 7/308-309 وقد ذكر الأحاديث الواردة في هذا الأمر. وسبق الحديث فيما مضى ص61 .
(66) الحديث في سنن أبي داود 4/300 (كتاب السنة، باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم).
(67)
الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في: مسلم 2/745-746 (كتاب الزكاة،
باب ذكر الخوارج وصفاتهم)، سنن أبي داود 4/300 (كتاب السنة، باب ما يدل
على ترك الكلام في الفتنة)، المسند (ط. الحلبي) 3/32، 48 .
(68) الحديث
- مع اختلاف في الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة، وعقبة بن عامر، وثوبان،
وجابر بن عبد الله، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم - رضي الله عنهم - في
أربعة مواضع في: البخاري 4/85 (كتاب فرض الخمس، باب فإن لله خمسه)، 4/207
(كتاب المناقب، باب حدثني محمد بن المثنى، حدثنا معاذ باب رقم 28) 9/101
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على
الحق يقاتلون وهم أهل العلم) 9/136 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:
{إنما قولنا لشيء}.
والحديث في: مسلم 1/137 (كتاب الإيمان، باب نزول
عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم)،
3/1523-1525 (كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين...).
وسنن
أبي داود 3/8 (كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصين رضي
الله عنه، 4/138-139 (كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها).
وسنن الترمذي (3/342 (كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين)، والحديث في سنن ابن ماجه والدارمي ومواضع كثيرة في مسند أحمد.
(69)
الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في: مسلم 3/1525 (كتاب الإمارة،
باب لا تزال طائفة..). قال النوري في شرحه على مسلم 14/68؛ (.. وقال معاذ:
هم بالشام، وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما
وراء ذلك).
(70) قال ياقوت في "معجم البلدان": "البيرة في عدة مواضع منها بلد قرب سُمَيْساط بين حلب والثغور الرومية، وهي قلعة حصينة".
(71)
قال ياقوت في "معجم البلدان": "هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي
قصبة ديار مضر، بينهما وبين الرُّها يوم وبين الرقة يومان".
(72) قال
ياقوت: "الرّقّة: بفتح أوله وثانيه وتشديده.. وهي مدينة مشهورة على الفرات
بينها وبين حرّان ثلاثة اثام، معدودة في بلاد الجزيرة، لأنها من جانب
الفرات الشرقي".
(73) قال ياقوت في "معجم البلدان": "سُمَيْسَاط: بضم
أوله وفتح ثانيه ثم ياء من تحت ساكنةوسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة،
مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات".
(74) في كتابه "مناقب الإمام علي" ص266 و310 (م).
(75) 1/372-373.
…قال أبو عبد الرحمن: انظر: ميزان الاعتدال (2/45)، لسان الميزان (2/449)، اللآلئ للسيوطي (1/357-358).
(76) ذكر ابن الجوزي سياقاً طويلاً يبدأ بقوله: حدثت عن عبد الله بن الحسين.. إلخ.
(77) الموضوعات: من عجائب ربّه.
(78) هذا النجم: زيادة من "الموضوعات".
(79) الموضوعات: قال: فطلبوا...
(80) الموضوعات: وهوى إلى أهل بيته.
(81) الموضوعات: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
(82) بعد كلامه السابق مباشرة.
(83) الموضوعات 1/273: منها أبو صالح باذام وهو كذّاب وكذلك...
(84) الموضوعات: قال المصنّف: قلت: والعجب.
(85) من تغفيل: كذا في "الموضوعات".
(86) الموضوعات: العقول.
(87) الموضوعات: ويثبت حتى يرى.
(88) الموضوعات: في زمن..
(89) بعد كلامه السابق مباشرة.
(90)
بدلاً من عبارة "ورووه بإسناد غريب" ذكر في "الموضوعات" الإسناد عن حمد بن
نصر بن أحمد.. إلى أن وصل إلى: "أبو الفضل نصر بن محمد بن يعقوب العطّار"
ثم استمر في ذكر السند..
(91) الموضوعات: قال حدثنا سليمان بن أحمد
بن يحيى بن عثمان المصري، قال حدثنا أبو قضاعة ربيعة بن محمد الطائي، قال:
حدثنا ثوبان بن إبراهيم المصري، قال: حدثنا مالك بن غسّان النهشلي، قال:
حدثنا ثابت عن أنس بن مالك.
(92) الموضوعات: الخليفة.
(93) قد: ليست في "الموضوعات".
(94) الموضوعات: عليّ بن أبي طالب.
(95) الموضوعات: جماعة من الناس.
(96) الموضوعات: عليّ بن أبي طالب.
(97) الموضوعات: والنجم إذا هوى، إلى قوله: وحي يوحى.
(98) بعد كلامه السابق مباشرة.
(99) في "الموضوعات": وهذا هو الحديث المتقدم.
(100) الموضوعات: إنما سرقه.
(101) الموضوعات: فغيّروا.
(102) الموضوعات: في زمن.
(103) الموضوعات: وأبو الفضل.
(104) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مسلم 4/1883 (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم).
(105)
الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها في: سنن الترمذي 5/30 (كتاب التفسير،
سورة الأحزاب)، 5/328 (كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم)، المسند (ط. الحلبي) 6/293، 298، 304. وهو جزء من حديث مطول
عن ابن عباس في المسند (ط. المعارف) 5/25-27.
(106) الحديث عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه في: سنن الترمذي 4/344 (كتاب تفسير القرآن، سورة
التوبة حديث رقم 5097) ونصه: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى
من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هو مسجدي هذا".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا
الوجه.." والحديث في سنن النسائي 2/30 (كتاب المساجد، باب ذكر المسجد الذي
أسس على التقوى)؛ المسند (ط. الحلبي) 3/8، 5/116، 331، 335.
(107)
الحديث عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما في: البخاري 2/61 (كتاب فضل
الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت) ونصه: "كان
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً، وكان
عبد الله رضي الله عنه يفعله". وجاء ذلك ضمن حديث في الباب الذي قبله (باب
مسجد قباء) 2/60-61. والحديث في: مسلم 2/1017 (كتاب الحج، باب فضل مسجد
قباء...).
(108) ذكر الحديث السيوطي في "الجامع الصغير" بلفظ: "آل محمد
كل تقي" وقال: "طس (الطبراني في الأوسط) عن أنس" وقال الألباني عنه في
"ضعيف الجامع الصغير وزيادته": "ضعيف جداً".
(109) الحديث عن أبي حميد
الساعدي رضي الله عنه في: البخاري 4/146 (كتاب الأنبياء، باب حدثنا موسى
بن إسماعيل..) ونصه: أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته،
كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على
إبراهيم، إنك حميد مجيد".
والحديث في مسلم 1/306 (كتاب الصلاة، باب
الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد التشهد)، الموطأ 1/165 (كتاب
قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصلاة على النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم)، سنن النسائي 3/42 (كتاب السهر، باب كيف الصلاة على النبي... نوع
آخر)، سنن ابن ماجه 1/293 (كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة على النبي).
(110)
الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في: البخاري 8/6 (كتاب الأدب، باب
يَبُلُّ الرحم ببلالها) ونصه: أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم جهاراً غير سر يقول: "إن آل أبي - قال عمرو (وهو عمرو بن
عباس): وفي كتاب محمد بن جعفر (الذي روى عنه عمرو بن عباس) ببياض - ليسوا
بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين". والحديث في: مسلم 1/197 (كتاب
الإيمان، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم...)؛ المسند (ط. الحلبي)
4/203.
(111) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، لكن جاء الحديث مطولاً عن معاذ
بن جبل رضي الله عنه في: المسند (ط. الحلبي) 5/235 ونصه.. عن معاذ بن جبل
قال: لما بعثه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى اليمن خرج معه رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسوله الله صلَّى الله
عليه وسلَّم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: "يا معاذ إنك عسى أن لا
تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبر" فبكى معاذ جشعاً
لفراق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو
المدينة فقال: "إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا". وصحح
الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 2/181-182. وقال ابن الأثير في
"النهاية في غريب الحديث": "والجشع الجزع لفراق الإلف".
(112)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: مسلم 1/218 (كتاب الطهارة، باب
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ونصه.. عن أبي هريرة أن رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم
مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنّا قد رأينا إخواننا".
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال: "أنتم أصحابي وإخواننا الذين
لم يأتوا بعد". فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟
فقال: "أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرٌّ محجلة بين ظهري خيل دُهْمٍ بُهْمٍ،
ألا يعرف خيله؟" قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "فإنهم يأتون غرّاً محجلين
من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن عن حوضي كما يذاد البعير
الضال. أناديهم: ألا هلمّ، فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك، فأقوال: سُحقاً
سًحقاً".
والحديث في سنن النسائي 1/79 (كتاب الطهارة، باب حلية
الوضوء)؛ سنن ابن ماجه 2/1439-1440 (كتاب الزهد، باب ذكر الحوض)؛ الموطأ
1/28-29 (كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء)؛ المسند (ط. المعارف) 15/152،
18/56-57 وجاء الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 6/107 وقال السيوطي إن
الحديث في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه.
(113) الحديث - مع اختلاف في
الألفاظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 1/145 (كتاب الأذان، باب
ما يقول بعد التكبير)، مسلم 1/419 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما
يقال بين تكبير الإحرام والقراءة)، سنن أبي داود 1/288-289 (كتاب الصلاة،
باب السكتة عند الافتتاح)، سنن النسائي 1/45 (كتاب الطهارة، باب الوضوء
بالثلج). والحديث في سنن ابن ماجه والدارمي ومسند أحمد.
(114) حديث
الإفك حديث طويل جاء عن عائشة رضي الله عنها. والحديث في البخاري
3/173-176 (كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً)، 5/116-120
(كتاب المغازي، باب حديث الإفك)، 6/76-77 (كتاب التفسير، سورة يوسف)، مسلم
4/2129-2138 (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك...)، المسند (ط. الحلبي)
6/194-197.
(115) الحديث عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في: سنن ابن
ماجه 1/52 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم، فضل عمّار بن ياسر)، المستدرك للحاكم 3/188 وقال: "هذا حديث صحيح
الإسناد ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "صحيح".
والحديث أيضاً في: مصنف ابن أبي شيبة 12/118. وانظر تعليق المحقق.
(116) انظر تفسير آية (36) من سورة النور في تفسير الطبري، وابن كثير، وزاد المسير، وتفسير الفخر الرازي (3/24).
(117) لم أجد هذا الحديث.
(118)
الحديث مع اختلافي الألفاظ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في: البخاري
4/178-179 (كتاب المناقب، باب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)،
6/129 (كتاب التفسير، سورة الشورى)، المسند (ط. المعارف) 3/320-321، 4/205.
(119)
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 7/284-285: "ثم في المراد بقرابته قولان:
أحدهما: عليّ وفاطمة وولداها. وقد رووه مرفوعاً إلى رسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم". وقال محقق الكتاب تعليقاً على ذلك: "قال السيوطي في "الدر"
6/7: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: { قُل لا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى }.
قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: علي وفاطمة
وولداها.
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف" وقال: في سنده
حسين الأشقر ضعيف ساقط. قال: وقد عارضه ما هو أولى منه؛ ففي البخاري من
رواية طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية، فقال سعيد بن جبير: قربى
آل محمد صلَّى الله عليه وسلَّم. فقال ابن عباس: عجِلتَ، إن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة... الحديث.
(120)
لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكن جاء الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي
الله عنه في: سنن الترمذي 5/317-318 (كتاب المناقب، باب مناقب أبي
الفضل... وهو العباس بن عبد المطلب) ولفظ الحديث في الترمذي: "... أن
العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مغضباً
وأنا عنده، فقال: "ما أغضبك؟" قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا
تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا بغير ذلك، قال: فغضب رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى احمرّ وجهه، ثم قال: "والذي نفسي بيده لا
يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله" ثم قال: "يا أيها الناس من
آذى عمّي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه". قال الترمذي: "هذا حديث
حسن صحيح".
وجاء هذا الحديث في المسند (ط. المعارف) 3/206، 207، 210،
(ط. الحلبي) 4/165) وجاء الحديث بألفاظ مقاربة في: سنن ابن ماجه 1/50
(المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله...، فضل العباس بن عبد المطلب).
وضعف الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 6/46 حديث الترمذي وأحمد ولكن قال
إن الطرف الآخر منه صحيح.
(121) الحديث بلفظ مقارب عن النعمان بن بشير
رضي الله عنه في: مسلم 4/1999-2000 (كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم
المؤمنين وتعاطفيهم وتوادهم). وجاء الحديث عنه بألفاظ أخرى فيه وفي:
البخاري 8/10 (كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم) وأوله في البخاري:
ترى المؤمنين في تراحمهم والحديث في: المسند (ط. الحلبي) 4/270.
وتكلم عليه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 3/71 (حديث رقم 1083).
(122)
الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في البخاري 5/5 (كتاب فضائل أصحاب
النبي...، باب قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: لو كنت متخذاً خليلاً)،
مسلم 4/1856 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر...)، سنن الترمذي
5/365 (كتاب المناقب، باب من فضل عائشة...)، المسند (ط. الحلبي) 4/203.
(123)
الحديث في: البخاري 5/7 (كتاب فضائل أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم،
باب مناقب أبي بكر الصديق) 8/168-171 (كتاب الحدود، باب رجم الحبلى)،
المسند (ط. المعارف) 1/323-327.
(124) لم أجد هذا الحديث الموضوع في كتب الحديث والسيرة، وانظر ما يلي في الصفحات التالية.
(125)
الحديث عن عائشة رضي الله عنها في البخاري 5/58-60 (كتاب مناقب الأنصار،
باب هجرة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه إلى المدينة).
(126) المقابلة على النص التالية مع "سيرة ابن هشام" 2/126-128.
(127) سيرة ابن هشام: جبريل عليه السلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: ...
(128) سيرة ابن هشام: عتمة من الليل.
(129) ابن هشام: مكانهم قال لعلي بن أبي طالب.
(130) ابن هشام: وتسج.
(131) ابن هشام: قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال...
(132) ابن هشام: أبو جهل بن هشام
(133) ابن هشام: جِنان كجنان...
(134) ابن هشام: ثم جُعلت...
(135) ابن هشام: وخرج عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
(136) نعم: ليست في "ابن هشام".
(137) بعد عبارة "فلا يرونه" توجد ثلاثة أسطر في "ابن هشام" اختصرها ابن تيمية.
(138) ابن هشام: إلا وقد وضع على...
(139) ابن هشام: يتطلّعون.
(140) ابن هشام: متسجياً.
(141) ابن هشام: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا.
(142) ابن هشام (2/128): قال ابن إسحاق: وكان مما أنزل الله عزَّ وجلَّ من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له.
(143)
ابن هشام: ذكر الآية التالية 31 من سورة الطور ثم ذكر أربعة أسطر اختصرها
ابن تيمية ثم قال: قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيه صلَّى الله عليه
وسلَّم.
(144) ابن هشام: عند ذلك في الهجرة.
(145) الترمذي 5/300
(كتاب المناقب، مناقب علي بن أبي طالب، باب 85) ونصه: عن ابن عمر قال: آخى
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين أصحابه، فجاء عليٌّ تدمع عيناه،
فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد: فقال له رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "أنت أخي في الدنيا والآخرة". قال الترمذي:
"هذا حديث حسن غريب وفيه عن زين بن أبي أوفى". وذكر الألباني الحديث في
"ضعيف الجامع الصغير" 2/14 وذكر السيوطي: "ت (الترمذي)، ك (الحاكم) عن ابن
عمر" وقال الألباني: "ضعيف جداً". وذكره التبريزي في "مشكاة المصابيح"
3/243-244.
(146) الحديث في المستدرك للحاكم 3/398 وقال الحاكم: "صحيح
على شرط مسلم ولم يخرجاه". ونسب الطبري في تفسيره هذا الكلام لعمر بن
الخطاب رضي الله عنه وقال إن الآية نزلت في صهيب، وكذا قال ابن كثير في
تفسيره، ولكنه قال بعد ذلك: قال ابن مردويه وساق بسنده - وذكر خبر هجرة
صهيب رضي الله عنه إلى أن قال: حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم فقال: "ربح صهيب، ربح صهيب" مرتين. وانظر: "زاد المسير"
لابن الجوزي.
(147) في تفسيره (ط. المعارف) 4/247-248.
(148) تفسير الطبري: ثم اختلف.
(149) انظر (4/247).
(150) تفسير الطبري: نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانهم.
(151) تفسير الطبري: حدثني حجاج.
(152) تفسير الطبري: عن ابن جريج.
(153) بعد "عكرمة" أورد الطبري الآية.
(154) تفسير الطبري: في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري جندب بن السكن.
(155) تفسير الطبري: حتى قدم على النبي عليه السلام.
(156) ذكر الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه 4/248 (ت1): أن المطبوعة كانت محرفة إلى: منقذ بن عمير، وتكلم على قنفذ رضي الله عنه.
(157) تفسير الطبري: وخلّى.
(158) ترك ابن تيمية تسعة أسطر من تفسير الطبري بعد كلمة "سبيله".
(159) تفسير الطبري: بل عنى...
(160) تفسير الطبري: أو أمر.
(161) انظر تفسير الطبري (4/250-251).
(162)
الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في : مسلم 4/1871 (كتاب فضائل
الصحابة، باب من فضائل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه) وهو حديث طويل
أوله: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسبّ أبا التراب؟
الحديث، والكلام الذي أورده ابن تيمية في آخر الحديث.
(163) في "مسلم" ذكر جزء من الآية حتى قوله "وأبناءكم" فقط.
(164)
الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في: البخاري
4/36-37 (كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) ونصه:
"عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه. فقال
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم"؟
والحديث بألفاظ مقاربة في:
سنن
النسائي 6/37-38 (كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف)، المسند (ط.
المعارف) 3/51 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه: "إسناده ضعيف
لانقطاعه".
وقال ابن حجر في "فتح الباري" 6/88-89 عن رواية البخاري:
"ثم إن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو
محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن
أبيه عند الإسماعيلي.... وكذا أخرجه هو والنسائي).
وجاء حديث آخر
بألفاظ مقاربة عن أبي الدرداء رضي الله عنه: سنن أبي داود 3/32 (كتاب
الجهاد، باب الانتصار برُذُل الخيل والضعفة)، المسند (ط. الحلبي) 5/198.
(165) الحديث بهذا اللفظ تقريباً عن البراء بن عازب رضي الله عنه في: المسند (ط. الحلبي) 4م283، 284، 297، 304.
ووجدت
حديثاً مقارباً عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: مسلم 4/1808 (كتاب
الفضائل، باب رحمته صلَّى الله عليه وسلَّم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل
ذلك) وأوله: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم.. وفيه. قال عمرو: (بن سعيد وهو الراوي عن أنس): فلما توفي إبراهيم
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إن إبراهيم ابني، وإنه مات في
الثدي، وإن له لظئرين تُكمِّلان رضاعه في الجنة".
مات في الثدي: أي مات وهو في سن رضاع الثدي، والظئر: هي المرضعة ولد غيرها.
والحديث
في: المسند (ط. الحلبي) 3/112. وجاء حديثان ضعيفان فيهما أن رضاعة إبراهيم
تتم في الجنة في: سنن ابن ماجه 1/484 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة
على ابن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وذكرته وفاته).
(166) انظر "مناقب الإمام علي" ص63. (م).
(167)
لم أستطع العثور على هذا الحديث الموضوع في كتاب "الموضوعات" لابن الجوزي.
قال أبو عبد الرحمن: انظر: اللآلئ للسيوطي (1/210)، تنزيه الشريعة
(1/295)، الفوائد المجموعة للشوكاني (394).
(168) ذكر سزكين من كتب
الدارقطني المخطوطة كتاب "الفوائد الأفراد" وكتاب "الفوائد المنتقاة
الغرائب الحسان". انظر: سزكين م1 ج1 ص422.
(169) النظر في هذا: زاد المسير لابن الجوزي 1/69؛ تفسير ابن كثير (ط. الشعب) 1/116.
(170) "مناقب الإمام علي" ص277. (م).
(171)
لم أجد هذا الحديث الموضوع. وانظر تفسير ابن كثير للآية (1/237-242 (ط.
الشعب)، وقال في تفسيره لقوله تعالى: { قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }: "ولما جعل الله إبراهيم إماماً سأل الله
أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك، وأخبر أنه سيكون من
ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله، ولا يكونون أئمة فلا يقتدي بهم".
وانظر: زاد المسير (1/139-141)؛ الدر المنثور للسيوطي (1/118).
(172)
لم أجد هذين الحديثين. وذكر ابن الجوزي في "زاد المسير" 5م266 ما قبل من
أن ابن عباس قال إن الاية نزلت في عليّ ولم يعلق على ذلك.
(173) انظر
تفسير ابن كثير للآية وانظر الحديث الصحيح الذي ذكره في تفسير الآية، وهو
عن أبي هريرة أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إذا أحب الله عبداً
نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه، فينادي في السماء، ثم ينزل له
المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عزَّ وجلَّ: { إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا
}" قال ابن كثير: "ورواه مسلم والترمذي، كلاهما عن عبد الله، عن قتيبة، عن
الدراوردي به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(174) هو أبو شجاع شيروية بن
شهردار بن شيروية بن فنا خسرو الديليم الهمدذاني، مؤرخ ومحدّث، ولد سنة
445 وتوفي سنة 509، له كتاب "فردوس الأخيار" كتاب كبير في الحديث، اختصره
ابن شهردار ثم اختصر المختصر ابن حجر العسقلاني.
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية (7/111-112) (وقال: وكان يلقب إنكيا)، الأعلام (3/268)، معجم المؤلفين (4/313)، كشف الظنون (1254).
(175)
روى الطبري هذا الحديث الموضوع في تفسيره (ط. المعارف) 16/357 فقال:
"حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال:
حدثن معاذ بن مسلم بيّاع الهروي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس قال: لما نزلت: "إنما أنت منذر ولكل قومٍ هادٍ" وضع صلَّى الله
عليه وسلَّم يده على صدره، فقال: أنا المنذر "ولكل قوم هاد" وأومأ بيده
إلى منكب عليّ، فقال: أنت الهادي يا عليّ، بك يهتدي المهتدون بعدي".
قال
أستاذي الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث الموضوع:
"والحسن بن الحسين الأنصاري العرني" كأنه قيل له: "العرني" لأنه كان يكون
في مسجد "حبة العرني"، كان من رؤساء الشيعة، ليس بصدوق، ولا تقوم به حجة.
وقال ابن حبان: "يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات والمناكير".
مترجم في ابن أبي حاتم (1/2/6)، وميزان الاعتدال (1/225)، ولسان الميزان (2/198).
ومعاذ
بن مسلم بياع الهروي، لم يذكر بهذه الصفة "بياع الهروي" في غير التفسير،
والهروي ثياب تنسب إلى هراة. وجعلها في المطبوعة: "حدثنا الهروي" فأفسد
الإسناد إفساداً.
ومعاذ بن مسلم مجهول، هكذا قال ابن أبي حاتم، وهو
مترجم في ابن أبي حاتم (4/1/248)، وميزان الاعتدال (3/178). وجعلها في
المطبوعة: "حدثنا الهروي" فأفسد الإسناد إفساداً.
ومعاذ بن مسلم مجهول، هكذا قال ابن أبي حاتم، وهو مترجم في ابن أبي حاتم (4/1/248)، وميزان الاعتدال (3/178)، ولسان الميزان (6/55).
وهذا
خبر هالك من نواحيه، وقد ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمة "الحسن بن الحسين
الأنصاري" قالا بعد أن ساقا الخبر بإسناده ولفظه، ونسبته لابن جرير أيضاً؛
"معاذ نكرة، فلعل الآفة منه"، وأقول: بل الآفة من كليهما: الحسن بن
الحسين، ومعاذ بن مسلم". وانظر ما ذُكر عن هذا الحديث في "مختصر التحفة
الإثني عشرية" ص157.
(176) في تفسيره (ط. المعارف) 16/353-354.
(177) تفسير الطبري ... بشر قال حدثنا.
(178) أدمج ابن تيمية السندين معاً (20138، 20139).
(179) في تفسير الطبري: قال حدثنا وكيع عن سفيان.
(180) "حدثنا يونس" هذه العبارة وما بعدها في "تفسير الطبري 16/356 وفيه: حدثني يونس.
(181) تفسير الطبري: قال أخبرنا ابن وهب.
(182) تفسير الطبري: قال ابن زيد في قوله: "ولكل قوم هاد". قال: لكل قوم نبي.
(183) تفسر الطبري: النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
(184) تفسير الطبري: أيضاً النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
(185) تفسير الطبري: قال.
(186) عبارة "حدثنا بشار" في تفسير الطبري قبل الكلام السابق 16/355 وفيه: حدثنا محمد بن بشار قال:..
(187) تفسير الطبري: محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.
(188)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كلامه على هذا الحديث في "سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" 1/78-79 (حديث رقم 58) إنه حديث موضوع ونقل
كلام ابن عبد البر وابن حزم في هذا الصدد. وانظر الأحاديث التالية: 59،
60، 61، 62 فهي مقاربة في المعنى وكلها أحاديث موضوعة.
(189) في "مختصر
التحفة الاثني عشرية": ".. وهذه الرواية واقعة في فردوس الديلمي الجامع
للأحاديث الضعيفة الواهية، ومع هذا فقد وقع في سندها الضعفاء والمجاهيل
الكثيرون...".
قال أبو عبد الرحمن: ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هذه
الرواية الموضوعة في ترجمة "علي بن حاتم أبو معاوية" في لسان الميزان ج4
ص211-212 ترجمة رقم 559 وقال: علي بن حاتم أبو معاوية يجهّل وأتى في أبيات
أفحش فيها بمنكر من القول: قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد: وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي.
وأيضاً ذكر هذه الرواية الموضوعة الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال" ج3 ص118 ترجمة رقم 5802.
والعجيب
أن الرافضي محمد باقر المحمودي ذكر في تعليقه على الكتاب المنسوب زوراً
وبهتاناً لأبي نعيم الأصبهاني والمسمى "النور المشتعل من كتاب ما نزل من
القرآن في علي عليه السلام" (طبع وزارة الإرشاد بإيران 1406ه) ص199: أن
هذه الرواية الموضوعة موجودة في "لسان الميزان" و "ميزان الاعتدال" ولكنه
لم يذكر قول ابن حجر والذهبي حول هذه الرواية. وهذا دأب الرافضة في
التدليس.
(190) لم أجد هذا الحديث الموضوع. وقال ابن كثير في تفسيره
للآية: "ولتعرفنهم في لحن القول: أي فيما يبدو من كلامهم الدال على
مقاصدهم، بفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد
من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر
أحدٌ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وانظر: زاد
المسير 7/411.
(191) الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري
5/32 (كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار)، مسلم 1/85 (كتاب الإيمان، باب
الدليل على أن حب الأنصار...)، المسند (ط. الحلبي) 3/130، 134، 249.
(192)
الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم في: مسلم
1/86 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار...)، سنن الترمذي 5/383
(كتاب المناقب، باب في فضل الأنصار وقريش)، المسند (ط. المعارف) 4/293،
18/114 وفي مواضع أخرى في المسند.
(193) الحديث عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه في: مسلم 1/86 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي
رضي الله عنهم من الإيمان...)، سنن الترمذي 5/306 (كتاب المناقب، باب
مناقب علي)، سنن ابن ماجه 1/42 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول
الله...، فضل علي...)، المسند (ط. المعارف) 2/57. وهو في مواضع أخرى في
المسند.
(194) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 1/12
(كتاب الإيمان، باب علامة المنافق). 3/180 (كتاب الشهادات، باب من أمر
بإنجاز الوعد)، مسلم 1/78-79 (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق) من
أربعة طرق وزاد في الطريقين الأخيرين: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم"، سنن
الترمذي 4/130 (كتاب الإيمان، باب في علامة المنافق). وقال الترمذي: "وفي
الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر".
(195) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (1/370)، تنزيه الشريعة لابن عراق (1/355)، الفوائد المجموعة للشوكاني (367). (م).
(196)
الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في: مسلم 1/453 (كتاب المساجد
ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى) وجاء الأثر مرتين 256،
257، وهو مطول في المرة الثانية، وأوله: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن".
والأثر في: سنن أبي داود
1/373 (كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة)، سنن النسائي 2/84
(كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث يُنادى بهن)، سنن ابن ماجه
1/255-256 (كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة)؛ المسند (ط.
الحلبي) 1/382، 414-415، 419، 455.
(197) انظر تفسير الطبري (ط. المعارف) 1/284 .
(198)
الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في: البخاري 1/12
(كتاب الإيمان، باب علامة المنافق)، 4/102 (كتاب الجزية والموادعة، باب
إثم من عاهد ثم غدر)، مسلم 1/78 (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق)،
سنن أبي داود 4/305-306 (كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان
ونقصانه).
(199) أول الحديث: "إنه لعهد النبي الأميّ: لا يجبني إلا مؤمن، ولا يبغضني. إلخ. وسبق فيما مضى.
(200)
قال شاه عبد العزيز الدهلوي (مختصر التحفة الاثني عشرية، ص158-159):
"ومدار هذه الرواية على أبي الحسن الأشقر، وهو ضعيف بالإجماع. قال
العقيلي: هو شيعي متروك الحديث. ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعاً إذ
فيه من أمارات الوضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله، كما
يدل عليه نص الكتاب... إلخ...".
قال أبو عبد الرحمن: هو ابن الحسن
الأشقر وليس كما قال الدهلوي رحمه الله تعالى. وهذه الرواية الضعيفة ذكرها
العلامة الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" ج1 ص360-361 وقال
حفظه الله تعالى: ضعيف جداً. ورواه الطبراني (3/111/2) عن الحسين بن أبي
السري العسقلاني، نا حسين الأشقر، نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً.
قلت: وهذا سند ضعيف جدّاً إن لم يكن
موضوعاً، فإن حسين الأشقر وهو ابن الحسن الكوفي شيعي غال، ضعفه البخاري
جداً فقال في "التاريخ الصغير" (230): "عنده مناكير".
وروى العقيلي في "الضعفاء" (90) عن البخاري أنه قال فيه: "فيه نظر".
وفي
"الكامل" لابن عدي (1/97): قال السعدي: كان غالباً، من الشتّامين للخبرة،
ووثقه بعضهم، ثم قال ابن عدي: وليس كل ما يروى عنه من الحديث الإنكار فيه
من قبله، فربما كان من قبل من يروي عنه، لأن جماعة من ضعفاء الكوفيين
يحيلون بالروايات على حسين الأشقر، على أن حسيناً في حديثه بعض ما فيه".
قلت:
وكأن ابن عدي يشير بهذا الكلام إلى مثل هذا الحديث فإنه من رواية الحسين
بن أبي السري عنه، فإنه مثله بل أشد ضعفاً، قال الذهبي: ضعفه أبو داود
وقال أخوه محمد: لا تكتبوا عن أخي فإنه كذاب، وقال أبو عروبة الحرّاني: هو
خال أبي وهو كذاب" ثم ساق له هذا الحديث من طريق الطبراني.
وقال الحافظ
ابن كثير في "التفسير" (3/570): "هذا حديث منكر، لا يعرف إلا طريق حسين
الأشقر، وهو شيعي متروك"، ونقل نحوه المناوي عن العقيلي، ونقل عنه الحافظ
في "تهذيب التهذيب" أنه قال: لا أصل له عن ابن عيينة".
(201) أبو الحسن
رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي، توفي سنة 535 وكان من
المحدثين ومن تصانيفه "التجريد للصحاح الستة". وانظر ترجمته في: شذرات
الذهب (4/106)، روضات الجنات (ص286)، معجم المؤلفين (4/155-156)، الأعلام
(3/46).
(202) الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في: مسلم
3/1449 (كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى)، المسند (ط.
الحلبي) 4/269. وانظر تفسير الطبري (ط. المعارف) 14/25، 26 .
(203)
الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري
1/85 (كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة...)، 5/20 (كتاب التفسير، سورة
البقرة، باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى...)، المسند (ط. المعارف)
1/323، 263.
والحديث في كتاب "فضائل الصحابة" الأرقام: 434، 435، 437، 493، 494، 495، 682.
(204)
قال ابن كثير في تفسيره لآية 12 من سورة المجادلة: "وقد قيل: إنه لم يعمل
بهذه الآية قبل نسخها سوى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه". ثم قال: "وقال
العوفي عن ابن عباس في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً -
إلى - فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }: كان المسلمون يقدّمون بين يدي
النجوى صدقة فلما نزلت الزكاة نُسخ هذا".
(205) الحديث - مع اختلاف في اللفظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه في: مسلم 2/713 (كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر).
(206)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 3/24 (كتاب الصوم، باب
الرّيّان للصائمين)، 4/26 (كتاب الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله)،
4/119 (كتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الجنة)، 5/6 (كتاب فضائل أصحاب
النبي، باب حدثنا الحميدي...)، مسلم 2/711-713 (كتاب الزكاة باب من جمع
الصدقة وأعمال البر)؛ سنن الترمذي 5/276-277 (كتاب المناقب، مناقب أبي
بكر...، باب 60) والحديث في سنن النسائي والدارمي والموطأ والمسند.
(207)
الحديث بشقيه - مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه في:
البخاري 3/103-104 (كتاب الوكالة، باب استعمال البقر للحراثة) 4/174 (كتاب
الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان)، 5/5-6 (كتاب فضائل أصحاب النبي...، باب
حدثنا الحميدي)، مسلم 4/1857-1858 (كتاب فضائل الصحابة..، باب فضائل أبي
بكر الصديق)، سنن الترمذي 5/279 (كتاب المناقب، مناقب أبي بكر..، باب رقم
64)؛ المسند (ط. المعارف) 13/71.
(208) سبق هذا الحديث في هذا الجزء قبل صفحات قليلة.
(209) سبق الكلام على هذا الحديث في هذا الجزء قبل صفحات قليلة.
(210)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: سنن أبي داود 4/295 (كتاب السنة،
باب في الخلفاء) ونص الحديث: "أتاني جبريل فأخذ بيدي، فأراني باب الجنة
الذي تدخل منه أمتي" فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى
أنظر إليه، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "أما إنك يا أبا بكر
أول من يدخل الجنة من أمتي". قال المحقق رحمه الله: "أبو خالد الدالاتي:
اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين لا بأس به، وعن
الإمام أحمد ونحوه، وقال فيه ابن حبان: لا يحتج به إذا وافق الثقات، فكيف
إذا انفرد عنهم بالمعضلات". والحديث في المستدرك للحاكم 3/73 وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "خ م (أي أن
الحديث في البخاري ومسلم) رواه المحاربي عنه"، ولكن ذكر السيوطي في
"الجامع الصغير" أن الحديث في سنن أبي داود والمستدرك، وضعف الألباني
الحديث في "ضعيف الجامع الصغير" 1/71 .
(211) ذكر البخاري 2/112 (كتاب التهجد، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) أن أبا بكر تصدق بماله كله.
وأورد
أبو داود 2/173-174 (كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك) حديث تصدقه عن
زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم... والحديث في صحيح الترمذي 5/277 (كتاب
المناقب، باب منه) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في: سنن الدارمي 1/391-392 (كتاب الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده).
(212)
الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه في: البخاري 5/5 (كتاب فضائل أصحاب
النبي..، باب حدثنا الحميدي..)، 6/60 (كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب قل
يا أيها الناس إني رسول الله...). وسبق الحديث في هذا الجزء، ص30.
(213)
الحديث عن عائشة رضي الله عنها في: سنن الترمذي 5/276 (كتاب المناقب،
مناقب أبي بكر الصديق، باب رقم 59) وقال الترمذي: "هذا حديث غريب". وذكره
السيوطي في "الفتح الكبير" 3/373 وقال إنه في سنن الترمذي عن عائشة. وقال
الألباني في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" 6/96: "ضعيف جداً".
(214)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه - مع اختلاف يسير في الألفاظ - في:
البخاري 5/34 (كتاب مناقب الأنصار، باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة)، 6/148 (كتاب التفسير، باب سورة الحشر)، مسلم 3/1624-1625 (كتاب
الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره).
(215) الأثر بمعناه عن علي بن
أبي طالب وعن ابن عباس رضي الله عنهم في: تفسير الطبري (ط. المعارف)
6/555-557، تفسير ابن كثير (ط. الشعب) 2/56، زاد المسير (1/414-415).
(216)
قال ابن كثير في تفسيره للآية: "وقوله سبحانه وتعالى: { وَاسْأَلْ مَنْ
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ
الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ }: أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس
إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداءن
كقوله جلت عظمته: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ
اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ }... وقال عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
جُمعوا له". وانظر زاد المسير 7/318-320.
(217) حلية الأولياء ج1 ص67،
وذكرها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" ج1 ص306 بلفظ آخر. عن مكحول عن علي في
قوله تعالى: { وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } قال علي: قال النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم: "دعوت الله أن يجعلها في أذنك يا علي".
وذكر الهيثمي
في "مجمع الزوائد" ج1 ص131 رواية أخرى بلفظ مقارب: عن أبي رافع أن رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لعلي بن أبي طالب: إن الله أمرني أن
أعلمك ولا أجفوك وأن أدنيك ولا أقصيك، فحق عليّ أن أعلمك وحق عليك أن تعي.
وقال بعد ذلك: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو منكر الحديث، وعبّاد بن يعقوب رافضي. (م).
(218)
ذكر ابن كثير في تفسيره لآية 12 من سورة الحاقة الحديث الأول من رواية ابن
أبي حاتم ثم قال: "وهكذا رواه ابن جرير عن عليّ بن سهل عن الوليد بن مسلم
عن عليّ بن وحشب عن مكحول به، وهو حديث مرسل". ثم ذكر الحديث الثاني من
رواية ابن أبي حاتم أيضاً، ثم قال: "ورواه جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن
آدم به، ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن داود الأعمى عن بريدة به، لا يصح
أيضاً" وانظر: زاد المسير (8/348).
(219) لم أجد هذا الحديث.
(220) ذكر سزكين (م1 ج1 ص330) هذا الكتاب ونسخه الخطية، وهو مطبوع في القاهرة سنة 1308ه.
(221)
أبو نعيم هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (أبو نعيم) حافظ مؤرخ ولد
بأصبهان سنة 326 وتوفي سنة 430ه. له حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
ودلائل النبوة وطبقات المحدثين والرواة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان
(1/75)، ميزان الاعتدال (1/111)، لسان الميزان (1/201)، طبقات الشافعية
(4/18-25)، الأعلام (1/150).
(222) هو أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن
حيدرة، القرشي الطرابلسي، ولد سنة 250 وتوفي سنة 343. وكان من حفاظ الحديث
وله كتاب كبير في "فضائل الصحابة" وآخر في "فضائل الصديق" ذكر سزكين أن
منهما نسخة خطية في الظاهرية. انظر ترجمته في: شذرات الذهب (2/365)، لسان
الميزان (2/411-412)، الأعلام (2/374)، معجم المؤلفين (4/131)، سزكين (م1
ج1 ص368-369).
(223) وهي سورة "السجدة".
(224) الحديث - مع اختلاف
في الألفاظ - عن ابن عمر رضي الله عنهما في: البخاري 8/124-125 (كتاب
القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) ونصه فيه: نهى النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم عن النذر، قال: "إنه لا يَرُدُّ شيئاً، وإنما يستخرج به من
البخيل" مسلم 3/1260-1261 (كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد
شيئاً) وجاءت فيه ثلاث روايات (الأحاديث رقم 2، 3، 4) منها الرواية التي
ذكرها ابن تيمية. والحديث أيضاً في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه
والدارمي والبيهقي ومسند أحمد، وانظر ما ذكره عنه الألباني في "إرواء
الغليل" 8/208-209 (رقم 255).
(225) لم أجد هذا الحديث.
(226)
الحديث - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه
في: البخاري 5/19 (كتاب فضائل أصحاب النبي...، باب مناقب عليّ بن أبي
طالب)، 3/65 (كتاب النفقات، باب خادم المرأة)، مسلم 4/2091-2092 (كتاب
الذكر والدعاء...، باب التسبيح أول النهار وعند النوم)، سنن أبي داود
4/430 (كتاب الأدب، باب في التسبيح عند النوم)، سنن الترمذي 5/142 (كتاب
الدعوات، باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم).
(227) سبق هذا الحديث في هذا الجزء ص183 .
(228)
الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه في: مسلم
2/716 (كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح)، سنن
النسائي 5/51 (كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل)، 6/198 (كتاب الوصايا،
الكراهية في تأخير الوصية)، سنن ابن ماجه 2/903 (كتاب الوصايا، باب النهي
عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت)، المسند (ط. المعارف) الأرقام
7159، 7401، 9367، 9767.
(229) ذكر هذا الأثر أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" 1/147 .
(230) "مناقب الإمام علي" ص269. (م).
(231)
أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، تابعي، مفسّر من أهل مكة، ولد سنة 21
وتوفي سنة 104. قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "الإمام، شيخ القراء
المفسرين... قال أبو بكر بن عباس: قلت للأعمش: ما بالهم يتقون تفسير
مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.. قال ابن خراش: أحاديث مجاهد
عن عليّ وعائشة: مراسيل". انظر تجمة مجاهد في: سير أعلام النبلاء
(4449-457) طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401-1981، ميزان الاعتدال
(3/439-440)، حلية الأولياء (3/279-310)، الأعلام (6/161).
(232) في تفسير الطبري (ط. بولاق) 4/24.
(233) تفسير الطبري: يقولون.
(234) تفسير الطبري: فاتبعنا...
(235) انظر تفسير ابن كثير، ط. الشعب (7/89-90)، زاد المسير (7/182).
(236) تفسير الطبري (3/24).
(237)
قال أبو عبد الرحمن: ذكر أبو نعيم في "حلية الأولياء" ج3 ص27 - بلفظ آخر
-: عن أبي الحمراء صاحب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: رسول الله
صلَّى الله عليه وسلَّم: رأيت ليلة أُسري بي مثبتاً على ساق العرش، أنا
غرست جنة عدن، محمد صلَّى الله عليه وسلَّم صفوتي من خلقي، أيدته بعلي.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن سعيد بن جبير لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
وذكر
الهيثمي هذه الرواية في: "مجمع الزوائد" ج9 ص121 ولكن بلفظ مقارب وقال:
رواه الطبراني وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك. وأيضاً ابن الجوزي في "العلل
المتناهية" ج1 ص237 وقال: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: أحمد بن الحسن
الكوفي يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك.
(238) قال أبو عبد الرحمن:
وله أيضاً "معرفة الصحابة" وقد طبع في ثلاثة مجلدات بتحقيق الدكتور محمد
راضي بن حاج عثمان، طبع مكتبة الدار بالمدينة المنورة 1408ه.
(239)
الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه في: البخاري 4/65-66 (كتاب الجهاد
والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب)، 5/94 (كتاب المغازي،
باب غزوة أحد)، المسند (ط. الحلبي) 4/293، ولم أجد الحديث في مسلم. وانظر:
جامع الأصول لابن الأثير (9/176-178).
(240) انظر عن عدد غزوات الرسول
صلَّى الله عليه وسلَّم وسراياه وبعثوه: زاد المعاد (1/129-130)، جوامع
السيرة (ص16-21)، صحيح مسلم 3/1447-1448 (كتاب الجهاد والسيرة، باب عدد
غزوات النبي صلَّى الله عليه وسلَّم).
(241) هذا جزء من حديث عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنه في: البخاري 3/84 (كتاب البيوع، باب بيع الميتة
والأصنام) وأوله: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام.. الحديث، وهو في: مسلم 3/1207 (كتاب المساقاة، باب تحريم بيع
الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، سنن ابن ماجه 2/732 (كتاب التجارات،
باب ما لا يحل بيعه)، المسند (ط. الحلبي) 3/324، 326.
(242) في
تفسير الطبري 11/556-557: "وأما قوله: "وجَاعِلُ الليلَ سكناً"، فإن
القراء اختلفت في قراءته. فقرأ ذلك عامة قراء أهل الحجاز والمدينة وبعض
البصريين: "وجَاعِلُ الليل" بالألف على لفظ الاسم، ورفعه عطفاً على
"فالقُ"، وخفض" الليل" بإضافة "جاعل" إليه، ونصب "الشمس والقمر"، عطفاً
على موضع "الليل"، لأن "الليل" وإن كان مخفوضاً في اللفظ، فإنه في موضع
النصب لأنه مفعول "جاعل". وحسُن عطف ذلك على معنى "الليل" لا على لفظة،
لدخول قول: "سكناً" بينه وبين "الليل".... وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين:
"وجَعَلَ الليلَ سكناً والشمسَ"، على "فَعَلَ"، بمعنى الفعل الماضي، ونصب
"الليل".
(243) الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في: البخاري 6/39
(كتاب التفسير سورة آل عمران، باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية). وانظر
تفسير ابن كثير (2/147).
(244) البيتان للمتنبي في مطلع قصيدة يمدح بها
سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة 345. انظر: شرح ديوان المتنبي
(4/307) وضع الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.
(245) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 3/178 (كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر).
والحديث
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً في: البخاري 3/110-111 (كتاب الشرب
والمساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء)، 9/79 (كتاب الأحكام، باب
من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا)، مسلم 1/103 (كتاب الإيمان باب بيان
غلظ تحريم إسبال الأزار والمنّ بالعطية...)، سنن النسائي 7/217 كتاب
البيوع، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع)، المسند (ط. المعارف) 13/180 .
(246)
قال أبو عبد الرحمن: من يطلع على كتب الصوفية لا سيما "الطبقات" للشعراني،
يجد العجب العجاب من كرامات الصوفية فيما يدّعونه من الكرامات التي لم تكن
للأنبياء عليهم السلام. وقد جمعت بعضاً منها وإن شاء الله تعالى - إن كان
في العصر بقية - سوف نفردها في رسالة متواضعة.
(247) في تفسيره (ط. المعارف) 10/413-414.
(248) الطبري: المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن هشام.
(249) تفسير الطبري: قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد...
(250) انظر: تفسير الطبري (10/411-413).
(251) انظر: تفسير الطبري (10/417-418).
(252) انظر: تفسير الطبري (10/416-417).
(253) انظر: تفسير الطبري (10/419).
(254) انظر: تفسير الطبري (10/419).
(255)
تفسير الطبري (10/419): "ولولا الخبر الذي رُوي في ذلك عن رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم بالخبر الذي روى عنه ما كان القول عندي في ذلك إلا قول
من قال: هم أبو بكر وأصحابه".
(256) تفسير الطبري (10/420): "قيل له:
إن الله تعالى ذكره لم يعد المؤمنين أن يبدلهم بالمرتدين منهم يومئذ خيراً
من المرتدين لقتال المرتدين، وإنما أخبر أنه سيأتيهم بخير منهم بدلاً
منهم، فقد فعل ذلك بهم قريباً غير بعيد، فجاء بهم على عهد عمر..".
(257) ذكر هذا الحديث الطبري في تفسيره 10/414-415 (وانظر تعليق المحقق).
(258)
يقد بهم ابن تيمية هنا الراوندية وهم أتباع ابن الراوندي الذي كان من ائمة
المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحداً زنديقاً. والراوندية فرقة من
فرق الكيسانية، ويقول ابن النوبختي في كتابه "فرق الشيعة" ص57:
"فالكيسانية كلها لا إمام لها وإنما ينتظرون الموتى إلا "العباسية" فإنها
تثبت الإمامة في ولد العباس وقادوها فيهم إلى اليوم".
وقال ابن
النوبختي قبل ذلك (ص45): "وفرقة قالت أوصى عبد الله بن محمد بن الحنفية
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب لأنه مات عندهم بأرض
الشراة بالشام، وأنه دفع إليه الوصية إلى أبيه علي بن عبد الله بن العباس،
وذلك أن محمد بن علي كان صغيراً عند وفاة أبي هاشم وأمره أن يدفعها إليه
إذا بلغ دفعها إليه، فهو الإمام، وهو الله عزَّ وجلَّ، وهو العالم بكل
شيء، فمن عرفه فليصنع ما شاء، وهؤلاء غلاة الراوندية".
وانظر كلام ابن
حزم في الفصل (4/154) حيث قال: "وقالت طائفة لا تجوز الخلافة إلا في ولد
العباس بن عبد المطلب وهم الراوندية". وانظر كتاب "أصول الدين" ص281.
(259) "مناقب الإمام علي" ص246. (م).
(260)
"الفردوس" ج2 ص421، وأيضاً ذكر هذه الرواية الموضوعة: أبو نعيم في "معرفة
الصحابة" ج1 ص302، الخطيب في "تاريخ بغداد" ج14 ص155 في ترجمة يحيى بن
الحسين المدائني رقم 7468 وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو من الضعفاء
المتروكين.
وأيضاً العلامة الألباني في "سلسلة الأحاديث، الضعيفة والموضوعة" ج1 ص358 رقم 355 وقال: موضوع. (م).
(261)
هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي صاحب الزيادات على كتاب
"فضائل الصحابة" وسيذكره ابن تيمية بعد قليل فيقول: "ورواه القطيعي أيضاً
من طريق آخر". ولد القطيعي سنة 273 وتوفي سنة 368. انظر ترجمته في: طبقات
الحنابلة (2/6-7) تاريخ بغداد (4/73-74)، الأعلام (1/103).
(262) في كتاب "فضائل الصحابة" 2/627-628 (رقم 1072).
(263) فضائل الصحابة: حدثنا محمد، ثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري.
(264) فضائل الصحابة: قال: نا عمرو بن جُمَيع عن ابن أبي ليلى.
(265) في "فضائل الصحابة" عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(266)
قال الدكتور وصي الله بن محمد عباس في تعليقه: "موضوع لأجل عمرو بن جميع
أبي المنذر، وقيل: أبي عثمان، فإنه متروك كذّبه ابن معين. وقال النسائي
والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: كان يتهم بالوضع" وانظر باقي التعليق.
(267) فضائل الصحابة 2/655-656 (رقم 1117).
(268) في "فضائل الصحابة": وفيما كتب إلينا... إلخ.
(269) فضائل الصحابة: أنا.
(270)
فضائل الصحابة: .. بن جميع البصري عن محمد بن أبي ليلى عن عيسى بن عبد
الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: قال رسول الله ..
(271) قال الدكتور وصي الله: "موضوع".
(272) قال الدكتور وصي الله: "الضعفاء للنسائي (ص229)، المجروحين (2/77) الميزان (3/251) اللسان (4/358).
قال أبو عبد الرحمن: وانظر:
تاريخ
بغداد (12/192)، المغني في الضعفاء للذهبي ج2 ص482 ترجمة رقم 4639،
المؤتلف والمختلف للدارقطني ج1 ص450، الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص303
ترجمة رقم 387، المجروحين لابن حبان (2/77) وقال: كان ممن يروي الموضوعات
عن الأثبات والمناكير عن المشاهير، لا يحل كتابة حديثه ولا الذكر عنه إلا
على سبيل الاعتبار.
ومناسبة ذكر قول ابن حبان أن ابن تيمية ذكر قوله
ناقصاً، فأحببت ذكره بتمامه للفائدة. وترجم لابن جُميع أيضاً ابن معين في
تاريخه والدولابي في الكنى وابن عدي في الكامل وغيرهم من أئمة الجرح
والتعديل.
(273) في: المسند (ط. الحلبي) 3/112 وفيه: حدثنا عبد الله
حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة، حدثنا قتادة أن أنس بن
مالك.. وحديث أنس في: البخاري 5/15 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل
عثمان..) وفيه "أحد" بدلاً من "حراء". وقد تكلم الألباني كلاماً مفصلاً
على الحديث وألفاظه ورواياته في "سلسلة الأحاديث الصحية" 2/45-458 (حديث
رقم 875).
(274) هذه الرواية في: المسند (ط. الحلبي) 5/331 .
(275)
الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في: البخاري
8/25 (كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ }، مسلم 4/2013 (كتاب
البر، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله)، سنن الترمذي 3/224-225 (كتاب البر
باب ما جاء في الصدق والكذب)، سنن أبي داود 4/407 (كتاب الأدب، باب
التشديد في الكذب) وأوله: إياكم والكذب....
وجاء الحديث مع اختلاف في
الألفاظ في: سنن ابن ماجه 1/18 (المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل)، سنن
الدارمي 2/299-300 (كتاب الرقاق، باب في الكذب)، المسند (ط. المعارف)
5/231، 275، 343. وفي عدة مواضع في الجزء السادس منه.
(276) انظر تفسير
ابن كثير الآية 274 من سورة البقرة وانظر ما رواه من أحاديث وآثار في أنها
نزلت في أصحاب الخيل أو في الذين يعلفون الخيل في سبيل الله، ثم ذكر عن
مجاهد حديثاً موافقاً للحديث الذي ذكره ابن المطهر ونسبه إلى ابن أبي حاتم
ثم قال: "وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف، ولكن
رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في عليّ بن أبي طالب".
قال أبو عبد الرحمن: وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ج6 ص324 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الواحد ابن مجاهد وهو ضعيف.
(277) في كتاب "فضائل الصحابة" 2/654 (رقم 1114).
(278) فضائل الصحابة: حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي، ثنا زكريا بن يحيى الكسائي، ثنا عيسى.
(279) قال الدكتور وصي الله في تعليقه: "إسناده ضعيف جداً لأجل زكريا من يحيى الكسائي".
(280) الحديث عن عكرمة رضي الله عنه في: البخاري 9/15 (كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة).
(281) لم أجد هذا الحديث.
(282)
الحديث عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه في: البخاري 3/190 (كتاب الشروط،
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح)، 5/22-23 (كتاب فضائل أصحاب
النبي...، باب ذكر أصهار النبي صلَّى الله عليه وسلَّم منهم أبو العاص بن
الربيع)، 7/37 (كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف)،
مسلم 4/1902-1904 (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة)، سنن أبي داود
2/304-305 (كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء)، سنن
الترمذي 5/359-360 (كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله
عنها)، سنن ابن ماجه 1/643-644 (كتاب النكاح، باب الغيرة)، المسند (ط.
الحلبي) 4/5، 328 .
(283) حديث الإفك حديث طويل جاء عن عائشة رضي الله عنها.
وأوله
- وهذا لفظ البخاري: 5/116 - قالت عائشة: كان رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها....
والحديث
في البخاري 3/173-176 (كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً)،
5/116-120 (كتاب المغازي، باب حديث الإفك)، 6/76-77 (كتاب التفسير، سورة
يوسف)، مسلم 4/2129-2138 (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك....)، المسند
(ط. الحلبي) 6/194-197.
(284) أي لم يعرف أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنكر على أبي بكر رضي الله عنه شيئاً.
(285)
ذكر ابن كثير في تفسيره لأول آية 43 من سورة النساء حدثنا عن ابن أبي حاتم
- وساق سنده - عن علي بن أبي طالب، قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً
فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدّموا فلاناً.
قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ما أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون.
فأنزل الله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ
الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ }. قال
ابن كثير: "هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد، عن
عبد الرحمن الدشتكي به، وقال: حسن صحيح".
ثم ذكر ابن كثير حديثاً آخر
رواه ابن جرير الطبري جاء فيه أن الذي صلى بهم هو عبد الرحمن بن عوف، ثم
قال ابن كثير: "وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به".
وذكر ابن كثير حديثاً ثالثاً رواه ابن جرير الطبري وفيه أن الذي صلى إماماً هو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
كما
ذكر حديثاً رابعاً رواه ابن جرير فيه أن الإمام هو عبد الرحمن بن عوف
واختلفت ألفاظه، عن الحديث الأول الذي رواه ابن أبي حاتم قليلاً.
انظر
تفسير الطبري (ط. المعارف) 8/376 (الآثار 9524، 9525). والحديث في: سنن
الترمذي 4/305 (كتاب تفسير القرآن، سورة النساء) وهو عن ابن أبي طاب وفيه..
فأخذت الخمر منا وحرت الصلاة فقدَّموني فقرأت ... الحديث، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح".
وأما
حديث عليّ في سنن أبي داود فهو فيها 3/445 (كتاب الأشربة، باب في تحريم
الخمر) وفيه: أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل
أن تحرّم الخمر، فأمهم عليّ في المغرب فقرأ... إلخ.
(286) الحديث عن
علي رضي الله عنه في: البخاري 6/88 (كتاب التفسير، سورة الكهف) 2/50 (كتاب
التهجد، باب تحريض النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على صلاة الليل...)،
المسند (ط. المعارف) 2/89، 172 .
(287) لم أجد الحديث بهذا اللفظ،
ولكن لفظ الحديث في البخاري 4/74 (كتاب الجهاد، باب من تكلّم بالفارسية
والرطانة...) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر
الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالفارسية:
"كَخٍْ كَخٍْ أما تعرف أنّا لا نأكل الصدقة". والحديث في: مسلم 2/751
(كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
وعلى آله...) وجاء من طريق آخر بلفظ: "أنَّا لا تحل لنا الصدقة" وجاءت
أحاديث أخرى في مسلم بهذا المعنى في هذا الباب ومثلها في سنن أبي داود
(2/83-84) وسنن الترمذي (2/165-167).
(288) الحديث عن ابن أبي أوفى رضي
الله عنه في: البخاري 8/77 (كتاب الدعوات، باب هل يُصلّي على غير النبي)،
سنن أبي داود 2/142 (كتاب الزكاة، وباب دعاء المصدق لأهل الصدقة)، سنن
النسائي 5/22 (كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة)، سنن ابن
ماجه 1/572 (كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة) المسند (ط.
الحلبي) 4/353-355، 381، 383 .
(289) الحديث - مع اختلاف في اللفظ. عن
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في: البخاري 6/195 (كتاب فضائل القرآن، باب
حسن الصوت بالقراءة) ونصه: "يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل
داود" والحديث في مسلم 1/546 الترمذي 5/355-356 (كتاب المناقب، باب مناقب
أبي موسى الأشعري). والحديث في سنن النسائي وابن ماجه ومسند أحمد.
(290)
الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه - مع اختلاف في اللفظ - في: مسلم
4/1782 (كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم) سنن
الترمذي 5/243 (كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم) المسند 4/107 .
(291) قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات:
"(مرج البحرين يلتقيان). قال ابن عباس: أي أرسلهما. وقوله: (يلتقيان) قال
ابن زيد: أي منعهما أن تلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفصل
بينهما. والمراد بقوله (البحرين): الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار
السارحة بين الناس. وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله
تعالى: { وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
مَّحْجُورًا }... { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ يَبْغِيَانِ } أي وجعل
بينهما برزخاً، وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على
هذا... (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) أي من مجموعهما فإذا وجد ذلك من
أحدهما كفى... واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل: هو صغار اللؤلؤ". وانظر
تفسير الطبري، وزاد المسير لابن الجوزي، والدر المنثور للسيوطي.
(292)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 4/140 (كتاب الأنبياء، باب
قوله تعالى: { وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً }، 4/149 (كتاب
الأنبياء، باب قول الله تعالى: { لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ
آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ }.
(293) انظر: تفسير الطبري (ط. بولاق) 27/74-76، زاد المسير (8/112).
(294) انظر: تفسير الطبري (ط. بولاق) 27/76-78، زاد المسير (8/113).
(295)
ذكر الطبري في تفسيره (ط. المعارف) 16/500-507 أنه على قراءة "ومَنْ
عِندَهُ عِلْمُ الكتابِ" يكون المعنى: "والذين عندهم علم الكتاب، أي الكتب
التي نزلتَ قبلَ القرآنَ، كالتوراة والإنجيل، وعلى هذه القراءة فسّر ذلك
المفسرون" ثم أورد آثاراً (20535-20541) تقول إنه عبد الله بن سلام وذكر
آثاراً أخرى فيها أنهم ناس من أهل الكتاب منهم عبد الله بن سلام وسلمان
الفارسي وتميم الداري.
وقال ابن كثير في تفسيره للآية: "... قيل:
نزلت في عبد الله بن سلام، قاله مجاهد وهذا القول غريب، لأن هذه الآية
مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم المدينة، والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من
اليهود والنصارى" وانظر سائر كلامه.
وقال القرطبي في تفسيره للآية:
"قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما من قال: إنه عليّ، فعوّل على أحد
وجهين: إما لأنه عنده أعلم المؤمنين، وليس كذلك، بل أبو بكر وعمر وعثمان
أعلم منه، ولقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: أنا مدينة العلم وعليّ
بابها، وهو حديث باطل".
(296) لم أجد هذا الحديث الموضوع.
(297)
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في: البخاري 4/139 (كتاب الأنبياء، باب
قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاً)...، 4/168 (كتاب الأنبياء،
باب واذكر في الكتاب مريم..) وهو البخاري في مواضع أخرى. والحديث في: مسلم
4/2194-2195 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر
يوم القيامة)، سنن الترمذي 5/4 (كتاب التفسير، سورة الأنبياء) وهو في
الترمذي في مواضع أخرى. والحديث في النسائي والدارمي ومسند أحمد.
(298)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في البخاري في عدة مواضع آخرها
9/139 (كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة...) وأول الحديث: استب رجلٌ
من المسلمين ورجل من اليهود... فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا
تخيّروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق،
فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان
ممن استثنى الله" والحديث مع اختلاف الألفاظ - في: مسلم 4/1844-1845 (كتاب
الفضائل، باب من فضائل موسى صلَّى الله عليه وسلَّم)، سنن أبي داود
4/301-302 (كتاب السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام)، المسند (ط. المعارف) 14/20-22 (رقم 7576).
(299) الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في:
مسلم
4/1839 (كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلَّى الله عليه
وسلَّم) ونصه: جاء رجل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا خير
البريّة. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "ذاك إبراهيم عليه
السلام". والحديث في: سنن الترمذي 5/116 (كتاب التفسير، سورة لم يكن..)،
المسند (ط. الحلبي) 3/178، 184. وقال النووي في شرحه على مسلم 15/121-122:
"قال العلماء: إنما قال صلَّى الله عليه وسلَّم هذا تواضعاً واحتراماً
لإبراهيم صلَّى الله عليه وسلَّم لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلَّى الله
عليه وسلَّم أفضل، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "أنا سيد ولد آدم" ولم
يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدّمه، بل قال بياناً لما أمر
ببيانه وتبليغه، ولهذا قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "ولا فخر" لينفي ما قد
يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة".
(300) هذه العبارات جاءت في حديث طويل
من أحاديث الشفاعة وروى عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي
الله عنهم في: سنن الترمذي 4/370-371 (كتاب تفسير القرآن، سورة الإسراء)
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن
ابن عباس، الحديث بطوله". وهو أيضاً في: سنن الترمذي 5/247 (كتاب المناقب،
باب ما جاء في فضل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حديث رقم 3693)، سنن ابن
ماجه 2/1440 (كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة)، المسند (ط. المعارف) حديث رقم
2546، 2692، (ط. الحلبي) 3/2، 144.
(301) ذكر هذا الأثر بمعناه ابن كثير في تفسير آية 12 من سورة الحديد ونسبه إلى الضحاك.
(302)
هذا جزء من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه في: مسلم 1/218 (كتاب
الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة..) أوله: أن رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين.. وددت أنا قد
رأينا إخواننا". قالوا: أو لسنا إخوانك يا سول الله؟... الحديث، وفيه...
قال: "فإنهم يأتون غُرّاً محجّلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا
ليُذادن رجال عن وحوضي كما يُذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هَلُمَّ،
فيقال: إنهم قد بَدَّلوا بعدك، فأقول سُحقاً سُحقاً". والحديث - مع اختلاف
في اللفظ - في: الموطأ 1/28-30 (كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء)، سنن ابن
ماجه 2/1439-1440 (كتاب الزهد، باب ذكر الحوض). وجاء الحديث مختصراً في
مسلم ومع اختلاف اللفظ 1/217 (رقم 37).
(303) الحديث عن جرير بن عبد
الله وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في: البخاري 1/31 (كتاب
العلم، باب الإنصات للعلماء)، مسلم 1/81-82 (كتاب الإيمان، باب بيان معنى
قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: لا ترجعوا...)، سنن أبي داود 4/305
(كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)، سنن الترمذي 3/329
(كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً)، سنن الدارمي 2/69 (كتاب
المناسك، باب في حرمة المسلم)، المسند (ط. المعارف) 7/316-317 وفي مواضع
أخرى في المسند.
(304) ما ذكره ابن تيمية هنا جزء من حديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن علي وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم في:
البخاري
4/200-201 (كتاب المناقب، باب علامات النبوة)، مسلم 2/740-747 (كتاب
الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، باب التحريض على قتل الخوارج).
وانظر:
جامع الأصول لابن الأثير (10/436-440)، سنن أبي داود 4/336 (كتاب السنة،
باب في قتال الخوارج)، سنن ابن ماجه 1/60-61 (المقدمة، باب في ذكر
الخوارج)، المسند (ط. الحلبي) 3/65، 68، 73، 353، 354-355 .
(305)
يقول ابن كثير في تفسير للآية: { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ
بَشَرًا } الآية، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل
الخلقة ذكراً وأنثى كما يشاء { فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا } فهو في
ابتداء أمره ولد نسيب، ثم يتزوج فيصير صهراً، ثم يصير له أصهار وأختان
وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين، ولهذا قال تعالى: { وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا }.
(306) انظر تفسير ابن كثير للآيتين 118، 119 من سورة التوبة، وما ذكره من الروايات المختلفة لحديث كعب بن مالك.
(307)
الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها في: البخاري 3/180 (كتاب الشهادات، باب
من أقام البيّنة بعد اليمين)، 9/25 (كتاب ترك الحيل، باب حدثنا محمد بن
كثير...) 9/69 (كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم) مسلم 3/1337-1338
(كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة)، سنن أبي داود 3/410
(كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ)، المسند (ط. الحلبي) 3/320 .
والحديث في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومواضع أخرى في المسند.
(308)
قال أبو عبد الرحمن: ذكر الإمام النسائي في "خصائص أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب رضي الله عنه" ص21 روايتين الأولى بسند ضعيف والثانية بسند صحيح،
بأن أمير المؤمنين رضي الله عنه أول من صلّى من هذه الأمة:
الرواية
الأولى: عن سلمة بن كهيل قال سمعت حبّة العرني: قال سمعت عليّاً كرم الله
وجهه يقول: أنا أول من صلّى مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
والرواية الثانية: عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من صلّى مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم علي.
وعلّق محقق "الخصائص" الشيخ أحمد ميرين على الحديثين، فقال عن الحديث الأول:
إسناده
ضعيف. رجاله ثقات سوى حبّة بن جُوين العرني، وثقه أحمد والعجلي، وقال
النسائي: ليس بالقوي. وقال الذهبي: من غلاة الشيعة، وهو الذي حدّث أن
عليّاً كان معه بصفين ثمانون بدرياً، وهذا محال. وقال ابن كثير: حبّة لا
يساوي حبّة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أغلاط، وكان غالباً في التشيع
(ت 76)، الميزان (1/450)، البداية والنهاية (7/334)، التهذيب (2/176).
قلت: وُصف حبّة بالغلو في التشيع، والغالي لا تُقبل روايته فيما يقوي به بدعته، كما قرره الحافظ في "نزهة النظر" ص50، 51 .
والحديث
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/21)، وابن أبي شيبة في مصنفه (12/65)،
وأحمد في المسند (1/141)، وفي فضائل الصحابة برقم (999، 1003)، وابن قتيبة
في "المعارف" ص169، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ق15/أ وفي الأوائل
(68)، والبغوي في "معجم الصحابة" (ق 418)، والخطيب في "تاريخ بغداد"
4/233، والخوارزمي في "المناقب" (21) وابن عساكر في تاريخ دمشق (12: 63،
64 برقم 84) من طريق سلمة بن كهيل عن حبّة به.
وقال عن الحديث الثاني: صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين سوى أبي حمزة واسمه طلحة بن يزيد فهو من رجال البخاري وحده.
وأخرجه
الطيالسي في مسنده برقم (678) وأحمد في "المسند" (4: 368، 370) وفي
الفضائل (1004) والبلاذري في "أنساب الأشراف" (1: 112) والقطيعي في "زوائد
فضائل الصحابة" برقم (1040) وابن جرير في "التاريخ" (5: 198) والبيهقي في
"السنن الكبرى" (6: 206) وابن عبد البر في الاستيعاب (3: 32) وابن
المغازلي في "مناقب علي" (14) والخوارزمي في "المناقب" (20) وابن عساكر
(106) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة به مثله.
وزاد أحمد والبغوي والطبراني والبيهقي: "قال عمرو: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فأنكره وقال: أبو بكر أول من أسلم".
(309)
في تفسير الطبري (ط. المعارف) 1/572 للآية: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ
وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ } [البقرة: 43]:
"قال أبو جعفر: ذُكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة، فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدِّقين
بمحمد وبما جاء به، وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخضعوا لله ولرسوله كما
خضعوا". وانظر (1/575)، وانظر تفسير ابن كثير للآية.
(310) لم أجد
أحداً ذكر هذا الحديث الموضوع، ولكن ذكر السيوطي في "الدر المنثور" 4/295
حديثاً بمعناه فقال: "وأخرج السلفي في "الطيوريات" بسندٍ واهٍ عن أبي جعفر
محمد بن عليّ قال: لما نزلت: { وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي،
هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي } كان رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم على جبل ثم دعا ربه، وقال: اللهم اشدد أزري بأخي عليّ، فأجابه إلى
ذلك".
(311) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله عنهما) في: سنن أبي داود 1/193 (كتاب الصلاة، باب متى
يؤمر الغلام بالصلاة)، المسند (ط. المعارف) 10/217-218 (وانظر تعليق
المحقق رحمه الله على الحديث وقوله: إسناده صحيح. وما ذكره من أن الحديث
في: المستدرك (1/197).
(312) الحديث في "فضائل الصحابة" 2/638-639 (رقم 1085).
(313)
تكلم محقق كتاب "فضائل الصحابة" على هذا المسند 1/525 (الحديث رقم 871)،
ثم قال عند التعليق على هذا الحديث: "إسناده ضعيف لأجل عبد المؤمن بن
عباد" وذكر قبل ذلك 1/525: "وفيه عبد المؤمن بن عباد العبدي، ضعفه أبو
حاتم، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، ذكره الساجي وابن الجارود في
الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (3/2/117)، الديوان
(ص202)، الميزان (2/670)، اللسان (4/76).
(314) انظر فضائل الصحابة 2/639 .
(315) ترجمة عبد المؤمن بن عباد في "الجرح والتعديل" م3 ق1 ص66 وقال عنه أبو حاتم "ضعيف الحديث".
(316)
الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري 3/96 (كتاب الكفالة، باب
قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم...) ونصه: "... حدثنا عاصم، قال:
قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: لا
حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بين قريش
والأنصار في داري". وجاء هذا الحديث أيضاً في مسلم 4/1960 (كتاب فضائل
الصحابة، باب مؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بين أصحابه)، سنن أبي
داود 3/178 (كتاب الفرائض، باب في الحلف) وفي مواضع أخرى في كتب السنة.
(317)
الحديث عن عروة بن الزبير في: البخاري 7/5 (كتاب النكاح، باب تزويج الصغار
من الكبار) ونصه: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خطب عائشة إلى أبي بكر،
فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: "أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي
لي حلال". قال ابن حجر في "فتح الباري" 9/124: "إنه وإن كان صورة سياقه
الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر،
فالظاهر أنه حم ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر".
(318)
الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري
8/19، 21 (كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، باب الهجرة وقول
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث)،
مسلم 4/1983 (كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم التحاسد والتباغض).
وجاء
الحديث بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 8/19 (الموضع
السابق)، مسلم 4/1985-1986 (كتاب البر...، باب تحريم الظن والتجسس...)
والحديث عن أنس رضي الله عنه في: سنن أبي داود 4/383 (كتاب الأدب، باب
فيمن يهجر أخاه المسلم) وهو في الترمذي وابن ماجه والمسند والموطأ.
(319)
الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في: البخاري 9/22
(كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصحابه أنه أخوه...)، مسلم 4/1996 (كتاب
البر..، باب تحريم الظلم)، سنن أبي داود 4/376-377 (كتاب الأدب، باب
المؤاخاة)؛ المسند (ط. المعارف) 8/46 .
(320) الحديث - مع اختلاف في
الألفاظ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري 1/12 (كتاب الإيمان،
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وأوله فيه: "لا يؤمن
أحدكم...". مسلم 1/67-68 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال
الإيمان...)، سنن ابن ماجه 1/26 (المقدمة، باب في الإيمان)؛ المسند (ط.
الحلبي) 3/176، 206، 251 .
(321) روى الترمذي الحديث مرتين - بألفاظ
مقاربة - 5/272، 273 (كتاب المناقب، باب 53) وقال الترمذي عن الطريق
الأول: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، والوليد بن محمد الموقّري يضعّف في
الحديث، ولم يسمع عليّ بن الحسين من عليّ بن أبي طالب، وقد رُوي هذا
الحديث من غير هذا الوجه. وفي الباب عن أنس وابن عباس". وأما الطريق الآخر
فلم يتكلم عليه الترمذي، وأورد الترمذي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه
قبل ذلك (5/272-273) وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". وأورد
الإمام أحمد الحديث في مسنده (ط. المعارف) 2/37-38 (رقم 602) وقال عنه
أحمد شاكر رحمه الله "إسناده صحيح" ثم قال: "والحديث رواه أيضاً الترمذي
(4: 310) وابن ماجه (1: 25-26) بإسنادين آخرين ضعيفين.
وهذا الحديث
والذي قبله من زيادات عبد الله بن أحمد". والحديث - مع اختلاف في اللفظ -
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه في: سنن ابن ماجه 1/38
(المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فضل أبي
بكر الصديق رضي الله عنه). وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير"
(6/75) وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي (9/53).
(322) الأثر في: سنن
أبي داود 4/288 (كتاب السنة، باب في التفضيل) ونصه: "من زعم أن عليّاً
عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خَطّأ أبا بكر وعمر والمهاجرين
والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء".
(323) ج3 ص354 رقم 5066 . (م).
(324) يشير ابن تيمية بهذا إلى كلام ابن عربي الذي زعم أنه خاتم الأولياء، وقال في ذلك:
أنا ختم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح
ويقول
ابن عربي (المتوفي سنة 669) في كتابه "فصوص الحكم" 1/62: ".. وهذا هو أعلى
علم بالله، وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد
من الأنبياء والرسل إلا مشكاة الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء
إلا من مشكاة الولي الخاتم، حتى أن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من
مشكاة خاتم الأولياء". وانظر "جامع الرسائل" لابن تيمية بتحقيقي
(1/205-206).
(325) ذكر هذه الأقوال الستة ابن الجوزي في "زاد المسير"
8/310-311. وفي تفسير الطبري 28/105 (ط. بولاق) ذكر بعض هذه الأقوال. وفي
تفسير ابن كثير (8/192): وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان
والضحّاك وغيرهم (وصالح المؤمنين): أبو بكر وعمر، زاد الحسن البصري:
وعثمان. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: (وصالح المؤمنين): قال: علي بن
أبي طالب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عليّ بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي
عمر، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين قال: أخبرني رجل ثقة
يرفعه إلى عليّ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: قوله: (وصالح
المؤمنين) قال: هو عليّ بن أبي طالب "إسناده ضعيف، وهو منكر جداً".
(326)
هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنه جاء في عدة مواضع في
البخاري منها 9/40-41 (كتاب التعبير، باب الأمن وذهاب الروع، باب الأخذ
على اليمين في النوم) وأوله في الموضع الأول: "إن رجالاً من أصحاب رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم فيقصونها على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.. الحديث.
وجاء
الحديث في البخاري بألفاظ أخرى وسياق آخر 2/69 (كتاب التهجد، باب فضل من
تعارَّ من الليل فصلّى). وهو في: مسلم 4/1927-1928 (كتاب فضائل الصحابة،
باب من فضائل عبد الله بن عمر) وأوله فيه: "نعم الرجل عبد الله لو كان
يصلي من الليل"، سنن ابن ماجه 2/1291 (كتاب تعبير الرؤيا)، المسند (ط.
المعارف) 9/148-150 (رقم 6330).
(327) الحديث عن سالم عن أبيه ابن عمر
رضي الله عنهما في: مسلم 4/1884-1885 (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد
بن حارثة وأسامة بن زيد..) ونصه: "إن تطعنوا في إمارته - يريد أسامة بن
زيد. فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقاً لها. وأيم
الله إن كان لأحب الناس إليّ، وأيم الله إن هذا لها لخليق - يريد أسامة بن
زيد - وأيم الله إن كان لأحبهم إليّ من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم".
(328) هو الحافظ الثقة المقرئ أبو بكر القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي.
قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/717): كان من أهل الحديث والصدق، والمكثرين في تصنيف المسند والأبواب والرجال. وانظر ترجمته في:
سير أعلام النبلاء (14/149)، تاريخ بغداد (12/441)، المنتظم (6/146) البداية والنهاية (11/128). (م).
(329)
هو أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني، رافضي متهم في دينه، وكان غالياً في
التشيع، كان يشتم الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم.
قال عنه ابن حبان: كان رافضياً داعية، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وانظر ترجمته في:
تهذيب
التهذيب (5/110)، الضعفاء لابن الجوزي (2/77)، الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع
الحديث للحلبي (146-147)، المجروحين لابن حبان (2/172)، الجرح والتعديل
(6/88)، الميزان (2/379). (م).
(330) قال أبو عبد الرحمن: هذه الحكاية
ذكرها ابن تيمية مختصرة ولأهمية هذه الرواية التي تكشف حقيقة معتقد هذا
الرافضي نوردها كاملة للقراء الكرام:
عن محمد بن المظفر قال: سمعت قاسم
بن زكريا المطرّز يقول: دخلت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلهم غير عبّاد بن
يعقوب، فلما فرغت دخلت إليه وكان يمتحن من يسمع منه. فقال لي: من حفر
البحر؟
قلت: الله خلق البحر.
فقال: هو كذلك ولكن من حفره؟
فقلت: يذكر الشيخ!!
فقال: حفره علي بن أبي طالب.
ثم قال: ومن أجراه؟
قلت: الله مجري الأنهار ومنبع العيون.
فقال: هو كذلك ولكن من أجرى البحر؟
فقال: يفيدني الشيخ!!
فقال: أجراه الحسين بن علي.
قال: فكان عبّاد مكفوفاً فرأيت في داره سيفاً معلقاً وجحفة (الترس الصغير يُطارق بين جلدين).
فقلت: أيها الشيخ لمن هذا السيف؟
فقال: أعددته لأقاتل به مع المهدي.
قال: فلما فرغت من سماع ما أردتُ أن أسمعه منه وعزمت على الخروج عن البلد، دخلت عليه فسألني فقال: من حفر البحر؟
فقلت: حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص.
ثم وثبت من بين يديه وجعلت أعدو وجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه.
وانظر: تهذيب التهذيب (5/109-110)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/77-78)، ميزان الاعتدال (2/379).
??
??
??
??
الإمَامَةُ
في ضَوءِ الكتابِ والسُّنَّة
لشيخ الإسلام ابن تيمية
ولد سنة 661ه توفي سنة 728ه
رضي الله عنه
الجزء الثاني
جمع وتقديم وتعليق
محمد مال الله
الفصل الأول
بيان كذب ووضع الرافضي لحديث جمعه (
أربعين رجلاً من بني عبد المطلب
قال الرافضي: "المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة، المنقولة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
الأول:
ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الأَقْرَبِينَ } [الشعراء: 214] جمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بني
عبد المطلب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلاً، وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة
مع مُدٍّ من البر ويعدّ لهم صاعاً من اللبن، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة
في مقعد واحد، ويشرب الفَرَق من الشراب في ذلك المقام، فأكلت الجماعة كلهم
من الطعام اليسير حتى شبعوا، ولم يتبين ما أكلوه، فبهرهم النبي صلَّى الله
عليه وآله بذلك، وتبين لهم آية نبوته، فقال: يا بني عبد المطلب، إن الله
بعثني بالحق إلى الخلق كافة، وبعثني إليكم خاصة، فقال: { وَأَنذِرْ
عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان،
ثقيلتين في الميزان، تملكون بهما العرب والعجم، وتنقاد لكم بهما الأمم،
وتدخلون بهما الجنة، وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله،
وأنّي رسول الله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر، ويؤازرني على القيام به يكن
أخي ووزيري، ووصيي ووارثي، وخليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد منهم. فقال أمير
المؤمنين: أنا يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس. ثم أعاد
القول على القوم ثانية فصمتوا. فقال عليّ: فقمت فقلت مثل مقالتي الأولى،
فقال: اجلس، ثم أعاد القول ثالثة، فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقمت فقلت: أنا
أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال: اجلس فأنت أخي ووزيري، ووصيي
ووارثي، وخليفتي من بعدي. فنهض القوم وهو يقولون لأبي طالب: ليهنك اليوم أن
دخلت في دين ابن أخيك، فقد جعل ابنك أميراً عليك".
والجواب
من وجوه: الأول: المطالبة بصحة النقل. وما ادّعاه من نقل الناس كافة من
أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث، فإن هذا الحديث ليس في شيء من كتب
المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل: لا في الصحاح ولا في المساند
والسنن والمغازي والتفسير التي يُذكر فيها الإسناد الذي يُحتج به(1)، وإذا
كان في بعض كتب التفسير التي يُنقل منها الصحيح والضعيف، مثل تفسير
الثعلبي والواحدي والبغوي، بل وابن جرير وابن أبي حاتم،لم يكن مجرد رواية
واحدٍ من هؤلاء، دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم؛ فإنه إذا عُرف أن تلك
المنقولات فيها صحيح وضعيف، فلابد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح
دون الضعيف.
وهذا الحديث غايته أن يُوجد في بعض كتب التفسير التي فيها
الغث والسمين، وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة، مع أن كتب التفسير التي
يُوجد فيها هذا مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي، يُنقل
فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذا، مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا
في سبب نزول الآية، فإنهم ذكروا مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي
اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك، ولكن هؤلاء المفسرون ذكروا ذلك
على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذُكر في سبب نزول الآية من المنقولات
الصحيحة والضعيفة، ولهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال، ليذكر
أقوال الناس وما نقلوه فيها، وإن كان بعض ذلك هو صحيح وبعضه كذب، وإذا
احتج بمثل هذا الضعيف وأمثاله واحدٌ بذكر بعض ما نُقل في تفسير الآية من
المنقولات، وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك، كان هذا من أفسد الحجج، كمن
احتجّ بشاهد يشهد له ولم تثبت عدالته بل ثبت جرحه، وقد ناقضه عدولٌ كثيرون
يشهدون بما يناقض شهادته، أو يحتج برواية واحدٍ لم تثبت عدالته بل ثبت
جرحه، ويدع روايات كثيرين عدول، وقد رووا ما يناقض ذلك.
بل لو
قُدِّر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة، وقد روى آخرون من أهل
الثقة والعدالة ما يناقض ذلك، لوجب النظر في الروايتين: أيهما أثبت وأرجح؟
فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضة لهذا
الحديث هي الثابتة الصحيحة، بل هذا الحديث مناقض لِمَا عُلم بالتواتر،
وكثير من أئمة التفسير لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه باطل.
الثاني:
أنّا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين: إما بإسنادٍ يذكره مما يحتج
به أهل العلم في مسائل النزاع، ولو أنه مسألة فرعية، وإما قول رجل من أهل
الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم.
فإنه لو تناظر فقيهان في فرع من
الفروع، لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يُعلم أنه مسند إسناداً تقوم
به الحجة، أو يصححه من يُرجع إليه في ذلك. فأما إذا لم يُعلم إسناده، ولم
يثبته أئمة النقل، فمن أين يُعلم؟ لا سيما في مسائل الأصول التي يُبنى
عليها الطعن في سلف الأمة وجمهورها، ويُتوسل بذلك إلى هدم قواعد المسألة،
فكيف يقبل في مثل ذلك حديث لا يُعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل ولا يعرف
أن عالماً صححه.
الثالث: أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث،
فما من عالم يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع، ولهذا لم يروه أحد
منهم في الكتب التي يُرجع إليها في المنقولات، لأن أدنى من له معرفة
بالحديث يعلم أن هذا كذب.
وقد رواه ابن جرير والبغوي بإسنادٍ فيه عبد
الغفار بن القاسم بن فهد، أبو مريم الكوفي(2) وهو مجمع على تركه، كذَّبه
سماك بن حرب وأبو داود، وقال أحمد: "ليس بثقةٍ، عامة أحاديثه بواطيل. قال
يحيى: ليس بشيء. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال النسائي وأبو
حاتم: متروك الحديث. وقال ابن حبان البستي: كان عبد الغفار بن قاسم يشرب
الخمر حتى يسكر، وهو مع ذلك يقلب الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به، وتركه
أحمد ويحيى"(3).
ورواه ابن أبي حاتم، وفي إسناده عبد الله بن عبد
القدوس، وهو ليس بثقة. وقال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث. وقال
النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف(4).
وإسناد الثعلبي أضعف، لأن فيه من لا يعرف، وفيه من الضعفاء والمتهمين من لا يجوز الاحتجاج بمثله في أقل مسألة.
الرابع:
أن بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلاً حين نزلت هذه الآية، فإنها نزلت
بمكة في أول الأمر. ثم ولا بلغو أربعين رجلاً في مدّة حياة النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم، فإن بني عبد المطلب لم يُعقِب منهم باتفاق الناس إلا
أربعة: العباس، وأبو طالب، والحارث، وأبو لهب. وجميع ولد عبد المطلب من
هؤلاء الأربعة، وهم بنو هاشم، ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة:
العباس، وحمزة، وأبو طالب، وأبو لهب، فآمن اثنان، وهما حمزة والعباس، وكفر
اثنان، أحدهما نصره وأعانه، وهو أبو طالب، والآخر عاداه وأعان أعدائه، وهو
أبو لهب.
وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين:
طالب، وعقيل، وجعفر، وعليّ. وطالب لم يدرك الإسلام، وأدركه الثلاثة، فآمن
عليّ وجعفر في أول الإسلام، وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة، ثم إلى المدينة
عام خيبر.
وكان عقيل قد استولى على رباح بني هاشم لما هاجروا وتصرف
فيها، ولهذا لما قيل للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حجته: "ننزل غداً في
دارك بمكة" قال: "وهل ترك لنا عقيل من دار"؟(5).
وأما العباس فبنوه كلهم صغار، إذ لم يكن فيهم بمكة رجل.
وهب
أنهم كانوا رجالاً فهم: عبد الله، وعبيد الله، والفضل، وأما قثم فولد
بعدهم، وأكبرهم الفضل، وبه كان يُكَنَّى. وعبد الله ولد في الشعب بعد نزول
قوله: { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } [الشعراء: 214] وكان له في
الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سنين، ولم يولد للعباس في حياة النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم إلا الفضل وعبد الله وعُبيد الله، وأما سائرهم فولدوا
بعده.
وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل، والحارث كان
له ابنان: أبو سفيان وربيعة، وكلاهما تأخر إسلامه، وكان من مسلمة الفتح.
وكذلك
بنو أبي لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح، وكان له ثلاثة ذكور، فأسلم منهم
اثنان: عتبة ومغيث، وشهد الطائف وحنيناً، وعتبة دعا عليه رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم أن يأكله الكلب، فقتله السبع بالزرقاء من الشام كفراً(6).
فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلاً، فأين الأربعون؟!
الخامس:
قوله: "إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفَرَق من اللبن" فكذب على
القوم، ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه الكثرة في الأكل، ولا عُرف فيهم من
كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقاً.
السادس: أن قوله للجماعة: "من يجيبني
إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووصي وخليفتي من
بعدي" كلام مفترى على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، لا يجوز نسبته إليه،
فإن جرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله، فإن
جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين، وأعانوا على هذا الأمر، وبذلوا
أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته، وفارقوا أوطانهم، وعادوا إخوانهم،
وصبروا على الشتات بعد الألفة، وعلى الذل بعد العز، وعلى الفقر بعد الغنى،
وعلى الشدة بعد الرخاء، وسيرتهم معروفة مشهورة، ومع هذا فلم يكن أحد منهم
بذلك خليفة له.
وأيضاً فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلاً أمكن
أن يجيبوه - أو أكثرهم أو عدد منهم - فول أجابه منهم عدد من كان الذي يكن
الخليفة بعده؟ أيعيّن واحداً بلا موجب؟ أم يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد؟
وذلك أنه لم يعلق الوصية والخلافة، والأخوة والمؤازرة، إلا بأمر سهل، وهو
الإجابة إلى الشهادتين، والمعاونة على هذا الأمر. وما من مؤمن يؤمن بالله
ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة، إلا وله من هذا نصيب وافر، ومن لم
يكن له من ذلك حظ فهو منافق، فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم؟!
السابع: أن حمزة وجعفراً وعبيدة بن الحارث
أجابوا إلى ما أجابه عليّ من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر، فإن
هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله في أول الأمر، بل
حمزة أسلم قبل أن يصير المؤمنين أربعين رجلاً، وكان النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان اجتماع النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم به في دار الأرقم، ولم يكن يجتمع هو وبنو عبد المطلب كلهم في دار
واحدة، فإن أبا لهب كان مظهراً لمعاداة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،
ولما حُصر بنو هاشم في الشِعب لم يدخل معهم أبو لهب.
الثامن: أن
الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا. ففي الصحيحين عن ابن عمر وأبي
هريرة - واللفظ له - عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما نزلت: {
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } [الشعراء: 214] دعا رسول الله
صلَّى الله عليه وسلَّم قريشاً، فاجتمعوا، فخص وعم فقال: "يا بني كعب بن
لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مُرَّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من
النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا
أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب
أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. فإني لا
أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها"(7).
وفي
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً لَمَّا نزلت هذه الآية قال: "يا
معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد
المطلب لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من
الله شيئاً. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً. سلاني ما شئتما
من مالي"(8) وخرجه مسلم من حديث ابن المخارق وزهير بن عمرو(9)، ومن حديث
عائشة وقال فيه: "قام على الصفا"(10).
وقال في حديث قبيصة: "انطلق إلى
رضمة من جبل، فعلا أعلاها حجراً، ثم نادى: يا بني عبد مناف إني لكم نذير،
إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق بربأ أهله، فخشي أن يسبقوه،
فجعل يهتف: يا صباحاه"(11).
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال:
"لما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى صعد الصفا،
فهتف: "يا صباحاه" فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه،
فجعل ينادي: "يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب" وفي
رواية: "يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان" لبطون قريش فجعل الرجل إذا
لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هو، فاجتمعوا فقال: "أرأيتكم لو
أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدّقي"؟ قالوا: ما جربنا
عليك كذباً. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" قال: فقال أبو لهب:
تبّاً لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ فقام فنزلت هذه السورة: { تَبَّتْ يَدَا
أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } [المسد: 1](12).
وفي رواية: ""أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم ويمسّيكم أكنتم تصدّقوني"؟ قالوا: بلى"(13).
فإن قيل: فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنِّفين في الفضائل، كالثعلبي والبغوي وأمثالهما والمغازلي.
قيل
له: مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث، فإن
في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع،
وفيها شيء كثير يُعلم بالأدلة اليقينية السمعية والعقلية أنها كذب، بل
فيها ما يُعلم بالاضطرار أنه كذب. والثعلبي وأمثاله لا يتعمدون الكذب، بل
فيهم من الصلاح والدين ما يمنعهم من ذلك، لكن ينقلون ما وجدوه في الكتب،
ويروون ما سمعوه، وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث،
كشعبة، ويحيى بن سعيد القطَّان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي
بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري،
ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، وأبي عبد
الله بن منده، والدارقطني، وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث ونقاده وحكامه
وحفاظه الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من الصحابة
والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من نقلة العلم.
وقد صنَّفوا الكتب
الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسماءهم، وذكروا أخبارهم
وأخبار من أخذوا عنه، ومن أخذ عنهم، مثل كتاب "العلل وأسماء الرجال" عن
يحيى القطَّان، وابن المديني، وأحمد، وابن معين والبخاري، ومسلم، وأبي
زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والترمذي، وأحمد بن عدي، وابن حبان، وأبي
الفتح الأزدي، والدارقطني وغيرهم.
وتفسير الثعلبي فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة، ومن الموضوع فيه من الأحاديث التي في فضائل السور: سورة سورة.
وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدي(14)، وهو كذب موضوع باتفاق أهل الحديث. وكذلك غير هذا.
وكذلك
الواحدي تلميذ الثعلبي. والبغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي،
لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه، والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا،
والبغوي أتبع للسنة منهما.
وليس كون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون
خلافة الثلاثة يُوجب له أن كل ما رواه صدق، كما أن كونه من الشيعة لا يوجب
أن يكون كل ما رواه كذباً، بل الاعتبار بميزان العدل.
وقد وضع الناس
أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: في الأصول،
والأحكام، والزهد، والفضائل، ووضعوا كثيراً من فضائل الخلفاء الأربعة،
وفضائل معاوية.
ومن الناس من يكون قصده رواية ما رُوي في الباب، من غير
تمييز بين صحيح وضعيف، كما فعله أبو نُعيم في فضائل الخلفاء وكذلك غيره
ممن صنَّف في الفضائل، ومثل ما جمعه أبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبو علي
الأهوازي وغيرهما في فضائل معاوية، ومثل ما جمعه النسائي في فضائل عليّ،
وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر في فضائل عليّ وغيره، فإن هؤلاء
وأمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه، فلا
يجوز أن يُجزم بصدق الخبر بمجرد رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم.
وأما
من يذكر الحديث بلا إسناد من المصنّفين في الأصول والفقه والزهد والرقائق،
فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة، ويذكر بعضهم أحاديث كثيرة ضعيفة
وموضوعة، كما يوجد ذلك في كتب الرقائق والرأي وغير ذلك.
الفصل الثاني
بيان أن إمامة عليّ لم تكن من الدين الذي أمر بتبليغه صلَّى الله عليه وسلَّم
قال
الرافضي: الثاني: الخبر المتواتر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: أنه
لَمّا نزل قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } [المائدة: 67] خطب الناس في غدير خُم وقال للجمع
كله: يا أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت
مولاه فعليٌّ مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره
واخذل من خذله. فقال عمر: بخٍ بخٍ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقرير منه صلَّى الله عليه
وسلَّم بقوله: ألست أولى منكم بأنفسكم؟.
والجواب عن هذه الآية والحديث
المذكور قد تقدم، وبيَّنّا أن هذا كذب، وأن قوله: { بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } [المائدة: 67] نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة.
ويوم
الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج، وعاش بعد ذلك شهرين
وبعض الثالث. ومما يبين ذلك أن آخر المائدة نزولاً قوله تعالى: {
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
} [المائدة: 3] وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع،
والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم واقف بعرفة، كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن،
وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم.
وغدير خم كان
بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عشر ذي الحجة بعد نزول هذه الآية بتسعة أيام،
فكيف يكون قوله: { بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } [المائدة:
67] نزل ذلك الوقت، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك،
وهي من أوائل ما نزل بالمدينة، وإن كان ذلك في سورة المائدة، كما أن فيها
تحريم الخمر، والخمر حُرِّمت في أوائل الأمر عقب غزوة أحد.
وكذلك
فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله: { فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } [المائدة: 42]. وهذه الآية نزلت إما في الحد لما
رجم اليهوديين، وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في
الدماء، ورجم اليهوديين كان أول ما فعله بالمدينة، وكذلك الحكم بين قريظة
والنضير، فإن بني النضير أجلاهم قبل الخندق، وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق.
والخندق
باتفاق الناس كان قبل الحديبية، وقبل فتح خيبر، وذلك كله قبل فتح مكة
وغزوة حنين، وذلك كله قبل حجة الوداع وحجة الوداع قبل خطبة الغدير.
فمن قال: إن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب مفتر باتفاق أهل العلم.
وأيضاً
فإن الله تعالى قال في كتابه: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [المائدة: 67] فضمن له
سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بلَّغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء،
ولهذا روي أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان قبل نزول هذه الآية يُحرس،
فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك(15).
وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ، وفي حجة الوداع تم التبليغ.
وقال
في حجة الوداع: "ألا هل بلغت ألا هل بلغت"؟ قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد"
وقال لهم: "أيها الناس إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب
الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون"؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت
ونصحت، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: "اللهم اشهد،
اللهم اشهد" وهذا لفظ حديث جابر في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث
الصحيحة(16).
وقال: "ليبلِّغ الشاهد الغائب، فربَّ مُبلَّغٍ أوعى من سامع"(17).
فتكون
العصمة المضمونة موجودة وقت التبليغ المتقدم، فلا تكون هذه الآية نزلت بعد
حجة الوداع، لأنه قد بلَّغ قبل ذلك، لأنه حينئذ لم يكن خائفاً من أحدٍ
يحتاج أن يُعصم منه، بل بعد حجة الوداع كان أهل مكة والمدينة وما حولهما
كلهم مسلمين منقادين له ليس فيهم كافر، والمنافقون مقموعون مُسِرُّون
للنفاق، ليس فيهم من يحاربه، ولا من يخاف الرسول منه. فلا يُقال له في هذه
الحال: { بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ }
[المائدة: 67].
وهذا مما يبين أن الذي جرى يوم الغدير لم يكن مما أمر
بتبليغه، كالذي بلَّغه في حجة الوداع، فإن كثيراً من الذين حجُّوا معه -
أو أكثرهم - لم يرجعوا معه إلى المدينة، بل رجع أهل مكة إلى مكة، وأهل
الطائف إلى الطائف، وأهل اليمن إلى اليمن، وأهل البوادي القريبة من ذاك
إلى بواديهم. وإنما رجع معه أهل المدينة ومن كان قريباً منها.
فلو كان
ما ذكره يوم الغدير مما أمر بتبليغه، كالذي بلَّغه في الحج، لبلَّغه في
حجة الوداع كما بلَّغ غيره، فلما لم يذكر في حجة الوداع إمامةً ولا ما
يتعلق بالإمامة أصلاً، ولم ينقل أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه في حجة
الوداع ذكر إمامة عليّ، بل ولا ذكر عليّاً في شيء من خطبته، وهو المجمع
العام الذي أمر فيه بالتبليغ العام، عُلم أن إمامة عليّ لم تكن من الدين
الذي أمر بتبليغه، بل ولا حديث الموالاة وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يُذكر
في إمامته.
والذي رواه مسلم أنه بغدير خم قال: "إني تارك فيكم الثقلين:
كتاب الله" فذكر كتاب الله وحضَّ عليه ثم قال: "وعترتي أهل بيتي أذكركم
الله في أهل بيتي" ثلاثاً. وهذا مما انفرد به مسلم(18)، ولم يروه البخاري،
وقد رواه الترمذي وزاد فيه: "وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض"(19).
وقد
طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، وقال: إنها ليست من الحديث.
والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو
هاشم لا يتفقون على ضلالة. وهذا قاله طائفة من أهل السنة، وهو من أجوبة
القاضي أبي يعلى وغيره.
والحديث الذي في مسلم، إذا كان النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم قد قاله، فليس فيه إلا الوصية باتِّباع كتاب الله. وهذا
أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتباع
العترة، ولكن قال: "أذكركم الله في أهل بيتي" وتذكير الأمة بهم يقتضي أن
يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم، والامتناع من ظلمهم،
وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خُم.
فعلم أنه لم يكن في غدير خُم أمر يشرع نزل إذ ذاك، لا في حق عليّ ولا غيره، لا إمامته ولا غيرها.
لكن
حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم أنه قال: "من كنت مولاه فعليّ مولاه". وأما الزيادة وهي قوله:
"اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه.." إلخ، فلا ريب أنه كذب(20).
ونقل الأثرم في "سننه" عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر، وأنه حدّث بحديثين:
أحدهما: قوله لعليّ: إنك ستعرض على البراءة مني فلا تبرأ.
والآخر: اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه، فأنكره أبو عبيد الله جداً، لم يشك أن هذين كذب.
وكذلك قوله: أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة، كذب أيضاً.
وأما
قوله: "من كنت مولاه فعليّ مولاه" فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه
العلماء، وتنازع الناس في صحته، فنُقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة
من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعَّفوه، ونُقل عن أحمد بن حنبل أنه
حسَّنه كما حسَّنه الترمذي. وقد صنَّف أبو العباس بن عُقْدَة مصنَّفاً في
جميع طرقه(21).
وقال ابن حزم(22): "الذي صح من فضائل عليّ فهو قول
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبيّ بعدي" وقوله(23): "لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه
الله ورسوله" وهذه صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل(24)، وعهده صلَّى الله
عليه وسلَّم(25): أن عليّاً "لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق". وقد
صح مثل هذا في الأنصار أنهم(26) "لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر".
قال(27):
"وأما "من كنت مولاه فعليّ مولاه" فلا يصح من طريق الثقات أصلاً. وأما
سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض(28) فموضوعه، يعرف ذلك من له أدنى
علم بالأخبار ونقلها"(29).
فإن قيل: لم يذكر ابن حزم ما في الصحيحين من قوله: "أنت مني وأنا منك" وحديث المباهلة والكساء.
قيل:
مقصود ابن حزم: الذي في الصحيح من الحديث الذي لا يُذكر فيه إلا عليّ.
وأما تلك ففيها ذكر غيره، فإنه قال لجعفر: "أشبهت خَلقي وخُلقي" وقال
لزيد: "أنت أخونا ومولانا". وحديث المباهلة والكساء فيهما ذكر عليّ وفاطمة
وحسن وحسين رضي الله عنهم، فلا يرد هذا على ابن حزم.
ونحن نجيب بالجواب
المركّب فنقول: إن لم يكن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قاله فلا كلام،
وإن كان قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل
عليه. ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلَّغ بلاغاً مبيناً.
وليس في
الكلام ما يدل دلالة بيّنة على أن المراد به الخلافة، وذلك أن المولى
كالولي. والله تعالى قال: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُواْ } [المائدة: 55]، وقال: { وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ } [التحريم: 4]، فبيَّن أن الرسول
وليُّ المؤمنين، وأنهم مواليه أيضاً، كما بيَّن أن الله وليّ المؤمنين،
وأنهم أولياؤه، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض.
فالموالاة ضد المعاداة،
وهي تثبت من الطرفين، وإن كان أحد المتواليين أعظم قدراً، وولايته إحسان
وتفضل، وولاية الآخر طاعة وعبادة، كما أن الله يحب المؤمنين، والمؤمنون
يحبونه. فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة، والكفّار لا يحبون
الله ورسوله، ويحادّون الله ورسوله ويعادونه.
وقد قال تعالى: { لا
تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } [الممتحنة: 1]. وهو
يجازيهم على ذلك، كما قال تعالى: { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [البقرة: 279].
وهو وليّ
المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان كذلك فمعنى
كون الله وليّ المؤمنين ومولاهم، وكون الرسول وليهم ومولاهم، وكون عليّ
مولاهم، هي الموالاة التي هي ضد المعاداة.
والمؤمنين يتولون الله
ورسوله الموالاة المضادة لملعاداة، وهذا حكم ثابت لكل مؤمن، فعليُّ رضي
الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه.
وفي هذا
الحديث إثبات إيمان عليّ في الباطن، والشهادة له بأنه يستحق الموالاة
باطناً وظاهراً، وذلك يرد ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب، لكن
ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره فكيف ورسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم له موالي، وهم صالحوا المؤمنين، فعليّ أيضاً له مولى بطريق الأولى
والأحرى، وهم المؤمنون الذين يتولونه.
وقد قال الني صلَّى الله عليه
وسلَّم: إن أسلم وغفاراً ومزينة وجهينة وقريشاً والأنصار ليس لهم مولى دون
الله ورسوله(30)، وجعلهم موالي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، كما جعل
صالح المؤمنين مواليه والله ورسوله مولاهم.
وفي الجملة فرق بين الوليّ
والمولى ونحو ذلك وبين الوالي. فباب الولاية - التي هي ضدّ العداوة - شيء،
وباب الولاية - التي هي الإمارة - شيء.
والحديث إنما هو في الأولى دون
الثانية. والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يقل: من كنت واليه فعليّ
واليه. وإنما اللفظ "من كنت مولاه فعليّ مولاه".
وأما كون المولى بمعنى الوالي، فهذا باطل. فإن الولاية تثبت من الطرفين، فإن المؤمنين أولياء الله، وهو مولاهم.
وأما
كونه أولى بهم من أنفسهم، فلا يثبت إلا من طرفه صلَّى الله عليه وسلَّم.
وكونه أولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته، ولو قُدِّر أنه نصَّ على
خليفة من بعده، لم يكن ذلك موجباً أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه، كما أنه
لا يكون أزواجه أمهاتهم. ولو أريد هذا المعنى لقال: من كنت أولى به من
نفسه. وهذا لم يقله، ولم ينقله أحد، ومعناه باطل قطعاً؛ لأن كون النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم أولى بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت في حياته ومماته،
وخلافة عليّ - لو قدر وجودها - لم تكن إلا بعد موته، لم تكن في حياته، فلا
يجوز أن يكون عليٌّ خليفة في زمنه، فلا يكون حينئذ أولى بكل مؤمن من نفسه،
بل ولا يكون مولى أحد من المؤمنين، إذا أريد به الخلافة.
وهذا مما
يدل على أنه لم يُرِد الخلافة؛ فإن كونه وليّ كل مؤمن، وصف ثابت له في
حياة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، لم يتأخر حكمه إلى الموت. وأما
الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت. فعُلم أن هذا ليس هذا.
وإذا كان
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياته وبعد
مماته إلى يوم القيامة، وإذا استخلف أحداً على بعض الأمور في حياته، أو
قُدِّر أنه استخلف أحداً على بعض الأمور في حياته، أو قُدِّر أنه استخلف
أحداً بعد موته، وصار له خليفة بنص أو إجماع، فهو أولى بتلك الخلافة وبكل
المؤمنين من أنفسهم، فلا يكون قط غيره أولى بكل مؤمن من نفسه، لا سيما في
حياته.
وأما كون عليّ وغيره مولى كل مؤمن، فهو وصف ثابت لعليّ في حياة
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وبعد مماته، وبعد ممات عليّ، فعليّ اليوم
مولى كل مؤمن، وليس اليوم متولياً على الناس. وكذلك سائر المؤمنين بعضهم
أولياء بعض أحياءً وأمواتاً.
الفصل الثالث
نقض احتجاج الرافضة بحديث "أنت مني بمنزلة هارون من موسى"
قال
الرافضي: الثالث: قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي
بعدي. أثبت له "عليه السلام" جميع منازل هارون من موسى عليه السلام
للاستثناء. ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى، ولو عاش بعده لكان
خليفة أيضاً، وإلا لزم تطرّق النقض إليه، ولأنه خليفته مع وجوده وغيبته
مدة يسيرة، فبعد موته وطول مدة الغيبة، أولى بأن يكون خليفته".
والجواب:
أن هذا الحديث ثبت في الصحيحين بلا ريب وغيرها، وكان النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم قال له ذلك في غزوة تبوك. وكان صلَّى الله عليه وسلَّم كلما
سافر في غزوة أو عُمرة أو حج يستخلف على المدينة بعض الصحابة، كما استخلف
على المدينة في غزوة ذي أمر عثمان(31)، وفي غزوة بني قَيْنُقَاع بشير بن
عبد المنذر(32)، ولما غزا قريشاً ووصل إلى الفُرع استعمل ابن أم
مكتوم(33)، وذكر ذلك محمد بن سعد(34) وغيره.
وبالجملة فمن المعلوم
أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف. وقد ذكر المسلمون من كان يتسخلفه،
فقد سافر من المدينة في عُمرتين: عُمرة الحديبية وعمرة القضاء. وفي حجة
الوداع، وفي مغازيه - أكثر من عشرين غزاة - وفيها كلها استخلف، وكان يكون
بالمدينة رجال كثيرون يستخلف عليهم من يستخلفه، فلما كان في غزوة تبوك لم
يأذن لأحد في التخلف عنها، وهي آخر مغازيه صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم
يجتمع معه أحد كما اجتمع معه فيها، فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان، أو
من هو معذور لعجزه عن الخروج، أو من هو منافق، وتخلّف الثلاثة الذين تِيب
عليهم، ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم، كما كان يستخلف
عليهم في كل مرة بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه،
لأنه لم يبق في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحداً، كما
كان يبقي في جميع مغازيه، فإنه كان يكون بالمدينة رجال كثيرون من المؤمنين
أقوياء يستخلف عليهم مَن يستخلف، فكل استخلاف استخلفه في مغازيه، مثل
استخلافه في غزوة بدر الكبرى والصغرى، وغزوة بني المصطلق، والغابة، وخيبر،
وفتح مكة، وسائر مغازيه التي لم يكن فيها قتال، ومغازيه بضع عشرة غزوة،
وقد استخلف فيها كلها إلا القليل، وقد استخلف في حجة الوداع وعمرتين قبل
غزوة تبوك.
وفي كل مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقى في غزوة تبوك، فكان
كل استخلاف قبل هذه يكون عليٌّ أفضل ممن استخلف عليه عليّاً، فلهذا خرج
إليه عليٌّ رضي الله عنه يبكي، وقال: أتخلّفني مع النساء والصبيان؟
وقيل:
إن بعض المنافقين طعن فيه، وقال: إنما خلّفه لأنه يبغضه. فبيّن له النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم: إني إنما استخلفتك لأمانتك عندي، وإن الاستخلاف
ليس بنقص ولا غضٍّ، فإن موسى استخلف هارون على قومه، فكيف يكون نقصاً
وموسى يَفْعَله بهارون؟ فطيَّب بذلك قلب عليّ، وبيّن أن جنس الاستخلاف
يقتضي كرامة المستخلَف وأمانته، لا يقتضي إهانته ولا تخوينه، وذلك لأن
المستخلَف يغيب عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد خرج معه جميع
الصحابة.
والملوك - وغيرهم - إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم
انتفاعهم به، ومعاونته لهم، ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه ولسانه،
ويده وسيفه.
والمتخلف إذا لم يكن له في المدينة سياسة كثيرة لا يحتاج
إلى هذا كله، فظن من ظن أن هذا غضاضة من عليّ، ونقص منه، وخفض من منزلته،
حيث لم يأخذه معه في المواضع المهمة، التي تحتاج إلى سعي واجتهاد، بل تركه
في المواضع التي لا تحتاج إلى كثير سعي واجتهاد.
فكان قول النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم مبيّناً أن جنس الاستخلاف ليس نقصاً ولا غضّاً، إذ لو
كان نقصاً أو غضاً لما فعله موسى بهارون، ولم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف
هارون، لأن العسكر كان مع هارون، وإنما ذهب موسى وحده.
وأما استخلاف
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فجميع العسكر كان معه، ولم يُخَلَّف
بالمدينة - غير النساء والصبيان - إلا معذورٌ أو عاصٍ.
وقول القائل:
"هذا بمنزلة هذا، وهذا مثل هذا" هو كتشبيه الشيء بالشيء. وتشبيه الشيء
بالشيء يكون بحسب ما دلّ عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء.
ألا
ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث
الأسارى لَمّا استشار أبا بكر، وأشار بالفداء، واستشار عمر، فأشار بالقتل.
قال: "سأخبركم عن صاحبيكم. مثلك يا أبا بكر كمثل إبارهيم إذ قال: { فَمَن
تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
[إبراهيم: 36]، ومثل عيسى إذ قال: { إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ
عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
[المائدة: 118]. ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: { رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى
الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا } [نوح: 26]، ومثل موسى إذ قال: {
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ
يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ } [يونس: 88]".
فقوله
لهذا: مثلك كمثل إبراهيم وعيسى، ولهذا: مثل نوح وموسى، أعظم من قوله: أنت
مني بمنزلة هارون من موسى؛ فإن نوحاً وإبراهيم وعيسى أعظم من هارون، وقد
جعل هذين مثلهم، ولم يرد أنهما مثلهم في كل شيء، لكن فيما دلّ عليه السياق
من الشدة في الله واللين في الله.
وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما
دلّ عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه، كما استخلف موسى هارون. وهذا
الاستخلاف ليس من خصائص عليّ، بلا ولا هو مثل استخلافاته، فضلاً عن أن
يكون أفضل منها.
وقد استخلف مَنْ عليّ أفضل منه في كثير من الغزوات،
ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المستخلف على عليّ إذا قعد معه، فكيف
يكون موجباً لتفضيله على عليّ؟
بل قد استخلف على المدينة غير واحد،
وأولئك المستخلفون منه بمنزلة هارون من موسى من جنس استخلاف عليّ، بل كان
ذلك الاستخلاف يكون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك، وكانت
الحاجة إلى الاستخلاف أكثر، فإنه كان يخاف من الأعداء على المدينة.
فأما
عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز، وفُتحت مكة وظهر الإسلام وعزّ.
ولهذا أمر الله نبيّه أن يغزو أهل الكتاب بالشام، ولم تكن المدينة تحتاج
إلى من يقاتل بها العدو.
ولهذا لم يَدَع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
عند عليّ أحداً من المقاتلة، كما كان يَدَع بها في سائر الغزوات، بل أخذ
المقاتلة كلهم معه.
وتخصيصه لعليّ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب، وهو
نوعان: لقب هو جنس، ولقب يجري مجرى العلم، مثل زيد، وأنت. وهذا المفهوم
أضعف المفاهيم، ولهذا كان جماهير أهل الأصول والفقه على أنه لا يُحتج به.
فإذا قال: محمد رسول الله. لم يكن هذا نفياً للرسالة عن غيره، لكن إذا كان
في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص، فإنه يحتج به على الصحيح.
كقوله: {
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } [الأنبياء: 79]، وقوله: { كَلاّ إِنَّهُمْ
عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ } [المطففين: 15].
وأما إذا
كان التخصيص لسبب يقتضيه، فلا يُحتج به باتفاق الناس. فهذا من ذلك؛ فإنه
إنما خصَّ عليّاً بالذكر لأنه خرج إليه يبكي ويشتكي تخليفه مع النساء
والصبيان.
ومن استخلفه سوى عليّ، لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف
نقصاً، لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام، والتخصيص بالذكر إذا كان لسبب
يقتضي ذاك لم يقتضِ الاختصاص بالحكم، فليس في الحديث دلالة على أن غيره لم
يكن منه بمنزلة هارون من موسى، كما أنه لما قال للمضروب الذي نَهَى عن
لعنه: "دعه فإنه يحب الله ورسوله"(35) لم يكن هذا دليلاً على أن غيره لا
يحب الله ورسوله، بل ذكر ذلك لأجل الحاجة إليه لينهى بذلك عن لعنه.
ولما
استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل حاطب بن أبي بلتعة، قال: "دعه فإنه قد
شهد بدراً"(36) ولم يدل هذا على أن غيره لم يشهد بدراً، بل ذكر المقتضى
لمغفرة ذنبه.
وكذلك لما شهد للعشرة بالجنة، لم يقتض أن غيرهم لا يدخل الجنة، لكن ذكر ذلك لسبب اقتضاه.
وكذلك
لما قال للحسن وأسامة: "اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما"(37) لا
يقتضي أنه لا يحب غيرهما، بل كان يحب غيرهما أعظم من محبتهما.
وكذلك لما قال: "لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة" لم يقتض أن من سواهم يدخلها.
وكذلك لَمّا شبّه أبا بكر بإبراهيم وعيسى، لم يمنع ذلك أن يكون في أمته وأصحابه من يشبه إبراهيم وعيسى.
وكذلك لَمّا شبّه عمر بنوح وموسى، لم يمتنع أن يكون في أمته من يشبه نوحاً موسى.
فإن قيل: إن هذين أفضل من يشبههم من أمته.
قيل: الاختصاص بالكمال لا يمنع المشاركة في أصل التشبيه.
وكذلك
لما قال عن عروة بن مسعود: "إنه مثل صاحب ياسين"(38). وكذلك لما قال
للأشعريين: "هم مني وأنا منهم"(39) لم يختص ذلك بهم، بل قال لعلي: "أنت
مني وأنا منك" وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا"(40) وذلك لا يختص بزيد، بل
أسامة أخوهم ومولاهم.
وبالجملة الأمثال والتشبيهات كثيرة جداً، وهي لا
توجب التماثل من كل وجه، بل فيما سبق الكلام له، ولا تقتضي اختصاص
المشبَّه بالتشبيه، بل يمكن أن يشاركه غيره له في ذلك.
قال الله تعالى:
{ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ
حَبَّةٍ } [البقرة: 261].
وقال تعالى: { وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ } [يس: 13].
وقال: { مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ } [آل عمران: 117].
وقد قيل: إن في القرآن اثنين وأربعين مثلاً.
وقول
القائل: إنه جعله بمنزلة هارون في كل الأشياء إلا في النبوة باطل، فإن
قوله: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى"؟ دليل على أنه يسترضيه
بذلك ويطيِّب قلبه لِمَا توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته، فقال هذا على
سبيل الجبر له.
وقوله: "بمنزلة هارون من موسى" أي مثل منزلة هارون،
فإن نفس منزلته من موسى بعينها لا تكون لغيره، وإنما يكون له ما يشابهها،
فصار هذا كقوله: هذا مثل هذا، وقوله عن أبي بكر: مثله مثل إبراهيم وعيسى،
وعمر: مثله مثل نوح وموسى.
ومما يبين ذلك أن هذا كان عام تبوك، ثم بعد
رجوع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعث أبا بكر أميراً على الموسم، وأردفه
بعليّ، فقال لعليّ: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمورن فكان أبو بكر أميراً
عليه، وعليّ معه كالمأمور مع أمره: يصلّي خلفه، ويطيع أمره وينادي خلفه مع
الناس بالموسم: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان(41).
وإنما
أردفه به لينبذ العهد إلى العرب، فإنه كان من عادتهم أن لا يعقد العقود
وينبذها إلا السيد المطاع، أو رجل من أهل بيته. فلم يكونوا يقبلون نقض
العهود إلا من رجل من أهل بيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
ومما
يبيّن ذلك أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده، لم يكن هذا خطاباً
بينهما يناجيه به، ولا كان أخَّرَهُ حتى يخرج إليه عليّ ويشتكي، بل كان
هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس كلهم، بلفظ يبين المقصود.
ثم
من جهل الرافضة أنهم يتناقضون، فإن هذا الحديث يدل على أن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم لم يخاطب عليّاً بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم في غزوة
تبوك، فلو كان عليّ قد عرف أنه المستخلف من بعده - كما رووا ذلك فيما تقدم
- لكان عليّ مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته، ولم يخرج إليه
يبكي، ولم يقل له: أتخلفني مع النساء والصبيان؟
ولو كان عليّ بمنزلة
هارون مطلقاً لم يستخلف عليه أحداً. وقد كان يستخلف على المدينة غيره وهو
فيها، كما استخلف على المدينة عام خيبر غير عيّ، وكان عليّ بها أرمد، حتى
لحق بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فأعطاه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
الراية حين قدم، وكان قد أعطى الراية رجلاً فقال: "لأعطين الراية غداً
رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله".
وأما قوله: "لأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسيرة، فبعد موته وطول مدة الغيبة أولى بأن يكون خليفته".
فالجواب:
أنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غير عليّ استخلافاً أعظم من استخلاف عليّ،
واستخلف أولئك على أفضل من الذين استخلف عليهم عليّاً، وقد استخلف بعد
تبوك على المدينة غير عليّ في حجة الوداع، فليس جعل عليّ هو الخليفة بعده
لكونه استخلفه على المدينة بأولى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كما
استخلفه، وأعظم مما استخلفه، وآخر الاستخلاف كان على المدينة كان عام حجة
الوداع، وكان عليّ باليمن، وشهد معه الموسم، لكن استخلف عليها في حجة
الوداع غير عليّ.
فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف، فبقاء من استخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك.
وبالجملة
فالاستخلافات على المدينة ليست من خصائصه، ولا تدل على الأفضلية، ولا مع
الإمامة، بل قد استخلف عدداً غيره. ولكن هؤلاء جهّال يجعلون الفضائل
العامة المشتركة بين عليّ وغيره خاصة بعليّ، وإن كان غيره أكمل منه فيها،
كما فعلوا في النصوص والوقائع.
وهكذا فعلت النصارى: جعلوا ما أتى به
المسيح من الآيات دالاًّ على شيء يختص به من الحلول والاتحاد، وقد شاركه
غيره من الأنبياء فيما أتى به، وكان ما أتى به موسى من الآيات أعظم مما
جاء به المسيح، فليس هناك سبب يوجب اختصاص المسيح دون إبراهيم وعيسى، لا
بحلول ولا اتحاد، بل إن كان ذلك كله ممتنعاً، فلا ريب أنه كله ممتنع في
الجميع، وإن فُسِّرَ ذلك بأمر ممكن، كحصول معرفة الله والإيمان به،
والأنوار الحاصلة بالإيمان به ونحو ذلك، فهذا قدر مشترك وأمر ممكن.
وهكذا
الأمر مع الشيعة: يجعلون الأمور المشتركة بين عليّ وغيره، التي تعمّه
وغيره، مختصةً به، حتى رَبَّبوا عليه ما يختص به من العصمة والإمامة
والأفضلية. وهذا كله منتفٍ.
فمن عرف سيرة الرسول، وأحوال الصحابة،
ومعاني القرآن والحديث: علم أنه ليس هناك اختصاص بما يوجب أفضليته ولا
إمامته، بل فضائله مشتركة، وفيها من الفائدة إثبات إيمان عليّ وولايته،
والرد على النواصب الذين يسبّونه أو يفسقونه أو يكفرونه ويقولون فيه من
جنس ما تقوله الرافضة في الثلاثة.
ففي فضائل عليّ الثابتة ردٌّ على النواصب، كما أن في فضائل الثلاثة ردّاً على الروافض.
وعثمان
رضي الله عنه تقدح فيه الروافض والخوارج، ولكن شيعته يعتقدون إمامته،
ويقدحون في إمامة عليّ. وهم في بدعتهم خير من شيعة عليّ الذين يقدحون في
غيره. والزيديدة الذين يتولون أبا بكر وعرم مضطربون فيه.
وأيضاً
فالاستخلاف في الحياة نوع نيابة، لابد منه لكل ولي أمر، وليس كل مَنْ يصلح
للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يُستخلف بعد الموت؛ فإن النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم استخلف في حياته غير واحد، ومنهم من لا يصلح
للخلافة بعد موته، وذلك كبشير ابن عبد المنذر وغيره.
وأيضاً فإنه
مطالب في حياته بما يجب عليه من القيام بحقوق الناس، كما يُطالب بذلك ولاة
الأمور. وأما بعد موته فلا يطالب بشيء، لأنه قد بلّغ الرسالة، وأدّى
الأمانة، ونصح الأمة، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربّه. ففي حياته يجب
عليه جهاد الأعداء، وتقسيم الفيء، وإقامة الحدود، واستعمال العمّال، وغير
ذلك مما يجب على ولاة الأمور بعده، وبعد موته لا يجب عليه شيء من ذلك.
فليس
الاستخلاف في الحياة كالاستخلاف بعد الموت. والإنسان إذا استخلف أحداً في
حياته على أولاده وما يأمر به من البرّ، كان المستخلف وكيلاً محضاً يفعل
ما أمر به الموكِّل، وإن استخلف أحداً على أولاده بعد موته، كان وليّاً
مستقلاًّ يعمل بحسب المصلحة، كما أمر الله ورسوله، ولم يكن وكيلاً للميّت.
وهكذا
أولو الأمر إذا استخلف أحدهم شخصاً في حياته، فإنه يفعل ما يأمره به في
القضايا المعيّنة. وأما إذا استخلفه بعد موته فإنه يتصرف بولايته كما أمر
الله ورسوله، فإن هذا التصرف مضاف إليه لا إلى الميت، بخلاف ما فعله في
الحياة بأمر مستخلفه، فإنه يُضاف إلى من استخلفه لا إليه. فأين هذا من
هذا؟!.
ولم يقل أحد من العقلاء: إن من استخلف شخصاً على بعض الأمور.
وانقضى ذلك الاستخلاف: إنه يكون خليفة بعد موته على شيء، ولكن الرافضة من
أجهل الناس بالمعقول والمنقول.
الفصل الرابع
نقض قياس الرافضة الاستخلاف في الممات على الاستخلاف في المغيب
قال
الرافضي: الرابع: "أنه صلَّى الله عليه وسلَّم استخلفه على المدينة مع قصر
مدة الغيبة، فيجب أن يكون خليفة له بعد موته. وليس غير عليّ إجماعاً،
ولأنه لم يعزله عن المدينة، فيكون خليفة له بعد موته فيها، وإذا كان خليفة
فيها كان خليفة في غيرها إجماعاً".
والجواب: أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة، التي هي من جنس بيت العنكبوت. والجواب عنها من وجوه:
أحدها:
أن نقول على أحد القولين: إنه استخلف أبا بكر بعد موته كما تقدم. وإذا
قالت الرافضة: بل استخلف عليّاً. قيل: الراوندية من جنسكم قالوا: استخلف
العبّاس، وكل من كان له علم بالمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالة
على استخلاف أحدٍ بعد موته إنما تدل على استخلاف أبي بكر، ليس فيها شيء
يدل على استخلاف عليّ ولا العباس، بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحداً
منهما. فيقال حينئذ: إن كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم استخلف أحداً
فلم يستخلف إلا أبا بكر، وإن لم يستخلف أحداً فلا هذا ولا هذا.
فعلى
تقدير كون الاستخلاف واجباً على الرسول، لم يستخلف إلا أبا بكر، فإن جميع
أهل العلم بالحديث والسيرة متفقون على أن الأحاديث الثابتة لا تدل على
استخلاف غير أبي بكر، وإنما يدل ما يدل منها على استخلاف أبي بكر. وهذا
معلوم بالاضطرار عند العالم بالأحاديث الثابتة.
الوجه الثاني: أن نقول:
أنتم لا تقولون بالقياس، وهذا احتجاج بالقياس، حيث قستم الاستخلاف في
الممات على الاستخلاف في المغيب. وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين
فنقول: الفرق بينهما ما نبّهنا عليه في استخلاف عمر في حياته، وتوقفه في
الاستخلاف بعد موته، لأن الرسول في حياته شاهد على الأمة، مأمور بسياستها
بنفسه أو نائبه، وبعد موته انقطع عنه التكليف.
كما قال المسيح: {
وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ } [المائدة: 117] الآية،
لم يقل: كان خليفتي الشهيد عليهم. وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف، فدل
على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت.
وكذلك ثبت عن النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "فأقول كما قال العبد الصالح: { وَكُنتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ } [المائدة: 117]"(42).
وقد
قال تعالى: { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ } [آل عمران: 144].
فالرسول بموته
انقطع عنه التكليف، وهو لو استخلف خليفة في حياته لم يجب أن يكون معصوماً،
بل كان يولّي الرجل ولايةً، ثم يتبيّن كذبه فيعزله، كما ولّى الوليد بن
عقبة بن أبي معيط، وهو لو استخلف رجلاً لم يجب أن يكون معصوماً، وليس هو
بعد موته شهيداً عليه، ولا مكلَّفاً بردّه عما يفعله، بخلاف الاستخلاف في
الحياة.
الوجه الثالث: أن يُقال الاستخلاف في الحياة واجبٌ على كل وليّ
أمر؛ فإن كل وليّ أمر - رسولاً كان أو إماماً - عليه أن يستخلف فيما غاب
عنه من الأمور، فلابد له من إقامة الأمر: إما: بنفسه، وإما بنائبه. فما
شهده من الأمر أمكنه أن يقيمه بنفسه، وأما ما غاب عنه فلا يمكنه إقامته
إلا بخليفة يستخلفه عليه، فيولّي على مَنْ غاب عنه مِن رعيته مَنْ يأمرهم
بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأخذ منهم الحقوق، ويقيم فيهم الحدود، ويعدل
بينهم في الأحكام، كما كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يستخلف في حياته
على كل ما غاب عنه، فيولِّي الأمراء على السرايا: يصلّون بهم، ويجاهدون
بهم، ويسوسونهم، ويؤمِّر أمراء على الأمصار، كما أمَّر عتاب بن أسيد على
مكة، وأمَّر خالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وأبا سفيان بن
حرب ومعاذاً وأبا موسى على قرى عُرينة وعلى نجران وعلى اليمن، وكما كان
يستعمل عمالاً على الصدقةن فيقبضونها ممن تجب عليه، ويعطونها لمن تحلّ له،
كما استعمل غير واحد.
وكان يستخلف في إقامة الحدود، كما قال لأنيس: "يا أنيس اغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"(43) فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
وكان
يستخلف على الحج، كما استخلف أبا بكر على إقامة الحج عام تسع بعد غزوة
تبوك، وكان عليّ من جملة رعية أبي بكر: يصلّي خلفه، ويأتمر بأمره، وذلك
بعد غزوة تبوك.
وكما استخلف على المدينة مراتٍ كثيرة، فإنه كان كلما
خرج في غزاة استخلف. ولما حج واعتمر استخلف، فاستخلف في غزوة بدر، وبني
المصطلق، وغزوة الفتح، واستخلف في غزوة الحديبية، وفي غزوة القضاء، وحجة
الوداع، وغير ذلك.
وإذا كان الاستخلاف في الحياة واجباً على متولي
الأمر وإن لم يكن نبيّاً، مع أنه لا يجب عليه الاستخلاف بعد موته، لكون
الاستخلاف في الحياة أمراً ضرورياً لا يؤدى الواجب إلا به، بخلاف
الاستخلاف بعد الموت، فإنه قد بلَّغ الأمة، وهو الذي يجب عليهم طاعته بعد
موته، فيمكنهم أن يعينوا مَنْ يؤمّرونه عليهم، كما يمكن ذلك في كل فروض
الكفاية التي تحتاج إلى واحد معيّن - عُلم أنه لا يلزم من وجوب الاستخلاف
في الحياة وجوبه بعد الموت.
رابع: أن الاستخلاف في الحياة واجبٌ في
أصناف الولايات، كما كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يستخلف على من غاب
عنهم مَنْ يقيم فيهم الواجب، ويستخلف في الحج، وفي قبض الصدقات، وحفظ مال
الفيء، وفي إقامة الحدود، وفي الغزو وغير ذلك.
ومعلوم أن هذا
الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء، بل ولا يمكن، فإنه لا يمكن أن
يعيّن للأمة بعد موته مَنْ يتولّى كل أرم جزئي، فإنهم يحتاجون إلى واحدٍ
بعد واحد، وتعيين ذلك متعذر، ولأنه لو عيَّن واحداً. فقد يختلف حاله ويجب
عزله، فقد كان يولّى في حياته من يُشكى إليه فيعزله، كما عزل الوليد بن
عقبة، وعزل سعد بن عبادة عام الفتح وولى ابنه قيساً، وعزل إماماً كان
يصلّي بقوم لما بصق في القبلة، وولَّى مرة رجلاً فلم يقم بالواجب، فقال:
"أعجزتم إلا ولّيت من لا يقوم بأمر أن تولّوا رجلاً يقوم بأمري"(44) فقد
فوّض إليهم عزل مَنْ لا يقوم بالواجب من ولاته، فكيف لا يفوض إليهم ابتداء
تولية من يقوم بالواجب؟!
وإذا كان في حياته مَنْ يولّيه ولا يقوم
بالواجب فيعزله، أو يأمر بعزله، كان لو ولّى واحداً بعد موته يمكن فيه أن
لا يقوم بالواجب، وحينئذ فيحتاج إلى عزله، فإذا ولّته الأمة وعزلته، كان
خيراً لهم مِنْ أن يعزلوا مَنْ ولاّه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. وهذا
مما يتبين به حكمة ترك الاستخلاف، وعلى هذا فنقول في:
الوجه الخامس: أن
ترك الاستخلاف بعد مماته كان أولى من الاستخلاف، كما اختاره الله لنبيه،
فإنه لا يختار له إلا أفضل الأمور. وذلك لأنه: إما أن يُقال: يجب أن لا
يستخلف في حياته من ليس بمعصوم، وكان يصدر من بعض نوّابه أمور منكرة
فينكرها عليهم، ويعزل من يعزل منهم. كما استعمل خالد بن الوليد على قتال
بني جذيمة فقتلهم، فوَدَاهم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بنصف دياتهم،
وأرسل عليّ بن أبي طالب فضمن لهم حتى مبلغة الكلب، ورفع النبي صلَّى الله
عليه وسلَّم يديه إلى السماء وقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد".
واختصم
خالد وعبد الرحمن بن عوف حتى قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تسبُّوا
أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ
أحدهم ولا نصيفه" ولكن مع هذا لم يعزل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
خالداً.
واستعمل الوليد بن عقبة على صدقات قومٍ، فرجع فأخبره أن القوم
امتنعوا وحاربوا، فأراد غزوهم، فأنزل الله تعالى: { إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ } [الحجرات: 6].
وولّى سعد بن عبادة يوم الفتح، فلما بلغه أن سعداً قال:
اليوم يوم الملحمة اليوم تستباح الحرمة
عزله، وولّى ابنه قيساً، وأرسل بعمامته علامةً على عزله، ليعلم سعد أن ذلك أمرٌ من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
وكان
يُشْتَكى إليه بعض نوابه فيأمره بما أمر الله به، كما اشتكى أهل قباء
معاذاً لتطويله الصلاة بهم، لما قرأ البقرة في صلاة العشاء فقال: "أفتَّان
أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها"(45).
وفي
الصحيح أن رجلاً قال له: إني أتخلّف عن صلاة الفجر مما يطوِّل بنا فلان،
فقال: "يا أيها الناس إذا أمَّ أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير
وذا الحاجة، وإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء"(46).
ورأى إماماً قد بصق في قبلة المسجد، فعزله عن الإمامة، وقال: "إنك آذيت الله ورسوله"(47).
وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل عليه الشيء أرسل إليه يسأله عنه.
فكان
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حياته يعلّم خلفاءه ما جهلوا،
ويقوِّمهم إذا زاغوا، ويعزلهم إذا لم يستقيموا، ولم يكونوا مع ذلك
معصومين، فعلم أنه لم يكن يجب عليه أن يولّي المعصوم.
وأيضاً فإن هذا
تكليف ما لا يمكن، فإن الله لم يخلق أحداً معصوماً غير الرسول صلَّى الله
عليه وسلَّم. فلو كُلِّف أن يستخلف معصوماً لكُلِّف ما لا يقدر عليه، وفات
مقصود الولايات، وفسدت أحوال الناس في الدين والدنيا.
وإذا عُلم أنه
يجوز - بل يجب - أن يستخلف في حياته من ليس بمعصوم، فلو استخلف بعد موته
كما استخلف في حياته، لاستخلف أيضاً غير معصوم، وكان لا يمكنه أن يعلّمه
ويقوِّمه كما كان يفعل في حياته، فكان أن لا يستخلف خيراً من أن يستخلف.
والأمة
قد بلغها أمر الله ونهيه، وعلموا ما أمر الله به ونهى عنه، فهم يستخلفون
من يقوم بأمر الله ورسوله، ويعاونونه على إتمامهم القيام بذلك، إذا كان
الواحد لا يمكنه القيام بذلك، فما فاته مِنَ العلم بيّنه له مَنْ يعلمه،
وما احتاج إليه من القدرة عاونه عليه من يمكنه الإعانة، وما خرج فيه عن
الصواب أعادوه إليه بحسب الإمكان بقولهم وعملهم، وليس على الرسول ما
حُمِّلوه، كما أنهم ليس عليهم ما حُمِّل.
فعُلم أن ترك الاستخلاف من
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد الموت أكمل في حق الرسول من الاستخلاف،
وأن مَنْ قاس وجوب الاستخلاف بعد الممات على وجوبه في الحياة كان من أجهل
الناس.
وإذا علم الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة، كما كان
يعلم أن أبا بكر هو أحق بالخلافة من غيره، كان في دلالته للأمة على أنه
أحق، مع علمه بأنهم يولُّونه، ما يغنيه عن استخلافه، لتكون الأمة هي
القائمة بالواجب، ويكون ثوابها على ذلك أعظم من حصول مقصود الرسول.
وأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل عمر، وخاف أن لا يولُّوه إذا لم يستخلفه لشدته، فولاه هو، كان ذلك هو المصلحة للأمة.
فالنبي
صلَّى الله عليه وسلَّم عَلِمَ أن الأمة يولُّون أبا بكر، فاستغنى بذلك عن
توليته، مع دلالته لهم على أنه أحق الأمة بالتولية، وأبو بكر لم يكن يعلم
أن الأمة يولُّون عمر إذا لم يستخلفه أبو بكر. فكان ما فعله النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم هو اللائق به لفضل علمه، وما فعله صدِّيق الأمة هو
اللائق به إذ لم يعلم ما علمه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
الوجه
السادس: أن يقال: هب أن الاستخلاف واجب، فقد استخلف النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم أبا بكر، على قول من يقول: إنه استخلفه، ودلَّ على استخلافه على
القول الآخر.
وقوله: "لأنه لم يعزله عن المدينة".
قلنا: هذا باطل،
فإنه لَمّا رجع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم انعزل عليّ بنفس رجوعه، كما
كان غيره ينعزل إذا رجع. وقد أرسله بعد هذا إلى اليمن، حتى وافاه بالموسم
في حجة الوداع، واستخلف على المدينة في حجة الوداع غيره.
أفترى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فيها مقيماً وعليّ باليمن، وهو خليفة بالمدينة؟!
ولا
ريب أن كلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، كأنهم
ظنّوا أن عليّاً مازال خليفة على المدينة حتى مات النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم، ولم يعلموا أن عليّاً بعد ذلك أرسله النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
سنة تسع مع أبي بكر لنبذ العهود، وأمَّر عليه أبا بكر، ثم بعد رجوعه مع
أبي بكر أرسله إلى اليمن، كما أرسل معاذاً وأبا موسى.
ثم لما حج النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم حجة الوداع استخلف على المدينة غير عليّ، ووافاه
عليّ بمكة، ونحر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مائة بدنة، نحر بيده
ثُلُثَيها، ونحر عليّ ثُلُثَها.
وهذا كله معلوم عند أهل العلم، متفق عليه بينهم، وتواترت به الأخبار، كأنك تراه بعينك.
ومن لم يكن له عناية بأحوال الرسول لم يكن له أن يتكلم في هذه المسائل الأصولية.
والخليفة
لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته، فالنبي صلَّى الله عليه
وسلَّم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها، كما أن سائر من
استخلفه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما رجع انقضت خلافته.
وكذلك سائر ولاة الأمور: إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف.
ولهذا لا يصلح أن يُقال: إن الله يستخلف أحداً عنه، فإنه حيّ قيوم شهيد مدبِّر لعباده، مُنزّه عن الموت والنوم والغَيبة.
ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لستُ خليفة الله، بل خليفة رسول الله، وحسبي ذلك.
والله
تعالى يوصف بأنه يخلف العبد، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "اللهم أنت
الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل"(48)، وقال في حديث الدّجَّال: "والله
خليفتي على كل مسلم"(49).
وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله.
كقوله:
{ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم } [يونس:
14]، { وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ }
[الأعراف: 69]، { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } [النور: 55].
وكذلك قوله: { إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً } [البقرة: 30]، أي: عن خلقٍ كان في الأرض قبل
ذلك، كما ذكر المفسرون وغيرهم(50).
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله، فهذا جهل وضلال.
الفصل الخامس
إثبات أن حديث "عليّ أخي ووصيي وخليفتي وقاضي ديني" كذب وموضوع
قال
الرافضي: "الخامس: ما رواه الجمهور عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه
قال لأمير المؤمنين: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي دَيْني، وهو
نصٌّ في الباب".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الحديث،
فإن هذا الحديث ليس في شيء من الكتب التي تقوم الحجة بمجرد إسناده إليها،
ولا صححه إمام من أئمة الحديث.
وقوله: "رواه الجمهور": إن أراد بذلك
أن علماء الحديث رووه في الكتب التي يُحتج بما فيها، مثل كتاب البخاري
ومسلم ونحوهما، وقالوا: إنه صحيح، فهذا كذب عليهم، وإن أراد بذلك أن هذا
يرويه مثل أبي نُعيم في "الفضائل" والمغازلي وخطيب خوارزم ونحوهم، أو
يُروى في كتب الفضائل، فمجرد هذا ليس بحجة باتفاق أهل العلم في مسألة
فروع، فكيف في مسألة الإمامة، التي قد أقمتم عليها القيامة؟!
الثاني:
أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث(51). وقد تقدّم كلام
ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة، يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار
ونقلتها.
وقد صدق في ذلك، فإن من له أدنى معرفة بصحيح الحديث وضعيفه،
ليعلم أن هذا الحديث ومثله ضعيف، بل كذب موضوع، ولهذا لم يُخَرِّجْه أحد
من أهل الحديث في الكتب التي يُحتج بما فيها، وإنما يرويه مَنْ يرويه في
الكتب التي يُجمع فيها بين الغثّ والسمين، التي يعلم كل عالم أن فيها ما
هو كذب، مثل كثير من كتب التفسير: تفسير الثعلبي والواحدي ونحوهما، والكتب
التي صنّفها في الفضائل مَنْ يجمع الغثّ والسمين، لا سيما خطيب خوارزم،
فإنه مِن أَرْوَى الناس للمكذوبات، وليس هو من أهل العلم بالحديث، ولا
المغازلي.
قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه "الموضوعات" لما رَوى هذا
الحديث(52) من طريق أبي حاتم البستي، حدثنا محمد بن سهل بن أيوب، حدثنا
عمّار بن رجاء، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا مطر بن ميمون الإسكاف، عن
أنس(53) أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إن أخي ووزيري وخليفتي من
أهلي، وخير من أترك بعدي، يقضي دَيْني، وينجز موعدي: عليّ بن أبي
طالب"(54) قال: هذا حديث موضوع. قال ابن حبان: مطر بن ميمون يروي
الموضوعات عن الأثبات، لا تحل الرواية عنه".
رواه أيضاً من طريق
أحمد بن عدي بنحو هذا اللفظ، ومداره على عبيد الله بن موسى، عن مطر بن
ميمون، وكان عبيد الله بن موسى في نفسه صدوقاً روى عنه البخاري، لكنه
معروف بالتشيع، فكان لتشيعه يروي عن غير الثقات ما يوافق هواه، كما روى عن
مطر بن ميمون هذا، وهو كذب. وقد يكون علم أنه كَذَب ذلك، وقد يكون لهواه
لم يبحث عن كذبه، ولو بحث عنه لتبين له أنه كذب هذا، مع أنه ليس في اللفظ
الذي رواه هؤلاء المحدِّثون: "وخليفتي من بعدي" وإنما في تلك الطريق:
"وخليفتي في أهلي" وهذا استخلاف خاص.
وأما اللفظ الآخر الذي رواه ابن
عدي فإنه قال(55): "حدثنا ابن أبي سفيان(56)، حدثنا عدي(57) بن سهل، حدثنا
عبيد الله بن موسى، حدثنا مطر(58)، عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم: "عليّ أخي وصاحبي وابن عمي وخير من أترك من بعدي(59)، يقضي
دَيْني وينجز موعدي"(60).
ولا ريب أن مطراً هذا كذَّاب، لم يرو عنه أحد
من علماء الكوفة، مع روايته عن أنس، فلم يرو عنه يحيى بن سعيد القطّان،
ولا وكيع، ولا أبو معاوية، ولا أبو نُعيم، ولا يحيى بن آدم ولا أمثالهم،
مع كثرة مَنْ بالكوفة من الشيعة، ومع أن كثيراً من عوامّها يفضّل عليّاً
على عثمان، ويروي حديثه أهل الكتب الستة، حتى الترمذي وابن ماجه قد يرويان
عن ضعفاء، ولم يرووا عنه، وإنما روى عنه عبيد الله بن موسى، لأنه كان
صاحبَ هوى متشيعاً، فكان لأجل هواه يروي عن هذا ونحوه، وإن كانوا كذَّابين.
ولهذا لم يكتب أحمد عن عبيد الله بن موسى، بخلاف عبد الرزاق، وذكر أحمد أن عبيد الله(61) كان يظهر ما عنده بخلاف عبد الرزاق.
ومما
افتراه مطر هذا ما رواه أبو بكر الخطيب في "تاريخه" من حديث عبيد الله بن
موسى، عن مطر، عن أنس، قال: كنت عند النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فرأى
عليّاً مقبلاً، فقال: "أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة" قال ابن
الجوزي(62): "هذا حديث موضوع، والمتهم بوضعه مطر. قال أبو حاتم: يروي
الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه".
الوجه الثالث: أن دَيْن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يقضه عليّ بل في الصحيح أن النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير
ابتاعها لأهله(63)، فهذا الدين الذي كان عليه يُقضى من الرهن الذي رهنه،
ولم يُعرف عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم دَيْن آخر.
وفي الصحيح عنه
أنه قال: "لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركت بعدَ نفقة نسائي
ومؤنة عاملي فهو صدقة"(64)، فلو كان عليه دَيْن قُضِيَ مما تركه، وكان ذلك
مقدَّماً على الصدقة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
الفصل السادس
إثبات أن أحاديث المؤاخاة بين عليّ والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم كلها موضوعة
قال
الرافضي: "السادس: حديث المؤاخاة. روى أنس أن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم لما كان يوم المباهلة، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعليٌّ واقف
يراه ويعرفه، ولم يؤاخ بينه وبين أحد، فانصرف باكياً، فقال النبي صلَّى
الله عليه وسلَّم ما فعل أبو الحسن؟ قالوا: انصرف باكي العين، قال: يا
بلال اذهب فائتني به، فمضى إليه. ودخل منزله باكي العين فقالت له فاطمة ما
يبكيك؟ قال: آخى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بين المهاجرين والأنصار،
ولم يؤاخ بيني وبين أحد. قالت: لا يخزيك الله، لعله إنما ادخرك لنفسه.
فقال بلال: يا عليّ أجب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتى فقال: ما
يبكيك يا أبا الحسن؟ فأخبره، فقال: إنما أدّخرك لنفسي، ألا يسرك أن تكون
أخا نبيك؟ قال: بلى، فأخذه بيده، فأتى المنبر، فقال: اللهم هذا مني وأنا
منه، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه،
فانصرف فاتبعه عمر، فقال: بخٍ بخٍ يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل
مسلم. فالمؤاخاة تدل على الأفضلية، فيكون هو الإمام".
والجواب أولاً:
المطالبة بتصحيح النقل، فإنه لم يعزُ هذا الحديث إلى كتاب أصلاً، كما
عادته يعزو، وإن كان عادته يعزو إلى كتبٍ لا تقوم بها الحجة، وهنا أرسله
إرسالاً على عادة أسلافه شيوخ الرافضة، يكذبون يروون الكذب بلا إسناد، وقد
قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء،
فإذا سُئل: وقف وتحيّر.
الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث،
لا يرتاب أحد من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع(65)، وواضعه جاهل، كذب
كذباً ظاهراً مكشوفاً، يعرف أنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث، كما سيأتي
بيانه.
الثالث: أن أحاديث المؤاخاة لعليّ كلها موضوعة(66)، والنبي
صلَّى الله عليه وسلَّم لم يؤاخ أحدأً، ولا آخى بين مهاجري ومهاجري، ولا
بين أبي بكر وعمر ولا بين أنصاري وأنصاري، ولكن آخى بين المهاجرين
والأنصار في أول قدومه المدينة(67).
وأما المباهلة فكانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر من الهجرة.
الرابع:
أن دلائل الكذب على هذا الحديث بيّنة، منها: أنه قال: "لما كان يوم
المباهلة وآخى بين المهاجرين والأنصار". والمباهلة كانت لما قدم وفد نجران
النصارى، وأنزل الله سورة آل عمران، وكان ذلك في آخر الأمر سنة عشر أو سنة
تسع، لم يتقدم على ذلك باتفاق الناس والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم
يباهل النصارى، لكن دعاهم إلى المباهلة، فاستنظروه حتى يشتوروا، فلما
اشتوروا قالوا: هو نبيٌّ، وما باهل قومٌ نبيّاً إلا استؤصلوا، فأقرُّوا له
بالجزية، ولم يباهلوا، وهم أول من أقرّ بالجزية من أهل الكتاب، وقد اتفق
الناس على أنه لم يكن في ذلك اليوم مؤاخاة.
الخامس: أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت في السنة الأولى من الهجرة في دار بني النجار، وبين المباهلة وذلك عدة سنين.
السادس:
أنه كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار، والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم
وعليّ كلاهما من المهاجرين، فلم يكن بينهما مؤاخاة، بل آخى بين عليّ وسهل
بن حنيف، فعُلم أنه لم يؤاخ عليّاً، وهذا مما يوافق ما في الصحيحين من أن
المؤاخاة إنما كانت بين المهاجرين والأنصار، لم تكن بين مهاجري ومهاجري.
السابع:
أن قوله: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى" إنما قاله في غزوة
تبوك مرة واحدة، لم يقل ذلك في غير ذلك المجلس أصلاً باتفاق أهل العلم
بالحديث.
وأما حديث الموالاة فالذين رووه ذكروا أنه قاله بغدير خم مرة واحدة، لم يتكرر في غير ذلك المجلس أصلاً.
الثامن:
أنه تقدم الكلام على المؤاخاة، وأن فيها عموماً وإطلاقاً لا يقتضي
الأفضلية والإمامة، وأن ما ثبت للصّدّيق من الفضيلة لا يشركه فيه غيره،
كقوله: "لو كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً"،
وإخباره: أن أحب الرجال إليه أبو بكر، وشهادة الصحابة له أنه أحبهم إلى
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وغير ذلك مما يبين أن الاستدلال بما
روي عن المؤاخاة باطل نقلاً ودلالة.
التاسع: أن مِنَ الناس مَنْ يظن أن
المؤاخاة وقعت بين المهاجرين بعضهم مع بعض، لأنه روي فيها أحاديث، لكن
الصواب المقطوع به أن هذا لم يكن، وكل ما روي في ذلك فإنه باطل: إما أن
يكون من رواية مَنْ يتعمد الكذب، وإما أن يكون أخطأ فيه، ولهذا لم يخرج
أهل الصحيح شيئاً من ذلك.
والذي في الصحيح إنما هو المؤاخاة بين
المهاجرين والأنصار، ومعلوم أنه لو آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبين
الأنصار بعضهم مع بعض، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، ولكان
يذكر في أحاديث المؤاخاة، ويذكر كثيراً، فكيف وليس في هذا حديث صحيح، ولا
خرَّج أهل الصحيح من ذلك شيئاً.
وهذه الأمور يعرفها مَنْ كان له خبرة
بالأحاديث الصحيحة والسيرة المتواترة، وأحوال النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم، وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودها، وأنهم كانوا يتوارثون بذلك،
فآخى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بين المهاجرين والأنصار، كما آخى بين
سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء،
ليعقد الصلة بين المهاجرين والأنصار، حتى أنزل الله تعالى: { وَأُوْلُواْ
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [الأنفال:
75] وهي المحالفة التي أنزل الله فيها: { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [النساء: 33](68).
وقد
تنازع الفقهاء: هل هي محكمة يورث بها عند عدم النسب أو لا يورث بها؟ على
قولين، هما روايتان عن أحمد، الأول: مذهب أبي حنيفة، والثاني: مذهب مالك
والشافعي.
الفصل السابع
الرد على من يثبت الإمامة لعليّ بقوله إنه اختص بحب الله ورسوله دون غيره
قال
الرافضي: السابع: ما رواه الجمهور كافة أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
لما حاصر خيبر تسعاً وعشرين ليلة، وكانت الراية لأمير المؤمنين عليّ،
فلحقه رمد أعجزه عن الحرب، وخرج مرحب يتعرض للحرب، فدعا رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم أبا بكر، فقال له: خذ الراية، فأخذها في جمع من
المهاجرين، فاجتهد ولم يغن شيئاً، ورجع منهزماً، فلما كان من الغد تعرَّض
لها عمر، فسار غير بعيد، ثم رجع يخبر أصحابه، فقال النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم: جيئوني بعليّ، فقيل: إنه أرمد، فقال: أرونيه أروني رجلاً يحب الله
ورسوله، ويحبه الله ورسوله، ليس بفرَّار، فجاءوا بعليّ، فتفل في يده
ومسحها على عينيه ورأسه فبرئ، فأعطاه الراية، ففتح الله على يديه، وقتل
مرحباً، ووَصْفُهُ عليه السلام بهذا الوصف يدل على انتفائه عن غيره، وهو
يدل على أفضليته، فيكون هو الإمام".
والجواب من وجوه:
أحدها:
المطالبة بتصحيح النقل. وأما قوله: "رواه الجمهور" فإن الثقات الذين رووه
لم يرووه هكذا، بل الذي في الصحيح أن عليّاً كان غائباً عن خيبر، لم يكن
حاضراً فيها، تخلّف عن الغزاة لأنه كان أرمد، ثم إنه شقَّ عليه التخلف عن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فلحقه، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
قبل قدومه: "لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله،
يفتح الله على يديه". ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر، ولا
قربها واحد منهما، بل هذا من الأكاذيب، ولهذا قال عمر: "فما أحببت الإمارة
إلا يومئذ، وبات الناس كلهم يرجون أن يُعطاها، فلما أصبح دعا عليّاً، فقيل
له: إنه أرمد، فجاءه فتفل في عينيه حتى برأ، فأعطاه الراية".
وكان هذا
التخصيص جزاء مجيء عليّ مع الرمد، وكان إخبار النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم بذلك وعليّ ليس بحاضر لا يرجونه من كراماته صلَّى الله عليه
وسلَّم، فليس في الحديث تنقيص بأبي بكر وعمر أصلاً.
الثاني: أن إخباره
أن عليّاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حق، وفيه رد على النواصب،
لكن الرافضة الذين يقولون: إن الصحابة ارتدوا بعد موته لا يمكنهم
الاستدلال بهذا، لأن الخوارج تقول لهم: هو ممن ارتد أيضاً، كما قالوا
لَمّا حكم الحكمين: إنك قد ارتددت عن الإسلام فعد إليه.
قال الأشعري في كتاب "المقالات"(69): "أجمعت الخوارج على كفر عليّ"(70).
وأما
أهل السنة فيمكنهم الاستدلال على بطلان قول الخوارج بأدلة كثيرة، لكنها
مشتركة تدل على إيمان الثلاثة، والرافضة تقدح فيها، فلا يمكنهم إقامة دليل
على الخوارج على أن عليّاً مات مؤمناً، بل أي دليل ذكروه قدح فيه ما يبطله
على أصلهم، لأن أصلهم فاسد.
وليس هذا الوصف نم خصائص عليّ، بل غيره
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكن فيه الشهادة لعينه بذلك، كما شهد
لأعيان العشرة بالجنة، وكما شهد لثابت بن قيس بالجنة، وشهد لعبد الله حمار
بأنه يحب الله ورسوله، وقد كان ضربه في الحد مرات.
وقول القائل: "إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره".
فيه جوابان:
أحدهما:
أنه إن سلَّم ذلك، فإنه قال: "لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه
الله ورسوله، يفتح الله على يديه"، فهذا المجموع اختصّ به، وهو أن ذلك
الفتح كان على يديه، ولا يلزم إذا كان ذلك الفتح المعين على يديه أن يكون
أفضل من غيره، فضلاً عن أن يكون مختصاً بالإمامة.
الثاني: أن يقال: لا
نسلِّم أن هذا يوجب التخصيص. كما لو قيل: لأعطين هذا المال رجلاً فقيراً،
أو رجلاً صالحاً، ولأدعون اليوم رجلاً مريضاً صالحاً، أو لأعطين هذه
الراية رجلاً شجاعاً، ونحو ذلك، لم يكن في هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك
الصفة لا توجد إلا في واحد، بل هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك.
ولهذا
لو نذر أن يتصدق بألف درهم على رجل صالح أو فقير، فأعطى هذا المنذر
لواحدٍ، لم يلزم أن يكون غيره ليس كذلك، ولو قال: أعطوا هذا المال لرجل قد
حجَّ عني، فأعطوه رجلاً، لم يلزم أن غيره لم يحج عنه.
الثالث: أنه لو قُدِّر ثبوت أفضليته في ذلك الوقت، فلا يدل ذلك على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك.
الرابع:
أنه لو قدَّرنا أفضليته، لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم منصوص عليه، بل
كثير من الشيعة الزيدية ومتأخري المعتزلة وغيرهم يعتقدون أفضليته، وأن
الإمام هو أبو بكر، وتجوز عندهم ولاية المفضول. وهذا مما يجوزه كثير من
غيرهم، ممن يتوقف في تفضيله بعض الأربعة على بعض، أو ممن يرى أن هذه
المسألة ظنية لا يقوم فيها دليل قاطع على فضيلة واحدٍ معين، فإن من لم يكن
له خبرة بالسنة الصحيحة قد يشك في ذلك.
وأما أئمة المسلمين
المشهورين فكلهم متفقون على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان وعليّ، ونقل
هذا الإجماع غيرُ واحد، كما روى البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي" - مسنده
عن الشافعي - قال: "ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر
وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة"(71).
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر
قال: "كنا نفاضل على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فنقول: خير
الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبو بكر ثم عمر"(72).
وقد تقدم نقل البخاري عن عليّ هذا الكلام.
والشيعة
الذين صحبوا عليّاً كانوا يقولون ذلك، وتواتر ذلك عن عليّ من نحو ثمانين
وجهاً. وهذا مما يقطع به أهل العلم، ليس هذا مما يخفى على مَنْ كان عارفاً
بأحوال الرسول والخلفاء.
الفصل الثامن
إثبات أن حديث الطير من المكذوبات الموضوعات
قال
الرافضي: "الثامن: خبر الطائر. روى الجمهور كافة أن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم أُتِيَ بطائر، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإليّ يأكل معي من
هذا الطائر، فجاء عليّ، فدق الباب، فقال انس: إن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم على حاجة، فرجع. ثم قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما قال
أولاً، فدق الباب، فقال أنس: ألم أقل لك إنه على حاجة؟ فانصرف، فعاد النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم، فعاد عليّ فدق الباب أشد من الأولين، فسمعه النبي
صلَّى الله عليه وسلَّم، فأذن له بالدخول، وقال: ما أبطأك عني؟ قال: جئت
فردني أنس، ثم جئت فردني أنس، ثم جئت فردني الثالثة، فقال: يا أنس ما حملك
على هذا؟ فقال: رجوت أن يكون الدعاء لرجل من الأنصار، فقال: يا أنس أوَ في
الأنصار خير من عليّ؟ أوَ في الأنصار أفضل من عليّ؟ فإذا كان أحب الخلق
إلى الله، وجب أن يكون هو الإمام".
والجواب من وجوه: أحدها:
المطالبة بتصحيح النقل. وقوله: "روى الجمهور كافة" كذب عليهم؛ فإن حديث
الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح، ولا صححه أئمة الحديث، ولكن هو مما
رواه بعض الناس، كما رووا أمثاله في فضل غير عليّ، بل قد رُوي في فضائل
معاوية أحاديث كثيرة، وصُنِّف في ذلك مصنفات. وأهل العلم بالحديث لا
يصححون لا هذا ولا هذا.
الثاني: أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات
عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل(73). قال أبو موسى المديني: "قد جمع
غير واحد من الحفَّاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة، كالحاكم
النيسابوري، وأبي نُعيم، وابن مردويه. وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا
يصح".
هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع، وقد طُلب منه أن يروي حديثاً
في فضل معاوية فقال: ما يجيء من قلبي، ما يجيء من قلبي، وقد ضربوه على ذلك
فلم يفعل. وهو يروي في "الأربعين" أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة
الحديث، كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، لكن تشيعه وتشيع
أمثاله من أهل العلم بالحديث، كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما، لا يبلغ
إلى تفضيله على أبي بكر وعمر، فلا يُعرف في علماء الحديث من يفضِّله
عليهما، بل غاية المتشيع منهم أن يفضّله على عثمان، أو يحصل منه كلام أو
إعراض عن ذكر محاسن من قاتله ونحو ذلك، لأن علماء الحديث قد عصمهم وقيدهم
ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية الشيخين، ومن ترفّض ممن
له نوع اشتغال بالحديث، كابن عُقدة وأمثاله، فهذا غايته أن يجمع ما يُروي
في فضائله من المكذوبات والموضوعات، لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل
الشيخين، فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر مما صح في فضائل عليّ وأصح
وأصرح في الدلالة.
وأحمد بن حنبل لم يقل: إنه صحّ لعليّ من الفضائل
ما لم يصح لغيره، بل أحمد أجلّ من أن يقول مثل هذا الكذب، بل نُقل عنه أنه
قال: "رُوي له ما لم يُرو لغيره" مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاماً ليس هذا
موضعه.
الثالث: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق
إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبرّ والفاجر، وليس في ذلك
زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل، ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا، فأي
أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله؟!
الرابع: أن هذا
الحديث يناقض مذهب الرافضة؛ فإنهم يقولون: إن النبي صلَّى الله عليه
وسلَّم كان يعلم أن عليّاً أحب الخلق إلى الله، وأنه جعله خليفة من بعده.
وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله.
الخامس: أن
يقال: إما أن يكون النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يعرف أن عليّاً أحب
الخلق إلى الله، أو ما كان يعرف. فإن كان يعرف ذلك، كان يمكنه أن يرسل
يطلبه، كما كان يطلب الواحد من الصحابة، أو يقول: اللهم ائتني بعليّ فإنه
أحب الخلق إليك، فأي حاجة إلى الدعاء والإبهام في ذلك؟! ولو سَمَّى عليّاً
لاستراح أنس من الرجاء الباطل، ولم يغلق الباب في وجه عليّ.
وإن كان
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يعرف ذلك، بطل ما يدّعونه من كونه كان
يعرف ذلك. ثم إن في لفظه: "أحب الخلق إليك وإليّ" فكيف لا يعرف أحب الخلق
إليه؟!
السادس: أن الأحاديث الثابتة في الصحاح، التي أجمع أهل الحديث
على صحتها وتلقّيها بالقبول، تناقض هذا، فكيف تعارض بهذا الحديث المكذوب
الموضوع الذي لمي صححوه؟!
يبيّن هذا لكل متأملٍ ما في صحيح البخاري
ومسلم وغيرهما من فضائل القوم، كما في الصحيحين أنه قال: "لو كنت متخذاً
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً". وهذا الحديث مستفيض، بل
متواتر عند أهل العلم بالحديث؛ فإنه قد أخرج في الصحاح من وجوه متعددة، من
حديث ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير، وهو صريح في أنه لم يكن
عنده من أهل الأرض أحد أحب إليه من أبي بكر؛ فإن الخلة هي كمال الحب، وهذا
لا يصلح إلا لله، فإذا كانت ممكنة، ولم يصلح لها إلا أبو بكر، عُلم أنه
أحب الناس إليه.
وقوله في الحديث الصحيح لما سئل: "أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة" قيل: من الرجال؟ قال: "أبوها".
وقول الصحابة: "أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم" يقوله عمر بين المهاجرين والأنصار، ولا ينكر ذلك منكر.
وأيضاً فالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم محبته تابعة لمحبة الله، وأبو بكر أحبهم إلى الله تعالى، فهو أحبهم إلى رسوله.
وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم وأكرمهم، وأكرم الخلق على الله تعالى أتقاهم بالكتاب والسنة.
وإنما
كان أتقاهم لأن الله تعالى قال: { وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى، الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ
تُجْزَى، إِلاّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى
} [الليل: 17-21].
وأئمة التفسير يقولون: إنه أبو بكر(74).
ونحن
نبيّن صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعاً وقد يكون شخصاً.
وإذا كان نوعاً فهو يجمع أشخاصاً. فإن قيل: إنهم ليس فيهم شخص هو أتقى،
كان هذا باطلاً، لأنه لا شك أن بعض الناس أتقى من بعض، مع أن هذا خلاف قول
أهل السنة والشيعة، فإن هؤلاء يقولون: إن أتقى الخلق بعد رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم من هذه الأمة هو أبو بكر، وهؤلاء يقولون: هو عليّ. وقد
قال بعض الناس: هو عمر. ويُحكى عن بعض الناس غير ذلك. ومن توقف أو شَكَّ
لم يقل: إنهم مستوون في التقوى. فإذا قال: إنهم متساوون في الفضل، فقد
خالف إجماع الطوائف. فتعين أن يكون هذا أتقى.
وإن كان الأتقى شخصاً،
فإما أن يكون أبا بكر أو عليّاً. فإنه إذا كان اسم جنس يتناول من دخل فيه،
وهو النوع، وهو القسم الأول، أو معيناً غيرهما. وهذا القسم منتف باتفاق
أهل السنة والشيعة، وكونه عليّاً باطل أيضاً لأنه قال: { الَّذِي يُؤْتِي
مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، إِلاّ
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى } [الليل:
17-21].
وهذا الوصف منتف في عليّ لوجوه:
أحدها: أن هذه السورة مكية
بالاتفاق، وكان عليٌّ فقيراً بمكة في عيال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم،
ولم يكن له مالٌ ينفق عنه، بل كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد ضمّه
إلى عياله لما أصابت أهل مكة سنة.
الثاني: أنه قال: { وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى } [الليل: 19].
وعليّ
كان للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم عنده نعمة تجزى، وهو إحسانه إليه لما
ضمه إلى عياله. بخلاف أبي بكر؛ فإنه لم يكن له عنده نعمة دنيوية، لكن كان
له عنده نعمة الدين، وتلك لا تُجزى؛ فإن أجر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
فيها على الله، لا يقدر أحد يجزيه. فنعمة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم
عند أبي بكر دينية لا تجزى، ونعمته عند عليّ دنيوية تجزى، ودينية.
وهذا الأتقى ليس لأحد عنده نعمة تُجزى، وهذا الوصف لأبي بكر ثابت دون عليّ.
فإن
قيل: المراد به أنه أنفق ماله لوجه الله، لا جزاء لمن أنعم عليه. وإذا
قُدِّر أن شخصاً أعطى من أحسن إليه أجراً، وأعطى شيئاً آخر لوجه الله، كان
هذا مما ليس لأحد عنده من نعمة تجزى.
قيل: هب أن الأمر كذلك، لكن عليّ
لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره به النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، والنبي
له عنده نعمة تجزى، فلا يخلص إنفاقه عن المجازاة، كما يخلص إنفاق أبي بكر.
وعليّ
أتقى من غيره، لكن أبا بكر أكمل في وصف التقوى، مع أن لفظ الآية أنه ليس
عنده قط لمخلوق نعمة تُجزى. وهذا وصف من يجازي الناس على إحسانهم إليه،
فلا يبقى لمخلوق عليه منّة. وهذا الوصف منطبق على أبي بكر انطباقاً لا
يساويه فيه أحد من المهاجرين؛ فإنه لم يكن في المهاجرين: - عمر وعثمان
وعليّ وغيرهم - رجل أكثر إحساناً إلى الناس، قبل الإسلام وبعده، بنفسه
وماله من أبي بكر. كان مؤلّفاً محبباً يعاون الناس على مصالحهم، كما قال
فيه ابن الدُّغُنَّة سيد القارة لما أراد أن يخرج من مكة: "مثلك يا أبا
بكر لا يَخْرُج ولا يُخْرَج؛ فإنك تحمل الكل، وتُقري الضيف، وتكسب
المعدوم، وتعين على نوائب الحق"(75).
وفي صلح الحديبية لما قال لعروة
بن مسعود: "امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال لأبي بكر: لولا يَدٌ
لك عندي لم أجزك بها لأجبتك"(76).
وما عُرف قط أن أحداً كانت له يدٌ
على أبي بكر في الدنيا، لا قبل الإسلام ولا بعده، فهو أحق الصحابة: {
وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى } فكان أحق الناس بالدخول في
الآية.
وأما عليّ رضي الله عنه فكان للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم عليه
نعمة دنيوية. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يَسْقُط السوط
من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه. ويقول: إن خليلي أمرين أن لا أسال
الناس شيئاً(77).
وفي المسند والترمذي وأبي داود حديث عمر، قال عمر:
"أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن نتصدّق، فوافق ذلك مالاً
عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي. فقال
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "ما أبقيت لأهلك"؟ فقلت: مثله. قال:
وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: "ما أبقيت لأهلك"؟ قال: أبقيت لهم الله
ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً".
فأبو بكر رضي الله عنه جاء
بماله كله، ومع هذا فلم يكن يأكل من أحد: لا صدقةً ولا صلةً ولا نذراً، بل
كان يتجر ويأكل من كسبه، ولما وَلِيَ الناس واشتغل عن التجارة بعمل
المسلمين أكل من مال الله ورسوله الذي جعله الله له، لم يأكل من مال مخلوق.
وأبو
بكر لم يكن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يعطيه شيئاً من الدنيا يخصه به،
بل كان في المغازي كواحد من الناس، بل يأخذ من ماله ما ينفقه على
المسلمين. وقد استعمله النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وما عُرف أنه أعطاه
عمالة، وقد أعطى عمر عمالة وأعطى عليّاً من الفيء، وكان يعطي المؤلّفة
قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا
يعطيهم، كما فعل في غنائم حُنين وغيرها، ويقول: "إني لأعطي رجالاً وأدع
رجالاً، والذي أدع أحب إليّ من الذي أعطي. أعطي رجالاً لما في قلوبهم من
الجزع والهلع، وأكل رجالاً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى
والخير"(78).